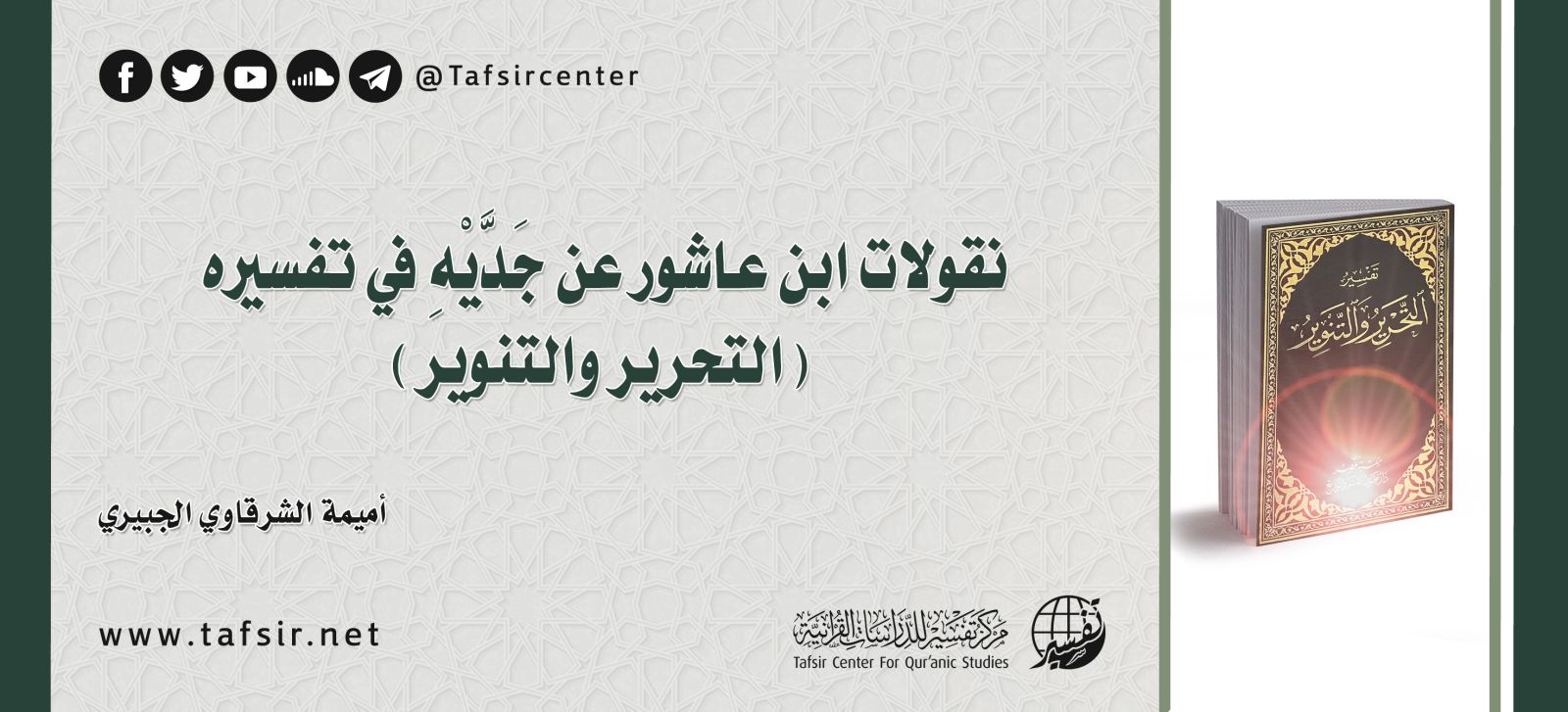النقد المنهجي للإسرائيليات عند ابن عطية: أنموذج تحليلي لكيفية النقد وإجراءاته
أنموذج تحليلي لكيفية النقد وإجراءاته
الكاتب: محمد صالح سليمان

النقد المنهجي للإسرائيليات عند ابن عطية
أنموذج تحليلي لكيفية النقد وإجراءاته[1]
توطئة:
إنّ النقد لا يُحْكَم عليه بكونه نقدًا على الحقيقة إلا حينما تمرُّ العملية النقدية بمخاض عسير، وتتجاوز عقبات كؤود: عقبة الفهم الصحيح للأقوال والمسائل والآراء على ضوء أصولها التي قامت عليها، وسياقها الذي سيقت فيه، وزمانها الذي قيلت فيه، وقائلها الذي صدرت عنه، ومكانها الذي انطلقت منه، وعقبة التحليل العميق لتلك الأقوال؛ بدراسة مكوناتها، وتفكيك جزئيّاتها، ومراقبة كيفيات تركيبها، ورَصْد المؤثّرات الداخلية والخارجية المحيطة بها، وعقبة الحكم النقدي القائم على مراعاة كلّ التفاصيل، والمدرك لتفاوت هذا الحكم بل وتضاده أحيانًا بين أجزاء الشيء الواحد بحسب ما يعرض لها من أحوال ومقامات، وعقبة العلل التي تأسّس عليها الحكم النقدي، والمستندات والأدلة التي استند إليها.
وهذه العقبات لا يمكن لأيّ ناقدٍ أن يتخطّاها ثم ينتسب للنقد؛ لأنها أركان لا بد منها لتخَلُّق النقد وتكوُّن دائرته، وليست نوافل يمكن وجود النقد المنهجي الصحيح بدونها.
ومَنْ تأمَّل تراث المفسرين المحقِّقين وجدَ ذلك ماثلًا في كثيرٍ من انتقاداتهم واستدراكاتهم، بخلافِ كثيرٍ من المواقف النقديّة المعاصرة التي يغلب عليها النقد المُجمَل دون التزام الإجراءات اللازمة لتصحيح النقد، ولكونه نقدًا منهجيًّا، كما نرى ذلك حاضرًا مثلًا في النقد المجمل للإسرائيليات من قِبَل كثيرٍ من المعاصرين.
إنّ النقد الذي يمارسه البعض وهو مغمض العينَيْنِ وباسط القَدَمَيْن، بدعوى أنّ أمثال تلك المسائل المنتقَدة من المسلَّمات والبدهيّات -هو ذاته يفتقر إلى المسلَّمات والبدهيات النقديّة، وقد وقعَتْ عيناي في تفسير ابن عطية على نموذج لبعض ما ننتقده بكونه من الخرافات وننادي بتنقية التفاسير منه، وصار بُطلانه عندنا من المسلَّمَات، حتى إن بعضنا قد ينتقده وهو متكئ على أريكته، ورأيتُ في المقابل كدح عقل ابن عطية فيه، وصولة ذهنه في أرجائه، ومعاناته في معالجته؛ مما جعلني أقف أمامه متأملًا ومتملِّيًا لاستكشاف منهجية الإمام في نقده، وتحليل عقليته في التعامل معه، ولأتبيَّن الطريقة التي يسلكها العلماء في النقد، والآليات والإجراءات التي يتبعونها في التعامل، لا لشيء سوى لأعرف المنهج العلمي الذي يجب التزامه في النقد، واتِّباعه في التعامل مع الأقوال والمسائل، والذي إن اتَّبعناه كنّا سائرين على جادَّة النقد وطريقه، وإن فارقناه كنّا منحرفين تمامًا عن منهج النقد وطريقه وإن ادَّعَيْنا أننا نمارسه ونُتقنه.
وإني أستميح القارئ الكريم عذرًا في الصبر على قراءة ذلك النموذج لأجل تأمُّل صنيع ابن عطية، وإن كنتُ أعرف أنّ صبره عليه شاقّ لكونه عند الكثير لا يستحقّ ذلك العناء وذلك التطويل؛ إذ هو بادئ ذي بدء -من وجهة نظر كثير من المعاصرين- مجرّد خرافات وخزعبلات ينبغي أن يتنزّه التفسير عنها.
لكنِ المقصودُ من دراسة هذا النموذج بشكلٍ تطبيقي تحليلُ العقلية النقديّة عند ابنِ عطيَّة، برصد حركتِها، وتتبُّعِ سيرها، ومراقبة خَطْوِها بُغية الوصول إلى كيفية صناعته للنقد، وتعلّم كيفية ممارسته، واستخلاص الإرشادات اللازمة لعملية النقد لتكون نبراسًا يُقتَدى، ونموذجًا يُحتذَى، ولن يحصُل هذا إلا بمحاولة الولوج إلى داخل فكرِه، والغوص في أعماق عقله، وتتبع تسلسل فكره، وهي مهمّة شاقة تستلزم استنطاق النموذج المدروس، وفحص زواياه، واستخراج خباياه قدر الطاقة.
وقد سرتُ في معالجة ذلك النموذج على الخطوات التالية:
1- ذِكْر الآية أو الآيات التي اندرج تحتها ذلك النموذج المختار.
2- سوق كلام الإمام ابن عطيَّة بنصِّه.
3- العرض التحليلي لصنيع ابن عطيَّة، وتحليل مكوناته، وذكر الاستفسارات حوله، والتنبيه على الدروس العملية فيه.
4- بيان الإجراءات والخطوات النقديّة التي سلكها ابن عطيَّة في معالجته للنموذج.
5- ذِكر خلاصة الدراسة للنموذج ببيان الإرشادات النقديّة المستفادة منه.
النموذج
قال تعالى: {وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ * فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ * فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ * فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ}[الأنعام: ٧٥- ٧٨].
قال الإمام ابن عطيَّة -رحمه الله-:
«ولفظ هذه القصة يَحتَمل أن تكون وقعَتْ له في حال صِباه وقبل بلوغه، كما ذهب إليه ابن عباس، فإنه قال: رأى كوكبًا فعبَده، وقاله ناسٌ كثيرٌ: إنّ النازلة قبل البلوغ والتكليف.
ويَحتَمل أن تكون وقعَتْ له بعد بلوغه، وكونه مكلَّفًا، وحكى الطبريُّ هذا عن جماعة، وقالت: إنه استفهم على جهة التوقيف بغير أَلِف... وقد حُكِي أن نمرود جبّار ذلك الزمن رأى منجِّموه أن مولودًا يولد في سنة كذا في عمله، يكون خراب المُلْك على يديه، فجعل يتَّبع الحَبالى ويُوكِل بهنّ حُرَّاسًا، فمَن وضعَتْ أنثى تُرِكَت، ومن وضعَتْ ذكرًا حُمِلَ إلى الـمَلِك فذبحه، وأنَّ أمَّ إبراهيم حملَتْ، وكانت شابة قوية، فسترت حملها، فلما قَرُبَت ولادتها بعثَتْ (تارخ) أبا إبراهيم إلى سَفر، وتحيَّلت لِمُضِيِّه إليه، ثم خرجت هي إلى غار فولدت فيه إبراهيم، وتركته في الغار وقد هيَّأت عليه، وكانت تتفقّده، فتجده يغتذي بأن يمصّ أصابعه فيخرج له منها عسل وسمن ونحوها، وحُكِي: بل كان يغذيه مَلَكٌ، وحُكي: بل كانت تأتيه بألبان النساء اللاتي ذُبح أبناؤهن، فشَبَّ إبراهيم أضعاف ما يشِبُّ غيره، والمَلِك في خلال ذلك يحسّ بولادته، ويشدّد في طلبه، فمكث في الغار عشرة أعوام، وقيل: خمس عشرة سنة، وأنه نَظرَ أوَّل ما عَقَلَ من الغار فرأى الكوكب، وجَرَت قصة الآية.
قال القاضي أبو محمد: وجلبْتُ هذه القصص بغاية الاختصار في اللفظ، وقصدتُ استيفاء المعاني التي تخصُّ الآية، ويَضعُفُ عندي أن تكون هذه القصة في الغار، لقوله في آخرها: {إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ}[الأنعام: 78]، وهي ألفاظ تقتضي مُحاجَّةً وردًّا على قوم، وحاله في الغار بعيدة عن مثل هذا؛ اللهمَّ إلا أن يُتَأوَّل في ذلك أنه قالها بَيْـنَه وبَيـنَ نفسه، أي قال في نفسه معنى العبارة عنه: {يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ}، وهذا كما قال الشاعر:
ثم انثنى وقال في التّفكير إنّ الحياة اليوم في الكرور[2]
قال القاضي أبو محمد: ومع هذا فالمخاطَبة تُبعِدُه، ولو قال: (يا قوم إني بريء من الإشراك) لصحَّ هذا التأويل وقَوِي، فإن قلنا بأنه وقعت له القصة في الغار في حال الصَّبْوة وعدم التكليف، على ما ذهب إليه بعض المفسرين ويحتمله اللفظ، فذلك ينقسم على وجهين:
إما أن يُجعَل قوله: {هَذَا رَبِّي} تصميمًا واعتقادًا، وهذا باطل؛ لأن التصميم لم يقع من الأنبياء صلوات اللّه عليهم، وإما أن يجعله تعريضًا للنظر والاستدلال، كأنه قال: (هذا المنيرُ البهيُّ ربي إنْ عضَّدَتْ ذلك الدلائلُ)، ويجيء إبراهيم -عليه السلام- كما قال اللّه تعالى لمحمد -صلى الله عليه وسلم-: {وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى}[الضحى: 7]، أي: مهمل المعتقَد.
وإن قلنا بأن القصة وقعَتْ له في حال كفره وهو مكلَّف، فلا يجوز أن يقول: {هَذَا رَبِّي} مصمِّمًا ولا معرضًا للنظر؛ لأنها رتبة جهل أو شك، وهو -عليه السلام- مُنزَّه معصوم من ذلك كلِّه، فلم يبق إلا أن يقولَها على جهة التقرير لقومه والتوبيخ لهم وإقامة الحجة عليهم في عبادة الأصنام، كأنه قال لهم: (أهذا المنير ربي؟)، أو {هَذَا رَبِّي} وهو يريد: على زَعْمِكم، كما قال اللّه تعالى: {أَيْنَ شُرَكَائِي}[النحل: ٢٧]، فإنما المعنى: على زعمكم. ثم عرَض إبراهيم عليهم من حركته وأُفوله أَمارةَ الحدوث، وأنه لا يصلح أن يكون ربًّا، ثم في آخرَ أعظمَ منه وأحرى كذلك، ثم في الشمس كذلك، فكأنَّه يقول: (فإذا بَانَ في هذه المنيرات الرفيعة أنها لا تَصلُح للربوبية، فأصنامكم التي هي خشب وحجارة أَحرَى أن يَبِينَ ذلك فيها)، ويُعضِّد عندي هذا التأويلَ قولُه:{إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ}[الأنعام: ٧٨]»[3].
دراسة النموذج:
أولًا: العرض التحليلي:
تَنَاوَلَ ابنُ عطيَّة الآيات التي تُبيِّن وقوعَ المُحاجَّة بين إبراهيم وقومه على النحو التالي:
1- بيَّن أن ألفاظ القصة تحتمل أحد أمرَين في وقت وقوع هذه المحاجة لإبراهيم:
أ) فإما أن تكون وقعَتْ في حال صِباه وعدم تكليفه.
ب) وإما أن تكون وقعَتْ بعد تكليفه.
ثم نسب كلّ احتمال من هذين الاحتمالَين إلى قائله.
2- أَتْبَعَ ذلك بجَلْبِ بعض الأخبار المنقولة في تفاصيل القصة وبعض ما احتفَّ بها، مما مفادُه أنّ نمرودَ -مَلِك الناسِ في هذا الوقت- أُخبِرَ بأنَّ ضياع مُلْكه سيكون على يدِ مولود يولد في ذلك الزمان، فأمَرَ بقَتْل كلِّ مولودٍ ذَكَرٍ، فأخفَتْ أمُّ إبراهيم-عليه السلام- حَمْلَها حتى آلَ الأمْرُ أنْ ولدَتْ إبراهيم -عليه السلام- في الغار، إلى أن انتهى إلى أنَّ إبراهيم -عليه السلام- مكث في الغار عشرة أعوام أو خمس عشرة سنة، وأنه نَظَرَ أول ما عَقَلَ من الغار فرأى الكواكب، وجرَتْ قصة الآية.
3- أردَفَ ذلك بتعليق يُبيِّن منهجيَّته في إيراد مثل تلك القصص والأخبار وأنه يختصر منها الكثير، وأن منهجيته في الاختصار تقوم على انتقاء واستيفاء المعاني التي تخصُّ الآية، وتَرْك ما سوى هذا مما لا يخصُّ الآية.
4- تلا ذلك تضعيفُهُ كون هذه القصة في الغار، لقوله تعالى: {يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ}[الأنعام: 78]، فألفاظ هذا الجزء من الآية تقتضي أنّ هناك تخاطبًا ومحاورة، والخبر المنقول يقتضي أنّ حاله في الغار بعيدة تمامًا عن المحاورة والمجادلة والتخاطب.
5- أشار إلى تأويل يمكن فيه الجمع بين ألفاظ الآية التي ظاهرها الدلالة على التخاطب وبين احتمال كون القصة في الغار، وذلك أن يُحمَل قوله: {يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ}[الأنعام: 78]،على أنه قال هذه العبارة وردَّدها في نفسه، ولم يكن ثَمَّ مخاطبةٌ ولا تحاورٌ.
6- دلَّلَ على وجاهة ذلك التأويل المُلْتَمَس من حيث اللغة، واستدلّ عليه ببيت من الشّعر.
7- استبعَدَ ذلك التأويل المُلْتَمَس من حيث كونه لا يتماشى مع دلالة السياق الدالة على التخاطب والتحاور، فقال: «ومع هذا فالمخاطَبة تُبعِدُه»[4].
8- بيَّن أنّ هذا التأويل كان يمكن قبوله لو كانت الألفاظ الواردة في الآية خالية من الدلالة على التخاطب والتحاور، فقال: «ولو قال: (يا قوم إني بريء من الإشراك)، لصحَّ هذا التأويل وقَوِي»[5].
9- أراد حصر الاحتمالات العقلية في توجيه مقالة إبراهيم -عليه السلام- ومحاوراته مع قومه فذكر عدّة احتمالات، واعتبر قصة الغار مقارنة لأحد هذه الاحتمالات، فقال: «فإن قلنا بأنه وقعَتْ له القصة في الغار في حال الصَّبوة وعدم التكليف، على ما ذهب إليه بعضُ المفسّرين ويحتمله اللفظ، فذلك ينقسم على وجهين»[6]، ثم ذَكَر الوجهين[7]. والشاهد هنا في ذِكْرِه لقصة الغار مع أحد هذه الاحتمالات رغم ما سبق من تضعيفه للارتباط بينها وبين الآيات.
والمتأمل في صنيع ابن عطيَّة النقدي في هذا المثال يظهر له ما يلي:
1- ابتدأ ببيان أنّ وقت وقوع قصة المحاجَّة لإبراهيم -عليه السلام- يُحتمَل أن تكون وقعَتْ في صِباه، أو يُحتمَل أن تكون وقعَتْ بعد تكليفه، وفي ذِكْرِه للاحتمال الأول تمهيد وتأسيس لما سيأتي بعد من القصص المروية التي اختصرها وانتقد بعض ما فيها، تلك القصص التي يفيد مجموعها حدوث تلك القصة لإبراهيم -عليه السلام- في حال صِباه.
وفي ذِكْر الإمام ابن عطيَّة لتلك الاحتمالات قبل التعرُّض لانتقاد ما تعلَّق بها إشارةٌ منه للمنهجيّة التي ينبغي على الناقد اتِّباعها في هذا الباب، وهي التأسيس لانتقاد القصة أو المعنى بذِكْرِ الأساس الذي بُنِيَ عليه، وبيان الأصل الذي قام عليه أوَّلًا، حتى يَسهُل تصوّر انتقاده ويُعْرَف مبناه وتُدْرَك غايته؛ إذ لا يصحّ انتقاد الفرع قبل معرفة الأصل.
2- أورد القصص التي نقلها بصيغة المبني للمفعول (التمريض) دون نسبة لأحد، وهي صيغة لا تعطي الثقة فيما ينقله ولا التكذيب له، وفي هذا فائدتان:
الأُولى: أهمية التفنُّن في طريقة عرض الأقوال، والإبداع في إيراد المعاني، فلكلّ مقام طريقة تتناسب معه في إيراد الأقوال المتعلّقة به، فما يليق بمقام الاختيار والترجيح لا يليق بمقام الإبطال والتضعيف، وكذا لا يليق بمقام التردّد والتوقّف، والناقد الحاذق يراعِي اختلاف المقامات فيغاير في العبارات، وينوِّع بين المصطلحات، كُلٌّ بحسب مقامه وحاله، بحيث يصل الإبداعُ في عرض الأقوال ذروتَه، والتفنُّنُ في إيراد المعاني غايتَه، إلى أن تكون طريقة عَرْض الأقوال نفسها نقدًا يكاد يُفصِح عن مكنونات الناقد ورؤيته تجاه الأقوال المنقولة، ويُغنيه عن التطويل والاحتياج إلى كثيرٍ من الجُمَلِ التي يتضح بها مراده، وتَبْرُزُ من خلالها وجهة انتقاده.
الثانية: التأنّي في نقد الأقوال وعدم التعجُّل بقَبُول قولٍ أو رَدِّه قبل ثبوت الأدلة الكافية للجزم بقبوله أو ردِّه، فإن لم يَقُم لدى الناقد أدلةٌ تدفع للجزم بالقبول، أو الجزم بالردِّ، أو الحكم بغَلَبة الظنّ، كان التوقّف والسكوت عن القول، وعدم القطع بقبوله أو ردِّه هو المسلك الصحيح الذي يسلكه الناقد.
3- أَوْرَدَ الأخبارَ والقصص المتضمنة لبعض الغرائب، ثم أَرْدَفَ ذلك ببيان منهجه في إيراد مثل تلك القصص والروايات؛ وفي صنيعه ذلك ما يفيد أنه يَحْسُن بالمتصدِّي للتصنيف أن يُفْصِحَ عن طريقته في مُصَنَّفِه، ويبِينَ عن منهجه في مؤلَّفِه، خاصةً إذا تَنَاوَلَ ما لا تبدو وِجْهَة تَناوُلِه لأوَّل وَهْلَة، أو نقل ما تستغرب روايته ونقله لأول نظرة، أو نحو ذلك مما يفتح بابًا للمؤاخذة عليه، أو يمهّد سبيلًا للانتقاد عليه، فيكون في إفصاحه عن طريقته، وإبانته عن منهجه دفعٌ لِمَا قد يَرِدُ على فِعلِه من مؤاخذات، أو يُوجَّه إلى صنيعه من انتقادات.
بيَّن أنّ منهجه في إيراد الروايات والقصص المروية في كتب التفسير يتمثّل في اختصار الكثير من تفاصيل تلك الروايات، وأن هذا الاختصار قائم على التدقيق في المرويات، والتأمّل في مجموع الروايات؛ لينتقي من مجموعها المعاني التي تَخصُّ الآية، ولا يضيرنا بعد ذلك صحة دعواه باختصاص هذه المعاني بالآيات بعد ذلك أو عدم صحتها، وإنَّما نحن هنا باحثون عن المنهج المتَّبَع عنده، وقد نَصَّ على هذه المنهجية في الاختصار والانتقاء والاعتماد على ما يخصّ معنى الآية من هذه الأخبار كثيرًا في تفسيره[8].
4- يدلُّ منهج ابنِ عطيَّة هذا دلالة واضحة على أنه يرى الاستفادة من تلك المرويات، وأن له نظرة نقديّة انتقائية حيالها لا تصل إلى الاعتماد الكُلِّي عليها، ولا إلى الإهمال التامِّ لها، بل هي نظرة تقوم على إهمال كلّ ما لا يخصّ الآية، مما قد يكون اللائق عدم التطويل بنقله، واختصار كتابته وذِكْرِه، وعلى ذِكْرِ ما يُدَّعى اختصاصه بالآية من المعاني المبثوثة في خلال الروايات، سواء صَدَقَتْ دعوَى ارتباط تلك المعاني بالآيات -مما يكون له أثر في زيادة البيان للآيات، أو الإسهام في تجلية بعض متعلقاتها- أو لم تَصْدُق دعوى ارتباط تلك المعاني بالآيات، فيكون نقلها لنفي ارتباطها بالآيات، وعدم وجود الصلة بينهما.
وهذا الاختيار من مجموع الروايات عملية نقديّة تقوم على حذفٍ واختصارٍ وانتقاءٍ، وتتطلب عقلية مُتَيَقِّظَة قادرة على النفاذ إلى مقصود الروايات والقصص وما تتضمنه من معانٍ، ثم تمييز ما دلَّت عليه الروايات والقصص من معانٍ تخصّ الآية فَتُنْقَل، ومن معانٍ لا تخصّ الآية ولا يُحتَاج إليها في زيادة البيان فتُهْمَل.
5- نصَّ على أنه اختصر القصص التي جلَبَها، وقَصَد استيفاء المعاني التي تخصّ الآية منها،وقد تأملْتُ في قصة الغار التي نَقَلَها لاستكشاف المعاني التي تخصّ الآية، التي دفعَتْه لنقل هذه القصة، فلم يبدُ لي أنَّ هناك معانِيَ تخصّ الآية فأرجعْتُ البصرَ وكرَّرْتُ النظر،فظهر لي أنّ آخر القصة المنقولة فيه التنصيص على أنَّ نظرَ إبراهيم للكواكب كان من الغار، ففي تفسير ابن عطيَّة ما نَصَّه: «وأنَّه نَظرَ أول ما عَقَلَ من الغار فرأى الكوكب وجَرَتْ قصة الآية»[9]،فهذا هو الموضع الوحيد الذي لاح لي أنه يخصّ الآية.
ولعلّ قائلًا يقول: لماذا لم يقتصر على نقل هذا الموضع الذي يخصُّ الآية ساعة نقله واختصاره للقصة؟ ولماذا نقل قبل هذا الموضع ما نقل من قصة ولادة إبراهيم -عليه السلام- إلخ، مما لا يخصُّ الآية؟
والجواب: أن هذا الموضع الذي يخصُّ الآية لا يمكن فهمه دون سوق القصة؛ إذ هو مُرْتَبِطٌ بالقصة وجزء منها ومُتَعَلِّق بها وواردٌ في سياقها، ولا يمكن تصوّره بدون السياق الوارد فيه.
ومما يدلّ على ذلك أن الإمام الطبريّ قد ساق القصة بصورة أطول يظهر منها المعاني التي نصَّ ابن عطيَّة على أنَّها تخصّ الآية بصورة أوضح، فقد نَقَلَ الطبريُّ الرواية بطولها، وفيها: «...فلم يلبث إبراهيم في المغارة إلا خمسة عشر شهرًا حتى قال لأمه: أخرجيني أنظر! فأخرجَتْه عِشاء فنظر، وتفكَّر في خلق السماوات والأرض، وقال: (إنَّ الذي خلقني ورزقني وأطعمنيوسقاني لَرَبِّي، ما لي إله غيره)، ثم نظر في السماء فرأى كوكبًا، قال: {هَذَا رَبِّي}، ثم اتّبعه ينظر إليه ببصره حتى غاب، فلما أفل قال: {لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ}، ثم طلع القمر فرآه بازغًا، قال: {هَذَا رَبِّي}، ثم اتّبعه ببصره حتى غاب، فلما أفل قال: {لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ}، فلما دخل عليه النهار وطلعَت الشمس، أعظَمَ الشمسَ، ورأى شيئًا هو أعظم نورًا من كلّ شيء رآه قبل ذلك، فقال: {هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ}، فلما أفلت قال: {يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ}[الأنعام: ٧٨- ٧٩]»[10].
وظاهرٌ جدًّا أنّ الرواية الطويلة التي ساقها الطبريُّ نصَّتْ على ارتباط قصة الغار بهذه الآيات بل جاء فيها إيراد الآيات بنصوصها.
وفي صنيع ابن عطيَّة هذا فائدة نفيسة، وهي أنَّ المفسِّر قد يُضطر لنقل قصة طويلةوهو لا يريد من ذِكرها ولا نَقْلها سوى جزءٍ يسير منها له ارتباط بالآيات، أو ادُّعِيَ أنه كذلك، بل يحاول أحيانًا الخلاص مما في القصة من زوائد والاقتصار منها على ما يخصُّ الآية، لكنَّه لا يستطيع ذكر الجزء الذي يخصُّها أو يُدَّعَى أنه كذلك إلا بذِكر شيء من القصة مما لا يخصُّ الآية ليُفْهَمَ به الجزء الذي يخصُّ الآية،وهكذا الحال هنا؛ فقد اضطر ابن عطيَّة -رغم اختصاره لكثير مما أورد الطبريُّ- أن يُورِد من القصة التي نقَلها أشياء ليس بينها وبين الآية ارتباط من قريب أو بعيد، لكنَّ فيها جزءًا يسيرًا يرتبط بالآيات أو يُدَّعى أنه كذلك، وهو -رغم محاولاته اختصار ما لا يخصّ الآية والإعراض عن ذكره- لا يستطيع بَتْر هذا الجزء اليسير من القصة وحده؛ لعدم تَمَكُّنِ القارئ -في هذه الحالة- من تصوُّر الارتباط المدَّعَى بين هذا الجزء وبين الآيات إلا بعد ذكر شيء من سياق القصة التي ورد فيها هذا الجزء؛ ليفهم وجه ادِّعاء ارتباطه بالآيات، سواء صح هذا الادِّعاء بعد ذلك أو لا[11].
فلا مناص أمام الناقد -والحال كذلك- من إيراد القصة كلِّها أو شيء منها مع كونه ينكر أكثرها أو يتوقف فيه،وذلك حتى يأتي الموضع الذي يخصّ الآيات -والذي هو المقصود من رواية تلك القصة- في السياق الذي تضمّنه؛ إذ عَزْلُه عن سياقه يجعل دعوَى اختصاصه بالآيات غير واضحة ولا مفهومة.
6- مما يثير الانتباه هنا ويلفت النظر عدم تعرُّض ابن عطيَّة لنقد قصة الغار التي نقلها من قريب أو بعيد -رغم اشتمالها على بعض ما يُستغرَب- وإنما انتقد ارتباطها بالآيات فحَسْب، فقال: «ويَضْعُفُ عندي أن تكون هذه القصة في الغار...»[12]، فيا تُرَى لماذا انتقد ارتباط قصة الغار بالآيات ولم ينتقد القصة ذاتها؟
والجواب، من وجوه:
أولها وأهمها: أنَّ القصة في ذاتها لا تعني الناظر في تفسير الآيات من قريب أو بعيد، وإنما كلّ ما يعنيه وجه تَعَلُّقِها بالآيات الذي هو الدافع الأساس لنقلها في كتب التفسير، وهذا عين ما فعله ابن عطيَّة فلا تعنيه صحة القصة في ذاتها، ولا يعنيه ما قد تشتمل عليه من معان مُستغرَبة وأمور مُستنكَرة، وإنما يعنيه صحة ارتباطها أو جزء منها بالآيات أو عدم صحة ذلك، فليس المقام مقام تَتَبُّع وانتقاد للإسرائيليات والقصص، وإنما المقام مقام تفسير الآيات وما قيل ورُوِي في تفسيرها، وتتبع ذلك وبيان وجه الصواب والخطأ فيه.
وفي صنيع ابن عطيَّة هذا فائدة نفيسة، وهي: أنَّ الناقد قد يُورِدُ بعض الإسرائيليات والقصص مما يُستغرَب أكثره ويبدو ضَعْفُ مُعظَمه، لكنه يُعْرِض عن انتقاد ما في طيَّاتها من ضعف، ويَصْدِف عن إظهار ما في ثناياها من خلل؛ لأنه يريد إبطال ارتباط جزء فيها بالآيات، وبإبطاله ينفكّ ارتباطها المُدَّعى بالآيات، فلا يضيره بعد نقده ارتباطها بالآية ما فيها من معانٍ مُستنكَرة أو أمور مُستغرَبة، بل يكون تَتَبُّع تلك الأمور وبيان نَكَارتِها -والحالة هذه- عناء ومشقة يَتَجَشَّمُه المفسِّر بعد ظهور انفصالها عن الآيات.
ثانيها: أنه بإبطال ارتباط القصة بالآيات يحصل المراد بأقصر طريق؛ لأن الجمع بين نَقْلِ الإسرائيلية وبين انتقاد ارتباطها بالآية هو في الحقيقة إبطال لها بأقرب طريق، فَلِمَ يعمد إلى التطويل بالإبطال وهو حاصل له؟!
ثالثها: أنّ الإسرائيليات والقصص كثيرًا ما تشتمل على أشياء لا يمكن تصديقها ولا تكذيبها، فيكون في قبولها أو إبطالها تجاسرٌ على الغيبيات، وجزمٌ بما لا سبيل للإنسان إلى الوصول إلى شيء فيه، فتكون السلامة ساعتها في السكوت عنها.
7- بيّن ابن عطيَّة علَّةَ تضعيفه لارتباط الآيات بقصة الغار، فقال: «ويَضْعُفُ عندي أن تكون هذه القصة في الغار لقوله في آخرها: {إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ}[الأنعام: 78]، وهي ألفاظ تقتضي محاجَّة وردًّا على قوم، وحاله في الغار بعيدة عن مثل هذا»[13].
وفي بيان ابن عطيَّة لأسباب تضعيفه فائدتان مهمَّتان:
الأولى: أهمية تعليل النقد، فالناقد لا يَحسُن به أن تتوقف مهمَّتُه عند تضعيف القصص والأقوال، بل عليه أن يُكسِبَ نقدَه قوة، ببيان سبب انتقاده، وعلَّة تضعيفه؛ إذ قوة النقد تكون بقوة السبب الذي دعا إليه، وإبراز الدافع الذي دفع إليه، وبغير ذلك يبقى النقد مُتَأَرجِحًا في الهواء لا يَستنِد إلى سبب، ولا يتَّكِئ على علَّة، وتبقى عملية النقد ناقصة مبتورة مُفتقِرة إلى ما يَسُدُّ نقصها، بل قد يكون ذلك سبيلًا لظنِّ التشهِّي والهوى بالناقد.
الثانية:اعتمد ابن عطيَّة في بيان ضعف ارتباط القصة بالآيات على النظر في سياق الآيات وسياق القصة، وفي هذا إشارةٌ إلى كون السياق من أهم الأمور التي يجب على الناقد مراعاتها، وتنبيهٌ على ضرورة اهتمام المفسِّر به في انتقاد الأقوال.
والمتأمِّل لصنيع ابن عطيَّة يجد أنه لم ينظر في سياق الآيات فقط ولا في سياق القصة فحَسْب، بل جَمَعَ بين النظر في السياقَين، فظهر له من سياق الآيات ودلالاتها كون الآيات تدلّ على أن هناك تخاطبًا وتحاورًا بينه وبين قومه، وَنَظَرَ في سياق القصة فوجدها تدلّ على أنه كان بمفرده، وأن حاله في الغار أبعد ما تكون عن أن يخاطب أحدًا، فظهر له التعارض بين السياقَين، فانتقد الارتباط المدَّعَى بينهما.
وفي هذا تنبيهٌ منه على أن المتصدِّي لنقد الإسرائيليات والقصص ونحوها لا بد له من مراعاة سياقَيْنِ:
أولهما: سياق الآيات.
وثانيهما: سياق القصة المنقولة.
إذ يحصل بالجمع بين النظر في السياقَيْنِ ما لا يحصل بالنظر في سياق واحد منهما من اكتمال رؤية الناقد، وزيادة قوة النقد باجتماع أسباب النقد من السياقَيْنِ، والسلامة من الوقوع في الخلل عند النظر في سياق واحد وتَرْك الآخر، إذ قد ينظر الناقد في سياق الآيات فلا يرى فيه شيئًا يصادم القصة فيربطها بالآية، ولا ينتبه لكون سياق القصة يشتمل على ما ينافي الآية أو يخالفها، وهكذا الأمر عند النظر في سياق القصة وعدم التنبّه لسياق الآية.
8- مما هو جدير بالتأمّل أن ابن عطيَّة رغم تضعيفه الارتباط بين الآيات وقصة الغار، إلا أنَّه حاول -مع ذلك- تَلَمُّسَ تأويلٍ يمكن به الربط بينهما، فقال:
«ويَضْعُفُ عندي أن تكون هذه القصة في الغار لقوله في آخرها: {إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ}[الأنعام: 78]، وهي ألفاظ تقتضي محاجَّةً وردًّا على قوم، وحاله في الغار بعيدة عن مثل هذا، اللهم إلا أن يُتَأوَّل في ذلك أنه قالها بَيْـنَه وبَيْـنَ نفسه، أي قال في نفسه معنى العبارة عنه: {يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ}، وهذا كما قال الشاعر:
ثم انثنى وقال في التّفكير إنّ الحياة اليوم في الكرور
قال القاضي أبو محمد: ومع هذا فالمخاطَبة تُبعِدُه، ولو قال: (يا قوم إني بريء من الإشراك) لصحَّ هذا التأويل وقَوِي»[14].
وفي محاولته تلَمُّس تأويلٍ للربط بينهما وما تَبِعَ ذلك من تعليقاته فوائد مهمّة للناقد:
الأولى:عدم المسارعة إلى انتقاد قولٍ قبل تقليبِ النظر فيه من جميع وجوهه، وتَخَيُّلِ كلّ مُحْتَمَلاته، واستِنْطاقِ ما في زواياه من افتراضات، والمفاضلةِ بين ما في خباياه من تأويلات، عسى أن يكون له وجاهة على تأويلٍ من التأويلات، أو يمكن تصحيحه على احتمالٍ مِن الاحتمالات، فيكون مُنْتَقِدُه مُنتَقَدًا، ومُهمِلُه مخطئًا، والمسارعُ إلى انتقاده مُقصِّرًا.
الثانية:دراسة كلّ التأويلات والتخريجات التي يمكن ورودها على القول، وقبول ما يمكن قبوله وردُّ ما يمكن ردُّه -يوسِّعُ أفق الناقد، ويَطْبَعُ نقده بالقوة، ويجعله أقرب للصواب من غيره؛ لكون القول قد انكشف له بجميع وجوه احتمالاته وتأويلاته، فصار بمنزلة من ينظر إلى الشيء من عَلٍ بحيث يرى ما لا يراه غيره.
الثالثة:يُلاحَظ أنَّ ابنَ عطيَّة أيّد التأويل المُلْتَمَس ببيت من الشعر؛ ليبين صحته في العربية ووجاهته اللغوية، حيث قال بعد ذكره للتأويل:
«...وهذا كما قال الشاعر:
ثم انثنى وقال في التّفكير إنّ الحياة اليوم في الكرور»[15]
وفي هذا إشارة منه إلى ضابط التماس التأويل للأقوال، وأنه ليس كلّ تأويل يكون مقبولًا؛ لاتساع باب التأويل، وتعدّد وجوه المحتملات، وإنما التأويل المقبول ما كانت له وجهة صحيحة، كأن يثبت استعماله لغة أو جوازه شرعًا، أو اعتباره عُرفًا ونحو ذلك مما تُصَحَّحُ به التأويلات.
الرابعة:ضَعَّف ابن عطيَّة التأويل الذي تأوَّله، ثم بَيَّنَ ما هي الوجهة التي كان يمكن قبوله عليها، فقال: «ومع هذا فالمخاطَبة تُبعِدُه، ولو قال: (يا قوم إني بريء من الإشراك) لصحَّ هذا التأويل وقَوِي»[16].
وفي تضعيفِه التأويل الذي لو صحَّ لربط به بين الآيات وقصة الغار، وبيانِه المانع من تصحيحه، ثم بيانِه كيف يمكن تصحيحه لولا مجيء اللفظ على خلاف ما تقتضيه صحة التأويل -فائدةٌ حَسنةٌ، وهي أن النقد لا يقتصر على تضعيف القول فقط، بل يكون أبلغ وأقوى إذا تم إبطال كلّ المحتملات التي يمكن أن يتخرَّج عليها.
وكأنَّ ابنَ عطيَّة أراد أن يُبيِّن أنَّ النقد درجات ومراتب، فأُولى درجاتِهِ انتقادُ القول فحَسْب، ثم يليها انتقادُه مع بيان علَّة الانتقاد، ثم التماسُ التأويلات التي يمكن بها تصحيح القول المنتقد، ثم تضعيفُ تلك التأويلات عند تعذُّر التصحيح بها.
وبهذا يكون الناقد قد استنفد غاية وُسْعِه في دراسة القول من جميع جوانبه التي يمكن من خلالها تصحيحه ووضعه في حيز القبول.
ثانيًا: الإجراءات النقديّة:
لقد مرَّت عملية الانتقاد عند الإمام ابن عطيَّة في هذا المثال بعدّة إجراءات، بيانها كالتالي:
1- قدَّم بذكر الاحتمالات التي تتفرّع عنها كلُّ الأقوال: «ولفظ هذه القصة يَحتمِل أن تكون وقعَتْ له في حال صباه وقبل بلوغه...، ويَحتمِل أن تكون وقعت له بعد بلوغه وكونه مكلَّفًا».
2- نَسَبَ كلَّ احتمال لقائله: «كما ذهب إليه ابن عباس...، وحَكى الطبريّ هذا عن جماعة».
3- نَقَلَ خبرًا من الأخبار الماضية بصيغة التمريض؛ لينتقد القول المرتبط بذلك الخبر: «قد حُكِي أن نمرود...».
4- نبَّه في آخر الخبر المنقول على الارتباط الذي ادَّعاه مَن ربَط بين الخبر والآيات: «وأنه نظر أول ما عَقَلَ من الغار فرأى الكوكب، وجَرَت قصة الآية».
5- بَيَّـنَ أنه اختصر هذا الخبر غاية الاختصار وقصَد التنبيه على الموضع الذي يخصّ الآية ليُعْرَف وجهُ الارتباط المدَّعَى بين الخبر والآيات: «وجلبتُ هذه القصص بغاية الاختصار في اللفظ، وقصدتُ استيفاء المعاني التي تخصّ الآية».
6- بَيَّـنَ ضعف الارتباط بين الآيات وبين الخبر المنقول: «ويضعف عندي أن تكون هذه القصة في الغار».
7- ذَكَرَ علةَ تضعيفه للارتباط بين الآيات والخبر: «لقوله في آخرها: {إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ}[الأنعام: 78]، وهي ألفاظ تقتضي محاجَّة وردًّا على قومٍ، وحاله في الغار بعيدة عن مثل هذا».
8- تلَمَّس تأويلًا يمكن تصحيح الارتباط عليه: «اللهم إلا أن يُتأوَّل في ذلك أنه قالها بَيـْنَه وبَيْـنَ نفسه، أي قال في نفسه معنى العبارة عنه: {يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ}[الأنعام: 78]».
9- أثبَتَ صحة هذا التأويل في العربية، واستدلّ على صحته ببيت من الشعر: «اللهم إلا أن يُتأوَّل في ذلك أنه قالها بَيـنَه وبَيـنَ نفسه، أي قال في نفسه معنى العبارة عنه: {يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ}، وهذا كما قال الشاعر:
ثم انثنى وقال في التّفكير إنّ الحياة اليوم في الكرور».
10- استبعَدَ التأويل المُلْتَمَس وبيَّن علَّة استبعاده: «ومع هذا فالمخاطَبة تُبعِدُه».
11- بَيَّـنَ الألفاظ التي كان يمكن تصحيح التأويل الملتَمَس عليها إن وُجِدَت: «ولو قال: (يا قوم إني بريء من الإشراك)، لصحَّ هذا التأويل وقَوِي».
12- أورَدَ الخبر الذي ضعَّفَه مقارنًا لأحد الاحتمالات الواردة في الآية على سبيل التنزُّل: «فإن قلنا بأنه وقعَتْ له القصة في الغار في حال الصَّبوة وعدم التكليف على ما ذهب إليه بعض المفسرين، ويَحتمله اللفظ...».
ثالثًا: إرشادات على طريق النقد من صنيع الإمام ابن عطيَّة:
1- صحةُ النقد مُتَوقِّفة على معرفة الناقد بالمرتكَزات التي ارتكزَتْ عليها الأقوال المنتقَدَة، وحُسْنِ تصوّره للأصول التي تأسَّسَتْ عليها المعاني، وإلا كان منتقِدًا لما لم يُعرَف أصلُه، وحاكمًا على ما لم يَفهم مَنشأَه ومُرتكَزَه.
2- الدّقة في عرض الأقوال من أهمّ ما يجب على الناقد مراعاته، بحيث تكون العبارةُ التي يُورِد بها الأقوال بالغةً من الدّقةِ والتحرير وحُسنِ الاختيار والتنوّعِ بحسب المقام -ما يجعلها مُبْرِزَةً لرؤيته النقديّة فيما يورد وينقل، ومحدِّدةً موقفَهُ تجاه الأقوال المنقولة.
3- يجب على الناقد التأنِّي في الحكم على الأقوال، وعدم المسارعة إلى قَبُولِ أو ردِّ ما لم تثبت دلائل قبوله أو ردِّه منها.
4- تعليل الناقد لصنيعه وإبانته عن طريقته وإفصاحه عن منهجه من أهمِّ الأمور التي يَحسُن بالناقد مراعاتها، وخاصّة عندما تشتدّ دواعيها مِن نقلٍ لأقوال لا تبدو وجهة نقلها، أو روايةٍ لأخبار تَخْفَى عِلَّة ذكرها، فيكون في إفصاحه عن منهجه بيانٌ لغرضه وإيضاحٌ لمقصوده، سواء وافقه بعد ذلك مُوافِق أو خالفه مُخالِف.
5- الملَكة النقديّة من أهمِّ ما يجب على المتصدِّي للنقد اكتسابه والدُّرْبَة عليه؛ لكون هذه الملَكة تُبَصِّرُ صاحبها بمعالم الأقوال ومقاصدها، وتجعله قادرًا على الموازنة بين الأقوال، والانتقاء منها واختصار كثيرٍ مما لا فائدة تحته.
6- انتقاد قصة من القصص أو خبر من الأخبار بما ينفي ارتباطه بالآيات، ويقطع وشيجته بها يُغْنِي عن انتقاد ما في تفاصيل القصة وما في مضامين الخبر من معانٍ مُستغرَبة.
7- بيان الناقد لمُسوِّغات نقده، وإبرازه للأسباب التي تأسَّس عليها يمنح نقده قوة، وبمقدار قوة تلك المسوِّغات، ووضوح هذه الأسباب بمقدار ما تحصل الطمأنينة لنقده والقناعة به لدى المتلقي.
8- إعمال القول أَولى من إهماله؛ ولذا يتعيَّن على الناقد أن لا يَرُدَّ قولًا إلَّا بعد التماس كلّ المخارج التي يمكن تخريجه عليها، ودراسة كلّ المحتمَلات والتأويلات التي يمكن حمله عليها؛ حتى لا يقع في إهدار قول له تأويل صحيح، وليكون نقده مبنيًّا على استقراءٍ تامٍّ لكلّ وجوه المحتمَلات فيَطمَئِنّ إلى سلامة نقده.
9- بيان الناقد للكيفية أو التركيب الذي لو جاء القول المردود على وفاقه لكان صحيحًا مقبولًا، يزيد الثقة بنقده، ويدلّ على نفاذه إلى أعماق القول، واستقصائه له من جميع وجوهه.
ولعلَّه من خلال ما سبق بيانه وتحليله لنقد الإسرائيليات عند ابن عطية، يتجلَّى لنا الفارق الرهيب بين صورة النقد ومنهجه وآليات ممارسته عند ابن عطية وصورة النقد عندنا في كثيرٍ من بحوثنا ودراساتنا، وأنّ العودة للنقد المنهجي للإسرائيليات وغيرها هي السبيل لقراءة واعية وفهم ناضج، وتكوين مواقف علميّة لها أسس وإجراءات ومعايير وأدوات، وأننا بحاجة لمحاكمةِ نَقْدِنا للإسرائيليات قبل نقد الإسرائيليات، وإلَّا فالدَّعاوَى يُحْسِنُها كلُّ أحد، والتعميم لا يعجز عنه أحد. واللهُ الموفِّق لا ربَّ سواه.
[1] نُشر هذا النموذج ضمن كتاب «مراجعات في الإسرائيليات» الصادر عن مركز تفسير، بعنوان: (نموذج تحليلي لآلية نقد الإسرائيليات عند ابن عطية)، وقد قمنا بإعادة نشره ضمن ملف: (الإسرائيليات في كتبِ التفسير). (موقع تفسير).
[2] لم أقف عليه، وقد ذكره الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير (7/ 325) ونسبه للعجاج، وقد رجعتُ لديوان العجاج فلم أقف عليه.
[3] المحرر الوجيز: (2/ 312- 313).
[4] المحرر الوجيز: (2/ 313).
[5] المصدر السابق، الصفحة نفسها.
[6] المصدر السابق، الصفحة نفسها.
[7] لم أُورد بقية كلامه على الوجهين وكذا بقية كلامه عن الاحتمالات الأخرى؛ لكونها خارجة عن معالجة الخبر المنقول في قصة الغار، إذ هي واردة في توجيه مُحاجَّة إبراهيم -عليه السلام- لقومه وقوله: {هَذَا رَبِّي}، وعَلامَ يُحمَل قول إبراهيم عليه السلام؟ هل على كونه كان لا يعرف ربَّه ويستدلّ عليه؟ أو كان يقرّر قومَه للاعتراف بربِّهم وخالقهم؟ وإنما معالجتنا هنا مقتصرة على حدود القصص المنقول في الغار وكيف تعامَل معه الإمام.
[8] ينظر ما سبق ذكره من نصوص (ص: 239).
[9] المحرر الوجيز: (2/ 312).
[10] تفسير الطبري: (11/ 481).
[11] قال الأستاذ محمود محمد شاكر في تعليقه على تفسير الطبري هامش رقم 2: (1/ 453): «تذكرة: تبيَّن لي مما راجعته من كلام الطبري، أن استدلال الطبري بهذه الآثار التي يرويها بأسانيدها، لا يُراد به إلا تحقيق معنى لفظ، أو بيان سياق عبارة...، وهذا مذهب لا بأس به في الاستدلال، ومثله أيضًا ما يسوقه من الأخبار والآثار التي لا يشك في ضعفها، أو في كونها من الإسرائيليات، فهو لم يسقها لتكون مهيمنة على تفسير آي التنزيل الكريم، بل يسوق الطويل الطويل، لبيان معنى لفظ، أو سياق حادثة، وإن كان الأثر نفسه مما لا تقوم به الحجة في الدين، ولا في التفسير التامّ لآي كتاب الله.
فاستدلال الطبري بما ينكره المنكرون، لم يكن إلا استظهارًا للمعاني التي تدلّ عليها ألفاظ هذا الكتاب الكريم، كما يستظهر بالشعر على معانيها. فهو إذن استدلال يكاد يكون لغويًّا، ولما لم يكن مُستنكَرًا أن يُستدلَّ بالشعر الذي كذب قائله، ما صحت لغته؛ فليس بمستنكر أن تساق الآثار التي لا يرتضيها أهل الحديث، والتي لا تقوم بها الحجة في الدين، للدلالة على المعنى المفهوم من صريح لفظ القرآن، وكيف فهمه الأوائل -سواء كانوا من الصحابة أو مَن دونهم. وأرجو أن تكون هذه تذكرة تنفع قارئ كتاب الطبري، إذا ما انتهى إلى شيء مما عدَّه أهل علم الحديث من الغريب والمنكر» اهـ.
[12] المحرر الوجيز (2/ 313).
[13] المصدر السابق، الصفحة نفسها.
[14] المصدر السابق، الصفحة نفسها.
[15] المصدر السابق، الصفحة نفسها.
[16] المصدر السابق، الصفحة نفسها.
كلمات مفتاحية
الكاتب:

محمد صالح سليمان
دكتوراه في التفسير وعلوم القرآن- جامعة الأزهر، ومدير الشؤون العلمية بمركز تفسير، أشرف على عدد من المشروعات العلمية المنشورة.
مواضيع ذات صلة
((المعلومات والآراء المقدَّمة هي للكتّاب، ولا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع أو أسرة مركز تفسير))