القرآن والكتاب المقدّس: النصّ والتفسير
جبريل سعيد رينولدز

يأتي هذا الكتاب مفيدًا لمن يستحسنون مقاربة جبريل سعيد رينولدز (Gabriel Said Reynolds) للقرآن؛ إذ يفحص فيه رينولدز القرآنَ آية بآية، ويشرح أطروحته من هذا المنطلق. وقد تناول هذا الموضوع حتى الآن من منظور أوسع، وجادل بأن بعض الآيات تتماشى جيدًا مع الافتراض القائل باستهدافها الارتباط بالسياق اليهودي المسيحي في جزيرة العرب المعاصرة لها، وذلك يمثّل جزءًا من مقاربة تأويلية معهودة منذ فترة وماتعة للقرآن. في هذا المجلد يقدّم القرآن بكامله مؤيدًا لأطروحته، مدعومًا بترجمة عليّ قلي قرائي (Ali Quli Qarai) الجديدة والواضحة تمامًا للنصّ القرآني، والتي يمثل وجودها في ذاتها أمرًا جيدًا. وقد تمّ نشرُ كثير من الترجمات مؤخرًا، وكان لكلّ منها مميزاتها، وفي بعض الأحيان بواعثها على الإحباط؛ إلّا أن ترجمة (قرائي) تحديدًا تُعَدّ تمثيلًا ثاقبًا للنصّ، فضلًا عن ملاءمتها مع أطروحة رينولدز عن وضوح النصّ بشكلٍ لا إبهام فيه. وتنصّ مجادلة رينولدز على أنه من الممكن تفسير explain أجزاء القرآن التي يصعب فهمها بإحالة حكيمة إلى السياق اليهودي-المسيحي؛ وإن لم تكن الإحالة إلى النصوص المعتمدة فلتكن إلى مجموعة متنوعة أخرى من الكتابات، السريانية في بعض الأحيان، وهو الأمر المُشير إلى غزارة الأدبيات الدينية الموجودة في العصور القديمة، والتي كان لها حضور ملموس في شبه الجزيرة العربية.
أنا، بصفة شخصية، لا أؤيد هذه الأطروحة على نحو مطلق، رغم أن عَلَيَّ القول بأن الإحالات والملاحظات المُفصَّلة التي يقدّمها المؤلف في كتابه مفيدة وبليغة. يرجع ذلك إلى أنّ هذا التوافق لا يجب أن يكون أمرًا مُفاجِئًا في حدّ ذاته؛ نظرًا لأن القرآن يعتبر نفسه تتويجًا للنصوص المقدّسة السابقة وتحقُّقًا لها. ويشير رينولدز -كما فعل سابقًا- إلى أن الشُّرّاح الأساسيين للقرآن أتوا متأخرين كثيرًا عن الكتاب نفسه، وأن عربيتهم ليست عربية القرآن عينها؛ لذلك فعندما يشيرون إلى مسألة لغوية -كما يفعلون كثيرًا محاولين فهم النصّ- فإنهم يرتكبون بعض الأخطاء، نظرًا لأنهم حتمًا يتحدّثون عن القواعد اللغوية الخاصّة بزمنهم وليس بأزمان أسبق. ذلك يعني أنه من الأفضل دراسة السياق اليهودي-المسيحي، وتفادي التعرّض للقواعد اللغوية العربية للمرحلة الزمنية السابقة[1].
وهناك بعض الحجج المعقولة ضدّ هذا الموقف، إحداها يتمثّل في اتهام اليهود والمسيحيين بـ "التحريف". فقد نُظِر إليهم في بعض الأحيان على أنهم أفسدوا نُسَخ القانون الإلهي الخاصّة بهم، وبالتالي يُفترض أن يكون إتْباعهم بمزيد من الوحي أمرًا ضروريًّا لإرجاع الأمور إلى نصابها، كما كانت قبل ذلك، وإذا كانت نُسخ الكتاب المقدس الماثلة بين أيادينا مُحرَّفة، فمن غير المحتمل أن الإحالة إليها من أجل شرح القرآن ستكون مفيدة تمامًا[2]. فنحن لا نحيل إلى وحي سابق ومحدّد، كما أن الأسلوب القرآني يختلف كثيرًا عن الكتب الأخرى؛ فهو أقل تأريخية وأكثر إيجازًا. فيرى القرآن أنه يقوم بتقديمٍ مثاليّ لما قدّمته الكتب الأخرى على نحو أقلّ جودة؛ أي: ربما كانت الكتب المقدسة السابقة قامت بذلك في البداية على النحو الصحيح، لكنها غُيِّرَت فيما بعد على أيدي من ابتغوا قوانين وأنظمة دينية أسهل. وهناك شيء من السذاجة في مقاربة رينولدز، وهو ظنّه بأن الشخصيات الرئيسة المُشار إليهم في القرآن والكتب المقدسة السابقة هم نفس الأشخاص، بَيْد أنّ اشتراك شخصيتين في الاسم لا يجعل منهما شخصًا واحدًا؛ فإذا كانَا مختلفين نسبيًّا في الشخصية، فعلينا إذن أن نُقرّر إذا كان القرآن والكتب المقدسة السابقة يقصدون نفس الشخص. وهذه مشكلة مألوفة في فلسفة المعنى: متى ينطبق وصف بعينه على نفس الشخص إذا كانت سمات ذلك الشخص مُتغيرة على حسب الحالة؟
يفترض رينولدز أن يسوع وعيسى هما الشخص نفسه، وأنهما يتشاركان في كثير من الصفات، إلّا أنّ الآية 157 من سورة النساء تخبرنا بأن يسوع لم يُصْلَب، على الرغم من زعم اليهود بصَلْبِهم إيّاه. وهناك مشكلة صغيرة في افتراض رينولدز بأن يسوع وعيسى هما الشخص نفسه، بمعطى أن موته يمثل أمرًا مهمًّا إلى حدّ ما في المسيحية، ويتساءل المرء كيف يمكن لشخصٍ أن يكون هو ذات الشخص إن قُتِل بدلًا من رفعِه إلى السماء مُنتظَرًا وصول المَهدي، وفقًا لكثير من الروايات الإسلامية. يتجنب رينولدز هذه المشكلة قائلًا بأنّ القرآن بالفعل يقول إنّ اليهود قد أخطؤوا ولم يقتلوا المسيح، بل إن الله قد أماته ورفعه إلى السماء؛ بما أنه هو مَن يحيي ويُميت (ص181). فاليهود أجرموا لمحاولتهم قتله، ولقتلهم أنبياءهم عمومًا، لكن الله هو مَن منعهم من قتله بأَنْ أماته هو بنفسه. وهذا حجاج غريب! فالله بالطبع هو المسؤول عن كلّ ما يحدث، ولا شيء يحدث بدون معرفته وموافقته، ومن ذلك المنطلق يكون رينولدز محقًّا. فالقرآن أحيانًا ما يدفع برسالة شديدة الجبرية بهذه الطريقة (تمثل الآية 17 من سورة الأنفال مثالًا جيدًا)، ولكنه غالبًا لا يفعل ذلك، على افتراض أن اليهود أجرموا لأنهم امتلكوا الاختيار بين محاولة قتل المسيح وعدمها، ثم فضلوا الاختيار الخاطئ؛ وبسبب الهوية الغالِطة، يقتلون الرجُل الخطأ، لكن دافِعهم المُذنِب يظلّ موجودًا، وكثيرًا ما مَثّلهم القرآن لُؤَماء مع الأنبياء. ومن الواضح أنّ وجهة النظر هذه متجذّرة في المسيحية، ويفصِّل رينولدز ذلك، إلّا أن هذه المسألة لا يجب أن تشتتنا عن مشكلة إذا ما كان يسوع وعيسى شخصًا واحدًا. لا يبدو أن هنالك مشكلة، فالمسيحيون لديهم رواية واحدة عمّا حدث له في نهاية حياته، ولدى المسلمين رواية أخرى، وكلتاهما تتحدثان عن الشخص عينه. قد يكون ذلك صحيحًا، لكن يجدر بنا التفكير بدلالة الطريقة التي مات بها يسوع من أجل المسيحية. إذ إن لها -ولِما تَبِعَها- دلالة هائلة، ولأتناول الأمر بقليلٍ من الرمزية، (راجع الفقرة التالية لفهم من أين تأتي هذه الفكرة) يمكن القول بأن كلية وجود ubiquity رموز يسوع على الصليب[3]، توحي بالأهمية الكبيرة لهذا الحدث في المسيحية؛ فيسوع الذي من أجله لم يقع هذا الحدث، أو لم يتم على هذا النحو، قد يكون شخصًا مختلفًا تمامًا[4].
يقودنا هذا إلى لُبّ الموضوع: ما الذي بإمكاننا قوله حول الشواهد الكثيرة التي اختلف فيها القرآن والكتب المقدسة السابقة اختلافًا كبيرًا؟ بالنسبة إلى رينولدز لا توجد مشكلة إِذْ إن ذلك حاصل «من أجل تطوير رمزية معيّنة» (ص14). أو لأن القرآن يتابع تعديلًا أسطوريًّا للتيمة الكتابية. وبالتالي فكلّ شيء يصبح مناسبًا: فإذا بدت الكتب متشابهة إلى حدّ ما، فإنها بالتالي تتناول تيمات متشابهة ولها خلفية مشتركة، وعندما لا يُبدون تشابهًا فإنهم يشيرون إلى خلفية أكثر غموضًا، وتحتاج إلى التنقيب عنها في بعض المصادر الأقلّ شهرة، كالسريانية ربما، أو غيرها، لكنْ هناك شيءٌ يمكن العثور عليه على الدوام. وقد كان هناك قدرٌ كبيرٌ من الأفكار اليهودية والمسيحية في العصور القديمة المتأخرة، وكلّ ما علينا فعله هو البحث عمّا يناسب، وإذا فشلنا في ذلك فبإمكاننا أن نخضعها إلى بعض الرمزية[5]، أيًّا كان معنى ذلك. هذا يفترض بكلّ تأكيد أنّ جامع -أو جامعي- القرآن كان لديه إمكانية الوصول إلى مكتبة ضخمة! وأنّ كلّ المعرفة كانت في قبضة يده، نظرًا لأن التشابه بين الأفكار يعني وجود رابط، وكذلك الاختلاف يؤسّس لرابط، إلّا أنه رابط غير مباشر، هذا يعني فحسب أنّ علينا النظر بقليلٍ من الإمعان.
أما النقطة الأخيرة فترتبط بطبيعة اللغة العربية؛ صحيح أن عربية أغلب الشُّرّاح أحدث من عربية القرآن، وأنهم عند التصدي لمسألة نحوية، كما يشير رينولدز، فهم يتناولون مسألة مرتبطة باللغة العربية المعاصرة أكثر من عربية الكتاب الأصلي. وعلى صعيد آخر، فمن المهم تذكيرنا بالدَّور الكبير الذي أداه القرآن في تأسيس العربية الفصحى المتأخّرة. إن الافتتان بقضايا متحيّزة مثل اللغة الخاصّة بالقرآن لا ينصف عالمية الرسالة الدينية التي يمثلها القرآن. فاللاهوت يمكن مناقشته بأيّ لغة، وبالتأكيد نحن بحاجة إلى فهم اللغة الأصلية للنصّ إلّا أنه لا يجب علينا أن نتقيد بها. يحرص رينولدز بشدة على وضع القرآن حيث يظنّ أنه سياقه المناسب، بطريقة من شأنها -للمفارقة- التقليل من دوره بصفته نصًّا دينيًّا[6]. ويجب ألّا ننشغل حصرًا بتاريخية النصّ، خاصة نصّ مثل القرآن الذي -على خلاف الكتب المقدسة السابقة- لا يُصَوِّر نفسه نصًّا تاريخيًّا في أيّ حال.
لقد أبديت بعض الملاحظات النقدية بشأن منهجية هذا الكتاب، لكن الكتاب نفسه ملآن بتفصيل مدهش والمعلومات المذهلة حول الأفكار الدينية في العصر القديم المتأخر[7]. ويعدّ بالتأكيد مساهمة ذكية جدًّا ومتبحرة في فهمنا لهذه المرحلة موضع البحث، على الرغم من عدم اقتناعي بأنه يُخبِر بالكثير عن القرآن بصفته مصدرًا للدين الإسلامي. كما أن الكتاب يناسب نموذجًا بحثيًّا حاليًّا في غاية الحيوية، يهدف إلى فحص القرآن بصورة منهجية، وتجريده من الأساطير من الناحية العملية، ومُعالجته بالطريقة نفسها المعالَج بها النصوص المقدّسة السابقة، فلا ضير من ذلك. ويطرح المشروع قدرًا هائلًا من الأفكار المهمّة والمثيرة للاهتمام، ومع ذلك فإنه إلى حدّ ما يشبه تحليل قطعةٍ موسيقيةٍ ما من خلال فسيولوجيا الصوت، أو صورة من خلال تحليل الطريقة التي يعمل بها الضوء. قد تساعدنا تلك المقاربات في فهم كيفية حدوث شيءٍ ما في المقام الأول، غير أنها لا تسهم إلّا بالقليل في توضيح كيف يعمل، ولماذا يبدو على هذه الحالة، وما الذي يجعله مذهلًا ومؤثرًا لهذه الدرجة. هذه هي الأسئلة المثيرة للاهتمام، التي لم يُنظَر بشأنها بما يكفي في هذا الكتاب وهذا النوع من البحث. وهذا معناه أنّ الأفكار المُفصّلة للكتاب ليس بوسعها إلّا أن تُذهِلنا، بينما افتراضاته النظرية ضعيفة للغاية وتَعِد بأكثر مما يمكنها تقديمه.
[1] هاهنا مغالطة ظاهرة في افتراضات رينولدز من جانبين؛ الأول: أن لغة قريش التي نزل عليها القرآن هي التي اهتم علماء العربية بنقلها والحفاظ عليها دون غيرها من لغات العرب ولهجاتهم، وهي التي قام عليها التقعيد العربي بصورة عامة للغة، ما يجعل من افتراض وجود بُعْدٍ كبير بين قواعد اللغة التي بين أيدينا ولغة القرآن أمرًا مشكلًا. الثاني: فهمُ القرآن مرتبط رأسًا باللغة ودلالات الألفاظ العربية، وحتى لو ساعدت دراسة السياق اليهودي والمسيحي في ذلك، فإن ذلك لا يتأتى أبدًا تصور وقوعه بدون اللجوء للغة النصّ؛ ومن ثم لا يتصور انفكاك الفهم بعيدًا عن اللغة بحال. (قسم الترجمات).
[2] يشير ليمان هنا إلى نقطة مهمّة من ضمن محددات المرجعية الذاتية للقرآن، حيث إنّ القرآن يعتبر نفسه وحيًا مصحِّحًا ومصدِّقًا لما سبق، ويدفع بكون الكتب السابقة قد تم تحريفها، هذه المحددات حتى ضمن منظور نصّي، تجعل من غير الممكن أن يتم اعتبار القصص الكتابي بكليته مفسرًا للقرآن بكليته، حيث يتجاهل ذلك الموقف النقدي المتخذ من قِبل القرآن ذاته تجاه هذه الكتب، ويسقط في تجميع التشابهات العرضية أحيانًا ليتجاهل عمق الصنيع القرآني في مجادلته لهذا القصص وإعادة بنائه لإبراز المنظور الخاصّ به؛ لذا فإنّ استخدام محتوى الكتب السابقة كأدوات لتفسير النصّ تحتاج لإدراك أوسع للنصّ القرآني في كليته وكذلك للمحتوى الكتابي (قصص- شخصيات- موضوعات) في تنوعاته، حيث تتّسع كثيرًا هذه المدونة وتنوّع سياقاتها اللاهوتية والتاريخية، وعند إهمال السياقات الكلية في المقارنة، يصبح بالإمكان المماثلة السطحية بين بعض أجزاء القصص القرآني وبين أيّ نتف من هذا القصص السابق على اختلافه، وهو ما ينتقده بعد قليل ليمان كأحد عيوب عمل رينولدز. (قسم الترجمات).
[3] فكرة الوجود الكلي التي يشير إليها ليمان، والتي تشير إلى كون الشخصية في الكتاب المقدس ترِد ضمن منظور عقدي محدّد يُشكِّل ويؤطِّر كل أبعاد حضور هذه الشخصية -قد يكون مختلفًا عن ورودها في القرآن- أمر شديد الأهمية، حيث تختلف كثير من الشخصيات من حيث طبيعة حضورها ووظيفته وأثره بين القرآن والكتب السابقة وفقًا لهذا المنظور، فمثلًا يتحدّث القرآن عن يوسف النبي في حين لا نجد يوسف نبيًّا في الكتاب المقدس، هذه السمة تصعّب تمامًا عملية مقارنة يوسف القرآن بيوسف الكتاب المقدس أو اعتبار قصته بكل أبعادها اشتقاقًا منها أو تعديلًا فيها، بل تصبح قصة مستقلّة تمامًا ذات منظور خاص حول الرؤيا والنبوة. (قسم الترجمات).
[4] رغم غرابة المثال الذي يذكره ليمان كدليل على اختلاف شخصيات الكتب المقدسة السابقة عن شخصيات القرآن، إلّا أن الفكرة ذاتها تظلّ وجيهة، وهذا من حيث كون قصص الكتاب المقدس تبنى عبر أجيال وأحقاب عديدة ويباعد بينها سياقات مختلفة تحكم سرد هذا القصص، خصوصًا مع تداخل الكتاب المقدس الكبير مع شروحاته ليمثلوا معًا تقليدًا كبيرًا ينظر إليه بقدر مقارب من التقديس والمرجعية، هذا يجعل القصص الكتابي على الأغلب مفككًا، ويفتقد كثيرٌ من شخوصه للوحدة القصصية والتاريخية، مما يجعل بالفعل عملية المقارنة بين شخصيات القرآن والتي تتسم بتماسك واضح مرتبط حتى من منظور تاريخي بحكم كونه قد تم إعلانه للمستمعين في جيلين فحسب، عملية تحتاج لكبير تدقيق حيث تفتقد المقارنة في بعض الأحيان حتى للمبرّر السردي الصرف، بله الحديث عن تأثر أو اقتباس أو ما شابه. (قسم الترجمات).
[5] يشير ليمان هنا إلى إشكال منهجي أساسي في كتابات المستشرقين المقتنعين بوجود علاقة ارتهان بين القرآن والكتب السابقة، وهو كون هذه العلاقة القائمة على استخدام القرآن واستناده وتبعيّـته للأسبق -أيًّا كان مقدار التبعية وحدودها وكيفيتها- هي علاقة قائمة بشكل أوَّلي كمسلَّمة لا تحتاج للبرهنة ولا الإثبات؛ لذا يقتصر العمل اللاحق على اكتشاف وتعيين المصادر الأصلية التي استند لها القرآن من بين ركام لا تني في اكتشافه تترا يومًا بعد يوم، وفي هذا السياق تستخدم المناهج الأدبية المعاصرة لا لاكتشاف الصنيع القرآني الخاصّ في بناء موضوعاته وقصصه، بل يتم استخدامها لمحاولة تنسيبه لبعض الكتب التي يتعذّر أن تربط قصصه بها إلّا بنوع من التأويل الرمزي المتعسف في كثير من الأحيان. (قسم الترجمات).
[6] نزع القرآن من السياق العربي عبر الإيهام بالاختلاف الكامل والتام للغته عن اللغة العربية بقواعدها في عصر التدوين العباسي، يدخل ضمن محاولة أوسع لتنسيب القرآن للسياق السرياني عند بعض الباحثين أو الهيليني عند بعضهم الآخر، حيث يتم بعد هذا القطع والذي يتم عبر محاولة تضخيم حضور بعض الكلمات أو التراكيب التي قد تشابه صوتيًّا كلمات وتراكيب غير عربية، صياغة ادعاءات واسعة حول كون القرآن العربي هو نسخة نشأت فوق نسخة أصلية آرامية أو سريانية أو يونانية، إمّا قصدًا أو لسوء الفهم، ولعلّ أبرز طرحين في هذا السياق، ما كتبه غونتر لولينغ في كتابه: (حول القرآن الأصلي، 1974) عن علاقة القرآن بالتراتيل المسيحية السريانية، أو ما كتبه لكسنبرج عن (قراءة آرامية سريانية للنصّ)، فضلًا -بطبيعة الحال- عن تيار من المستشرقين الذي اتّكؤوا على تلك الملحوظات الفيلولوجية الصغيرة المختلف فيها بين الباحثين ليبلوروا نظريات عن انتماء الإسلام والقرآن لسياقات أخرى يونانية أو سورية أو خلافه. (قسم الترجمات).
[7] لرينولدز كتاب آخر يتنزل في ذات السياق بعنوان «القرآن، والكتاب المقدس كنصٍ ضمنيٍّ له»، وقد ترجمنا عرضًا نقديًّا لهذا الكتاب، كتبته الألمانية أنجيليكا نويفرت، ترجمة: أمنية أبو بكر، يمكن الإطلاع عليه ضمن الترجمات المنوعة على قسم الترجمات بموقع تفسير. (قسم الترجمات).
مواد تهمك
-
.jpg) تاريخ القرآن في الدراسات الغربية المعاصرة؛ الجزء الثاني: نشأة وطبيعة سلطة القرآن
تاريخ القرآن في الدراسات الغربية المعاصرة؛ الجزء الثاني: نشأة وطبيعة سلطة القرآن -
.jpg) القرآن، والكتاب المقدّس كنصٍّ ضمنيٍّ له، لجبريل سعيد رينولدز
القرآن، والكتاب المقدّس كنصٍّ ضمنيٍّ له، لجبريل سعيد رينولدز -
 قصص القرآن في كتاب (مصادر يهودية بالقرآن) لشالوم زاوي، قراءة تحليلية نقدية لنماذج مختارة
قصص القرآن في كتاب (مصادر يهودية بالقرآن) لشالوم زاوي، قراءة تحليلية نقدية لنماذج مختارة -
 القرآن من خلال القرآن؛ مصطلحات وحجج الخطاب القرآني حول القرآن، آن سيلفي بواليفو
القرآن من خلال القرآن؛ مصطلحات وحجج الخطاب القرآني حول القرآن، آن سيلفي بواليفو -
 القرآن في أوروبا؛ قراءة في التعامل الأوروبي مع القرآن في بدايات العصر الحديث
القرآن في أوروبا؛ قراءة في التعامل الأوروبي مع القرآن في بدايات العصر الحديث -
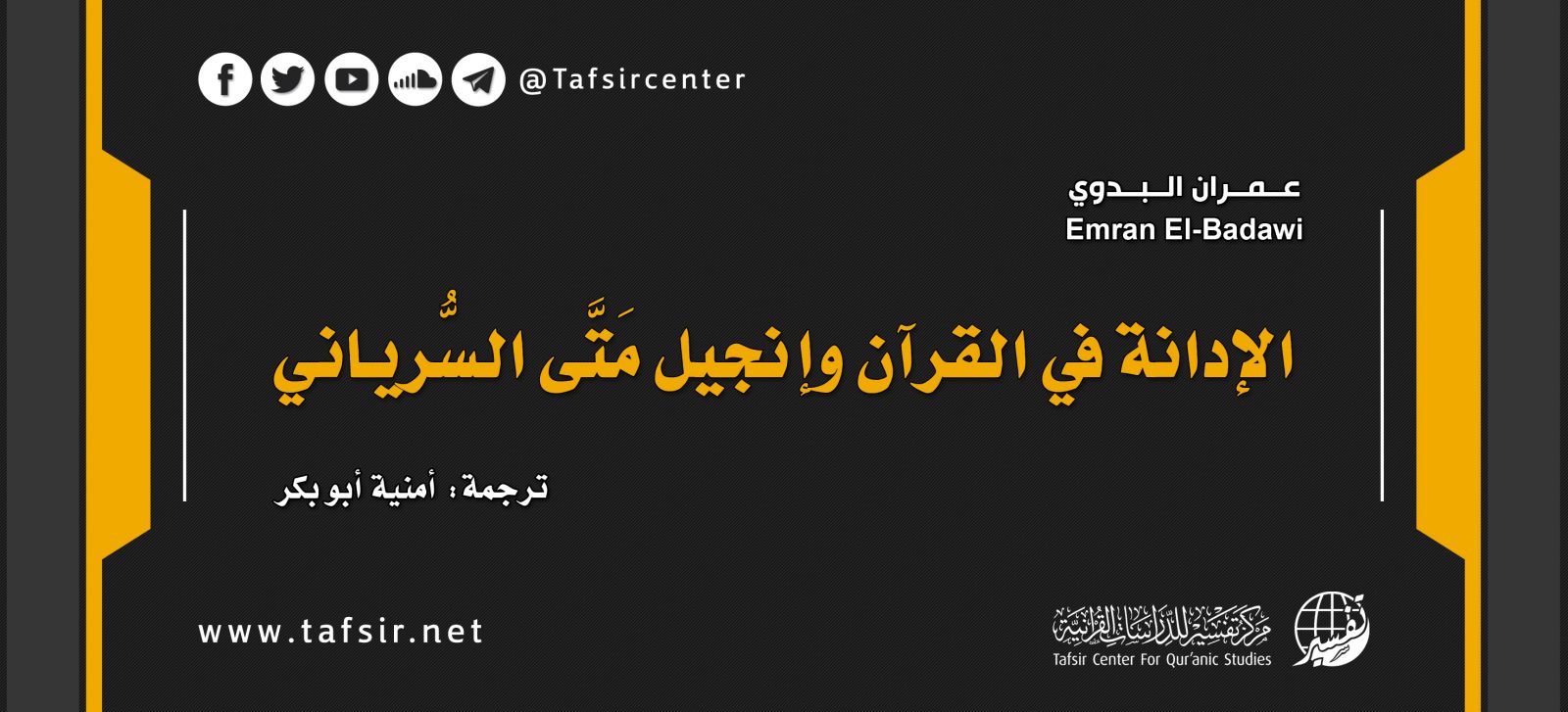 الإدانة في القرآن وإنجيل متّى السُّرياني
الإدانة في القرآن وإنجيل متّى السُّرياني


