قراءة تحليليَّة لتفسير ابن جرير الطبري لقوله تعالى: (وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ)
قراءة تحليليَّة لتفسير ابن جرير الطبري لقوله تعالى: (وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ)
الكاتب: محمد مصطفى عبد المجيد
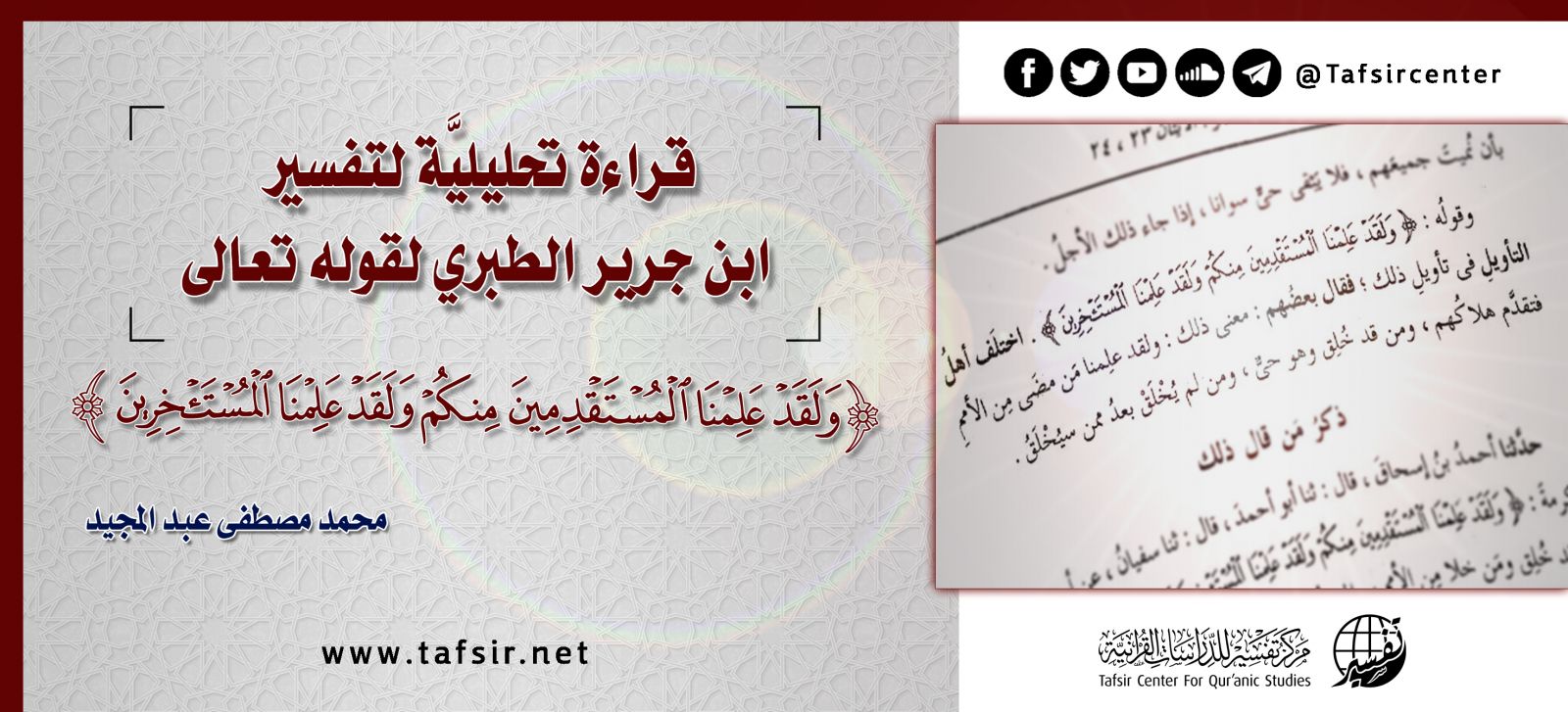
مما ينبغي أن تُصرَف إليه الهمم في كتب التفسير: العنايةُ بقراءة كلام المحرِّرين مِن متقدِّمي المفسّرين، وكدّ الذّهن في تحليله واستقراء الأصول والقواعد التي ابتُني عليها، لا بعينِ تقريراتِ المتأخرين وتقعيداتِهم وتحكيمِها في كلام السابقين تصحيحًا وتخطئةً، وليس هذا انطلاقًا مِن عصمة الأوائل؛ بل لما في هذا الصنيع من إخلالٍ بالمنهجيةِ، وعدمِ تحريرٍ يؤثِّر في تصوُّر مسائل العلم، وينسحبُ إلى التغليط في غير مواضع الغلط، فضلًا عن حجبِه كثيرًا مِن العلم المبثوث في ثنايا كلام الأوائل، ثمَّ إذا كان مجال حديثنا عن علمٍ لم يَنَلْ نصيبه من التقعيد والتأصيل المحرَّر كالتفسير؛ فإنّ الحاجة إلى التنبيه على هذا الأمر أدعى وأشدُّ.
ولا يخفى ما لإمام المفسّرين ابن جرير الطبري (ت: 310هـ) مِن مكانة رفيعة بين المفسرين، وما لتفسيره من شهرة وجلال وتأثير، وما تميَّز به مِن تحرير الأقوال، وتوجيهها، والترجيح بينها، وذِكر وجوه الترجيح، إلى غير ذلك ممَّا تميَّز به تفسير هذا الإمام المقدَّم، كما لا يخفى على مَن له عنايةٌ به أن مصنِّفَه قد أقامه على أصولٍ مستقِرَّةٍ وثوابتَ حاضرةٍ تتلمَّسها في أقواله وترجيحاته وتعليلاته في طول كتابه، ولكنها ربما لم تَلْقَ العناية اللائقة بها في بحثها واستخراجها من مكنون عباراته.
ونحن في هذه المقالة نقف مع تفسير ابن جرير الطبري لآية مختارة من القرآن الكريم، ونسعى في قراءة كلامه، وتحليل صنيعه، والاجتهاد في تسليط الضوء على مخبَّـآته، لا بقصد الحكم والترجيح أو التصحيح والتخطئة؛ بل مِن باب ما ذكرنا من القراءة التأصيلية لكلام إمام من أئمة التفسير.
والآية المختارة لتسليط الضوء على كلام ابن جرير في تأويلها هي قول الله -تعالى-: {وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ}[الحِجر: 24]، ولاختيار هذه الآية بالخصوص أسباب ستتضح تفصيلًا من خلال تحليل كلام الإمام -رحمه الله-، لكن يأتي في مقدمتها: ما ورد في الآية من سببٍ للنزول، عَدَّه بعضُهم مشكِلًا؛ في موافقته السياق أو في معناه ودلالته، وتأمُّل طريقة الإمام -رحمه الله- في التعامل معه، والتي لا تتوافق مع أكثر التقعيد المشتهِر في مشكل أسباب النزول عند كثير من المتأخرين، بل عند التأمُّل لا يكاد يظهر أثرٌ لهذا التقعيد في تعامله مع هذه الرواية في هذه الآية، ولا شكَّ أن لهذا أثرَه في إعادة النظر في منهج الإمام في التعامل مع هذه المسألة، وإعادة النظر في التقعيد المتأخِّر نفسِه واعتباراته عند مقعِّديه، خاصّة مع عدم حضور أكثره عند أحدِ أهمِّ أئمةِ هذا الفنّ.
وكذلك من أسباب تناول هذه الآية بالخصوص ما ظهر في صنيع ابن جرير -رحمه الله- فيها من تعدُّد مراتب الترجيح، وهو مَلْمَحٌ متكرِّرٌ في تفسيره، لم يأخذ حظّه -أيضًا- من التأمل والدراسة والتحليل.
والقطع بمنهج المفسِّر في مثل هذه القضايا أو غيرها يحتاج إلى استقراء تامٍّ لتفسيره، وتحليلٍ متمهِّلٍ للمواضع التي تعرَّض فيها لنظائره؛ حتى تُستخلص قواعده التي بنى عليها تعامله بصورة منهجية صحيحة؛ لذا فتناولنا في هذه المقالة ليس من شأنه التحرير الكامل لمنهج المفسِّر في مشكل أسباب النزول أو في مراتب الترجيح أو غير ذلك مما سيُتعرَّض له أثناء التحليل لكلامه؛ لكن فتحٌ للبابِ لمثل هذا النَّظر، ولفتٌ للأنظار إلى ما قد يخفى في ثنايا الكلام، وإثارة للأذهان لتناول هذه المسائل وغيرها انطلاقًا من كلام المفسِّر نفسه وتحليلِه، لا بتحكيم تقعيدات غيره فيه.
ثم بعد أن نستعرض كلام ابن جرير الطبري -رحمه الله- ونتناوله بالقراءة والتحليل نُردف ذلك بتذييلٍ فيه جملةٌ من أقوال المفسرين بعد ابن جرير، مع بعض التنبيهات عليها، وهي أقوال مختارة الغرض منها: مزيدُ بيان لكلامه وتحريره ببيان أوجه الموافقة والمفارقة مع هذه الأقوال.
ونبدأ أولًا بعرض الأقوال التي ذكرها ابن جرير في قوله تعالى: {وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ}[الحِجر: 24].
الأقوال التي أوردها ابن جرير في تفسير الآية:
أورد ابن جرير عدة أقوال في تفسير الآية، وأسندها إلى قائليها، وهي:
1. ولقد علمنا مَن مضى مِن الأمم فتقدَّم هلاكهم، ومَن قد خُلق وهو حيٌّ، ومَن لم يُخلق بعدُ ممَّن سيُخلق.
2. عنى بالمستقدمين: الذين قد هلكوا، والمستأخرين: الأحياء الذين لم يهلكوا.
3. ولقد علمنا المستقدمين في أول الخلق، والمستأخرين في آخرهم.
4. ولقد علمنا المستقدمين من الأمم، والمستأخرين من أمة محمد -صلى الله عليه وسلم-.
5. ولقد علمنا المستقدمين منكم في الخير، والمستأخرين عنه.
6. ولقد علمنا المستقدمين منكم في الصفوف في الصلاة، والمستأخرين فيها بسبب النساء[1].
التنبيه على محلِّ الإشكال في تفسير الآية:
من خلال سرد الأقوال التي أوردها ابن جرير في تفسير الآية يتبين أنَّ محلَّ النزاع هو {الْمُسْتَقْدِمِينَ} و{الْمُسْتَأْخِرِينَ} والمراد بهما في الآية، والأقوال الخمسة الأولى لا إشكال فيها من حيث تقدير الموصوف في المستقدمين والمستأخرين، وكلها احتمالات عقلية مقبولة، أما السادس فقد يُستشكَل، إلا أن مستنده ما ورد في نزول الآية، وقد أورده ابن جرير في ذكر القائلين بهذا القول، فساق بسنده إلى أبي الجوزاء عن ابن عباس: قال: كانت تصلي خلفَ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- امرأةٌ حسناءُ مِن أحسن الناس، فكان بعضُ الناس يستقدم في الصف الأول لئلَّا يراها، ويستأخِر بعضهم حتى يكون في الصف المؤخَّر، فإذا ركع نظر مِن تحت إبطيه في الصف، فأنزل الله في شأنها: {وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ}[الحِجر: 24][2].
وقد رواه غيرُ ابن جرير، واختُلف في ثبوته[3].
تحليل صنيع ابن جرير في تفسيره للآية:
استعرض ابن جرير الأقوال الواردة في تفسير الآية، مع ذكر القائلين بكلٍّ منها، وإسناد كلّ قول لقائله، ثم عقَّب بذكر اختياره وتعليله؛ كما هي عادته في تفسيره.
وسننقل كلامه بعد سرده للأقوال وقائليها مجمَلًا، ثم نتناوله بالتحليل والمناقشة.
قال -رحمه الله-: «وأولى الأقوال عندي في ذلك بالصحة قول مَن قال: معنى ذلك: ولقد علمنا الأموات منكم يا بني آدم فتقدَّم موتُه، ولقد علمنا المستأخرين الذين استأخر موتُهم ممن هو حيٌّ، ومَن هو حادث منكم ممَّن لم يحدث بعدُ؛ لدلالة ما قبله من الكلام، وهو قوله: {وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ}[الحجر: 23]، وما بعده وهو قوله: {وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ}[الحجر: 25]، على أن ذلك كذلك؛ إِذْ كان بين هذين الخبرين، ولم يَجْرِ قبلَ ذلك مِن الكلام ما يدلُّ على خلافه، ولا جاء بعده، وجائزٌ أن تكون نزلت في شأن المستقدمين في الصفِّ لشأن النساء، والمستأخرين فيه لذلك، ثم يكونُ الله -عزّ وجلّ- عمَّ بالمعنى المراد منه جميعَ الخلق، فقال -جلَّ ثناؤه- لهم: قد علمنا ما مضى مِن الخلق وأحصيناهم، وما كانوا يعملون، ومَن هو حيٌّ منكم ومَن هو حادث بعدكم أيها الناس، وأعمالَ جميعِكم خيرَها وشرَّها، وأحصينا جميع ذلك، ونحن نحشر جميعَهم، فنجازي كلًّا بأعماله؛ إن خيرًا فخيرًا، وإن شرًّا فشرًّا، فيكون ذلك تهديدًا ووعيدًا للمستأخرين في الصفوف لشأن النساء، ولكلِّ مَن تعدَّى حدَّ الله، وعمل بغير ما أذن له به، ووعدًا لمن تقدَّم في الصفوف لسبب النساء، وسارع إلى محبة الله ورضوانه في أفعاله كلها»[4].
هذا ما عقَّب به ابن جرير -رحمه الله- بعد ذكر الأقوال وقائليها، ويمكن تقسيم كلامه على محاور ثلاثة:
1. الترجيح، وذكر مستنده وهو السياق.
2. تجويز أن تكون الآية نزلت في السبب المذكور.
3. بيان وجه دخول الأقوال في عموم لفظ الآية.
وإلى بيان هذه المحاور والتعليق عليها.
1. الترجيح، وذكر مستنده وهو السياق:
صدَّر ابن جرير تعقيبه بذكر أولى الأقوال عنده بالصواب، وهو أول الأقوال التي سردها وأسندها إلى قائليها، ثم علَّل ترجيحه بقوله: «لدلالة ما قبله من الكلام، وهو قوله: {وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ}[الحجر: 23]، وما بعده وهو قوله: {وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ}[الحجر: 25] على أن ذلك كذلك؛ إِذْ كان بين هذين الخبرين، ولم يَجْرِ قبلَ ذلك من الكلام ما يدلُّ على خلافه، ولا جاء بعده».
ونلحظ في هذا التعليل عدّة أمور:
1. أن ترجيحه راجع إلى ما دلَّ عليه سياق الآيات.
2. بيانه وجه قوة دلالة السياق في هذا الموضع من خلال أمرين:
أ) كون السياق سابقًا ولاحقًا، وهذا يزيد دلالة السياق قوةً عن لو كان مقتصرًا على السابق أو اللاحق[5].
ب) استبعاد سائر الاحتمالات ببيان أنَّ ما قبل سابق الآية ولاحقها -والذي استدل به على المعنى- لا دلالة فيه على معنى آخر، فقال: «ولم يَجْرِ قبلَ ذلك من الكلام ما يدلُّ على خلافه، ولا جاء بعده».
3. تقديمه لدلالة السياق على المعنى الذي دلَّ عليه ما رواه في نزول الآية، وهو المتعلق بصفوف الصلاة والنساء، وفيه احتمالان عقليَّان:
أ) أن يكون مسلِّمًا بكون القصة سببًا للنزول، ورغم ذلك يقدِّم السياق.
ب) أن لا يسلِّم بكونها سببًا للنزول، فيُحتاج إلى الوقوف على وجه عدم اعتبارها سببًا.
وتحديد أيّ الاحتمالين وتعليله يتضَّح معنا في المحور التالي.
2. تجويز أن تكون الآية نزلت في السبب المذكور:
بعد أن ذكر ابن جرير اختياره في تأويل الآية، وبيَّن وجهه؛ جوَّز أن تكون الآية نزلت في سبب النزول المذكور، ثم عمَّت بعد ذلك، وذلك في قوله: «وجائزٌ أن تكون نزلت في شأن المستقدمين في الصفِّ لشأن النساء، والمستأخرين فيه لذلك، ثم يكونُ الله -عز وجل- عمَّ بالمعنى المراد منه جميعَ الخلق».
ونلحظ هنا عدّة أمور:
1. فرَّق ابن جرير بين مرتبتين في الحكم على الأقوال: الترجيح والتجويز، فرجَّح القول الأول، وأنزل المعنى الذي دلَّت عليه القصة الواردة في النزول إلى مرتبة الجائز.
2.الفرق بين المرتبتين في هذا الموضع ليس في اعتبار عموم اللفظ أو خصوص السبب، فابن جرير يفرِّق هنا بين تفسير الآية بما دلَّ عليه سياقها وهو الذي رجَّحه، وما دلّ عليه سبب النزول حتى مع القول بعموم اللفظ فيه وهو الذي جوَّزه.
3. يُلاحظ أنّ قوة السياق أثَّرت عند ابن جرير في الحكم على صحة سببية السبب في نزول الآية، لا أنه تقديم للسياق على سبب النزول مع التسليم بكونه سببًا، فجَعَلَ السياقَ حَكَمًا في اعتبار السببيَّة، وهذا بيِّن في عبارته في التجويز: «جائز أن تكون نزلت...»، فمحل النظر هنا: (هل يُحكَّم السياقُ في اعتبار السببية مِن عدمها؟)، وليس: (هل يُقدَّم السياق على المعنى الدال عليه سبب النزول مع التسليم بسببيَّته؟).
وقد تكرَّر من ابن جرير اعتبار سياق الآيات حَكَمًا على أسباب النزول: قبولًا وردًّا، أو في الترجيح بينها، وفي هذا الموضع: نقلها من درجة القبول إلى درجة الجائز.
وإلا فلو ثبت السبب عنده فدخول صورته قطعي، ولا يحتمل أن يخرج بالاجتهاد، وهو محلّ اتفاق بين أهل العلم، وهو صنيع ابن جرير في مواضع عدّة في تفسيره[6].
4. لم يتعرَّض ابن جرير للنقد الحديثي للقصة، ولم يستشكل المتن وما نُسب للصحابة فيه، فلم يكن لهذين الأمرين حضور في ترجيحه، بل كان مستنده في الترجيح هو مراعاة السياق، ولم يُشِر إلى غيره.
ومن المهمِّ العناية بمنازع الأقوال واعتباراتها؛ فأسباب عدم اختيار القول قد تتعدَّد، وبينها مراتب، ولا يمكن التسوية بينها في الصناعة التفسيرية، كما لا يمكن تقويل نصّ المفسِّر ما لم يَقُلْه أو يَلزم منه، فهذا فضلًا عن كونه غير مستقيم منهجيًّا فإنه يحجُب الاعتبار الذي انطلق منه المفسر في ترجيحه واختياره.
5. في سياق تجويز نزول الآية في قصة صفوف الصلاة بيَّن ابن جرير أنها عمَّت بمعناها جميع الخلق، ومن دلالات ذلك:
- أن ابن جرير يَعُدُّ نزول الآية على سبب معيَّن غير مانع للقول بالعموم فيها، وقد نصَّ على ذلك في أكثر من موضع، منها قوله: «وقد تنزل الآية في الشيء ثم يعمُّ بها كلّ مَن كان في معناه»[7].
- أن تقديم ابن جرير للمعنى الذي دلَّ عليه السياق في هذا المقام حتى مع الاعتبار بعموم لفظ الآية في المعنى الآخر، فالمعنى الدالّ عليه السبب مع عموم الآية في مرتبة الجائز هنا، وصياغته في العموم هي توجيه لتجويزه، كما سيأتي.
ونلفت النظر هنا إلى أمرين:
1. قد ينقل بعض المفسّرين عن ابن جرير التوقّف في بعض المسائل، أو الجمع بين الأقوال الواردة فيها، وبالرجوع إلى كلامه يُلاحَظ أنَّ في كلامه تجويزًا لبعض الأقوال أو لها جميعًا، وهذا لا يُعَدُّ توقفًا، بدلالة:
- ما يذكره في بعض المواضع تعقيبًا على التجويز؛ كالمنع من تعيين أحدها أو الجمع بينها[8].
- ما ذكره في مثل هذا الموضع، حيث جوَّز بعد ترجيحه.
2. تحرير مسلك ابن جرير في التعامل مع أسباب النزول بصفة عامة يحتاج إلى دراسةٍ لمواقفه منها.
فما منزلة صيغ أسباب النزول عند ابن جرير؟ وما مدى تأثير ثبوت خبر سبب النزول في القول به من عدمه؟ وهل يَعُدُّ ابن جرير أسباب النزول مما يلزم أن يُتشدد في أسانيده كما يشدِّد في بعض المواضع؟ وإلى أيّ مدى تكون قوة المرجِّحات الأخرى -كالسياق في هذا الموضع- لتُقَدَّم على سبب النزول؟ ومتى يَنتقل المعنى الدّال عليه سبب النزول إلى مرتبة المرجوح؟ ومتى يكون من باب الجائز التفسيري؟ كلها أسئلة تحتاج إلى بحث متأنٍّ واستقراء وتحليل دقيق للنصوص.
3. بيان وجه دخول الأقوال في عموم لفظ الآية:
بعد أن رجَّح ابن جرير القول الأول في تفسير الآية، ثم بيَّن جواز أن تكون الآية نزلت في شأن صفوف الصلاة ثم عمَّت الآية بعد ذلك؛ صاغ معنى الآية بما يَدخل فيه معنى صفوف الصلاة، وبما يحتمل غيره من المعاني، كالسَّبق في عمل الخير ونحوه.
قال: «قال -جلّ ثناؤه- لهم: قد علمنا ما مضى مِن الخلق وأحصيناهم، وما كانوا يعملون، ومَن هو حيٌّ منكم ومَن هو حادث بعدكم أيها الناس، وأعمالَ جميعكم خيرها وشرّها، وأحصينا جميع ذلك، ونحن نحشر جميعهم، فنجازي كلًّا بأعماله؛ إن خيرًا فخيرًا، وإن شرًّا فشرًّا، فيكون ذلك تهديدًا ووعيدًا للمستأخرين في الصفوف لشأن النساء، ولكلِّ مَن تعدَّى حدَّ الله، وعمل بغير ما أذن له به، ووعدًا لمن تقدَّم في الصفوف لسبب النساء، وسارع إلى محبة الله ورضوانه في أفعاله كلّها».
ونلحظ هنا بعض الأمور:
1. اعتنى ابن جرير بصياغة معنى الآية بعبارة أطال فيها، وركَّب المحتملات في صياغته؛ بيانًا لوجه العموم على هذا الاحتمال.
2.ما أورده ابن جرير هنا ليس ترجيحًا للقول بالعموم، بل توجيه لما ذكره من تجويزِ غيرِ ما دلَّ عليه السياق، وهذا مما قد يقع فيه الخطأ في نسبة القول لابن جرير، وسيأتي ذكر مثال لهذا الخطأ.
3. تفترق دلالة (العلم) باختلاف القول المختار في تفسير الآية؛ بين إرادة الإعلام بالعلم نفسه، وإرادة لازمه مِن المحاسبة أو الوعد والوعيد.
وعبارة ابن جرير في جَمْعِه غاية في التحرير؛ فإنَّ ذِكر العلم فيمَن مضى من الخلق ومَن هو حيٌّ ومَن لم يأت بعد مُرادٌ به نفس العلم، والتدليل على سعة علم الله -عز وجل- وشموله للمستقدمين والمستأخرين، فاكتفى في صدر عبارة الجمع بذكر العلم.
أما في ذكر العمل خيره وشرّه -من التقدّم والتأخّر في الصفوف وغيره- فإنّ المرادَ فيه مِن العلم لازمُه، وهو الوعد للمستقدم والتهديد للمستأخر، فنصَّ على ذلك في عبارة الجمع بقوله: «فنجازي كلًّا بأعماله؛ إن خيرًا فخيرًا، وإن شرًّا فشرًّا، فيكون ذلك تهديدًا ووعيدًاللمستأخرين في الصفوف لشأن النساء، ولكلِّ مَن تعدَّى حدَّ الله، وعمل بغير ما أذن له به، ووعدًا لمن تقدَّم في الصفوف لسبب النساء، وسارع إلى محبة الله ورضوانه في أفعاله كلّها».
وهذا دقيقٌ في اعتبار الدلالات المترتبة على اختلاف الأقوال في الآية[9].
تذييل في صنيع بعض المفسرين:
وبعد هذه الملاحظات في قراءة كلام ابن جرير حول الآية نذيِّل بذكر أقوال بعض المفسرين مع التعليق عليها، واخترتُ منهم مَن في كلامه موافقةٌ أو زيادةٌ أو مخالفةٌ تزيد ما ذكرناه في تحليل كلام ابن جرير جلاءً ووضوحًا.
1. ابن عطية (ت: 542هـ):
قال رحمه الله: «ثم أخبر -تعالى- بإحاطة علمه بمن تقدَّم من الأمم، وبمن تأخَّر في الزمن من لدن أُهبط آدم إلى الأرض إلى يوم القيامة»، ثم قال: «بهذا سياق معنى الآية، وهو قول جمهور المفسرين».
ثم نقل قول الحسن في الطاعة والمعصية، وهو القول الخامس فيما ذكر ابن جرير، وعقَّب بقوله: «وإن كان اللفظ يتناول كلَّ تقدُّم وتأخُّر على جميع وجوهه، فليس يطَّرد سياق معنى الآية إلا كما قدَّمنا».
ثم ذكر قصة صفوف الصلاة، وقال: «وما تقدَّم الآية من قوله: {وَنَحْنُ الْوارِثُونَ} وما تأخر من قوله: {وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ}، يُضعِف هذه التأويلات، لأنها تُذهِب اتصال المعنى».
ومما يلاحظ في كلامه:
1. أنه نسب القول الأول -والذي اختاره ابن جرير- إلى جمهور المفسرين.
2. أنه مع كون اللفظ عامًّا ومحتملًا لدخول سواه من المعاني، إلا أن سياق الآيات جعله مقدِّمًا للقول الأول، فالمفارقةُ بين القول بالعموم والقول الدّال عليه السياق واضحةٌ عنده كما هي عند ابن جرير.
3. استدلاله بالسياق السابق واللاحق على إضعاف سائر التأويلات كصنيع ابن جرير.
4.عدم مناقشته لمدلول قصة صفوف الصلاة من أيّ اعتبار سوى مخالفة السياق.
وزاد على ابن جرير نسبة القول لجمهور المفسرين، وزاد ابنُ جرير عليه تجويز أن تكون الآية نزلت في هذا المعنى، مع توجيه المعنى في ضوء عموم اللفظ.
2. ابن العربي (ت: 543هـ):
ذكر المسألة الأولى في سبب نزول الآية، وذكر فيها قصة صفوف الصلاة والمرأة، ثم المسألة الثانية في شرح المراد منها، فذكر خمسة أقوال، خامسها: (المستقدمين في صفوف الصلاة والمستأخرين بها)، ثم قال: «وكلّ هذا معلوم لله سبحانه؛ فإنه عالمٌ بكلّ موجود ومعدوم، وبما كان، وبما يكون، وبما لا يكون أن لو كان كيف كان يكون»[10].
ومما يلاحظ في كلامه:
1. جمعه بين الأقوال؛ باعتبارها كلّها داخلة في معلوم الله تعالى.
2. إثباته لسببية قصة صفوف الصلاة لنزول الآية.
3. يُلحظ بوضوح وجه مفارقة هذا الاختيار لكلام ابن جرير الذي سبق تحليله.
3. ابن كثير (ت: 774هـ):
قال -رحمه الله-: «ثم قال مخبرًا عن تمام علمه بهم، أولهم وآخرهم: {وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ}، قال ابن عباس -رضي الله عنهما-: المستقدمون: كلّ من هلك من لدن آدم -عليه السلام-، والمستأخرون: مَن هو حيٌّ ومَن سيأتي إلى يوم القيامة»، ثم ذكر جملة ممن رُوي عنهم نحوه، وقال: «وهو اختيار ابن جرير، رحمه الله».
ثم ذكر قصة صفوف الصلاة، ووصف الحديث بأنه «حديث غريب جدًّا»، وقال: «وهذا الحديث فيه نكارة شديدة»، وتكلَّم في إسناده، ثم قال: «فالظاهر أنه من كلام أبي الجوزاء فقط، ليس فيه لابن عباس ذكر»[11].
ومما يلاحظ في كلامه:
1.أنه توجَّه إلى النقد الحديثي للقصة، ولم يتعرَّض لدلالة السياق في ثبوتها كسبب نزول من عدمه، وعدُّه لها أنها من كلام أبي الجوزاء يجعلها من باب المرسَل.
2. ما وصف به الحديث بالنكارة الشديدة وشدة الغرابة قد لا يتجه حديثيًّا حتى في ضوء ما ذكره من انتقادات، والظاهر أنه أراد نكارة المتن، وغرابة القصة ذاتها[12].
4. الآلوسي (ت: 1270هـ):
قال: «{وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ} مَن مات، {وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ} مَن هو حيّ لم يمت بعدُ» وعزاه لابن عباس من رواية ابن أبي حاتم، ثم ساق أقوالًا أخرى مقاربة، وذكر قول الحسن في السبق إلى الطاعة والتأخر عنها، ثم قال: «وروي عن معتمر أنه قال: بلغَنا أن الآية في القتال، فحدثت أبي فقال: لقد نزلت قبل أن يُفرض القتال، فعلى هذا أخذ الجهاد في عموم الطاعة ليس بشيء، على أنه ليس في تفسير ذلك بالمستقدمين والمستأخرين فيها كمال مناسبة، والمراد من علمه –تعالى- بهؤلاء علمه -سبحانه- بأحوالهم، والآية لبيان كمال علمه -جلَّ وعلا- بعد الاحتجاج على كمال قدرته تعالى، فإن ما يدل عليها دليل عليه ضرورةً أن القادر على كلّ شيء لا بد من علمه بما يصنعه، وفي تكرير قوله تعالى: {وَلَقَدْ عَلِمْنَا} ما لا يخفى من الدلالة على التأكيد».
ثم قال: «وأخرج أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه والحاكم وصححه والبيهقي في سننه. وجماعة من طريق أبي الجوزاء عن ابن عباس قال:...»، وذكر قصة صفوف الصلاة والمرأة.
ثم قال: «وقال الربيع بن أنس: حرَّض النبي -صلى الله عليه وسلم- على الصف الأول في الصلاة فازدحم الناس عليه، وكان بنو عذرة دُورهم قاصية عن المسجد، فقالوا: نبيع دُورنا ونشتري دُورًا قريبة من المسجد؛ فأنزل الله تعالى الآية»، وهذا سبب آخر[13].
قال: «وأنت تعلم أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ومن هنا قال بعضهم: الأولى الحمل على العموم، أي: عَلِمنا مَن اتصف بالتقدم والتأخر في الولادة والموت والإسلام وصفوف الصلاة وغير ذلك»[14].
ومما يلاحظ في كلامه:
1. اختياره المعنى المناسب للسياق، واستدلاله به عليه، حتى إنه لما ذكر الاعتراض على كون الآية في القتال بأن القتال لم يكن قد شُرع بعد؛ عقَّب بما يُفهم منه أنه ولو كان القتال داخلًا في عموم العمل فإن الكلام غير موافق للسياق.
2. ذكر قصتين في سبب النزول إحداهما قصة صفوف الصلاة والمرأة، وعقَّب عليهما بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وعزا إلى بعضهم القول بأن الأولى الحمل على العموم.
3. فهم الألباني (ت: 1420هـ) من كلام الآلوسي فيمن قال أن الأولى الحمل على العموم أن المراد كلام ابن جرير، فقال بعد كلام الآلوسي السابق: «وهو يشير بذلك إلى الإمام ابن جرير -رحمه الله- فإنه اختار حمل الآية على العموم المذكور»[15]، وهو وإن استحسن كلام ابن جرير ووصفه بأنه «غاية في التحقيق»[16]؛ إلا أن توصيفه لصنيع ابن جرير ليس دقيقًا؛ فابن جرير لم يختَرْ حمل الآية على العموم، بل رجَّح أحد المعاني فيها، وجوَّز أن تكون قد نزلت في السبب المذكور في صفوف الصلاة، وبيَّن وجه العموم على هذا التجويز، كما تبيَّن ذلك فيما سبق، فنسبة القول بالعموم له غير صحيحة.
وتستقيم نسبة الكلام الذي ذكره الآلوسي في القول بالعموم لابن العربي ومن وافقه كالقرطبي، والذي بينَّا وجه مفارقته لكلام ابن جرير.
خاتمة:
لا يخفى على كلّ معتنٍ بتفسير الإمام ابن جرير الطبري رتبة هذا الإمام في التفسير، وقوة صناعته التي استحق بها أن يكون شيخ المفسرين، وأن تكون لكتابه هذه الصدارة بين كتب التفسير، وضرورة العناية بتحليل أقواله وتأمّلها، فإن هذا من شأنه أن يُثير كثيرًا من المسائل العلمية للبحث، وإعادة النظر في بعض التقريرات، لكن شريطة أن تكون قراءة تفسيره بعين تفسيره، لا بعين تقريرات غيره ممن بعده من أهل العلم، ثم يبقى كلّ اجتهاد محتمِل للصواب والخطأ إذا وُزن بميزان العلم، لكن أولًا يُفْهَم الاجتهاد وتُدْرَك منازعه بصورة صحيحة، ولا يُحكم على تصوّر غير صحيح بالصواب والخطأ.
وقد خلصت هذه القراءة لتفسير ابن جرير لقوله تعالى: {وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ}[الحجر: 24] إلى عدد من النتائج، من أهمها:
1. أنَّ ابن جرير قد يُحكِّم السياق في الحكم على سبب النزول من حيث ثبوت سببيته وعدمها.
2. أنَّ من مراتب الحكم على الأقوال عند ابن جرير: ترجيح القول، وتجويز القول، وأن تجويز القول مباين للتوقف في الحكم.
3. توجيه ابن جرير للقول المجوَّز رغم ترجيح غيره، وكونه سببًا في وقوع الخطأ في نسبة القول إليه، لذلك فلا بد مِن الدّقة في تحليل كلامه، والحرص قدر المستطاع على عدم نقل اختياره بواسطة؛ لكثرة وقوع الخطأ فيه.
4. قد تتعدّد اعتبارات مرجوحية القول عند المفسّرين، فينبغي عدم تحميل نصوصهم ما لا تحتمله من الاعتبارات، خاصة المحرِّرين منهم؛ حتى يتسنى الاستفادة من تحريراتهم.
5. قراءة كتب الأئمة المحرِّرين من متقدِّمي المفسرين بعين تقريرات المتأخرين فيه خللٌ منهجيٌّ، له آثاره في تقرير مسائل العلم، والتغليط في غير مواضع الغلط، وعدم الإفادة من تأصيلات أئمة الصَّنعة، مما هو أولى وأحرى بالعناية والتأمل.
واللهَ أسأل أن يرحم ابن جرير الطبري وسائر علمائنا، وأن يجزيهم عن الإسلام خيرًا، وأن ينفعنا بعلومهم، ونبرأ إليه من الخطأ والزلل، ونسأله العفو والغفران، والله المستعان.
[1] يُنظر: جامع البيان، ابن جرير الطبري (14/ 48-54)، ط. عالم الكتب.
[2] المصدر السابق (14/ 54).
[3] رواه أيضًا: أحمد (2783)، والترمذي (3122)، والنسائي (869)، وفي الكبرى (869)، وابن ماجه (1046)، وابن خزيمة (1696، 1697)، وابن حبان (401)، والحاكم (2/ 353).
كما عزاه ابن كثير إلى ابن أبي حاتم في تفسيره (تفسير ابن كثير 4/ 532، ط. طيبة)، وعزاه السيوطي في (الدر المنثور) إلى سعيد بن منصور، وابن المنذر، وابن مردويه. (5/ 73، 74)، ط. دار الفكر.
ورجَّح الترمذي إرساله فقال عقب روايته الحديث: «وروى جعفر بن سليمان هذا الحديث عن عمرو بن مالك، عن أبي الجوزاء، نحوه، ولم يذكر فيه عن ابن عباس، وهذا أشبه أن يكون أصحَّ من حديث نوح».
ووصفه ابن كثير بأنه «حديث غريب جدًّا»، وقال: «هذا الحديث فيه نكارة شديدة»، وقال: «الظاهر أنه من كلام أبي الجوزاء فقط، ليس فيه لابن عباس ذِكر، وقد قال الترمذي: هذا أشبه من رواية نوح بن قيس، والله أعلم». تفسير القرآن العظيم (4/ 532).
وسوى تصحيح ابن خزيمة وابن حبان والحاكم للحديث؛ فقد صحَّحه من المعاصرين: أحمد شاكر في تعليقه على المسند، وعلَّق على التعليل السابق بعد كلام له بقوله: «وتعليل الترمذي وابن كثير ليس بعِلَّة». حاشية (3/ 236، 237)، ط. دار الحديث.
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة، وذكر إعلال الترمذي واعتماد ابن كثير له، ثم قال: «وهذا الإعلال ليس بشيء عندي، وذلك من وجوه»، وذكر ثلاثة وجوه. يُنظر: السلسلة الصحيحة (ح 2472) (5/ 608-612)، ط. المعارف.
[4] جامع البيان (14/ 54، 55).
[5] فيما رواه ابن جرير في تفسير الآية استدلال لمحمد بن كعب القرظي بالسياق اللاحق في هذه الآية، فقد روى عن أبي معشر، قال: «سمعت عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود يذاكر محمدَ بن كعب في قول الله: {وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ}، فقال عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود: خير صفوف الرجال المقدَّم، وشرّ صفوف الرجال المؤخَّر، وخير صفوف النساء المؤخَّر، وشرّ صفوف النساء المقدَّم، فقال محمد بن كعب: ليس هكذا {وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ} الميت والمقتول، و{الْمُسْتَأْخِرِينَ}: مَن يلحق بهم مِن بعد، {وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ}، فقال عون بن عبد الله: وفقك الله، وجزاك خيرًا». جامع البيان (14/ 48).
[6] يُنظر: جامع البيان (3/ 347)، (3/ 376)، (6/ 552)، والاستدلال في التفسير، د. نايف الزهراني (ص487، 489).
والاتفاق ذكره السيوطي نقلًا عن أبي بكر الباقلاني؛ قال: «دخول صورة السبب قطعي، وإخراجها بالاجتهاد ممنوع، كما حكى الإجماع عليه القاضي أبو بكر في التقريب، ولا التفات إلى مَن شذَّ فجوَّز ذلك». الإتقان (1/ 190).
[7] جامع البيان (6/ 330)، ويُنظر: الإحالات في الاستدلال في التفسير، نايف الزهراني (حاشية ص489).
[8] مثاله: ما ذكره ابن جرير في تفسير الكلمات في قوله تعالى: {وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ}[البقرة: 124]؛ حيث ذكر ثمانية أقوال واردة في تعيين المراد بالكلمات، ثم قال: «والصواب من القول في ذلك عندنا أن يُقال: إن الله -عز وجل- أخبر عباده أنه اختبر إبراهيم خليلَه بكلمات أوحاهن إليه، وأمره أن يعمل بهن فعمل بهنَّ وأتمهن، كما أخبر الله -جل ثناؤه- عنه أنه فعل.
وجائز أن تكون تلك الكلمات جميع ما ذكره مَن ذكرنا قوله في تأويل الكلمات، وجائز أن تكون بعضه؛ لأن إبراهيم -صلوات الله عليه- قد كان امتُحِن فيما بلغنا بكلّ ذلك، فعمل به، وقام فيه بطاعة الله وأمره الواجب عليه فيه.
وإذ كان ذلك كذلك؛ فغير جائز لأحدٍ أن يقول: عنى اللهُ بالكلمات اللواتي ابتَلي بهن إبراهيمَ شيئًا من ذلك بعينه دون شيء، ولا عنَى به كلّ ذلك، إلا بحُجة يجب التسليم لها: مِن خبر عن الرسول -صلى الله عليه وسلم-، أو إجماع من الحُجة، ولم يصح بشيء من ذلك خبرٌ عن الرسول بنقل الواحد، ولا بنقل الجماعة التي يجب التسليم لما نقلته» جامع البيان (2/ 506، 507).
فجوَّز أن تكون الكلمات كلّ ما ذكره، وجوَّز أن تكون بعضها، ولم يجوِّز تعيين شيء منها، أو القول بالعموم.
فلا يُقال في مثل ذلك أنه توقف في تفسيرها، وأنه قال بالعموم كما فهمه ابن كثير من كلامه، حيث قال بعد ذكر كلام ابن جرير في أثر لمجاهد في تعيين الكلمات: «قلت: والذي قاله أولًا من أن الكلمات تشمل جميع ما ذكر أقوى من هذا الذي جوَّزه من قول مجاهد ومن قال مثله؛ لأن السياق يعطي غير ما قالوه، والله أعلم» تفسير القرآن العظيم (1/ 140)؛ فإنَّ ابن جرير لم يَقُل أنّ الكلمات تشمل جميع ما ذكر، بل ذكره احتمالًا، بل لم يجوِّز تعيينه.
[9] لم أقف على تنبيه صريح على هذا التفريق في دلالة العلم على اختلاف القولين سوى عند الواحدي (ت 468هـ) في تفسيره البسيط؛ فقال بعد ذكر رواية صفوف الصلاة عن ابن عباس: «وعلى هذا القول معنى {عَلِمْنَا}: الوعيد والمحاسبة، وروي عنه أيضًا أنه قال: المستقدمون الأموات، والمستأخرون الأحياء»، وذكر قول غيره قريبًا من هذا المعنى، ثم قال: «وعلى قول هؤلاء: معنى {عَلِمْنَا}: التمدُّح بالعلم؛ لأن علمه شامل لأعداد مَن مضى ومَن بقي، ومَن خلقه ومَن سيخلقه فيما بقي». التفسير البسيط (12/ 589). ط. عمادة البحث العلمي - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
[10] أحكام القرآن، ابن العربي (3/ 101، 102)، ط. دار الكتب العلمية.
وبنحوه قال القرطبي، إلا أنه ساق ثمانية أقوال ثامنها في صفوف الصلاة، ثم قال: «وكلّ هذا معلوم لله تعالى؛ فإنه عالم بكلّ موجود ومعدوم، وعالم بمن خلق وما هو خالقه إلى يوم القيامة، إلا أن القول الثامن هو سبب نزول الآية». الجامع لأحكام القرآن (10/ 19)، ط. دار الكتب المصرية.
[11] تفسير القرآن العظيم، ابن كثير (4/ 531، 532).
[12] قال الألباني: «أما النكارة الشديدة التي زعمها ابن كثير -رحمه الله-، فالظاهر أنه يعني أنه من غير المعقول أن يتأخر أحد من المصلين إلى الصف الآخر لينظر إلى امرأة، وجوابنا عليه: أنهم قد قالوا: إذا ورد الأثر بطل النظر، فبعد ثبوت الحديث لا مجال لاستنكار ما تضمَّنه من الواقع، ولو أننا فتحنا باب الاستنكار لمجرد الاستبعاد العقلي للزم إنكارُ كثير من الأحاديث الصحيحة، وهذا ليس من شأن أهل السنة والحديث، بل هو من دأب المعتزلة وأهل الأهواء. ثم ما المانع أن يكون أولئك الناس المستأخرون من المنافقين الذين يُظهرون الإيمان ويبطنون الكفر؟! بل وما المانع أن يكونوا من الذين دخلوا في الإسلام حديثًا، ولمَّا يتهذبوا بتهذيب الإسلام، ولا تأدبوا بأدبه؟!». السلسلة الصحيحة (5/ 612).
ومن عجيب الاعتراض ما ذكره صاحب (المحرر في أسباب النزول) حين عدَّ من أسباب عدم اعتبار هذا الحديث سببًا للنزول: «النَّيْل من الصحابة والقدح فيهم دليلُ الخطأ والزلل، فوقوع هذا الفعل من الصحابة من أبعد البعيد، فكيف إذا كانوا يصلُّون؟!»، واستنكر على مَن جعل القصة ممكنة -كابن جرير- فقال: «وهذا -والله- لا يُمكن أن يصح إِذْ كيف يُظن ببعض أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- هذا الظنّ السيِّئ مع ما لهم من المنزلة والإحسان والرفعة والإيمان والسابقة التي لا يلحقهم بها أحد أن يفعلوا هذا الفعل، وهم قائمون بين يدي الله وراكعون وساجدون. إنَّ رجلًا من أهل هذا الزمان لو قيل لك: إنه يفعل ذلك في صلاته لاقشعر جلدك ولم تكد تصدق حتى ترى هذا منه بأُمّ عينيك، فكيف يصدق مثله في أشرف صحب وأطهر قوم؟!» إلى آخر كلامه. (2/ 649، 650).
وهو كلام بعيد عن التحرير والموضوعية، وعلى فرض القول بثبوت هذا السبب فليس فيه طعنٌ في مجموع صحابة النبي -صلى الله عليه وسلم-، وإلّا فكيف يُظَن أن يقع بعض الصحابة في الكلام في عائشة -رضي الله عنها- في حادثة الإفك؟ وكيف يُظن في صحابي أن ينقل أخبار المسلمين لأعدائهم كما وقع في قصة حاطب بن أبي بلتعة -رضي الله عنه-؟ وكيف يُظن غير ذلك من الأمور الثابتة بالأحاديث الصحيحة والتي كان القرآن ينزل في تصحيحها وتقويمها؟ فليس هذا مسلكًا علميًّا في نقد الروايات.
ويكفي في عدم اعتبار القصة سببًا للنزول ما ذكره المؤلف مِن كونها مخالفة لسياق الآيات، ويكفي أن أكثر الناقدين من محرِّري المفسرين لاعتبار القصة سببًا لنزول الآيات كان اعتراضهم على سياقها دون نقد متنها بهذه الصورة، أو اعتبار القول بذلك طاعنًا في صحابة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، أو منقِصًا منهم.
وشبيه بذلك ما يحشِّي به بعض المحقِّقين لكتب التفسير في الحكم على القصة بالوضع أو الكذب، وهذا بعيد عن الصنعة الحديثية، والمنهجية العلمية.
[13] ذكره الواحدي في أسباب النزول (ص276)، ط. دار الإصلاح.
[14] روح المعاني، الآلوسي (7/ 277، 278).
[15] السلسلة الصحيحة (5/ 611).
[16] السلسلة الصحيحة (5/ 612).
كلمات مفتاحية
الكاتب:

محمد مصطفى عبد المجيد
حاصل على ماجستير التفسير وعلوم القرآن، وله عدد من المشاركات العلمية.
مواضيع ذات صلة
((المعلومات والآراء المقدَّمة هي للكتّاب، ولا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع أو أسرة مركز تفسير))









