التشريع القرآني عند المستشرق نويل جيمس كولسون
(4-4)
نقد رؤية كولسون لعدم استقصاء الحوادث في التشريع القرآني
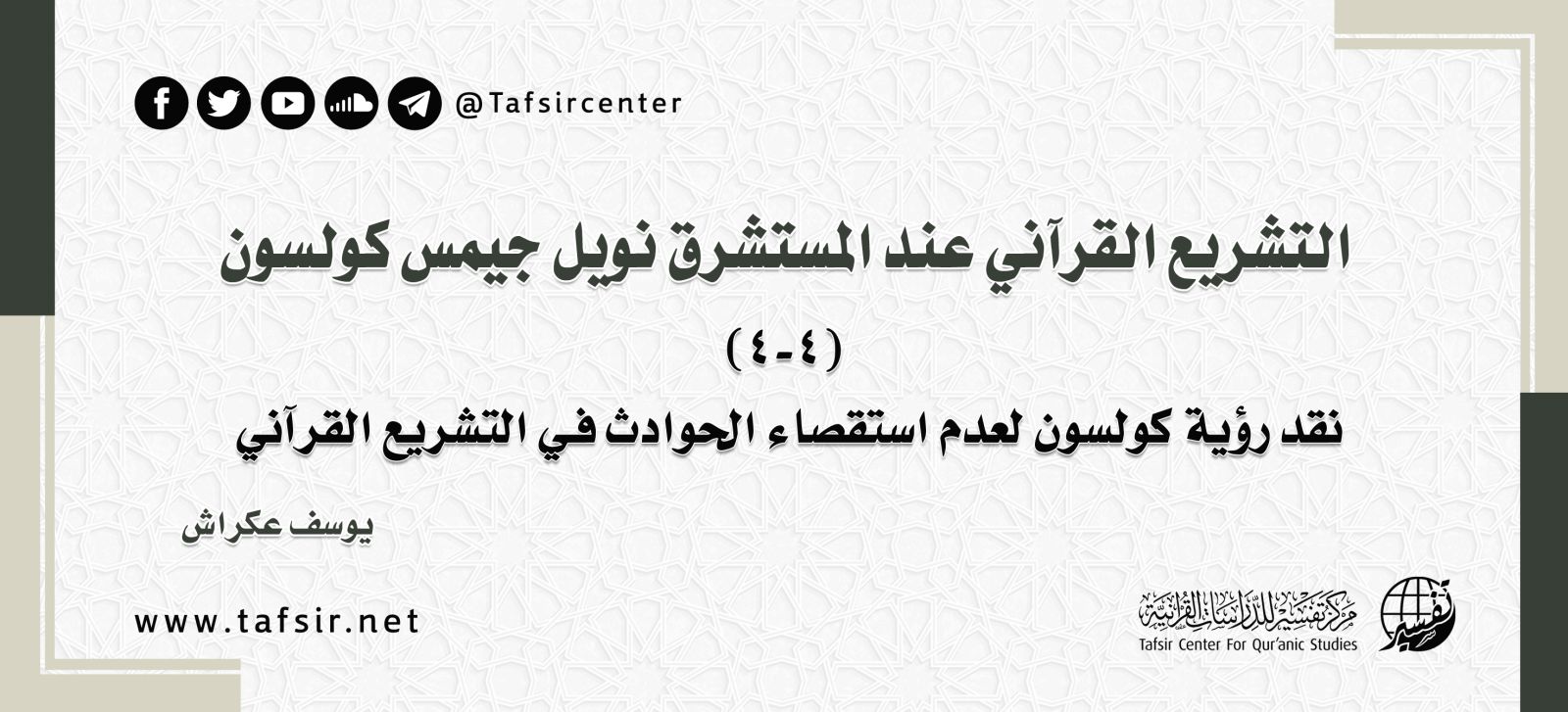
وقفنا في المقالة السابقة[1] مع نقد تقرير كولسون للمشكلة الأولى التي مفادها أنّ التشريع القرآني يُعاني من غَلبة الاتجاه الخُلقي على التشريعات، ما جعل هذه الغلبة طريقًا لإهمال الجزاء العملي الذي يستحقّه كلّ مَن هو مُخالف في نظره، وقد جرى مسلك النقد من خلال فهم ماهية الأخلاق وعلاقتها بالتشريع، وطبيعة الجزاء الذي أتى به التشريع القرآني، وبيان أثر الأخلاق في الامتثال إلى التشريع.
وفي هذه المقالة الأخيرة سنأتي على مناقشة ونقد المشكلة الثانية التي قررها كولسون قائلًا: «وتتصل المشكلة الثانية، ولعلّها أكثر وضوحًا من سابقتها، بظاهرة عدم استقصاء التشريع القرآني للمشكلات القانونية، وعدم الإشارة لها ولو بكلمة للعديد منها... ومن ذلك ما تواردَت عليه الآيات على وجوبِ أخْذِ الزّكاة من فضول أموال الأغنياء لتُدفع إلى المحتاجين من الفقراء، دون بيان للتفصيلات العديدة التي تضبط جبايتها وتوزيعها»[2].
وإنّ المتأمّل في طرح كولسون لهذه المشكلة وما حفّها به من مضامين واستدلالات يستنتج أنّ كولسون ينظر للقرآن الكريم على أنه مدوّنة قوانين، وقد سبقت الإشارة إلى تأثّره البالغ بنمط التقنين الوضعي في صِيَغِهِ الحديثة، كما سعى للمقارنة بين التشريع الوضعي والتشريع القرآني بشكلٍ مباشر أو غير مباشر، ما جعله يطرح مسألة عدم الاستقصاء والتتبّع مع وصفه لها بأنها أكبر المشكلات المطروحة.
لذلك فإنّ مناقشة هذه المشكلة ونفي مضمونها سيكون من خلال أمرين اثنين؛ الأول متعلق بالأحكام، والثاني بالحدود؛ لأنهما يمثّلان روح التشريع ومكمنه، كما عليهما دار حديث كولسون في مقاربته للتشريع القرآني.
أولًا: استغراق التشريع القرآني لجميع الأحكام:
لقد أثار كولسون في أكثر من موضع أنه «غير مقتنع بحجم الآيات التشريعية في القرآن عند مقارنتها مع الوصايا الأخلاقية، فمن بين 500 آية أو أكثر، 80 آية فحسب، هي التي تتعلّق بموضوعات قانونية خالصة، أمّا الآيات الأخرى فلا تدخل في التصنيف القانوني؛ لأنها تتعلق بفروض الكفاية التكليفية؛ كالعبادات: الصلاة، والصوم، والحج. وعلى الرغم من أن الآيات التشريعية تناولَتْ تفاصيل كثيرة إلا أنها ما زالت -من وجهة نظره- لا تمثّل إلّا حلولًا لمشكلات معيّنة[3]. وهذا يزيد الأمر وضوحًا بأنّ كولسون يرى أن التشريع لا يجب أن يخرج عن البنود والمواد القانونية التي تستهدف المشكلات القانونية بشكلٍ مباشر.
وفي حين أنّ الخطاب القرآني لا يسلك أسلوب القوانين الوضعية في التشريع «فما يقرّره القرآن على سبيل الندب أو الوجوب أو الكراهة أو التحريم أو ما يدعه على الإباحة الأصلية... إلخ، كلّ ذلك تشريع. والقرآن في التشريع لا يسلك سبيلًا واحدًا في التعبير، إنما يسلك سبلًا عديدة في غاية الإعجاز، وكما يمكن أن يُعرف الوجوب أو التحريم أو غيره من الأحكام السابقة من صيغة أمر أو نهي أو من وضع عقاب، فإنه كذلك يُعرف الحكم من القصة والمثل المضروب»[4].
وما قيل في الأمثال والقصص يُقال في جميع آيات القرآن، فكلّ آية لا تخلو من حُكم مباشر أو ترشد له بترغيب أو ترهيب وغيرها من الأساليب التي ينهجها القرآن في التشريع لتكون أدعى بالارتباط بعقيدة الإنسان ومخاطبة وجدانه، ثم تكون مطيةً لاستخراج مجموعة من الأجوبة القانونية ومنبعًا وأصلًا للتشريعات. ولا ريب أن القرآن اكتنف 6236 آية[5] في 114 سورة تعرَّض فيها لعدّة موضوعات لها علاقة وطيدة بالعقيدة والعبادات والمعاملات والقواعد القانونية.
ورغم النَّسَق الذي يتبعه الخطاب القرآني في التشريع، نجد هناك مَن بذل جهدًا من المتخصِّصين في مجال الشريعة والقانون بتتبّع آيات القرآن فألفاها على التشكّل الآتي:
- «سبعون آية تخصّ الأحوال الشخصية أو ما يسمى بقانون الأسرة؛ كالزواج والطلاق والنسب والولاية وتنظيم علاقات الأسرة بالمجتمع.
- سبعون آية تخصّ ما يسمَّى القانون المدني، وهي ما يتعلّق بمعاملات الأفراد مع بعضهم؛ مثل الإجارة والكفالة والبيع والرهن وغيرها.
- ثلاثون آية تخصّ القانون الجنائي، وهي ما يتعلّق بتحديد الجرائم وعقوبتها وحفظ الضرورات الخَمْس.
- خمس وعشرون آية تتعلّق بالقانون الدولي العام والخاصّ، وهي تنظيم علاقة الدولة الإسلامية بغيرها ووَضْع غير المسلمين في الدول الإسلامية.
- ثلاث عشرة آية تخصّ قانون المرافعات، وهي ما يتعلّق بالقضاء والشهادة واليمين وتنظيم إجراءات التقاضي لتحقيق العدالة في المجتمع.
- عشر آيات عن القانون الدستوري، وهي ما يتعلّق بنظام الحكم وعلاقة الحاكم بالمحكوم وحقوق وواجبات أفراد المجتمع»[6].
ورغم هذه الاجتهادات التي سَعَت لحصر عدد آيات التشريع، إلا أنّ كلّ آية في الخطاب القرآني صالحة لاستنباط حُكْم أو قيمة أو عِبْرة مما يجعل القرآن أصلًا في التشريع باستمرار[7]، لكن ليس كباقي التشريعات الوضعية، فهو تشريع «يتّصف بالصفة الدينية في الحلال والحرام، ويرتبط بالعقيدة والإيمان في الامتثال والالتزام، والمسؤولية والحساب في الدنيا والآخرة، ويمتزج بالأخلاق الفاضلة والقيم السامية أثناء التطبيق والمعاملات، ويلتقي مع الفطرة البشرية، ويقيم التوازن العادل بين الفرد والمجتمع، أو الفرد والدولة، وبين الدنيا والآخرة، ويسعى لتحقيق السعادة لجميع بني البشر والعالم، فيؤمِّن الصالح العام، والمصلحة الجماعية والفردية في الدنيا والآخرة»[8].
وهذا ما جعل القرآن الكريم ذا أهمية بالِغة في التشريع، وأنه المصدر الوحيد الذي يتميز بمعجزة الثبات والاستمرار في تشريعاته، «وينكشف هذا الإعجاز اليوم حين تقر المؤتمرات الدولية القانونية في دول الغرب نفسها أن التشريع الإسلامي تشريع مميز يحمل مِن عناصر الحياة ما لم تحمله نُظُم الغرب. تقرّر ذلك في مؤتمر الحقوق في (فيينا) 1928، ومؤتمر لاهاي 1356هـ= 1937م في المؤتمر الدولي للقانون المقارن، ومؤتمر المحامين الدولي في لاهاي 1948، ومؤتمر الفقه الإسلامي في جامعة باريس 1950، وغير هذه المؤتمرات كثير»[9].
لكن قد يتساءل سائل بقوله: كيف للخطاب القرآني الذي مرَّت عليه أربعة عشر قرنًا أن يستمر في المواكبة بأحكامه ويجيب عن كلّ المستجدات في كلّ عصر ومِصْر؟ وإنّ الجواب عن هذا السؤال بالذات هو طريق لفهم استمرارية القرآن وشموليته وصلاحيته لكلّ زمان ومكان، وأنّ مسألة عدم الاستقصاء التي أوردها كولسون تجاه التشريع القرآني لا أساس لها من الصحة، وأنها حكم متسرّع قبل فهم منهج القرآن ونسقه وآليات تشريعه.
فالمتأمّل في القرآن الكريم يُلْفِيه كتابًا حوى كليات تشريعية[10] جامعة، وذلك «من خلال ما يطغى عليه من صفة الكلية التي انْتَسَجها في تقرير الأحكام، وتوشّح بها أسلوبه البياني حيث تواضَعت النصوص على مجامع المعاني، ورسَت على زُباد الأهداف ولُباب المرامي، وانصرفت عنايته تلقاء القواعد والأصول وكُبَر الأساس والمباني، من غير تعرّض للكفايات والجزئيات، إلّا في مواقع معدودة بأمور ثابتة مستقرّة، لا تتبدّل عبر الزمان والمكان؛ كنظام الأسرة، وقواعد الإرث، وقانون العقوبات، فكانت هذه المواقع بمثابة مَرْسَى للثوابت وقاعدة تلتقي عليها أصول النظام الشرعي العام»[11].
وبهذا فإنّ القرآن هو «المصدر الرئيس الأول للتشريع، منه تتفرّع الأدلة المتنوّعة، وإليه مآل اعتبارها. وإنّ دور القرآن الكريم في تزويد المجتمع الإسلامي بالأحكام بطريق مباشر أو غير مباشر لَيُعَدّ من المعجزات الشاخصة الملموسة، فما زال المسلمون يستنبطون من آيات القرآن الكريم الأحكام الشرعية لمستجدّات العصر»[12]، ونحن في القرآن أمام نوعين من الآيات يتمثّلان في الآيات المحكمة والتفصيلية «فالآيات المحكمات هي أصوب وأمهات لغيرها، مما يندرج فيها أو يتفرع عنها أو يخضع لها من التفصيلات والجزئيات والتطبيقات. فمجمل الدِّين وشريعته مؤسَّس على هذه المحكمات الكليات ونابع منها. والقرآن الكريم باعتباره الأصل الأول والمرجع الأعلى للإسلام وشريعته، لا بدّ أن يكون هو مستودع هذه الكليات الأساسية ومنجمها... بل حتى في التنزيل والتبليغ، جاءت الآيات المحكمة الكلية سابقة على الآيات التفصيلية»[13].
وبهذا، فإنّ الخطاب القرآني يؤسّس لأصلين عظيمين من أصوله التشريعية يتمثّلان في الثابتة والمرنة، فأمّا الثابتة فتشمل التشريعات التي اختصت بالعقائد، والعبادات، والقيم الأخلاقية، والمبادئ التي لا تتغير بتغير الزمان والمكان؛ كالعدل والأمانة[14]، وبعبارة أخرى فالأحكام الثابتة في القرآن الكريم ترتبط بوجود الإنسان وحياته وبعد مماته، وتنظِّمها في أبعادها الثلاثة، بدءًا بالأحكام تجاه خالقه، وتجاه نفسه، وتجاه باقي المخلوقات، وتأخذ بعين الاعتبار تحقيق العبودية لله -عز وجل- وإقامة الاستخلاف في الأرض، حيث تمثّل الأصول والقواعد المستغرقة لحدود الزمان والمكان والأشخاص، أي: كلّ ما يقيم الدين والدنيا.
ومما تميّزت به القواعد الكلية الثابتة في التشريع القرآني أنها جاءت متدرجة شيئًا فشيئًا، لم تشمل أصول الأوامر فقط، بل حتى النواهي؛ وفي هذا السياق يذكر الشاطبي قائلًا: «اعلم أنّ القواعد الكلية هي الموضوعات أولًا، والذي نزل بها القرآن على النبي -صلى الله عليه وسلم- بمكة، ثم تبعها أشياء بالمدينة، كملت بها تلك القواعد التي وُضِع أصلُها بمكة، وكان أوّلها الإيمان بالله ورسوله واليوم الآخر، ثم تبعه ما هو من الأصول العامة؛ كالصلاة وإنفاق المال وغير ذلك، ونهى عن كلّ ما هو كفر أو تابع للكفر؛ كالافتراءات التي افترَوْها مِن ذبحٍ لغير الله وللشركاء الذين ادَّعَوهم افتراءً على الله، وسائر ما حرّموه على أنفسهم، أو أوجبوه من غير أصل، مما يخدم أصل عبادة غير الله. وأمَرَ مع ذلك بمكارم الأخلاق كلّها؛ كالعدل والإحسان، والوفاء بالعهد، وأخذ العفو، والإعراض عن الجاهل، والدفع بالتي هي أحسن، والخوف من الله وحده، والصبر والشكر، ونحوها؛ ونَهَى عن مساوئ الأخلاق من الفحشاء، والمنكر، والبغي، والقول بغير علم، والتطفيف في المكيال والميزان، والفساد في الأرض، والزِّنا والقتل، والوأد، وغير ذلك مما كان سائرًا في دين الجاهلية»[15].
أمّا أصوله التشريعية المرنة أو المتغيرة فهي «التي رَاعَى فيها تطوّر البشر وتنوّع احتياجاتهم مع اختلاف الزمان والمكان؛ كقواعد المصالح، وقواعد الضرورات، وسدّ الذرائع، والقياس، والاستحسان، ومراعاة العرف. وكلّ ذلك ضمن ضوابط لا تخرج عنها، وكلّ هذا مرجعه إلى القرآن الكريم بطريق مباشر أو غير مباشر»[16]، أي: هي التشريعات المنوطة بزمن معيّن ومكان معيّن أو لارتباطها بشخصٍ ما أو جماعة معيّنة، ما يجعلها مؤقتة خاضعة للتغيير والتطوير تبعًا للحوادث والمستجدات التي تعرض للإنسان في مختلف مناحي الحياة.
والذي ينبغي العلم به أيضًا أنّ هذه الأحكام التي تخضع للتغيير أو التطوير ليست مستقلّة عن الأحكام والقواعد الكلية التي سبق ذِكْرها، بل هي منبثقة عنها ولا تتعارض معها ولا تعود عليها بالإبطال، أي: الكلية أصل والمتغير فرع، ولا ينبغي للفرع أن يخرج عن الأصل أو يعطّله. أمّا إذا بُنِيَت الأحكام المتغيّرة أو طُوِّرتْ دون استحضار الأصل وأخذه بعين الاعتبار فإنّ هذه المتغيرات لا يُعتد بها لأنها خرجت عن دائرة أصول التشريع ولا تُعَدّ من التشريعات الإسلامية في شيء، حينئذ نكون أمام تشريع وضعي صِرف.
وبالاعتماد على هذين الأصلين -الثابت والمتغير- والإلزام بهما في كلّ التشريعات؛ نعلم حينئذ أنّ الخطاب القرآني استوعب «أحكام الشّرع كلّها، فهي لا تخرج عن واجب، أو مندوب، أو مكروه، أو محرّم، أو مباح. ولا يشذّ ولا يندّ عن هذه الأحكام الخمسة أمر من أمور العباد، ولا يخرج عن هذه الدائرة حدث من الأحداث؛ ولذا قرّر علماؤنا أنه ما من حدث إلا وله في كتاب الله حُكم.
وقد شملت تشريعات القرآن الكريم حاجات البشر أجمعين في أمورهم الاعتقادية، والأخلاقية، والاجتماعية، والتربوية، والاقتصادية، وأحكام الأسرة، وآداب السلوك، والتعامل بين المسلمين أنفسهم، وبينهم وبين غيرهم، وكذا نظم العلاقات الدولية في حالات السِّلْم والحرب، وكلّ ذلك مع مراعاة الواقع العلمي، والقدرات الإنسانية، والفكرة السليمة، وبتوازن في شأن الإنسان بين العقل والجسم والروح، فلا يطغى جانب على جانب آخر»[17].
ومن عظيم كليات القرآن أنه أرشد العباد إلى سُنّة سيد الأنام، حيث تمثِّل التطبيق العملي النموذجي لِما جاء به القرآن من خلال وظيفتين؛ أولاهما: وظيفة بيان لفظ القرآن ونَظْمِه، والمقصود بها تبليغ القرآن قولًا وفعلًا. والثانية: وظيفة الشرح والبيان لِما اكتنفه اللفظ القرآني؛ كتقييد المطلق، أو تخصيص العام، أو بيان المجمل؛ إمّا عن طريق القول أو الفعل أو التقرير الصادر عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم[18]. وبهذا المعنى فإن السنّة النبوية «انتصبت لاستنزال كليات القرآن على الوقائع الشاخصة في عصر التنزيل، آخذةً إبَّان ذلك محتفّات القرآن والأحوال، وعوارض الزمان والمكان، وخصوصيات الأفراد والجماعات بالحُسبان... حرصًا على الثبات والاطراد واستغراق الزمان والمكان، وهو ما يكفل للشريعة البقاء والخلود والصّلوح الأبدي من غير انقطاع»[19].
ومن خلال ما تقدَّم يظهر لنا كيف يمكننا فهم استغراق التشريع القرآني لجميع الأحكام في كلّ عصر ومِصْر، وكيف ينصب الشارع الحكيم الأمارات وتمهيد المسالك التي يمكن التوصّل بها إلى الأحكام، وعظم منزلة السنّة من القرآن؛ لنكون أمام أحكام تغطي الوقائع لا تخرج عن الآتي:
- «الواقعة التي دلّ على حكمها نصٌّ قطعي في وروده وقطعي في دلالته، بمعنى: لا مجال للعقل فيها.
- الواقعة التي دلّ على حكمها نصٌّ ظنِّي الدلالة، بمعنى: أنّ النصّ يحتمل الدلالة على حكمها أو أكثر، وللعقل مجال لأنْ يُدرك منه، أي: الحكم.
- الواقعة التي ما دلّ على حكمها نصّ أصلًا، واتفق المجتهدون على حكمٍ فيها في عصر من العصور لا مجال فيها للاجتهاد.
- الواقعة التي ما دلّ على حكمها نصّ ولا انعقد على حكمها إجماع»[20]، وهي بوفرة في كلّ زمان ومكان ولا يُمنع من الاجتهاد فيها لمن توفرت فيه الأهلية.
وخلاصة لمسألة استغراق التشريع القرآني لجميع الأحكام فإنّ علماء التشريع لا يُنْشِئُون حكمًا وضعيًّا البتة؛ لأنّ كلّ الأحكام مصدرها الخطاب القرآني أصالةً؛ إمّا بالتنصيص المباشر والصريح أو غير المباشر من خلال ما يعتمده القرآن في ذلك من عِبَر وأمارات ومقاصد وقيم؛ الشيء الذي يتقرّر معه أنّ التشريع القرآني مستغرِق لجميع الأحكام في كلّ زمان ومكان، وهذا مخالف وداحض لما قرّره كولسون حول أحكام القرآن في علاقتها بالمشكلات القانونية.
ثانيًا: استغراق التشريع للعقوبات:
سبقت الإشارة أنّ الخطاب القرآني قد أرسى الأصول الكلية للتشريع، ومن ذلك «الجرائم التي يتصوّر ارتكابها، سواء في حق الأفراد أو في حق المجتمع، وتمثِّل اعتداءات على المصالح الخمس المقررة: حفظ الدين- حفظ النفس- حفظ المال- حفظ النسل- حفظ العقل. ولقد عُني المشرِّع الإسلامي بفرض عقاب لكلّ اعتداء مباشر على هذه المصالح الخمس الأساسية، وأبرز ذلك في عقوبات الحدود الشرعية. أمّا فيما يتعلق بالاعتداءات الأخرى التي هي اعتداءات على مصلحة حاجية أو تحسينية فقد تُركت لاجتهاد وليّ الأمر؛ نظرًا لتغيّر مضمون هذه الاعتداءات من زمان لزمان ومن مكان لمكان. وهذا يعني أنّ عقابها تُرك الاجتهاد فيه لوليّ الأمر؛ رغبةً في تحقيق معالجة عقابية أكثر فاعلية تتماشى مع طبيعة المجتمع»[21].
ومن هذا المنطلق نفهم أنّ العقوبات في التشريع على قسمين؛ الأول منها يتمثّل في الحدود والقصاص والدّية[22]، أي: يشمل «العقوبات في الجرائم التي فيها حدّ أو الجرائم التي يقتصّ فيها أو يُودَى، فهي مثل واضح لمبدأ الشرعية، فالعقوبات محدّدة تحديدًا واضحًا صريحًا لا لَبْسَ فيه. وقد اتفقت كلمة فقهاء المسلمين على أن العقوبات -وخاصّة في الحدود- مما لا يثبت بالرأي والقياس، وأنها لا تثبت إلا بالنصّ»[23]. والجرائمُ التي وردَت فيها حدود محدودة بعدد معيّن سبعٌ، تتمثّل فيما يأتي: الزنا، والشرب، والقذف، والسرقة، والحرابة، والبغي، والرِدّة، وجرائم القصاص والدية خمس تتمثل في الآتي: القتل العمد، والقتل شبه العمد، والقتل الخطأ، والجناية على ما دون النفس عمدًا، والجناية على ما دون النفس خطأ[24]. والحكمة من تحديد هذه العقوبات بحيث لا ينبغي تغييرها أو الزيادة فيها أو نقصانها؛ لأنها تنخر مرتكزات المجتمع وأُسسه الضرورية، ولا يمكن معالجتها إلا عن طريق ما قدّره الشارع الحكيم فيها.
أمّا القسم الثاني فيضمّ التعزِير، وقد تعدّدت تعريفات العلماء له باعتباره وضعًا شرعيًّا، وكلّها تتفق على أن التعزير هو العقوبة التي يشرعها الحاكم بغرض الزجر والردع على ارتكاب جُرم معيّن لا حَدّ فيه ولا كفارة، ومن ذلك كما عرّفه ابن قدامة: «هو العقوبة المشروعة على جناية لا حدَّ فيها»[25]، وقد «أبرز القرآن هذا المفهوم والذي يُعتبر السند الشرعي للتعزير، حينما قال عز وجل: ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [آل عمران: 104]، ... وترِد بالقرآن الكريم عدّة نماذج للجرائم التعزيرية. ولكن هذا العرض القرآني ورَدَ على سبيل المثال لا الحصر. ومن هذه النماذج قوله تبارك وتعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا﴾ [النساء: 34]»[26].
وإنّ عدم تحديد العقوبة في عدد من المخالفات التي تقع في حياة الناس «ينطوي على حكمة عظيمة، ومصلحة باهرة؛ وذلك لأنّ عدم تقدير عقوبات التعازير وتحديدها يُعتبر من أهمّ الأسباب التي جعلت من الشريعة الإسلامية صالحة لكلّ زمان ومكان، وجعلها شريعة باقية دائمة متفوقة على غيرها، وجنّب نظام العقوبات (التعازير) الشرعية الجمود والانغلاق، وعدم مواكبة الأحوال والظروف والبيئات والمستجدات»[27] التي لا تكاد تنتهي.
والمتأمّل في حياة الناس آخذًا بعين الاعتبار التغيرات الحاصلة على جميع المستويات بما في ذلك طبيعة الجُرم الذي صار يُرتكب، حيث إن الجريمة في حدّ ذاتها تخضع لتشكّلات جديدة ناشئة عن المتغيرات والتطورات التي تعرفها المجتمعات، والواقع أعظم الشهود حيث صرنا اليوم نسمع ونرى أنواعًا من الجرائم لم تشهدها العصور السالفة؛ لذلك فإن «التحديد المطلق يعدّ ظلمًا، وعدم التحديد المطلق للعقوبة كذلك يعدّ من قبيح الظُّلْم المطلق»[28]، الشيء الذي تتجلّى معه الحكمة والإعجاز في التشريع الجنائي الإسلامي.
وهذا منهج القرآن في هذا الشقّ من التشريع؛ إِذْ «لا يفرض لكلّ جريمة من جرائم التعزير عقوبة معيّنة كما تفعل القوانين الوضعية؛ لأن تقييد القاضي بعقوبة معينة يمنع العقوبة من أن تؤدِّي وظيفتها، ويجعل العقوبة غير عادلة في كثير من الأحوال؛ لأنّ ظروف الجرائم والمجرمين تختلف اختلافًا بيِّنًا، وما قد يُصْلِح مجرمًا بعينه قد يُفْسِد مجرمًا آخر، وما يردع شخصًا عن جريمة قد لا يردع غيره»[29].
ولتحقيق مبدأ العدالة في العقوبات المطبّقة «وَضَعت الشريعة لجرائم التعازير عقوبات متعدّدة مختلفة هي مجموعة كاملة من العقوبات تتسلسل من أتفه العقوبات إلى أشدّها، وتركت للقاضي أن يختار من بينها العقوبة التي يراها كفيلة بتأديب الجاني واستصلاحه وبحماية الجماعة من الإجرام، وللقاضي أن يُعاقِب بعقوبة واحدة أو بأكثر منها، وله أن يخفّف العقوبة أو يشدّدها إن كانت العقوبة ذات حدَّين، وله أن يوقف تنفيذ العقوبة إن رأى في ذلك ما يكفي لتأديب الجاني وردعه واستصلاحه»[30].
وإنّ هذا التنوّع في العقوبات من خلال التعزير يكسو التشريع الإسلامي طابع الشمولية والاستمرارية والاستغراق بحيث يراعي التعزيرُ شخصيةَ الجاني، ومِن ذلك على سبيل المثال: فإن ما يصلح لعامة النّاس من عقوبات لا يصلح لأشرافهم، فعادة عامة الناس يصلح حالهم بالعقاب البدني والإشعار بالألم، في حين أنّ الشرفاء وعِلْيَة القوم لا يصلح معهم هذا الأمر بقدر ما أنّ الإعلام والامتثال أمام الولي والحرمان هو العقاب الأقرب لحالهم، ثم التّدرج معهم شيئًا فشيئًا؛ لأن هذا الأخير حريص كلّ الحرص على مكانته في المجتمع، وأنّ كلّ ما يُذهبها عنه هو يراه عقابًا في حدّ ذاته أكثر من العقاب البدني.
ومن ذلك ما نجده في الخطاب القرآني من نماذج تطبيقية لهذا الأمر، حيث خاطب الله -عز وجل- قارون بالخطاب اللّيِّن ورغّبه في الدار الآخرة وعدم الإسراف في طلب الدنيا، بينما خاطب الفقراء من قوم قارون الذين تمنَّوا مثل ما آتاه الله من مال وكنوز بالتوبيخ والتقريع والويل، وما هذا الفرق إلا لاختلاف مكانة كلّ شخص. وإذا راعى القرآن اختلاف الشخصيات وظروفها فإنّ مراعاة الزمان والمكان من بابٍ أَوْلَى. وهكذا الأمر في كلّ الأحوال؛ فما يصلحُ للغني لا يصلحُ للفقير، وما يصلحُ للرجل لا يصلحُ للمرأة، وما يصلحُ للشاب في مقتبل العمر لا يصلح للشيخ الكهل، وما يصلح لمعاقبة البدو لا يصلح لأهل المدينة والحضارة.
ومما يزيد أمر شمولية التعزير للعقوبات واستغراقها أنّه يشكّل أساسًا وأصلًا عامًّا للعقاب «وما عقوبات الحدود إلا استثناءات[31] من هذا الأصل العقابي، ويظهر هذا بجلاء على ضوء الحقيقتين المهمّتين الآتيتين:
أمّا الحقيقة الأولى: فهي أن عقوبات الحدود الشرعية في أغلبها عقوبات بدنية، بمعنى أنها من طبيعة واحدة لا تتغير في نوعيتها، في حين أن عقوبات التعزير على قدرٍ كبيرٍ من التنوع والاختلاف... وأمّا الحقيقة الثانية التي تؤكّد ذات الفكرة تتلخص في أن حدود تطبيق أحكام الحدود الشرعية وشروطها ضيقة جدًّا وقلّما تتوفر، ومن ثم فإن التطبيق الجوهري العام للعقوبة في الإسلام يقبع في (التعزير)»[32].
ومما تقدّم في هذا المقال نفهم منهج التشريع الإسلامي بصفة عامة والتشريع القرآني بوجه خاصّ، وكيف استغرقت عقوباته كلّ المخالفات؛ سواء عن طريق الحدود أو القصاص أو الدِّيَات التي نُصّ عليها بشكلٍ مباشر، أو عن طريق نظرية التعزير التي أشار لها الخطاب القرآني وطبّقها في أكثر من موضع؛ والتي تُظْهِر لنا نوعًا من الإعجاز التشريعي الذي يحقّق الشمولية والاستمرار والمواكبة لكلّ المشكلات والمخالفات، وهذا الأمر أعمّ وأحكم وأعدل مما ذهب إليه كولسون متأثرًا بالتشريعات الوضعية التي تعرفُ فشلًا رهيبًا في تحقيق العدالة والأمن جرّاء وضع قوالب للعقوبات وتنزيلها بشكلٍ مباشر على المعنيين دون مراعاة أدنى الفوارق الشخصية فضلًا عن الزمانية والمكانية، الشيء الذي يترتّب عليه تغيير دوري وجذري لعدد من القوانين بين الفينة والأخرى إلى ما لا نهاية، بل الأكبر من ذلك حيث صِرنا نسمع بتصدير القوانين من دولة لأخرى، وغزو قوانين الدول الكبرى للدول الصغرى، وأمّة الإسلام ليست ببعيدة عن ذلك.
الخاتمة:
لقد انعقدت هذه المقالات -كما تقدم سلفًا- حول نقد التشريع القرآني عند المستشرق نويل جيمس كولسون، حيث تمّ بحمد الله في هذه المقالة الأخيرة استكمال النتائج المتوصَّل إليها في هذه المساجلة المطوَّلة، ويمكن إجمال النتائج والاستنتاجات لهذه المقالة في الآتي:
- أنّ التشريع القرآني قد استغرق أحكام الوقائع والأحداث؛ وذلك أن كلّ آية لا تخلو من حكم أو قيمة أو عِبرة ترشد له، مما يجعل القرآن أصلًا تشريعيًّا باستمرار، ولا يسلك مسالك القوانين الوضعية في تحرير بنود سرعان ما تكون عرضة للتغيير والتبديل.
- وأنّ التشريع القرآني يؤصّل لأصلين عظيمين من التشريع؛ الأول: مرتكزاته الثابتة التي اختصّت بالعقائد، والعبادات، والقيم الأخلاقية، وعامة المبادئ التي لا تتغير بتغير الزمان والمكان، أمّا الثانية: فهي المرونة التي راعى فيها الشارع سير الحياة، وتطوّرها، وتغير الزمان والمكان.
- وأن التشريع القرآني لم يحدّد العقوبات كلّها، بل أرسى أصولها التي لا تقبل الزيادة ولا النقصان والتغيير، وهي التي تتمثّل في الحدود والقصاص والدّيات، وترك الشقّ الآخر لنظرية التعزير؛ لِما في ذلك من حكمة بالغة جعلت نظام العقاب في التشريع الإسلامي صالحًا لكلّ زمان ومكان.
- وأن نظرية التعزير جنّبت نظام العقوبات في الإسلام الركود والجمود تجاه الجرائم والمخالفات التي تتطور بشكل مهول جرّاء تغيّر المجتمعات، وكَسَت التشريع الإسلامي طابع الشمولية والاستمرار.
- وأن نظام العقوبات في الإسلام نظام متكامل وشامل؛ بدءًا بما هو وجداني معنوي، مرورًا بما هو بدني، ثم ما هو أُخروي.
- أن التحديد المطلق للعقوبات يعدّ ظلمًا، وعدم التحديد يعدّ ظلمًا؛ لذلك راعَى الشارع الحكيم بين الثابت والمتغير.
[1] المقالة الثانية من هذه السلسلة: (التشريع القرآني عند المستشرق نويل جيمس كولسون (3- 4)؛ نقد رؤية كولسن لغلبة الاتجاه الخُلقي في التشريع القرآني)، على هذا الرابط: tafsir.net/paper/82.
[2] في تاريخ التشريع الإسلامي، ن.ج. كولسون، ترجمة وتعليق: محمد أحمد سراج، ص39.
[3] أخلاقية التشريع بين الشريعة وقوانين الدولة الحديثة، هيثم سلطان، ص155.
[4] مصادر الشرعية الإسلامية مقارنة بالمصادر الدستورية، عليّ جريشة، ص10.
[5] على اختلاف يسير في عدّها بين الأمصار؛ ففي المدني عددان، ولكلّ من مكة وأهل البصرة والشام والكوفة عدد واحد. ينظر: الميسَّر في علم عدّ آي القرآن، أحمد خالد شكري، راجعه عدد من المتخصصين، مركز الدراسات والمعلومات القرآنية، معهد الإمام الشاطبي، السعودية، الطبعة الأولى 1433هـ= 2012م، ص13.
[6] إجابة المتخصص القانوني أحمد بن عبد الله الراجحي عن سؤال: هل القرآن دستور بالمعنى القانوني المتعارَف عليه؟ موقع الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر، السعودية، من خلال الآتي: https://2u.pw/uCNqf7ub، تم الاطلاع بتاريخ: 1/ 6/ 2024م.
[7] لذلك نجد الزركشي ينازع مَن ذهبَ إلى حصر عدد آيات الأحكام بعدد معيّن قائلًا: «وكأنهم رأوا مقاتل بن سليمان أوّل من أفرد آيات الأحكام في تصنيفٍ، وجعلها خمسمائة آية، وإنما أراد الظاهر لا الحصر؛ فإن دلالة الدليل تختلف باختلاف القرائح فيختصّ بعضهم بدَرْكٍ ضرورةٍ فيها... وقد نازعهم ابنُ دقيق العيد أيضًا وقال: هو غير منحصر في هذا العدد، بل مختلف باختلاف القرائح والأذهان، وما يفتحه اللهُ على عباده من وجوه الاستنباط، ولعلهم قصدوا بذلك الآيات الدّالة على الأحكام دلالة أوّليّة بالذّات، لا بطريق التضمُّن والالتزام». البحر المحيط، بدر الدين الزركشي، دار الكتبي، بيروت، 1994م، (8/ 230).
[8] الإعجاز القرآني في التشريع الإسلامي، محمد الزحيلي، (1/ 68).
[9] طرق استنباط الأحكام من القرآن الكريم؛ القواعد الأصولية واللغوية، عجيل جاسم النشمي، مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، مكتبة الشريعة، الكويت، الطبعة 1418هـ= 1997م، ص11.
[10] الكليات التشريعية أو أصول التشريع: هي المعالم الكبرى التي تؤسس لتنظيم حياة الناس بما يحفظ لهم دينهم وأنفسهم وأموالهم... وجميع حقوقهم وواجباتهم، سواء مع خالقهم أو أنفسهم أو فيما بينهم.
[11] الكليات التشريعية وأثرها في الاجتهاد والفتوى، محمد هندو، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، عمان، الطبعة الأولى 1437هـ= 2016م، ص232- 233.
[12] طرق استنباط الأحكام من القرآن الكريم؛ القواعد الأصولية واللغوية، عجيل جاسم النشمي، ص11.
[13] الكليات الأساسية للشريعة الإسلامية، أحمد الريسوني، دار الأمان ودار السلام، الرباط والقاهرة، الطبعة 1431هـ= 2010م، ص30.
[14] طرق استنباط الأحكام من القرآن الكريم؛ القواعد الأصولية واللغوية، عجيل جاسم النشمي، ص10.
[15] الموافقات في أصول الشريعة، أبو إسحاق الشاطبي، تحقيق: محمد عبد الله دراز، الطبعة 1395هـ= 1975م، (3/ 102- 103).
[16] طرق استنباط الأحكام من القرآن الكريم؛ القواعد الأصولية واللغوية، عجيل جاسم النشمي، ص10.
[17] طرق استنباط الأحكام من القرآن الكريم؛ القواعد الأصولية واللغوية، عجيل جاسم النشمي، ص10.
[18] منزلة السنّة في الإسلام وبيان أنه لا يُستغنى عنها بالقرآن، محمد ناصر الدين الألباني، دار السلفية، الكويت، الطبعة الرابعة 1404هـ= 1984م، ص6- 7.
[19] الكليات التشريعية وأثرها في الاجتهاد والفتوى، محمد هندو، ص236.
[20] مصادر التشريع الإسلامي فيما لا نصّ فيه، عبد الوهاب خلاف، دار القلم، الطبعة الثانية، ص9- 10.
[21] الجريمة والعقوبة في الشريعة الإسلامية؛ دراسة تحليلية لأحكام القصاص والحدود والتعزير، عبد الرحيم صدقي، ص132.
[22] وتجدر الإشارة أن تقسيم العقوبات يختلف بين الفقهاء؛ فهناك من يجمع بين الحدود والقصاص والديات في قسم واحد بحكم أنها لا تخضع للاجتهاد، ثم التعزيرات، وهناك من يعتمد ثلاثة أقسام تتمثل في الحدود أولًا، ثم القصاص والدّية ثانيًا، وأخيرًا التعزير، وهو اختلاف لا يضر أو يؤثر على مناقشة الموضوع لكن وجب التنبيه عليه.
[23] الحدود في الإسلام، أحمد فتحي بهنسي، مؤسسة المطبوعات الحديثة، القاهرة، 2003م، ص18- 19.
[24] التشريع الجنائي الإسلامي مقارنًا بالقانون الوضعي، عبد القادر عودة، دار الكتاب العزلي، بيروت، (1/ 79).
[25] المغني، ابن قدامة المقدسي، تحقيق: سيد إبراهيم، ومحمد شرف الدين، والسيد محمد السيد، دار الحديث، القاهرة، سنة الطبع 1425هـ= 2004م، (12/ 401).
[26] الجريمة والعقوبة في الشريعة الإسلامية؛ دراسة تحليلية لأحكام القصاص والحدود والتعزير، عبد الرحيم صدقي، ص130.
[27] أحكام التعزير بالمال في الشريعة الإسلامية؛ مقارنة بالقانون اليمني، محمد أحمد يحيى الخاشب، رسالة ماجستر، جامعة الإيمان، كلية الشريعة، اليمن، 1431هـ= 2010م، ص43.
[28] الجريمة والعقوبة في الشريعة الإسلامية؛ دراسة تحليلية لأحكام القصاص والحدود والتعزير، عبد الرحيم صدقي، ص131.
[29] التشريع الجنائي الإسلامي مقارنًا بالقانون الوضعي، عبد القادر عودة، دار الكاتب العربي، بيروت، (1/ 585).
[30] التشريع الجنائي الإسلامي مقارنًا بالقانون الوضعي، عبد القادر عودة، دار الكاتب العربي، (1/ 586).
[31] والمقصود هنا بالاستثناءات من حيث العدد والتنوع لا من حيث الماهية، وإلا فإن الحدود هي الأصل والأساس.
[32] الجريمة والعقوبة في الشريعة الإسلامية؛ دراسة تحليلية لأحكام القصاص والحدود والتعزير، عبد الرحيم صدقي، ص133.


