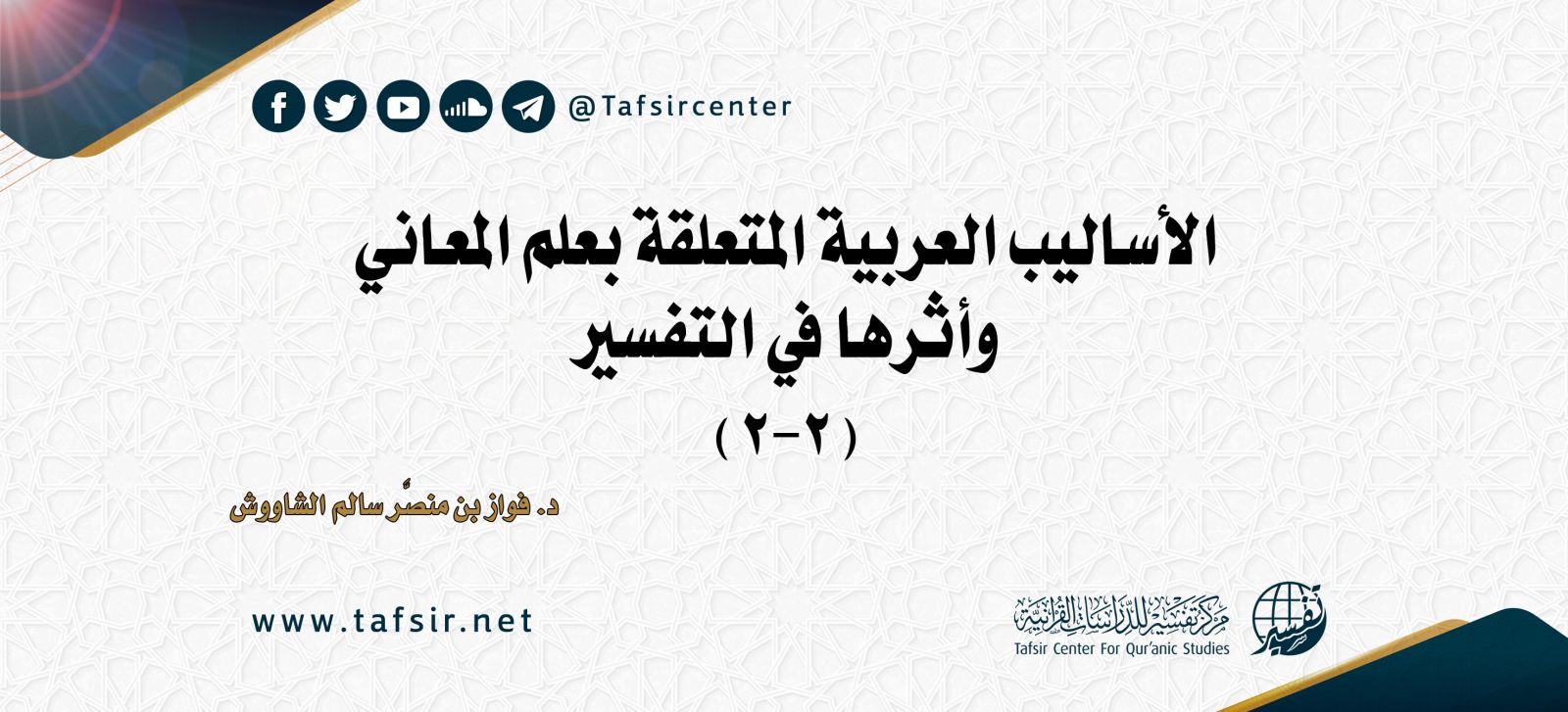إشكالية النموذج المرجعي في تقييم المؤلَّفات في أصول التفسير وقواعده؛ رؤية تحليلية نقديّة
إشكالية النموذج المرجعي في تقييم المؤلَّفات في أصول التفسير وقواعده؛ رؤية تحليلية نقديّة
الكاتب: مصطفى فاتيحي

يهدف تقويم وتقييم المؤلَّفات في أصول التفسير وقواعده إلى تقدير وتثمين الجهود المبذولة في هذا الحقل العلمي الواعد، ووزنها بمعيار العلم واختبار نجاعتها وفعاليتها، وتدقيق القول في الحكم بالأصل أو الفرع في أُفق تحقيق عِلْمِيّة هذا الحقل المعرفي الناشئ والبِكْر، لكن في خضمّ ذلك يعترض الباحثَ إشكالٌ جوهري يتعلّق بالإطار المرجعي (النموذج) الذي يحتكم إليه من أجل أن يكون النقد موضوعيًّا، والتقويم مفيدًا ومنهجيًّا، بحيث تتكامل الجهود ويحصل الانسجام بين محصِّلة النظر لدى جمهور المختصّين في هذا الميدان، وبين الجهود المستقبلية التي من المفترَض أن تنبني على التراكم السابق، وقد تجلّى ذلك من خلال المؤلَّفات التي نحَت هذا المنحى، إِذْ لم يكن روّادها أمام منطلقات مرجعية واضحة ومحددة؛ بل كان الأمر مجرّد اجتهادات يَرِدُ عليها الكثير من الاعتراضات، ويصعب على المخالف التسليم بها. وإذا كنّا نروم تجويد النظر وتسديد الوجهة من أجل الصياغة العلمية لأصول التفسير؛ كان حريًّا أنْ تتوجّه الجهود بالموازاة مع ذلك إلى نموذج التقويم ذاته.
ولذلك يروم المقالُ مناقشةَ الإشكال المشار إليه آنفًا والتنبيه إلى أهمية الوعي به واستصحابه أثناء مناقشة ونقد المؤلَّفات في أصول التفسير. وقد اتضح لديَّ وجهُ كونه إشكالًا وجدوى معالجته أثناء اشتغالي لمدّة غير يسيرة على أصول التفسير في (التحرير والتنوير)، وكنت أجد كلفًا أثناء تقويم أصل من الأصول المعتبرة عند ابن عاشور، بمعنى: ما هي الأسس والمنطلقات التي نحكم بها على أنّ هذا أصل وهذا فرع؟ وزاد من حِدّة ذلك لمّا طالعتُ الدراستَيْن المنهجيّتَيْن: (التأليف المعاصر في قواعد التفسير؛ دراسة نقديّة لمنهجية الحكم بالقاعدية)، وكذا (أصول التفسير في المؤلفات؛ دراسة وصفية موازنة)، فقد كانت الدراستان على وعي بهذا الإشكال وبالحاجة الماسّة إلى معالجته والاشتباك معه. ومِن ثَمَّ فإن المحاولة تروم المساءَلة المنهجية لمنطلقات النقد، وكأنّه نقدُ النقدِ وتقويمُ التقويمِ من خلال المدخل المنهجي، عسى أن يفضي ذلك إلى استبانة بعض المعالم الموجِّهة.
وتكمن أهمية الموضوع في الإسهام في توحيد الجهود وتكامل الأعمال الساعية إلى الصياغة العلمية لأصول التفسير وقواعده، فكلما كان النقد مؤسّسًا على محدّدات منهجية واضحة، كلما كانت النتائج إيجابية وفعالة، وحصل التراكم الباني عوض الاجترار والتكرار أو النقض والتجاوز دون استيعاب.
وأنبّه إلى أنني لا أزعم العمل على استخراج نموذج التقويم من الدراسات التي سأتناولها، وإنما حسبي أن أستشكِل المسألة عبرها ومن خلالها؛ اقتداءً بقول الإمام شهاب الدين القرافي -رحمه الله-:«وما لا أعرفه وعجزَتْ قدرتي عنه فَحَظِّي منه معرفة إشكاله؛ فإنّ معرفة الإشكال علمٌ في نفسه وفتحٌ من الله تعالى»[1].
وذلك أنّ للاستشكال دورًا محوريًّا في التنبيه إلى معاقد القضايا وتحقيق المسائل العلمية، ولا تخفى أيضًا أهمية الضابط الإشكالي في البحث العلمي[2].
وعليه، فبَعد عرض النقد أُشير إلى غياب المرجع لهذا النقد، بحيث قد يأتي باحث آخر فينتقد من منطلقٍ مختلف؛ لأنني انطلقت من فرضية أنّ الإطار المرجعي للنقد غير موجود، وإلّا سأصادر على المطلوب، ومن ثَم فإنّ الدراسات التي ناقشتها لم تكن تعير هذا الجانب اهتمامًا، وهدفي من المقالة بيان أنه جدير بأن تُصرف له الجهود من أجل صياغة هذا الإطار الذي يُفضي إلى النقد البنّاء، لا أنّ هذا الإطار موجود في تلك الدراسات وينبغي استخراجه. وأزعم أنه أمرٌ مفيد لو أثبَتْنا أنّ الدراسات النقدية في ميدان أصول التفسير وقواعده تخلو من إطار مرجعي للتقييم يلمّ شتات الموضوع وينظمه في كليات جامعة، وأنّ فعالية التقييم تقوم على صياغة ذلك النموذج.
كذلك فإنّ الضميمة -رؤية تحليلية نقدية- التي في العنوان تقييد له حتى لا يُحَمَّل ما لا يحتمل، فهو تحليلٌ ونقدٌ وفتحٌ لآفاق اقتراح البديل فيما بعدُ، وذلك ما سألتزم به في محتوى المقالة.
كما أُشير إلى أنّ معيار اختيار الدراسات التي سأشتغل عليها يتمثّل في: كونها دراسات خضعتْ للتحكيم والمراجعة وتمّت المشاركة ببعضها في مؤتمرات دولية، أو كتب محكَّمة أصبحت عمدة في بابها، ومن ثَم فهي رائجة ومتداولة بين الباحثين.
هذا، وقد اقتضت طبيعة المقالة الاعتماد على المنهج التحليلي الذي يُنظر إليه في الأدبيات المنهجية على أنه عملية تفسير ونقد لإشكالات معرفية، القصد من ورائها الوقوف على حقيقتها وطبيعتها العلمية[3].
ويضُمُّ هذا المنهج عملياتٍ ثلاثًا، وهي: التفسير، والنقد، والاستنباط.
أولًا: إشكالية النموذج المرجعي في الدراسات النقديّة لأصول التفسير:
تكمن أهمية النموذج المرجعي في تقويم الأعمال العلمية في انطلاقه من وجهةٍ بيّنة وأُسس متينة، واستشرافه لآفاق واضحة؛ مما يُفضي إلى العمل العلمي الرّصين والمسؤول، فإذا كان النقد يروم التقويم والتسديد، فإنه لا يمكن أن ينطلق من مجرّد قناعات شخصية أو اختيارات ذوقيّة.
ومن الحقول المعرفيّة التي شهدت حركة علميّة ملحوظة أصول التفسير، في محاولة لتحرير مفهومه وتقعيد قواعده وضبط معاقده وتحقيق وظائفه، وقد أثمر ذلك جهودًا معتبرة، مما استوجب متابعتها بالتقويم والنقد البنّاء، لكن هذا التقويم واجَهه إشكالٌ حقيقيّ يصعب تجاوزه، بل يجدر الوقوف عنده مليًّا، ويتعلّق بالنموذج الذي يتم الاحتكام إليه والصدور منه؛ تقريبًا للرؤى وجمعًا للجهود وتوفيقًا بين المرجّحات والمرجوحات.
وفيما يأتي عرض لمجموعة من المواقف في الموضوع من خلال بعض الدراسات والأبحاث:
-جاء في دراسة: (أصول التفسير في المؤلفات؛ دراسة وصفية موازنة بين المؤلّفات المسمّاة بأصول التفسير)، عند الحديث عن محدّدات نموذج التقييم: «ولأن أصول التفسير حقل علمي ناشئ فإنّ تقييم المؤلفات لن يكون بمحاكمتها إلى أصول كلية متّفق عليها، وإنما بالنظر إلى ما استقر عليه علميًّا في تقييم الرسائل والمؤلّفات العلمية، وذلك فيما يخصّ المنهج والأهداف. وبالنظر إلى الموضوعات والمسائل المتناولة»[4].
وعلى أهمية هذا المقترح لكنه غير كافٍ من أجل النقد والتقويم، لا سيّما إذا استحضرنا الحاجة الماسّة إلى الانتقال بمسائل هذا العلم الناشئ من الدراسة الوصفية ومجرّد المسح إلى التحليل والتفكيك والتركيب بما يُفضي إلى الصياغة العِلْمية المحكمة.
وإذا كانت هذه الدراسة صرّحت بصعوبة محدّدات التقييم وتكلّمت عنها بنسبية؛ فإن دراسة (التأليف المعاصر) تناولتْ ذلك بلغة يطبعها نوع من الحسم والقطع من خلال تقرير ما يأتي: «ولما كان الأمر بهذه الخطورة، وكان التأليف المعاصر في قواعد التفسير قد أتى بالكثير من القواعد التي نسَبَها لساحة التفسير والمفسّرين، لم تكن وجهتنا إنجاز عمل في القواعد ينضاف لغيره، ويسهم في تكثير أعداد القواعد وزيادتها، وإنما آثرنا العودة لمؤلّفات قواعد التفسير عودة منهجية متأنية تقصد قصدًا لاستكشاف البناء المنهجي الذي أسّستْ عليه تلك المؤلّفات الحكم بقاعدية قواعد التفسير، عبر فحص منطلقاتها المنهجية، ومرتكزاتها الكلية، ومداخلها العلمية، لتقرير القاعدية والتثبّت منها، فإذا استقام لنا ذلك المنهج، وظهرت معالمه، واتضح توارُد مؤلّفات القواعد على أصول ذلك المنهج وتتابُعها على الانطلاق من خلاله؛ فقد استقام لنا المنهج، وظهرتْ معالمه، واتضح توارُد مؤلّفات القواعد على أصول ذلك المنهج وتتابُعها على الانطلاق من خلاله، فقد استقام لنا ولغيرنا منهج العمل في قواعد التفسير، وانضبطت مسالك السّير فيه، وإن لم تظهر لنا استقامة منهج البناء والتقرير لقواعد التفسير، فذاك يعني أنّ القواعد التي أتى بها التأليفُ يعتريها فسادٌ يمنع من التسليم بقاعديتها، وأنّنا لا نزال بحاجة لضبط منهج التقعيد وتحرير المداخل والمنطلقات اللازمة لتقرير القاعدية، ثم مواصلة البحث في القواعد من جديد تبعًا لها؛ ففساد المنهج في تقرير القاعدية يلزم منه فساد كلّ ما قام عليه وتفرّع عنه»[5].
ومما يَرِد على هذه الخطّة المنهجية وهذا التقرير التساؤل عن وسائل فحص المنطلقات المنهجية والمرتكزات الكلية والمداخل العلمية لتقرير القاعدية، وكيف يتّضح توارُد مؤلّفات القواعد على أصول ذلك المنهج؟
وتخلص الدراسةُ بعد فحص وتحليل الكثير من المؤلّفات والبحوث إلى القول: إنّ الإشكالات المنهجية التي كشف عنها واقع الدراسة للتأليف المعاصر في قواعد التفسير تدفعنا للقول بأنّ الخطو لبناء قواعد التفسير يجب أن يأخذ حظّه من النظر والفكر والبحث والدرس، وأن تُعقد بشأن التأسيس لكيفية العمل فيه بحوثٌ نظرية وتأصيلية كثيرة، حتى يتحرّر مسلك السّير في القواعد، وتنضبط مداخل البحث فيها ومنطلقاته على نحو دقيق، بحيث تصبح لدينا خارطة منهاجية محرّرة تمكن من المزاولة والممارسة البحثية في هذا الميدان، وتهدي لمجاوزة العقبات ومعالجة الإشكالات.
إنّ الخطو لبناء قواعد التفسير والعمل فيها يحتاج لضبط المنطلقات الكلية اللازمة للسير، وتحرير المفاهيم والاصطلاحات، والاشتغال بدرس القضايا الجوهرية الخاصّة باستمداد قواعد التفسير ومجالاتها، وغير ذلك من الأمور المهمّة التي تُعِين على تهيئة التربة للعمل في قواعد التفسير، وتصون الجهود العلمية فيه من تكرار الإشكالات التي ظهرت لدى التأليف المعاصر فيها[6].
- أمّا القراءة النقدية في كتاب مولاي عمر بن حماد: (أصول التفسير؛ محاولة في البناء)، لـخليل اليماني، فإنها أخذَتْ على المؤلِّف وَضْعه تصورًا مجملًا في مقدّمة كتابه للموضوعات تبعًا لقياسه أصول التفسير على أصول الفقه من حيث المهمّة والغرض، ثم انطلق في سائر كتابه في البناء على ذلك التصوّر، وهو ما جعل الكتاب لا يعدو أن يكون مجرّد محاولة لمقاربة أصول التفسير، كشأن المحاولات السابقة عليه؛ إِذْ لا محدّدات تمَّ بناؤها فيمكن التحاكُم إليها، لا سيّما وأنّ فكرة قياس أصول التفسير على أصول الفقه مطروقة وليست غائبة عن التأليف في أصول التفسير بصورة عامة[7].
وبالرجوع إلى كتاب مولاي عمر بن حماد يتّضح صحة ما ذهب إليه الناقد؛ إِذْ لم نكن أمام محدّدات يمكن الاحتكام إليها، سواء على مستوى مفهوم أصول التفسير أو موضوعاته أو استمداده، وظلّت الإشكالات القائمة في مجمل كتب التفسير كما هي.
- وأمّا دراسة: (قواعد التدبّر الأمثل للشيخ الميداني: تحليل ونقد، لرزان الحديد وجهاد محمد نصيرات)، فرغم تنصيص صاحبيها على أنهما سيقومان بتحليل أهم القواعد الواردة في كتاب الميداني، ونقدها؛ ليقدِّمَا وصفًا علميًّا يبين مدى صلاحية هذا المؤلَّف للاعتماد مرجعًا أصيلًا في علم أصول التفسير وقواعده، الذي يحيا الآن مرحلة التنظير. رغم ذلك لم يوضِّحا منطلقات النقد والتحليل، ولم يتّضح في ثنايا البحث؛ إِذْ جاءت الدراسة وصفية في الغالب الأعم دون أن يصدر الوصف عن منطلقات واضحة المعالم.
- أمّا دراسة محمد مغربي: (علم أصول التفسير؛ دراسة في المصطلح ومناهج البحث فيه)، فهي أيضًا تعاني من اضطراب في نموذج التقييم، وقد أورد ثلاثة تعاريف لأصول التفسير؛ تعريف فهد الرومي، وخالد السبت، ومساعد الطيار. دون أن يبرهن على خلفيات هذا الاختيار خصوصًا أنه سيبني على ذلك مجموعة من الأحكام ليركّب تعريفًا بناءً على نقده لتلك التعريفات التي بيّن أنها كلّها مدخولة وفي حاجة إلى محدّدات أصول التفسير، وأنها تخلط بين أصول التفسير ومناهجه.
وقد اختار لتعريف أصول التفسير أنه: هو العلم بوجوه القواعد العلمية وفروعها التي يتوقف عليها فهمُ مراد القرآن واستنباط معانيه وكيفية الترجيح في ذلك.
ثم شرح تعريفه بما يأتي: أمّا قيد (وجوه القواعد)، أي: ما يستمد منه التفسير، فأشبهت الأحكام الكلية وجزئياتها التي ترتدُّ إليها كالمصادر استمدادًا وتفريعًا، فلولاها لما اتخذ المفسّر منها منضبطًا، بل لا يقدر على التفسير إلّا بالاستمداد منها... والذي يطرد على هذا التفصيل ذكر كليات التفسير ومصادره المعروفة بالأصول وما يتفرّع عليها، فقد أوجزتها في كليّات ستٍّ؛ هي: تفسير القرآن بالقرآن، وبالسُّنة، وبالإجماع، وقول الصحابي فيما لا رأي فيه، واللغة، والرأي، فهذه هي وجوه القواعد الكلية التي يتوصّل بها إلى معرفة التفسير.
مما يلحظ على ما حرّره محمد مغربي أنّ تعريفه لم يَسلم مما سجله على غيره من الخلط بين مناهج المفسّرين والأصول الكلية؛ إذ القواعد التي اقترحها جليّ أنها تنسجم مع التفسير بالأثر، كما أنها مرتهنة إلى أصول الفقه، فلا تخطئ العين تأثّرها بترتيب مصادر التشريع كما هي في كتب أصول الفقه ومباحث الاجتهاد. فضلًا عن أنّ التعريف الذي يحتاج إلى كبير شرح فهو يدلّ على عدم استوائه عند صاحبه.
ثم يضيف: وأمّا قيد (الفروع) في التعريف، فأردتُ بها صغريات القواعد الكلية، أي: ما تحوي هذه الكليات من قواعد فرعية.
وأمّا قيد (التي يتوقف عليها فهمُ مراد القرآن)؛ فلأنها مُعَدَّة لذلك بل موضوعها هو موضوع التفسير، فلا يستغني عنها باحث ولا مفسّر، واشتراط التوقّف عليها حقّ ثابت لهذه الأصول؛ فإنّ القول على الله بغير علم من كبائر الإثم ومن التجني على الله تعالى في كلامه.
وأمّا قيد (استنباط المعاني)، فلإمكان الاجتهاد في التأويل، أو التنبيه على معنى خفيٍّ وفَطنَ إليه أولو التفسير والمعاني، أو استجلاء معنى غير ظاهر خفي على غير واحد من المهرة.
وأمّا قيد (كيفية الترجيح في ذلك)، أي: في التفسير، فهو للإرشاد إلى معرفة طريق أيّ المعاني أَوْلَى بالتقديم إذا كان للّفظ معانٍ مشتركة متساوية؛ فإنه يُحمل على جميعها تكثيرًا للمعاني وإيفاءً بما عسى أن يكون مرادًا بالخطاب.
ثم قال لمّا تحدّث عن مناهج المفسِّرين: إنّ البحث في أصول التفسير متعدّد الأشكال والطُّرُق، والأنواع والتقاسيم، وفي ذلك قيمة علمية تعود إلى المصادر نفسها، أي: مصادر أصول التفسير... ولو حاولنا وضع نمط جامع لطرُق البحث فيه لاتخذنا في ذلك تشريحًا لظاهرة المصادر وأنواعها... وأرى أنّ مسالك الباحثين في علم أصول التفسير متنوّعة كتنوع البحث في أصول الفقه، فلا ضير من اختيار أحد المسالك إذا كان سليم المأخذ، غير أني أستَحِبُّ تفضيل طريقة الجمهور في استجلاء مسائل أصول التفسير من المصادر الكلية لا من الفروع لأجل إحكام أمهات القواعد ما أمكن، والتفرّغ لفروع القواعد حالة بحث قضية جزئية[8].
مما سبق نخلص إلى أنّ محاولة محمد مغربي على أهميتها لا تخرج عن كونها تأمّلات في الموضوع المطروق، ولم تصل إلى صياغة محدّدات واضحة يتم الإفادة منها في تقويم الإنتاجات المعاصرة في أصول التفسير بما يُفضي إلى تدقيق مباحث العلم ووزنها بالمعايير العلمية الواضحة.
- أمّا دراسة: (قواعد التفسير -إشكالية المفهوم والعلاقة-دراسة تقويمية)، لسعود فهيد العجمي.
فإنها تناولَتْ مشكلة المرجعية في النقد والتقويم من خلال فحص مسمَّى القاعدة والأصل من خلال الإشكالية الآتية: ما الإشكاليات الواردة في مفهوم قواعد التفسير؟ ما منزلة قواعد التفسير من علوم القرآن وعلم التفسير وأصول التفسير؟
وبعد عرض تعريفات القاعدة ومشمولاتها قال: وجد الباحث أنّ هناك إشكالية في كون القاعدة هل هي كلية أم أغلبية؟ وبعد تحقيق المسألة تبيّن أنّ الخلاف بين الفريقين هو خلاف شبه اصطلاحي؛ إِذْ إنّ صاحب النظرة الكلية يرى أنّ المستثنيات من القاعدة لا تدخل في شرط أمثلة القاعدة، أو الحكم يكون للغالب، بينما الفريق الآخر الذي يرى أنها تستحق أن تكون أغلبية حتى لا تشمل مستثنياتها، فإنّ لكلّ قاعدة استثناء. فهم متّفقون على خروج المستثنيات من القاعدة، ولكن موضع الخلاف في إطلاق المفهوم ووصفه، مع اتفاقهم على لزوم تعدّد تطبيقات القاعدة، فلا ينطبق الحديث على القاعدة مهملة التطبيقات أو ذات المثال والمثالين[9].
لكن هذا الاستنتاج لا يحلّ المشكلة المطروحة في محدّدات ونموذج التقييم، خصوصًا إذا استحضرنا أنّ الدراسة اكتفت بتناول تعريفين لقواعد التفسير؛ واحد لخالد السبت وآخر لمساعد الطيار، مرجِّحة تعريف خالد السبت.
بالإضافة إلى الانطلاق من مفهوم القواعد، فيرى الباحث ضرورة مراعاة مفهوم التفسير كمنطلق يحدّد قواعده، فالتفسير يفترض أن يكون كشفًا وبيانًا لمعاني مراد الله، والأَوْلى ألّا يتجاوز ذلك حتى لا يدخل فيه ما ليس منه، فاشتمال مصطلح التفسير ما ليس منه له تأثير على القواعد؛ لأنّ التفسير إذا جاء مشتملًا على بيان المعاني، واستخراج الِحكَم والأحكام، فلا بد من اشتمال القواعد التفسيرية على قواعد متعلّقة بالمعاني، وأحوال القرآن، واستخراج الحِكم والأحكام، فالتوسّع في مصطلح التفسير ترتَّب عليه التوسّع في إيراد القواعد وتعدّدها، بينما اقتصار مصطلح التفسير على بيان معاني القرآن الكريم ينتج عنه قواعد تفسير متعلّقة بالمعاني دون توسّع وزيادة، مما يسهم في ضبط القواعد، وسهولة دراستها، وتداولها بين المتخصّصين والمهتمّين، فلا بد من الانتباه لهذا الملحظ، ومقابلة المصطلحات إفرادًا وتركيبًا، فالتعريف لا بد أن يكون جامعًا مانعًا، لا يدخل فيه ما ليس منه، ولا يخرج منه ما كان فيه[10].
لكن ما هو المستند الذي ركن إليه الباحث لقصر التفسير على بيان المعاني؟!
- أمّا الدكتورة فريدة زمرد في دراستها: (علم أصول التفسير مصطلحًا ومفهومًا؛ الواقع والمتوقّع).
فقد ناقشت في دراستها أيّ المصطلحات أدَلّ على العلم الذي يبحث في معاني القرآن ويكون جديرًا بلمِّ شعث متفرّقات العلم، هل هو أصول التفسير أو أصول البيان أو أصول التأويل، مرجِّحة أصول البيان.
وفي سياق حديثها عن الموضوع أشارت إلى أنّ الكتابات المعاصرة في موضوع أصول التفسير لا تكاد تراوح مكان ما وصلتْ إليه جهود الأوّلين، باستثناء بعضٍ منها، وباستثناء ما نجد فيها من تقسيم وترتيب وتبويب، يقرِّب المادة ويختصِر الطريق إلى المقصود. ولخّصت الدكتورة فريدة ما تضمنته تلك المؤلَّفات فيما يأتي: مصادر التفسير (استمداد التفسير)، وقواعد التفسير (قواعد تتعلّق بخصائص النصّ المفسّر): اللغوية والقرائية والسياقية (النزول)، وشروط المفسِّر (العلوم التي يحتاجها المفسِّر)، ومناهج المفسِّرين (اتجاهات التفسير وأنواعه). لتخلص في النهاية إلى أنّ بناء علم أصول البيان يقتضي تبنِّي رؤية ثلاثية الأبعاد: منهجية، وعِلْميّة، وتكاملية:
فالعِلْميّة تقتضي: الحفر بحثًا عن القواعد الأساس التي بناها الأوائل، وتجميعها بعد إخراج ما كان مغمورًا منها، وصقل ما احتاج منها إلى صقل، وطرح ما لا حاجة إليه منها، ثم النظر في ما يمكن استكمال البناء به من لَبِنات.
والمنهجية تقتضي: وضع خطة لتنفيذ عملية البناء، تتضمّن تحديد أدوات الحفر والدَّرْس، والإخراج والصّقل، واختيار أحسن العاملين القادرين على تنفيذ هذه الخطة من الباحثين المتخصّصين والمهتمّين.
والتكاملية تقتضي: التنسيق بين كلّ الجهود والجهات العاملة في هذا المشروع[11].
ومما سبق يصعب القول بأنّ الدراسة وضعَتْنا أمام محدّدات واضحة يمكن الانطلاق منها لنقد المؤلّفات في أصول التفسير، بل يمكن القول: إنّ الدراسة تبيِّن بذاتها الحاجة الماسّة إلى ذلك.
- أمّا دراسة الدكتور سعيد شبار الموسومة بـ: (المحدّدات المنهاجية في القرآن الكريم: أصول تفسيرية ذات أولوية، "محدد الإكمال والإتمام" نموذجًا)، فقد استهلّها بأهمية التناول المنهجي للقرآن الكريم كما هو عند طه جابر العلواني عند حديثه عن الجمع بين القراءتين، والوحدة البنائية للقرآن الكريم وعلاقتها بنظرية النَّظْم، والوحدة الموضوعية، والقيم العليا الحاكمة (التوحيد والتزكية والعمران)[12]، وعلى أهمية ما جاء في الدراسة فإنّه يتعذّر القول بأنها أضافت جديدًا إلى منهجية تقويم المؤلّفات، على اعتبار أنّ الأفكار الواردة فيها على عمقها إلّا أنها ذات طابع فكري تأمُّلي أكثر منه تقعيدي، ولكن تفيد في أهمية التفكير في جعل الوحدة البنائية أصلًا من أصول التفسير بحيث تكون تلك الوحدة مرجعًا لتقويم مجموعة من المباحث خصوصًا تلك المتعلّقة بعلوم القرآن: (أسباب النزول، والناسخ والمنسوخ، والمكي والمدني، والقراءات، والمحكم والمتشابه، والإسرائيليات)، وكذا مقاصد القرآن وكليّاته ومقاصد السّور.
- كذلك نجد الدكتور/ إدريس نغش الجابري يصوغ الإشكال من خلال السؤال الآتي: كيف يحدّد علم أصول التفسير موضوعه، ومفاهيمه لم تتضح بعد؟ هل يأخذ في ذلك بنموذج علم أصول الفقه مع تبديل لفظ القرآن بالفقه، فيقال مثلًا: علم أصول التفسير هو العلم بالقواعد التي ترسم المناهج لاستنباط المعاني من أدلّتها التفصيلية؟ إنّ هذه الطريقة لا تعطي لعلم أصول التفسير استقلاله المنشود، فضلًا عن أنها تَغفل عن الخاصية التي تُميّز علم أصول الفقه، وهي أنه عِلم منهجي أساسًا، إذ إنّ موضوعه «بيان طريق استنباط»، أمّا علم أصول التفسير فالمنهج فيه جزءٌ لا كلٌّ... فالاختلاف بين عمل المفسِّر وعمل الفقيه يمتد إلى العلاقة بين أصول التفسير وأصول الفقه، فلا يُقاس هذا على ذاك موضوعًا ولا منهجًا ولا بناءً نظريًّا. ومن ثم فلا بد من بناء تعريف علم أصول التفسير على فهم دقيق لعمل المفسِّر، أعني على تعريف علم التفسير نفسه[13].
- أمّا ما يتعلّق بقضية مناهج المفسِّرين فإنّ الإشكال الذي أورده فريد الأنصاري ما زال قائمًا لمّا تحدَّث عن استخراج مادة أصول التفسير من التراث فقال: «استخراج المناهج العمليّة والنقديّة من خلال كتب التفاسير، من أول ما صُنِّف إلى اليوم...، والشرط في ذلك ألّا تكون البحوث سطحية، فلا تتناول طريقة المؤلِّف في تفسيره للقرآن، بإحصاء الأدوات العلمية المستعملة لديه فحسب؛ كتوظيفه للغة مثلًا، والشِّعر والقراءات القرآنية، والحديث النبوي...إلخ فهذا مطلوب، نعم، ولكن لا بد من تعميق العمل، بأنْ تُستنبط القواعد المعتمدة لديه في عملية الفهم، والتأويل، والتوجيه، وكذا الضوابط، والمقاصد، المتحكِّمة في العملية التفسيرية عنده، فلا بد من بيان الأصل والفرع في ذلك، وكذا الكلي والجزئي، والثابت والمتغيّر، والشرط والركن...إلخ. ثم حالات التقديم والتأخير لهذه الأدوات، أو حالات الإعمال والإهمال لها عند التعارض، وضوابط هذه وتلك في كلّ حال، إلى غير ذلك مما يسهم في بناء النظرية التفسيرية من بعد حقًّا؛ إذ استخراج المناهج واستنباطها بهذه الصورة يعتبر خطوة مهمّة في طريق بناء وتركيب (علم أصول التفسير) باعتبارها نظرية متكاملة الأطراف، وذلك بقيام دراسات وبحوث أخرى، تجمع كلّ ذلك وتركّبه تركيبًا ينسق بين أجزائه من حيث وظائفها التفسيرية للخروج بكليات محكمة، تقنّن التفسير وتضبطه»[14].
وهذا الذي ذَكَره فريد الأنصاري طموحٌ لم تصل إليه أغلبُ الدّراسات التي تناولتْ مناهج المفسِّرين، إلا فيما نزر، كما قرّر كثيرٌ من النظّار والنقّاد، وهذا ما وقفتُ عنده من خلال البحوث التي تناولَتْ منهج ابن عاشور. وحتى لا نجازف بالتعميم فإنّ دراسة محمد المالكي حول الطبري: (دراسة الطبري للمعنى من خلال تفسيره جامع البيان عن تأويل آي القرآن)، توفّر فيها الشرط الذي ذكر فريد -رحمه الله-؛ إِذْ لم يكن صاحبها فقط يصف الخطوات والأصول المعتمدة عند الطبري، بل كان يبين الأصل والفرع، والوظيفة والمنهج أثناء التعارض، والعلاقة بين الأصل اللغوي والأصلين العقلي والنقلي.
وهذا الشّرط الذي ذكره فريد الأنصاري لو رُوعي في البحوث والدراسات التي تناولَتْ مناهج المفسِّرين لأفضى ذلك إلى سدّ فراغٍ مهمّ في صَرْح بناء أصول التفسير وأجاب عن إشكالات مهمّة. ومن ثَمَّ فإنّ الحاجة ماسّة لعمل نقدي على شكلِ مشروع جماعي لفحص الأطروحات التي تناولتْ مناهج المفسِّرين. والقيام بدراسات استقرائية على منوال دراسة التأليف المعاصر في أصول التفسير، بما ينبِّه الباحثين على ضرورة تجاوز الاختلالات في البحوث السابقة، وأن تتبنّى المشروعَ المراكزُ العلمية ووحدات البحث في الجامعات.
ثانيًا: استنتاجات وآفاق (محاولة لتلمُّس معالم النموذج المرجعي في التقويم):
نخلص مما تم عرضه آنفًا أنّ هناك فراغًا حقيقيًّا في ما يتعلّق بنموذج النقد ومرجعه، وأنّ حالة الاختلاف الشديد والاضطراب البيِّن أو الاجترار والتكرار كلّها تعود إلى غياب المرجع.
ومما يستفاد من كلّ ذلك ضرورة إعادة بحث وتحقيق كثير من المسائل والمباحث والقضايا، من قبِيل مفهوم التفسير وكونه علمًا أو عدم ذلك، ومفهوم أصول التفسير وموضوعه، واستمداده، ووظيفته، ومفهوم الأصول والقواعد، ومعيار الحكم بالأصل والقاعدية.
-مفهوم التفسير: قد يظنّ بعضُهم أنّ مفهوم التفسير من القضايا التي لا يتكلّف لها الحدّ، لكن الواقع يثبت الضرورة العِلمية والمنهجية لتدقيق المفهوم حتى ينماز عن غيره ولا يدخل فيه ما هو ليس منه، ولا يخرج ما هو من صُلبه. وكما توصّلت الدراسات المشار إليها سابقًا إلى أنّ هناك اضطرابًا واسعًا في تحديد هذا المفهوم، بين مقتصر على مجرّد بيان المعنى، وبين متجاوز ذلك إلى استخراج اللطائف والنُّكَت والأسرار والحِكَم، وكذلك الالتباس الحاصل بين مسمَّى التفسير والمصطلحات القريبة منه من قَبِيل التأويل والاستنباط والبيان.
وفي ذلك يشير الدكتور/ مساعد الطيار إلى توجيه مهمّ، لما ذهب إلى أنّ التفسير إنما هو شرح وبيان للقرآن الكريم، فما كان فيه بيان فهو تفسير، وما كان خارجًا عن حَدّ البيان فإنه ليس من التفسير وإنْ وُجِد في كتب المفسِّرين. وبهذا الضابط يمكن تحديد المعلومات التي هي من التفسير، وليس بلازم هنا أن يذكر كلّ ما هو من التفسير؛ لأن المراد ذكر الحدّ الضابط، وليس ذكر منثورات البيان[15].
وهذا ما غاب في مجمل مؤلّفات أصول التفسير التي عرَّفت التفسير، كما أشارت إلى ذلك دراسة (أصول التفسير في المؤلّفات) مما كان له أثر في تحديد مفهوم أصول التفسير، وإذا تحرّر مفهوم التفسير مكّن من تحديد مفهوم أصول التفسير.
ولو جُرِّد التفسير من كثير من المعلومات كما يرى مساعد الطيار لتقاربتْ مناهج المفسِّرين، ولكان جُلّ الخلاف بينهم في وجوه التفسير، وترجيح أقوال المتقدِّمين[16].
ويمكن مراعاة هذا التوجيه المنهجي أثناء تقديم أطروحات تدرس مناهج المفسِّرين من أجل تمييز المسائل الصُّلبية من المُلَح التي ليس لها تعلُّق كبير بمضمون التفسير، ولا أثر لها في استيعاب منهجية المفسِّر وأصوله المعتمدة، مما يساعد على استثمار الجهد والوقت.
ولكن الدكتور/ مساعد مَثَّل لبعض المسائل التي ليست من صُلب التفسير، بل من مُلَحه ولطائفه، وذكر منها المناسبات كما هي عند أبي حيان التوحيدي، وأغراض السور كما عند ابن عاشور، وما ذهب إليه الدكتور يصعب التسليم له؛ لِمَا للمناسبات من دَور في ترجيح المعاني خصوصًا عند التعارض، وأحيانًا يتوقّف المعنى على ذلك، وكذا فإنّ أغراض السورة تكون موجِّهة للمفسِّر وقِبلة هادية له، ويجمع المناسبات وأغراض السور ما اصطلح عليه الوحدة البنائية للقرآن الكريم، ومعلوم أهميتها في التفسير الموضوعي، كذلك لا ينكر علاقة المناسبات وأغراض السور بالسياق، وقد برع ابن عاشور في ردّ كثير من التفسيرات بناءً على السياق، وما ذكره مساعد الطيار يصدق على التفسير التحليلي الذي ينظر إلى المعنى مجردًا عما قبله وما بعده.
وملحظ آخر يوجّه إلى دراسة (التأليف المعاصر في أصول التفسير)، وهو انتصارها إلى القول بعدم عِلْمية علم التفسير؛ لأنّ قواعده لم تُجمع، والعلم يقوم على وضوح القواعد، لكن تحرير القواعد لا يعني أنها غير موجودة، وقد يُقْبَل الأمر إذا قُصِدَ بالعلم الصياغة الدقيقة والصارمة، وهذا أمر متعذّر في الدراسات الإنسانية، والتفسير باعتباره اشتغالًا على النصّ واللغة هو أقرب إلى العلوم الإنسانية وليس إلى العلوم الحقّة، ومعلوم أنّ سِمة العلوم الإنسانية تأبِّيها عن الضبط الصارم والتقعيد الحدِّي القاطع عكس العلوم الحقّة.
-مفهوم أصول التفسير: انعكس الخلاف الواسع في تحديد مفهوم التفسير على تحديد مفهوم أصول التفسير، فتَباينَت المؤلفات في ذلك، ويُستنتج من التباين في المعاني التي يحتملها مفهوم أصول التفسير -كما توصّلَتْ إليه دراسة: (أصول التفسير في المؤلفات المعاصرة)- اضطرابُ المفهوم وغموض رؤية المؤلَّفات له، وحاجة المفهوم إلى تحرير وبيان؛ فالناظر إلى تلك المؤلَّفات لِيستبين منها مفهوم أصول التفسير لا يرجع منها بشيء[17].
إِذْ كيف يمكن تحقيق الصياغة العلميّة لهذا الحقل المعرفي دون تحديدِ مفهومه ووضعِ حدِّه ورسمه؟ ولِمعترضٍ أنْ يقول: إنّ كثيرًا من العلوم نشأتْ أولًا ثم حُدّد مفهومها؛ مثل علم أصول الفقه وعلم الحديث. وهو اعتراض وجيه بالنظر إلى وَفْرَة المادة العلمية المتناثرة في المصادر المختلفة، وهذا يُحيلنا إلى تدقيق وظيفة أصول التفسير التي لا يمكن أن تكون نظرية محضة، باستحضار الأفق البياني المنتظر من العمل على تأسيس هذا العلم.
وتكمن وظيفة أصول التفسير في البيان وفهم مراد الله، وبهذا يكون كلّ ما له اتصال مباشر بتحقيق ذلك الهدف يُعَدُّ من أصول التفسير، ويمكن أن يشكِّل هذا معيارًا مهمًّا لوزن المؤلفات في أصول التفسير ونَخْل المعلومات الواردة فيها، مما من شأنه أن يسهم في استبعاد المسائل المقحمة لشُبهة تعلّقها بالتفسير وإنْ ضَعُفَتْ فائدتها.
وأعتقد أنّ الخلاف في وظيفته ليس واسعًا بالمقارنة مع مسائل وقضايا أخرى، وضَعْف الخلاف في ذلك يقرِّب الرؤى والتصوّرات.
ولا غرو أنّ تحقيق القول في الوظيفة يُفْضِي إلى تحديد مجالات الاستمداد ومصادر القواعد؛ لأنّ قضية الاستمداد من الإشكالات المطروحة في موضوع أصول التفسير، لأنّ تاريخ التفسير يكشف تداخُل الكثير من الحقول المعرفية على أرضيته، لا سيّما إذا استحضرنا تعدُّد موضوعات القرآن وتشابُك القضايا التي تناولتها الآيات والسور. ويضطر المفسِّر إلى الاستعانة بقضايا المجال المعرفي الذي تروم الآية معالجته. فتختلط علوم اللغة بالتاريخ والحديث والفقه، وقد ينجرُّ المفسِّرُ إلى تفريعات في فنّ من فنون العلم دون أن يكون لذلك تعلّق مباشر بالبيان المراد تحقيقه؛ وعليه، من المفيد جدًّا بعد تحديد مصادر الاستمداد بيان القدر المحتاج إليه.
ونَستنتج من ذلك معيارًا مهمًّا في التقويم، وهو قدرة المؤلِّف في أصول التفسير على ضبط مصادره ووضوح الرؤية عنده في الاستمداد؛ تجنبًا للخلط وإقحام المسائل دون سبب علمي وجيه.
فيتحصّل لدينا إذًا ثلاثة معايير أساسية متكاملة، وهي: مفهوم أصول التفسير، ووظيفته، واستمداده. كما هو مبيَّن في دراسة: (أصول التفسير في المؤلفات؛ دراسة وصفية موازنة). وذلك ما تؤكِّده هذه المقالة وتدعو إلى تبنِّيه وتعميق النظر فيه؛ تدقيقًا وتحليلًا وتفعيلًا.
خاتمة:
أفضى التحليلُ السابق إلى الوقوف عند أهمية معالجة إشكالية النموذج المرجعي في تقييم الدراسات التي تناولَتْ أصول التفسير، وبيان أثر ذلك في تجويد الأعمال المقدَّمة في هذا الحقل المعرفي، والانعتاق من حالة التكرار من جهة، أو الاختلاف حدّ التضاد من جهة أخرى، خاصّة في ميدان المفاهيم والاصطلاحات، بالنظر إلى دورها في تقعيد العلم وضبط حدّه ومشمولاته.
ويمكن القول، إذا كان التقارب في المواقف والرؤى إلى حدّ التكرار والاجترار أمرًا غير علمي وغير منهجي وغير مفيد، فإنّ التباعد حدّ التناكر لا يقلّ ضررًا عنه، وهذا ما يمكن تسجيله على أغلب الدراسات حول أصول التفسير؛ ومرَدّ جزء من ذلك إلى غياب الإطار المرجعي للنقد والتقويم.
توصّلْتُ كذلك من خلال هذا المقال إلى أنّ البحث في أصول التفسير يَعرف نقاشًا علميًّا إيجابيًّا ومحاولات نقدية واعدة، ومن شأن استثمار تلك الجهود أنْ يحقّق الصياغة العِلْمِيّة المحكمة بما يجعل أصول التفسير عِلْمًا له قواعده وأسسه، وبما يضمن له الاستقلالية والفعالية، ومن القضايا التي يجدر الاشتغال عليها البحثُ في الإطار المرجعي الناظم والمنظّم لعملية النقد، وهو أمر تظهر الحاجة إليه أثناء الموازنة والمقارنة والترجيح.
من المقترحات التي أَخْلُصُ إليها: أهمية أنْ تبرمج مثل هذه الدراسات في قسم التفسير وعلوم القرآن، ابتداء من الإجازة والماجستير إلى الدكتوراه للطلاب؛ لأنها تكسب الملَكة وتمرّن على التحليل والتركيب وبناء القدرة النقديّة والمران على تحليل المحتوى. وكم هو مفيد وناجع أن ينشأ الطالب مدركًا لهذه الإشكالات من بداية الطلب؛ لأنه يفضِي إلى تجويد البحوث العلمية وطرق القضايا المفصلية ذات الأولوية والجدارة، كما ذكرتُ عن القرافي في المقدمة.
وأخيرًا، لا أزعم أنّ ما قدّمتُ كافٍ لصياغة نموذج للتقييم؛ فالأمر أوسع من أن تستوعبه مقالة، وهو ممتد ومترامي الأطراف ويحتاج إلى جهود جماعية، وإنما القصد هو تنبيه الباحثين -وأنا واحد منهم- إلى تكثيف الجهود في هذه القضية التي بَدَا لي أنها جديرة بأن تُصرف لها الهمم، وهذا الذي قدّمتُ مجرّد بداية وأفكار أولية يمكن تطويرها من خلال بحثٍ مطوَّلٍ بعد أن تنضج الفكرة جيدًا وبعد مزيد من الاطلاع.
[1] الفروق، (1/ 121).
[2] على حَدّ اطلاعي المتواضع لم أعثر على عمل أفرَد لهذا الإشكال معالجة خاصّة، مما شجعني على اقتحامه.
[3] مقدمة في مناهج البحث، مولاي مصطفى الهند، ص159.
[4] أصول التفسير في المؤلفات؛ دراسة وصفية موازنة بين المؤلفات المسمّاة بأصول التفسير، ص305.
[5] التأليف المعاصر في أصول التفسير، ص7- 8.
[6] التأليف المعاصر في أصول التفسير، ص7- 8.
[7] قراءة في كتاب علم أصول التفسير؛ محاولة في البناء، للدكتور/ مولاي عمر بن حماد، خليل اليماني، ص13.
[8] علم أصول التفسير؛ دراسة في المصطلح ومناهج البحث فيه. المؤتمر العالمي الثالث للباحثين في القرآن وعلومه. بناء علم أصول التفسير: الواقع والآفاق، فاس، أيام: 19- 20- 21 من جمادى الآخرة 1436هـ = الموافق 9- 10- 11 من أبريل 2015.
[9] دراسة: قواعد التفسير -إشكالية المفهوم والعلاقة- دراسة تقويمية، لسعود فهيد العجمي، ص723، دراسات، علوم الشريعة والقانون، المجلد 46، العدد 1، 2019.
[10] دراسة: قواعد التفسير -إشكالية المفهوم والعلاقة- دراسة تقويمية.
[11] (علم أصول التفسير مصطلحًا ومفهومًا: الواقع والمتوقع)، المؤتمر العالمي الثالث للباحثين في القرآن الكريم وعلومه في موضوع: بناء علم أصول التفسير: الواقع والآفاق، أيام: 19- 20- 21 من جمادى الآخرة 1436هـ = الموافق 9- 10- 11 من أبريل 2015م.
[12] المؤتمر العالمي الثالث للباحثين في القرآن الكريم وعلومه في موضوع: بناء علم أصول التفسير: الواقع والآفاق، أيام: 19- 20- 21 من جمادى الآخرة 1436هـ = الموافق 9- 10- 11 من أبريل 2015م.
[13] أصول تفسير القرآن الكريم العقلية: الواقع والمقترح، المؤتمر العالمي الثالث للباحثين في القرآن الكريم وعلومه في موضوع: بناء علم أصول التفسير: الواقع والآفاق، أيام: 19- 20- 21 من جمادى الآخرة 1436هـ = الموافق 9- 10- 11 من أبريل 2015م.
[14] أبجديات البحث في العلوم الشرعية، فريد الأنصاري، ص157.
[15] مفهوم التفسير والتأويل والاستنباط، مساعد الطيار، ص64.
[16] مفهوم التفسير والتأويل والاستنباط، مساعد الطيار، ص71.
[17] التأليف المعاصر في قواعد التفسير؛ دراسة نقدية لمنهجية الحكم بالقاعدية. ص131.
كلمات مفتاحية
الكاتب:

مصطفى فاتيحي
حاصل على الدكتوراه من جامعة القاضي عياض بمراكش - المغرب، وأستاذ التعليم التأهيلي الثانوي.
مواضيع ذات صلة
((المعلومات والآراء المقدَّمة هي للكتّاب، ولا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع أو أسرة مركز تفسير))