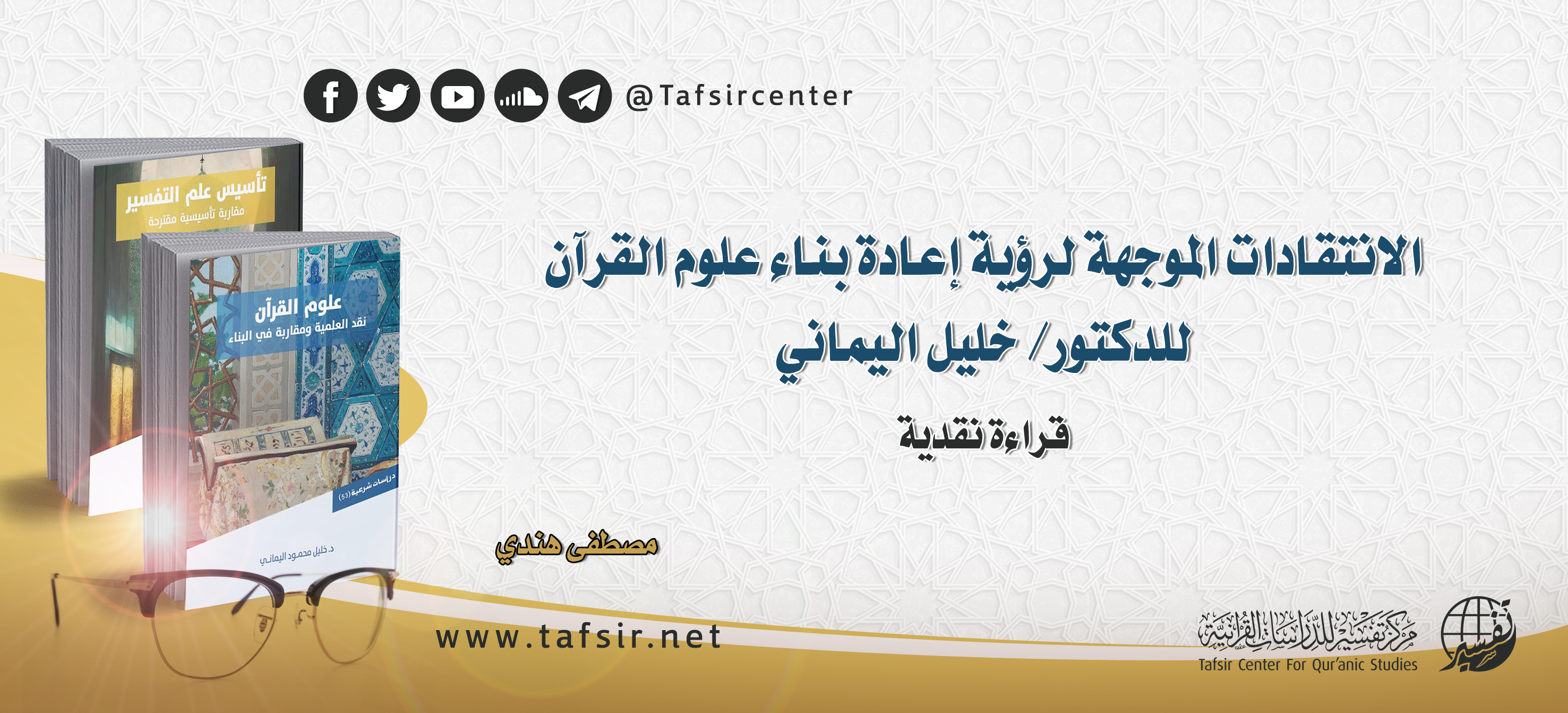كتاب (قواعد الترجيح عند المفسِّرين) للدكتور/ حسين الحربي؛ قراءة نقديّة لمنطلقات القول بالقاعدية
كتاب (قواعد الترجيح عند المفسِّرين) للدكتور/ حسين الحربي؛ قراءة نقديّة لمنطلقات القول بالقاعدية
الكاتب: محمد يحيى جادو

تمهيد:
تشهد ساحةُ قواعد التفسير جدلًا واسعًا على صُعُدٍ عديدة، من أهمّها واقع التأليف المعاصر في القواعد وما إذا كان قد أتى بما ينضاف إلى الموروث التراثي في قواعد التفسير، وفي ظلّ نقدٍ موسّع من قِبَل بعض الدراسات لمسار قواعد التفسير وإثباتها لعوارٍ منهجي في واقع هذا التأليف يحيله بلا قيمة منهجيّة، وفي ظلّ كون هذه الدراسات النقديّة لم تتعرّض بالتقويم الموسّع لمسار قواعد الترجيح[1]؛ فإنّنا ارتأَيْنا أنْ نخطو هذه الخطوة في تقويم إحدى الكتابات المهمّة في هذا المسار؛ وهو كتاب (قواعد الترجيح عند المفسّرين) للدكتور/ حسين الحربي، وتهدف هذه المقالة إلى تحرير منطلَق الكتاب في القول بقاعدية قواعده، ومن ثم تقويم هذا المنطلَق والنظر في آثاره وانعكاساته.
أولًا: منطلق الحربي في القول بالقاعدية؛ عرض وبيان:
نرمي في هذا المقام لبيان الإطار المنهجي الكلّي الذي تأسّس عليه الحُكْم بالقاعدية في الترجيح لدى الكاتب، وبيان كيفيات إقراره بقاعدية هذه المعلومات في الترجيح وما يرتبط بهذا الغرض من محدّدات ومعايير وأُطُر منهجية؛ وبكلّ ما له أثر في تكوين الرؤية المنهجية للكتاب في الحكم بالقاعدية.
ينطلق كتاب الحربي من مفهوم محدّد لقواعد الترجيح، وهو أنها ضوابط وأمور أغلبية يُتَوصّل بها إلى معرفة الراجح من الأقوال المختلفة في تفسير كتاب الله[2].
وإنّ الناظر في الكتاب لاستجلاء منهجيةٍ في الحكم بالقاعدية؛ يلحظ أنّ الكتاب لم يُفرد للأمر كلامًا مستقلًّا على خلاف ما هو متوقَّع، فبرغم وجود مقدّمات نظرية للكتاب إلّا أنها لم تُعْنَ ببيان كيفية الحكم بالقاعدية، ولا المعايير التي اعتمدها في ذلك الحكم، غير أنّنا ومن خلال النظر في الكتاب؛ أَلْفَيْنَا الكتاب منطلِقًا في القول بالقاعدية من منطلق عام يتمثّل في القول بتقرّر قواعد التفسير لدى السابقين، وبالتالي فيقوم الكتاب بجمعها وشرحها والتمثيل عليها، لا بنائها وتقريرها.
وهذا المنطلق شديدُ الظّهور في الكتاب، ويدلّ عليه جملة من نصوص المؤلِّف مصرِّحة بفكرة التقرّر؛ منها:
قوله في مستهلّ عمله: «استقرأْتُ هذه الكتب الثلاثة؛ فقرأتُ (جامع البيان) و(أضواء البيان) كاملَيْن، وتسع مجلدات من (المحرّر الوجيز)، أقفُ عند كلّ خلاف وكلّ ترجيح سطره هؤلاء الأئمة، وأقيّد ذلك مقسمًا حسب خطة الرسالة. ثم تتبعتُ كلام شيخ الإسلام ابن تيمية المتناثر في الفتاوى فيما يتعلّق بالتفسير وأصوله، وقرأتُ كلام ابن القيّم المجموع في (التفسير القيِّم). وقد استغرق هذا الاستقراء منّي ما يزيد على أربعة عشر شهرًا»[3].
وقوله عن القواعد: «هذه القواعد منها ما هو منصوص عليها بلفظها ومعناها من قَبْل، ومشهورة بين العلماء بلفظها، ومنها ما يَقِلّ ذكرها والتنصيص عليها بلفظها غير أنها معتمَدة ومعروفة ومعمول بمضمونها، ومنها ما لم أجد مَنْ ذكَرها بلفظها فاستخرجتُها من ترجيحاتهم واجتهدتُ في صياغتها وبيّنتُ عمل العلماء بمضمونها»[4]، وقال أيضًا: «وأحيانًا توجد قواعد مشتهرة بين علماء الأصول بلفظ معيّن، غير أني أختار عبارة بعض المفسّرين وإنْ خالف المشهور».
ويقول عن طريقته في عرض أقوال العلماء في اعتماد القاعدة: «أذكرُ فيها أقوال العلماء التي تدلّ على اعتماد المفسِّر للقاعدة، واستعماله لها في الترجيح، وأختارُ الواضحَ الصريحَ الذي لا يَحْتاج إلى تعليق وبيان. وطريقتي في عرضها أَنّي أجتزئ من كلام العالِم القولَ الذي يقرّر به القاعدة سواء ذَكَرها بلفظها أو بمضمونها، أو رجّح بما يتّفق مع مضمونها»[5].
ويقول عن قواعده: «فأبرزتُ جملةً من قواعد الترجيح في موضع واحدٍ مبيّنًا موقف المفسّرين منها ومدى تطبيقهم واعتمادهم لها»[6].
وقوله أيضًا عن كتب التفسير: «ولم أُهْمل بقيةَ كتب التفسير... خاصّة التي تهتم بذكر الخلاف والترجيح فيه، وقيّدتُ ترجيحاتهم وأقوالهم في اعتماد القاعدة»[7].
ويقول عن قواعده الفرعية التي ذكرها في عقب قواعده الرئيسة: «ذكرتُ بعضَ القواعد المتفرّعة عن القاعدة الأصلية...، وشرحتُ منها ما يحتاج إلى شرح، واكتفيتُ في بعضها بالنصّ عليها والإحالة على مَنْ ذكرها من العلماء»[8].
ويقول في كلامه عن قواعد الترجيح: «ولم أعتمد في الترجيح إلّا ما كان صريحًا من أقوالهم»[9].
ويقول في شأن تصرّفه في بعض الصياغات للقواعد: «قد أحتاجُ أحيانًا إدخالَ بعض كلامي في نَصٍّ منقول بِلَفْظِه لأحد العلماء لإيضاح إحالة إلى محذوف...»[10].
ويقول أيضًا: «ومن تقديم قواعد الأثر ما قرّره العِزّ بن عبد السلام بقوله...»[11].
ويقول أيضًا في شأن إحدى قواعده: «وقرّر هذه القاعدة كثيرٌ من العلماء؛ كأبي جعفر النحّاس، وأبي شامة، وأبي حيان، والسمين الحلبي، وابن المنير، والزركشي، وابن الجزري»[12].
ويقول أيضًا: «ومن العلماء الذين قرّروا هذه القاعدة الإمام ابن جرير الطبري... وقرّرها ابن حجر والشنقيطي»[13].
والناظر في هذه الأقوال يظهر له انطلاقته من تقرّر القواعد قطعًا، وأنه يجمعها، لا أنه يقوم ببناء القاعدية وتقريرها عبر استقراء وتتبع الجزئيات.
إنّ هذه النصوص صريحة في كونه لم يمارِس الحكمَ بالقاعدية، ولم يَخُضْ غِمَاره ومشاقّه، وأنه كُفِي خوض ذلك الغمار لسبْق العلماء الأوائل -بحسب تصريحه- إلى الحكم بالقاعدية، وعنايتهم بتقريرها وذِكْر نصوصها؛ ولذا فإنّنا نقرّر ما قرَّرَتْه «دراسة التأليف المعاصر في قواعد التفسير؛ دراسة نقديّة لمنهجية الحكم بالقاعدية» من القولَ بأنّ كتابَ الحربي صادرٌ عن اعتقادِ تَقَرُّرِ قواعدِ الترجيح لدى المفسّرين وحضورها في كتب التفسير منصوصًا عليها، وأنه يجمع هذه القواعد ولا يقوم ببناء القاعدية.
ومع أنّ هذه النصوص المتكاثرة قاضية عند كلّ باحث بضرورة انطلاق الكتاب من هذا المنطَلَق الذي تكاثرت النصوص في التدليل عليه وذكره والتصريح به، إلّا أنّنا ولخطورة هذا الموقف وأثره الحادّ فيما سيأتي لاحقًا آثرْنا أن نزيد من البيِّنات والدلائل والبراهين على هذا المرتكز كمنطلق للكتاب في الحكم بالقاعدية في الترجيح، وأبرزها ما يأتي:
- دلالة أعداد القواعد الترجيحية التي ذكرها الكتاب:
إنّ المتأمّل لعددِ القواعد التي أَوْرَدَهَا المؤلّفُ يعلم يقينًا أنه جامِعٌ لما تقرّرتْ قاعديته في الترجيح من قَبْل وليس مؤسِّسًا لهذه القواعد؛ إِذْ قد حوى الكتاب ما يربو على أربع وأربعين قاعدة رئيسة وتحتها أضعافها مما سمّاه قواعد فرعية أو داخلة في مضمون القاعدة الرئيسة، ومثل هذا العدد لا يمكن تهيؤه لمن يؤسّس القواعد ويخوض مشاقَّ التقرير لقاعديتها.
- منهجية الكتاب في التمثيل للقواعد التي ذكرها:
إنّ المتأمّل لمسلك الكتاب في التمثيل للقواعد التي ذَكَرَهَا يجده يكتفي بمثالٍ واحدٍ غالبًا، يقول: «حيث أَبْسُط الكلام على مثالٍ واحدٍ غالبًا»[14].
ولا شكّ أنّ هذه طريقة مَنْ ينقل القواعد لا من يؤصِّلها ويقرِّرها، لا سيما وأنّ هذه الطريقة -طريقة المثال الواحد- لا تصلح إلّا لمطلَق التبيين لما هو مقرَّر سلفًا، لا بِمَنْ يبحث سريان حكم كلي في جزئياته، والتي حينها سيستلزم الأمرُ تتبّعًا للجزئيات وحصرًا للمستثنيات ومعرفةَ ما يَدْخل وما يَخرج والتنبيهَ على هذه القيود في كلّ فرع للقاعدة.
إنّ طريقةَ الكتاب في التمثيل لما زَعَمَهُ من قواعد قاضيةٌ بأنها لا يمكن أن تكون طريقة مَنْ يؤصِّل للقواعد ويحكم بقاعديتها ويخوض غِمار هذا الحكم بما يستلزمه من تتبّع للجزئيات وبيانِ أَثَرِ كلّ جزئية في تقرير الحكم الكلي القاعدي، بل على العكس تمامًا، فالأمثلة هنا تابعة، لا هي الطريق الذي يُسلك للحكم بالقاعدية من عدمه.
- الواقع التطبيقي للكتاب:
إنّ مَنْ يتأمّل الواقع التطبيقي للكتاب يجده مِصْدَاق هذا الذي قرّرناه مِنْ أنه انطلقَ انطلاقةَ جَمْعٍ وترتيبٍ للقواعد، لا انطلاقةَ مَنْ يؤصِّل لها ويخوض غمار إثبات قاعديتها، ويظهر ذلك في عملِ المؤلِّف حيث يُصَدِّرُ بالنصّ مسبوكًا في صورة قاعدية، ثم يوضّح النصَّ ويبيّنه، وآكدُ شيء في ذلك ما يُعَـنْوِن به من قوله: «أقوال العلماء في اعتماد القاعدة»، ثم ذِكْر بعض الأمثلة والتطبيقات الموضحة لها؛ وهذا دالٌّ بوضوح على أنّ الكتابَ ناقلٌ جامعٌ لما تقرّرتْ قاعديته من القواعد، وإلّا فكما أسلفتُ؛ فبناء القاعدة الترجيحية الواحدة وتقرير قاعديّتها وفق مفهوم القواعد الذي انطلق منه الكتاب أمرٌ شاقٌّ وعسيرٌ وله دروب طويلة وغمار كثيرة، كما أنه يستحيل قيامُ الكتابِ بعبءِ التّأصيل لهذا الكمِّ الكبيرِ من القواعد الذي تَنُوءُ بالتأصيل لها المجامعُ والهيئات.
- دلالةُ نوعيّةِ المصادر التي اختارها المؤلّفُ لاستخراج القواعد:
إنّ تأمُّلَ تقسيم المؤلِّف لكتب التفسير، ونوعية التفاسير التي اصطفاها للعمل على القواعد من خلالها؛ يدلّ بوضوح أيضًا على انطلاق المؤلِّف من تَقَرّر القواعد الترجيحية في الكتابات السابقة، وتأمَّلْ قوله: «تأملتُ كتبَ التفسير فرأيتُها لا تخرج عن ثلاثة أقسام؛ أوّلها: ما يكون مختصرًا يعرض ما تَرَجَّح عنده دون ذِكْرٍ لخلاف أو سَرْدٍ لأقوال؛ كالبيضاوي والنسفي.
وثانيها: مَنْ يذكر الخلاف، ولكنه لا يهتم بالترجيح، وإنْ رجَّحَ لا يذكر وجهَ ترجيحه؛ كالماوردي وابن الجوزي.
وثالثها: مَنْ يذكر الخلاف والترجيح ووجه الترجيح؛ كالطبري وابن عطية والقرطبي»[15].
والمتأمّل لهذا النصّ من كلام المؤلِّف يجده شاهدًا خفيًّا قويًّا على انطلاقة المؤلِّف التي سبق تقريرنا لها، وذلك أنّ المؤلِّف استبعد جميعَ كتب التفسير سوى التي يرى أنّ فيها نصًّا على قواعد الترجيح حتى يمكنه جمعها وترتيبها، وإلّا فلو قَصَدَ المؤلّفُ لاستكناه القواعد الترجيحية بطريق الاستنباط مع الاستقراء لكان استخراج القواعد الترجيحية من كلّ كتابٍ تفسيري ممكنًا؛ لأنه حتمًا قد استبْطَنَ قواعدَ عَمِلَ من خلالها للتفسير والبيان، ومن ثَمّ نقد التفاسير وميْزها، إلّا أنّ جنوح المؤلِّف لهذه الكتب التي اختارها ظنًّا منه أنّ هذه الوجوه والتعليلات التي قد يَذْكُرونها في سياق نقد التفسير هي بمثابة قواعد ترجيحية جرى تركيبها واستقراؤها من قِبَل هؤلاء المفسّرين، وهو ما يؤكِّد صدوره عن تقرّر القواعد وأنها حاضرة بنصوصها في التفاسير.
وبهذا نكون قد أَنْهَيْنَا ضبطَ القول في منهجية كتاب الدكتور الحربي في القول بالقاعدية، وما صَدَرَ منه من منطلَق القول بتقرّر قواعد الترجيح عند السابِقِين، لندلف مباشرة لتقويم هذا المنطلق ومناقشته.
ثانيًا: منطلق كتاب (قواعد الترجيح عند المفسّرين) في الحكم بالقاعدية؛ نقد وتقويم:
وفي هذا المقام سنُعْنَى أولًا في تقويمنا لكتاب الحربي بالمنطلق الذي صدر عنه في ذاته، ثم تقويم عمل الكتاب من خلاله.
أولًا: منطلق تقرّر قواعد الترجيح؛ نقد وتقويم:
المتأمّل لفكرة سبقِ الأوّلِين لاستقراء القواعد وتركيبها والنصِّ عليها التي انطلق منها الحربي؛ يجدها أمرًا مصادمًا لعددٍ من الحقائق في إطار فنّ التفسير، ومن أهمها ما يأتي:
أولًا: الفراغ التأليفي في ميدان القواعد عبر تاريخ التفسير:
الناظر في تاريخ الكتابة في قواعد الترجيح يجد أنّ الكتابات التي قصدتْ إلى هذا المسار الذي خَطَّهُ الدكتورُ معدومةً، ولم نَظْفَر بهذا العنوان حاملًا هذه الدلالة عن طريق هذا المسلَك إلّا في هذا الكتاب، وأمّا الكتابات التي تُقَارِب هذا الموضوع من حيث الاشتغال فإنها مع نُدْرَتِها الشديدة فإنها لم تتوارد مع الكتاب في مفهومٍ محدّد للقاعدة، ولم تتوارد معه في النصِّ على كيفية الاشتغال بهذه المعلومات في الترجيح بين أقوال المفسِّرين، وهذه الكتابات في نفسها لم تَخْطُ بتاتًا إلى إيجاد قواعد كلية استقرائية مركّبة للترجيح بين أقوال المفسّرين[16].
وبالتالي فإنّ إحالة التركيب والاستقراء على هذه الكتابات باعتبار أنّها قد سبقتْ لذلك تُعَدُّ غلطًا ظاهرًا؛ إِذْ واقعها يشهد بخلاف ذلك، وأصحابها لم يَنُصُّوا على ذلك ولا قَصَدُوا إليه.
ثانيًا: نصوص العلماء في عدم تَوَفّر قواعد للتفسير:
إنّ مما يُثِيرُ العجب أنّ العلماء الذين مَارسوا التفسير بأنفسهم يَنُصُّ كثيرٌ منهم على أن هذا الفنّ -أي التفسير- مما لم يَحْظَ بجانب تنظيري كافٍ، ونصوصهم في ذلك متوافرة؛ مِنْ أَشْهَرِها:
قال الإمام الزرقاني الحنفي في (حواشي أنوار التنزيل): «إنّ هذا الفنّ لم تَظْهَرْ له قواعد، ولم يتعرّض لها أحدٌ»[17]، وكذلك نَصَّ الإمام الفناري على هذه الحقيقة[18]، ونَقَل الشيخُ الذهبي كلامَ بعض العلماء الذين ينصُّون على ذلك[19].
ولا شَكّ أنّ كلام العلماء على عدم توفّر قواعد لهذا العلم؛ يصادم تمامًا ما ارتكز عليه الكتابُ من وجود القواعد في الكتابات السابقة.
ثالثًا: تتابُع العلماء المتأخِّرين على التصريح بعدم سَبْقِ المتقدِّمين لكتابات تأصيلية في الجانب القواعدي للتفسير:
إنّ المصنّفات والمؤلّفات التراثية التي حامتْ حول هذا الحقل يُلْحَظُ أنها شديدة النُّدْرة شديدة التباين على مستوى الموضوعات والمعالجات، ومرّ معنا كونها كتابات متأخّرة ومتباعدة فيما بينها على مستوى الخط الزمني، ومما نَوَدّ أنْ نرصده في هذا المقام شكاوى العلماءِ المتأخّرين حتى القرن الثامن والتاسع وما بعد ذلك من أن القرون المتقدّمة لم تُلْقِ عنايةً بالتأصيل لعلم التفسير، وأنهم سابقون لهذا المسلك، وأنّ ثمة فراغًا تقعيديًّا يحتفُّ بهذا العلم، وهذا الرَّصْدُ لدى العلماء يصادم تمامَ المصادمة ما ينطلق منه الدكتور الحربي من كون هذه القواعد سَبَق إليها المفسِّرون المتقدِّمون وذكرُوها، وأنّ قواعدَ الكتاب مجموعةٌ من تقريرات السابقين ونصوصهم، ومِن أبرز مَنْ نَصَّ على ذلك: الإمام الزركشي (ت: 794)[20]، والإمام الكافيجي؛ فقد نصّ على سَبْقِه للتأصيل لعلم التفسير[21]، وكذا الإمام السيوطي وشَكْوَاه من عدمِ تأليفِ العلماء في قواعد التفسير وأصوله[22]، وأيضًا العلّامة الفراهي ومتابعته للسَّابِقِين في عدم وجود إطار قواعدي متكامل للتفسير[23].
إنّ استمرارَ شكوى العلماء من هذا الفراغ التقعيدي لعلمِ التفسير حتى هذه العصور المتأخّرة قَاضٍ ببطلان إمكانية توفّر بناء نظري متماسك بعد القرنين التاسع والعاشر مثلًا، بل الشكوى مستمرّة حتى القرن الرابع عشر، والفراغ ما زال قائمًا في ساحة الدرس القواعدي للتفسير.
وفي ضوء هذه الحالة من الفراغ التقعيدي لدى السابقِين حتى وقت متأخّر وفي ضوء شكوى العلماء من عدم قيام قواعد كلية استقرائية للتفسير، وفي ضوء الإطار النظري العام لهذا العلم؛ ساغ لدراسة (التأليف المعاصر في قواعد التفسير) أنْ تطرح عددًا من التساؤلات المشروعَة، والتي تمثّل علامات استفهامٍ كبيرةٍ على هذا المنطلَق الكلي القائل بتقرّر القواعد لدى السابقِين، منها أنه: متى حصل التقرّر لقواعد التفسير الكلية إذن؟! ولِمَ كانت شكوى بعض العلماء عبر التاريخ وحتى وقت متأخّر من غياب التّقنين والتقعِيد للتفسير؟! وما مسوّغات تلك الشكوى إذا كان الأمرُ كما ادّعت المؤلَّفات المعاصرة بأنّ للتفسير بناءً قاعديًّا متقرّرًا عبر تآليف؟! وكيف يمكننا أنْ نفهم تلك المقولات السابقة إذا كانت القواعد الكلية للتفسير قد وَصَلَتْ إلى هذا النضج بأنْ صارت مُقَرَّرَة ومنصوصًا عليها؟! وكيف نفهم ادّعاء بعض العلماء السبق إلى الكتابةِ في الجانب القاعدي للتفسير كما ظهر عند الكافيجي؟! وإذا كانت موضوعات علوم القرآن وقضاياه في رأي الزركشي والسيوطي لم تُجْمَعْ وتُدَوّن وتُضْبَط على غِرَار مصطلح الحديث، فكيف يسوغ القول -والحالة هذه- بتقرّر قواعد التفسير التي هي في رُتْبَةٍ أعلى وأُفُقٍ أَرْقَى بكثيرٍ مما قَصَدَ إليه الزركشي والسيوطي في جمع الموضوعات والقضايا[24]؟!
رابعًا: تتابُع شكوى عددٍ من المحقّقين المعاصِرين على استمرارية الفراغ التقعيدي الصحيح للتفسير:
إنّ كثرة الإنتاج المعاصر في حقل أصول التفسير وقواعد التفسير وفي حقل (مناهج المفسرين) لم تمنع عددًا من أهلِ التدقيق من المعاصِرين من التصريح بأنّ هذا التتابع الإنتاجي في هذه الحقول النظرية للتفسير لم يَقُمْ على النّحْو الذي يَسُدّ الفراغ الحاصل في هذه المساحات، بل أتى العملُ فيها غير محرّرة منطلقاته، ولا ممنهَجة مسالكه، ولم يؤخَذ بِحَقِّهِ بحيث يستطيع أن يقوم بناءً نظريًّا لحقلٍ تطبيقي واسعٍ كحقل التفسير، ومنهم الدكتور/ مولاي عمر حماد[25]، والدكتور/ فريد الأنصاري[26]، وقد توسّعتْ دراسة قواعد التفسير في تحرير هذا ونَقْلِ النصوص الدالّة على ذلك، فلْتُرَاجَع في مَوْضِعِهَا مِنَ الدّراسة[27].
وبعد هذا التّطواف في نقدِ وتقويم منهجيّة كتاب (قواعد الترجيح عند المفسّرين) في الحُكْم بالقاعدية؛ ظهر جليًّا أنّه لا يمكن بحال التّسليم بصحّة هذا المنطلَق ولا الموافقة عليه ولا التسليم بما أفرزه من نتائج؛ لِمَا أظهره النقدُ من مصادمته لحقيقة واقع علم التفسير في التاريخ، ولمصادمته لما هو متقرّر عند العلماء من ضعفِ البناء النظري لعلم التفسير، ومصادمته لجميع ما أسلفْنا مما يَرِدُ على هذا القول ويعارضه.
وليس أمامنا بعد هذه الجولة الموسّعة في محاولة تقويم هذه الدّعوى الكبيرة التي نَصَّ عليها الكِتَابُ وجعلها مُتَّكَأً له في ترك خوض غمار الحُكْم بالقاعدية لِما جلبه من قواعد ترجيحية؛ إلّا أنْ نلج واقعَ الكتاب ذاته لنحاول أنْ نستلمِح منهجَه في جمع القواعد وصياغتها ومسالك ذلك ومحدّداته حتى نتعرّف على واقع الكتاب منهجيًّا بشكلٍ أكثر دقّة.
ثالثًا: كتاب الحربي ومسلكه في تقرير قواعد الترجيح؛ نقد وتقويم:
إنّ من يطالع كتاب (قواعد الترجيح) لا يَشُكّ أن الكتاب ارتأى عددًا من الخصائص والميزات التي تجعل هذه المعلومات التي جمعها قواعدَ دون غيرها من المعلومات، وأنه ارتأى خصوصيةً كذلك لموارِده التي استقَى منها هذه القواعد، وأنه كذلك في صياغة هذه القواعد أو جمْعها وترتيبها كانت له محدّدات وإن لم يَنُصَّ عليها، وإن لم يَتَعَنَّ إبراز هذه المحدّدات والتدليل والتعليل لها، إلّا أنّنا في هذا المقام سوف نُعْنَى بمحاولة استكشاف كلّ قرينة أو علامة أو إشارة أو إيماءة يمكن أن تكون مبررًا للمؤلّف في القول بالقاعدية، وسَنُعْنَى ببحث كلّ ما يمكن أن يتّصل بالحُكْم بالقاعدية مما يظهر اتصاله بنتائج الكتاب وتقريراته.
- موقف الكتاب من التدليل على تقرير العلماء للقواعد:
إنّ مَنْ يلحظ واقع الكتاب يجده لا يعتني في مقام إثبات القاعدية إلا بمحاولة جمع نصوص عددٍ من العلماء تحت عنوان: «أقوال العلماء في اعتماد القاعدة»، ثم ينقل أقوالًا عامّة تحت كلّ نصّ أَوْرَدَهُ على أنه قاعدة، والعجيب أنه قَبْل ذِكْر النصوص العامة التي يُورِدُهَا يقول: «أقوال العلماء في اعتماد هذه القاعدة كثيرة، وكلامهم فيها واضح جَلِيّ»[28].
إنه من الظاهر جدًّا أنّ فكرةَ تتابُع العلماء على تقرير القواعد، وتواردهم على تحريرها واعتمادها أمرٌ لا يقبل الشكّ ولا يدخله الرّيب عند المؤلِّف؛ لذا فمن الطبيعي لدى المؤلّف أن لا يتجشّم غمار إثبات قاعديّة أيّ قاعدة في التفسير لما يراه من توارد العلماء وتتابعهم على الاستقراء والتركيب للقواعد؛ ولذا فإنّ حَظَّ الكتاب من التدليل وإثبات القاعدة هو نَقْلُ عددٍ من النصوص لعلماء سابقين في سياقات خاصّة أو في جزئية معيّنة دون ينصّوا على قاعدية ما ذكروه، إلّا أن الكاتب يجمع ذلك تحت عنوان: «أقوال العلماء في اعتماد القاعدة»، مع أنّ السياقات التي تُجْتَزَأ منها هذه النصوص ليستْ مقامات إثبات قاعدية، ولا يوجد نصّ على قاعدية هذا الأمر عند هؤلاء العلماء، ولم يَتَعَنّ المؤلِّف إثبات التطابق بين مفهومه للقاعدة ومفهومها عند هؤلاء العلماء، ولم يَتَعَنَّ أصلًا محاولة تحرير مفهوم القاعدة بين هؤلاء العلماء الذين يجمع نصوصهم معًا في قرن واحد، مع إمكانية تباين المفهوم بينهم كما سبق وأثبتْنا عدم حصول توارد على مفهومٍ محدّد للقاعدة لدى السابقين؛ ولذا فإنّ المسلك الذي سَلَكَهُ الكتاب نفسه واتكأ عليه في تجاوز تحرير القواعد واستقرائها مسلكٌ مشكِل، وهو نقلُ نصوصٍ للعلماء في سياقات جزئيّة بما يُفْهَم منه موافقةٌ للمعنى الذي صَاغَهُ؛ وذلك لجملة هذه الأسباب:
- عدم نَصِّ هؤلاء العلماء المنقولة نصوصُهم على كون هذا المستند قاعدة في التفسير.
- عدم إثبات المؤلِّف تَوَارُدَ مَنْ يجمعُ نصوصَهم على مفهومٍ واحدٍ للقاعدة بموجبه يتتابعون عليه ويقرِّرون به.
- عدم إثبات سريان هذا المعنى في كافّة تطبيقات هؤلاء العلماء فيما يشابه هذه الجزئية وإِعمال هذا المعنى الكلي في جزئياته.
وبالجملة فإنّ واقعَ الكتاب خالٍ من أيّ محدّدات أو أدلّة تُثْبِتُ قاعديّة هذه النصوص في التفسير سوى هذه النصوص التي يجمعها من أقوال العلماء، وهذه الأقوال بحاجةٍ في نفسها إلى إثبات قاعديّتها عند العلماء أنفسهم؛ ولذا فإنّ واقعَ الإثبات للقواعد في الكتاب واقعٌ في غاية الإشكال، بحيث لم نظفر بأيّ شيء مما يمكن مناقشته في القول بقاعدية هذه النصوص في الترجيح بين أقوال المفسّرين.
ولذا فإننا أيضًا سنحاول أن نتلمّس أمرًا مهمًّا في واقع الكتاب عسى أن يكون له مدخلٌ خفيّ في الحكم بقاعدية هذه النصوص التي ذكرها الكتاب:
موارد الكتاب في تقرير القواعد:
إنه وإن كان الكتاب لم يُظْهِر أيَّ محدّدات ولا علامات خاصّة في القول بالقاعدية في الترجيح إلا أنه قد اختار عددًا من المصادر رأى أنها تصلح لاستمداد القواعد أكثر من غيرها، مما قد يدلّ على ميزة خاصّة تتعلّق بهذه الموارد في القول بالقاعدية في الترجيح، ومن يتأمل هذه الموارد يجدها على قسمين:
- كتب التفسير:
ونَصَّ الكتابُ -كما أسلفنا- على أنه تتبَّعَ كتبَ التفسير فوجدها على ثلاثة أنحاء:
- كتب تَذْكُرُ قولًا واحدًا.
- كتب تَذْكُرُ الخلاف من غير ترجيح.
- وكتب تَذْكُرُ الخلاف وترجِّح وتذكُر مستندات هذا الترجيح، واختار من بينها (تفسير الطبري- تفسير ابن عطية- تفسير الشنقيطي)، وأخذ يقيّد كلّ وجه ترجيحي تَذْكُرُهُ هذه الكتب[29].
وقد ذكر أنه لم يُهمل كتبَ التفسير الأخرى، بل كان يقيّد ترجيحاتها، ويذكر قواعدَها، ويُدَوّن ذلك كلّه[30].
- كتب عامة:
وقد ذكر أنه قرأ مجموع الفتاوى لابن تيمية ليستخرج منه القواعد المتعلّقة بالتفسير وقواعده، وكذلك الكلام المجموع من نصوص ابن القيم المسمى بـ(التفسير القيّم).
فأمّا عن كتب التفسير بصورة عامة كمحلٍّ لتقرير القواعد، والادّعاء بكونها تُقَرِّر قواعد التفسير، وبالتالي كان العمل على جَمْعِ ما تُقَرِّرُهُ التفاسير، فهو أمرٌ مستغرَب جدًّا؛ لأنّ طبيعة الاشتغال في المدونة التفسيرية هو اشتغال تطبيقي، وكذا كتب التطبيق في أيّ فنٍّ ليست محلًّا لتقرير القواعد الكلية واستقرائها وتحرير قيودها وشروطها ومستثنياتها ونَحْتِ صِيَغِها...إلخ من غمار العمل التقعيدي. ومن المغالطة في أيّ فنٍّ أن تُجْعَلَ كتبُ التطبيق -التي هي ساحة لتطبيق القواعد المستكنّة في نَفْسِ المصنِّف- محلًّا لعمل تقعيدي يَخْرُج بها عن مقصدها أصلًا، إنه غير متصوَّر أصلًا كيف لمن يقصد إلى بيان معاني الآيات وفَكّ مشكلاتها، والنّظر في الآثار الواردة في التفسير والاختيار منها، ومحاولة إعمال القرائن والأدوات البيانية في سَبْكِ المعنى المراد وتحريره من خلال تركيب الأدوات؛ أنْ يَدَعَ هذا كلّه ويقصد إلى تركيب واستقراء القواعد الكلية الحاكمة لهذا الفنّ، فليس من مقاصد كُتُبِ التفسير تحريرُ القواعد ولا تركيبها ولا استقرائها، وإلّا لم تَعُدْ كتبًا للتفسير أصلًا!
إنّ ثمة فارقًا كبيرًا بين أن تكون كتبُ التفسير محلًّا لتقرير القواعد -وهو مما لا يُتَصَوّر أصلًا، والقول به غلطٌ ظاهرٌ- وبين القول بأنّ هذا لا يمنع من أنّ المفسِّر حال تفسيره مُستحضِر لكثيرٍ من القواعد والمباني الأصولية التي يؤسِّسُ عليها التفسير، وأنّ كلًّا منهم مستبطِنٌ لمنهج وقواعد تَهْدِيه وترشِدُه في تحرير المعنى المُرَاد، سواء ذَكَرَهَا أم لم يَذْكُرْهَا، لكنها حاضرة لديه.
وليس الأصل أنْ يَنُصّ المفسِّر على قواعده، بل تصوُّر ذلك خلافُ الواقعِ المشاهَد في كتب التفسير، وليس ذلك بمعيب عليهم، لكنهم يفسِّرون مطبِّـقين لهذه القواعدِ الماثلةِ في أذهانهم الساريةِ في تطبيقاتهم[31].
ثم إنّ هذا لا يمنع أن تَنُصَّ بعضُ التفاسير على بعض قواعدها، ولكنّ نَقْلَ هذا بوصفه قاعدة لا بُدّ أن يَحْصُلَ توافقٌ بين مفهومه للقاعدة ومفهوم الجامِع حتى لا يَقَعَ إِشْكال كما هو في كتاب الدكتور الحربي، فحتى مع قِلّة نَصِّ التفاسير على قواعدها قِلّة شديدة إلا أنه لا يَصِحّ منهجيًّا أَخْذ ما نَصَّت على قاعديته باعتباره قاعدة لدى أيِّ جامع للقواعد حتى يحصل التوارد على دلالة واحدة بين المصدَرَيْنِ.
إنّ كون التفاسير مدوّنات تطبيقية يجري فيها تطبيق القواعد المستكنّة في نَفْسِ المفسِّر ولا يَنُصُّ عليها؛ كان يجب مراعاته في استكشاف قواعدها مسلكٌ آخر تمامًا يقوم على التروّي فيما تُظَنُّ قاعديته، ومحاولة جمع نظائره واختبار مساحات تطبيقِه في المدوّنة التفسيرية، مع ملاحظة نَظَرِ المفسِّرين له كمعنى كلي يَسْرِي في جزئياته. وكلّها خطوات طويلة تخالِف فكرةَ جَمْعِ المتقرّر تمامًا، فهي خوضٌ موسّع في الجزئيات والنظائر وملاحظة التطبيق في الجزئيات، وتمييزها عن الكليات، ومعرفة كيفيات ارتباطها بها، كما يستلزم جمع الجزئيات المتناظرة ودراسة العِلّة الجامعة التي أدّت لتناظرها وتماثلها إلى غير ذلك، ومقارنة الإعمال والإهمال بين المفسرين... إلى آخر ذلك من الخطوات الواجبة قبل نِسْبَةِ أيّ معلومة إلى فَنّ كبيرٍ كالتفسير باعتبارها قاعدة كلية حاكمة على الفَنّ، فهو عمل معضل شَاقّ الإجراءات، وهو الأمر الذي لم نَرَه بتاتًا في طرح الدكتور الحربي؛ مما يؤكِّد على غياب فكرة التقعيد تمامًا عن الكتاب.
وأمّا عن كتب التفسير التي اختارها خاصّة: فإنّ المتأمّل لاختيار الدكتور الحربي للتفاسير التي يَعْمَلُ عليها يَجِدُ إشكالًا كبيرًا، وهو أن الدكتور اصطفى تفسير الطبري، وتفسير ابن عطية، وتفسير الشنقيطي، ونسب ما جَمَعَهُ من قواعد إليهم، وهو ما يعني أنّ هذه القواعد الترجيحية التي ذكرَها هي القواعد التي صَدَرَ عنها الطبري في الترجيح والتحرير وكذلك ابن عطية وكذلك الشنقيطي، ولا ندري كيف تكون قواعدهم متّحِدة بهذه الصورة من التطابق مع أنه لا يخالِف باحثٌ في أن مناهجهم متابينة تمامًا، ومقاصدهم متغايرة أيضًا، ومنطلقاتهم في التفسير متنوّعة؟! فكيف حصل هذا التوارُد في القواعد على هذا النحو الذي يُصَوّره الدكتور الحربي، كيف تكون قواعد ابن جرير الطبري الذي يقوم منهجه على اعتماد قولِ السلف دون مَنْ بعدهم هي ذاتها قواعد ابن عطية الذي قد يرجّح قولَ بعض المتكلّمين على قول السلف[32]؟! وكيف تكون قواعد كلّ منهما هي ذاتها قواعد الشيخ الشنقيطي الذي أكثر بَحْثِه في التفسير هو بحث أصولي فقهي؟! إنّ هذه التفاسير التي يقرّر الدكتور الحربي أن هذه النصوص قواعدها لم تتوارَد على مفهوم واحد للتفسير سعةً وضيقًا، بل الدكتور الحربي قد فَرَضَ عليها تعريفًا للتفسير لا تقول به ولا تَعْمَلُ من خلاله كما في مَدَاخِلِهِ النظرية، وهذه التفاسير لم تَعْمَل من خلال منطلقات واحدة؛ فَبَيْنَ كتابٍ يُعْنَى بالنقل والاختيار على مستوى المعنى، وتفسيرٍ أكثر توسّعًا منه من جهة المعنى، وثالثٍ لا يعتني بالمعنى بل يبحث بحثًا أصوليًّا أكثر منه تعلّقًا بالمعنى، فكيف يسوغ أنْ يُقَال إنّ هذه التفاسير المتباينة على مستوى حدود عملها، وعلى مستوى مركزية اشتغالها من حيث مقاصدها؛ قد تواردتْ على قواعد بعينها وبحدودها وبأعدادها كما يصوِّر الدكتور الحربي؟!
وفي مداخل عمل الدكتور الحربي على هذه التفاسير أغلاط كبيرة، منها:
أولًا: فَرْضُ الحدود والمفاهيم على الكتب لا استخراجها منها:
إنّ مَنْ يتأمّل صنيع الكاتب يجده قد دخل للكتب التفسيرية الثلاثة وقد اتّخذ مفاهيم مُسبقة ليست تعبّر عن واقع هذه الكتب نفسها، إنّ المؤلِّف قد أَقَرّ في مقدّماته النظرية أن مصطلح التفسير يكتنفُه اختلافٌ وتباين بين المشتغِلين بالتفسير، وبالتالي فإذا وقع العمل في كتب تفسير معيّنة كان لا بد أنْ يُؤْخَذَ مفهومها للتفسير إمّا بنصِّها، وإمّا باستنباطِ ذلك من تطبيقها؛ ولذا يبدو صنيعُ المؤلّفِ مشكلًا، إِذِ اعتمد تعريفَ أبي حيان للتفسير وجَعَلَه منظارًا يَلِجُ به إلى ساحة كتبٍ تختلف عن هذا المفهوم سعةً وضيقًا، باعتبار تبايُن التطبيق بين هذه الكتب وبين تفسير البحر المحيط لأبي حيان، إنّ غَيْبَة المؤلِّف عن محاولة استكناه رؤية هذه التفاسير للتفسير ذاته أمرٌ مستغرَب، وأكثر منه غَرابة أنْ يَلِجَ هو بتعريف للتفسير لا تقول به هذه التفاسير ولا تَنُصُّ عليه.
والأعجبُ من هذا أنْ يعتمد المؤلِّفُ مفهومَ أبي حيان للتفسير ثم يعلّل سببَ اختياره للطبري وابن عطية والشنقيطي دون غيرهم من التفاسير كمثل تفسير أبي حيّان؛ أنّ أبا حيّان ممّن يستطرِد في مباحث أجنبية عن التفسير كالمباحث النحْويّة، رغم أن المؤلّف ذاته قد ارتضى تعريف أبي حيّان ذاته للتفسير والذي يَنْعَى عليه استطراده وخروجه عن حيّز صُلْبِ التفسير[33]، فلا نكاد نتفهّم هذا التناقض العجيب بين أنْ يختار من بين التعاريف المتباينة تعريفَ أبي حيان ويرتضيه كحَدٍّ للتفسير ثم يعود المؤلِّف فيكرّ على ذلك بالبطلان ويستبعِد تفسيرَ أبي حيان بِحُجّة أنه يخرج عن صُلْب التفسير إلى استطرادات في النّحو وغيره[34]!
وهذا الإشكال في إطار عدم عناية المؤلّف بمحاولة استنباط رؤية هذه الكتب للمفاهيم التي يطرحها في كتابه؛ كمفهوم القاعدة، ومفهوم التفسير، ومفهوم الترجيح، ومفهوم القواعد الترجيحية، والعلاقة بين القاعدة الترجيحية والقاعدة التفسيرية، وفي ظلّ كون هذه الكتابات كتابات تطبيقية في الفنّ فإنها بلا شك ليست ملزَمة ببيان هذه المباحث النظرية، ولا هي قاصدة لذلك ونحوه، فكان لزامًا على المؤلّف والحال هذا أنْ يَسْلُكَ سبيلًا طويلة في محاولة استكناه هذا عَبْر تتبُّعٍ مطوَّل للجزئيات وتحليلٍ للنظائر ومحاولةِ الغوص في عَقْلِ صُنّاع هذه المدوّنات لاستخراج هذا من عقولهم وإبراز دلائل هذا وأدواته ومسالكه ومراحله؛ حتى يصلح منهجيًّا البحثُ التطبيقي في إطار المفاهيم التي يرتضيها أصحابُ هذه المدوّنات، أمّا أن يكون البحث بهذه المثابة من الدخول لساحة هذه الكتابات بتعريفات قَبْليّة ومحاولة إلصاقها بأيّ محتوى تطبيقي في هذه المدوّنات، فهو أمرٌ ظاهرُ الغلط يقضي بإعادة النّظر في كلّ ما كاثَرَنا به الكتاب من معلومات تُدَّعَى نسبتُها كقواعد لهذه المدوّنات التفسيرية.
ثانيًا: العمل الناقص على بعض الكتب التي جرى العملُ فيها:
قد نَصَّ المؤلِّفُ على أنه قد عمل على تفسير الطبري وتفسير الشنقيطي وتفسير ابن عطية لاستخراج القواعد، ومن الغريب أنه نَصَّ على أن عملَه على تفسير ابن عطية قد اقتصر على تسعة مجلّدات من تفسير ابن عطية ولم يستوعب الكتاب كاملًا، وهذا الموقف شديد الظهور في الدلالة على المنهجيّة الحقيقية للكتاب من أنه جَمْعُ نصوصٍ من مواضع من كتب التفسير، وليس عملًا استقرائيًّا استنباطيًّا تركيبيًّا من خلال تأمُّل صنيع المفسّر على طُول تفسيره، من خلال الاعتناء بالجزئيات ونظائرها على مستوى التفسير ولَحْظِ المعنى الكلي الساري فيها، ومحاولة رَصْدِ ما إذا كان ثمة جزئيات ونظائر لا يسرِي فيها هذا المعنى الكلي، ومحاولة إدراك الفارق بين هذه الجزئية وسائر الجزئيات، إنّ العملَ التقعيدي بهذا المفهوم للقاعدة الذي انطلق منه الدكتور الحربي قائمٌ بالأساس على المسح الشامل والاستقراء الموسّع لأكبر قَدْرٍ ممكن من الجزئيات ومقارنتها وإدراك فوارقها واتفاقاتها، وهذا العمل الشاقّ المضني أَوّلُ خطواته وأيسَرُها -في حقل تطبيقي كالتفسير- هو المسح الشامل الدَّقيق للتفسير حتى نُدرك المنهج الكلي التركيبي والمعاني الكلية المباشرة التي يُعْمِلُها المفسِّر على مستوى تفسيره، فعدم لَحْظِ هذا كلّه، والاكتفاء بعددٍ من الأجزاء من التفسير الذي يَستخرج منه المؤلّفُ القواعدَ يَدُلّ على أن هذا المنطلق الاستقرائي الاستنباطي لم يكن حاضرًا لدى الدكتور الحربي أصلًا، وهذا الصنيع يتواءَم تمامًا مع سائر مسالك الدكتور الحربي من أنّ العمل مرتكِز على نصوصٍ جاهزة واردة في أيّ سياق تُشَمّ منه رائحةُ القاعدية، فيجري اجتزاؤها أو إعادة صياغتها ونسبتها كقواعد لهذا المصدر وأنه قد حكم بقاعديتها في الترجيح... إلخ.
إنّه من التناقض الصارخ بين الانطلاق من مفهوم كلية القاعدة وبين العمل على جزءٍ من مصدر وتَرْك جزء آخر منه لم يَجْرِ النظرُ فيه، إِذْ كيف يمكن نسبة قاعدة بمفهومها الكلي التركيبي الاستقرائي لمصدر دون معرفة المنهج الكلي في جميع أجزاء الكتاب وجزئياته، وهو الأمر الذي يكرّس ويؤكّد فكرةَ ارتكاز الدكتور الحربي على جَمْعٍ ذَوْقي لبعض النصوص في بعض المصادر ونسبة هذه المعلومات إلى القواعد وإعادة القول بقاعديتها إلى المصادر وأصحابها.
وأمّا عن الكتب العامة التي عمل عليها وهي مجموع الفتاوى لابن تيمية -رحمه الله- وكتاب مجموع من كلام ابن القيم -رحمه الله- تحت مسمى (التفسير القيِّم)، ومن العجيب جدًّا أن يُقال: إنّ مثل هذه الكتابات قد تَسَنَّى لها عمل تقعيدي لقواعد التفسير؛ فكتاب كمجموع الفتاوى كما هو ظاهرٌ يَخْتَصّ بالفُتيا والتي يكون فيها الأمر في أصله جوابًا عن سؤالِ سائل، ويدخله عددٌ من العوامل؛ كمدخل الزمان والمكان والأحوال والأشخاص وعامل النفسية، وأكثر هذه الفتاوى إنما يكون في الفقه والأصول والحديث والعقائد، وإنما يأتي الحديث عن التفسير -غالبًا- عارضًا، وإنّ أَخْذ التفسير من سياق هذه الفتاوى أمرٌ مشكِل على التحقيق، فكيف تسنّى لمن يُجِيب عن سائِل في فقه أو عقيدة أن يتعرّض لآية ثم يستطرِد ليخوض غمارًا مطوّلًا لإثبات قاعديّة نَصٍّ أو كُليةِ حُكْم في التفسير، إنّنا لو فرضْنا أنّ هذه الفتاوى مجموعة فتاوى تفسيرية لَمَا تصوّرنا أنه يمكن حدوث عمل تقعيدي استقرائي تركيبي لإثبات قاعدية نصّ أو كلية حكم أثناء جواب يتعلّق بتفسير آية أو بيان معناها، فكيف يُتَصَوّر أن يجري استقراء أو تركيب أو غيره من ضرورات التقعيد في هذا الشأن أثناء فتوى فقهية أو عقدية؟!
إنّ مقام الفتيا عمومًا ليس مقام تدليل فضلًا عن أنْ يكون مقام تأصيل، وقد أكثر العلماء من بحث كون الفقيه ليس مضطرًّا لذِكْرِ دليل الحكم الفقهي الذي انبنى عليه الحكم والجواب؛ لما قد تَقَرّر عندهم من أنّ مقام الفتيا غير مقام البحث والتحرير، فمقام الفتاوى غايته ذِكْر المستخلصات والنتائج لضِيق المقام، وربما قيام عددٍ من الظروف غالبًا تَحُول دون صلاحية المقام للتحرير والتدليل، وكلام العلماء جارٍ في سياق التدليل لنفْس الحكم الذي سِيقت الفتاوى لأجله؛ كالتدليل لحُرمة كذا، أو التعليل لإباحة كذا، فكيف يُـتَصَوَّر بعد ذلك القولُ بقيام فتاوى -أكثرها فقهية أو عقائدية- بالتأصيل والتدليل عبر الاستقراء لكليّة عددٍ من القواعد في الترجيح بين أقوال المفسرين؛ فهذا أمرٌ ظاهرُ الغلط.
إنّنا وإنْ راعينا خصوصية شيخ الإسلام في التوسّع في مقام الفتيا، والتفضّل بذِكْر أدلّته في بناء الأحكام، وربما الاستطراد للتعرّض لأقوال المخالِفين والجواب عن أدلّتهم وإيراداتهم؛ إلّا أنّ هذه الخصوصية لا يمكن أن تسوِّغ القول بأنّ فتاواه المتناثِرة في أبواب الفقه والأصول والعقائد، والتي ربما لها تعلّق بالتفسير وأصوله؛ قد خَطَتْ إلى عمل استقرائي موسّع في بناء قواعد فنٍّ خَلَتْ ساحتُه من العمل التنظيري لقواعده، وكيف يَسُوغ هذا القول مع أنّ لابن تيمية نفسه كتابات مفردة في هذا الشأن قد خَلَتْ تمامًا عن الخطو إلى استقراء أو تتبّع أو عمل قواعدي بالمفهوم الذي يرتضيه الدكتور الحربي للقاعدة بأنها حكم كلي أو أغلبي، فكيف يُنْتَزَعُ ما لو صَحّ أن يكون قاعدة عند ابن تيمية ويُدْرَج تحت مفهوم الدكتور الحربي لقواعد الترجيح مع التباين في مفهوم القاعدة بين شيخ الإسلام وبين الدكتور حسين الحربي في كتابه؟!
ومثل هذا يقال في غلط القول بتقرّر القواعد في الكتاب المسمى بـ(التفسير القيِّم)؛ إِذْ كيف يَصِحّ أنْ يُدّعَى تقرّر قواعد كلية استقرائية في كلام مجموع من سياقات مختلفة فيها تعرُّض لبعض الآيات، فمِثْل هذا أيضًا لا يمكن القول فيه إنه قد عمد إلى عمل استقرائي تركيبي لقواعد ترجيحية بين أقوال المفسّرين.
وعليه فإنّنا لا يمكننا متابعة الدكتور الحربي على قولِه بتقرّر قواعد في هذه الموارد التي عَمِلَ عليها في جَمْعِ القواعد الترجيحية وترتيبها، ولم يقع في هذه الموارد أيّ اشتغال تقعيدي، بل العمل التقعيدي خارجٌ عن مقاصدها أصلًا سواء كتب التفسير التي ذَكَرَها، أو الكتب العامة التي ذَكَرَها أيضًا، على أنّنا في ختام هذا المقام نتساءَل عن عدم حضور جميع الموارد التي ذَكَرَ الدكتور الحربي أنها مصادر استمداد قواعد الترجيح، فلم يبيّن لنا الدكتور سبب عزوفه عن جلب هذه المصادر وإِطْلَاعِنَا على ما بها من قواعد متقرّرة، ولعلّنا نحاول أن نستكشف ذلك لاحقًا إن شاء الله. ولم يَبْقَ لنا في مسايرة الكتاب إلا أن نَلِجَ معه ساحةَ النصوص التي جَلَبَهَا على أنها قواعد حاكمة على أقوال المفسّرين بحيث تصلح أن تكون حاكمة على أقوالهم.
وبذلك نكون قد أَنْهَيْنَا تقويمنا لمنهجيّة الحربي التي قام عليها كتابُه في العمل في قواعد الترجيح.
ويلاحَظ أنّ هذا المنطلق المشكِل قد أثّر سلبًا على الكتاب؛ حيث أفضى إلى ما يأتي:
الأثر الأول: اجترار قواعد الفنون الأخرى ونقْلها كما هي إلى ساحة التفسير:
قد مرّ معنا صنيعُ المؤلِّف في الحديث عن قواعد النَّسْخ مثلًا، أو قواعد المجاز والاشتراك...إلخ، وكلّ هذه المباحث قد جرى بحثُها في عددٍ من العلوم من حيثيات مختلفة ومتباينة، ولاحظْنا أنّ المؤلّف يَجْتَرّ هذه الحمولات المعرفية بكاملها إلى حقل التفسير دون أن يعالجها من حيثية علم التفسير، وهذا أمرٌ مشكِل من وجهين:
أولهما: أنّ العلوم تتمايز بحيثيات وغايات تقوم عليها مسائلها وتتعيّن بها موضوعاتها، فتنبع قواعدُها وتنبت أصولُها في ظلّ هذه الغايات وتلك الحيثيات، وليس من الميسور أبدًا نسبة قواعد فنّ لآخر إلّا بعد إجراءات منهجيّة مطوّلة وتغييرات ربما جوهرية في نسق القواعد، وإلّا فقبول أحد الفنون لقواعد غيره هكذا يدلّ أنه ليس فنًّا أصلًا اللهم إلّا على التجوُّز والمسامحة؛ ولهذا كان استحضارُ المؤلّف لهذه القواعد واعتبارها قواعد ترجيحية للتفسير بلا أيّ إجراءات منهجية أمرًا ظاهرَ الإشكال[35].
ثانيهما: أنّ هذا الصنيع يكرّس بالأساس للقول بعدم عِلْمِيّة التفسير؛ فما دامت الساحة القواعدية للتفسير هي ناتج تزاحُم قواعد الفنون الأخرى وتجمُّعها، فإن إطلاق لقب العلمية على التفسير حينئذ يُعَدُّ أمرًا غير سائغ، اللهم إلّا على وجه التسامح والتساهل، وإلّا فعلميّة العِلْم تُكتسَب أوّل ما تُكتسب من اكتناز الفنّ لقواعد تَخُصّه وتُمَيّزه دون غيره من سائرِ الفنون، وهذه القواعد يُشترط لها أن تكون قد اكتسبتْ وجودَها في ضوء حيثية هذا العِلْم ومنطلقاته وغاياته، بحيث يجري تركيبُها وتقنينُها في ضوء الحيثية الخاصّة بالفنّ لتسهم في تحقيق أهدافه وغاياته، وأمّا صنيع المؤلّف فإنه يُبْقِي التفسيرَ بلا حيثية أصلًا، فإنّ ما اجترّه من قواعد ترجيحية هي في غالبها نصوص يجري استعمالُها في مباحث الأصول واللغة ونحوها، فاجترار هذه الكُثْبان من النّصوص إلى ساحة التفسير باعتبارها قواعد ترجيحية في التفسير يُعَدُّ أمرًا ظاهر الغلط.
الأثر الثاني: محاكَمة النّتاج التفسيري إلى أطروحة ابن تيمية واختياراته:
إنّ من الآثار التي نجمتْ عن هذه المعالجة المختلّة للقضية أنْ صار المؤلّف يُحَاكِمُ سائرَ النتاج التفسيري إلى أطروحة ابن تيمية -رحمه الله- كما مَرّ معنا في قاعدة «الأخذ بالظواهر»، ومن عجبٍ أن يُحَاكم سائرَ النتاج التفسيري الهائل إلى أُطروحة ابن تيمية مع ما فيها من تنظير حائدٍ تمامًا عن الواقع التطبيقي للتفسير، ومع ما يعتريها أيضًا من إشكالات في التنظير للتفسير عمومًا، فإنها تخلق وضعيّة شديدة الإشكال؛ كونها تَدْفَعُ نحو تحييد النتاج التفسيري وأهمية استقراء قواعده للوصول من مشتركات هذه القواعد إلى قواعد التفسير الحاكمة للعملية التفسيرية، والتقعيد للتفسير بصورة تجريدية بمَعْزل عن تطبيقات المفسّرين واستقرائها، الأمر الذي لا يُعِين على استكشاف قواعد التفسير بصورة صحيحة بل ويَصُدُّ عن ذلك أصلًا، وكذلك يُفْضِي لمحاكمة النتاج التفسيري عند دَرْسِه لهذه التأصيلات المفترَضة تجريديًّا باعتبارها قواعد مقرّرة للتفسير، وهو ظاهر الإشكال على صُعُد[36].
الأثر الثالث: إيهام القارئ بقوّة البناء النظري للتفسير:
إنّ من الآثار التي تنجم لا مَحالة عن مثل هذا الطّرح -بادي الرأي- أن ينبهر الناظرُ في مثل هذه الثروة الهائلة التي نَسَبَهَا المؤلّفُ كقواعد ترجيحية لدى المفسِّرين، بما يعني أنه قد حصل تقرّر وتركيب لمثل هذه القواعد كقواعد صارمة وكقانون ضابط وموحَّد لدى المفسّرين؛ وهو الأمر الذي نقطع بعدم حصوله لما سبق من دلائل قاطعة، وكما أثبتَتْه بعض الدراسات، فيبقى القارئ أمام هذه الثّروة القواعدية المنسوبة للمفسّرين كأنّ البناء النظري والقواعدي للتفسير بهذه الثروة وبهذا التوافر، وقد وَصَلَ بين المفسِّرين إلى هذا النضج الذي صار بمثابة قانون شامل حاكم جرى استقراؤه وتركيبه وصوغه ونحْته من قِبَل المفسرين، وهو الأمر الذي يصادمُ واقعَ هذا العلم تمام المصادمة، كما أنه تترتّب على هذا التصوّر المشكِل آثار عديدة أخرى؛ كأنْ يشيع الحديث في الأوساط العلميّة عن علم التفسير وقواعده بموجب هذه المضامين التي ذَكَرَهَا المؤلِّف والتي سلف معنا نقضُها والتشكيكُ فيها من حيث كونها قواعد ترجيحية كلية استقرائية لدى المفسّرين، وآثار أخرى تتفاقم في ظِلّ هذا الوضع المشكِل الذي يكرّس له واقعُ الكتاب بهذه الصورة.
الأثر الرابع: الحيلولة دون قيام حركة تقعيدية جادّة لقواعد التفسير والترجيح في علم التفسير:
إنّ الشّلل والتكلُّس الذي تُحْدِثُه المسارات المشكِلة في واقع العلوم أكبر خطرًا وأفدح أثرًا مما يحدث للعلوم حال تَوقُّف عَجَلة العلم على ما هو عليه من مسارات صحيحة منضبطة في إطار حيثية العلم وأهدافه...إلخ، فمع أنّ تَوقُّف الإنتاج والإثمار في ميادين العلوم عن طريق تكرار المعرفة وإعادة استحضارها على ما هي عليه =أمرٌ مؤذِن بهرم المعرفة وذُبولها، إلّا أنّ إحداث مسارات غالطة من حيث منطلقاتها وإجراءاتها المنهجية أمرٌ مُؤْذِنٌ بانسداد آفاق المعرفة ذاتها، وربما المُضِيّ بها في طريق مجهولة قد تؤدّي إلى تحوّر العلم وتغيّر ملامحه إلى مَسْخٍ آخر تمامًا، وتَحُول ربما دون الرجوع بالعلم إلى ما كان عليه قبل تشقّق هذه المسارات المشكِلة. وبالجملة فإنّ المراد هنا هو أنّ هذا الكمّ الهائل من القواعد التي جرى استحضارُها وتقييدُها تحت مسمى قواعد ترجيحية كلية عند المفسرين =حالتْ دون الشعور بضرورة القيام الجادّ باستنباط واستخراج قواعد المفسّرين عبر الاستقراء والتتبّع المعمّق لتطبيقاتهم؛ لأن الناظر لهذا البناء القائم في الكتاب سيخالطه وَهْمٌ -بادي الرأي- أنه ما دامت توفّرتْ لنا قواعد كلية استقرائية جرى تركيبها من قِبَلِ المفسّرين وقد حصل لنا جمعُها بهذه الغزارة والوفْرة فما الحاجة إذن من البحث المطوّل والمعمّق مرّة أخرى للقول الصحيح في قواعد الترجيح والتفسير؟! إنه ما لم يتوفّر القارئ على هذه الإشكالات التي رصدْناها فإنه سيظلّ حبيسَ الشعور الواهم بأنّ هذا الكتاب قد كفانَا مُؤْنَة القول في قواعد الترجيح والتفسير، في حين أن المؤلِّف لم يلجْ قواعد الترجيح التي يُمْكِن أن يُقال عنها إنها قواعد ترجيح، وإلّا فعملُ المؤلّف عملٌ صوري في غالبه، شكْلي في أكثر مناحيه، وإلّا فهو غير مجدٍ وغير تام على المستوى التطبيقي في علم التفسير، وإذا كان العلماء عبر الزمن -كما سبق- يتنادون بحاجة علم التفسير إلى قواعد وقوانين تَضْبِطُ مسلكَ التعامل معه، ويصرِّحون بقِلّة الجهود في ذلك الجانب، فقد كان المنتَظَر أن يكون الكتابُ أكثرَ إسهامًا في إفادة ساحة التفسير تطبيقيًّا ونظريًّا على صُعد عديدة، إلا أنه بهذه الصورة قد بقي إشكال علم التفسير به كما كان من دونه، وبقيتْ مباحثه الكبيرة وقضاياه الرئيسة المختصّة به خالية من القواعد أو قليلة القواعد.
وقد تعرّض المؤلِّفُ لبعض هذه المساحات، إلا أنه كان غافلًا تمامًا عن إشكالات كثيرة في هذه التقريرات التي يقرّرها، لا سيما في قضية تفسير القرآن بالقرآن وما تتضمنه من أنواع ومراتب مختلفة؛ ككون هذا المصدر دالًّا على المعنى المفسَّر بصورة قطعية لا تَقْبَل الاحتمال، أو كون دلالته محتملة، ومن حيث كون المعنى المقابل له مناقضًا له أو غير مناقض، وإمكانية حمل الآية على المعنيين جميعًا من عدمه، ومن حيث ورود الآية القرآنية على سبيل التفسير للمعنى أو على سبيل الاستشهاد للمعنى والاستدلال عليه، ومن حيث ورود عدّة معانٍ يستند كلٌّ منها إلى آية قرآنية وكيفيات التوفيق أو الترجيح بينها، وهذه الإشكالات ونحوها لم يأتِ فيها المؤلِّف بما يمكن أن تطمئنّ إليه النفس، ولم يجلب لنا جوابات مستنبطة أو منصوصًا عليها عند المفسّرين مع أن ظاهرَ عَمَلِه قائمٌ على استقراء كتب التفسير.
وكذلك في الحديث عن تفسير القرآن بالسنّة وكيفيات التعامل مع ذلك المصدر، وتحديد أنواع دلالته على المعنى التفسيري، ودرجة كلّ دلالة من تلك الأنواع على المعنى، وكيفية الترجيح بين المعاني المتعدّدة التي يستند كلٌّ منها إلى حديث نبوي، وآليات توظيف المفسّرين الأحاديثَ وكيفية فهمها، والقواعد التي يَحْصُل التمييز بها بين انطباق دلالات الأحاديث على معنى الآية أو عدم انطباقها، وتفسير الصحابة والتابعين وأتباعهم، ومتى يُقَدَّم قول بعضهم على بعض، وهل لتقدّم الطبقة دورٌ في تقديم أقوال بعضهم على بعض، أم أن مردّ الأمر لشيء آخر، وكيفية فهم اختلاف المفسّرين والتعامل معه... إلى آخر هذه القضايا التي تمسّ الواقع العملي لترجيح قولٍ على قول في التفسير[37].
لذا فقد بقي هذا الكتاب قائمًا قيامًا صوريًّا في سَدّ ثغرة التأصيل والتحرير لِمَا سمّاه قواعد الترجيح عند المفسّرين باعتباره بناءً نظريًّا للتفسير، وفي حقيقة الأمر أنه لم يسلك مسلك التأصيل على الحقيقة، وأننا بحاجة إلى استئناف القول من جديد على غير هذه الأُسس ومن غير هذه المنطلقات التي صَدَرَ عنها الكتابُ، وبغير هذه المسالك التي ارتضاها الكتابُ، حتى تحصل ممارسة جادّة ومنضبطة في هذا الصدد، وإلّا فلا يمكن أن يكون العمل بهذه الصورة بناءً نظريًّا منسوبًا للتفسير والمفسّرين.
الأثر الخامس: التدليس في نِسبة القواعد لكتب التفسير:
إنّ عملَ المؤلّف في كتابه لهو عمل مقارب بصورة كبيرة لِمَا اعتمدتْه المؤلفاتُ المعاصرة التي شاركتْ في الكتابة في قواعد التفسير، على مستوى المنطلَقات وبعض الأمور الأخرى، ومن هذه المشتركات نسبة ما يجتلبونه من نصوص باعتبارها قواعد للمصادر التي يعملون عليها، وهذا أدّى إلى وقوع الكِتاب وغيره في التّدليس على المصادر؛ وليس بالضرورة أن يكون المؤلّف قد تعمّد ذلك، وإنما هو مآل انطلاقه من تَقَرّر القواعد ونسبة تقريرها وكليّتها واستقرائها لمصادر لم تَزْعُم تقرير القواعد، ولم تَدَّعِ إعمالها للاستقراء، ولا وَصَفَتْ تلك النصوص المنتَزَعة منها بوصف القاعدية، وقد كان ذلك كلّه أثرًا من آثار الانطلاق من منطلقات متوهّمة أو غير منضبطة.
والناظر في كافة ما أَوْرَدَهُ المؤلِّف من نصوص ونِسبة قاعديته للمصادر لا يملك في ضوء غياب مسوّغات تلك النِّسبة إلّا نقض نسبة قاعدية تلك النصوص للمصادر، أمّا النصوص من حيث هي نصوص فموجودة في المصادر، لكن المنتقَض نسبة القاعدية للمصادر؛ ذلك أنّ المصادر التي اشتغل المؤلِّف بجمع قواعدها -كما سبق بيانه- لم يكن لها قَصْدٌ ظاهر ولا خفيّ لتقرير القواعد وبنائها، ولم تَدّعِ أنها استَقْرَتْ ما نُسِب إليها من قواعد، ولا تتبعتْه بالمعنى الذي في الكتاب، كما أنّ إثبات هذا مما لم يَنْهَضْ له المؤلّفُ ولا أوضحه، بل لم يكن له حيال الأمر برمّته منهجية واضحة ومنصوص عليها؛ ومن ثَمّ فمَنْ يُطالع الكتابَ ثم يُطالع مصادِرَه التي عمل عليها ليتبيّن حقيقة ما إذا كانت هذه المصادر قد قَرّرتِ القواعد فعلًا، وكيف كان هذا منها، وبأيّ شكلٍ وعلى أيّ صورة؛ فلن يَجِدَ في الواقع شيئًا يُعَوِّل عليه، ولن يكون أمامه حينئذ إلّا أن يقرّ بأن القول بالقاعدية جرى من قِبَلِ المؤلّف لا من قِبَلِ المفسّرين[38].
وبهذا نكتفي من القول في أبرز الآثار والانعكاسات السلبية التي نجمتْ عن هذا المسلك في التقعيد أو القول في القواعد الترجيحية.
خاتمة:
ظَهَرَ معنا أنّ الكتاب قد صَدَرَ في التقعيد لقواعده عن القول بتقرّر قواعد الترجيح عند السابِقين، وَمَرّ معنا أنّ هذه الانطلاقة مصادِمة لواقع علم التفسير وتاريخه وتقريرات علمائِه، وظَهَرَ معنا أنّ ما يمكن أن يُستلمَح من واقع الكتاب كمنطلقات أخرى للقول بالقاعدية؛ لا يمكن أيضًا التسليم بها ولا اعتبارها منطلقات صحيحة في هذا الصّدد، مما يجعلنا لا نُقِرّ بأيٍّ من هذه الثّروة القواعدية التي طَرَحَها المؤلِّفُ في ساحة التفسير، وعلى أنّ هذا النقد يأتي على بُنيان الكتاب من القواعد، ويجعل ما أتى به بلا قيمة منهجية، إلا أنّ الكتاب ما زال بحاجة إلى إشباع القول في إشكالات أخرى فيه على صُعُدٍ عديدة، وهو ما سأعرض له في مقالة قادمة.
[1] تعرّضت دراسةُ (التأليف المعاصر في قواعد التفسير؛ دراسة نقديّة لمنهجية الحكم بالقاعدية، نَشْر مركز تفسير) لهذا الكتاب الذي نحن بصدد تقويمه، وذكرتْ أنه ينطلق في القول بالقاعدية من فكرة تقرّر القواعد، ونقلتْ جانبًا من نصوصه، إلّا أنها لم تتوسّع في إثبات ذلك، وهو ما سنحاول القيام بطرح دلائله مفصّلة من واقع الكتاب.
[2] قواعد الترجيح عند المفسرين؛ دراسة نظرية تطبيقية، حسين الحربي، دار القاسم، ط: الاولى، 1417ه-1996م، (1/ 39).
[3] قواعد الترجيح عند المفسرين، (1/ 12-13).
[4] قواعد الترجيح عند المفسرين، (1/ 13).
[5] قواعد الترجيح عند المفسرين، (1/ 14).
[6] قواعد الترجيح عند المفسرين، (1/ 11).
[7] قواعد الترجيح عند المفسرين، (1/ 13).
[8] قواعد الترجيح عند المفسرين، (1/ 15).
[9] قواعد الترجيح عند المفسرين، (1/ 16).
[10] قواعد الترجيح عند المفسرين، (1/ 16).
[11] قواعد الترجيح عند المفسرين، (1/ 60).
[12] قواعد الترجيح عند المفسرين، (1/ 94).
[13] قواعد الترجيح عند المفسرين، (1/ 105).
[14] قواعد الترجيح عند المفسرين، (1/ 14).
[15] قواعد الترجيح عند المفسرين، (1/ 11).
[16] ينظر: التأليف المعاصر في قواعد التفسير؛ دراسة نقدية لمنهجية الحكم بالقاعدية، ص87.
[17] مخطوط بعنوان: (الروض الأزهر في حدود مشاهير علوم الجامع الأزهر)، ص32 من المخطوط، وقد أفادني بهذا المخطوط الدكتور الفاضل/ أحمد فتحي البشير.
[18] بقوله: «وليس لعِلْمِ التفسير قواعد يتفرّع عليها الجزئيات، إلا في مواضع نادرة» كَشْف الظنون عن أسامي الكتب والفنون (1/ 427).
[19] انظر: التفسير والمفسرون (1/ 58).
[20] المنثور، للزركشي (1/ 72).
[21] ومما ينبغي أن يُلْحَظَ أنّ الكافيجي كان متّسقًا مع تقريره هذا تمامًا؛ فمع رؤيته أنّ هذا الحقل لم يُسْبَق لطَرْقِه وتعبِيده، فقام هو بمحاولة التأصيل لقاعدَتَيْنِ ارتأى هو أنهما تمثّلان قاعدتَيْن كليّتَيْن في التفسير، فخاض غِمَار محاولة التأسيس لكونهما قاعدَتَيْنِ عَبْرَ خطوات ومحدّدات يَلْحَظُهَا مَنْ طَالَع كتابَه (التيسير في أصول علم التفسير).
[22] الإتقان في علوم القرآن (1/ 4).
[23] التأليف المعاصر في قواعد التفسير، ص88.
[24] التأليف المعاصر في قواعد التفسير، ص90.
[25] أصول التفسير؛ محاولة في البناء، ص25.
[26] أبجديات البحث في العلوم الشرعية، دار السلام، ط:2، 1431هـ- 2010م، ص195- 196.
[27] التأليف المعاصر في قواعد التفسير، ص110.
[28] قواعد الترجيح (1/ 75).
[29] قواعد الترجيح عند المفسرين، (1/ 13).
[30] قواعد الترجيح عند المفسرين، (1/ 13).
[31] انظر: رسالة في الطريق إلى ثقافتنا، ص20، والتأليف المعاصر في قواعد التفسير، ص129.
[32] انظر: مقدمة أصول التفسير، لابن تيمية، ص35.
[33] ومما ينبغي أن يُشار إليه أن المؤلّف استبعد باقي التفاسير سوى تفسير الشنقيطي وابن عطية بحُجّة أنّ هذه الكتابات تستطرد وتخرج عن حَدّ التفسير، وهو الأمر ذاته الذي يمكن أن يوجّه نقدًا إلى المؤلّف بأن يُقال: ولماذا لا يكون صنيع الشنقيطي في تفسيره هو عين الاستطراد الذي تنتقده على التفاسير التي استبعدْتَ من إطار العمل، وقد صرّح الدكتور مساعد الطيار بأن تفسير الشنقيطي (أضواء البيان) هو حالة من الاعتناء بالبحث الأصولي وما يتعلّق به في النصّ القرآني. فما الذي يجعل رأي الدكتور الحربي مقدّمًا على رأي الدكتور الطيار، لا سيما وأن الدكتور الطيار يضع حدًّا واضحًا يحاكِم إليه التفاسير وهو اعتبار بيان المعنى، وجملة القول أن الدكتور الحربي لم يتنبّه إلى الآثار المترتبة على الاختلاف الدلالي الحاصل في مفهوم التفسير؛ مما جعل اختياراته عمليةً انتقائية ذوقيّة بحتة لا تستند إلى معايير ولا إلى محدّدات واضحة غير مضطربة.
[34] انظر: قواعد الترجيح، (1/ 12).
[35] انظر: التأليف المعاصر في قواعد التفسير؛ دراسة نقدية لمنهجية الحكم بالقاعدية، ص98.
[36] انظر: مقاربة في تحرير منطلق العمل في قواعد التفسير، خليل محمود اليماني، تحت هذا الرابط: tafsir.net/article/5336.
[37] انظر: التأليف المعاصر في قواعد التفسير؛ دراسة نقدية لمنهجية الحكم بالقاعدية، ص99.
[38] انظر: التأليف المعاصر في قواعد التفسير؛ دراسة نقدية لمنهجية الحكم بالقاعدية، ص99.
كلمات مفتاحية
الكاتب:

محمد يحيى جادو
باحث في التفسير وعلوم القرآن، وله عدد من المشاركات العلمية.
مواضيع ذات صلة
((المعلومات والآراء المقدَّمة هي للكتّاب، ولا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع أو أسرة مركز تفسير))