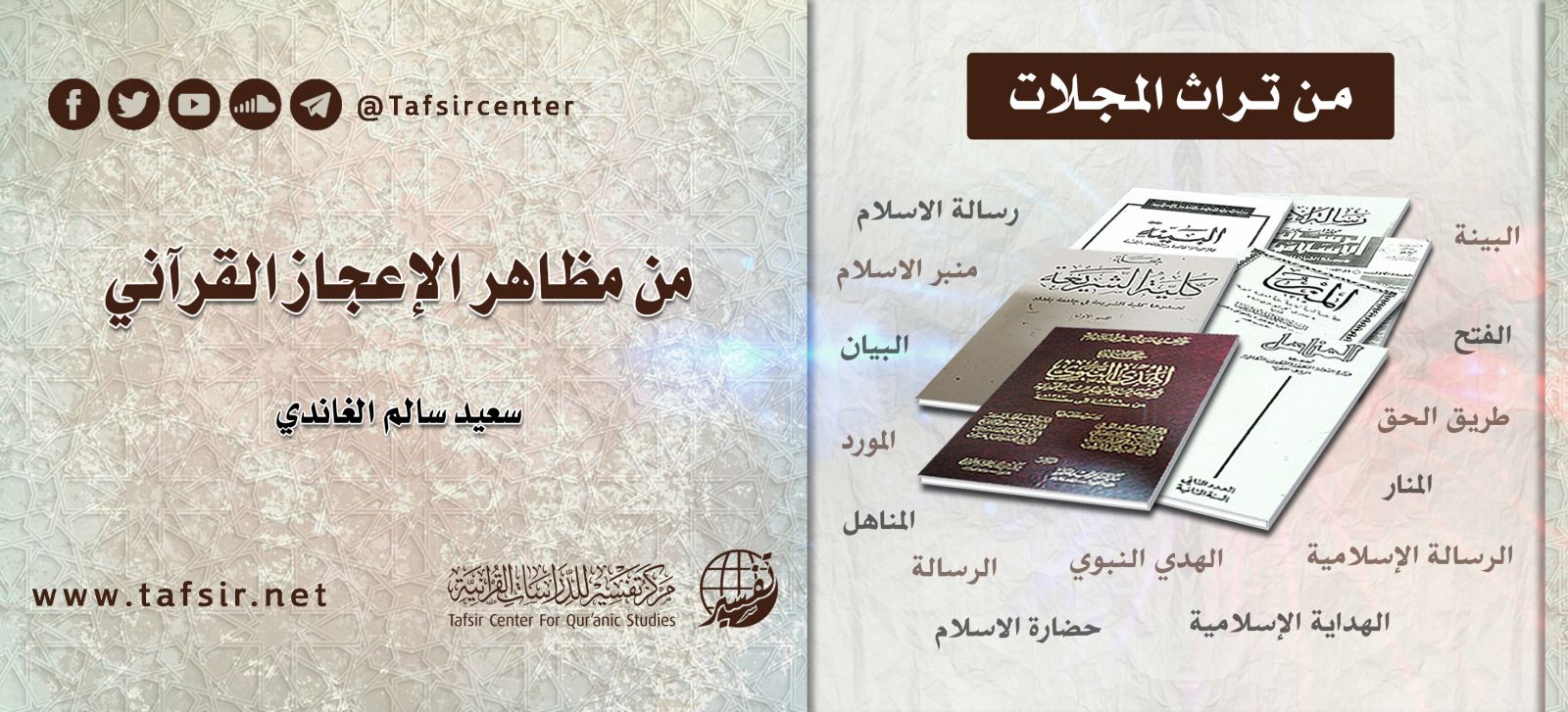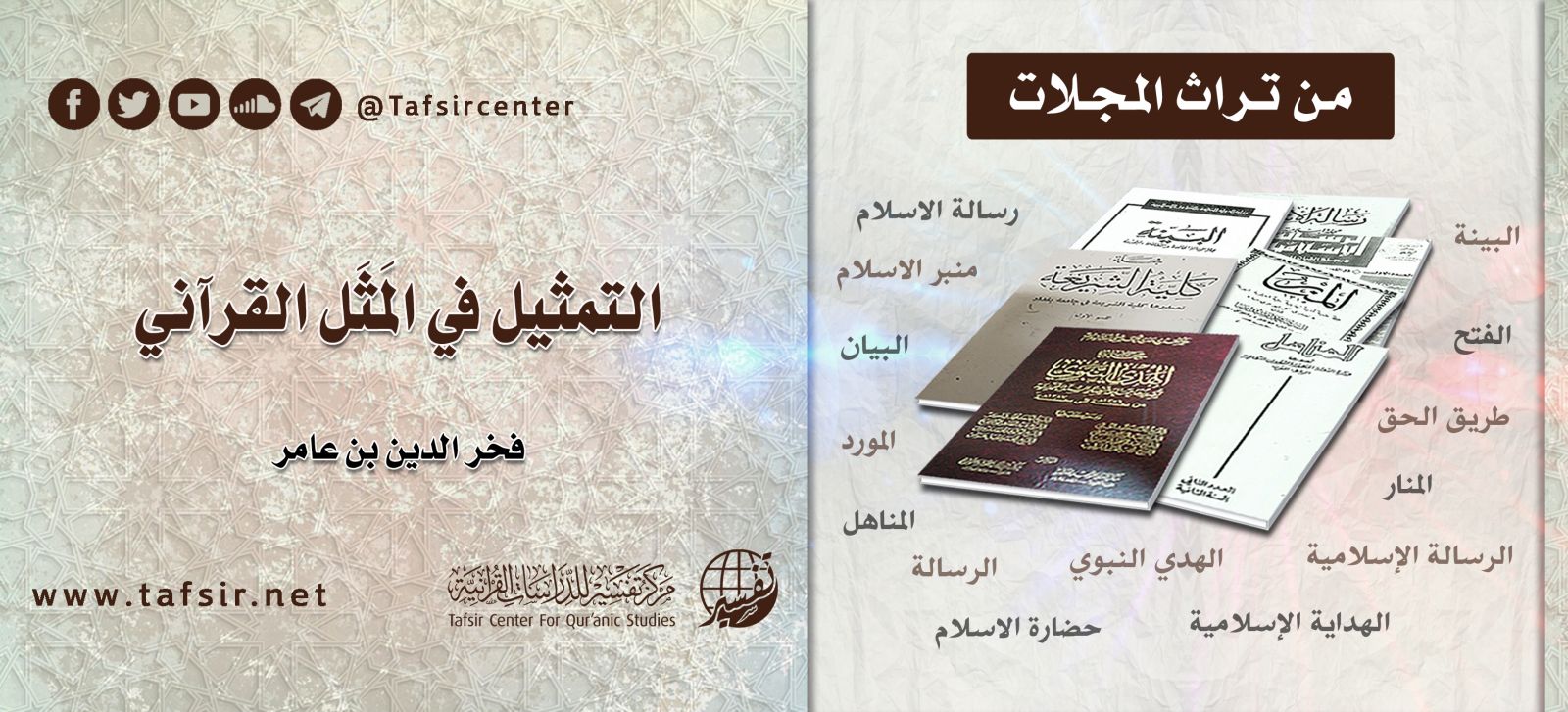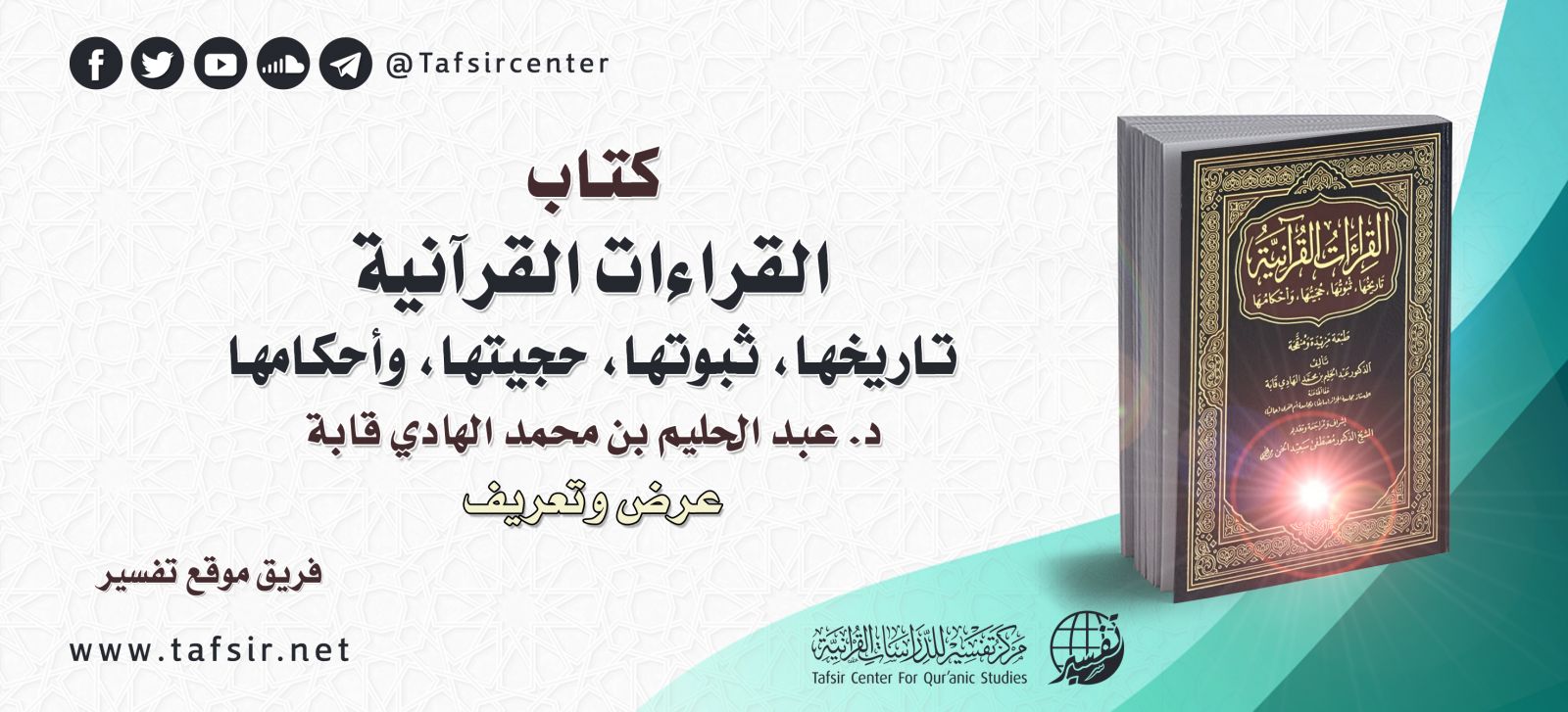دَوْر المصطلح في فهم النصّ القرآني
دَوْر المصطلح في فهم النصّ القرآني
الكاتب: الطيب شطاب

مقدمة:
لم تَعُد قيمة (المصطلح) مجالًا للشكّ والمحاججة بين الكاتبِين والدارِسِين، بل أصبح يمثّل في نظرهم أعلام القصد بالخطاب، وهوادي التداول المعرفي والفكري بين البشرية أجمعين. وليس من العجب أن يكون بين أفراد الأمة اليوم من يتّخذ المصطلح وسيلته المُثْلَى في بثّ قناعاته الفكرية والسياسية والدينية، ويستثمر حمولته الدلالية في التلاعب بالخطاب بما يحقّق مصالحه. وإذا صحّ أن التسامحَ في استعمال المصطلح مطلوبٌ بين المستعمِلين له، فإنّ المصطلح الشرعي -ولا سيّما القرآني- له من الخصوصية ما يُلْزِم بالانضباط المنهجي في تأويله، وتمثُّل مبادئه؛ لِمَا لمصدره من سمات ربّانية ترقَى عن الخطاب البشري، بعضها راجع إلى مقام المتكلِّم به، وبعضها راجع إلى بنياته الداخلية.
ومن هنا كان لا بد من إثارةِ قيمة المصطلح، وتبيُّنِ مكانته داخل النصّ القرآني، وبعض الآليات المنهجية في تبصُّر دلالته، وتلك هي الغاية من هذه السطور، مرسومة قضاياها في خمس مسائل:
1. مركزية النصّ القرآني في الخطاب الإسلامي:
يُعَدّ النصّ القرآني في الخطاب الإسلامي القاعدة الأساس في صحة المواقف والمعتقدات، ومدى سلامتها أو بطلان حجتها، والسؤالُ دائمًا ما يقع عليه؛ وجودًا ودلالة، وإليه يُوكَل النظر فيها؛ فهمًا واعتبارًا، حتى عُدّ واحدًا من أُسس بناء الحضارة؛ إِذْ لا أُمّة ذات حضارة بلا نصّ يقوم عليه كيانها، ويُحفظ به ميراثها. وجُلُّ ما يثار من تساؤلات دينية وما يجري بين الناس من حوارات إسلامية، منشؤها تساؤلٌ عن النصّ من حيث وجوده وحمولته المعرفية والفكرية. حتى وإنْ بَدَا في الظاهر إمكانية الوقوف عليه بيسرٍ لكون آياته محصورة العدد، فإنّ ما تكتنزه ألفاظه من معانٍ ووجوهٍ من التأويل، لا يقع تحت الحصر، وقد تظهر لبعضٍ وتخفى على آخرين.
والمعنيّ بالنصّ القرآني في هذا المساق: خطابه المضمّن في ألفاظه[1]، بعموم دلالاته وأحواله، الذي له من الصلاحية الربانية والتجرّد والإطلاق والعالمية ما يدرأ عنه التحيز ويضفي عليه كامل الموضوعية. وهي سمات لا تُرى إلا فيه وفيما صح من السُّنّة النبوية التابعة له؛ بيانًا وتفصيلًا، وهما أصلان لبقية أصول الشريعة، ومُستمَدُّ كلياتها وقواعدها المعتبرة. وقد ألمع الإمامُ الشاطبي إلى أصالة القرآن الكريم ومكانته في الشريعة الإسلامية في نصٍّ جامعٍ يستحقّ استكناه إشاراته، يقول -رحمه الله-: «إنّ الكتاب قد تقرّر أنه كلية الشريعة، وعمدة الملّة، وينبوع الحكمة، وآية الرسالة، ونور الأبصار والبصائر، وأنه لا طريق إلى الله سواه، ولا نجاة بغيره، ولا تمسُّك بشيء يخالفه، وهذا كلّه لا يحتاج إلى تقرير واستدلال عليه؛ لأنه معلوم من دين الأمة، وإذا كان كذلك؛ لزم ضرورة لمَن رام الاطلاع على كليات الشريعة وطمع في إدراك مقاصدها واللحاق بأهلها، أن يتخذه سَمِيرَه وأنيسَه، وأن يجعله جليسَه على مَرّ الأيام والليالي؛ نظرًا وعملًا، لا اقتصارًا على أحدهما؛ فيوشك أن يفوز بالبُغْيَة، وأن يظفر بالطِّلْبَة، ويجد نفسه من السابقين في الرعيل الأول»[2]، فبَانَ بهذا أنّ الخطابَ الإسلامي المسدَّد بنور هذا القرآن -لا شك- منتظمٌ على نهجٍ لاحِبٍ في الرؤية والعمل؛ إِذْ لا نَصّ في الوجود له من هذه الصفات ما يجعله على وزانه في الفهم والاستنباط، عَدَا بيانه المتمثل في السُّنّة النبويّة في بعض التجليات.
وإذا كانت مثاراتُ الغلط ومَنازعُ الجدال في البيئة الإسلامية لا تكمن في رفض أو قبول هذا النصّ، بل عمق رؤاها في مناحيه الفهميّة، أو ما ترمز إليه دلالته؛ باعتباره رسالة تستوجب الكشف عن مراد المتكلم به، فإنّ اللازم على مَن رام الغوص في أعماق هذا الخطاب، أو حُبِّب إليه التحاور فيه، أن يكون له زادٌ معرفيّ في أهم مدخليْه: فقه البيان، وفق المقاصد؛ وهما نظامان معرفيّان تفرّعت عنهما علوم لسانية؛ (كالنحو والبلاغة وغيرهما) بما هي آليات لغوية لفهم النصّ. وعلوم آلية شرعية لفقهه؛ (كعلم الأصول والقواعد والمقاصد الشرعية) التي تزخر بها مدوَّنات علمائنا في المكتبات العالمية بمختلف اللغات ووسائل النشر.
غير أنّ ما قد يغفله الكثيرون (حتى مَن له حظّ من هذه الآليات المعرفية، ولا يحظى عنده بقيمة واعتبار في تناول النصّ والاستناد إليه في التحاور، والاحتجاج به عند المساءلة) أمران لهما عظيم الأهمية في إدراك المراد من خطاب القرآن:
أولهما: قيمة المصطلح داخل نصّه، ومجراه الدلالي، ومفهومه المراد من المتكلّم به، مقارنةً بمقام خطابه.
ثانيهما: أهمية سياق النصّ في تحديد مدلوله حتى لا تسلَّط عليه اعتبارات خارجية.
فهما إذن قضيتان لا بد من كشف مبناهما في فهم النصّ القرآني، أحاول بسط أُولاهما في هذه السطور، منبِّهًا على الثانية في معالجة الأخرى حين الحديث عن سُبل دراسة المصطلح؛ إذ من أهم سبلها: معرفة سياقه داخل النصّ.
2. معنى المصطلح:
لئن كان النصّ عبارة عن رموز وعلامات أُنْتِجت متتالية متناغمة بعضها مع بعض، فشكّلت بذلك مفاهيم الرسالة المتضمّنة فيه، فإنّ تلقِّي مضمونها على وجهٍ يريده المتكلّم ويقصده بخطابه، لا يسْتَدُّ على سبيل قويم إلا إذا بُنِي على فهم سليم لدلالة ألفاظه من تراكيبه، والتراكيبُ لا تنفكّ عن مقامها، والألفاظ لا تُبَتُّ عن جُملها. ومن تلك الألفاظ ما يعبّر عن مفاهيم تُعَدّ من أعلام القصد بالخطاب، وتُسَوِّر موضوعه وتنير درب متلقيه؛ آيات بارزة في ثناياه، وهي ما يسمى (مصطلحات)، ومن الألفاظ ما جيء به للربط بين تلك المفاهيم، وتحصيل تناسق في نظم الكلام ليجري على سنن لغوي سليم، يساعد على تفهّم المفاهيم المكتنزة داخل بنية النصّ. فبَانَ بهذا أنّ المصطلح هو لُبّ النصّ وجوهر الخطاب، وغيره له متمم... فما معنى المصطلح؟
المصطلح لغة: اسم مفعول مشتقّ من الصُّلْح، من قولهم: «اصطَلَحَا وتَصَالحَا»، ذلك أن الصلح هو: «تصالح القوم بينهم»[3]، فيكون الاصطلاح من قولك: «اصطلح القوم: زال ما بينهم من خلاف، وعلى الأمر: تعارفوا عليه واتفقوا»[4].
أمّا المصطلح عرفًا: فالوارد منه عند المصنِّفين القُدامَى صيغة الاصطلاح دالّة عليه بكونه اسمًا، كما ورد دالًّا على معناه المصدري، بيانهما في التعريفات، يقول الجرجاني: «الاصطلاح: عبارةٌ عن اتفاق قوم على تسمية الشيء باسم ما ينقل عن موضعه الأول. الاصطلاح: إخراج اللفظ من معنى لغوي إلى آخر؛ لمناسبة بينهما...، وقيل: الاصطلاح: لفظٌ معيَّن بين قوم معيَّـنِين»[5].
والمعنى الأخير في قوله: (لفظ...إلخ) هو المعنى الاسميّ، ويرادفه المصطلح، وهو الشائع في العصر الحاضر، ويستعمل مرادًا به: كلّ لفظ يدلّ على مفهومٍ ما؛ (علمي أو فكري أو ديني)، غلب عليه استعماله فيه لدى فرد أو جماعة، سواء نقل عن أصله الطبيعي أو توارد عليه العرف واللغة.
وعلى نفس المدلول يطلق المصطلح متعلقًا بالنصّ القرآني، مستحضرًا فيه خواصه الخارجية الداخلية، ويقال في تعريفه: هو كلّ لفظ قرآني يعبّر عن مفهوم ومعنى، كيفما كانت صيغته «مفردة كانت أم مركّبة، ومطلقة كانت أم مقيّدة، وعلى الصورة الاسمية الصريحة، أم على الصورة الفعلية التي تؤول بالاسمية»[6].
فبَانَ بهذا التقريب للمصطلح بالمفهوم العام والخاصّ، أن المفهوم هو السّمة البارزة فيه، من حيث إنه المعنى الخاصّ المتحصّل في الذّهن من اللفظ، وخصوصيته من خصوصية استعماله داخل مجاله، وللقرآن الكريم خصوصية دلالية ومعرفية لا تخفى على المتدبّرين لآيِهِ، المتذوّقين لإشاراته، فكيف يتوصّل إلى هذه الخصوصية وما قيمتها داخل هذا؟
3. قيمة المصطلح في فهم النصّ القرآني:
إنّ فَهْم مصطلحات القرآن هو الوسيلة المُثلَى لفهم آيِهِ؛ من أجلِ تحصيل مدركاته، وتمثّلها على الوجه السليم وتداول مبادئها على منهاج قويم =لا يُحْدِث اضطرابًا بين أصل المنهج ومريديه، ولا يُثِير الخلل في أنظمته المعرفية، ولا يُعجز المتعطشين إليه قَصْد تبيُّنِ مبادئه الربانية؛ وكم زلّت فهومٌ بسوء فهمِ المصطلحات القرآنية، وكم تصارعت أقوامٌ بسبب اختلاف الفهم للمصطلح المستنبَط منه، مِن قَبِيل: مصطلح الجهاد، والقدَر، والدعوة، والفقه، والتربية، والربا، والتوحيد، والسيرة، والطاعة، والسياسة، والحكم، والتجديد، والحرية، والإرهاب، والدين، والسلفية، والسُّنة، والبدعة، والوسطية، والتسامح، والولاية، والشورى، والمعروف، والمنكر، والفتنة، والسّلم، والحرب... ونحو ذلك من مصطلحات أضحت مناهج في الرؤى والمعتقدات، كان تعدّد تأويلاتها السبب في اتساع البَوْن بين أفراد الأمة الإسلامية، كلٌّ يدّعِي أن ما يفهمه من هذه المصطلحات هو المعيار السديد في المنهج، من ثَمّ لا يتردّد في ربطه بالقرآن تارةً أو السُّنّة أخرى، دون أن يفرّق بين اللفظ والمفهوم. فليتساءل كلّ واحد من أمثال هؤلاء: هل ما فهمه هو الفهم المراد من الاصطلاح الشرعي، أم فيه مجال لاحتمال معنى آخر قد يُقتبس من فهم غيره، فتتعاضد المفاهيم وتكتمل لتؤسِّس المفهوم التام؟
ومن هنا يمكن اعتبار المصطلح لُبّ النصِّ-أيّ نصٍّ- إنْ لم يكن النصَّ نفسَه؛ لأنه الأصل لباقي علاماته. وقد تواترت مقالات عن أئمةٍ أعلام حول قيمة المصطلح، نجتزئ منها ما ينبه على المراد دون التفاصيل؛ فهي مفاتيح العلوم[7]، وإنها السبب في اختلاط العلوم المذمومة بالعلوم الشرعية[8]، وهي الواصفة للعلم في ماضيه وحاضره ومستقبله[9]، وإنها لُبّ العلم وجوهره، بل هي العلم كلّه، فما موضوع العلم -أيّ علمٍ- إلّا مفاهيم تترابط فيما بينها لتنتج قواعد وقضايا[10]، وما الدوال على المفاهيم إلا مصطلحات.
أمّا النصّ القرآني فلا ريب أنه المصدر الأول والأسمى للمعارف والعلوم الشرعية، وكلّ معرفة انحازت في أصل تنشئتها عن مبادئه سرعان ما تتنكّب عن المنهج، ولا يحتكم إليها في إصدار القيم، وما تنزَّل القرآن إلا بالعلم، وما ارتُضِيَ نهجًا لهذه الأمة إلا لسداد محتواه المعرفي؛ فهو الهدى والنور، والذِّكر الحكيم وصراط الله المستقيم وشِرعته المرتضاة للعالمين، وهو خطاب عالمي كوني لكافة الناس أجمعين، فهل مِن تردُّدٍ في عدِّ مفاهيمه مِن أزكى العلم وأسمى المعرفة؟! يقول الدكتور الشاهد البوشيخي في تقرير مكانة المصطلح القرآني: «وإذا كان هناك نصٌّ ما، في لغةٍ ما، قد أحدَث (ثورة دلالية)، وشكَّل (طفرة مفهومية)، تحتاج لِـيَحْدُث بعضٌ من بعضها في مكانٍ ما، وزمانٍ ما، إلى قرون وقرون =فهو القرآن العظيم. ومن ثَم كيف يسوغ أن تتردّد نفوس في اعتبار الألفاظ القرآنية مصطلحات، وهي لها من الخصوصية والخصوبة المفهومية -بحكم قرآنيتها- ما ليس لمثلها من الألفاظ، في أيّ علم من العلوم، بحكم بشريّتها؟
كيف يجوز أن تسلِّم النفوسُ بمصطلحيةِ ألفاظِ كلِّ طائفة أو فِرقة أو مذهب، وعمدتُها وأساسُها ألفاظ ونصوص مؤسِّس الطائفة أو الفِرقة أو المذهب، ثم لا تسلِّم بمصطلحية (ألفاظ أصل الدين)، وهي ألفاظ (كتاب رَبّ العالمين). إنّ الغفلة عن هذه الحقيقة أحدثت أضرارًا بالغة؛ من أخطارها: عدم الالتزام بمصطلحات القرآن في عدد من علوم الدين، واستعمال ألفاظ أخرى بدلًا منها، لا بد أن تحمل -بحكم طبيعة العلاقة بين الدالّ والمدلول والمصطلح والمفهوم- قدرًا من التشوُّه أو التشويه في فهم الدين وتبليغ الدين»[11].
وقد كان الراغب الأصفهاني وغيره من الأئمة، من المسلِّمين بهذه الحقيقة؛ فقال في كتابه الفريد (مفردات ألفاظ القرآن): «فألفاظ القرآن هي لُبّ كلام العرب وزبدته، وواسطته وكرائمه، وعليها اعتماد الفقهاء والحكماء في أحكامهم وحكمهم، وإليها مفزع حذّاق الشعراء والبلغاء في نظمهم ونثرهم، وما عَدَاها وعَدَا الألفاظ المتفرّعات عنها والمشتقّات منها هو بالإضافة إليها كالقشور والنوى بالإضافة إلى أطايب الثمرة، وكالحثالة والتبن بالإضافة إلى لبوب الحنطة».
ووعيُ هؤلاء الجِلَّة الأعلام بهذه القيمة المصطلحية لهذا النصّ المعظَّم، آتٍ من معرفتهم بالخلل الذي ينشأ عن الجهالة بها في تفسير نصّ القرآن وبناء الأحكام عليه؛ ذلك أن إجراء المفهوم القرآني مجرى المعاني اللفظية العادية يبتُّ المعنى عن نسقه، ويباعد بين المعرفة العلمية المؤسّسة منه عن مقصدها، ويفصل بين موارد المصطلح ومقتضياتها المتكاملة، كما سنوضح ذلك ببعض المثُل.
ومن هنا كانت الخطوة الأولى للدراسة العلمية الجادّة للنصّ القرآني وتفهُّم مبادئه وأحكامه =في اقتفاء المصطلحات واستيعاب مداليلها في سياقاتها. وإغفالُ المصطلح في دراسة النصوص مَضَلّةٌ إلا للمهتدين إليه. ولنوضح ذلك بمثال في القرآن الكريم:
يقول الله تعالى: {أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً[12] وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ * مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ * إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ * أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ * الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ}[التوبة: 16-20].
لا يتردّد الدارس وهو يتلو هذه الآيات تلاوة اعتبار وتذكُّر؛ طلبًا للتحقّق من مفاهيمها المكثّفة، التي ترتجّ على لسانه -أو تهزّ أُذن من يستمع إليها استماع تذكُّر- في اعتبار عمق اصطلاحاتها، معترفًا بأنها ألفاظ ثقيلة الدلالة على ما تشير إليه، فيتطلّع إلى مدلولها؛ إنْ بقدرته المعرفية، أو بالرجوع إلى غيره من المصادر المعتبرة. وانظُرْ فيما تحمله هذه الجمل القرآنية من عظيم المفاهيم؛ تَرَ ما لا تراه لو تلَوْتَ الآية من غير تلاوة ذِكر:
عبارة النصّ الحاملة للمصطلح | المفهوم المستخلص |
- جاهَدوا منكم. جاهَدوا في سبيل الله. | - مفهوم الجهاد. |
- أن يَعمُروا مساجد الله. | - مفهوم عمارة المساجد. |
- للمشركين- شاهدين على أنفسهم بالكفر. | - مفهوم الشرك والكفر. |
- حبطت أعمالهم. | - مفهوم حبوط الأعمال. |
- مَن آمن بالله. | - مفهوم الإيمان بالله. |
- واليوم الآخر. | - مفهوم الإيمان باليوم الآخر. |
- وأقام الصلاة. | - مفهوم إقامة الصلاة. |
- وآتَى الزكاة. | - مفهوم الزكاة. |
- ولم يخشَ إلا الله. | - مفهوم خشية الله. |
- من المهتدين. | - مفهوم الاهتداء. |
- وعمارة المسجد الحرام. | - مفهوم عمارة المسجد الحرام. |
- جاهَد في سبيل الله. | - مفهوم الجهاد في سبيل الله. |
- هاجَروا (في سبيل الله). | - مفهوم الهجرة في سبيل الله. |
- القوم الظالمين. | - مفهوم القوم الظالمين. |
ثم إنّ الآية 19 وحدها: {أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ...} تنبِّه على مفهوم عظيم في العمل الديني وهو (فقه الأولويات)، لسنا بسبيل دَرْسِه فَلْنَكِلْهُ إلى مَظانّه. وفيه من الإشارة إلى هذا المغزى المفهومي في آيِ القرآن ما يستوجب الاعتبار به عند تفسيرها واستنباط الأحكام والحِكم منها.
وبسطُ هذه المصطلحات وما تنبه إليه من مقتضيات لا تكفي فيه ورقات أو سطور، وليس ذلك من هدفنا في هذه المحاولة، وإنما غايتنا أن نبرز حجم حضور المصطلح في النصّ القرآني، فإنْ تبينّا ذلك في بعض آيات، فما بالك بالسور ومئات الآيات، وإنه لحقٌّ أنّ القرآن الكريم كتابٌ مفاهيميّ بكلّ امتياز، فكيف يَفُكُّ مفاهيمَه إذن مَن ابتغى السّير على هدى وبصيرة، ولم يرتضِ لنفسه السطحية والظاهرية في فهم الدين وتنزيله؟
4. سبل دراسة المصطلح في النصّ القرآني:
لا شك أنّ لدراسة المصطلح القرآني خطوات تتوقّف على تأنٍّ وطولِ ابتحاث في سبيل الوصول إلى مدلوله المراد، ما لا يحتاجه غيره من الألفاظ، لِمَا بينّاه من قيمة المصطلح وثقل وزنه داخل النصّ القرآني، وأهم تلك الخطوات:
* الدلالة المعجمية الأصيلة للكلمة، الجارية على المعهود العربي زمن التنزيل، أي: النظر في مدلول اللفظة في التداول العربي القديم؛ قبل أن تُحْدِث فيها التطوراتُ اللسانية ما تُحْدِث من جديد المعاني، من أجلِ ملاحظة حضور ذلك المعنى في استعمال القرآن، أو عدم حضوره، وفائدة هذه الخطوة تتجلى في الربط بين المعنى اللغوي والاصطلاحي، والعلاقة بينهما، وكشفِ ما عسى أضافَه الشّرع على المدلول الأصل، مما أطنب القولَ فيه علماءُ اللغة والأصول تحت اصطلاحات الحقيقة العرفية واللغوية ونحو ذلك.
* النظر في مدلول المصطلح داخل النصّ، وكيفية جريانه فيه؛ هل جاء مطلقًا أو متعلقًا بغيره، موصوفًا أو صفةً، مركَّبًا أو مفردًا، مستعينًا بالقرائن والمقامات الحالية والمقالية التي سيق معها النصّ[13]. وبالجملة عليه أن يسعى لتفكيك المصطلح والمفهوم داخل النصّ المدروس، متوسلًا بقدراته المعرفية واللغوية، ومستعينًا ببيان أهل التفسير وأئمة الشرع والدين.
وإذا رامَ الناظر الوقوف على مفهوم المصطلح القرآني عامة دون تعلّق بنصٍّ ما، فيلزمه البحث عن كافة نصوص المصطلح إن وُجدت، وهو ما يعبّر عنه بالإحصاء[14]، وهو خطوةٌ عادةً ما تُذكر قبل سابقتها، إلّا أن قارئ النصّ الشرعي لأول وهلة لمّا يواجهه المصطلح في نصِّ مقروئه، عادةً ما يستهلّ نظره بالبحث المعجمي، ولا يسعه أن يقتصر عليه ما لم ينظر في بنيته داخل النصّ، ثم لا يكتفي بذلك -إن ابتغى دلالة النصّ عامة- حتى يُجرِي العمل نفسه في كافة النصوص، ليميز عندئذ بين المصطلح في نص مفرد، وبين المصطلح عامة في كافة النصوص. فمِن الأول مثلًا: مفهوم التلاوة في قوله تعالى: {نَتْلُو عَلَيْكَ مِنْ نَبَإِ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ}[القصص: 3]. ومن الثاني: لفظة التلاوة حيثما وردت في القرآن الكريم، ونصوصها كثيرة؛ من مثل قوله تعالى: {قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ}[الأنعام: 151]، وقوله -عز ذِكره-: {الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ}[البقرة: 121]، وغيرهما. فإنّ استخلاص المفهوم العام للتلاوة يستوجب تتبع اللفظة هذه في كلّ النصوص، مستحضرًا سياقاتها ووسائل تفهُّمها[15]. بَيْد أنّ الذي يساعد على فهم النصّ كثيرًا هو تبيُّن المصطلح في سياقه الخاصّ، ومن الخطأ إجراء المعنى العام على الخاصّ دون تبيُّن، وتنزيله على المفردة في السياق الخاصّ.
وإذا انتهى الباحث من كشف مجريات المصطلح في هذه النصوص لا بد وأن يخرج بنتائج حول مفهومه، وهي الخطوة التالية:
* استخلاص مفهوم المصطلح؛ خاصًّا كان أو عامًّا، أيْ: إنْ وقَع النظر على نصٍّ مفردٍ عَلِقَ ذلك المفهوم به، فيقول مثلًا: معناه في قوله تعالى كذا، ولا يحقّ له أن يُطْلِق حيث التقييد، فيقول مثلًا: البيان في القرآن الكريم كذا، وهو لم يستقرئ كافة النصوص، وإن امتد بحثه لنصوص عدّة وَسِعَه أن يعمم، ملاحِظًا صياغة المفهوم بطريق تجمع المعاني الجزئية إن كانت.
ولمّا كانت الدراسة النصيّة أهم هذه الخطوات، وكان أهم السبل إليها اعتبار سياق النصّ لتبيُّنِ المراد من المصطلح أولًا، وقضية النصّ ثانيًا =كان الاعتناء به لازمًا.
5. دور السياق في فهم المصطلح القرآني:
لكلّ نصّ شرعي مقاصده الأساسية، تُعَدّ ظروف وروده أو تَنَزُّله مُعينات على كشفها، وإن كانت ألفاظه أكثر شمولية من مراد المتكلم به؛ فإنّ الثانية مرادة من النصّ باليقين، وشاهد اعتبارها ظروف التنزيل، أمّا الأولى ففي إرادتها محلّ اجتهاد الناظرين، فكان استحضار تلك الملابسات المصاحبة للنصّ ألزم على شارحه ومتلقيه لزوم تأكيد وتسديد، على قدرٍ لا يُلحظ مع المعاني التابعة المفهومة من مجرد الدلالات اللفظية.
ومن هنا كان للسياق مكانة رفيعة ضمن آليات فهم النصوص الشرعية، وإنما تتأكّد هذه المنزلة مع ترجيح المعاني وتحديد المفاهيم والمصطلحات؛ بما هي لُبّ النصّ وجوهره كما أسلفنا. فكثيرة هي الألفاظ القرآنية التي سيقت محتملة من الدلالات ما لا سبيل إلى تعيين إحداها أو القول فيها بإطلاق إلا بكشف مساقاتها، ومقام المتكلم والمخاطَب بها، وقد كانت النصوص الشرعية بين متكلم ومخاطَب؛ الأول هو صاحب الوحي؛ ومقامهما في الإطلاق والتجريد والإحاطة لا سبيل للمحاججة فيه، والثاني هم العرب الذين نزل القرآن بلسانهم، متدرِّجًا في تلقين الرسالة ومبادئها إليهم، وملاحِظًا قدراتهم المعرفية والحالية، فلا يمكن مع هذا النهج في الخطاب إلّا مراعاته حين التَّوق إلى تفهُّم دلالاته، على نحوِ ما أصَّله العالم الأندلسي الخبير بمقاصد الشارع في خطابه، وقد ألـحّ في كتابه على تنزيل هذه القاعدة في فهم الشريعة، فبعد ما قرّر معنى كون القرآن عربيًّا أوضح ما يلزم عنه، فقال: «فإن قلنا: إنّ القرآن نزَل بلسان العرب وإنه عربي وإنه لا عُجمة فيه، فبمعنى أنه أُنزل على لسان معهود العرب في ألفاظها الخاصّة وأساليب معانيها، وأنها فيما فُطِرَت عليه من لسانها تخاطِب بالعامِّ يُراد به ظاهرُه، وبالعامِّ يُراد به العامُّ في وجهٍ والخاصُّ في وجهٍ، وبالعامّ يراد به الخاصُّ، والظاهر يراد به غيرُ الظاهر، وكلُّ ذلك يُعرف من أول الكلام أو وسطه أو آخره، وتتكلّم بالكلام يُنبئ أوّلُه عن آخره، أو آخرُه عن أوّله، وتتكلّم بالشيء يُعرف بالمعنى كما يُعرف بالإشارة، وتسمِّي الشيءَ الواحد بأسماء كثيرة، والأشياءَ الكثيرة باسمٍ واحد، وكلُّهذا معروف عندها لا ترتاب في شيء منه هي ولا مَن تعلَّق بعلمِ كلامها؛ فإذا كان كذلك، فالقرآنُ في معانيه وأساليبه على هذا الترتيب»[16].
وانبنَى على هذا الأصلِ قاعدةٌ في فهم الشريعة وألفاظها، وهي: «لا بدّ في فهمِ الشريعة من اتّباعِ معهود الأُمّيين، وهم العرب الذين نزَل القرآن بلسانهم، فإنْ كان للعرب في لسانهم عُرفٌ مستمرٌّ، فلا يصح العُدول عنه في فهم الشريعة، وإن لم يكن ثَمّ عرفٌ فلا يصح أن يُجْرَى في فهمها على ما لا تعرفه، وهذا جارٍ في المعاني والألفاظ والأساليب»[17].
وهذه التفاتة من الشاطبي إلى أن تفكيك المفهوم داخل نصّ شرعي تتحكّم فيه سياقات الألفاظ العربية؛ وهي ما عناه بــ«أول الكلام أو وسطه أو آخره»، أي: إنّ علائق المصطلح ومجراه البنيوي معيارٌ في تبيُّنه تمام التبيُّن، فلا يفسَّر بدلالة عامّة ومقامه خاصّ، أو العكس. وإنْ كان هذا مقصورًا على نوع من السياق؛ وهو السياق اللفظي، فثمة اعتبار للسياق الخارجي كذلك؛ لأن الشريعة لم تنسخ كلَّ ما ألْفَتْهُ من الواقع الجاهلي إلا ما كان منافيًا لمقاصد الدين الحنيف؛ فأقرَّت كثيرًا من المبادئ التشريعية والأخلاقية، واستعملتها بألفاظها المعروفة لدى العرب، وعليه قد يفسَّر المصطلح بالمعهود الاجتماعي، ويفكّك داخل النصّ انطلاقًا من ذلك المحيط، على نحو مصطلحات القَسَامة والدِّيَة والقِراض والكرم والشجاعة والمعرفة وبَذْل المعروف، مما تردّد في بعض النصوص الشرعية على نفس المعنى المتداول. ولأسباب النزول في هذا اعتبارُها الخاصّ كما قرّر ذلك علماء التفسير، يقول الطاهر بن عاشور: «إنّ من أسباب النزول ما ليس المفسِّر بغِنًى عن علمه؛ لأن فيها بيانَ مجمَلٍ أو إيضاح خفيّ وموجَز، ومنها ما يكون وحده تفسيرًا، ومنها ما يدلّ المفسِّر على طلب الأدلة التي بها تأويل الآية أو نحو ذلك»[18]. وقد يكون في النصّ مزيد تقييدات للألفاظ فرَضها السياق التشريعي الإسلامي، إلا أنها لا تُلغِي المقصود الأصلي، كما أن ذلك لا يعني حصرها في تاريخها والدعوة إلى تاريخية الخطاب الشرعي، كيف! وهو للناس أجمعين، أنَّى كان المفهوم المُدرَك منه، ما دام تنزيله يتّفق ومقاصد الشريعة، وتحقيق مناطه ليس فيه ما يضرّ بالأمة.
إنّ معرفة سياق النصّ القرآني، والقرائن المصاحبة له، وما منه تركّب الكلام، والصياغة التي بها نظمُه =ذو أهمية بالغة في تحديد مدلول المصطلح القرآني، ولا سيّما في المفردة ذات الوجوه المتعدّدة في اللغة العربية والقرآن، وإذا استعملت في آيةٍ من آيِه بوجهٍ واحد دون الوجوه الأخرى يتعيَّن حملها عليه؛ ولذلك أَوْلَى المفسرون عنايةً بالغةً بــ(الوجوه) كفنٍّ من فنون القرآن التي يجب اعتبارها في التفسير، واستعانوا لتحديد الوجه المراد في المصطلح القرآني بقواعد اللغة، وسياق النظم القرآني.
ومن أمثلة ذلك: تحديد المعنى المراد بمصطلح (الظن) -وقد ورد في القرآن الكريم على وجوه- في قوله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ}[البقرة: 230]، يقول أبو حيان: «ومعنى الظنّ هنا تغليبُ أحد الجائزَيْن...، وقال أبو عبيدة وغيره: المعنى: أيْـقَنَا، جعَل الظنّ هنا بمعنى اليقين، وضَعُف قولُهم بأنّ اليقين لا يعلمه إلا الله؛ إذ هو مغيبٌ عنهما. قال الزمخشري: (ومَن فسَّر الظنّ هاهنا بالعلم فقد وَهِمَ من طريق اللفظ والمعنى؛ لأنك لا تقول: علمتُ أنْ يقومَ زيدٌ، ولكن: علمتُ أنّه يقومُ زيدٌ، ولأنّ الإنسان لا يعلم ما في الغد، وإنما يظُنّ ظنًّا)[19]، انتهى كلامه. وما ذكره من: أنك لا تقول: علمتُ أنْ يقومَ زيد، قد قاله غيره، قالوا: إنّ(أنْ) الناصبة للمضارع لا يعمل فيها فعل تحقيق، نحو: العلم واليقين والتحقيق، وإنما يعمل في (أنّ) المشدّدة، قال أبو علي الفارسي في (الإيضاح): ولو قلتَ: علمتُ أنْ يقومَ زيد، فنصبتَ الفعل بــ(أنْ)، لم يَجُز؛ لأنّ هذا من مواضع (أنّ)؛ لأنها مما قد ثبت واستقر، كما أنه لا يَحْسُن: أرجو أنّك تقوم»[20].
وبالجملة فمصطلح الظنّ في الآية مرادٌ به المعنى الراجح من الأمرين، فإذا ترجّح لدى الزوجين أنهما سيقيمان حدود الله فلا بأس أنْ يتراجعا، ولا يصح تفسير الظنّ بمعنى اليقين لمخالفته للواقع؛ لأن المستقبل لا يتيقن العلم به، كما أن قانون النحو شاهد لبطلانه؛ لأن (أنْ) المخففة لا تدخل على فعل تحقيق، وهو من قواعد السياق المقالي.
والحاصل أنّ سياق النصّ آليّة عظيمة في فهم مصطلحه، ومحدِّد للمدلول المراد منه، ولو لم يحظَ بهذا الاعتبار ما كان الباحثون في أصول التشريع وأُسس فهمِ الوحي المحمدي ليجعلوا من أهم تلك الأصول: (مبحث القرائن) التي تُعين على كشف كثير من دلالات الألفاظ[21]؛ كالحقيقة والمجاز، والعموم والخصوص، والإطلاق والتقييد، والكناية والتصريح، ومقتضى الأمر والنهي، والمنطوق والفحوى، والنصّ والظاهر، ومعقول النصّ ولازمه، ونحو ذلك من مباحث لا سبيل إلى التشكيك في أهميتها في فهم الألفاظ الشرعية داخل بنياتها النصية. والألفاظ في نصوص الشرع أكثرها مصطلحات، فكيف تحدَّد بمعزل عن هذه الآليات، وهي جوهر مباحث السياق.
ولعلّ الوقوف على مزيد من المثُل يكشف شيئًا من هذا؛ فمن ذلك أيضًا في القرآن الكريم: تحديد مفهوم (القُرْء) الوارد في قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ}[البقرة: 228]،فكلمة (القروء) مصطلح شرعي كثير التداول بين الفقهاء، غير أن مدلوله لم يكن متفقًا عليه بينهم؛ لوروده مشتركًا في اللغة العربية بين معنيَيْن: الطُّهْر والحَيْض، وهما مفهومان للكلمة مجرّدة عن سياقها في هذا النصّ القرآني، ولا ريب أنّ حملها عليهما معًا متعذّر؛ لاختلاف حساب العدّة بالأطهار والحِيَض كما هو معروف، فما المدلول الأقرب إلى سياق الآية إذن؟
يرى كثير من الفقهاء أن الأرجح حمل اللفظة على الطهر؛ لأن القرينة اللفظية والخارجية توجب ذلك[22]؛ أمّا اللفظية فمن وجهين:
أحدهما: أن القُرْء إذا جُمع على (قروء) فالمراد به الطهر لا الحيض، وإذا جمع على (أقراء) كان المراد به الحيض؛ كقول النبي -صلى الله عليه وسلم- لعائشة: «دعي الصلاة أيام أقرائك»[23]، والصلاة إنما تترك زمن الحيض لا زمن الطهر.
ثانيهما: أن الأطهار مذكّرة فيجب ذكر التاء في العدد المضاف إليها، فيقال: ثلاثة أطهار، والحِيَض مؤنثة فيجب حذف التاء من العدد المضاف إليها، فيقال: ثلاث حِيَض، ولما قال الله تعالى: {ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ}[البقرة: 228]، بالتاء علمنا أنه أراد الأطهار.
كما أن استحضار السياق العام للقرآن في حديثه عن العدّة عقب الطلاق يرجح هذا المعنى، وتفسير ذلك أن الله تعالى يقول في كتابه: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}[الطلاق: 1]، فأمَر بطلاقهن طلاقًا يستعقب عدّتهن، ولا تتراخى العدّة عنه، وقد قرأ ابن مسعود: (لِقُبُلِ عِدَّتِهِنَّ) وليس ذلك إلا في الطهر لا في الحيض؛ فإن الطلاق في الحيض حرام.
كما أن قواعد الشريعة وسياقها العام في تشريع الأحكام يوجب هذا المعنى، وهو ما عبّر عنه التلمساني بموافقة القياس؛ ذلك أن العدّة لما كانت مأمورًا بها كانت عبادة من العبادات، والشأن في العبادة أن الحيض ينافيها، ولا تتأدّى فيه، فضلًا عن أن تتأدّى به، ألَا ترى أن الصلاة والصيام والطواف لا تصح مع الحيض، بخلاف الطهر، فالقياس يقتضي في العدة أنها تتأدى بالطهر لا بالحيض، وإذا كان كذلك وجب حمل القروء في الآية على الأطهار لا على الحيض»[24].
خاتمة:
لقد تبينّا من هذه السطور مجموعة من الإفادات، نجملها في الآتي:
- أن للنصّ القرآني مكانة عليّة من بين سائر النصوص، وله من سمات التقديس المستفادة من مصدره ما يستلزم اعتبارها في التبيُّن والبيان لمعانيه وحِكمه، والاسترشاد بهديه في كلّ شؤون الحياة الدينية والمدنية.
- أن المصطلح يمثّل المفتاح الأساس لقراءة النصّ، والغوص في أعماقه الأسلوبية، وكشف دلالاته المعنوية، والوقوف عند رسالته الفكرية، فلا يتجاوز عند تأويل النصّ دون تفكيك مدلوله بالآليات المنهجية المذكورة، ولا يُعْبر دون إيلائه ما يستحقّ من الاعتبار. وهذه قاعدة صار توظيفها في المصطلح الأُم (مصطلح القرآن) لازمًا؛ لأن جُلّ مفرداته بمثابة مفاتيح الاهتداء للتي هي أقوم في هذا الكتاب، ومفاتيحه: مصطلحاته. ومفتاح الولوج إليها منهج الدراسة المصطلحية المُلمع لبعض خطواتها فيما سلف.
- ولا شك أن للبُعد السياقي لهذا النصّ الجليل دورًا معتبرًا في كشف أسراره، وإدراك المغزى من مصطلحاته، ومراد المتكلم به، ولا سيما المصطلحات المتعدّدة المفاهيم، والمشتركة الدلالة، فدون كشف موقعها السياقي لا تتبين دلالتها، فضلًا عن تمثُّلها العملي.
- وإذا تقرر ذلك، فلعلّه يتخذ نهجًا لاحِبًا في دراسة النصوص القرآنية، ويتجاوز به منهج التجزيء في تأويل جملها ومفرداتها، وفي الوقت نفسه يدرأ عنها الانفتاح المطلق في القراءة والتأويل التي لا تنضبط بكليات الشريعة وقواعد البيان العربي الذي تنزل به. ذلك هو المسعى من هذه السطور التي نأمل أن تتوسّع رؤاها وتعمّق نتائجها فيما يتهيّأ من بحوث.
واللهُ الموفِّق والهادي لا إله إلا هو.
[1] لمفهوم النصّ اعتبارات واختيارات تختلف من مجال تداولي لآخر، غير أن العبرة عند الإطلاق العام له، في كونه خطابًا مقصودٌ منه نسيجُه اللغوي والتواصلي.
[2] الموافقات، تحقيق: مشهور حسن (4/ 144).
[3] لسان العرب: (صلح).
[4] المعجم الوسيط: (صلح).
[5] التعريفات: الجرجاني. (الاصطلاح)، تحقيق: عبد المنعم الحفني، ط: دار الرشاد، ص38.
[6] نحو معجم تاريخي للمصطلحات القرآنية المعرفة: د. الشاهد البوشيخي، ط: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف - المدينة المنورة، ص1.
[7] مفاتيح العلوم: الخوارزمي، تحقيق: عثمان خليل، ط:1- 1339هــ، ص4.
[8] إحياء علوم الدين: لأبي حامد الغزالي، ط: مصر 1998م، (1/ 46).
[9] مصطلحات النقد العربي، الشاهد البوشيخي، ط: عالم الكتب الحديث 1438، ص15.
[10] المصطلح الأصولي عند الإمام الشاطبي، فريد الأنصاري، ط:1- 2004، ص11.
[11] نحو معجم تاريخي للمصطلحات القرآنية المعرفة، الشاهد البوشيخي، ص1.
[12] وليجة الرجل: بطانته وخاصته. [مختار الصحاح: ولج].
[13] سيأتي مزيد بيان لأهمية السياق في فهم المصطلح.
[14] ينظر في هذا المجال ما كتبه الرائد في منهج الدراسة المصطلحية: الدكتور الشاهد البوشيخي، مثل أطروحته: (مصطلحات النقد العربي لدى الشعراء الجاهليين والإسلاميين)، و(نظرات في المصطلح والمنهج) وكلاهما مطبوع ومتداول.
[15] ينظر للتوسّع في هذا المثال: (مصطلح التلاوة في القرآن الكريم)، الطيب شطاب. منشورات معهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية التابع لجامعة القرويين - المغرب.
[16] الموافقات: الشاطبي، تحقيق: عبد الله دراز، تخريج: أحمد السيد، ط: المكتبة التوفيقية، (2/ 55).
[17] نفسه (2/ 68).
[18] التحرير والتنوير، ط: الدار التونسية (1/ 47).
[19] الكشاف، ط: دار الكتاب العربي 1407، (1/ 276).
[20] البحر المحيط، ط: دار الكتب العلمية 1413، (2/ 213).
[21] يقول ابن دقيق العيد: «أمّا السياق والقرائن: فإنها الدالة على مراد المتكلم من كلامه، وهي المرشدة إلى بيان المجملات، وتعيين المحتملات». [إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، شرح حديث: 188، ص345].
[22] مفتاح الوصول، لأبي عبد الله التلمساني، ط: دار الرشاد الحديثة، ص56.
[23] السنن الكبرى للبيهقي، ح (1693)، ط: الأولى - الهند 1344هـــ.
[24] مفتاح الوصول، ص58.
كلمات مفتاحية
الكاتب:

الطيب شطاب
أستاذ التعليم العالي المساعد بكلية الآداب جامعة ابن زهر بأكادير - المغرب، وله عدد من المشاركات العلمية.
مواضيع ذات صلة
((المعلومات والآراء المقدَّمة هي للكتّاب، ولا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع أو أسرة مركز تفسير))