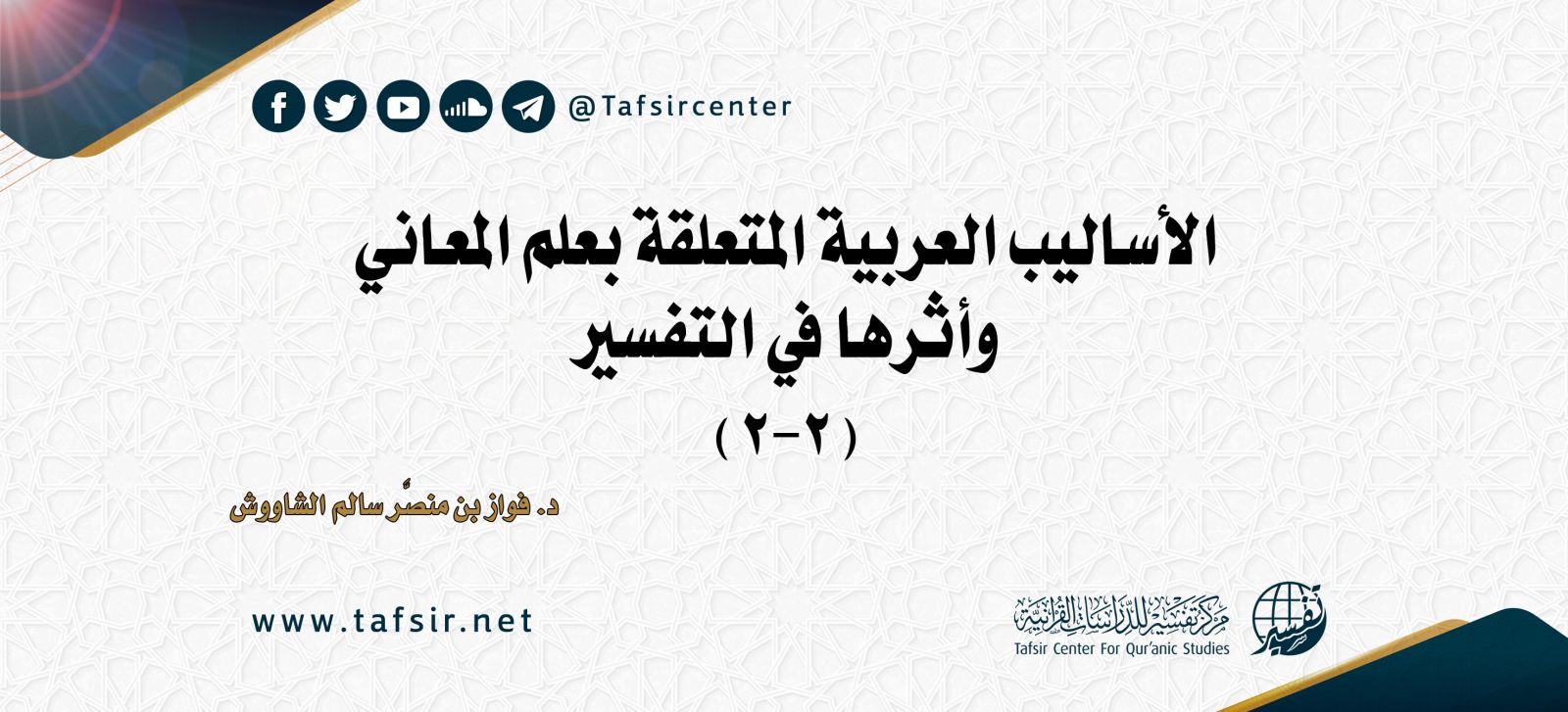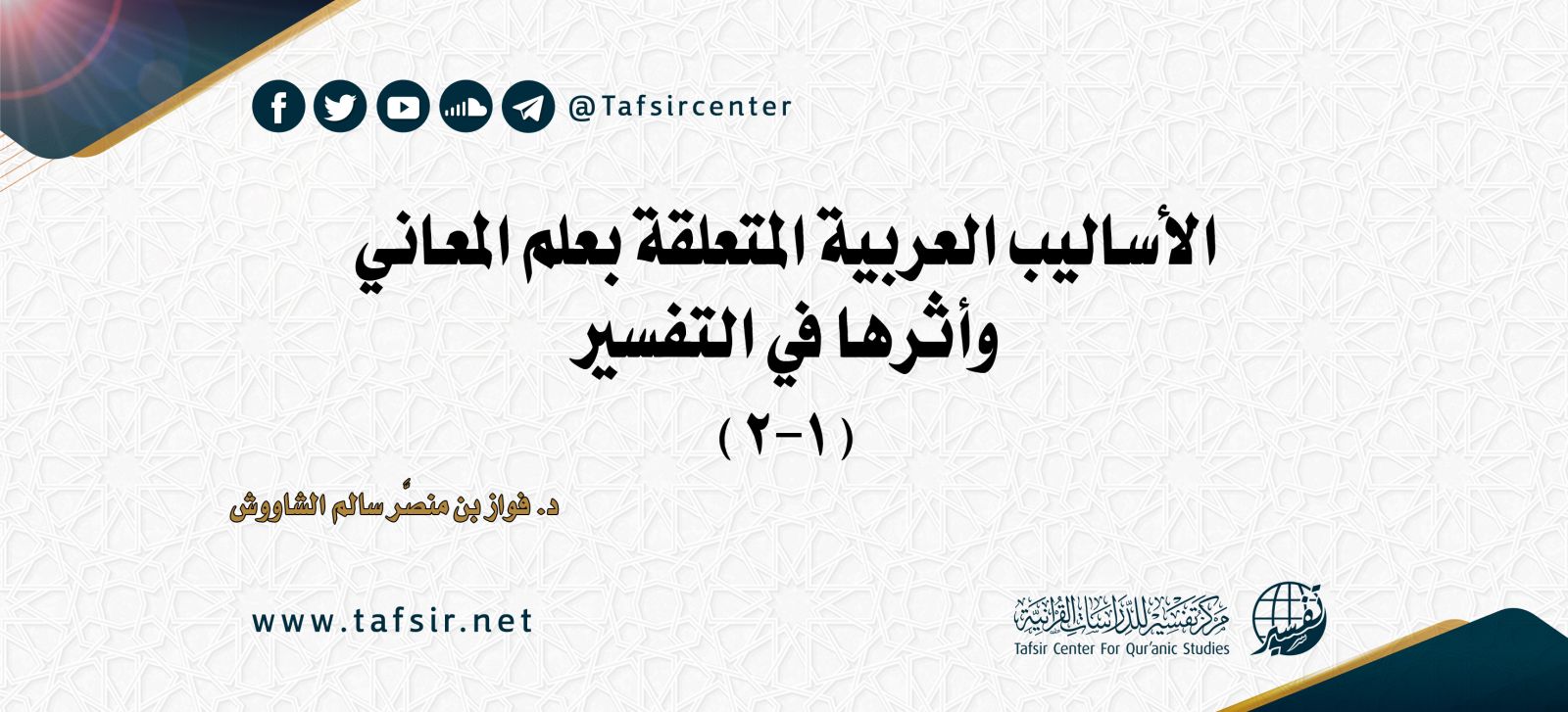الأساليب العربية المتعلقة بأحكام الكلمة حال الإفراد وأثرها في التفسير (2-2)
وأثرها في التفسير (2-2)
الكاتب: فواز بن منصَّر سالم الشاووش

الأساليب العربية المتعلقة بأحكام الكلمة حال الإفراد
وأثرها في التفسير (2-2)[1]
الأسلوب السابع: «ذِكْرُ مَكْنِيِّ اسمٍ لم يَجرِ له ذِكْرٌ ظَاهرٌ في الكلام»[2]:
أولًا: توضيح الأسلوب:
المراد بـ(الـمَكْنِيّ): الضمير، يسمّيه الكوفيون الكناية والـمُكْنى. وعند البصريين: الضمير والمضمر، وهو بالمعنى نفسه[3].
فيكون المعنى: من عادات العرب في كلامهم أنهم يذكرون الضمير ولا يذكرون الاسم الذي يعود عليه اختصارًا، إذا كان في الكلام ما يدلّ عليه[4].
ومن ذلك قول النبي -صلى الله عليه وسلم- لـمّا مرَّ بقبرين: (إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ)[5].
فقوله –صلى الله عليه وسلم-: (إنهما) أعاد الضمير على غير مذكور، والمراد به صاحبا القَبْرَيْنِ؛ لدلالة سياق المقام على ذلك[6].
ثانيًا: صيغ الأسلوب:
ورَدَت عدّة صِيَغ لهذا الأسلوب عند الطبري، منها صيغتان متقاربتان:
الصيغة الأولى: «غير مُحالٍ في الكلام أن يُذْكَرَ مَكْنِيُّ اسمٍ لم يَجْرِ له ذِكْر ظاهر في الكلام»[7].
الصيغة الثانية: «...وكنَّى عن الكلمة، ولم يَجْرِ لها ذِكْرٌ مُتَقَدِّم. والعرب تفعل ذلك كثيرًا، إذا كان مفهومًا المعنى المرادُ عند سامِعِي الكلام»[8].
ومن خلال النظر في هاتَيْن الصيغتَيْن تبيَّن أنَّ العرب قد يَسْتغنون عن ذِكْر عائد الضمير إذا كان الكلام مفهومًا، وفيه ما يدلُّ عليه.
ثالثًا: دراسة الأسلوب:
لقد أشار إلى هذا الأسلوب علماءُ اللغة والتفسير، وقرّروه في كتبهم، ومنهم:
1- الفراء (ت: 207هـ):
قال عند قوله تعالى: ﴿فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا﴾ [العاديات: 4]: «يريد: بالوادي، ولم يَذكره قبل ذلك، وهو جائز؛ لأنَّ الغبار لا يُثار إلا من موضعٍ وإن لم يُذْكر، وإذا عُرِف اسمُ الشَّيء كُنِّي عنه، وإن لم يَجْرِ له ذِكْر...»[9].
2- أبو عبيد القاسم بن سلام (ت: 224هـ):
قال في عود الضمير على غير مذكور: «وهذا سائـرٌ كثيرٌ في القرآن، وفي كلام العرب وأشعارهم، أن يَكْنُوا عن الاسم، من ذلك قول الله-جل ثناؤه-: ﴿وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ﴾ [فاطر: 45]، وفي موضع آخر: ﴿مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ﴾ [النحل: 61]، فمعناه عند الناس: الأرضُ، وهو لم يَذْكُرها...»[10].
3- ابن قتيبة (ت: 257هـ):
قال في باب (الحذف والاختصار): «ومن الاختصار أن تضْمِر لغير مذكور؛ كقوله -جلّ وعز-: ﴿حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ﴾ [ص: 32]، يعني: الشمس، ولم يذكرها قبل ذلك...»[11].
رابعًا: الأمثلة التطبيقية:
ورَدَت لهذا الأسلوب عند الطبري أمثلة، منها:
1- قوله تعالى: ﴿فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا﴾ [البقرة: 66].
ذكر الطبري خلاف أهل التأويل في تأويل الهاء والألف من قوله: ﴿فَجَعَلْنَاهَا﴾، وذكر روايتين لابن عباس، وهما:
الأولى: فجعلنا تلك العقوبة، وهي المسخةُ، نكالًا.
الثانية: ﴿فَجَعَلْنَاهَا﴾، يعني: الحيتان.
وذكر أقوالًا أخرى[12]، ثم رجَّح الرّوايةَ الأُولى عن ابن عباس، ثم قال: «وأمّا الذي قال في تأويل ذلك: ﴿فَجَعَلْنَاهَا﴾، يعني: الحيتان؛ عُقوبة لِما بين يدي الحيتانِ من ذنوب القوم وما بعدها من ذنوبهم. فإنه أبْعَد في الانتزاع؛ وذلك أنّ الحيتان لم يَجْرِ لها ذِكْر فَيُقَال: ﴿فَجَعَلْنَاهَا﴾. فإنْ ظنَّ ظانٌّ أنّ ذلك جائز وإن لم يكن جرى للحيتان ذِكْر؛ لأنَّ العرب قد تَكْنِي عن الاسمِ ولم يَجْرِ له ذِكْر، فإنّ ذلك وإن كان كذلك، فغير جائز أن يُترك المفهوم من ظاهر الكتاب -والمعقولُ به ظاهر في الخطاب والتنزيل- إلى باطنٍ لا دلالة عليه من ظاهر التنزيل، ولا خبر عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- منقول، ولا فيه من الحُجّةِ إجماع مستفيض»[13].
2- قوله جلّ جلاله: ﴿فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ﴾ [يوسف: 77].
قال الطبري: «وقال: ﴿فَأَسَرَّهَا﴾ فأنّث؛ لأنه عَنى بها الكلمة، هي: ﴿أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ﴾ [يوسف: 77]، ولو كانت جاءت بالتذكير كان جائزًا، كما قيل: ﴿تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ﴾ [هود: 49]، و﴿ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَى﴾ [هود: 100][14]، وكنَّى عن الكلمة، ولم يَجْرِ لها ذكرٌ متقدِّم. والعربُ تَفْعَلُ ذلك كثيرًا إذا كان مفهومًا المعنى المرادُ عند سامِعِي الكلام، وذلك نظير قولِ حاتم الطائي[15]:
أمَاوِيَّ مَا يُغْنِي الثَّرَاءُ عَنِ الْفَتَى ** إِذَا حَشْرَجَتْ يَوْمًا وَضَاقَ بِهَا الصَّدْرُ
يريدُ: وضاق بالنَّفْسِ الصدرُ، فكنَّى عنها ولم يَجْرِ لها ذِكْر؛ إِذْ كان في قوله: (إذا حشرجت يومًا)، دلالة لسامع كلامه على مراده بقوله: (ضاق بها). ومنه قول الله: ﴿ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [النحل: 110]. فقال: ﴿مِنْ بَعْدِهَا﴾، ولم يَجْرِ قبل ذلك ذِكر لاسم مؤنث»[16].
3- قوله تعالى: ﴿إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ﴾ [يس: 8].
قال الطبري بعد ذِكْرِه لمعنى الآية: «وقوله: ﴿فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ﴾، يعني: فأَيمانهم مجموعةٌ بالأغلال في أعناقهم، فكنَّى عن الأَيمان، ولم يجرِ لها ذِكْر؛ لمعرفة السامعين بمعنى الكلام، وأنَّ الأغلال إذا كانت في الأعناق لم تكن إلا وأَيْمُنُ أيدي المغلولين مجموعة بها إليها، فاستغنى بذِكْر كونِ الأغلال في الأعناق من ذِكْرِ الأَيمان، كما قال الشاعر[17]:
وَمَا أَدْرِي إِذَا يَمَّمْتُ وَجْهًا ** أُرِيدُ الْخَيْرَ أَيُّهُمَا يَلِينِي
الْخَيْرُ الَّذِي أَنَا أَبْتَغِيهِ ** أَمِ الشَّرُّ الَّذِي لَا يَأْتَلِينِي
فكنَّى عن الشر، وإنما ذكر الخير وحده؛ لعلمِ سامع ذلك بمعنى قائله، إذ كان الشرُّ مع الخير يُذْكَرُ»[18].
خامسًا: أثره في التفسير:
يتبيَّن أثر هذا الأسلوب في اختلاف المفسِّرين في مرجع الضمير، إضافة إلى ما يحويه من المعاني البليغة، وإليك بيان ذلك:
ففي المثال الأول: يتبيَّن أثر هذا الأسلوب في اختلاف المفسِّرين في مرجع الضمير الذي في قوله: ﴿فَجَعَلْنَاهَا﴾؛ فمنهم مَن جعله إلى غير مذكور، ومنهم من جعله إلى مذكور.
فالذين قالوا إنّ الضمير يرجع إلى غير مذكور اختلفوا في مرجع الضمير؛ فمنهم من جعله عائدًا على (المسخة) وهو الفرّاء[19]، وتبعه على ذلك الطبري[20]، ومنهم من جعله عائدًا على (الحيتان)، وهي رواية عن ابن عباس[21]، وقد استبعده الطبري؛ لعدم الدلالة عليه من ظاهر التنزيل، ولأنه لم يُنقل عليه دليل من السُّنة أو الإجماع، ومنهم من جعله عائدًا على (القرية)، وهو ابن كثير[22].
والذين قالوا إنّ الضمير يرجع إلى مذكور جعلوه عائدًا على (القردة)[23]، ومنهم من جعله عائدًا على (المسخة) و(القردة)، وهو الأخفش[24].
وفي المثال الثاني: يظهر أثر هذا الأسلوب في اختلاف المفسِّرين في مرجع الضمير الذي في قوله: ﴿فَأَسَرّهَا﴾، فيرى الطبري والزجّاج وغيرهما: أنَّ الضمير يعود إلى ما بعده ويفسره قوله: ﴿أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ﴾ [يوسف: 77]، فيكون الإسرار على هذا الوجه مستعملًا على حقيقته من كونه يدلُّ على الإخفاء، بمعنى أنَّ يوسف -عليه السلام- أسرَّ هذه الكلمة في نفسه ولم يُظْهِرها لإخوته، وهي قوله: ﴿أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ﴾[25].
بينما يرى أبو حيان والشوكاني وغيرهما، أنَّ الضمير يعود إلى جملة: ﴿قَالُوا إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ﴾ [يوسف: 77]، فيكون معنى الإسرار على هذا القول، أنه تحمَّلها ولم يُظهِر غضبَه منها، ويكون قوله: ﴿أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ﴾، كلامًا صريحًا مستأنفًا، بمعنى أنه خاطبهم بذلك توبيخًا[26].
وفي المثال الثالث: يتجلَّى أثر هذا الأسلوب في اختلاف المفسِّرين في مرجع الضمير في قوله: ﴿فَهِيَ إِلَى الأَذْقَانِ﴾ [يس: 8]، فيرى الفرّاء أنَّ الضمير عائد على (الأيدي) وهي غير مذكورة؛ لدلالة السياق عليها، وتبعه على ذلك الطبري والنَّحاس وغيرهما، فيكون المعنى على هذا الوجه: أنَّ الأيدي مجموعة بالأغلال في أعناقهم[27].
بينما يرى الزمخشري أنَّ الضمير عائد على (الأغلال)، بمعنى: أنَّ الأغلال واصلةٌ إلى الأذقان مشدودة إليها، فلا تجعل المغلولَ يُطأطئ رأسه[28].
وقال ردًّا على القائلين بأنَّ الضمير عائد على (الأيدي): «هذا الإضمار فيه ضربٌ من التعسُّف وترك الظاهر الذي يدعوه المعنى إلى نفسه، إلى الباطن الذي يجفو عنه»[29]، وتبعه على ذلك أبو السعود[30].
وعند التأمُّل في هذا الأسلوب تجد أنه يُظْهِر معنى جديدًا للآية، وهو زيادة النَّكال والعذاب على الكافرين، وذلك أنَّ بقاء اليد مشدودةً مع العنق في الغُلّ فيه كربٌ وشِدَّةٌ على المغلول -والعياذ بالله-، فيكون هذا الوصف على هذا التفسير أشدَّ نكايةً، وأمّا إذا قيل إنَّ الضمير عائد على (الأغلال)، فتكون يداه مرسلة مخلاة، وكان للمغلول بعضُ الفرج بإطلاقها، ولعلّه يتحيَّل بها على فكاك الغُلّ، ولا يحصل هذا إذا كانت مشدودة مع العنق[31].
الأسلوب الثامن: «وَصْفُ الشَّيء بالدَّوامِ أبدًا، وذلكَ بِتَعْلِيقه بغير زَائِل»[32]:
أولًا: توضيح الأسلوب:
من أساليب العرب أنَّها إذا أرادت وصف شيء ما بصفة دائمة لا تتغيّر عن حالها أبدًا علَّقتها بغير زائل، فيقولون: لا أفعل ذلك ما اختلف الـمَلَوَان، وهما الليل والنهار، وما أورق الشجرُ وطلع القمرُ، وما بقي إنسان ونطق لسان، يريدون بذلك كلّه لا أفعله أبدًا.
ثانيًا: صيغ الأسلوب:
ورَدَت لهذا الأسلوب عند الطبري صِيغة واحدة، وهي:
«العرب إذا أرادت أن تَصِفَ الشَّيء بالدَّوامِ أبدًا، قالت: هذا دائم دوامَ السماواتِ والأرض، بمعنى أنه دائم أبدًا، وكذلك يقولون: هو باقٍ ما اختلف الليلُ والنهارُ، وما سَمر ابنا سَمِيرٍ[33]، وما لَأْلَأَتِ العُفْرُ بأذنابها[34]، يعنون بذلك كلّه: أبدًا»[35].
ثالثًا: دراسة الأسلوب:
لقد اعتمد علماء اللغة على هذا الأسلوب، وأشاروا إليه، فمنهم:
1- أبو عبيد القاسم بن سلام (ت: 224هـ):
قال في (باب الأمثال في ترك اللقاء ودُهُوره وأزمنته): «قال الأصمعي: يُقال في الاعتزام على ترك اللقاء: لا آتيك ما حَنَّتِ النِّيبُ[36]. قال: ومثله: لا آتيك ما أَطَّتِ الإبلُ[37]...»[38].
2- ابن قتيبة (ت: 276هـ):
قال: «فإنّ للعرب في معنى الأَبَدِ ألفاظًا يستعملونها في كلامهم، يقولون: لا أفعل ذلك ما اختلف الليل والنهار، وما طَمَى البحر، أي ارتفع، وما أقام الجبل، وما دامت السماوات والأرض، في أشباهٍ لهذا كثيرة، يريدون: لا أفعله أبدًا؛ لأنَّ هذه المعاني عندهم لا تتغير عن أحوالها أبدًا، فخاطبهم الله بما يستعملونه، فقال: ﴿خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ﴾ [هود: 107]، أي: مقدار دَوَامِهما، وذلك مدة العالم»[39].
3- أبو العباس أحمد ثعلب (ت: 291هـ):
قال: «العرب تقول: لا آتيك ما أنَّ في بَحرٍ قطرة[40]، ولا آتيك ما دامت السَّماء سماء، ولا آتيك ما سَمَر –وأَسْمَرَ- ابنا سَمِير، يعنى الليل والنهار... يضعون هذا موضع أبد الدهر»[41].
رابعًا: الأمثلة التطبيقية:
ورَدَ لهذا الأسلوب عند الطبري مثال واحد، وهو:
قوله تعالى: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ هُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ) [هود: 106- 107].
قال الطبري: «يعني بقوله تعالى ذِكْره: ﴿خَالِدِينَ فِيهَا﴾: لابثين فيها. ويعني بقوله: ﴿مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ﴾: أبدًا. وذلك أنَّ العرب إذا أرادت أن تَصِف الشيء بالدَّوامِ أبدًا، قالت: هذا دائم دوام السماوات والأرض. بمعنى أنه دائمٌ أبدًا، وكذلك يقولون: هو باقٍ ما اختلف الليل والنهارُ، وما سَمَر ابنا سَمير، وما لَأْلَأَتِ العُفْرُ بأذنابها. يعنون بذلك كلّه أبدًا. فخاطبهم جلَّ ثناؤه بما يتعارفونه بينهم، فقال: خالدين في النار ما دامَتِ السَّماوات والأرضُ. والمعنى في ذلك: خالدين فيها أبدًا»[42].
خامسًا: أثره في التفسير:
كان لهذا الأسلوب أثر في توضيح معنى الآية، وفي إزالة إشكال قد يرِد في فهمها، وإليك البيان:
ففي قوله تعالى: ﴿خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ﴾ [هود: 107]، أي: لابثين فيها أبدًا لا يخرجون منها، جريًا على أساليب العرب في خطابهم إذا أرادوا وصف الخبر بالدوام والأبدية علّقتها بغير زائل.
ويرِد في الآية إشكال، وهو أنَّ القائلين إنَّ عذاب الكفار منقطع وله نهاية، استدلوا بهذه الآية[43]، ووجهُ استدلالهم أنَّ الله تعالى قال: ﴿مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ﴾، فدلّ هذا النص على أن مدة عقابهم مساوية لمدَّة بقاء السماوات والأرض متناهية، فلزم أن تكون مدة عقاب الكفار منقطعة!
ويُجاب عن ذلك، فيُقال: إنَّ قوله تعالى: ﴿مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ﴾، لا يُفهم منه انقطاع العذاب بفناء السماوات والأرض، وإنما المراد الوصف بالدوام والأبدية جريًا على عرف العرب في كلامهم؛ إِذْ إنهم يعبّرون عن الدوام والأبدية بقولهم: ما دامت السماء والأرض، وما اختلف الليل والنهار، وما شابه ذلك، والقرآن نزل على لغة العرب وأساليبهم[44].
الأسلوب التاسع: «وضعُ الكَلِمَةِ مَكانَ غيرِها، إذا تَقَاربَ مَعنياهُما»[45]:
أولًا: توضيح الأسلوب:
من أساليب العرب أنهم يضعون إحدى الكلمتين موضع الأخرى إذا تقارب معنياهما، وإذا كان للكلمتين أكثر من معنى، وهما متقاربتان في بعض المعاني دون بعض، فإنهم يضعون إحداهما موضع الأخرى في المعنى الذي يتقاربان فيه.
فمثلًا كلمة (المشفر)، تُستعمل في لغة العرب للبعير[46]، وقد يعبّر بها عن شفة الإنسان إذا كانت غليظة، فتقول: هو غليظ المشافر[47]، وتقول: مشافر الحبش، تشبيهًا بِمَشافِرِ الإبل، للتقارب والتشابه بينهما من حيث الكبر[48].
ثانيًا: صيغ الأسلوب:
وردَت ثلاث صيغ لهذا الأسلوب عند الطبري، وهي:
الصيغة الأولى: «من شأن العرب استعارة الكلمة ووضعها مكان نظيرتها»[49].
الصيغة الثانية: «العرب ربما استعارت الكلمة فوضعتها في غير موضعها[50]»[51].
الصيغة الثالثة: «يَتَقارَبُ معنى الكلمتين في بعض المعاني، وهما مختلفتا المعنى في أشياءَ أُخَرَ، فَتَضَعُ العرب إحداهما مكان صاحبتها في الموضع الذي يتقارب معنياهما فيه»[52].
ثالثًا: دراسة الأسلوب:
لقد ذكر علماء اللغة والتفسير هذا الأسلوب وأشاروا إليه، ومن هؤلاء:
1- ابن قتيبة (ت: 276هـ):
قال: «فالعرب تستعير الكلمة فتضعها مكان الكلمة، إذا كان المسمّى بها بسبب من الأخرى، أو مجاورًا لها، أو مشاكلًا، فيقولون للنبات نوءٌ؛ لأنه يكون عن النوء عندهم... ويقولون للمطر: سماء؛ لأنه من السماء ينزل، فيقال: ما زلنا نطأُ السماء حتى أتيناكم... ويقولون: ضحكت الأرض، إذا أنبتت؛ لأنها تُبدِي عن حُسن النبات، وتَنْفتقُ عن الزهر كما يَفْتَرُّ الضاحك عن الثغر... ومثل هذا في كلام العرب كثير يطول به الكتاب»[53].
2- محمد عليّ القَصَّاب (ت: 360هـ):
قال عند قوله تعالى: ﴿سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ﴾ [القلم: 16]: «دليل على أنّ في كلام العرب استعارة، ووضع الكلمة موضع غيرها؛ فالخرطوم للسباع أَخْبَرَ به عن الناس كما ترى... وكلُّ هذا دليل على سعة اللسان، فمن زاحم في لسانها قبل أن يعرف هذا من كلامها -وسائر ما ذكرناه من لطيف إشارتها- ركب خطة عظيمة، وأخافُ أن يخوض النار خوضًا، وهو لا يعلم»[54].
رابعًا: الأمثلة التطبيقية:
وردَت أمثلة لهذا الأسلوب عند الطبري، منها:
1- قوله تعالى: ﴿ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الخَاسِرِينَ﴾ [البقرة: 64].
قال الطبري: «يعني تعالى ذِكْره بقوله: ﴿ثُمَّ تَوَلَّيْتُم﴾: ثم أَعْرَضْتُم. وإنما هو (تَفَعَّلْتُم)، من قولهم: ولَّاني فلانٌ دُبُرَه. إذا اسْتَدْبر عنه وخلَّفه خلف ظهره، ثم يُستعمل ذلك في كلِّ تارك طاعة أمرٍ، وهاجرِ خِلٍّ، ومُعْرِضٍ بوجهه، فيقالُ: فلان قد تَوَلَّى عن طاعةِ فلانٍ، وتولَّى عن مواصلته. ومنه قول الله تعالى ذِكْره: ﴿فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ﴾ [التوبة: 76]، يعني بذلك: خالَفُوا ما كانوا وعَدُوا الله من قولهم: ﴿لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ [التوبة: 75]، ونبذوا ذلك وراء ظهورهم. ومن شأنِ العرب استعارةُ الكلمةِ ووَضْعُها مكانَ نَظيرتها... ونظائر ذلك في كلام العرب أكثر من أن تُحصى. فكذلك قوله: ﴿ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ﴾. يعني بذلك: أنّكم تركتُمُ العمل بما أخذنا ميثاقكم وعهودكم على العمل به بجد واجتهاد، بعد إعطائكم ربَّكم المواثيق على العمل به، والقيام بما أمركم به في كتابكم، فنبذتموه وراء ظهوركم»[55].
2- قوله جل جلاله: ﴿سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ﴾[الأنفال: 12].
ذكر الطبري خلاف أهل التأويل في تأويل قوله: ﴿فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ﴾، وذكر ثلاثة أقوال، ونسب كلَّ قول إلى قائله إلا القول الثالث فلم ينسبه[56]، والأقوال هي:
قال بعضهم: معناه: فاضربوا الأعناق.
وقال آخرون: بل معنى ذلك: فاضربوا الرؤوس.
وقال آخرون: معنى ذلك: فاضربوا على الأعناق. وقالوا: (على) و(فوق) معنياهما متقاربان فجاز أن يُوضَعَ أحدُهما مكانَ الآخر[57].
ثم قال: «والصواب من القول في ذلك أن يُقال: إنّ الله أمَر المؤمنين، مُعلِّمَهم كيفية قتل المشركين وضربهم بالسيف، أن يضربوا فوق الأعناق منهم والأيدي والأرجل. وقوله: ﴿فَوْقَ الْأَعْنَاقِ﴾، مُحتمل أن يكون مرادًا به الرؤوسُ، ومحتمل أن يكون مرادًا به: من فوق جلدة الأعناق، فيكون معناه: على الأعناق، وإذا احتمل ذلك صح قول مَن قال: معناه الأعناق. وإذا كان الأمر محتملًا ما ذكرنا من التأويل، لم يكن لنا أن نوجّهه إلى بعض معانيه دونَ بعض إلا بحُجّةٍ يجب التسليم لها، ولا حُجّة تدلُّ على خصوصه، فالواجب أن يُقال: إنّ الله أمَر بضربِ رؤوسِ المشركين وأعناقهم وأيديهم وأرجلهم أصحابَ نبيّه الذين شهدوا معه بدرًا»[58].
3- قوله عز وجل: ﴿لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ﴾ [الدخان: 56].
ذكر الطبري معنى الآية وأنَّ المتقين في الجنة لا يذوقون الموت بعد الموتة الأولى التي ذاقوها في الدنيا، وذكر عن بعض أهل العربية أنه جعل (إلا) في هذا الموضع بمعنى (سوى)[59]، وردَّ هذا الوجه قائلًا:
«وليس للذي قال من ذلك عندي وجه مفهوم؛ لأنَّ الأغلب من قول القائل: لا أذوقُ اليومَ الطعامَ إلا الطعام الذي ذُقته قبل اليوم. أنه يُريدُ الخبر عن قائله أنّ عنده طعامًا في ذلك اليوم، ذائقُه وطاعِمُه، دونَ سائر الأطعمة غيره. وإذا كان ذلك الأغلب من معناه، وجبَ أن يكون قد أَثْبَت بقوله: ﴿إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى﴾ موتةً من نوع الأُولى هم ذائقوها، ومعلوم أن ذلك ليس كذلك؛ لأن الله -عزَّ وجلَّ- قد آمَن أهل الجنة في الجنة إذا هم دخلوها من الموت، ولكن ذلك كما وصفتُ من معناه. وإنما جاز أن تُوضَعَ (إلا) في موضع (بعد)؛ لتقارب معنييهما في مثل هذا الموضع، ...ومن شأن العرب أن تضع الكلمة مكان غيرها إذا تقارب معنياهما... فكذلك قوله: ﴿لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الأُولَى﴾، وُضِعَت (إلا) في موضع (بعد)؛ لما وُصِفَ من تقارب معنى (إلا) و(بعد) في هذا الموضع، وكذلك: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [النساء: 22]. إنما معناه: بعد الذي سلفَ منكم في الجاهلية، فأمّا إذا وُجّهت (إلا) في هذا الموضع إلى معنى (سوى)، فإنما هو ترجمةٌ عن المكان، وبيانٌ عنها بما هو أشد التباسًا على من أراد علم معناها منها»[60].
خامسًا: أثره في التفسير:
أثَّر هذا الأسلوب في بيان معنى الآية، وفي اختلاف المفسِّرين في فهمها، وفي الترجيح بين الأقوال، وإليك التفصيل:
ففي المثال الأول: أثَّر هذا الأسلوب في بيان معنى قوله: ﴿ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ﴾ [البقرة: 64]، وذلك أنَّ أصل التولِّي: «الإعراض والإدبار عن الشَّيء بالجسم، ثم استُعمل في الإعراض عن الأمور والأديان والمعتقدات اتساعًا»[61]؛ لتقارب الإعراض الحسي (التولِّي) والمعنوي في المعنى، فأطلق عليهما اسم التولِّي، فيكون معنى الآية: ثم أعرضتم عن الإيمان، وتركتم العمل بما أخذنا عليكم من العهود والمواثيق أن تعملوه، وتركتموه وراء ظهوركم.
وفي المثال الثاني: يظهر أثر هذا الأسلوب في اختلاف المفسِّرين، وذلك أنَّ من عمل به جعل قوله تعالى: ﴿فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ﴾ [الأنفال: 12]، بمعنى (على الأعناق)؛ لتقارب (على) و(فوق) في المعنى، وإلى هذا ذهب أبو عبيدة[62]، وتبعه على ذلك أبو الليث السمرقندي[63]، والذين لم يعملوا به في هذا الموضع اختلفوا في تفسير الآية، وقد تقدّمت أقوالهم، والله الموفِّق.
وفي المثال الثالث: أثَّر هذا الأسلوب في الترجيح بين الأقوال، وذلك أنّ الإمام الطبري رأى أنّ (إلا) التي في قوله تعالى: ﴿لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى﴾ [الدخان: 56]، بمعنى (بعد)؛ لتقارب معنييهما، وكان استناده في هذا الترجيح هو أن من شأنِ العرب أن تضع الكلمة مكان غيرها إذا تقارب معنياهما، وتبعه على ذلك مكّي بن أبي طالب[64].
بينما يرى الفرّاء والزجاج أن (إلا) بمعنى (سوى)[65]، وردَّ هذا المعنى الطبري[66]، وتعقّبه ابن عطية بقوله: «وليس تضعيفه بصحيح، بل يصح المعنى بـ(سوى) ويتسق»[67].
الأسلوب العاشر: «وَضْعُ الحَرْفِ مَكانَ غيره، إذا تَقَارَب مَعْناهُما»[68]:
أولًا: توضيح الأسلوب:
من أساليب العرب وتفنُّنِهم في الخطاب وتوسُّعِهم فيه، أنهم يضعون الحرف موضع غيره، بشرط أن يكون المعنى مكشوفًا واللّبس مأمونًا، وأن يكون الحرفان متقاربين في المعنى، فأمّا إذا وقع اللبسُ أو كان الحرفان مختلفين في المعنى، فلا يضعون أحدهما موضع الآخر[69].
ثانيًا: صيغ الأسلوب:
وردَت صيغتان لهذا الأسلوب عند الطبري، وهما:
الصيغة الأولى: «وإنما يُوضَعُ الحرفُ مكان آخر غيره إذا تقارب معنياهما. فأمّا إذا اختلفت معانيهما، فغير موجود في كلامهم وضعُ أحدهما عقيب الآخر»[70].
الصيغة الثانية: «لكلِّ حرفٍ من حُرُوف المعاني[71] وجهٌ هو به أَوْلَى من غيره، فلا يصلح تحويل ذلك عنه إلى غيره، إلا بحُجّة يجب التسليم لها»[72].
من خلال النظر في هاتين الصيغتين تبيَّن أنّ الحرفين إذا لم يكونا متقاربين في المعنى، فلا يُوضع أحدهما مكان الآخر خوفًا من اللبس وذهاب المعنى؛ ولأنَّ لكلّ حرف معناه الذي وُضع له، فلا يُصرف إلى غيره إلا بحجة واضحة.
ثالثًا: دراسة الأسلوب:
اختلف النحويون -بَصْرِيُّهم وكوفِيُّهم- في نيابة الحروف ووَضْع بعضها موضع بعض على مذاهب:
المذهب الأول: جواز نيابة الحروف وإقامة بعضها مقام بعض، وممن ذهب إلى هذا القول:
1- الأخفش (215هـ):
قال: «وتكون (إلى) في موضع (مَعَ) نحو: ﴿قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّه﴾ [آل عمران: 52]، كما كانت (مِن) في معنى (على) في قوله: ﴿وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ﴾ [الأنبياء: 77]، أي: على القوم، وكما كانت الباء في معنى (على)... وكما كانت (في) في معنى (على)...»[73].
وذكر أمثلة من القرآن ومن كلام وأشعار العرب.
2- ابن قتيبة (276هـ):
قال: «باب دخول بعض حروف الصفات مكان بعض»[74].
وذكر (في) مكان (على)، والباء مكان (عن)، و(عن) مكان الباء، واللام مكان (على)، و(إلى) مكان (مع)، إلى غير ذلك من الحروف، وذكر لها أمثلة من القرآن، ومن كلام العرب وأشعارهم[75].
3- المبرِّد (285هـ):
قال: «وحروفُ الخفض يُبْدَلُ بعضُها من بعض، إذا وقع الحرفان في معنى في بعض المواضع، قال اللهُ جلّ ذِكْره: ﴿وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ﴾ [طه: 71]، أي: (على)، ولكن الجذوع إذا أحاطت دخلت (في)؛ لأنها للوعاء، يُقال: (فلان في النخل). أي: قد أحاط به»[76]. وذكر أمثلة من القرآن ومن أشعار العرب.
4- ابن السراج (316هـ):
قال في حروف الجر: «واعلم أن العرب تتسع فيها فتقيم بعضها مقام بعض إذا تقاربت المعاني، ...فإذا تقارب الحرفان فإن هذا التقارب، يصلح لمعاقبة، وإذا تباين معناهما لم يجز، ألا ترى أن رجلًا لو قال: (مررت في زيد، أو كتبت إلى القلم)، لم يكن هذا يلتبس به، فهذا حقيقة تعاقب حروف الخفض، فمتى لم يتقارب المعنى لم يَجُز»[77].
وهذا ما ذهب إليه الطبري، وهو مذهب أكثر الكوفيين[78].
المذهب الثاني: أنه لا نيابة بين الحروف، وأنّ الحرف يبقى على معناه الذي عُهد فيه إمّا بتأويل يقبله اللفظ[79]، أو بتضمين الفعل الذي تعدّى بحرف جرّ غير معتاد تعديه به معنی فعل آخر يتعدى بذلك الحرف[80]، وما لا يمكن فيه ذلك فهو من وضع أحد الحرفين موضع الآخر على سبيل الشذوذ[81]، ومن الذين ذهبوا إلى أنه لا نيابة بين الحروف:
1- الزجاج (311هـ):
قال عند قوله: ﴿مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ﴾ [آل عمران: 52]: «جاء في التفسير: مَن أنصاري مع الله، و(إلى) ههنا إنما قاربت (مع) معنى، بأنْ صار اللفظ لو عُبّر عنه بـ(مع) أفاد مثل هذا المعنى، لا أنَّ (إلى) في معنى (مع)... وقولهم إنَّ (إلى) في معنى (مع) ليس بشيء، والحروف قد تقاربت في الفائدة فيظنُّ الضعيفُ العلم باللغة أن معناهما واحد»[82].
2- النحاس (338هـ):
قال عند قوله تعالى: ﴿مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللهِ﴾ [آل عمران: 52]، بعد ذِكْره قول من قال: أي (مع الله): «وقد قال هذا بعض أهل اللغة، وذهبوا إلى أنَّ حروف الخفض يُبدل بعضها من بعض، واحتجوا بقوله تعالى: ﴿وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ﴾ [طه: 71]، قالوا: معنى (في) معنى (على). وهذا القول عند أهل النظر لا يصح، لأنّ لكلّ حرف معناه، وإنما يتفق الحرفان لتقارب المعنى، فقوله تعالى: ﴿وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ﴾ [طه: 71]، كان الجذع مشتملًا على مَنْ صُلب، ولهذا دخلت (في)؛ لأنه قد صار بمنزلة الظرف»[83].
3- ابن درستويه (ت: 347هـ):
قال: «في جواز تعاقبها -أي الحروف- إبطال حقيقة اللغة، وإفساد الحكمة فيها، والقول بخلاف ما يوجبه العقل والقياس»[84].
4- أبو هلال العسكري (ت: بعد 400هـ):
قال: «قال المحقّقون من أهل العربية: إنّ حروف الجر لا تتعاقب...؛ وذلك أنها إذا تعاقبت خرجت عن حقائقها، ووقع كلّ واحد منهما بمعنى الآخر، فأوجب ذلك أن يكون لفظان مختلفان لهما معنى واحد، فأبى المحقّقون أن يقولوا بذلك، وقال به من لا يتحقّق المعاني»[85].
وإلى هذا القول ذهب أكثر البصريين[86].
ويرى ابن جني أنّ الحروف قد يكون بعضها في موضع بعض في بعض المواضع على حسب الأحوال الداعية والمسوّغة إلى ذلك، لا في كلّ المواضع والأحوال، فقد ذكر في (باب استعمال الحروف بعضها مكان بعض) أنّ الناس تلقّوه مغسولًا ساذجًا من الصنعة، وذكر من كلامهم، فقال: «وذلك أنهم يقولون: إنّ (إلى) تكون بمعنى (مع)... ويقولون: إنّ (في) تكون بمعنى (على)... ولسنا ندفع أن يكون ذلك كما قالوا، لكنّا نقول: إنه يكون بمعناه في موضعٍ دون موضع، على حسب الأحوال الداعية إليه، والمسوّغة له، فأمّا في كلّ موضع وعلى كلّ حال فلا؛ ألا ترى أنك إن أخذت بظاهر هذا القول غُفْلًا هكذا لا مقيّدًا لزمك عليه أن تقول: سرت إلى زيد، وأنت تريد معه، وأن تقول زيد في الفرس، وأنت تريد عليه... ونحو ذلك مما يطول ويتفاحش. ولكن سنضع في ذلك رسمًا يُعمل عليه، ويؤمن التزام الشناعة لمكانه. اعلم أن الفعل إذا كان بمعنى فعلٍ آخر، وكان أحدهما يتعدّى بحرف، والآخر بآخر، فإن العرب قد تتسع فتوقع أحد الحرفين موقع صاحبه إيذانًا بأن هذا الفعل في معنى ذلك الآخر، فلذلك جيء معه بالحرف المعتاد مع ما هو في معناه، وذلك كقول الله عزّ اسمه: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ﴾ [البقرة: 187]، وأنت لا تقول: رفثت إلى المرأة وإنما تقول: رفثت بها، أو معها؛ لكنه لـمّا كان الرفث هنا في معنى الإفضاء، وكنتَ تُعَدِّي أفضيت بـ(إلى)، كقولك: أفضيت إلى المرأة، جئت بـ(إلى) مع الرفث؛ إيذانًا وإشعارًا أنه بمعناه»[87].
وذكر أمثلة أخرى من القرآن ومن كلام وأشعار العرب، ثم قال: «ووجدت في اللغة من هذا الفنّ شيئًا كثيرًا لا يكاد يُحاط به؛ ولعلّه لو جُمع أكثره لا جميعه لجاء كتابًا ضخمًا؛ وقد عرفت طريقه. فإذا مرّ بك منه فتقبَّله وَأْنَس به؛ فإنه فصل من العربية لطيف حسن، يدعو إلى الأُنس بها والفقاهة فيها»[88].
المذهب الثالث: أن نيابة الحروف وإقامة بعضها مقام بعض موقوف على السماع غير جائز القياس عليه، وإلى هذا ذهب ابن السيد البطليوسي، فيقول: «هذا الباب أجازه قوم من النحويين أكثرهم الكوفيون، ومنع منه قوم أكثرهم البصريون، وفي القولين جميعًا نظر... فإذا لم يصح إنكار المنكرين له، وكان المجيزون له لا يجيزون في كلّ موضع ثبت بهذا أنه موقوف على السماع، غير جائز القياس عليه، ووجب أن يُطلب له وجه من التأويل، يزيل الشناعة عنه، ويُعرف كيف المأخذ فيما يرِد منه، ولم أرَ للبصريين تأويلًا أحسن من قولٍ ذَكَره ابن جني في كتاب الخصائص»[89]. ثم ذكر كلام ابن جني السابق ذِكْره.
وعند التأمل في هذه الأقوال نجد أنّ مِن المجيزين لنيابة الحروف وإقامة بعضها مقام بعض مَن يشترط أن يكون الحرفان متقاربين في المعنى، وأما إذا لم يكونا متقاربين فلا يجيز ذلك؛ وإلى هذا ذهب المبرد وابن السراج، ووافقهما على ذلك الطبري، ومنهم من لم يصرّح بهذا الشرط؛ كالأخفش وابن قتيبة.
وأمّا المانعون لنيابة الحروف فإنهم لا ينكرون تقارب الحروف في المعنى، وإنما ينكرون أن تكون هذه الحروف في معنى واحد؛ لأنّ لكلّ حرف معنى خاصًّا به لا يَشْرَكُه فيه غيره؛ ولهذا لجؤوا إلى التأويل الذي يقبله اللفظ وإلى التضمين ومنهم من رأى جواز النيابة في بعض المواضع دون بعض حسب الأحوال الداعية إليه والمسوغة له، وهو ابن جني.
ومنهم من خطّأ القولين السابقين وجعل النيابة موقوفة على السماع ولا يقاس عليه، وهو ابن السيد البطليوسي.
والذي يظهر جوازه بشرطين:
الأول: أن يكون الحرفان متقاربين في المعنى، كما قرّر ذلك المبرد والطبري وابن السراج.
الثاني: أن يكون المعنى مكشوفًا واللبسُ مأمونًا، كما قرّر ذلك ابن القيم، والله أعلم[90].
رابعًا: الأمثلة التطبيقية:
وردَت أمثلة لهذا الأسلوب عند الطبري، منها:
1- قوله تعالى: ﴿وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَالُوا ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ﴾[البقرة: 14].
قال الطبري بعد ذِكْرِه معنى الآية: «فإن قال لنا قائل: أرأيتَ قوله: ﴿وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ﴾، فكيف قيل: ﴿خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ﴾، ولم يُقَل: خلوا بشياطينهم، فقد عَلِمْت أن الجاري بين الناس في كلامهم خَلَوْتُ بفلان، أكثر وأفشى من خلوت إلى فلان، ومن قولك: إن القرآن أفصحُ البيان؟
قيل: قد اختلف في ذلك أهلُ العلم بلغة العرب، فكان بعض نحويي البصرة[91] يقول: يقال: خَلَوتُ إلى فلان، إذا أريد به: خلوت إليه في الحاجة خاصَّةً، لا يحتمل -إذا قيل كذلك- إلا الخلاء إليه في قضاء الحاجة، فأمّا إذا قيل: خلوتُ به فيحتمل معنيين: أحدهما الخلاء به في الحاجة، والآخر في السخرية به، فعلى هذا القول: ﴿وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ﴾، لا شكّ أفصحُ منه لو قيل: وإذا خلوا بشياطينهم؛ لِما في قول القائل: (إذا خلوا بشياطينهم) من التباس المعنى على سامعيه الذي هو منتف عن قوله: ﴿وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ﴾، فهذا أحد الأقوال.
والقول الآخر: أن تُوَجِّه معنى قوله: ﴿وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيْطِينِهِمْ﴾: وإذا خلوا مع شياطينهم، إِذْ كانت حروف الصفات يُعاقِبُ بعضُها بعضًا، كما قال الله مخبرًا عن عيسى بن مريم أنه قال للحواريين: ﴿مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللهِ﴾ [آل عمران: 52]، يريد مع الله، وكما توضع (على) في موضع (مِن) و(في) و(عن) و(الباء)... وأمّا بعض نحويي أهل الكوفة، فإنه كان يتأوّل أن ذلك بمعنى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنّا، وإذا صرفوا خلاءهم إلى شياطينهم، فيزعُمُ أنّ الجالب لـ(إلى) المعنى الذي دلّ عليه الكلام من انصراف المنافقين عن لقاء المؤمنين إلى شياطينهم خالين بهم لا قوله: (خَلَوْا)، وعلى هذا التأويل لا يَصلُحُ في موضع (إلى) غيرها؛ لتغيّر الكلام بدخول غيرها من الحروف مكانها.
وهذا القول عندي أَوْلَى بالصواب؛ لأنَّ لكلّ حرف من حروف المعاني وجهًا هو به أَوْلَى من غيره، فلا يصلُحُ تحويل ذلك عنه إلى غيره إلا بحُجّةٍ يجب التسليم لها، ولـ(إلى) في كلّ موضع دخلت من الكلام حُكْمٌ، وغيرُ جائز سَلْبها معانيها في أماكنها»[92].
3- قوله عز وجل: ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللهُ﴾ [المائدة: 4].
ذكر الطبري معنى قوله تعالى: ﴿تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ﴾ أي: تؤدِّبون الجوارح، فتعلِّمونهن طلب الصيد لكم، مما علَّمَكم الله من التأديب الذي أدّبكم اللهُ والعلم الذي علّمكم. ثم ذكر عن بعض أهل التأويل أنَّ معنى قوله: ﴿مِمَّا عَلَّمَكُمْ﴾؛ أي: كما علّمكم الله[93]، ورَدَّ هذا المعنى قائلًا:
«ولسنا نَعْرِفُ في كلام العرب (مِنْ) بمعنى الكاف؛ لأن (مِنْ) تَدْخُلُ في كلامهم بمعنى التبعيض، والكاف بمعنى التشبيه، وإنما يُوضَعُ الحرفُ مكان آخرَ غيره إذا تقارب معنياهما، فأمّا إذا اختلفت معانيهما، فغير موجود في كلامهم وضع أحدهما عقيب الآخر، وكتابُ الله تعالى ذِكْره وتنزيله أحرى الكلام أن يُجَنَّبَ ما خرج عن المفهوم والغاية في الفصاحة مِن كلام مَنْ نزل بلسانه»[94].
3- قوله جل ثناؤه حاكيًا عن فرعون: ﴿فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ﴾ [طه: 71].
قال الطبري عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ﴾: «يقول: ولَأُصَلِّبَنَّكم على جذوع النخل، كما قال الشاعر[95]:
هُمُ صَلَبُوا العَبْدِيَّ فِي جِذْعِ نَخْلَةٍ ** فَلَا عَطَسَتْ شَيْبَانُ إِلَّا بِأَجْدَعا
يعني: على جذع نخلة، وإنما قيل: (في جُذوع)؛ لأنّ المصلوب على الخشبة يُرْفَعُ في طولها ثم يَصِيرُ عليها، فيقال: صُلب عليها»[96].
خامسًا: أثره في التفسير:
يتجلى أثر هذا الأسلوب في اختلاف المفسِّرين في معنى الآيات، وفي الفهم الصحيح لها، وإليك التفصيل:
ففي المثال الأول: أثّر هذا الأسلوب في اختلاف المفسِّرين -واختلافهم هذا نتيجة للخلاف السابق في نيابة الحروف وإقامة بعضها مقام بعض- في معنى قوله تعالى: ﴿وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ﴾ [البقرة: 14]، وذلك أن القائلين بنيابة الحروف اختلفوا على قولين:
الأول: أنّ (إلى) بمعنى الباء، فيكون المعنى: وإذا خلوا بشياطينهم، وهذا ما ذهب إليه السَّمعاني[97].
الثاني: أنها بمعنى (مع)، فيكون المعنى: وإذ خلوا مع شياطينهم، وهذا ما ذهب إليه الأخفش[98].
وأمّا القائلون بعدم نيابة الحروف في هذا الموضع فقد قالوا: إنّ الجالب لـ(إلى) ليس (خَلَوا)، وإنما المعنى الذي ضُمِّن وهو: انصراف المنافقين، فيكون المعنى: وإذا صَرفوا خلاءهم إلى شياطينهم، وهذا ما ذهب إليه ابن عطية والقرطبي[99].
ولكنَّ الإمام الطبري -وهو وإن كان من القائلين بنيابة الحروف- لم يقل بالنّيابة في هذه الآية، وصوّب أن تكون (إلى) في معناها الذي وضع لها، وذلك أنه لو قيل: إنّ (إلى) بمعنى الباء، لوقع اللبسُ في المعنى على سامعيه؛ لأن العرب لا تقول: خلوت بفلان، إلا إذا أرادت أحد أمرين: إمّا الانفراد والخلوة، وإمّا السخرية به، وإذا قالت: خلوت إلى فلان فلا تقصد إلا الخلوة والانفراد فقط، فإذا قيل في الآية بالباء، احتمل أحد الأمرين، وليست الآية على معنى السخرية، وهذا لا يرِد إذا قيل بـ(إلى)، فكان الأنسب أن تكون (إلى) في مكانها، وأيضًا أنّ لـ(إلى) حُكمًا في كلِّ موضع دخلت من الكلام، وأنها في الآية على معناها، وأمّا إذا قيل: إنها بمعنى (مع) أو الباء، فقد سُلِبَتْ من معناها، وتغيَّر الكلام بدخول غيرها من الحروف مكانها، وإن لكلِّ حرف معنى هو به أَوْلَى من غيره، فلا ينتقل إلى غيره إلا بحجة يجب التسليم بها.
وفي المثال الثاني: يظهر أثر هذا الأسلوب في الفهم الصحيح لقوله تعالى في الجوارح: ﴿تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللهُ﴾ [المائدة: 4]، أي: تؤدّبونهنَّ من التأديب الذي أدّبَكم الله، فجاءت (مِن) للتبعيض، وقد ردّ الطبري قول مَن قال: إِنَّ (مِن) في الآية بمعنى الكاف؛ لعدم التقارب بين (مِن) والكاف في المعنى، إِذْ إنَّ (مِن) في كلام العرب للتبعيض، والكاف للتشبيه، ولا تضع العرب الحرف مكان غيره إلا إذا تقارب الحرفان في المعنى.
وفي المثال الثالث: يتبيَّن أثر هذا الأسلوب في اختلاف المفسِّرين في معنى قول الله تعالى -حكاية عن فرعون-: ﴿وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ﴾ [طه: 71]، وذلك أن القائلين بنيابة الحروف قالوا: إنَّ (في) بمعنى (على)، فيكون المعنى: ولأُصَلِّبَنَّكم على جذوع النخل، وإليه ذهب مقاتل بن سليمان، والفرّاء، وأبو عبيدة[100]، وتبعهم على ذلك الطبري.
بينما يرى القائلون بعدم النيابة في هذا الموضع أنّ (في) تبقى على معناها دالة على الظرفية، وذلك أن الجذع لـمَّا كان مَقرًّا للمَصْلوب مشتمِلًا عليه اشتمال الظرف على المظروف، عُدّي الفعلُ بـ(في) التي هي للوعاء، وإلى هذا ذهب النحاس والرازي وأبو حيان[101].
الأسلوب الحادي عشر: «تَحْوِيلُ الفِعلِ عن موضعِه إذا كان المراد به مَعلُومًا»[102]:
أولًا: توضيح الأسلوب:
من سنن العرب المأثورة وتصاريف لغتهم المشهورة، قلبُ الكلام وإسنادُ الفعل إلى مَن ليس له، فيقولون: استوى العود على الحرباء، وعرضتُ الحوض على الناقة، يريدون: اسْتَوتِ الحرباء على العود، وعرضتُ الناقةَ على الحوض، وما شابه ذلك من كلامهم، يفعلون ذلك اتساعًا في الكلام لظهور المعنى عند سامعيه[103].
ثانيًا: صيغ الأسلوب:
وردَت صيغتان لهذا الأسلوب عند الطبري، وهما:
الصيغة الأولى: «... ونظائر ذلك من كلام العرب أكثر من أن تُحصى، مما تُوَجِّهُه العربُ من خبرِ ما تخبِرُ عنه إلى ما صاحبَه؛ لظهور معنى ذلك عند سامعيه، فتقول: اعرض الحوض على الناقة، وإنما تُعرَضُ الناقةُ على الحوض، وما أشبه ذلك من كلامها»[104].
الصيغة الثانية: «...وهذه الكلمة مما حَوَّلت العرب الفعل عن موضعه... ولكنهم استعملوا ذلك كذلك، لـمّا كان معلومًا المرادُ فيه»[105].
ثالثًا: دراسة الأسلوب:
لقد أشار علماء اللغة والنحو إلى هذا الأسلوب وقرّروه في كتبهم، فمنهم:
1- الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت: 170هـ):
قال: «وكذلك يُلزمون الشيء الفعلَ ولا فِعلَ، وإنما هذا على المجاز، كقول الله -جلَّ وعزَّ- في البقرة: ﴿فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ﴾ [البقرة: 16]. والتجارة لا تَربَحُ، فلمّا كان الرِّبحُ فيها نُسِبَ الفعل إليها، ومثله: ﴿جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ﴾ [الكهف: 77]...»[106].
وذكر أمثلة أخرى من كلام وأشعار العرب على ذلك.
2- سيبويه (ت: 180هـ):
قال: «هذا باب جرى مجرى الفاعل الذي يتعداه فعله إلى مفعولَيْنِ في اللفظ لا في المعنى... وتقول على هذا الحدّ: سَرَقْتُ الليلةَ أهلَ الدار، فتجْرِى الليلة على الفعل في سَعَةِ الكلام، كما قال: صِيدَ عليه يومان، ووُلِدَ له ستون عامًا، فاللفظ يجرى على قوله: هذا مُعْطي زيدٍ درهمًا، والمعنى إنّما هو في الليلة، وصِيدَ عليه في اليومين، غير أنّهم أوقعوا الفعلَ عليه لسعة الكلام... ومثلُ ما أُجْرِيَ مجرى هذا في سَعة الكلام والاستخفافِ قوله -عزّ وجلّ-: ﴿بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ﴾ [سبأ: 33]، فالليل والنهار لا يَمكُران، ولكنّ المكرَ فيهما»[107].
3- الفراء (ت: 207هـ):
قال عند قوله تعالى: ﴿فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ﴾ [هود: 28]: «وسمعتُ العرب تقول: قد عُمِّيَ عليَّ الخبر وعَمِي عليَّ، بمعنى واحد، وهذا مما حوّلت العرب الفعل إليه وليس له، وهو في الأصل لغيره؛ ألا ترى أن الرجل الذي يَعْمَى عن الخبر أو يُعَمَّى عنه، ولكنَّه في جوازه مثل قول العرب: دخل الخاتمُ في يدي والخُفُّ في رِجلي، وأنت تعلم أنّ الرِّجْل التي تدخل في الخُفّ، والأصبُعَ في الخاتم، فاستخفوا بذلك إذا كان المعنى معروفًا لا يكون لذا في حال ولذا في حال، إنما هو لواحد، فاستجازوا ذلك لهذا»[108].
ومن خلال النظر في كلام مَن تقدّم ذِكْرهم، نجد أن العرب يستجيزون تحويل الفعل عن موضعه اتساعًا في الكلام؛ لظهور المعنى، ولثقتهم بفهم السامع لذلك.
رابعًا: الأمثلة التطبيقية:
وردَت أمثلة لهذا الأسلوب عند الطبري، منها:
١- قوله تعالى: ﴿أَوْلَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ﴾ [البقرة: 16].
قال الطبري عند قوله تعالى: ﴿فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ﴾: «فإن قال قائل: فما وجه قوله: ﴿فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ﴾. وهل التجارة مما تَربَحُ أو تُوكَسُ[109]، فيقال: ربحت أو وُضِعَت؟
قيل: إنّ وجه ذلك على غير ما ظننتَ، وإنما معنى ذلك: فما ربحوا في تجارتهم لا فيما اشتروا ولا فيما شَرَوا. ولكنَّ الله -جل ثناؤه- خاطب بكتابه عربًا، فسلك في خطابه إياهم وبيانه لهم مسلَكَ خطاب بعضهم بعضًا وبيانهم المستعمل بينهم، فلما كان فصيحًا لديهم قول القائل لآخر: خاب سعيُك، ونام ليلُك، وخَسِر بيعُك. ونحو ذلك من الكلام الذي لا يَخْفى على سامعه ما يريد قائله، خاطبهم بالذي هو في منطقهم من الكلام، فقال: ﴿فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ﴾؛ إِذْ كان معقولًا عندهم أن الربح إنما هو في التجارة، كما النوم في الليل، فاكتفى بفهم المخاطبين بمعنى ذلك عن أن يُقال: فما ربحوا في تجارتهم. وإن كان ذلك معناه»[110].
2- قوله تعالى: ﴿قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَآتَانِي رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ﴾ [هود: 28].
ذكر الطبري معنى الآية، ثم ذكر خلاف القرَّاء في قراءة قوله تعالى: ﴿فَعُمِّيَتْ﴾، وذكر قراءتين:
الأولى: ﴿فَعَمِيَتْ﴾، بفتح العين وتخفيف الميم[111].
والثانية: ﴿فَعُمِّيَتْ﴾، بضم العين وتشديد الميم[112].
ثم قال: «وهذه الكلمةُ مما حَوَّلت العرب الفعل عن موضعه؛ وذلك أن الإنسان هو الذي يَعْمَى عن إبصار الحقِّ، إِذْ يَعْمَى عن إبصاره، والحقُّ لا يُوصَفُ بالعَمَى، إلا على الاستعمال الذي قد جَرَى به الكلام، وهو في جوازه لاستعمال العرب إياه، نظير قولهم: دَخَل الخاتم في يدي والخُفُّ في رِجْلي، ومعلوم أنَّ الرِّجْل هي التي تدخل في الخُفّ، والأصْبُعَ في الخاتم، ولكنهم استعملوا ذلك كذلك، لـمّا كان معلومًا المرادُ فيه»[113].
3- قال جل ثناؤه: ﴿خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ﴾ [الأنبياء: 37].
ذكر الطبري خلاف أهل التأويل في تأويل الآية، وذكر أقوالًا، ونسب بعض هذه الأقوال إلى قائليها، وخلاصة هذه الأقوال:
قال بعضهم: معناه: مِن عَجَلٍ فِي بِنْيَتِه وخَلْقه، وكان من العَجَلَة، وعلى العَجَلَة.
وقال آخرون: معناه: مِن تَعْجيلٍ في خَلْقِ اللَّهِ إِيَّاه ومِن سُرعةٍ فِيه، وعلى عَجَلٍ.
وقال آخرون: خلقه من تعجيلٍ من الأمر، بأن قيل له: كُنْ؛ فكان[114].
ثم ذكر قولًا آخر في معنى الآية، فقال:
«وقال آخرون منهم: هذا من المقلوب، وإنما هو: خُلِقَ العَجَلُ مِن الإنسان، وخُلِقَتِ العَجَلَةُ من الإنسان، وقالوا: ذلك مثل قوله: ﴿مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ﴾ [القصص: 76]، إنما هو: لَتَنُوء العصبة بها مُتَناقِلَة. وقالوا: هذا وما أشبهه في كلام العرب كثير مشهور. قالوا: وإنما كُلّم القومُ بما يعقلون. قالوا: وذلك مثل قولهم: عرَضْتُ الناقةَ، وكقولهم: إذا طلعتِ الشِّعرَى واستوى العودُ على الحرباء، أي: اسْتَوتِ الحرباء على العود... وفي إجماع أهل التأويل على خلاف هذا القول الكفاية المغنية عن الاستشهادِ على فساده بغيره»[115].
ثم رجّح القول الثاني، وهو: أنّ الإنسان خُلق من عجلٍ في خلقه، أي: على عجل وسرعة في ذلك[116].
خامسًا: أثره في التفسير:
يظهر أثر هذا الأسلوب في توضيح معنى الآية، وفي اختلاف المفسِّرين في فهمها، وفي إبراز المعاني البليغة فيها، وفي مخالفة القول المشهور عن أهل التأويل، وإليك بيان ذلك بالتفصيل:
ففي المثال الأول: كان لهذا الأسلوب أثر في توضيح قوله تعالى: ﴿فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ﴾ [البقرة: 16]؛ إِذْ قد يقول قائل: كيف أُضيف عدم الربح إلى التجارة، والتجارة لا توصف بالربح والخسارة؟!
فيُقال: إنَّ هذا جارٍ على أساليب العرب في كلامهم من إضافة الفعل إلى من ليس له؛ اتساعًا في الكلام، إذ المراد به أصحاب التجارة، فيكون المعنى: فما ربحوا في تجارتهم، وفائدةُ ذلك المبالغةُ في وصفهم بالخسارة.
يقول أبو السعود: «وإسنادُ عدمِه الذي هو عبارة عن الخسران إليها وهو لأربابها؛ بناءً على التوسّع المبنيّ على ما بينهما من الملابسة، وفائدته المبالغة في تخسيرهم لِمَا فيه من الإشعار بكثرة الخسار وعمومه المستتبع لسرايته إلى ما يُلابسهم»[117].
وكذلك أنَّ قوله تعالى: ﴿فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ﴾ أبلغ في المعنى لسامعيه من قوله: (فما ربحوا في تجارتهم)؛ لِمَا فيها من رونق العبارة وطلاوتها، ولِمَا تحويه من بلاغة الإيجاز والاختصار في العبارة[118].
وفي المثال الثاني: يتبيَّن أثر هذا الأسلوب في اختلاف المفسِّرين في تفسيرهم قراءة مَن قرأ: ﴿فَعَمِيَتْ عَلَيْكُمْ﴾ [هود: 28]، بفتح العين وتخفيف الميم؛ فمنهم من يرى أنَّ في الآية قلبًا، والمعنى فعميتم عن البَيِّنة التي أتتكم؛ لأنَّ البيِّنة لا تُوصف بالعمى، وإنما يُوصف الناسُ بالعمى؛ جريًا على استعمال العرب ذلك من تحويل الفعل إليه وليس له، وإلى هذا ذهب الفرّاء والطبري[119].
يقول مكي بن أبي طالب: «قوله: ﴿فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ﴾ [هود: 28]، مَن خفّفه من القراء حمله على معنى: فعميتم عن الأخبار التي أتتكم، وهي الرحمة فلم تؤمنوا بها ولم تَعْمَ الأخبار نفسها عنهم، ولو عَمِيت هي لكان لهم في ذلك عذر، إنما عموا هم عنها، فهو من المقلوب...»[120].
بينما يرى آخرون أنَّ الآية ليس فيها قلب، والمعنى: فخَفِيت عليكم البيِّنة؛ إِذْ لو كان فيها قلب، لكان التعدِّي بـ(عن) دون (على).
يقول أبو حيان: «والقلب عند أصحابنا مطلقًا، لا يجوز إلا في الضرورة... ولو كان ﴿فَعَمِيَتْ عَلَيْكُمْ﴾ من باب القلب، لكان التعدّي بعن دون على، ألا ترى أنك تقول: عميت عن كذا، ولا تقول: عميت على كذا»[121].
وفي المثال الثالث: أثّر العملُ بهذا الأسلوب إلى القول بمخالفة المشهور عن أهل التأويل في تأويل قوله تعالى: ﴿خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ﴾ [الأنبياء: 37]، وذلك أنّ أبا عبيدة ادّعى أنّ في الآية قلبًا، وأنَّ المعنى: خُلِق العَجَل من الإنسان، جريًا على أساليب العرب في ذلك من تحويل الفعل عن موضعه[122]، وهذا القول الذي ذهب إليه مخالفٌ للمشهور عن أهل التأويل؛ إِذ المشهور عندهم أن الآية على ترتيبها وليس فيها قَلْب، وإن اختلفت أقوالهم في معنى العجلة التي خُلِق منها الإنسان[123]؛ ولهذا عقّب الطبري على كلام أبي عبيدة، فقال: «وفي إجماع أهل التأويل على خلاف هذا القول الكفاية المغنية عن الاستشهاد على فساده بغيره»[124].
الأسلوب الثاني عشر: «إِتيَانُ (أو) دَالَّةً على مِثْلِ ما تَدُلُّ عليه (الواو)، لو كانت مَكَانَها»[125]:
أولًا: توضيح الأسلوب:
الأصل في (أو) أن تأتي بمعنى أحد الشيئين[126]؛ ولكنها قد تخرج عن أصل وضعها إلى معاني أخرى؛ كالتقسيم[127] والإباحة والإضراب وغيرها[128]، تُعْرَف هذه المعاني من خلال القرائن، وسياق الكلام[129].
ومن تلك المعاني: مطلق الجمع الذي تدلّ عليه (الواو)؛ فإنّ (أو) قد تأتي دالةً على مثل ما تدلُّ عليه الواو لو كانت مكانها؛ لتقارب معنييهما، بشرط أمن اللَّبس[130].
ومن ذلك قول سلمان -رضي الله عنه-: «لَقَدْ نَهَانَا -صلى الله عليه وسلم- أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ لِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ... أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ أَوْ بِعَظْمٍ»[131].
فـ(أو) التي في قوله -رضي الله عنه-: (بِرَجِيعٍ أَوْ بِعَظْمٍ)، ليست بمعنى أحد الشيئين، ولم ترِد للشكّ هنا؛ وإنما هي بمعنى (الواو)، أي: نهانا عن الاستنجاء بهما[132].
ثانيًا: صيغ الأسلوب:
وردَت صيغتان لهذا الأسلوب عند الطبري، وهما:
الصيغة الأولى: «...و(أو) وإن كانت في بعض الكلام تأتي بمعنى الشكّ، فإنها قد تأتي دالّة على مثل ما تدلُّ عليه الواو، إمّا بسابق من الكلام قبلها، وإمّا بما يأتي بعدها»[133].
الصيغة الثانية: «...(أو) وإن استُعملت في أماكن من أماكن (الواو) حتى يلتبس معناها ومعنى (الواو)؛ لتقارب معنييهما في بعض تلك الأماكن، فإنّ أصلها أن تأتي بمعنى أحد الاثنين، فتوجيهها إلى أصلها مَن وَجَدَ إلى ذلك سبيلًا أعجبُ إليَّ مِن إخراجها عن أصلها ومعناها المعروفِ لها»[134].
ومن خلال النظر في هاتين الصيغتين تبيَّن أنّ الأصل في (أو) أن تأتي بمعنى أحد الشيئين، وقد تأتي لمعانٍ أخرى -كالواو- على خلاف الأصل؛ ولكن إن أمكن توجيهها إلى أصلها فهو الأَولى.
ثالثًا: دراسة الأسلوب:
اختلف النحويون بصريّهم وكوفيّهم في (أو) -وخلافهم هذا مبنيّ على الخلاف السابق في نيابة الحروف وإقامة بعضها مقام بعض- هل تخرج عن معناها الأصلي من كونها دالة على أحد الشيئين إلى معنى (الواو) أو لا؟ على مذهبين:
المذهب الأول: جواز خروجها عن معناها الأصلي إلى معنى (الواو)، وممن ذهب إلى هذا القول:
1- الخليل (ت: 170هـ):
فقد ذكَرَ لـ(أو) معاني أخرى غير معناها الأصلي، وذكرَ من تلك المعاني (الواو)، وذكر لها أمثلة من القرآن الكريم، وأشعار العرب[135].
2- أبو عبيدة (ت: 210هـ):
قال عند قوله تعالى: ﴿وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ [سبأ: 24]: «مجازه: إنّا لعلى هدى، وإياكم إنكم في ضلال مبين؛ لأن العرب تضع (أو) في موضع واو الموالاة»[136].
3- الأخفش (ت: 215هـ):
قال عند قوله تعالى: ﴿فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً﴾ [البقرة: 74]: «وليس قولك: (أَوْ أَشَدُّ) كقولك: هُوَ زيدٌ أو عمرو؛ إنّما هذه (أو) التي في معنى (الواو)، نحو قولك: نَحْنُ نأكُلُ البُرَّ أَو الشعير أو الأرُزّ، كلَّ هذا نَأكُلُ»[137].
4- ابن قتيبة (ت: 276هـ):
ذكر في كتابه: (تأويل مشكل القرآن) لـ(أو) عدّة معانٍ، وذَكَر من هذه المعاني (الواو)، وذَكر لها أمثلة من القرآن ومن أشعار العرب[138].
وهذا مذهب جماعة من الكوفيين[139]، واختاره الطبري مع الأَوْلى في رأيه توجيهها إلى معناها الأصلي ما أمكن.
المذهب الثاني: أنها لا تأتي بمعنى (الواو)، وتبقى على أصل وضعها من كونها دالةً على أحد الشيئين، وممن ذهب إلى هذا القول:
1- الفراء (ت: 207هـ):
قال بعد ذِكره قول من قال إنّ معنى (أو) التي في قوله تعالى: ﴿وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ [سبأ: 24]، بمعنى (الواو): «غير أن العربية على غير ذلك، لا تكون (أو) بمنزلة الواو، ولكنها تكون في الأمر المفوّض، كما تقول: إن شئتَ فخذ درهمًا أو اثنين، فله أن يأخذ واحدًا أو اثنين، وليس له أن يأخذ ثلاثةً. وفي قول مَن لا يبصر بالعربية، ويجعل (أو) بمنزلة (الواو)، يجوز له أن يأخذ ثلاثةً؛ لأنه في قولهم بمنزلة قولك: خذ درهمًا واثنين»[140].
2- الزجاج (ت: 311هـ):
قال: «و(أو) لا تكون بمعنى (الواو)؛ لأن (الواو) معناها الاجتماع، وليس فيها دليل أنّ أحد الشيئين قبل الآخر، و(أو) معناها إفراد أحد شيئين أو أشياء»[141].
3- ابن جني (ت: 392هـ):
قال في (باب إقرار الألفاظ على أوضاعها الأُوَل، ما لم يَدْعُ داعٍ إلى التركِ والتَّحَوُّل): «من ذلك (أو) إنما أصلُ وضعها أن تكون لأحد الشيئين أين كانت وكيف تَصَرَّفت، فهي عندنا على ذلك، وإن كان بعضهم قد خَفِي عليه هذا من حالها في بعض الأحوال حتى دعاه إلى أنْ نَقَلَها عن أصل بابها»[142].
وهذا مذهب جماعة من البصريين[143].
والذي يترجح هو المذهب الأول؛ وذلك لورودِ أمثلة لا يمكن فيها حمْلُ (أو) على أصل وضعها، كحديث سلمان -رضي الله عنه- السابق ذِكْره.
ولكن يُشترط في جواز ذلك شرطان:
الأول: عند عدم وجود سبيل يبقيها على أصلها، وإلا فالأَوْلى أن تبقى على معناها المعروف، كما قرّره الطبري.
الثاني: عند أمنِ اللَّبس كما قرّره ابن هشام[144]، والله تعالى أعلم.
رابعًا: الأمثلة التطبيقية:
وردَت أمثلة لهذا الأسلوب عند الطبري، منها:
1- قوله تعالى ذِکره: ﴿مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ﴾، إلى قوله: ﴿أَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ﴾ [البقرة: 17- 19].
قال الطبري بعد ذِكْره لمعنى الآية: «فإن قال لنا قائل: أخبِرْنَا عن هذين المثلَين، أهما مثلان للمنافقين، أو أحدهما؟ فإن يكونا مثلَين للمنافقين، فكيف قيل: ﴿أَوْ كَصَيِّبٍ﴾، و(أو) تأتي بمعنى الشكّ في الكلام، ولم يُقَل: (وَكصَيِّب) بالواو التي تُلحِق المثَلَ الثاني بالمثل الأول؟ أو يكون مَثلُ القوم أحدهما، فما وجه ذِكْر الآخر بـ(أو)؟ وقد علمتَ أنَّ (أو) إذا كانت في الكلام فإنما تدخُل فيه على وجه الشَّكِّ من الـمُخبِر فيما أخبر عنه، كقول القائل: لَقِيَني أخوك أو أبوك، وإنما لقيه أحدهما؛ ولكنه جَهِلَ عَيْنَ الذي لقيه منهما، مع علمه أنّ أحدهما قد لقيه، وغير جائز في حق الله -جلَّ ثناؤه- أن يُضاف إليه الشكُّ في شيءٍ، أو عزُوبُ عِلمِ شيءٍ عنه، فيما أخبر أو ترك الخبر عنه.
قيل له: إنّ الأمر في ذلك بخلاف الذي ذهبت إليه، و(أو) وإن كانت في بعض الكلام تأتي بمعنى الشكّ، فإنها قد تأتي دالةً على مثل ما تدلُّ عليه الواو إمّا بسابق من الكلام قبلها، وإمّا بما يأتي بعدها... فكذلك ذلك في قول الله -جل ثناؤه-: ﴿أَوْ كَصَيِّبٍ﴾، لـمَّا كان معلومًا أن (أو) دالة في ذلك على مثل الذي كانت تدلُّ عليه (الواو) لو كانت مكانها، كان سواءً نَطَق فيه بـ(أو) أو بـ(الواو)»[145].
2- قوله جل ثناؤه: ﴿ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً﴾ [البقرة: 74].
قال الطبري بعد ذكره معنى الآية: «فإن سأل سائل، فقال: وما وجه قوله: ﴿فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً﴾، و(أو) عند أهل العربية إنما تأتي في الكلام لمعنى الشكّ، والله تعالى -جلَّ ذِكره- غير جائز في خبره الشكّ؟
قيل: إن ذلك على غير الوجه الذي توهَّمْتَه أنه شكٌّ من من الله -جلَّ ذكره- فيما أخبر عنه؛ ولكنه خبرٌ منه عن قلوبهم القاسية أنها -عند عبادِه الذين هم أصحابها الذين كذَّبوا بالحق بعد ما رأوا العظيم من آيات الله- كالحجارة قسوةً أو أشدُّ من الحجارة عندهم وعند من عرف شأنهم، وقد قال في ذلك جماعة من أهل العربية أقوالًا...»[146].
ثم ذكر هذه الأقوال، وخلاصتها ما يأتي:
الأول: إنّ إتيان (أو) في الآية للإبهام على المخاطب، مع العلم بأيِّ ذلك كان، كقول القائل: أكلتُ بُسْرةً أو رُطَبَةً، وهو عالـِمٌ أيَّ ذلك أكَلَ؛ ولكنه أبهم على المخاطب.
الثاني: إنّ الخبر بـ(أو)، ليس للشكّ، وإنما معناه أنه لم يخرج عن هذين المثَلَين؛ فبعضها كالحجارة قسوةً، وبعضها أشدُّ قسوةً من الحجارة.
الثالث: إنّ (أو) بمعنى (الواو)، فيكون المعنى: وأشدُّ قسوة.
الرابع: إنّ (أو) بمعنى (بل)، فيكون المعنى: بل أشدُّ قسوة.
الخامس: معنى ذلك: فهي كالحجارة أو أشدّ قسوة عندكم[147].
ثم قال: «ولكلٍّ مما قيل من هذه الأقوال التي حكينا وجهٌ ومَخْرج في كلام العرب، غير أن أعجبَ الأقوال إليَّ في ذلك ما قلناه أوَّلًا، ثم القول الذي ذكرناه عمَّن وجَّه ذلك إلى أنه بمعنى: فهي أوجه في القسوة من أن تكون كالحجارة أو أشَدّ، على تأويل أنّ منها كالحجارة، ومنها أشد قسوة؛ لأن (أو) وإن استُعملت في أماكن من أماكن (الواو) حتى يلتبس معناها ومعنى (الواو)؛ لتقارب معنييهما في بعض تلك الأماكن، فإنّ أصلها أن تأتي بمعنى أحد الاثنين، فتوجيهها إلى أصلها مَن وَجَدَ إلى ذلك سبيلًا أعجبُ إليَّ مِن إخراجها عن أصلها ومعناها المعروفِ لها»[148].
3- قوله عز وجل: ﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ [سبأ: 24].
ذكر الطبري خلاف أهل العربية في وجه دخول (أو) في الآية وذكَر ثلاثة أقوال، وخلاصتها ما يأتي:
الأول: إنّ دخول (أو) ليس للشكّ، ولكن هذا في كلام العرب على أنه هو المهتدي، كقول السَّيد لعبده: أحدُنا ضاربٌ صاحبَه، ولا يكون فيه إشكال على السامع أنّ السيد هو الضارب.
الثاني: إنّ (أو) بمعنى (الواو)، فيكون المعنى: إنَّا لعلى هُدى وإنكم إياكم في ضلالٍ مبين.
الثالث: إنّ (أو) لا تكون بمنزلة (الواو)؛ ولكنها تكون في الأمر الـمُفوَّض، أي: في أحد المعنيين، فيكون المعنى: إنّا لضالُّون أو مهتدون، وإنكم أيضًا لضالون أو مهتدون، وهو يعلم أنّ رسوله المهتدي وأنّ غيره الضالّ[149].
ثم قال: «والصواب من القول في ذلك عندي، أنّ ذلك أمرٌ مِن الله لنبيّه بتكذيب مَن أمره بخطابه بهذا القول بأحسن التكذيب، كما يقول الرجل لصاحب له يخاطبه وهو يريد تكذيبه في خبر له: أحدنا كاذب، وقائلُ ذلك يعني صاحبه لا نفسه؛ فلهذا المعنى صَيَّر الكلامَ بـ(أو)»[150].
خامسًا: أثره في التفسير:
عند النظر في الأمثلة السابقة يظهر أثر هذا الأسلوب في دفع إشكال قد يرِد في معنى الآيات، وفي اختلاف المفسِّرين، وإليك تفصيل ذلك:
ففي المثال الأول: يتبيَّن أثر هذا الأسلوب في دفع إشكال قد يرِد في معنى قوله تعالى: ﴿مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا﴾، ثم قال: ﴿أَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّمَاءِ﴾ [البقرة: 17، 19]، وهو إن كان هذان المثلان مضروبين للمنافقين، فلماذا جيء بـ(أو)، التي تأتي في الكلام بمعنى الشك؟ وإن كان مثَلُ القوم أحدهما، فما وجه ذكر الآخر بـ(أو)؟ وغير جائز في حق الله -جل ثناؤه- أن يُضاف إليه الشكّ تعالى وتقدَّس.
فيقال في الجواب عن ذلك: إنّ من أساليب العرب وتفننهم في الخطاب الإتيان بـ(أو) في مكان (الواو)؛ لتقارب معنييهما، والقرآن عربي نزل بلغة العرب، وهذه الآية جاءت كذلك على نحو سننهم وليست للشك، فيزول حينئذ الإشكال. وكذلك يظهر أثر هذا الأسلوب في اختلاف المفسِّرين في معنى (أو) التي في الآية: هل تبقى على أصل وضعها، أو تخرج عنه؟ ونتج عن هذا الخلافِ خلافٌ آخر، يأتي بيانه بإذن الله تعالى.
فمَن رأى جواز خروجها عن أصلها اختلفوا على معنيين:
الأول: أنها بمعنى (الواو)، وهذا ما ذهب إليه الطبري[151].
الثاني: أنها بمعنى (بل)، وهذا ما حكاه الرازي[152].
ومَن رأى عدم خروجها عن أصلها في هذا الموضع، اختلفوا على معنيين كذلك:
الأول: أنها بمعنى التفصيل؛ أي: إنّ الناظرين في حالهم وأصنافهم، منهم من يُشبِّههم بحال المستوقد الذي هذه صفته، ومنهم من يُشبِّههم بحال ذوي صيِّبٍ هذه صفتُهُ، وهذا ما ذهب إليه أبو حيان وابن عادل[153].
الثاني: أنها بمعنى التخيير، أي: أنت مخيَّر بين هذين المثلين؛ فَلَك أن تمثِّلهم بهذا، أو بهذا، وهذا ما ذهب إليه ابن عطية والبيضاوي[154].
ونتج عن هذا الخلاف خلاف آخر، وهو: هل هذان المثلان ضُربَا لصنفٍ واحدٍ من المنافقين أو لصنفين؟
فمَن جعل (أو) بمعنى التخيير أو (الواو)، أو (بل)، كان هذان المثلان مضروبين لصنف واحد من المنافقين.
ومَن جعلها بمعنى التفصيل كانا مضروبين لصنفين من المنافقين كلُّ مَثَلٍ منهما ضُرب لصنف منهم يَتَّفق مع صفته وحاله، وهذا الذي رجحه ابن کثير[155].
وفي المثال الثاني: يتبيَّن أثر هذا الأسلوب في دفع إشكال قد يرِد في معنى قوله تعالى: ﴿ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسَوَةً﴾ [البقرة: 74]، وهو أنّ (أو) تأتي في الكلام لمعنى الشك، وغير جائز في كلام الله وخبره الشكّ، تعالى وتقدَّس سبحانه.
فيقال في الجواب عن ذلك: إنّ (أو) في الآية ليست للشك، وإنما جاءت بمعنى (الواو)، كما تفعله العرب في كلامها، فيكون المعنى: فهي كالحجارة وأشدّ قسوةً منها، فيزول حينئذ الإشكال.
وكذلك كان لهذا الأسلوب أثر في اختلاف المفسِّرين في معنى (أو) في الآية -وهذا الخلاف شبيه بالخلاف السابق ذكره في المثال الأول- فمَن رأى جواز خروجها عن أصل وضعها اختلفوا على معنيين:
الأول: أنها بمعنى (الواو)، وهذا ما ذهب إليه الأخفش[156].
الثاني: أنها بمعنى (بل)، وهذا ما ذهب إليه الخليل[157].
ومَن رأى عدم خروجها عن أصلها في هذا الموضع اختلفوا على عدّة معان، منها:
الأول: معنى ذلك أن قلوبهم كالحجارة قسوة أو أشدّ من الحجارة عندهم وعند مَن عَرف شأنهم، وهذا ما ذهب إليه الطبري[158].
الثاني: أن (أو) للتنويع فيكون المعنى كأنّ قلوبهم على قسمين: قلوب كالحجارة قسوة، وقلوب أشد قسوة منها، وهذا ما ذهب إليه أبو حيان[159].
الثالث: أنها للتخيير بمعنى: إنْ شئتَ شبهتهم بهذا أو بهذا، مع جواز كونها للشك والتردد؛ ولكن في نظر المخاطبين، بمعنى أنهم شكُّوا أهي كالحجارة أو أشد قسوة منها؟ وهذا ما ذهب إليه البيضاوي وأبو السعود[160].
ونتج عن هذا الخلاف خلاف آخر، وهو: هل هذا التشبيه ضُرب لصنف واحد من الكفار أو لصنفين؟
فمَن جعل (أو) للتخيير، أو بمعنى (الواو)، أو (بل)، كان التشبيه مضروبًا لصنفٍ واحدٍ من الكفار، ومَن جعلها للتنويع كان مضروبًا لصنفين من الكفار؛ صنف قلوبهم كالحجارة قسوة، وصنف آخر قلوبهم أشد قسوة منها، وهذا الذي رجّحه ابن كثير[161].
وفي المثال الثالث: يتجلّى أثر هذا الأسلوب في دفع إشكال قد يرِد في قوله -تعالى ذِكْره- لنبيه محمد -صلى الله عليه وسلم-: ﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ [سبأ: 24]، وهو أنّ (أو) في كلام العرب تأتي للشك، ولا يُتَصوّر أن يكون النبي -صلى الله عليه وسلم- شاكًّا في أنه على هدى وغيره على ضلال، فما وجه دخول (أو) في الآية إذًا؟
فيُقال في الجواب على ذلك: إنّ (أو) في الآية ليست للشك، ولم يكن النبي -صلى الله عليه وسلم- شاكًّا في أنه على هدى مستقيم وأنّ الكفار على ضلال مبين؛ ولكنها جاءت بمعنى (الواو) فيكون المعنى: إنّا لعلى هدى وإياكم إنكم في ضلال مبين، فيزول حينئذ الإشكال.
وهذا التوجيه على قول مَن رأى أنّ (أو) خرجت عن أصل وضعها إلى معنى (الواو)، وهذا ما ذهب إليه أبو عبيدة[162]؛ ولكن الفرّاء والطبري، وتبعهما على ذلك أبو حيان، رأوا أن تبقى على أصلها من كونها دالةً على أحد الشيئين، ووجّهوا الآية بأنها جارية على جهة التلطّف في الخطاب مع الخصم وإرخاء العنان له؛ ليكون ذلك سببًا في قبوله الحق؛ لأنّ الردّ بالتعريض أبلغ من التصريح، كقول الرجل لصاحبٍ له: أحدنا كاذب، وهو بلا شك لا يعني نفسه، وإنما يعنيه[163].
[1] هذه المقالة من كتاب (الأساليب العربية الواردة في القرآن الكريم وأثرها في التفسير، من خلال جامع البيان للطبري)، الصادر عن مركز تفسير سنة 1436هـ، ص123 وما بعدها، وقد قسمنا مادة هذا الفصل على مقالتين، تناولت كلّ منهما ستة أساليب من مجموع اثني عشر أسلوبًا متعلقًا بأحكام الكلمة حال الإفراد، ويُراجَع الجزء الأول منها على هذا الرابط: tafsir.net/article/5590. (موقع تفسير)
[2] انظر: جامع البيان (1/ 603).
[3] انظر: توضيح المقاصد والمسالك (2/ 359)؛ وهمع الهوامع، للسيوطي (1/ 190)؛ ومعاني النحو، لفاضل السامرائي (1/ 61، 62).
[4] انظر: تأويل مشكل القرآن ص(174)؛ وهمع الهوامع (1/ 219).
[5] أخرجه البخاري في صحيحه (1/ 90) في كتاب الوضوء، باب (بدون)، برقم (218)؛ ومسلم في صحيحه ص(139)، في كتاب الطهارة، باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه، برقم (292).
[6] انظر: فتح الباري (1/ 414).
[7] جامع البيان: (1/ 603).
[8] جامع البيان (13/ 275)؛ وانظر إلى صيغة أخرى (2/ 73).
[9] معاني القرآن (3/ 174).
[10] غريب الحديث لأبي عبيد (2/ 444، 445).
[11] تأويل مشكل القرآن (2/ 562، 563)؛ وانظر: الصاحبي في فقه اللغة ص(256)؛ وفقه اللغة، للثعالبي (2/ 562، 563).
[12] انظر: جامع البيان (2/ 68، 69).
[13] جامع البيان (2/ 72، 73).
[14] انظر: معاني القرآن، للفراء (1/ 362).
[15] البيت في ديوانه، ص(210).
[16] جامع البيان (13/ 275، 276).
[17] هو المُثَقَّب العبدي، وهو في ديوانه ص(212، 213)، بلفظ: (... أم الشرُّ الذي هو يبتغيني).
[18] جامع البيان (19/ 403)؛ وانظر: معاني القرآن، للفراء (2/ 258)؛ وينظر أمثلة أخرى للطبري: (1/ 603)، (7/ 674، 675) (8/ 479)، (112/ 322)، (13/ 470)، (14/ 402)، (15/ 122)، (16/ 41، 42)، (21/ 532)، (24/ 437، 580).
[19] انظر: معاني القرآن (1/ 41).
[20] انظر: جامع البيان (2/ 72).
[21] انظر: جامع البيان (2/ 176).
[22] انظر: تفسير القرآن العظيم (1/ 440).
[23] انظر: جامع البيان (2/ 69).
[24] انظر: معاني القرآن، للأخفش، ص(82).
[25] انظر: جامع البيان (13/ 275، 276)، ومعاني القرآن، للزجاج (3/ 123)، وذهب إلى هذا القول الزمخشري في الكشاف (3/ 311)؛ وابن كثير في تفسيره (8/ 61).
[26] انظر: البحر المحيط (5/ 329)؛ وفتح القدير، للشوكاني (3/ 62)؛ والتحرير والتنوير (13/ 34، 35).
[27] انظر: معاني القرآن، للفراء (2/ 258)؛ وجامع البيان (19/ 403)؛ ومعاني القرآن الكريم، للنَّحاس (5/ 477)، وإلى هذا القول ذهب مكي بن أبي طالب، انظر: الهداية إلى بلوغ النّهاية، له: (9/ 6005).
[28] انظر: الكشاف (5/ 166).
[29] الكشاف (5/ 167).
[30] انظر: إرشاد العقل السليم (5/ 291).
[31] انظر: الانتصاف من الكشاف، لابن المنير، مطبوع بهامش الكشاف (5/ 166، 176)، حاشية رقم (4).
[32] انظر: جامع البيان (12/ 578) بتصرف يسير في العبارة.
[33] السَّمير: الدهر، وابناه: الليل والنهار، والمعنى: ما تعاقب الليل والنهار، أي: الدهرُ كلُّه؛ وإنما قيل للدَّهر سمير؛ لإتباع بعضه بعضًا، كإتباع المتسامرين حديثهما، إذا فرغ أحدهما تبعه الآخر. انظر: المحكم والمحيط الأعظم (8/ 492)، والمستقصي في أمثال العرب للزمخشري (2/ 249).
[34] العُفْر: الظباء، والمعنى: ما حركت الظباء أذنابها. انظر جمهرة اللغة، لابن دريد (3/ 288) باب اللام في الهمز؛ وحياة الحيوان الكبرى، للدميري (2/ 178) باب الفاء.
[35] جامع البيان: (12/ 578).
[36] النِّيبُ: جمع ناب، والناب: الناقة الـمُسِنَّة، سموها بذلك حين طال نابها وعظم، انظر مادة (نيب) في لسان العرب (6/ 4591)، وتاج العروس (4/ 322، 323)، ومعنى حنَّت النِّيبُ: ذكَرَت أوطانها، وقيل: حنينها رغبتها في الوطء، وفيه نوع من التيئيس؛ لأنَّ الناقة الـمُسِنَّة لا تُنتج؛ لضعف رغبتها في الوطء، انظر كتاب: الأمثال، لأبي الخير الهاشمي، ص(225)؛ والمستقصي في أمثال العرب (1/ 89).
[37] أَطَّتِ الإبلُ أنَّت تعبًا، أو حنينًا، وقيل: الأطيط صوت الرَّحل والإبل من ثقل أحمالها، انظر كتاب: الأمالي في لغة العرب، لأبي عليّ القالي (1/ 233)، والمحكم والمحيط الأعظم (9/ 198)، ولسان العرب (1/ 92)، مادة (أطط).
[38] كتاب الأمثال، لأبي عبيد، ص(380).
[39] تأويل مشكل القرآن، ص(54).
[40] أي: ما كانت في بحر قطرة، انظر: إصلاح المنطق، لابن السكيت، ص(393)؛ والمحكم والمحيط الأعظم (10/ 477).
[41] مجالس ثعلب (1/ 321)؛ وانظر كتاب: خواص الخواص، لأبي منصور الثعالبي، ص(56).
[42] جامع البيان (12/ 578، 579).
[43] نُسب القول بفناء النار إلى بعض الصحابة كعمر بن الخطاب وابن مسعود وابن عمرو وغيرهم -رضي الله عنهم-، ذكر بعض هذه الآثار الطبري في جامع البيان (12/ 582)، والبغوي في معالم التنزيل (4/ 201، 202)، وابن القيم في حادي الأرواح، ص(435- 446)، وقد ذكر هذه الآثار سليمان العلوان وتكلّم على أسانيدها، وقال: إنه لم يصح شيء عن الصحابة في فناء النار، فنسبة القول إليهم بفناء النار خطأ قطعًا يجب إنكاره. انظر: الأدلة والبراهين لإيضاح المعتقد السليم، لسليمان العلوان، ص(22)، وعلى التسليم بصحتها فمرادهم: أن لا يبقى فيها أحد من أهل الإيمان، وأمّا مواضع الكفار فممتلئة أبدًا. انظر: معالم التنزيل (4/ 202).
[44] انظر: مفاتيح الغيب، للرازي (18/ 64، 65)؛ واللباب في علوم الكتاب (10/ 568، 569).
[45] انظر: جامع البيان (12/ 68).
[46] انظر: تهذيب اللغة (11/ 351)، والقاموس المحيط، ص(442)، مادة (شفر).
[47] انظر: تأويل مشكل القرآن، ص(116).
[48] انظر: تهذيب اللغة (11/ 351)، مادة (شفر).
[49] جامع البيان (2/ 55).
[50] نلاحظ أن مفهوم الاستعارة عند الطبري يتفق مع أصل معناها اللغوي الذي وُضعت له، فالاستعارة في اللغة تدل على طلب العارية، تقول: استعرتُ منه الشيء وأعرته إياه، انظر: لسان العرب (4/ 3168) مادة (عور)، فكذلك الكلمة حين تنقلها من مكانها الأصلي إلى غير موضعها، فإنها تشبه العارية التي تنتقل من صاحبها الأصلي إلى الآخر، فالطبري اكتفى بالمعنى اللغوي للاستعارة، وأمّا الاستعارة عند البلاغيين، فهي: (تشبيهٌ حُذف أحد طرفيه، وعلاقته المشابهة دائمًا)، انظر: علم البيان، لعبد العزيز عتيق، ص(173- 175).
[51] جامع البيان (13/ 120).
[52] جامع البيان (21/ 69).
[53] تأويل مشكل القرآن، ص(102، 103).
[54] نكت القرآن الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام، للقَصَّاب (4/ 380، 381). وانظر: (1/ 211، 212)، (3/ 564)، (4/ 220، 221).
[55] جامع البيان (2/ 54- 56).
[56] وهو قول أبي عبيدة في مجاز القرآن (1/ 242).
[57] انظر: جامع البيان (11/ 69- 71).
[58] جامع البيان (11/ 71).
[59] وهو الفراء في معاني القرآن (2/ 335)؛ وانظر: جامع البيان (21/ 67).
[60] جامع البيان (21/ 67- 69)؛ وانظر أمثلة أخرى: (1/ 228- 231)، (4/ 135، 443، 444)، (5/ 667)، (7/ 456)، (9/ 258)، (12/ 121)، (13/ 120)، (18/ 397، 398)، (23/ 297).
[61] المحرر الوجيز (1/ 159).
[62] انظر: مجاز القرآن (1/ 242).
[63] انظر: بحر العلوم، للسمرقندي (2/ 10).
[64] انظر: الهداية إلى بلوغ النهاية (10/ 6760).
[65] انظر: معاني القرآن، للفراء (2/ 335)؛ ومعاني القرآن، للزجاج (4/ 428).
[66] انظر: جامع البيان (21/ 67- 69).
[67] المحرر الوجيز (5/ 78).
[68] انظر: جامع البيان (8/ 108).
[69] انظر: بدائع الفوائد، لابن القيم (1/ 357)، (3/ 945).
[70] جامع البيان (8/ 108).
[71] المراد بحروف المعاني: هي الحروف التي تفيد معنى مختصًّا بها؛ كحروف الجر، وتسمى عند الكوفيين بحروف الصفات وحروف الإضافة؛ لأنها تحدث في الاسم صفة من ظرفية أو غيرها؛ ولأنها تضيف الاسم إلى الفعل، أي: توصله إليه وتربطه به، انظر: همع الهوامع (2/ 331)؛ والكليات، للكفوي، ص(394، 395).
[72] جامع البيان (1/ 310، 311).
[73] معاني القرآن، للأخفش (1/ 51).
[74] تأويل مشكل القرآن، ص(426).
[75] انظر: تأويل مشكل القرآن، ص(426- 432)؛ وأدب الكاتب، ص(331- 344).
[76] الكامل، للمبرد (2/ 1000، 1001).
[77] الأصول في النحو، لابن السّراج (1/ 414، 415).
[78] انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام (21/ 123، 124)؛ والجنى الداني في حروف المعاني، للمرادي، ص(46)؛ ومغني اللبيب (2/ 180- 181).
[79] كما قيل في قوله تعالى: ﴿وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ﴾ [طه: 71]: إن (في) ليست بمعنى (على) ولكن شبه المصلوب لتمكنه من الجذع بالحالّ في الشيء، انظر: معاني القرآن، للنحاس (1/ 405)، ومغنى اللبيب (2/ 179، 180).
[80] وفائدته -أي التضمين- أن تُؤدِّي كلمةٌ مُؤَدَّى كلمتين، كقوله: (سمع الله لمن حمده)، أي: استجاب الله لمن حمده، فعدَّى (سمع) باللام، وإنما أصله أن يتعدى بنفسه، انظر: مغني اللبيب (6/ 671)، ومعاني النحو (3/ 12).
[81] انظر: الجنى الداني، ص(46)، ومغني اللبيب (2/ 179، 180).
[82] معاني القرآن، للزجاج (1/ 416).
[83] معاني القرآن، للنحاس (1/ 405).
[84] انظر: الفروق اللغوية، لأبي هلال العسكري، ص(36).
[85] الفروق اللغوية، ص(36).
[86] انظر: الإنصاف في مسائل الخلاف، لأبي البركات الأنباري، ص(384).
[87] الخصائص (2/ 307، 308)، ومجموع الفتاوى (21/ 123، 124)، والجنى الداني، ص(46)، ومغني اللبيب (2/ 179، 180).
[88] الخصائص (2/ 310).
[89] الاقتضاب في شرح أدب الكاتب، لابن السيد البطليوسي (1/ 338، 339).
[90] انظر: بدائع الفوائد، لابن القيم (1/ 357)، (3/ 945).
[91] انظر: معاني القرآن، للأخفش (1/ 51).
[92] جامع البيان (1/ 309- 311).
[93] وهو السدي، انظر: جامع البيان (8/ 108).
[94] جامع البيان (8/ 108).
[95] وهو سويد بن أبي كاهل، كما في الكشف والبيان، للثعلبي (6/ 253)، ولسان العرب (4/ 2325) مادة (شمس)، ونُسب هذا البيت لامرأة من العرب، كما في الخصائص (2/ 313)، وبلا نسبة في أدب الكاتب، ص(334)، والكامل، للمبرد (2/ 1001)، ومغني اللبيب (2/ 515).
[96] جامع البيان (16/ 115)؛ وانظر أمثلة أخرى: (2/ 321)، (3/ 718)، (5/ 436)، (6/ 316)، (9/ 101، 206، 207)، (12/ 262، 263، 375)، (13/ 591، 592، 608)، (17/ 367)، (18/ 43)، (19/ 657)، (20/ 190، 485).
[97] انظر: تفسير القرآن، للسمعاني (1/ 50).
[98] انظر: معاني القرآن، للأخفش (1/ 51).
[99] انظر: المحرر الوجيز (1/ 96)؛ والجامع لأحكام القرآن، للقرطبي (1/ 313).
[100] انظر: تفسير مقاتل (2/ 334)، (3/ 286)؛ ومعاني القرآن، للفراء (2/ 102)؛ ومجاز القرآن (2/ 23، 24).
[101] انظر: معاني القرآن، للنحاس (1/ 405)؛ ومفاتيح الغيب، للرازي (22/ 87)؛ والبحر المحيط (6/ 242، 243).
[102] انظر: جامع البيان (12/ 382)، مع تصرف في الصياغة.
[103] انظر: الكتاب، لسيبويه (1/ 175، 176)، ودُرَّة الغواص، للحريري، ص(53، 54).
[104] جامع البيان (3/ 48، 49).
[105] جامع البيان (12/ 382).
[106] الجُمَل في النحو، للخليل، ص(44).
[107] الكتاب، لسيبويه (1/ 175، 176).
[108] معاني القرآن، للفراء (1/ 330، 331)؛ وانظر: الكامل، للمبرد (1/ 475).
[109] الوكس يأتي بمعنى النقص والخسران، انظر: مقاييس اللغة (6/ 139)، ولسان العرب (6/ 4906)، مادة (وكس).
[110] جامع البيان (1/ 330، 331).
[111] وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو ونافع وابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر، انظر كتاب: السَّبعة في القراءات، لأبي بكر بن مجاهد التميمي، ص(332)؛ والنشر في القراءات العشر، لابن الجزري (2/ 288)؛ وحجة القراءات، لابن زنجلة، ص(339).
[112] وهي قراءة حمزة والكسائي وحفص، انظر كتاب: السبعة في القراءات، ص(332)؛ والنشر في القراءات العشر، لابن الجزري (2/ 288)، وحجة القراءات، ص(338).
[113] جامع البيان (12/ 382)؛ وانظر: معاني القرآن، للفراء (1/ 330، 331).
[114] انظر: جامع البيان (16/ 270- 273).
[115] جامع البيان (16/ 273، 274).
[116] انظر: جامع البيان (16/ 274، 275)؛ وانظر أمثلة أخرى: (3/ 48، 49)، (13/ 39)، (18/ 289، 290، 317- 319).
[117] إرشاد العقل السليم (1/ 68).
[118] انظر: المحكم والمحيط الأعظم، لابن سيده (3/ 322)؛ ودلائل الإعجاز، للجرجاني، ص(294، 295).
[119] انظر: معاني القرآن، للفراء (1/ 330، 331)، وجامع البيان (12/ 382).
[120] مشكل إعراب القرآن، لمكي (1/ 360).
[121] البحر المحيط (5/ 216، 217).
[122] انظر: مجاز القرآن (2/ 38- 39)، وتبعه على ذلك الزجاج، انظر كتابه: معاني القرآن (3/ 392).
[123] انظر أقوالهم في جامع البيان (16/ 270- 274)، والهداية إلى بلوغ النهاية (7/ 4755- 4757)، والدر المنثور في التفسير بالمأثور، للسيوطي (10/ 294، 295).
[124] جامع البيان (16/ 274).
[125] انظر: جامع البيان (1/ 354، 355).
[126] انظر: جامع البيان (2/ 133)، والخصائص (2/ 457).
[127] نحو قولهم: الكلمة اسم أو فعل أو حرف، ومجيء (الواو) في التقسيم أجود، انظر: مغني اللبيب (1/ 424، 425).
[128] لمعرفة هذه المعاني، انظر: الجنى الداني في حروف المعاني، ص(228- 232)، ومغني اللبيب (1/ 398- 435)، وهمع الهوامع (3/ 173- 176).
[129] انظر: الجنى الداني، ص(231).
[130] انظر: أوضح المسالك (3/ 337).
[131] أخرجه مسلم في صحيحه، ص(129)، في كتاب الطهارة، باب الاستطابة، برقم (262).
[132] انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود، لمحمد آبادي (1/ 26).
[133] جامع البيان (1/ 354).
[134] جامع البيان (2/ 133).
[135] انظر: الجُمل في النحو، ص(289، 290)، والعين، للخليل (8/ 438، 439).
[136] انظر: مجاز القرآن (2/ 148).
[137] معاني القرآن، للأخفش (1/ 115).
[138] انظر: تأويل مشكل القرآن، ص(414، 415).
[139] انظر: الإنصاف في مسائل الخلاف، ص(383)، والجنى الداني في حروف المعاني، ص(229، 230)، ومغني اللبيب (1/ 405).
[140] معاني القرآن، للفراء (2/ 248).
[141] انظر: معاني القرآن، للزجاج (4/ 314).
[142] الخصائص (2/ 457).
[143] انظر: الإنصاف في مسائل الخلاف، ص(383، 384).
[144] انظر: أوضح المسالك (3/ 337).
[145] جامع البيان (1/ 354- 356).
[146] جامع البيان (2/ 130، 131).
[147] انظر: جامع البيان (2/ 131- 133).
[148] جامع البيان (2/ 133).
[149] انظر: جامع البيان (19/ 284- 286).
[150] جامع البيان (19/ 286)، وانظر أمثلة أخرى: (7/ 588)، (10/ 60)، (21/ 535)، (22/ 417)، (23/ 573).
[151] انظر: جامع البيان (1/ 354- 356).
[152] انظر: مفاتيح الغيب، للرازي (2/ 86).
[153] انظر: البحر المحيط (1/ 221)، واللباب في علوم الكتاب (1/ 385).
[154] انظر: المحرر الوجيز (1/ 101)، وأنوار التنزيل، للبيضاوي (1/ 51).
[155] انظر: تفسير القرآن العظيم (1/ 300، 303، 306).
[156] انظر: معاني القرآن، للأخفش (1/ 115).
[157] انظر: الجمل في النحو، ص(293).
[158] انظر: جامع البيان (2/ 133).
[159] انظر: البحر المحيط (1/ 428).
[160] انظر: أنوار التنزيل، للبيضاوي (1/ 88)، وإرشاد العقل السليم (1/ 149).
[161] انظر: تفسير القرآن العظيم (1/ 459).
[162] انظر: مجاز القرآن (2/ 148).
[163] انظر: معاني القرآن، للفراء (2/ 248)، وجامع البيان (19/ 286)، والبحر المحيط (7/ 267، 268).
كلمات مفتاحية
الكاتب:

فواز بن منصَّر سالم الشاووش
حاصل على الدكتوراه في التفسير وعلوم القرآن من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وله عدد من المشاركات العلمية.
مواضيع ذات صلة
((المعلومات والآراء المقدَّمة هي للكتّاب، ولا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع أو أسرة مركز تفسير))