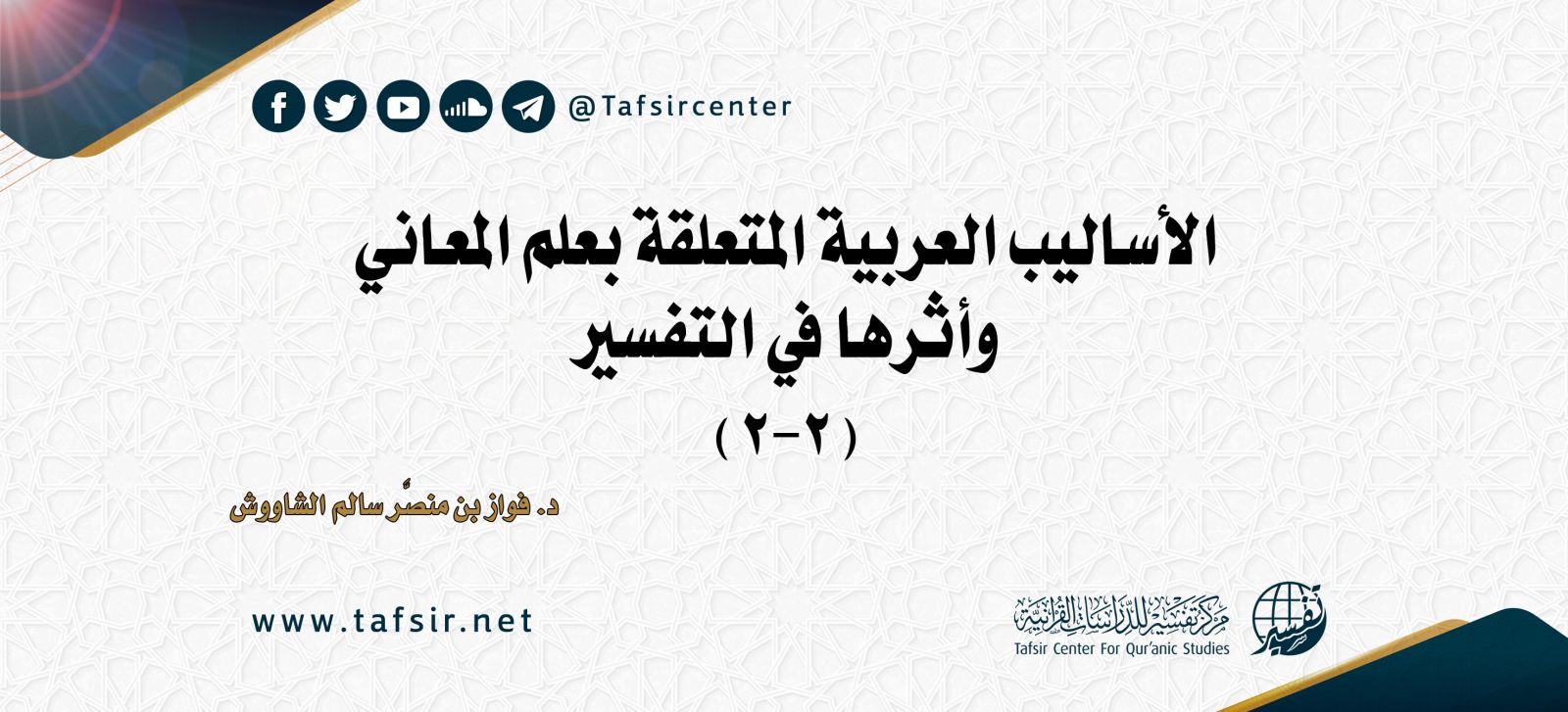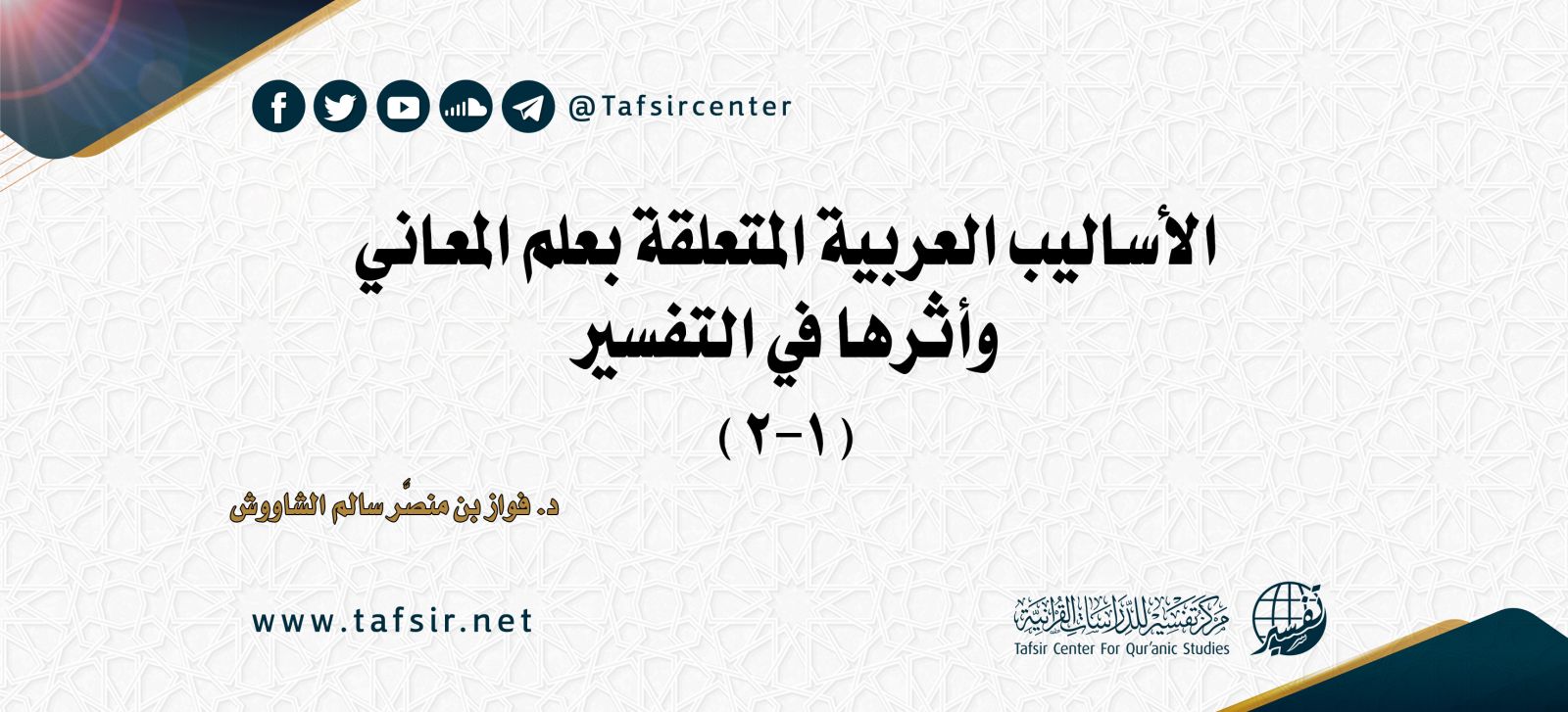الأساليب العربية المتعلقة بأحكام الكلمة حال الإفراد وأثرها في التفسير (1- 2)
(1- 2)
الكاتب: فواز بن منصَّر سالم الشاووش

الأساليب العربية المتعلقة بأحكام الكلمة حال الإفراد
وأثرها في التفسير (1- 2)[1]
الأسلوب الأول: «إخراج مصادر الأفعال على غير بناء أفعالها»[2]:
أولًا: توضيح الأسلوب:
من أساليب العرب وعاداتهم في الخطاب أنهم يذكرون فعلًا، ثم لا يأتون بمصدره، وإنما يأتون بمصدر فعل آخر، إذا كان الفعلُ المذكورُ يَدُلُّ على الفعل المتروك الذي اشْتُقَّ منه المصدر؛ بأن يكونَا متّفِقَيْن في المعنى[3].
مثال ذلك: قولهم: أَكْرَمْتُ فلانًا كَرَامَة، فـ(كَرامَة) مصدر؛ ولكنه ليس للفعل (أَكْرَمْتُ)؛ لأنّ مصدر (أَفْعَلْت) (الإِفْعَال)، أي: الإِكْرَام؛ وإنما هو مصدر لفعل آخر وهو (كَرُم)؛ لأنّ مصدر (فعل) (فَعَالَة)، تقول: كَرُمَ كَرَامَة[4]، وإنما جيء بـ(كَرامة) بدلًا من (إكرامًا) لـمّا كان الفعل المذكور (أكرمتُ) يدلّ على الفعل المتروك (كَرُم)؛ لاتفاق معنييهما.
ثانيًا: صيغ الأسلوب:
ورَدَ هذا الأسلوب عند الطبري بعدّة صيغ متنوّعة، وهي:
الصيغة الأولى: «إنّ العرب قد تُخْرِج المصادر مبهمة على أسماء مختلفة»[5].
الصيغة الثانية: «وقد تفعل العرب مثل ذلك، تُخرِج المصادر على غير ألفاظ الأفعال التي تَقَدَّمَتْها، إذا كانت الأفعال المتقدّمة لها تدلُّ على ما أُخرجت منه»[6].
الصيغة الثالثة: «وقد تفعلُ العرب ذلك كثيرًا؛ أن يأتوا بالمصادر على أصول الأفعال، وإن اختلفت ألفاظها في الأفعال بالزيادة»[7].
ومن خلال جَمْع هذه الصيغ بعضها إلى بعض؛ يتّضحُ: أن المصادر الواردة على غير ألفاظ أفعالها لا بدّ أن يتقَدَّمَها فعل يدلُّ على أصل المصدر الذي اشتُقَّ منه.
ثالثًا: دراسة الأسلوب:
اعتمد علماء اللغة والتفسير على هذا الأسلوب، وقرَّروه في كتبهم وأشاروا إليه؛ فمنهم على سبيل المثال:
1- سيبويه (ت: 180هـ):
قال: «هذا باب ما جاء المصدرُ فيه على غير الفعل؛ لأن المعنى واحد»[8].
ثم ذكر أمثلة على ذلك من القرآن، وأشعار العرب.
2- ابن قتيبة (ت: 276هـ):
قال: «باب ما جاء فيه المصدرُ على غير صَدْر[9]» [10].
ثم قال -بعد ذِكْرِه لأمثلة من القرآن وأشعار العرب-: «وإنما تجيء هذه المصادرُ مخالفة للأفعال؛ لأنّ الأفعال وإن اختلفت في أبنيتها فهي واحدةٌ في المعنى»[11].
3- الْمُبَرِّد (ت: 285هـ):
قال: «واعلَمْ أنّ الفعلين إذا اتَّفَقَا في المعنى، جاز أن يُحْمَل مصدرُ أحدهما على الآخر؛ لأنّ الفعل الذي ظهر، في معنى فعله الذي ينصبه»[12].
رابعًا: الأمثلة التطبيقية:
لقد ذكر الإمام الطبري لهذا الأسلوب أمثلة، منها:
1- قوله تعالى: ﴿بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ [الفاتحة: 1].
ذكر الطبري أنّ معنى قوله: (بسم الله) أقرأ بسم الله، وكذا عند القيام وعند القعود؛ فيكون المراد به: أقوم بسم الله، وأقعد بسم الله، وسائر الأفعال.
ثم ذكر قول مَن اسْتَشْكَلَ المعنى على هذا الوجه، بأنه إذا كان المعنى كذلك، فكلُّ قارئٍ لكتاب الله، أو قاعدٍ أو قائمٍ أو فاعلٍ فعلًا؛ فبعون الله وتوفيقه، فهلا -إِذْ كان كذلك- قيل: (بالله الرحمن الرحيم) بدلًا من (بسم الله)؛ لأنه أوضح معنًى لسامعه من قوله: (بسم الله)؛ إذْ كان قوله: أقوم، أو أقعد باسم الله؛ يُوهم سامعه أنّ قيامه وقعوده بمعنى غير الله.
ثم ذكر الجواب على هذا الإشكال؛ بأنّ المقصود من معنى (باسم الله): أبدأ بتسمية الله وذِكْره قبل كلّ شيء، وكذلك أقوم، أو أقعد، لا أنَّه يُعْنَى بقيله: (باسم الله) أقوم بالله، أو أقعد بالله، أو أقرأ بالله[13].
ثم قال: «فإن قال[14]: فإن كان الأمر في ذلك على ما وصَفْتَ، فكيف قيل: (بسم الله)، وقد علمت أنّ الاسم اسم، وأنّ التسمية مصدر من قولك: سمَّيت؟
قيل: إنّ العرب قد تُخْرِجُ المصادر مُبهمةً على أسماء مختلفة، كقولهم: أكرمتُ فلانًا كَرامة. وإنما بناء مصدرِ (أَفْعَلْتُ) إذا أُخرج على فعله: الإِفعال.
وكقولهم: أهَنْتُ فلانًا هوانًا، وكلَّمْته كلامًا. وبناء مصدر (فعَّلْتُ) التفعيل.
ومن ذلك قول الشاعر[15]:
أَكُفْرًا بَعْدَ رَدِّ الْمَوْتِ عَنِّي ** وَبَعْدَ عَطَائِكَ الْمِائَةَ الرِّتَاعَا
يريدُ: إعطاءَك.
(...) فإذا كان الأمر -على ما وصفنا من إخراجِ العرب مصادرَ الأفعال على غير بناء أفعالها- كثيرًا، وكان تصديرها[16] إياها على مخارج الأسماء موجودًا فاشيًا؛ فبَيِّنٌ بذلك صوابُ ما قلنا من التأويل في قول القائل: (بسم الله) أنّ معناه في ذلك عند ابتدائه في فعل أو قول: أبدأ بتسمية الله قبل فعلي، أو قبل قولي...»[17].
2- قوله عز وجل: ﴿وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾ [البقرة: 265].
ذكر الطبري قولَ مَنْ قال: إنّ معنى قوله: ﴿وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾: يتثبّـتون أين يضعون أموالهم. وردَّ هذا القول بأنه لو كان المعنى كذلك لكان: (وتَثَـبُّتًا من أنفسهم)؛ لأنّ المصدر من الكلام إذا كان على (تَفَعَّلْتُ)؛ التَّفَعُّل، مثل: تكرَّمتُ تكرُّمًا، ولكن معنى ذلك: وتثبيتٌ من أنفُس القوم إياهم بصحة العزم، واليقين بوعد الله تعالى ذِكْره[18].
ثم قال: «فإن قال قائل: وما تُنْكِر أن يكون ذلك نظيرَ قول الله عز وجل: ﴿وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا﴾ [المزمل: 8]، ولم يقل: تبتُّلًا. قيل: إنّ هذا مخالف لذلك، وذلك أنّ هذا إنما جاز أن يقال فيه: (تبتيلًا)؛ لظهور ﴿وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ﴾، فكان في ظهوره دلالة على متروك من الكلام الذي منه قيل: ﴿تَبْتِيلًا﴾، وذلك المتروك هو: وتَبَتَّل فيُبتّلك الله إليه تبتيلًا، وقد تفعل العرب مثل ذلك، تُخرِج المصادر على غير ألفاظ الأفعال التي تَقَدَّمَتْها إذا كانت الأفعال المتقدمة لها تدلُّ على ما أُخْرِجَتْ منه... وليس قبل قوله: ﴿وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾ كلامٌ يجوز أن يكون متوهمًا به أنه معدول عن بنائه، وأن معنى الكلام: ويتثبّـتون في وضع الصدقات مواضعها، فيُصْرَف إلى المعاني التي صُرِفَ إليها قوله: ﴿وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا﴾. وما أشبه ذلك من المصادر المعدولة عن الأفعال التي هي ظاهرة قبلها»[19].
3- قوله تعالى: ﴿فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا﴾ [آل عمران: 37].
قال الطبري: «يعني بذلك أنّ الله -جلّ ثناؤه- تَقَبَّل مريم مِن أُمِّها حَنَّة تَحريرَها إياها للكنيسة، وخِدمتها وخِدمة ربها ﴿بِقَبُولٍ حَسَنٍ﴾.
والقبول: مصدر مِن: قَبِلَها ربُّها. فأخرج المصدر على غيرِ لفظ الفعل، ولو كان على لفظه لكان: (فَتَقَبَّلَهَا ربُّها تَقَبُّلًا حسنًا). وقد تفعلُ العرب ذلك كثيرًا؛ أن يأتوا بالمصادر على أصول الأفعال، وإن اخْتَلَفَت ألفاظها في الأفعال بالزيادة، وذلك كقولهم: تكلَّم فلان كلامًا. ولو أُخْرِج المصدرُ على الفعل لَقِيلَ: تَكلَّم فلانٌ تَكَلُّمًا، ومنه قوله: ﴿وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا﴾، ولم يقل: إنباتًا حسنًا»[20].
خامسًا: أثره في التفسير:
لقد أثَّر هذا الأسلوب في التفسير، وذلك في الفهم الصحيح للآيات القرآنية، وفي إزالة اللَّبْس الذي قد يَرِد في فهمها، إضافة إلى ما يحويه هذا الأسلوب من المعاني البلاغية اللطيفة، وإليك بيان هذا الأثر:
ففي المثال الأول: اعتمد الطبري على هذا الأسلوب في تفسير (بسم الله) وأن المراد به التسمية؛ أي: أبدأ بتسمية الله، وليس المراد به: أقرأ بالله؛ ثم أزال بهذا الأسلوب الإشكال الذي قد يرِد، وهو: كيف يكون المراد بـ(بسم الله) التسمية، والتسمية مصدرٌ من سمَّيتُ، وليس من (بسم)؟
وأجاب عن ذلك بأنّ من أساليب العرب وفعلهم إخراج مصادر الأفعال على غير بناء أفعالها؛ مثل: أكرمتك كرامة، والأصل أن يُقال: إكرامًا، وهذا التفسير جارٍ على أساليبهم، فيزول حينئذ الإشكال.
وفي المثال الثاني: أثَّر هذا الأسلوب في معنى قوله تعالى: ﴿وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾، وذلك في تفسير بعض أهل التأويل؛ أنّ المراد بها: أنهم يَتَثَـبَّتون أين يضعون أموالهم. فجاء المصدرُ على خلاف لفظ الفعل؛ مثل قوله تعالى: ﴿وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا﴾، ولم يقل: تبَتُّلًا؛ ولكنَّ الطبري ردَّ هذا التخريج؛ وذلك أنّ قوله: ﴿وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا﴾ يختلف عن قوله: ﴿وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾؛ لتقدّم الفعل الذي يدلُّ على أصل المصدر وهو (وَتَبَتَّل)، ولم يتقدّم كلامٌ قبل قوله: (وَتَثْبِيتًا) يدلُّ على أن المعنى يتثبّـتون.
وأيضًا يُوجد أثـرٌ لطيف في قوله تعالى: ﴿وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا﴾ وهو: الجمع بين معنيي التَّبتُّل والتَّبْتِيل، وذلك أنّ تَبَتَّل على وزن (تَفَعَّلَ)، وتَفَعَّلَ: يُفيد التدرُّج والتكلُّف، مثل: تَجسَّس وتَحسَّس، وتَبَصَّر وتدرَّج، وتمشَّى وغيرها؛ فإنّ في تجسَّس وتحسَّس وبقية الأفعال تدرُّجًا وتكلُّفًا. ألا ترى أنَّ في (تَبَصَّر) من التدرّج وإعادة النظر والتكلّف ما ليس في (بَصَر)، وفي (تمشَّى) من التدرج ما ليس في (مشى)؟
وأمّا (فَعَّل) فيُفيد التكثير والمبالغة[21]، وذلك نحو: كَسَر وكسَّر، فإنّ في كسَّر المضاعف من المبالغة والتكثير ما ليس في كَسَر الثلاثي... فالله سبحانه جاء بالفعل لمعنى التدرُّج، ثم جاء بالمصدر لمعنى آخر وهو التكثير، وجمع المعنيين في عبارة واحدة موجزة؛ ولو جاء بمصدر الفعل (تَبَتَّل) فقال: (وتَبَتَّلْ إليهِ تَبَتُّلًا) لم يفد غير التدرج، وكذلك لو قال: (وبَتِّلْ نفسَكَ إليه تبتيلًا) لم يفد غير التكثير؛ ولكنه أراد المعنيين فجاء بالفعل من صيغة والمصدر من صيغة أخرى، وجمعهما، فهو بدل أن يقول: (وتَبَتَّلْ إليه تَبَتْلًا وبَتِّل نفْسَكَ إليه تبتيلًا) جاء بالفعل لمعنى، ثم جاء بالمصدر لمعنى آخر، ووضعهما وضعًا فنيًّا فكسب المعنيين في آنٍ واحد؛ وهذا باب شريف جليل»[22].
وكذلك مراعاة لفواصل الآيات السابقة في قوله: ﴿تَبْتِيلًا﴾، وأيضًا أطرى للسامع، وأيسر للقارئ من قوله: (وَتَبَتَّلْ إليهِ تَبَتُّلًا)، ففيها نبرة قوية في أُذُن السامع، وصعوبة على لسان القارئ، وأمّا (تبتيلًا) فهي سهلةٌ في نطقها، عذبةٌ في أُذُن سامعها.
وفي المثال الثالث: يظهر أثر هذا الأسلوب في إيضاح معنى قوله تعالى: ﴿فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ﴾، وذلك أن الأصل في نَظْمِ الكلام أن يأتي: (فَتَقَبَّلها ربُّها تَقَبُّلًا حَسَنًا)، وإنما عُدل عن لفظة (تَقَبُّلًا) إلى لفظة ﴿بِقَبُولٍ﴾ لفائدة، يقول صاحب تاج العروس: «وإنّما قال: بقَبُولٍ، ولم يَقُلْ: بتَقَبُّل، للجمع بين الأمرين: التَّقَبُّلُ الذي هو التَّرَقِّي في القَبُول، والقَبُول الذي يقتضي الرّضا والإثابة»[23].
وقد تقدَّم أنّ صيغة (تَفَعَّلَ) تفيد: التدرُّج والتكلُّف، فجمع بين المعنيين، وهذا وارد في القرآن بكثرة، يقول ابن القيم: «وهذا كثير في القرآن، وهو من أحسن الاختصار والإيجاز»[24].
الأسلوب الثاني: «ورود (فَاعِل) بلفظ (مَفْعُول)[25]، و(مَفْعُول) بلفظ (فَاعِل)، في مقام المدح أو الذمّ»[26]:
أولًا: توضيح الأسلوب:
من سنن العرب وعاداتهم في الكلام أنهم يأتون بصيغة (فاعِل) في معنى (مَفْعُول) والعكس، على وجه المبالغة في المدح والذم، فيقولون: سرٌّ كاتمٌ، أي: مكتومٌ، ويقولون: إنك مشؤوم علينا وميمون، أي: شائِمٌ ويامِنٌ[27].
ومن ذلك قول النبي -صلى الله عليه وسلم- لأبي طلحة -رضي الله عنه- لـمّا تصدّق بأحبّ الأموال إليه، وهي بَيْرُحَاء[28]: «بَخٍ، ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ، ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ»[29]، أي: هو مال مربوح فيه[30].
ثانيًا: صيغ الأسلوب:
ورَدَ هذا الأسلوب عند الطبري بعدّة صيغ مختلفة ومتقاربة المعنى، ومنها:
الصيغة الأولى: «ولا يُنكر أن يَخْرج المفعولُ على فاعِل»[31].
الصيغة الثانية: «والعربُ قد تُخْرِجُ (فاعلًا) بلفظ (مفعول) كثيرًا»[32].
الصيغة الثالثة: «والعربُ تَفعل ذلك -أي إخراج مفعول بلفظ فاعِل- في المدح والذمّ»[33].
من خلال النظر في هذه الصيغ وجمع بعضها إلى بعض تبيَّن أنّ العرب إذا أرادوا المبالغة في المدح والذمّ، أخرجوا (مفعولًا) بلفظ (فاعِل) والعكس، ولا يكادون يفعلون ذلك في غير المدح والذمّ فلا يجوز أن تقول للضارب: مضروب، ولا للمضروب: ضارب؛ لأنه لا مدح فيه ولا ذمّ[34].
ثالثًا: دراسة الأسلوب:
لقد اعتمد علماء اللغة والتفسير على هذا الأسلوب أثناء تفسيرهم لبعض الآيات، وأشاروا إليه، ومن هؤلاء:
1- الفرّاء (ت: 207هـ):
قال: «... والعرب تقول: هذا ليل نائم، وسرّ كاتم، وماء دافق، فيجعلونه فاعلًا، وهو مفعول في الأصل، وذلك: أنهم يريدون وجه المدح أو الذمّ»[35].
2- أبو عبيدة (ت: 210هـ):
قال: «إنّ العرب وضعوا أشياء من كلامهم في موضع الفاعل والمعنى أنه مفعول»[36].
3- ابن قتيبة (ت: 276هـ):
قال في باب (مخالفة ظاهر اللفظ معناه): «ومنه أن يجيء المفعول به على لفظ الفاعل... ومنه أن يأتي الفاعلُ على لفظ المفعول به، وهو قليل»[37].
رابعًا: الأمثلة التطبيقية:
ذكر الطبري أمثلة تطبيقية لهذا الأسلوب في مواضع من تفسيره، ومنها:
1- قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا﴾ [الإسراء: 45].
قال الطبري: «وكان بعض نحويي أهل البصرة يقول: معنى قوله: ﴿حِجَابًا مَسْتُورًا﴾ ساتِرًا، ولكنه أُخرِج وهو فاعِل في لفظ المفعول، كما يقال: إنّك مشئُوم علينا وميمون، وإنما هو شائم ويامِن؛ لأنه من شَأَمهم ويَمَنهم. قال: والحجاب ههنا هو الساتر. وقال: (مستورًا).
وكان غيره من أهل العربية يقول: معنى ذلك: حجابًا مستورًا عن العباد فلا يرونه. وهذا القولُ الثاني أظهرُ بمعنى الكلام، أن يكون المستور هو الحجاب، فيكون معناه: أنَّ الله ستره عن أبصار الناس فلا تُدركه أبصارهم. وإن كان للقول الأوَّل وجه مفهوم»[38].
2- قوله عزّ ذِكْره: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا﴾ [الإسراء: 101].
قال الطبري: «يقول: فقال لموسى فرعونُ: إني لأظنُّك يا موسى تتعاطى عِلْم السِّحر، فهذه العجائب التي تفعلها مِن سحرِك. وقد يجوز أن يكون مرادًا به: إني لأظنُّك يا موسى ساحرًا، فوضع (مفعول) موضعَ (فاعِل)، كما قيل: إنك مشئُوم علينا وميمون، وإنما هو شائم ويامن. وقد تأوَّل بعضُهم ﴿حِجَابًا مَسْتُورًا﴾ بمعنى: حجابًا ساترًا، والعربُ قد تُخْرِج (فاعلًا) بلفظ (مفعول) كثيرًا»[39].
3- قوله عزّ وجل: ﴿فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ﴾ [الحاقة: 21].
يقول الطبري في تأويل هذه الآية: «يقول تعالى ذِكْره: فالذي وصَفْتُ أَمْرَه، وهو الذي أُوتي كتابه بيمينه؛ في عيشةٍ مَرْضِيَّةٍ، أو عيشة فيها الرضا. فَوُصِفَت العيشةُ بالرضا وهي مَرْضِيَّةٍ؛ لأن ذلك مدح للعيشة. والعرب تفعل ذلك في المدح والذمّ، فتقول: هذا ليلٌ نائم، وسِرٌّ كاتم، وماءٌ دافقٌ، فيوجّهون الفعل إليه، وهو في الأصل مفعول لِمَا يُراد من المدح أو الذمّ، ومن قال ذلك لم يَـجُز له أن يقول للضارب: مضروبٌ، ولا للمضروب: ضاربٌ، لأنه لا مدحَ فيه ولا ذمّ»[40].
خامسًا: أثره في التفسير:
كان لهذا الأسلوب أثر في اختلاف المفسِّرين في معنى الآيات، إضافةً إلى ما أودعه هذا الأسلوب من المعاني البلاغية والبيانية للآية، وإليك تفصيل ذلك:
ففي المثال الأول: يظهر أثر هذا الأسلوب في اختلاف المفسِّرين في معنى قوله تعالى: ﴿حِجَابًا مَسْتُورًا﴾، ويرجع هذا الاختلاف إلى العمل بهذا الأسلوب، وذلك أنّ مَن عمل به قال: إنّ معنى قوله: (مَسْتُورًا) أي ساترًا، فيكون معنى الآية إذًا: ﴿وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَينَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا﴾ أي: حائلًا وساترًا يمنعهم مِن تفهُّمِ القرآن وإدراكه لئلّا يفقهوه فينتفعوا به، وهذا ما ذهب إليه الأخفش[41].
وعلى هذا القول: فالحجاب المستور هو ما حجب اللهُ به قلوبهم عن الانتفاع بكتابه.
ومَن لم يرَ العمل به في هذه الآية قال: إنّ قوله: ﴿مَسْتُورًا﴾ على معناه الظاهر من كونه اسم مفعول؛ لأن ذلك الحجاب مستور عن أعين الناس فلا يرونه، وهذا الذي مال إليه الطبري، ورجّحه ابن عطية[42].
وفي المثال الثاني: أثَّر هذا الأسلوب كذلك في اختلاف المفسِّرين في معنى ﴿مَسْحُورًا﴾، في قوله تعالى: ﴿فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا﴾ [الإسراء: 101]، فمَن عمل بهذا الأسلوب فسَّر ﴿مَسْحُورًا﴾ بمعنى ساحِر، وهذا ما ذهب إليه الطبري[43]، بينما أبو حيان الأندلسي لم يعمل بهذا الأسلوب في هذا الموضع، ورجّح أن يكون ﴿مَسْحُورًا﴾ على ظاهره من كونه اسم مفعول، بمعنى أنك قد سُحِرْتَ، فكلامك هذا مختلّ، وما تأتي به غير مستقيم[44]، ووافقه على ذلك السَّمين الحلبي[45] والألوسي[46].
وفي المثال الثالث: يتجلّى أثر هذا الأسلوب في إيضاح معنى الآية، وإثرائها بالمعاني البلاغية، وذلك أن قوله تعالى: ﴿فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَة﴾ [الحاقة: 21]، بمعنى مرضيَّة، «والعيشة ليست راضية، ولكنها لـحُسنها رضي صاحبُها، فوصفها بـ(رَاضِيَة) من إسنادِ الوصفِ إلى غير ما هو له، وهو من المبالغة؛ لأنه يدلُّ على شدَّةِ الرِّضَى بسببها حتى سَرَى إليها»[47].
والغرضُ البياني من إضافة الرّضَى للعيشة «الإشعارُ بمصاحبة الرّضا لكلِّ أجزاء عيشة المؤمن في الجنّة، فلا يُوجَدُ عُنصرٌ منها ولا أجزاء زَمَنيّةٌ مرافقة لها تخلو من الرّضا، وهذا المعنى لا تؤديه عبارة: فهو راضٍ عن عيشته؛ وذلك لأنّ الإنسان قد يرضى عن عيشته ولو دخلت ضمنها منغّصات، إِذْ هو ينظر إلى عيشته باعتبار الأغلب من أحوالها، بخلاف العيشة نفسها التي تمرُّ أجزاءً مع توالي الأزمان؛ إذْ كُلُّ جزء منها مُنْفَكّ عن سابقه وعن لاحقه، فإسناد الرّضا إليها يدلُّ على أنّ كلَّ أجزائها مغمور بالرضا»[48].
الأسلوب الثالث: «استعمالُ (المُفَاعَلة) من فريقين أو اثنين فصاعدًا، ولا تكون من واحدٍ إلا قليلًا في أَحرفٍ مَعدودةٍ»[49]:
أولًا: توضيح الأسلوب:
من أساليب العرب استعمال صيغة (الـمُفاعَلة) وهي: مصدر من مصادر (فَاعَلَ)، الذي يدلُّ على المشاركة، تقول: فَاعَلَ يُفاعِلُ مُفاعَلَة، كصاحَبَ يُصاحِبُ مُصاحَبة.
وصيغة (الـمُفاعَلة) مصدر، ولا تكون مأخوذة من الأسماء غير المصادر، فلا تقول لاثنين إذا أكَلا خبزًا: بينهما مخابزة[50].
وغالبًا ما تدلُّ (المفاعَلة) على المشاركة بين طرفين أو أكثر؛ يَفْعَلُ كلُّ طَرَفٍ بصاحبه ما يفعله صاحبه به، تقول: صاحبتُ زيدًا مُصاحَبة، وحاربنا العدو محاربة؛ إذ المصاحبة والمحاربة كانتا مشتركة بين الطرفين.
وقد تأتي (المفاعَلة) من طرفٍ واحدٍ؛ وورود ذلك في اللغة قليل ونادر[51]، نحو: عاقبتُ اللصّ معاقبة[52].
ثانيًا: صيغ الأسلوب:
ورَدَت لهذا الأسلوب عند الطبري صيغتان، وهما:
الصيغة الأولى: «(التَّفاعُل) الذي لا يكون إلا من اثنين، كسائر ما يُعرَفُ مِن معنى (يُفاعِلُ) و(مُفاعِل) في كلّ كلام العرب»[53].
الصيغة الثانية: «(فاعَلْتُ) لا تكادُ أن تَجِيءَ فِعْلًا إِلا مِن اثنين»[54].
ثالثًا: دراسة الأسلوب:
لقد قرّر علماء اللُّغة والتفسير هذا الأسلوب، وأشاروا إليه في كتبهم، ومنهم:
1- أبو عبيدة (ت: 210هـ):
قال: «ولا يكاد يجيء (يُفاعِل) إلا من اثنين، إلا في حروف»[55]، وقال أيضًا: «وقلّما يُوجد (فَاعَلَ) إلا أن يكون العملُ من اثنين، وقد جاء هذا ونظيره ونِظْره: عافاك الله، والمعنى: أعفاك الله، وهو من الله وحده»[56].
2- الأخفش (ت: 215هـ):
قال: «ولا تكون (المفاعَلة) إلا من شيئين... وقد تكون (المفاعَلة) من واحد في أشياء كثيرة»[57].
3- ابن قتيبة (ت: 276هـ):
قال: «و(المفاعَلة) تكون من اثنين تقول: غاضَبْتُ فلانًا مُغاضَبةً وتَغاضَبْنَا: إذا غضب كلُّ واحدٍ منكما على صاحبه... وقد تكون (المفاعَلة) من واحدٍ، فتقول: غاضبتُ مِن كذا: أي غضبْتُ»[58].
ومن خلال النظر في أقوال من تقدَّم ذِكْرهم، يُلاحظ أنَّ أبا عبيدة وابن قتيبة قد جعلَا (المفاعَلة) من طرف واحد خلاف الغالب من كلام العرب، وهذا هو المفهوم من كلامهم، وتابعهما على ذلك الطبري وصرّح به[59].
وأمّا الأخفش فإنّه يرى أنَّ ذلك واردٌ عن العرب في أشياء كثيرة، ويمكن أن يُجمع بين القولين، فيُقال: إنَّ الأخفش حينما قال بالكثرة لعلّ مراده بذلك أنَّ لها أمثلة كثيرة، وإن كانت هي قليلة بالنسبة إلى الكثير الوارد عن العرب من كونها من طرفين، والله أعلم[60].
رابعًا: الأمثلة التطبيقية:
لقد ورَدَت لهذا الأسلوب عند الطبري أمثلة، منها:
1- قوله تعالى: ﴿يُخَادِعُونَ اللهَ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ﴾ [البقرة: 9].
قال الطبري -بعد ذِكْره معنى الآية من أنّ خداع المنافق ربَّه والمؤمنين إظهاره بلسانه من القول والتصديق، خلاف الذي في قلبه من الشكّ والتكذيب؛ لِيَدْرَأ عن نفسه القتل والسباء-: «فإن قال لنا قائل: قد علِمْتَ أنّ (المفاعَلة) لا تكونُ إلا من فاعِلَيْن، كقولك: ضَارَبْتُ أخاك، وجالَسْتُ أباك، إذا كان كلُّ واحدٍ مُجالِسَ صاحبِه ومضاربه، فأمّا إذا كان الفعلُ من أحدهما فإنما يقالُ: ضَرَبتُ أخاك، أو: جلَسْتُ إلى أبيك، فمَن خادعَ المنافقُ فجاز أن يُقال فيه: يُخادِعُ اللهَ والمؤمنين. قيل: قد قال بعض المنسوبين إلى العلم بلغات العرب[61]: إنّ ذلك حرف جاء بهذه الصورة، أعني (يُخادِعُ) بصورة (يُفاعِلُ) وهو بمعنى (يَفْعَل)، في حروفٍ أمثالها شاذَّةٍ من منطق العرب، نظير قولهم: قاتلك الله، بمعنى: قتلك الله.
وليس القولُ في ذلك عندي كالذي قال، بل ذلك من (التَّفاعُلِ) الذي لا يكون إلا من اثنين، كسائر ما يُعْرَفُ مِن معنى (يُفاعِلُ) و(مُفاعِل) في كلّ كلام العرب، وذلك أن المنافق يخادِعُ اللهَ -جلَّ ثناؤه- بكَذبه بلسانه على ما قد تقدَّم وصفه، واللهُ خَادِعُه بخذلانه عن حُسْنِ البصيرة بما فيه نجاة نفسه في آجِل معاده»[62].
2- قوله عزّ ذِكْره: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [آل عمران: 200].
ذكر الطبري عدّة أقوال في تأويل هذه الآية، وهي:
الأول: اصبروا على دينكم وصابروا الكفار ورابطوهم.
الثاني: اصبروا على دينكم وصابروا وَعْدِي إياكم على طاعتكم لي، ورابطوا أعداءكم.
الثالث: اصبروا على الجهاد وصابروا عدوّكم ورابطوهم.
الرابع: معنى قوله: (وَرَابِطُوا) أي: رابطوا على الصلوات، أي: انتظروها واحدة بعد واحدة.
ثم رجّح أنَّ معنى الآية (اصْبِرُوا) على دينكم وطاعة ربكم، (وَصَابِرُوا) أعداءكم من المشركين[63].
ثم قال: «وإنما قلنا ذلك أَوْلَى بالصواب؛ لأن المعروف من كلام العرب في (المفاعلة) أن تكون من فريقين أو اثنين فصاعدًا، ولا تكون من واحد إلا قليلًا في أحرفٍ معدودة. وإِذْ كان ذلك كذلك، فإنما أُمِر المؤمنون أن يُصابروا غيرهم من أعدائهم، حتى يُظْفِرَهم الله بهم، ويُعْلِيَ كلمته، ويخزي أعداءهم، وأن لا يكون عدوّهم أصبرَ منهم. وكذلك قوله: ﴿وَرَابِطُوا﴾ معناه: ورابطوا أعداءَكم وأعداء دينكم من أهل الشرك في سبيل الله»[64].
3- قوله جل جلاله: ﴿قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ﴾ [التوبة: 30].
ذكر الطبريُّ قولَ ابن عباس له في معنى قوله: ﴿قَاتَلَهُمُ اللهُ﴾ أي: لعنهم الله، ثم قال: «فأمَّا أهلُ المعرفة بكلام العرب فإنهم يقولون: معناه: قَتَلَهُم الله، والعرب تقول: قاتَعَك الله، وقاتَعَها الله، بمعنى: قاتَلَك الله، قالوا: وقاتَعَك اللهُ أهونُ مِنْ قاتله الله... فإن كان الذي قالوا كما قالوا، فهو من نادرِ الكلام الذي جاء على غير القياس؛ لأنّ (فاعَلْتُ) لا تكاد أن تجيء فِعْلًا إلا من اثنين، كقولهم: خاصمتُ فلانًا وقاتَلتُه، وما أشبه ذلك، وقد زَعَمُوا أنّ قولهم: عافاك اللهُ منه، وأن معناه: أعفاك الله، بمعنى الدعاء لمن دعا له بأن يُعْفِيَه من السوء»[65].
خامسًا: أثره في التفسير:
يتبيَّن أثر هذا الأسلوب في اختلاف المفسِّرين، وفي الترجيح بين الأقوال، وفي إيضاح معنى الآية، وإليك تفصيل ذلك:
ففي المثال الأول: أثّر هذا الأسلوب في اختلاف المفسِّرين في معنى قوله تعالى: ﴿يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ [البقرة: 9]، فالإمام الطبري رأى أنّ المفاعلة على بابها، بمعنى أنها تكون من الطرفين من الله والمؤمنين ومن المنافقين، فمخادعةُ الله والمؤمنين لهم بإمهالهم في الدنيا، واستدراجهم، وإجراء أحكام الإسلام الظاهرة عليهم، وأمّا في الآخرة فالعذاب المهين ينتظرهم.
وأمّا مخادعة المنافقين اللهَ والمؤمنين: فبإظهارهم بألسنتهم من التصديق ما ليس في قلوبهم.
فالمخادعة على رأي الطبري مشتركة بين الطرفين، وتبعه على ذلك القرطبي[66].
وأمّا أبو عبيدة فإنه رأى أنَّ (المفاعلة) ليست على بابها في الآية، وإنما هي من طرف واحدٍ وهم المنافقون؛ وذلك أنهم: يُظْهِرون غير ما في أنفسهم، فيكون ﴿يُخَادِعُونَ﴾ بمعنى (يخدعون)، نظير قوله تعالى: ﴿قَاتَلَهُمُ اللهُ﴾ [التوبة: 30]، بمعنى: قتلهم الله[67]، وتبعه على ذلك البغوي[68].
وفي المثال الثاني: يظهر أثر هذا الأسلوب في الترجيح بين الأقوال، وذلك في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [آل عمران: 200]، ففي معنى الآية أقوال تقدّم ذِكْرُها؛ ولكنَّ الطبري رجّح أنّ معنى الآية: ﴿اصْبِرُوا﴾ على دينكم وطاعة ربكم ﴿وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا﴾ أعداءكم من المشركين.
وذلك لأنّ هذا المعنى جارٍ على الأسلوب العربي في (المفاعَلة)، وأنها تكون في الغالب من فريقين أو اثنين فصاعدًا، وأمّا تفسير المصابرة: بالصبر على وعد الله، والمرابطة بالمرابطة على الصلوات، فخروج عن المألوف والمعروف من كلام العرب في (المفاعَلة).
وفي المثال الثالث: كان لهذا الأسلوب أثر في فهم قوله تعالى: ﴿قَاتَلَهُمُ اللهُ﴾ [التوبة: 30]، وذلك أنَّ صيغة (المفاعَلة) لم ترِد على بابها من كونها تدلُّ على المشاركة، وإنما جاءت من الله وحده؛ على غير القياس المعروف من كلام العرب؛ ولهذا جاء التفسير عن ابن عباس أنَّ معنى الآية: لعنهم الله[69]، وعند أبي عبيدة: قتلهم الله[70]، وكِلا القولين متقاربان في المعنى يدلّان على بُغْضِ الله تعالى للمنافقين.
إضافةً إلى ما تقدّم من أنَّ صيغة (المفاعَلة) تدلُّ على المبالغة في الدعاء على المنافقين، بمعنى: قتلهم اللهُ قتلًا شديدًا[71].
الأسلوب الرابع: «إبهامُ العَددِ في الأيام والليالي خاصةً، مع تغليب اللَّيالي في العَدَد»[72]:
أولًا: توضيح الأسلوب:
أ- معاني الألفاظ:
الإبهام لغةً: قال ابن فارس: «الباء والهاء والميم: أن يبقى الشيء ولا يُعْرَفُ المأْتَى إليه، يُقال: هذا أمرٌ مُبْهَم»[73]، ويُقال: طريقٌ مُبْهَم: إذا كان خفيًّا لا يَسْتَبِين، ومسألةٌ مُبهَمةٌ؛ لأنها أُبهمت عن البيان فلم يُجعل لها دليل[74].
وأمّا إبهام العدد: فأن يُذكر العدد غير مميَّز بشيء، بمعنى أن يُذكَرَ العدد ولا يُذكَرَ معه المعدود.
وللعدد من الثلاثة إلى العشرة ثلاثة أحوال:
الأولى: أن يُقصد بها العدد المطلق، ويجب في هذه الحالة أن يكون اللفظ مقرونًا بالتاء، نحو: (ثلاثة نصف ستة).
الثانية: أن يُقصد بها معدودٌ ويُذْكَر: فيُذَكَّرُ العدد مع المعدود المؤنث، ويُؤنَّث مع المعدود المذَكَّر، نحو قوله تعالى: ﴿سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا﴾ [الحاقة: 7].
الثالثة: أن يُقصد بها معدود ولا يُذْكَر: وهذه الحالة هي الواردة في هذا الأسلوب، ولها وجهان:
الأول: أن يُذَكَّرَ العددُ مع المؤنث، ويؤنَّث مع المذكَّر، كما لو ذُكِر المعدود، وهو الفصيح تقول: (سِرْتُ خمسًا) تريد ليالي، و(صُمْتُ خمسةً) تريد أيامًا.
الثاني: ويجوز أن يُذَكَّر العدد مع المذكَّر، ويؤنَّث مع المؤنَّث، تقول: (صُمتُ خمسًا) تريد أيامًا، و(سِرْتُ خمسةً) تريد ليالي[75].
ب- المعنى الإجمالي:
من أساليب العرب أنَّهم يُبْهِمون العدد ولا يذكرون معه المعدود، ويجري على المؤنَّث -وذلك في الأيام والليالي خاصّة- بمعنى: أن يُذَكَّرَ العدد؛ لأنّ المعدود مؤنَّث وهي الليالي، تغليبًا لها على الأيام، وتدخل الأيام فيها.
ثانيًا: صيغ الأسلوب:
ورَدَ هذا الأسلوب عند الطبري بصيغةٍ واحدةٍ، وهي: «وذلك أن العرب في الأيام والليالي خاصةً، إذا أَبهمت العدد غَلَّبَت فيه الليالي... فإذا أظهروا مع العددِ مُفَسِّره أسْقَطوا من عدد المؤنث الهاء وأثبتوها في عدد المذكَّر»[76].
ثالثًا: دراسة الأسلوب:
لقد قرّر علماءُ اللّغة هذا الأسلوب، وأشاروا إليه في كتبهم، مع اتفاقهم إذا أبهم العدد في الأيام والليالي على أن يجري اللفظ على الليالي، وتدخل الأيام فيها، واختلفوا في سبب ذلك:
فمنهم من يرى أن ذلك من باب التغليب؛ أي: تغليب الليالي على الأيام، ومنهم من لا يرى ذلك، وإليك تفصيل ذلك:
فالإمام الطبري رأى أنَّ ذلك من باب تغليب المؤنث على المذكَّر في الأيام والليالي خاصةً، وغيرُ جائز مثله في عددِ بني آدم من الرجال والنساء[77]، وممن ذهب إلى أنَّ ذلك من باب التغليب:
1- الفراء (ت: 207هـ):
قال عند قوله تعالى: ﴿يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: 234]: «وقال: ﴿وَعَشْرًا﴾ ولم يقل: (عشرة)، وذلك أن العرب إذا أبهمت العدد من الليالي والأيام غلّبوا عليه الليالي، حتى إنهم ليقولون: قد صُمنا عشرًا من شهر رمضان؛ لكثرة تغليبهم الليالي على الأيام، فإذا أظهروا مع العدد تفسيره كانت الإناث بطرح الهاء والذّكران بالهاء، كما قال الله تبارك وتعالى: ﴿سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا﴾ [الحاقة: 7]، فأُدخل الهاء في الأيام حين ظهرن، ولم تُدخل في الليالي حين ظهرت»[78].
2- ابن قتيبة (ت: 276هـ):
قال في (باب ما يجري عليه العدد في تذكيره وتأنيثه): «العددُ يجري في تذكيره وتأنيثه على اللفظ لا على المعنى... وتقول: (سار فلان خَمْس عَشْرَةَ ما بين يوم وليلة): العدد يقع على الليالي، والعلم محيط بأنّ الأيام قد دخَلَت معها، قال الجعدي[79] يصف بقرة:
فَطَافَتْ ثَلَاثًا بَيْنَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ** وَكَانَ النَّكِيرُ أَنْ تُضِيفَ[80]وَتَجْأَرَا
يريد ثلاثة أيام وثلاثَ لَيَالٍ، ولا يُغَلّب المؤنث على المذكّر إلا في الليالي خاصةً، وتقول: (سِرْنَا عَشْرًا) فَيُعْلَم أنّ مع كلّ ليلة يومًا»[81].
3- الزجاجي (ت: 340هـ):
قال: «اعلم أنَّ التاريخ محمول على الليالي دون الأيام؛ لأنَّ أوّل الشهر ليلةٌ، فلو حُمِل على الأيام لسقطتْ من الشهر ليلة، فتؤنّث التاريخ لِمَا ذكرت لك، فتقول: (كَتبْتُ لخمسٍ خَلَوْن من الشهر، ولِسِتٍّ خَلَون من الشهر)، فيقع التاريخ على الليالي دون الأيام؛ لأنَّ الأهلّةَ فيها، وقد عُلم أنّ مع كلّ ليلة يومًا، وليس في العربية موضع يُغلَّبُ فيه المؤنّث على المذكَّر إلا في التاريخ، فأمّا ما سوى هذا، فإنه يُغلَّب المذكّر على المؤنّث»[82].
4- البغوي (ت: 516هـ):
قال عند قوله تعالى: ﴿يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: 234]: «وإنما قال (عشرًا) بلفظ المؤنث لأنه أراد الليالي؛ لأنَّ العرب إذا أبهمت العدد بين الليالي والأيام غلّبت عليها الليالي، فيقولون: صُمنا عشرًا، والصوم لا يكون إلا بالنهار»[83].
5- الحريري (ت: 516هـ):
قال: «من أصول العربية التي يطَّرد حكمها، ولا يَنْحَلُّ نَظمها، أنه متى اجتمع المذكّر والمؤنث غُلّب حكم المذكّر على المؤنث؛ لأنه الأصل، والمؤنث فرع عليه إلا في موضعين:
أحدهما: أنك متى أردت تثنية الذّكر والأنثى من الضباع، قلت: ضَبعان، فأُجريت التثنية على لفظ المؤنث الذي هو ضبع، لا على لفظ المذكّر الذي هو ضبعان. وإنما فُعِل ذلك فرارًا مما كان يجتمع من الزوائد لو ثُنّي على لفظ المذكّر[84].
والموضع الثاني: أنهم في باب التاريخ أرّخوا بالليالي التي هي مؤنثة دون الأيام التي هي مذكّرة، وإنما فعلوا ذلك مراعاة للأسبق، والأسبقُ من الشَّهر ليلته، ومن كلامهم: سرنا عشرًا من بين يوم وليلة»[85].
ورأى آخرون من علماء اللُّغة أنَّ جريان اللفظ على المؤنث في الأيام والليالي ليس من باب التغليب، وإنما لسبقِ الليالي على الأيام، ولأنَّ اللَّيالي مُسْتَلْزِمةٌ للأيام، والأيام تابعة لها وداخلة فيها، ومن هؤلاء:
1- سيبويه (ت: 180هـ):
قال: «وتقول: سار خمسَ عشرةَ مِن بين يوم وليلة؛ لأنك أَلْقَيْتَ الاسم على الليالي ثم بَيَّنتَ فقلت: من بين يوم وليلة، ألا ترى أنك تقول: لخمسٍ بَقِينَ أو خَلَونَ، ويَعْلَمُ المخاطَب أن الأيام قد دخلت في الليالي، فإذا ألقى الاسم على الليالي اكتفى بذلك عن ذِكْر الأيام، كما أنه يقول: أتيتُه ضَحْوةً وبُكْرةً، فيَعلَمُ المخاطَب أنها ضَحوة يومك وبكرة يومك، وأشباه هذا في الكلام كثير، فإنما قوله: مِن بَين يوم وليلة، توكيد بعد ما وقع على الليالي؛ لأنه قد علم أن الأيَّام داخلة مع الليالي، وقال الشاعر وهو النابغة الجعدي:
فطافَتْ ثلاثًا بين يوم وليلة ** يكونُ النَّكيرُ أَنْ تُضيفَ وتجأَرَا»[86].
2- ابن مالك (ت: 672هـ):
قال: «أوّلُ الشَّهر: ليلة طلوع هلاله، فلذلك أوثر في التاريخ قصد الليالي، واستُغني عن قصد الأيام؛ لأن كلَّ ليلة من ليالي الشهر يتبعها يوم، فأغناهم قصد المتبوع عن التابع، وليس هذا من التغليب؛ لأن التَّغليب هو: أن يُعَمَّ كِلا الصنفين بلفظ أحدهما، كقولك: (الزيدون والهندات خَرَجوا)، فالواو قد عمَّت: (الزَّيدِين) و(الهندات) تغليبًا للمذكّر، وقولك: (كُتِبَ لخَمْسٍ خَلَوْنَ) لا يتناول إلا الليالي، والأيام: مستغنى عن ذِكْرها لكون المراد مفهومًا»[87].
3- أبو حيان (ت: 745هـ):
قال: «عددُ اللَّيالي والأيام بالنسبة إلى ما مضى من الشهر أو السَّنة وإلى ما بقي منها، وفِعْلُه أَرَّخَ وورَّخَ، تأريخًا وَتَوْرِيخًا لغتان، فإن ذكَرْتَ الليالي والأيام بالنسبة إلى السَّنة أو الشهر، وذَكَرْت العدد كان على جنسه من تذكير وتأنيث، فتقول: سرتُ من شهر كذا خمس ليالٍ أو خمسة أيام، وإن لم تذكر المعدود، فالعرب تستغني بالليالي عن الأيام، فتقول: كُتِبَ لثلاثٍ خَلَوْن مِن شهر كذا، وليس من تغليب المؤنث على المذكّر خلافًا لقومٍ منهم الزجاجي[88]»[89].
4- ابن هشام (ت: 791هـ):
قال: «قولهم: (يُغَلَّب المؤنث على المذكَّر في مسألتين:
إحداهما: ضَبعان في تثنية (ضبع) للمؤنث، و(ضبعان) للمذكَّر؛ إِذْ لم يقولوا ضبعانان.
والثانية: التأريخُ، فإنهم أرّخوا باللَّيالي دون الأيام... وهو سهو؛ فإنّ حقيقة التّغليب أن يجتمع شيئان فَيَجري حُكْمُ أحدهما على الآخر، ولا يجتمع الليلُ والنهارُ[90]، ولا هنا تعبير عن شيئين بلفظ أحدهما على الآخر، وإنما أَرَّخَتِ العربُ بالليالي لِسَبْقها؛ إِذْ كانت أَشْهُرُهم قمرية، والقمر إنما يطلعُ ليلًا، وإنما المسألة الصحيحة[91] قولك: (كتبته لثلاثٍ بين يوم وليلة)، وضابطها[92] أن يكون معنا عدد مميَّز بمذكَّرٍ ومؤنَّث، وكلاهما مما لا يَعقِلُ، وفُصِلَا من العدد بكلمة (بين)»[93].
خلاصة هذه الأقوال:
من خلال النظر في الأقوال السابقة نجد أنّ الفرّاء، والطبري، والزجّاجي، والبغوي، والحريري، قد رأوا أنَّ إبهام العدد في الأيام والليالي، وجريان اللفظ على الليالي من باب تغليب الليالي على الأيام؛ لكونها الأسبق في الحدوث، فالليلة قبل اليوم.
بينما يرى سيبويه، وابن مالك، وأبو حيان، وابن هشام، أنَّ ذلك ليس من باب التَّغليب؛ لأنه لا ينطبق عليه تعريف التغليب، وحقيقته: أن يُعَمَّ كِلَا الصِّنْفَيْن بلفظ أحدهما، أو أن يجتمع شيئان فَيَجري حُكْمُ أحدهما على الآخر، وليس هذا حاصلًا عند إبهام الأيام والليالي، إذْ لم يُعَمَّ كِلَا الصِّنْفَين بلفظ أحدهما، وإنما تناول اللفظ الليالي فقط، والأيام مستغنى عن ذِكْرها، وكذا لم يجتمع لفظ الليل والنهار في الذِّكْر؛ بل ولم يأتِ ذِكْرُ واحدٍ منهما ليدلَّ على الآخر، ولكن السبب في ذلك أنَّ اللَّيلة أسبق من اليوم؛ ولأنَّ الأيام تابعة لها وداخلة فيها، فأغناهم قصد المتبوع عن التابع.
وعند التأمّل في تعريف التغليب المذكور يمكن أن يُقال: القائلون إنَّ ذلك من باب التغليب لم يخرجوا عن تعريف التغليب؛ وذلك أنَّ في اللفظ الجاري على التأنيث بمخالفة العدد المعدود ما يدلُّ على أحدهما، وهي الليالي وإن لم تُذْكَر، فإشارة اللفظ عمّت كلا الصنفين وهما الأيام والليالي بلفظ أحدهما وهي الليالي، والله أعلم.
رابعًا: الأمثلة التطبيقية:
ورَدَ لهذا الأسلوب عند الطبري مثال واحد، وهو:
- قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: 234].
قال الطبري بعد ذِكْرِه لمعنى الآية: «فإنْ قال لنا قائل: وكيف قيل: ﴿يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ ولم يُقَل: وعشرة؟ وإِذْ كان التنزيل كذلك أفبالليالي تَعْتَدُّ المتوفَّى عنها العشر أم بالأيام؟ قيل: بل تَعْتَدُّ بالأيام بلياليها. فإن قال: فإِذْ كان ذلك كذلك، فكيف قيل: ﴿وَعَشْرًا﴾ ولم يُقَل: وعشرةً. والعشر بغير الهاء من عدد الليالي دون الأيام؟ فإن جاز ذلك المعنى فيه ما قلت، فهل تُجِيزُ: عندي عشر. وأنت تُرِيدُ عشرةً من رجال ونساء؟
قلتُ: ذلك جائز في عدد الليالي والأيام، وغير جائز مثله في عددِ بني آدم من الرجال والنساء؛ وذلك أنّ العرب في الأيام والليالي خاصةً إذا أبهَمَت العددَ غَلَّبَت فيه الليالي، حتى إنهم فيما رُوي لنا ليقولون: صُمْنا عشرًا من شهر رمضان لتغليبهم الليالي على الأيام؛ وذلك أن العدد عندهم قد جرى في ذلك بالليالي دون الأيام، فإذا أظهروا مع العددِ مُفَسِّره أسقطوا من عدد المؤنث الهاءَ وأَثْبتوها في عدد المذكَّر، كما قال تعالى ذكره: ﴿سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا﴾ [الحاقة: 7]. فأسْقَط الهاء من (سبع)، وأَثْبَتَها في (الثمانية)»[94].
خامسًا: أثره في التفسير:
أثَّر هذا الأسلوب في الفهم الصحيح للآية، وفي الترجيح بين الأقوال، وإليك بيان ذلك:
ففي قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: 234]، كان لهذا الأسلوب أثر في إيضاح معنى الآية وإبراز المعنى الرَّاجح، وذلك أن المراد بقوله: ﴿وَعَشْرًا﴾ الأيام بلياليها تغليبًا للّيالي، وتدخل الأيام فيها، خلافًا لِمَا ذهب إليه آخرون من أنّ المراد بها الليالي دون الأيام؛ لأنَّ العدد جاء مذكَّرًا فيدلُّ على أن المعدود مؤنث وهي الليالي، ولا يدخل اليوم العاشر في العِدَّة؛ لأنها انقضت بتمام عشر ليال[95].
وتظهر ثمرة هذا الخلاف: ما إذا عُقِد على المرأة المتوفَّى عنها زوجها، وقد مضت أربعة أشهر وعشر ليالٍ؛ فعند مَنْ يرى أنَّ العِدَّة تكون بأربعة أشهر وعشرة أيام بلياليها، يرى أنّ العقد باطل حتى يمضي اليوم العاشر، ومَن يرى أنها تكون بالليالي دون الأيام يرى صحةَ العقد، وأنَّها حَلَّت للأزواج[96].
وبالنظر إلى هذا الأسلوب العربي في تغليب الليالي على الأيام عند إبهام العدد ودخول الأيام فيها رجّح الطبري أنّ المراد في الآية: الأيام بلياليها.
الأسلوب الخامس: «الإضمار لكلِّ مُعايَن نكرةً كان أو معرفةً (هذا) و(هذه)»[97]:
أولًا: توضيح الأسلوب:
من أساليب العرب في خطابهم أنهم يُضمِرون لكلّ ما يعاينونه -نكرة كان اسم ذلك الـمُعايَن أو معرفة- (هذا) و(هذه)؛ لعِلْم المخاطب بذلك، فيقولون عند معاينتهم رجلًا جميلًا: جميلٌ واللهِ، أي: هذا جميل، وإذا رأوا شخصًا معروفًا قالوا: عبد الله وربي، أي: هذا عبد الله، وما شابه ذلك من كلامهم[98].
ثانيًا: صيغ الأسلوب:
ورَدَ لهذا الأسلوب عند الطبري ثلاث صيغ، وهي:
الصيغة الأولى: «العرب تُضْمِرُ النَّكرات مرافعها قبلها إذا أَضْمَرت، فإذا أَظهَرَت بدأت به قبلها، فتقولُ: جاءني رجل اليوم. وإذا قالوا: رجل جاءني اليوم. لم يكادوا أن يقولوه إلا والرجلُ حاضرٌ يُشيرون إليه بـ(هذا)، أو غائب قد عَلم المخبَرُ عنه خبره، أو بحذفِ (هذا) وإضماره، وإن حذفوه لمعرفة السامع بمعنى المتكلّم»[99].
الصيغة الثانية: «من شأنِ العرب أن يُضْمِروا لكلِّ معايَن نكرة كان أو معرفة ذلك المعايَن، هذا وهذه»[100].
الصيغة الثالثة: «العرب لا تكاد تبتدئ بالنكراتِ قبل أخبارها إذا لم تكُن جوابًا»[101].
من خلال النظر في هذه الصيغ يتبيَّن أنَّ العرب لا تبتدئ بالنكرات إلا بمسوّغ، ومن هذه المسوّغات أنها تُضمِرُ كلامًا قبلها يعرفه السامع من المتكلّم، كقولهم: مَن عندك؟ فتقول: رجل، التقدير: عندي رجلٌ[102].
ثالثًا: دراسة الأسلوب:
لقد اعتمد علماء اللُّغةِ على هذا الأسلوب وأشاروا إليه، فمنهم:
1- سيبويه (ت: 180هـ):
قال: «هذا باب يكون المبتدأُ فيه مضمرًا، ويكون المبنيُّ عليه مظهرًا، وذلك أنك رأيت صورة شخص فصار آية لك على معرفة الشخص، فقلتَ: عبد الله ورَبِّي، كأنك قلت: ذاك عبد الله، أو هذا عبد الله»[103].
2- الكسائي (ت: 189هـ):
قال: «رُفعت: ﴿كِتَابٌ أُنْزِلَ إِلَيْكَ﴾ [الأعراف: 2]، وأشباهه من المرفوع بعد الهجاء[104] بإضمار (هذا) أو (ذلك) وهو وجه»[105].
3- الفرّاء (ت: 207هـ):
قال: «قوله: ﴿بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ [التوبة: 1] مرفوعة، يُضمر لها (هذه)، ومثله قوله: ﴿سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا﴾ [النور: 1]، وهكذا كلُّ ما عاينته من اسم معرفة، أو نكرةٍ جاز إضمار (هذا) و(هذه)، فتقول إذا نظرت إلى رجل: جميلٌ واللهِ، تريد: هذا جميل»[106].
وقال أيضًا: «قوله: ﴿سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا﴾ [النور: 1]، تَرفع السُّورةَ بإضمار (هذه سورة أنزلناها)، ولا ترفعها براجع ذكرها؛ لأنّ النكرات لا يُبتدأ بها قبل أخبارها، إلا أن يكون ذلك جوابًا»[107].
رابعًا: الأمثلة التطبيقية:
ورَدَت لهذا الأسلوب عند الطبري أمثلة، منها:
1- قوله تعالى: ﴿بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ [التوبة: 1].
قال الطبري في تفسير الآية: «هذه براءةٌ من الله ورسوله. فـ﴿بَرَاءَةٌ﴾ مرفوعة بمحذوف، وهو هذه، كما في قوله: ﴿سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا﴾ [النور: 1]، مرفوعة بمحذوف، هو هذه، ولو قال قائل: (بَرَاءَة) مرفوعة بالعائد من ذكرها في قوله: ﴿إلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ﴾ وجَعَلها كالمعرفةِ تَرْفَعُ ما بعدها؛ إذْ كانت قد صارت بصِلَتِها وهي قوله: ﴿مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ كالمعرفة، وصار معنى الكلام: براءة من الله ورسوله[108]، إلى الذين عاهدتم من المشركين، كان مذهبًا غير مدفوعة صحته، وإن كان القول الأول أعجب إِلَيَّ؛ لأنَّ مِن شأنِ العرب أن يُضْمِروا لكلّ معايَن نكرةً كان أو معرفةً ذلك الـمُعايَن (هذا) و(هذه)، فيقولون عندَ مُعاينتهم الشيء الحسن: حسنٌ والله، والقبيح: قبيحٌ والله، يُريدون: هذا حسن والله، وهذا قبيح والله؛ فلذلك اخترتُ القول الأول»[109].
2- قوله جل ذِكره: ﴿سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ [النور: 1].
قال الطبري: «يعني بقوله تعالى ذِكْره: ﴿سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا﴾ وهذه السُّورة أنزلناها. وإنما قلنا معنى ذلك كذلك؛ لأنَّ العرب لا تكاد تبتدِئُ بالنكراتِ قبل أخبارها إذا لم تكُن جوابًا؛ لأنها تُوصَلُ كما يُوصَل (الذي)، ثم يُخبَرُ عنها بخبر سوى الصّلة، فيُستقبَحُ الابتداء بها قبل الخبر إذا لم تكن موصولةً، إِذْ كان يصيرُ خبرها إذا ابتُدئ بها كالصِّلَة لها، ويصيرُ السَّامعُ خبَرَها كالمتوقِّع خبَرَها، بعد إِذْ كان الخبر عنها بعدها كالصِّلَة لها. وإذا ابتُدئ بالخبر عنها قبلها لم يدخُلِ الشكُّ على سامع الكلام في مراد المتكلِّم»[110].
3- قوله جل وعز: ﴿تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ﴾ [الزمر: 1].
قال الطبري: «ورُفع قوله: ﴿تَنْزِيلُ﴾ بقوله: ﴿مِنَ اللهِ﴾، وتأويل الكلام: من الله العزيز الحكيم تنزيل الكتاب، وجائزٌ رفعه بإضمار (هذا)، كما قيل: ﴿سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا﴾ [النور: 1]، غير أنّ الرفع في قوله: ﴿تَنْزِيلُ الْكِتَابِ﴾ بما بعده أحسنُ من رفع ﴿سُورَةٌ﴾ بما بعدها؛ لأنَّ (تَنْزِيلُ) وإن كان فعلًا فإنه إلى المعرفة أقرب؛ إِذْ كان مضافًا إلى معرفة، فحسن رفعه بما بعده، وليس ذلك بالحسن في ﴿سُورَةٌ﴾؛ لأنه نكرة»[111].
خامسًا: أثره في التفسير:
أثَّر هذا الأسلوب في إيضاح معنى الآيات، وفي إعطائها معاني بلاغية لطيفة، وإليك التفصيل:
ففي المثال الأول: أثَّر هذا الأسلوب في توضيح معنى الآية، وإكسابها معنًى جديدًا، وذلك أنه إذا قيل: إنَّ ﴿بَرَاءَةٌ﴾ مرفوعة بمحذوف وهو (هذه)؛ دلّ على أن البراءة حادثة وحاصلة من الله ورسوله لم يُعهد عند المخاطبين حدوثها من الله ورسوله، ولا يحصل هذا المعنى إذا قيل إنَّ (بَرَاءَةٌ) مبتدأ، وسَوَّغ الابتداء بالنكرة لتخصّصها بالصفة في قوله: ﴿مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾.
قال أبو السعود بعد ذِكْرِه أنَّ ﴿بَرَاءَةٌ﴾ خبر لمبتدأ محذوف، تقديره: (هذه براءة مبتدئة من جهة الله ورسوله): «وقيل: هي مبتدأ لتخصّصها بالصفة، وخبرُه ﴿إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ﴾ إلخ، والذي تقتضيه جزالة النَّظْم هو الأول؛ لأنَّ هذه البراءة أمرٌ حادث لم يُعهَد عند المخاطبين ذاتُها ولا عنوانُ ابتدائها من الله تعالى ورسوله، حتى يَخرج ذلك العنوان مخرج الصفة لها ويُجعل المقصود بالذات والعمدة في الإخبار شيئًا آخر هو: وصولها إلى المعاهَدين، وإنما الحقيق بأن يُعتنى بإفادته حدوث تلك البراءة من جهته تعالى ووصولها إليهم؛ فإنّ حقّ الصفاتِ قبل علم المخاطب بثبوتها لموصوفاتها أن تكون أخبارًا، وحقّ الأخبار بعد العلم بثبوتها لِمَا هيَ له أن تكون صفاتٍ»[112].
وفي المثال الثاني: يظهر أثر هذا الأسلوب في إبراز المعاني البلاغية اللطيفة التي في قوله تعالى: ﴿سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا﴾ [النور: 1]، وذلك إذا قيل: إنَّ ﴿سُورَةٌ﴾ خبر لمبتدأ محذوف تقديره: (هذه سورة)، فيصير اسم الإشارة على هذا التقدير مشيرًا إلى حاضر في السَّمع، وهو الكلام المتتالي، فكلُّ ما يُنَزَّلُ من هذه السورة وأُلحِقَ بها من الآيات فهو من الـمُشَار إليه باسم الإشارة المقدَّر[113]، وأشير إليها مع عدم سبق ذِكرها؛ لأنها باعتبار كونها في شرف الذِّكْر في حكم الحاضرِ الـمُشاهَد، ولا تحصل هذه المعاني إذا قيل: إنَّ (سُورَةٌ) مبتدأ محذوف الخبر على تقدير: (فيما أوحينا إليك سورةٌ أنزلناها)؛ لأنَّ المقامَ بيانُ شأن هذه السُّورة الكريمة ومنزلتها، لا أنَّ في جملة ما أُوحي إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- سورة من شأنها كذا وكذا[114].
وفي المثال الثالث: يكون أثر هذا الأسلوب كذلك في إبراز المعاني البلاغية، وذلك إذا قيل: إنَّ قوله: ﴿تَنْزِيلُ الْكِتَابِ﴾ مرفوع بإضمار (هذا)، على تقدير: (هذا تنزيل الكتاب) فيكون اسم الإشارة مشيرًا إلى السُّورة أو القرآن، تنزيلًا لهما منزلة الحاضر المشار إليه؛ لكونهما على شرف الذِّكْر والحضور؛ ولأنَّ مقتضى المقام هو بيان أنَّ السُّورة أو القرآن تنزيل الكتاب من الله، لا بيان أن تنزيل الكتاب منه تعالى لا من غيره[115]، ولا يحصل هذا المعنى إذا قيل: إِنَّ قوله: ﴿تَنْزِيلُ الْكِتَابِ﴾ مرفوع بما بعدُ، وهو قوله: ﴿مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ﴾، فيكون المعنى: (من الله العزيز الحكيم تنزيل الكتاب)، وهو ما ذهب إليه الطبري[116].
الأسلوب السادس: «تسميةُ اليَقِينِ ظَنًّا، والشَّكّ ظَنًّا»[117]:
أولًا: توضيح الأسلوب:
الغالب في (ظنَّ) أنها تفيد التردّد، ولكن مع رجحان أحد الأمرين[118]، ولكن العرب قد تضعها في موضع اليقين الذي ليس بيقين عيان ومشاهدة، وإنما يقين تَدبُّر واستدلال، فأمّا العيان فلا يُقال فيه إلا عَلِم[119]، وإنما صحّ إطلاق اسم الظنّ على اليقين؛ لأنهما يشتركان في كون كلّ واحدٍ منهما اعتقادًا راجحًا، إلا أنّ اليقين راجح مانع من النقيض، والظنَّ راجح غير مانع من النقيض[120].
وكذلك يضعونها في موضع الشّك الذي هو مطلق التردّد[121]؛ لأنّ أحد طرفيها شكّ، والثاني يقين راجح، فهي من أسماء الأضداد[122].
ثانيًا: صيغ الأسلوب:
ورَدَ هذا الأسلوب عند الطبري بثلاث صيغ:
الصيغة الأولى: «إنَّ العرب قد تُسَمِّي اليقينَ ظنًّا، والشكَّ ظنًّا، نظير تسميتهم الظلمةَ سُدْفَة، والضياءَ سُدْفَة، والمُغيث صارخًا، والمُسْتَغِيثَ صارخًا، وما أشبه ذلك من الأسماء التي تُسمِّي بها الشيءَ وضدَّه»[123].
الصيغة الثانية: «والعربُ تُوجِّهُ الظنَّ -إذا أدخَلَتْه على الإخبار- كثيرًا، إلى العلم الذي هو من غير وجه العيان»[124].
الصيغة الثالثة: «...وكوضعهم الظنَّ موضعَ العلم الذي لم يُدْرَكْ من قِبَل العيان، وإنما أُدْرك استدلالًا أو خبرًا»[125].
ومن خلال النظر في هذه الصيغ اتَّضح أنَّ العرب يضعون الظنَّ موضع اليقين والعلم، ومرادهم بالعلم هو: العلم الذي يُدرك عن طريق الخبر أو الاستدلال، لا العلم الذي يُدرك عن طريق الحِسّ والمشاهدة، ولا تجدهم يقولون في رجل مرئي حاضرٍ: أظنُّ هذا إنسانًا[126].
ثالثًا: دراسة الأسلوب:
لقد ذكر اللغويون والنحويون هذا الأسلوب وأشاروا إليه، ومنهم:
1- الفرّاء (ت: 207هـ):
قال: «وقوله: ﴿وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ﴾ [ص: 24]، أي عَلِم، وكلُّ ظَنٍّ أدخَلْتَه على خبر فجائز أن تجعلَهُ عِلمًا؛ إلا أنه عِلم ما لا يُعَايَن»[127].
2- أبو عبيدة (ت: 210هـ):
قال: «﴿الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ﴾ [البقرة: 46]، معناها: يوقنون، فالظنّ على وجهين: يقين وشكّ؛ قال دُرَيْدُ بن الصمة[128]:
فَقُلْتُ لَهُمْ ظُنُّوا بِأَلْفَيْ مُدَجَّجِ ** سَرَاتُهُمُ فِي الْفَارِسِيِّ الْمُسَرَّدِ
ظُنُّوا، أي: أيقنوا»[129].
3- ابن قتيبة (ت: 276هـ):
قال في باب المقلوب: «ومن ذلك أن يُسَمَّى المتضادان باسم واحد، والأصل واحد، فيقال للصُّبح: صَرِيمٌ، ولليل: صريمٌ، قال الله سبحانه: ﴿فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ﴾ [القلم: 20]، أي: سوداء كالليل؛ لأنَّ اللَّيل يَنْصَرِمُ عن النَّهار، والنَّهار ينصرم عن الليل... ولليقين: ظَنّ، وللشك: ظَنّ؛ لأنَّ في الظنِّ طرَفًا من اليقين، قال الله عز وجل: ﴿قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو اللهِ﴾ [البقرة: 249]، أي: يَسْتَيقِنُون، وكذلك: ﴿إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ﴾ [الحاقة: 20]، ﴿وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا﴾ [الكهف: 53]، و﴿إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾ [البقرة: 230]، هذا كلّه في معنى اليقين»[130].
رابعًا: الأمثلة التطبيقية:
ورَدَت لهذا الأسلوب عند الطبري أمثلة، منها:
1- قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ [البقرة: 46].
قال الطبري: «إنْ قال لنا قائل: وكيف أخبر الله -جلَّ وعزَّ- عمَّن قد وصفه بالخشوع له بالطاعة أنه يَظُنُّ أنه مُلاقِيه، والظنُّ شكٌّ، والشاكُّ في لقاء الله -جلَّ ثناؤه- عندك بالله كافـرٌ؟
قيل: إنَّ العرب قد تُسَمِّي اليقينَ ظنًّا، والشكَّ ظنًّا، نظير تسميتهم الظُّلمةَ سُدْفَة، والضياءَ سُدْفَة، والـمُغِيثَ صارخًا، والـمُسْتَغِيثَ صارخًا، وما أشبه ذلك من الأسماء التي تُسمِّي بها الشيءَ وضدَّه. ومما يَدُلُّ على أنه يُسَمَّى به اليقين، قولُ دُرَيْدِ بن الصمة:
فقلتُ لهم ظُنُّوا بألْفَيْ مُدَجَّجِ ** سَراتُهم في الفارسيّ المُسَرَّدِ
يعني بذلك: تَيَقَّنُوا ألفَيْ مُدَجَّجٍ تَأْتيكم... والشَّواهدُ مِن أشعارِ العرب وكلامها على أن الظنّ في معنى اليقين أكثرُ مِن أن تُحصى، وفيما ذكرنا لمن وُفِّق لفهمه كفاية»[131].
2- قوله جل جلاله: ﴿وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ﴾ [ص: 24].
قال الطبري -بعد ذِكْره معنى الآية وسرده لأقوال السَّلَف في معناها، وأنها بمعنى: وعَلِم داود أنّما ابْتَلَيناه-: «والعربُ تُوجِّهُ الظنَّ -إذا أدخَلَتْه على الإخبار- كثيرًا، إلى العلم الذي هو من غيرِ وَجه العيان»[132].
3- قوله جل ذِكره: ﴿وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ تَقُولَ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا﴾ [الجن: 5].
قال الطبري: «يقولُ: قالوا: وأنَّا حَسِبْنا أن لن تقول بنو آدمَ والجنُّ على الله كذبًا من القول. والظنُّ في هذا الموضع بمعنى الشكّ، وإنما أنكر هؤلاء النفرُ من الجنّ أن تكونَ عَلِمَت أن يكون أحدٌ يَجْترئ على الكذب على الله لـمَّا سَمِعَت القرآنَ؛ لأنهم قبل أن يسمعوه، وقبل أن يعلموا تكذيب الله الزاعمين أن لله صاحبةً وولدًا، وغير ذلك من معاني الكفر -كانوا يَحْسَبون أنَّ إبليس صادق فيما يَدْعُو بني آدمَ إليه من صنوف الكفر، فلمّا سَمِعوا القرآنَ أيقَنُوا أنه كان كاذبًا في كلّ ذلك، فلذلك قالوا: ﴿وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا﴾ [الجن: 4]، فسمّوه سفيهًا»[133].
خامسًا: أثره في التفسير:
كان لهذا الأسلوب أثر في إزالة الإشكال واللَّبْس في فهم الآية، إضافةً إلى ما فيه من توضيح معناها، وإليك التفصيل:
ففي المثال الأول: يظهر أثر هذا الأسلوب في إزالة إشكال قد يرِد في فهم الآية، وهو: كيف يُوصَف المؤمنون الذين عُرِفوا بالخشوع والطاعة لله -عز وجل- بأنهم يظنون أنهم ملاقو ربهم، والظنّ هو الاعتقاد الذي يقارنه تجويز النقيض، فيقتضي أن يكون صاحبه غير جازم بيوم القيامة، وذلك كفر، والله تعالى مدح على الظنِّ، والمدح على الكُفْرِ غير جائز؟!
فيقال: إنَّ الظنَّ هنا بمعنى اليقين، كما ورَدَ ذلك في كلام العرب وأشعارهم، فيزول حينئذ هذا الإشكال.
وهناك أثـرٌ لطيفٌ في إطلاق لفظ الظنِّ على العِلم في الآية، وهو: التنبيه على أنّ عِلْم أكثر الناس في الدنيا بالإضافة إلى عِلْمه في الآخرة كالظنِّ في جنب العلم، وأنّ العِلم الحقيقي في الدنيا لا يكاد يحصل إلا للنبيِّين والصدِّيقين الذين ذكرهم الله تعالى في قوله: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا﴾ [الحجرات: 15][134].
وفي المثال الثاني: يتجلّى أثر هذا الأسلوب في توضيح معنى قوله تعالى: ﴿وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ﴾ [ص: 24]، بمعنى: وعَلِمَ العِلم الاستدلالي الذي يُقارب اليقين وليس به، ولو أخبر جبريل داود بهذه الفتنة لم يُعبّر عنها بـ(ظنَّ) وعبّر بـ(علم) العلم اليقيني[135].
وقيل: إنّ «السبب الذي أوجب حمل لفظ الظنّ على العِلْم ههنا أنّ داود -عليه السلام- لـمّا قضى بينهما نظر أحدهما إلى صاحبه فضحك، ثم صعدَا إلى السماء قِبَل وجهه، فعلم داود أنّ الله ابتلاه بذلك، فثبت أن داود عَلِمَ ذلك، وإنما جاز حمل لفظ الظنِّ على العلم؛ لأن العلم الاستدلالي يشبه الظنَّ مشابهة عظيمة... [و] هذا الكلام إنما يلزم إذا قلنا: الخصمان كانَا ملَكَيْن. أمّا إذا لم نَقُل ذلك لا يلزمنا حملُ الظنّ على العِلْم، بل لقائلٍ أنْ يقول: إنه لـمّا غَلَب على ظنّه حصول الابتلاء من الله تعالى اشتغل بالاستغفار والإنابة»[136].
وقيل: إنَّ وضع الظنّ موضع العلم في الآية يدلُّ على أنّ المراد بالفتنة التي ابتُلي بها داود -عليه السلام- إنما هي المبادرة في الحكم على المدَّعَى عليه أنه ظلم قبل أن يسمع كلامه، فعاتبه الله على ذلك، وليس المراد بها قصة المرأة التي ينبغي على كلّ مسلم تنزيهه منها[137] وسائر إخوانه عليهم السلام، ولو كان المراد بالفتنة تلك القصة لقيل: (وعَلِمَ داود)، ولم يقل: ﴿وَظَنَّ﴾[138].
وفي المثال الثالث: كان أثر هذا الأسلوب في فهم الآية وتوضيحها، وذلك أنَّ (ظنَّ) في قوله تعالى: ﴿وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ تَقُولَ الإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا﴾ [الجن:5]، جاءت بمعنى الشَّك، فيكون المعنى: وأنّا حَسِبْنا أن لن تقول بنو آدم والجنُّ الكذب على الله، وإلى هذا المعنى ذهب الفرّاء والطبري[139].
ويرى بعض أهل التأويل أنَّ (ظنَّ) هنا بمعنى اليقين، وهو يقين مخطئ، وتأكيد المظنون بـ(لن) المفيدة لتأبيد النفي يفيد أنهم كانوا متوغِّلين في حُسْن ظنِّهم بـمَن ضلّلوهم[140].
[1] هذه المقالة من كتاب (الأساليب العربية الواردة في القرآن الكريم وأثرها في التفسير، من خلال جامع البيان للطبري)، الصادر عن مركز تفسير سنة 1436هـ، ص123 وما بعدها، وقد قسمنا مادة هذا الفصل على مقالتين، تناولتْ كلّ منها ستة أساليب من مجموع اثني عشر أسلوبًا متعلقًا بأحكام الكلمة حال الإفراد. (موقع تفسير)
[2] انظر: جامع البيان (1/ 115).
[3] انظر: المقتضب، للمبرد (1/ 211، 212)، ط: الثانية، تحقيق: محمد عبد الخالق عضيمة، القاهرة، لجنة إحياء التراث، 1415هـ= 1994م.
[4] انظر: الشافية في علم التصريف، لابن الحاجب، ص27، ط: الأولى، تحقيق: حسن أحمد العثمان، مكة المكرمة: المكتبة المكية، 1415هـ= 1995م.
[5] جامع البيان (1/ 114).
[6] جامع البيان (4/ 671).
[7] جامع البيان (5/ 344).
[8] الكتاب، لسيبويه (4/ 81)، ط: الثانية، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، القاهرة: مكتبة الخانجي، الرياض: دار الرفاعي، 1402هـ = 1982م.
[9] قال شارح كتاب أدب الكاتب: «وقوله: (على غير صَدْر)، أي: على غير الفعل المذكور معه». انظر حاشية رقم (1) من كتاب أدب الكاتب، لابن قتيبة، ص421، ط: الأولى، شَرَحَ وكَتَبَ هوامشه وقدَّم له: عليّ فاعور، بيروت: دار الكتب العلمية، 1408هـ= 1988م.
[10] أدب الكاتب، ص421.
[11] أدب الكاتب، ص421.
[12] المقتضب (1/ 211- 212)، وانظر: الأصول في النحو، لأبي بكر محمد بن سهل البغدادي (3/ 134، 135)، ط: الثالثة، تحقيق: عبد الحسين الفتلي، بيروت: مؤسسة الرسالة، 1417هـ= 1996م؛ والخصائص (2/ 309).
[13] انظر: جامع البيان (1/ 113، 114).
[14] أي: المسْتَشْكِلُ السابق.
[15] البيت للقطامي وهو في ديوانه، ص37. ط: الأولى، تحقيق: إبراهيم السامرائي، وأحمد مطلوب، بيروت: دار الثقافة، 1960هـ.
[16] قال محمود شاكر: «أراد بقوله: (تصديرها)، أي: جعلها مصادر تصدر عنها صوادر الأفعال، وذلك كقولك: ذهب ذهابًا، فذهب صدرت عن قولك: (ذهاب)، ويعمل عندئذ عمل الفعل، وعنى أنهم يُخرِجون المصدر على وزن الاسم فيعمل عمله؛ كقولك: (الكلام) هو اسم ما تتكلّم به، ولكنهم قالوا: كلَّمْته كلامًا، فوضعوه موضع التكليم، وأخرجوا من (كلَّم) مصدرًا على وزن اسم ما تتكلّم به وهو الكلام، فكان المصدر (كلامًا)». انظر حاشية رقم (1) من جامع البيان (1/ 117)، ط: الثانية، حققه وخرَّج حواشیه: محمود محمد شاكر، وخرَّج أحاديثه: أحمد محمد شاكر، القاهرة: مكتبة ابن تيمية، بدون تاريخ.
[17] جامع البيان (1/ 114- 115).
[18] انظر: جامع البيان (4/ 669- 671).
[19] جامع البيان (4/ 671)؛ وانظر: شرح المفصَّل للزمخشري، لأبي البقاء يعيش بن عليّ الموصلي (1/ 274- 276)، ط: الأولى، قدَّم له ووضع هوامشه وفهارسه: إميل بديع يعقوب، بيروت: دار الكتب العلمية، 1422هـ= 2001م.
[20] جامع البيان (5/ 344)؛ وانظر أمثلة أخرى: (8/ 245)، (14/ 611).
[21] انظر: الكتاب، لسيبويه (4/ 64، 65).
[22] التعبير القرآني، لفاضل صالح السامرائي، ص34- 35، ط: الرابعة، عمان: دار عمار، 1427هـ= 2006م؛ وانظر: مدارج السالكين، لابن قيم الجوزية (1/ 452)، ط: الأولى، تحقيق: رضوان جامع رضوان، القاهرة: مؤسسة المختار، 1422هـ= 2001م.
[23] تاج العروس (30/ 209) مادة (قبل)، تحقيق: عبد الستار أحمد فرّاج وآخرين، الكويت: التراث العربي، 1385هـ= 1965م.
[24] مدارج السالكين (1/ 452)، ولمزيد من الأمثلة، انظر: التعبير القرآني، لفاضل السامرائي، ص34- 48.
[25] انظر: جامع البيان (15/ 106).
[26] انظر: جامع البيان (12/ 418)، (23/ 233).
[27] انظر: معاني القرآن، للأخفش (2/ 424)، ط: الأولى، تحقيق: هدى محمود قراعة، القاهرة: مكتبة الخانجي، 1411هـ= 1990م؛ ومعاني القرآن، للفراء (3/ 80)، ط: الأولى، تعليق: إبراهيم شمس الدين، بيروت: دار الكتب العلمية، 1423هـ= 2002م.
[28] وهي بئر في المدينة تقع مستقبلة المسجد النبوي، انظر: المصباح المنير، للفيومي، ص95، مادة (ب ء ر)، ط: الخامسة، صححه: حمزة فتح الله، القاهرة: المطبعة الأميرية،1922م.
[29] أخرجه البخاري (1/ 451)، في كتاب الزكاة، باب الزكاة على الأقارب، برقم (1461)، وقوله: (بخ)، كلمة إعجاب، انظر: غريب الحديث، للخطابي (1/ 610)، ط: الثانية، تحقيق: عبد الكريم إبراهيم العزباوي، مكة المكرمة: جامعة أمّ القرى، 1422هـ= 2001م.
[30] انظر: فتح الباري (3/ 411).
[31] جامع البيان (12/ 418).
[32] جامع البيان (15/ 106).
[33] جامع البيان (23/ 233)؛ وانظر إلى الصيغ الأخرى: (9/ 30)، (14/ 608).
[34] انظر: معاني القرآن، للفراء (3/ 80).
[35] معاني القرآن (3/ 80).
[36] مجاز القرآن (1/ 279).
[37] تأويل مشكل القرآن، ص228- 229؛ وانظر: معاني القرآن، للأخفش (2/ 424)؛ والصاحبي في فقه اللغة، ص224، 237.
[38] جامع البيان (14/ 608، 609).
[39] جامع البيان (15/ 106).
[40] جامع البيان (23/ 233)؛ وانظر أمثلة أخرى: (9/ 30)، (12/ 418)، (15/ 575)، (24/ 292).
[41] انظر: معاني القرآن، للأخفش (2/ 424).
[42] انظر: المحرر الوجيز (3/ 460)، ط: الأولى، تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد، بيروت: دار الكتب العلمية، 1422هـ= 2001م.
[43] انظر: جامع البيان (15/ 106).
[44] انظر: البحر المحيط (6/ 83).
[45] انظر: الدر المصون، للحلبي (7/ 422) تحقيق: أحمد محمد الخراط، دمشق: دار القلم.
[46] انظر: روح المعاني، للألوسي (15/ 184، 185)، بيروت: دار التراث العربي.
[47] التحرير والتنوير، لابن عاشور (30/ 133)، تونس: السداد التونسية للنشر، 1984م؛ وانظر: المخصَّص، لابن سِيده (15/ 70)، بيروت: دار الكتب العلمية.
[48] البلاغة العربية، لعبد الرحمن حبنكة (2/ 300)، ط: الأولى، دمشق: دار القلم، بيروت الدار الشامية، 1416هـ= 1996م.
[49] انظر: جامع البيان (6/ 336، 337).
[50] انظر: تاج العروس (7/ 151)، مادة: (ملح).
[51] هذا ما ذهب إليه الطبري وغيره أنّ وروده قليل، ومنهم من يرى كثرة وروده في اللغة، وسيأتي ذِكرُ ذلك -إن شاء الله- في دراسة الأسلوب.
[52] انظر: المصباح المنير (1/ 413)، مادة: (ش ت م).
[53] جامع البيان (2/ 282).
[54] جامع البيان (11/ 416).
[55] مجاز القرآن (1/ 31).
[56] مجاز القرآن (1/ 256).
[57] معاني القرآن، للأخفش (1/ 40).
[58] تأويل مشكل القرآن، ص314.
[59] انظر: جامع البيان (4/ 336، 337).
[60] وممن ذهب إلى القول بالكثرة: أبو الحسن المعروف بابن سِيده، فقال عند قوله: ﴿يُخَادِعُونَ اللهَ﴾ [البقرة: 9]: «جاز (يُفاعِل) لغير اثنين؛ لأنَّ هذا المثال يقع كثيرًا في اللغة للواحد نحو عاقبتُ اللصَّ، وطارقتُ النعل». المحكم والمحيط الأعظم، لابن سيده (1/ 321)، ط: الأولى، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، بيروت: دار الكتب العلمية، 1421هـ= 2000م.
[61] لعلّه يقصد أبا عبيدة، فإنه قال بهذا القول في مجاز القرآن (1/ 31).
[62] جامع البيان (1/ 281، 282).
[63] انظر: جامع البيان (6/ 232- 235).
[64] جامع البيان (6/ 336، 337).
[65] جامع البيان (11/ 415، 416).
[66] انظر: الجامع لأحكام القرآن (1/ 298، 314- 318).
[67] انظر: مجاز القرآن (1/ 31، 256، 257).
[68] انظر: معالم التنزيل، للبغوي (1/ 65)، ط: الأولى، تحقيق: محمد عبد الله النمر وآخرين، الرياض: دار طيبة، 1409هـ= 1989م.
[69] انظر: جامع البيان (11/ 415).
[70] انظر: مجاز القرآن (1/ 256، 257)؛ والبحر المحيط (5/ 32).
[71] انظر: التحرير والتنوير (10/ 169).
[72] انظر: جامع البيان (4/ 257).
[73] مقاييس اللغة (1/ 311)، مادة: (بهم).
[74] انظر: تهذيب اللغة، للأزهري (6/ 337، 338)؛ ولسان العرب (2/ 376)، مادة: (بهم).
[75] انظر: توضيح المقاصد (3/ ۱۳۱۸)؛ وكلام شارح أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، لابن هشام (4/ 220) هامش رقم (1)، شرح وتعليق: محمد محيي الدين عبد الحميد، بيروت: المكتبة العصرية، 1418هـ= 1998م.
[76] جامع البيان (4/ 257، 258).
[77] انظر: جامع البيان (4/ 257، 258).
[78] معاني القرآن، للفراء (1/ 109).
[79] البيت في ديوانه، ص61، ط: الأولى، تحقيق: واضح الصمد، بيروت: دار صادر، 1998م.
[80] المراد بالإضافة: الإشفاق والحذر، انظر: لسان العرب (4/ 2627)، مادة (ضيف).
[81] أدب الكاتب، ص190، 191.
[82] الجُمَل في النحو، للزجاجي، ص145، ط: الأولى، تحقيق: عليّ توفيق الحمد، بيروت: مؤسسة الرسالة، الأردن- دار الأمل، 1404هـ= 1984م.
[83] معالم التنزيل، للبغوي (2/ 281).
[84] يعني لو كانت التثنية على لفظ المذكّر لكثرت الأحرف الزائدة فيكون: ضبعانان.
[85] دُرَّة الغوَّاص، للحريري، ص305، 306، ط: الأولى، تحقيق: عبد الحفيظ فرغلي عليّ القرني، بيروت: دار الجيل. القاهرة: مكتبة التراث الإسلامي، 1417هـ= 1996م.
[86] الكتاب، لسيبويه (3/ 563).
[87] شرح الكافية الشافية، لابن مالك (2/ 200)، ط: الأولى، تحقيق: عليّ محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود، بيروت: دار الكتب العلمية، 1420هـ= 2000م.
[88] انظر: الجمل في النحو، للزجاجي، ص145.
[89] ارتشاف الضرب (2/ 774).
[90] أي: لفظهما عند قصد الإبهام في التاريخ، فإنه لم يذكر واحدًا منهما فضلًا عن اجتماعهما؛ فلا تعبير عن شيئين بلفظ أحدهما. انظر: خزانة الأدب (7/ 415).
[91] أي: لتغليب المؤنث على المذكّر في التأريخ، وليس مراده أنه لا يُغلب المؤنث على المذكّر إلا في التاريخ؛ إذ ليس الكلام على مطلق تغليب المؤنث على المذكر. انظر: خزانة الأدب (7/ 415).
[92] أي: تغليب المؤنث على المذكَّر.
[93] مغني اللبيب، لابن هشام (6/ 576- 578)، ط: الأولى، تحقيق: عبد اللطيف محمد الخطيب، الكويت- دار التراث العربي، 1421هـ= 2000م، ومن الذين نصروا هذا القول وأنه ليس من باب التغليب: عبد القادر البغدادي. انظر: خزانة الأدب (7/ 407- 416).
[94] جامع البيان (4/ 257، 258).
[95] وإلى هذا القول ذهب الأوزاعي وغيره، انظر: الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي (4/ 143).
[96] انظر: الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي (4/ 142، 143).
[97] انظر: جامع البيان (11/ 303).
[98] انظر: الكتاب، لسيبويه (2/ 130)؛ ومعاني القرآن، للفراء (1/ 282).
[99] جامع البيان (4/ 398).
[100] جامع البيان (11/ 303).
[101] جامع البيان (17/ 136).
[102] ذكر ابن عقيل في شرحه لألفية ابن مالك أربعة وعشرين مُسَوِّغًا للابتداء بالنكرة، انظر شرحه (1/ 203- 212)، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، بيروت: المكتبة العصرية، 1422هـ= 2001م.
[103] الكتاب، لسيبويه (2/ 130).
[104] مراده بالهجاء الحروف المقطعة في أوائل السور، مثل قوله تعالى: ﴿الـمص﴾، والله أعلم.
[105] معاني القرآن، للكسائي، ص141، أعاد بناءه وقدَّم له: عيسى شحاتة عيسى، القاهرة: دار قباء، 1998م؛ وانظر: معاني القرآن، للفراء (1/ 249).
[106] معاني القرآن، للفراء (1/ 282).
[107] معاني القرآن (2/ 147).
[108] جاء في طبعة محمود شاكر (البراءة من الله ورسوله)، ثم علق قائلًا: «في المطبوعة والمخطوطة: (براءة) مكان (البراءة)، والسّياق يقتضي ما أُثبت إن شاء الله». انظر جامع البيان (14/ 95) ط: شاكر، هامش رقم (1).
[109] جامع البيان (11/ 303).
[110] جامع البيان (17/ 136)؛ وانظر معاني القرآن، للفراء (2/ 147).
[111] جامع البيان (20/ 154)؛ وانظر أمثلة أخرى للطبري (4/ 397، 398)، (15/ 452، 453).
[112] إرشاد العقل السليم (3/ 119)، ط: الأولى، وضع حواشيه: عبد اللطيف عبد الرحمن، بيروت: دار الكتب العلمية، 1419هـ= 1999م.
[113] انظر: التحرير والتنوير (18/ 141).
[114] انظر: إرشاد العقل السليم (4/ 437)؛ وروح المعاني (18/ 74).
[115] انظر: إرشاد العقل السليم (5/ 376، 377).
[116] انظر: جامع البيان (20/ 154).
[117] انظر: جامع البيان (1/ 623).
[118] انظر: أوضح المسالك (2/ 39)؛ وتاج العروس (35/ 365)، مادة (ظنن).
[119] انظر المحكم والمحيط الأعظم (10/ 8)، مادة (ظ ن ن)؛ والمدخل لعلم تفسير كتاب الله، للحدادي، ص197، ط: الأولى، تحقيق: صفوان عدنان داوودي، دمشق: دار القلم، بيروت: دارة العلوم، 1408هـ= 1988م.
[120] انظر: مفاتيح الغيب، للرازي (3/ 53)، ط: الأولى، بيروت: دار الفكر، 1401هـ= 1981م؛ واللباب في علوم الكتاب، لعمر بن عليّ الدمشقي (2/ 35)، ط: الأولى، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وآخرين، بيروت: دار الكتب العلمية، 1419هـ= 1998م.
[121] انظر: الكواكب الدريَّة على متممة الأجرومية، لمحمد الرعيني، ص293، ط: الأولى، بيروت: دار الفكر، 1419هـ= 1998م.
[122] انظر: المدخل لعلم تفسير كتاب الله، للحدادي، ص197.
[123] جامع البيان (1/ 623).
[124] جامع البيان (20/ 64).
[125] جامع البيان (21/ 68).
[126] انظر: معاني القرآن، للزجاج (1/ 126)، ط: الأولى، تحقيق وشرح: عبد الجليل عبده شلبي، بيروت: عالم الكتب، 1408هـ= 1988م؛ والمحرر الوجيز (1/ 138)؛ والجامع لأحكام القرآن، للقرطبي (2/ 73).
[127] معاني القرآن (2/ 286).
[128] البيت في ديوانه، ص60، بلفظ: (علانية ظنوا بألفي...)، تحقيق: عمر عبد الرسول، القاهرة: دار المعارف.
[129] مجاز القرآن (1/ 39، 40).
[130] تأويل مشكل القرآن، ص143، 144، وانظر ما اتفق لفظه واختلف معناه من القرآن المجيد، للمبرد، ص53، 54، ط: الأولى، تحقيق وشرح: أحمد محمد سليمان أبو رعد، الكويت: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، 1409هـ= 1988م؛ ومعاني القرآن، للزجاج (1/ 126).
[131] جامع البيان (1/ 623، 624).
[132] جامع البيان (20/ 63، 64).
[133] جامع البيان (23/ 321، 322)، وانظر أمثلة أخرى: (4/ 495، 496)، (15/ 299)، (20/ 457)، (21/ 68، 69)، (23/ 232، 515).
[134] انظر: مفاتيح الغيب، للرازي (2/ 225).
[135] انظر: المحرر الوجيز (4/ 501).
[136] مفاتيح الغيب، للرازي (26/ 198)؛ وانظر: اللُّباب في علوم الكتاب (16/ 407، 408).
[137] وردت هذه القصة في كثير من كتب التفسير بألفاظ متنوعة خلاصتها: (أنّ داود -عليه السلام- لـمّا وجد فضل إبراهيم وإسحاق ويعقوب -عليهم السلام- في الكتب التي يقرؤها سأل ربه أن يُعطيه مثلهم، وأُخبِر أنهم ابتُلوا ببلايا لم تُبتَل بها، فسأل ربه أن يبتليه بمثل ما ابتلاهم به؛ فبينما هو في المحراب إِذْ وقعت حمامة من ذَهَبٍ عند رجليه فأراد أن يأخذها فطارت إلى كوَّة فذهب ليأخذها فطارت، فأبصر امرأة جميلة، فأُعجب بها وسأل عنها، فأُخبِر أنّ لها زوجًا وهو في الغزو، فأرسل إلى أمير تلك الغزاة أن يجعله في مقدمة الجيش، فلمّا قُتل خطبها وتزوّجها)، انظر: جامع البيان (20/ 64- 69)؛ والجامع لأحكام القرآن، للقرطبي (18/ 155 وما بعده) وغيرهما، ولا يخفى بُطلان هذه الرواية الإسرائيلية؛ لِمَا فيها من القدح في نبي الله داود -عليه السلام- وحاشاه أن يكون كذلك، يقول ابن كثير معلقًا على هذه الرواية: «قد ذكر المفسِّرون هاهنا قصة أكثرها مأخوذ من الإسرائيليات ولم يثبت فيها عن المعصوم حديث يجب اتّباعه؛ ولكن رَوى ابن أبي حاتم هنا حديثًا لا يصح سنده؛ لأنه من رواية يزيد الرقاشي عن أنس، ويزيد وإن كان من الصالحين لكنه ضعيف الحديث عند الأئمة، فالأَوْلَى أن يُقتصَر على مجرّد تلاوة هذه القصة، وأن يُرَدَّ علمها إلى الله عز وجل، فإنّ القرآن حقٌّ، وما تضمّن فهو حقّ أيضًا». تفسير القرآن العظيم (12/ 81، 82) ط: الأولى، تحقيق: مصطفى السيد وآخرين، جيزة: مؤسسة قرطبة ومكتبة أولاد الشيخ للتراث، 1421هـ= 2000م، وأحسن مَن تكلّم في إبطال هذه الرواية الرازي؛ فقد ذكر أوجهًا كثيرة لإبطالها، انظر: مفاتيح الغيب، للرازي (26/ 189- 194).
[138] انظر: نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، للبقاعي (16/ 361، 362)، ط: الثانية، القاهرة: دار الكتاب الإسلامي؛ ومفاتيح الغيب، للرازي (26/ 193، 194).
[139] انظر: معاني القرآن (3/ 89)؛ وجامع البيان (23/ 321، 322).
[140] انظر: التحرير والتنوير (29/ 224).
كلمات مفتاحية
الكاتب:

فواز بن منصَّر سالم الشاووش
حاصل على الدكتوراه في التفسير وعلوم القرآن من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وله عدد من المشاركات العلمية.
مواضيع ذات صلة
((المعلومات والآراء المقدَّمة هي للكتّاب، ولا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع أو أسرة مركز تفسير))