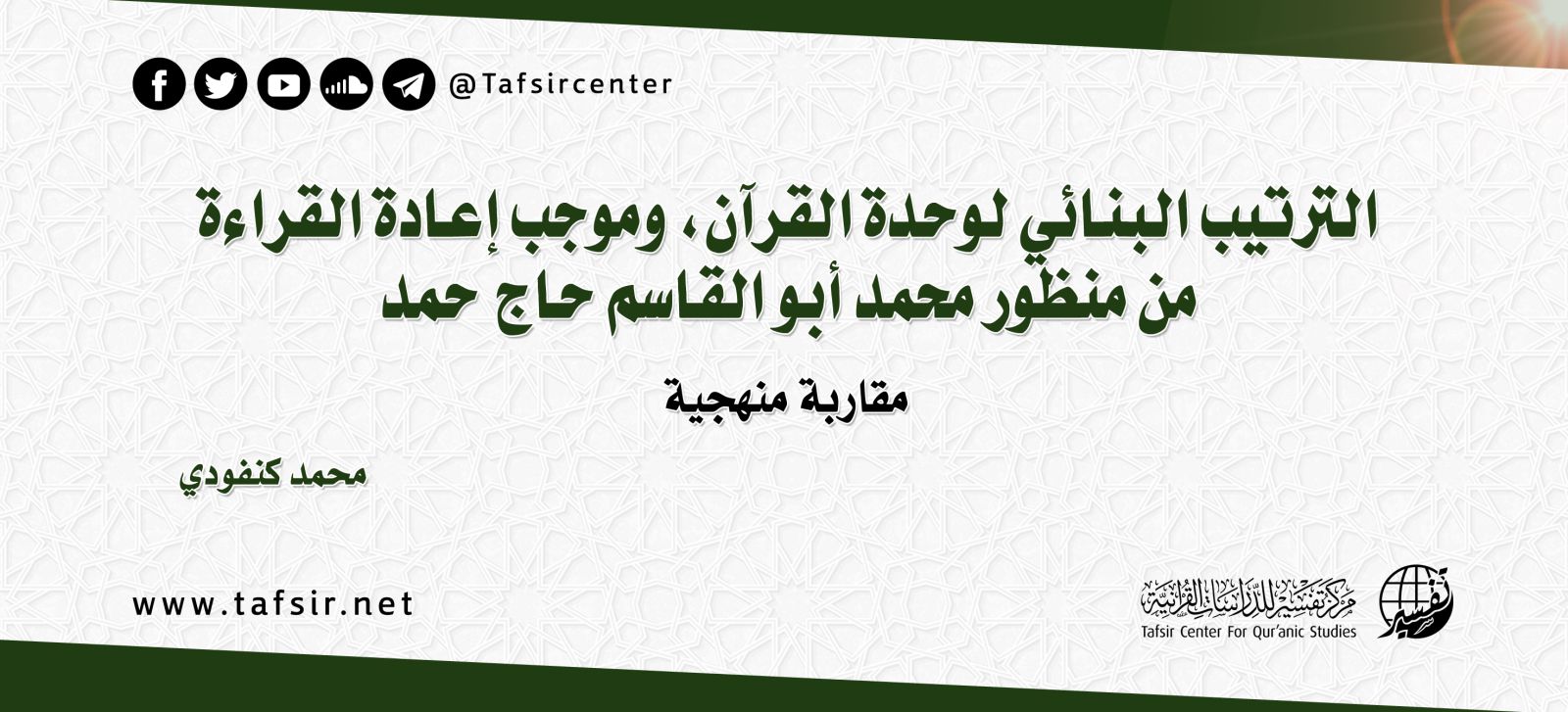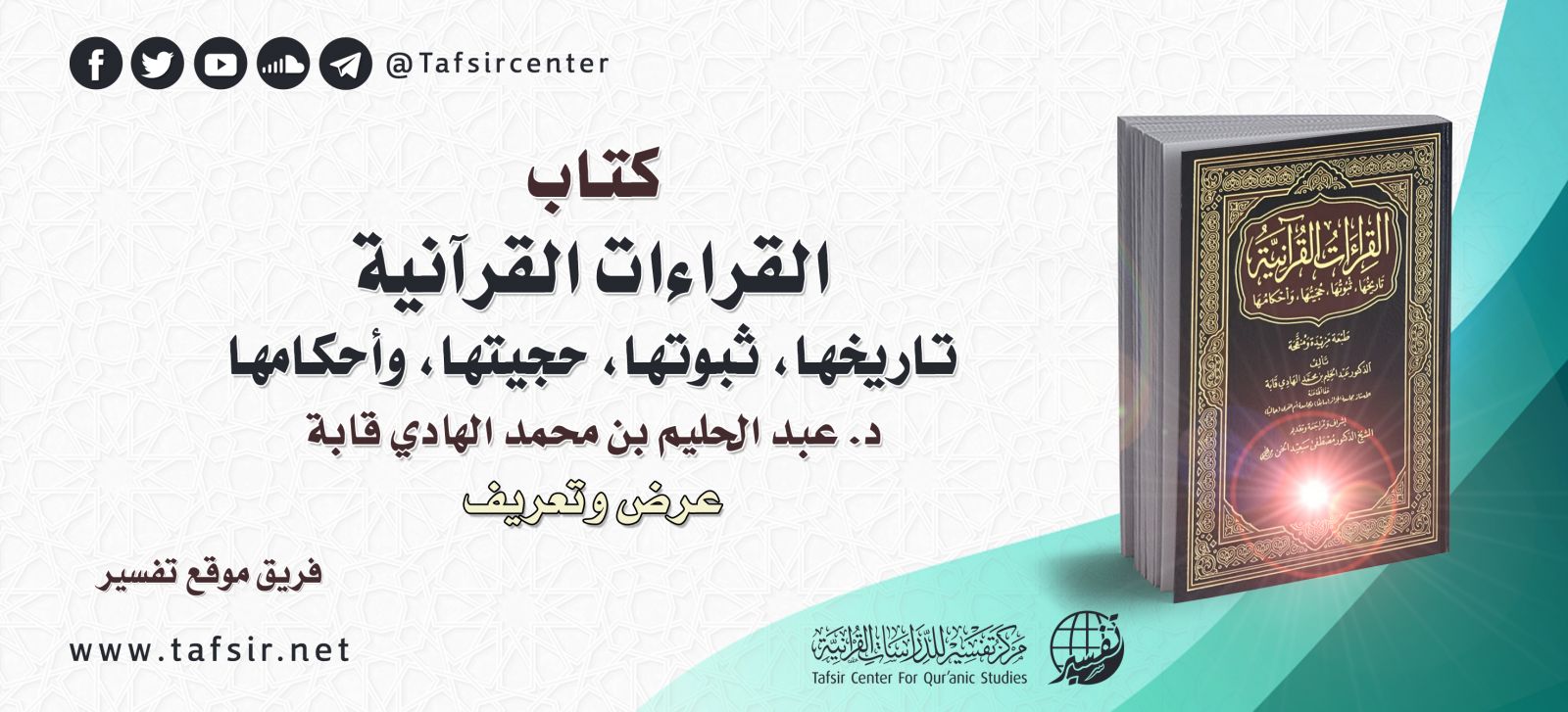القراءات الحداثية للقرآن (8): محمد أركون والرهان الإبستمولوجي للقراءة
محمد أركون والرهان الإبستمولوجي للقراءة
أولًا: طبيعة النصّ القرآني
الكاتب: طارق محمد حجي

ربما يمكننا اعتبار خطاب الجزائري محمد أركون (1928- 2010) هو التكثيف الأكبر والأعمق لمعظم محدَّدات ومنطلقات ورهانات القراءة الحداثية للقرآن، حتى إنَّ تناوُلَ خطابه قد يصلح أن يكون النافذة الأوسع لمُعايَنة مجمل أبعاد هذه القراءة؛ ملامحها ومنطلقاتها وآفاقها، بالطبع يظلّ لخطاب أركون ملامحه الخاصّة تمامًا، والتي يعطيها له بناؤه المنهجي الخاصّ، أو حتى قبل هذا رؤيته للمنهج ولضرورة الاتساع المنهجي، والاستفادة من مجمل المقاربات والمداخل التي وفَّرَتها ثورة العلوم الإنسانية الحديثة: (الألسنيات- السيميائيات- الأنثروبولوجي- علوم الأديان- الأركيولوجي- النقد الأدبي)، كخصيصة من خصائص «العقل الاستطلاعي، المستقبلي، المنبثق حديثًا»[1]، هذا المفهوم «العقل الاستطلاعي» المركزي في (إسلامياته التطبيقية)؛ كذلك تلك الملامح الخاصّة التي يعطيها لخطاب أركون تعدُّد الخطابات التي يقيم بناء خطابه في مواجهتها، فأركون يبني خطابه في مواجهة -أو دعنا نقول: عبر الحوار مع- الخطابات الإسلامية التقليدية والحداثية من جهة، والخطاب الاستشراقي الفيلولوجي الذي أولاه أركون اهتمامًا بالغًا بنقد ربما هو الأشرس من جهة أخرى. لكن ربما هذه الخصوصية ذاتها لخطاب أركون بكلّ أسبابها تلك هي ما تُبْرِز الخطاب كتحقيق وتكثيف وتعميق للقراءة الحداثية للقرآن في مجملها، كما سنحاول أن نوضح في مقالَيْنا هذين عن أركون.
ونريد التأكيد -مبدئيًّا- أنه ورغم اتساع المساحة التي يشغلها القرآن في خطاب أركون حتى ربما ليغطي هذا الاشتغال على بقية المساحات، كذا ورغم مركزية اشتغاله على القرآن كجزء من مشروع أوسع هو (نقد العقل الإسلامي)[2] -إلا أن هذا الاهتمام على اتساعه ومركزيته ليس الوحيد في اهتمامات أستاذ الدراسات الإسلامية في جامعة السوربون؛ فلأركون عددٌ كبيرٌ من الاهتمامات الأخرى المُتّصِلة/المُنفصِلة بمساحة الاشتغال على القرآن، مثل اهتمامه بالتراث الإسلامي في مجمله في (عقله الكلاسيكي) و(عقله السكولاستيكي)، أو اهتمامه بـ(المنسي) و(اللا مفكر فيه) في هذا التراث، كذا اهتمامه بالتراث الإنسانوي الإسلامي خصوصًا في فترة القرن الرابع الهجري والذي كتب عنها رسالته لدكتوراه الدولة في الستينيات: (الإنسانية العربية في القرن الرابع الهجري: مسكويه فيلسوفًا ومؤرخًا)، واهتمامه -بحكم حياته في فرنسا- بقضايا العلمنة والإسلام والتحديث وعلاقات الأديان الكتابية ببعضها وبالعلمانية، كذلك اهتمامه الكبير بالاستشراق وعلاقته بالإسلام ودخوله في عدد من الجدالات مع مستشرقين كبار مثل الفرنسي ماكسيم رودونسون والألماني جوزيف فان إس حول المناهج المُستَخدمة في دراسة الإسلام، كذا اهتمامه بمنهجيات علوم الأديان المعاصرة، وغيرها من اهتمامات شكَّلت خطاب أركون وأعطته سماته الخاصّة حتى على مستوى نمط الكتابة ذاته الذي يتسم -وكما يعرف كلّ من قرأ كتابات أركون- بتداخل وبدائرية، مصدرها ربما تَعُّدد الإشكالات المطروحة وتَعدُّد المداخل والمقاربات وتَعدُّد المخاطَبِين المُوجَّه إليهم الخطاب ذو الأهداف الكثيرة المضمونية والمنهجية والمُتعلِّقَة بهدف أشمل هو (إعادة تشكيل حقل الإسلاميات)[3].
هذا الاتساع في اهتمامات أركون سَيُشَكِّل بالطبع طريقة تعامله مع النصّ القرآني ومساحات اشتغاله عليه، فخطاب أركون ربما يكون أكثر القراءات الحداثية اتساعًا في التعامل مع مساحات درس النصّ القرآني؛ فأركون لا يقتصر في التعامل مع القرآن على التعامل التأويلي ويَدَع في مقابل هذا مساحة جَمْع النصّ، بل وحتى مساحة تنزُّل النصّ، أي: مرحلة الوحي (مثل: نصر أبو زيد)، كذا لا يقتصر على مساحة جَمْع النصّ والوحي ويدَع مسألة التأويلية (مثل: عبد المجيد الشرفي)، بل يحاول أركون -بحكم اتساع منهجياته واشتغالاته وتَعدُّد منظوراته- أن يتعامل مع معظم هذه الإشكالات المحيطة بدرس القرآن، فيتعامل مع القرآن في مرحلة تداوله الشفهي ثم في مرحلة تدوينه الكتابي ثم في مرحلة تلقِّيه الطقسي ثم في مرحلة تلقِّيه التفسيري، ويتعامل مع إشكالات تدوين المصحف وجَمْعه، ويُسيِّق القرآن تاريخيًا في تاريخٍ طويلِ المدة، ويُفرِد اهتمامًا خاصًّا للقصص القرآني كمساحة أساسية من مساحات (العجيب المُدهِش) -تلك المقولة المهمّة في فكر أركون والتي سنتناولها تفصيلًا-، كما يهتم اهتمامًا خاصًّا لـ(الألسنية الدينية)، ولطبيعة النصّ القرآني، كذا يتشابك أركون مع بعض علوم القرآن التراثية، مثل: أسباب النزول، ويتشابك كذلك مع بعض النصوص التراثية، مثل: تفسير الطبري لآية الكلالة، ومثل: تفسير الرازي لسورة الفاتحة، كما حاول أركون بلورة اهتمامه (التأويلي) بالقرآن عبر تقديم تفسير/نقد لسورة الفاتحة وسورة الكهف وسورة العلق، تفسير يتجاوز به بروتوكولات القراءة المعتادة: البروتوكول الطقسي الإيماني، والبروتوكول التفسيري التقليدي[4]، ويتجاوز كذلك نمطَي القراءة المُتَكرِّسَيْنِ: نمط القراءة الإيمانية التبجيلية السائدة إسلاميًّا وعربيًّا، ونمط القراءة الفيليوجية الاستشراقية المحبوسة في وضعانية القرن التاسع عشر السائدة غربيًّا، بقراءة جديدة (ألسنية- نقدية) لا تجزم ولا تقطع بتأويل، بل تجعل مهمتها الأساس (التعامل النقدي مع القرآن)، أي: استكشاف نمط اشتغال النصّ القرآني، واستشكال قضية (المعنى).
محاولتنا في هذا المقال هي تحديد أبعاد خطاب أركون من حيث رهانات الخطاب وبنائه المفاهيمي والمنهجي وتحديده لطبيعة النصّ القرآني، وبيان كيف يُعتبَر خطاب أركون تكثيفًا للاشتغال الحداثي على القرآن وكشفًا عن ملامحه وآفاقه، وهذا عبر مقارنة دائمة -مبثوثة داخل المقال- لخطاب أركون بخطابات نصر أبو زيد وعابد الجابري ويوسف الصديق، قبل أن نحاول في المقال الثاني الوقوف على أبعاد (تأويليته الخاصّة) للقرآن المُتبَدِّية في تشابكه مع تفسير الطبري والرازي من جهة، وبلورته تفسيرًا أوّلِيًّا لسور الفاتحة والكهف والعلق من جهة أخرى.
نبذة تعريفية بمحمد أركون:
محمد أركون هو مفكر جزائري وُلد في فبراير عام 1928، بقرية ثاوريرت ميمون بمنطقة بني يني، التابعة لولاية تيزي وزو الأمازيغية.
وقد تعلَّم أركون القرآن في سنٍّ صغيرة في مدرسة أسّسَها عمه، ودرس أركون في المرحلة الثانوية في وهران، لدى الآباء البيض، والتي تدعى حاليًا بثانوية باستور، وحصل على شاهدة البكالوريا عام 1949.
ثم درس أركون في جامعة الجزائر الأدب العربي والقانون والفلسفة والجغرافيا، وتخرج عام 1952، ليشتغل أستاذًا بثانوية الحراش.
حصل أركون على الماجستير في اللغة والأدب العربي، عام 1954، وكان موضوع دراسة الماجستير هو الجانب الإصلاحي في أعمال طه حسين.
ثم سافر أركون إلي فرنسا ليلتقي بالمستشرق الفرنسي الكبير لوي ماسينون، وبالمستشرق ريجي بلاشير والمستشرق جاك بيرك.
نال هناك أركون أطروحة دكتوراه الدولة عن دراسة حول الإنسانية العربية في القرن الرابع، وتحديدًا فلسفة ابن مسكويه، عام 1968.
منذ عام 1956 شغل أركون عدة مناصب في التعليم الثانوي والجامعي داخل فرنسا وخارجها:
- فشغل منصب أستاذ بكلية العلوم الإنسانية بستراسبورغ، منذ عام 1956 وإلى عام 1959.
- ومنصب أستاذ مساعد بجامعة السوربون منذ عام 1961 وحتى عام 1969.
- ومنصب أستاذ مشارك بجامعة ليون منذ عام 1969 إلى عام 1970.
- ومنصب أستاذ بجامعة السوربون الجديدة بباريس منذ عام 1972 وحتى عام 1992.
منذ عام 1980 عُيِّن محمد أركون أستاذًا لتاريخ الفكر الإسلامي والفلسفة في جامعة السوربون العريقة.
ومنذ عام 1993 شغل أركون منصب عضو في مجلس إدارة معهد الدراسات الإسلامية في لندن، وظلّ في منصبه هذا وإلى وفاته في 2010.
كذلك تمت دعوة أركون للتدريس لفترات قصيرة في عدد من الجامعات خارج فرنسا، حيث دَرَّس:
عام 1969 بجامعة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، وأعوام: 1986- 1987- 1990 في جامعة برلين بألمانيا.
ودرَّس في جامعة برنستون بالولايات المتحدة الأمريكية، منذ عام 1991 وإلى عام 1993.
وفي هذه الفترة نفسها كان أركون قد ألقَى عددًا من المحاضرات في جامعتي: روما بإيطاليا، وأمستردام بهولندا.
وتوفي أركون في سبتمبر عام 2010، في أحد مستشفيات باريس، بعد معاناة مع مرض السرطان، وعاد وبناءً على وصيته إلى المغرب ليُدفَن هناك[5].
تزامنية أركون غير المحدودة:
ربما، وكما حاولنا أن نُبيِّن من خلال المقالات السابقة، فإن (التاريخية) تُشكِّل موقعًا مركزيًّا داخل العُدّة المنهجية لكلّ القراءات الحداثية للقرآن، وكنا قد أشرنا في مقال (عبد المجيد الشرفي، القرآن وتحديث الإسلام)[6] إلى أن التاريخية مفهوم مهمّ وأساس في الدّرس الحداثي للقرآن، من حيث إن الحداثة -وكما يرى داريوش شايغان- هي في تجليها المعرفي: (نسيان نَشِط للنبوة)، ورفض للأركيتيبات أو الكتب الأزليّة التي تنظر لها الحداثة (كأصنام ذهنية) ينبغي التحرّر منها للعودة للعقل الفطري (ديكارت)، أو العقل الصفحة البيضاء (بيكون-لوك)؛ لذا فإنّ القرآن -وعبر النظرة المستقِرَّة له في التقليد ككتاب أزلي مُفارِق يحوي التجلي الأكمل والأخير لكلامٍ لله- يُقاوِم الحداثة القائمة في عمقها على التخلّص من النماذج الأزلية، من هنا تأتي رهانية ومركزية مفهوم التاريخية في كلّ تعامل حداثي مع النصّ[7]، فهو المفهوم الذي يتم عبره مواجهة هذه الأزلية بإعادة تسييق القرآن في سياقه التاريخي والاجتماعي والفصل بين جهات النصّ: جهة دلالته على الكلام الأزلي، وجهة دلالاته على النصّ الذي بين أيدينا، والذي يُنسبَن وتُرفَع عنه القداسة ويُنظَر إليه على أنه أحد التجليات النسبية للكلام الأزلي فحسب، وليس التجلي الأكمل كما تراه النظرة التقليدية.
لكن كما حاولنا أن نُوضِّح أيضًا في المقالات السابقة، فإن مفهوم التاريخية ليست له الدلالة نفسها عند معظم روّاد القراءة الحداثية، بل دعنا نقول إنه لا يوجد مفهوم أكثر إشكالية ربما وتعقيدًا وغموضًا وبُعدًا عن إيجاد دلالة واضحة مُشترَكة بين الحداثيين أنفسهم من مفهوم التاريخية هذا، وهذا على أكثر من مستوى، سواء على مستوى رهانات فكرة التاريخية في كلّ خطاب من هذه الخطابات، أو على مستوى دلالة التاريخية كتقنية منهجية مُشغَّلة على القرآن، أو على مستوى موقع ودَور التسييق التاريخي في عملية اكتشاف/ إنتاج المعنى، ففي كلّ هذه المستويات نحن أمام رؤى تختلف من مفكِّر لآخر.
ففي خطاب الجزائري محمد أركون الذي نتناوله هنا، فإن للتاريخية رهانات خاصّة تمامًا ربما لا يشاركه فيها إلا خطاب نصر أبو زيد في مرحلته الأولى التي عَنْوَنَّاها سابقًا بمرحلة (تأسيس مقولة التاريخية)، هذا الرهان هو تخليص القرآن من «جملة المفاهيم المُؤطِّرة له في التقليد والمنهجيات المُستَخدَمة في قراءته المُتماشية مع هذه المفاهيم»، أو ما عبَّرنا عنه سابقًا، بـ(أرخنة القرآن) كمُحدِّد ومُؤسِّس للقراءة الحداثية، أي: عملية تغيير (طبيعة النصّ القرآني)، من نصّ أزلي مُفارِق إلى نصّ بشَريّ من جهةٍ ما. وهذا؛ تمهيدًا للدرس الحداثي للنصّ والقائم على تطبيق منهجيات تنتمي لسياق معرفي مُغايِر، فالتاريخية هنا هي بهذه الدلالة أُولى خطوات عملية (الزحزحة)[8] -وهو مصطلح أركوني أصيل- للنصّ القرآني من حقل اللاهوت ومجمل الإبستيمة التقليدية إلى حقول العلوم الحديثة بإبستيماتهها المغايرة[9].
وربما نستطيع القول أنّ جزءًا ليس بالقليل من مساحة اشتغال أركون على النصّ القرآني كانت محاولة لإحداث هذه (الزحزحة)، عبر تشغيل ترسانة مفاهيمية وظَّفها أركون لنزع إطار القرآن المفاهيمي فالمنهجي التقليدي، وإعادة تأطيره في جملة مفاهيم ومناهج أخرى، من هنا حاول أركون القيام بعدد من إجراءات نزع الإطار التقليدي وبلورة إطار جديد، فقام أركون بنزع عبارات التعظيم، وقام بالتخلّص من المفاهيم التقليدية في تأطير النصّ، مثل: (القرآن)، (الآية)، ليضع محلها مصطلحات أخرى: (الظاهرة الإسلامية)، و(الظاهرة القرآنية)، و(الحدث الإسلامي)، و(النصّ الرسمي المغلق)، و(مجتمعات الكتاب)، و(الخطاب النبوي)، و(الوحدة النصيّة المتمايزة)[10]؛ ليقوم -وكما يقول مترجِمُه وصديقُه هاشم صالح- بـ(إزاحة الشحنات اللاهوتية القائمة في هذه المفاهيم التقليدية)، والتي تُعيِق الدرس الحديث للنصّ القرآني، وتسجنه في سياجات (دوغماطيقية) كرَّستها قواعد التفسير الموروث أو (السيادات المأذونة) كما يُعبِّر أركون[11].
ومن هنا وعَبْر استحضار هذا الرهان للتاريخية، نفهم لماذا لم يكن أركون مُرحِّبًا -بصورة كبيرة- بالاشتغالات التي تُوظِّف مفهوم التاريخية من أجل أرخنة بعض التشريعات أو تمرير بعض التشريعات القانونية الحديثة مثل اشتغال نصر أبو زيد أو اشتغال الصادق بلعيد[12]، فما كان مهمًّا ومركزيًّا عند أركون هو تأكيد وتشغيل هذا الرهان الإبستمولوجي لفكرة التاريخية، والذي لا يمكن حصره في الاشتغال على بعض أجزاء النصّ التي تعيق بعض إجراءات الحداثة، بل لا بد بحكم إبستمولوجيته أن يَتّسِع ليشمل أشكلة مفهوم الوحي التقليدي وتغيير طبيعة النصّ القرآني المُنتِجَة لمنهجيات القراءة، والذي يعيق الحداثة معرفيًّا عبر مخايلته بالأزلية. وهذا ما يمكن أن نعتبره إدراكًا من أركون للرهان الإبستمولوجي لهذا المفهوم، غاب عن كثير ممن استخدموه.
وفي هذا الاستخدام لمفهوم التاريخية برهانه الإبستمولوجي نستطيع اعتبار أركون مُبلوِرًا ومُكثِّفًا لذلك الرهان الذي اعتبرناه رهانًا حاسمًا في القراءات الحداثية للقرآن الناشئة في مُنْعَطَف التأسيس الثاني للنهضة، أي: رهان الانتقال في التعامل مع الحداثة من التعامل الانتقائي البراني الإجرائي، لتعامل أعمق يُنجِز التحديث على مستواه المعرفي المُؤسِّس، فالتاريخية بتخليصها القرآن من أزليته وبتغييرها طبيعته، وبأشكلة مفهوم الوحي، و(تفكيك التصور التقليدي حوله)[i]، ودراسته (ألسنيًّا وأنثروبولوجيًّا)[ii]، فإنها تتجاوز الترقيع الذي وصل في الفكر العربي حدّ كونه (لا مفكر فيه) والذي يقوم بالدمج بين (الدراسة الأفقية للنصّ) والتي تؤرخِن بعض تشريعاته القانونية، والقراءة العمودية له كنصّ (موحى به)[iii]؛ وهذا لأن هذه التاريخية -وعلى عكس هذه الترقيعات- تقضي على (الذاكرة الأزلية/الأصنام الذهنية) التي تعيق الحداثة معرفيًّا.
كذلك إذا تركنا التاريخية كمُحدِّد منهجي ونظرنا لها من حيث كونها تقنية منهجية مُشغَّلة على النص، كجزء من برنامج تأويلي لإنتاج/اكتشاف المعنى، هو ما يُعبِّر عنه أركون بـ(القراءة التزامنية للقرآن)[iv]، أي: «القراءة المُطابِقة زمنيًّا للنصّ المقروء، القراءة التي تحاول العودة إلى الوراء، إلى زمن النص كي تقرأ مفرداته وتركيباته بمعانيها السائدة آنذاك»، وهذه القراءة التزامنية بدلالتها هذه هي: «عكس القراءة الإسقاطية التي تقع في المغالطة التاريخية»[v]، و«التي استمرت قرونًا وقرونًا في الفكر الإسلامي ولا تزال مُستَمِرَّة»، كما أنها من جهة أخرى «مُضادَّة للقراءة التجزيئية، وذلك من حيث إنّ (القراءة التزامنية) هي قراءة كلية تنظر إلى القرآن في كليته»[vi]، «قراءة تستعيد لحظات التلقي الأصلية»، «قراءة العجيب المدهش كما كان يتلقاها العربي المعاصر للنصّ»، نقول: إننا لو انتقلنا للبحث عن دلالة التاريخية كتقنية داخل برنامج التزامنية هذا، فسنجد أن لها دلالة خاصّة تمامًا تختلف عن دلالتها عند غير أركون، من حيث مدى التاريخ المُسيَّق فيه القرآن، فبينما وجدنا هذا التسييق يخضع غالبًا للتاريخ قصير المدّة والتاريخ اليومي: (نصر أبو زيد وعابد الجابري، تاريخ عشية الدعوة وتاريخ الدعوة)، أو للتاريخ متوسط المدة: (يوسف الصديق، تاريخ الحضارة اليونانية)، نجد أركون يستخدم بالإضافة لهذه التواريخ، التاريخ طويل المدة، فهو يُسيِّق القرآن في تاريخ مدونات الديانات السامية وديانات الشرق الأوسط القديم[vii]، وهو ما كان يشير إليه نصر أبو زيد مُنتَقِدًا على أنه إغراق تزامنية أركون في كلية الزمن اللامحدود[viii].
وهذه الطبيعة الخاصة لتزامنية أركون كانت لها بالطبع أثرها على كثير من أبعاد تعامل أركون مع النص القرآني التي افترق بها عن غيره ممن وظَّفوا التاريخية كتقنية منهجية كذلك.
فبسبب هذا التحديد للتزامنية كــ(تزامنية تتعلق بزمن لا محدود) نجد أن أركون رغم تاريخيته ينطلق في التعامل مع النصّ القرآني كنصّ له (وحدة)، وحدة قائمة في مركز دلالي تتشابك عنده كلّ مستويات الدلالة والمعنى وتَستنِد إلى ما كان قد دُعِيَ في التوراة بـ(البنية المركزية للميثاق)[ix][13]، كما نجده يلتفت لضرورة البحث عن (ألسنية دينية) وربما قرآنية خاصّة[x].
فالوحدة والتماسك التركيبي والدلالي حول مركز مُوحَّد للدلالة، وتَميُّز اللغة وعلوّها عن أن تكون مجرد لغة توصيلية، كمفاهيم مُشكِّلة لما كان قد أسماه عليّ حرب بـ(وقائعية النصّ)، تُعطِي للقرآن استقلالًا تجاه الواقع القرشي عشية الدعوة وأثناءها، وتعلو به عن (تاريخ الواقعة) الذي يُدافِع عنه الجابري وأبو زيد، وينقله من البحث عن أسباب النزول الرابِطة القرآن بالواقعة، لمحاولة اكتشاف (ظرف الخطاب) المُرتَبِط بكلية النصّ[14]، ويُمكِّن بصورة كبيرة من اكتشاف عمليات التحوير والتعديل وآليات الانفصال والمباعدة والاستيعاب والتعديل التي قام بها القرآن تجاه الواقع القرشي على مستويات مُتداخِلة: مستوى اللغة والفكر والسرد والشعائر؛ مما يعني تَشَكُّلًا مختلفًا تمامًا لبرنامج التأويلية الأركوني على مستوى الأدوات ومستوى التعامل مع المدونة التراثية وعلومها.
الألسنية الدينية وطبيعة القرآن:
كما قلنا فإن أركون يتحدث عن ضرورة البحث عن (ألسنية دينية) من أجل دراسة لغة القرآن؛ وهذا لأن أركون يرى أنّ لغة القرآن ليست لغة توصيل عادية رغم أنها تستخدم في الأخير لغة بشرية لها قواعدها النحوية والتركيبية والأسلوبية وموازينها الصرفية، فهذه اللغة ولكونها مرتبطة بالوحي فهي «اللغة المتعالية وذات القدرة الهائلة على التعالي»[xi]، من هنا قدرتها على التعالي بالوقائع والأحداث وطمس تاريخيتها، والتأثير في السامع سيكلوجيًّا ونفسيًّا، وهي لغة مُرتَبِطة بــ«المنطق الشعري أكثر من ارتباطها بالمنطق العقلاني، إنها تُغذِّي الخيال وتهزّ العاطفة أكثر مما تسجن أو تحجز القارئ في مقولات وتحديدات وقواعد عقلانية»[xii].
هذه اللغة بطبيعتها تلك ترتبط بمنطق الخطاب القرآني ككلّ، والذي هو منطق ميثي مُرتَبِط بالميثوث العجيب المدهش أكثر من ارتباطه باللوغوس العقلاني.
فالقرآن -وفقًا لأركون- (نصّ ميثي)[xiii] بمعنى أنه يلجأ لتقنيات السرد الأسطوري[xiv] في التعالي بالأحداث وفي التأثير على السامع وفي جعله جزءًا من بنية تَمَثُّلِيّة يكون القائل/الفاعل المُطلَق (الله) جزءًا منها.
ويحاول أركون -ومن أجل تأسيس أفكاره هذه عن (اللغة الدينية) و(طبيعة القرآن كنصّ ميثي)- أن يُحلِّل بعض الثنائيات اللغوية القرآنية ليُبرِز كيف أنّ هذه المفاهيم التي قد تشير إلى موجودات زمانية ومكانية عادية قد تم شحنها بحمولة دينية إيحائية تتجاوز منطق التوصيل العادي وتخترق وتعيد تشكيل الفضاء الزمكاني المحايد، كذا حاول تحليل ما أسماه بمفاهيم الحساسية والإدراك والتي يراها تُعبِّر عن كون القلب هو منطق التفكير والإدراك في الإسلام لا العقل.
فيتناول أركون لغة القرآن من خلال (تركيبة الضمائر) أو (إشارية الضمائر)[15] ومن خلال (إشارية الزمكان) ليرى الطريقة التي ينظمهم بها النصّ القرآني.
فيرى أنّ القرآن يستخدم عددًا كبيرًا من كلمات زمكانية، مثل: الأرض والسماء والبحر والشمس والقمر والنجوم والسَّنة والشهر والليل والنهار والفجر والضحى، كما تستخدم مؤشرات لسانية على الزمن أو المكان مثل: (وحين، يومئذ، وسوف، وأجل، وأمد) وغيرها، ويرى أركون أن هذه العلامات الزمكانية حين تذكر في القرآن فإنها تندرج ضمن إدراك شمولي للكون/الزمن، بوصفها الكون عبارة عن مخزن للعلامات أو الآيات أو الرموز.
وهذه المفردات -وفقًا له- لا تُستخدَم في القرآن لذاتها أو للإشارة لموجودات محسوسة، وإنما كنوع من العلامات والرموز إلى أشياء أخرى تتجاوزها، فهي تشكل نظامًا من العلاقات والإحداثيات الروحية[xv].
كذلك يقوم القرآن -وفقًا لأركون- بربط هذه الرموز الزمكانية بثنائيات ضدية، مثل: الموت والحياة، ليتحول الحيز الزمكاني من حيز طبيعي فيزيقي محايد إلى حيز زمكاني متجاوز، مخترق بالحادث الأهم والأكثر مركزية أي: العهد والميثاق بين الله والإنسان.
لذا ينقسم هذا الحيز الزمكاني -وفقًا لعلاقة الإنسان بالله الميثاقية- إلى ثلاثة أزمنة: الزمن القصير والعابر والمؤقت للحياة الدنيا، ثم الزمن غير المحدود للموت والإقامة البرزخية في القبر، ثم زمن الآخرة والعودة الأبدية والخلود، وهذا هو الزمن الذي يقود إلى كِلا الزمنين السابقين ويعلو عليهما[xvi]
وربما النقطة الأهم في تأسيس أركون لتصوره عن (اللغة الدينية) للنصّ القرآني وارتباطها بـ(ميثية النص) هي بحث أركون في طبيعة العقل الذي يتحدث عنه القرآن والذي يتوجَّه إليه خطابه مُطالِبًا إياه بالتدبُّر والتفكُّر، حيث يحاوِل أركون -ومن أجل تأكيده على (ميثية النصّ)- إبراز أن العقل المذكور في القرآن، هو العقل الميثي المرتبط بالميثوث العجيب الخلاب أكثر من ارتباطه باللوغوس العقلاني سواء اليوناني أو الحديث.
من أجل هذا قام أركون بدراسة استعمال القرآن لما أسماه مفاهيم «التحسس (الإحساس) والتصور والإدراك، مثل: عقل ويعقل ويبصر ويسمع ويفهم ويتدبر وينظر ويتفكر، والتي تخرج كمفاهيم مترابطة بمفهوم العقل والتعقل القرآني إلى دلالات القلب والعاطفة أكثر من دلالة العقل بالمفهوم الفلسفي اليوناني أو بالمفهوم العقلاني الحديث، فالتحليل الألسني لورود أفعال (عقل - يعقل) في القرآن يكشف عن فعَّالية الإدراك والتصور لدلالات متعالية في وعي لا يتجزّأ، و(يتمثل هذا الإدراك -الإحساس- في آن معًا بعملية الحجز أو الربط والتذكر - تفكر- تذكر) وفي فهم الخطاب (فقه) وفي إحساس صميم بالمعنى (شعر) وهو يتمثل أخيرًا في العلم الآني والكلي (علم)، الذي يولّد الموافقة والخضوع لكلام الله الخلاق»[xvii].
فالعقل الذي يتحدث عنه القرآن هو -وفقًا لأركون- ليس عقلًا يُفسِّر العالم، بل عقلًا ينبهر ويندهش بالخلق، ويعكس دهشة المؤمن، وعجبه من معجزات الله، فالعجيب المدهش هو ما يُحيِّر الإنسان بسبب عدم قدرة الإنسان على معرفة علّته وسببه أو الطريقة التي ينبغي اتباعها من أجل التأثير عليه، وهو عجب ينتهي بالألفة والتكرار[xviii].
ولعلّ هذا التعامل مع (العقل) في القرآن يُخالِف تمامًا تعامل يوسف الصديق ونصر أبو زيد وعابد الجابري؛ حيث -كما وجدنا سابقًا- إن الصدِّيق يراه هو العقل اليوناني ويُوحِّد بينه وبين الإيمان، ويرى نصر أبو زيد في تحليله آيات الجنّ والشياطين والسحر في القرآن أن النصّ القرآني قام بتحويرات دلالية في هذه المفاهيم المُنغَرِسة في (اللغة) الجاهلية ذات التصورات الأنطولوجية المخصوصة مغزاه الانتقال إلى بوابات العقلانية، ويرى الجابري -كما سيأتي تفصيله في مقال لاحق مخصص لخطابه- أنّ القرآن خطاب عقلاني، ربما دون تحديد دلالة عقلانيته وإنْ كان يشابهه بالعقلانية الحديثة عَبْر وساطة المنظور الرشدي.
وإن كان الوقت مبكرًا على إصدار حكم على هذه الاشتغالات، إلا أنه من اللافت أن اشتغال أركون وحده بين هذه الاشتغالات هو النابع من تحليل لحقل مفاهيم الإدراك في القرآن! وهذا يجعل أركون هو المُكثِّف والمُبلوِر لهذا الرهان الأساس في القراءات الحداثية للقرآن، أي: تجاوز التلفيق والإسقاط الذي يفضي لاستنطاق النصّ القرآني بقِيَم الحداثة مع عدم مراعاة الطبيعة التداولية الخاصة لمفاهيم القرآن ولا السياقات المعرفية المخصوصة لتبلور المفاهيم الحديثة -ومنها مفهوم العقل بدلالته الحديثة- والدلالات الحافَّة بها.
وبالطبع وفي سياق تناول أركون لـ(العجيب المُدهِش) فإنه يتناول القصص القرآني، باعتباره أحد تجليات هذا العجيب المُدهِش، ويرى أنّ مقاربة القصص القرآني تتطلب القيام بخطوتين مزدوجتين: الأولى: هي تحديد الحقيقة التاريخية لهذا القصص حتى يمكن الوصول لتحديد عمليات الخلط والحذف والإضافة والمغالطات التاريخية التي أحدثتها الروايات القرآنية بالقياس إلى التاريخ الواقعي، والثانية: القيام بتحليل بنيوي للقرآن لنتبيّن كيف ينُجِز ويُبلوِر القرآن بنفس طريقة الفكر الأسطوري شكلًا ومعنًى جديدًا[xix]؛ لذا تكون القصة القرآنية -من منظور أركون- هي أفضل تجلٍّ لسمة القرآن كنصّ ميثي يُعدِّل ويُحوِّر ويخلط من أجل إنجاز معانٍ جديدة، ويكون تناولها بالتحليل كشفًا عن هذه الطبيعة الميثية وآليات اشتغالها.
ويرى أركون أنّ العجيب المدهش في القرآن ليس غرضه التسلية بل هو دومًا ما يَبرُز كدعامة أساس في كلّ انفتاح على الكائن والكينونة[xx].
فالقصص القرآني كأكبر مساحات هذا العجيب المُدهِش هدفه -وفقًا لأركون- إدراك، أو بالأحرى الشهادة على حضور الكائن المُطلَق الفعَّال في التاريخ، لمنع انحطاط التاريخ الإلهي إلى مجرد تاريخ بشري دنيوي، عبر كونها -أي: القصص- لا تُسمَع بل تُتَمَثَّل كبنية تمثيلية يُدرِك المؤمن عبر وعيه كونه جزءًا لا يتجزأ منها، يكون الله فيها هو المُؤلِّف والمُرسِل للأحداث وهو من يُرسِل إليه الطاعة وفقًا للميثاق، ويظهر الأنبياء كمساعدين لعمل الله ضمن تاريخ النجاة[xxi].
البناء المنهجي عند محمد أركون:
إذا حاولنا تحديد البناء المنهجي لخطاب أركون، وانتقلنا من المُحدِّدات المنهجية والتي على رأسها التاريخية برهانها الإبستمولوجي، كذا التاريخية بوصفها تسييقًا للقرآن في تاريخٍ ما، إلى التقنيات المنهجية المُشغَّلة على القرآن، فسنجد اتساعًا كبيرًا في استخدام مناهج مُتعدِّدة، فأركون لا يحصر نفسه في منهج مُحدَّد، بل ولا يحصر نفسه كذلك في مدرسة مُحدَّدة داخل منهج علمي معيّن، وهذا -وكما يقول- محاولة منه للبحث عن المناهج المُلائِمَة للنصّ وعدم التعسف المنهجي في فرض وإسقاط منهجٍ ما على النصّ، وهو ما يَتَطَلَّب منه ابتعادًا عن التعامل الأرثوذوكسي مع أيٍّ من المناهج[xxii]، «فالمنهجية مُتَعدِّدة الاختصاصات والعلوم هي وحدها القادرة على تقديم مفتاح الفهم»[xxiii] كما يُعبِّر؛ لذا فإننا نجد أركون يستعين في اختياراته المنهجية بمنهجيات مُتعدِّدة ما بين اللسانيات وما بين السرد البنيوي ومناهج تحليل الخرافة والحكاية والشعبية والأنثروبولوجيا والأثنوغرافيا والتحليل النفسي وغيرها، ويحضر في خطابه أسماء مرجعيات متعددة، مثل: بروديل وجورج زيميل وريكور وبورديو ورينيه جيرار، وغيرهم.
ومسألة المناهج المُستخدَمة لدراسة القرآن هي من تلك المساحات التي يشترك فيها اشتغال أركون على القرآن مع اشتغاله على قضايا أخرى، مثل اشتغاله على نقد (الاستشراق الكلاسيكي)، ومحاولة إنشاء (إسلاميات تطبيقية) تنهض فيما تنهض بمحاولة دراسة تلك المساحات التي أهملها هذا الأخير، واستخدام منهجيات تخلَّف عنها أو استثنى منها الإسلام قصدًا، فأركون يُقيم جزءًا كبيرًا من نقده للاستشراق على أساس إخراجه الإسلام من مساحة استخدام منهجيات حديثة، فالإسلام -وفقًا لأركون- لا يزال غربيًا سواء من قِبَل المستشرقين المحترفين أو من قِبَل الفلاسفة وعلماء الأديان يُدرَس وفقًا لمنهجيات عتيقة غير مُنْتِجَة[16]، في حين أن المسيحية واليهودية استفادَا كثيرًا من استخدام منهجيات أكثر معاصرة في علوم الأديان والأنثروبولوجي والسيميائيات؛ لذا يهدف أركون لتوظيف هذه المنهجيات المعاصرة والتي ثوَّرَت ميدان البحث في المسيحية واليهودية في دراسته للإسلام.
ولا بد لنا من التنبّه هنا لكون استخدام أركون لهذه المنهجيات هو استخدام لا يبغي إنتاج/استكشاف معاني جديدة من النصّ القرآني بالضرورة، بل يبغي -بالأحرى وبالأساس وبصورة مركزية- نقد النصّ القرآني بمعنى: (إبراز كيفية اشتغال هذا النصّ)، ولعلّنا لمسنا جزءًا من هذا في حديثنا عن تحليلاته الألسنية والسردية لـ(اللغة القرآنية)، ولـ(طبيعة النصّ القرآني)، ولـ(طبيعة العقل في القرآن)، فهذا الاشتغال يوُضِّح تمامًا كون الرهان الأساس عند أركون ليس رهانًا تأويليًّا يبغي إنتاج/استكشاف دلالات جديدة للنصّ، بل الرهان الأصلي هو تفكيك ونقد النصّ لكشف آليات اشتغاله.
وهذا الرهان هو رهان خاصّ تمامًا لخطاب أركون، فرغم أننا قد نستطيع القول عن الجابري أن التأويل ليس رهانه وإنما (الإيضاح) وتخليص القرآن من أنظمة معرفية مُسقَطة عليه، إلا أننا لا نعدم عند الجابري بعض نتاجات تأويلية بالمعنى المفهوم، مصدرها كونه مثله، مثل: نصر وفضل الرحمن وعبد المجيد الشرفي هم -وبقدرٍ كبيرٍ- مفكرون ملتزمون همّهم استلهام النصّ القرآني كي يكون مُعاصِرًا لنا في إنجاز حداثة معاصرة مما يتطلب منهم الاشتباك التأويلي مع النصّ، أما أركون فيبدو أن اكتشاف/زحزحة طبيعة النصّ وكشف آليات اشتغاله هو رهانه الأخصّ والأهم على الإطلاق حتى يتراجع أمامها أهمية الإنتاج التأويلي، وهو ما اعتبرناه تكثيف وبلورة خطاب أركون لأعمق رهانات (القراءة الحداثية للقرآن) كانعطاف معرفي في تاريخ التعامل الحداثي مع القرآن ما يعطي لخطابه أهمية خاصّة بين كل هذه الخطابات.
[1] (هو عقل يشتمل على عقل الحداثة ويتجاوزه في آن معًا، بمعنى أنه ينقد الحداثة ويغربلها لكي يطرح سلبياتها ولا يبقي إلا على إيجابياتها، ثم يُشكِّل عقلانية أكثر اتساعًا ورحابة، وهي عقلانية تتجاوز عقل التنوير بعد أن تستوعب مكتسباته الأكثر رسوخًا، إنها عقلانية لا تحتقر الجانب الروحاني أو الرمزي من الإنسان كما كانت تفعل العقلانية الوضعية الظافرة منذ القرن التاسع عشر والتي سيطرت على أوروبا حتى أمدٍ بعيدٍ). القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني، محمد أركون، ترجمة وتعليق: هاشم صالح، دار الطليعة، بيروت، ط2، 2005، (ص15، 16)، هامش/ هاشم صالح: «بالطبع هذا التجاوز لعقل الحداثة الكلاسيكي هو ما يجعل أركون يستخدم بعض المنهجيات المعاصرة التي تتناول مساحات المخيال والرمز وغيرها من مساحات أهملتها العقلانية الوضعانية كما يعبر».
[2] يضع أركون مشروعه تحت عنوان: (نقد العقل الإسلامي)، ويميزه عن مشروع الجابري: (نقد العقل العربي)، ويعتبر أن هذا النقد من الجابري هو استهلاك أيدولوجي للتراث، حيث يحاول إظهار مزايا الفترة الكلاسيكية الإسلامية ليواجه بها المسلمون الحداثة، وهذا في رأي أركون غير ممكن، فالتراث حتى فتراته الزاهرة يبقى سجين المناخ العقلي القرووسطي الذي على الرغم من أهميته وعظمته، فهو ليس الحل، وإنما الوسيلة التي لو عرفنا كيف نستخدمها ونطورها ونتجاوزها نستطيع الوصول إلى الحل، كذلك يرى أركون أن العقل الإسلامي هو أفضل كمادة للتحليل النقدي التاريخي حيث هو أكثر محسوسية، باعتباره قائمًا في النصوص والعقول ونحن نصطدم به كلّ يوم، ويعتبر أن دخول المسلمين الحداثة رهين بنقدهم للعقل الإسلامي. انظر: حوار أجراه مع أركون هاشم صالح، بعنوان: (الظاهرة الأصولية وإشكالاتها)، قضايا في نقد العقل الديني، كيف نفهم الإسلام اليوم، محمد أركون، ترجمة وتعليق: هاشم صالح، دار الطليعة، بيروت، ص331.
[3] في كتابه: (النص والمجتمع، آفاق علم اجتماع النصّ) يشير بيار زيما لكون كلّ كتابة لا تحمل فحسب مضامين معرفية، بل إنها كذلك قد تكون فعلًا يبغي تعديلًا في وضعية الكتابة وتُحدِث مأسسة لبعض طرق الاشتغال المعرفية، وتجري تغييرًا في قُوَى المجال أو الحقل المعرفي كحقل اجتماعي، وهذا عبر بلورته نظرية (لوضعية الألسنية- الاجتماعية) مستندًا لنظريات بورديو وباختين وغريماس، ونحن نستطيع الاستفادة من نظرية زيما في قراءة نصوص أركون، حيث إنّ نصوص أركون تحاول أن تكون بداية لتعديل حقل الإسلاميات المعرفي سواء غربًا أو في البلاد العربية والإسلامية، بإنشاء (الإسلاميات التطبيقية)، وهذا الرهان لنصوص أركون، يجعلها دومًا مُرهِقة في القراءة، وبادية التشتت بسبب كثرة الإشارات وتعدّد المخاطبين وكثرة نقط الانطلاق حتى في بناء النصّ الواحد، غير أن هذا التشتت قد لا يكون سوى عرض لتعدد المخاطبين في النصّ ولكون النصّ محاولة لتعديل أنماط الكتابة وقوى المجال في أكثر من اتجاه، وليست سمة لكتابة أركون نفسها. انظر: (النص والمجتمع، آفاق علم اجتماع النص)، بيار زيما، ترجمة: أنطوان أبو زيد، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، ط1، 2013.
[4] القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني، محمد أركون، دار الطليعة، بيروت، ط2، 2005، (ص120، 121).
[5] مؤلفات محمد أركون:
- تاريخية الفكر العربي الإسلامي، ترجمة: هاشم صالح، مركز الإنماء القومي، بيروت، لبنان، والمركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط2، 1995.
- من الاجتهاد إلى نقد العقل الإسلامي، ترجمة: هاشم صالح، دار الساقي، بيروت، لبنان، ط2، 1992.
- القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني، ترجمة: هاشم صالح، دار الطبيعة، بيروت، ط2، 2005.
- الفكر الإسلامي قراءة علمية، ترجمة: هاشم صالح، مركز الإنماء القومي، بيروت، لبنان، والمركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط2، 1996.
- الإسلام، أوروبا، الغرب، رهانات المعنى وإرادات الهيمنة، ترجمة: هاشم صالح، دار الساقي، بيروت، لبنان، ط2، 2001.
- نزعة الأنسنة في الفكر العربي، جيل مسكويه والتوحيدي، ترجمة: هاشم صالح، دار الساقي، بيروت، لبنان، ط1، 1997.
- الفكر الأصولي واستحالة التأصيل، نحو تاريخ آخر للفكر الإسلامي، ترجمة: هاشم صالح، دار الساقي، بيروت، لبنان، ط1، 1999.
- من فيصل التفرقة إلى فصل المقال، أين هو الفكر الإسلامي؟ ترجمة: هاشم صالح، دار الساقي، ط2، 1995.
- تحرير الوعي الإسلامي، نحو الخروج من السياجات الدوغمائية المغلقة، ترجمة: هاشم صالح، دار الطليعة، بيروت، لبنان، ط1، 2011.
- الفكر الإسلامي؛ نقد واجتهاد، دار الساقي، بيروت، لبنان، ط3، 1998.
- قضايا في فهم العقل الديني، كيف نفهم الإسلام اليوم؟ ترجمة: هاشم صالح، دار الطليعة، بيروت، لبنان، ط2، 2000.
- معارك من أجل الأنسنة، في السياقات الإسلامية، ترجمة: هاشم صالح، دار الساقي، بيروت، لبنان، ط1، 2001.
- العلمنة والدين، ترجمة: هاشم صالح، دار الساقي، بيروت، لبنان، ط3، 1996.
[6] منشور على موقع تفسير على هذا الرابط:tafsir.net/article/5116
[7] لذا فالتاريخية قائمة في معظم المقاربات الحداثية حتى قبل التأسيس الثاني للنهضة، الذي تكفّل في بعض خطاباته بمفهمة وبلورة ما كان مستنبطًا من تصوُّر للتاريخية في هذه الكتابات.
[8] انظر: (الإسلام، أوروبا، الغرب، رهانات المعنى وإرادات الهيمنة)، ترجمة: هاشم صالح، دار الساقي، بيروت، ط2، 2001، وانظر: (القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني)، ص20، ص75، هامش: هاشم صالح، في ص119.
[9] المقصود بالإبستيمة: مجمل العلاقات التي وجدت في فترةٍ ما من فترات التاريخ بين مختلف مجالات العلم والمعارف ومختلف الخطابات التي قيلت في القطاعات العلميّة المتنوّعة التي تشكّل النظام المعرفي لتلك الفترة. وبالتالي فالإبستيمية تعني نظام الفكر أو النظام العميق الذي يتحكّم بفكر فترة كاملة من فترات التاريخ.
[10] انظر: الفكر الإسلامي واستحالة التأصيل، (ص29، 30، 31، 199)، وانظر: القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني، محمد أركون، دار الطليعة، بيروت، ط2، 2005، ص38.
[11] (الفكر الإسلامي واستحالة التأصيل، نحو تاريخ آخر للفكر الإسلامي)، محمد أركون، ترجمة: هاشم صالح، دار الساقي، بيروت، ط1، 1999، ص336.
[12] انظر: القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الإسلامي، ص15، وانظر: (الفكر الأصولي واستحالة الـتأصيل، نحو تاريخ آخر للفكر الإسلامي)، ترجمة: هاشم صالح، ص64، وانظر: صوت من المنفى، نصر أبو زيد وإيستر ويلسون، (ص297، 280)، وجدير بالذكر أن أركون -ورغم كونه سواء في القصة التي يحكيها نصر عن لقائه به، هو وسروش، أو في حديثه عنه في كتابه: (الفكر الأصولي واستحالة التأصيل)- ظلّ على رأيه بكون دراسات أبو زيد ليست ثورية ولا انقلابية، إلا أن الموضع الذي اعتبره مهمًّا في اشتغال نصر، هو الموضع المتعلق بالرهان الإبستمولوجي لفكرة التاريخية، يقول أركون: «إنها أكثر من عادية أو طبيعية، فهو يعرض بوضوح تربوي رائع شروط إمكانية تطبيق التحليل الألسني الحديث على القرآن بصفته نصًّا لغويًّا».
[13] انتقد نصر أبو زيد في دراسته المهمّة عن أركون (اللغة الدينية والبحث عن ألسنية جديدة) المنشورة في كتابه: (الخطاب والتأويل)، كون أركون غير مضطرد في افتراضه مركز الوحدة للنصّ القرآني، حيث يفترض مرة كون مصدرها قائمًا في النصّ ذاته (البنية المركزية للميثاق)، ويفترض مرة كونها مُعطاة عبر التقمّص الجسدي الذي يقوم به المؤمن عبر أدائه الشعائر والطقوس والتخلق، والذي يجعلها مضفاة من (الظاهرة الإسلامية) على (الظاهرة القرآنية)، لكن في ظننا ليس في الأمر تناقض كما يفترض نصر، فالحديث هنا عن وحدتين للنصّ وليس وحدة واحدة، وحدتان تتعلق كلّ منهما بتعاملٍ ما مع النصّ، فالوحدة القائمة في طبيعة النصّ هي الوحدة التي يفترض أركون أهميتها ومركزيتها في فعل التأويل فهي خاصّة بالنصّ المقروء والمتلوّ، وهي التي يرفضها نصر، أما الوحدة الأخرى والخاصة بالتقمص الجسدي فهي وحدة شعائرية وليست تأويلية مرتبطة بالنص المعاش، وهذا بقدر ما يكشف لنا سيطرة ما أسميناه سابقًا -استعارة من طه عبد الرحمن- بـ(آفة التجريد) على معظم القراءات الحداثية للقرآن ومنها خطاب نصر، حيث حصر التعامل مع النصّ على مساحة التأويل العقلي له فحسب. انظر: الخطاب والتأويل، ص119.
[14] هذا الخلاف بين أركون ونصر يكشف بوضوح الاختلاف في طريقة تعامل كلّ منهما مع أسباب النزول وارتباط هذا بتصور كلّ منهما لمدى التاريخ المُسيَّق فيه القرآن، فبسبب تمسّك نصر بربط القرآن بوقائع التاريخ اليومي فإنه يلجأ بكلّ أريحية لأسباب النزول لإقامة هذا الربط، في حين أن أركون -ولأنه من جهةٍ يسيِّق القرآن في زمان أوسع، ومن جهة أخرى له اعتراضاته على علم أسباب النزول، سواء من حيث كونه نشأ في سياقات أيدلوجية وصراعات مذهبية، أو من حيث عدم فائدته في إعطاء صورة شاملة وكلية للتلقي الشفهي للقرآن- فإنه يقترح بدلًا منهم مفهوم (ظرف الخطاب) أو (الوضعية العامة للكلام)، وهو (مجمل الظروف التي جرى داخلها فعل كلامي شفهي أو مكتوب، ويخصّ في آن معًا المحيط الفيزيائي المادي والاجتماعي الذي نُطِق فيه الكلام، كما يخصّ الصورة التي شكلها المستمعون عن الناطق لحظة تفوهه بالخطاب ويخصّ هوية هؤلاء، والفكرة التي يشكلها كلّ منهم عن الآخر، كما يخص الأحداث التي سبقت فعل التلفظ بالقول التبادلات الكلامية التي اندرج فيها الخطاب المعنيّ)، وهذا اختلاف عميق بين الخطابين في تقنيات الاشتغال وفي التعامل مع المدونة التراثية كذلك. انظر: القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني، ص37، وص114.
[15] سنتناول بحث أركون لإشارية الضمائر في القرآن في المقال القادم، في تناول قراءته لسورة العلق والتوبة والفاتحة.
[16] انظر -مثلًا-: تاريخية الفكر العربي الإسلامي، ترجمة: هاشم صالح، مركز الإنماء، بيروت، والمركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط2، 1996، ص53، وانظر كذلك: تحرير الوعي الإسلامي، نحو الخروج من السياجات الدوغمائية المغلقة، ترجمة: هاشم صالح، دار الطليعة، بيروت، ط1، 2011، ص63.
[i] (القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الفكر الديني) محمد أركون، ترجمة: هاشم صالح، دار الطليعة، بيروت، ط2، 2005، ص17.
[ii] (الإسلام، أوروبا الغرب، رهانات المعنى وسياقات الهيمنة) محمد أركون، ترجمة: هاشم صالح، دار الساقي، بيروت، ط2، 2001، ص20.
[iii] (القرآن من التفسير إلى الموروث إلى تحليل الفكر الديني)، ص43.
[iv] (الفكر الإسلامي، قراءة علمية)، محمد أركون، دار الطليعة، ص213.
[v] نفسه، نفس الصفحة، الهامش الثاني.
[vi] (الخطاب والتأويل)، نصر أبو زيد، ص113.
[vii] (القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الفكر الديني)، ص40.
[viii] نفسه، ص120.
[ix] (الفكر الإسلامي قراءة علمية)، ص201.
[x] نفسه، ص215.
[xi] (من الاجتهاد إلى نقد العقل الإسلامي)، محمد أركون، ترجمة: هاشم صالح، دار الساقي، بيروت، ط1، 1991، ص99.
[xii] (الفكر الإسلامي؛ قراءة علمية)، ص207.
[xiii] (تاريخية الفكر العربي الإسلامي)، محمد أركون، ترجمة: هاشم صالح، مركز الإنماء القومي، بيروت، لبنان، والمركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط2، 1996، ص210.
[xiv] نفسه، ص203.
[xv] نفسه، ص1215.
[xvi] نفسه، ص205.
[xvii] نفسه، ص194.
[xviii] نفسه، ص223، 224.
[xix] (الفكر الإسلامي، قراءة علمية)، محمد أركون، دار الطليعة، ص203.
[xx] نفسه، ص204.
[xxi] نفسه، ص203.
[xxii] نفسه، ص230.
[xxiii] (الفكر الأصولي واستحالة التأصيل)، محمد أركون، ص298.
كلمات مفتاحية
الكاتب:

طارق محمد حجي
باحث مصري له عدد من المقالات البحثية والأعمال المنشورة في مجال الدراسات القرآنية.
مواضيع ذات صلة
((المعلومات والآراء المقدَّمة هي للكتّاب، ولا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع أو أسرة مركز تفسير))