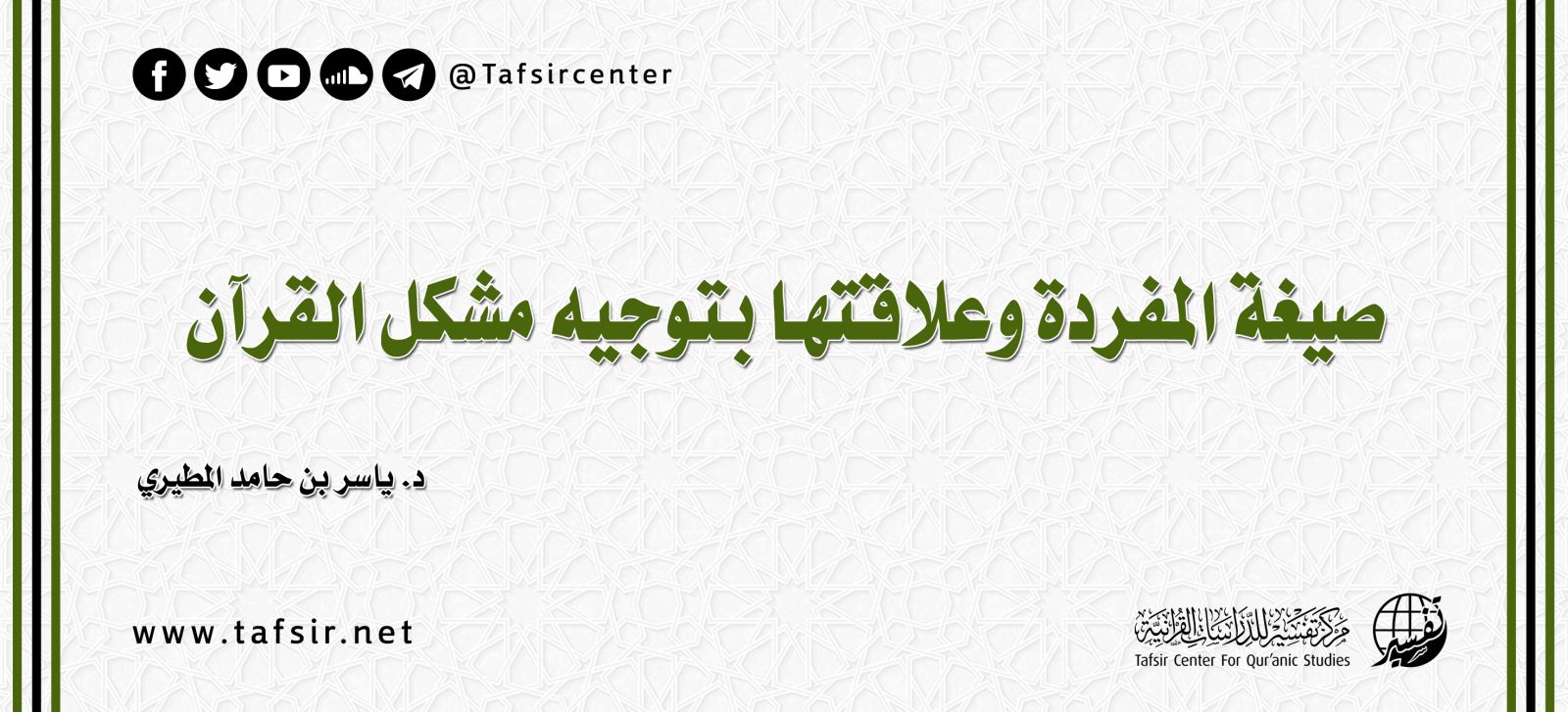المفردة القرآنية؛ المراحل التي تمرُّ بها حال تفسيرها
المفردة القرآنية؛ المراحل التي تمرُّ بها حال تفسيرها
الكاتب: مساعد بن سليمان الطيار

المفردة القرآنية؛ المراحل التي تمرُّ بها حال تفسيرها[1]
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله الطيبين، وعلى صحبه الكرام، وعلى مَن تابعهم إلى يوم القيامة، أما بعد:
فقد أدرتُ الفِكْرَ في المفردة القرآنية، فظهر لي في دراستي لها عددٌ من الموضوعات التي قد تكون مطروقة لكنها تحتاج إلى جمع في مكان واحدٍ يتعلق بالمفردة القرآنية، التي قد تختصُّ ببعض المعاني التي لا تجدها في دراسة الدارسين للغة العرب.
ومما طرأ لي في هذا الموضوع أنَّ ألفاظ القرآن لا تخرج عن خمس مراحل، وهي:
الأول: أن تأتي اللفظة على الأصل الاشتقاقي.
الثاني: أن تأتي اللفظة على الاستعمال الغالب عند العرب، وفي هذه الحال يكون فيها معنى الأصل الاشتقاقي.
الثالث: أن يكون للَّفظة استعمال سياقيٌّ، وهو ما استفاد منه أصحاب (الوجوه والنظائر) فركَّبوا كتبهم منه.
والاستعمال السياقي قد يرجع إلى أصل اللفظة الاشتقاقي، وقد يرجع إلى المعنى الغالب في استعمال اللفظة عند العرب، وهو على كلِّ الأحوال لا يخلو من الأصل الاشتقاقي.
الرابع: المصطلح الشرعي، وهذا كثير في القرآن، والمقصود به أن يكون استخدام اللفظ في القرآن والسنة على معنى خاصٍّ؛ كالصلاة والزكاة والحج والجهاد، وغيرها.
والمصطلح الشرعي لا بدَّ أن يكون راجعًا من جهة المعنى إلى الأصل الاشتقاقي، وقد يكون راجعًا إلى أحد المعاني التي غلب استعمال اللفظ فيها عند العرب.
الخامس: المصطلح القرآني، وهو أخصُّ من المصطلح الشرعي ومن الاستعمال السياقي؛ لأنَّ المراد به أن يكون اللفظ في القرآن جائيًا على معنى معيِّنٍ من معاني اللفظِ، فيكون معنى اللفظ الأعم قد خُصَّ في القرآن بجزء من هذا المعنى العامّ، أو يكون له أكثر من دلالة لغوية فتكون إحدى الدلالات هي المستعملة لهذا اللفظ في القرآن.
وسأتحدَّث عن كلّ نوع من هذه الأنواع المذكورة، وأضرب له أمثلة، وأسأل الله المعونة والتوفيق والسداد.
أولًا: الأصل الاشتقاقي للَّفظة:
يُعتبر الاعتناء بالأصل الاشتقاقي للَّفظة من المسائل المهمّة لمن يدرس التفسير، لحاجته الماسَّة لدقّة توجيه التفسيرات التي تُفسَّر بها اللفظة القرآنية.
ولا تكاد تخلو لفظة قرآنية من وجود أصلٍ اشتقاقي، ومعرفته تزيد المفسِّر عمقًا في معرفة دلالة الألفاظ ومعرفة مناسبة تفسيرات المفسرين لأصل هذا اللفظ.
ولم تخل تفسيرات السلف من الإشارة إلى مسألة الاشتقاق، فتجد في تفسيراتهم التنبيه على هذه المسألة اللغوية المهمّة، ومن ذلك ما رواه الطبري (ت: 310) وغيره في تفسير قوله تعالى: {وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا}[البقرة: 31]، فقد أورد عن ابن عباس (ت: 68) أنه قال: «بعث ربُّ العزة ملكَ الموت فأخذ من أديم الأرض؛ من عذبِها ومالحها، فخلق منه آدم، ومن ثَمَّ سُمِّي آدم؛ لأنه خلق من الأرض»[2].
وفي تفسير غريب لأبي العالية (ت: 93) في تفسيره لقوله تعالى: {ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ}[البقرة: 51]، قال: «إنما سُمِّي العجل؛ لأنهم عَجِلُوا فاتخذوه قبل أن يأتيهم موسى»[3].
وممن له في تفسيره شيء من العناية بهذا الباب مقاتل بن سليمان (ت: 150)، ومن غريب ما ورد عنه في الاشتقاق قوله: «تفسير آدم عليه السلام؛ لأنه خُلِق من أديم الأرض، وتفسير حواء؛ لأنها خُلِقت من حيٍّ، وتفسير نوح؛ لأنه ناح على قومه، وتفسير إبراهيم: أبو الأمم، ويقال: أبٌ رحيم، وتفسير إسحاق؛ لضحِك سارَّة، ويعقوب؛ لأنه خرج من بطن أمه قابض على عقب العيص، وتفسير يوسف: زيادة في الحسن، وتفسير يحيى: أُحيي من بين مَيِّــتَيْن؛ لأنه خرج من بين شيخ كبير وعجوز عاقر، صلى الله عليهم أجمعين»[4].
وممن عُنيَ بأصل الاشتقاق من اللغويين ابن قتيبة (ت: 276)، في كتابَيْه (تأويل مشكل القرآن)، و(تفسير غريب القرآن).
ومن ذلك قوله: «أصل قضى: حَتَمَ، كقول الله -عز وجل-: {فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْت}[الزمر: 42]؛ أي: حَتَمَه عليها.
ثُمَّ يصير الحتم بمعانٍ؛ كقوله: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ}[الإسراء: 23]؛ أي: أمر؛ لأنه لما أمر حتم بالأمر.
وكقوله: {وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرائيلَ فِي الْكِتَابِ}[الإسراء: 4]؛ أي: أعلمناهم؛ لأنه لما أخبرهم أنهم سيفسدون في الأرض، حتم بوقوع الخبر.
وقوله: {فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَات}[فصلت: 12]؛ أي: فصنعهن.
وقوله: {فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ}[طه: 72]؛ أي: فاصنع ما أنت صانع.
ومثله قوله: {فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيّ}[يونس: 71]؛ أي: اعملوا ما أنتم عاملون ولا تُنْظِرونِ.
قال أبو ذؤيب:
وعليهما مسرودتان قضاهما داود أو صَنَعُ السوابغ تُبَّعُ
أي: صنعهما داود وتُبَّع.
وقال الآخر في عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-:
قضيت أمورًا ثم غادرت بعدها بوائج في أكمامها لم تُفَتَّقِ
أي: عملت أعمالًا؛ لأنَّ كلّ من عمل عملًا وفرغ منه فقد حتمه وقطعه.
ومنه قيل للحاكم: قاض؛ لأنه يقطع على الناس الأمور ويحتِم.
وقيل: قُضِيَ قضاؤك؛ أي: فُرِغ من أمرك.
وقالوا للميت: قد قضى؛ أي: فرغ.
وهذه كلها فروع ترجع إلى أصل واحدٍ»[5].
ويظهر أنَّ ابن فارس (ت: 395) قد استفاد منه هذه الفكرة، فصنَّف كتابه العظيم (مقاييس اللغة) منتهجًا بذلك ما كان قد طرحه ابن قتيبة (ت: 276) في كتابَيْه السابقَيْن[6].
كما عُنِيَ الراغب الأصفهاني (ت: 400) بأصل الاشتقاق في كتابه (مفردات ألفاظ القرآن).
ثمَّ إنك تجد لأصل الاشتقاق منثورات في كتب اللغويين، ككتاب الاشتقاق للأصمعي (ت: 215)، وابن دريد (ت: 321)، وغيرها من كتب أهل اللغة.
وممن كان لهم بذلك عناية واضحة أبو علي الفارسي (ت: 377)، وتلميذه ابن جني (ت: 392).
وليس المقصد التأريخ لهذه المسألة العلمية، وإنما ذكرت إشارات منه.
وقد يكون للّفظة أصلٌ واحدٌ تدور عليه تصريفات الكلمة في لغة العرب، وقد يكون لها أكثر من أصل.
ومن أمثلة الألفاظ القرآنية التي يكون لها أصلٌ واحدٌ: لفظ (الأليم)، قال ابن فارس (ت: 395): «الألف واللام والميم أصل واحدٌ، وهو الوجع»[7]، وعلى هذا فإنَّ تَصَرُّفَات مادة (أَلَمَ) ترجع إلى هذا المعنى الكُلِّي، فكلّ تقلُّباته في القرآن وفي استعمال العرب يعود إلى معنى الوجع؛ كقوله تعالى: {فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ}[البقرة: 10]، وقوله تعالى: {وَلا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا}[النساء: 104].
أهمية معرفة أصل الاشتقاق:
معرفة أصل اشتقاق اللفظ يفيد في جمع جملة من المفردات القرآنية المتناثرة بتصريفات متعددة تحت معنى كليٍّ واحد، وهذه المعرفة تسوق إلى تفسير اللفظ في سياقه، بحيث يُعبَّر عنه بما يناسبه في هذا السياق، ويعبر عنه بما يناسبه في السياق الآخر، وكلّها ترجع إلى هذا المعنى الاشتقاقي الكليِّ.
ومن أمثلة ذلك: قوله تعالى: {وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ (17) وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ}[الانشقاق: 17- 18]، فمادة (وسق) تدلُّ على جمع وضمِّ واحتواء، ولفظة (وسق) و(اتسق) مشتقة منها، فمعنى الآية الأولى: والليل وما جمع وحوى وضمَّ من نجوم وغيرها، ومعنى الآية الأخرى: والقمر إذا اجتمع واكتمل فصار بدرًا.
وبهذا تكون مادة اللفظتين من أصل واحد، وهو الجمع والضمُّ.
ومنها لفظ (أيَّد) بمعنى قوَّى، وقد ورد لهذا الأصل عدة تصريفات، منها:
قوله تعالى: {إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرائيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ}[المائدة: 110].
وقوله تعالى: {لا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ}[المجادلة: 22].
وقوله تعالى: {اصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ}[ص: 17].
وقوله تعالى: {وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ}[الذاريات: 47].
وقوله تعالى: {وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لا تَهْوَى أَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ}[البقرة: 87].
فالمعنى الذي ترجع إليه الألفاظ (أيّدتُك/ أيَّدهم/ أيدناه/ ذا الأيد/ بأيد) كلّها ترجع إلى معنى القوة: (قويتك/ قواهم/ قويناه/ ذا القوة/ بقوة).
ومنها قوله تعالى: {وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا}[البقرة: 255]، وقوله تعالى: {وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ}[التكوير: 8].
فلفظ: لا يؤوده بمعنى: لا يُثقِله.
والموؤودة هي البنت التي تُدفَنُ وهي حيَّة، وإذا أرجعت اللفظ إلى أصل اشتقاقه، وجدت أنها إنما سُمِّت موؤودة؛ لأنها أُثقِلت بالتراب حتَّى ماتت، فرجعت اللفظة إلى أصل الثِّقَلِ، فصارت لفظتي (يؤوده، والموؤودة) ترجعان إلى أصل واحد، وهو الثِّقَلُ.
ثانيًا: أن تأتي اللفظة على الاستعمال الغالب عند العرب:
إنَّ اللغةَ كائنٌ حيٌّ متولّد، ومن أبرز ما في لغة العرب كثرة تصرفات الألفاظ المنبثقة من الأصل اللغوي الكلي للّفظة، والمراد هنا أنه يغلب استعمال أحد هذه التصريفات اللفظية على معنى مشهورٍ متبادرٍ بين المخاطبين، فإذا وقع في الكلام فإنَّ الذهن ينصرف إليه، لكن قد يأتي تفسيرٌ آخر للكلامِ بناءً على أنَّ هذا التصريف في اللفظة يرد بمعنى آخر، فيُحمل الكلام عليه.
ولأضرب لك مثلًا يوضح مرادي من ذلك:
مادة (ثَوَبَ) أصل صحيح واحد، وهو العَوْدُ والرّجوع، قاله ابن فارس في (مقاييس اللغة). وزاد الراغب الأصفهاني في مفرداته قيدًا في معنى العَوْد والرجوع، فقال: «أصل الثَّوب: رجوع الشيء إلى حالته الأولى التي كان عليها، أو إلى الحالة المقدَّرة المقصودة بالفكرة… فمن الرجوع إلى الحالة الأولى قولهم: ثاب فلان إلى داره… ومن الرجوع إلى الحالة المقدَّرة المقصودة بالفكرة: الثَّوْبُ، سُمِّي بذلك لرجوع الغَزْل إلى الحالة التي قُدِّرت له[8]، وكذا ثواب العمل…»[9].
وقد ورد استعمال العرب للفظة (أثاب) ولفظة (الثواب) في الجزاء على العمل، وقد ورد في القرآن من هذين عددٌ من الآيات؛ منها:
قوله تعالى: {فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ}[المائدة: 85].
وقوله تعالى: {لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا}[الفتح: 18].
وقوله تعالى: {فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ}[آل عمران: 148].
وقوله تعالى: {أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا}[الكهف: 31].
وقوله تعالى: {وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا}[مريم: 76].
وغلب استعمال لفظة (الثياب) على الملبوسات، وقد ورد في القرآن في عدة آيات؛ منها:
قوله تعالى: {أَلا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ}[هود: 5].
وقوله تعالى: {أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا}[الكهف: 31].
وقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلاةِ الْعِشَاءِ ثَلاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآياتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}[النور: 58].
ويُستفاد من معرفة غَلَبة استعمال العرب لِلَفظةٍ ما بمعنى من المعاني أن تُحمَل على هذا المعنى حال اختلاف التفسير، ومن ذلك ما ورد في تفسير قوله تعالى: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ}[المدثر: 4]، فقد ورد في معنى الثياب في هذه الآية أقوال، منها:
1- أنها الثياب الملبوسة، ويشهد لهذا غلبة استعمال هذا اللفظ بهذا التصريف عن العرب على ما يُلبس.
2- وقد فسَّر بعضهم الثياب بالفعل والعمل، والمراد: أصلِح عملك، واجعله خالصًا لله، وقد ورد هذا الإطلاق عن العرب، فكان الرجل إذا كان خبيث العمل، قالوا: فلان خبيث الثياب. وإذا كان حسن العمل، قالوا: فلان طاهر الثياب. قاله أبو رُزين[10].
وهذا المعنى مركبٌ من تصوُّرِ مادتَين لغويتَين، وهما: الثوب، واللبس. فلما كان العمل يتلبس به الإنسان كما يتلبس بثوبه الذي يلبسه، عبَّروا عن الثوب بالعمل من أجل هذا المعنى، والله أعلم.
وكأنَّ في العمل معنى العود؛ وكأنه تُصُوِّرَ أنَّ الإنسان يعمل العمل، ثمَّ يعود إليه، ففيه أصل معنى مادة الثوب، وهي العَوْدُ، والله أعلم.
3- وفسَّر آخرون بأن المراد بالثياب: النفس، والمعنى: طهر نفسك من المعاصي والدَّنس.
ومنه ما نُسِب إلى ليلى الأخيلية، قالت:
رموها بأثواب خفاف فلا ترى لها شبهًا إلا النعام المنَفَّرا
والمراد رموا الركاب بأبدانهم؛ أي: ركبوا الإبل.
ولا يبعد أنهم سمَّوا الأبدان أثوابًا لكثرة ملابستها للأثواب، وهذا من طرائق تسميات الأشياء عند العرب، فكثرة الملابسة تنقل الاسم من المعنى المتبادر المعروف إلى معنى آخر، حتى يصير اسمًا له، وبهذا يكون من معاني اللفظة.
وهذا من دقيق تاريخ الألفاظ، وهو علمٌ عزيزٌ، ونيله صعبٌ، وأغلبه من الظَّنِّ أو غلبته على حسب ما يتحرَّر في دراسة كلّ لفظ من الألفاظ.
ومن تسميته للشيء بما يلابسه أو ينتج عنه ما ورد من تسميته النوم بردًا، وعليه حُملَ قوله تعالى: {لا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلا شَرَابًا}[النبأ: 24]، لا يذوقون نومًا ولا شرابًا، وإنما سمَّوا النوم بردًا؛ لأنَّ النائم يبرد جسمه، والله أعلم.
ومن ذهب إلى هذا التفسير فإنَّ قوله -من جهة التفسير- يتضمَّنُ قول من قال: أصلح عملك؛ لأنَّ إصلاح العمل جزءٌ من تطهير النفس، والله أعلم.
لكن لو ذهب مرجِّح إلى ترجيح معنى الثياب الملبوسة في هذه الآية لغلبة هذا الاستعمال على معنى اللفظة عند العرب، وكونه هو الظاهر المتبادر في تفسيرها لجاز، وهو مذهبٌ صحيح في ترجيح هذا المعنى.
مثالٌ آخر:
مادة (لبس) أصل صحيح واحد يدل على مخالطة ومداخلة، قاله ابن فارس في (مقاييس اللغة). وجعل الراغب الأصفهاني في (مفردات ألفاظ القرآن) أصل اللبس: السَّتر[11]، والذي يظهر من هذه المادة أن أصلها ما ذهب إليه ابن فارس، وما قاله الراغب إنما هو أثر من آثار أصل هذه المادة، وليس هو أصلها، فالاختلاط والمداخلة مظِنَّةُ السَّتر، ويمكن أن يقال: كلّ مخالطة يقع فيها سَتْرٌ، ولا يلزم أنَّ كلّ سترٍ يكون فيه مخالطة.
ومما ورد من تصريفات الألفاظ من هذه المادة في القرآن: (لباس/ لبسنا/ يلبسون/ تلبسون/ يلبسكم/ لبس/ لبوس).
ومما جاء على أصل معنى المادة في القرآن:
قوله تعالى: {وَلا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ}[البقرة: 42].
وقوله تعالى: {وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ}[الأنعام: 9].
وقوله تعالى: {الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ}[الأنعام: 82].
وأشهر المعاني والإطلاقات في هذه المادة يعود إلى الثياب الملبوسة، ومنها:
قوله تعالى: {يَلْبَسُونَ مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقَابِلِينَ}[الدخان: 53].
وقوله تعالى: {يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ}[الأعراف: 26].
وقوله تعالى: {يَا بَنِي آدَمَ لا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ}[الأعراف: 27].
وقوله تعالى: {جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ}[فاطر: 33].
وقد غلب هذا الاستعمال -وهو الثياب الملبوسة- على هذه المادة، حتى كاد أن يكون أصلًا لها؛ لذا ترى أنَّ التشبيه يقع بها في بعض موارد لفظ اللبس، ومن ذلك قوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ}[البقرة: 187].
وقوله تعالى: {وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ}[الأعراف: 26].
وقوله تعالى: {وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا}[الفرقان: 47].
وقوله تعالى: {وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا}[النبأ: 10].
وقوله تعالى: {وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ}[النحل: 112].
وكلُّ هذه السياقات نُظِرَ فيها إلى معنى الثياب الملبوسة، ووقع تنظير هذه المعاني في هذه السياقات بها، وعلى سبيل المثال: جُعِلَ الليل بمخالطته للناس وتغطيته لهم كاللباس الذي يخالطهم ويغطيهم، وقس على ذلك غيرها من الآيات الأخرى.
والمعنى الأصلي لهذه اللفظة، وهو المخالطة والمداخلة لم يتأخر في أيّ استعمال من هذه الاستعمالات، وإن كان قد يغيب؛ لأنَّ النظر في السياقات إلى الاستعمال، وليس إلى أصل الاشتقاق.
ثالثًا: الاستعمال السياقي:
هذه هي المرحلة الثالثة التي تقع للمفردة القرآنية، فأيّ كلمة لها في سياقها معنى مراد، قد يكون خارج المعنى اللغوي المطابق، وهذا المعنى المراد للكلمة في هذا السياق قد يكون في أكثر من سياق قرآني، وقد لا يكون له إلا سياق واحد.
ومن الاستعمال السياقي انطلقت كتب الوجوه والنظائر[12] في تعيين الوجوه للألفاظ القرآنية؛ لذا تعدَّدت الوجوه للفظ الواحد الذي يعود إلى معنى لغوي واحدٍ؛ لأنه لا اعتبار لأصل اللفظ ولا لاستعمال العرب في تحديد الوجوه إلا إذا كان هو المعنى المراد في السياق.
ومن أمثلة ذلك في كتب الوجوه والنظائر:
قال الدامغاني (ت: 478): «تفسير إفك على سبعة أوجه: الكذب، عبادة الأصنام، ادّعاء الولد لله تعالى، قذف المحصنات، الصرف، التقليب، السحر.
فوجه منها: الإفك؛ يعني: الكذب، قوله تعالى في سورة الأحقاف: {وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا} إلى قوله: {فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ}[الأحقاف: 11]؛ يقولون: كَذِبٌ تَقَادَم، ونظيره فيها: {وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ}[الأحقاف: 28]، ونحوه كثير.
والوجه الثاني: إفك: عبادة الأصنام، قوله تعالى في سورة الصافات: {إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ * أَإِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ}[الصافات: 85 - 86]؛ يعني: عبادة آلهةٍ دون الله.
والوجه الثالث: الإفك: ادّعاء الولد لله تعالى، قوله تعالى في سورة الصافات: {أَلا إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ * وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ}[الصافات: 151- 152].
والوجه الرابع: الإفك: قذف المحصنات، قوله تعالى في سورة النور: {إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالإفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ}[النور: 11]؛ يعني: بُهْتَان عائشة.
والوجه الخامس: الإفك: الصّرف، قوله تعالى في سورة والذاريات: {يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ}[الذريات: 9]، كقوله تعالى في سورة الأحقاف: {لِتَأْفِكَنَا عَنْ آلِهَتِنَا}[الأحقاف: 22]؛ أي: لتصرفنا، ونحوه كثير.
والوجه السادس: الإفك: التقليب، قوله تعالى في سورة والنجم: {وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَى}[النجم: 53]، كقوله تعالى في سورة الحاقة: {وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ}[الحاقة: 9].
والوجه السابع: الإفك: السحر، قوله تعالى في سورة الشعراء: {تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ}[الشعراء: 45][13].
وإذا رجعت إلى تحليل هذه اللفظة من جهة الاشتقاق والاستعمال العربي ظهر لك ما يأتي:
1- قال ابن فارس: «الهمزة والفاء والكاف أصل واحد يدلُّ على قلب الشيء وصرفه عن وجهه»[14].
وزاد الراغب قيدًا في أصل المادة، فقال: «كلّ مصروف عن وجهه الذي يحقُّ أن يكون عليه، ومنه قيل للرياح العادلة عن المهابِّ: مؤتفكة…»[15].
وهذا يعني أنَّ هذه الدلالة الأصلية ستكون موجودة في جميع الوجوه المذكورة، وهي كذلك؛ فالكذب فيه معنى القلب والصّرف، فهو قلب للحق باطلًا، وللباطل حقًّا. وعبادة الأصنام قلب للعبادة الحقيقية إلى العبادة الباطلة. وادعاء الولد لله تعالى قلب للحقيقة التي هي الوحدانية إلى الإشراك. وقذف المحصنات قلب للحقيقة، حيث يجعل العفيفات زانيات.
وأما الصرف والتقليب فهو المعنى الأصلي للّفظة. والسحر فيه قلب للحقائق، وجعل الباطل حقًّا والحقَّ باطلًا.
2- وإذا رجعت إلى استعمال العرب للإفك، فإنه يغلب إطلاقه على أشدِّ الكذبِ، ويرجع إلى هذا المعنى الوجه الأول والثاني والثالث والرابع.
فالرابع مثلًا، وهو قذف المحصنات؛ إنما ذُكِر وجهًا مستقلًّا نظرًا لأن المراد بالإفك في هذا الموضع الافتراء الذي افتراه المنافقون في حقِّ بيت النبوة، حيث قذفوا عائشة -رضي الله عنها-، وهو في النهاية عائد إلى الكذب، وإنما جاء التعبير عنه بقذف المحصنات؛ لأنَّ مراد المؤلف هنا بيان المراد بالإفك من جهة الاستعمال السياقي وليس بيان معناه من جهة اللغة.
كما يرجع إلى هذا المعنى الوجه السابع، وهو السحر؛ لأنَّ الآية التي استدل بها لهذا الوجه تدلُّ على هذا، وهي قوله تعالى: {فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ}[الشعراء: 45]، أي: ما يكذبونه من العصي والحبال التي يسحرون بها أعين الناس فيخيّل للناس أنها ثعابين، وهي ليست كذلك.
وأما الألفاظ: (يؤفك/ تأفكنا/ المؤتفكات)، فإنها تأتي بمعنى الصرف والقلب الذي هو أصل معنى اللفظ؛ ولذا فالوجه الخامس والسادس معناهما واحدٌ، ولا داعي لجعلهما وجهين متغايرين.
ولو تُتُبِّعت أقوال المفسرين في تفسير الألفاظ لوجدتهم كثيرًا ما يبينون المراد باللفظ في سياقه دون ردِّه إلى معناه اللغوي، وعلى هذا الأسلوب جمهور تفسير السلف، وهو ما يُعبَّر عنه بالتفسير على المعنى.
وعلى سبيل المثال، لو رجعت إلى تفسير قوله تعالى: {وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ}[الأعراف:117]، فإنك ستجد في تفسير السلف لــ{يَأْفِكُونَ}:
1- يكذبون، وذلك قول مجاهد، وهو بيان لمعنى الإفك من جهة الاستعمال اللغوي، وهو مراد في الآية.
2- حبالهم وعصيُّهم، وهذا قول الحسن، وهذا بيان للمراد من جهة السياق، فالذي يأفكونه؛ أي: يكذبون به هو حبالهم وعصيُّهم.
ولا تنافي بين القولين؛ فالأول بيَّن المعنى المراد من جهة اللغة، والثاني بيَّن المعنى المراد من جهة السياق، والله أعلم.
والنظر إلى الاستعمال السياقي للّفظة جعل بعض المفسرين يحكمون بالخطأ على بعض التفاسير، وليست تلك التخطئة بسديدة؛ لأنَّ المفسّر غير ملزم -دائمًا- ببيان المعنى من جهة اللغة، بل قد يكون بيان اللفظة من جهة اللغة في مثل هذا الحال من الاستطراد الذي لا يحتاجه المقام.
والنظر إلى الاستعمال السياقي لا ينفكّ عنه اللغوي الذي يقصد بيان ألفاظ القرآن وعربيّته، بَلْه مفسرو السلف الذين يكثر في تفسيرهم الاعتناء ببيان المعاني دون تحرير الألفاظ من جهة اللغة، ومن أمثلة ذلك تفسير أبي عبيدة معمر بن المثنى البصري (ت: 210) لقوله تعالى: {وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْل}[البقرة: 191]، قال: «أي: الكفر أشدُّ من القتل في أشهر الحُرُمِ؛ يقال: رجلٌ مفتونٌ في دينه؛ أي: كافر»[16].
ولو ذهب أبو عبيدة إلى التفسير اللغوي، لقال: الفتنة: الامتحان والاختبار، لكنه ذهب إلى تفسير المراد بالفتنة في هذا السياق، وهو الكفر، والله أعلم.
وقد يجمع بين التفسير على اللفظ والتفسير على المعنى، وذلك في مثل قوله تعالى: {وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ}[الأعراف: 24]، قال: «إلى وقت يوم القيامة، وقال:
وما مِزَاحُكَ بَعْدَ الحِلْمِ والدِّينِ وقد علاكَ مَشِيبٌ حين لا حين
أي: وقت لا وقت»[17].
فقوله: «إلى وقت» هذا بيان لغوي لمعنى الحين.
وقوله: «يوم القيامة» هذا بيان للمراد بالحين على التعيين في هذا السياق، وهذا تفسير معنى.
وهناك فرع لمسألة التفسير على المعنى اللغوي والتفسير على المعنى السياقي لعلِّي أطرحه لاحقًا إن شاء الله.
رابعًا: المصطلح الشرعي:
يراد بالمصطلح الشرعي ما جاء بيان معناه في لغة الشارع سواءً أكان ذلك في القرآن أم كان في السنة النبوية.
وكلام الشارع مبني على بيان الشرعيات لا على بيان اللغات؛ لذا استخدم ما تعرفه العرب من كلامها وزاد عليه معاني أو خصَّص ألفاظًا على معنى معيَّن، وهذا يُعرف من جهة الشرع، وهو ما يسمى بالتعريف الشرعي، فنقول مثلًا:
تعريف الصلاة لغة، ونبيّن فيه أصل معنى اللفظ واستعمالات العرب لهذا اللفظ في لغتها.
تعريف الصلاة شرعًا، ونبيّن استعمال الشارع للصلاة، وهو أنه نقلها من المعنى اللغوي المعروف إلى معنى زائد أو مخصوص بأعمال وأفعال مخصوصة سمَّاه صلاةً.
والمعنى الشرعي لا ينفكُّ عن أصل اللفظ في لغة العرب، وهو موجودٌ فيه غير أنه يزيد عليه بتحديدات شرعية لم تعرفها العرب من قبل.
ولقد برز عند العلماء بسبب هذا قاعدة تقديم المعنى الشرعي على المعنى اللغوي عند وجود احتمال التعارض بين المعنيين في سياق واحد، وسبب ذلك أنَّ الشارع معنيٌّ ببيان الشرع لا ببيان اللغات.
ومن أوضح أمثلة احتمال التعارض بين المعنى الشرعي والمعنى اللغوي ما ورد في قوله تعالى: {وَلا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ}[التوبة: 84]، إذ السياق يحتمل المعنيين، فقد يكون المراد: لا تَدْعُ لهم، وهو معنى الصلاة في أصل اللغة.
وقد يكون المراد: لا تصلِّ عليهم صلاة الجنازة، وهو المعنى الشرعي المخصوص، وهو المقدَّم هنا.
لكن الصلاة على المؤمنين قد وردت في سياق آخر، ولا يُراد بها الصلاة الشرعية، بل الصلاة بمعناها اللغوي، وهو الدعاء، وذلك في قوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ}[التوبة: 103].
فالصلاة المأمور بها هنا هي الدعاء، بدلالة قول عبد الله بن أبي أوفى كما في صحيح البخاري، قال: «…ثم كان النبيّ -صلى الله عليه وسلم- إذا أتاه قوم بصدقة قال: اللهم صلِّ عليهم. فأتاه أبي بصدقته، فقال: اللهم صَلِّ على آل أبي أوفى»[18].
فدلَّ هذا الحديث أنَّ صلاة النبي -صلى الله عليه وسلم- لمن جاء بصدقته ليست صلاة مخصوصة، بل هي مجرد الدعاء لهم، ولو كانت صلاة مخصوصة كصلاة الجنائز أو غيرها لبيَّنها الرسول بفعله.
وفِعْلُه هنا -وهو نوع من التفسير النبوي، وهو ما يسمَّى بتأوُّل القرآن- دلَّ على أنَّ المراد المعنى اللغوي.
وهذا الموضوع -وهو المصطلح الشرعي- من الموضوعات المهمّة، وقد تطرَّق إليه علماء العقائد وعلماء أصول الفقه، لكن الملاحظ أنَّ كثيرًا منهم قد يحيد عن المعنى الشرعي في بعض الأبواب، ويدَّعي بقاءها على المعنى اللغوي؛ لشبهة وقعت له في ذلك الباب، ومن أوضح الأمثلة في ذلك: قَصْر المرجئة مسمَّى الإيمان في الشرع على التصديق دون دخول الأعمال في مسمَّاه، وهذا مخالف للشرع الذي بيَّن دخول الأعمال في مسمى الإيمان، وكذا فهم السلف ذلك.
ولهذا لو قال قائلٌ: إنَّ المراد بالصلاة: الدعاء فقط، بناءً على المعنى اللغوي، كما جعل ذلك مسمَّى الإيمان على المعنى اللغوي عند الشارع؛ لأنكر عليه ذلك، واحتجَّ عليه بورود الشرع بمعنى الصلاة، فإذا كان ذلك كذلك عنده، فإنه يُحتجُّ عليه بورود مسمى الإيمان على العمل، والنصّ على دخولها فيه.
وهذا الموضوع يطول الحديث عنه، وهو يؤخذ من كتب الاعتقاد، ولعلّ الإشارة هنا كافية في الدلالة على المقصود.
هذا، وقد كُتِبَ في المعنى الشرعي كتابات كثيرة، وأشير هنا إلى دراسة معاصرة جيدة في هذا الباب، وهي: (التطوّر الدلالي بين لغة الشعر ولغة القرآن) تأليف الأستاذ عودة خليل أبو عودة.
ولعلّك تلاحظ من خلال الحديث السابق أن مستوى تفسير اللفظ بالمصطلح الشرعي أخصُّ من المستويات السابقة؛ فكلُّ لفظة لها مصطلح شرعي متميز لها أصلٌ واستعمال في لغة العرب، ولا يلزم من كلّ لفظٍ في لغة العرب أن يكون له مصطلح شرعي خاصٌّ.
ومن باب الفائدة، فإنَّ بعض الباحثين يخلط بين المعنى الاصطلاحي في العلوم والمعنى الشرعي، فيقول مثلًا: تعريف المعجزة شرعًا. وهذا خطأ؛ لأنَّ هذا اللفظ ليس من مصطلحات الشارع ولا استخدمها، والصواب أن يقال: تعريف المعجزة اصطلاحًا؛ أي: فيما اصطلح عليه العلماء الذين بحثوا المعجزة.
والمراد: أنه لا يُنسب إلى اصطلاح الشرع إلَّا ما نصَّ عليه أو كان موجودًا فيه على معنى مستقلٍّ عن المعنى اللغوي.
أما اصطلاحات العلماء في العلوم -وإن كانت في بعض العلوم الشرعية التي لها مساس بالأصلين: الكتاب والسنة- فإنها لا يصلح أن يُطلق عليه مسمى المصطلح الشرعي؛ لأنَّ ذلك من مصطلح العالِم وليس من مصطلح الشارع.
خامسًا: المصطلح القرآني:
قد يكون اللفظ القرآني له وجه واحدٌ في الاستعمال العربي، ولا يَرِدُ في الشرع زيادة على هذا المعنى، كما هو الحال في المصطلح الشرعي، بل ترى أنّ اللفظ باقٍ على استعماله العربي، وهذا كثيرٌ جدًّا في القرآن الكريم، ومن أمثلة ذلك لفظ (مَزَجَ)، فقد ورد في القرآن في مواضع، وهي:
قوله تعالى: {إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا}[الإنسان: 5]، وقوله تعالى: {وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا}[الإنسان:17]، وقوله تعالى: {وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ}[المطففين: 27].
ولفظة (مزج) لا تخرج عن معناها الذي يدلُّ على خلط الشيء بغيره، وهذا لا يدخل في المصطلح القرآني؛ لأنَّ المراد بالمصطلح القرآني أن يكون له تخيُّرٌ دلاليٌّ لِلَفظةٍ تتعدَّد فيها الدلالة اللغوية، أو أن يكون للفظةٍ مدلولٌ واسع فيستخدمها القرآن في مدلول خاصٍّ بعينه دون ما سواه.
وإذا كان استعمال اللفظة القرآنية على وجهٍ واحدٍ، ولها في اللغة معنى واسع أو أن لها أكثر من مدلول، فإنه يمكن إطلاق (المصطلح القرآني) أو (عادة القرآن) أو (طريقة القرآن) على استعمال هذه اللفظة.
ومن هنا يمكن أن يقسم الموضوع إلى قسمين:
القسم الأول: أن يكون للّفظة في اللغة مدلولٌ واسعٌ، فيخصُّ القرآن من هذا المدلول استعمالًا خاصًّا لهذه اللفظة، كلفظ (وصف) فهو لفظ يشمل كلّ موصوف، وإنما يدرك كون المادة في الصدق أو الكذب من السياق، فلا يُخَصُّ إلا به.
ومن أمثلة ذلك مادة (وصف)، فمدلول لفظة (وصف) تعمُّ مطلق الوصف للأشياء سواءً أكان الوصف كاذبًا، أم كان الوصف صادقًا، وإذا نظرت في موارد هذه اللفظة في القرآن، فإنك تجدها تجيء فيما يكون من باب الكذب، وليس لمطلق الوصف أو لصادقه.
قال تعالى: {وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ}[يوسف: 18].
وقال تعالى: {وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى لا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ}[النحل: 62].
وقال تعالى: {وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا وَإِنْ يَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ}[الأنعام: 139].
وتُنظر الآيات الآتية: (الأنعام: 100، يوسف: 77، النحل: 116، الأنبياء: 18، 22، 112، المؤمنون: 19، 96، الصافات: 159، 180، الزخرف: 82).
قال شيخ الإسلام: «...فإنّ الصفة عندهم قائمة بالموصوف ليست مجرد قول الواصف إن قاله من يقول: إنّ الصفة هي الوصف، وهي مجرد قول الواصف، فالواصف إن لم يكن قوله مطابقًا كان كاذبًا؛ ولهذا إنما يجيء الوصف في القرآن مستعملًا في الكذب بأنه وصف يقوم بالواصف من غير أن يقوم بالموصوف شيء كقوله سبحانه: {سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ}[الأنعام: 139]، {وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ}[النحل: 116]، {وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى}[النحل: 62]، {سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ}[الصافات: 180].
وقد جاء مستعملًا في الصدق فيما أخرجاه في الصحيحين عن عائشة: «أن رجلًا كان يُكثِر قراءة {قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ}، فقال النبيّ -صلى الله عليه وسلم-: سلوه لِمَ يفعل ذلك؟ فقال: لأنها صفة الرحمن، فأنا أحبُّها، فقال النبي-صلى الله عليه وسلم-: أخبروه أن الله يحبه»[19].
ومن الأمثلة كذلك مادة (فرى)، قال الراغب: «الفريُ: قطع الجلد للخرز والإصلاح، والإفراء للإفساد، والافتراء فيهما، وفي الإفساد أكثر، وكذلك استعمل في القرآن في الكذب والشرك والظلم، نحو: {وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيما}[النساء: 48]، {انْظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ}[النساء: 50]، {افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا}[الأنعام: 140]، {وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ}[المائدة: 103]، {أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ}[يونس: 38]، {وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِب}[يونس: 60]، {إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ}[هود: 50]، {لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا}[مريم: 27]»[20].
القسم الثاني: أن يكون للّفظة أكثر من مدلول على سبيل الاشتراك اللفظي اللغوي، لكن الوارد من هذا الاشتراك أحد المعاني.
ومن ذلك لفظة (شَطْرَ)، فلها في اللغة ثلاثة أصول:
الأول: يدلّ على نصف الشيءِ.
الثاني: يدلّ على المواجهة، أو الاتجاه للشيء.
الثالث: يدلّ على البُعد[21].
والذي ورد في القرآن من هذه المعاني الثلاثة المعنى الثاني، وهو الاتجاه، وقد ورد في قوله تعالى: {قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ}[البقرة: 144].
وقوله تعالى: {وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ}[البقرة: 149].
وقوله تعالى: {وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ}[البقرة: 150].
ومن اللطائف في هذه المادة أنها لم تَرِدْ في القرآن إلا في التوجه إلى الكعبة، كما ترى في هذه الآيات الكريمات.
أما أن يكون للّفظة أكثر من مدلول في لغة العرب، وَيَرِد التفسير بها؛ فهذا كثير جدًّا، وقد يَرِدُ التفسير بها في موطن دون موطن، كما هو الحال في الوجوه، وقد يُختلف في تفسير اللفظ في ذاته، فيَحملُه مفسرٌ على معنى، ويحمله آخر على معنى آخر، مثل تفسير لفظ (سجرت، عسعس، كورت) وغيرها، وهذا النوع خارج عن المراد بهذا الموضوع.
وهاهنا تنبيهان:
الأول: أنَّ ألفاظ المصطلح القرآني للّفظة أقلّ بكثير من (المصطلح الشرعي) أو (الوجوه والنظائر).
الثاني: أنَّ السبيل إلى معرفة (المصطلح القرآني) الاستقراء التامُّ للّفظة في مواردها، والتأكُّد من أنها جاءت على وجه واحدٍ لا غير، أما إذا كان لها أكثر من وجه، فإنها تخرج من هذا، وتكون من باب (الوجوه والنظائر) كلفظ البعل -مثلًا-؛ فالبعل في القرآن الزوج إلا قوله تعالى: {أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ}[الصافات: 125]، فإنه أراد صنمًا.
والآيات التي ورد فيها البعل بمعنى الزوج هي:
{وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ}[النور: 31].
{وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا}[النساء: 128].
{قَالَتْ يَا وَيْلَتَى أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ}[هود: 72].
وبهذا ينتهي الحديث الأول عن المفردة القرآنية، وسيتبعه -إن شاء الله- حديث آخر عن علاقة اللفظ بالمعنى المفسِّر لها عند المفسرين، أسأل الله أن يبارك في الوقت والعلم، حتى يخرج هذا البحث، واللهُ الموفِّق.
[1] نُشرت هذه المقالة بملتقى أهل التفسير بتاريخ 5/8/1424هـ - 1/10/2003م. (موقع تفسير).
[2] جامع البيان (1/511)، ط. هجر.
[3] جامع البيان (1/674).
[4] تفسير مقاتل بتحقيق د. عبد الله شحاتة (3/53).
[5] تأويل مشكل القرآن (ص: 442).
[6] يُنظر: مقدمة السيد أحمد صقر لكتاب تأويل مشكل القرآن (ص: 83).
[7] مقاييس اللغة (1/126).
[8] يمكن أن يكون تسمية الثوب من معنى آخر ذكره ابن فارس، قال: «والثّوب الملبوس محتمل أن يكون من هذا القياس؛ لأنه يلبس ثم يلبس ويثاب إليه».
[9] المفردات في غريب القرآن (179).
[10] يُنظر: تفسير الطبري (23/409).
[11] مسألة اختلاف العلماء في أصل المادة مما أرجأتُ الحديث عنه لأنظر هل له أثر في بيان المعاني واختلافها في السياقات القرآنية، أو أنَّ الاختلاف ليس له أثر من هذه الجهة، وإن ظهر لي فيها شيءٌ فإني سأطرحه لاحقًا إن شاء الله.
[12] قد يسمى هذا العلم بالأشباه والنظائر، وهذه التسمية فيها نظر، وقد بيَّنته في كتابي (التفسير اللغوي للقرآن الكريم)، ص: 89 - 90.
[13] الوجوه والنظائر للدامغاني، تحقيق: فاطمة يوسف، ص: 72- 74.
[14] مقاييس اللغة، مادة: أفك (1/118).
[15] المفردات، ص: 79.
[16] مجاز القرآن (1: 68).
[17] مجاز القرآن (1: 212).
[18] صحيح البخاري (4/1529).
[19] مجموع الفتاوى (6/ 318- 319).
[20] مفردات ألفاظ القرآن (ص: 634)، ينظر أيضًا في مفردات الراغب الأصفهاني لفظ (زعم: 380، الذوق: 332).
[21] ينظر: مقاييس اللغة، مادة شطر، وقد جعلها على أصلين؛ حيث جعل الثاني والثالث أصلًا واحدًا.
كلمات مفتاحية
الكاتب:

مساعد بن سليمان الطيار
أستاذ الدراسات القرآنية بجامعة الملك سعود، له العديد من المؤلفات والمشاركات العلمية.
مواضيع ذات صلة
((المعلومات والآراء المقدَّمة هي للكتّاب، ولا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع أو أسرة مركز تفسير))