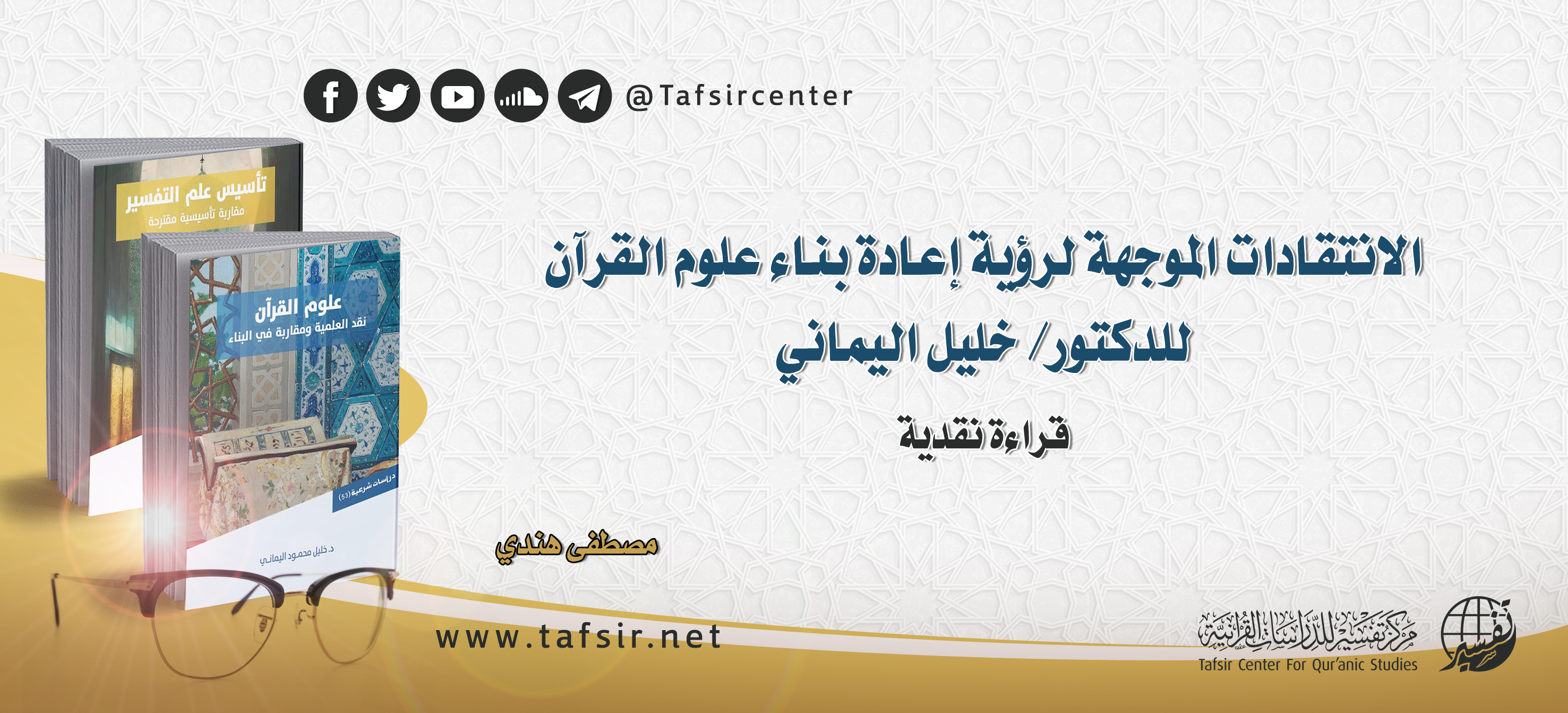القراءات الحداثية للقرآن (7): فضل الرحمن مالك؛ القرآن والحداثة والتأويلية الناجزة
القراءات الحداثية للقرآن (7): فضل الرحمن مالك؛ القرآن والحداثة والتأويلية الناجزة
الكاتب: طارق محمد حجي

في المقال الأول حول القراءات الحداثية للقرآن، مقال (المداخل العامة)، كنا قد أشرنا لإشكالَيْن رئيسَيْن من الممكن اعتبارهما من أهم السياقات المعرفية المُنشِئَة لـ(القراءات الحداثية للقرآن)؛ الإشكال الأول هو تأزُّم الخطاب الإصلاحي والنهضوي العربي والإسلامي، والذي تجسّد معرفيًّا في سيطرة التلفيق و(التجاور) والتساكن بين المنظومات الفكرية المختلفة على بنية هذا الخطاب، والإشكال الثاني هو الفراغ المنهجي الذي سببته واقعة اهتزاز التقليد[1] خصوصًا في مساحة تفسير القرآن؛ وهما إشكالان متداخلان بالطبع دفَعَا الخطاب نحو تأسيسه الثاني على ما أوضحنا هناك، ونحن حين نتناول خطاب فضل الرحمن مالك المفكر الباكستاني (1919- 1988م) فإننا نجده يؤسِّس ذاته في قلب هذه الإشكالات المُتداخِلة ويُقدِّم تأويليته للقرآن كمحاولة لتجاوزها.
فنحن نجد في هذا الخطاب إلحاحًا واضحًا على إشكال (التجاور)؛ وهذا لأن فضل الرحمن قد قارب القرآن بالأساس من خلال مشروع واقعي وأكاديمي لدراسة واقع النظام التربوي والتعليمي الإسلامي[2]، وهو الاشتغال الذي كشف له عن سيطرة (التجاور الميكانيكي) -كما يسميه- على هذا النظام في كلّ البلاد الإسلامية؛ سواء الهند أو تركيا أو مصر، بين نظام تعليمي وتربوي إسلامي خالٍ من الحداثة، أيْ من القدرة على «تحقيق إنتاجية ثقافية أخلاقية إسلامية في كافة حقول الجهد العقلي»[i]، ونظام تعليمي غربي حديث لا ينطلق من (مبادئ العقلانية الإسلامية) ولا يتأسَّس عليها، بالإضافة لمحاولات غير مُجدِية لأسلمة هذا النظام التعليمي والتربوي عبر أسلمة العلوم التي تنتظم داخله طبيعية كانت أو إنسانية[ii].
ويعتبر فضل أن الحل لتجاوز هذا التجاور -والذي هو مجرد مثال للتجاور الذي يشمل كلّ مساحات المؤسسات والأفكار في واقع البلدان الإسلامية- هو العودة «للقرآن في انطلاقته الأولى مع محمد»[iii]، واكتشاف العقلانية الإسلامية والممكنات الكامنة في هذا القول القرآني المؤسِّس للجهد العقلي الإسلامي في كلّ المساحات.
وهذا الحل الذي يقترحه فضل الرحمن هو ما يدفعه للتأكيد على هذا الجانب الآخر من الإشكالات المؤسِّسة لنشأة الدرس الحداثي للقرآن؛ أيْ غياب وجود منهجية واضحة لقراءة القرآن بعد واقعة اهتزاز التقليد، ففي مواجهة تلك الاستشكالات التي قد ترد على حَلِّه الذي يفترضه، من قبيل أن تلك الدعوة -دعوة العودة للقرآن في انبثاقته الأولى- هي نفسها دعوة الجميع ربما من إحيائيين وحداثيين، مما يجعل حديث فضل الرحمن مُكرَّرًا يَعِدُ بنفس الآمال المحدودة، عن رؤية ربما هي التي تسببت في نشأة هذا التجاور على مستوى الفكر والواقع من الأساس[3]، يجيب فضل بأن يميز اشتغاله عن هذه الاشتغالات بكونه بالأساس لا يركّز على إنتاج تأويلات جديدة بل على بلورة منهجية تأويلية متماسكة تُمَكِّنُنَا من استخراج ممكنات القول القرآني ومن ربطها بالحياة المعاصرة للمسلمين، في صورة بعيدة عن أيّ تجاور أو تبرير.
ومحاولة بلورة هذه المنهجية التأويلية هو ما لا يقوم به الحداثيون ولا الإسلاميون في رأي فضل مما يبرر طرحه؛ فالتحديثي الكلاسيكي -وفقًا له- لا يمتلك أيّ منهج يستحق هذا الاسم، بل يقتصر نشاطه على التعاطي الإجمالي مع مشكلات تبدو له وكأنها تتطلب حلًّا يفيد المجتمع الإسلامي، لكنها في حقيقتها مُستلهَمة من تجربة الغرب. أما الإسلاميون الأصوليون فإنهم «يتحدثون عن الأصل دون بلورة أيّ فكر أصيل من حوله، ولا يملك الإحيائي الجديد سوى أن يكون ردّ فعل على ما يأتي به الحداثي الكلاسيكي حول بعض القضايا الاجتماعية، دون أن يُتعب نفسه في البحث عن منهجية للتفسير القرآني تكون أمينة وموثوقة دراسيًّا وعقليًّا»[iv]؛ لذا فرغم الاشتغال الطويل على القرآن وعلى الحداثة وعلى الإشكالات التي يطرحها لقاؤهما أو صدامهما، إلا أن قضية المنهج تظلّ غائبة عن العقل الإسلامي -وفقًا لفضل- وفي هذا الغياب، ومن أجل ملء هذا الفراغ بمنهج متماسك يتجاوز التجاور الفكري والواقعي يؤسس فضل تأويليته للقرآن.
يطرح فضل تأويلية للقرآن يؤسسها نظريًّا في كتاب (الإسلام والحداثة، 1978م) أو الإسلام وضرورة التحديث كما هي الترجمة العربية، فيُحدِّد منطلقاته ويُبلوِر منهجيته في التعامل مع القرآن، ويثير الأسئلة التي قد تُثار على تأويليته في منطلقاتها وأدواتها، ويحاول الإجابة على هذه الأسئلة بالدخول في نقاش مع هذه الاعتراضات المُتوقعَة، ثم في كتابه الأهم ربما (المسائل الكبرى في القرآن، 1980م) يقوم فضل بتقديم تطبيق لهذه التأويلية بتحديد المسائل والموضوعات الكبرى للقرآن التي تُشكِّل مركز تأويليته مزدوجة الحركة كما سنوضح.
في هذا المقال سنحاول توضيح الملامح الرئيسة لهذه التأويلية التي يقدمها فضل الرحمن، والتساؤل عن مدى تماسك منطلقاتها، ومدى قدرتها على تحقيق الرهان الذي يبغيه فضل الرحمن منها، كما سنحاول في ثنايا هذا المقال الإشارة -ولو البسيطة- إلى بعض الاشتراكات والتباينات بين تأويلية فضل وتأويلية غيره من الكُتَّاب الحداثيين الذين ذكرنا سابقًا: (نصر أبو زيد- عبد المجيد الشرفي- يوسف الصديق)، ففي ظنّنا فإن هذا، كما يضيء لنا خطاباتهم وخطاب فضل بصورة أكبر؛ فإنه كذلك يضيء لنا الكثير من أبعاد القراءة الحداثية للقرآن في العموم.
نبذة تعريفية بفضل الرحمن مالك:
فضل الرحمن مالك مفكر باكستاني، وُلِد في سبتمبر 1919م، في مقاطعة حرزة الباكستان (وإن كان ميلاده سابقًا على التقسيم)، لوالدٍ كان من علماء مدرسة (ديبوند) في شمال الهند، وهي من المدارس الإسلامية التقليدية حتى إنها تُعرَف بأزهر الهند.
واستطاع مالك الجمع بين الدرس التقليدي والدرس الحديث، فقد تكفَّل بالأول والده (مولانا شهاب الدين) في المنزل؛ فحفظ فضل الرحمن القرآن على يديه، وعايش من خلاله الدرس التقليدي وعلوم المدونة الإسلامية الكلاسيكية خصوصًا التفسير والحديث والفقه، وتعلّم العلوم المعاصرة عبر الذهاب لمدرسة حديثة.
في عام 1943م حصل فضل الرحمن على الماجستير من جامعة (بنجاب) بلاهور، ثم سافر بعدها إلى إنجلترا ليحصل على شهادة الدكتوراه في فلسفة ابن سينا من جامعة أوكسفورد، وتلَتْ هذه الفترة فترةُ تدريس للفلسفة في جامعة دوهام بإنجلترا.
ومنذ عام 1962م أصبح فضل الرحمن أستاذًا مشاركًا في (معهد الدراسات الإسلامية) بجامعة ماكجيل بكندا.
وفي هذه الفترة كتب فضل مجموعة من الكتب المهمّة حول الفلسفة وفلسفة ابن سينا تحديدًا وحول النبوة والفلسفة، وترجم فصلًا من كتاب النجاة لابن سينا مع تعليقات تاريخية وفلسفية.
عاد فضل لباكستان بطلب من رئيسها محمد أيوب خان في مهمّة استشارية، وبعد أن أثار كتابه (الإسلام) بعض المواقف ضده اضطر للهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية ليعمل هناك أستاذًا زائرًا في جامعة كالفورنيا في 1969م، ثم أستاذًا محاضرًا بجامعة شيكاغو في خريف نفس السنة حيث عُيَّن أستاذَ كرسيّ (هارولد سويفت) للفكر الإسلامي حتى وفاته.
كتب فضل طوال حياته كُتبًا حول الإسلام والتجديد والإصلاح أهمها ربما (الإسلام والحداثة)، و(المسائل الكبرى في القرآن).
تُوفِيَ فضل الرحمن في يوليو عام 1988م.
الملامح الأساسية لتأويلية فضل الرحمن:
هذه التأويلية الحديثة التي يحاول فضل أن يبلورها لها منطلقٌ أساس، وهو محاولة تجاوز هذا الخطأ الذي ميّز (التأويلية الكلاسيكية) من وجهة نظر فضل، أو فلْنقُل: (التـأويليات الكلاسيكية)؛ حيث لا يتحدث فضل عن تأويلية كلاسيكية واحدة متناغمة بل عن تأويليات فقهية وفلسفية وكلامية وصوفية، هذا الخطأ والقصور الذي سيطر على هذه التأويليات هو -وفقًا لفضل- عدم الاهتمام الكبير لقضية وحدة القرآن كناظم منهجي تبتدئ تأويلية القرآن من محاولة تحديده، ثم تستند عليه في تأويلاتها الجزئية، فوفقًا لفضل فإن الحال كان؛ إما عدم الاهتمام بهذه الوحدة من الأساس، بل الإصرار على التجزئة وعلى استخدام أدوات واهية مثل القياس كأداة وحيدة تُمكِّن من الوصول لتعميمات معقولة ومُلِحَّة لأحكام قرآنية يتطلبها الواقع، هذا بدلًا من الانخراط في إنشاء عمل «يقوم باستنباط مُمنهَج للقيم والمبادئ من نصوص القرآن»[v]، وهذا كان حال (التأويلية الفقهية) وفقًا لفضل، أو في جهة أخرى الاهتمام لوحدة القرآن لكن بفرض وحدات من خارج القرآن عليه، كما حدث مع (التأويلية الفلسفية)؛ فالفلاسفة -وفقًا لفضل- انتبهوا لوحدة القرآن بالفعل، لكنهم لم يستخرجوا هذه الوحدة من داخل القرآن نفسه ووفقًا لدراسة حثيثة له، بل استعيرت هذه الوحدة -غالبًا- من أنظمة فكرية أخرى، «ليست في تناحر مع القرآن بالضرورة لكن بالتأكيد غريبة عنه»[vi].
لذا يحاول فضل في مواجهة قصور هذه (التأويليات الكلاسيكية) أن يصل لـ(الوحدة) التي ينطوي عليها النصّ القرآني ذاته كأساس تبتدئ منه تأويليته الحديثة وتستند عليه.
ولا بد من الإشارة هنا لكون فهم فضل لقضية الوحدة ولـ(كلية النصّ القرآني) وتماسكه والتي يؤسِّس عليها تأويليته؛ هو فهم له ملامحه الخاصة بين فهوم الكتابات الحداثية التي ذكرناها سابقًا: (نصر أبو زيد، والشرفي مثلًا)، فالوحدة لا تعني عند فضل مجرد ربط الآيات -في موضوع واحد- ببعضها، أو قراءة الآيات الجزئية في ضوء آيات كلية حول قضايا اجتماعيةٍ ما[4]، وإنما تعني -تحديدًا- تأسُّس القرآن كاملًا على عدد من المفاهيم المركزية و(المسائل الكبرى) التي يُمثِّلها بالأساس: (التوحيد، والحساب، والوحي)، كمفاهيم عقدية اجتماعية مركزية (تكوينية) بلغة كانط التي يستعيرها فضل، يمكن في ضوئها فهم رسالة الإسلام التشريعية والاجتماعية والأخلاقية، فـ«نظريات الخالق الواحد القيوم، وضرورة الوصول إلى عدالة اجتماعية اقتصادية، والإيمان باليوم الآخر، إنما هي عناصر تقود إلى التجربة الدينية الأصيلة التي جاء بها محمد»[vii]، فالوحدة عند فضل -والتي تكشف عن مبادئ العقلانية الإسلامية- تكمُن في تأسُّس الجانب التشريعي على الجانب العقائدي، حيث هما غير منفصلين، فـ(الله) هو العنصر النظام لتجربة هي دينية وأخلاقية وسلوكية في آن[viii]، ومن هنا تأتي ثورية القرآن التي اختفت نتيجة تفويت الوحدة في العصور الزاهرة، أو نتيجة تحويل (الله) لموضوع نهائي في ذاته للتجربة الدينية «فبدلًا من أن يواصل البشر سعيهم للحصول على القيم انطلاقًا من هذه التجربة، أصبحت التجربة هي الغاية في ذاتها»، أو تحت ركام دراسة بديعية وبيانية مُخدِّرة ميَّزت عصور الانحطاط تحديدًا[ix].
ومنهجية فضل التي يقترحها لقراءة القرآن تقوم على خطوتين رئيستين، أو قُلْ على حركة مزدوجة تسير في اتجاهين: اتجاه من لحظتنا الراهنة نحو القرآن، واتجاه من القرآن نحو لحظتنا الحالية؛ فـ«الحركة الأولى تقوم انطلاقًا من خصوصيات القرآن، وصولًا إلى تحديد ومنهجة مبادئه العامة وقيمه وغاياته بعيدة المدى»، وهذه المرحلة المركز فيها هو اكتشاف الوحدة القرآنية، والحركة الثانية «تنطلق من هذه النظرة العامة وصولًا إلى النظرة الخاصّة التي يتعين الآن صياغتها وإنجازها»[x].
وكلّ حركة من هاتين الحركتين تستلزم تأسيسًا منهجيًّا خاصًّا بسبب الإشكالات التي قد تُثار عليها، ورغم أن (فضلًا) كتب عن هذه التأويلية كتابًا واحدًا هو كتابه (الإسلام وضرورة التحديث)، وأشار إليها مرة أخرى في مقدمة كتابه (المسائل الكبرى في القرآن) إلا أننا نجد إلمامًا مناسبًا تمامًا بالإشكالات التي قد تُثار حول تأويليته ومنطلقاتها، خصوصًا إشكالين رئيسين ينتبه لهما فضل ويحاول الإجابة عنهما في معرض تأسيسه لتأويليته؛ الإشكال الأول: هو إشكال إمكان الوصول من الأساس -وبموضوعيةٍ- للمرتكزات القرآنية ولوحدته هو الداخلية من عدمه، وهو الموضوع الذي تتنازع حوله المناهج التأويلية المعاصرة بعد طرح جادمر لنظرته التي تتحدث عن حتمية الوعي المسبق والتي تجعل بالتالي الموضوعية مسألة مشكوكًا فيها، والإشكال الثاني: هو هل تعني تأويليته وانتقاده الدائم لتغييب الوحدة تراثيًّا وربطها بتشتت الآراء بنزعة منه لتأويل أُحادي للقرآن؟!
فبالنسبة للإشكال الأول، فإنّ (فضلًا) الذي يعي تمامًا كون تأويليته تقوم في حركتها الأولى على أساس إمكان الوصول لفهم موضوعي لمرتكزات القرآن بكلّ ما يحيط بهذه العملية من صعوبات تفترضها خطوات منهجيته (التاريخية- المفهومية) كما سنوضح، يستعيد ذلك الخلاف المطروح على ساحة التأويليات المعاصرة حول الموضوعية، وهو خلاف يمثل طرفَيْه الأقصى: بيتي الهرمنيوطقي الأمريكي أحد أهم أقطاب الهرمنيوطيقا المنهجية، وجادمر الهرمنيوطقي الألماني الشهير أحد أهم أقطاب الهرمنيوطيقا الفلسفية؛ فبينما يرى بيتي أن هدف التأويل هو الوصول في حركة ارتدادية لما كان يقصده (عقل) قائل النصّ حين كتب نصّه، فإن جادمر على العكس يرى أن هذا الأمر مستحيل، ليس فقط بسبب (التاريخ الفعَّال) الذي يُؤثِّر في موضوع البحث أو النصّ المقروء، ولكن بسبب حتمية وجود التحديد المُسبَق للوعي في عقل القارئ نفسه، وهو تحديد ينطلق من (التاريخ الذي يُشكِّل قماشة كينونتي)، والذي ورغم أن الوعي به يرقى بالوعي التاريخي من وعي تاريخي عادي لوعي تاريخي فعلي، إلا أنه لا يجعلنا نفلت من تأثيره، فهذا (التاريخ المؤثِّر أو الفعَّال) يظلّ حاسمًا في إحداث هذه المسافة بيني وبين النصّ وقائله وتاريخه (أي قماشة كينونته)، وحتى مع طرح جادمر لفكرته عن الإنصات وعن أنصار آفاق القارئ والنصّ، إلا أنه يظلّ ضد الحديث عن وصول موضوعي لمعنى مقصود عبر منهج مناسب وهو ما يجعله على الضدّ تمامًا من طرح فضل الرحمن عن ملامح تأويليته.
لذا يحاول فضل الرحمن ومن أجل التأكيد على إمكان الوصول لفهم موضوعي مناسب لمرتكزات القرآن كخطوة أولى من منهجيته، والتي يتأسَّس عليها كلّ شيء انطلاقًا من نظرته عن تماسك النصّ كما أسلفنا وكما سنوضح تفصيلًا -أن يُبرِز عدم دقة فكرة جادمر عن (حتمية التاريخ الفعَّال) هذه، يقوم فضل بهذا عن طريق إثارة إشكال (الانقطاع في التقاليد)، فالتقاليد الثقافية الكبرى سواء في المسيحية أو في الإسلام على سبيل المثال تشهد لحظات من الانقطاع يكون أبطالها أفرادًا يحدثون انقطاعًا عبر قيامهم بحركة مزدوجة تجاه ماضيهم وحاضرهم، حيث ينطلقون من وضعية راهنة تثير استشكالات وانتقادات نحو تقاليدهم ويعودون لتأسيس وضعية جديدة تغير واقعهم وذواتهم والنظرة لتاريخهم الذي ينخرطون فيه والتاريخ الفعلي اللاحق عليهم؛ مما يجعل حديث جادمر عن أفراد وعيهم الذاتي يحدث داخل إطار (الحلقات المغلقة للحياة التاريخية)، وغياب لتلك القدرة على إدراك الماضي بقدرٍ ما من الموضوعية؛ هو أمر لا يقبله التاريخ ولا العقل وفقًا لفضل الرحمن، «فإيجاد أجوبة واعية على الماضي تتضمن حركتين لا يمكن تمييزهم، التيقن من الماضي...، والجواب نفسه، الذي يتحدد -لا بشكل مسبق- عن طريق الوضعية الراهنة التي يكون التاريخ الفعلي جزءًا منها، ولكن يأتي جهدي الواعي ونشاط وعيي الذاتي كذلك ليشكِّلَا جزءًا أساسيًّا منها»[xi].
الإشكال الثاني الذي يثيره فضل في مواجهة تأويليته الخاصة، هو إشكال أحادية المعنى، ففضل ينتقد التأويليات التراثية بما في ذلك الفقهية تحديدًا على كثرة الخلافات وتشتت الآراء، فقلَّة النصوص الحاسمة واللجوء للقياس الذي هو تقنية مظنونة يؤدي لتشعّب الآراء واختلافها المستمر[xii]، وهذا شيء يحِدُّ منه اكتشاف الوحدة القرآنية التي يقترحها فضل في مواجهة هذا التشتّت، لكن هذا -كما يؤكد فضل- لا يعني وجود تأويل أحادي؛ وهذا لأن الخطوة الأولى من تأويلية فضل والتي تقوم بتحديد مرتكزات القرآن، هي خطوة أصلًا تأويلية، فهذا التحديد هو بمثابة خطاطة أولية لفهم القرآن، لكنه بالطبع ليس تأويلًا وحيدًا، ولا يمتلك في ذاته أيَّة إطلاقية.
لكن محاولة تأسيس منهجية تتوخى الوحدة كأساس، ومحاولة الاقتراب من هذه الوحدة هو -كما يصرُّ فضل- أمرٌ يُقلِّل من التأويلات المُتعسِّفة ويستبعدها، وللتقليل أكثر فإنّ (فضلًا) يتحدث عن (تأويلية جماعية) ربما، ليس فقط بمعنى وجود طواقم عمل لإجراء هذه التأويلية، بل كذلك في البحث عن نقاشات جماعية تمنح القدرة للجماعة كلّها على قبول بعض التأويلات ورفض بعضها، فهذه التأويلية بهذه السمات والاقتراحات هي التي تستطيع التخلص -وفقًا له- من تلك الدائرة الجهنمية، دائرة تكرار التساؤل الذي لا ينتهي عن نقطة البدء في الإصلاح[xiii].
ولعلّ هذه (التأويلية الجماعية) تبدو في حديث فضل عن أن إنجاز تأويليته مزدوجة الحركة هي مهمّة يشترك فيها المؤرخون وعلماء الاجتماع وعلماء الأخلاق؛ فالمؤرخون يحددون الوضعية التاريخية الراهنة، وعلماء الاجتماع يحددون عناصر هذه الوضعية التي نحياها وكيفية تغيير حاضرنا بقدر ما يبدو ذلك ضروريًّا، وعلماء الأخلاق يحددون سلَّم أولويات جديد يجعلنا قادرين على توطيد للقيم القرآنية توطيدًا جديدًا، أيْ إن دورهم (التوجيه الفعال)، أو (الهندسة الأخلاقية)[xiv]، هذا يجعل تأويلية فضل في حاجة لعملٍ جماعي بالفعل.
بهذا يكون فضل قد أسس لمنطلقات تأويليته، «غياب الوحدة في التأويليات الكلاسيكية أو وجودها لكن كوحدة مُقحَمة على القرآن من خارجه»، «إمكان الوصول لفهم مقصد القرآن/ وحدة النص القرآني/ مرتكزات العقلانية الإسلامية»، «استبعاد التأويلات السيئة والذاتية والمُتعسِّفة التي تُشوِّش على النصّ القرآني وعلى إنجاز تأويلية فعَّالة له تستعيد حيويته».
وحدَّد هدف تأويليته هذه باستعادة الفعالية والحيوية للنصّ القرآني في حياة المسلم المعاصر بشكلٍ يتجاوز الدائرة الجهنمية للتجاور والتساكن على مستوى الفكر والواقع.
وكما نحن محظوظون بكون فضل -على خلاف غيره- قدَّم تأسيسًا واضحًا لتأويليته ومنطلقاتها يمكن التداخل معه والنقاش حوله، فكذلك نحن محظوظون للغاية حيث إن (فضلًا) كتب تطبيقًا لهذه التأويلية لا تناولًا لبعض آيات كما هي العادة، بل كتابًا كاملًا (المسائل الكبرى في القرآن الكريم)؛ مما يجعلنا قادرين على فهم الملامح الرئيسة لهذه التأويلية، والأدوات المنهجية التي يتوّسلها فضل في اشتغاله على القرآن.
الخطوة الأساس: كيفية تحديد المسائل الكبرى في القرآن:
بالنسبة للخطوة الأولى أو الحركة الأولى ذات الاتجاه الارتدادي في تأويلية فضل، والتي تتعلق بالاتجاه نحو القرآن لاكتشاف وحدته التي تُمثِّل الأساس لتأويليته، فإن (فضلًا) -وكما قلنا- يعتبر أن الوحدة القرآنية تعني تأسُّس النظام التشريعي على النظام العقدي؛ لذا فمع إصرار فضل على ضرورة تحليل التشريعات الإسلامية في ضوء تاريخيتها، وفي ضوء كونها استجابة قرآنية على وضعيات خاصة شهدها المجتمع القرشي، تجعلنا نستطيع بقراءة تجريبية لهذه التشريعات[xv] تجريدها من ملابساتها التاريخية والوصول لمبادئ عامّة تُمثِّل المعقولية الإسلامية الناظمة للتشريعات، إلا أن هذا التجريد ليس كافيًا وحده للوصول للوحدة التي يتحدث عنها كأساس لتأويليته، بل لا بد مع هذا من السير في اتجاه كشف المرتكزات الرئيسة للنصّ القرآني، من هنا فإننا نفهم تمامًا لماذا يشتغل فضل الرحمن في أكبر مساحة في خطابه على تحديد هذه المرتكزات، باعتبارها مرتكزات عقَدية اجتماعية، أو تكوينية -كما أسلفنا- للحياة الأخلاقية الإسلامية، بدلًا من الوقوع في نفس الخطأ الذي لا يقع فيه فقط الحداثيون وإنما الإسلاميون كذلك كما يقول، وهو الانشغال بعلاج مسائل اجتماعية جزئية -كردِّ فعل في أغلب الأحيان- عن الهدف الأهم وهو اكتشاف الوحدة القرآنية الناظمة للمبادئ العامة لكلّ هذه التفصيلات والتي تُمثِّل الركن الأساس في (تأويلية قرآنية أمينة وموثقة دراسيًّا وعقليًّا).
ولكي يقوم فضل بالوصول لهذه المرتكزات كأساس لتأويليته فإنه يلجأ لتشغيل تقنية مزدوجة على القرآن، تقع (التاريخية) في قلبها، فهذه التقنية تجمع بين التحليل المفهومي لصلة التصوّرات القرآنية بالتصوّرات الإبراهيمية من جهة، وبين التسييق التاريخي لهذه التصورات باستحضار الوضعية التاريخية التي تنزَّل فيها القول القرآني من جهة أخرى؛ من أجل كشف وإبراز ما يمكن أن نُعبِّر عنه بكونه (هيكلة) المفاهيم في مواجهة الواقع القرشي، فالمسألة القرآنية الكبرى هي مسألة إبراهيمية مُهيكَلَة في مواجهة الواقع القرشي.
ويصل فضل من خلال هذا الجدل المفهومي التاريخي إلى وجود ثلاثة مرتكزات للقرآن، هي: (التوحيد)، و(الوحي)، و(الحساب أو البعث)، وكونهم مرتكزًا قرآنيًّا ينبع من مركزيتهم في الرؤية الإبراهيمية من جهة، ومن جهة أخرى لكون هذه المساحات الثلاث هي تحديدًا ما رفضه القرشيون، مما جعل القرآن يُبرِزهم (ويهيكلهم) باستمرار لتأكيد انفصاله عن النظام العقَدي الجاهلي، هذا الذي كان يحاول قراءة الإسلام من خلال نظامه هو العقَدي، فيُحيل الوحي لكهانة والتوحيد لشرك[5]، فكان لا بد للإسلام من تأكيد انفصاله عن هذه الرؤية.
هذه التقنية بازدواجيتها لا تمنح (فضلًا) -فحسب- القدرةَ على تحديد مرتكزات القرآن الثلاثة: (توحيد، وحي، بعث)، بل كذلك تمنحه أفضليّة كبيرةً في القدرة على تحديد وتركيب هذه المفاهيم المركزية نفسها، وكيف تكون هي نفسها حقولًا مفاهيمية بسبب فعل التهيكل هذا، وهو أمر مهم للغاية لتقنية فضل كما سيتضح.
فالتوحيد الإسلامي -على سبيل المثال- ليس مجرد مفهوم بسيط، بل هو مفهوم مركّب من عدة مفاهيم هي التي تفصل الإسلام عن توحيديات أخرى منها التوحيدية الوثنية[6] ذاتها التي كان القرآن يقابلها؛ فالتوحيد الإسلامي يجمع بين مفاهيم: (توحيد المفارقة) والذي يميز التوحيد الإبراهيمي عن الواحدية وتأليه الطبيعة، و(توحيد التصريف) والذي يميزه عن ديانات، مثل: (الثنوية المعتدلة)، و(الثنوية الجذرية) مثلًا، والتي هي مُوحِّدة في العبادة وفي الأصل وفي المآل[xvi]، لكنها ترى تاريخ العالم محكومًا بصراع إله الشر لإله الخير، و(توحيد العبادة) الذي يميزه عن ديانات تُوحِّد الخالق لكن لا تُفرِده بالعبادة مثل الديانة الجاهلية، ونحن نجد مركزية كبيرة لمفاهيم (توحيد التصريف)، و(توحيد البيان)، و(توحيد العبادة) في القرآن؛ وهذا لأن هذه المفاهيم هي أساس خلاف مع المعتقدات القرشية التي تمثّل الوضعية التاريخية لتنزّل القرآن، وهذا يعطي لتقنية فضل بازدواجيّتها هذه مزية كبيرة وفعالية في تحديد المرتكزات كما في بيان تركيبها.
لكنَّ (فضلًا) لا يتوقف في كتابه عند تقديم منهجية تتيح له تحديد هذه المرتكزات فحسب، ولا حتى في بيان تعقّد وتركيب كلّ مفهوم نتيجة تهيكله في مواجهة النظام العقَدي الاجتماعي التشريعي الجاهلي، بل كذلك يقوم فضل بربط مفاهيم أخرى أقلّ مركزية بهذه المفاهيم المركزية حتى يستطيع فهم القول القرآني فيها؛ انطلاقًا من (خصوصية المنطق القرآني ذاته) وابتعادًا عن الوقوع في أيّ إسقاط كأحد الرهانات الأساس لتأويلية فضل (كـتأويليةٍ أمينةٍ للقرآن).
ففضل -مثلًا- حين يدرس مسألة (الطبيعة) في القرآن، فإنه يتناولها باعتبارها مسألة متعلقة بقضية الحساب الأخروي كمسألة كبرى ومركزية، فالحديث القرآني حول تدمير الطبيعة والذي يتجلى بصورة كبيرة في السور الأولى (ذات الطابع الأبوكاليبسي) المُركِّز على اندثار العالم وقرب الآخرة كما يقول جعيط[xvii]، ليس حديثًا عن انتظامها أو عدم انتظامها «فمفاهيم انتظام الطبيعة واستقلالها من جهة، ولا مطلقيتها من جهة ثانية لا تظهر في القرآن على وجه الحصر، بل والأهم أنها لا تظهر بارتباط مع الاعتقاد في المعجزات»، لكن من أجل «إثبات قابلية الطبيعة للتدمير وإثبات إمكان خلقها من جديد من أجل المساءلة الأخيرة للإنسان»[xviii].
هذا التحديد مهمّ جدًّا، حيث يتيح لفضل دراسة الطبيعة في القرآن دون إسقاط لأيّ إشكالات من خارج القرآن عليه، مثل إشكال انتظام الطبيعة واستقلال قانونها، وهو الإشكال الذي يحتلّ موقعًا مركزيًّا في الإبستمولوجي الحديث الذي ينطلق من مسلَّمة انتظام الطبيعة كأساس للعلم التجريبي الاستقرائي، والذي يتكرر كثيرًا إسقاطه على القرآن بسؤاله عن الطبيعة في ضوء ثنائيات الانتظام/ اللا انتظام، القانون/ اللا قانون، دون السؤال عن المجال الذي يتناول فيه القرآن نفسه قضية الطبيعة كمُحدِّد أوَّليّ لطرح السؤال.
ونحن نظنّ أن (فضلًا) مدينٌ كثيرًا للياباني إيزوتسو في منهجيته تلك في التعامل مع المسائل الكبرى[7]، سواء في تقنية تحديد المرتكزات، أو -والأهم- في الجزء الخاصّ بكشف العلاقة بين هذه المرتكزات (المسائل الكبرى)، وكشف العلاقات بين المفاهيم هذا له أهمية مضاعفة في تأويلية فضل، فهو من جهة يجعله أقدر على كشف الوحدة القرآنية التي تربط بين هذه المفاهيم، ومن جهة يساعده على معالقة الإشكالات الطارئة بهذه المفاهيم المركزية (المسائل الكبرى) دون أن يمارس الإسقاط كما وضحنا في مثال تعامله مع قضية الطبيعة، من هنا تأتي أهمية ما نظنه استفادة منهجية من إيزوتسو وإن كانت استفادة قدمت كذلك لمنهجية إيزوتسو[8] الكثير حيث هي تطوير وتحريك لها.
فعمل فضل على القرآن وتحديد مفاهيمه المركزية يمتاز في كونه يشتغل لا على مفاهيم مختارة بتقنية غير واضحة كما هو الحال مع اللساني الياباني[9]، بل يشتغل على مفاهيم عقديّة مختارة؛ انطلاقًا من تقنيته المزدوجة التي أسلفنا الحديث عنها، والتي هي تطعيم (مفاهيمي تاريخي) لمنهجية إيزوتسو الدلالية؛ مما يعطي لمفاهيمه ثقلًا أكبر حين تُدْرَس كمفاهيم مركزية أو مسائل كبرى في القرآن، وهذا امتياز منحه عمل فضل لتقنية إيزوتسو حيث نقلها من حقلها اللساني لحقل تأويلي أكثر ثراءً، وهذا الثراء يزداد حين نتحدث عن تعامل فضل مع هذه المرتكزات وعلاقاتها بشكل يُركِّز على كشف العلائق ما بينها، حيث وكما كانت المفاهيم عند إيزوتسو هي حقول مفاهيمية لها مركز ومفاهيم متعالقة؛ انطلاقًا من تفريقه بين المعنى الأساسي والمعنى العلاقي، فكذلك يوجد هنا -أيضًا- حقولٌ عقَدية لها مركز مفهومي ومفاهيم متعالقة به، فهذا أمر حاسم بالنسبة لفضل الذي يُصِر على تماسك القرآن مبادئًا وتشريعًا كسطح عقَدي تشريعي ترتبط فيه المفاهيم وتتعالق، مما يجعل تقنية إيزوتسو في غاية الإفادة لفضل حين تخضع لتطوير يناسب مدخله.
ولعلّ هذا التعالق بين المفاهيم وأثر تقنية إيزوتسو في كشفه يَظهر لنا بوضوح لو تناولنا مفهوم من أهم المفاهيم التي تناولها فضل في كتابه وربما أكثرها قدرة على بيان مقصوده بالتماسك العقائدي الأخلاقي للنصّ القرآني وهو مفهوم (الآخرة) وكيف يراه فضل مفهومًا أخلاقيًّا، وكيف يربط به مفاهيم مثل: (التقوى)، و(العدل)، و(المساواة).
الآخرة والوحدانية والأخلاق:
تُعَدّ قضية الآخرة والحساب مسألة كبرى في القرآن -وفقًا لفضل-، فهي مسألة حاسمة في التوحيد الإبراهيمي، كما أنها مسألة مركزية في البيئة الجاهلية التي واجهها القرآن بعقائده وتشريعاته، تلك التي كانت ترفض تمامًا الإيمان بوجود حياة أخرى خلف هذه الحياة، وهو الذي يتضح حتى في المفاهيم السائدة عندهم عن الموت كـ(رَدى)، و(هلاك)، لا (وفاة) كما في الإسلام[10]؛ لذا يرى فضل أن هذه المسألة ربما كانت من تلك المسائل التي نازع فيها القرشيّون النبيَّ وطلبوا منه التخلي عنها في مقابل أن يؤمنوا له ويدخلوا في دينه «كما فعلوا في التوحيد وفي النبوة»[xix].
وفضل حين ينظر لهذه المسألة فإنه ينظر لها كأساس لنظام أخلاقي، فكما قلنا فإن (فضلًا) يعتبر أن الله هو الناظم لتجربة هي سلوكية وأخلاقية في الأخير، «فرسالة محمد النبوية توجهت نحو التحسين الأخلاقي لوضعية الإنسان بالمعنى الملموس والجماعي للكلمة»[xx]، وأن الإيمان باليوم الآخر هو والدعوة لعدالة اجتماعية جوهرٌ لتلك التجربة التي خاضها محمد.
لكن كيف تكون الآخرة أساسًا لنظام أخلاقي في نظر فضل الرحمن؟ أو لو عبَّرنا بما يناسب تأويليته، فسنقول: كيف تكون (الآخرة)كمسألة قرآنية كبرى نواة لحقل مفاهيمي سلوكي/عقَدي تشريعي؟
إنّ الآخرة -وفقًا لفضل- هي تصوّر يُحتِّم على الإنسان النظر للحياة باعتبارها مُنتهيَة في أحد مستوياتها، لكنها في مستوى آخر باقية، فلها غاية هي الآخرة، مما يعني أن الدنيا المُدانة في القرآن ليست تعبيرًا عن الحياة التي نعيشها أو عن العالم، وإنما تعبير عن النزعات المنحطَّة في الاكتفاء بهذا العالم وفي الانطلاق من دوافع الأنانية واللذة، أما الأفعال التي تتعالى على هذه النزعات فإنها ورغم أنها تبدأ هنا والآن إلا أنها باقية وممتدة، وهذا يترتب عليه كون الإنسان ينشط للتعامل مع أفعاله الدنيوية مهما دقّت بجدّية تامّة، وأن يتعوّد على ميزانها بميزان غير ميزان الذهب والفضة، سواء على مستوى الظاهر أو على مستوى الباطن، فالآخرة -بما هي الغاية النهائية لأعمال هذا العالم- هي آخرة تنكشف فيها الأبصار ويُبصِر فيها الإنسان حقيقة الأمور وتظهر فيها القيمة الحقّ لكلّ شيء وتنجلي فيها الأسرار والبواطن، مما يجعل الإنسان في حياته لا يتهاون في الخروج على النظام الأخلاقي، وينشط أن يكون له في حياته هذه بصر شبيه ببصر الآخرة يستطيع وزن حقيقة الأشياء.
ومن هنا يأتي مفهوم قرآني شديد الأهمية والمركزية، يترتب ويتعالق بـ(الآخرة)حيث يصير كـ«مفهوم معْبَر» يتركّز فيه تحول المفهوم العقَدي إلى مفهوم ناظم للأخلاق في الإسلام، أيْ مفهوم (التقوى)، فالتقوى هي بصيرة الإنسان بأفعاله ظاهرًا وباطنًا، ومصباح يفرّق به بين الخطأ والصواب، وهو حساسية تزداد بممارستها[xxi]، حتى يصل الإنسان من الانتباه لأفعاله والتدقيق فيها إلى مستوى يمكن التعبير عنه بأنه مستوى (آخري)، أيْ شبيه بتلك اللحظة في الآخرة التي ينكشف للإنسان فيها حقيقة الأمور ومقدارها الحقّ، والتي ينكشف فيها حقيقة المرء المخفية، فالإيمان بالآخرة بهذا يكون ناظمًا للنظام الأخلاقي والسلوكي في أدقّ مستوياته عبر طرحها لمفهوم (معبر) أساس هو مفهوم (التقوى).
كذلك يرتبط مفهوم الآخرة من ناحية أخرى -فكما قلنا فالمفهوم حقل مفاهيمي- بمفهوم العدل كقيمة يُطالِب القرآن المسلمين بتوخِّيها دومًا حتى مع من يَكرهون، وهذا المفهوم (مفهوم العدل) ينطرح عبر الآخرة من حيث الآخرة هي التجلي الأشمل للعدل ولحسم الخلافات وإعطاء الحقوق، فهي لحظة تكريس أخلاقية الكون في مجمله، فرغم أن هذا العالم لا ينتهي دومًا للعدل كمبدأ أعلى للأخلاقية الإسلامية، إلا أن العدالة الإلهية قادمة لا محالة، وهذا ما يبرر الفعل الأخلاقي البشري المحقق للعدل حيث هو التناغم مع النظام الأخلاقي الساري في الكون والمتحقق حتمًا.
وبالتالي فإنّ هذا التصور العقَدي في وجود آخرة وبعث وحساب نفسي وجسماني[11] ليس مجرد مسألة تصورية تتعلق بآخر هذا العالم، أو كما يقال أحيانًا: تصوّر يصرف عن هذا العالم، بل إنه -وعلى العكس- مُوجَّه تمامًا نحو هذا العالم؛ لتغييره وتأسيس أخلاقية هي الناظم الوحيد له على مستوى الفرد والمجتمع. وهو حقل مفاهيمي حيث يدور في مجاله مفاهيم (المسؤولية)، و(التقوى)، و(جدية الحياة)، و(العدل)كمفاهيم تعبُر وتَشِع في الأخلاقية الإنسانية التي يريد الإسلام تحقيقها.
هذا التأسُّس للقضايا الأخلاقية والسلوكية والاجتماعية على المفاهيم العقدية التي تصير بهذا حقولًا مفاهيمية تتعالق بها المفاهيم التشريعية وتنطلق من إشعاعها وتدور في مجالها، هو الذي يفسر -وفقًا لفضل- تَواكُب هذه التشريعات مع تكريس التصورات العقَدية منذ انطلاقة القرآن الأولى؛ فالقرآن تبنَّى تحريم الربا وإدانة الكَنز وتحرير العبيد منذ لحَظاته الأولى في مكة، مما يعني أن المساواة وخلق مجتمع متساوٍ مؤاخٍ، ورفع الظلم عن الفئات التي كان يظلمها النظام التشريعي الجاهلي، هي مبادئ تعمل في بنية التشريع القرآني ذاته، وتكشف «عن ما هو معقول وعقلاني خلف وصاياه وتشريعاته وتعليقاته»[xxii].
ويرى فضل أن الوصول للمبادئ العامة للتشريع الإسلامي يتطلب -وبالإضافة لهذا الاشتغال على المعتقد كمفهوم تكويني عقَدي أخلاقي- الاشتغال على التشريعات/الوصايا القرآنية الاجتماعية ذاتها، لا عبر قراءة حرفية لغوية لها، بل عبر مجادلة هذه التشريعات بالسياق التاريخي لنزولها من أجل الوصول لتحديد أهدافها الناظمة.
فكما يذكر فضل فإنه سيكون من العبث الكبير التعامل حرفيًّا مع أمر القرآن بتحرير الرقاب على اعتباره تكريسًا لنظام العبيد! حيث يكتسب المرء جدارته الأخلاقية عبر التحرير الدوري للعبيد مما يحتّم وجود هذه المؤسسة، والخروج من حرفية كهذه يأباها أيّ عقل حسّاس تأتي من الانتباه لهذه المجادلة التي يتحدّث عنها فضل، والاشتغال بها على مساحات أخرى مثل إدخال النساء في فئات الوارثين، ومثل التنبيه على عدم حسن الوراثة عبر القرابة[xxiii]، فالتأكيد على سياق التشريع القرآني التاريخي حاسم تمامًا في الوصول لهذه المبادئ الناظمة.
لكن هنا نقطة مهمّة لا بد من التأكيد عليها، وهي أن هذه المجادلة لا بد أن تتم دومًا بالإضافة للعمل على المفاهيم العقدية التشريعية كمجالات مفاهيمية تمثّل نواة لمفاهيم تشريعية واجتماعية، أيْ إن ثمّة هنا اشتغال مزدوج بين العمل على مستوى المفاهيم العقَدية والسير منها إلى التشريعات، والعمل العكسي من التشريعات وإلى المبادئ الناظمة؛ وهذا لأن (فضلًا) لا يأمن كثيرًا لما يسميه «فوضى أسباب النزول» كمصدر لكشف مبررات التشريع القرآني، فيرى أن الأجيال الأولى ربما لم تهتم كثيرًا للتسجيل الحرفي لسببِ كلِّ آية، وللواقعة التي تسببت في نزول تشريعٍ ما؛ لذا فربما كانت هذه الأسباب التي تُذكر كأسباب نزول هي تفسيرات وتخمينات من اللاحقين، مما يقلّل من إمكان الأمن لها، لكنه في ذات الوقت لا يرى في هذا إشكالًا كبيرًا، حيث إنّ القرآن وإنْ كان لا يذكر السبب أو الواقعة الجزئية إلَّا أنه يشير مع هذا لمبررات تشريعِهِ[xxiv]، خصوصًا مع الانتباه لمفاهيمه ومسائله الكبرى كمفاهيم عقَدية تشريعية، مما يساعد على بلورة هذه المبادئ العامة الناظمة للتشريعات الإسلامية، والتي سنعود بها -في الحركة الثانية من تأويلية فضل- لواقعنا؛ من أجل أن نستنبط منها حلولًا لمشكلات وضعيتنا الاجتماعية الخاصّة.
إذن فنحن أمام منهجية شديدة التركيب، فهي منهجية منطلقاتها «الوصول للوحدة القرآنية»، «إمكان تحديد المرتكزات»، وهدفها هو «استعادة حيوية وفعالية القرآن»، وهي عبارة عن حركة مزدوجة من الوضعية الراهنة إلى القرآن، ومن القرآن إلى الوضعية الراهنة.
وفي الحركة الأولى للبحث عن الوحدة القرآنية فإنها تستخدم تقنية مزدوجة (مفاهيمية تاريخية) لتحديد المرتكزات، وفي كشف الوحدة وعلاقات المرتكزات تُطوِّر منهجية إيزوتسو عن المجال الدلالي و(المعنى الأصلي)، و(المعنى العلاقي)، ثم تُدخِل هذا التحديد لمرتكزات (عقَدية أخلاقية تشريعية) في إطار منهجية مزدوجة أدقّ تنطلق من المفاهيم العقَدية إلى التشريع، ومن التشريع لتحديد مبادئه العامة الناظمة لعقلانيته التشريعية.
وفي الحركة الثانية ومن أجل تشخيص الوضعية الراهنة من أجل الوصول من المبادئ والمرتكزات التي تم التوصل لها في الحركة الأولى إلى حلول جزئية يفترض فضل تضافر جهود علماء اجتماع وتاريخ وأخلاق وتأويلية جماعية.
ويمكننا توضيح هذا برسم مبسط:
القرآن والإسلام وروحية الأخلاق:
إنّ هذه العودة للإسلام لاستلهام نظامه الأخلاقي والتشريعي تنطلق من رؤية لفضل حول المجتمعات المعاصرة ومدى فعالية الأخلاق فيها، ومدى حاجة الإنسان المعاصر لتفسير أخلاقي مُتأسِّس على نظرة روحية للكون؛ لهذا فنحن نجد سيطرةً كبيرةً لهذا البُعد الأخلاقي على مقاربة فضل للقرآن حتى إنه يتحوّل لمنظور يُحدِّد إطار التعامل مع القرآن ومفاهيمه ومرتكزاته، ونحن في هذا الجزء الأخير من المقال نحاول أن نتساءل حول مدى تأثير هذا المنظور على تشكيل تأويلية فضل وإعطائها ملامح منهجية خاصة، كما نتساءل بأيّ حال كان هذا المنظور ذاته متوائمًا مع منطق القرآن الداخلي الذي يدافع عنه المفكر الباكستاني طوال خطابه.
فمبدئيًّا نحن نرى الأثر الواضح لهذا المنظور على الشكل الذي يتصور به فضل مرتكزات الإسلام من جهة، وعلى المصدر الذي ينطلق منه فضل لبحث مرتكزات الإسلام هذه من جهة أخرى، وهما جهتان متداخلتان، ففضل ينطلق في مقاربته من مطابقة ما بين الإسلام والقرآن، وهي مطابقة ليست بهذا القدر الذي يبدو من البداهة[12]، بالعكس، فهذه المطابقة مُشكِلَة للغاية؛ هذا لأن مرتكزات الإسلام تتضح في الشعائر وفي القصص بقدر ما تتضح في النصوص القرآنية الكلية، مما يجعل الاقتصار على هذه الأخيرة غير كُفءٍ من الناحية المنهجية في كشف هذه المرتكزات، بل لعلّنا نلاحظ هنا كيف أن عزل الشعائر والقصص عن كونها مصدرًا رئيسًا لفهم الإسلام يعمل على إعادة تشكيل القرآن نفسه، حيث يتحول لكتاب منطق نبحث فيه عن قواعد ومبادئ عامة، ومفاهيم تتعالق وتترابط، فهذه هي الصورة التي يتصور فضل بناء عليها مرتكزات الإسلام (مفاهيم عقدية تشريعية ومبادئ ناظمة لتجارب سلوكية)، في تناسٍ لطبيعة كونه قولًا دينيًّا، بما يعنيه هذا من انفتاح أصيل على الأبعاد الشعائرية والسردية التي تعطي القرآن سماته كذِكْرٍ ونداء وحضور إلهي دائم عبر الكلمة، هذه الجوانب تقلّ وتخفت كثيرًا حين يتم الاقتصار على التعامل مع القرآن كنظام لمسائل ومفاهيم عقدية أخلاقية.
وظنُّنا أن الانتباه لهذه العلاقات والتي تغير تصورنا للقرآن، وكذلك الانتباه للشعائر والقصص ودورها كمساحات أساسية لفهم الإسلام، وتناولها بالدرس، ينطوي على ما هو أهم وأكثر عمقًا وجذرية من استنباط نظام أخلاقي من مفاهيم عقدية أو من نصوص تشريعية كلية، حيث يقوم بدلًا عن هذا بالكشف عن أخلاقية الكون الإسلامي أو «العالم الذي يؤسسه الإسلام»[13]، والمُتبدِّية في كلّ مساحاته، وهذا حتمًا يغير نظرنا لعملية تثوير الإسلام حتى في المسألة الأخلاقية، حيث لا يتم هذا التثوير فحسب بتقديم تأويلية للقرآن كما يفترض فضل، بل بتقديم تأويلية للدين في كلّ مساحاته ومنها الشعائر التي هي وسيلة صرف قيم الإسلام في العالم اليومي والاجتماعي[14].
ونحن نستطيع أن نضرب على الأقل مثالًا واحدًا على هذه الأهمية للعمل على الشعائر الإسلامية من أجْل كشف مرتكزات الإسلام وخصوصًا في الجانب الأخلاقي، ويمكننا هنا الانطلاق من مسألة اشتغل عليها فضل الرحمن بالفعل، ألا وهي (الطبيعة)؛ حتى لا نسير بعيدًا عن اشتغال فضل، وسنقوم بقراءتنا هذه في (الطبيعة) مستلهمين منهجية إيزوتسو ومساحاتها الجديدة التي فتحها لها فضل، محاولين الإضافة قليلًا، عبر نقل منهج (إيزوتسو/فضل الرحمن) لمساحة جديدة هي مساحة علم الأديان العام.
فكما قلنا بالأعلى فإنّ (فضلًا) يربط الطبيعة بمسألة (الحساب) كمسألة كبرى في القرآن، وظنُّنا أن دراسة الطبيعة في الإسلام تكشف عن ما هو أعمق من هذا، وعن موقع -ربما- أكثر حسمًا في بناء الإسلام لعالمه؛ فمبدئيًّا -وحتى في مستوى القرآن- فإنه لا يمكننا اعتبار الطبيعة مرتبطة بمفهوم الحساب وحده إلا لو اقتصرنا على الظهور الأوليّ للطبيعة في القرآن، أي الآيات المكّية الأولى ذات الطابع الأبوكاليبسي، في حين للطبيعة ظهور أكثر استمرارًا في القرآن يُدخِلها في سياقات أخرى غير سياق الإعلان عن عدم أبَديتها، خصوصًا سياق ارتهانها التام لله، وهذا يربطها بـ(التوحيد)، وتحديدًا (توحيد المفارقة).
هذه العلاقة بين (التوحيد) و(الطبيعة) تعطي هذه الأخيرة أهمية كبيرة، كذلك فإنه ومن نفس منظور فضل عن مزاوجة التحليل المفهومي والتاريخي لتحديد المسائل الكبرى، فإنّ الطبيعة تصبح (مسألة كبرى) حيث إن الطبيعة وارتهانها التام لله هي -أيضًا- مسألة عارضها الجاهليون كمعارضتهم للتوحيد وللوحي وللآخرة، حيث هي على الضد -تمامًا- من الموقع الذي يعطيه الدين الجاهلي للطبيعة؛ فالطبيعة في الجاهلية مُؤلَّهة، وتحليل الوضعية التاريخية كما تُصِر منهجية فضل، تكشف عن كون الدين الجاهلي دينًا توجد الطبيعة المُؤلَّهة في مركزه، وهذه المركزية تتبدَّى في الشعائر الجاهلية، في طقوس الإفاضة وفي طقوس الاستمطار على سبيل المثال[15]؛ ولكون الشعائر هي أمرٌ حاسمٌ، فالجسد «ديني بامتياز»، حيث هو وعبر الشعائر مَن يعيد خلق العوالم القدسية التي تم رسمها في المعتقد، ويقوم بهذا بجَسْدَنة هذه القيم والانتقال بها من الشعائري، للثقافي، لليومي؛ فإن مواجهة الإسلام لهذه المركَزَة للطبيعة[16]، وكما تمت بالقرآن، تمت كذلك شعائريًّا بإدانة القرآن لكثير من الشعائر الجاهلية، وبتغيير القرآن للزمان المقدّس (عدم الصلاة مع طلوع الشمس على سبيل المثال)، وبتشريع شعائر، مثل: الصلاة/القيام، والركوع، والسجود؛ وهي التي تجعل الإنسان منتصبًا فوق الطبيعة، فلا يحاكيها ولا يماثلها رمزيًّا بشعائره، بالعكس، فالطبيعة هي التي تماثل الإنسان، فهي التي تسجد كالإنسان وتسبح لله الذي هو مفارق ومتعالٍ.
ولعلّ كلّ هذا يوضح لنا تمامًا كيف أن تحليل الشعائر الإسلامية مساحة شديدة الأهمية لاكتشاف مرتكزات غابت تمامًا عن مقاربة فضل.
كذلك، فالشعائر الإسلامية في مجملها تكشف عن مركزية العدل كأساس للنظام الأخلاقي في هذا العالم الذي يبنيه الإسلام، كما يشير الحكيم الترمذي في (إثبات العلل) في حديثه عن علة فرض الأعمال: «وأما علة الأعمال، فإنهم لما عرفوه قلبًا، واعترفوا به نطقًا،... اقتضاهم الوفاء بها، وهي الأعمال، فلو لم يدْعُهم إلى عمل الأركان، وقدِموا عليه يوم القيامة ما كان لهم محلّ. ومنهم من اعترف باللسان وهو منافق، ومنهم من اعترف وعرف بقلبه، ثم زاغ ببعض الأهواء،... فمتى كان يظهر عند الجمع من الملائكة والرسل وجنود ربك يومئذ في تلك العرصة شأن أهل الثواب والعقاب؟! وكانوا لا يرون من ربهم شيئًا إلا أن يأمر بواحد إلى الجنة، وبواحد إلى النار،... ومتى كان يظهر قوله: {إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ}، حين قال للملائكة: {إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً}[البقرة: 30][xxv]، فالمسلم حين يمارس الشعائر يستعيد هذه الصورة لكامل السردية الدينية والتي يقع في قلبها (مشهدة) مفهوم العدل، ولعلّ هذا يتماشى كثيرًا مع حديث فضل عن الآخرة كانكشاف وجلاء للأسرار وظهور للحقيقة في العالم اليومي، عبر وصول التقوى لمرحلة «الوعي الآخري» الذي تحدثنا عنه بالأعلى، فالشعائر -وفقًا لهذا التعليل من الترمذي- حاسمة تمامًا في زيادة هذه الحساسية وتكوين «الوعي الآخري» الذي يعتبره فضل حاسمًا في الأخلاقية.
ونحن لا نرى أنّ الاقتصارَ على القرآن في محاولة الوصول لمرتكزات الإسلام، وإهمالَ مساحات الشعائر والسرد -أمرٌ مقتصر على فضل، بل ربما هو مسيطر على كلّ المقاربة الحداثية للقرآن، بل دعْنا نقول على (المقاربة الحديثة) لو استعرنا كلمات طه عبد الرحمن عن (آفة التجريد)[17]، لكن وبما أننا نتناول هنا القراءة الحداثية، فعلينا الإشارة للعلاقة بين رهانات ومنطلقات هذه القراءة وبين هذا الاقتصار على القرآن وإهمال المساحات الأخرى.
فكما قلنا سابقًا، فإن هذه القراءة تحاول تكريس الحداثة جوانيًّا عبر اقتحام آليات العقل المعرفي العربي والذي تُشكِّل أدوات مقاربة القرآن مركز التأسيس له، هذا بالطبع يجعل الاتجاه لمقاربة (القرآن) هو الأغلب، فضلًا عن أن سيطرة البُعد التقليصي والاختزالي على أغلب هذه المقاربات يجعلها تتبنى مقاربات منهجية لا تنظر للشعائر وللسرد كأجزاء رئيسة في البنية الدينية بل تنظر لها على اعتبارها ذات وظائف ضبطية ونفسانية وتخيلية/وهمية، وبالتالي لا تحاول التداخل معها لتحليلها[18].
وبالطبع فهناك أسباب ترجع -ربما- لكلّ خطاب من خطابات هؤلاء المفكرين على حِدَة؛ فمثلًا خطاب نصر وبسبب من مدخله الألسني ضيِّقِ الأفق قليلًا، والمتخشب بحيث لا يتحرك في مساحات أوسع، حتى تلك المساحات التي تفتحها الألسنيات ذاتها؛ يجعله مقتصرًا على التعامل مع القرآن كنصّ لغوي، وبالنسبة لفضل الرحمن فإن سيطرة همِّ البحث عن نظام تشريعي وأخلاقي انطلاقًا من تشخيص الإشكال بغياب الأخلاقية، ومن إيلاء الاهتمام الأكبر للنظام التربوي كان له أثره -كما قلنا- على النظر للإسلام كقرآن، وللقرآن كمنظومة نسقية.
* * *
الطريف أنّ (فضلًا) بمحاولته تأسيس أخلاقية معاصرة عبر استلهام النصّ القرآني كان يُصِرّ على كون التأسيس الذي قامت به الحداثة الأوروبية لمبادئ الحرية والمساواة هو تأسيس لا يمكن له الانغراس واقعيًّا بصورة كبيرة، حيث إن المنطق وحده لا يستطيع إشعال نار قناعة حيّة، بينما الوحي يستطيع هذا، إلا أن الوحي ذاته تحوَّل على يد فضل لمفهوم وتحولت فعاليته المنشودة لفعالية مفهومية ونسقية مُحتاجة لعُدّةٍ منهجية شديدة التركيب النظري من أجل الوصول لها! مما يجعلنا نتساءل أيّ مصير لهذه الأخلاقية المُتأسِّسة على هذه الرؤية؟! وأيّة قدرة لها على الانغراس في الواقع؟!
[1] ذكرنا في أول مقال (المداخل العامة) أننا سنحاول تصنيف القراءات الحديثة والمعاصرة للقرآن انطلاقًا من معيار الصلة بالتقليد، كمعيار منهجي مستقل عن رؤانا الذاتية حول (النهوض) و(الإصلاح) حيث يرتبط بواقعة صلبة، هي واقعة تعرّض المدونات التقليدية الإسلامية للاهتزاز في قيمتها المرجعية نتيجة صدمة الحداثة؛ مما أحدث مسافة مع هذا التقليد بأطره المفاهيمية وطرائقه المنهجية.
لمراجعة المقال على هذا الرابط: tafsir.net/article/5079.
[2] يشير فضل لهذا المشروع في مقدمة كتابه (الإسلام وضرورة التحديث)، حيث جاءت دراسته هذه في ضوء مشروع بحث قامت به جامعة شيكاغو وموَّلته (مؤسسة فورد للتربية الإسلامية)، والذي صُمِّم في إطار مشروع أوسع حول (الإسلام والتغيير الاجتماعي)، وقد سبقه اشتغال لــ(فضل) على نفس المشروع مع رئيس باكستان الجنرال محمد أيوب خان، قدّم من خلاله مجموعة من الرؤى والتوصيات التي لم تُقبل حينها. انظر: الإسلام وضرورة التحديث، ص9، والإسلام والحداثة من خلال كتابات المفكر الإسلامي الحداثي فضل الرحمن مالك، دونلد بيري، ترجمة: ميرنا معلوف ونسرين ناضر، الشبكة العربية للأبحاث، بيروت، ط1، 2013، ص38.
[3] يرى نصر أبو زيد وعلي مبروك -مثلًا- كون التجاور كسِمَة بنيوية في الخطاب الإصلاحي العربي المعاصر سببه هو سيطرة آلية التفكير بـ(الأصل) على هذا الخطاب، فهذا التفكير هو الذي يجرد الأنظومات الفكرية والنصوص من سياقاتها الاجتماعية والثقافية؛ مما يجعلها تتجاور في العقل الذي يفكر بها سكونيًّا دون إمكان أيّ تفاعل بينها، بهذا يتجاور القرآن كأصل مستعصٍ على الدرس العلمي لجوار منتجات الفكر والعلم الغربي معزولة عن سياقات نشأتها، وهذا ما يعتبره علي مبروك سياسوية الخطاب، والذي يجاوب التجاور الواقعي بين مؤسسات تقليدية ومؤسسات حديثة والناتج عن تحديث سياسوي براني منشغل بقطف الثمرة لا تهيئة التربة. انظر: ثورات العرب خطاب التأسيس، علي مبروك، ص46، أما صلة التجاور والتلفيق بالتفكير بالأصل فقد تناولناه تفصيلًا في مقالاتنا عن نصر.
[4] مثلًا قراءة آيات السحر والجنّ والشياطين في ضوء بعضها، أو قراءة آيات المواريث في ضوء آيات المساواة، (نصر أبو زيد)، أو قراءة آيات الجنسانية في ضوء بعضٍ، (الشرفي)، ورغم أن نصر وكما ذكرنا في مقال «نصر أبو زيد وطبيعة القول القرآني، ثالثًا: القرآن من (النص) إلى (الخطاب)» كان يحاول تأسيس المساواة بين الذكر والأنثى في التشريعات الاجتماعية على المساواة في التعبد، إلا أن هذا كان في مرحلة النصّ كخطابات والتي ترفض وجود مركز دلالي يوحّد دلالات النصّ، كما أنها كانت محض ملاحظة لم تتحول لدرس واضح المعالم حول المبادئ العقدية والتعبدية التي سيتأسس عليها الجانب التشريعي، وكذلك حديثه في تأسيسه للمقاصد الجديدة عن ضرورة توسعة كلية النصّ القرآني لتشمل القصص، وهو ما لم نَرَ له تطبيقًا فعليًّا بسبب طبيعة ورقته الاقتراحية كما يقول، كما لم نجده في اشتغاله على آيات المواريث في (نقد الخطاب الديني).
لمراجعة المقال على هذا الرابط: tafsir.net/article/5107.
[5] كما يتضح في أكثر من موضع، فإنّ (فضلًا) يميل إلى صحة «قصة الغرانيق»، ويعتبر أن النبي قد تردّد وتنازل للقرشيين بالسماح بعبادة آلهتهم بجوار عبادة الله كنوع من «تسويات حول بعض المسائل الرئيسة» كان مدفوعًا إليها «في خضمِّ جدلية جوانية يحياها محمد بين إرادة تقضي بتسوية وإرادة حاسمة وحازمة»، ونظن -ودون الدخول في تفاصيل القراءة التاريخية للقصة- أن منهج فضل نفسه يعارض قبول هذه القصة على اعتبار أنها تنازُل مقدَّم للقرشيين؛ فالتوحيد كمبدأ قرآني لم يكن ممكنًا التراجع عنه في أيّ لحظة من مبدأ الدعوة لنهايتها، حيث هو ما يعطيها ماهيتها كالمفهوم المركز على الإطلاق، لكنه تهيكل في مواجهة الواقع القرشي وفي مقابل الوضعية القرشية الخاصّة التي كانت تواجه القرآن، فحين تم عرض هذا المبدأ المركز (التوحيد) حاول القرشيون -انطلاقًا مما يسميه إسمان بمبدأ (إمكان الترجمة) المُميِّز للديانة الشركية، والذي يعطيها القدرة على دمج الآلهة في منظومتها الدينية- استيعاب الإله الجديد في منظومتهم دون تغيير حاسم فيها، وهنا تحديدًا جاء رفض القرآن حاسمًا لتأكيد وإبراز مقصوده المُحدَّد بالتوحيد كإفراد الإله المستحق بالعبادة وحده، بوصف هذه الآلهة بكونها مجرد أسماء فارغة وأن الله هو وحده الإله الحق، مما يعني نفي (إمكانية الترجمة)؛ لذا فربما التحليل الأدق لهذه القصة -وهو كما يقول جعيط- أن القرشيين هم من عرضوا مساومةً لا النبي، وأن القرآن جاء حاسمًا تجاه هذه المساومة؛ انطلاقًا من مركزية التوحيد بمعناه الإبراهيمي أيْ وجود إله واحد حقّ، فأبرز القرآن سمات توحيده الخاصّ هذه عبر إلغاء (إمكانية الترجمة) معلنًا أن الله لا سميّ له ولا كُفُؤ له وهو محيط وواحد بلا تجزئة أو انقسام أو إمكان الذوبان في إله آخر أو أن يُعْبَدَ إلى جواره أحد.
انظر: الإسلام وضرورة التحديث، ص30، وانظر: التمييز الموسوي أو ثمن التوحيدية، يان إسمان، ترجمة: حسام الحيدري، منشورات دار الجمل، كولونيا، ألمانيا، ط1، 2006م، ص27، 28، 28، وانظر: تاريخية الدعوة المحمدية في مكة، هشام جعيط، دار الطليعة، ط1، 2007م، ص280، وربما من المفيد الاطلاع على الفصل بتمامه والمعنون بـ(قصة الغرانيق وضبط مسار الأحداث).
[6] يرى الحاج سالم «أن الديانة الجاهلية هي (توحيد من نوع الهينوثييزم)، وهي نوع معيَّن من التوحيد، يتم فيه الإيمان بإله أعلى خالق ومدبر، مع الإيمان بآلهة أخرى، ويوجد فيه إلى جانب الآلهة الصغيرة للقبائل العربية ثالوث نجمي رئيس هو الشمس والقمر والزهرة، لم تكن المعبودات العربية القبلية -مثل اللّات، ومَناة، والعُزَّى- سوى تنويعات ترمز له». من الميْسِر الجاهلي إلى الزكاة الإسلامية، محمد الحاج سالم، دار المدار الإسلامي، ط1، 2014م، ص357.
[7] أشار فضل الرحمن في (المسائل الكبرى) لأهمية عمل إيزوتسو ونصح بقراءاته رغم خلافه معه في بعض المسائل، وكان فضل الرحمن قد كتب دراسة أو مراجعة لكتاب إيزوتسو، وهي منشورة في الترجمة العربية لكتاب إيزوتسو، تحدّث فيها عن بعض اعتراضاته هذه على إيزوتسو، وربما أهمّها هي حديثه عن أهمية استخدام المنهج التاريخي، وفعالية التنبّه للسياق التاريخي القرشي في التعامل مع المفاهيم الإسلامية بصورة تتفوق كثيرًا على المنهج الدلالي. انظر: الله والإنسان في القرآن، ص 23، وانظر: المسائل الكبرى في القرآن، فضل الرحمن مالك، ترجمة: محمد أعفيف، دار جداول، ط1، 2013م، ص19.
[8] ينطلق إيزوتسو في دراسته للمفاهيم المركزية في القرآن، أو لـ«الكلمات المفتاحية» بتعبيره المتناسب مع مدخله الألسني، من تقسيم المعجم العربي إلى ثلاثة سطوح دلالية: السطح الدلالي الجاهلي، والسطح الدلالي القرآني، والسطح الدلالي اللاحق للقرآن، (العصر العباسي خاصّة والذي ابتدأ فيه تدوين العلوم)، والمقصود بالسطح عنده هو اصطناع حالة سكونية في مسيرة تطور الكلمات تاريخيًّا بغرض منهجي هو دراستها (سانكرونيًّا) أو (آنيًّا)، ولهذا أثرٌ كبيرٌ على فهم التغييرات الدلالية التي أدخلها كلّ سطح من هذه السطوح الثلاثة على المفاهيم من حيث دلالتها، ومن حيث موقعها في (الحقول الدلالية)، ومن حيث إعادة تحديد الكلمات المفتاحية لرؤية العالم.
ومن الميزات الرئيسة لاشتغال إيزوتسو هو اشتغاله على كلّ مفهوم من هذه المفاهيم بتأكيده على وجود نوعين من الدلالة: دلالة يأخذها المفهوم من معناه الأساس، وأخرى من معناه العلائقي المرتبط بموقعه في حقل مفاهيمي ما؛ وبالتالي تصبح عملية تحديد الحقول المفاهيمية وتحديد علائق المفاهيم ببعضها مسألة حاسمة وأساسية في عمل إيزوتسو على القرآن، ونحن نظنّ أن هذا الاشتغال أثَّر كثيرًا على فضل الرحمن مع تطويرٍ كبيرٍ من هذا الأخير.
(الله والإنسان في القرآن، علم دلالة الرؤية القرآنية)، توشيهيكو إيزوتسو، ترجمة: هلال محمد الجهاد، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، ط1، 2007م، ص72، 73.
[9] يشير إيزوتسو أن اختياره الكلمات المفتاحية قد يتضمن قدرًا من الاعتباطية، فمثلًا لفظة (عرش) وردت في أكثر من عشرة مواضع في القرآن، ولها أهمية كبيرة في الكلام والتصوف الإسلامي، إلَّا إنها لا تمثّل مفهومًا محوريًّا في القرآن إلا بعد مناقشة، على عكس تصورات: الله، والكفر، والهداية مثلًا؛ هذه الملحوظة توضح محدودية المدخل الدلالي وحده في الوصول لمفاهيم القرآن المركزية. انظر: الله والإنسان في القرآن، ص53.
[10] في كتابها (الموت وطقوسه) تورد رجاء بن سلامة رأيًا لافتًا عن كون مفردة: (الوفاة)، هي مفردة قرآنية لم توجد إلا مع القرآن، كذلك ما يماثلها كـ(لقاء الله)، (الجود بالنفس إلى الله)، (اللحاق بالرفيق) وهذا -لا شك- يرتبط بتغير في مفهوم الموت؛ حيث لم يعد مجرد مفارقة الروح للبدن بل أصبح عودة ورُجعى ووفاةً؛ نتيجة اختلاف المنظور العقدي الإسلامي عن المنظور العقدي الجاهلي في تصوره للروح، كما يقول محمد عبد السلام. رجاء بن سلامة، الموت وطقوسه من خلال صحيحي البخاري ومسلم، دار رؤية، ط2، 2009م، ص62، ص71.
[11] يقيم فضل حجاجه على مسألة البعث الجسدي في مواجهة الآراء الفلسفية الإسلامية النافية له على أساس كون مفهوم النفس في الاستخدام القرآني تشمل الروح والجسد كليهما، و(الشخص)، و(داخلية الشخص)، فليس ثمة هذا الانفصال بين الجسد والروح والذي تبلور لاحقًا في الفلسفة. انظر: المسائل الكبرى في القرآن الكريم، ص224.
[12] هذا التعامل مع الأمر وكأنه بداهة نراه بوضوح في نصّ لنصر أبو زيد في تقديمه لكتابه (مفهوم النصّ)، حيث يقول في تبرير اختيار المنهج اللغوي، أن اختيار هذا المنهج، ليس اختيارًا عشوائيًّا، «بل إنه المنهج الوحيد الممكن من حيث تلاؤمه مع موضوع الدرس ومادته، فموضوع الدرس هو الإسلام، ولا خلاف بين علماء الأمة -على اختلاف مناهجهم قديمًا وحديثًا- أن القرآن يقوم على أصلين، هما: القرآن والسنة»، هذا التعامل في ظنّنا مُستغرَب تمامًا؛ فلا يوجد بالتأكيد أحد يتفق على عدم الاهتمام لمساحات الشعائر والسرد كمساحات أساس في درس (الإسلام)، وإن كان لهذا التغييب لهذه المساحات عن بؤرة الاهتمام سواء قديمًا أو حديثًا -بالأخصّ حديثًا- أسباب يطول شرحها ويخرج بنا -ربما- عن موضوع مقالنا. انظر: مفهوم النص، نصر أبو زيد، ص29.
[13] كما يرى إلياد فإن الأديان تقوم بـ«إعادة تأسيس العالم»، بنقله من العادية إلى تقديس بعض مساحاته مكانيًّا وزمانيًّا كمساحات تجلي للمقدس، وهي عملية يقوم بها الدين في كلّ أوجه بنيته: (المعتقد- السرد- الشعائر)، وإن كان للشعائر في هذا التأسيس -دومًا- الدور الأكبر وخصوصًا في صِلاتها بالسرد، حيث الشعائر أو النظام الشعائري بتعبير أشمل، هي التي تقوم بتكريس الأزمنة والأمكنة المقدّسة والتي تحمل ملامح المقدّس الخاصة في كلّ دين وتحدث هذا الانقطاع في عادية وتجانس الزمان والمكان؛ مما يجعل لها الدور الأكبر في تأسيس العالم الديني. انظر: المقدس والعادي، مرسيا إلياد، ترجمة: عادل العوا، دار التنوير، 2009م، ص60.
[14] تقوم الشعائر أو النظام الشعائري (الشعائر- الزمان المقدس- المكان المقدس- الأعياد) بمهمّة تحيين العوالم القدسية؛ لذا يعتبرها كايو (المقدّس معيشًا)، فهي التي تضمن للمعتقد أن يُجَسْدَن، أيْ: أن ينطبع على الجسد كـ«جسد في العالم»، فيصرف قيم المقدس المنبثّة في العبادات «الجسد اليومي الديني» أو «الجسد العبادي» في «الجسد اليومي الاجتماعي»، «فيكمل الشعائر المتصلة بالعبادات ويؤطرها بحركات معينة للجلوس والأكل والنظر ودخول الحمّام». انظر: الجسد والمقدس والصورة في الإسلام، فريد الزاهي، أفريقيا الشرق، بيروت، 1999م، ص40.
[15] لتحليل معمق لعلاقة الطقوس الجاهلية بالديانة النجمية وتأليه الطبيعة، انظر: الحاج سالم، من الميسر الجاهلي إلى الزكاة الإسلامية.
[16] يشير إسمان لفكرة مهمة تستحق التأمل، وهي علاقة التوحيد بالشرك من جهة، وبديانة الطبيعة من جهة أخرى، فيرى أن العدو الأكبر للتوحيد ليس الشرك بل عبادة الطبيعة؛ وهذا لأن الشرك الخالص -وفقًا له- لم يوجد؛ فأعتى الشركيات كانت تقرّ بوجود إله متعالٍ تدعوه في الملمّات، كما أن كثيرًا من مراحل التوحيد شابها الشرك، بل إنه يرى أنه باستثناء الإسلام في بعض مراحلة فإن التوحيد الصارم لم يوجد، أما بالنسبة لديانة الطبيعة فهي شديدة الخلاف مع التوحيد، ويعتبر أن تحريم الصور يعني فيما يعنيه رفض تأليه الطبيعة. انظر: التمييز الموسوي أو ثمن التوحيدية، ص57، 91.
[17] يعلّق طه عبد الرحمن على المدرسة السلفية الإصلاحية بدءًا من محمد عبده، بكونها يسيطر عليها آفة التجريد، ويعني بها «إفراد العقل النظري بالقدرة على التأمل في النصوص، على اعتبار أن قيمة هذه النصوص تنحصر في الأفكار والتصورات التي تُنال بهذا التأمل»، وهذه سمة غالبة ربما على الفكر العربي المعاصر في تعامله مع كلّ النصوص، وخصوصًا القرآن. انظر: العمل الديني وتجديد العقل، طه عبد الرحمن، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط2، 1997م، ص99.
[18] انظر: مقال (عبد المجيد الشرفي وتحديث الإسلام)، على هذا الرابط: tafsir.net/article/5116.
[i] الإسلام وضرورة التحديث، فضل الرحمن مالك، ترجمة: إبراهيم العريس، دار الساقي، بيروت، ط1، 1993م، ص197.
[ii] نفسه، ص192، 193.
[v] نفسه، ص42.
[vi] نفسه، ص12.
[vii] نفسه، ص25.
[viii] نفسه، س27.
[ix] نفسه، ص57.
[x] نفسه، ص17.
[xi] نفسه، ص 22.
[xii] نفسه، ص42.
[xiii] نفسه، ص 211، 212.
[xiv] نفسه، ص 17.
[xv] نفسه، ص39.
[xvi] فراس السواح، الشيطان والرحمن، منشورات دار علاء الدين، 2000م، ص12.
[xvii] هشام جعيط، في السيرة النبوية -2- (تاريخية الدعوة المحمدية في مكة)، دار الطليعة، ط1، 2007م، ص167.
[xviii] المسائل الكبرى في القرآن، فضل الرحمن مالك، ترجمة: محمد أعفيف، دار جداول، بيروت، ط1، 2013م، ص168.
[xix] المسائل الكبرى في القرآن، ص230.
[xx] الإسلام وضرورة التحديث، ص10.
[xxi] المسائل الكبرى في القرآن، ص237.
[xxii] الإسلام وضرورة التحديث، ص33.
[xxiii] نفسه، نفس الصفحة.
[xxiv] نفسه، ص 32.
[xxv] إثبات العلل، الحكيم الترمذي، تحقيق: خالد زهري، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، سلسة نصوص ووثائق، رقم 2، الرباط، ط1، 1998م، ص82، 83.
كلمات مفتاحية
الكاتب:

طارق محمد حجي
باحث مصري له عدد من المقالات البحثية والأعمال المنشورة في مجال الدراسات القرآنية.
مواضيع ذات صلة
((المعلومات والآراء المقدَّمة هي للكتّاب، ولا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع أو أسرة مركز تفسير))