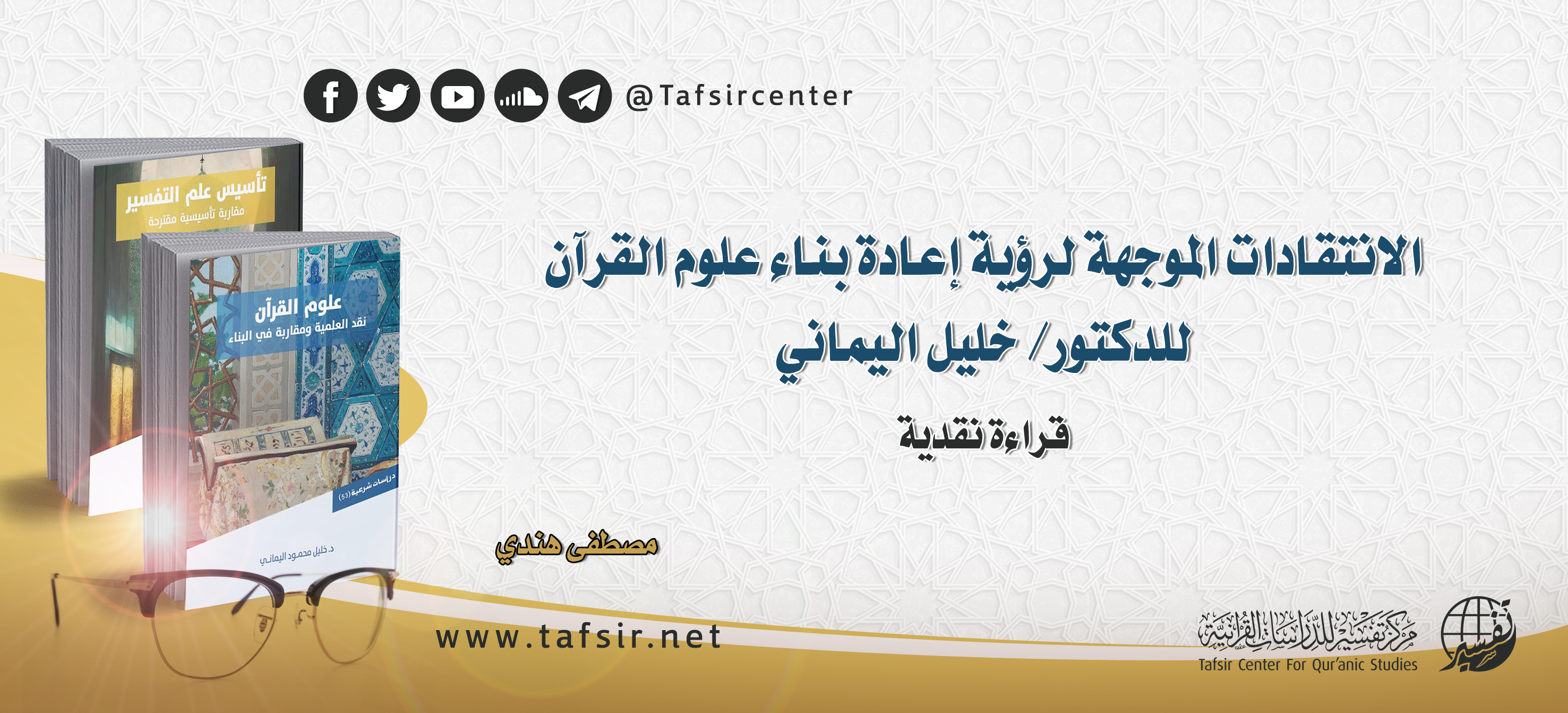نصر أبو زيد وطبيعة القول القرآني، ثالثًا: القرآن من «النص» إلى «الخطاب»
ثالثًا: القرآن من «النص» إلى «الخطاب».
الكاتب: طارق محمد حجي
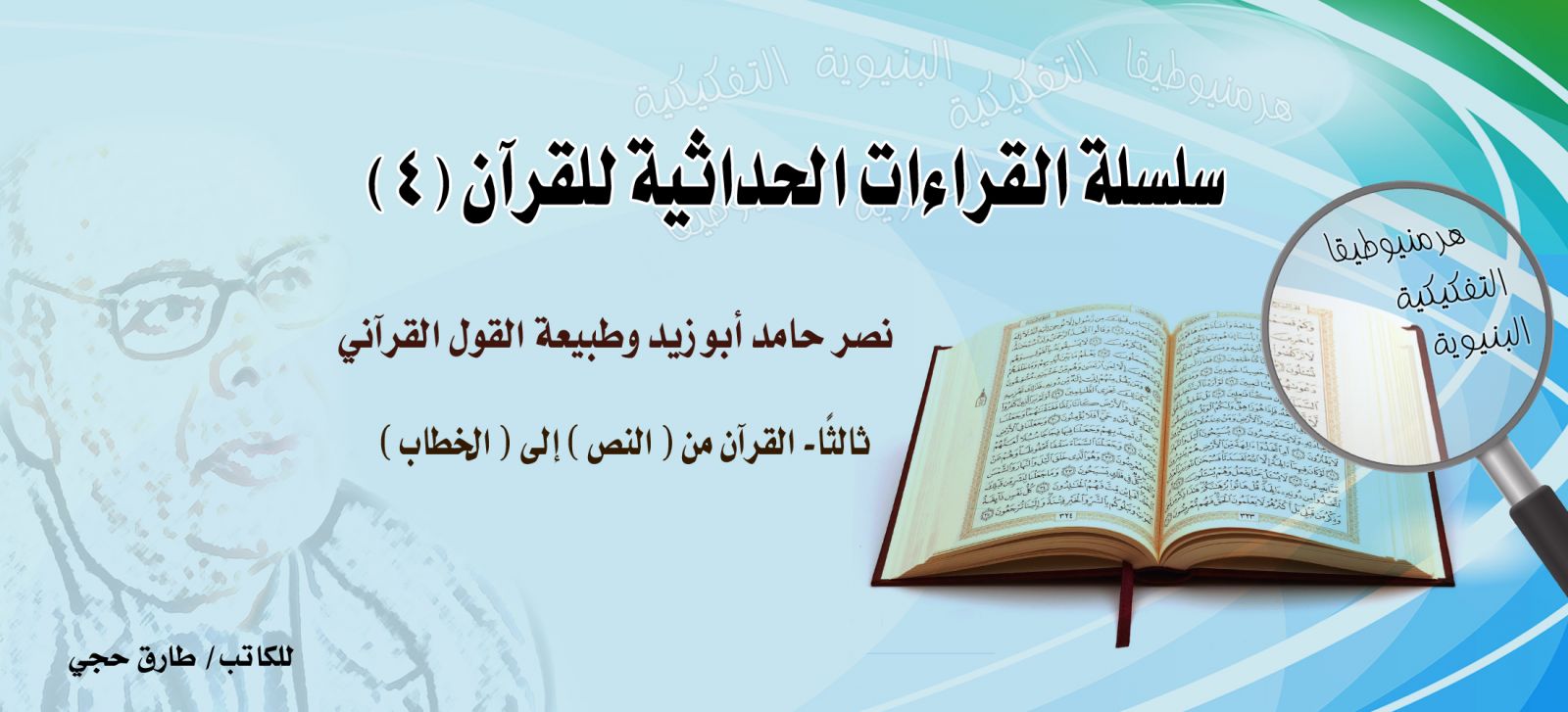
رغم تأخُّر خطاب نصر في الانتقال من التَّعاملِ مع القرآن كـ«نصٍّ» إلى التعامل معه كـ«خطاب»، إلا أنَّ هذه الخطوة في ظنِّنا كانت قادمة لا محالة، فهذا الانتقالُ ليس طارئًا على الخطاب ولا يُمثِّلُ من وجهة نظرنا تحولًا مجانيًّا أو ابتدائيًّا في مسيرته، بل بالأحرى هذا الانتقال بتغييره طبيعة القرآن لمجموعة من«الخطابات»، والتخلّص تمامًا من «نصيّة» القرآن بكلّ ما تعنيه وتستتبعه من وجود مركز دلالي يُوحِّد دلالات القرآن، ويجعله «بنيةً لُغوية تركيبية تتجاوز حدّ الآيات وسياقاتها»، وتمنحه «وقائعيّة» وحضورًا وحركة في مقابل «التاريخ قصير المدة، تاريخ عشيّة الدعوة» و«التاريخ اليومي، تاريخ الثلاثة وعشرين عامًا عمر الدعوة»، هو سيرُ خطاب نصر نحو الاتساق مع تصوّراته ومنطلقاته، التي تُحدِّد ملامح خطابه وتتماشى تمامًا مع خصوصية برنامجه للتاريخيّة.
وهو سيرٌ أصبح حتميًّا لإنقاذ الخطاب، خصوصًا بعد مرحلة تأزَّم فيها خطابُ نصر بسبب عدم الاتساق بين تصوُّر الخطاب للتاريخ «المفهوم المركز»كتاريخ ضيّق يتمثل في تاريخ قريش عشية الدعوة مُقلَّص الصلة بالإبراهيمية، بحيث لا تُمثِّل هذه الأخيرة جزءًا من معجم قريش «اللغوي»، والذي يقضي بغياب «وقائعية النصّ» من جهة، وبين رهانات الخطاب من جهة أخرى، والتي قضت بمحاولة إيجاد ما يمنحُ للقرآن وقائعية وحركة بالحديث عن مقاصد كليّة جديدة للنصِّ «العقلانية- الحرية- العدل-المساواة»،كمرتكزات للنصِّ يتمُّ استخراجها من القرآن عبرَ آلية تعتمد التسييق التاريخي، ولا تقتصرُ على الجدل اللغوي. وهو تأزُّم وصل -وكما قلنا في المقال السابق- حدَّ سقوط الخطاب في نفي منطلقه الأساس، أي قضية «الأرخنة»، بما هي (تغيير لطبيعة النص، وتنحيةٌ للإله من موقعه كمُحدِّد لعملية القراءة ومانح للمعنى)، والتي تُمثِّل الأساس لـ«القراءة الحداثية للقرآن»، فرغم دفاع نصر المتكرر عن هذا المنطلق إلا أنَّ ما انتهت إليه تأويلية نصر في الأخير بسبب عدم قدرة الخطاب على التماسك بين مفاهيمه ورهاناته ليس إلا إعادة الإلهي -هذا الذي كان إقصاؤه شرط قيام قراءة علمية للنصوص- كمُحدِّد في عملية القراءة، تلك التي تحوَّلت من عملية إنتاج للمعنى التاريخي من نصّ لا يَحْمِلُ دلالات مفارقة إلى بحث عن مقاصد القائل عبر جدل المعنى-المغزى، عادت تأويلية نصر بهذا لتكون بحثًا عن «المقصد الإلهي» على حسب الجهد كما هي عملية التأويل عند الأقدمين، بفارق وحيد، هو اشتراط «التسييق التاريخي» كجزء من خطة القارئ للوصول إلى «خطة المؤلف» المبثوثة في النصّ عبر آليات (المراعاة للسياق التاريخي والتحوير الدلالي) للكشف عن (مقاصد الوحي الفعلية)، ممَّا يجعلنا أمام «تلوين» حديث للتأويلية الكلاسيكية هو آخر ما كان يريده نصر لخطابه -الذي وللمفارقة- لم يترك خطابًا إلا وصفه بالتلفيقية والتلوين من محمد عبده إلى محمد شحرور مرورًا بحسن حنفي[1].
كلّ هذا التأزُّم أدَّى لضرورة تجاوز مرحلة «النص» في التعامل مع القرآن إلى مرحلة جديدة -وإن كانت ثاوية في منطق الخطاب، ربما منذ بدايته- هي مرحلة «الخطاب» أو «الخطابات»، بما تستتبعه من آليات تحليل مختلفة للقرآن، في محاولة تأسيس جديد لطبيعة القرآن تُحقِّق رهانات خطاب نصر، وتُحافظ على تماسك منطلقاته وعلى رأسها «القراءة العلمية للنصوص»، التي يُمثِّل تأسيسها أحد أهم ميزات خطاب نصر التي تعطيه موقعه على خارطة القراءة الحداثية للقرآن كما أسلفنا في المقال السابق.
لكنَّ هذه المهمّة التي يؤدِّيها هذا الانتقال في التَّعامل مع القرآن من «النص» إلى «الخطاب» بتجاوز أزمة الخطاب، وإعادة تأسيسه إن صحَّ التعبير، ليست وحدها ما يجعلنا نولِي هذه الانعطافة اهتمامًا كبيرًا في قراءتنا لخطاب نصر، بل ما يهمُّنا بصورة أكبر، هو ما أدَّت إليه هذه الانعطافة من بروز عددٍ كبيرٍ من المفاهيم الرئيسة في الخطاب، والتي كان حضورها في مرحلة الخطاب الأولى مُشوَّشًا وينقصه الكثير من التحديد والإجلاء، فقد عادت هذه المفاهيم لتَبرُز هنا بصورة أكثر جلاءً ووضوحًا كما ينبغي لموقعها في الخطاب، على رأس هذه المفاهيم مفهوم «سلطة النص» -المفهوم المقابل لمفهوم «تاريخية النصّ» أو المفهوم الضد له- وما يرتبط به من إشكالات على رأسها إشكال «وحدة القرآن» وإشكال «الآمرية الإلهية»، وهي إشكالات في غاية الأهمية كما سنوضِّحُ، حيث يُشكل نقاشها التكثيف الأكبر لرهانات خطاب نصر طوال تمرحلاته «رهان المعنى المتحرك» و«رهان تجاوز التلفيق»؛ مما يجعل تناولها بالتحليل أمرًا في غاية الأهمية لتعمق أكبر في خطاب نصر.
فنحن حين نعودُ للكتابات الأولى لنصر عن القرآن؛ أي «مفهوم النصّ» و«نقد الخطاب الديني» و«النص، السلطة، الحقيقة»، نَجِدُ هذا المفهوم مفهوم «سلطة النصوص»، مفهومًا لا يتعلقُ بالنصِّ ذاته، بقدر ما يتعلَّقُ بطريقة تلقِّي النصّ، لا نَقْصِدُ تلقيه تفسيريًّا، بل تلقيه في الأُطر الناظمة لطبيعة النصِّ، وهي أُطرٌ كلامية عقائدية بالأساس، فـ«سلطة النص» تنبعُ من كونه في طبيعته التي استقر عليها في الرأي الكلامي بأزليته، وباعتباره صفة ذات سابق في وجوده على القرن السابع الميلادي[i]، يحمل دلالات مفارقة للمجتمع والتاريخ، هذه الدلالات المفارقة والأزلية تُمثِّل سلطة على العقل وفقًا لنصر، فهي تُهدِرُ الواقع الذي تشكَّلت فيه النصوص فتُحوِّله هو والنصّ لأسطورة، وتهدرُ العقل الذي يتأسَّس عليه الوحي ذاته كسلطة أولى قد تُخطئ لكنَّها قادرة على تصويب ذاتها[ii]،كما تُحوِّلُ عملية فهم القرآن من عملية بشرية عقلية تتَّبِعُ قواعد تشكّل النصوص في التاريخ إلى (عملية تتطلَّبُ تدخل العناية الإلهية بوهب البشر طاقات خاصة تمكِّنهم من الفهم!)[iii][2]، في هذه المرحلة وبهذا التحديد لقضية «سلطة النص» يبدو وكأنَّ فعل «الأرخنة» بما هو تغيير طبيعة النص والتّعامل معه «كمُنتَج ثقافي»، والتَّعامل مع دلالاته كدلالات (لا تحملُ إطلاقيّة المطلق ولا قداسة الإله)[iv]، وبلورة آليات قراءة تَنْطَلِقُ من تاريخية المعنى ودور المؤوِّل في إنتاجه كأفق له وجزء منه، كافيًا تمامًا للتخلص من هذه «السلطة»، التي منحها التقليد الكلامي المُستَقِرّ للنصِّ، وأعاد إنتاجها الخطاب الديني المعاصر.
إلا أنَّ الأمرَ ليس بهذه البساطة؛ هذا لأنَّ هذا التحديد لـ«سلطة النص» ذاته يحمل قدرًا كبيرًا من التَشوُّش، فثمةَ إشكالٌ رئيس يتمُّ تجاهله هنا، وهو أنَّ «سلطة النصّ» ترتبط بالأساس بكونه نصًّا أيًّا كانت طبيعته أزليّة أم تاريخية، فالنصُّ بما هو (وحدة تركيبية تتجاوز أجزاءه) هو في ذاته سلطة على الأجزاء المتفرقة (الآيات بالنسبة للقرآن)، والتي وفقًا لنصر مرتبطة بأحداث متغيّرة على مدى ثلاثة وعشرين عامًا «التاريخ اليومي»[v]، ممّا يعني أنَّ التخلُّصَ من «سلطة النصّ»، وتجذير الآيات في التاريخ بالمعنى الذي حدَّده خطاب نصر؛ لتصير خطابات ذات طبيعة تداولية بحكم تَعدُّد السياقات والمخاطبين، غير ممكن إلا بالتخلص من «نصيّة القرآن» ذاتها، أي بتغيير طبيعة القرآن عن كونه نصًّا من الأساس (وحدة تركيبية لها تماسك دلالي مهما تدخَّلت العمليات التدوالية)[vi]،وليس بالجدل حول طبيعة النصّ أزلي أم تاريخي، صفة ذات أم صفة فعل[3]!
لذا كان لا بُدّ لنصر من العودة خطوات في تحديد أسباب نشأة «سلطة النصّ» وطريقة التخلّص منها، فلم يَعُدِ التَقَبُّل الكلامي الأشعري المُؤطِّر للنصِّ بطبيعة أزلية هو المُنشئ لهذه السلطة، ولا الثنائيات التي يخلُقها الفكر الديني المعاصر المُنطلِق من الحاكمية بين الله/الإنسان، القدرة/العجز، العلم/الجهل، والتي تُفضي في الأخير لتقبُّل الإنسان كلّ سلطة[vii]، بل جمع القرآن من الأساس في مصحفٍ واحدٍ، حيث خلق هذا التقنين (قناعة مؤدَّاها أن القرآن «نصٌّ»)[viii]، أي كونه بنية تفرض مركزًا دلاليًّا يَنتُج عنه تأويلًا كليانيًّا للقرآن، يُقِرُّ الانسجام بين أبعاده، ويرفع كلّ ما يُظنُّ تناقضًا، أي تأويل سلطوي[ix] بتعبيرات نصر.
لذا ففي هذه المرحلة الجديدة من خطاب نصر بإعلانها القرآن خطابًا، أو خطابات ذات طبيعة تداولية، مُتعدِّدة السياقات من جهة، ومُتعدِّدة المستقبلين التاريخيين من جهة أُخرى[x]، لم يعد نصر يتأرجحُ ما بين إدانة التجزيء الفقهي للنصّ في مرة، وما بين إدانة البحث عن مركز دلالي له في مرة أخرى، كما وجدنا في مرحلة الخطاب الأولى بكلّ تجاذباتها، بل أصبح نصر يَدِيْنُ بوضوح عملية البحث عن مركز دلالي للقرآن، لا كعملية يفرضها الفقهاء، بل كعملية فرضها جمع النصِّ نفسه المُحدِّد لآليات التعامل الفقهي والكلامي مع النصّ، والمُتجاهِل إلى حدٍّ كبيرٍ لطبيعته الأصلية، هنا يعبِّر نصر عن موقف طالما عبَّر عنه خصوم القراءة الحداثية في مواجهتها، وهو ارتباط نظرية التأويل بأدقِّ آلياته (ردِّ المحكم على المتشابه- نسخ المتأخّر للمتقدِّم- استخدام المجاز آلية لتأويل المتشابه- تفصيل المفصل للمجمل- تخصيص الخاصّ للعام) بتصوّر الوحي وتصور النصّ وتصور اللغة كتصورات مُتداخِلَة مُنبثِقَة ومُثبَّتة في العقل الإسلامي الجمعي منذ لحظة الجمع[4]. وهذا له أهمية كبيرة في ظنِّنا، حيث -وفي هذه اللحظة تحديدًا- افترق خطاب نصر تمامًا عن التأويلية الكلاسيكية التي لم يكن قادرًا على مفارقتها طوال مرحلة خطابه الأولى، فرغم كلّ النَّقد الذي وجّهه نصر لها بأنَّها العائقُ الأساس أمام بلورة قراءة تحريكية للنصّ، فقد كان وقبل هذه المرحلة يتحرَّكُ فوق أرضها لا يبارحها.
من «النصّ» إلى«الخطاب»:
سنذكر أولًا مثالًا تطبيقيًّا يوضِّح لنا بصورة أكبر معنى هذه الانتقالة في تعامل خطاب نصر مع القرآن من «النصّ» إلى «الخطاب»، وما الذي تُقدِّمه هذه الطبيعة الجديدة بما تفترضه من آليات تأويلية لفهم بعض آيات القرآن بصورة تفصيلية، وما الذي يعنيه تحديدًا التخلّص من «نصيّة» القرآن الذي يستتبعه هذا الانتقال؛ هذا قبل أن نُناقش في الجزء الثاني من هذا المقال المعنى الدقيق لـ«سلطة النصّ» في خطاب نصر، وكيف يُمثِّل هذا المفهوم في عمقه تكثيفًا لما تحاول رهانات خطاب نصر «تجاوز التلفيق»، «تحريك المعنى» تجاوزه؛ مما يجعل هذا المفهوم هو المفهوم-الضد للخطاب، ومدى قدرة خطاب نصر على التعامل مع ما يرتبط بإشكال «سلطة النص» من إشكالات، أي إشكالات «وحدة النص» و«الآمرية الإلهية» من أجل إنجاز رهانات خطابه.
من الآيات التي يشتغل عليها نصر من أجل تطبيق مقاربته الجديدة للقرآن، والتي تصلح كمثل جيد، آيات تشريع الزواج من غير المسلمات؛ فحين نستحضرُ الآيات الخاصة بالزواج من غير المسلمات نجدُ آيتين؛ آية البقرة:{وَلَا تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُوْلَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللّهُ يَدْعُوَ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ}[البقرة:221]. وآية المائدة:{الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَن يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ}[المائدة:5]، وفقًا للتعامل النصِّي مع القرآن، ووفقًا للطرائق التي بلورتها المدونة التفسيرية التقليدية انطلاقًا من هذا التعامل مع القرآن (كنصّ في أرقى مستويات البناء)، ومدونة قانونية تشريعية («كتابًا» بالمعنى القانوني)[xi]، فإنَّ هاتين الآيتين يتمُّ التعامل معهما؛ إمَّا من خلال مقولات العموم وتخصيص العموم، أو مقولات الناسخ والمنسوخ، والهدف هو رفع أي تناقض قد يُظن بين الآيتين، والوصول إلى حكم قرآني واحد في هذه المسألة. فإمَّا يتم النظر لآية البقرة باعتبارها ناسخة لآية المائدة كما هو رأي بعض الفقهاء الذين يُحرِّمون وفقًا لهذا الزواج من الكتابيات، وإما يُنظر لآية المائدة كتخصيص لما ورد في البقرة، وهو الرأي الأكثر قبولًا، والذي يقرُّ بحِلِّ زواج الكتابيات.
أمَّا بالنسبة للطريقة الجديدة التي يقترحها نصر، والتي تتعامل مع القرآن كخطابات ذات طبيعة تداولية، (متعددة السياقات، ومتعددة المخاطبين التاريخيين)، فإنَّه يقوم بتحديد طبيعة هذا الخطاب القرآني من حيث سياقاته ومخاطبيه، فهو خطاب حواري موجَّه للمؤمنين في قضية اجتماعية مُحدَّدة، ثمَّ يقوم نصر بموضعة وتسييق كلّ آية في النمط الخطابي المرتبط بسياقها التاريخي، فالآيتان تنتميان لمرحلتين مختلفتين من حيث علاقة المسلمين بالمشركين وأهل الكتاب، فآية البقرة تنتمي لخطاب التباعد والذي كان يُكرِّس التباعد والانفصال عن غير المسلمين، والذي أسسته سورة الكافرون في المرحلة المكيّة[xii]، وآية المائدة تنتمي لخطاب التعايش المدني الذي كان يُكرِّس الانفتاح على الكتابيين، هذا الارتباط لكلّ آية بوضعية خطابية معينة يجعل البحث عن قول واحد في المسألة هو إهدارٌ لهذه الوضعيات «المُؤسِّسة» لهذين الحكمين.
ثم يثيرُ نصر سؤالًا مهمًّا تفتتحه هذه المقاربة ونتائجها التي تربط كلّ حكم بسياق خطابي ما، وهو أيُّ القواعد يجب أن يسود، قواعد خطاب التعايش أم قواعد خطاب التباعد؟ والسؤال الأهمُّ هل خطاب التعايش سيتأسّس على مبدأ التساوي بين الذكر والأنثى أم يظلُّ متأسسًا على عدم التساوي، وإعطاء الحقّ للذكر بزواج الكتابية دون إعطاء الحقّ للمسلمة بتزوّج الكتابي؟
الطريف هو أن نصر وكي يحاول تقديم ولو إجابة تقريبية لأسئلته خصوصًا السؤال الثاني؛ فإنَّه يلجأُ وبعد سطور قليلة لتأويل «كلياني وسلطوي»، فنصر يُقَسِّمُ القرآن لأصل وفرع، ويعتبر أنَّ قضية التعبّد هي القضية الأصل، وفيها يحضر الخطاب القرآني ليساوي الذكر بالأنثى تكليفًا وإثابة، وأنه ورغم ارتباط الخطاب التشريعي بوضعيات تاريخية خاصّة إلا أنه الأكثر منطقية هو بناء الفرع الاجتماعي على الأصل التعبدي عكس ما قام به الفقهاء[xiii]، مما يعني أنّنا أمام بحث من نصر عن «مرتكز دلالي» للقرآن يُوحِّد خطاباته ذات الطبيعة التداولية، ويفترض توجيهًا تأويليًّا في اتجاه «المساواة» -التي اعتبرها نصر في مرحلة الخطاب الأولى أحد مرتكزات النصّ ومقاصده-، وهذا يجعلنا نعود لنسأل: ما فائدة هذا الانتقال الذي قام به نصر في التعامل مع القرآن من «النصّ» إلى «الخطاب»، والإدانات المطوّلة لتعامل الفقهاء والمستشرقين والمعاصرين مع القرآن كنصّ، ونقد الآليات الفقهية والكلامية والتفسيرية التي وضعها القدامى بتمييزها مساحات القرآن ما بين المتقدم والمتأخر والعام والخاص، طالما أن نصر سيقسّم القرآن كذلك لأصل وفرع، وطالما سيظل يبحث عن مرتكزات تُوجِّه القرآن تأويليًّا في اتجاه ما؟!
في ظنِّنا فإنَّ خطاب نصر لا يمكنه الاستغناء عن هذه «المقاربة التقصيدية» التي تهدف لتحديد مرتكزات للنصّ والكاشفة عن اتجاه حركته، وأنَّ هذه المقاربة غير قائمة في خطابه لأهداف سجالية، وأنَّها وعلى الرغم من عدم اتساقها مع جوانب الخطاب إلا أنَّها تظلُّ في غاية الأهمية له، حيث إن خطاب نصر -وكما قلنا مرارًا- هو خطاب مهموم بقضايا التحديث الاجتماعي والسياسي، وبربط القرآن بهموم المسلم المعاصر؛ مما يعني ضرورة إيجاد مُتجهٍ قرآنيٍّ لهذه القيم، حتى لو تعارض هذا مع كلّ أبعاد الخطاب طوال تمرحلاته!
وربما هذا هو ما يُقلِّل في ظننا قيمة النتائج الجزئية التي يخرج بها خطاب نصر بانتقاله من «النصّ» إلى «الخطاب»، حيث إنّ كلّ مقاربة تأويلية لآية قرآنية ستظل مهمومة بنفس الهموم ومتجهة لتكريس نفس القيم مهما اختلفت الأدوات أو الأُطر المُحدِّدة لطبيعة النصّ، كما يشهد هنا اشتغاله على هاتين الآيتين، لكن الأهمية الكبرى التي ينطوي عليها هذا الانتقال، هو كما قلنا بالأعلى بروزُ إشكال «سلطة النصّ» بوضوح في هذه المرحلة، وما يرتبط بهذا الإشكال من إشكالات «وحدة النصّ» و«الآمرية الإلهية» كإشكالات مركزية تمامًا في خطاب نصر، وهو ما سنحاول تناوله في الجزء الباقي من هذا المقال.
سلطة النص، المفهوم-الضد:
كما قلنا مُسبقًا فإننا نستطيع اعتبار خطاب نصر خطابًا يدور حول رهانين مركزيين، رهان «تجاوز التلفيق»، ورهان «تحريك المعنى القرآني وتعديده»، وهما رهانان متشابكان ومتجذّران فيما عبّرنا عنه سابقًا بكون خطاب نصر فكرته المركز هي محاولة الانتقال بالفكر العربي الإسلامي (من براديغم العناية إلى براديغم القانون)، حيث يتأسَّس تعديد المعنى على تاريخيّته المرتبطة باشتغال النصّ الديني وفقًا لقوانين تشكّل النصوص في التاريخ، وحيث يتأسَّس تجاوز التلفيق على تجاوز فعل الإرادة في حقلي السياسة والمعرفة واختلاطهما عبر اشتغال المعرفي بآليات السياسي في حقل المعرفة. وهذا الترابط بين الرهانين وتجذره في هذه الفكرة المركزية في خطاب نصر يتجلّى تمامًا في هذا العنوان الأبرز على خطابه، والذي دار حوله كلّ السجال، أي محاولة «التحرر من سلطة النصوص»، حيث إنَّ «سلطة النصّ» بالمعنى الذي يظهر في كتابات نصر هي العائق أمام تعديد المعنى من جهة، والعائق أمام تجاوز التلفيق من جهة أخرى، أي أنَّها عائق الخطاب عن تحقيق رهاناته؛ مما يجعلها الفكرة-الضد الأساس الذي يجنّد الخطاب كلّ أدواته لنقدها.
فسلطة النصّ القائمة وكما قلنا في النصيّة ذاتها، تحرم النصّ من التجذّر في التاريخ الذي يُوحِّد نصر بينه وبين تعديد المعنى وحركيته[xiv]، كذلك فهي العائق أمام التحرّر من التلفيق، حيث تُعد هي ذاتها تكريسًا لسمات الإرادة الخارقة للقانون في الأنطولوجي المؤسِّس للمعرفي وللسياسي، فسلطة النصّ هي قراءة فقهية تشريعية له تُكرِّس صورته ككتاب أحكام، وصورة الإنسان كعبد فاقد القدرة على التدبير في واقع خالٍ من قوانين تحكمه، وصورة الإله كملك/أب/مهندس يُشرِّع للإنسان «الماكينة» كتيب إرشادات لحياته بتفاصيلها[xv]، من هذا الربط بين سلطة النصّ/الإرادة/التشريع، يتضحُ لنا لماذا كلّ حديث لنصر عن «سلطة النصوص» ينحل في الأخير لحديث عن «الآمرية الإلهية»، حيث يرى نصر هذه الأخيرة مجرد نتاج لقراءة تعامل النصّ كسلطة[xvi]، مما دفع نصر لطرح مقاربته الجديدة عن القرآن كخطابات، كي يتخلّص من «سلطة النصّ» وما يرتبط بها من «وحدة للنصّ» و«آمرية إلهية» تقف ضد تحقيق الخطاب لرهاناته، وكي يُحقِّق هذا الانتقال بالفكر الإسلامي من (براديغم العناية إلى براديغم القانون).
وكي نستطيع إقامة نقاش جدّي مع خطاب نصر حول هذه القضايا، فإنَّ هذا يدفعنا لإثارة عدد كبير من الأسئلة، خصيصًا عن هذه الروابط التي يقيمها نصر طوال خطابه بين هذه المفاهيم «النصيّة» و«الجمود» و«سلطة النصّ» و«الآمرية الإلهيّة» ومدى لزومها المنطقي أو التاريخي حتى، فهل بالفعل -عقليًّا أو تاريخيًّا- تُمثِّل «النصية» -بمعناها الأدنى أي كونه تركيبًا يتجاوز الآيات، ويمنحُ القرآن وقائعيّة- عائقًا أمام المعنى المتعدد، وهل بالفعل -عقليًّا أو تاريخيًّا- «الآمرية الإلهية» هي نتاج لقراءة فقهية للقرآن أو رؤية أنطولوجية تنطلق من الإرادة المنفلتة والفصل الكامل المُباعِد بين الإلهي والإنساني؟
أو دعنا نعود بالأسئلة خطوة، هل النصيّة هي نتاج الجمع (الذي أدَّى لقناعة مفادها أن القرآن نصّ)، ففرض وقائعية النصّ ثم آمريته؟ أم العكس، أن الوحدة و«الوقائعية» هي التي فرضت «النصيّة» لاحقًا، وأدَّت لقناعة مفادها ضرورة جمع القرآن وتثبيته بالكتابة؟
إننا بهذه الأسئلة التي نُوردها على خطاب نصر نُرِيدُ المُضيّ بتساؤلات نصر عن «نصيّة النصّ» خطوات أكثر للوراء، فلا نقف عند لحظة تدوين المصحف، بل نتخطاها إلى لحظة القول القرآني ذاتها، لحظة «الظاهرة القرآنية» بتعبيرات محمد أركون، لنتسائل حولها وحول علاقتها بجمع القرآن وبالانطلاق في التعامل معه من وجود مركز دلالي يُوحِّد دلالات هذا الكتاب.
وأسئلتنا هذه موجّهة بالأساس لعمق منهجية نصر أبو زيد، حيث هو تساؤل حول ألسنية نصر، وحول تعامله مع الهرمنيوطيقا، وحول مدى قدرة الآليات الحاضرة في عدّته المنهجية والمستقاة من هذه الحقول على الوصول إلى بلورة رؤى متماسكة في قضايا مثل «وحدة النصّ الديني» ومثل «الآمرية الإلهية»، التي اعتبرهما نصر عائقًا أمام رهانات الخطاب. فبأي قدر كان على نصر توسعة عدّته المنهجية من أجل الولوج لهذه المساحات ونقاشها نقاشًا جديًّا يتناسب مع مركزيتها هذه في خطابه؟
الآمرية الإلهية، ووحدة القرآن:
ربما علينا أولًا أن نفصم -بصورة إجرائية- هذا الارتباط الذي يقيمه نصر بين «وحدة القرآن» وبين «الآمرية الإلهية»، حتى نستطيع تبيّن كلّ فكرة من هاتين الفكرتين على حدة، وتحديد المدخل المناسب لبحثهم أولًا، حتى نستطيع بعد هذا تقييم هذا الارتباط الذي يقيمه نصر بينهما عبر مفهوم «سلطة النصوص» ومدى دقته.
فبالنسبة لقضية الآمرية والتي تُعَدُّ في ظننا هي مركز نقاش نصر طوال تمرحلات خطابه، فالتحرر منها هو عمقُ هذا الخطاب؛ لذا فإننا حتى في مرحلة الحديث عن «وحدة القرآن» نَجِدُ مرتكزات النصّ محاولة للتحرر من «العبودية»، وتكريس «العبادية» للتحرر من الآمرية كذلك -وهو ما أرجعناه في مقالنا الأول عن نصر لسيطرة الهمّ السياسي الاجتماعي على خطابه[xvii] -، رغم هذا فإنَّنا لا نرى أي محاولة من نصر لتأسيس جدِّي لنقاش هذه «الآمرية» المُؤرِّقة لخطابه، بل إنَّ نصر يكتفي أن يحيل هذه الفكرة إلى غلبة العقل الفقهي، أو لسلطة النصوص، إلا أن كلّ هذه التفسيرات لا تعدُّ حتى نقاشًا جادًّا للفكرة؛ هذا لأنَّ الآمرية ليست شأنًا طارئًا على الأديان، بل هي أحد أبعاد القداسة ذاتها؛ لذا فهي حاضرة في كثير من الأديان، ومنها الدين الإبراهيمي الذي يُنسب الإسلام نفسه إليه.
فإذا كانت القداسة لها وجهان؛ جذَّاب ومُنفِّر بتعبيرات اللاهوتي الألماني رودولف أوتو (1869- 1937)، فإنَّ هذا يتجلى في طائفة من الطقوس والأوامر والتحريمات التي تفرضها الأديان أي أديان، بهدف هو -بدايةً- تنظيم للعلاقة بين العالم الملتبس المسحوب من التداول (المقدس/المدنس-الطاهر/الدنس) وبين العالم العادي، لتنظيم تجلي هذه القوة التي وكما أنها خالِقة ومُبدِعَة وأنيسة فهي وحشية ومُدمِّرة ومُنفِّرة[5]؛ لذا ففي كلّ دين نظام للطقوس والأوامر والتحريمات، هي (ممارسات سلبية تُصنَّف في خانة الإمساك والامتناع) وفقًا لأوجيه كايو[xviii].
بالطبع ثمة فارق بين القداسة في الأديان غير التوحيدية، والقداسة في الأديان التوحيدية الإبراهيمية، فالقداسة في هذه الأخيرة ترتبط بسمات الإله الإبراهيمي، فثمة -وكما يقول «أوتو» ثم «تيليش» و«يان أسمان»- تعديلٌ في القداسة نحَّى الجانب المُدمِّر، هذا الذي أصبح متمركزًا في البعد الدنس الشيطاني الخاضع أصلًا للقداسة المتوحدة بالطهارة والشاملة والمهيمنة والخيرة[xix]، من هنا تأخذ الشرائع والشعائر في الأديان التوحيدية-الإبراهيمية أبعادًا جديدة فهي ليست مُوجهَّة تجاه التحرّر من قوة المقدس المُدمِّرة، بل من فعالية المدنس المُشوِّشة، والتي تقف حائلًا بين الإنسان والإلهي.
لذا فإنَّ فعالية المقدّس/المدنس في العالم العادي، وهي الفعالية المستمرة لـ«إعادة تأسيس العالم» ليست فحسب «فعالية وجودية» بل كذلك «فعالية وجوبية»، تتجلَّى في الطقوس والأوامر، والفعاليتان ليستا منفصلتين، فالتجلي الآمري هذا للقداسة؛ غرضه تنظيم العالمين العادي و(المقدس/المدنس الملتبس) الوجودي فيما غير الديانات التوحيدية، والعوالم العادي والمقدس والمدنس في الديانات التوحيدية، وربما هذا ما يجعل التجلي الآمري يزداد مع الديانات التوحيدية، ويتعقد ما بين المساحات الثلاثة هذه[6].
ويأخذ التجلِّي الآمري في الديانات الإبراهيمية حضورًا أكبر حيث يقلُّ التجلي الوجودي بسبب سمة المفارقة كسمة مركزية للإله الإبراهيمي، ويظهر هذا التجلي في شكل الوصايا، وهذا مرتبط بسمة هذا الإله كإله متكلم ومرسل «موحي»، (فالكلام الإلهي وساطة المؤمن نحو العالم في كليته، فكلّ صلة بالأشياء، أو بالجسد، أو بالخالق، تمرُّ بالضرورة عبر الكتاب وبفضل قوله)[xx].
فالعلاقة بين «القداسة» و«الأمر» هي علاقة أساسية مُتجذِّرة في طبيعة القداسة «كقوة»، وهي قائمة في شكل جديد يناسب تعديل القداسة في الديانات الإبراهيمية «ذات خيرة ومهيمنة ومتكلمة»، لكنَّ نصر لا يكتشف هذه العلاقات ولا يضع يده على هذه الروابط بين القداسة والتحريم والأمر، سواء في الأديان عمومًا أو في الأديان التوحيدية الإبراهيمية تحديدًا، وهذا لسببين؛ الأول: هو اقتصار نصر في عدته المنهجية على المناهج الألسنية وعدم الاستعانة بمناهج أخرى تغطي المساحات التي يفتتحها الخطاب لنقاشها مثل مساحة «الآمرية»، والثاني: وهو الأهمُّ، هو أنه حتى لو كان نصر سيستعين بهذه المناهج فربما لم تكن ستفيده بشيء، حيث إن نصر كما قُلنا سابقًا يُقلِّص الصلة بين الإسلام والإبراهيمية إلى حدّ كونها محض أيدلوجي للطبقات الثائرة! وهذا يحرم خطاب نصر من بحث قضية «الآمرية الإلهية» في الإسلام كأحد تجليات المقدس الإبراهيمي، مما يسمُ إثارته لهذه القضية على حساسيتها ومركزيتها الشديدة في خطابه بسمة اللاجدية.
وهذان السببان اللذان جعلا خطاب نصر غير قادر على تأسيس جدِّي جيد لإشكال «الآمرية» هما نفسهما يقفان ضد تأسيس جدِّي جيد لقضية «وحدة القرآن» أو «وقائعيته» بالتعبير الأشمل، حيث إنَّ اكتشاف «طبيعة القول القرآني» ترتبط بإدراك سمات القداسة التوحيدية كذلك، فالكتاب الديني -أي كتاب ديني- هو التجلي السردي لقداسة ما، سواء كانت هذه القداسة حقيقية أم غير حقيقية، مُعايَنة أم مُتخيَّلة، تاريخية أم أزلية، في كلّ الأحوال لا يمكن دراسة طبيعة القول الديني في دين ما بعيدًا عن سمته تلك، حيث هذه القداسة التي يعدُّ القول الديني تجليًا لها هي التي تمنحه خصائصه وتفرقه عن غيره من الأقوال، وبالنسبة للقرآن فإنَّه القول الديني الذي يُمثِّل التجلِّي السردي للقداسة التوحيدية الإسلامية؛ مما يعني ضرورة بحث سماته عبرها، فهي التي تمنحه خصائصه التي يفترق بها -كما يُكرِّر نصر نفسه- عن أنواع أقوال أخرى كالكهانة والشعر، كأقوال مرتبطة بتنظيمات أخرى لفضاء القداسة.
لكن نصر الذي يُصِرُّ على اعتبار القرآن مجرّد نصّ لغوي، دون تحديد طبيعة هذا القول اللغوي[xxi]، وعلى اعتبار التباعد الذي يُحدثه القرآن بينه وبين الكهانة والشعر محاولة للتخلص من التصورات الأرواحية، و«الوقوف على بوابات العقل» و«الهيمنة النصية»، دون أن يحاول بحث صلة هذا التباعد بالسمات الخاصة للإله التوحيدي، التي تتجلى سردًا في القرآن، يعزل النصّ عمّا يمنحه ماهيته «القداسة التي يجليها»؛ لينشغل بدراسة قرآن لم يفقد فحسب قداسته وأزليته، بل فقد حتى بعده الديني أو النبوي، فأضحى محض كتاب لغوي لا سمة له!
ونصر يصادر على (لا دينية النصّ) هذه من البداية كمنطلق لخطابه، ومؤسِّس لاشتغاله حتى دون بحث دقيق لهذا النصّ نفسه وعلاقته بالدين الذي يجليه سرديًّا، فيصرُّ على الاقتصار على المنهج اللغوي في دراسة القرآن، رغم كون هذا المنهج غير قادر أبدًا على الكفاية في قراءة القرآن الذي يحتاج لمقاربة متعددة المنهجيات تناسب كونه فضاءً تأويليًّا هائلًا[xxii]، ويعتبر ببساطة أن الحديث عن بلورة «ألسنية دينية» تناسب القرآن كقول ديني مجرد «تطمينات» مُقدَّمة للمخالفين[xxiii]، وليس تأسيسًا منهجيًّا لطبيعة هذا القول يسبق كلّ تحليل له!
لكن الأكثر غرابة وطرافة هو أن نصر في هذه المساحة تحديدًا لم يكن محتاجًا لانتهاج مناهج خارجة عن الألسنيات والهرمنيوطيقا حتى يستطيع تأسيس نقاش جدِّي لهذا الإشكال، فالمناهج الألسنية والتأويلية ذاتها كانت تُتيح لنصر بالفعل إمكانات هائلة في دراسة طبيعة القول القرآني؛ وهذا لانفتاح كثير من مقارباتها على إشكالات السرد والرمز التي تعد مساحة مشتركة بين اشتغال مناهج قراءة النصوص ومناهج تحليل الأديان في مساحة مخصوصة هي طبيعة القول الديني، ولعلّ أبرز مثال هو ريكور الذي يذكره نصر سريعًا دون استفادة منه[xxiv]، والذي قد أسس لمقاربة لافتة في هذا السياق، حيث اعتبر أنّ ثمة «هرمنيوطيقا توراتية» تتأسس على خصوصية النصِّ التوراتي المرتبطة بطبيعة الإله العبراني، ألم يكن من الممكن الاستفادة من مقاربة كهذه للسؤال حول طبيعة القول القرآني وعلاقته بسمات القداسة الإبراهيمية-الإسلامية؟ بدلًا من اقتصار نصر على النفي المتعسف لوحدة القرآن لا لسبب سوى تصوّر تسببها في واحدية المعنى وتجميده! وهو التصور الذي لا يجد مُبرِّرًا لا واقعًا ولا نظرًا ولا عقلًا ولا تاريخًا ككلّ الروابط التي يربطها نصر طول خطابه.
فتلك الروابط شديدة الغرابة التي يقيمها نصر طوال خطابه بين أحادية المعنى وتعاليه، وبين تعددية المعنى وتاريخيته، وبين وحدة النص وجموده، هي روابط غير لازمة -وللمفارقة- حتى من منظور تاريخي صرف[7]! فبالإمكان تمامًا الحديث عن نموذج متصور لتاريخية أخرى[8]غير تاريخية نصر، ليس فيها أي رابط من هذه الروابط التي يتخيلها نصر، فمن منظور تاريخي ينظر للقرآن (كنص تاريخي متجذر في تاريخ الإبراهيمية كتشكيل خاصّ للقداسة، وتأسيس لوعي كوني منفصل عن الطبيعة، يُهيكل مفاهيمه في مواجهة الدين الجاهلي ومعجمه اللغوي)، فإنَّ هذا النصّ ستكون له مرتكزات تنتمي لـ«لتاريخه الطويل والرمزي والحكائي» تعطيه حضورًا وحركة في مواجهة التاريخ «اليومي- تطورات الدعوة» و«قصير المدة-تاريخ قريش عشية الدعوة»، لكنها مرتكزات تحمل في ذاتها قدرة على الحركة، وتنطوي على زخمٍ تأويلي سببه عدم القدرة على القطع بها، وكون تحديدها هو في ذاته أمر تأويلي من جهة، ولارتباطها بحدود بشرية جذرية من جهة أخرى. المعنى في هذا النصِّ سيكون تاريخيًّا، سواء في بروزه الأول أو في ارتحاله، لكن في ذات الوقت لن يعني هذا كون النصّ متشذّرًا كخطابات!! فسنكون بنموذج تاريخي مُتصوَّرٍ كهذا أمام «وحدة للقرآن» لا تعني «الجمود» ولا «واحدية المعنى»، وأمام «تاريخية» لا تعني حتمًا «عدم وجود وقائعية للنصّ»! مما ينفي تمامًا أي لزوم لثنائيات نصر شديدة التعسف، وهي الثنائيات المرتبطة فحسب بتصوّر نصر الخاصّ للتاريخ على ما وضحنا في المقال السابق، وكذلك لرهاناته التي يسيطر عليها همّ الانتقال لتكريس قيم التنوير العربي!
فربما كلّ نقطة في خطاب نصر، كلّ تأزُّم، كل ّخفّة منهجية، تُفضي بنا فورًا إلى تصور نصر لـ«التاريخ»، وهو التصور الخاصّ تمامًا من حيث طبيعته وتعيينه، فهذا التصوّر للتاريخ يعدُّ في ظنِّنا السبب الرئيس لتأزُّم الخطاب وعدم قدرته على تحقيق رهاناته، بل حتى على الحفاظ على سلامة منطلقاته، وهذا يفضِي بنا لسؤال ربما يحسن أن يكون خاتمة الأسئلة التي نوردها على خطاب نصر، وهو بأي قدر يبدو غريبًا أن خطابًا يُمثِّل فيه التاريخ «الكلمة المفتاح» والمفهوم المركز لا يعبأ بمراجعة هذا المفهوم؟ ربما يُثير هذا استغرابنا بالفعل، لكن فقط لوهلة، فبالتعمُّق في خطاب نصر يبدو من الواضح تمامًا أن هذا التصور للتاريخ لا يمكن مراجعته، حيث هو تصور لا يتأسس علميًّا ولا يتأسس عبر دراسة الإسلام والقرآن حتى يمكن نقاشه، إنه يتأسس فيما هو أعمق، في رهانات الخطاب السياسية والفكرية، فهذا الخطاب الذي يرى من الضروري تغيير طريقة التعامل مع الحداثة من البراني للجواني، من السياسي للثقافي، وتغيير طريقة تحديث المجتمعات العربية حيث الطريق الأمثل لتحديثها هو تهيئة التربة لا قطف الثمرة وفرضها عليها من أعلى، ومراعاة السياق التاريخي لا مُصادمة التصوّرات الإسلامية التي تُشكِّل للمجتمع العربي والإسلامي الواقع والواقعة، والتحديث من أسفل لا التحديث من أعلى، يتصور أن للإسلام نفس الإستراتيجية في التعامل مع الدين القرشي وأنَّ للقرآن نفس القوانين في التعامل مع واقعه، ربما في شرعنةٍ من هذا الخطاب لحاضره أو في استيهام منه للتاريخ الذي يدافع عنه! لكنَّ الأهم، في تجاهل واضح لدرس جدِّي للظاهرة الوحيدة التي يتكفَّل هذا الخطاب بدراستها أي القرآن.
[1] يشير نصر في دراسة من أمتع دراساته بعنوان «مركزية الغزالي وهامشية ابن رشد» إلى كون الخطابات المتدافعة وحين تمارس على بعضها آليات الإقصاء والمباعدة؛ فإنَّها تستعير بعض آليات الخطابات التي ترفضها على مستوى البنية والسرد، ليس فحسب على مستوى واعي عبر الترضيات، بل كذلك عبر اختراق آليات الخطاب المُتنقَد للخطاب المُنتقِد بصورة ربما غير واعية، هل يُمكنُ لنا تفسير وقوع نصر في التلفيقية التي كان دائم النقد لها بنفس الطريقة، وهي أنَّ آليات الخطاب المُنتقَد قد اخترقت الخطاب المُنتقِد؟ انظر: «الخطاب والتأويل»، ص25.
[2] يستغرب علي حربكما نستغرب نحن تمامًا، وكما قد يستغرب أي شخص من هذا الإطلاق الغريب من نصر، فطوال أربعة عشر قرنًا يؤمن فيهم العلماء القدامى بقدسية النصّ كمنطلق لكلّ رؤاهم؛ استخدموا الآليات العلمية المتاحة لهم لفهم القرآن، بل إنهم قاسوا القرآن على كلام العرب لبيان إعجازه، مما يجعل هذه الصلة التي يقيمها نصر بين الانطلاق من إلهية النصّ ومفارقة دلالاته وبين قراءته فحسب، عبر الكشف الصوفي أمرًا في غاية العجب. انظر: نقد النص، علي حرب، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط4، 2005، ص206.
[3] كهذا الجدل الكلامي الطويل، الذي استغرق فيه نصر في دراسته «التاريخية» المفهوم الملتبس دون فائدة كبيرة، على ما أوضحنا في المقال السابق.
[4] يقول مثلًا عمر حسن القيام في معرض نقاشه لطرح أركون عن اللغة الرمزية القرآنية، أنَّ نظرية التفسير في الإسلام منسجمة إلى أبعد الحدود مع التصوّر الجوهري للغة وطبيعتها ووظيفتها، بل كذلك -ومستعينًا بايزوتسو- مع تصور الوحي ككلمة إلهية، تكلمها الله عبر لغة مبينة قابلة للفهم، في ظهوره الذي يظلُّ الضامن النهائي لصدق تجربة المؤمنين. انظر: عمر حسن القيام، أدبية النصّ القرآني، بحث في نظرية التفسير، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، هرندن، فرجينيا، ط1، 2011، ص105. نصر أبو زيد، التجديد، التحريم، التأويل، ص200.
[5] انظر في هذا السياق: تحليلات أوتو في كتابه الكلاسيكي المهمّ، والذي يمثل منعطفًا في دراسة «المقدس» و«الدين»، «فكرة القدسي»، دار المعارف الحكمية، بيروت، لبنان، ط1، 2010.
[6] لتحليل جيد ومفيد للمقدس في الإسلام، انظر: نور الدين الزاهي، المقدس الإسلامي، دار توبقال، الدر البيضاء، المغرب، ط1، 2005، خصوصًا من ص26 إلى ص32.
[7] فضلنا الاقتصار في متن المقال على بيان عدم لزومية هذه الروابط التي يقيمها نصر طول خطابه عبر اللجوء لقراءات تاريخية أخرى؛ حتى نظل داخل إطار التاريخية، ولنشدد على خصوصية تاريخية نصر، في حين أننا لو وسّعنا إطار نظرتنا، فسنجد بكلّ وضوح أنّ تعدّد المعنى يقام أصلًا في كثير من الدراسات القرآنية المعاصرة -الفكر الديني المعاصر الذي ينتقده نصر ويدّعي الإحاطة به- على أزليّة القرآن، ولعلّ هذا يتضح مثلًا في نظرية الظهورات المتعددة للقرآن، التي يتحدث عنها «كامل الحيدري»، والتي تقضي بتعدد الظهور الموضوعي للقرآن في كلّ عصر من العصور، والمؤسسة على تعدد مراتب وبواطن القرآن، وعدم نفاذ خزائنه أو ما يسميه «التعدد الطولي للمعنى»، ففي هذه الرؤية الشيعية العرفانية المعاصرة نجد تصوّرًا لتعدد المعنى، ونجد أنه متأسس ببساطة على أزليّة النص! انظر: كامل الحيدري، منطف الفهم، الجزء الأول، دار فراقد، 2013، وسنعود تفصيلًا لرؤية كامل الحيدري في مقالات لاحقة تتناول الدرس الشيعي المعاصر للقرآن.
[8] هذا التصور الذي نذكره هنا يتماشى مع تاريخية العروي وتاريخية جعيط، بل حتى مع تاريخية أركون، أو يتركَّب منهم، انظر لكاتب هذه السطور مقال «تاريخيات القرآن» المنشور على موقع الملتقى الفكري للإبداع.
[i] النص، السلطة، الحقيقة، ص68.
[ii] نقد الخطاب الديني، ص131.
[iii] نقد الخطاب الديني، ص206.
[iv] النص، السلطة، الحقيقة، ص33.
[v] التجديد، التحريم، التأويل، ص216.
[vi] بلاغة الخطاب وعلم النصّ، صلاح فضل، عالم المعرفة، الكويت، العدد 164، أغسطس، 1992، ص236.
[vii] نقد الخطاب الديني، ص117.
[viii] التجديد والتحريم والتأويل، ص200.
[ix] التجديد، التحريم، التأويل، ص215.
[x] نفسه، نفس الصفحة.
[xi] التجديد والتحريم والتأويل، ص210.
[xii] نفسه، ص227.
[xiii] نفسه، 229.
[xiv] نقد الخطاب الديني، ص202.
[xv] صوت من المنفى، ص166.
[xvi] نقد الخطاب الديني، ص131.
[xvii] الخطاب والتأويل، من ص204 إلى ص206.
[xviii] الإنسان والمقدس، أوجيه كايو، ترجمة: سميرة رشا، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، ط1، 2010، ص61.
[xix] بواعث الإيمان، بول تيليش، ترجمة: سعيد الغانمي، منشورات الجمل، ط1، 2007، ص22، ولعلاقة التوحيدية بالعدالة والأخلاق، انظر: التمييز الموسوي أو ثمن التوحيدية، يان إسمان، ترجمة: حسام الحيدري، منشورات الجمل، (كولونيا) ألمانيا، ص68.
[xx] المقدس الإسلامي، ص12.
[xxi] نقد النصّ، علي حرب، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط5، 2005، ص207.
[xxii] علي حرب، نقد النصّ، ص208.
[xxiii] الخطاب والتأويل، ص122.
[xxiv] التجديد والتحريم والتأويل، ص217.
الكاتب:

طارق محمد حجي
باحث مصري له عدد من المقالات البحثية والأعمال المنشورة في مجال الدراسات القرآنية.
مواضيع ذات صلة
((المعلومات والآراء المقدَّمة هي للكتّاب، ولا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع أو أسرة مركز تفسير))