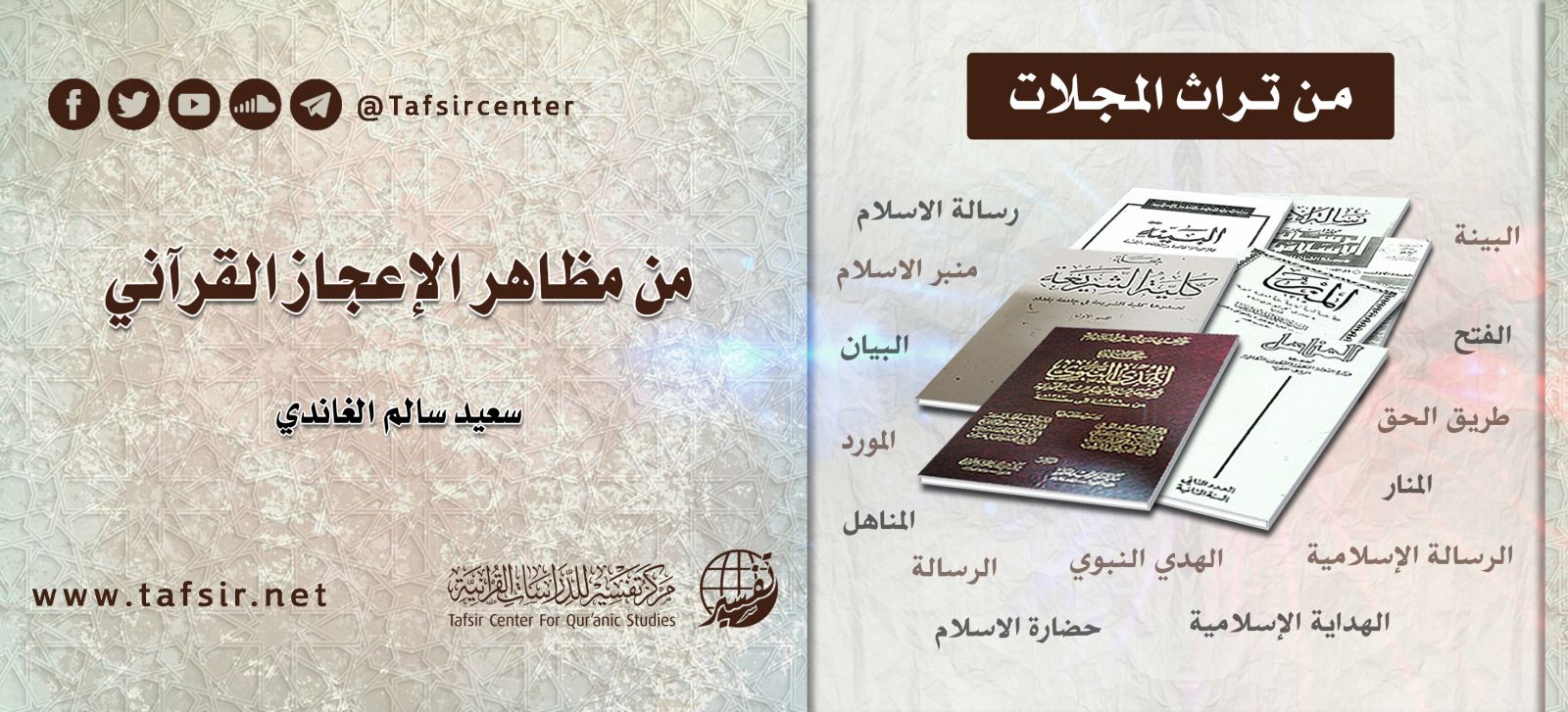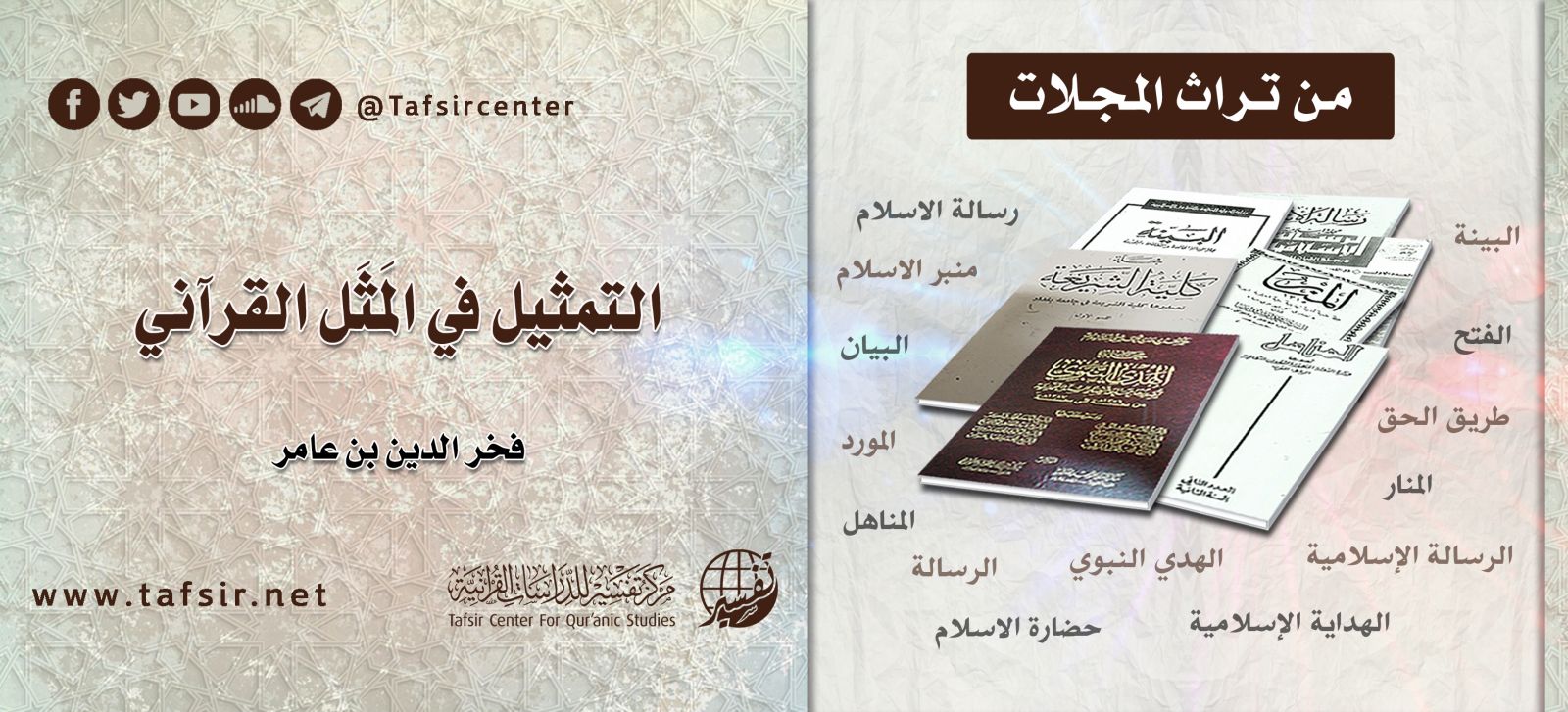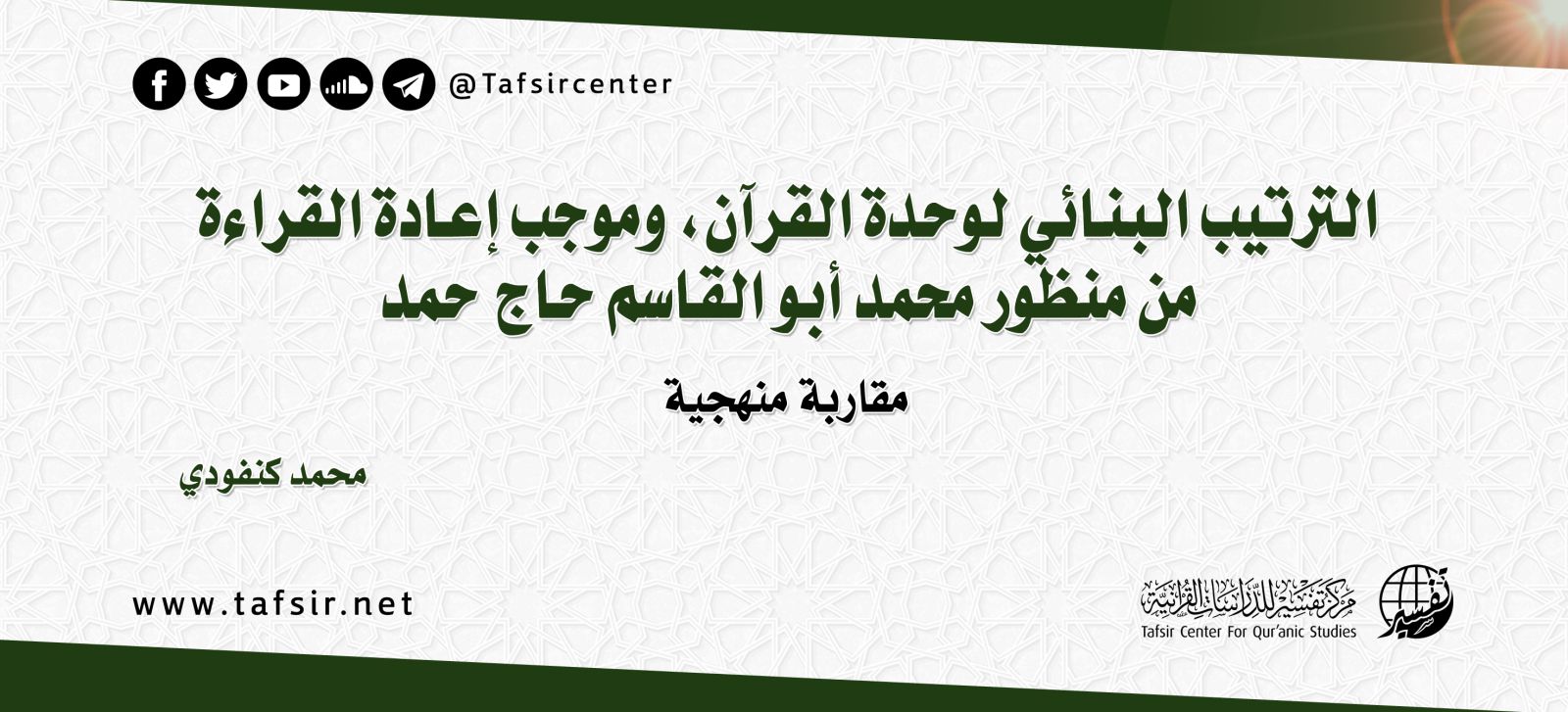نصر أبو زيد وطبيعة القول القرآني، ثانيًا: تأسيس مقولة التاريخية
نصر أبو زيد وطبيعة القول القرآني، ثانيًا: تأسيس مقولة التاريخية
الكاتب: طارق محمد حجي

إذا كانت القراءات الحداثية للقرآن تتوسَّلُ بناءً منهجيًّا يقعُ في قلبه القول بـ«تاريخية القرآن» لا كتقنية منهجيّة ضمن تقنيات أخرى، بل كمُحدِّد منهجي أساس؛ حيث يُشكِّل القول بـ«التاريخية» طرح نظرة مختلفة لـ«طبيعة النصِّ القرآني» كأساس لمقاربة القرآن، وفقًا لمناهج قراءة حديثة مُستقاة بالأساس من علوم قراءة النصِّ المعاصرة، إلا أنَّ قضية «التاريخية» في خطاب نصر أبو زيد لها حضورٌ خاصٌّ، فخطاب نصر ليس مجرد خطاب يقول بالتاريخيّة كمنطلق، ويقرأ القرآن وفقًا لعدة منهجية تتوسَّل التسييق التاريخي كأداة أساس لإنتاج المعنى، بل إنَّه خطاب مُتمَحور بصورة رئيسة حول المنافحة عن فكرة التاريخية ذاتها كمُنطلق ومُحدِّد منهجي للقراءة، إنَّ خطاب نصر هو محاولةٌ لتأسيس تلك المقولة التي كانت تُتداوَل مُمفهَمة أو مُستبطَنة في كتابات السابقين والمعاصرين له[1]، تأسيس وصقل لها بحيث تجسد منطلقات الخطاب ورهاناته، وبحيث تَبرُز كَحَلّ لكلّ إشكالات الخطاب العربي النهضوي الحديث والخطابات المعاصرة المتناسلة منه، محققةً الانعطافة المطلوبة لهذا الخطاب نحو «تأسيسه الثاني» على ما أوضحنا في مقالينا السابقين؛ لهذا فإنَّ تتبع كيفية هذا التأسيس والصقل الذي قام به نصر لـ«التاريخية» من مقولة غير حسنة المَفْهَمَة لتتحول إلى «أساس منهجي متماسك» لقراءة القرآن حداثيًّا، يصلح أن يكون نافذة تُضيء لنا الكثير من أبعاد خطاب نصر التصوّرية والمنهجية، وتبرز لنا الحركة الداخلية لهذا الخطاب وتجاذبات منطلقاته ورهاناته، كما أنها -وربما هذا هو الأهمّ- توضح لنا موقع خطاب نصر شديد الأهمية على خارطة «القراءات الحداثية للقرآن»؛ بل على خارطة التعامل الحداثي مع القرآن بوجه عام، سواء فيما قبل منعطف «التأسيس الثاني للنهضة» أو بعده.
لذا فإنَّنا في هذا المقال الثاني عن نصر نحاول أن نتناول تأسيس نصر لفكرة «التاريخية»، وكيف توسَّل المناهج الألسنية المعاصرة في بلورته هذه الفكرة-المنظور، وكيف تشكَّلت هذه الفكرة في خطابه عبر تجاذباتها مع رهانات الخطاب ومُنطلقاته وتصوّراته لتُصْبِحَ لها ملامحها الخاصة، ثم نتناول ببعض التفصيل هذه الملامح الخاصة لتاريخية نصر أبو زيد؛ أولًا، لتسييقها بصورة أدقّ في القراءات التاريخية ذات البرامج المختلفة كما سنوضح، وثانيًا، لكشف أثر هذه الملامح الخاصة على تصوّر نصر للقرآن وعلى كيفية استخدامه لتقنياته المنهجية المُشغَّلة على القرآن بُغية «إنتاج المعنى»، وأثر كلّ هذا على بناء الخطاب بأكمله وحظّه من التماسك، وقدرته على تحقيق رهاناته والقيام بأدواره.
تأسيس مقولة التاريخية:
إنَّ القول بتاريخية القرآن، والتي تعني (وصل الآيات بظروف نشأتها وبيئتها)، وفقًا لتعريف طه عبد الرحمن[i] -والذي نستخدمه على إطلاقه بشكلٍ إجرائي في هذه الخطوة من المقال، لكنّنا لاحقًا سنقوم بتحديده بدقة أكبر- هو أداة لازمة وشرط ضروري من أجل تطبيق المنهجيات الحديثة على القرآن وفقًا للحداثيين، فهذا التطبيق رهين بتغيير تصوّر «طبيعة النصّ» من «نصٍّ أزلي مفارق» إلى «نصّ مرتبط بسياقاته التاريخيّة»، وبتنحية الإلهي من موقعه المستقر في التقليد التفسيري كمُحدِّد في عملية القراءة من حيث التفسير هو (بيان المعنى الإلهي على حسب الجهد البشري) إلى اعتبار عملية القراءة عملية تَقْتَصِرُ على تناول القرآن في تموضعه البشري دون حاجة لاستحضار أُلوهية قائله، وبتغيير طبيعة فعل القراءة من كونه بحثًا عن معنى مفارق إلى كونه إنتاجًا للمعنى يُشاركُ فيه المؤوِّل بالأساس، ونستطيع أن نطلق على هذه العلمية الهادفة لتغيير طبيعة النصِّ ولتنحية الإلهي من موقعه في عملية القراءة ومنح المعنى بـ«أرخنة القرآن»[2].
والقراءات الحداثية لا تَهدفُ لـ«أرخنة القرآن» كغاية للخطاب، بل تهدفُ لشرعنة «التسييق التاريخي للآيات» كتقنية أساس في القراءة إلى جانب القراءة الجزئية والكلية للنصِّ والمعتمدة على القراءة اللغوية بالأساس[ii] كـ«أوسع المصادر استعمالًا» في المدونة التفسيريّة التقليدية[iii]، ووسيلتها في هذه الشرعنة هي «الأرخنة»، أي إثبات الصلة الحاسمة للآيات بهذا التاريخ؛ لذا يُمكننا القول بأن «الأرخنة» بهذا التحديد تُمثِّل خطوة من أهم خطوات ما يسميه محمد أركون بـ«الزحزحة»، كعملية هدفها نزع القرآن من «حقل اللاهوت» بكلّ حمولاته المفاهيمية والمنهجية بل والشعائرية المُؤطِّرة لتناول القرآن في العلمي وفي الشعائري وفي اليومي؛ ليصير من الممكن موضعته في حقل العلوم الحديثة بمنهجياتها ذات الأساس المعرفي المُغاير[3].
لكن الطريف وكما يثبتُ اشتغال نصر لمحاولة تأسيس فكرة التاريخية، هو أنَّ «أرخنة القرآن» أي إثبات ارتباطه فعليًّا بالتاريخ والمؤسسة للدرس الحداثي للقرآن هي نفسها فكرة مفتقرة للتأسيس، وأنَّ تأسيسها يحتاجُ هو نفسه أن يتوسَّل تطبيق المنهجيات الحديثة على القرآن! مما يعني أنَّ «الفكرة الوسيلة» تحتاج هي ذاتها لما تتوسَّل به، «الفكرة المنطلق» تحتاج لمنطلق تتأسس عليه، هو نفسه للمفارقة ما تريد تكريسه كنتيجة، فتطبيق المناهج الحديثة لازم للقول بتاريخية القرآن، الذي يُعدّ هو نفسه منطلق القول بضرورة تطبيق منهجيات حديثة على القرآن!
والحقيقة أنَّ الخروج من هذه الدائرة المغلقة (تطبيق مناهج حديثة- أرخنة- تطبيق مناهج حديثة) التي يكشفها لنا اشتغال نصر سواء في «مفهوم النص» أو في «النص، السلطة، الحقيقة»- كما سنوضح تفصيلًا- يتمُّ فقط بالعودة لمُحدِّدات الخطاب، لرهاناته المرتبطة بسياقاته المعرفية المُنشِئة، فكما قُلنا مسبقًا فإنَّ من أهم المُحدِّدات لـ«القراءات الحداثية للقرآن» الناشئة في منعطف «التأسيس الثاني لخطاب النهضة» هو كونها تحاول تجاوز الفصم بين المنهجيات الحديثة، والتراث/الدين/الإسلام بتطبيق هذه المنهجيات على القرآن نفسه، كتجذير للحداثة جوانيًّا في عمق العقل المعرفي العربي في أعلى تمظهراته، هذا المُحدِّد يجعلُ الانطلاق لتطبيق المناهج الحديثة على القرآن لا يحتاجُ منطلقًا أو مبُرِّرًا معرفيًّا، بل إنه يُؤسِّس ذاته بذاته كرهان مركزي للخطاب، (فتحقيق وعي علمي بالتراث وبالنص) -هذا الرهان المركز- يتحقَّقُ بالتعامل مع النصِّ في تموضعه البشري والثقافي «في تاريخيته» و(دون انشغال بالأصل الإلهي له)، أي فحسب بـ«القراءة العلمية للنصّ»[iv].
لذا فإنَّ تأسيس «فكرة التاريخية» وفقًا للدرس الألسني مع نصر كما سنبين هي أبعد خطوة قد يَقومُ بها الخطاب الحداثي لتأسيس منطلقاته ولتبيئة القرآن في الدرس الحديث، دون أن يبحث لهذه التبيئة نفسها عن أساس أو منطلق معرفي، فهي منغرزة في الخطاب كرهان مركزي، كمنظور قبلي يحضر كمُحدِّد أساس من محدِّداته.
ونستطيعُ القول أنَّ هناك ثلاث نظريات مركزية يَلجأُ إليها نصر لبلورة القول بـ«تاريخية القرآن» بشقّيها (إثبات ارتباط القرآن بالسياق التاريخي أو الأرخنة) وما يتأسس على هذا من (اعتماد التسييق التاريخي أداة رئيسة ضمن منهجية القراءة)، نظرية فردناند دي سوسير في علاقة الدال اللغوي بالمدلول الذهني «وجهي العملة اللغوية» بالواقع، ونظرية شلايرماخر في التفريق بين النصّ المُنتَج والنص المُنتِج، ثم لاحقًا تقنية هيرش في التفريق بين «معنى النصّ» و«مغزى النصّ».
النظريتان الأولى والثانية ارتبطا بشقّ «الأرخنة»، وهذا تمَّ في كتاب «مفهوم النصّ» تحديدًا، وتقنية هيرش ارتبطت بشقّ التسييق التاريخي كأداة في عملية «إنتاج المعنى»[4] من جهة، وبمحاولة مواءمة القول بالتاريخية مع رهانات الخطاب، وأهمها «رهان المعنى المتحرك» و«رهان تجاوز التلفيق» من جهة أخرى، وهذا تمّ في «نقد الخطاب الديني».
يُقيمُ نصر أولًا قوله بـ«تاريخية المفاهيم القرآنية» على أساس ارتباط الدال وفقًا لنظريات اللغة الحديثة بدءًا من سوسير (1857-1913)[5]، بالمدلول الذهني لا بمدلول واقعي، فاللغة لا تشير وكما كان يُفترَض في النظرية الكلاسيكية لأشياء واقعية خارج الذهن، سواء أكانت الإشارة اتفاقًا أو توقيفًا، فعلاقة اللغة بالعالم ليست من الأساس (تعبيرًا مباشرًا عن العالم الخارجي الموضوعي القائم)[v]، بل تشير دوال اللغة لمدلولات ذهنية عن الواقع، هذه المدلولات منتظمة في واقع فكري وثقافي ما يشكل رؤية أنطولوجية خاصة للعالم، هي التي تحكم العلاقة بين اللغة والواقع، وبالتالي فدوال مثل «الجن» و«الشياطين» و«الملائكة» لا تشير حتمًا لمدلولات واقعية تمّت معاينتها وتجريبها، بل تشير بالأحرى لمدلولات ذهنية قائمة في الواقع الفكري والثقافي الذي يُشكِّل الرؤية الأنطولوجية للعالم العربي القرشي، هذا الذي يعبّر عنه نصر مستعينًا كذلك بتفريقات سوسير بـ«اللغة» التي يتمُّ من خلالها إنتاج «الكلام»[vi].
بالطبع هذه الرؤية لا تكفي لتأسيس القول بتاريخية المفاهيم القرآنية، فحتى إن كان هذا التحديد مقبولًا في سياق تحديد دلالة المفاهيم في «السطح الدلالي الجاهلي»[6]، فإنَّ التساؤل سيظلّ قائمًا عن التناول القرآني لهذه المفاهيم، بحيث تُطرَحُ أسئلة عن الاستخدام القرآني لها، وهل يُعطيها في ذاته دلالة الارتباط بواقع حقيقي أم إنه لا يستطيع أن يمنحها هذه الواقعية، أو بتعبيرات أكثر وفاءً لمفاهيم نصر، سيظل السؤال مطروحًا: ما العلاقة الدقيقة بين «الكلام» القرآني وبين «اللغة» الجاهلية (التي تعطيه المقدرة القوليّة)؟ هل العلاقة علاقة مفعولية أم علاقة فاعلية أم علاقة أكثر تشابكًا؟
هنا تأتي أهمية نظرية شلايرماخر في التفريق بين «النص المُنتَج» و«النص المُنتِج» في سياق تأسيس نصر للتاريخية، فكما قُلنا في المقال الأول عن نصر، عن كون خطابه انتقال من «براديغم العناية» لـ«براديغم القانون»، فإنَّ نصر يقرأُ تشكّل النصّ القرآني كتشكّل أي نصّ، بحيث يخضع لنفس قوانين تشكّل النصوص أيّة نصوص، ووفقًا لشلايماخر (1767- 1834) الهرمنيوطيقي الألماني ومُؤسِّس الهرمنيوطيقا الحديثة[7]، فإنَّ النصوص أيّ نصوص تمرّ بمرحلتين «متداخلتين ومتجادلتين»، مرحلة تكون فيها نتاجًا للثقافة (فتبني كلامها في لغته)، ومرحلة تكون فيها مُنتِجة للثقافة[8]، والنصُّ حين يكون في مرحلة المُنتَج للثقافة، فإنَّه يبني ذاته، أو قل: إنه ينبني عبر المفاهيم والطرائق الأسلوبية والتركيبية لـ«اللغة» التي ينتسب إليها، والتي هي نسبية قطعًا -كما قلنا- من حيث تعلّقها بواقع ثقافي ما منغرز في رؤية أنطولوجية خاصّة عن العالم، من هنا فإنَّ القرآن وفقًا لنصر هو نتاج لبيئته الثقافية[vii] فكريًّا وأسلوبيًّا ودلاليًّا. بالطبع هنا نرى عند نصر «تجاورًا» بين الحديث عن الله والحديث عن النصِّ، أو بين العناية والقانون، فأحيانًا يقول نصر إن هذا مراعاة من الله قائل النصّ للواقع الذي تنزل فيه القرآن، وأحيانًا يكتفي بالإشارة للقانون دون استحضار إرادة العناية[9]، ثم في مرحلة لاحقة يقوم النصُّ بالتحوّل لمُنتِج للثقافة فيقوم بالتغيير في رؤية العالم الأنطولوجية، عبر جملة من التحويرات الدلالية في المفاهيم المركزية التي تقوم عليها هذه الثقافة، بحيث يبني فيها تصوراته الجديدة عن العالم.
لكنَّ هذا التأسيس عبر نظرية شلايرماخر قد يكفي في وصل القرآن بتاريخه «الأرخنة»، لكنّه لا يستطيع أن يُقدِّمَ رؤية مُتماسكة لإمكانية التواصل مع هذا النصِّ؛ مما يعني أنَّ هذا التأسيس يجعلُ النصَّ في حالته هذه يبدو وكأنَّه مسجونًا في زمانه محرومين أو محرومًا من التواصل الدلالي معه، وكأنَّ «الأرخنة» غاية لا وسيلة!
في أحد دراساته اللاحقة «التاريخية: المفهوم المُلتبِس» حاول نصر نفي هذه النتيجة عبرَ حديثٍ طويل لكن غير مُأَدْوَتْ (غير متوسل بأداة) عن كون النصوص الكُبرى في كلّ الثقافات تظلُّ قادرة على التواصل مع المعاصرين مهما تباعدت الأزمان معها[viii]، وفي «نقد الخطاب الديني» لجأ نصر لتقنية واضحة هدفها تحريك النصّ القرآني، وهذا في ظنِّنا ليست استجابة للنقد الذي وُجِّه لتاريخيته واتهامها بسجن النصّ ولا مواربة ولا تقيّة ولا ترضية ولا طمأنة كما قد يظنُّ البعض، بل هي خطوة يبررها الخطاب ذاته بمنطلقاته ورهاناته، فأحد المنطلقات الأساسية للخطاب هو القول بجمود المعنى القرآني، وتَكَلُّسه بسبب المنهجيات الموروثة في قراءته، وأحد الرهانات الأساسية إن لم يكن الرهان الأساس للخطاب، هو تحريك المعنى وتعديده وتجاوز التلفيق بالتوفيق المبدع بين الإسلام والحداثة، وجعل القرآن معاصرًا للمسلم الذي يشكِّلُ أُفق الرسالة وغايتها؛ لذا كان لا بد أن يُحاول نصر الاستعانة بتقنية منهجية تُؤسِّس هذا التواصل الدلالي وتُخرِج تاريخيته من التحوّل لسجن، أو بتعبير آخر تقنية تحدد موقع «الأرخنة» كوسيلة ومُحدِّد منهجي لا كغاية للخطاب، كشقٍّ من شقي «التاريخية» يُؤسِّس للشقّ الثاني أي (اعتماد التسييق التاريخي كأداة رئيسة من أدوات إنتاج المعنى)، من هنا حضرت تقنية هيرش كخطوة مركزية في طريق تأسيس مقولة التاريخية.
وما تقوم به تقنية هيرش في خطاب نصر ليس فقط تحريك المعنى القرآني، ولا إكمال بلورة مفهوم «التاريخية» بشقيه، بل هي تحضرُ كذلك كأحد نتاجات التفاعل بين تصوّرات الخطاب ورهاناته، حيث إنَّها -وكما سنوضح- تُحقِّق رهانًا مركزيًّا في خطاب نصر وفي القراءات الحداثية عمومًا، أي (رهان تجاوز التلفيق) والذي اعتبرناه أهم ملامح التأسيس الثاني للنهضة، السياق المعرفي المُنشئ للقراءة الحداثية.
تقنية هيرش (1928)، القرآن والتواصل الدلالي:
وفقًا لهذه التقنية التي حضرت لإكمال تأسيس تاريخية نصر من حيث كونها إخراجًا للتاريخية من أن تكون غاية عبر حضورها كأداة للتسييق التاريخي كجزء من عملية إنتاج المعنى، فإنَّ (المعنى يُمثِّل المفهوم المباشر لمنطوق النصوص النَّاتج عن تحليل بنيَتِها اللغوية في سياقها الثقافي، ويفترق عن «المغزى» في كونه «ذو طابع تاريخي، أي إنَّه لا يمكن الوصول إليه إلا بالمعرفة الدقيقة لكلّ من السياق اللغوي الداخلي والسياق الثقافي الاجتماعي الخارجي»، أمَّا «المغزى»، (وإن كان لا ينفصل عن المعنى بل يُلامسه وينطلق منه- ذو طابع معاصر، بمعنى أنه محصلة لقراءة عصر غير عصر النصّ...)، (والمعنى يتمتَّع بقدر ملحوظ من الثبات النسبي، والمغزى ذو طابع متحرك مع تغير آفاق القراءة، وإن كانت علاقته بالمعنى تضبط حركته وترشدها)[ix].
وحين يُطبِّقُ نصر هذه التقنية بتفريقها بين «المعنى» و«المغزى» على القرآن، تصبح مغازي النصّ بهذا المعنى الذي حدَّده لها أداة لتحريك النصّ؛ حيث إنَّها تستطيع كشف (مقاصد الوحي الفعلية)[x] «كلياته»، والتي تُعطي للنصّ حضوره وحركته في مواجهة الواقع الجاهلي، وكذا حضوره وحركته في الواقع العربي المعاصر، فتحقق «رهان المعنى المتحرك»، وهذه المغازي أيضًا وبسبب صلتها بـ«المعنى» المرتبط بسياق تشكل النصّ التاريخي (تلامسه وتنطلق منه)، فإنها تتجاوزُ التلوين والتجاور لتُحقِّقَ الرهان الآخر «رهان تجاوز التلفيقية».
لتوضيح تقنية الهرمنيوطيقي الأمريكي وما تؤدِّيه من أدوار داخل خطاب نصر، يضرب نصر مثالًا تطبيقيًّا لهذا، التقنية بجدل «المعنى» و«المغزى» في آيات الميراث، فيرى أنَّ «معنى» النصّ القرآني والذي يتبيَّن وفقًا للتحليل اللغوي المباشر، والذي يقضي بتوريث المرأة نصف ما يرثُ الذكر، ليس هو نتاج وغاية تأويل النصّ، فتأويل النصّ لا يتمّ إلا عبر الوصول لـ«مغزى» النصّ، هذا «المغزى» المستنبط من مجادلة «المعنى» المُحصَّل لغويًّا بـ«السياق التاريخي لتنزله» لاكتشاف (اتجاه حركته)، والتي تسيرُ في اتجاه (المساواة) كأحد عناصر العدل -والحرية=كنقيض للعبودية- كمقصد كلي للقرآن.
فالنصّ القرآني وفقًا لقراءة نصر يتّجه نحو مساواة المرأة بالرجل في الميراث، فالمساواة هي اتجاه حركته، لكن لأنَّه مُحدَّد بإطار الأعراف الجاهلية غير الممكن مصادمتها، وإنما فحسب خلخلتها، فقد اكتفى بهذه الخطوة وهي توريث المرأة النصف، حتى تَتَكفَّل القراءة التحريكيّة بعد هذا، و(المُتوسِّلة بأدوات التسييق التاريخي) بكشف «المغزى» من وراء (المعاني التاريخيّة المُحدَّدة)، وإقرار المقصد الذي تُشيرُ إليه حركتها[xi].
فالعدل وكجزء منه المساواة بالإضافة لـ«العقل» ولـ«الحرية»، هي مقاصد النصّ الأصلية التي تُعطيه حضوره في مواجهة الواقع الجاهلي، وتمنحه الحركة والمُتجَه لتغييرات أوسع مع تغير الوقائع التاريخية، وهي مقاصد شديدة الاتصال بمعاني النصّ؛ مما يجعلها بعيدة عن أي تلفيق.
لتوضيح فكرة نصر أكثر نذكرُ مثالًا آخر يتعلَّقُ بالتصوّرات العقدية هذه المرة لا التشريعات، وهو قراءة نصر لـ«العقلانية» كمقصد قرآني، وكيف أن «العقلانية» كمقصد للنصّ تتجلّى في آيات الشياطين والجنّ والحسد.
فيرى نصر أنَّ ذكر القرآن للجنِّ والشياطين، لا يعني إقرار القرآن بوجودها، فذكرُ القرآن لهذه «الكائنات الأرواحية» التي تُمثِّل جزءًا من تصوّرات الجاهليين الأنطولوجية واللغوية كما أوضحنا، تمّ عبر تحويرات دلالية «تحجيم القدرة والأنسنة» تهدف في النهاية إلى التخلّص من التصوّرات الأسطورية؛ بتعبيره: تهدفُ إلى (نقل الثقافة من مرحلة الأسطورة لبوابات العقل)[xii]، (فنقل الثقافة من مرحلة الأسطورة) يصبح هو مغزى النصّ المُحدِّد لمقصد الوحي واتجاهه أي «العقلانية»، «العقلانية» -بهذا المعنى المُحدَّد كمضاد للأسطورة كخرافة-، هي مقصد النصّ الذي يُعطيه الحضور أمام التصوّرات الجاهلية، بحيث يعمل على تحوير هذه التصورات لا مُضادتها مباشرة، ليَدَعَ للقراءة التحريكية للنصِّ المُتوسِّلة بالتسييق التاريخي كأداة رئيسة مهمّة كشفَ «المغزى» من وراء هذه التحويرات وكشف اتجاهها و«مقصدها» نحو نزع الخرافة.
بهذه التقنية التي تنطلق من «التسييق التاريخي» للنصِّ من أجل التفريق بين «معانيه» و«مغازيه»، يرى نصر أنَّه استطاع تحريك النص باكتشاف «كلياته» التي تمنحه وقائعية وحضور وحركة، وكذلك استطاع تجاوز التلفيق والتلوين؛ حيث تمَّ اكتشاف هذه الكليات-المقاصد عبر اكتشاف حركة «مغازي» النص ذات الصلة بـ«المعاني» التاريخية المُحصَّلة بالقراءة اللغوية.
بذا يكتمل تأسيس مقولة «التاريخية» بشقّيها، وبالشكل الذي يُحقِّق رهانات خطاب نصر أبو زيد، فيُؤسِّس نصر على مبادئ سوسير وشلايرماخر تاريخية القرآن كطبيعة للنصّ تعارض طبيعته في التراث التقليدي المُحدِّدة لطرائق التفسير «الأرخنة»، وبالتالي تقترح طرق حديثة لمقاربته كنصّ ثقافي دون انشغال بأصله الإلهي، ويُؤسِّس عبر تقنية هيرش الحديثة (دور التسييق التاريخي في عملية القراءة وإنتاج المعنى)، بما يجسد رهانات الخطاب.
لكن، ورغم أهمية هذا التأسيس الذي يقوم به نصر لـ«التاريخية» سواء لخطابه أو للقراءات الحداثية في العموم، إلا أن تاريخية نصر حين نتناولها كبرنامج قراءة له تصوّراته ومنهجياته وحتى رهاناته الخاصة، تظلّ تاريخية خاصّة تختلف كثيرًا عن غيرها من التاريخيات، وإدراك هذه الملامح الخاصة لتاريخية نصر شديد الأهمية في إدراك أعمق لتوترات خطابه وللشكل الخاصّ الذي تحضر بها تقنيات القراءة في برنامجه، وأثر كلّ هذا على تماسك الخطاب بين كلّ أبعاده، ويُؤهِّلنا إدراك كلّ هذا تبيُّن مآلات خطاب نصر وقدرته على تأدية الأدوار التي ينيطها به موقعه على خارطة القراءات الحداثية. كلّ هذا يجعل إلقاء بعض الضوء على الملامح الخاصة لتاريخية نصر أمرًا في غاية الأهمية؛ لاكتمال رؤيتنا لهذه «المرحلة الأولى» من خطابه؛ ولتقييم أدق لتأسيسه مقولة «التاريخية».
الملامح الخاصّة لتاريخية نصر أبو زيد:
كما قُلنا بالأعلى فإنَّ تعريف طه عبد الرحمن للتاريخيّة بأنَّها (وصل الآيات بظروف نشأتها وبيئتها)، هو تعريف يفتقر للدقّة في ظنِّنا، لا في وصف التاريخية، لكن فيما يُوحي به هذا التحديد من وجود برنامج واحد للتاريخية من حيث تصوراته وبنائه المنهجي، وهو أمرٌ غير دقيق في ظنِّنا؛ لذا فإننا سنحاول في هذا الجزء من المقال أن نوضِّحَ الملامح الخاصّة لتاريخية نصر كبرنامج محدد له تصوراته ورهاناته وتقنياته المنهجية المتأثرة بالرهانات كما أوضحنا آنفًا، والاختلافات بينه وبين غيره من برامج أخرى للتاريخية، وأثر هذه الملامح الخاصة على بناء خطاب نصر، وتماسكه ما بين رهاناته ومنطلقاته.
مبدئيًّا نستطيع أن نُحدِّد موضع الخلاف الرئيس بين القائلين بـ«تاريخية القرآن» في تعريفهم للتاريخ نفسه، أي الكلمة المفتاح في هذه الرؤية، والخلاف في «التاريخ» هو خلاف في؛ أولًا: ماهية هذا التاريخ من حيث كونه أقرب للصيرورة أم للثبات، وثانيًا: خلاف في تعيين هذا التاريخ، بمعنى أي تاريخ يتمُّ تسييق القرآن فيه، وهما أمران مرتبطان بالطبع ولهما الأثر الكبير على تصوّر علاقة النص بالتاريخ.
وحين نتناول التاريخ عند نصر أبو زيد فإنَّنا نجد أنفسنا أمام تاريخ هو صيرورة لا يحمل أي قدر من الثبات، ولعلّ هذا واضحًا في الثنائيات المتقابلة التي تشيع في خطاب نصر، بين أزليّة النص وثبات المعنى، وبين تاريخية النصّ وصيرورة المعنى[10].
وهذا التصوّر الذي يَحمله خطاب نصر ليس الوحيد للتاريخ، فنحن حين نطالع كتابات تاريخيّة أخرى مثل كتابات أركون وفضل الرحمن والعروي ويوسف الصديق كما سنوضح تفصيلًا في المقالات القادمة؛ نجد أنَّ التاريخ عندهم يَحْمِلُ قدرًا من الثبات، وهذا الخلاف في طبيعة التاريخ بين الصيرورة والثبات مرتبط تمامًا بالخلاف في «تعيين التاريخ» المُسيَّق فيه القرآن، فنصر يُسيِّق القرآن في تاريخ مُحدَّد، هو «التاريخ القرشي عشية الدعوة»، يتّضح هذا تمامًا حين نتناول التنسيب الذي يقوم به نصر لبعض مفاهيم القرآن، مثل «الشياطين» و«العرش» و«النبوة»، حيث نجد أنَّ نصر ينسبهم للتصورات القرشية أو لـ«اللغة» القرشية بالمعنى الذي ذكرنا والذي يستعيره من سوسير، وهذه القرشية هي تحديدًا قرشية منزوعة الصلة بالإبراهيميّة أو مُقلَّصة الصلة بها[11]؛ لذا فإنَّ نصر ينظر لمفهوم «النبوة» مثلًا وكأنَّه في ذاته مفهومًا غير معروف للقرشيين، ولا يُشكِّل جزءًا من معجمهم الثقافي، فيقوم بتنسيبه على أنه تطوير لمفهوم الكهانة القرشي (الأساس الثقافي للوحي)، والذي لولا حضوره في الثقافة القرشية (لظلَّ تقبل الوحي مستحيلًا!)[xiii]،وهذا بالطبع غير دقيق، فالإبراهيمية بوحيها بأنبيائها معلومة لأهل الجزيرة وتُشكِّل جزءًا من معجمهم اللغوي -بتعبير سوسير الذي يستخدمه نصر- مما يجعل هذا التنسيب غير دقيق حتى من ناحية تاريخية[12]، لكنَّنا هنا لا يشغلنا مسألة مدى صحة تصوّر نصر لتاريخ قريش، وإنما ما يُعنينا هو تحديد هذا التاريخ الذي يُسيِّق نصر فيه القرآن، والذي هو تاريخ قُرشي مُقلَّص الصلة بالإبراهيمية، ولو استخدمنا تعبيرات بروديل (1902-1985)[13]لوصف هذا التاريخ، فإنَّنا نستطيع القول بأنَّ التاريخ الذي يُسيِّق نصر فيه القرآن، والذي ينتج عنه خطأ التنسيب هذا هو «تاريخ قصير المدة» معاد تشكيله كذلك بحيث يتقلَّص حضور الإبراهيمية إلى «أيدولوجي الطبقات الثائرة» وتنقطع صلتها بالمعجم اللغوي-الثقافي القرشي، في حين نجدُ فضل الرحمن مالك ومحمد أركون وعبد الله العروي ويوسف الصديق -وكلهم تاريخيون- يُسيِّقون القرآن في تواريخ أكثر اتساعًا، (التاريخ متوسط المدة؛ تاريخ المسيحية الشرقية)، (التاريخ طويل المدة؛ تاريخ اليونان -تاريخ الإبراهيمية- الذاكرات الجماعية للشرق الأوسط القديم)، (التاريخ الرمزي والحكائي؛ تاريخ إبراهيم كرمز لوعي الإنسان بالانفصال عن الطبيعة).
هذا التعيين للتاريخ المُسَّيق فيه النصّ وما يفضي إليه من تصور لمدى ديمومة التصورات التاريخية ينعكس حتمًا على العلاقة بين النصِّ «المُؤرخَن» والتاريخ، وبلغة تناسب حقل النصوص فإنَّنا نقول أنَّه يُؤثِّر على تصوّر «وقائعية النص» -أي كونه واقعة في ذاته- و«وحدته» ومدى استقلاله تجاه «التاريخ اليومي» و«التاريخ قصير المدة».
فبالنسبة لنصر نجدُ إصرارًا على نفي «وحدة النص»، ونفي وجود مركز دلالي يُوحِّد دلالاته، بل وإدانة واضحة -مشوبة بسخرية- لعلوم القرآن التقليدية تحديدًا؛ لكونها وحين تتحدث عن «مركز دلالي للنص» وعن ردّ متشابه النصّ لمحكمه وتقييد مطلقه بالمقيد ونسخ بعض آياته بأُخرى، أنَّها تتعامل مع الله (كمؤلف لنصّ في أرقى مستويات البناء)[xiv]، وهذا إمعانًا في تسييق النصِّ في التاريخ اليومي للدعوة لا فقط التاريخ قصير المدة.
ولعلّ هذا الإصرار على نفي الوحدة والمرتبط بتصوره للتاريخ المُسيَّق فيه القرآن يتضح لا فقط في رفضه للطرائق التقليدية في قراءة القرآن بل حتى في جداله مع بعض معاصريه، خصوصًا هذا السجال الذي دخله نصر مع أفكار أركون حول وحدة القرآن وانسجامه الكلي، فبينما يقرأ أركون القرآن تزامنيًّا (كعمل كلي واحد حيث تتشابك كلّ مستويات الدلالة والمعنى، تستند إلى ما كان قد دُعِيَ بالنسبة للتوراة بـ«البنية المركزية للميثاق»)[xv]، فإنَّ نصر لا يرى في حديث أركون هذا عن الوحدة إلا محض تطمينات أو ترضيات! وهي قراءة غير سليمة في ظنِّنا، فخلاف نصر مع أركون هنا ليس خلافًا في مقدار «التطمينات» المُقدَّمة للمخالفين، بل في تصور كلّ منهم للتاريخ المُسيَّق فيه النصّ، وما يترتب على هذا من تصور للنصّ ولعلاقته بالتاريخ، ولعلّ نصر نفسه يَلْمَحُ ذلك حين يتحدث عن كون (تزامنية أركون عليها أن تتعلّق بالزمن المحدود بدلًا من الزمن غير المحدود)[xvi]، فخلافهم هو خلاف في معنى التاريخ محدود/غير محدود، وما يرتبط به من تصورهم لكينونة النصّ ووقائعيته.
هذا الإهدار لوحدة النصّ وانسجامه وكينونيته جعل علي حرب يعتبر نصر أهدر «وقائعية النصّ»[xvii]، الذي كان يعتبر خطابه بأكمله دفاعًا عنها! فبينما كانت التاريخية كمقولة هدفها تحييد الإلهي عن ابتلاع النصّ -المُستَقِلّ في قوانين تَشَكُّله وقراءته عنه- بحيث يُقرأ فحسب وفقًا للدرس العلمي الحديث دون انشغال بأصله الإلهي، فإنَّ الأمر انتهى لابتلاع الواقع الضيّق تمامًا و«التاريخ اليومي» و«قصير المدة المعاد تشكيله» لهذا النصّ؛ مما حرمه من أي وقائعية خاصّة -حتى لو كانت تاريخية- تُعطيه حضورًا وحركة في مواجهة هذا الواقع/السجن.
رهانات الخطاب، و«التاريخ» المأزق:
هذه الملامح الخاصّة لتاريخية نصر كنتاج لتصوّره لـ«التاريخ» كمفهوم مركزي في الخطاب مهمّة تمامًا في فَهم أبعاد خطاب نصر؛ حيث كانت قضيّة «وحدة القرآن» الناتجة عنها محورًا للتجاذب بين مفاهيم الخطاب من جهة، وبين رهانات الخطاب من جهة أخرى، فكما تحدّثنا بالأعلى عن تقنية هيرش، فهذه التقنيةُ كانت محاولةً لإنقاذ رهان «حركة النصّ» و«حضوره»/«وقائعيته» -وهو الرهان المُضيَّع بسبب تصور التاريخ- عَبْرَ افتراض تأسيس علمي حديث يَعتَمِدُ التسييق التاريخي لتحديد مقاصد/كليات/مرتكزات للقرآن، تُعطي هذا النصّ مركزًا يُوحِّد دلالاته، ويمنح له حضورًا في مواجهة الواقع الجاهلي وحركة في الأزمنة المعاصرة، لكن هذا الإنقاذ تمَّ دون الالتفات لعلاقة كلّ مآزق الخطاب بتصوّر التاريخ الذي ينطلق منه، والذي يسجن النصّ بالفعل في تاريخ ضيق، ويحرمه من كلّ وحدة ومن أي مركز دلالي، فيجعلُ كلّ تحريك له تلفيقًا وإسقاطًا، حيث بعد إهدار ما يمكن أن يُعطي للنصّ وقائعية وحضورًا وحركة من داخله بنفي وحدته لا يمكن أن يتمَّ هذا التحريك إلا عبر استحضار كليات للنصّ من خارجه، بالنسبة لنصر كانت هذه الكليات هي أمنيات التنوير العربي -وعلى رأسها العقلانية بالمعنى الحديث- مقروءة ككليات للنص، وهذه مفارقة كبيرة بالطبع، فنصر الألسني لم يأتِ بكليات النصّ من النصّ، ونصر التاريخي لم يأتِ بكليات النصّ من التاريخ، بل أتى بها نصر -الأيدولوجي دعنا نقول[14]- من أمنيات التنوير العربي!![15]
كلّ هذا جعل تأسيس فكرة التاريخية في خطاب نصر يظلُّ غير متماسك رغم كلّ محاولات نصر لإنقاذ رهانات الخطاب؛ بل إنَّ هذا الاستمرار في تجاهل المأزق الرئيس للخطاب «مفهومه للتاريخ» أوقع الخطاب في كثير من التناقضات التي لا تقف عند نفي «وحدة النصّ» وإدانة المدونات التقليدية التفسيرية والأصولية على الاهتمام بها، ثم محاولة فرض أي وحدة عليه والعودة لإدانة المدونات التقليدية التفسيرية والأصولية على تجزئة النصّ هذه المرة! بل تصلُ حدَّ جعل الخطاب يتراجع عن منطلقه ذاته الذي بذل أكبر الجهد في تأسيسه، والذي يُعطيه موقعه المهمّ على خارطة الدرس الحداثي للقرآن، نقصد «الأرخنة» كأساس للدرس الحديث للقرآن!
فعلى عكس هذا المنطلق والذي يقضي بأنه وطالما تمَّ اعتبار النصّ تاريخي فإنه يُقرَأُ بعدما تموضع بشريًّا دون حاجة لاستحضار ألوهته كمُحدِّد للقراءة، وهو المنطلق الذي بدا نصر مُصِرًّا عليه في كلّ مرافعة عن فكرة التاريخية، وبكلّ الطرق الممكنة[16]، فإنَّ فكرة المقاصد التي عَهِد لتقنية هيرش بتحديدها كغاية لفعل القراءة تجعل النصّ لا يُقرَأُ إلا في استحضار الإلهي، فبدون استحضار مقاصد قائل النصّ- «مقاصد الوحي» كما يُعبِّر نصر- وخطته في الكتابة وفي التحوير الدلالي وفي مراعاة السياق التاريخي؛ فإننا لا نستطيع قراءة النص وتحديد مغازيه[17] التي تُحدِّد كغاية للقراءة مُتّجَه «مقاصد الوحي الفعلية»[xviii]، إنّ «الله» يعود في تأويلية نصر كمُحدِّد للقراءة، كمُؤلِّف نموذجي[18]لـ«نصّ في أرقى مستويات البناء!»، ويتحوّل القارئ -أفق الرسالة- الذي كان يُريدُه نصر مشاركًا في عملية «إنتاج المعنى» -هذا الذي لا يحمل أي إطلاقية أو ثبات- إلى «قارئ نموذجي» عليه اكتشاف الخطة المنبثة في النصِّ «مراعاة السياق التاريخي واستراتيجيات التحوير الدلالي»؛ لاكتشاف مراد القائل «المؤلف الفعلي» -الأزلي حتمًا لارتباطه بصفة ذات أي العلم[19]-، بالطبع على حسب الجهد! مما يجعل تأويليّة نصر بهذا مجرد «تلوين» حديث للتأويلية الكلاسيكية التي يرفضها بشدّة ولا يتوقف عن إدانتها لأسباب متناقضة!!
* * *
كلّ هذه المحاولات لتأسيس فكرة التاريخية بشقّيها، وكلّ هذه التجاذبات بين المفهوم المركزي في الخطاب «التاريخ»، ومنطلقاته «الأرخنة كأسس للدرس الحديث للقرآن»، ورهاناته «تحريك المعنى» و«تجاوز التلفيق»، بكلّ آثارها على تماسك الخطاب؛ كانت تُمثِّل مرحلة ما في خطاب نصر، هي مرحلة التّعامل مع القرآن كـ«نص» -بمركز دلالي أو دون مركز دلالي-، في مرحلة لاحقة سيتمُّ التعامل مع القرآن كـ«خطاب»، بذا سيتم التخلّص من هذا التذبذب الناتج من الصراع بين الرهان والتصورات والمنطلقات، بافتراض طبيعة جديدة للقرآن «القرآن كخطابات متداولة» قد تكون أفضل في تحقيق رهانات الخطاب وأكثر ارتباطًا بمفهوم التاريخ المتبنى من قبله، وأيضًا بمفهوم سنتناوله لاحقًا بدقة هو مفهوم «سلطة النصوص»، لكن هل هذا التأسيس الجديد لطبيعة القرآن كـ«خطاب» كان أفضل حالًا من تأسيس مقولة التاريخية كطبيعة للقرآن، ومُحدِّد للقراءة وطريق لنزع سلطة النصّ؟ وهل استطاع هذا التأسيس الجديد لطبيعة جديدة للقرآن تلافي كلّ تناقضات الخطاب، وتحقيق انسجام بين أبعاده أولًا قبل أن نتساءل عن فعالية تأويليّة مُنتَظرة؟ هذه أسئلة نُنهي بها مقالنا هذا آملين محاولة تقديم بعض الإجابات عنها في المقال القادم.
[1] نستطيع القول بأنَّ فكرة تاريخية بعض مساحات القرآن وارتباطها بالسياق القرشي الذي تنزل في سياقه النصّ، خصوصًا التشريعات وبصورة أقلّ القصص والعقائد، كانت متداولة في كتابات كثيرة فيما قبل نصر، لكنَّ خطاب نصر قام بتوسعة مجال التاريخيّة ليشمل كلّ القرآن، وكذلك -وهو الأهم- قام بمحاولة تأسيس لهذه الفكرة بشكل علمي متماسك. وربما من أهم هذه الكتابات السابقة على نصر والتي عاملت التشريعات كأمر تاريخي كتاب محمد النويهي «نحو ثورة في الفكر الديني»، وبالنسبة للتعامل مع القصص القرآني كاستخدام لمعهود العرب وللقصص الشائع في السياق التاريخي للدعوة، فأهم كتاب هو كتاب خلف الله «الفن القصصي في القرآن»، أمَّا بالنسبة للتصورات العقدية وارتباط بعضها بعقائد الجاهليين وتصوراتهم، فربما يعدّ تفسير محمد عبده للكائنات غير المرئية «الجنّ، الشياطين، الملائكة» بأنها قوى نفسية وروحية لا كائنات لها وجود موضوعي خارج الإنسان هو الأشهر في هذا السياق. انظر: تفسير المنار، دار المنار، القاهرة، ط2، 1947 الجزء الأول، ص267-270.
[2] نستخدم هنا تعبير «الأرخنة» بشكل مغاير لكن ذا اتصالٍ باستخدام طه عبد الرحمن لمفهوم «خطة الأرخنة»، فطه عبد الرحمن يرى أن ثمّة استراتيجيات للقراءة الحداثية، هدف كلّ استراتيجية منها إزالة عائق اعتقادي معين، من هذه الاستراتيجيات «استراتيجية الأرخنة»، والتي تهدف لإزالة عائق «حُكمية النصّ» عبر وصل الآيات بسياقها التاريخي لتنسيب الأحكام القرآنية وإخراجها عن حكم الثبات والأبدية، وظننا أنَّ وصل الآيات بسياقها ليس مجرد وسيلة لنزع الحُكمية، بل إنه وسيلة لتغيير طبيعة النصِّ من أجل إمكان موضعته في حقل العلوم الحديثة ومنهجياتها؛ لذا فالأرخنة (وصل الآيات بسياقها) ليست نتيجة للاشتغال الحداثي، وليست وسيلة لبعض أهداف جزئية مثل إزالة عائق الحُكمية، بل وسيلة لإمكان درس القرآن حداثيًّا بتغير طبيعته وإثبات صلته بالتاريخ، تغيير طبيعة النصّ هذه هي التي سيترتب عليها إزالة كلّ العوائق التي يتحدث عنها طه عبد الرحمن «عائق القدسية» «عائق الغيبية» كنتاج طبيعي، لهذا وكما سنوضح في اشتغالنا على نصر هنا، فإنَّ تاريخية نصر ذات شقين؛ شقّ ينشغل بإثبات اتصال الآيات بالتاريخ أي ينشغل بالأرخنة، وشقّ ينطلق من هذا نحو الهدف الأساس لهذه المقاربات، أي شرعنة التسييق التاريخي كأداة مركزية في تفسير للنص.
[3] يشيرُ أركون تحديدًا في دراسته للوحي (لضرورة استخدام كلّ مصادر التفكير والمعقولية الحديثة التي تقدمها لنا علوم الإنسان والمجتمع؛ من أجل زحزحة إشكالية الوحي في النظام الفكري والموقع الإستمولوجي الخاصّ بالعقلية الدوغمائية إلى فضاءات التحليل والتأويل التي يفتتحها الآن العقل الاستطلاعي الجديد المنبثق حديثًا)، وهي استراتيجية مستمرة في كتابات أركون حيث يُجري تعديلًا على كلّ المفاهيم المتعلقة بالقرآن، القرآن والآية فيجعلها «الظاهرة الإسلامية» و«الظاهرة القرآنية» و«الوحدة النصية المتمايزة» من أجل أن يتخلص من الحمولة اللاهوتية المشحونة بها هذه المفاهيم. انظر: «القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني»، ص27، 75، هامش هاشم صالح في ص119، وسنعود لهذا تفصيلًا في مقالاتنا القادمة حول أركون.
[4] إذا كان المعنى وفقًا لكلّ التقليد التفسيري، هو معنى إلهي، يستنفذُ الإنسان جهده في بيان ما يستطيع بيانه منه، فإنَّ المعنى في نصوص نصر معنى بشري، ثمّة إصرار من نصر على هذا حيث يقول في «نقد الخطاب الديني»: (إنَّ القول بإلهية النصوص والإصرار على طبيعتها الإلهية يستلزم أنّ البشر عاجزون بمناهجهم عن فهمها ما لم تتدخل العناية الإلهية بوهب بعض البشر إمكانات خاصة للفهم)، ويقول في «النصّ، السلطة، الحقيقة»: (وبما هو تاريخي فإنَّ معناه لا يتحقق إلا بالتأويل البشري، أنه لا يتضمن معنى مفارقًا جوهريًّا ثابتًا له إطلاقية المطلق وقداسه الإله)، ورغم أنّ المعنى عند نصر يبدو وكأنّه معنى مُكتشَفًا، إلا أن هذا المعنى المُكتشَف يظلُّ للسياق التاريخي للقارئ دورٌ في بنائه، مما يجعل إنتاج المعنى عند نصر متأرجحًا بين كونه اكتشافًا وبين كونه بناءً للمعنى، إلا أنه في الأخير معنى بشري. انظر: نقد الخطاب الديني، ص206.
[5] فردناند دي سوسير، العالم السويسري، هو مؤسس المدرسة البنيوية في دراسة اللغة، والتي أَوْلت الاهتمام لدراسة المنظور السانكروني الآني في دراسة اللغة، بعدما كان المنظور الدياكروني أو التعاقبي أو التاريخي هو الأكثر ارتيادًا في دراسة اللغة، وبعد سوسير اتّسع الدرس البنيوي بحيث ظهرت وإلى جانب الألسنيات البنيوية الأنثروبولوجيا البنيوية مع شتراوس، وعلم النفس البنيوي مع لاكان، بل تحولت البنيوية لفلسفة وليس مجرد منهج في البحث، ومن الكتب التقديمية المبسطة والماتعة والعميقة في آن في هذا السياق، كتاب مشكلة البنية لزكريا إبراهيم، مكتبة مصر.
[6] في كتابه «الله والإنسان في القرآن» ينطلق ايزوتسو من تقسيم المعجم العربي لثلاثة سطوح دلالية: السطح الدلالي الجاهلي، والسطح الدلالي القرآني، والسطح الدلالي اللاحق للقرآن (العصر العباسي خاصّة، والذي ابتدأ فيه تدوين العلوم)، والمقصود بالسطح عنده هو اصطناع حالة سكونية في مسيرة تطور الكلمات تاريخيًّا بغرض منهجي هو دراستها «سانكرونيا» أو آنيًّا، ولهذا أثر كبير على فهم التغييرات الدلالية التي أدخلها كلّ سطح من هذه السطوح الثلاثة على المفاهيم، من حيث دلالتها، ومن حيث موقعتها في الحقول الدلالية، ومن حيث إعادة تحديد الكلمات المفتاحية لرؤية العالم. انظر: «الله والإنسان في القرآن، علم دلالة الرؤية القرآنية»، تيوشيهكو ايزوتسو، ترجمة: هلال محمد الجهاد، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، ط1، 2007، ص72، 73.
[7] هذا على حسب أشهر التقسيمات، والتي تقسّم الهرمنيوطيقا لثلاثة مراحل: الكلاسيكية، وتمتد من اليونان إلى ما قبل شلايرماخر، والحديثة، وتمتد من شلايرماخر إلى أواخر القرن التاسع عشر، والهرمنيوطيقا المعاصرة، والتي تبدأ مع دلتاي وتصل إلى هيدجر وجادمر وريكور وليفيناس.
[8] هذا التفريق يتعلق بأحد مراحل تأويل النصّ عند شلايرماخر، وهي مرحلة التفسير الأدبي، ثمّة مرحلة أخرى هي مرحلة التفسير النفسي؛ حيث للنصّ جانبان، لغوي ونفسي، موضوعي وذاتي، وحيث يحاول التأويلي الوصول لإدراك عملية الإبداع ذاتها بغية فهم النص أفضل من كاتبه.
[9] فيشير نصر في «مفهوم التاريخية الملتبس» لكون القرآن من حيث هو «كلام» فإنَّه يستمد مقدرته القولية من «اللغة»، ويؤكد على كون المقصود باستمداد المقدرة القولية هو النصّ من حيث هو نصّ ثقافي موجّه لبشر في ثقافة بعينها، وليس من حيث مقدرة القائل أي الله، في هذا السياق فإنَّ نصر يظلُّ متماشيًا مع تصوّره عن استقلال قانون بناء النصّ تجاه الإلهي، مما يمكن من دراسة النصّ دون اعتبار الله مُحدِّدًا في عملية القراءة، لكن في «نقد الخطاب الديني» نجد نصر يتحدث عن مراعاة السياق التاريخي وعدم مصادمة الأعراف والتقاليد؛ مما يجعل الحديث هنا هو عن إرادة إلهية مراعية وليس عن قانون. انظر: «النصّ، السلطة، الحقيقة»، ص87، «نقد الخطاب الديني»، ص223.
[10] يقول نصر في «النص، السلطة، الحقيقة»، ص33: (وبما هو «تاريخي»، فإنَّ معناه لا يتحقق إلا من خلال التأويل الإنساني، أنه «لا يتضمن» معنى مفارقًا جوهريًّا «ثابتًا» له إطلاقية المطلق وقداسة الإله، على العكس من ذلك يقضي مفهوم «قدم الكلام الإلهي» بـ«تثبيت» المعنى الديني)، في هذا فإنَّ نصر يتفق تمامًا مع من يقول إنه يعارضهم في تصورهم للتاريخ كموضع تغير وهدم ونقض وتشذر، لكن بينما هم يقولون بوجود سابق للنصّ في اللوح المحفوظ من أجل حمايته من هذا الوقوع في التاريخ وتغيره وتشذّره -أي من أجل حفظ كينونة له-، فإن نصر يرفض احتفاظ النصّ بأي كينونة أو وحدة متماسكة بسبب تاريخيته بالذات!
[11] رغم أنَّ نصر أبو زيد يذكر أن الواقع القرشي لم يكن متجانسًا، بل كان ينطوي على واقع مسيطر وآخر نقيض يناهضه، وأنَّ (محمدًا لم يكن ينتمي في هذا الواقع إلى الواقع المسيطر ونمط القيم السائد فيه)، ويذكر الحنيفية كحركة فكرية (لم يكن محمد معزولًا عنها)، ويشير لأهمية دين إبراهيم في هذه الحركة، إلا إنَّه يقلصه إلى حدّ كونه أيدولوجي الطبقات الثائرة الذي يعطيها هوية، فضلًا عن كونه يقلّص حضور المسيحية واليهودية لأيدلوجيتين لا تستطيعان تحقيق أهداف الثائرين، في خضم هذه الأيدولوجيات المتناحرة، ينسى نصر أن بحثه الألسني عن المفاهيم في «اللغة» الجاهلية ينبغي أن يراعي وجود معجم كتابي يشمل كلمات «النبوة» و«الوحي» و«الشياطين» و«العرش»؛ مما يجعل عدمَ وجود أساس ثقافي يؤسس للنبوة، أو عدم وجود مقدرة «للغة» لتؤسس في «الكلام» القرآني معنى النبوة، كلامًا شديد الغرابة، ولعلّ ايزوتسو في المقابل قد أكّد على أهمية هذا المعجم، حيث قسّم السطح الدلالي الجاهلي لثلاثة معاجم: المعجم البدوي، والمعجم التجاري، والمعجم اليهودي-المسيحي. إنّ نصر هنا تحوّل لمحلل اجتماعي لا لألسني! انظر: مفهوم النصّ، نصر أبو زيد، ص68، 70، 72، 73، وانظر: الله والإنسان في القرآن، توشيهيكو ايزوتسو، ص75.
[12] يخلط نصر بين عدم معرفة الوحي أو «إمكانه» بتعبيرات علي حرب، وبين معرفته ونفيه قصدًا خارج إطار الدين الجاهلي، فالوحي الذي كان معروفًا للجاهليين نتيجة معرفتهم بالأنبياء من خلال اتصالهم بالمسيحية واليهودية، الذين شكلت مفاهيمهم جزءًا من المعجم اللغوي القرشي، كانوا ضدّ الإيمان به، وهذا لكون الوحي ونبوته الحصرية والتوحيدية يعمل على مصادمة الاجتماع القبلي الجاهلي القائم على التفتت «اللقاحية»، والذي يرتبط فيه كـ«ظاهرة كلية» -بتعبيرات مارسيل موس- نفي وحدة الزعامة ونفي وحدة الدين وحصريته، من هنا حاصر الجاهليون الوحي وحاولوا دمجه في تصوراتهم عن الكهانة كوسيلة واحدة لقبوله، في إطار مقاومتهم لكلّ ما يؤدي إلى خطر الاندماج في دولة، ومن هنا أصرَّ القرآن على إبراز اختلاف الوحي عن الكهانة وعدم إمكان وجوده لجوارها. فالحديث ليس عن عدم معرفة تؤسس لعدم الإمكان، بل عن عدم إمكان قبول ظاهرة معروفة مُؤسَّس على معرفة بالنتاجات الكلية الدينية والاجتماعية لها، لتحليل دقيق لهذه الإشكالات وعلاقة «اللقاحية الجاهلية» بـ«الدين الجاهلي» وتحريم الإسلام لممارسات جاهلية مثل «الميسر» في إطار تكريس «التوحيد» بمختلف أبعاده الديني والاجتماعي والسياسي. انظر: المقدمة الطويلة لكتاب «من الميسر الجاهلي إلى الزكاة الإسلامية»، محمد الحاج سالم، دار المدار الإسلامي، ط1، 2014، خصوصًا من ص42، إلى ص58.
[13] فردناند بروديل هو أحد أبرز الأسماء في مدرسة الحوليات التاريخية الفرنسية، وهي المدرسة التي ظهرت بتأسيس مجلة الحوليات عام 1929، وعلى رأسها لسيسان فيفر ومارك بلوخ، فقطعت مع عزوف المؤرخين في بدايات القرن العشرين عن دراسة كلّ ما له علاقة بالمجتمع والاقتصاد والذهنيات، وطالبت ببعث تاريخ جديد يُعنى بهذه المسائل، ويولي أهمية خاصة للبنى المستترة، ويقلص من السياسي و«تاريخ الكرّ والفرّ»، ومن التاريخ الحدثي بصفة عامة، ويعتني بالناس العاديين وبالمهمشين وبالمغيبين، ويعد بروديل من أبرز من رأس هذه المدرسة منذ عام 1969، وأسس مفاهيم «الأمد الطويل» و«المتوسط» و«القصير» في محاولة لتأسيس علم التاريخ في مواجهة رواج مفهوم البنية، واعتبار البنيويون التاريخ ليس علمًا. انظر: المدارس التاريخية الحديثة، الهادي التيموثي، التنوير، بيروت، ط1، 2013، ص179، 180، 185.
[14] يفترض كريم الصيّاد في دراسة بعنوان «منهج الحفر الأيدولوجي عند نصر أبو زيد»، أن قراءة نصر أبو زيد للتراث هي قراءة تدخل فيما أسماه «الحفر الأيدولوجي»، كمنهج يستخدمه أغلب المفكرين العرب في تعاملهم مع التراث -على الأقل الثلاثة الذين ركزت عليهم ورقته، أي حسن حنفي ونصر أبو زيد وعلي مبروك، مدرسة القاهرة الفلسفية-، والقراءة عبر الحفر الأيدولوجي، هي قراءة تسعى لتغيير الواقع المعاصر عبر قراءة للتراث تنتهج الانتقاء لموضوع بحث من التراث -مدرسة أو مذهب أو عالم- وإعادة بناء النموذج المنتقى ثم إسقاط الصراع السياسي- الاجتماعي على مجمل الصراعات التي يدخل فيها النموذج المعاد بنائه، للخلوص لكون كلّ هذه الصراعات هي ذات أصل سياسي- اجتماعي، وهذا لتحقيق أهداف معاصرة تغيرية؛ منها: إسقاط الخصوم المعاصرين، وبيان نسبية المطلقات الافتراضية، وإن كان اشتغال الصياد اقتصر على مسألة التراث، وخصوصًا كتاب «الشافعي وتأسيس الأيدلوجية الوسطية»، إلا أننا في حقيقة الأمر نستطيع لمس نتائج هذا الحفر الأيدولوجي في تعامل نصر مع القرآن وتاريخه كذلك، فنصر كذلك يُعيد بناء تاريخ قريش، ثم يقوم بإسقاط الصراع السياسي- الاجتماعي على كلّ صراعاته؛ لكي يتقلص بهذا الواقع القرشي لواقع محتقن ثوريًّا بسبب صراعات طبقية باحثة عن أيدولوجي لتأطيرها، وبحيث يتمُّ قراءة الصراعات القرشيّة الفكرية ما بين الوثنية والإبراهيمية والمسيحية واليهودية باعتبارها في الأصل فحسب صراعات سياسية اجتماعية، كما أنه يعيد بناء القرآن نفسه وتحديد مرتكزاته بحيث تسقط عليه خلافاته وخلافات التنوير العربي مع خصومه، والتي هي خلافات يُنظَر لها كخلافات ذات أصل سياسي واجتماعي كذلك، ونحن لا نحتاج هنا الجدال طويلًا حول عدم فعالية هذا المنهج الأيدولوجي الانتقائي والتلفيقي؛ حيث إنَّ نصر نفسه تكفّل بنقده ونقد سماته في كلّ مشاريع الإصلاح السابقة عليه وخصوصًا مشروع اليسار الإسلامي مع حسن حنفي، لكنه مع هذا لم ينتهج منهجًا مغايرًا! انظر: منهج الحفر الأيدولوجي، كريم الصياد، مؤمنون بلا حدود، 27 نوفمبر، 2017.
[15] في حين نجد مفكرًا آخر مثل محمد عابد الجابري، وهو مفكر يقرأ القرآن كذلك باستحضار سياقه التاريخي كمحدد رئيس للقراءة، يستقي «كليات القرآن» المُشكِّلة لوحدته من خلال تتبع القرآن في ترتيب نزوله؛ لذا فإنَّ هذه «الكليات» تأتي مساوِقة لتاريخ الدعوة المُسيَّق فيه القرآن، وسنتعرض لهذا تفصيلًا في مقالنا اللاحق عن محمد عابد الجابري.
[16] فيشير نصر لضرورة هذا المنطلق من أكثر من زاوية، من زاوية عدم إمكان درس قائل النصّ أي الله، ومن زاوية كون اعتبار المعاني إلهية يجعل من غير الممكن فهم النصّ، ومن ناحية كون النص رسالة ودعوة وبلاغ.
[17] يستخدم نصر هنا كلمة «مغزى» بدلالتين متعارضتين؛ الدلالة الأولى، هي الدلالة التي تتبادر للذهن فورًا من كلمة «مغزى» أي مقصد، وهذا هو الذي يصل للذهن بقراءة تطبيق نصر لتقنية هيرش في قضية الميراث. أما الدلالة الأخرى، فهي دلالة «مغزى» كمقابل لـ«معنى» عند هيرش، فال«مغزى» عند هيرش هو نتاج حركة النصّ في التاريخ مستقلًّا عن مقصد القائل وعن «معنى» النصّ؛ لذا فهو متغير بالنسبة للمؤلف نفسه بسبب حركة كلّ منهما في التاريخ، وهذا ما يشرحه نصر عن هيرش في «إشكاليات القراءة وآليات التأويل، ص48»، وهذا الاستخدام لـ«مغزى» بدلالتين متعارضتين مع علم نصر بالدلالة التي يريدها هيرش والتي لا تتعلق أبدًا بمقصد القائل، بل هي مستقلة عنه، يعتبر تلفيق كبير من نصر في استخدام تقنية هيرش، تلفيق عابه على غيره من الكتّاب الحداثيين قبله مثل طه حسين وزكي نجيب، فنصر يفرّغ تقنية هيرش من دلالتها المخلصة تمامًا للتاريخ؛ لتندمج في عملية كشف المعنى الإلهي الأزلي المنبثّ في النص عبر الأزمان!
[18] نستخدم تعبيرات «قارئ نموذجي» و«مؤلف نموذجي» استعارة من إمبرتو إيكو (1932- 2016) السيميائي والفيلسوف والروائي الإيطالي، حيث يقسم إيكو القرّاء لـ«قارئ تجريبي» أو قارئ فعلي و«قارئ نموذجي»؛ فالقارئ التجريبي هو أي قارئ للنصّ، أمّا «القارئ النموذجي» فهو فرضية يبنيها «المؤلف النموذجي» كاستراتيجية تحضر في النصّ لتقليل حقل احتمالات التأويل تحقيقًا لـ«اقتصادية التأويل»، و«المؤلف النموذجي» هو فرضية يبينها «القارئ التجريبي» من أجل الوصول لمقصد النصّ، أو لخطة المؤلف المبثوثة نصيًّا، من أجل تقليل احتمالات التأويل، فيما يسميه إيكو «بالتعاضد النصّي»، إلا أن إيكو يشير لكون «المؤلف النموذجي» المبني عبر «القارئ التجريبي» قد لا يقارب «المؤلف التجريبي» في شيء، وهذا لسبيين؛ الأول: المسافة بين «المؤلف التجريبي» وبين خطته المبثوثة في النصّ «قارئه النموذجي» الذي بناه وبين «القارئ التجريبي». والثاني: المسافة بين «القارئ التجريبي» وبين «مؤلفه النموذجي» الذي بناه وبين «المؤلف التجريبي»؛ لذا فهناك أدوار على «القارئ التجريبي» القيام بها من أجل الاقتراب من «المؤلف التجريبي».
بالنسبة للقرآن وفقًا لقراءة نصر، فإنَّ ما يبدو هو أن نصر لا يقيم مسافة بين الله كـ«قائل للنصّ» وبين خطة بناء «القارئ النموذجي» المتمثلة في «المقاصد -المغازي- المعاني- مراعاة السياق التاريخي- التحوير الدلالي»، كذلك فهو يجتهد في إعطاء «القارئ التجريبي» للقرآن القدرة على الوصول لهذه الخطة للاقتراب من مقصد القائل الفعلي أي الله «مقاصد الوحي» عبر آليات القراءة المعتمدة التسييق التاريخي، وهذا يجعل قراءة نصر رغم استعانتها بهيرش ورغم استعانتنا لتوضيحها بإيكو تعود فتصير تفسيرًا بالمعنى الكلاسيكي أي (بيان مقصد الله المبثوث في النصّ على قدر الجهد). انظر: القارئ في الحكاية، إمبرنو إيكو، ترجمة أنطوان أبو زيد، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، بيروت، ط1، 1997، ص 77، 78، 79.
[19] في دراسته التي ذكرناها هنا مرارًا «التاريخية: المفهوم الملتبس» يشير نصر لكون فكرة أزلية القرآن فكرة مرتبطة بتصور خاصّ للصفات الإلهية، يخلط ما بين صفات الفعل وصفات الذات، فيخلط بين «القدرة» كصفة أزلية قائمة بالذات، وبين الفعل المرتبط بالحوادث، والذي يدل على هذه القدرة رغم حدوثه في الزمان وتاريخيته، فبمثل هذا الخلط تمّ الخلط بين صفة «الكلام» وصفة «العلم»، فالعلم صفة أزليّة قائمة بالذات لكنها تتجلى في الحوادث التي تفعلها القدرة، فتظهر في إحكام وحكمة هذه الحوادث، كما يىستدلّ المعتزلة، لكن التصور الذي ساد في التراث الإسلامي قام بربط صفة «الكلام» بصفة «العلم» كصفة أزلية مما أنتج تصور أزليّة القرآن؛ لذا يقوم نصر بإعادة الكلام الإلهي لصفات الفعل كأحد تجليات «القدرة» في التاريخ.
ونحن حين ننظر لربط نصر بين معاني القرآن ومغازيه وبين «مقاصد الوحي» فإننا نتساءل عن فائدة كلّ الذي قاله نصر وموقع استعادة كلّ هذا الجدل الكلامي من الإعراب، فهذا الربط لا يجعل القرآن الحادث في الزمان مجرد فعل يدلّ فحسب على أزليّة القدرة والعلم، بل يجعله فعلًا يرتبط تمامًا بأزليّة هذا العلم فهو أساس مقاصده التي توجه الفعل وتسبقه وتحور دلالاته لإنتاج المغازي وتحريك المعنى؛ مما يعني إعادة ربط القرآن بصفة العلم مرة أخرى، وهو ما انتقده نصر!
[i] روح الحداثة، طه عبد الرحمن، ص184.
[ii] نقد الخطاب الديني، نصر أبو زيد، ص220، الخطاب والتأويل، نصر أبو زيد، ص203.
[iii] التحرير في أصول التفسير، مساعد الطيار، ص41.
[iv] مفهوم النص، ص27، نقد الخطاب الديني، ص200.
[v] «التاريخية: المفهوم الملتبس»، منشورة في كتاب «النص، السلطة، الحقيقة»، ص80.
[vi] نقد الخطاب الديني، ص203.
[vii] «النص، السلطة، الحقيقة»، ص87.
[viii] نفسه، ص75.
[ix] نصر حامد أبو زيد، نقد الخطاب الديني، ص221.
[x] نفسه، ص222.
[xi] نفسه، ص224.
[xii] نفسه، ص213.
[xiii] مفهوم النص، نصر حامد أبو زيد، ص38.
[xiv] نصر حامد أبوزيد، التجديد والتحريم والتأويل، ص211، 212.
[xv] الفكر الإسلامي، قراءة علمية، محمد أركون، ص201.
[xvi] الخطاب والتأويل، نصر أبو زيد، ص120.
[xvii] الاستلاب والارتداد، علي حرب، المركز الثقافي العربي، بيروت، الدار البيضاء، ط1، 1997، ص101.
[xviii] نقد الخطاب الديني، ص222.
كلمات مفتاحية
الكاتب:

طارق محمد حجي
باحث مصري له عدد من المقالات البحثية والأعمال المنشورة في مجال الدراسات القرآنية.
مواضيع ذات صلة
((المعلومات والآراء المقدَّمة هي للكتّاب، ولا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع أو أسرة مركز تفسير))