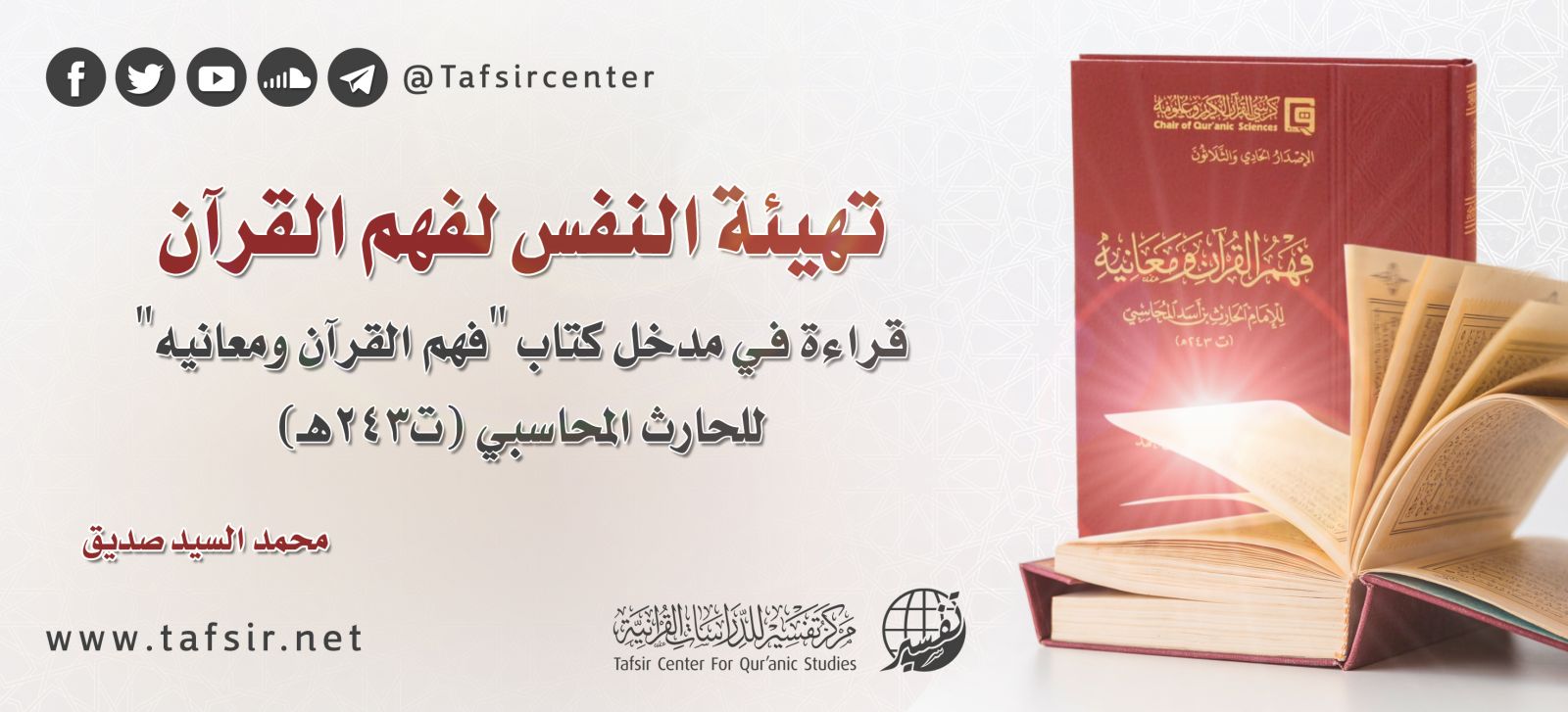مدخل، المحددات الرئيسة للقراءات الحداثية للقرآن
مدخل، المحددات الرئيسة للقراءات الحداثية للقرآن
الكاتب: طارق محمد حجي
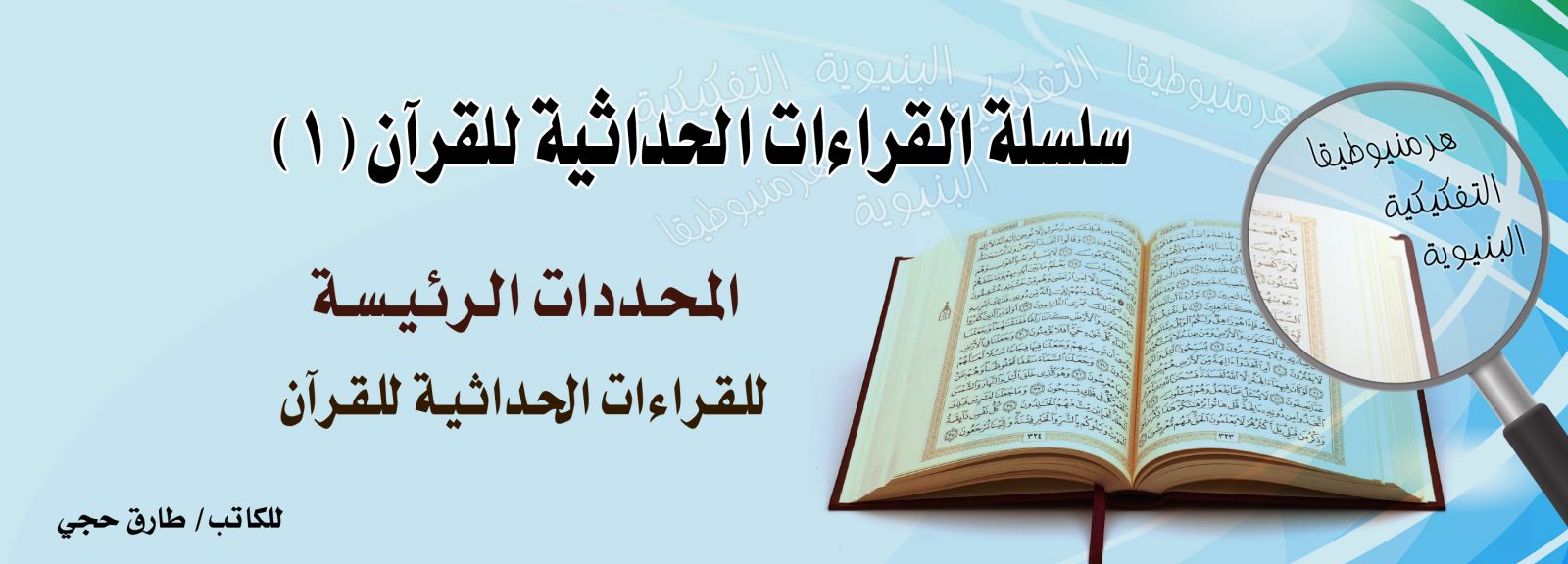
مدخل: المُحدِّدات الرئيسة للقراءات الحداثية للقرآن:
بالرغم من الشيوع الواضح لاستخدام مصطلح «القراءة الحداثية» لوصف عدد معين من الدراسات المعاصرة حول القرآن (مثل كتابات نصر أبو زيد، ومحمد أركون، وعابد الجابري، والطيب تيزيني، ويوسف الصدّيق، وغيرهم)، إلا أن هذا الاستخدام في ظننا يبتعدُ كثيرًا عن الدِّقة، ويُعاني من قدر ليس بالقليل من الغموض أو ربما حتى من الفوضى، والتي لا تقتصر بطبيعة الحال على التعامل مع هذا المصطلح وحده؛ بل تتعدَّاه لتشمل التعامل مع مجمل المصطلحات المـُتّصِلَة به، سواء التي يُنظر لها كمصطلحات مقابلة له مثل «القراءة التقليدية»، و«القراءة التراثية»، و«القراءة الإحيائية» ([1])، أو تلك التي تتبادل معه موقع العنونة على هذه القراءات مثل «القراءة التجديدية»، و«القراءة العصرية»، و«القراءة العصرانية».
ولعلَّ هذا الغموض والتشوّش والابتعاد عن الدِّقَّة في تحديد هذه المصطلحات -والمـُفضِي لتداخلها وتبادلها في كثير من الأحيان- يَتَّصِلُ فيما يتصل بإشكالٍ أعمق، هو إشكالُ تصنيف القراءات المعاصرة للقرآن -منذ لحظة دخول العرب في الأزمنة الحديثة بتعبير فهمي جدعان-، فمع غياب معايير واضحة مُتّفَق عليها من أجل إجراء كهذا لتصنيف هذه النتاجات الواسعة من تفاسير ودراسات -أكثر من عشرين تفسير طويل ([2])، إضافة إلى أكثر من ثلاثين دراسة قرآنية متميزة، فضلًا عن بحوث ومقالات لا تدخل تحت حصر ([i]) -كما يذكر النيفر- تظلُّ الحدود بين القراءات غير واضحة، وتفتقد المصطلحات دقتها الدلالية فيما تشير إليه، ومنها بالطبع وربما على رأسها المصطلح الذي يشغلنا هنا بالأساس أي «القراءة الحداثية».
لذا فربما علينا أولًا وكخطوة أساسية في اشتغالنا، البدء بمحاولة تحديد أبعاد هذا المصطلح، وتحديد مصطلح «القراءة الحداثية»، يعني بالنسبة لنا محاولة بَنْيَنَةبرنامج القراءة الحداثية، بتحديد بنائه التصوّري، وبنائه المنهجي بالمعنى الأوسع أي الذي يشمل، وإلى جانب التقنيات المنهجية الدقيقة (جملة المفاهيم التي تؤطِّر النصّ من حيث طبيعته وحركته ووظيفته) ([ii])، وأسس انطلاقه، وآفاقه، ورهاناته، وكشف الصلات بين هذه الأبعاد كلّها؛ حتى نستطيع إيجاد تحديد دقيق لهذه القراءات.
وهذا يتطلب منّا عددًا من الإجراءات، فسيكون علينا القيام باستعادة ولو موجزة لتاريخ القراءات القرآنية الحديثة والمعاصرة، وتحديد معيار لتصنيف هذه القراءات؛ حتى نستطيع مَوْقَعَة «القراءات الحداثية»، وتحديد معالم افتراقها عن غيرها، كما سيتوجب علينا البحث في السياقات المعرفية المُنشِئة لهذه القراءة، كذا تحديدُ الرهانات التي تَعِدُ بتحقيقها، وهذا ما سنحاول القيام به في هذا المقال، المدخل الذي تتمثل وظيفته الأساس في تحديد الملامح العامة للقراءة الحداثية للقرآن، قبل التعامل التفصيلي مع برامج أعلام هذه القراءة كلّ على حدة في المقالات المقبلة، وهو التَّعامل الذي سيزيدُ بالضرورة فهمنا لأبعاد هذه القراءة وملامحها الرئيسة.
أولًا: القرآن في الأزمنة الحديثة، وموقع الدراسات الحداثية:
كما قلنا فإنَّ إشكال تحديدِ ما تعنيه «القراءة الحداثية» يرتبط أول ما يرتبط بغياب معيار ناجع في تصنيف هذا الكمِّ الكبير من التفاسير والدراسات القرآنية المعاصرة، نستطيع من خلاله تحديد موقع ورهانات وآفاق هذه القراءة المسمَّاة حداثية، بالطبع حديثُنا عن غياب معيار ناجع وليس غياب معيار في العموم، فالكتابات التي تناولت التفاسير المعاصرة أو القراءات الحداثية تحديدًا -وهي كثيرة في الحالتين- لها معاييرها بالطبع في تصنيف هذه التفاسير والدراسات، لكن هذه المعايير تظلُّ عاجزة عن أن تفيدنا فيما نريد القيام به هاهنا، وهذا لأن هذه المعايير -ولو استثنينا المعايير الأيدولوجية الواضحة في التصنيف سواء من قِبَل الإسلاميين أو العلمانيين، واقتصرنا على المعايير المعرفية ([3])- تظلّ في أغلبها معايير مضمونية؛ سواء «مضمونية اتجاهية» ([4])، تُصنِّف التفاسير على أساس الاتجاه الغالب على أفكارها دون انشغال كبير بقضية المنهج؛ مما يجعل تصنيفها إلى حدٍّ كبير تصنيفًا سكونيًّا، أو «مضمونية فكرية» تنطلق في التصنيف من الموقف الخاصّ تجاه إشكالات فكرية معينة، (إشكالات النهوض والتقدم والإصلاح بالأساس؛ لصلتها بنشأة القراءات المعاصرة للقرآن) ([5])، مما يجعلها وإلى حدٍّ كبير معايير غير موضوعية، وبالتالي ففي الحالتين، فإنَّ هذه المعايير تظلّ بعيدة عن أن تساعدنا على إيجاد تصنيف منهجي حركي للدراسات المعاصرة يستطيع أن يكشف لنا حركية وتطوّر الدرس القرآني في الأزمنة الحديثة، وهو وحده ما يستطيع أن يطلعنا على العلاقات العميقة بين الدراسات القرآنية المعاصرة، وكذا الفروقات الدقيقة بينها، ويُمكِّننا من موضعة دقيقة للقراءات الحداثية في خريطة القراءات المعاصرة منهجًا ورهانات وآفاقًا.
لذا فإنَّ محاولتنا هنا هي اقتراحُ معيار آخر يستطيع أن يُحقِّقَ ما نصبو إليه من تصنيفٍ منهجي وحركي، فيكون من جهة مستندًا لواقعة صلبة ومستقلة؛ مما يجعله على مسافة من رؤانا الفكرية المختلفة تجاه إشكالات الإصلاح وثنائيات الحداثة والتراث والتجديد والجمود، ومجمل حمولتها التقيمية التي قد تغرقنا في المضامين، ومن جهة أخرى يكون قائمًا على إشكال المنهج، بحيث تكون له القدرة على إعطائنا مُتّجَهًا لتطور هذه القراءات معرفيًّا. وهذا المعيار الذي نقترحه هو معيار «الصلة بالتقليد»، والمُستَنِد لواقعة (اهتزاز الثقة في التقليد).
فالواقعة الأكثر صلابة واتساعًا واستمرارًا منذ دخول العرب الأزمنة الحديثة وإلى الآن -والتي ربَّما لا تعرف خلافًا من الأطراف الأيدولوجية المتصارعة- هي واقعة (اهتزاز الثقة في التقليد)، ونقصد بـ«التقليد» مجمل الرؤى المعرفية والقيمية، وصورة العالم المُنبثَّة في الخطابات التراثية والمؤسسات الاجتماعية المُنغرِسة فيها، والتي شكَّلت أساسًا للأحكام والرؤى وأنماط التَذَوُّت للمسلمين طيلة العصور السابقة على الصدام بالحداثة الغربية ([6])، هذه الرؤى كانت قد تعرَّضت لاهتزاز بفعل مسيرة التحديث الدولتي والكولونيالي ([7])، وبفعل الترسانة الفكرية المصاحبة ([8])، فقد أدَّى التَّحديث المادي لتقليل أهمية المؤسسات والنخب التقليدية الوسيطة بخلق مؤسسات جديدة موازية، ونخب مُدرَّبة في أوروبا ومُتّصِلة بسلطة الدول الناشئة، ومُعدَّة من أجل تسيير دولابها البيروقراطي، وبالتالي فهي مؤسسات غير مُنغرِسة عموديًّا وأفقيًّا في رؤى العالم الإسلامي وغريبة على أنماط التذوّت التي عهدها المسلم طيلة قرون، كما أدَّت الترسانة الفكرية المصاحبة ومجمل تقيماتها وأحكامها ورؤاها حول الإسلام وعلاقته بانحطاط المسلمين -والمُوجَّهة بالأساس للنخب الدينية التقليدية- لإحداث مسافة لازمة مع «التقليد» وتَنَافُر مع مكوناته، مما نتج عنه محاولة لـ«الخروج من التقليد»؛ إما نحو بَلْورة علاقة تبعية مع الغرب، أو نحو بَلْورة علاقة تأسيسية جديدة مع «الأصل».
ولو انتقلنا من الحديث عن «التقليد» عمومًا، وحدَّدنا حديثنا بالقرآن كما تفترض مساحة دراستنا، فإننا نستطيعُ القولَ أنَّ هذه الواقعة واقعة «اهتزاز التقليد» أدَّت للتشكيك في كثير من نتاجات وأصول «طرائق ومصادر» ([9]) المدونة التفسيرية التقليدية، وفتحت الباب لمحاولة التخفف من ثقل هذا «التراث» مضمونًا وطرائقًا، والبدء بمحاولة شقّ طريق جديد «عصري»، وبالتالي فإنَّه وجرّاء هذه الواقعة الصلبة (اهتزاز الثقة في التقليد التفسيري)، ونشأ شكل جديد من قراءات القرآن، يمكن أن نصطلح عليه بـ«قراءات خارج التقليد»، وخارجيتها تتحدَّد بالأساس بالخروج من المنهج التقليدي بالمعنى العميق للكلمة، أي حتى بمعنى (مجمل المفاهيم المؤطِّرة للنصِّ ولطبيعته وحركته ووظيفته).
وحين نتتبّع حركة القراءات المعاصرة بعد «الخروج من التقليد»، فسنجدُ أنَّ الشكل الأول الذي ظهرت عليه «قراءات خارج التقليد»، هو قراءات لا تنشغل بصورة كبيرة بقضية تأسيس المنهج، ولا تجري نقاشًا منهجيًّا مع الطرائق التقليدية في التفسير، بل إنَّها تتخفف من الأدوات التقليدية، وتحاول إنجاز طريقة جديدة في التفسير، جدتها «مضمونية» و«اتجاهية» في الغالب، أي تتعلق بمضامين التفسير وبالاتجاه العام لها -وربما ظرفية وانفعالية كذلك تتعلق بالردِّ على إحراجات فكرية غربية-، أمَّا في المنهج فكانت جدتها في معظمها سلبية، تعمل على تنقية القرآن من صدأ الخرافات والإسرائيليات، وتجريد تفسيره من ثِقل الاصطلاحات الفنية ([iii])؛ مما يجعلنا نُصنِّف هذه التفاسير في علاقتها بالتقليد على أنَّها «قراءات ضد التقليد». لكن ولأنّ هذا الفراغ المنهجي والناشيء جرَّاء اهتزاز التقليد، والذي كرَّسته «قراءات ضد التقليد»، لم يكن له أن يدوم، حيث أنَّ المضامين والاتجاهات التي أتى بها التفسير الجديد كرهان أساس له؛ لم يكن لها أن تستقر طالما ظلَّ حضورها سطحيًّا، (فنحن نتحدثُ عن تقليد مهتز لا منعدم)، فقد كان لا بد لهذه القراءات «ضد التقليد» أن تتطور في اتجاه ملء الفراغ المنهجي بمنهجيات جديدة؛ تُواجِه الشرعية الفكرية والمعرفية للطرائق القديمة، إمَّا بتطوير منهجيات قرآنية، وهذه نطلق عليها «قراءات المناهج قرآنية» ([10])، أو باستحداث منهجيات حديثة، وهي ما نُعبِّرُ عنه بـ«القراءات الحداثية».
مما يجعلنا نُصنِّف القراءات القرآنية الحديثة والمعاصرة -وفقًا لمعيار الصلة بالتقليد والمُستَنِد لواقعة اهتزازه- معرفيًّا لـ«قراءات ضد التقليد»، «قراءات المناهج القرآنية»، «قراءات حداثية»، هذا في مواجهة «قراءات تقليدية جديدة».
لو عُدنا إذن لإشكال تحديد مصطلح «القراءات الحداثية للقرآن»، فإننا وانطلاقًا من هذا التصنيف نستطيع القول مبدئيًّا (كتحديد لأحد أبعاد المصطلح)، بأنَّ القراءات الحداثية هي: قراءات تقف خارج التقليد مضمونيًّا ومنهجيًّا، فهي لاحقة على مرحلة اهتزاز التقليد والمُرسَّمة عبر «قراءات ضد التقليد»، وهي تحاول ملء الفراغ المنهجي الناتج من واقعة اهتزاز التقليد عبر استحداث مناهج غربية حديثة.
هذا التحديد الذي قُمنا به هنا عبر التصنيف والـمَوْقَعَة لهذه القراءات يُعبِّر فقط عن أحد أبعاد «القراءات الحداثية»، ففي الحقيقة إنَّ استحداث المنهجيات الغربية لم يكن مجرد محاولة من أجل تجاوز الفراغ المنهجي الحادث بعد «الخروج من التقليد»، بل إنَّه يتعلق كذلك بإطار خاص وسياق معرفي مُحدَّد في مسيرة التحديث العربي؛ أي ظهور ما يسميه محمد جابر الأنصاري بـ«العلمانية الإسلامية»، وما يسميه علي مبروك بـ«التأسيس الثاني للنهضة». هذا السياق حاسم في ظننا في تَشكُّل القراءات الحداثية بالشكل الذي نعرف، حتى إننا لا يمكننا ربما تصوّر الاستحداث للمناهج الغربية وتطبيقها على القرآن دون هذا السياق المُؤسِّس؛ لذا فإنّ هذا السياق المعرفي يُعتبَر أحد المُحدِّدات المهمة للقراءات الحداثية، من حيث كونه هو الذي يُؤسِّس هذه القراءات معرفيًّا، ويمنحها رهاناتها الخاصة -أو ربما نسختها الخاصة من رهانات عامة كما سيأتي-، وبالتالي فإن هذا المُحدِّد يحتاج منَّا إلى عناية؛ لسبر مضمونه من أجل تدقيق أعمق لمصطلح القراءات الحداثية.
ثانيًا: السياق المعرفي للقراءات الحداثية، أو القرآن والتأسيس الثاني للنهضة:
في فصل خاصّ من كتابه «ثورات العرب، خطاب التأسيس» يُؤرِّخ علي مبروك لمرحلة مهمة من مراحل التحديث العربي، وهي مرحلة تأزُّم الخطاب النهضوي العربي في نسخته الأولى «الخطاب الإصلاحي من الطهطاوي لعبده» وما تبعها من محاولة «التأسيس الثاني لخطاب النهضة» عبر نقل «ثقل مقاربة الخطاب للحداثة من السياسي للثقافي».
وأزمة التحديث وفقًا لمبروك لا تتعلّق فحسب بكونه قد بدأ سياسيًّا، حيث ابتداء التحديث بمحاولات الدول استحضار المؤسسات الحديثة، وإرسال البعثات وإجراء التنظيمات، بل الأزمة هي أن هذه «السياسوية» في مقاربة الحداثة؛ لم تقتصر على فعل الساسة المنشغلين وبطبيعة حقل السياسة بالجاهز والبراني، (بمنطق قطف الثمرة، وليس أبدًا تقليب التربة وغرس البذرة) ([iv])، وما يتبع هذا من مقاربة للحداثة تقوم بنزع نتاجاتها من سياقاتها الفكرية التي تُؤسِّسها «التنظيمات دون ديموقراطية - التكنولوجيا دون منهج علمي»، فتنتهي لتحديث براني سطحي قشري، بل تعدَّت حقل السياسة لتعمل على تشكيل الخطاب الفكري النهضوي نفسه سياسويًّا، وهذا ووفقًا لمبروك يتضحُ تمامًا في هذا الخطاب ومنذ لحظة تدشينه مع الطهطاوي «مُنظِّر دولة الباشا الحديثة» وإلى محمد عبده؛ لذا فقد جاءت مقاربة هذا الخطاب للحداثة مقاربة سياسوية، تهتمُّ لمعلول الحداثة لا لعلتها، للجانب الخارجي من الحداثة لا للجانب الجواني المعرفي المُؤسِّس لها. فقامت بالفصل النفعي بين نتاجات الحداثة الفكرية وما يُؤسِّسها معرفيًّا تمهيدًا لدمجها في النظام الفكري التقليدي ([v])، فكما يؤكِّد نصر أبو زيد فإنَّ الطهطاوي ومحمد عبده روَّاد هذا الخطاب، ورغم أنَّهم كانوا قد تجاوزوا بالفعل التعامل مع الغرب كتكنولوجي كما تعامل معه الساسة، إلى الوعي بالفكر الحداثي في عمقه، إلا أنَّ هذا الاهتمام وبسبب هذه السياسوية التي يشير لها مبروك كان لا يزال يقتصر على الانهمام بنتاج الفكر الغربي لا بمناهجه؛ مما يجعل مقاربتهما «الفكرية» أيضًا مقاربة برانية.
هذه السياسوية المُسيطِرَة على الخطاب وما نتج عنها من سمات لتعامل الخطاب مع الحداثة ووفقًا لمبروك أدَّت لفشل هذا الخطاب على مستوى الفكر والواقع، على المستوى الأول نشأ الخطاب ذرائعيًّا وانتقائيًّا ونفعيًّا يقيم طلاء حداثي برّاني فوق مضمون تقليدي «أثر السياسة على حقل المعرفة وفقًا لنصر أبو زيد»، أمّا على هذا المستوى الأخير فقد كان الفشل مُدوِّيًا حيث انتهى إلى الهزيمة أمام الغرب والاحتلال؛ مما يدل على سطحية هذا التحديث، لذا ومع تعقُّد أزمة هذا الخطاب كان لا بد من «البحث عن حلّ»؛ لتجاوز إشكال التأسيس، فكان لا بد من نقل ثقل المقاربة من البراني للجواني، من السياسي للثقافي، من النتاجي للمنهجي ([11]).
إعادة التأسيس لخطاب النهضة، ونقل مركز ثقل الخطاب من السياسة للثقافة، ومن النتاجي للمنهجي، ابتدأت مع كتابات طه حسين وعلي عبد الرازق، ثم زكي نجيب محمود «رواد العلمانية الإسلامية، وفقًا لتصنيف محمد جابر الأنصاري» ([vi])([12])، فهذه الكتابات هي التي ابتدأت في تغيير نمط العلاقة مع الحداثة بالتركيز على مناهجها لا على نتاج أفكارها، فوفقًا لنصر أبو زيد فإنَّ معادلة التوفيق قد تحرّكت قليلًا مع طه حسين، حيث تحوَّل الغرب معه لأداة منهجية ([vii]) مُشغَّلَة على تراث الشعر الجاهلي، وعلى قصص القرآن، لكنّها عادت للوراء مرة أخرى مع زكي نجيب، حيث تمَّ إقصاء المناهج الغربية المستحضرة عن الدين وعن التراث، والذي نُفِيَ لخانة الوجدان بعيدًا عن أي مقاربة علمية ([viii]).
وسبب من أسباب تثمين مبروك لتجربة نصر؛ هي أنها محاولة لاستعادة الطريق بعد هذا الانحراف، عبر استعادة تطبيق المنهجيات الحديثة على الفكر العربي وعلى التراث وعلى القرآن ذاته، وبالطبع هذه الاستعادة جزء من طيف أوسع، فالانتقال من الاحتفاء بنتاجات الحداثة الفكرية إلى استلهام مناهجها كان هدفًا لعدد كبير من المشاريع في مرحلة ما بعد هزيمة حزيران1967م «التأزّم الثاني للخطاب في الفكر والواقع»، ومشاريع نقد التراث باستخدام منهجيات غربيّة حديثة من أهم الأمثلة على هذا -أبرزها مشروع الجابري في نقد العقل العربي-، فهي تحاول تغيير نمط المقاربة مع الحداثة والتراث بتكوين «وعي علمي منهجي» بالتراث ([13]).
وفي الحقيقة؛ إنَّ هذا الانتقال من السياسي للثقافي، وخصوصًا ما نُظِر إليه كاستعادة للطريق بعد انحرافه في الخطابات اللاحقة على خطاب العميد، كان لا بد له أن ينعكس على العلاقة بالقرآن، من حيث أن القرآن يُمثِّل المركز في هذا المنفى في جانب الوجدان من جهة ([ix])، ومن جهة أخرى من حيث يُمثِّل تصوّر طبيعة القرآن المُؤسِّس لطرق التعاطي معه المستوى المعرفي الأعمق لتأسيس العقل العربي ([x]) «هذا الذي تمّ تحميله مسئولية الإخفاق»، والذي تُعتَبَر سياسويته العميقة المُتَبدّية في كونه «تفكيرًا بالأصل» سببًا مركزيًّا للانبناء السياسي لخطاب النهضة السلفي في عمقه وفقًا لما يرى مبروك ([xi]).
بهذا كان لا بد للقرآن أن يكون مركز التفكير لهذا المنعطف الجديد الطامح لاستعادة الطريق، فإعادة تأسيس خطاب النهضة لا يمكن لها أن تمرّ إلا عبر بوابة درس النصّ القرآني درسًا علميًّا.
هذا السياق المعرفي الأعمق والذي كان له دور شديد الحسم في ظهور القراءة الحداثية للقرآن، يُعتَبَر في ظننا أهم محدِّدات هذه القراءة؛ هذا لأن هذا السياق هو من أعطى لهذه القراءة «رهاناتها»، وبالتالي هو الذي أعطاها الكثير من ملامحها الخاصة.
ثالثًا: رهانات القراءات الحداثية:
في ظننا إنّ دراسة أيّ خطاب غير ممكنة دون إدراك مبدئي لرهاناته الخاصة وأهدافه، فهذه الرهانات هي التي تُحدِّدُ أفق الخطاب، ولها الأثر الأكبر على تشكيل تقنياته المنهجية، إننا نستطيع القول أنَّ رهانات الخطاب هي النافذة التي نتمكن من خلالها من فهم الوظائف التي يمنحها هذا الخطاب لدراساته واستشكالاته وأجوبته، ومن فهم أثر هذا على نمط اشتغاله واختياراته حتى لأدق تقنياته المنهجية.
ونظنُّ أن حديثنا عن السياق المعرفي للقراءات الحداثية للقرآن، يضعُنا في أول الطريق لتحديد هذه الرهانات، فوفقًا لما ذكرنا بالأعلى يتبين كون «القراءات الحداثية للقرآن»، هي في أحد أوجهها محاولة لتجاوز أزمة خطاب النهضة المُتبدِّيَة بالأساس في نمط التعاطي مع الحداثة كـ«نتاجات فكرية»، ومع التراث كـ«منطقة محظورة مُبعدَة عن الدرس العلمي الحديث» وكلّ ما ينتج عن هذا النمط من سمات «التلفيق»، «التجاور»، «الانتقائية»، حيث تقوم القراءة الحداثية وعبر نقل ثقل المقاربة من البراني للجواني، بالتعامل مع الغرب لا كنتاجات فكرية بل كأداة منهجية، يتمُّ تشغليها لإنتاج وعي علمي بالتراث وبالدين، فهذا الخطاب النهضوي الجديد يريد تحقيق النهوض كما حاول سلفه، لكنّ رهانه الأساس -بنقل مركز المقاربة- هو تقديم صياغة جديدة لأطراف معادلة النهوض، تبتعد عن كلّ سمات الخطاب المأزوم وتُسرِع بالعرب نحو الدخول في الأزمنة الحديثة في محاولة لتجاوز «الحصاد الفقير للتنوير».
ونحن نجدُ تأكيدًا دائمًا ومُستمِرًّا على هذه السمات كسمات محايثة لخطاب النهضة ومحورًا لأزمته وسببًا لفشله عند عدد كبير من مفكري القراءة الحداثية، والأهم نجد هذا التأكيد على كون «القراءة الحداثية» هي الطريق المـَلَكي لتجاوز هذه السمات، فنصر أبو زيد يُفرِد مقدمة طويلة في كتابه «النص، السلطة، الحقيقة» ليُقدِّم قراءة لرواد خطاب النهضة من الطهطاوي لعبده، ولمسيرة التنوير العربي من طه حسين إلى زكي نجيب محمود، تقوم على أساس تشخيص أزمة الخطاب بالتلفيق وشيوع التجاور بين الأفكار والمناهج، ويعتبر أن التاريخية كمركز لمشروع القراءة الحداثية للقرآن هي الطريق لتجاوز هذا التلفيق، الذي لم يستمر في خطاب النهضة وما تناسل عنه من خطابات، إلا بسبب تفويت فرصة الحسم بالقول بتاريخية القرآن ([xii]).
كذلك فالشرفي في كتابه «الإسلام بين التاريخ والرسالة»، يتناول هو الآخر بعض المحاولات الإصلاحية، ويعتبر أن عيبها الرئيس هو كون أفكارها خالية من أداة تُؤسِّسها معرفيًّا، ويعتبر أن المناهج التي يتوسَّل بها قراءة القرآن والإسلام هي الطريق لتثبيت علمي لهذه الأفكار ([xiii]) يعطيها النجاعة المطلوبة والجذرية اللازمة.
كذلك يُميِّز محمد أركون مقارباته عن إصلاحات عبده «الاجتهادية» انطلاقًا من كون هذه الأخيرة انتقائية ونفعية وذرائعية، تتوقف عن أن تثير الإشكالات الأساسية، على عكس المطلوب من المجتهد بـ«زحزحة» شروط الاجتهاد النظرية وحدوده من المجال اللاهوتي - القانوني الذي حُصِر فيه، إلى مجال التساؤلات الجذرية غير المعروفة حتى الآن من قبل التراث الإسلامي، أي إلى مجال نقد العقل الإسلامي ([xiv])، كما يصرُّ فضل الرحمن مالك في «الإسلام وضرورة التحديث» على إرجاع فشل التحديث في الهند إلى أنماط التعامل البراني مع الحداثة، وما نتج عنها من تجاورات بين التقليد والحداثة (والتي لا تختلف كثيرًا عن الحال في العالم العربي)، ويعتبر أنَّ الحلّ هو تحديث مُؤسَّس من داخل الإسلام ([xv])، هذا الذي يُشكِّل الواقع -لا الواقعة- المحتاج تهيئة بتعبيرات علي مبروك لتنبت منه الحداثة.
لذا فإنّنا نظنُّ أن الحديث عن تحريك المعنى القرآني وإنقاذه من الجمود وفتح الباب لتعددية المعنى وإدخال القرآن في الحياة المعاصرة للمسلمين، ليست هي الرهانات الأكثر دلالة على القراءات الحداثية للقرآن، هذا على الرغم من كثرة تكرارها سواء من رواد هذه القراءة أو ممن يروجون لكتاباتهم بصورة أيدولوجية تبسيطية واختزالية بالأساس، فهذه الرهانات يشاركه فيها كلّ القراءات المعاصرة تقريبًا (وفيها ما يوافقه على مضمون القيم التي يدعوا لها كقيم جديدة كذلك)، أمّا الرهانات الخاصة لهذه القراءات والدالَّة فعلًا عليها كأحد مُحدِّداتها الرئيسة -وبالتالي التي تعنينا في إيجاد تعريف دقيق لها- فهي البحث عن طريق «علمي»؛ لتحقيق هذه الرهانات يكون قادرًا على تكريسها وتجذيرها في الفكر والواقع الإسلامي، فهذا الرهان أساسي في بناء وتشكيل برامج هذه القراءات ([14]).
وبالطبع فحديثنا هنا هو عن الرهانات الأوسع للقراءات الحداثية، أي تلك التي تصلح في ظننا كمُحدِّد من مُحدِّدات هذه القراءات، غير أنّ هذا لا يمنع بالطبع من وجود رهانات خاصّة عند كلّ قراءة حداثية خاصة.
القراءة الحداثية، ماذا تعني؟
نستطيع إذن أن نُجمِل كلامنا السابق عن أبعاد القراءة الحداثية فنُحدِّدها إجمالًا بأنها: قراءات معاصرة تقف خارج التقليد، وتستخدم مناهج مستقاة من الفكر الغربي الحديث؛ «سواء الحداثي أو ما بعد الحداثي» لتُشغِّلها على النص القرآني، وترتبط في نشأتها بمنعطف التأسيس الثاني لخطاب النهضة العربية وما له من ملامح فكرية خاصة، وبالتالي فرغم تشابه رهاناتها مع مجمل رهانات النهضة إلا أنها تحاول تحقيق التحديث بصورة أكثر جذرية وعمقًا، وأبعد عن التلفيق والتجاور والتساكن، فهي تُمثِّل من وجهة نظر روادها الحلّ لأزمة التنوير، والطريق لتجاوز فشله.
بالطبع فإنّ هذا التحديد الذي قمنا به لأبعاد القراءات الحداثية في هذا المقال -المدخل، يظلُّ تحديدًا عامًّا، بحيث لا ينفي وجود أبعاد خاصة لكلّ برنامج قراءة حداثي، وهذا طبيعي بحكم السياقات الفكرية المخصوصة لكلّ خطاب، بل وكذلك الرهانات الخاصة لكلّ مفكر من هؤلاء، وطبيعة المناهج التي يستخدمها كلّ مفكر والمُؤثِّرة على مدخله ونمط مقاربته ومساحات اشتغاله، وهو ما سنحاول بيانه تفصيلًا في تناولنا لاحقًا لكلّ مفكر من مفكري القراءة الحداثية على حدة، وهو العمل الذي سيُعمِّق فهمنا لأبعاد القراءة الحداثية، لكن ما ندَّعيه هنا هو أنَّ ما قمنا بتحديده يُعدّ الملامح العامة الرئيسة لكلّ قراءة حداثية، وأنّ هذه الملامح هي التي تُميِّز القراءة الحداثية عن كلّ قراءة أخرى مهما تشابهت معها في المضامين أو تَغَيَّت نفس الأهداف.
[1] يقسّم طه عبد الرحمن القراءات إلى: «القراءات الحداثية» و«القراءات التراثية»، ويقسم هذه الأخيرة لـ«قراءات تجديدية» و«قراءات تأسيسية»، أمَّا النيفر فيقسم القراءات إلى «المدرسة التراثية»، والتي تنقسم إلى «قراءات سلفية» و«قراءة سلفية إصلاحية» -والاثنان معًا يدخلان وفقًا لتصنيف طه تحت باب «القراءات التجديدية»-، أمَّا التجديد فمختص عنده بـ«قراءات المدرسة الحديثة»، ويدخل فيها القراءات الحداثية، والتي يطلق عليها مفهوم «القراءة التأويلية»، أمَّا محمد حمزة فيختار مصطلح «القراءة التجديدية»؛ ليطلقه على القراءات الحداثية وحدها. وبينما ينتقد طه عبد الرحمن إطلاق مصطلح «القراءة العصرية» على القراءات الحداثية، فإن رقية علواني تطلق على القراءات الحداثية مصطلح «القراءة العصرانية»، وهذه بعض أمثلة على اضطراب المصطلحات في وصف وتصنيف القراءات المعاصرة وعدم الاتفاق حول مدلولاتها، والذي يرجع للحمولات التقيمية المشحونة بها هذه المصطلحات؛ مما يجعلها تتغير وفقًا لأيدولوجيا المصنف ومواقفه من مفاهيم مثل التجديد والعصرية.
انظر: طه عبد الرحمن، روح الحداثة، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، بيروت، لبنان، ط1، 2006، ص176، ومحمد حمزة، إسلام المجددين، دار الطليعة، بيروت، لبنان، ط1، 2007، ص6، ورقية العلواني، قراءة في ضوابط التأويل وأبعادها المنهجية، وهو بحث في ندوة دراسة التطورات الحديثة في الدراسات القرآنية المعاصرة، بيروت، 2006.
[2] على رأسها طبعًا، «فتح البيان في مقاصد القرآن» لمحمد صديق حسن القنوجي (1889)، تفسير «المنار» لمحمد عبده (1905)، و«محاسن التأويل» للقاسمي (1914)، «نظام القرآن وتأويل الفرقان بالفرقان» للعلامة الفراهي (1938)، و«تيسير الكريم المنان في تفسير كلام الرحمن» لعبد الرحمن السعدي (1956)، و«التحرير والتنوير» للطاهر بن عاشور (1960)، و«التفسير الحديث» لمحمد عزة دروزة (1960)، وتفسير «في ظلال القرآن» لسيد قطب (1967)، و«التفسير الكاشف» لمحمد جواد مغنية (1968)، «الميزان في تفسير القرآن» لمحمد حسين الطبطبائي (1972)، و«الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل» لناصر مكارم الشيرازي (1984)، و «من هدي القرآن» للسيد تقي المدَرِّسي (1985).
[3] نستطيع أن نرى المعايير الأيدولوجية -القائمة على ثنائيات صلبة وتقييمات فاقعة- بوضوح في تصنيف محمد حمزة مثلًا، فحمزة يضيف صفة تقيمية على القراءة الحداثية بوصفها وحدها بالتجديد، والذي يتمّ حصر معناه في القطع مع المرجعيات القديمة، كذلك في تصنيف طه عبد الرحمن، والذي يجعل مُحدِّد الفارق بين «القراءة الحداثية» و«القراءة غير الحداثية»، انتقادية الأولى واعتقادية الثانية، وهذه المعايير مشحونة بحمولة تقيمية لا تستطيع أن تطلعنا على -أو قُلْ إنها تحجب عنا- السمات الأساسية المنهجية لهذه الدراسات، فضلًا عن أن صلابة ثنائيتها تُهدِرُ العلاقة بين كلّ القراءات العصرية، سواء ما يطلق عليها حداثية أو ما يطلق عليها تجديدية، وهي العلاقة المهمة في اكتشاف حركة تطور الدرس القرآني المعاصر المُحدِّدة لموقع كلّ قراءة ولمُبرِّر حضورها، ورهاناتها وآفاقها.
انظر: محمد حمزة، مرجع سابق، ص6، وطه عبد الرحمن، مرجع سابق، ص176.
[4] ينطبق هذا بوضوح على تصنيف عبد المجيد عبد السلام المحتسب في «اتجاهات التفسير في العصر الراهن»، مكتبة النهضة الإسلامية، ط3، 1982، والذي يصنف التفاسير لـ«اتجاه سلفي، اتجاه عقلي توفيقي، اتجاه علمي»، وأشمل منه تصنيف فهد الرومي -بحكم أن كتاب المحتسب لم يكتمل- في «اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر»، مؤسسة الرسالة، القاهرة، ط3، 1997، والذي يصنّف التفاسير «الاتجاه العقائدي، الاتجاهات العلمية، الاتجاه الأدبي، الاتجاهات المنحرفة»، وهو تصنيف سكوني أقرب لتنظيم المادة الموجودة منه إلى تصنيف حركي له معيار منهجي واضح، يساعدنا في اكتشاف تطور مقاربة النصّ القرآني، واكتشاف العلاقات بين مدراسه.
[5] من الأمثلة مثلًا على إشكالات التصنيف القائم على أساس الموقف الخاصّ من قضايا التجديد والنهوض، القراءة التي قدمها محمد إبراهيم شريف لتفسير المنار وعلاقة التفاسير اللاحقة عليه به، فرغم امتياز كتاب الشريف بأنه حاول مبدئيًّا تحديد الفارق بين «المنهج» و«الاتجاه»؛ لتبديد الغموض الذي طال استخدام المصطلحين قبله في معظم الكتب التي يستعرضها، إلا أن تصنيفه ظلّ في الأخير تصنيفًا اتجاهيًّا، فهو يصنّف التفاسير لـ«اتجاه هدائي، اتجاه أدبي، اتجاه علمي»، ويصنف كلّ اتجاه على ثلاثة مناهج «المنهج التقليدي - المنهج الموضوعي- منهج المقال التفسيري»، وهذا لأن المنهج عند شريف لا يعني أكثر من «الطريقة» طريقة كتابة التفسير، وهذا يختلف تمامًا عمّا نقصده بالمنهج كطرائق وتقنيات اكتشاف إنتاج المعنى، والمتصل بما يطلق عليه النيفر «المفاهيم المؤطّرة للنصّ ووظيفته وحركته»، كلّ هذا يعني أن محدّد التصنيف الأساس عند شريف لا يزال هو الاتجاه لا المنهج الذي ينحل إلى مجرد طريقة في كتابة الاتجاه. وهذا التصنيف الاتجاهي لشريف قائم على مُحدِّد خاصّ، فهو ليس محض تصنيف سكوني منظم للمادة الموجودة، كما وصفنا تصنيفات الرومي والمحتسب، بل ينطلق من مُحدِّد معين هو «التجديد»؛ ولأن هذا المُحدِّد هو مُحدِّد «تقييمي» أو «معياري»، وأن شريف يحمل عنه وعن حدوده ومداه وآفاقه رؤية خاصة، فقد أغرق هذا المحدد التصنيفَ في المضمونية، وأثر على تصور شريف للعلاقات بين التفاسير والدراسات القرآنية المعاصرة. فشريف الذي يعتبر أن المنار هو أساس كلّ التجديد المنهجي في الدراسات التفسيرية المعاصرة، لا يقدم رؤية متوازنة لعلاقة عبده بما لحقه من تفاسير ودراسات بسبب رؤيته الخاصة لـ«التجديد»، والذي يعتبر المنار رائدها، فبينما يصرُّ على إيجاد صلات بين المناهج الموضوعية في التفسير وبين تفسير المنار، فإنه لا يرى أي صلة بين كتاب خلف الله «الفن القصصي في القرآن» وتفسير المنار إلا التحريف وعدم الفهم؛ مما يجعله غير قادر على تبين العلاقات الأعمق التي تربط مثل رؤية خلف الله بتفسير المنار، وهذه العلاقات لا يلزم أن تكون في تشابه الأفكار ولا حتى في تشابه المنهج، بل في الإمكانات الأبستمولوجية «المعرفية»، التي وفّرها المنار «كتفسير خارج التقليد» لتأسيس قراءات غير تقليدية أيًّا كان منطلقها أو اتجاهها أو منهجها، ونحن لا نستطيع تبين العلاقات بين قراءات مثل خلف الله وقراءات مثل التفسير الموضوعي، وكذلك الافتراقات العميقة فيما بينهم إلا عبر تأسيس علاقتهم بالمنار على أساس «منهجي» بعيدًا عن آمالنا الفكرية الخاصة وتصوراتنا المسبقة عن إشكالات النهوض والتجديد وكيفيته ومداه وحدوده.
انظر: اتجاهات التجديد في تفسير القرآن العظيم في مصر، محمد ابراهيم شريف، دار التراث، القاهرة، ط1، 1982، ص63، ص291.
[6] هذا الوجود لـ«التقليد» بهذه الدلالة، هو ما يجعل كلّ قراءة لأحد المفاهيم أو المؤسسات أو الحقول المعرفية في التاريخ الإسلامي تعزلها عن مجمل هذه الرؤى القيمية والروحية والاجتماعية؛ هي قراءة تهدر الكثير من الأبعاد الرئيسة لما تقرأ، ولعلّ هذا يظهر تمامًا في مفهوم «الشريعة» الذي اختزل حداثيًّا في اعتباره مجرد مدونة قانونية، وهو ما حاول وائل حلاق إظهار محدوديته بإعادة «الشريعة» لمجمل العلاقات الاجتماعية والروحية المُنغرِسة فيها، ومدى تعقد «الشريعة» كممارسة خطابية بمفهوم فوكو، كمركب من علاقات اجتماعية وسياسية وثقافية وأخلاقية، يتضمن: مؤسسات استراتيجية لحماية نفسها من الاستغلال السياسي، تحويل القانون إلى ثقافة، منظومة فكرية، وركيزة ثيولوجيّة (كلامية) صبغت كثيرًا من رؤية الناس للعالم، ورغم أننا لا ندَّعي كون هذا «التقليد» متجانسًا تمامًا طوال تاريخ وجغرافيا الحضارة الإسلامية، إلا أننا نميلُ لرأي طلال أسد الذي يرى بأن هذا التقليد يطمح التجانس بنفس الطريقة التي تطمح بها كافة التقاليد الشاملة، وإن كانت لا تبلغه نتيجة الظروف السياسية والاقتصادية التي تمارس ضغوطها على هذه التقاليد أو بسبب ما تتصف به من محدودية.
انظر: ما هي الشريعة؟ وائل حلاق، ترجمة: طاهرة عامر، وطارق عثمان، مركز نماء، بيروت، لبنان، ط1، 2016، ص28-30، وانظر، أنثروبولوجيا الإسلام، إعداد: د. أبو بكر أحمد باقادر، دار الهادي، بيروت، لبنان، ط1، 2005، 79و.
[7] إن واقعة «اهتزاز التقليد» ترجع لهذه المسيرة التي تبدأ من الغزو الاستعماري الذي مثَّل اللقاء الأول بالحداثة، ثم التحديث الدولتي لبعض الدول «مصر وتركيا»، ثم التحديث الكولونيالي، الذي قامت به الدول الاستعمارية في مجمل دول العالم الإسلامي.
[8] نظنُّ أن وصف الترسانة الفكرية المصاحبة لمسيرة اللقاء بالحداثة الغربية بـ«الاستشراقية» يعدُّ وصفًا غير دقيق، فإن أعلام هذه المرحلة الذين صاغوا أهمّ الخطابات تجاه الإسلام وعلاقته بالانحطاط مثل رينان وكرومر وهانوتو، والذين كان لخطاباتهم التأثير الكبير في صياغة كثير من مواقف خطاب النهضة، ليسوا مستشرقين بالمعنى الدقيق والذي لا يعني كلّ اهتمام للشرق، بل يعني دراسة الشرق دراسة أكاديمية وفق منهجيات حديثة، أو بتعبير رودنسون «الاستشراق هو ميدان علمي مُكرَّس للشرق».
انظر: جاذبية الإسلام، ماكسيم رودنسون، ترجمة: إلياس مرقص، التنوير، بيروت، ط2، 2005، ص52.
[9] يقسم مساعد الطيار في كتابه «التحرير في أصول التفسير» أصول التفسير إلى: مصادر التفسير، والاختلاف في التفسير، وقواعد التفسير، وخلاف «القراءات ضد التقليد» مع أصول التفسير يشمل تحديدًا مساحتي المصادر والقواعد، فهذه القراءات تدين بعض المصادر مثل الإسرائيليات، كما تتخفف من التفسير المأثور.
انظر: التحرير في أصول التفسير، مساعد الطيار، مركز الدراسات والمعلومات القرآنية بمعهد الإمام الشاطبي، جدة، ط1، 2014.
[10] وهي قراءات تقف على مسافة من التقليد، وتحاول بلورة منهجيات خاصّة في قراءة القرآن، هذه المنهجيات ورغم وجود بعض أساساتها في المدونات التقليدية، إلا أنّها تُؤسس مع هذه القراءات كمناهج قرآنية تواجه بالأساس طرائق المدونة التراثية المُتهَمة بتضييع السمات الأكثر مركزية للنص القرآني، ونستطيع أن نُدخِلَ في هذا السياق «قراءات المنهجية القرآنية»، و«قراءات التدبُّر»، وسنتناول هذه القراءات بالتفصيل لاحقًا في بحوث خاصة بها.
[11] في هذا السياق يقرأ مبروك نشأة الجامعة المصرية، كمحاولة لتجاوز أزمة الخطاب عبر إيكال مهمة إثارة الأسئلة الكبرى والتأسيس الفلسفي للحداثة إليها وإلى كلية الآداب تحديدًا.
علي مبروك، ثورات العرب، خطاب التـأسيس، دار العين، القاهرة، ط1، 2012، ص106.
[12] رغم أن مصطلحي «العلمانية الإسلامية» و«التأسيس الثاني للنهضة»، يصفان تقريبًا نفس الخطاب ونفس المرحلة من تطور الخطاب الحداثي العربي، إلا أنَّ ثمة اختلاف بين مدلول المصطلحين لا بد من الإشارة إليه، فبينما يعتبر مبروك أن هذه المرحلة هي مرحلة من مراحل تجاوز التلفيق والتجاور والتساكن في الخطاب التنويري العربي نحو تأسيس علاقة بالحداثة وبالإسلام تتحول فيها الحداثة لأداة منهجية مُشغَّلَة على الإسلام، فإنَّ محمد جابر الأنصاري يعتبر أن هذه المرحلة هي عودة للتوفيقية مرة أخرى وتراجع للخطاب العلماني والعقلاني، ومرحلة جديدة من مراحل تأجيل الحسم في صراع الإسلام والحداثة، وظننا أنَّ هذا الاختلاف ناتج من مساحة الخطاب التي يشير إليها ويفسِّرها المصطلح، حيث إن الأنصاري يُحدّد مرحلة «العلمانية الإسلامية» بفترة صعود التوفيقية وخصوصًا في صورتها الرومانسية، وهو ما يناسب مثلًا خطاب طه حسين في مرحلة «على هامش السيرة»، لكنه لا ينطبق على «مرحلة الشعر الجاهلي» وهي التي تدخل في اصطلاح مبروك «التأسيس الثاني للنهضة»، ونحن نميل لاستخدام مصطلح «العلمانية الإسلامية» بصورة مُوسَّعة، بحيث يشمل انتقال الخطاب الحداثي من التعامل الداعي للتنوير في قيمه بمعزل عن الانشغال بالإسلام، إلى التعامل الذي ينطلق من عملية تحديث الإسلام ذاته، ليقترب من مصطلح «التأسيس الثاني للنهضة»، لكن في ذات الوقت يتعداه ليشمل مرحلة تراجع هذا الخطاب وتلوَّنه باللون الرومانسي في فترة أواخر الثلاثينيات وإلى الستينيات، بل ربما لأبعد من هذا وفقًا لتحليلات الأنصاري.
[13] إذا كان علي مبروك يعتبر أن هزيمة عرابي ودخول الإنجليز مصر يعتبر نتاج لفشل الخطاب واقعيًّا ومعبرًا عن أزمته الأولى التي تحتاج لتأسيس ثانٍ، فإن معظم المفكرين العرب اعتبروا هزيمة حزيران 67 هي النتاج الأكبر لفشل التنوير والتحديث، وأنَّها التعبير عن خطاب مأزوم يحتاج لإعادة تأسيس، ولعلّ هذا يوافق أيضًا بقية تحليل مبروك لتأدية الجامعة لدورها المطلوب، حيث يعتبر أن الجامعة التي كانت محاولة لتجاوز الأزمة هي نفسها وُلِدَت مأزومة؛ مما يجعل الخطاب يحتاج لتأسيس جديد.
[14] وربما من هنا نفهم مركزية «التاريخية» في برامج القراءة الحداثية، فالتاريخية وكما سنوضح في المقالات اللاحقة تفصيلًا تمثل رفضًا للتفكير بالأصل وتمثل الطريق للتخلص من حمولة التقليد تخلصًا مؤسسًا على اختلاف السياقات المعرفية والسياسية والثقافية، والأهم والأسبق، أنها تمثل الأساس المنهجي لـ«لقراءة الحداثية للقرآن» من حيث كونها تغييرًا في «طبيعة النص»، كما استقرت في المدونة التقليدية و«زحزحة» له من مجمل المفاهيم المُؤطِّرة لطبيعته ووظائفه وعلاقته بالمؤوِّل وبالمعنى.
[i]الإنسان والقرآن وجهًا لوجه، أحميدة النيفر، دار الفكر، دمشق، سوريا، ط1، 2000، ص18.
[ii] نفسه، ص17.
[iii] اتجاه التفسير في العصر الحديث، مصطفى محمد الطير، ص21، 22، نقلًا عن اتجاهات التجديد في تفسير القرآن الكريم في مصر، محمد إبراهيم الشريف، دار التراث، القاهرة، ط1، 1982، ص120.
[iv] ثورات العرب خطاب التأسيس، علي مبروك، دار العين، القاهرة، ط1، 2012، ص94.
([v] نفسه، ص93.
[vi] الفكر العربي وصراع الأضداد، محمد جابر الأنصاري، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط2، 1999، ص 92.
[vii] النص، السلطة الحقيقة، نصر حامد أبو زيد، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، بيروت، لبنان، ط1، 1995، ص32.
[viii] نفسه، ص42.
[ix] نفسه، ص45.
[x] نفسه، ص19، الأزهر وسؤال التجديد، علي مبروك، مصر العربية، القاهرة، ط1، 2016، ص27.
[xi] الخطاب العربي المعاصر، دراسة تحليلية نقدية، محمد عابد الجابري، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان، ط5، 1994.
[xii] «النص، السلطة، الحقيقة»، ص34.
[xiii] الإسلام بين الرسالة والتاريخ، عبد المجيد الشرفي، دار الطليعة، بيروت، لبنان، ط2، 2008، ص57.
[xiv] من الاجتهاد إلى نقد العقل الإسلامي، محمد أركون، دار الساقي، بيروت، لبنان، ط1، 1991، ص12، وص17.
[xv] الإسلام وضرورة التحديث، فضل الرحمن مالك، ترجمة: إبراهيم العريس، دار الساقي، بيروت، لبنان، ط1، 1993، ص162.
كلمات مفتاحية
الكاتب:

طارق محمد حجي
باحث مصري له عدد من المقالات البحثية والأعمال المنشورة في مجال الدراسات القرآنية.
مواضيع ذات صلة
((المعلومات والآراء المقدَّمة هي للكتّاب، ولا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع أو أسرة مركز تفسير))