بحث: "هل كان ابن كثير متحدثًا باسم ابن تيمية؟ تفسير قصة يونس أنموذجًا" لـ يونس ميرزا "عرض وتقويم"
بحث: "هل كان ابن كثير متحدثًا باسم ابن تيمية؟ تفسير قصة يونس أنموذجًا" لـ يونس ميرزا "عرض وتقويم"
الكاتب: محمد يحيى جادو
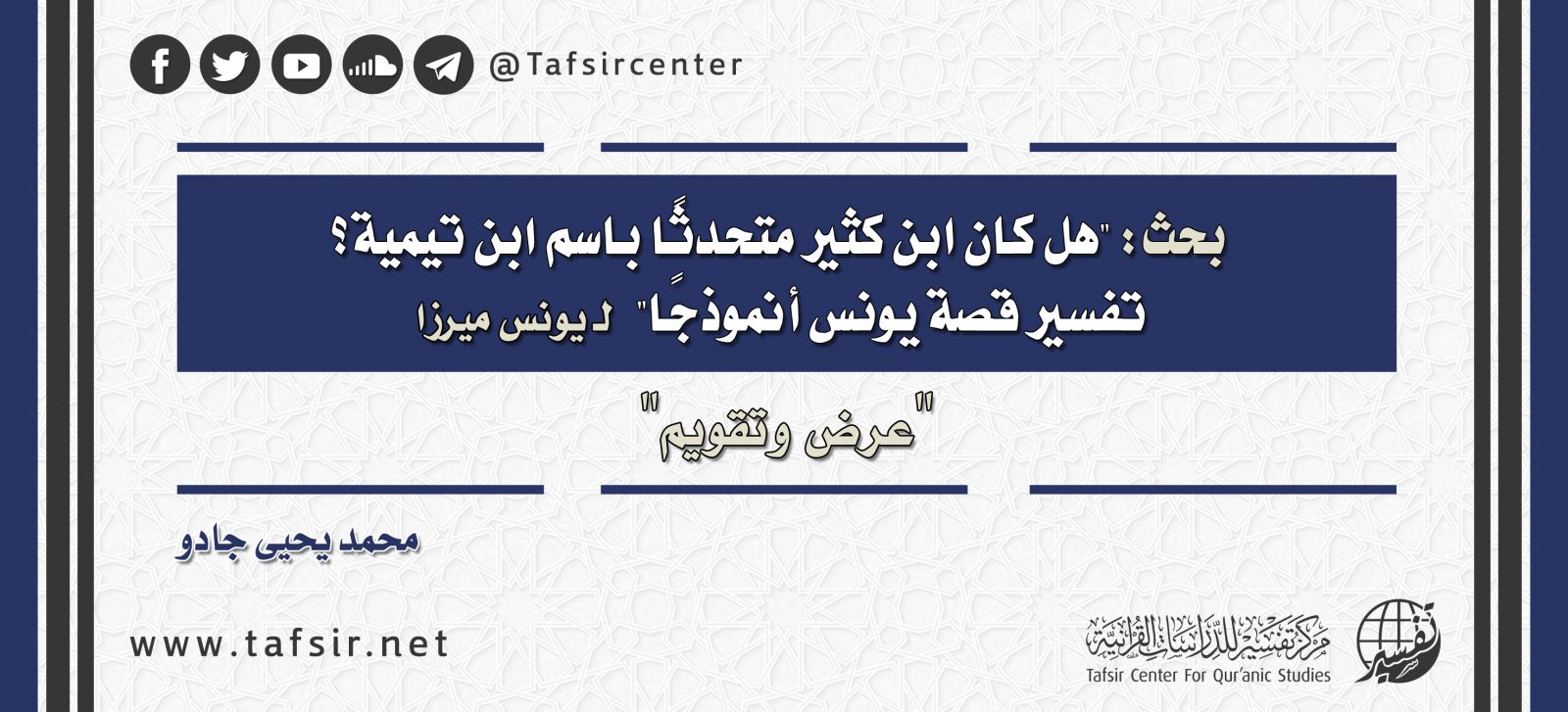
نُشرت مؤخرًا ترجمة ورقة بحثية لأحد الباحثين الغربيين، والتي تناوَل فيها الباحث أحد الموضوعات المهمة، وهي ورقة (هل كان ابن كثير متحدثًا باسم ابن تيمية؟ تفسير قصة يونس أنموذجًا؟)[1] للباحث يونس ميرزا[2]، وفي هذه المقالة سنحاول تقويم ورقة ميرزا وبيان الموقف منها، وستأتي معالجتنا النقدية مقسومة لقسمين؛ أحدهما لعرض بحث ميرزا، والثاني لتقويمه، وذلك بعد تمهيد نعرج فيه على كيفية التعاطي مع الفكر الغربي ومناقشته.
تمهيد:
لا شكَّ أن تلاقح الأفكار والتثاقف المعرفي بين الرؤى المؤسّسة على وجهات نظر متنوعة لهو سبيل لاحب في نضج المعارف والعلوم. وإن الدرس الاستشراقي المعاصر قد قام بجهود مكثفة في حقل الدراسات القرآنية لا سيما التفسيرية منها، وهذه الجهود -على تباين مستوياتها- بحاجة إلى أن توضع على مائدة الفحص والدرس لا سيما إذا لم تكن هذه الجهود على هامش علم التفسير، ولا في زواياه الجانبية، بل الجادّ منها ضارب في أعماقه، من محاولات تأريخية لعلم التفسير، ومن دراسة للعلاقات الداخلية بين التفاسير...الخ. ومع الحراك العلميّ الذي يشهده واقعنا المعاصر في علم التفسير؛ صار لزامًا علينا ملاحقة هذه الجهود الاستشراقية، وإخضاعها للفحص والدرس تأثيرًا وتأثرًا، واستفادة منها وإضافة لها. كما صار من الواجب تجاوز هذه الحالات الشعورية غير المتزنة التي تقف إحداها من الاستشراق وقفة المستهجن الصادّ الرادّ كلَّ شيء أتى من قِبلهم، وإن كان فيه حقٌّ. والأخرى التي استسلمت لسطوة الدرس الاستشراقي قلبًا وقالبًا ووقفت منه موقف السمع والطاعة. وسبيل الأمة الوسط أن تنظر لهذا الطرح الاستشراقي بعين التقويم بغضّ النظر عن جهة صدوره، لا سيما الجهود القاصدة إلى مركزيات هذا العلم وجذوره وتعقيدات تشكُّله وبناه الأساسية.
وهذه مقاربة نقدية نأمل أن تكون مثالًا صالحًا للتعاطي المنهجي مع الدرس الاستشراقي بصورة عامة، وأن تكون موضوعية منصبّة على الآراء العلمية، قاصدة إلى البناء المنهجيّ والمعاقد الكلية التي تأسَّس عليها طرح ميرزا.
وتأتي أهمية الدراسة محلّ النقد من كونها تتصدى لدراسة العلاقة بين الرؤى التأويلية الكبرى التي تأسست عليها التفاسير الكبرى، لما في هذا من تعميق فهمنا لهذا الفن وطريقة تشكّل مدوناته.
ونحن إذ نتصدى لهذه المحاولة بالعرض والنقد فلا يعني هذا أننا نبغي من وراء ذلك نقد كل ما قرره البحث، ولا الاختلاف معه جملةً وتفصيلًا، وإنما نرمي إلى تناول الإشكالات التي تحول دون القطع بهذه النتائج التي قررها ميرزا، واختبار مدى منهجية الإجراءات التي اتخذها ميرزا للتوصل لنتائجه[3].
القسم الأول: بحث يونس ميرزا؛ عرض وبيان:
هدف البحث:
قرر الباحث بجلاء أن ورقته البحثية ترمي مباشرة إلى تحدي قولٍ شائعٍ -في نظره وتقديره- بأنّ ابن كثير تلميذ لاهج بالنظرية التأويلية لابن تيمية، وتُحاجج الدراسة بأن الصواب هو النظر لتفسير ابن كثير كردٍّ على أقرانه الأشاعرة الذين أدخلوا الكلام في مصنفاتهم، وبالأخص تفسير الرازي (مفاتيح الغيب)، لا أنَّه تطبيق للنظرية التيمية في التفسير[4].
إشكالية البحث:
يرى ميرزا أنّ ثمة قولًا شائعًا يتردد في كتب التراجم حول ابن كثير بوصفه تلميذًا لابن تيمية، ويرى أن كثرة ترديد هذا القول في كتب التراجم قد أورث الباحثين العرب والغربيين -على حدٍّ سواءٍ- تصورًا بأنّ ابن كثير ناطق باسم ابن تيمية، وأنَّ تفسيره صدى النظرية التيمية التفسيرية، في حين يرى ميرزا أنّ لابن كثير مشروعًا فكريًّا مغايرًا لمشروع ابن تيمية، وأنه أقرب إلى كونه ردًّا على إخوانه الأشاعرة الذين أوغلوا في الكلام والفلسفة، وفي سبيل التوصّل لذلك اتخذ ميرزا عددًا من السبل للتدليل على هذا التقرير الجديد، فبعد أن جال خلال كتب التراجم ليثبت ذيوع تلمذة ابن كثير على ابن تيمية -والذي يراه مفيدًا لدى الباحثين أنّ ابن كثير متحدث باسم ابن تيمية- أخذ ميرزا في طرح بناءاته الخاصة المفيدة لتقريره الجديد، وذلك بتثبيت عدد من المقدمات المركزية.
أولًا: ابن كثير بوصفه شافعيًّا تقليديًّا بدلًا منه تيميًّا:
استحضر ميرزا قضية تكتنف جدلًا واسعًا بين الباحثين وهي قضية «الصراع بين الاتجاه التقليدي والاتجاه العقلاني في التراث الإسلامي»، ورأى أنها هي السياق الأكثر مناسبة لتسييق مشروع ابن كثير في ضوئها، فيرى ميرزا أن الاتجاه العقلاني قد انتسب أكثر روّاده إلى المذهب الحنفي فقهيًّا، وأن أكثر رواد الاتجاه التقليدي انتسبوا فقهيًّا إلى مذهب أحمد، فيما ظلّ المذهب الشافعي يتنازعه الاتجاهان، فكان ابن كثير وجماعة في عصره شافعيين تقليديين، وتتمثل تقليديتهم في كونهم رافضين لأيّ حجاج كلامي، غير متوغلين في الفلسفة ولا يعتمدون أيّ مصادر خارجية في فهم النص أو تفسيره. وحسب ميرزا فإن كون منهجهم بهذا الوصف فَهُم أقرب إلى اتجاه تقليدي شافعيّ لا تيار تيميّ؛ لأنه إضافة لكون ابن تيمية حنبليًّا وابن كثير شافعيًّا؛ فإن تأويلية ابن تيمية مغايرة لهذا النسق؛ إذ هي تأويلية فريدة من نوعها قائمة على التوفيق بين العقل والنقل بخلاف نسق ابن كثير وتياره، ومن هنا يلج ميرزا إلى أن بإمكانه القول بأن تفسير ابن كثير ليس صدًى لابن تيمية؛ لأنه قرر أن وجهة ابن كثير وتأويليته مغايرة لوجهة ابن تيمية، ولأنه قد قرر أن النظرة الصائبة لابن كثير تتمثل في كونه ضمن تيار شافعي تقليدي يضم آخرين كالذهبي والمزي والبرزالي، فإنه ينبغي أن ينظر لتفسيره هكذا أيضًا، كونه صدى لانتمائه لهذا التيار وخاصة الحافظ المزي الذي كان مهتمًّا بإثبات مصداقية الحديث، ومن ثم يظهر لنا أنّ كلام ميرزا عن تفسير ابن كثير في هذا السياق تخريج على نتيجة اعتمدها وهي أنّ ابن كثير تقليدي شافعي فيكون المؤثّرُ عليه في تفسيره هم التقليديين الشافعيين لا ابن تيمية.
ثانيًا: هرمينوطيقا ابن كثير الخاصة:
يلج ميرزا بعد ذلك إلى محاولة إثبات دعائم خاصة لنظرية ابن كثير التأويلية المغايرة لابن تيمية، فبعدما أثبت أنَّ الاتجاه الذي يصح أن ينتمي إليه ابن كثير هو اتجاه التقليديين من الشافعية؛ ذهب أعمق من ذلك محاولًا إيجاد ملامح لتأويلية ابن كثير تباين ملامح تأويلية ابن تيمية، لكنه في بادئ الأمر يعترف بأنّ ابن كثير قد اعتمد بناء ابن تيمية النظري للتفسير الذي أرساه في رسالته (مقدمة في أصول التفسير)، وقد نقل مضامينَها بل نصوصَها ابنُ كثير معتمدًا إياها في مقدمة تفسيره، لكن يرى ميرزا أن هذا لا يعكر على بنائه كثيرًا فإنه طبقًا لوليد صالح: أحيانًا يختلف المسار التطبيقي للمدونة التفسيرية عن التأويلية التي يطرحها المؤلف لمدونته، فيرى ميرزا أن هذا يتطلب دراسات تطبيقية موسعة لبحث هذه المساحات من الاتفاق أو الافتراق بين تأويليته وتطبيقاته في تفسيره، ويتجاوز ميرزا هذه العقبة قاصدًا إلى إبراز فروقات وتمايزات بين تأويلية ابن كثير وتأويلية ابن تيمية، فيرى أن تأويلية ابن كثير مقتصرة على النقل في أغلب مساحاتها، معتمدة على السالفين كابن جرير الطبري، وابن أبي حاتم، فيما يركز ابن تيمية على دحض التفسيرات العقلانية، كما يرى ميرزا أنّ من ملامح الافتراق بين التأويليتين أنّ ابن كثير مهتم بتوثيق الأحاديث في حين أن ابن تيمية لا يهتم بالتخريج والتوثيق في حديثه، ويرى ميرزا أن المنهج الاستدلالي بالحديث عند ابن كثير ليس أمرًا عشوائيًّا ولا هكذا كيفما اتفق؛ بل هو عمل دقيق من الانتقاء والاصطفاء المنهجي الذي يلحظه ميرزا ساريًا في أعماق هذا الكتاب، وعليه فإن ميرزا اتخذ من هذه الفروق -برأيه- حجة في إثبات الافتراق بين تأويلية ابن كثير وتأويلية ابن تيمية.
ثالثًا: مسألة عصمة الأنبياء -مثالًا- لمفارقة ابن كثير أطروحة ابن تيمية:
ولكي يزيد ميرزا في تقديم دلائل افتراق بين المشروعين طرَح مثالًا تطبيقيًّا يتمثل في قصة نبي الله يونس -عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم- والتي يرى ميرزا أن معالجة ابن كثير لها تدل على أنّ مفهومه للعصمة مغاير لمفهوم ابن تيمية، وأن مفهوم ابن كثير أقرب ما يكون إلى مفهوم الرازي، غير أن ابن كثير لا يدخل لها بالمدخل الكلامي الذي يسلكه الرازي، وإنما بالأدوات التقليدية لديه، فيصول ميرزا ويجول في تتبع إجراءات ابن كثير لإظهار نبي الله يونس بثوب المطيع لله، وكيف أن ابن كثير -في سبيل تأسيس رؤيته- غضّ طرفه عن المرويات القائلة بأن ثمة مخالفة ارتكبها نبي الله يونس، بخلاف ابن تيمية الذي يرى العصمة لا تتناقض مع وقوع الخطأ والتوبة لله والرجوع إليه، وبهذا يكون قد أوجد ميرزا مفارقة في إحدى المسائل والتي تبدو لها أهمية كبرى عند ميرزا في إثبات التباين بين رؤية ابن تيمية وابن كثير، الأمر الذي يؤكد على عدم تبعية ابن كثير لابن تيمية من وجهة نظره.
أهم مزايا البحث:
ينطوي البحث على بعض الميزات أهمها ما يأتي:
أولًا: محاولة الإمساك بعدّة خيوط لتحديد موقع تفسير ابن كثير من النظرية التيمية التفسيرية:
حاول هذا البحث الإمساك بعدد من الخيوط التي لو أحسن تخليصها وترتيبها لأفاد في تحديد ملامح العلاقة بين ابن كثير وابن تيمية تفسيرًا، غير أنه قد عكّر صفْوَ فكرته عددٌ من الورطات المنهجية، والمعالجات السطحية، وإن كان الموضوع في ذاته صالحًا للفحص والدرس، ولو أحسنت معالجته، لآتَى أُكلَه في التبصير بملامح العلاقة بين هذيْن المفسّرَيْن الكَبِيرَيْن، فتثميني يتوجه إلى الموضوع في ذاته، ونقدي يتوجه إلى معالجة ميزرا؛ لما وَقعتْ فيه من إشكالات سيأتي بيانها.
ثانيًا: شفع التنظير بالتطبيق:
حيث لم تُغفِل الدراسة الجانب التطبيقي -بغضِّ النظر عن كفايته- لكن هذا مفيد في نشر ثقافات البحث التطبيقي في التراث التفسيري، وهو أمر قليل الحضور في واقعنا البحثي التفسيري.
ثالثًا: التبصير بملامح منهجية غائبة عن فهمنا لتفسير ابن كثير:
من أبرز ميزات هذه الدراسة ما ألمحت إليه من متفرقات بالغة الأهمية كملامح منهجية لتفسير ابن كثير، كالإشارة إلى أنه -بخلاف ما يرى كثير من الباحثين- فإن المادة الاستدلالية الحديثية في تفسير ابن كثير منتقاة بعناية وفق منهج منتظم ومنضبط يحسن بالباحث الجاد استكشاف ملامح هذا المنهج على طول التفسير، وقد ظهر ذلك جليًّا في مناقشة ميرزا لاستدلال ابن كثير على قصة يونس.
القسم الثاني: بحث ميرزا؛ نقد وتقويم:
مع ما سلف ذِكره من حسنات الدراسة، فإنه لا يمنع احتواءها على عدد من الإشكالات الحقيقة بالنَّظر. ولمّا كانت هذه الدراسة متصدية لتغيير رأيٍ جماهيري -على حد زعم الدراسة- فكان لا بد أن تكون الإجراءات المنهجية قاطعة وحاسمة في هذا الصدد بشكل كافٍ لنقض هذا القول الجماهيري السيَّار، ولمّا كانت الدراسة قاصدة إلى تفتيت علاقات علمية، وتشابكات فكرية، وتكوين روابط أخرى وسلاسل نسب فكرية مغايرة؛ كان لا بد من تمحيص تأسيساتها وبناها المنهجية قبل أن نقبل بهذه التقريرات. ولذا فإني لن أتوقف كثيرًا عند الإشكالات العامة التي أورثت تخبطًا كبيرًا في عدد من الجزئيات؛ بل سأطرح الإشكالات المركزية والتي تراكمت بسببها أخطاء في الدراسة. وأبرز الإشكالات ما يأتي:
أوّلًا: تأسُّس الدراسة على قبول مغالطة القسمة الثنائية واعتمادها:
وهي مغالطة منطقية شهيرة تحصر الآخر بين حُكمين في قضية لا يلزم فيها هذا الحصر، والمراد بها ها هنا أن ميرزا قد قَبِلَها أو سلَّم ضمنًا بقبولها، بتصويره الأمر هكذا: «ابن كثير إمّا متحدث باسم ابن تيمية أو لا علاقة له به»، أو بعبارة أخرى: تفيد المصادر بأنّ ابن كثير لصيق بابن تيمية، إذن يجب أن يكون مخلصًا حتى النخاع لنظريته التفسيرية، وهذا ما توهَّمه ميرزا من كلام بعض مَن ترجموا لابن كثير، ومن كلام بعض الباحثين الغربيين، وميرزا يقول لهم ويريد أن يقول لنا: هو ليس كذلك؛ إذن فلنبحث له عن انتماءٍ آخر. ومكمن الغلط هنا أن الأمر ليس على هذه الصورة، فالبديهي المتقرر لدى كل مُطَّلع على علاقة ابن كثير بابن تيمية أنها علاقة تلمذة واستفادة وانتفاع وتأثر، لا علاقة تبعية وذوبان تامٍّ، وأجزم أن هذه هي رؤية أصحاب التراجم لعلاقة ابن كثير بابن تيمية، كما سننقل عنهم في موضعه من المقال.
وتناثَر من هذه المغالطة عدةُ إشكالات تفرّقت في جميع أنحاء الدراسة، فينبغي التوقف هنا مليًّا لتفكيكها.
إنَّ الناظر في هذه الدراسة ليلحظ لَمْز ميرزا للتراجم قاطبة لسوء نظرتها لابن كثير على أنه «تلميذ للمفكر الأصلي ابن تيمية، وأنه خارج من عباءة ابن تيمية، وأنه يلهج ببساطة بلسان معلِّمه»؛ كما نص بحروفه[5].
فهل قالت الترجمات ذلك أصلًا؟ وهل هذا حق في نفسه؟
أولًا: بعد البحث والغوص المطول في أعماق المدونات المترجمة لابن كثير وجدناها جميعًا تنص على أنّ ابن كثير إمام علّامة وفقيه متفنن ومحدِّث متقن ومفسر نقَّاد[6].
يقول ابن حجر: وكان كثير الاستحضار حسن المفاكهة سارت تصانيفه في البلاد في حياته وانتفع بها الناس بعد وفاته، قال الذهبي في المعجم المختص: الإمام المفتي المحدِّث البارع فقيه متفنن محدث متقن مفسر[7].
ويقول السيوطي: الإمام المحدّث الحافظ ذو الفضائل عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير وتخرج بالمزي ولازمه وبرع، له التفسير الذي لم يؤلف على نمطه مثله[8].
ويقول الداودي: كان قدوة العلماء والحفاظ وعمدة أهل المعاني والألفاظ[9].
كل المصادر -بلا استثناء- تنص نصًّا على إمامته في الفقه والتاريخ والتفسير ثم يقال إنهم ينظرون إليه فقط كلسانٍ لشيخه؟ إن هذا لأمر عُجاب! وهو الأمر المفيد قطعًا بأن ميرزا لم يقرأ المصادر على النحو المنهجي المنضبط الذي يبني على ما فيها، وهذا مبدأ الخلل في قراءة ميرزا.
وينبغي التفطن إلى أمر مهم وهو أن هذا الذي تحكيه التراجم هو واقع الأمر في نفسه، واقعه من حيث إمامة ابن كثير في عدد من العلوم، وهو الأمر الذي ركزت عليه التراجم تركيزًا بالغًا، فقد اعتنت التراجم ببيان إمامته في علم الحديث وفي علم الفقه وفي علم التاريخ وفي علم التفسير، كما عبرت التراجم أيضًا عن واقع تلمذته على شيوخه، فاعتبار ميرزا أنّ ذِكر التراجم لعلاقة ابن كثير بابن تيمية على النحو المذكور فيها = نوعًا من الغلوّ؛ فهو وشأنه، إلا أننا نؤكد على أن ما ذكرته التراجم هو حقيقة الواقع في نفسه من حيث كونه تلميذًا لابن تيمية كغيره من أقرانه من تلاميذ الشيخ، ومن حيث كونه إمامًا في العلوم ومنها التفسير.
ولو اعتبر ميرزا ذِكر التراجم لعلاقة ابن كثير بابن تيمية؛ بهذا القدر المذكور = نوعًا من الغلوّ، فإن السؤال المتحتم عليه الجواب عنه هو: لماذا لم تعتبر ذكر التراجم وتركيزها على علاقة ابن كثير بالمزّي نوعًا من الغلو؟ أو بصيغة أخرى؛ فلماذا لم يلمز التراجم من جهة غلوّها (على حد تعبيره) في تصوير العلاقة بين ابن كثير والمزي، وكأنّ ابن كثير متحدِّث باسم المزي، على الرغم من أنّ ما ذكرته التراجم من علاقة ابن كثير بالمزي أبينُ في تصوير توطُّد صلته بالمزي مما ذكروه في تصوير توطُّد علاقته بابن تيمية، وإليك طرفًا مما ذكروه من هذه العلاقة:
لقد أتت ترجمة الحافظ ابن حجر لابن كثير وجيزة جدًّا، مما جعل المعلومات التي أوردها مركَّزة في استكناه شخصية ابن كثير، ومع ذلك فكان مما ذكره الحافظ قوله: «ولازَم المزي وقرأ عليه تهذيب الكمال، وصاهره على ابنته»[10]. فكيف فات ميرزا التدقيق في دلالة هذه الكلمة (لازَم) مع ما هو حاصل من علاقة اجتماعية زائدة على العلاقة العلمية، وهو الأمر الذي يجعل العلاقة شديدة الصلة شديدة الارتباط.
ونجد السيوطي وهو يترجم لابن كثير في طبقات الحفاظ يعتني بإبراز هذه العلاقة الخاصة بين ابن كثير والمزي، بل يجعل المزي هو الشيخ الأكبر لابن كثير، فيقول: وتخرج بالمزي ولازمه وبرع[11].
ثم نجد الداودي وهو الذي يعتني في طبقاته والتي يفترض أن تعتني بكون ابن كثير مفسرًا نجده يعتني بذكر الأثر العظيم للمزي على ابن كثير بقوله: ثم صاهر الحافظ أبا الحجاج المزي ولازمه، وأخذ عنه وأقبل على علم الحديث[12].
إن هذا الذي ذكروه في شأن العلاقة بين ابن كثير والمزي؛ أكبر بكثير مما ذكروه في شأن العلاقة بين ابن كثير وابن تيمية، فهل يقال إنهم يقولون: إنّ ابن كثير كان متحدثًا باسم المزي؟!
فإن قيل: فماذا عن النصوص التي نقلها ميرزا والتي ينص فيها ابن حجر ومن جاء بعده على أنّ ابن كثير كان تلميذًا لابن تيمية معجبًا به وامتُحن بسببه، وقيل إنه كان يفتي بقول ابن تيمية في الطلاق؟
فنقول: إن ابن كثير كان تلميذًا لابن تيمية بلا ريب، ومنهج التراجم إنها إذا ترجمت لعالم فإنها تبرز مكانته من خلال عظماء شيوخه، وكما قيل فالمرء بشيخه، فلا يعني شيئًا أن تنص التراجم على أن ابن كثير كان تلميذًا لابن تيمية سوى رفعة شأن ابن كثير بذلك. وأمّا إعجابه الشديد بابن تيمية كسائر من عرفوا ابن تيمية عن قرب، ما عرفه أحد إلا وأُعجب به، وذهل من سعة اطلاعه وحافظته، شأنه شأن الإمام ابن دقيق العيد مع ابن تيمية، وشأنه شأن الأصبهاني مع ابن تيمية، وشأنه كشأن الإمام الفقيه الجليل ابن الرفعة مع ابن تيمية، وشأنه كشأن العلامة ابن ناصر الدين الدمشقي مع ابن تيمية، وكشأن عشرات من جِلّة العلماء الذين لقوا ابن تيمية فأدهشهم ما فتح الله عليه به من حافظة وسيلان ذهن، وتوقد عقل، وأكثرهم من مخالفي ابن تيمية في أمور، والشاهد أنّ ذِكر ذلك في ترجمة ابن كثير لا يعني سوى أنه كغيره ممن عرفوا ابن تيمية عن قرب وأُعجبوا به، وبعضهم امتُحن بسببه. أمّا أن يَستخلص الباحثون الغربيون من ذلك -ويُسلِّم لهم ميرزا- أنَّه متحدِّث باسم شيخه؛ فهذا مما لم ينطق به أحد، ولم يقله عالم، ولا يقال في حق عالم أصلًا، إنّ هذا لم يُقَل في حق ألصق الناس بابن تيمية وهو الإمام ابن قيم الجوزية وهو الحنبلي الشهير اللصيق بابن تيمية، فلا أدري كيف تطرق هذا الوهم إلى ذهن ميرزا؟
وجملة القول أنّ بناء البحث على التسليم بهذه المغالطة قد أفقد ميرزا الاتزان في الرؤية فظن أنّ المؤرخين يعتبرونه مجرد تلميذ ناطق باسم شيخه، فانتقل من ذلك إلى رأيٍ مباينٍ تمامًا قائلٍ بأنّ ابن كثير ذو اتجاه تقليدي مناوئ للاتجاه الكلامي داخل المذهب الشافعي، وهذه النتائج وليدة من رحم قراءة مجتزأة وغير ذواقة للكتابات حول ابن كثير، والنظر السديد يدرك بسهولة أن ابن كثير كغيره من نجباء تلاميذ ابن تيمية، أخذ عنه واستفاد منه وقَبِل منه وردَّ عليه، وابن كثير في عيون التراثيين هو العالم العلامة الفقيه المؤرخ المحدِّث المفسِّر الكبير لا التلميذ الصغير كما يتصوَّر الباحثون الغربيون ويُسلّم لهم ميرزا.
وفي هذا الصدد يجدر بنا أن نشير إشارة خاطفة إلى أمر مهم وهو أن المتتبع المتفحص للمفسرين ومنتجاتهم التفسيرية يجد أمرًا شائعًا مشتركًا بينهم، وهو أن الممارسة التفسيرية لدى العالم غالبًا ما تأتي بعد اكتمال آلته العلمية، أو على الأقل استوائها ونضجها، بحيث إنّ المتأمل يرى حصيلة العالم العلمية بأكملها موظفة في التفسير بما يراه المفسر داخلًا في حيثية علم التفسير، وبمعنى آخر يمكننا القول إنّ السمة العامة للكتابات التفسيرية أنها أتت بعد نضج العالم معرفيًّا بما يجعل تفاسير غالبهم نتاج عمل علمي ثقيل تنصهر فيه كافة علومهم ومعارفهم وقناعاتهم وأطروحاتهم في صناعة المعنى التفسيري، بغض النظر عن مفهوم المعنى التفسيري وحدوده لدى المفسرين، وهذه القناعات والعلوم والمعارف والمناهج وإن لم تظهر متمثلة منصوصًا عليها بوضوح في التطبيق؛ فإنها كامنة في الناتج التفسيري، تظهر لمن يتلطف في استنباطها. وهذا يعني أن تفسير ابن كثير كغيره من المدونات التفسيرية تمثّل نتاج المصهور العلمي الكثيري، هذا على مستوى التطبيق في تحرير المعنى، ويتضح هذا أجلى ما يتضح حينما يخوض غمار تحرير المعنى، هنا تظهر الفروق بين التكوينات العلمية المختلفة، وإن اتفقت في نظرية تأويلية واحدة، لا سيما إذا ما بينّا أن التكوين العلمي لدى ابن كثير كان مزيجًا من ثقافات مختلفة ورؤى متباينة المشارب، فلقد كان بين شيوخه على كافة المستويات نوعٌ من التباين والتمايز بما صبغ شخصية ابن كثير صبغة فريدة في التشكُّل والتكوُّن مغايرةً لكل واحد من شيوخه، فلك أن تعجب أنّ ابن كثير قد أخذ الكثير عن ابن تيمية، وهو العالم التقليدي السلفي النازع إلى تأويلية عقدية لها سماتها الخاصة والتي تقوم على منافرة التيار الكلامي عمومًا في صورتيه الأشعرية والاعتزالية، وعلى العدوة القصوى نجد ابن كثير يقرأ أصول الدين وأصول الفقه على الإمام الأصفهاني قطب المدرسة الأشعرية في عصره ومقدمها في الأصلين[13]، فلك أن تعجب من الانفتاح الذي انطبعت به شخصيته فأنالتها هذه التعددية، ولك أن توقن أن التعدد والتنوع في مصادر التلقي، وعدم الانكفاء على شيخٍ واحدٍ والاكتفاء به لا بد أن يورثه الخلال النفسية والملكات العلمية التي تجعل ممارسته متفردة على مستواها التطبيقي بشكل عام وإن اتفق في جزئيات مع مصادر التأثير المتنوعة تلك، وهذا متفهم جدًّا، كما لا يعارض هذا كونه ارتضى منهجية عامة يسير في ضوئها في التفسير، وهي المنهجية التي طرحها ابن تيمية في (مقدمة في أصول التفسير). أمّا كيفية تدوير هذه الأصول وتطبيقيها، ومواضع تقديم بعضها على بعض أو تأخير بعضها على بعض أو تحديد لوازم هذه التراتبية في العملية التفسيرية وهذه الدقائق التطبيقية بشكل عام = فهو عمل كثيري خاص ناتج عن صبغته هو ومجموع تكوينه العلمي ومجموع المؤثرات الخارجية المتنوعة عليه.
ثانيًا: الدراسة ليست تفسيرية الطابع:
إنَّ من أعظم الإشكالات التي اعترت الدراسة وبناءها أنها رفعَت سقف توقعات المطالع لعنوانها إلى أنَّها دراسة تفسيرية ستعنى بتفكيك البنى النظرية للمادة التفسيرية عند العالِمَين، وستغطي -في سبيل ذلك- نطاقًا تطبيقيًّا واسعًا تفككه وتحلله وتبرز ملامح المنهج عند كل عالم، ومن ثم تُوازن وتقرر، ولكن الدراسة أتت مخيبة للآمال والتوقعات على هذا الصعيد ابتداء من إشكالية الدراسة؛ إذ ذهب ميرزا يقرر أن ثمة قولًا شائعًا بكون ابن كثير ناطقًا باسم ابن تيمية في مسألة الطلاق، وامتُحن بسببها! وإذ لم يأت لنا بنصٍّ واحد يربط بين ابن تيمية وابن كثير تفسيريًّا كما هو المنتظر لمن يعالج هذه المسألة القضية التفسيرية؛ ذهب ليستظهر بقولٍ فقهيٍّ تابَع فيه ابنُ كثير ابنَ تيمية[14]، على أنَّ في ثبوته نظرًا[15]. فكأنَّه جعل قضية العلاقة التفسيرية بينهما قياسًا أو تخريجًا على مسألة فقهية واحدة، وبنى على ذلك ما توهمه من نطق ابن كثير باسم ابن تيمية في كل مسائل العلم.
وعليه؛ فالواضح أنَّ الدراسة لم تنجح في التدليل على وجود إشكالية حقيقية في النظرة التراثية لتفسير ابن كثير، التي تصفه كتفسير فريد لم يُنسج على منواله كما نص على ذلك الحافظ السيوطي[16]، في إطار كونه مستفيدًا من ابن تيمية بحكم التلمذة والتعلم، وأظهر دليل على ذلك -ومثل هذا مما لا يحتاج تدليلًا- أن البناء النظري التيمي المتمثّل في (مقدمة أصول التفسير) هو ما اعتمده ابن كثير بناءً نظريًّا لكتابه، ولا بد من ملاحظة أمر بالغ الأهمية، أننا نقرر أن ابن كثير اعتمد مقدمة ابن تيمية في أصول التفسير، ولا نقول إنه اعتمد ابن تيمية كله جملة واحدة، فهذا مما لا يقول به عاقل فضلًا عن باحث، فليتنبه لهذا، وليكن من القارئ الكريم على ذُكر حتى لا يورد على كلامي ما ليس بوارد عليه.
إنّ ابن كثير قد اقتبس الفصلين الأخيرين من رسالة ابن تيمية بحروفها وأدرجها في مقدمة تفسيره دون عزوها إلى ابن تيمية، وهذا النقل النصي المطول شاهدٌ واضحٌ على ارتضاء ابن كثير هذا المنهج التيمي في التفسير وتراتبية المصادر في توضيح النص القرآني، وهذا الأمر مما لا يمكن المراء فيه بمثل هذه الأوهام التي استدعاها ميرزا، وقد أكّد وليد صالح وصرّح بهذا الأمر الواضح بقوله: إن تفسير ابن كثير هو العمل التفسيري الأضخم والأول من نوعه الذي يحاول صاحبه إعمال النظرية التيمية في التفسير.
على أننا نؤكد أنَّ ارتضاء ابن كثير للنظرية التيمية لا يعني أنَّه متحدث باسمه، ولا أنَّ ابن كثير في معالجاته قائلٌ بكلِّ ما يقول به ابن تيمية، ولا أنَّ ابن تيمية مسؤول عن آراء ابن كثير في تفسيره، أو يمكن نسبتها إليه، أو أيّ شيء من هذا القبيل. فالاختلاف في بعض آرائهما متوقَّعٌ، ولا يُعكِّر بحالٍ على ارتضاء ابن كثير النظرية التأويلية التيمية.
ثالثًا: التأسيس على بنى معرفية مشكلة ومتداخلة:
وهذا سمت عام في الدراسة حيث يتجلى فيها قدر كبير من إدخال المسارات الفكرية في بعضها، وهو ما أثمر لنا القول بأنّ تفسير ابن كثير ردٌّ غير مباشر على تفسير الرازي.
وهذه النتيجة مؤسسة على عدد من الأوهام التي يجب علينا الوقوف معها مليًّا بالتمحيص والتقويم، ومنها:
1- القول بتأسُّس الصراع بين التقليديين والعقلانيين على اختلاف مصادر الاستدلال وتراتبيتها:
انطلق ميرزا في تأسيسه لقضية تفسيرية من وجود صراع تاريخي بين تيارين كبيرين يشكّلان العقل التراثي، وهما تيارا التقليدية والعقلانية، ويصور ميرزا أن هذا الصراع قائم على التنازع حول ماهية الأدلة المستخدمة في النص، فيحاول تصوير أن القضية متمثلة في رفض التقليديين أيّ دليل كلامي أو فلسفي، وهو الذي توغل فيه العقلانيون. وهذه النظرة الاستشراقية مع بطلانها الظاهر؛ فإن العقل الاستشراقي ما زال متحجرًا على هذه النظرة ولم يتجاوزها بعدُ، ولو أن الأمر كما يصورون من أنه صراع قائم على مصادر الاستدلال لمَا التأم أبدًا حتى يرجع أحد الفريقين عن رأيه، إلّا أن الواقع والحقيقة والتاريخ كلها شواهد على خلاف ذلك، بل أئمة الاتجاهين شاهدون على خلاف ذلك، فالإمام أحمد بن حنبل -وهو بمعيارهم إمام تقليدي بامتياز- يقول: «ما زلنا نلعن أهل الرأي ويلعنوننا حتى جاء الشافعي فوفَّق بيننا»[17].
فمع هذا القول الذي لا يمكن إهماله في تفهُّم حقيقة الخلاف من هذا الإمام الجليل المعروف لدى الأصوليين بإمام أهل السُّنة والجماعة؛ يظهر بجلاء أن حقيقة الصراع تكمن في عدم قدرة الطرفين على تفهم مناهج النَّظر لدى الآخر وأدلته وحججه؛ حتى جاء من يستطيع أن يقرب بين وجهات النظر فالتأم الخلاف.
وغير خافٍ على قارئ مطلع على التاريخ أنَّ الأشاعرة العقلانيين والحنابلة التقليديين كانوا لُحمة واحدة حتى وقعت فتنة ابن القشيري، يقول ابن عساكر: «ولم تزل الحنابلة ببغداد في قديم الدهر على ممر الأوقات تعتضد بالأشعرية على أصحاب البدع؛ لأنهم المتكلمون من أهل الإثبات فمَن تكلم منهم في الردّ على مبتدع فبلسان الأشعرية يتكلم، ومن حقق منهم في الأصول في مسألة فمنهم يتعلم، فلم يزالوا كذلك حتى حدث الاختلاف في زمن أبي نصر القشيري ووزارة النظام، ووقع بينهم الانحراف من بعضهم عن بعض لانحلال النظام»[18].
وابن تيمية ينقل هذا الكلام مقرًّا له في أكثر من موضع في كتبه، ثم قال بعد نقل كلام ابن عساكر في فتنة أبي نصر القشيري آنفة الذكر: «ثم بعد حدوث الفتنة وقبلها لا تجد من يمدح الأشعري بمدحة، إلا إذا وافق السُّنة والحديث، ولا يذمه من يذمه إلا بمخالفة السُّنة والحديث. وهذا إجماع من جميع هذه الطوائف على تعظيم السّنة والحديث واتفاق شهاداتهم على أن الحق في ذلك؛ ولهذا تجد أعظمهم موافقة لأئمة السّنة والحديث أعظم عند جميعهم ممن هو دونه»[19].
ويقول في موطن آخر:«وأمّا بغداد فلم تجرِ فيها لعنة أحد على المنابر، بل كانت الأشعرية منتسبة إلى الإمام أحمد وسائر أئمة السُّنة»[20].
وبعد أن زالت هذه الفتنة العصيبة بين هذين التيارين رجعوا تيارين متقاربين جدًّا حتى عصر ابن تيمية -رحمه الله- فلا موضع أبدًا لما تعنَّى ميرزا في تأسيسه من أنَّ هناك صراعًا حول مصادر الاستدلال، وأن الشافعية قد اتجهوا نحو الكلام والفلسفة، فأراد ابن كثير أن يرجع إلى المسار التقليدي، فألّف تفسيره انطلاقًا من هذه الإرادة.
ويمارس ميرزا قفزات مزعجة، فينتقل من كلامه على الشافعية كمذهب فقهي إلى الحديث عن الأشاعرة -وهو مذهب عقدي- ثم ينتقل بما استنبطه من ذلك للحديث عن تفسير ابن كثير، دون مراعاة لتباين حيثيات هذه العلوم، والحديث بهذه الصورة مُفكَّك مربكٌ.
والصواب أن تتقرر المذاهب في العلوم المتباينة كلّ على حدة، فلا علاقة كبيرة بين شافعية ابن كثير الفقهية أو أشعريته العقدية بتأويليته التفسيرية إلا في نطاق صغير وهو المتعلق بآيات الأحكام وآيات الصفات. فحيثية علم التفسير مختلفة عن الحيثية الفقهية، والحيثية العقدية. واستدعاء هذه التداخلات في غير محلّها مع غضِّ الطرف عن صلب بنائه النظري في مقدمة تفسيره؛ قد أنتج هذا القدر من الأوهام.
وأمّا ابن كثير فهو من ناحية المذهب الفقهي شافعي المذهب، ومن ناحية المذهب العقدي فقد نقل ابن حجر عنه أنه يقول إنه أشعري[21]، وهو مع ذلك تلميذ ابن تيمية ومتأثر به -بلا شك- ومرتضٍ لتأصيله التفسيري المبيَّن في مقدمته، وهي التي اتّبعها في عامّة كتابه، وحتى تخرج لنا دراسات تحليلية إحصائية؛ فالأصل أنَّ بناء ابن كثير في أصول التفسير متأثر بالتأصيل التيمي، وأمَّا تطبيقاته بحذافيرها فتمثِّله هو من حيث كونه المفسّر ذا الرؤية الخاصة المتشكّلة من تفاعل جميع الظروف الملابسة له في بيئته العلمية.
2- القول بأن تقليدية ابن كثير لرفضه التوسع الحجاجي والجدلي:
ويبدو أن هذا القول مؤسس على أنه لا يوجد مادة حجاجية أو جدلية كلامية في تفسيره بخلاف ابن تيمية، وهذا يوهم القارئ بأنَّ ابن كثير معادٍ للحِجاج الجدلي والأصولي والكلامي، فإذا ما راعينا أن المفسر لا يلزمه أصلًا التوسع الجدلي والكلامي -لا سيما وأن ابن تيمية منظِّر لذلك أصلًا- اتَّضح خطأ ميرزا الفاحش في ذلك. وبتأمل موقف ابن تيمية من التفاسير نجده يُقوّمها بمدى اعتنائها بالتفسير الأثري، وليس الحجاج الكلامي، بل مدار ذمّه لعدد من التفاسير هو اعتناؤها بالحجاج الكلامي دون قول السلف ومنهجهم. يقول ابن تيمية: «وأمّا التفاسير التي في أيدي الناس فأصحها تفسير محمد بن جرير الطبري، فإنه يذكر مقالات السلف بالأسانيد الثابتة، وليس فيه بدعة، ولا ينقل عن المتهمين كمقاتل بن بكير، والكلبي. والتفاسير غير المأثورة بالأسانيد كثيرة: كتفسير عبد الرزاق، وعبد بن حميد، ووكيع، وابن أبي قتيبة، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه. وأمّا التفاسير الثلاثة المسؤول عنها فأسلمها من البدعة والأحاديث الضعيفة (البغوي)، لكنه مختصر من (تفسير الثعلبي)، وحذف منه الأحاديث الموضوعة، والبدع التي فيه، وحذف أشياء غير ذلك. وأمّا (الواحدي)، فإنه تلميذ الثعلبي، وهو أخبر منه بالعربية، لكن الثعلبي فيه سلامة من البدع، وإنْ ذكرها تقليدًا لغيره. وتفسيره وتفسير الواحدي البسيط والوسيط والوجيز فيها فوائد جليلة، وفيها غث كثير من المنقولات الباطلة وغيرها.
وأمّا (الزمخشري) فتفسيره محشوّ بالبدعة، وعلى طريقة المعتزلة من إنكار الصفات، والرؤية، والقول بخلق القرآن، وأنكر أن الله مريد للكائنات، وخالق لأفعال العباد، وغير ذلك من أصول المعتزلة. وتفسير (القرطبي) خير منه بكثير، وأقرب إلى طريقة أهل الكتاب والسُّنة، وأبعد عن البدع. وإن كان كل من هذه الكتب لا بد أن يشتمل على ما ينقد، لكن يجب العدل بينها وإعطاء كل ذي حق حقه. وتفسير (ابن عطية) خير من تفسير الزمخشري، وأصح نقلًا وبحثًا، وأبعد من البدع. وإن اشتمل على بعضها، بل هو خير منه بكثير، بل لعله أرجح هذه التفاسير، لكن تفسير ابن جرير أصح من هذه كلها[22].
فمدار مدحه لابن جرير الطبري هو اعتناؤه بآثار السلف لا التوسع الحجاجي أو الكلامي ومدار ذمّه للزمخشري أو الواحدي هو الاعتناء بالكلام والحجاج على غير طريقة السلف، وحتى مقاربته في أمر تفسير ابن عطية متعلق أيضًا بمدى قُربه أو بُعده من الاقتصار على قول السلف، ومن هنا نعلم أن ميزانه للتفاسير قائم على الاعتناء بالتفسير الأثري، وأمّا الحجاج العقلي فيوضح ابن تيمية أن أكثره هو مضطر إليه من باب منازلة الخصوم بأدواتهم، وله كلام طويل في هذا في (درء تعارض العقل والنقل)[23].
وقد غفل ميرزا عن ذلك؛ لعدم تفريقه بين مقام الحديث عن التفسير، وبين مقام الحديث في الجدل العقائدي، وهذا القدر كافٍ في إبطال هذا القول. فإذا ما انضاف إلى ذلك أن الواقع العملي لابن كثير يكذب هذا القول ويخالفه، فإن كتب التراجم قد رصدت لنا نشاطًا أصوليًّا جدليًّا على طريقة المتكلمين، يتمثل في عناية الحافظ ابن كثير بمختصر ابن الحاجب، المسمى (بمختصر منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل). ولقد اعتنى الحافظ ابن كثير بهذا الكتاب عكوفًا عليه ومدارسة له، حتى بلغ من عكوفه عليه أنه ألَّف جزءًا في تخريج أحاديث المختصر.
وهذا قاضٍ ببطلان ما يؤسس له ميرزا؛ وإظهارُه لابن كثير في صورة المنكر المعارض للبحث الكلامي والأصولي والجدلي لا دليلَ عليه، بل سيرته شاهدة على خلاف ذلك، ودراسته واعتناؤه بمختصر ابن الحاجب يدل على خلاف ما يحب ميرزا، ولعل ما دفع ميرزا لهذا القول هو خلو تفسير ابن كثير عن مثل هذا الجدل والتحرير الكلامي، وهذا متفهم في ظل كون تأويليته التي طرحها في مقدمة كتابه تنص على المصادر الواجب اعتمادها في التفسير، ولا يعني هذا إغفال المصادر الأخرى في علوم أخرى. وهذا الأمر لو استقام لميرزا لذابت لديه كثير من الأوهام، ولا أدري كيف فات ميرزا أن ابن تيمية الذي يراه مجادلًا متكلمًا متوسعًا في الحجاج الكلامي؛ هو ذاته يرفض هذه الأدوات في تفسير النص، فما يفرضه ميرزا لابن كثير هو عين تأويلية ابن تيمية في التفسير.
وعليه؛ فتأويلية ابن كثير في التفسير تدل على أن ثمة تقاربًا كبيرًا في تأويليته مع ابن تيمية في المنهج التفسيري، وينبغي أن يتقرر هذا بعيدًا عن الزج بهذا في تداخل التمايز المذهبي العقدي أو الفقهي حتى لا تتداخل حيثيات علوم مختلفة في غير محلها، ونبقى في أمر مريج.
3- القول بتوصيف تفسير ابن كثير كمحاولة أشعرية في مقابل تفسير الرازي الأشعري:
يحاول ميرزا في ورقته هذه تسييق تفسير ابن كثير في مقابل تفسير الرازي؛ ليبدو الأمر وكأنه جدل داخل التيار الأشعري، بعيدًا عن ابن تيمية. والإشكال الأكبر أن ميرزا ما زال واقعًا في فخ استدعاء المنتج التفسيري في مساحات أجنبية عنه، فلا تأثير كبيرًا في التأويلية التفسيرية بكون ابن كثير أشعريًّا شافعيًّا تقليديًّا، ولا بكون الرازي أشعريًّا يخالف مبادئ الأشعرية أو الشافعية في معالجته التفسيرية، بل الصواب أن المدارس العقدية أو الفقهية ليس بالضرورة أن يمتلك كل منها نظرية تأويلية في التفسير تميزها عن غيرها، بحيث يصح أن يقال مثلًا: إن الرازي قد توسع في التفسير مخالفًا تأويلية الشافعية أو الأشعرية في ذلك، وقد أراد ابن كثير تنقيح هذا المسار. فتصوير الأمر بهذه المثابة مشكل من وجوه كثيرة؛ من أهمها: عدم وجود تأويلية تفسيرية خاصَّة لكل مذهب عقدي أو فكري، وليس لزامًا على كل مذهب امتلاك ذلك.
والتفكير بهذا النمط لدى ميرزا ناشئ -في ظني- من سطحية المعالجة وعدم عمق الاطلاع على التراث الإسلامي كما ينبغي لباحث متخصص، مما أدّى إلى عدم وضوح علم التفسير عنده كعلم خاص متفرد له حيثيته التي تختلف عن حيثية المذهب العقدي أو الفقهي. وليكن هذا الأمر من القارئ على ذكرٍ؛ بأننا لا نوافق ميرزا على هذا التقعيد من أساسه بالزج بالمدونات التفسيرية وتصوير تشكُّلها وتكوُّنها في ضوء الملابسات الفقهية أو العقدية، ولا نرى هذا الإطار صالحًا لفهم واقع المنتج التفسيري الكثيري، لا سيما وقد نص على تأويلية تفسيرية بعيدة عن تعقيدات المذهبية والعقدية، لكن ما سنذكره من باب التنزُّل لإبداء إشكالات الطرح في سياق ما استظهره من رؤية، وإن كانت رؤيتنا للأمر لا توافِق رؤيتَه، ولا توافقُ عليها.
أولًا: تباين تأويليات المنتجات التفسيرية لدى المنتمين للمدرسة الأشعرية:
العلماء الشافعيون الأشعريون كثيرون منذ عصر أبي الحسن الأشعري، وحتى عصر ابن كثير، مختلفون زمانًا ومكانًا، وفي بيئاتهم العلمية، وتكويناتهم المعرفية، وهُم وإنِ اتفقوا إجمالًا في أصول تضبط عملهم في البحث الفقهي المتعلق بالحكم على أفعال المتكلمين، وهي أصول الشافعي، وإنِ اتفقوا أيضًا في قواعد عقلية تضبط الكلام في الإلهيات والنبوات والسمعيات، وهي قواعد الأشعري =فلا يعني هذا بالضرورة اتفاقهم على أصول تأويلية لعملية التفسير من بيان المعنى وبيان حدوده، وما يدخل فيه وما يخرج عنه، وما يحتاجه من أدوات، وتراتبية هذه الأدوات في الأهمية، وكيفية إعمال هذه الأدوات ومواضع تقديم بعضها على بعض وآلية ذلك، كل هذه العمليات التأويلية لم نر لهؤلاء العلماء إطارًا عامًّا يصرّحون به أو يتفقون عليه، كما هو الحال في أصول الفقه مثلًا. بل على العكس، خرجت منتجات تفسيرية تنتمي لهذا الإطار الشافعي الأشعري مختلفة فيما بينها متباينة في مضامينها التفسيرية، لا تكاد تتفق على حدود واضحة لمساحات العملية التفسيرية وحدودها وأدواتها.
فمثلًا لدينا تفسير الإمام الماوردي وهو شافعي أشعري نرى ممارسته تقتصر على بيان معنى الآي دون توسع في الكلام على النكات البلاغية أو الفقهية أو العقدية، ودون التوسع فيما يتعلق الآية من علوم، بل يقصد إلى تحرير المعنى باستخدام حمل الآيات على بعضها، واستخدام الآثار في البيان، وكذلك المرويات الإسرائيلية أيضًا. فيما نجد البيضاوي يعتني بالتحليل اللغوي ويبتعد تمامًا عن استعمال الإسرائيليات ولا يعتني كثيرًا بالآثار. وهكذا لدينا تفسير الجلالين، وهما شافعيان، ولدينا تفسير الثعلبي والسمعاني والخطيب الشربيني والرازي، وكلهم شافعية أشاعرة، ولا يخفى ما بين هذه التفاسير من تفاوت حتى مستوى النظرية التأويلية؛ فضلًا عن الاختلاف في مفهوم التفسير وحدوده وأدواته عندهم جميعًا، وكلُّهم شافعية أشاعرة، ولم يمنعهم هذا من التباين في نظرتهم لعلم التفسير وحدوده وأدواته، ولا يتعلق الأمر بتقدُّم ولا تأخُّر؛ حتى لا يسبق للذهن أن للمتقدمين منهم نظرية تأويلية واحدة تواطؤوا عليها، ثم أتى المتأخرون من بعدهم بنظرية تأويلية مغايرة، بل كل تأويلية لها قدر يميزها عن غيرها، وهي غير ناشئة من تأثير فقهي أو عقدي، بل ناشئة من رؤية المصنف لعلم التفسير وما يدخل فيه وما يخرج عنه، سواء نص على ذلك أم لم ينص.
وأضرب مثالًا بتفسير الإمام الرازي -رحمه الله- فقد يظن ظانٌّ أن حشو الرازي لتفسيره بالمباحث التي يستنكرها بعضهم إنما هي أثرٌ محضٌ عن مذهبه العقدي أو الفقهي أو غيره، والحقّ أن الأمر يتعلق بنظرته الشخصية لعلم التفسير ذاته بعيدًا عن أيّ شيء آخر، سواء اتفقتَ معه أو اختلفتَ، لكن يبقى الأمر بعيدًا عن مذهبه العقدي والفقهي.
يقول -رحمه الله-: «وربما جاء بعضُ الجهّال والحمقى وقال: إنك أكثرتَ في تفسير كتاب الله من علمي الهيئة والنجوم، وذلك على خلاف المعتاد. فيقال لهذا المسكين: إنك لو تأملتَ في كتاب الله حقّ التأمل لعرفت فساد ما ذكرته، وتقريره من وجوه؛ الأول: أن الله تعالى ملأ كتابه من الاستدلال على العلم والقدرة والحكمة بأحوال السماوات والأرض، وتعاقب الليل والنهار، وكيفية أحوال الضياء والظلام، وأحوال الشمس والقمر والنجوم، وذكر هذه الأمور في أكثر السور وكرّرها وأعادها مرّة بعد أخرى، فلو لم يكن البحث عنها والتأمل في أحوالها جائزًا لمَا ملأ اللهُ كتابه منها. والثاني: أنه تعالى قال: {أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ}[ق: 6]، فهو تعالى حثّ على التأمّل في أنه كيف بناها، ولا معنى لعلم الهيئة إلا التأمل في أنه كيف بناها وكيف خلق كلّ واحد منها. والثالث: أنه تعالى قال: {لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ}[غافر: 57]، فبيَّن أنّ عجائب الخلقة وبدائع الفطرة في أجرام السماوات أكثر وأعظم وأكمل مما في أبدان الناس، ثم إنه تعالى رغب في التأمّل في أبدان الناس بقوله: {وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ}[الذاريات: 21]، فما كان أعلى شأنًا وأعظم برهانًا منها أولى بأن يجب التأمّل في أحوالها ومعرفة ما أَوْدع اللهُ فيها من العجائب والغرائب. والرابع: أنه تعالى مدح المتفكِّرين في خلق السماوات والأرض فقال: {وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا}[آل عمران: 191]، ولو كان ذلك ممنوعًا منه لمَا فعل. والخامس: أنّ مَن صنّف كتابًا شريفًا مشتملًا على دقائق العلوم العقلية والنقلية بحيث لا يساويه كتاب في تلك الدقائق، فالمعتقدون في شرفه وفضيلته فريقان: منهم مَن يعتقد كونه كذلك على سبيل الجملة من غير أن يقف على ما فيه من الدقائق واللطائف على سبيل التفصيل والتعيين، ومنهم من وقف على تلك الدقائق على سبيل التفصيل والتعيين، واعتقاد الطائفة الأولى وإن بلغ إلى أقصى الدرجات في القوة والكمال إلا أن اعتقاد الطائفة الثانية يكون أكمل وأقوى وأوفى. وأيضًا فكلّ من كان وقوفه على دقائق ذلك الكتاب ولطائفه أكثر كان اعتقاده في عظمة ذلك المصنَّف وجلالته أكمل»[24].
وهذا نص قاطع في إبطال زعم ميرزا أن الأمر وكأنّه تيار عقدي يزج برؤيته في أفق التفسير، بل الأمر يتعلق برؤية الرازي نفسه لعلم التفسير وحدوده وما يدخل فيه وما يخرج منه، وأمّا ابن كثير فقد ارتضى رؤية ابن تيمية في نظريته التأويلية إجمالًا؛ من تراتبية تفسير القرآن بالقرآن ثم بالسُّنة، ثم بأقوال الصحابة، بعيدًا عن أقوال من جاء بعدهم من متكلمين وفلاسفة وحكماء، ولهذا جاء تفسير ابن كثير تفسيرًا للقرآن بالقرآن والسُّنة والآثار[25].
ثانيًا: اعتبار الرازي ممثلًا للتيار الأشعري العام الذي يناوئه ابن كثير وتياره:
إني وأنا أؤكد على أن الكلام على الأشعرية والشافعية غير مؤثر برأيي كثيرًا في صلب المنتج التفسيري لابن كثير والرازي؛ فمع التسليم جدلًا بأنها مؤثرة، فلا تزال هناك إشكالات تعتري طرح ميرزا، فهو يصور الأمر وكأنّ الرؤية التفسيرية الرازية هي الرؤية المستقرة السائدة لدى المدرسة الأشعرية، وأنَّه نتاج الطرح الأشعري الكلامي العام، وهذا خلاف الحاصل والواقع؛ إذ يعلم المحصلون أنّ طرح الرازي الكلامي -في واقعه- بعيد تمامًا عن المستقر الأشعري العام، فإذا ما تنزّلنا مع ميرزا في تصويب رؤيته؛ فإننا نقرر خطأ حُسبانه لتفسير الرازي نتاج النظرية الأشعرية السائدة في القرن الثامن الهجري، فكل المقولات المعيارية التي بها يكون الأشعري أشعريًّا لا يقول بها الرازي، ومَن طالَع كتابه: (المطالب العالية) يجده قائلًا بقيام الحوادث بذات الله، وقائلًا بإمكان الصفات الإلهية، وقائلًا بإمكان التسلسل، وقائلًا بالقوى المودعة في الأشياء، وقائلًا بتأثير ذاتي للأشياء، منتهيًا إلى القول بتأثير الأفلاك كما في (المباحث المشرقية)، وتوقفه في حدوث العالم، وأن الصفات مجرد نسب وإضافات، بل يقول في مواضع أنها «مغايرة للذّات»، ولست أول من سبقَ إلى اكتشاف هذا التباين والخلاف بين الرازي والأشاعرة، بل الأئمة المعتمدون في التقرير العقدي الأشعري قد أدركوا هذا وناقشوا الإمام الرازي ونقدوه وبالغوا في نقده والتحذير من معتقده، بل وبلغ ببعضهم أن يصفه بالزيغ والضلال، وهاك نصوصهم:
قال الشيخ السنوسي الأشعري-صاحب المقدمات المعتمدة: «وليحذر المبتدئ جهده أن يأخذ أصول دينه من الكتب التي حُشيت بكلام الفلاسفة وأولع مؤلفوها بنقل هوسهم وما هو كفر صراح من عقائدهم التي ستروا نجاستها بما يَنْبَهِمُ على كثير من اصطلاحاتهم وعباراتهم التي أكثرها أسماء بلا مسميات، وذلك ككتب الإمام الفخر في علم الكلام، وطوالع البيضاوي ومَن حذا حذوهما في ذلك، وقَلَّ أنْ يفلحَ مَن أولع بصحبة كلام الفلاسفة أو يكونَ له نور إيمان في قلبه أو لسانه، وكيف يفلح من والى مَنْ حادَّ الله ورسوله وحرق حجاب الهيبة ونبذ الشريعة وراء ظهره وقال في حق مولانا -جلَّ وعزَّ- وفي حق رسله -عليهم الصلاة والسلام- ما سوَّلت له نفسه الحمقاء ودعاه إليه وهمه المختل؟! ولقد خُذِل بعض الناس فتراه يُشَرِّف كلام الفلاسفة الملعونين ويشرِّف الكتب التي تعرضت لنقل كثير من حماقاتهم لما تمكن في نفسه الأمَّارَة بالسوء من حب الرياسة وحب الإغراب على الناس بما يَنْبَهِم على كثير منهم من عبارات واصطلاحات يوهمهم أنّ تحتها علومًا دقيقة نفيسة وليس تحتها إلا التخليط والهوس والكفر الذي لا يرضى أن يقوله عاقل، وربما يؤثر بعضُ الحمقى هوسَهم على الاشتغال بما يعنيه من التفقه في أصول الدين وفروعه على طريق السلف الصالح والعمل بذلك، ويرى هذا الخبيث -لانطماس بصيرته وطرده عن باب فضل الله تعالى إلى باب غضبه- أنّ المشتغلين بالتفقه في دين الله تعالى العظيم الفوائد دنيا وأخرى بُلَداء الطبع ناقصوا الذكاء، فما أجهل هذا الخبيث وأقبح سريرته وأعمى قلبه حتى رأى الظلمة نورًا والنور ظلمة؛ {وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ * سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ...}[المائدة: 41- 42...][26].
وأشد مما سبق ما قاله شِهابُ الدِّين المـَرْجَانِي في حاشيته على شرح الجلال الدواني للعَقائد العَضُدِيَّة، إِذْ قَالَ: «فَخْرُ الدِّينِ بنُ الخَطِيبِ الرَّازِي فِي أَوَاخِرِ المِائَةِ السَّادِسَةِ مِنَ الهِجْرَةِ، وَاشْتهرَ بِالتَّبَحُّرِ فِي العُلُومِ، وَانْتَشَرَ خَبَرُهُ وَأَمِرَ أَمْرُهُ؛ فَاتَّخَذَهُ النَّاسُ إِمَامًا فِي العُلُومِ النَّقْلِيَّةِ وَالفُنُونِ العَقْلِيَّةِ، (فَذَهَبَ بِهِمْ كُلَّ مَذْهَبٍ وَلَعِبَ بِعُقُولِهِمْ كُلَّ مَلْعبٍ)، (وَالرَّجُلُ عَاطِلٌ) مِنَ التَّحْقِيقِ وَالوُقُوفِ عَلَى حَقِيقَةِ الحَقِّ فِي كِلَا الصَّنَاعَتَيْنِ، (وَآرَاؤُهُ الرَّكِيكَةُ) هِيَ التِي يَتَدَاوَلُهَا عَامَّةُ مَنْ جَاءَ بَعْدَهُ عَلَى زَعْمِ أَنَّهَا السُّنَّةُ وَالجَمَاعَةُ وَمَذْهَبُ أَهْلِ الحَقِّ وَالفِرْقَة النَّاجِيَة، وَحَاشَاهُمْ عَنْهَا ثُمَّ حَاشَا».
فتجاوز هذه الخلافات والمساجلات بين أئمة الأشاعرة المحررين لمعتمد المذهب وبين الإمام الرازي؛ وجعله ممثلًا للمذهب والبناء على ذلك في تصوير تشكّل تفسيره، والمقارنة بينه وبين تفسير ابن كثير بهذا النحو، سلسلة من الأوهام والبناءات على أساس مشكل غير محرر.
كما أن الإشكال يزداد تعقُّدًا إذا ما دلّنا واقع التاريخ على أن ثمة تعقبات أشعرية لاحقت تفسير الرازي وساجلته في بنائه التفسيري، ولا أدري كيف أغفل ميرزا هذا الجانب؟! وهذه التعقبات تكمن أهميتها ليس فقط في كونها تعقبات أشعرية بما يوحي أنّ الأمر في البناء التفسيري بعيد دائمًا عن التوجه العقدي، بل تكمن أهميتها في كونها مساجلات في المادة التفسيرية التي أدخلها الرازي في تفسيره، ومن أبرز هذه المساجلات تلكم التي ذاعت على لسان عالم أشعري كبير هو أبو حيان النحوي، فيقول عن تفسير الرازي: «فيه كلّ شيء إلّا التفسير»؛ تصويرًا لحجم خروج الرازي في تفسيره عن حدود التفسير، واستطراداته فيما لا يمتُّ له بِصِلَة، وعزاها أبو حيان لعالم لم يسمِّه، وأبو حيان ومَن نقل عنه أشاعرة، فكيف يسوغ تصوير تفسير الرازي على أنه نتاج الرؤية الأشعرية في التفسير إن كان لهذه الرؤية الأشعرية وجودٌ أصلًا؟
رابعًا: إشكالات كبيرة تعتري النموذج التطبيقي الذي طرحه ميرزا:
لقد كان أمر النموذج التطبيقي الذي طرحه ميرزا أمرًا صادمًا بالنسبة لي؛ إذ كان من المنتظر في مثل هذه الحالة أن يقوم الجانب التطبيقي بعبء تقرير النتيجة التي يرمي إليها ميرزا، وأن يكون شاهدًا صريحًا على تحليلاته ونتائجه، إلا أنّ البحث التطبيقي أتى -على غير المتوقع- قاصرًا في جوانب كثيرة، منها ما يأتي:
1- الاعتماد على أنموذج وحيد في بناء حجته:
اعتمد ميرزا للتدليل على نتيجته على أنموذج وحيد يتعلق بالكلام على عصمة الأنبياء بين ابن كثير وابن تيمية، وهذا أمر مستغرب في مثل هذا الموطن تحديدًا، في حين كان المنهج يحتِّم عليه -وهو بصدد تحرير تشابكات تفسيرية- أن تكون الدراسة التطبيقية استقراء موسعًا وسبحًا مطولًا في عدد وافٍ من الأمثلة التي تتيح إبراز صورة الاشتغال التفسيري عند كلٍّ من الإمامين؛ فيقوم بعبء النتائج التي يقررها. لقد كان المنهج قاضيًا عليه في الجانب التطبيقي أن يُجلّي لنا تباينات صارخة بين تطبيقية ابن تيمية التفسيرية، وتطبيقية ابن كثير في صميم الصنعة التفسيرية؛ حتى يتسنى له أن ينقض القول الشائع بأنّ ابن كثير متأثِّر بتأويلية ابن تيمية.
لقد كان واقع الدراسة التطبيقية لدى ميرزا مخيِّبًا لنا إلى حد بعيد؛ إذ اكتفى ببحث قضية هي في الأصل قضية عقدية ليُثبت بها قطعية التباين بين التوجُّهَين التفسيريين التيميّ والكثيري.
إنّ ميرزا، ولو سلّمْنا له بسلامة هذا الأنموذج في وجود تباين بين الأطروحتين فيه، وهو غير مسلَّم؛ فإنَّ تمثيله بموطنٍ واحد غيرُ كافٍ لإثبات النتيجة القائلة بعدم وجود علاقة بين تفسيرية ابن كثير وتفسيرية ابن تيمية. وفي هذا المأزق تتورط كثير من الأطروحات التي لا تأخذ في اعتبارها طبيعة علم التفسير، فتبني بتحليل موضعٍ واحدٍ نتائج تستلزم الاستقراء الموسع للقطع بنتيجة يمكن الاعتماد عليها؛ نظرًا لطبيعة علم التفسير، وطول مدوّنته. والنظر المستقيم قاضٍ بأنَّ الوصول إلى حُكم تطمئن له النفس أو تُقارِب لا يُمكن أن يكون بتحليل موضعٍ وموضعَين. وهذا المأخذ المنهجي وحده كافٍ للتوقف بشأن هذه النتيجة التي خرج بها ميرزا، فدراسته لم تُقِم الدلائل التطبيقية الكافية لحصول ما يقارب الطمأنينة للقطع بها. وإن كان المشتغلون بالعلوم التجريبية يعلمون أنَّه لا بد من تحليل عدَّة مُكرّرات من العيّنة المراد تحليلها بجهازٍ قياسيّ غير خاضع للانحياز الشخصيّ من أجل الوصول للطمأنينة الكافية بالنتائج المتحصَّل عليها، فما الظنُّ باستخلاص نتيجةٍ يراد أن يُطمأَنَّ لها بتحليل منتج تفسيريٍّ لموضعٍ واحدٍ يقوم بها باحثٌ لا يخلو -ككل البشر- عن بعض الانحياز الشخصيّ، والرأي المسبّق؟[27].
2- الغلط في الأنموذج التطبيقي قيد الدراسة:
أولًا: الغلط في تصوير الخلاف:
يصور ميرزا الخلاف بين ابن تيمية والرازي في أنّ «الرازي يرى أنَّ الأنبياء يجب أن يكونوا معصومين في الأساس، وأنّ ابن تيمية يجادل بخلاف ذلك».
وهذا التصوير للخلاف في هذه المسألة بهذا الشكل قاصرٌ إلى حد بعيد، فإن ابن تيمية والرازي وجميع العلماء مُطبقون على عصمة الأنبياء في الأساس، وإنما وقع الخلاف في حدود العصمة ولوازمها، وليس في العصمة ذاتها، ونقل الإجماع على ذلك جماعات من أهل العلم منهم ابن بطال في شرح البخاري، والإمام سيف الدين الآمدي، وإنما وقع الخلاف في عدد من الأمور في حدود البعثة ووقت تعينها، فالاختلاف وقع في: هل العصمة تتعين قبل البعثة أم بعدها؟ ثم اختلفوا في حدود العصمة، هل هي من الخطأ مطلقًا؟ أم من الكبائر دون الصغائر؟ هنا يقع الخلاف بين العلماء، ومن ثم فنحن نؤكد على أن حكاية ميرزا لصورة الخلاف يعوزها كثير من التدقيق والتحقيق.
ثم يبقى مشكلًا أن يعمد ميرزا إلى قضية عقدية بالمقام الأول ليس لابن كثير نص فيها، وفيها نصّان صريحان لابن تيمية والفخر الرازي ثم يحاول أن ينسب ابن كثير إلى أحدهما دون أن يكون له نص فيها، ثم إنّ محاولة استنباط موقف عالم من مسألة عقدية في بحث تفسيري أو قصص أمرٌ مشكل جدًّا، فلو كان المقام مقام بحث عقدي وحاول المصنف أن يستنبط رأيًا للعالم غير منصوص عليه لَتوقف كثيرون في التسليم لهذا، فكيف والبحث ليس بحثًا عقديًّا؟ فكيف جاز لميرزا أن ينسب لابن كثير قولًا في مسألة عقدية من محاولة تلمُّحٍ ضعيف لموقف تفسيري واحد مع إهمال المواقف التفسيرية الكثيرة المتعلقة بهذه المسألة، فنحن أمام عدد كبير من الإشكالات التي تعتري طرح ميرزا تجعلنا نردّ تقريره في أمر رأيِ ابن كثير حول العصمة.
ثانيًا: الإجمال الموهم في نسبة الأقوال في المسألة:
ينسب ميرزا قول الرازي في عصمة الأنبياء -باعتبارها عصمة من الصغائر والكبائر جميعًا- إلى الأشاعرة، ويصور ابن تيمية محاججًا ضد التيار الأشعري الذي يتبنى خلاف قوله، والتحقيق أن نسبة قول الرازي إلى جميع الأشاعرة نسبة غير محررة، فكثير من الأشاعرة قائلون بما يقول به ابن تيمية من عصمة الأنبياء من الكبائر دون الصغائر التي لا تقدح في العدالة، ومن أئمة الأشاعرة القائلين بقول ابن تيمية ابن بطال في شرح البخاري، حيث تطرَّق في شرحه لحديث الشفاعة -وفيه ذَكَرَ الأنبياء خطاياهم- للكلام على أقوال الفِرَق في العصمة وحدودها، ونسب لأهل السُّنة القول بجواز الصغائر التي لا تقدح في العدالة، وهذا نصه: قال ابن بطال: «فإنّ الناس اختلفوا هل يجوز وقوع الذنوب منهم؟ فأجمعَت الأمة على أنهم معصومون في الرسالة، وأنه لا تقع منهم الكبائر، واختلفوا في جواز الصغائر عليهم، فأطبقت المعتزلة والخوارج على أنه لا يجوز وقوعها منهم، وزعموا أن الرسل لا يجوز أن تقع منهم ما ينفر الناس عنهم وأنهم معصومون من ذلك. وهذا باطل لقيام الدليل مع التنزيل وحديث الرسول أنه ليس كل ذنب كفرًا. وقولهم: إنّ الباري تجب عليه عصمة الأنبياء -عليهم السلام- من الذنوب فلا ينفر الناس عنهم بمواقعتهم لها؛ هو فاسد بخلاف القرآن له، وذلك أنّ الله تعالى قد أنزل كتابه وفيه متشابه مع سابق علمه أنه سيكون ذلك سببًا لكفر قوم، فقال تعالى: {فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ}[آل عمران: 7]، وقال تعالى: {وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ}[النحل: 101]، فكان التبديل الذي هو النسخ سببًا لكفرهم كما كان إنزاله متشابهًا سببًا لكفرهم، وقال أهل السُّنة: جائز وقوع الصغائر من الأنبياء، واحتجوا بقوله تعالى مخاطبًا لرسوله: {لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ}[الفتح: 2] فأضاف إليه الذنب، وقد ذكر الله في كتابه ذنوب الأنبياء فقال تعالى: {وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى}[طه: 121]، وقال نوح لربه: {إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي}[هود: 45]، فسأله أن ينجيه، وقد كان تقدّم إليه تعالى فقال: {وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ}[هود: 37]، وقال إبراهيم: {وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ}[الشعراء: 82]، وفي كتاب الله تعالى من ذكرِ خطايا الأنبياء ما لا خفاء به[28].
وبالمثل صرّح الإمام النووي بوقوع الخلاف في العصمة من الصغائر، ونسب لجماهير العلماء القول بوقوع الصغائر من الأنبياء، في نص صريح، قال: «واختلفوا في وقوع غيرها من الصغائر منهم فذهب معظم الفقهاء والمحدّثين والمتكلمين من السلف والخلف إلى جواز وقوعها منهم»[29].
ثالثًا: غفلة ميرزا عن عدد من اللوازم التي يتضمنها الأنموذج وتعكّر على تأصيلاته:
لقد تضمّن الأنموذج التطبيقي الذي اصطفاه ميرزا ليكون محل البحث عددًا من اللوازم التي تتناقض مع ما قرره أولًا من تأصيلات واختيارات منها ما يأتي:
1- ما قرره من أنه من الأَولى النظر لتفسير ابن كثير كردٍّ على تفسير الرازي، يقول: «ويمكن النظر إلى تفسير ابن كثير بوصفه تفسيرًا مضادًّا لتفسير الرازي»[30]، ثم أتى ليقول: إنّ واقع هذا الأنموذج التطبيقي لَيشهد أنّ رؤية ابن كثير لمفهوم العصمة أقرب منها إلى رؤية الرازي من ابن تيمية، وهذا من التناقض الواضح البيّن.
2- قرر أولًا في بنائه النظري أنّ ابن كثير تقليدي يسير في فلَك نقلي كفلك ابن جرير الطبري، ثم اضطر في هذا المقام للقول بأنّ ابن كثير قد خالف ابن جرير الطبري، فأهمل دلالة عدد من المرويات الإسرائيلية التي استعملها الطبري، فهل هو متابع لابن جرير في منهجه التقليدي النقلي؟ أم هو مخالف له في اعتماد أداة مهمة اعتمدها ابن جرير كثيرًا كالإسرائيليات؟ أم هو مفسر ناقد كغيره من نقَدة المفسرين -يأخذ ويترك، ويقبل ويردّ- فلا يبقى فائدة لكل هذه العلاقات غير محررة المعالم؟!
إنني مدرك إمكان أن يكون لميرزا جوابات عن هذه الأسئلة الوجيهة، لكن مناط المؤاخذة أن تُلقى هذه العُقد هكذا من غير توجيه لهذه المتشابهات، فلْيُبدِ لنا المؤلف رأيه أيًّا ما كان لكي نفهم محل هذه التناقضات من البحث لا سيما وأنّ كثيرًا منها يكر على تقريرات سابقة بالفساد والبطلان.
رابعًا: عدم صلاحية هذا الأنموذج -خصيصًا- للتدليل على انعتاق ابن كثير عن أطروحة ابن تيمية التأويلية:
استدعى ميرزا تفسير قصة يونس والتي تبين حدود العصمة عند ابن كثير، والتي يبدو من صنيعه أنه يرى عصمة الأنبياء من الصغائر ومن الكبائر، على خلاف ابن تيمية، والوقوف عند هذا الحد لا يعني شيئًا سوى وقوع التباين بينهما في فرع خلافي من الفروع الكلامية، وهذا ليس بذي قيمة دلالية كبيرة في التشابك التفسيري بين ابن كثير وابن تيمية، لكن عند تأمل الإجراءات الاستدلالية في بناء المعاني والدلالات التي سلّط عليها ميرزا الضوء في صنيع ابن كثير لإثبات طاعة نبي الله يونس، وخلوه عن أيّ صغيرة من المعاصي، فعند التأمل برهة في إجراءات ابن كثير؛ ندرك سريعًا أن هذه الإجراءات -وإن نتج عنها تقرير مخالف لابن تيمية- فإنها تبقى هي هي الأدوات التأويلية التي أصَّل لها ابن تيمية في رسالته، وهي عين ما اعتمده ابن كثير في مقدمة تفسيره، فما زال ابن كثير في هذا الموضع جاريًا على أصول ابن تيمية من البحث عن الآثار الصحيحة في الباب، ومن استعمال النص القرآني في بيان داخلي للآيات، ومن استبعاد تام للإسرائيليات في مقام استكناه المعنى، فالمتأمل لا يرى هذا الصنيع من ابن كثير عدولًا عن تأويلية ابن تيمية في أصولها، وإن اختلفا في منتوج إعمال هذه الأدوات، والعبرة بالاتفاق في الأصول والمناهج لا بالاختلاف في المنتَج، فحتى مع هذا التغاير في الرأي حول هذا الفرع الكلامي في العصمة فإننا لا نخطئ إخلاص ابن كثير للأدوات التفسيرية التي ارتضاها هو من نضال ابن تيمية لتوطيد مكانتها في الدرس التفسيري. لذلك، ومع هذا الاختلاف الحاصل في النظرة لهذا الفرع الكلامي، فإننا لا نستطيع القول بانعتاق ابن كثير عن ابن تيمية.
خاتمة:
وبعد هذا التطواف في فحص هذه الأطروحة التي قدّمها ميرزا، وتمحيص هذه البناءات منهجيًّا تبين لنا أن ميرزا قد أقام إشكالية هذا البحث بصورة غير محررة ناشئة عن قراءة سطحية غير دقيقة لكتب التراجم، كما قدّم حجاجه مؤسّسًا على مغالطة منطقية فجة وهي مغالطة القسمة الثنائية؛ فإمّا أن يكون ابن كثير متحدثًا باسم ابن تيمية، أو يكون منتميًا لطائفة شافعية تجابه الشافعية الكلامية، كما أن كثيرًا من تقريرات ميرزا التي ساقها للتدليل على بنائه لا تسلم من نقد وإشكال، فعاد الأمر غير محرر يفتقد المنهجية الواضحة، مما أرجعنا لأوّل الأمر مستظهرين أنّ صفوة القول في ابن كثير أنه عالم شافعي أصولًا وفروعًا، وأمّا في التفسير فقد اقتنع ابن كثير إلى حدٍّ بعيدٍ بأطروحة ابن تيمية في الأدلة التفسيرية وتراتبيتها، وارتضاها إلى حدِّ أنْ نَقَلَها بطولها في مقدمة تفسيره، وهذا هو الموقف الواجب اعتباره حتى يأتي ما يخالف ذلك مما في رتبته في القوة الدلالية. أمّا التكهنات والتخرصات، والخلل المنهجيّ، والقراءة السطحية، والغفلة أو التغافل عن قضايا تراثية قريبة المأخذ تناقض النتيجة التي استخلصها الباحث؛ كلُّ ذلك لا يُقيم ولا يُقعد في هذه القضية، بَلْهَ أن يُعتمد في النظرة لهذا التفسير المهمّ، والله الموفق.
[1]هذه المادة من ترجمة: مصطفى الفقي، وهي منشورة على موقع تفسير للدراسات القرآنية تحت الرابط الآتي: tafsir.net/translation/79.
[2] يونس ميرزا هو باحث حاصل على الدكتوراه من جامعة جورج تاون في الدراسات العربية والإسلامية. وعمل كأستاذ مساعد وأستاذ للدراسات العربية والإسلامية في عدد من الجامعات. يراجع التعريف بميرزا في صدر ترجمة مادته التي نقوم بعرضها والمنشورة على موقع تفسير.
[3] ولا يفوتني أن أنوّه إلى أمر تجب الإشارة إليه، وهو أن شكري موصول لعدد ممن أسهموا بقوة في ثراء هذه المباحثة وإثرائها وأخص بالذكر الدكتور الجليل والعالم الفاضل/ محمود عبد الجليل روزن، فجذوة هذه الورقة وبدايتها كانت نطفة نقاش وتلاقح مع فضيلته، وكما شرّفني وأسعدني بمراجعة هذه الورقة قبل نشرها.
[4] هل كان ابن كثير متحدثًا باسم ابن تيمية؟ يونس ميرزا، (ص7).
[5] انظر البحث، ص6.
[6] انظر: طبقات الحفاظ للسيوطي (1/ 534)، طبقات المفسرين للداودي (1/ 111)، الردّ الوافر ص92، الأعلام (1، 320)، ذيل تذكرة الحفاظ للحسيني، والدرر الكامنة (1/ 373)، والبدر الطالع (1/ 153)، والدارس (1/ 36 ثم 2/ 582)، وشذرات الذهب (6/ 231)، وآداب اللغة (3/ 193).
[7] الدرر الكامنة (1/ 445).
[8] انظر: طبقات الحفاظ للسيوطي (1/ 534).
[9] طبقات المفسرين للداودي (1/ 111).
[10] الدرر الكامنة (1/ 445).
[11] طبقات الحفاظ للسيوطي (1/ 534).
[12] انظر: طبقات المفسرين للداودي (1/ 111).
[13] طبقات المفسرين للداودي (1/ 111).
[14] وأمرٌ سائغ شائع في الفلسفة الفقهية الإسلامية الاختيارُ من المذاهب والتلفيق بينها بشروط، وممن نص على ذلك القرافي والنووي بل الشافعي -رحمهم الله- فهم يجوزون الانتقال من جميع المذاهب إلى بعضها بعضًا في كل ما لا ينتقض فيه حكم حاكم، ذلك في أربعة مواضع: أن يخالف الإجماع أو النص، أو القياس الجلي، أو القواعد. ولذا، ففِعل ابن كثير ليس مستغربًا ولا مستنكرًا ولا مما يحتمل كل هذه الدلالات البعيدة، يَعرف هذا مَن خبرَ الفلسفة الفقهية والمذهبية، ولعل الاستنباط الذي بناه ميرزا على هذه القضية من ضعف اطلاعه على البيئة الفقهية الإسلامية.
[15] وفي حصول هذا الأمر شكٌّ لعدد من الأمور؛ أولًا: عدم شيوع ذلك في التراجم مع وجود المقتضى، فإنّ هذا الأمر لو وقع لكان حريًّا بالرصد لا سيما أن هذه القضية كانت بمثابة رأي عام في البيئة العلمية وقتها نظرًا لصدمها للواقع المذهبي، وإن تغير الوضع الآن وصارت معتمدة في دُور الإفتاء بالعالم الإسلامي. ثانيًا: عدم وجود أيّ ذكر لهذه المسألة في كتابات ابن كثير، مع أن القول بها وقتها كان يستدعي بسطًا في القول والتأسيس والتدليل. ثالثًا: تشنيع الفقهاء حينها وبسطهم يد الأذى إلى من قال بهذا القول تقليدًا أو اجتهادًا ولم يصلنا أنه طال ابنَ كثير من ذلك شيءٌ، ويكفي أن نشير إلى أن المؤلف يشكُّ -كمثلنا- في صحة وقوع هذا.
[16] انظر: طبقات الحفاظ للسيوطي (1/ 534).
[17] ترتيب المدارك للقاضي عياض (1/ 91).
[18] تبيين كذب المفتري لابن عساكر (ص163).
[19] مجموع الفتاوى (4/ 17).
[20] التسعينية (3/ 1007).
[21] نقل ابن حجر أنه وقعت مخاصمة بين عماد الدين بن كثير وإبراهيم بن القيم في تدريس الناس، فقال له ابن كثير: أنت تكرهني لأنني أشعري. انظر: الدرر الكامنة (1/ 65)، وأنا في شكّ من أشعرية الحافظ ابن كثير لأمور كثيرة، وربما خرج ذلك منه على سبيل الممازحة لا سيما وأن ابن حجر يقول بأن هذه من طرفه ونوادره، والله أعلم.
[22] مقدمة في أصول التفسير (ص52).
[23] يقول ابن تيمية: «وأمّا مخاطبة أهل الاصطلاح باصطلاحهم ولغتهم فليس بمكروه، إذا احتيج إلى ذلك وكانت المعاني صحيحة؛ كمخاطبة العجم من الروم والفرس والترك بلغتهم وعرفهم، فإن هذا جائز حسن للحاجة، وإنما كرهه الأئمة إذا لم يحتج إليه» (1/ 43) فتأمل كيف أن الأمر عنده بقدر الحاجة بحيث ينازل كل خصم بسلاحه، ويناقشه بأدواته لا غير، وإلا فالأصل عنده ثبوت الوحي، وفهم السلف له، فذلكم الحجة عنده.
[24] تفسير الرازي (14/ 274).
[25] كما أن نظرة ميرزا لابن كثير كمعتنٍ بالحديث أكثر من ابن تيمية؛ نظرة مشكلة مخالفة للواقع، وإن اتفقنا معه بأن مادة ابن كثير مادة تفسيرية منتقاة بعناية شديدة.
[26] (شرح أم البراهين) ص(70- 71).
[27] انظر مقال شيخنا الجليل الدكتور محمود عبد الجليل روزن: «وقفة نقدية مع بحث الإسرائيليات بين ضرورة التوظيف وإمكانية الاستغناء»؛ منشور على موقع تفسير للدراسات القرآنية تحت الرابط الآتي: tafsir.net/article/5277.
[28] شرح ابن بطال لصحيح البخاري (10/ 439-440).
[29] شرح صحيح مسلم للنووي (3/ 54).
[30] هل كان ابن كثير متحدثًا باسم ابن تيمية؟ (ص7).
الكاتب:

محمد يحيى جادو
باحث في التفسير وعلوم القرآن، وله عدد من المشاركات العلمية.
مواضيع ذات صلة
((المعلومات والآراء المقدَّمة هي للكتّاب، ولا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع أو أسرة مركز تفسير))








