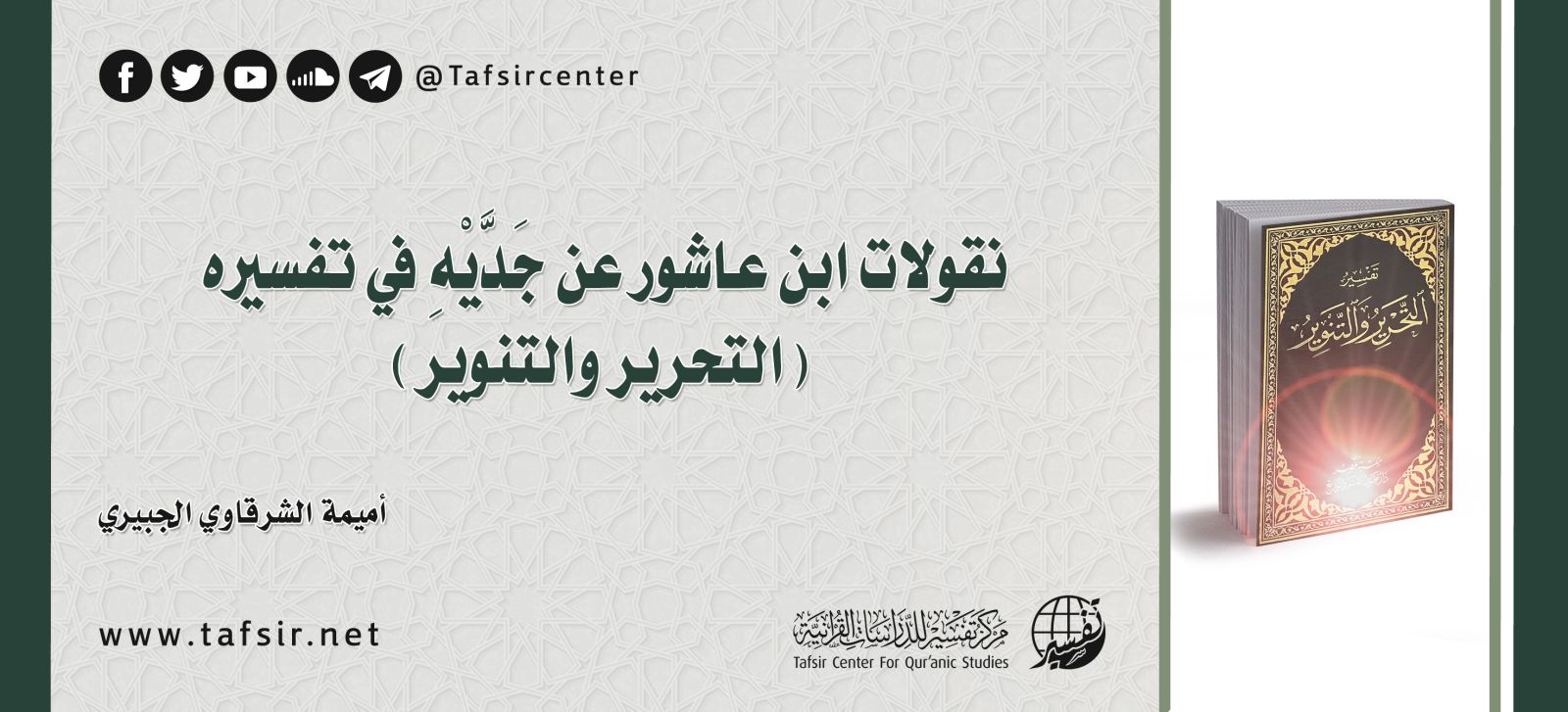نقد روايات النزول عند ابن عطية
نقد روايات النزول عند ابن عطية
الكاتب: محمد صالح سليمان

نقد روايات النزول عند ابن عطية[1]
اعتنى ابن عطية عنايةً بالِغة بانتقاد الأخبار الواردة في روايات النزول روايةً ودرايةً؛ فقد ذكَرَ الروايات وبَيَّنَ ما بينها من اختلافات، وما يرِدُ عليها من اعتراضات وإشكالات، ورجَّح بينها، ووازَنَ وصحَّح وضعَّف، وانتقدَ منها واستشكَل عليها، وسنبيِّن فيما يأتي أهمَّ العناصر البارزة في انتقاداته لروايات النزول.
ملامح المنهج النقدي لروايات النزول عند ابن عطية:
يمكن بيان بعض ملامح هذا المنهج عند ابن عطية من خلال النقاط الآتية:
1) انتقاد روايات النُّزُول المُخالِفَة للسُّنّة:
انتقد ابن عطية بعض روايات النزول بمخالفتها لِمَا ثبَتَ في السُّنّة، وجعلَ ما صحّ واشتهر من السُّنّة أصلًا تُقاس به صحة روايات النزول مِن عَدَمِها، وصوابها مِن خَطَئِها؛ فمِن ذلك: انتقاده قول السدي بأنَّ قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ﴾ [المائدة: 33]؛ نزلَت تنهَى النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- عن تَسْمِيل أَعيُنِ العُرَنِيِّينَ[2]، لـمَّا أرادَ ذلك، وأنه -صلى الله عليه وسلم- لم يُسَمِّل أَعيُنَهم. فقد تعقَّبَه ابنُ عطية بقوله: «وهذا قولٌ ضعيفٌ تُخَالِفُهُ الرواياتُ المتظاهرةُ»[3].
ومقصودُه بالروايات المتظاهرة =الروايات التي تضمَّنت قصة العُرَنيِّين، وأثبتَت تَسمِيلَ النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- أَعيُنَهُم؛ وذلك فيما رواه أنسُ بن مالك -رضي الله عنه- أنَّ ناسًا مِن عُرَيْنَة قَدِمُوا على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المدينةَ، فاجْتَوَوْهَا[4]، فقال لهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (إن شئتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة؛ فتشربوا من ألبانها وأبوالها)؛ ففعلوا فصَحُّوا، ثم مالوا على الرِّعَاءِ فقتلوهم، وارتدُّوا عن الإسلام، وساقوا ذَوْدَ رسول الله-صلى الله عليه وسلم-؛ فبلغ ذلك النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- فبعَث في أَثَرِهم، فأُتِيَ بهم فقطعَ أيدِيَهُم وأرجُلَهُم، وسَمَلَ أَعيُنَهُم[5].
2) انتقاد روايات النزول المُخالِفَة للسياق:
كانت دلالة السياق من أهمّ الدلالات التي اعتمد عليها ابن عطية في انتقاد روايات النزول؛ فقد انتقد كثيرًا من الأقوال التي زعم قائلوها أنها أسباب نزول، بخروجها عن السياق، وعدم تناسقها معه، وقِلّة التناسب بينه وبينها. فمِن ذلك: ما نقله عن مجاهد في قوله تعالى: ﴿يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ [التوبة: 74]؛ قال: «وقال مجاهد في قوله:﴿وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا﴾: إنها نزلت في قومٍ من قريش أرادوا قتل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. قال القاضي أبو محمد: وهذا لا يُناسِب الآية»[6]. فقد نصَّ ابن عطية على عدم مناسبة قول مجاهد للآية، وذلك لكون السورة كلّها مدنية، وهذه الآيات بعينها نازلة في فضحِ المنافقين، وكشفِ عَوارهم، وبيانِ مخازيهم، ولم يجرِ لقريش ذِكرٌ لا في الآيات قبلها ولا بعدها حتى يُقال إنها نزلَت فيهم.
ومن ذلك أيضًا: قوله عند تفسير قوله تعالى: ﴿وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ﴾ [الأنعام: 9]؛ قال: «وذكر بعض الناس في هذه الآية أنها نزلت في أهل الكتاب، وسياق الكلام ومعانيه يقضي أنها في كُفّار العرب»[7].
فقد رَدّ قول مَن يقول: إنها نزلت في أهل الكتاب؛ لكون السياق مخاطبة قريش، وليس لأهل الكتاب ذِكرٌ هنا حتى يُقال إنها نازلة فيهم.
3) انتقاد ما ضَعُفَ إسناده من أسباب النزول:
الكلامُ في أسباب النزول عِمادُه النقل؛ ولذا كان الإسناد من أهمِّ المقاييس التي يستخدمها العلماء في بيان ثبوت سبب النزول أو عدم ثبوته، وقد اعتمد ابن عطية الإسناد ساعةَ تَعامُلِهِ مع الأقوال المروية في النزول؛ فانتقد كثيرًا من الأقوال بافتقارها للسند الذي يثبتها؛ فمن ذلك:
ما نقله ابن عطية عن الطبري وغيره في قوله تعالى: ﴿قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [الأنعام: 14]؛ قال: «قال الطبريُّ وغيرُه: أُمِرَ أن يقول هذه المقالة للكَفَرَة الذين دَعَوْه إلى عبادة أوثانهم؛ فتجيء الآية على هذا جوابًا لكلامهم. قال القاضي أبو محمد: وهذا التأويل يحتاج إلى سندٍ في أنَّ هذا نزل جوابًا»[8].
ومن ذلك أيضًا: ما ذكره عند قوله تعالى: ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا﴾ [الأنعام: 160]، قال: «قال أبو سعيد الخدري وعبد الله بن عمر: هذه الآية نزلت في الأعراب الذين آمنوا بعد الهجرة؛ فضاعفَ اللهُ حسناتهم للحسنة عشرٌ، وكان المهاجرون قد ضُوعِفَ لهم الحسنة سبعمائة. قال القاضي أبو محمد: وهذا تأويل يحتاج إلى سندٍ يقطعُ العُذر»[9].
4) انتقاد ما خالف وقائع التاريخ وأحواله:
كان لابن عطية اعتماد ظاهر على الوقائع والمعلومات التاريخية في انتقاده للأقوال المروية في النزول؛ فقد انتقد كثيرًا من تلك الأقوال، وبَيَّنَ زيفها بعرضِها على أحداث التاريخ ووقائعه، وكانت له في ذلك نظرات تدلّ على يقظة عقله ونفاذ بصيرته.
ومن الأمثلة على ذلك: ما نقله عند قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ﴾ [النحل: 103]، ومَن هو الذي كانت تقصده قريش ساعةَ اتهامِها للنبي -صلى الله عليه وسلم- بكون معلِّمِه بشرًا أعجميًّا، فنقل عدّة أقوال في ذلك، ثم قال: «وقال الضحّاك: الإشارة إلى سلمان الفارسي. قال القاضي أبو محمد: وهذا ضعيف؛ لأنَّ سلمان إنما أسلَمَ بعد الهجرة بمدّة»[10].
فالآيات دالّة على أنَّ اتهام قريشٍ هذا كان بمكة قبل الهجرة، ويؤيّد هذا مكيةُ السورة؛ فالقول بأنها في سلمان الفارسي خطأ تاريخي؛ لكون سلمان لم يُسْلِم إلا بعد الهجرة.
ومن الأمثلة على ذلك أيضًا: ما نقله في قوله تعالى: ﴿يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ﴾ [الفتح: 15]؛ عن عبد الله بن زيد بن أسلم قال: «كلام الله: قوله تعالى: ﴿فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا﴾ [التوبة: 83]، وهذا قولٌ ضعيف؛ لأن هذه الآية نزلت في رجوع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من تبوك، وهذا في آخر عمره، وآية هذه السورة نزلت سنة الحديبية»[11].
5) انتقاد ما طَرَأ على روايات النزول من تصحيفٍ أو وَهْمٍ:
لا شكّ أنَّ خلوّ رواية سبب النزول من الوَهْم والتصحيف يضمن سلامة الفهم وصحّته؛ ولذا كان من أكبر أسباب وقوع الخطأ في مبحث النزول =وقوع الوَهْم والاشتباه لدى الناقل للخبر؛ حيث تشتبه عليه آية بآية، أو شخص بشخص، أو قصة بقصة، فيدَّعِي لآيةٍ سببًا ظانًّا أنه نزل فيها، وإنما نزل في شبيهتها، أو يدَّعِي نزولها في شخص، ولم تنزل فيه وإنما تصحَّف عليه اسمه، أو يدَّعِي نزولها في حادثة مشهورة، وإنما هي في حادثة مشابهة لكنها أقلّ شهرة. ومثل هذا الاشتباه يترتّب عليه إدخال آيات في أسباب النزول وليست منها، ويخرج من أسباب النزول آيات هي المقصودة -أوّلًا- بالنزول؛ ولذا يجب على الناقد التنبُّه لمثل ذلك حتى لا تَزِلَّ فيه قَدَمُه. وقد كان ابن عطية يقظًا أشد التيقُّظ لمثل هذا الخَلل، بصيرًا به، عارفًا بمسالكه وطرقه؛ ولذا انتقد كثيرًا من الأقوال، وأرجع الخطأ فيها لاشتباه الراوي أو المفسّر ووَهْمِه ساعةَ تفسيره للآية أو نقلِهِ للخبر.
فمن ذلك مثلًا: ما ذكره عند تفسير قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ فَأَلْقَوُا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ﴾ [النحل: 28]؛ قال: «وظاهر الآية أنها عامة في جميع الكفار...، وقال عكرمة: نزلت في قوم من أهل مكة آمنوا بقلوبهم ولم يهاجروا، فأخرجهم كُفّار مكة مُكْرَهِين إلى (بدر) فقُتِلُوا هنالك؛ فنزلت فيهم هذه الآية. قال القاضي أبو محمد: وإنما اشتبهت عليه بالآية الأخرى التي نزلت في أولئك باتفاقٍ من العلماء»[12].
فقد بَيَّن ابن عطية أنَّ قول عكرمة ينطبق على الآية الواردة في سورة النساء؛ وهي قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ [النساء: 97]، وأنَّ إيراده في آية سورة النحل إنما هو بسبب التشابه المتحقّق بين ألفاظ الآيتين.
ومن ذلك أيضًا: ما ذكره ابن عطية في تفسير قوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا﴾ [الفرقان: 27]؛ قال: «وقال ابن عباس وجماعة من المفسرين: ﴿الظَّالِمُ﴾ في هذه الآية (عُقْبَةُ بنُ أَبِي مُعَيْط)، وذلك أنه كان أسلَمَ أو جنَحَ إلى الإسلام، وكان أُبَـيُّ بنُ خَلَف الذي قتله رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بيدِه يوم أُحُد خليلًا لـ(عقبة)، فنَهَاه عن الإسلام، فقَبِلَ نَـهْيَهُ، فنزلت الآية فيهما. فـ﴿الظَّالِمُ) عُقبة، و﴿فُلانًا﴾ أُبَـيّ، وفي بعض الروايات عن ابن عباس أنَّ ﴿الظَّالِمُ﴾ أُبَـيّ؛ فإنه كان يَحضُرُ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- فنَهَاه عُقبَةُ فأطاعَه. قال الفقيه الإمام القاضي: ومَن أدخلَ في هذه الآية أُميّةَ بنَ خَلَف فقد وَهِمَ»[13]. فمنشأ الوَهْم أنّ اسم (أُبَـيّ بن خَلَف) تصحَّف على الناقل فذكَرَ أنه (أُمَيّة بن خَلَف)؛ وذلك وَهْمٌ.
6) توجيهه للاختلاف بين الأقوال وبيان أثره:
الاختلاف في القول بالنزول على نوعين:
الأول: إمّا أن يكون اختلافًا بين نزول الآية ابتداءً، أو نزولها على سبب.
الثاني: وإمّا أن يكون اختلافًا في تعيين السبب الذي نزلت الآية فيه.
وسواء كان هذا أو ذاك؛ فإنّ للاختلاف بنوعيه أثرًا اعتنى ابن عطية ببيانه، وبيان ما يترتب عليه، وما يندرج تحته من مسائل، فمن ذلك:
بيانه لاختلاف مقصد الآية باختلاف زمن نزولها:
ذكر ابن عطية في قوله تعالى: ﴿لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا﴾ [الحديد: 10] الآية، أنها نزلت بسبب أنّ جماعة من الصحابة أنفقَت نفقات كثيرة حتى قال ناس: هؤلاء أعظم أجرًا مِن كلِّ مَن أنفق قديمًا. فنزلت الآية مبينة أنّ النفقة قبل الفتح أعظم أجرًا، ثم علَّق بقوله: «وهذا التأويل على أنَّ الآية نزلَت بعد الفتح، وقد قيل: إنها نزلت قبل الفتح تحريضًا على الإنفاق، والأول أَشهَر»[14].
فظاهرٌ جدًّا أنّ مقصد الآية يختلف باختلاف زمن النزول المترتب على كلّ قول من القولين المذكورين: فمقصدُ الآية على القول بنزولها بعد الفتح بيانُ فضل الإنفاق قبل الفتح، وأنه أعظم أجرًا. ومقصد الآية على القول بنزولها قبل الفتح التحريض على الإنفاق، والحث عليه.
بيانه لاختلاف معاني المفردات بحسب اختلاف روايات النزول:
تختلف المعاني المتعلقة بألفاظ الآية باختلاف روايات النزول، وقد حرص ابن عطية على بيان ذلك والتنبيه عليه.
فمِن ذلك مثلًا ما ذكره ابن عطية عند قوله تعالى: ﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ [آل عمران: 180]؛ قال: «وقال السدي وجماعة من المتأوِّلين: الآية نزلت في البخل بالمال والإنفاق في سبيل الله، وأداء الزكاة المفروضة، ونحو ذلك، قالوا: ومعنى:﴿سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا﴾ هو الذي ورَدَ في الحديث عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (ما مِن ذي رحم يأتي ذا رحمِهِ، فيسأله عن فضلِ ما عنده فيبخل به عليه، إلّا خرج له يوم القيامة شجاعٌ أقرع من النار يتلمَّظ حتى يطوِّقَه»[15].
وقال ابن عباس: «الآية إنما نزلت في أهل الكتاب وبُخلِهِم ببيان ما علَّمَهُم الله مِن أمرِ محمد -صلى الله عليه وسلم-، وقال ذلك مجاهد وجماعة من أهل التفسير، وقوله تعالى: ﴿سَيُطَوَّقُونَ﴾ على هذا التأويل معناه: سَيُحَمَّلُون عقابَ ما بخلوا به، فهو من الطاقة، كما قال تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ﴾ [البقرة: 184]، وليس من التطويق. وقال إبراهيم النخعي: ﴿سَيُطَوَّقُونَ﴾ سَيُجعَل لهم يوم القيامة طوقٌ من نار، وهذا يجري مع التأويل الأول الذي ذكرتُه للسدي وغيره. وقال مجاهد: سَيُكَلَّفُون أن يأتوا بمثل ما بخلوا به يوم القيامة، وهذا يَضرِبُ مع قوله: إنَّ البخل هو بالعلم الذي تفضَّل الله عليهم بأنْ علَّمَهُم إيّاه»[16]، فقد أشار ابن عطية إلى اختلاف معنى قوله تعالى: ﴿سَيُطَوَّقُونَ﴾ باختلاف المعنى الذي ارتأته كلُّ طائفة؛ فقال بعضهم: هو من التطويق، وقال آخرون: هو من الطاقة، وذلك راجع إلى اختلاف القول فيمن نزلَت فيه.
وفي قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا...﴾ [البروج: 10]؛ ذكَرَ قولَين في المراد من قوله تعالى: ﴿فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ﴾:
الأول: أنهم المذكورون في قصة أصحاب الأخدود، وعليه تكون الفتنة بمعنى الإحراق.
الثاني: أنها نزلت في قريش، وعليه يكون معنى الفتنة الامتحان والتعذيب[17].
فاختَلَفَ معنى الفتنة باختلاف الطائفة التي نزلت فيها الآية أو صَدَقَ عليها معناها.
بيانه لأثر الاختلاف في النزول على اتساع المعنى:
ففي قوله -سبحانه وتعالى-: ﴿وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ﴾ [الرعد: 13]؛ قال ابن عطية: «ورُوي عن عبد الرحمن بن صُحَار العبديّ أنه بَلَغَه أنَّ جبّارًا من جبابرة العرب بَعَثَ إليه النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- لِيُسلِمَ، فقال: أخبروني عن إلهِ محمد، أمِن لؤلؤٍ هو، أو مِن ذهبٍ؟! فنزلت عليه صاعقة ونزلت الآية فيه.
وقال مجاهد: إنّ بعض اليهود جاء إلى النبيّ -صلى الله عليه وسلم- لِيُناظِرَه، فبينما هو كذلك إذ نزلت صاعقة فأخَذَت قِحْفَ[18] رأسه؛ فنزلت الآية فيه.
وقوله: ﴿وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ﴾، يجوز أن تكون إشارةً إلى جدال اليهودي المذكور، وتكون الواوُ واوَ حالٍ، أو إلى جدال الـجبّـار المذكور. ويجوز إنْ كانت الآية على غير سبب، أن يكون قولُه: ﴿وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ﴾ إشارةً إلى جميع الكَفَرة من العرب وغيرهم الذين جُلِبَت لهم هذه التنبيهات»[19].
7) بيان تنزُّل الأسباب المروية على قراءة دون أخرى:
عندما تختلف القراءات، وتختلف روايات النزول في الموطِن نفسِه كذلك، فلا بد مِن بيانِ القراءة التي تتنزل عليها كلّ رواية؛ إِذْ إنّ انتقاد الروايات دون بيان القراءة التي تتنزل عليها، وتمييزها عن غيرها من القراءات الأخرى التي لا ترتبط بها =مُوقِعٌ في الحيرة والاضطراب، ومُفْضٍ إلى حصول الوَهْم والخَلْط؛ إِذْ لا يَدري القارئ ساعتها على أيّ قراءة يتنزَّل الانتقاد، ولا على أيّ وِجهة يفهمه إلا بعناء وطول نَظر.
فقد ذكر ابن عطية اختلاف المفسِّرين في سبب نزول قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ﴾ [آل عمران: 161]، وبَيَّنَ أنّ اختلافهم واردٌ على قراءة مِن القراءات في لفظ ﴿يَغُلَّ﴾ دون الأخرى؛ فقال: «واختلف المفسِّرون في السبب الذي أَوجَبَ أنْ ينفي اللهُ تعالى عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يكون غالًّا على هذه القراءة التي هي بفتح الياء وضمِّ الغين»[20]. ثم ذكر أقوالًا كثيرة في سبب النزول، ثم قال: «وأمّا قراءة مَن قرأ: ﴿أَنْ يُغَلَّ﴾ بضمِّ الياء وفتح الغين؛ فمعناها عند جمهورٍ مِن أهل العلم: أنْ ليس لأحدٍ أن يَغُلَّه، أي: يخونه في الغنيمة، فالآية في معنى نَهْيِ الناس عن الغُلول في المغانم والتوعُّد عليه»[21]. فظاهرٌ من كلامه تقييدُ الأسباب التي نقلها ونقل اختلاف المفسِّرين فيها بكونها واردةً على قراءة ﴿يَغُلَّ﴾ بفتح الياء وضمِّ الغين، دون قراءة ﴿يُغَلَّ﴾ بضمِّ الياء وفتح الغين، وقد أتْبَعَ ذلك بانتقاد بعض ما رُوي من أسباب النزول وبيانِ ما استُشكِل عليها.
8) بيان مقصد المفسِّر من التعبير بالنزول قبل المسارعة إلى انتقاده:
للمفسِّرين في التعبير بلفظ النزول مقصدان:
المقصد الأول: بيان سبب نزول الآية.
المقصد الثاني: بيان ما يدخل تحت الآية من المعاني.
وظاهرٌ أنّ المقصد الثاني واسع جدًّا، لا يتقيّد بزمنٍ ولا بحادثة ولا بسبب؛ بل كلُّ ما تشمله الآية من المعاني يُعبَّر عنه بالنزول، فهو من باب التفسير لا من باب النزول.
وعلى هذا يجوز أن يَذكر المفسِّر معنًى من المعاني أو حادثةً من الحوادث حصلت بعد نزول الآية أو قبلها ولو بزمن طويل، ويقول بكون الآية نازلةً في ذلك المعنى أو تلك الحادثة؛ لأنه -والحالة هذه -لا يقصد الحكم بسببية تلك الحادثة للآية، وإنما يقصد شمول معنى الآية لتلك الحادثة، ولكلّ الحوادث المشابهة لها في كلّ زمان. ولا شكّ أنَّ الغفلة عن ذلك المقصد لها أثر كبير في انتقادِ كثيرٍ من عبارات المفسِّرين في النزول؛ لكون المنتقد معتقدًا أن المفسِّر القائل بلفظ النزول يقصد سبب النزول.
وقد كان ابن عطية متيقظًا لذلك المقصد، عارفًا بأغراض المفسِّرين ومقاصدهم في التعبير بالنزول، فتراه يوجِّه كثيرًا من تلك العبارات، ويبيِّن مقاصد قائليها، ويعدِّد الاحتمالات التي يمكن تخريجها عليها، ويَذكر كيفية التعامل معها؛ دفعًا لِمَا قد يُتوَهَّم فيها من خطأ، أو يُوَجَّه إليها من انتقاد.
وكانت له مع أمثال هذه التعبيرات لفتاتٌ رائعة، ووقفاتٌ رائقة؛ فتراه -مثلًا - يَقبل القول بنزول الآية المكية في حادثة مدنية، أو القول بنزول الآية في حادثة حدثت قبل نزولها، أو يوازن بين المقصدَيْن: التفسيري، وسبب النزول؛ لِيَرَى أيّهما ألْيَق بالمعنى، وأقرب للصواب.
فمن ذلك مثلًا: قول قتادة: إنّ قوله تعالى: ﴿وَإِنْ يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ﴾ [الأنفال: 71]، نزلت في عبد الله بن سعد بن أبي سَرْح.
فقد علَّق عليه ابن عطية بقوله: «وأمّا تفسير هذه الآية بقصة عبد الله بن أبي سَرْح فينبغي أن يُحرَّر؛ فإنْ جُلبت قصة عبد الله بن أبي سرح على أنها مثال، كما يمكن أن تُجلَب أمثلة في عصرنا من ذلك فحَسَنٌ، وإن جُلبت على أنّ الآية نزلت في ذلك فخطأ؛ لأن ابن أبي سرح إنما تبيَّن أمرُهُ في يوم فتح مكة، وهذه الآية نزلت عَقِيب بدرٍ»[22].
وتحرير ابن عطية هنا بالغ الدقة؛ فقد ذكر احتمالين لقول قتادة، وبَيَّن صحّة أحدهما وخطأ الآخر، وعلّة تصحيح وتخطئة كلّ احتمال منهما.
ومن الأمثلة على ذلك أيضًا:
ما ذكره ابن عطية عند قوله تعالى: ﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ﴾ [النحل: 112]. قال: «وحكَى الطبري عن حفصة أمّ المؤمنين أنها كانت تسأل -في وقت حَصْرِ عثمان بن عفان رضي الله عنه-: ما صنع الناس؟ وهي صادرة من الحج من مكة. فقيل لها: قُتِل. فقالت: والذي نفسي بيده إنها القرية، تعني المدينةَ، التي قال الله لها: ﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا﴾ الآية.
قال القاضي أبو محمد: فأدخل الطبري هذا على أنّ حفصة قالت: إنّ الآية نزلت في المدينة، وإنها هي التي ضُربت مثلًا. والأمر عندي ليس كذلك، وإنما أرادت أنّ المدينةَ قد حصَلَت في محذور المثَل، وحلَّ بها ما حلَّ بالتي جُعلت مثلًا، وكذلك يتوجَّه عندي في الآية أنها قُصد بها قريةٌ غير معيَّنة جُعلت مثلًا لمكة، على معنى التحذير لأهلها ولغيرها من القرى إلى يوم القيامة»[23].
فقد انتقد ابن عطية الطبري لكونه فهمَ من كلام حفصة أنّ الآية نزلت في المدينة، وبَيَّن أنّ حفصة لم تُرِد بقولها: (إنها القرية) مكانَ نزول الآية، وإنما أرادَت أنّ المدينة شابهَت القريةَ المضروبَ بها المثَلُ في الوقوع فيما حرَّمه الله عليها؛ فكانت داخلةً في الآية لوقوعها في المحذور[24].
9) الترجيح بين الروايات الواردة في النزول:
يُعتبر الترجيح مِن أهمِّ الأمور التي يَسْتَلْمِحُها المتتبِّع لمنهج ابن عطية في نقد روايات النزول؛ فقد كان يُوازن بين الروايات، ويُرجِّح منها ما يتقوَّى لديه معتمدًا في ذلك على المرجِّحات التي تُعضِّد ترجيحه وتقوِّيه وتُبرِز علّته. وما مِن شكّ في أنّ الترجيح من أهم الإجراءات النقدية التي يعتمد عليها عمل الناقد؛ وذلك لكون الترجيح ما هو إلا عملية مقارنة وموازنة بين الأقوال، ينتقي الناقدُ من خلالها، ويختارُ ما قامت القرائن والدلائل على تقويته وتصحيحه، ذاكرًا لمسوِّغات ترجيحه وقرائن تصحيحه.
وقد اعتمد ابن عطية في ترجيحه بين روايات النزول على عدّة مرجِّحات؛ كان من أهمها ما يأتي:
أ- الترجيح بالأحاديث والآثار:
ففي قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ﴾ [المائدة: 101]؛ ذكر ابن عطية عدة روايات في سبب نزولها، ومنها رواية بنزول هذه الآية في السؤال عن وجوبِ الحج كلَّ عام، ثم قوَّى هذه الرواية بقوله: «ويقوِّي هذا حديثُ سعد بن أبي وقاص أنّ النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (إنّ أعظمَ المسلمين جُرمًا؛ مَن سأل عن شيء لم يُحرَّم، فحُرِّم مِن أجْلِ مسألته)»[25].
ب- الترجيح بدلالة السياق:
ومن ذلك ما ذكره في سبب نزول قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ﴾ [المائدة: 11].
فقد ذكر اختلاف المفسِّرين في سبب النزول، لكنه رجَّح نزولها في دفعِ الله محاولة بني النضير قَتْل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لـمّا ذهب لاستعانتهم في ديةٍ تحمَّلها المسلمون جرّاء قَتْل عمرو بن أميّة الضَّمْرِي رجلَين عاهَدَهما النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- من بني سُليم، في قصة بئر معونة، ثم رجَّح ابن عطية هذه الرواية في نزول الآية مستندًا إلى سياق الآيات؛ فقال: «وهذا القول يترجَّح بما يأتي بعدُ من الآيات في وصفِ غدرِ بني إسرائيل ونقضِهم المواثيق»[26].
10) بيان ما يتعلّق بروايات النزول من إشكاليات واحتمالات وتوجيهات:
كانت دراسة ابن عطية للروايات الواردة في نزول الآيات القرآنية دراسة قائمة على التحليل والتدقيق والموازنة بين الروايات، وبيان ما يَرِد عليها من إِشكالات، وتعديد الاحتمالات التي يمكن أن تتخرَّج الإشكاليات عليها، وتوجيه ذلك كلّه بتوجيهات رائقة ولفتات بديعة.
وقد كان توجيهُه للأقوال ورَفْعُه للإشكال على صور؛ منها:
ذِكْر معنى آخر للَّفظة المفسَّرة ينسجم والمعنى المُفسَّر:
ففي قوله تعالى: ﴿فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ﴾ [النساء: 88]؛ نقلَ ابن عطية الاختلاف في المراد بالمنافقين، فذكر أقوالًا مفادُها أنهم كانوا بمكة ولم يهاجروا، وأقوالًا أخرى مفادُها أنهم كانوا بالمدينة، ثم أَوْرَدَ إِشكالًا على من قال بكونهم في المدينة قائلًا: «وكلُّ من قال في هذه الآية إنها فيمن كان بالمدينة يَرُدُّ عليه قولُه: ﴿حَتَّى يُهَاجِرُوا﴾ [النساء: 89]»[27].
ثم ذكر كيفية رفْعِ هذا الإِشكال بقوله: «لكنّهم يُخرِجُون الـمُهَاجَرةَ إلى هَجْرِ ما نهَى الله عنه، وتركِ الخلافِ والنفاقِ، كما قال -صلى الله عليه وسلم-: (والـمُهَاجِرُ مَن هَجَرَ ما نهَى اللهُ عنه)»[28]. فقد حمَلَ الهجرةَ على معنى تركِ المحرَّمات لا على معنى الانتقال من مكان إلى مكان؛ دفعًا للإشكال الوارد على معنى الانتقال.
إخراج كلام المفسِّر في النزول مخرج المُبالَغة:
فعند قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ [النساء: 38].
قال ابن عطية: «قال مجاهد: نزلت هذه الآية في اليهود. قال الطبري: وهذا ضعيف؛ لأنه نفَى عن هذه الصفةِ الإيمانَ بالله واليوم الآخر، واليهود ليسوا كذلك. قال القاضي أبو محمد: وقول مجاهد مُتَّجِه على المبالغة والإلزام؛ إِذْ إيمانُهُم باليوم الآخر كَلَا إيمانٍ، من حيث لا ينفعهم»[29].
فقد انتقد الطبري قولَ مجاهد بكون أهل الكتاب يؤمنون بالله واليوم الآخر، لكن ابن عطية وَجَّه كلامَ مجاهد على جهة المبالغة والنظر إلى حقيقة حالهم، وأنَّ أفعالهم تُنافِي إيمانهم؛ فصاروا بمنزلة الفاقد للإيمان.
التفريق بين سبب نزول الآية والاحتجاج أو الاستشهاد بها:
قد يحكي المفسِّر الاستشهاد بالآية في موقفٍ من المواقف بعبارة النزول، فيلتبسُ ذلك بسبب النزول، فيَظنُّ الظانُّ نزول الآية في ذلك الموقف، وليس كذلك، وقد كان ابن عطية بصيرًا بذلك منبِّهًا عليه. ففي كلامه عن سورة يس قال: «هذه السورة مكية بإجماع، إلا أن فرقة قالت: إنّ قوله: ﴿وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ﴾ [يس: 12]، نزلت في بني سلمة من الأنصار حين أرادوا أن يتركوا ديارهم وينتقلوا إلى جوار مسجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال لهم: (دِيارَكُم تُكْتَبْ آثارُكُم)[30]، وكَرِهَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- أنْ يُعْرُوا[31] المدينة، وعلى هذا فالآية مدنية، وليس الأمر كذلك؛ وإنما نزلت الآية بمكة، ولكنه احتج بها عليهم في المدينة، ووافقها قولُ النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- في المعنى، فمِن هنا قال مَن قال: إنها نزلت في بني سلمة»[32].
فقد بَيَّن ابن عطية أنَّ القول بمدنية الآية المذكورة لا يصحّ، وأنّ اعتقاد كونها مدنية ناشئ من استشهاد النبي-صلى الله عليه وسلم- بها في موقف بني سلمة، ثم بَيَّنَ كون الآية مكية، وأنَّ استشهاده -صلى الله عليه وسلم- بها في المدينة لا يعني مدنيتها؛ فالمقام هنا مقام استشهاد بالآية على معنى، لا مقام الإخبار عن نزولها.
كانت تلك أهمَّ العناصر التي ظهر لي من خلالها طرفٌ من معالم المنهج النقدي في التعامل مع روايات النزول عند ابن عطية، سواء قَصَدَ المفسِّر بتعبيره بالنزول الإِخبارَ عن السببية، أو قَصَدَ بعبارة النزول تفسيرَ الآية، وبيانَ اندراج المعنى الذي ذكَرَهُ تحتَ عُمُومِها.
[1] هذه المقالة من كتاب (الصناعة النقدية في تفسير ابن عطية)، الصادر عن مركز تفسير سنة 1437هـ= 2016م، ص291 وما بعدها. (موقع تفسير)
[2] سَملُ العين فَقْؤُها بحديدة محماة أو غيرها. النهاية في غريب الحديث والأثر (2/ 403)، والعُرَنِيِّينَ نسبة إلى قبيلة عُرَيْنَة، قال في الفتح: وعُرَيْنَة بالعين والراء المهملتين والنون مصغرًا؛ حَيٌّ من قضاعة وحَيٌّ من بجيلة، والمراد هنا الثاني، كذا ذكره موسى بن عقبة في المغازي. اهـ. فتح الباري (1/ 337).
[3] المحرر الوجيز (3/ 154)، وينظر: أمثلة أخرى (2/ 595، 596، النساء: 65)، (7/ 103 الأحزاب: 19)، (8/ 444، المزمل: 11).
[4] اجتَوَوا: كرهوا المقام بها لسقم أصابهم، وهو مشتق من الجَوَى، وهو داء في الجوف. ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم (11/ 154).
[5] ينظر: صحيح البخاري، كتاب الوضوء، باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها، ص53، (ح: 233). صحيح مسلم، كتاب القسامة، باب حكم المحاربين والمرتدين (3/ 151)، (ح:1671).
[6] المحرر الوجيز (4/ 366).
[7] المحرر الوجيز (3/ 318)، وينظر أيضًا: (6/ 654، العنكبوت: 51)، (8/ 257، 258، المجادلة: 22).
[8] المحرر الوجيز (3/ 323).
[9] المحرر الوجيز (3/ 502)، وينظر أيضًا: (3/ 442، الأنعام: 111)، (4/ 366، 367، التوبة: 74).
[10] المحرر الوجيز (5/ 408).
[11] المحرر الوجيز (7/ 675) بتصرف يسير، وينظر أمثلة أخرى: (1/ 496، 497، البقرة: 204)، (3/ 367، 368، الأنعام: 52)، (5/ 356، النحل: 41).
[12] المحرر الوجيز (5/ 347).
[13] المحرر الوجيز (6/ 434).
[14] المحرر الوجيز (8/ 222).
[15] المحرر الوجيز (2/ 430، 431)؛ لم أقف عليه بهذا اللفظ، وهو في المعجم الأوسط للطبراني (5/ 372)، (ح:5593) بلفظ قريب منه، ونصه: (ما من ذي رحم يأتي ذا رحمه ليسأله فضلًا أعطاه الله إيّاه فيبخل عليه؛ إلا أخرج الله له يوم القيامة من جهنم حية يُقال لها شجاع، يتلمَّظ فيطوّق به).
[16] المحرر الوجيز (2/ 430، 431).
[17] المحرر الوجيز (8/ 579)، وينظر: (2/ 408، 409، آل عمران: 161)، (2/ 590، النساء: 60)، (5/ 416، النحل: 110).
[18] القِحْف: العَظْم فوق الدماغ من الجُمْجُمَة، والجميع: القِحْفة والأَقحاف. والقَحْف: قَطْعُه وكَسْرُه؛ فهو مقحوف، أي: مقطوع القِحْف. العين (3/ 51) (باب الحاء والقاف والفاء).
[19] المحرر الوجيز (5/ 191).
[20] المحرر الوجيز (2/ 408).
[21] المحرر الوجيز (2/ 409).
[22] المحرر الوجيز (2/ 555).
[23] المحرر الوجيز (5/ 418).
[24] المحرر الوجيز (4/ 168)، وينظر: (4/ 232، 233، الأنفال: 63).
[25] المحرر الوجيز (3/ 271)، والحديث في صحيح البخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب والسُّنة، باب ما يُكره مِن كثرة السؤال ومِن تكلُّفِ ما لا يعنيه، ص1527، (ح:7289). وصحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب توقيره صلى الله عليه وسلم، وترك إكثار سؤاله عمّا لا ضرورة إليه أو لا يتعلق به تكليف وما لا يقع، ونحو ذلك. (4/ 136)، (ح:2358).
[26] المحرر الوجيز (3/ 125).
[27] المحرر الوجيز (2/ 620، 621).
[28] المحرر الوجيز (2/ 621)، والحديث في صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب: المسلم مَن سلم المسلمون من لسانه ويده، ص6، (ح:10).
[29] المحرر الوجيز (2/ 552).
[30] صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل كثرة الخُطا إلى المساجد (1/ 479)، (ح:665). وبمعناه في صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب احتساب الآثار، ص132، (ح:665).
[31] (يُعْرُوا) يتركوا المدينة عراءً، أي: فضاءً خاليةً ليس حولها بيوتٌ ومساكن. ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (3/ 226)، (مادة: عرا).
[32] المحرر الوجيز (7/ 231).
كلمات مفتاحية
الكاتب:

محمد صالح سليمان
دكتوراه في التفسير وعلوم القرآن- جامعة الأزهر، ومدير الشؤون العلمية بمركز تفسير، أشرف على عدد من المشروعات العلمية المنشورة.
مواضيع ذات صلة
((المعلومات والآراء المقدَّمة هي للكتّاب، ولا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع أو أسرة مركز تفسير))