تفسير محمد بن إسحاق (ت: 153هـ)
مكانته وموقف المفسِّرين منه - طرق روايته – موضوعات تفسيره
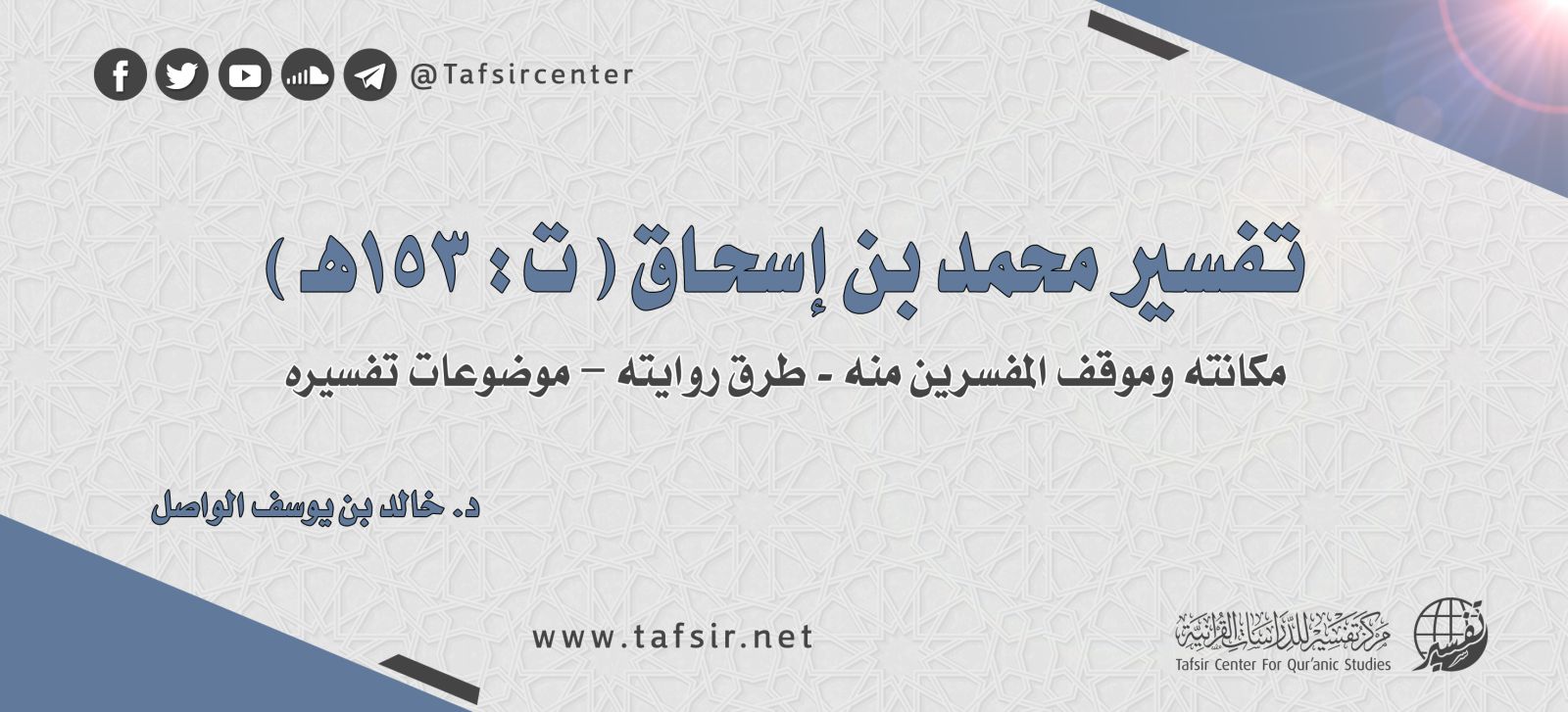
تفسير محمد بن إسحاق (ت: 153هـ)
مكانته وموقف المفسِّرين منه - طرق روايته - موضوعات تفسيره[1]
محمد بن إسحاق بن يسار بن خيار، أبو بكر -وقيل: أبو عبد الله- المطّلبي مولى قيس بن مخرمة بن المطلب بن عبد مناف رضي الله عنه، كان جدّه يسار من سبي عين التمر.
وُلِد عام 80هـ، ورحل إلى كثير من البلاد؛ كالكوفة، والري، ومصر، وبغداد التي أقام بها آخر حياته حتى توفي عام 151، وقيل 152، 153[2].
وحدَّث عن كثير من التابعين، منهم: أبان بن عثمان، وسعيد المقبري، وعبد الرحمن بن هرمز، والزهري، وعمرو بن شعيب، وأبو جعفر الباقر، ومكحول، ومحمد بن المنكدر، وغيرهم[3]. وقيل إنه رأى أنس بن مالك بالمدينة[4]، وسعيد بن المسيب[5].
حَدَّث عنه يحيى بن سعيد الأنصاري، وابن جريج، وشُعْبة بن الحجّاج، والسفيانان: الثوري وابن عيينة، والحمّادان: ابن سلمة وابن زيد، وغيرهم[6].
منزلته في العلم والرواية:
قال عنه الذهبي: «هو أوَّل مَن دَوَّن العلم بالمدينة، وذلك قبل مالك وذويه؛ وكان في العلم بحرًا عجاجًا».
وله مكانة عظيمة عند أهل الحديث؛ نظرًا لسعة روايته وكثرة مَن روى عنه، حتى قال عليّ ابن المديني: «مدار حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على ستّة، فذكرهم، ثم قال: فصار علمُ الستة عند اثني عشر، أحدهم محمد بن إسحاق»[7]؛ بل رُوي عن الزهري أنه قال عنه: «لا يزال بالمدينة عِلْمٌ ما بقي هذا»[8]، ووَصَفَه شُعبة بأنه أمير المحدِّثِين؛ لحفظه[9].
وقد كان واسع العلم، متفننًا، لا سيِّما في السِّيَر والمغازي؛ فهو أول مَن جمعها كما ذكر ابن سعد[10]، وكان أعلم الناس بها كما رُوي عن الزهري[11]، وقال الشافعي: «مَن أراد أن يتبحَّر في المغازي؛ فهو عيال على محمد بن إسحاق[12]، ومِن أشهر مصنفاته كتابه (المغازي) الذي جعله في ثلاثة أقسام: المبتدأ، والمبعث، والمغازي[13]، وقد هذَّبه عبد الملك بن هشام (ت: 218)[14]في كتابه الذي اشتهر بـ(سيرة ابن هشام).
أمّا منزلته في الرواية فقد تضاربتْ أقوال أهل العلم في توثيقه؛ فقال يحيى بن معين: «هو ثقة وليس بحُجّة»، وقال أحمد بن حنبل: «حسن الحديث»، وقال عليّ ابن المديني: «حديثه عندي صحيح»، وقال النسائي: «ليس بالقوي»، وقال الدارقطني: «لا يُحتجّ به».
كذلك اتّهمه بعض أقرانه ومعاصريه بالكذب؛ كهشام بن عروة (ت: 146)، ومالك بن أنس (ت: 179)، لكن حُمِل كلامهم على أنَّ قَدْح الأقران بعضهم في بعض لا عِبْرة به، ولا يُلتفت إليه إلا ببيان وحُجّة، وهو مما يُطوى ولا يُروى، قال الذهبي بعد ذِكْرِ مَن جَرَّحَهُ: «وقد أمسك عن الاحتجاج بروايات ابن إسحاق غيرُ واحدٍ من العلماء لأشياء؛ منها: تشيُّعه، ونُسِب إلى القَدَرِ، ويُدلِّس في حديثه؛ فأمّا الصدق فليس بمدفوع عنه»[15]، وقال في موضع آخر: «الذي تقرّر عليه العمل أنّ ابن إسحاق إليه المرجع في المغازي والأيام النبوية مع أنه يشذُّ بأشياء، وأنه ليس بحُجّة في الحلال والحرام، نعم ولا بالواهي، بل يُستشهد به»[16]، وقال أيضًا: «وليس بذاك المتقِن فانحطّ حديثه عن رتبة الصحة، وهو صدوق في نفسه مرضيّ»[17].
مكانته في التفسير وموقف المفسِّرين منه:
لم يرِد عن ابن إسحاق أنه تصدَّر للتفسير أو صَنَّف فيه؛ وإنما عُرِف عنه الرواية في الحديث والتوسُّع في القصص والأخبار والسِّيرة. أمّا ما نُقل عنه من تفسير فممّا فسَّره من الآيات المتعلقة بالقصص والمغازي والسِّيرة في كتابه عن السِّيرة؛ إِذ انتهج نهجًا فريدًا في معرض ذِكره للمبتدأ والمبعث والمغازي، حيث كان يفسِّر الآيات المتعلّقة بها ويربطها بمعاني القرآن رواية ودراية[18]. وقد أورَد الثعلبي كتابه (المغازي) ضِمن مصادره في التفسير مِن ثلاث طرق[19]، ومِن طريقه البغوي في تفسيره[20].
كما نَقَلَ آثارَ ابنِ إسحاق في التفسير كثيرٌ من أئمة المفسِّرين؛ كابن جرير الطبري، وابن المنذر، وابن أبي حاتم[21]، ومن المتأخِّرين ابن كثير، والسيوطي في (الدر المنثور)، رواية[22] ودراية، وقد حاول محمد عبد الله أبو صعيليك جمع تفسيره الاجتهادي من تلك المصنفات إضافة إلى سيرة ابن هشام في كتابه الذي صدر بعنوان: (تفسير محمد بن إسحاق)[23].
أمّا عن كونه مفسّرًا فإنه لم يفسِّر القرآن كاملًا، ولم يتصدَّر للتفسير، ولم يصنِّف فيه، وعليه فإنَّ الحكم بأنه من المفسِّرين فيه تجوُّز، وإنما اندرج ضِمن مفسِّري أتباع التابعين؛ لأنَّ أئمة المفسِّرين نقلوا ما جاء في سيرته من الآيات التي فسَّرها، والمرويات التي لها علاقة بتلك الآيات، والأقرب أنْ يوصَف بأنه مشاركٌ في التفسير.
أبرز طرق أقواله في التفسير:
من أشهر الطرق التي يروي عنها ابن جرير تفسير ابن إسحاق ما جاء من طريق تلميذه سلمة بن الفضل[24](ت: 190)[25]، وكذلك ابن أبي حاتم[26]، أمّا ابن المنذر فأكثر ما يروي عن ابن إسحاق من طريق إبراهيم بن سعد[27](ت:183)[28]، ويروي قليلًا من طريق زياد بن عبد الله البكائي[29](ت: 183) الذي أخذ عنه عبد الملك بن هشام (ت: 218) صاحب (سيرة ابن هشام)[30].
أمّا الثعلبي فقد سرد في مقدّمة كتابه ثلاثة أسانيد لمغازي ابن إسحاق[31]، مِن أشهرها رواية يونس بن بكير (ت: 199)[32] الذي وَصَلَتْنَا قطعة من الكتاب عن طريقه.
موضوعات تفسيره:
لو تتبّعتَ ما رُوي من تفسير ابن إسحاق الاجتهادي؛ أو نظرتَ في تفسيره الذي جُمع -بل حتى مروياته في التفسير وأسباب النزول- ستجد أنه لا يفسِّر إلا الآيات المتعلقة بالمبدأ والسيرة والمغازي وقصص القرآن، أمّا ما سوى ذلك فقليل جدًّا؛ فعلى سبيل المثال: سورة النساء مِن أطول سور القرآن تلاوةً وتفسيرًا، ومع ذلك فقد أحصيتُ مروياته في تفسيرها من موسوعة التفسير المأثور فبلغَت (12) أثرًا فقط، كلّها في تفسير آيات متعلقة بالسِّيرة -وأغلبها في أسباب نزول، أو قصص السابقين[33]-؛ بينما في المقابل أحصيتُ له في تفسير سورة آل عمران (164) أثرًا، وتعليل ذلك واضح؛ لِما في سورة آل عمران من قصةِ وفدِ نصارى نجران، وقصة عيسى -عليه السلام-، ثم قصة غزوة أُحُد، بخلاف سورة النساء التي اشتمل أغلب آياتها على الأحكام.
من هنا يمكننا القول أنّ تفسير محمد بن إسحاق هو في الجانب التاريخي من القرآن المشتمل على القصص والسِّيرة النبوية، دون الجوانب الأخرى. وهو يُعْنَى عند تفسير تلك الآيات بأسباب النزول[34]، وتعيين مَن نزلت فيهم الآيات عناية بالغة[35]؛ نظرًا لأهميتها في السيرة، إضافةً إلى بيان الغريب عند توضيح معنى تلك الآيات.
مثال ذلك: ما جاء في سيرته عن غزوة أُحُد حيث ذكر القصة ومروياتها ثم عقَّب عليها بقوله[36]: «فكان مما أنزل الله -تبارك وتعالى- في يوم أُحُد من القرآن ستون آية مِن آل عمران؛ فيها صفة ما كان في يومهم ذلك، ومعاتبة مَن عاتب منهم، يقول الله -تبارك وتعالى- لنبيه -صلى الله عليه وسلم-: ﴿وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ * إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا﴾ [آل عمران: 121- 122]، قال: الطائفتان كانتا بني سَلِمَة من جُشَم بن الخزرج، وبني حارثة من النبيت من الأوس، وهما الجناحان. ﴿أَنْ تَفْشَلَا﴾، قال: أي: أن يتخاذلا. ﴿وَاللهُ وَلِيُّهُمَا﴾، أي: الـمُدافِع عنهما ما هَـمَّا به مِن فشَلِهما، وذلك أنّه إنَّما كان ذلك منهما عن ضعفٍ ووهنٍ أصابهما، من غير شَكٍّ أصابهما في دينهما، فتولَّى دَفْعَ ذلك عنهما برحمته وعائدته، حتى سَلِمَتَا من وهنهما وضعفهما، ولحقتا بنبيِّهما صلى الله عليه وسلم، ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾، أي: مَن كان به ضعفٌ من المؤمنين أو وَهَنٌ فليتوكل عَلَيَّ؛ أُعِنْه على أمره وأدفع عنه حتى أَبلُغَ به وأُقَوِّيَه على نِيَّـتِه»، وهكذا شرعَ يفسِّر الآيات إلى قوله تعالى: ﴿مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ﴾ [آل عمران: 179][37].
أمّا في جانب الإسرائيليات وقصص السابقين فهو يروي الكثير منها[38]، بعضها تُعزى إليه دون إسناد[39]، وبعضها الآخر يسنده إلى مَن فوقه، لا سيِّما وهب بن منبه (ت: 114)، الذي اعتنى ابن إسحاق برواية الإسرائيليات عنه، خصوصًا من طريق عبد الصمد بن معقل (ت: 183) ابن أخي وهب.
كما عُرِف عنه أنه كان يأخذ مباشرة عن أهل الكتاب؛ قال الفلاس: «العجب من رجل يُحدِّث عن أهل الكتاب ويرغب عن شرحبيل»[40]، وعن ابن أبي فديك قال: «رأيت محمد بن إسحاق يكتب عن رجلٍ من أهل الكتاب»[41].
[1] هذه المقالة من كتاب (تفسير أتباع التابعين؛ عرض ودراسة)، الصادر عن مركز تفسير سنة 1436هـ= 2015م، تحت عنوان: «محمد بن إسحاق»، ص109 وما بعدها. (موقع تفسير)
[2] سير أعلام النبلاء (7/ 42).
[3] ينظر مسرد لشيوخه في سير أعلام النبلاء (4/ 34).
[4] ولهذا سلكه ابن حجر في صغار الطبقة الخامسة، وهي الطبقة الصغرى من التابعين الذين رأوا الواحد والاثنين ولم يثبت لبعضهم السماع من الصحابة. تقريب التهذيب، ص467.
[5] ينظر: تهذيب الكمال (24/ 40)، سير أعلام النبلاء (6/ 340)، طبقات المفسرين للأدنوي (1/ 19).
[6] تاريخ بغداد (1/ 231)، سير أعلام النبلاء (6/ 340).
[7] سير أعلام النبلاء (7/ 36).
[8] سير أعلام النبلاء (7/ 36).
[9] سير أعلام النبلاء (7/ 41).
[10] سير أعلام النبلاء (7/ 48).
[11] سير أعلام النبلاء (7/ 36).
[12] سير أعلام النبلاء (7/ 36).
[13] وَصَلَنَا قسم من الكتاب برواية يونس بن بكير، طُبعت قطعة منه بتحقيق د. محمد حميد الله، بالمغرب، كما طُبع طبعة أخرى بتحقيق د. سهيل زكار، بدمشق.
[14] عبد الملك بن هشام بن أيوب، أبو محمد الذهلي، وقيل الحميري النحوي، الأخباري البصري نزيل مصر، قال الذهبي: «هذَّب السيرة النبوية، وسمعها من زياد البكائي صاحب ابن إسحاق، تُوفي عام 218». ينظر: سير أعلام النبلاء (10/ 428).
[15] سير أعلام النبلاء (7/ 39).
[16] تذكرة الحفاظ (1/ 130).
[17] تذكرة الحفاظ (1/ 130).
[18] ينظر: مسرد للآيات المفسرة آخر كتاب السيرة لابن إسحاق، ص323- 324، تحقيق: د. محمد حميد الله، معهد الدراسات والأبحاث والتعريب، فاس المغرب 1396= 1976. أيضًا ممن حفظ لنا هذا التفسير ابن هشام في سيرته المختصرة من سيرة ابن إسحاق.
[19] ينظر: مقدمة الكشف والبيان عن تفسير القرآن، ص145- 149.
[20] ينظر: تفسير البغوي (1/ 37).
[21] أمّا عبد الرزاق الصنعاني فلم أجد في تفسيره لابن إسحاق إلا رواية نقلية يتيمة من طريق سفيان ابن عيينة؛ وهي في بيان مَن نزل فيهم قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ﴾ الآية [النساء: 97]، ينظر: تفسير عبد الرزاق (1/ 172).
[22] ومِن أشهر مَن نقلَ ابنُ إسحاق تفسيرَه: ابنُ عباس؛ وذلك من طريق مشهورة حَسَّنها بعض أهل العلم، يروي فيها عن محمد بن أبي محمد مولی آل زيد بن ثابت، عن عكرمة أو سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال السيوطي: «هي طريق جيّدة وإسنادها حسن، وقد أخرج منها ابن جرير وابن أبي حاتم كثيرًا، وفي معجم الطبراني الكبير منها أشياء». الإتقان (6/ 2336).
وقد نقلَ ابنُ كثير في تفسيره -وغيره- كثيرًا من تلك الطريق بواسطة المصادر السابقة، ينظر على سبيل المثال: (1/ 172، 173، 177، 181- 183)، وكذلك السيوطي في الدر المنثور، لكن يلاحظ عزوه لابن إسحاق مباشرة كما في (1/ 129، 130، 137، 145)، مع أنه لم يذكر كتابه ضِمن مصادره في مقدمته وربما كان ذلك بواسطة، لكن يرِد أنه لم يصرِّح به مع أنه عادةً ما يصرِّح إذا كان نقله بواسطة، ينظر: مقدمة تفسير الدر المنثور للسيوطي بين المخطوط والمطبوع، ص246.
[23] نشرته مؤسسة الرسالة ببيروت عام 1417= 1996م، علمًا أنّ منهج جامِعِه كان بتركِ مرويات ابن إسحاق النقلية في التفسير ومِن ضِمنها الإسرائيليات. ومن الرسائل الجامعية التي جمعت أقواله في التفسير:
- (تفسير محمد بن إسحاق، من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة التوبة: جمعًا ودراسة)، للباحث: سليمان بن عبد الله القشعمي، رسالة ماجستير بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 1419هـ.
- (تفسير محمد بن إسحاق، من أول سورة يونس إلى آخر سورة الناس: جمعًا ودراسة)، للباحث: عبد الرحمن بن ناصر اليوسف، رسالة ماجستير بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 1419هـ.
- (مرويات الإمام محمد بن إسحاق 80- 150هـ في تفسير القرآن الكريم، من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الأنفال: جمع وتوثيق ودراسة مقارنة)، فائزة أحمد عبد الرحمن محمد، دكتوراه، جامعة أم درمان، 2008م.
- (أقوال الإمام محمد بن إسحاق في التفسير وعلوم القرآن: جمع وتوثيق ودراسة)، طلبة السيد عليّ أبو العينين، جامعة الأزهر، دكتوراه، 2011م.
- (مرويات محمد بن إسحاق في أسباب النزول من خلال السيرة النبوية لابن هشام: جمعًا ودراسة)، شريف عبد العليم محمود، ماجستير، جامعة الأزهر، 2005م.
ينظر: قاعدة بيانات أوعية المعلومات القرآنية.
[24] سلمة بن الفضل الأبرش الأنصاري مولاهم، أبو عبد الله الأزرق الرازي، قاضي الري من صغار أتباع التابعين، وثّقَه ابن معين، قال البخاري: عنده مناكير، روى عن ابن إسحاق، والحجاج بن أرطاة وسفيان الثوري وغيرهم. ينظر: سير أعلام النبلاء (9/ 50).
[25] يروي ابن جرير نسخة تفسيرية من طريق شيخه محمد بن حميد الرازي عن سلمة بن الفضل، وإسناده ضعيف لحال محمد بن حميد، لكن مقبولة منه لكونها نسخة تفسيرية مشهورة ومقبولة، ولها متابعات تقوِّيها وتعضدها. ينظر: أسانيد نسخ التفسير، ص523.
[26] يروي نسخته التفسيرية من ثلاث طرق إلى سلمة بن الفضل، وإسنادها حسن. ينظر: أسانيد نسخ التفسير، ص523- 524.
[27] إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري أبو إسحاق المدني، نزيل بغداد، من الطبقة الوسطى من أتباع التابعين، حدَّث عن أبيه قاضي المدينة، وعن قرابته ابن شهاب الزهري، وابن إسحاق وغيرهم، وعنه أبو داود الطيالسي، وابن مهدي، وابن وهب، ويحيى بن آدم، ويزيد بن هارون، وأحمد بن حنبل، وغيرهم. روى له الجماعة؛ وتوفي ببغداد عام 183. ينظر: سير أعلام النبلاء (8/ 305)، تقريب التهذيب، ص89.
[28] يروي ابن المنذر نسخته التفسيرية عن زكريا بن داود النيسابوري، عن عمرو بن زرارة، وإسنادها صحيح. ينظر: أسانيد نسخ التفسير، ص522.
[29] زياد بن عبد الله بن الطفيل العامري، البكائي، الكوفي، حدَّث عن عطاء بن السائب، ومنصور بن المعتمر، وسليمان الأعمش، وابن إسحاق، وغيرهم، وعنه: عبد الملك بن هشام النحوي، وأحمد بن حنبل، وآخرون، قال أحمد وغيره: «ليس به بأس»، وقال ابن معين: «ثقة في ابن إسحاق»، وقال أبو حاتم: «لا يُحتجّ به»، توفي عام 183. ينظر: سير أعلام النبلاء (9/ 50)، تقريب التهذيب، ص220.
[30] يروي ابن المنذر نسخته التفسيرية عن عليّ بن عبد العزيز البغوي، عن أحمد بن محمد بن أيوب، وإسنادها حسن. ينظر: أسانيد نسخ التفسير، ص522.
[31] ينظر: مقدمة الكشف والبيان عن تفسير القرآن، ص145- 149.
[32] يونس بن بكير بن واصل الشيباني الكوفي، من صغار أتباع التابعين، حدَّث عن هشام بن عروة، وسليمان الأعمش، ومحمد بن إسحاق فأكثر عنه، وروى عنه يحيى بن معين، ومحمد بن مثنى، وآخرون، حديثه في صحيح مسلم والسنن، وروى له البخاري تعليقًا، قال ابن معين: «صدوق»، وقال أبو داود: «ليس هو عندي حُجة، يوصل كلام ابن إسحاق بالأحاديث»، توفي عام 199. ينظر: سير أعلام النبلاء (9/ 246)، تقريب التهذيب، ص613.
[33] وهي قوله تعالى: ﴿وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا﴾ [النساء: 1]، ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾، ﴿وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾، وكلتا الآيتين مما يتكرّر تفسيرهما، ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ﴾ [النساء: 44]، ﴿وَرَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ﴾ [النساء: 46]، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ ءَامِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا﴾ [النساء: 47]، ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ﴾ [النساء: 60]، ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ﴾ الآية [النساء: 97]، ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾، ﴿وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ﴾ الآية [النساء: 157]، ﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ﴾، ﴿لَكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ﴾ وأيضًا لم يورِد له جامع تفسيره محمد عبد الله أبو صعيليك إلا ثلاثة آثار في ثلاث آيات، جميعها متعلقة بالمبدأ والسيرة والقصص، وهي الآيات: 1، 97، 157.
[34] وقد أحصى له د. ماهر الفحل في كتاب (أسباب النزول) للواحدي (35) رواية. ينظر مقدمة تحقيق الكتاب، ص69، 72.
[35] بل يستطرد حتى يذكر الأنساب بطولها.
[36] ينظر: سيرة ابن هشام (2/ 106). وأخرجه ابن جرير في (1/ 496)، وابن المنذر في تفسيره (1/ 359- 361)، وابن أبي حاتم في تفسيره (3/ 749- 750).
[37] ينظر: سيرة ابن هشام (2/ 106- 121). وقد أخرج تفسير هذه الآيات ابن جرير، وابن المنذر وابن أبي حاتم في تفاسيرهم مفرّقة على الآيات. وينظر أمثلة أخرى:
- لمّا ذكر قصة غزوة بدر عقَّب عليها بذكر ما نزل من آيات سورة الأنفال مع تفسيرها من قوله: ﴿كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ﴾ [الأنفال: 5]، إلى آخر السورة. ينظر: سيرة ابن هشام (1/ 667- 677).
- لمّا ذكر مرويات قصة غزوة الأحزاب وبني قريظة؛ قال: «وأنزل الله تعالى في أمر الخندق، وأمر بني قريظة من القرآن، القصة في سورة الأحزاب، يذكر فيها ما نزل من البلاء، ونعمته عليهم، وكفايته إيّاهم حين فرَّج ذلك عنهم، بعد مقالة مَن قال من أهل النفاق: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا﴾ [الأحزاب: 9]، ثم شرع في تفسير الآيات إلى قوله تعالى: ﴿وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا﴾ [الأحزاب: 27]. ينظر: سيرة ابن هشام (2/ 245- 250).
- غزوة الحديبية: لمّا ذكر قصتها أورَد نزول سورة الفتح وشرع في تفسير بعضها إلى قوله تعالى: ﴿لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ءَامِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا﴾ [الفتح: 27]، ينظر: سيرة ابن هشام (2/ 320- 322).
[38] بل يسرد من تلك القصص ما يُسوّد العدد من الصفحات، وفيها الكثير من التفاصيل وتعيين الأسماء والغرائب؛ ينظر مثال ذلك: قصة عاد مع نبيهم هود -عليه السلام- في تفسير سورة الأعراف عند ابن جرير في تفسيره (10/ 269- 274)، وابن كثير في تفسيره (3/ 436- 437)، وغيرهما، وقد علّق ابن كثير عليه بقوله: وهذا سياق غريب؛ فيه فوائد كثيرة. ونحوها قصة ثمود مع نبيهم صالح -عليه السلام- في نفس السورة عند ابن جرير في تفسيره (10/ 286- 295)، وابن كثير في تفسيره (3/ 436- 439). وكذلك قصة خلقِ آدم -عليه السلام- عند ابن جرير (1/ 496)، وغيرها.
[39] ذكَرَ د. محمد عبد الله الخضيري في بحثه: (التفسير بالأثر بين ابن جرير وابن أبي حاتم)، ص91، أنَّ ابن إسحاق أكثر أتباع التابعين رواية للإسرائيليات عند ابن أبي حاتم؛ فقد بلغَت نسبة مروياته 21٪ من الإسرائيليات المذكورة في تفسيرهم، وبلغت نسبتها عند ابن جرير 9٪ من الإسرائيليات المذكورة في تفسيره، فجاء في المرتبة الثانية عند ابن جرير في رواية أتباع التابعين للإسرائيليات، ولا يخفى أنّ ابن جرير وابن أبي حاتم لم يعتنيا بتفسير الكلبي ومقاتل اللذَيْن قد يكونان أكثر رواية للإسرائيليات منه.
[40] سير أعلام النبلاء 7/ 52.
[41] سير أعلام النبلاء 7/ 53، وعقَّب الذهبي على ذلك بقوله: «هذا يُشنِّع به على ابن إسحاق، ولا ريب أنه حملَ ألوانًا عن أهل الذمَّة مترخصًا بقوله -صلى الله عليه وسلم-: (حدِّثوا عن بني إسرائيل ولا حَرَج)».


