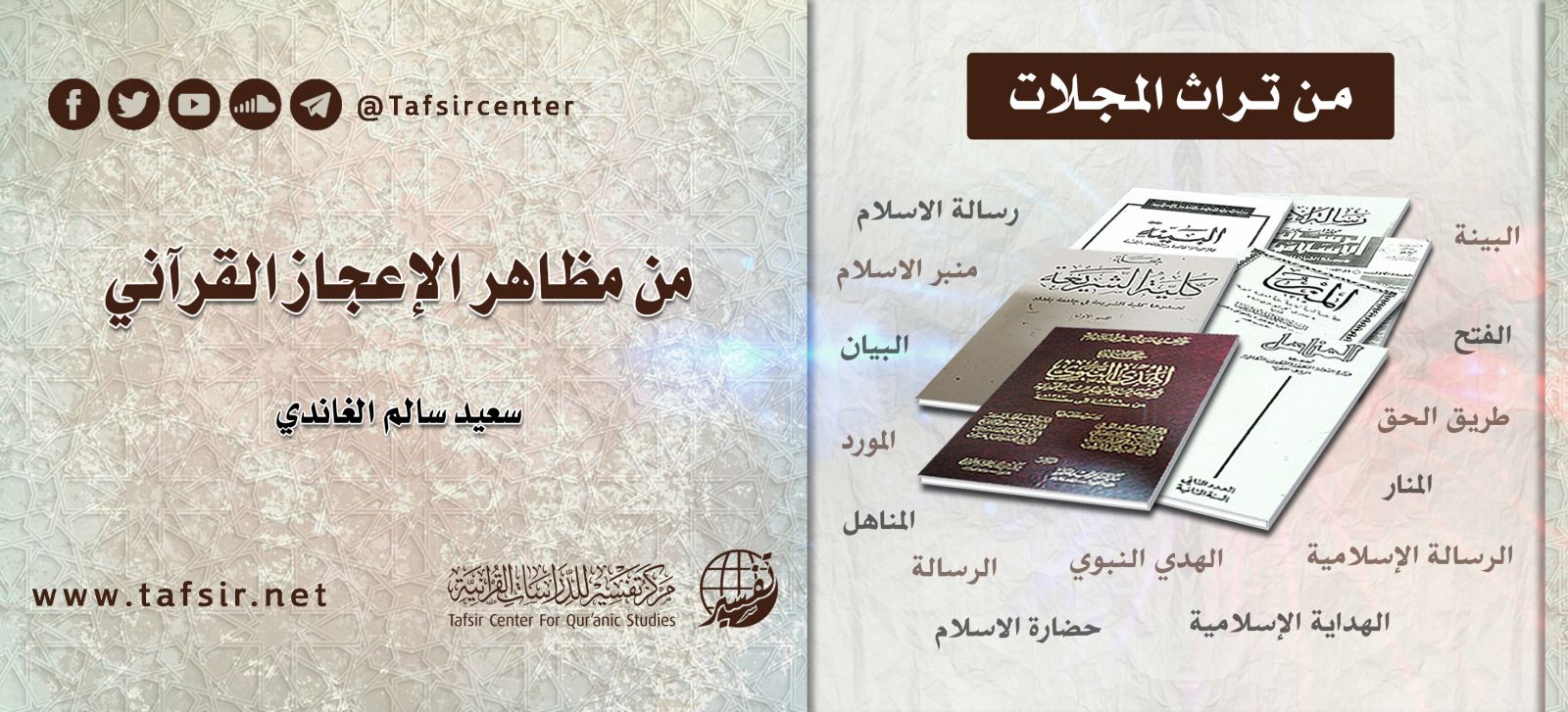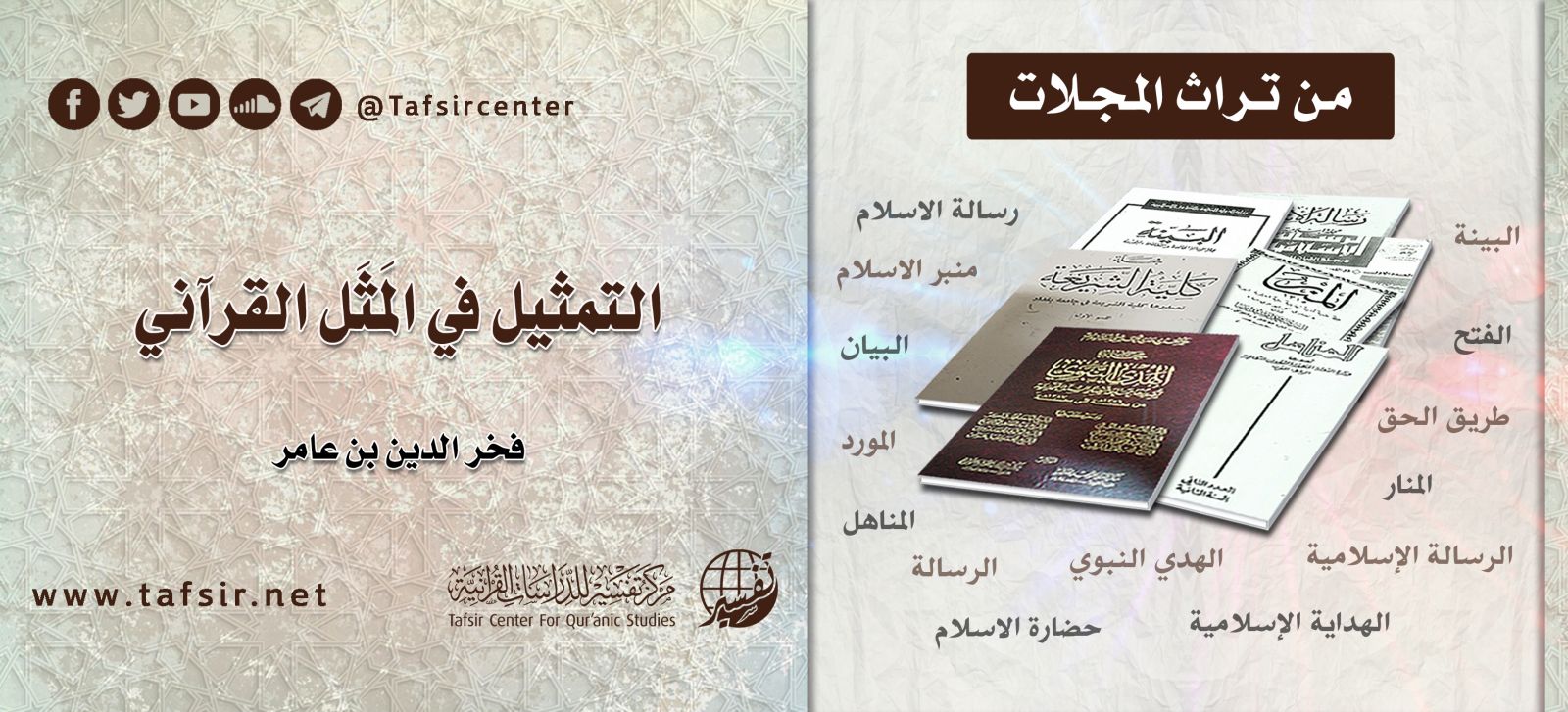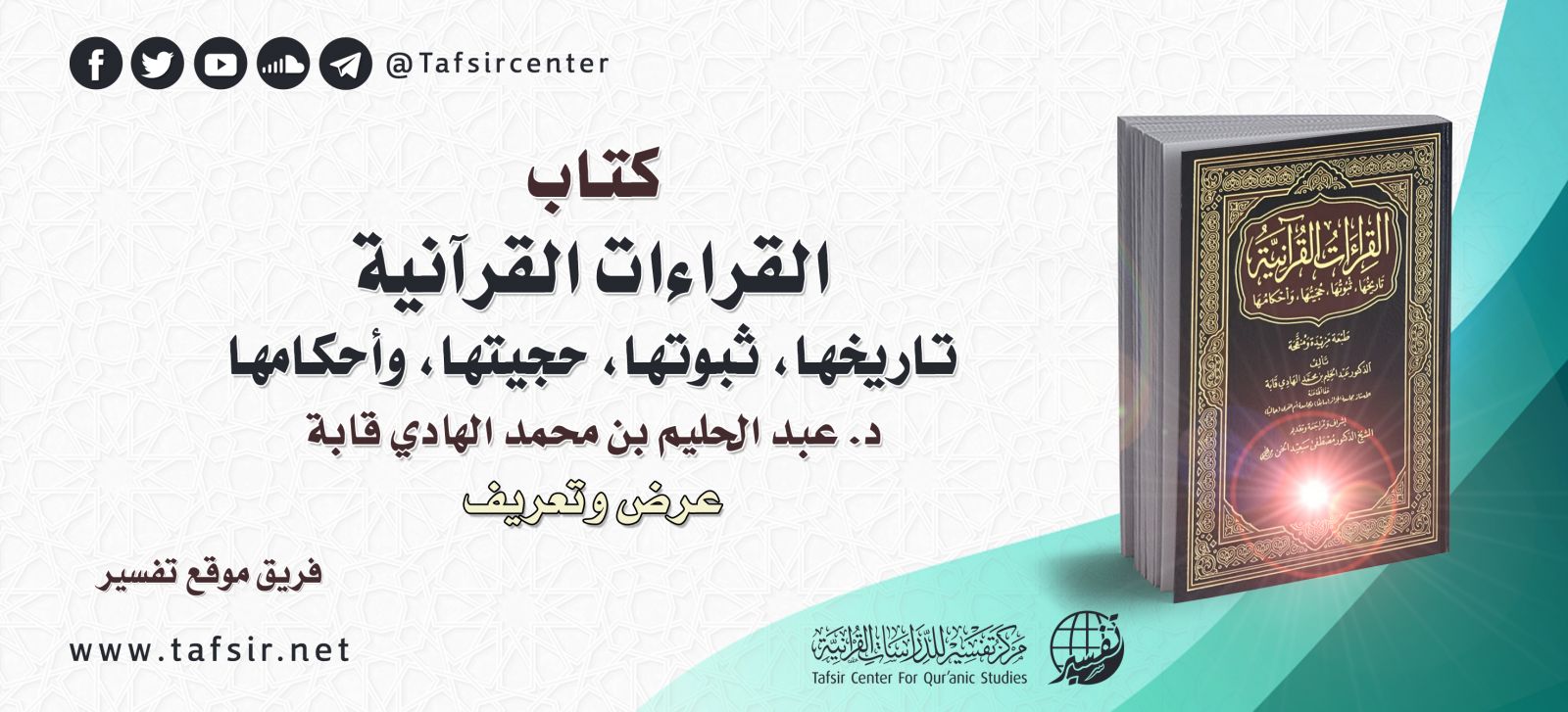نظرات في التعبير القرآني في المواقف الحيائية
نظرات في التعبير القرآني في المواقف الحيائية
الكاتب: محمد فريد المشهدي

صدق اللهُ -سبحانه وتعالى- إِذْ يُثْنِي على كلامه المحكَم بثَنائه النوراني: {إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ}[الإسراء: 9]، أي: إِنَّ القرآنَ يهدينا بإذن الله -سبحانه وتعالى- إلى أعدل شيءٍ وأحكمه وأعلاه في العقائد والأعمال والأخلاق.
فإذا كان ذلك كذلك فحتمًا يجب علينا أن نتأمّل كلّ حرف من حروفه النورانية، والتي ترسم لنا طريقنا الأوحد للسعادة في الدارَيْن.
ألَا، ومِن أقومِ الأخلاق الكريمة، وأعلى القِيَم السامية التي حَضَّ عليها القرآنُ الكريم؛ خلق: (الحياء)، وبعيدًا عن التنظير فقد عَلَّمَنَا القرآن الكريم كيفية التطبيق لهذا الخُلُق السامي، لا سيما عند حديثنا عن المواقف الحيائية، وهو ما سنحاول تجليته في هذه المقالة من خلال تطوافنا مع تعبير القرآن الكريم عن المواقف الحيائية.
لعلّ أوّل ما يلاحظه المتدبّر للقرآن، هو تميّز القرآن بمعجم إلهيّ متميّز الخصائص ينفرد به عن سائر الكلام العربي، ومِن أبرزِ الخصائص التي يتميّز بها المعجم الرباني في القرآن خاصيتَا (التعفف، الحياء).
ولا شيء يُظْهِرُ الحياء ويبرزه أكثر مما يكشفه الحديثُ عن العورات، خاصّة إذا كان متعلّقًا بالعلاقة الزوجية الخاصّة!
فما لا نقاش فيه، ولا خلاف عليه البتة أنّ العلاقة الزوجية تتربّع على قِمّة الأمور التي تُبْرِز هاتين الخصلتَيْن الطاهرتَيْن (التعفف، الحياء).
ولَمَّا كان القرآنُ كتابًا مُنَظِّمًا لشؤون الحياة قاطبة دِقّها وجلّها بغير استثناء لأيٍّ منها، فكان طبيعيًّا أن يأتي على ذِكْر تشريعات متعدّدة منظّمة لتلك العلاقة الحميمية بين الزوجين.
ولكنَّ الإرادة الإلهية في تنظيم هذه العلاقة الحميمية كانت متحقّقةً بمقتضى الأسماء الحسنى والصفات العُلى، والتي منها هذا الاسم الحَسَن: «الْحَيِيُّ»، وصدَق نبيُّنا -صلى الله عليه وسلم- إِذْ يقول: «إِنَّ رَبَّكُمْ -تَبَارَكَ وَتَعَالَى- حَيِيٌّ كَرِيمٌ، يَسْتَحْيِي مِنْ عَبْدِهِ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَيْهِ، أَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا»[1].
وفي حديث آخر يقول -صلى الله عليه وسلم-: «إِنَّ اللَّهَ -عَزَّ وَجَلَّ- حَيِيٌّ سِتِّيرٌ يُحِبُّ الْحَيَاءَ وَالسّتْرَ»[2].
ألَا، فقد تجلَّتْ مقتضيات هذا الاسم الحسن «الْحَيِيِّ» في المعالجات القرآنية للتشريعات المتعلّقة بتلك العلاقة الحميمية؛ إِذْ تناولها بكناياتٍ عفيفةٍ متضمّنة دلالاتٍ واضحةً على حياء مُنزلها، سبحانه وتعالى.
فلنتأمّلْ بعضَ التعبيرات القرآنية عن «الجِمَاع» بهذه الكنايات الربانية المتوافقة مع أسمائه الحسنى، سبحانه وتعالى.
* ومن هذه الكنايات الإلهية عن الجِمَاع:
«الرَّفَثُ» في قوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ}[البقرة: 187].
«المباشَرة» في قوله تعالى: {وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْـمَسَاجِدِ}[البقرة: 187].
«الاقتراب» في قوله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ}[البقرة: 222].
«الإتيان» في قوله تعالى: {فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ}[البقرة: 223].
«المسّ» في قوله تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ}[البقرة: 237].
«الإفضاء» في قوله تعالى: {وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ}[النساء: 21].
«الدُّخول» في قوله تعالى: {...مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ...}[النساء: 23].
«الاستمتاع» في قوله تعالى: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ}[النساء: 24].
«الـمُلامَسة» في قوله تعالى: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ}[النساء: 43]، [المائدة: 6].
«التغشِّي» في قوله تعالى: {فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا}[الأعراف: 189].
«الـمُلابَسة» في قوله تعالى: {هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ}[البقرة: 187].
«الـمُضَاجَعَة» في قوله تعالى: {وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ}[النساء: 34].
«الـمُسافَحة» في قوله تعالى: {مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ}[النساء: 24].
«الـمُخادَنة» في قوله تعالى: {وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ}[النساء: 25].
«البُهتان» في قوله تعالى: {وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ}[الممتحنة: 12].
«الطَّمْث» في قوله تعالى: {فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ}[الرحمن: 56].
«الشُّغُل» في قوله تعالى: {إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ * هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ}[يس: 55- 56].
فتأمّل هذا التعريض الرباني، وتلك الكنايات الإلهية، وما فيها من الحياء الربَّانيِّ، وعفّة الألفاظ عند الإشارة إلى أكثر العلاقات حرجًا بين الرجل والمرأة، سواء أكانت في الحلال أم الحرام، أعاذنا اللهُ من الحرام كلّه!
ولا ريب أنّ اختيار نوع الكناية يتناسب مع الموضع، ويتناغم مع السياق، وله من الحِكَم ما تُفْرَد له المصنّفات الطّوال، والإشارة إلى ما فيها من الحياء والعفة ليست إلّا إشارة لبعض ما فيها من الجمال.
فكم يجمل بنا أن نتخلّق بهذا الخُلُق الرباني السامي، ونلتزم به في كلّ معاملاتنا الاجتماعية بما يضفي طابعًا ساميًا على أجيالنا الصاعدة.
ألَا، فما أعظم العفاف في التعبير، والحياء في الحديث، وما أعظم أثره البالغ على الفرد والمجتمع بأَسْرِه.
وإليك قصصًا ربانيًّا آخر تتجلى فيه فيوض اسمه «الْحَيِيّ»:
إِذْ لا يمكن البتة أن يكون هناك أدنس، ولا أقذر، ولا أرجس من ذلك الموقف الخسيس الذي تتخلّى فيه المرأة عن أيّ أثر لدِين، أو خُلق، أو حياء، أو إنسانية، فلا يبقى منها إلا الأنثى العارية عن كلّ فضيلة، المحرومة من أيّ غطاء آدمي!
ورغم ذلك فقد قصَّ -سبحانه وتعالى- القصة بما يليق واسمه «الْحَيِيّ»، فلم يبرز منها إلّا ما أراد الله -سبحانه وتعالى- إبرازه من العِبَر الجليلة والدروس العظيمة حيث التعفّف اليوسُفِيّ المعروف، ومراقبته اللامتناهية لله -سبحانه وتعالى- في مواطن الخلوة حيث لا يراه إلّا خالقه -سبحانه وتعالى-، هذا مع وفور داعي الفاحشة، وقوّة الترهيب من التعفّف عنها.
ولم يَعُد خافيًا أنّ القصة المعنيّة هي قصة سقوط امرأة العزيز في قاع القاع من الشهوة البهيمية!
فتأمّل التعبيرات الربانية الراقية التي قَصّ بها -سبحانه وتعالى- أكثر الفصول حرجًا في تلك القصّة: {وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ * وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ * وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ * قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي}[يوسف: 23- 26].
حقًّا... إنه كلام رباني يقينًا، وسياق إلهي صدقًا!
وقبل قَصِّ القصة برمّتها؛ فقد وصف -سبحانه وتعالى- هذا القصص بقوله: {نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ}[يوسف: 3].
نعم لقد كان أحسن القصص في تعبيراته الربانية الراقية، وعِبَرِهِ الإلهية الرائعة؛ كما أخبر -عز وجل- قائلًا: {لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ}[يوسف: 111].
ليس (عِبرة) فقط؛ بل: {وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً}[يوسف: 111].
نعم فما قَصَّ -سبحانه وتعالى- هذا القصص للتسلية، حاشاه ذلك -سبحانه وتعالى- فما قَصَّه إلّا عبرةً، وتفصيلًا للشرّع، وهدى ورحمة!
بَيد إنَّ القَصص القرآني لن يكون دروسًا جليلة، وعِبَرًا عظيمة، ولا هدى ولا رحمة لكلِّ أحدٍ؛ بل لفئةٍ مخصوصةٍ، وهي التي أخبر عنها -سبحانه وتعالى- بقوله: {لِأُولِي الْأَلْبَابِ}[يوسف: 111]، وكما قال تعالى: {لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ}[يوسف: 111].
ولعلّنا بهذا الاستعراض السريع تتضح لنا قضايا من أهم القضايا في الفهم. ألَا وهي قضية: (الموازنات)، أو: (الوسطية في التطبيق) أو: (فقه التطبيق)، وهي قضايا من الأهمية بمكان.
إِذْ لَدَيْنَا في الإسلام أوامر عديدة، منها ما يأتي:
الأمر الأول: تعلّم العِلْم وتعليمه حتى فيما يتعلّق بالأمور الحيائية أو المخجِلة.
الأمر الثاني: التزام الحياء في كلّ أمر؛ لأنّ الحياء كلّه خير كما جاء عن النبي -صلى الله عليه وسلم-.
ولكنَّ الناس في العادة يجنحون إلى أحد الطرفَيْن من دون الآخر، وهو ما يُعْرَفُ بالتطرّف في التطبيق.
فترى بعضهم يتكلّم في المواضيع الحيائية بصورة فجّة، وأساليب مبتذَلة يبدّد بها الحياء، وينسف بها الفضيلة نسفًا، معلّلًا تطرّفه الفجّ، وبذاءته المفرطة أنه يتكلّم في الدِّين، ولا بد من توعية الناس وتعليمهم!
وفي مقابل هذا التطرّف في التفريط تطرّف على الجانب الآخر؛ إِذْ ترى خجَلًا مُفْرِطًا يَحُول بين أصحابه وتعلُّم تلك الأمور أو تعليمها.
ولا ريب أنَّ كِلَا الأمرين ذميمٌ في الإسلام، وحريٌّ بالمؤمنين أن يستخلصوا من بين رفث التفريط، ودم الإفراط، لبنَ الوسطية السائغ للشاربين، وأن يشربوه هنيئًا مريئًا.
وأعتقد أن تدبّر الآيات الكريمة يرشدنا -بإذن الله- إلى الخُلُق الأقوم، والأسلوب الأسمى؛ إِذْ قصّ -سبحانه وتعالى- علينا ما يريد قصَّه بأقومِ حياء، وأسمى عِفّة!
فلا أخفى عنّا من الحقيقة شيئًا بداعي الحياء، ولا خَدَش الحياء بداعي التعليم!
فبيّن -سبحانه وتعالى- لنا كيفية الجَمْع بين المطالب الشرعية بصورة عمليّة ومنهج تطبيقي، بدون إغفال شيء منها.
كما علَّمَنا اللهُ -سبحانه وتعالى- في هذا السياق الرباني الرفيع التطبيقَ الصحيح للمنهج الرباني في «الوسطية» بعيدًا عن الإفراط أو التفريط.
فلا نُفَرِّطُ في خُلُق (الحياء) بداعي التعلّم والتعليم، ولا نُفْرِطُ فيه إفراطًا يحرِمنا التعلُّم، ويمنعنا من التعليم.
كما يعلّمُنا القرآن الكريم (فقه التطبيق) لكلٍّ من الحياء، وتعلّم الأمور الحيائية وتعليمها بصورة شرعية صحيحة.
وفوق كلّ هذا يعلّمُنا القرآن (فقه الموازنات) بين تعلُّم الدِّين وتعليمه مع الحفاظ على حيائه وأخلاقه.
ألَا، فما أحرانا أن نقرأ القرآن قراءة المتدبّر، المتعلّم، وليستْ قراءة العادّ للأجزاء المقروءة!
اللهم فاجعلنا من المؤمنين أولي الألباب النقية، والعقول النيّرة، والقرائح الصافية التي تفهم عنك ما تريده لنا من الخير، والحياء، والعفاف، والهدى والرحمة.
ولا ريب أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- أعظم الخَلْق انتفاعًا بالقرآن. فإذا كانت حصة كلِّ امرئ من الانتفاع بالقصص القرآني على قَدْرِ صِدْقِ إيمانه، وصفاء لُبِّه؛ فغنيّ عن البيان حينئذٍ أنْ يكون القدح الْمُعَلَّى، والحظّ الأكفى، والنصيب الأجزل للنبي -صلى الله عليه وسلم- الذي كان يعتمد التعبيرات الراقية، والكنايات السامية ليغطي بها المعاني الحرجة والمسائل الخاصّة.
وإليك مثالًا رائقًا على ذلك الاتباع النبوي للمنهج القرآني السامي في التعبير عن الأمور الحرجة بالكنايات الرائقة:
فمن ذلك قوله -صلى الله عليه وسلم-: «حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ، وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ»[3]. فكنَّى -صلى الله عليه وسلم- عن الجِمَاع بالعُسَيلة، وذلك لامرأة رفاعة إِذْ أرادتْ الرجوع لزوجها الأول.
ويا لها من تعبيرات سامية، وكنايات رائقة عن أمور شديدة الحساسية!
وإليك مثالًا آخر من كنايته النبويّة عن العورات الحسّاسة:
وذلك كما جاء عَنْ أُسَامَةَ بنِ زَيْدٍ -رضي الله عنهما- قَال: «كَسَانِي رَسُولُ اللَّهِ قُبْطِيَّةً [ثوبًا أبيض شديد البياض] كَثِيفَةً، مِمَّا أَهْدَاهَا لَهُ دِحْيَةُ الْكَلْبِيُّ، فَكَسَوْتُهَا امْرَأَتِي. فقال: مَا لَكَ لَمْ تَلْبَسِ الْقُبْطِيَّةَ؟ قُلْتُ: كَسَوْتُهَا امْرَأَتِي. فَقَالَ: مُرْهَا فَلْتَجْعَلْ تَحْتَهَا غِلَالَةً [الثوب يكون تحت الدِّرع]؛ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ تَصِفَ عِظَامَهَا»[4].
فانظر -رحمني الله وإياك- قِمّة السموّ النبوي؛ إنَّ الثوبَ الشفّافَ يصف المحاسن الليّنة للمرأة، ويكشف عوراتها عياذًا بالله، ولكنَّ النبيّ -صلى الله عليه وسلم- كنَّى عن العورات والأعضاء الليّنة بلفظ العظام!
وهو لفظٌ مليءٌ بالوقار والاحتشام، بعيدٌ عن أيّ لفظ محرج، أو تعبير خادش للحياء!
إنَّه لفظٌ لا يحرّك ساكنًا، ولا يخرج كامنًا، وفي الوقت نفسه يبعد عن الذّهن أيَّ تصوّر، أو خيالٍ غير رائق!
ومع ذلك فلا عجب أنْ تكون هذه التعبيرات الراقية والكنايات السامية من أعظم الخَلْقِ طرًّا فهمًا للقرآن، وانتفاعًا به، واتّباعًا له، والتزامًا بهديه الإلهي!
ولو تتبّعنا ذلك لكان مصنَّفًا مستقلًّا ضخمًا، ولكن الهدف متحقّق بالمذكور ولله الحمد؛ إِذِ الهدف هو بيان أثر التدبّر القرآني على معجم الْمُتَدَبِّرِ، وسموّ خُلقه، ورِفْعَة أدبه.
ومن الطبيعي أن يكون الصحابة أعظم الناس اتّباعًا لهذا المنهج القرآني الرائق؛ وذلك أنَّهم خير الأمة، وأعظمها إيمانًا كما في الحديث عن عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قال: قال النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «خَيْرُ أُمَّتِي قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ»[5].
فلا ريب أنْ يكون أعظمُ الأمة إيمانًا وأصفاها لُبًّا وأكثرُها تدبّرًا للقرآن؛ أقوانَا اتّباعًا لهذا السموّ القرآني في التعبير.
ومن الأمثلة على ذلك: الحديث المشهور عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ -رضي الله عنه- قَالَ: «كَانَ ابنٌ لِأَبِي طَلْحَةَ يَشْتَكِي، فَخَرَجَ أَبُو طَلْحَةَ، فَقُبِضَ الصَّبِيُّ. فَلَمَّا رَجَعَ أَبُو طَلْحَةَ، قَالَ: مَا فَعَلَ ابْنِي؟ قَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ: هُوَ أَسْكَنُ مَا كَانَ، فَقَرَّبَتْ إِلَيْهِ العَشَاءَ فَتَعَشَّى، ثُمَّ أَصَابَ مِنْهَا، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَتْ: وَارُوا الصَّبِيَّ، فَلَمَّا أَصْبَحَ أَبُو طَلْحَةَ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ فَأَخْبَرَهُ. فَقَالَ: أَعْرَسْتُمُ اللَّيْلَةَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمَا. فَوَلَدَتْ غُلامًا. قَالَ لِي أَبُو طَلْحَةَ: احْفَظْهُ حَتَّى تَأْتِيَ بِهِ النَّبِيَّ، فَأَتَى بِهِ النَّبِيَّ وَأَرْسَلَتْ مَعَهُ بِتَمَرَاتٍ، فَأَخَذَهُ النَّبِيُّ. فَقَالَ: أَمَعَهُ شَيْءٌ؟ قَالُوا: نَعَمْ، تَمَرَاتٌ، فَأَخَذَهَا النَّبِيُّ فَمَضَغَهَا، ثُمَّ أَخَذَ مِنْ فِيهِ، فَجَعَلَهَا فِي فِي الصَّبِيِّ وَحَنَّكَهُ بِهِ، وَسَمَّاهُ عَبْدَ اللَّهِ»[6].
ألَا، وقد بلغ الحديث شُهرة بالغةً، وذيوعًا فائقًا بدرجة يصعب معها أن تجد مَنْ لم يسمعه عشرات المرات؛ بَلْه أن تجد جاهلًا به لم يسمعه أصلًا! وذلك أنه حديث عمدة يقال في الجنائز والمصائب التي لا يخلو منها إنسانٌ، سواء أكان فاسقًا، أم من أهل الإيمان!
ألَا، ومع شُهْرة الحديث هذه الشّهرة البالغة فلم أجد مَنْ لَفَتَ النظر لأبرز دلائله الأخلاقية، وسماته الراقية، وألفاظه السَّامية!
ولم أُوْرِد الحديث هنا لأتناوله من جوانبه المشهور بها عند العالمين. كذلك فلن أتناول الحديث من الأبواب التي ترجم له بها العلماء، وهي: أبواب: «تحنيك المولود، وتسميته، والخميصة السوداء، ووسم الحيوان، والفضائل،...»، وغيرها من الأبواب الجليلة؛ فقد شاء الله -سبحانه وتعالى- أن يبهرني الحديث من جانب لم أجد أعظم منه رقيًّا، وهو رقيّ الألفاظ المستخدمة، والتي تشير إلى أخصّ أنواع العلاقة الزوجية، والتي سترها اللهُ -سبحانه وتعالى- حتى عن أقرب المقرّبين من الآباء والأمهات، والبنين والبنات، فلا يعلم بها غير ربّ الأرض والسماوات تعالى شأنه وجل عن الزلات والهفوات.
فانظر إلى التعبيرات الراقية في الحديث والمستخدمة للكناية عن الجِمَاع، وتأمّل -رزقني الله وإياك الحياء- في تعبير أنس -رضي الله عنه- مُشِيرًا للجِمَاع بقوله: «ثُمَّ أَصَابَ مِنْهَا»!
وهو لفظٌ جَمَع في مُراده بين الرِّقَّة والدِّقَّة، وفي سياقه بين الخفاء والنقاء، فنِعْمَ المراد من نِعْمَ المريد، رضي الله عنه!
ثم تأمَّل -رزقني الله تعالى وإياك الحياء- في تعبير أبي طلحة -رضي الله عنه- عن الجِمَاع بقوله: «تَلَطَّخْتُ».
والتَّلطخ: هو أن يتعلّق بالرجل شيءٌ من الطِّيب الذي تطيبتْ به زوجه وهي تتزيّن له، فكنَّى -رضي الله عنه- عن الجِماَع بالطِّيب والعِطْر! ألَا، فما أطيبها من كناية أطيب من كلّ طِيبٍ!
ثم تأمل -رزقني الله وإياك الحياء- في تعبير النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- وإشارته إليه بقوله -صلى الله عليه وسلم-: «أَعْرَسْتُمُ اللَّيْلَةَ؟».
والتَّعريس: هو نزول القوم في السفر من آخر الليل في مكانٍ ما للنوم[7]، فعبَّر النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- عن الجِمَاع بكناية رقيقة، وهي النوم في السّفر، وهي كناية عن الشيء بزمانه، ومكانه بغير التطرّق لأصله وبيانه!
فإليكَ -يا طالب الخلق الحَسَن- ثلاثة تعبيرات مختلفة عن شيء واحد وهو الجِمَاع؛ عَلَّنَا بذلك نتعلّم الأخلاق الفضيلة، والكلمات الطاهرة من خير السلف -رضي الله عنهم-؛ لنكون لهم -بعون الله عز وجل- خير خَلَف.
ولعلّنا بهذا المثال الموجَز نكون قد أشرنا إلى أيّ مدى «تَأثّرَ مجتمع السّلف بتدبّر القرآن الكريم»: وكيف كان تدبّرهم للقرآن الكريم مؤثّرًا عليهم في معجمهم، وتعبيراتهم، وأساليبهم، وكلّ مناحي حياتهم.
ألَا فلنتأمل المفارقة وسببها:
وبينما أتأمل سموّ الألفاظ في الحديث إِذْ ألقى الله -سبحانه وتعالى- في رُوعي مقارنةً بين هذا الحديث الرقيق وذلك الموقف الدقيق، وما تَميَّزَ به من السياق الرَّاقي والتعبير السَّامي؛ وما يصم الأذن من الألفاظ الفجَّة، والتعبيرات الممجوجة حتى توشك الأُذن أن تتقيّأ ما تسمع، تلك التي يستخدمها بعض الناس!
حينئذٍ طُرِحَ على خاطري سؤال خطير، وهو: ما سبب هذه المفارقة العجيبة في الأسلوب، وذلك التباين الرهيب في السياق؟
فإذا بقوله -سبحانه وتعالى- يلوح في الأفق: {أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ}[النساء: 82].
نعم، إنَّ الفرق بين رُقِيِّ ألفاظهم، وانحطاط أسلوب الكثيرين يكمن في تدبّر القرآن لا غير!
فإن قيل: إنَّ بيننا الكثيرين ممن يحفظون القرآن! أوضحت مُذَكِّرًا: ألَا إنَّ سببَ المفارقةِ العجيبة ليس في (حفظ القرآن) البتة؛ بل في: (تدبره وفهمه ووعيه)!
ألَا إنَّ سببَ المفارقةِ العجيبة هو: «المأخذ القرآني»، فبينما كان مأخذ الصحابة -رضي الله عنهم- للقرآن قائمًا على التدبّر، والتفكّر، والوعي، والإدراك، والاتباع، والتطبيق! إِذْ بنا أمام فريقٍ حادَ حيدة تامّة عن ذلك المأخذ الرباني، واقتصر في أخذه للقرآن على الحفظ، والتلاوة، وتحسين الصوت، وحصد الجوائز! فما كان منه إلّا أن أرانا من نفسه مسخًا مشوّهًا من جيلٍ يُوصف بأنه (جيل القرآن)؛ لكنه للأسف لم يأخذ منه سوى الكلمات المجرّدة عن المعنى، والألفاظ الخاوية من المضمون؛ إلَّا مَن رحم ربي. مخالفًا بذلك منهج الصحابة -رضي الله عنهم- في تعلُّم القرآن وأَخْذه؛ إِذْ لم يكن قائمًا على إتقان الألفاظ، وتجميل الأصوات، وحصد الجوائز كما هو أَخْذ الكثيرين اليوم، بل كان قائمًا على التدبّر، والتفكّر، والتفهّم، والعمل والتطبيق، والاقتداء، والاهتداء.
وهذا تبرير مُعْتِمٌ، وجوابٌ مُفْحِمٌ لِفِئَةٍ زائغةٍ عن الحقِّ؛ إِذْ نرى اليوم أمورَ الكثيرين منهم معاكسة تمامًا لمنهج القرآن وتعبيراته الراقية، وكناياته السامية! إذ تجد مذيعًا يستضيف طبيبة على الهواء لتتحدّث فيما يُظَنُّ أنّ إبليس نفسه يستحيي منه! ومذيعةً تستضيف طبيبًا على الهواء لتحدّثه فيما لا يجوز أن تتحدّث فيه مع أمّها! وشرّ من هذا وتلك متسربلون بسربال الدعوة يتخيّرون أقذع الألفاظ وأفحش التعبيرات!
وشر من هذا كلّه أنهم يستدلّون على فُحْشِهم بنصوص صحيحة لها قرائنها التي توجب التوضيح مكان التلميح، وتفرض العبارة مكان الإشارة، وذلك لخطورة موقف عظيم اضطُرُّوا -لعظيم خطره- إلى البيان صراحةً؛ إذ لم يَفِ خفاء الكناية، لا سيما وأنَّه يتعلّق باستحلال أرواح العباد، وإزهاقها بالأحكام القضائية!
وهذا ما لا يتجاسر أحدٌ على إنكاره؛ كمَوَاطِنِ الشهادة، والقضاء، وما لا تتحقّق المصلحة بغيره من التصريح والبيان. وذلك حرصًا ألّا تزهق أرواح العباد بغير الحقّ البَيِّنِ الواضحِ الذي لا لبس فيه ولا تأويل!
فمثلًا: لفظ (الزنا) -أعاذنا اللهُ منه ومن أهله- لفظٌ صريحٌ قويّ، ومع ذلك فقط يُطْلَقُ على الفاحشةِ الكبرى التي توجب الحدّ على صاحبها، نعوذ بالله منها. وفي الوقت نفسه فقد يُطلق لفظ (الزنا) -عياذًا بالله- على النظرة المحرّمة، والكلمة المحرّمة، واللمسة المحرّمة، والهاجس المحرّم، وهي منكرات سيئة لا ريب، لكنها مع ذلك ليست والفاحشة الكبرى سواء بسواء، نعوذ بالله من الفواحش ما ظهر منها وما بطن.
ولكن لماذا هذا التمَحُّك في الدِّين عند ارتكاب الفواحش، عياذًا بالله؟! إِنَّ هذا التمحّك في الدِّين إنَّما يشير إلى الهوى في انتقاء الأدلة، والانتكاسِ في فقه الاستدلال، وطمسٍ في نور البصيرة، عياذًا بالله!
ألَا، وقد أشار نبينا -صلى الله عليه وسلم- لهؤلاء المنكوسين بقوله -صلى الله عليه وسلم-: «رُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَيْسَ بِفَقِيهٍ»[8]، نعوذ بالرحمن الرحيم من الزّيغ والهوى وطمسِ البصيرة!
وكما كان الحياء إيمانًا كان الفُحْش نفاقًا، عياذًا بالله. فكما كان التعفّف في الألفاظ من سمات الشخصية القرآنية التي تأدّبَت بآداب القرآن! فعلى النقيض تمامًا نجد التفحّش من أبرز سمات المنافقين، أعاذنا اللهُ منهم؛ وذلك كما جاء عنه -صلى الله عليه وسلم- إِذْ يقول: «إِنَّ الْحَيَاءَ وَالْعَفَافَ وَالْعِيَّ (عِيَّ اللِّسَانِ لَا عِيَّ الْقَلْبِ) وَالْفِقْهَ =مِنَ الْإِيمَانِ، وَهُنَّ مِمَّا يَزِدْنَ فِي الْآخِرَةِ، وَيُنْقِصْنَ مِنَ الدُّنْيَا، وَمَا يَزِدْنَ فِي الْآخِرَةِ أَكْثَرُ. وَإِنَّ الْبَذَاءَ وَالْجَفَاءَ وَالشّحَّ =مِنَ النِّفَاق، وَهُنَّ مِمَّا يَزِدْنَ فِي الدُّنْيَا، وَيُنْقِصْنَ فِي الْآخِرَةِ، وَمَا يُنْقِصْنَ فِي الْآخِرَةِ أَكْثَرُ»[9].
وَمن ذلك أيضًا ما جاء عن أبي بَكْرَةَ -رضي الله عنه- عن النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- قال: «الْحَيَاءُ مِنَ الْإِيمَانِ، وَالْإِيمَانُ فِي الْجَنَّةِ، وَالْبَذَاءُ مِنَ الْجَفَاءِ، وَالْجَفَاءُ فِي النَّارِ»[10].
ومن ذلك ما جاء عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «الْحَيَاءُ مِنَ الْإِيمَانِ، وَالْإِيمَانُ فِي الْجَنَّةِ، وَالْبَذَاءُ مِنَ الْجَفَاءِ، وَالْجَفَاءُ فِي النَّارِ»[11].
كما رُوِيَ عن أبي سعيد الخدري أنّ رسول اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قال: «الْغَيْرَةُ مِنَ الْإِيمَانِ، وَالْبَذَاءُ [وفي بعض النسخ: المزاء] مِنَ النِّفَاقِ. قَالَ: قُلْتُ: وَمَا الْبَذَاءُ؟ قَالَ: الَّذِي لَا يَغَار»[12].
قَالَ الْحَلِيمِيُّ -رحمه الله-: «الْمِذَاءُ: أَنْ يَجْمَعَ الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ ثُمَّ يُخَلِّيهِمْ يُمَاذِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا، وَأُخِذَ مِنَ الْمَذْيِ. وقيل: هو إرسال الرجال مع النساء، من قولهم: مَذَيْتُ فَرَسًا إِذَا أَرْسَلْتَهَا تَرْعَى»[13].
فكما علَّمَنا القرآنُ أنَّ التعبيراتِ الراقية والكنايات السامية في المواقف الحيائية من دلائل الإيمان! فكذلك البذاءة والفُحش في القول أو العمل من علامات النفاق؛ خاصّة ما كان منه يثير الساكن في النّفس، ويخرج الكامن منها، عياذًا بالله.
وصدق الله -سبحانه وتعالى- إِذْ يقول: {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ}[الأعراف: 33].
وكما أنّ المتَّبِعَ للتعبيرات الربانية الراقية والكنايات الإلهية السامية مستوجبٌ لمحبة الله -سبحانه وتعالى-، ومعيَّته بما تدبَّره من القرآن واتَّبَعَه! كذلك فالفاحش في قوله أو عمله مستوجِب لبُغْضِ الله -سبحانه وتعالى-، وبُعْدِه عنه كمّا أخبر -صلى الله عليه وسلم-: «إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفُحْشَ، وَلَا التَّفَحُّشَ»[14].
خاتمة:
تعرّضْنَا في هذه المقالة للتعبير القرآني عن المواقف الحيائية، وَرَأَيْنَا كيف أنه عرض لبيان هذه المواقف والكلام فيها بطريقة عفيفة ليس فيها هتك ولا فضح ولا بذاءة، وهو سلوك قرآني حريّ بكلّ مسلم مُقْبِل على القرآن ومتدبِّر له أنْ يترجمه في حديثه وكلامه، فلا يصدر منه أيُّ لفظ فاحش، أو كلمة منكرة.
كيف وقد تعلَّم من القرآن أنّ ذلك من دلائل النفاق، عياذًا بالله!
كيف وقد تعلَّم من القرآن أنه لن يكون من أهله حتى يتّبع منهجه!
كيف وقد تعلَّم التخلّق بالأخلاق الإلهية، ومن أهمها: (الحياء).
كيف وهو لم يقرأ القصص القرآني تسليةً؛ بل مستفيدًا من عِبَرِه الجليلة، ودروسه العظيمة.
اللهم ارزقنا برحمتك من الإيمان والتقوى والتفكّر والتدبّر والفهم ما يُعِينُنَا على الانتفاع بالقصص القرآني خاصّة، والقرآن بصورة عامة.
وأخيرًا... فالحمد لله الذي أنعم علينا، وعلَّمَنا أرقى الكلمات، وأسمى التعبيرات، وأنقى العبارات بالكتاب والسنّة، وأنعم علينا بنعمتي التفكر والتدبّر للكتاب والسنّة وفهم المراد، واتّباعه بقدر المستطاع!
ألَا، فيا لها من نعمة تستوجب الشكر من خلال تعلُّمِها، وتدبُّرِها، والعمل بها؛ إذ الرقيّ في الأسلوب بعض ثمرات التدبّر للكتاب المجيد.
اللهم بحقّ وجهك الكريم نسألك أن تجعلنا ممن زكّيتهم بقولك العزيز: {وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْـحَمِيدِ}[الحج: 24].
[1] صحيح؛ رواه الإمام أحمد (23714)، وأبو داود (1488)، والترمذي (3556)، وابن ماجه (3865).
[2] صحيح؛ رواه الإمام أحمد (17970)، وأبو داود (4012)، والنسائي (407).
[3] صحيح؛ رواه الإمام أحمد (24058)، والبخاري (2639)، ومسلم (1433).
[4] حسنٌ؛ رواه الإمام أحمد (21788).
[5] صحيح؛ رواه الإمام أحمد (19823)، والبخاري (2651)، ومسلم (2535).
[6] صحيح؛ رواه الإمام أحمد (12028)، والبخاري (5470)، ومسلم (2144).
[7] انظر: العين (1/ 328).
[8] صحيح؛ رواه الإمام أحمد (21590)، وأبو داود (3660)، والترمذي (2656)، والنسائي بالكبرى (5816)، وابن ماجه (230).
[9] صحيح؛ رواه الدارمي (526).
[10] صحيح؛ رواه البخاري بالأدب المفرد (1314)، وابن ماجه (4184).
[11] حسنٌ؛ رواه الإمام أحمد (10512)، والترمذي (2009).
[12] رواه المروزي في تعظيم قدر الصلاة (490، 492)، وابن بطة في الإبانة الكبرى (925)، وأبو نعيم في صفة النفاق ونعت المنافقين (180)، والقضاعي في مسند الشهاب (154). ورجاله ثقات عدا أبا مرحوم؛ هو: عَبْد الرَّحِيمِ بن كَرْدَمٍ الْبَصْرِي؛ وهو: ابْنُ عَمِّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْنٍ الإمام. «قال أبو حاتم: هو مجهول. قال الذهبي: مجهول العدالة عنده، ما تبيّن له أنه حجّة». تاريخ الإسلام (4/ 438). قال ابن حجر: «فهذا شيخٌ ليس بواهٍ، وَلا هو مجهول الحال، وَلا هو بالثبت ويكنى أبا مرحوم». لسان الميزان (4/ 7). وذكره ابن حبان بالثقات، وقال: «كَانَ يخطئ». (7/ 133). والصواب فيه الإرسال والله أعلم، كما جاء: عن زيد بن أسلم، قال: قال النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «إِنَّ الْغَيْرَةَ مِنَ الْإِيمَانِ، وَإِنَّ الْبَذَاءَ مِنَ النِّفَاقِ». وَالْبَذَّاءُ: الدَّيُّوثُ. [مرسل] رواه معمر بن راشد بالجامع (19521)، والبيهقي بالسنن الكبرى (21023)، وبالشُّعَب (10308). وقيل لزيد بن أسلم: وما المذاء؟ قال: الذي لا يغار.
[13] شعب الإيمان (13/ 260) باختصار.
[14] صحيح؛ رواه الإمام أحمد (25029)، والبخاري (6395)، ومسلم (2165).
كلمات مفتاحية
الكاتب:

محمد فريد المشهدي
مدير معهد الأرقم للعلوم الشرعية في ماليزيا، وله عدد من المشاركات العلمية والتحقيقات.
مواضيع ذات صلة
((المعلومات والآراء المقدَّمة هي للكتّاب، ولا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع أو أسرة مركز تفسير))