المنهج القرآني في الاستدلال على وجود الله تعالى

المنهج القرآني في الاستدلال على وجود الله تعالى[1]
تعدّد الأسلوبُ الذي اتخذه القرآنُ الكريم في الاستدلال على وجود الله -سبحانه وتعالى- وعظيم قدرته وجليل حكمته، والقرآن الكريم قد جعل هذه الأدلة درجات تتناسب مع كافة مستويات خلق الله؛ فهناك الأدلة التي تقوم على المحسوس لتناسب المستويات الدنيا في التفكير لدى السذّج والعوام، وهناك الأدلة التي تقوم على المجردات والتي تتطلّب مستوى عاليًا من الفكر المنظّم، ثم هناك أدلة بين هذه وتلك، لتناسب مَن هم بين هؤلاء وأولئك.
وفي مقالنا هذا سوف نلمِح إلى شيء من المزايا التي امتاز بها المنهج الاستدلالي في القرآن الكريم على ما عداه من المناهج الأخرى التي اعتمد عليها المتكلّمون والفلاسفة وغيرهم من المفكرين الذين لم يَقْنَعوا بما ورد في القرآن من أدلة، ولم يسيروا على النحو القرآني، وإنما اخترعوا لأنفسهم مناهج، ووضعوا على أساسٍ منها أدلةً كثيرة ومتنوّعة، وسنوضح في هذه المقالة قصور هذه المناهج، وتهافت أدلتها التي بُنِيت عليها.
وابتداءً سوف نلمح إلى شيء من المزايا التي انفرد بها المنهج القرآني، في الاستدلال على وجود الله -سبحانه وتعالى- وعلى صفاته وأفعاله، ونقول: «إلى شيء من هذه المزايا»؛ لأنّ حصر المزايا القرآنية جميعها ليس يدخل تحت استطاعة بشر، فالقرآن الكريم دائمًا فيه الجديد، وهذا الجديد يتناول كلّ موضوعٍ يبحثه وكلّ مجالٍ يتطرّق إليه، ومن هنا كان ميدان الاجتهاد للتوصل إلى هذا الجديد مفتوحًا دائمًا أمام كلّ مسلم صادق النية، سليم الطوية، عنده قدر من الذكاء، وقدر أكبر من توفيق الله -سبحانه وتعالى-.
ومن الواضح أن كلّ ميزة نذكرها للمنهج القرآني، يوجد في مقابلها نقص في المناهج البشرية، وهذا النقص في المناهج البشرية هو الذي يوضح بجلاء ما في منهج القرآن من المزايا؛ ولذا فلعلّه من الأوفق أن نشير بجانب كلّ ميزة للمنهج الرباني إلى ما يقابلها من نقص في المنهج الإنساني.
على أنه ينبغي علينا أن ننبه إلى مرادنا هنا من استعمال لفظة (منهج) بجانب فعل الحقّ -سبحانه وتعالى- من حيث إنّ المراد بالمنهج هو مجموعة القواعد التي يتكوّن منها أسلوب معيّن يلتزمه الفاعل إزاء فعلٍ ما. وهذا أن يكون هو نفسه واضع تلك القواعد ومؤسّسها، أو واضع هذا المنهج، فالفاعل لا بد أن يخضع لقواعد المنهج وأن يتقيد به حتى لو كان هو واضعه، بل إن ذلك يجعله أكثر تقيُّدًا والتزامًا بتلك القواعد التي وضعها، فالمنهج -إذن- هو قيد يحدّ من حرية الفاعل، ويضعه في إطار من الجبر، ونحن لا نقصد هذا المعنى حين نتكلم عن فعل الحقّ -سبحانه وتعالى-؛ فالحقّ سبحانه منزّه عن الجبر، وله الإرادة التامة، والمشيئة المطلقة، ولكنا نقصد من كلمة (منهج) بجانب كلام الله سبحانه أن نتلمّس تلك الأسس التي امتاز بها القرآن الكريم في طريقته الاستدلالية، وأن نصوغ من هذه الأسس -بقدر ما نستطيع- منهجًا نتبعه نحن، إذا أردنا أن نقوم -في هذا المجال- بشيء يستحق الذِّكْر.
وأهم ما استطعنا أن نصل إليه من مميزات المنهج القرآني في الاستدلال ما يأتي:
أولًا: أن القرآن الكريم -كما أشرنا سابقًا- يوجّه أدلته إلى الناس أجمعين، بكلّ طوائفهم وفئاتهم، والقرآن الكريم يرعى تلك الفوارق الضرورية في الفهم والوعي والثقافة، وعامة جميع فوارق الإدراك، فيخاطب الجاهل الساذج بأدلة تتفق مع إدراكه، ويخاطب الذكي العالم بأدلة تتفق مع علمه وذكائه، ويخاطب الذين هم بين هؤلاء وأولئك من مستويات على قدر مستوياتهم.
وإلى جانب هذه الميزة للمنهج القرآني نرى ذلك النقص الواضح في المناهج البشرية، حيث يضع كلُّ فريق أدلتَه على صورة لا يمكن أن يفهمها غيرهم، فالفلاسفة يضعون أدلة لا يفهمها إلا الفلاسفة وكذلك المتكلمون، فالمفكر من هؤلاء كان يجهد نفسه في إقامة الدليل، وكان هذا الدليل يخرج صورة لنفسية صاحبه ونوع ثقافته.
ولقد أتى على هؤلاء المفكرين حينٌ من الدهر كانوا يضعون هذه الأدلة لا للتدليل على وجود الله تعالى وصفاته وأفعاله، ولكن لإظهار براعتهم وذكائهم ومدى تمكّنهم من فنونهم، وطبيعي أن هذه الأدلة -على هذه الصورة- هي عقيمة الإنتاج ضئيلة الفائدة، وأنّ دليلًا مشهورًا لدى المتكلمين، هو دليل الحدوث، لهو أعجز من أن يجعل كافرًا يؤمن، أو يزيد مؤمنًا إيمانًا، وأكثر منه عقمًا ما يسمى بدليل الإمكان، وعلى مثل ذلك في بقية الأدلة عند هؤلاء وأولئك.
ثانيًا: أن المنهج القرآني يقوم على إقناع الإنسان بجانبيه الوجداني والعقلاني، فالإنسان -كما هو معروف- مركَّب من جانبين؛ جانب وجداني، وجانب عقلاني. وكلّ من هذين الجانبين له أسلوبه الذي يعالَج به، فليس يُقنِع الجانب الوجداني ما يُقنِع الجانب العقلاني، والعكس صحيح. وحين نقتصر في محاولاتنا إقناع الإنسان بقضيةٍ ما على مخاطبة جانب واحد فإنّ تلك المحاولات تفشل يقينًا، ولا تؤتي ثمارها المرجوّة، وقصارى ما نصل إليه في تلك الحال هو أن نخلق نوعًا من الشك والحيرة لدى الإنسان، ولكنا -أبدًا- لن نصل إلى مرتبة الإقناع؛ لأنّ الوصول إلى تلك المرتبة رهنٌ بتضافر الوجدان والعقل جميعًا.
إذا عرفنا ذلك، استطعنا أن نضع أيدينا على العلّة ومكمن الداء في تلك الحال المحيّرة، حين نرى دليلًا من الأدلة وقد صيغ على درجة كبيرة من الدقّة والصياغة المنطقية، ولا نكاد نضع أيدينا على خلل منطقي فيه، ولكنا -رغم ذلك- نجده عديم الثمرة، عقيم الإنتاج، لا يشعرك بشيء من اليقين فيما سيق من أجله، ولا تحسّ بأنه يفرض عليك شيئًا أو يلزمك بشيء، وما ذلك إلا لأنه أهمل جانبًا مهمًّا من جانبَي شخصية الإنسان.
وإنك حين تدرك أن الدِّين في كلّ قضاياه يعتمد على الجانب الوجداني أكثر من اعتماده على الجانب العقلاني، فإنك تدرك أن الأدلة التي صيغت بأسلوب عقلي محض لم تفقد الجانب المهم فحسب، بل فقدت الجانب الأهم، حين عَرَت عن كلّ ما يخاطب الوجدان ويأسره.
وعلى هذا النقص الواضح والقصور الذي لا يخفى سارت كلّ أدلة المتكلمين والفلاسفة؛ ولذا لم نحس أبدًا أن هذه الأدلة قد جعلت الكافر يؤمن أو زادت المؤمن إيمانًا، بل لعلّ ضررها كان أوضح حين يقرؤها من لا يتعمق في دين الله، فيتوهم أن هذا الدين إنما يقوم على أساس من هذه القواعد التي لا تحرك فيه شعورًا ولا وجدانًا، فيحسّ بنوع من خيبة الأمل، وربما شعر بدبيب الشك يراود نفسه المؤمنة.
وعلى العكس من ذلك كانت أدلة القرآن الكريم، فهي أدلة عقلية في المستوى الأسمى من حيث الدقة والإصابة، ولكنها لم تأتِ في تلك الصورة الجامدة التي تأنفها الفطرة، وينفر منها الطبع، وإنما سيقت هذه الأدلة في جوّ وجداني يأسر القلب، ويستأثر بالوجدان، ويهزّ المشاعر، ويستجيش العواطف والأحاسيس، فهي إذن أدلة تخاطب الإنسان بكلّ نواحيه؛ تخاطب العقل بلغته، والوجدان بلغته. ولعلّ هذا سرّ من أسرار الإبداع القرآني، واقرأ في ذلك -على سبيل المثال- قوله تعالى من أول سورة الرعد:
{المر تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ * اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ * وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ}... الآيات إلى قوله تعالى: {كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ}[الرعد: 1-17].
ثالثًا: أن الأدلة القرآنية تعتمد على الأمور الموضوعية الواقعية التي يتعامل معها الإنسان في كلّ وقت، مثل قوله تعالى: {وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ}[الذاريات: 21]، وقوله سبحانه: {فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ * أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا * ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا * فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا * وَعِنَبًا وَقَضْبًا * وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا * وَحَدَائِقَ غُلْبًا * وَفَاكِهَةً وَأَبًّا * مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ}[عبس: 24-32].
وهذا من شأنه أن يقرّب الدليل، وييسّر إدراكه، ويمهّد النفس لتقبله، ويقوي الالتزام به، وفي نفس الوقت يقطع السبيل على المجادلين المعاندين، فلا يتيح لهم سبيلًا إلى جحده أو الطعن فيه.
هذا بخلاف أدلة الفلاسفة والمتكلمين التي تعتمد على أسس نظرية، أو تحتوي على بعض الأمور الموضوعية لكنها لا تدرك بسهولة، ولا يمكن التسليم بها بيُسْر. وعلى سبيل المثال: دليل الإمكان، يعتمد على تقسيمات منطقية محضة، تفتح المجال أمام الجدل واللجاج، وكذلك دليل الحدوث يعتمد في بعض جوانبه على أمور موضوعية، ولكنها مصوغة صياغة منطقية نظرية تجعل إدراكها صعب المنال على المتخصصين، فضلًا عن غيرهم، بالإضافة إلى أن كلّ مقدمة من مقدمات الدليل تحتاج إلى دليل، والدليل إلى دليل وهكذا، ووسط ركام الأدلة، وأدلة الأدلة، تصاب النفس بالسأم والملل، وتنصرف عن مقصودها الأصلي.
رابعًا: أن الأدلة القرآنية تعتمد على ما ركزه اللهُ سبحانه في الفطرة الإنسانية من السعي إلى معرفته، والدينونة له؛ ولذا فإن القرآن الكريم لا يسوق الأدلة على وجود الله سبحانه بشكل مباشر، ولكنه يعتمد على البذرة المغروسة في فطرة الإنسان، فهو يغذيها وينميها ويوجه الخطاب إليها، ومن هنا نجد أن أدلة القرآن الكريم تقوم على لفت الأنظار إلى قدرة الله سبحانه، وعظيم إبداعه، وجليل حكمته في صنعه، وجزيل نعمه على خلقه، والذي يقرأ حديث القرآن عن وجود الله سبحانه لا يكاد يستشف منه أنه حديث إلى مُنْكِرٍ لوجود الله تعالى بقدر ما يشعر بأنه حديث إلى غافلٍ عن هذا الوجود، فكأنّ الاعتراف واقع، ولكن الداء في الغفلة عما يجب لهذا الموجود.
وحديث القرآن الكريم بهذه الكيفية يلفت انتباه الإنسان إلى فطرته التي لوّثها وانحرف بها الوسواس الخناس، ويمهّد الطريق لعودة الإنسان إلى ربه، وذلك بإشعاره أنه ليس من شأنه أن يكون منكرًا بل غافلًا، واقرأ -على سبيل المثال بالإضافة إلى الآيات السابقة- قول الله تعالى من سورة يونس:
{قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ * فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ}[يونس: 31، 32].
خامسًا: أن القرآن الكريم لا يسوق الدليل على صورة عامة مجملة، ولكنه يسوق الأدلة على هيئة جزئية مفصّلة؛ وبذلك يغني عن التفصيل بعد ذلك، وما يحتويه التفصيل من تفريعات قد تلفت النفس عن الهدف الأصلي، فضلًا عن أن الأمور الجزئية تدركها النفس بسهولة ويُسر، واقرأ في ذلك -إضافة إلى ما سبق- قوله سبحانه وتعالى:
{هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ * يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ * وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ}... إلى قوله تعالى: {وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ}[النحل: 10-18].
وذلك عكس الأدلة الوضعية، فهي تقوم على التعميم، ثم تنتقل إلى التفصيل، ويحتاج التفصيل إلى تفصيل، وهذا من شأنه أن ينفّر النفس ويجعلها تشعر بالملل والسأم، ويصرفها عن الهدف المنشود.
سادسًا: أن القرآن الكريم ينوّع من الأدلة التي يذكرها في المجال الواحد؛ فأنت تستطيع في أيّ مجال يتحدّث فيه القرآن عن عظيم صنع الله سبحانه أن تجد مجموعة من الأدلة المنسقة المرتبة ترتيبًا بديعًا، بحيث لا تقف من بديع صنع الله سبحانه على مثال واحد بل أمثلة كثيرة متعددة ومتنوعة، فأنت تجد نفسك محاصَرًا بهذه الأدلة التي تأخذ بلُبّك، وتأسر فؤادك، ولا تدعك إلّا وقد أسلمت نفسك للعليم الحكيم. واقرأ في ذلك -بالإضافة إلى كل الآيات السابقة- قوله تبارك وتعالى:
{وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ * وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ * وَمِنْ آَيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ * وَمِنْ آَيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ}... إلى قوله تعالى: {وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ}[الروم: 20-27].
وبعدُ، فهذه بعض الميزات التي استطعنا أن نلمح إليها من ميزات المنهج القرآني في حديثه عن وجود الله -سبحانه وتعالى- وصفاته وأفعاله.
ونؤكّد أخيرًا ما أشرنا إليه ابتداءً من أننا لا نستطيع أن نحيط بتلك الميزات، وحسبنا أن نلفت النظر إلى شيء منها على قدر الجهد والطاقة، فهو حديث العليم الحكيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد.
[1] نشرت هذه المقالة في مجلة «كلية أصول الدين والدعوة الإسلامية» بالمنوفية - جامعة الأزهر، المجلد 1، العدد 1، عام 1981م، ص106.
ويلاحظ أن المقالة لم تحرر المنهج القرآني في الاستدلال على وجود الله من حيث هو بقدر ما حاولت بيان مسالك عرض هذا الاستدلال ومزاياه، كما أن نقدها لمناهج المتكلمين والفلاسفة في الاستدلال على وجود الله مما يحتاج لبحث. (موقع تفسير).
مواد تهمك
-
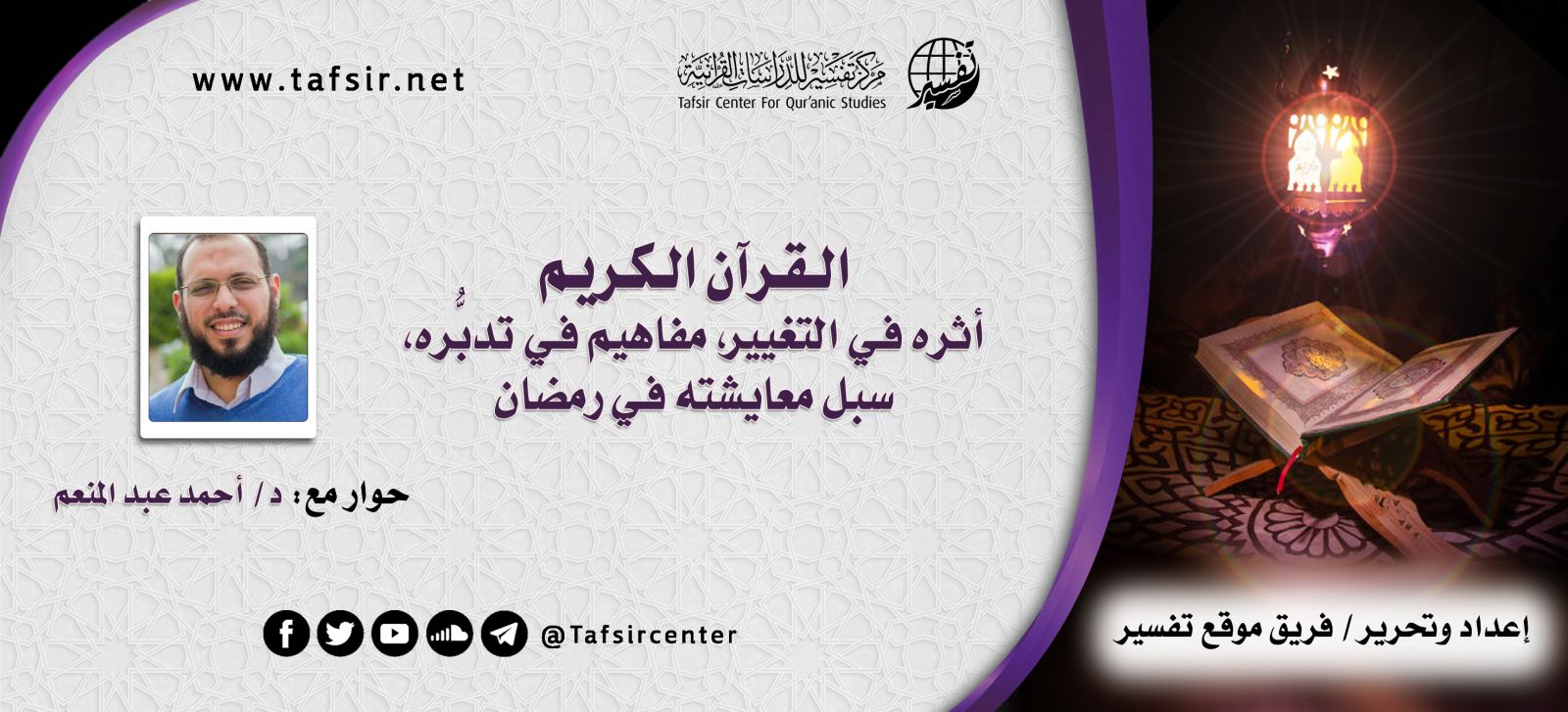 القرآن الكريم: أثره في التغيير، مفاهيم في تدبُّره، سبل معايشته في رمضان
القرآن الكريم: أثره في التغيير، مفاهيم في تدبُّره، سبل معايشته في رمضان -
 تدارس القرآن الكريم (مفهومه – أهميته - آليات تطبيقه)
تدارس القرآن الكريم (مفهومه – أهميته - آليات تطبيقه) -
 قراءة القرآن من منظور طه عبد الرحمن؛ عرض وتحليل (3-4)
قراءة القرآن من منظور طه عبد الرحمن؛ عرض وتحليل (3-4) -
 نظرات في موقف حسن حنفي من القرآن الكريم
نظرات في موقف حسن حنفي من القرآن الكريم -
 التعريف بكتاب "القرآن الكريم بين ترتيب المصحف وترتيب النزول دراسة منهجية نقدية في الترتيب المصحفي والتاريخي للقرآن"
التعريف بكتاب "القرآن الكريم بين ترتيب المصحف وترتيب النزول دراسة منهجية نقدية في الترتيب المصحفي والتاريخي للقرآن"


