الإيمان وثمراته القلبية
نظرات من وحي القرآن

إنّ نعمة الإيمان بالله سبحانه هي جنة الدنيا، وطوق النجاة الذي يحتمي به العبد أمام أمواج الشهوات والشبهات والفتن العاتية، وهو دواء القلوب الذي متى غفل عنه الإنسان لهثًا وراء حطام الدنيا الفانية ضاق عيشُه ومرض قلبُه؛ وإنك لَترى كثرة الشكاوى والهموم والغموم والقلق والاضطراب في دنيا الناس، فترى فيه آثارًا للابتعاد عن الإيمان بالله -عز وجل- والإعراض عن دينه وشرعه؛ فقد قال تعالى: {وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا}[طه: 124].
يقول الإمام ابن كثير -رحمه الله-: «{وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي} أي: خالَف أمري، وما أنزلتُه على رسولي، أعرض عنه وتناساه وأخذ من غيره هداه؛ {فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا} أي: في الدنيا، فلا طمأنينة له، ولا انشراح لصدره، بل صدره ضيّق حرج لضلاله، وإنْ تنعَّم ظاهره، ولَبِسَ ما شاء وأكَل ما شاء، وسكَن حيث شاء، فإنّ قلبه ما لم يخلص إلى اليقين والهدى، فهو في قلق وحيرة وشكّ»[1].
والإنسان في حاجة ماسّة إلى غذاء روحه ودواء قلبه في كلِّ وقت وحين، وتتأكّد هذه الحاجة مع طغيان الجوانب المادية على الجوانب الروحية، وذلك لا يكون إلا بتحقيق الإيمان، ومن هنا كان تحقيق الإيمان هو الحلّ الأكيد لإنقاذ البشرية من طريق الشقاء والاضطراب والتيه والحيرة والخوف والحزن إلى طريق السعادة والهداية والطمأنينة والأمن.
يقول الدكتور مجدي الهلالي: «ستظلّ نقطة البداية للخروج من هذا التيه هي: الإيمان، الإيمان أوّلًا، وكلما زاد الإيمان في القلب تحسّنَت أحواله وانتقل من المرض إلى الصحة، وانعكس ذلك على علاقته بربه، وازداد تعلّقه به، ومن ثمَّ اقترب من تحقيق الحنيفيّة ومعها الأمن والطمأنينة، قال تعالى: {الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ}[الأنعام: 82][2].
وتحقيق الإيمان وتعلُّمه من أوجب الواجبات على المكلَّف، فقد قال اللهُ تعالى لرسوله -صلى الله عليه وسلم-: {فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ}[محمد: 19].
يقول الشيخ السعدي -رحمه الله- مبيّنًا معنى العلم المراد في الآية وكيفية تحصيله: «العلم الذي أمر اللهُ به -وهو العلم بتوحيد الله- فرضُ عينٍ على كلّ إنسان، لا يسقط عن أحد، كائنًا مَن كان، بل كلٌّ مضطر إلى ذلك، والطريق إلى العلم بأنه لا إله إلا هو أمور؛ أحدها بل أعظمها: تدبّر أسمائه وصفاته، وأفعاله الدالّة على كماله وعظمته وجلالته؛ فإنها توجِبُ بذل الجهد في التألُّه له، والتعبُّد للربّ الكامل الذي له كلّ حمْدٍ ومجْدٍ وجلالٍ وجمالٍ. الثاني: العلم بأنه تعالى المنفرد بالخلق والتدبير، فيعلم بذلك أنه المنفرد بالألوهية. الثالث: العلم بأنه المنفرد بالنعم الظاهرة والباطنة، الدينية والدنيوية، فإن ذلك يوجب تعلّق القلب به ومحبته، والتألّه له وحده لا شريك له...»[3].
فمَن حقّق هذه الغاية كان حقًّا على الله أن يسعده في الدنيا والآخرة، ومن لم يحقّق هذه الغاية فلا قيمة له عند الله سبحانه، قال تعالى: {قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ}[الفرقان: 77]، قال ابن عباس: لولا دعاؤكم: لولا إيمانكم[4].
من ثمرات الإيمان في القلب:
فبمجرد أن تثبت شجرة الإيمان في قلب العبد إلّا وعادت عليه بكلِّ خيرٍ عاجلٍ وآجلٍ في الدنيا والآخرة، ولمَ لا وهي شجرة مباركة أصلها ثابت وفرعها في السماء.
وفيما يلي نقف -أيها القارئ الكريم- على بعض ثمرات الإيمان في القلب خاصةً؛ لشدّة حاجتنا لمعرفة هذه الثمرات والسعي في تحصيلها، لعظم آثارها وانعكاساتها على الحياة وخطورة افتقادها كما سنبيّن، ونتعرّف على حال قلب العبد المؤمن متى حقَّق الإيمان كما أمره اللهُ -عز وجل- من خلال آيات القرآن الكريم.
أولًا: هداية القلب إلى الرضا بقضاء الله وقدَره والصبر عليه:
فإنّ الحياة الدنيا لا تخلو من الابتلاءات والمنغّصات في النفس والأهل والمال، فقد قال تعالى: {لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ}[البلد: 4]، وقال سبحانه: {وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ}[البقرة: 155].
والناس في تلقّي هذه الابتلاءات والمنغّصات مختلفون؛ فمنهم الهَلوع الجَزوع، وهذا حال أكثر الناس، كما قال تعالى: {إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا * إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا}[المعارج: 19، 20].
ومنهم المؤمن الذي يدرك أن كلَّ بلاء ينزل بقضاء الله وقدَره وبعلمه وبمشيئته وبمقتضى حكمته؛ فيهدأ قلبُه وتسكن نفسه عند نزول المصائب؛ لأنه حقّق الإيمان وقام بما يجب عليه من لوازمه كالصبر والتسليم والرضا والاحتساب، فقد قال تعالى: {مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ}[التغابن: 11].
وهذه الآية من أعظم الآيات التي تصوّر لنا أثر الإيمان وثمراته في حياة العبد عند نزول البلاء، حيث إنّ الإيمان يعصم صاحبَه من السخط وقت الابتلاءات؛ لعلمه بأنها بقضاء الله وقدَره، وأنها لا تخرج عن حكمته سبحانه.
ثانيًا: هداية القلب للتوكل على الله:
فالتوكل هو صدق اعتماد القلب على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع الأخذ بالأسباب، وهو من علامات صدق الإيمان، فعلى حسب إيمان العبد يكون توكّله على الله سبحانه، قال الله تعالى: {قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ}[التوبة: 51].
يقول الشيخ السعدي: {وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ}، أي: «يعتمدوا عليه في جلب مصالحهم ودفع المضار عنهم، ويثقوا به في تحصيل مطلوبهم، فلا خاب مَن توكل عليه، وأمّا من توكل على غيره فإنه مخذول غير مدرك لِمَا أمّل»[5].
فإذا حقّق العبدُ التوكلَ على الله اطمأنّ قلبه، وارتاحت نفسه؛ لأنه يأوي إلى ركن شديد، ويفوِّض أمره ويعتمد بقلبه على مَن بيده ملكوت السماوات والأرض، وعلى من لا يعجزه شيء، قال تعالى: {وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا}[الطلاق: 3].
ثالثًا: هداية القلب للحياة الطيبة:
فكلُّ الناس يبحث عن الحياة الطيبة، ولكن القليل من يعرف الطريق إليها، فكم من إنسان بذل حشاشة نفسه، وضيَّع زهرة عمره، وأغلى سِنيّ حياته من أجلِ تحقيق السعادة فلم يدركها؛ لأنه إنما ضلّ الطريق إليها، وظنّ أن السعادة في جمعِ الأموال وإشباعِ لذّات الأبدان.
لكن الطريق الصحيح لإدراك الحياة الطيبة لن يكون إلا بتحقق الإيمان بالله سبحانه، فقد قال الله تعالى: {مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ}[النحل: 97].
يقول الشيخ السعدي -رحمه الله- في تفسير قوله: {فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً}: «وذلك بطمأنينة قلبه وسكون نفسه، وعدم التفاته لما يشوِّش عليه قلبه، ويرزقه اللهُ رزقًا حلالًا طيّـبًا من حيث لا يحتسب»[6].
ويقول الدكتور مجدي الهلالي: كلّما حافظ المرءُ على الإيمان بالله ولوازمه عاشَ حياة طيبة؛ لانسجام ذلك مع فطرته التي فطره اللهُ عليها، وكلّما ابتعد عنه كانت الوحشة والضيق والقلق بقدر هذا الابتعاد[7].
وهذا ما يشهد له الواقع فكم من غنيٍّ ضاقت به الدنيا بما رحبت؛ لأنه فقيرٌ إلى الإيمان، وكم من فقيرٍ معدَمٍ قد ملَك الدنيا في قلبه؛ لأن حياته عامرة بالإيمان والعمل الصالح.
رابعًا: شعور القلب بالأمن والهداية في الدنيا والآخرة:
فمِن ثمرات الإيمان الشعور بالأمن والأمان، هذا الشعور الذي لا يقدّر بثمن، فمَن فقَدَ الإيمان فقدَ نعمة الأمن والأمان فيستوحش قلبُه من كلِّ شيء، ويستوحش منه كلُّ شيء، فلا أمان ولا طمأنينة بل خوف وقلق وتوتّر، هذا حاله في الدنيا؛ وأمّا في الآخرة فالأمر أعظم والخَطْب أجلُّ، إنه يوم الفزع الأكبر ولا أمان وقتئذ إلا لأهل الإيمان، فقد قال الله تعالى: {الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ}[الأنعام: 82].
يقول ابن كثير في تفسير هذه الآية: «أي: هؤلاء الذين أخلصوا العبادة لله وحده لا شريك له، ولم يشركوا به شيئًا هم الآمنون يوم القيامة، المهتدون في الدنيا والآخرة»[8].
خامسًا: انتفاع القلب بالمواعظ والتذكير:
إنّ القلوب العامرة بالإيمان قلوبٌ حيّة، تتأثّر بالمواعظ وتنزجر وتعتبر بالتذكير، أمّا قلوب غير المؤمنين قلوب قاسية ميتة لا يؤثر فيها شيء، فقد قال الله تعالى عن القرآن: {إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ * لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ}[يس: 69، 70].
يقول الإمام ابن كثير: «أي: لينذر هذا القرآنُ البيِّنُ كلَّ حيّ على وجه الأرض، وإنما ينتفع بنذارته مَن هو حيّ القلب، مستنير البصيرة»[9].
وكذلك أخبر سبحانه -عندما أمَر نبيّه بالتبليغ والتذكير- أنّ الذكرى إنما تنفع المؤمنين، فقال تعالى: {وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ}[الذاريات: 55].
يقول الشيخ السعدي: «وأخبر اللهُ أنّ الذكرى تنفع المؤمنين؛ لأن ما معهم من الإيمان والخشية والإنابة، واتّباع رضوان الله، يوجِبُ لهم أن تنفع فيهم الذكرى، وتقع الموعظة منهم موقعها، كما قال تعالى: {فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى * سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى * وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى}[الأعلى: 9-11]، وأمّا من ليس له معه إيمان ولا استعداد لقبول التذكير فهذا لا ينفع تذكيره، بمنزلة الأرض السبخة التي لا يفيدها المطر شيئًا، وهؤلاء الصنف لو جاءتهم كلّ آية لم يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم»[10].
سادسًا: امتلاء القلب بحُسن الظنّ بالله تعالى:
إنّ حُسن الظنّ بالله من أعظم ثمرات الإيمان، فإنّ العبد إذا حقّق الإيمان بالله وتعرَّف على أسمائه وصفاته هداه ذلك لحسن الظنّ به، فلا يقنط من رحمته، ولا ييأس من تأييده ونصرته حتى في أصعب المواقف، وهذا ما جسّده لنا النبيّ -صلى الله عليه وسلم- عندما كان في الغار مع صاحبه أبي بكر، وقد وقف الكفار أمام فتحة الغار، فخاف أبو بكر على النبي -صلى الله عليه وسلم-، فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم-: «ما ظنُّك يا أبا بكرٍ باثنين اللهُ ثالثُهما»[11].
كما ذكر اللهُ تعالى في كتابه العزيز: {إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا}[التوبة: 40].
وذكَر القرآنُ لنا كذلك موقفًا مشابهًا لموسى -عليه السلام- عندما لحقه فرعونُ وجنودُه عند البحر، فـيَـئِس بعضُ ضعاف الإيمان وتيقّنوا من الهلاك، ولكن موسى -عليه السلام- كان محسنًا للظنّ في الله موقنًا بوعده سبحانه إلى النهاية، فقد قال تعالى في ذلك: {فَلَمَّا تَرَاءَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ * قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ}[الشعراء: 61، 62].
هكذا يتجلى الإيمان ويظهر أثرُه في حسن الظنّ في الله في مثل هذه المواقف الصعبة. أمّا سوء الظنّ بالله فمن صفات المنافقين والكافرين الذين توعّدهم اللهُ بالعذاب، فقال تعالى: {وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا}[الفتح: 6].
سابعًا: هداية القلب عند الموت فلا يشعر بخوف ولا بحزن:
فالإنسان عند معاينة الموت تتجاذبه مشاعرُ الخوف والحزن، فالخوف يكون مما هو مُقْدِم عليه من أمور الآخرة، والحزن يكون على ما سيفوته من الدنيا، وهذا من فعلِ الشيطان، أمّا العبد المؤمن الذي استقام على مراد الله وحقّق مقتضيات الإيمان فتنزل عليه الملائكة بالطمأنينة والبِشْر، فلا يحزن على ما فات ولا يخاف مما هو آت، قال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ}[فصلت: 30].
يقول ابن عاشور -رحمه الله-: «وهو تنزُّلٌ خفيٌّ يُعرَف بحصول آثاره في نفوس المؤمنين، ويكون الخطاب بــ{أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا} بمعنى إلقائهم في رُوعهم عكس وسوسة الشياطين القرناء بالتزيين، أي: يُلْقُون في أنفُس المؤمنين ما يصرفهم عن الخوف والحزن ويذكِّرهم بالجنة، فتحلّ فيهم السكينة فتنشرح صدورهم بالثقة بحلولها»[12].
وقيل أيضًا: إن الملائكة تتنزل عليهم يوم القيامة لتبشيرهم، كما قال تعالى: {لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ}[الأنبياء: 103].
وفي الختام: هكذا تعرّفنا -أيها القارئ الكريم- على بعض ثمرات الإيمان في القلب، وإلّا فثمرات الإيمان أكثر من أن تُحْصَى، فهي متعدّدة ومتنوّعة، وتشمل جوانب الدنيا والآخرة؛ لذلك ينبغي على المسلم أن يحافظ على شجرة الإيمان الثابتة في قلبه، وأن يحرص على رعايتها وتعهُّدِها بالأعمال الصالحات التي تزيد من ثباتها ورسوخها حتى يلقى الله بها، فيكون بذلك قد حقّق السعادة في الدنيا والآخرة، مصداقًا لقوله تعالى: {أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ}[الجاثية: 21].
نسألُ اللهَ سبحانه أن يحيينا على الإيمان، وأن يميتنا عليه، وأن يبعثنا في زمرة المؤمنين، وصلِّ اللهم وسلِّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
[1] تفسير القرآن العظيم، لابن كثير (5/ 323).
[2] انظر: الإيمان أوّلًا، لمجدي الهلالي (ص4).
[3] تيسير الكريم الرحمن، للسعدي (ص787).
[4] تفسير القرآن العظيم، لابن كثير (6/ 134).
[5] تيسير الكريم الرحمن، للسعدي (ص339).
[6] تيسير الكريم الرحمن، للسعدي (ص449).
[7] انظر: الإيمان أوّلًا، لمجدي الهلالي (ص4).
[8] تفسير القرآن العظيم، لابن كثير (3/ 294).
[9] تفسير القرآن العظيم، لابن كثير (6/ 592).
[10] تيسير الكريم الرحمن، للسعدي (ص812).
[11] متفق عليه.
[12] التحرير والتنوير، لابن عاشور (24/ 284).


 أحوال المؤمن وقت نزول البلاء؛ نظرات من وحي القرآن
أحوال المؤمن وقت نزول البلاء؛ نظرات من وحي القرآن نحو خطاب دعوي متّزن في الأزمات
نحو خطاب دعوي متّزن في الأزمات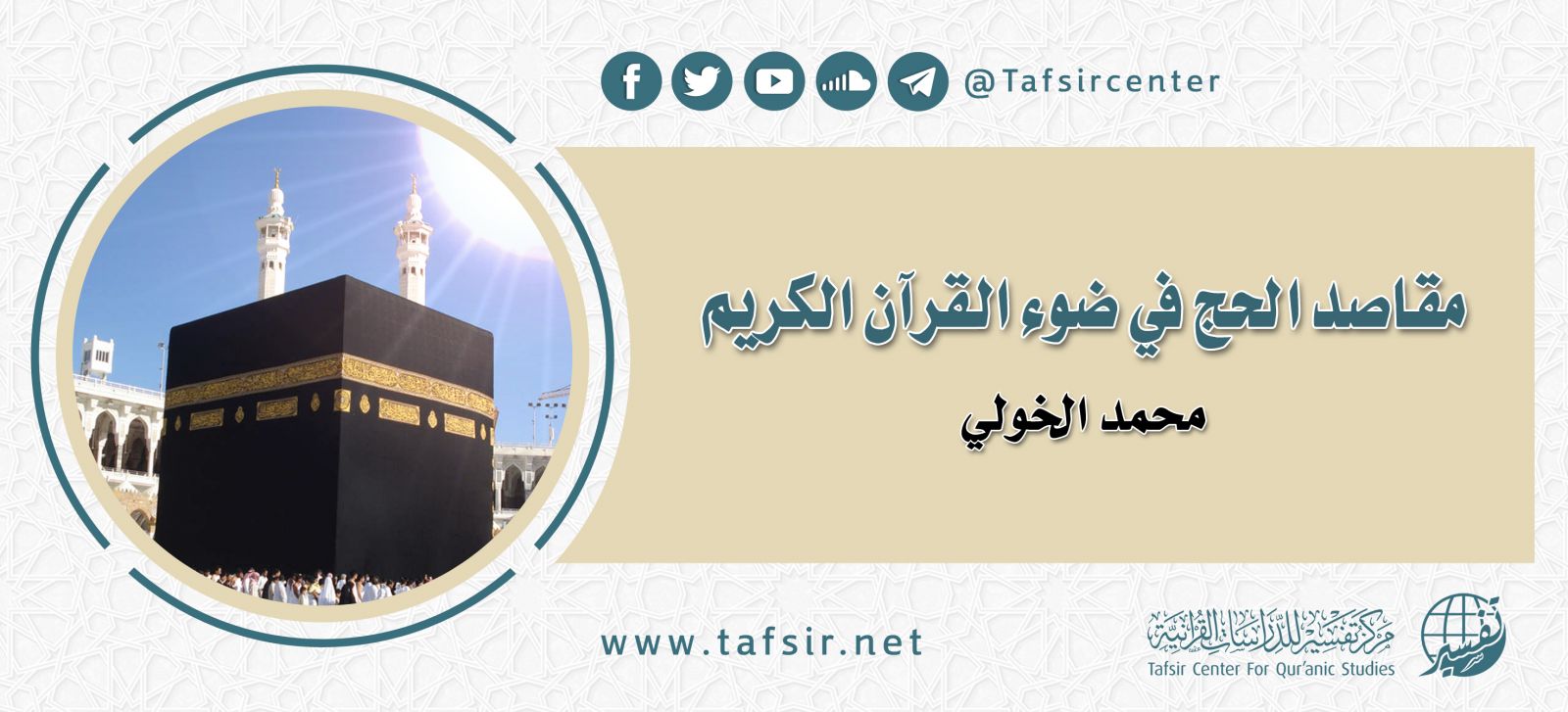 مقاصد الحج في ضوء القرآن الكريم
مقاصد الحج في ضوء القرآن الكريم ثنائيات الوقاية الأُسريّة في ظلال الآية السادسة من سورة التحريم
ثنائيات الوقاية الأُسريّة في ظلال الآية السادسة من سورة التحريم حكمة الله في إنزال البلاء وأسباب دفعه في القرآن الكريم
حكمة الله في إنزال البلاء وأسباب دفعه في القرآن الكريم فانظر إلى آثار رحمة الله
فانظر إلى آثار رحمة الله