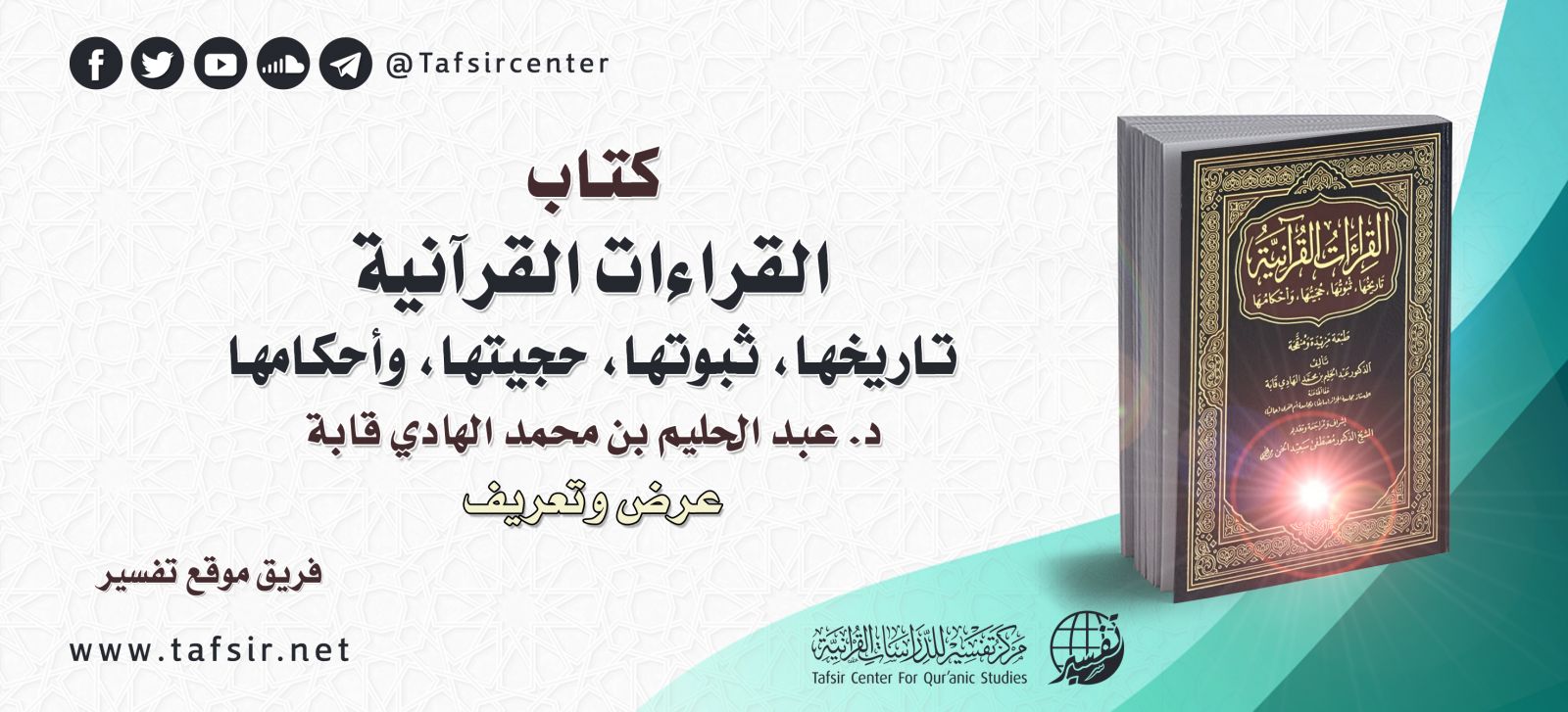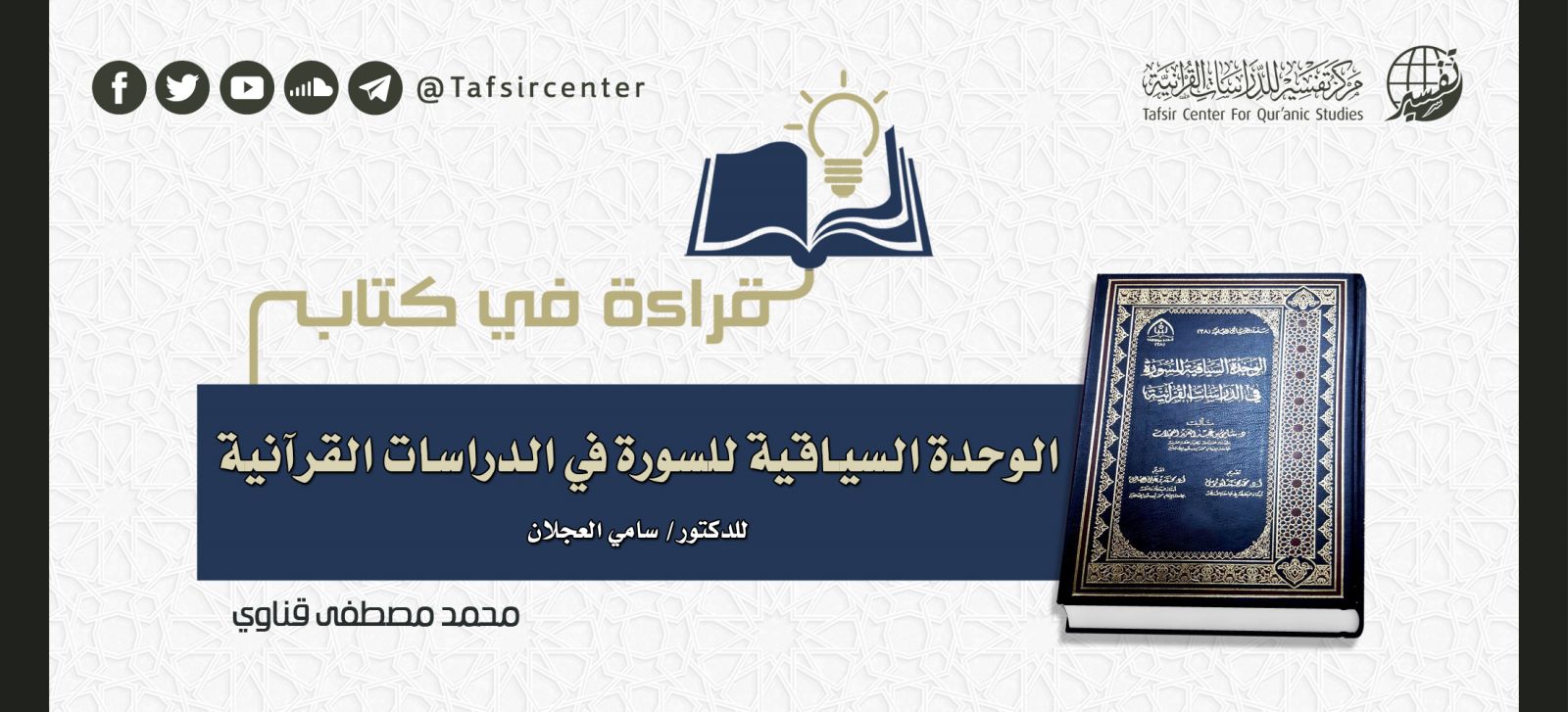دلالات الألفاظ القرآنية؛ أنواعها، وقيمتها، وكيفية الوقوف عليها (1-3)
دلالات الألفاظ القرآنية؛ أنواعها، وقيمتها، وكيفية الوقوف عليها (1-3)
الكاتب: عبد الحميد هنداوي

تتعدّد دلالات الألفاظ والتراكيب بحسب المستوى اللغوي الذي يُنظر إليها من خلاله؛ فقد يُنظر إليها من خلال المستوى الصوتي أو المعجمي أو الصرفي أو النحوي أو البياني.
وهذه الدلالات قد صار لها أثرٌ كبيرٌ في تصوّر المعاني الكلية للألفاظ والتراكيب، لا سيَّما مع بروز منهج الأسلوبية وبدء تطبيقه من قِبَل بعض الدارسين.
ويلاحظ أن كتب التفسير تتفاوت في العناية بهذه الدلالات ما بين إشارات سريعة لدى القدماء إلى دراسات متأنية في الآونة الأخيرة؛ بفضل التأثّر بالمنهج الأسلوبي الوافد الذي يعدُّ -في الحقيقة- أثرًا من آثار إشارات أسلافنا القُدامَى في هذا المجال.
وترجع أهمية هذه المقالات إلى أن كثيرًا من الناس لا يَعرف من دلالات ألفاظ القرآن إلّا نوعًا واحدًا؛ ولذلك تراه لا يَسأل عن غيره؛ وذلك لجهله أن للألفاظ دلالات شتى: منها ما يرجع إلى المعجم، وهو المعنى المعجمي، وهو ما يسأل عنه عامة الناس ولا يسألون عن غيره، ومنه ما يرجع إلى الأصوات من دلالة صوتية، وهو ما يوحي به الصوت من معنى يشارك به دلالته المعجمية، ومنه ما يرجع إلى الصرف، وهو الدلالة الصرفية للصِّيَغ والأبنية الصرفية، حيث تدلّ على معانٍ متعددة؛ كالفاعلية والمفعولية والمرّة والهيئة والمبالغة والطلب والمطاوعة، ومنه الدلالة النحوية، وهي دلالة الموقع النحوي، وهو ما يفيده الإعراب، والدلالة التصويرية البيانية، وهذه قد اهتمّ بالكشف عنها المفسِّرون البيانيُّون.
وهذه سلسلة من المقالات ستقوم -بمشيئة الله- بعرضِ هذه الدلالات وتتوسّع في إبرازها؛ بغية بيان أهميتها في ذاتها وفَتْح الباب لتأملها في الواقع التفسيري، وبيان تطبيقاتها لدى المفسرين وبيان مقدار اعتنائهم بها، وكذلك أثرها في إثراء المعنى التفسيري.
وسوف نبدأ هذه السلسلة بهذا المقال الذي يهدف إلى الكشف عن الدلالة الصرفية للكلمة[1]؛ كدلالة كونها اسمَ فاعل، أو فعلًا مضارعًا أو غير ذلك؛ ليبين قيمة هذه الدلالة وأهميتها في إثراء المعنى التفسيري، ومدى التفات المفسرين إليها قديمًا وحديثًا.
قيمة الدلالة الصرفية:
من خصائص العربية التي عدَّها العلماء لها ما تمتاز به من اتساع الأبنية، وكثرة الصيغ التي تستوعب المعاني التي يمكن أن تجيش بها نفسُ إنسانٍ في وقت من الأوقات، ولمّا كان التصريف هو سبيل الوصول إلى تلك الصيغ فقد قالوا: «أمّا التصريف فإن مَن فاتَهُ عِلمه فاتَهُ المعظم»[2].
ويعلّل ابن فارس لتلك المقولة بأمثلة كثيرة تكشف عن فائدة التصريف في التمييز بين المعاني التي تتحول بتصريف صيغها من الضدّ إلى الضدّ: «يقال: القاسِط للجائر، والمقسِط للعادل؛ فتحوّل المعنى بالتصريف من الجَور إلى العدل...»[3].
وثمّة قصة وقعت لعمرو بن عبيد المعتزلي مع أبي عمرو بن العلاء تكشف عن التفات علماء اللغة القُدَامَى لخطورة أمر الصيغ، والخلط بين بعضها وعدم التفريق الدقيق بين دلالاتها؛ فقد أشارت المصادر إلى وفود أبي عثمان عمرو بن عبيد المعتزلي على أبي عمرو بن العلاء يسأله قائلًا: «يا أبا عمرو: أيُخلِف الله وَعْده؟ قال أبو عمرو: لا. قال عمرو: أفرأيت مَن وَعَده الله على عملٍ عقابًا، أيخلف الله وَعْده؟ فقال أبو عمرو: من العجمة أتيت أبا عثمان؛ إنّ الوعد غير الوعيد...»[4].
فعمرو بن عبيد -إن صحّت الرواية- قد أخطأ هنا التفريق بين الصيغتين: فالوَعْد مصدر (وَعَدَ)، أما الوعيد فهو مصدر (أَوْعَدَ)؛ فالصيغة الأولى مصدر ثلاثي، والثانية صيغة مصدر رباعي.
والخلط بين الصيغتين ومصدريهما قد أدَّى إلى الانتقال من الضدّ إلى الضدّ، وهذا المعنى الضدِّي هو ما يستفاد من المعنى الصِّيَغيّ للكلمة، وفي اللغة نظائر كثيرة تنقل الصيغة فيها الكلمة من الضدّ إلى الضدّ كما في (قَسَط) و(أقسَط)، و(حنث) و(تحنَّث)، و(أثم) و(تأثَّم)...إلخ، مع اختلاف أنواع الصيغ الممثل بها.
وهذا كلّه يدلنا على خطورة أمر الصيغ؛ إِذْ إنّ الخطأ فيها يحوّل المعنى من الضدّ إلى الضدّ.
فضلًا عن أن الصيغ لا تكلِّفنا مادة جديدة، بل يأتي المعنى الوظيفي للصيغة محمولًا على المادة متراكبًا مع الدلالة المعجمية أو اللفظية على حدّ تعبير ابن جنِّي، وذلك عن طريق صورة اللفظ التي تتلبس به لتعطي للكلمة صيغتها، ومِن ثَم معناها الوظيفي. فضلًا عن أن المعاني الوظيفية ذاتها تتعدّد وتتراكب للصيغة الواحدة في الوقت الواحد في السياق الواحد.
بالإضافة إلى ذلك، فإنّ الصيغة الواحدة قد تشترك بين عدّة معانٍ وظيفية، تجعل للكلمة الواحدة وجوهًا متعدّدة من الدلالة، وظلالًا إيحائية، تعمل على إثراء المعاني الفنية التي يريد المبدع أن يعبر عنها[5].
التفات عبد القاهر الجرجاني للدلالة الصرفية السياقية لبعض الصيغ:
نلاحظ أن البيانيِّين المبرزين قد عُنوا بتلك الدلالات عناية فائقة؛ وذلك أن غاية المشتغل بالبيان أن يكشف عن دقيق المعنى بدقيق اللفظ المستعمل له في كلام البلغاء؛ وذلك أن عامة المتكلمين باللغة -من غير البيانيين والمفسّرين العالمين بأثر تلك الدلالات في بيان المعاني- لا يلتفتون إلى كثيرٍ من تلك الدلالات الصرفية، فهم لا يكادون يفرقون في كلامهم بين دلالة الاسم ودلالة الفعل؛ ولذا يهتم عبد القاهر بتأكيد الفارق بينهما فيقول: «وبيانه أن موضوع الاسم على أن يثبت به المعنى للشيء من غير أن يقتضي تجدّده شيئًا بعد شيء، وأمّا الفعل فموضوعه على أنه يقتضي تجدد المعنى المثبت به شيئًا بعد شيء»[6].
ويوضّح ذلك عبد القاهر بضرب أمثلة له فيقول: «فإذا قلت: (زيد منطلق)، فقد أثبتَّ الانطلاق فعلًا له، من غير أن تجعله يتجدّد ويحدث منه شيئًا فشيئًا، بل يكون المعنى فيه كالمعنى في قولك: (زيد طويل) و(عمرو قصير)؛ فكما لا تقصد هنا إلى أن تجعل الطول أو القصر يتجدّد ويحدث، بل توجبهما فقط، وتقضي بوجودهما على الإطلاق، كذلك لا تتعرض في قولك: (زيد منطلق) لأكثر من إثباته لزيد. وأما الفعل، فإنه يُقصَد فيه إلى ذلك، فإذا قلت: (زيد ها هو ذا ينطلق) فقد زعمت أن الانطلاق يقع منه جزءًا جزءًا، وجعلته يزاوله ويزجيه»[7].
إذن؛ كلّ من الاسم والفعل هنا يشتركان في الدلالة على الانطلاق، ولكن المبدع الواعي بدلالة الألفاظ التي يقتضيها النظام اللغوي هو الذي يختار الصيغة المناسبة للمعنى الدقيق الذي يريده، وهذا المعنى الدقيق لا يعبر عنه إلّا صيغة واحدة.
التفت عبد القاهر الجرجاني إذن للدلالة الصرفية السياقية لكلّ من الاسم والفعل، ويستشهد لما قرّره بشاهدين: أحدهما يلطُف فيه إدراك الفرق بين الاسم والفعل، والثاني الفرق فيه واضح بحيث لا يخفى. فاستشهد لِمَا يلطف بقول الشاعر:
لا يألفُ الدرهمُ المضروبُ خِرْقَتَنا لكن يَمُرّ عليها وهو مُنطَلِقُ
ثم يعلق عليه بقوله: «هذا هو الحُسن اللائق بالمعنى، ولو قلته بالفعل: (لكن يمرّ عليها وهو ينطلق) لم يحسُن».
ثم يمثِّل لِمَا لا يخفى بقوله تعالى: {وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ}[الكهف: 18]، ثم يعلِّق عليه قائلًا: «فإن أحدًا لا يشك في امتناع الفعل ههنا، وأن قولنا: (كَلْبُهُم بَسَط ذِرَاعَيْهِ)، لا يؤدى الغرض؛ وليس ذلك إلّا لأن الفعل يقتضي مزاولة وتجدد الصفة في الوقت، ويقتضي الاسم ثبوت الصفة وحصولها من غير أن يكون هناك مزاولة وتزجية فعل ومعنًى يحدث شيئًا فشيئًا، ولا فرق بين {وكلبُهم باسِطٌ} وبين أن يقول: (وكلبُهم واحدٌ) مثلًا في أنك لا تثبت مزاولة، ولا تجعل الكلب يفعل شيئًا، بل تثبته بصفةٍ هو عليها. فالغرض إذن تأدية هيئة الكلب»[8].
وهذا الذي التفت إليه عبد القاهر -رغم كونه لم يتعدَّ الاسم والفعل إلى الصيغ العديدة لكلّ منهما- أقول: هذا الذي التفت إليه من التفرقة بين دلالة كلّ من الاسم والفعل، وأن الاسم يدلّ على الثبوت، والفعل يدلّ على الحدوث والمزاولة -وافقه في الالتفات إليه عددٌ من المفسرين البيانيين وقفوا على استثمار دلالة كلّ من الاسم والفعل في إثراء المعنى التفسيري؛ لكنهم تفاوتوا في طبيعة اهتمامهم بتلك الدلالات حسب طبيعة تخصصاتهم واهتماماتهم اللغوية.
ففي قوله تعالى: {أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ}[الملك: 19]، نجد أن ابن عطية على اهتمامه البالغ بالنحو والصرف في كتابه المحرر الوجيز يكتفي بقوله: «وقوله تعالى: {وَيَقْبِضْنَ} عطف المضارع على اسم الفاعل، وذلك جائز، كما عطف اسم الفاعل على المضارع في قول الشاعر [الرَّجَز]:
بات يغشّيها بعضب باتر يقصد في أسوقها وجائر»[9].
حيث نراه يكتفي بالتعليل لصحة الظاهرة اللغوية، وهي عطف الفعل المضارع على اسم الفاعل وعكسه، دون بيان القيمة الدلالية لذلك العدول السياقيّ من اسم الفاعل إلى المضارع.
وهذا ما انشغل به كذلك نحويٌّ آخر من المفسرين، وهو أبو حيان في البحر المحيط؛ حيث يقول: «عَطْف الفِعْل على الاسم: {صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ} أي: قَابِضَات، كما عُطِفَ الاسمُ على الفعل في قوله:
فألفيته يومًا يبير عدوه وبَحْرَ عطاءٍ يستحق المَعَابِرَا
عُطِفَ (وبحرَ) على (يبير)»[10].
التفات نابهي البلاغيين إلى الدلالة الصرفية للألفاظ وأثرها في إثراء المعنى:
إذا كان ذلك حظّ المفسرين النحويين -كمَن ذكرنا- فإننا نجد مفسرًا بلاغيًّا مبرزًا في البلاغة كالزمخشري مهتمًّا بأسرار الألفاظ ودلالاتها، يقف لينبّه على الدلالة الصرفية التي يفيدها اسم الفاعل والفعل المضارع في هذه الآية؛ فيقول: «فإن قلت: لِمَ قيل: ويقبضن، ولَمْ يقل: وقابضات؟ قلت: لأن الأصل في الطيران هو صفُّ الأجنحة، لأنّ الطيران في الهواء كالسباحة في الماء، والأصل في السباحة مدّ الأطراف وبسطها. وأمّا القبض فطارئ على البسط للاستظهار به على التحرك، فجيء بما هو طارئ غير أصل بلفظ الفعل، على معنى أنهن صافات، ويكون منهن القبض تارة كما يكون من السابح»[11].
حيث نرى أن تلك الدلالة الصرفية على وجازتها قد دلّت على معانٍ كثيرة؛ فدلّ التعبير باسم الفاعل {صافّات} أنهن يصففن أجنحتهن على الثبات والدوام؛ حيث عبّر باسم الفاعل عن الهيئة الثابتة للطير في جو السماء (وهي صفّ الأجنحة) ودل المضارع (يقبضن) على تجدد فعل القبض منهن حينًا بعد حين، كلما أرَدْنَ الهبوط؛ فصار المعنى: (يصففن أجنحتهن على الدوام، ويتجدّد منهن القبض أحيانًا)، وهذا المعنى ما كان لنا أن نقف عليه بغير الوقوف على الدلالة الصرفية.
ويلاحظ أن التعبير بتلك الصيغ الصرفية أفاد ثراء المعنى ووجازة اللفظ ورشاقته، على حين أن المعادل الدلالي لتلك الصيغ -كما رأينا- هو كلام كثير لا يرقى لرشاقة اللفظ القرآني وفصاحته.
ونحو ذلك ما أشار إليه شيخ البلاغيين عبد القاهر الجرجاني في دلائل الإعجاز في قوله تعالى: «{هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ}[فاطر: 3]. فلو قيل: (هل من خالقٍ غير الله رازق لكم) لكان المعنى غير ما أُرِيدَ»[12].
«وذلك أن المقصود في الآية تقرير العباد برزق الله تعالى لهم، ويمكن أداء ذلك المعنى الأصلي باسم الفاعل (رازق) أو بالمضارع (يرزق) أو غير ذلك، إلّا أن في التعبير بالمضارع (يرزق) من الدلالة على تجدّد الرزق وحصوله للعباد كلّ وقت، ووجدانهم إيّاه بعد حاجةٍ إليه وافتقار -فيه من دقة المعنى ولطفه ما لا يفيده التعبير باسم الفاعل»[13].
وبعد ذلك الجهد المشكور لعبد القاهر في التفرقة بين دلالة كلّ من الاسم والفعل في بعض سياقاتهما القرآنية تفاوَتَ التحليل الدلالي للصيغ الصرفية؛ حيث بدأ إشارات سريعة ثم اتسع في الدراسات الأسلوبية الحديثة»[14].
فيذكر السيوطي كلامًا عن أبي حيان يدلّنا على مدى الدَّور الذي تؤديه الصيغ في التعبير عن المعاني التي لا تكاد تتناهى، والتي لولا الصيغ لضاقت اللغة عنها.
يقول أبو حيان: «وأنواع المعاني المتفاهمة لا تكاد تتناهى، فخصُّوا كلّ تركيب بنوعٍ منها؛ ليفيدوا بالتراكيب والهيئات أنواعًا كثيرة، ولو اقتصروا على تغاير المواد؛ حتى لا يدلوا على معنى الإكرام والتعظيم إلّا بما ليس فيه من حروف الإيلام والضرب لمنافاتهما لهما؛ لضاق الأمر جدًّا، ولاحتاجوا إلى أُلوفِ حروفٍ لا يجدونها، بل فرقوا بين (معتِق) و(معتَق) بحركة واحدة حصل بها تميز بين ضدين»[15].
دَور الصرفيين في بيان الدلالات المطردة للصيغ الصرفية:
الحقّ أن الصرفيين قد بذلوا ما عليهم في بيان الدلالات المختلفة المطّردة للصيغ؛ كدلالة اسم الفاعل واسم المفعول وصيغ المبالغة والمصادر واسم المرّة واسم الهيئة وصيغ الأفعال المجردة والمزيدة، وبيان الأثر الدلالي الذي تحدثه الزيادة في تلك الصيغ، وغير ذلك كثير مما نقف عليه في عامة كتب الصرف.
وإنما الذي نعنيه هنا هو استثمار تلك الدلالات التي كشف عنها الصرفيون؛ للوقوف على دلالاتها السياقية وما يكون بينها وبين سياقاتها ومقاماتها من تفاعل؛ حيث تضيف إليه ويضيف إليها، ويأتي التحليل الأسلوبي للخطاب ليكشف عن أثر تلك الدلالة الصرفية في إثراء المعنى.
أمثلة لبيان قيمة الدلالة الصرفية في إثراء المعنى التفسيري في غير صيغ الاسم والفعل:
ونتمم البحث هنا بتقديم أمثلة لبيان قيمة الدلالة الصرفية في إثراء المعنى التفسيري في غير صيغ الاسم والفعل التي وقف كلّ من عبد القاهر الجرجاني والزمخشري عند بعضها؛ فمن ذلك:
صيغة المبالغة: مثل صيغة (فعّال):
ومن أمثلتها ما ورد في سورة الشعراء في قصة موسى على لسان فرعون: {قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ * يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ * قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَابْعَثْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ * يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمٍ}[الشعراء: 34-37].
حيث جاء التعبير بصيغة المبالغة (سحّار) في هذا الموضع دالًّا على مقابلة الملأ وصف فرعون لموسى بالسحر، وتأكيده على أنه يريد أن يخرجهم من أرضهم (بسحره)؛ فناسب ذلك أن يقابلوا ذلك بالوصية بالإتيان بكلّ سحّار عليم يفوق سحره سحر موسى.
وتتضح هذه النكتة حينما نقف على سياق القصة المشابه في سورة الأعراف، حيث يقول الله تعالى على لسان الملأ من قوم فرعون: {قَالَ المَلأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ * يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ * قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي المَدَائِنِ حَاشِرِينَ * يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ}[الأعراف: 109-112].
ولكن يُضْعِف من هذا التعليل أن الملأ قد وَصَف موسى كذلك في الشعراء بأنه (سَاحِرٌ عَلِيمٌ). وأرى أنه لم تأتِ المبالغة (سحّار) في سورة الأعراف؛ لأنه لم ينصّ على أن المحذور -وهو إخراج موسى لهم من أرضهم- إنما يقع (بسِحرِه) فلم تُذكَر هذه الكلمة في سورة الأعراف، ومِن ثَم لم تُقابَل بصيغة المبالغة (سحّار) في وصف السحرة، فكأنَّ الملأ في هذا الموضع لم يتصوّر أنّ ما جاء به موسى -وهو ما وصفوه بكونه سحرًا- يكون له من القوة والتأثير أن يخرجهم من أرضهم، فَمِن ثَم لا يحتاج إبطال سحره إلى الإتيان بمهرة السحرة. أمّا في سورة الشعراء فإن الكلام فيها على لسان فرعون لا الملأ، وهو يؤكد لهم أن معجزة موسى -عليه السلام- (والتي سمّاها فرعونُ سِحْرًا) تبلغ من القوة والتأثير أن يخرجهم موسى من أرضهم بها. ومِن ثَم بالغوا له في وصف السحرة الذين يؤتَى بهم لإبطال معجزة موسى -عليه السلام-.
ويمكن أن يقال: إنه لمّا كان الواصف لموسى -عليه السلام- في هذا الموضع بـ(السحر) هو فرعون؛ لذا «جاؤوا بكلمة الإحاطة وبصيغة المبالغة ليطيبوا قلبه، وليسكنوا بعض قلقه»[16].
الصفة المشبهة:
من ذلك ما جاء في قول الله تعالى في وصف قوم نوح: {فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ}[الأعراف: 64].
حيث آثرت الآية التعبير عن وصف هؤلاء المكذبين بالصفة المشبهة على غيرها من الصيغ كاسم الفاعل مثلًا (عامِين).
ونستطيع أن نتبين سرّ اختيار هذه الصيغة إذا ما راجعنا سياق الآية من أوله، قال تعالى: {لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ * قَالَ المَلأُ مِن قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلالٍ مُّبِينٍ}[الأعراف: 59، 60].
حيث نجد أن الملأ من قوم نوح قد برَّرُوا تكذيبهم لنبيِّهم بادِّعائهم ضلالَهُ، وكان طريق إثبات هذه الدعوى الكاذبة هو افتراؤهم عليه بإثبات رؤيتهم له في ضلال مبين، ولمّا كان أساس تلك الدعوى الكاذبة هو ادعاء الرؤية المبالغ في إثباتها بـ(إنّ واللام)، واستخدم حرف الجر (في) الدال على انغماسه في الضلال وإحاطته به، فضلًا عن ادعاء كون ذلك الضلال بيِّنًا واضحًا -أقول: لما كان أساس تلك الدعوى هو تلك الرؤية الكاذبة المبالغ فيها على هذا النحو؛ ناسب هذا السياق أن يبالغ في وصف هؤلاء المكذبين بوصفٍ مقابِلٍ لذلك بطريقة أبلغ مما يقتضي إثبات العمى لهم بصيغة دالة على الثبات واللزوم تناسب ما هم عليه من انطماس بصائرهم.
ولذا قال الزمخشري: «{عَمِين} عمى القلوب، غير مستبصرين، وقرئ (عامين)، والفرق بين العمي والعامي أن العمي يدلّ على عمى ثابت، والعامي على عمى حادث»[17].
ويوضح الطيبي ذلك ويعلله بقول: «لدلالة الصفة المشبهة على الثبوت... ولأن اسم الفاعل دونها في الدلالة على الثبوت»[18].
وغير ذلك أمثلة كثيرة فطن إليها الدارسون المحدَثون خاصّة ممن استخدموا المناهج الألسنية الحديثة، وخاصة المنهج الأسلوبي في تحليل النصّ القرآني.
الخاتمة:
من خلال ما سبق تتبيّن تعدّد دلالات الألفاظ القرآنية وتنوّعها بتعدّد مستويات اللغة بين الأصوات والمعجم والصرف والنحو والبيان، وقد سلَّط هذا المقال الضوء على قيمة الدلالة الصرفية خاصّة وأثرها في إثراء المعنى، كما عرض لبيان اهتمام المبرزين من المفسرين -في مجال دلالات الألفاظ القرآنية- بالكشف عن الدلالة الصرفية للكلمة والوقوف على أثرها في بناء المعاني التفسيرية، وكشفت الأمثلة التحليلية التي تعرَّض لها المقال عن قيمة الدلالة الصرفية في إثراء وبناء المعنى التفسيري.
[1] سيتم معالجة كلّ من الدلالتين الصوتية والنحوية في مقالَين تاليَين، إن شاء الله تعالى.
[2] المزهر في علوم اللغة وأنواعها، السيوطي، ط دار الجيل، (1/ 330) نقلًا عن ابن فارس. ويلاحظ أن التصريف الذي يعنيه ابن فارس هنا يدخل فيه الصياغة وغيرها من موضوعات الصرف.
[3] السابق.
[4] طبقات النحويين واللغويين، الزبيدي، أبو بكر محمد بن الحسن الأندلسي، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف، القاهرة. ص39.
[5] الإعجاز الصرفي، للدكتور عبد الحميد هنداوي، المكتبة العصرية- بيروت، ط1، 1422هـ- 2001م، ص7، 8.
[6] دلائل الإعجاز، الجرجاني (عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد)، ط. المدني، تحقيق: أ/ محمود شاكر. ص174.
[7] السابق.
[8] دلائل الإعجاز، ص174.
[9] تفسير ابن عطية (أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي المحاربي، ت: 542هـ) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، المحقق: عبد السلام عبد الشافي محمد، الناشر: دار الكتب العلمية- بيروت، الطبعة الأولى، 1422هــ. (5/342).
[10] البحر المحيط في التفسير، أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين الأندلسي (المتوفى: 745هــ)، المحقق: صدقي محمد جميل، الناشر: دار الفكر- بيروت، 1420هــ. (8/ 521).
[11] تفسير الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله (المتوفى: 538هـ)، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، الناشر: دار الكتاب العربي- بيروت، الطبعة: الثالثة، 1407هــ. (4/ 581).
[12] دلائل الإعجاز، ص177.
[13] الإعجاز الصرفي، (1/ 75).
[14] كان من الدراسات السابقة والرائدة -بحمد الله تعالى- في هذا المجال: كتاب الإعجاز الصرفي لكاتب هذا المقال، ثم ظهرت دراسات أسلوبية عديدة عنيت بالتفسير الأسلوبي للقرآن الكريم الذي يُعنى بكافة جوانبه الدلالية، وقد بيّنتُ العديد من تلك الدراسات في بحث سابق منشور بمركز تفسير كذلك بعنوان: التفسير الأسلوبي للقرآن الكريم. على هذا الرابط: tafsir.net/research/36.
[15] انظر: المزهر، (1/ 347).
[16] الرازي (12/ 120)، وأُحبّ أن أنبّه إلى أن أكثر المفسرين قد انشغلوا في هذا الموضع بمجيء الكلام المذكور على لسان فرعون في سورة الشعراء؛ وعلى لسان الملأ في سورة الأعراف، فانشغلوا بذلك عن تأمل ما ذكرتُ، وقد التفَتَ بعضهم إلى اختلاف الصيغة في السورتين ولكنه لم يحسن توجيه ذلك الاختلاف. انظر على سبيل المثال: الكشاف (2/ 81). روح المعاني، الآلوسي- ط. دار إحياء التراث، (9/ 22، 23).
[17] الكشاف (2/ 68). وانظر: الآلوسي (8/ 154). الدر المصون، السمين الحلبي (شهاب الدين أبو العباس بن يوسف)، تحقيق: عادل عبد الموجود وزميله، ط. دار الكتب العلمية. (3/ 289).
[18] فتوح الغيب للطيبي، رسالة دكتوراه، مخطوط، جامعة الأزهر، كلية اللغة العربية، تحقيق. د: جميل الحسين المحمود. (1/ 575).
كلمات مفتاحية
الكاتب:

عبد الحميد هنداوي
أستاذ ورئيس قسم البلاغة والنقد الأدبي بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، وله عدد من المشاركات العلمية المنشورة.
مواضيع ذات صلة
((المعلومات والآراء المقدَّمة هي للكتّاب، ولا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع أو أسرة مركز تفسير))