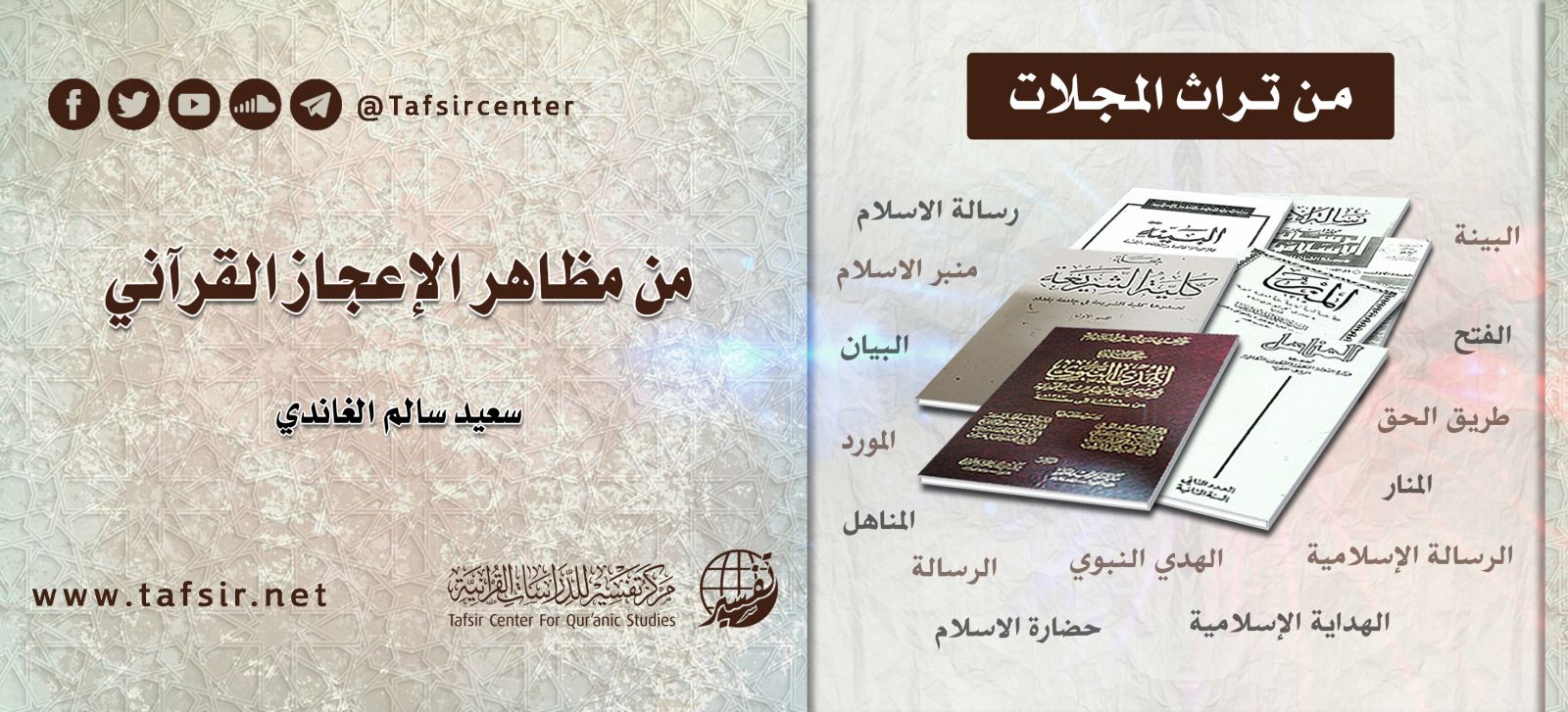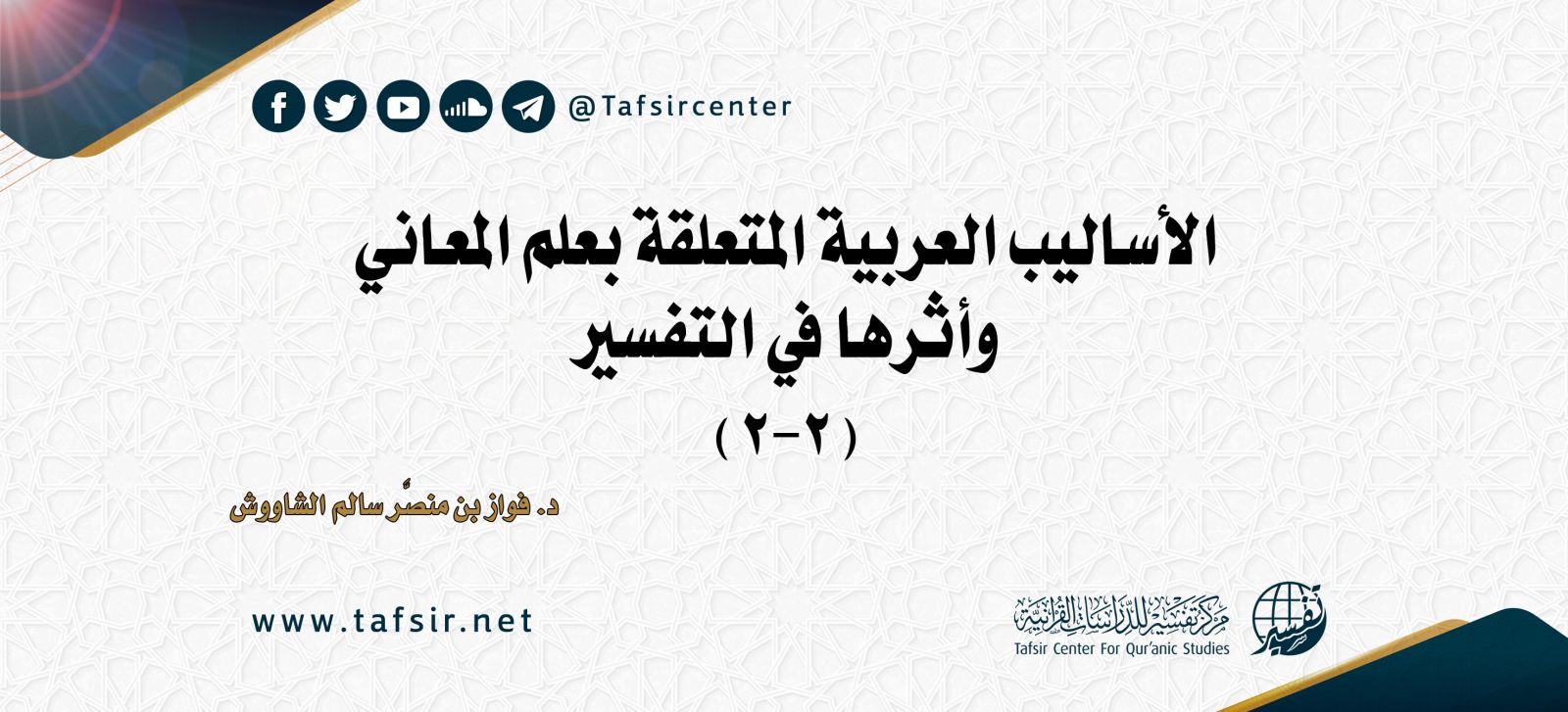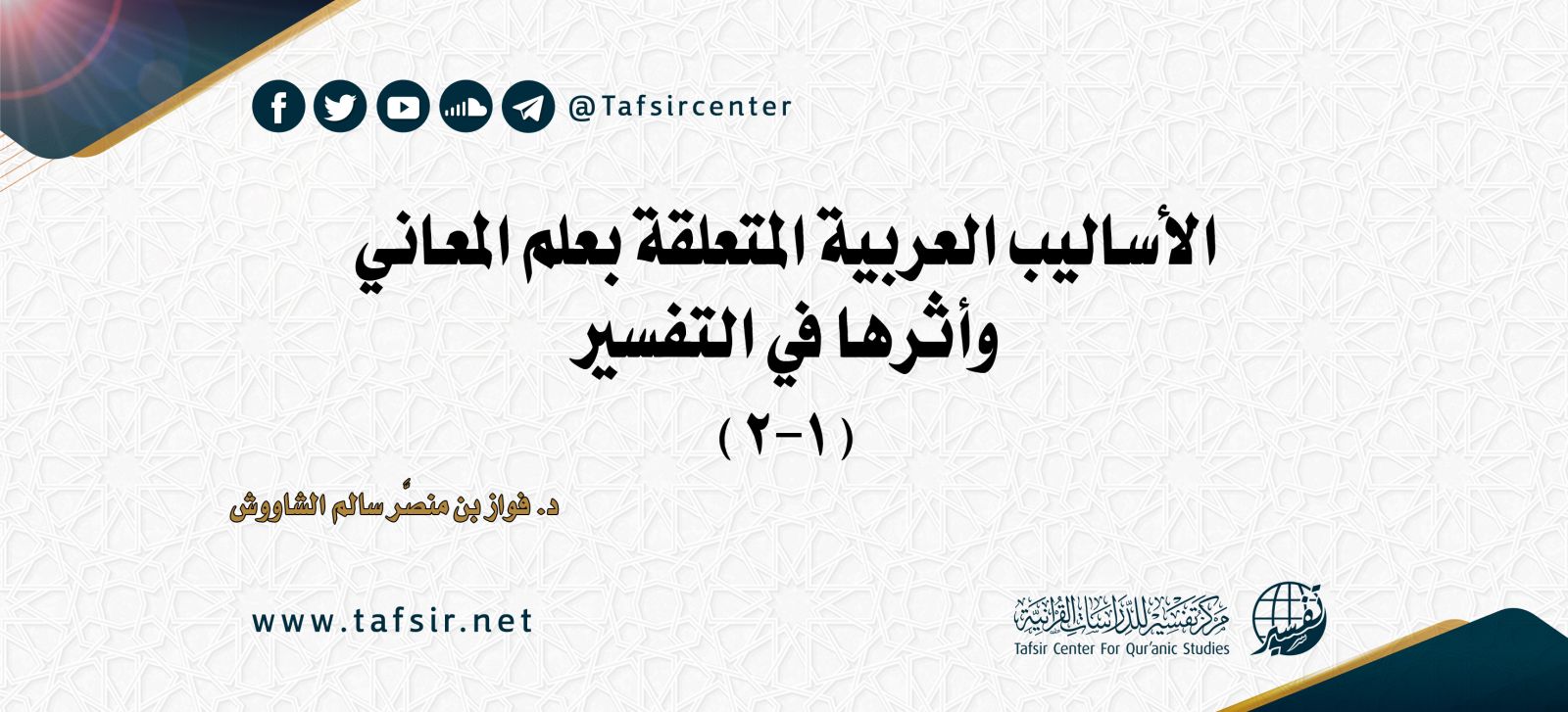البلاغة العربية وقضية الإعجاز
البلاغة العربية وقضية الإعجاز
الكاتب: علي محمد حسن العماري

البلاغة العربية وقضية الإعجاز[1]
سأل إبراهيم بن إسماعيل، من كُتَّاب الوزير الفضل بن الربيع ومن جلسائه، سأل أبا عبيدة معمر بن المثنى عن قول الله تعالى: {طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُؤُوسُ الشَّيَاطِينِ}[الصافات: 65]، كيف وقع هذا التشبيه والمشبَّه به غير معروف؟! وإنما يقع الوعد والإيعاد بما عُرف مثله، فقال أبو عبيدة: إنما كلَّم اللهُ العرب على قَدْر كلامهم، أمَا سمعتَ قول امرئ القيس:
أَيَقْتُلُني والمَشْرَفِيُّ مُضَاجِعِي ومَسْنُونَةٌ زُرقٌ كأَنْيَابِ أغوالِ
وهم لم يروا الغول قط؟! ولكنهم لما كان أمر الغول يهولهم أُوعدوا به... وعزم أبو عبيدة منذ ذلك الحين أن يضع كتابًا في القرآن في أشباه هذا، وما يُحتاج إليه من عِلْمه، ثم وضع كتابه (المجاز)، فكان أول كتاب أُلِّف في فنّ البلاغة.
يبدو واضحًا من هذه القصة التي سقناها باختصار أن التأليف في جوّ البيان وُلِد في جوّ القرآن الكريم، ولو تتبعنا تاريخ البيان العربي لوجدنا أنه كذلك نشأ وأيفع واكتهل في جوّ القرآن، يدلّنا على ذلك أن العلماء منذ عهد أبي عبيدة كانوا يضعون نصب أعينهم حين يؤلفون في البيان قضيةَ الإعجاز، وإن كانوا يضعون بجانب ذلك أغراضًا أخرى، كمعرفة السَّرِيّ والمتَخَلِّف من الكلام، وكالقدرة على إنشاء الجيد من الشعر والنثر، واختيار الجيد منهما، فإنّ المتعلم إذا «فاته هذا العلم، مزج الصفوَ بالكدَر، وخلط الغرر بالعرر... وساء اختياره، ودلّ على قصور فهمه»[2].
ويرى السكاكي أنّ من أهم البواعث على دراسة البلاغة طلبَ الاستعانة على فهم كتاب الله، فهو يذكر في مقدمة كتابه (المفتاح) أنه إذا كان المراد من علم الأدب مجرد الوقوف على بعض الأوضاع فذلك أمر ميسور، «أما إذا خُضْتَ فيه لهِمّة تبعثك على الاحتراز عن الخطأ في العربية، وسلوك جادّة الصواب فيها، اعترض دونك منه أنواع تلقى لأدناها عَرَق القِرْبة، ولا سيما إذا انضم إلى همتك الشغف بالتلقي لمراد الله تعالى من كلامه، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه»[3].
ثم يعود في مقدمة علم المعاني والبيان، فيقول: «وفيما ذكرنا ما ينبّه على أن الواقفَ على تمام مراد الحكيم -تعالى وتقدَّس- من كلامه مفتقرٌ إلى هذين العِلْمين كلّ الافتقار، فالويل كلّ الويل لمن يتعاطى التفسير وهو فيهما راجلٌ»[4].
وهذا كلام سبق به عبدُ القاهر حين قسَا بقلمه على بعض المفسرين، فرماهم بالجهل، ووسمهم بالغفلة، وجعل مردَّ ذلك إلى أنهم لا يحسنون فهم الدقائق والأسرار[5]، وردَّده الزمخشريُّ في مقدمة كتابه (الكشاف)، حيث نقل قولَ الجاحظ: «وليس كلّ ذي علم يستطيع أن يغوص على أسرار التفسير، وأن يدرك لطائف الآيات»[6]، ثم جعل القدرة على ذلك وقفًا على من برع في علمي المعاني والبيان.
ومِنَ العلماء مَن جعل الغاية الوحيدة من دراسة علوم البيان معرفة سرّ الإعجاز، ويبدو ذلك واضحًا في كلام عبد القاهر في (دلائل الإعجاز)، وابن خلدون في (المقدمة): «واعلم أن ثمرة هذا الفنّ -يريد البيان- إنما هو في فهم إعجاز القرآن»[7].
ويرى القائلون بالصَّرْفة أنّ دراسة البلاغة أيضًا ضرورية لفهم إعجاز القرآن؛ فإن هذه الدراسة تحقّق للدارس معنى الفصاحة، فهو في حاجة ماسّة إلى دراسة فصاحة القرآن ليقطع أنها كانت في مقدورهم من جنس فصاحتهم.
هذه هي جماع الأغراض التي ذكرها القدامى والمحدَثُون من دراسة البلاغة، فهل استطاعت أو تستطيع هذه الدراسة أن توصلنا إليها؟
وقبل أن نجيب على هذا السؤال نُحِبُّ أن نفصِّل القول في الطرق التي سلكها العلماء في هذه الدراسة، ويبدو لنا واضحًا أن الدراسة في علوم البيان اتخذت مناهج ثلاثة:
الأول: الطريقة النقدية: وهي طريقة تُعْنَى بالشواهد وتحليلها، ويمثلها عندي كتاب (الوساطة بين المتنبي وخصومه)، وكتاب (الموازنة بين أبي تمام والبحتري).
الثاني: الطريقة التقعيدية: وهي طريقة تُعْنَى بوضع الضوابط، والتدقيق في تحديدها، ويمثلها عمل السكَّاكي ومَن تابعه.
الثالث: الطريقة الوسطى: وهي تجمع بين الطريقتين السابقتين، فهي تُعْنَى بالشواهد، كما تُعْنَى بالقواعد، وإن كانت لا تدقّق في الضبط كطريقة السكّاكي، ويمثلها كتاب (الصناعتين) وما أشبه.
ثم نعود إلى السؤال فنقول في الجواب عنه:
إنّ الأغراض الأخرى غير الإعجاز قد تحققها الطرق الثلاث، وإن كان بعضها أكثر إعانة على هذه الأغراض من بعض، غير أن بعض الباحثين من المحدَثِين لا يرون للطريقة السكاكية جدوى، بل يراها بعضهم تؤدي إلى عكس المقصود، وفي ذلك يقول الشيخ عبد العزيز البشري، بصراحته المعهودة، وسخريته اللاذعة: «فوق التعقيد الشديد في عبارات هذه الكتب، والمبالغة في إبهامها وغموضها، فإنّ ملاك البحث فيها إنما هو الجدل اللفظي، والاعتساف في بحوث فلسفية لا غناء لها في صنعة البيان، بل إنني لأزعم أنه لو كان هناك مَن يريد التخلّص من فصاحة اللسان وفصاحة البيان، فليس عليه أكثر من أن يدرس هذه الكتب حقّ درسها ويديم النظر فيها، ويقلّب في عباراتها لسانه وفكره؛ ليكون له كلّ ما يحب إن شاء الله».
أما الإعجاز، هل تمكن معرفته أو لا تمكن؟ فهنا فقِفْ!
يرى الشيخ عبد القاهر أن معرفة أسرار الإعجاز ممكنة، وأنّ دراسة البيان هي الوسيلة لهذه المعرفة، «فإذا كنتَ لا تشكّ في أن لا معنى لبقاء المعجزة بالقرآن إلا أن الوصف الذي له كان معجزًا قائمٌ فيه أبدًا، وأن الطريق إلى العلم به موجود، والوصول إليه ممكن، فانظر أيّ رجل تكون إذا أنت زهدتَ في أن تعرف حجّة الله تعالى، وآثرت فيها الجهل على العلم وعدم الاستبانة على وجودها، وكان التقليد فيها أحبّ إليك، والتعويل على علم غيرك آثر لديك»[8].
ويرى السكّاكي أن معرفة أوجه الإعجاز عن طريق الدراسة أمر غير ممكن «نعم، للبلاغة وجوه متلثمة، ربما تيسرت إماطة اللثام عنها لتجلى عليك، أما نفس وجه الإعجاز فلا»[9].
المعرفة والإدراك:
لقد طال القول في إمكان معرفة الإعجاز وعدم إمكانه، وأطال الشيخ عبد القاهر، وفصّل القول تفصيلًا في رأيه. وأصرّ السكّاكي في أكثر من مناسبة على أن هذه القواعد ليست الطريق لمعرفة أسرار الإعجاز، ثم رأيتُ كلامًا أعجبني للعلامة ابن خلدون، وهو كلام جديد، لعلّه كذلك وسطٌ بين الرأيين، رأيته يفرّق بين المعرفة والإدراك، ويرى أن معرفة الإعجاز ممكنة عن طريق دراسة البلاغة، أما إدراكه فغير ممكن عن طريق هذه الدارسة: «واعلم أنّ ثمرة هذا الفنّ؛ إنما هو في فهم إعجاز القرآن... وهذا هو الإعجاز الذي تقصر الأفهام عن إدراكه، وإنما يُدرِك بعضَ الشيء منه مَنْ كان له ذوق بمخالطة اللسان العربي، وحصول مَلكته، فيدرك من إعجازه على قدر ذوقه»[10].
ويمكن بسهولة أن نفرّق بين المعرفة والإدراك، ونضرب لذلك مثلًا بدراسة العَرُوض؛ فبعض الناس يعرف سلامة البيت واعتلاله عن طريق هذه الدراسة، فهو ينظر إلى البيت يعرضه على ما عرفه من البحور وقواعدها، ويتبيّن ما فيه من زحاف وعلة، ويحكم بما يجوز من ذلك وما لا يجوز، فهذا عارف، وبعض آخر له أذن موسيقية تحسّ نُبُوَّ الوتَر -كما يقول حافظ إبراهيم- يحكم على البيت بالصحة أو بالاعتلال بمجرد سماعه، وهذا هو الإدراك.
الذوق هو الحكم:
إذن ما هي الوسيلة التي نعرف بها الإعجاز على ما يرى السكّاكي، أو ندركه على ما ذكر ابن خلدون؟ الوسيلة هي الذَّوْق، وقد ظهر ذلك واضحًا من كلام ابن خلدون، وليس هذا الأمر بأقلّ وضوحًا في كلام السكّاكي، بل إنه ذكره وأكّده، وأصرّ عليه وكرّره في كتابه، فمرة يقول بعد أن ذكر أوجهًا أربعة للإعجاز: «ويخمسها ما يجده أصحاب الذّوق من أوجه الإعجاز... ولا استبعاد في إنكار هذا الوجه ممن ليس معه ما يطلع عليه، فَلَكَمْ سحبنا الذّيل في إنكاره، ثم ضممنا الذّيل ما أَنْ ننكره»[11]، ويقول في موضع آخر: «ومدرك الإعجاز عندي هو الذَّوْق ليس إلَّا»[12].
وينسب الإمام الخطَّابي هذا الرأي إلى الأكثرين من علماء النظر، فيقول: «ذهب الأكثرون من علماء النظر إلى أن وجه الإعجاز في القرآن من جهة البلاغة، لكن صعب عليهم تفصيلها، وصفوا فيه إلى حكم الذوق»[13].
ويرى ابن سنان الخفاجي أنّ العلّة في المفاضلة بين الكلمات كثيرًا ما تخفى، ولا مدرك لها إلا الذَّوْق، ويسوق هذا المثال: «وليس يخفى على أحد من السامعين أن تسمية الغصن غصنًا أو فننًا أحسن من تسميته عسلوجًا، وأن أغصان البان أحسن من عساليج الشوحط في السمع... كلّ ذلك لما قدمته من وقوعه على صفة يسبق العلم بقبحها أو حسنها من غير معرفة بعلتها أو بسببها»[14].
هذا، وما أظننا نحتاج إلى كثير من الجدل لنثبت أن كلّ روائع الجمال سواء كانت في الطبيعة أو في الفنون لا يمكن إدراكها إدراكًا حقيقيًّا بواسطة الإبانة عن أوصافها، فجمال الزهرة، وجمال النحت والتصوير والموسيقى والكلام، كلّ ذلك يدرك على حقيقته عن طريق الذَّوْق، وقديمًا قال بعض الخلفاء العباسيين لإسحاق الموصلي: «صِفْ لي جيّد الغناء، فقال: يا أمير المؤمنين، إنّ من الأشياء أشياء تصيبها المعرفة، وتعجز عن أدائها الصفة»، وما قاله إسحاق في جيّد الغناء هو نفسه الذي يقال في جيّد الكلام، والجيد من الفنون بعامة، وقد كنتُ قرأت قصة قديمة وقفتُ عندها طويلًا: «كانت عائشة بنت طلحة تنافِس بالحُسن سكينة بنت الحسين، فقالت لها سكينة يومًا: أنا أجمل منك، قالت عائشة: بل أنا، فاختصمتا إلى عمر بن أبي ربيعة، فقال: لأقضينَّ بينكما، أما أنت يا سكينة فأملح منها، وأما أنت يا عائشة فأجمل، فقالت سكينة: قضيتَ لي ورب الكعبة»، فهم إذن كانوا يفضلون الملاحة على الجمال، وفرقٌ بينهما؛ إنك تستطيع أن تصف الجمال وتبيّن حدوده وقواعده، ولكنك لا تستطيع أن تصف الملاحة، وإنما تدرك الملاحة بالذَّوْق، وبالذَّوْق فقط.
والسكَّاكي قد ربط بين بلاغة الكلام وبين الملاحة حيث يقول: «واعلم أن شأن الإعجاز عجيب؛ يُدرَك ولا يمكن وصفه، كاستقامة الوزن تُدرَك ولا يمكن وصفها، وكالملاحة»[15].
وقد اعترف الجاحظ بالعجز عن وصف الجَيّد من الكلام؛ فقد تذاكر الناسُ يومًا شعرَ أبي العتاهية بحضرته إلى أن جرى ذكر أرجوزته المزدوجة التي سماها ذات الأمثال، فأخذ بعض من حضر ينشدها حتى أتى على قوله:
يا للشبابِ المرح التّصَابي روائحُ الجنةِ في الشبابِ
فقال الجاحظ للمنشد: قف. ثم قال: انظروا إلى قوله: روائح الجنة في الشباب، فإن له معنى كمعنى الطرب الذي لا يقدر على معرفته إلا القلوب، وتعجز عن ترجمته الألسنة إلا بعد التطويل وإدامة النظر[16].
قلتُ: ووهم الجاحظ حيث ظن أنّ الألسنة تستطيع أن تصف معنى هذا الكلام، أو معنى الطرب بعد التطويل وإدامة النظر، فمهما بلغ الجاحظُ في الوصف، ومهما استعان بقدرته البيانية؛ فإنه لن يستطيع أن ينقل إلى القلوب بواسطة بيانه هذا الذي أدركه.
ما فائدة علوم البلاغة إذن؟
إنّ الشيخ عبد القاهر يؤكد أن دراسة هذه العلوم ضرورية جدًّا لمعرفة الإعجاز، وأنها الوسيلة لها، ولذلك يرى الصادَّ عنها كالصادِّ عن سبيل الله، ويقصد عبد القاهر حين يذكر، أن مجرد هذه الدراسة لا يغني في هذه الغاية، بل لا بد عنده من أن يكون الدارس ذا ذوقٍ يساعده على الإدراك، لا سيما أنه حاول أن يفاضل في كتابه بين بعض الكلمات وبعض، ولم يستطع أن يهتدي إلى علّة صحيحة، فهو -مثلًا- يوجّه نظرك إلى أن كلمة «شيء» قد تحسن في موضع وتقبح في موضع، ولكنه لا يذكر لماذا حسنت هنا وقبحت هناك.
والسكّاكي وإن جعل الوسيلة لإدراك الإعجاز الذَّوْق، إلا أنه يرى أنه لا سبيل لتكوين هذا الذَّوْق إلا بطول خدمة علمي المعاني والبيان، وما دام الذَّوْق الفطري الذي كان عند العرب الذين أدركوا إعجاز القرآن بسلائقهم ليس موجودًا؛ فلا مندوحة لنا عن أن نكوِّن أذواقًا جديدة، ودراسة علوم البيان هي سبيلنا إلى ذلك[17].
وما من شك في أن دراسة البلاغة على الطريقة النقدية وعلى الطريقة الوسطى تساعدنا كلّ المساعدة على الوصول إلى هذه الغاية، وربما أعانتْنا على ذلك الطريقة السكّاكية، إذا استطعنا أن نعرضها في معارض أخرى، أنصع بيانًا، وأقشب ثوبًا.
[1] نُشرت هذه المقالة في مجلة (رسالة الإسلام)، العدد 22، ص: 201-207. وقد عزونا النقول التي أوردها الكاتب إلى مصادرها في الحاشية. (موقع تفسير).
[2] من مقدمة كتاب (الصناعتين) للعسكري، ص: (2، 3)، ط. المكتبة العصرية، بيروت.
[3] مفتاح العلوم، للسكاكي، ص: (38، 39)، ط. دار الكتب العلمية.
[4] السابق، ص: (249).
[5] الرسالة الشافية لعبد القاهر بطولها في تقرير هذا المعنى، وانظره: مفتتح (دلائل الإعجاز)، عناية: محمود شاكر.
[6] الكشاف، للزمخشري (1/96)، ط. مكتبة العبيكان.
[7] مقدمة ابن خلدون، ص: (630)، ط. دار الأرقم.
[8] دلائل الإعجاز، فاتحة المصنف في مكانة علم البيان، ص: (8)، ط. دار المنار.
[9] مفتاح العلوم، ص: (526).
[10] مقدمة ابن خلدون، ص: (630).
[11] مفتاح العلوم، ص: (615).
[12] السابق، ص: (526).
[13] بيان إعجاز القرآن، للخطابي، ص: (24)، المطبوع ضمن (ثلاث رسائل في إعجاز القرآن)، دار المعارف بمصر، الطبعة الثالثة.
[14] سر الفصاحة، لابن سنان، ص: (87)، ط. كتاب ناشرون.
[15] مفتاح العلوم، ص: (526).
[16] انظره: الأغاني، لأبي الفرج الأصفهاني (4/36)، ط. الهيئة المصرية العامة للكتاب.
[17] يُنظر: مفتاح العلوم، ص: (526).
كلمات مفتاحية
الكاتب:

علي محمد حسن العماري
أستاذ البلاغة بجامعة الأزهر وجامعة أم درمان والجامعة الإسلامية بمكة المكرمة، توفي عام 1419هـ/ 1998م.
مواضيع ذات صلة
((المعلومات والآراء المقدَّمة هي للكتّاب، ولا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع أو أسرة مركز تفسير))