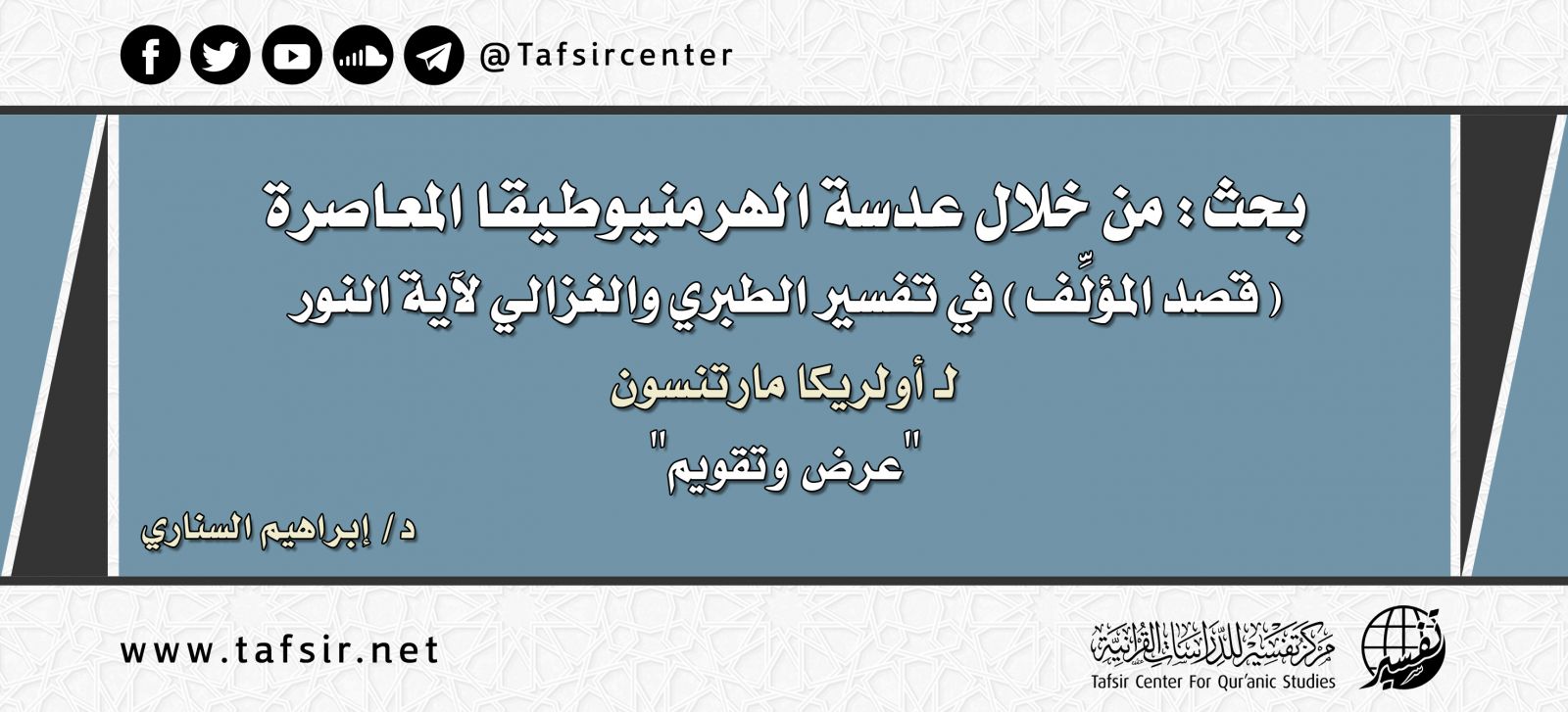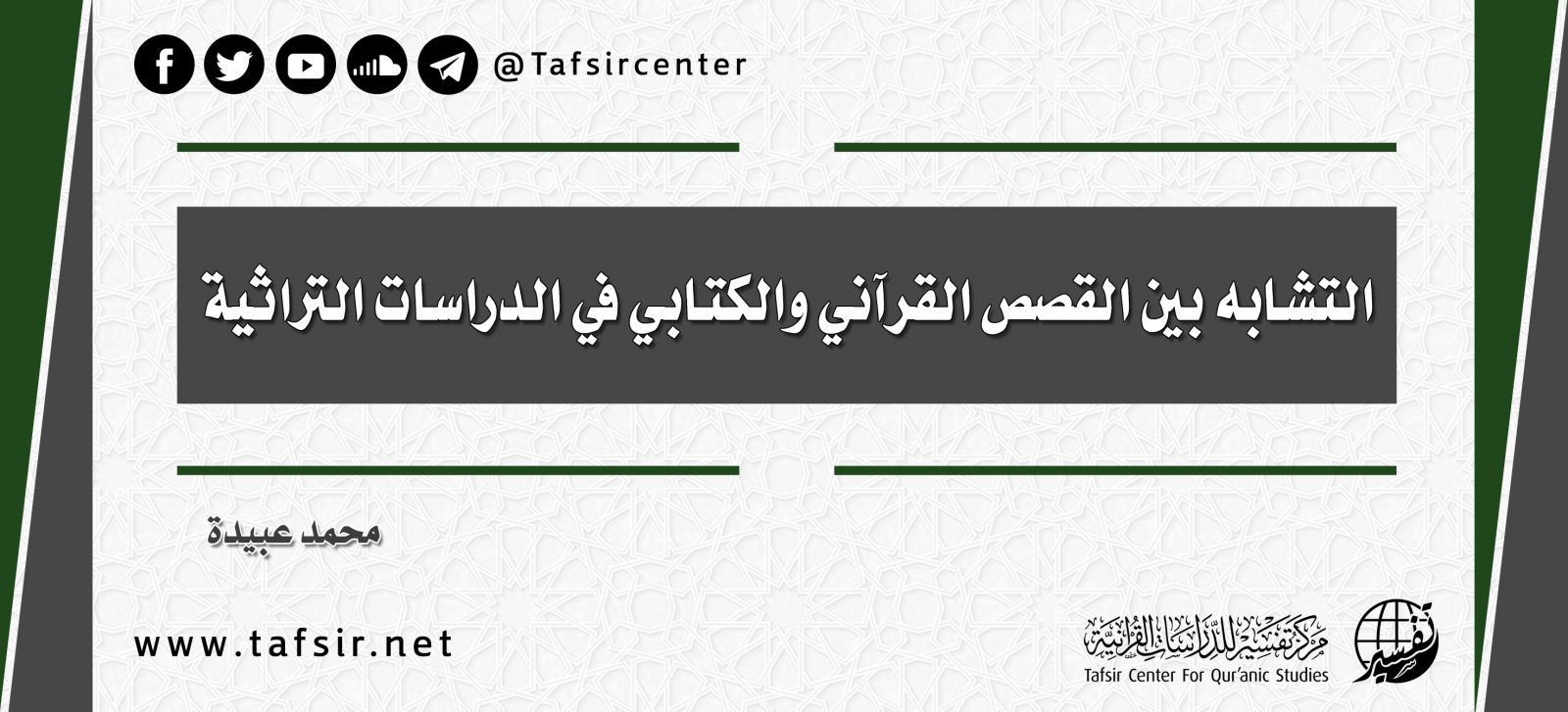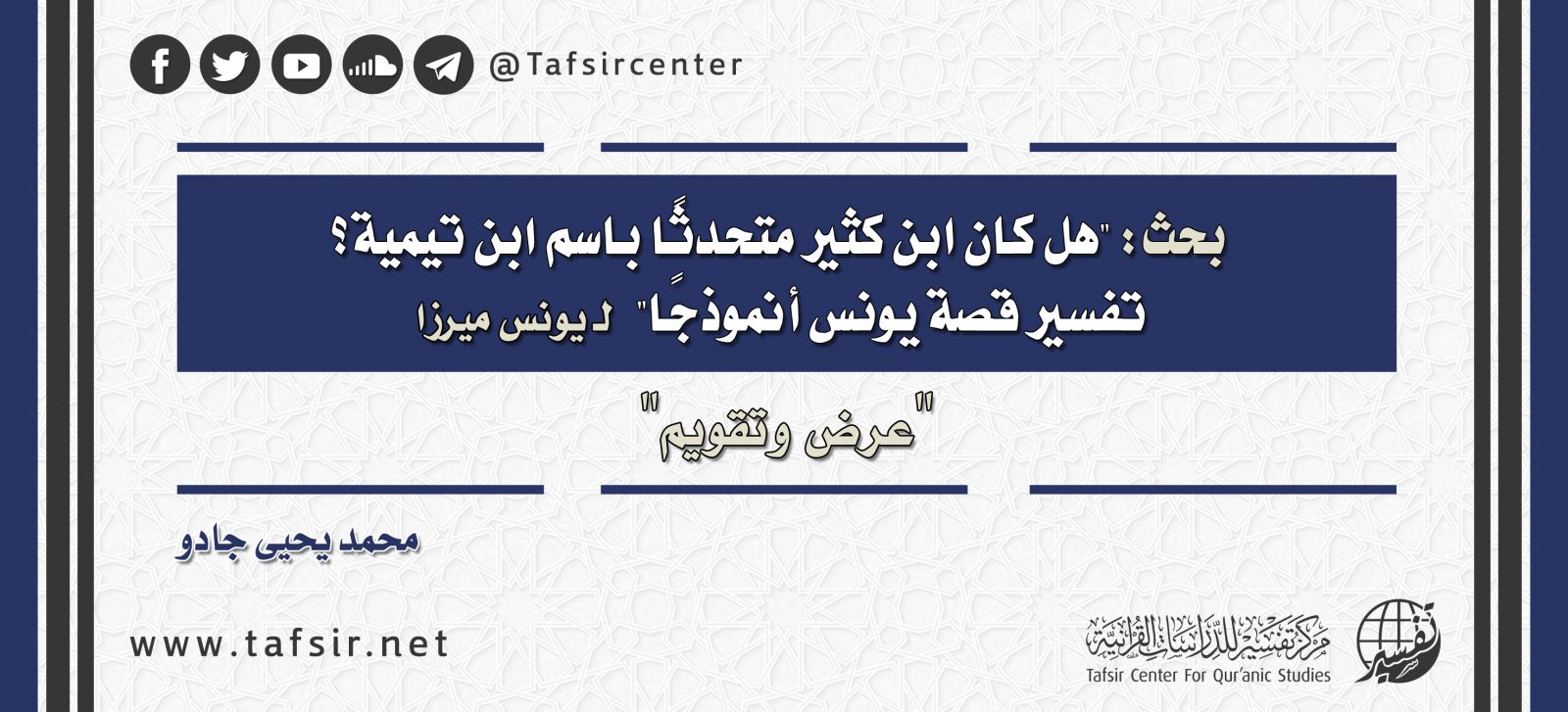البحث عن مراد المتكلم بين الطبري والغزالي: هل كان الغزالي -كالطبري- قريبًا من هيرش بعيدًا عن غادامير؟
هل كان الغزالي -كالطبري- قريبًا من هيرش بعيدًا عن غادامير؟
الكاتب: محمد عبيدة

تقديم:
شهدت الدراسات القرآنية الحديثة نزوعًا نحو توظيف النظريات النقدية والأدبية في سعيها إلى استكشاف المعاني القرآنية؛ ومن هذه النظريات البارزة في السياق الأدبي المعاصر: نظريات التلقي والتأويل، التي نهلت من منجزات الهرمنيوطيقا الفلسفية في التقليد الفلسفي الألماني، التي انحدرت منذ القرن التاسع عشر، على يد شلايرماخر ثم ديلتاي، ثم تطويرات هايدغر وتلميذه جورج هانز غادامير. وقد أثارت هذه التوجهات النقدية نقاشًا واسعًا حول قصدِ المؤلِّف وإمكانِ الوصول إليه؛ وقد اشتهر النقاش الذي أثاره الناقد الأمريكي هيرش ضدّ نظرية غادامير في انصهار الآفاق وضرورة التقليد في التأويل وكون المعنى ناتجًا عن تفاعل أفُق القارئ مع النصّ لا كشفًا عن مراد القائل.
وفي سياق هذا الجدل، تأتي دراسة الباحثة أوليريكا مارتنسون في بحثها: من خلال عدسة الهرمينوطيقا المعاصرة، المنشور مترجمًا بموقع مركز تفسير للدراسات القرآنية؛ لتنظر إلى بعض الاتجاهات التأويلية في تاريخ التفسير الإسلامي، انطلاقًا من منظور هذا النقاش بين هيرش وغادامير، وقد سعت الباحثة في دراستها هذه إلى إبراز اتفاق الغزالي والطبري في موقفهما من التأويل، بوصفه كشفًا عن المراد، مع إبرازها لكون الغزالي سلك طريقًا مختلفًا للوصول إلى المراد، بالاستعانة ببعض المعطيات العلمية السائدة في عصره. وقد ربطت الباحثة بين الطبري والغزالي وبين هيرش، صاحب نظرية قصد المؤلِّف، كما أبرزت ابتعادهما عن تأويلية غادامير. وقد كان لبحثها نتائج مهمّة، إِذْ سعت إلى إبراز التقارب والتقاطع بين التأويليات العربية وبعض التوجّهات في التأويليات الغربية الحديثة في مسألة قصد المؤلِّف، محاوِلةً -بذلك- الردَّ على القول بالانفصال التام بين الحضارتين الإسلامية والغربية الحديثة والمعاصرة. بيدَ أن ثمة مجموعة من الملحوظات على بحثها، خاصّة في الشقّ المتعلّق بالغزالي؛ إِذْ جعلته أقرب إلى الطبري، لكونهما -في نظرها- أشعريَّيْن[1]، مع إبرازها لبعض الاختلافات غير المؤثرة بينهما؛ وأيضًا، جعلته -رفقة الطبري- أقربَ إلى تأويلية هيرش التي تدافع عن قصد المؤلِّف، وإقرارهما بموضوعية التأويل، وبُعدهما عن النسبية التأويلية التي يدعو إليها غادامير. ومن النتائج التي توصلت إليها أيضًا: أنّ كلًّا من الغزالي والطبري قد اعتمد على آليات التأويل المجازي للوصول إلى المراد من آية النور، ووصل إلى نفس النتائج، وأنّ كليهما قد ابتعد عن التأويلات الباطنية التي تستعمل النصّ لغاياتها السياسية والأيديولوجية.
بيدَ أن دراستها -رغم أهميتها في إدخال الطبري والغزالي في قلب النقاش التأويلي المعاصر- أثارتْ مجموعة من الإشكالات والأسئلة التي تستوجب مزيدًا من النظر والبحث، خاصّة في مدى دقّة التقريب بين الغزالي والطبري من جهة، ودقة التقريب بين الغزالي وهيرش من جهة أخرى. وفي هذا السياق، تأتي هذه الورقة لتعيد النظر في العلاقة بين الطبري والغزالي من جهة، وبين الغزالي وهيرش وغادامير من جهة أخرى، من خلال توسيع الأمثلة، وعدم الاقتصار على آية النور، ومن خلال التركيز على الآليات التأويلية المعتمدة وشروط توظيفها لدى كلّ من الطبري والغزالي. ذلك أن الاتفاق بين الطبري والغزالي في ضرورة الكشف عن المراد ليس كافيًا من وجهة نظرنا للحكم بالتقارب بينهما؛ إِذْ يظلّ الإشكال قائمًا في طريقة الكشف عن هذا المراد، وشروط بلوغه وإدراكه؛ إِذْ من المتفق عليه بين مختلف طوائف الإسلام أن الغرض من التفسير هو معرفة مراد الله تعالى. وذلك راجع إلى التصوّر اللغوي الوظيفي عند العلماء القدامى؛ فقد كانوا ينظرون إلى اللغة بوصفها أداةً للتواصل، يهدف من خلالها المتكلِّمون إلى نقل معتقداتهم ومراداتهم إلى المخاطبين، مع الحرص على إيصال هذا المراد دون لَبْس. ولذلك، كانوا يستعملون لفظ: البيان، الذي يعني الكشف والظهور. يقول ابن جرير: «إنّ مِن أعظم نعم الله تعالى ذِكْره على عباده، وجسيم مِنَّته على خلقه، ما منحهم من فَضْل البيان الذي به عن ضمائر صُدورهم يُبينون، وبه على عزائم نفوسهم يَدُلّون، فذَلَّل به منهم الألسن وسهَّل به عليهم المستصعب. فبِهِ إيّاه يُوَحِّدون، وإيَّاه به يسَبِّحون ويقدِّسون، وإلى حاجاتهم به يتوصّلون، وبه بينهم يتَحاورُون، فيتعارفون ويتعاملون»[2].
ويقول الغزالي: «وأمّا الاصطلاح فبِأَنْ يجمع اللهً دواعي جمعٍ من العقلاء للاشتغال بما هو مهمُّهم وحاجتُهم من تعريف الأمور الغائبة التي لا يمكنُ الإنسانُ أن يصل إليها، فيبتدئ واحد ويتبعه الآخر حتى يتم الاصطلاح؛ بل العاقل الواحد ربما ينقدح له وجه الحاجة وإمكان التعريف بتأليف الحروف فيتولّى الوضع ثم يعرِّف الآخرين بالإشارة والتكرير معها للّفظ مرّة بعد أخرى، كما يفعل الوالدان بالولد الصغير وكما يعرِّف الأخرسُ ما في ضميره بالإشارة»[3].
ويقول الرازي: «اعلم أنّ الإنسان الواحد لمّا خُلق بحيث لا يمكنه أن يستقلَّ وحده بإصلاح جميع ما يحتاج إليه، فلا بد من جمعٍ عظيم ليعين بعضهم بعضًا، حتى يتمَّ لكلّ واحد منهم ما يحتاج إليه. فاحتاج كلّ واحد منهم إلى أن يُعَرِّف صاحبه ما في نفسه من الحاجات، وذلك التعريف لا بد فيه من طريق، وكان يمكنهم أن يضعوا غير الكلام معرِّفًا لِما في الضمير كالحركات المخصوصة بالأعضاء المخصوصة معرِّفات لأصناف الماهيات، إلا أنهم وجدوا جَعْلَ الأصوات المتقطعة طريقًا إلى ذلك أَوْلَى من غيرها»[4].
كما نجدهم متّفقين على بعض آليات الكشف عن المراد وتعيينه. بيد أن هذا الاتفاق في الإطار النظري، لم يمنع أن تختلف مناهج التأويل؛ نظرًا إلى دخول بعض الشروط التأويلية على بعض المفسِّرين، وهو ما لا يقبله بعضهم الآخر. ويرجع السبب الجوهري في اعتماد هذه الشروط التأويلية إلى ما يسمى في التأويليات المعاصرة بـ(المسبقات)، وهي تلك المقدمات المعرفية التي يعتمدها المؤوِّل، ويبني عليها تأويلاته. أو بلغة غادامير: تلك التي تنتمي إلى أفُق القارئ؛ وهي في حالتنا هذه: المقدمات الكلامية التي أسّس عليها مفسرو المتكلمين تأويلاتهم. وبناء على هذا التمهيد، فإنّ الفرق المنهجي الأساس بين الطبري والغزالي يعود إلى سعي الطبري إلى تجنّب مختلف أشكال المسبقات، والاعتماد على فهم المخاطبين الأوائل الذين نزل القرآن وَفق أعرافهم اللسانية والثقافية، كما تلقَّوا بيانَه وتفسيرَه عن النبي عليه الصلاة والسلام، فسعى إلى الالتزام بأفهامهم، والترجيح بينها بالاعتماد على الشروط اللغوية والمعرفية السائدة زمن نزول القرآن. ولذلك، فهو أقرب إلى تأويليات هيرش كما ذهبت إليه الباحثة أوليريكا مارتنسون.
وأمّا الغزالي -فكما سنبيّن بإذن الله تعالى- فإنه رغم اتفاقه ظاهريًّا مع هيرش، وإقراره بكون التأويل يستند إلى ما يتعلّق بأفُق المتكلّم، وأن كلامه يجب أن يحمل على مراده، وأنّ المراد ينكشف بمعرفة استعمالاته اللغوية وعاداته في الكلام، إلا أنه سعى إلى إدماج المعارف الكلامية والفلسفية السائدة في عصره، وجعل النصّ دالًّا عليها بطريق الإشارة وبطريق الباطن؛ وقد وجد لمنهجه التأويلي تسويغًا كلاميًّا/ فلسفيًّا، يتمثّل في شمول علم الله، وفي تصنيف المخاطبين إلى طبقات. وبالتالي، فممارسته التأويلية -عمليًّا- هي أقرب إلى غادامير من هيرش؛ فلا يمكن لأيّ قارئ يطلع على تأويلات الغزالي إلا أن يقف على الحالة العلمية لعصره، والتأثير الكبير الذي مارسته علوم الأوائل على ممارسته التأويلية.
وقد نتج عن هذا التباين المنهجي اختلافٌ واضح في بعض التأويلات التي قدّمها كلّ من الطبري والغزالي لآيات من القرآن الكريم، خاصّةً تلك التي تؤدِّي فيها المسبقات دورًا أساسيًّا في صرف الآيات عن ظواهرها إلى معانٍ أخرى. وسنقف في ثنايا هذه الورقة على بعض النماذج والأمثلة بإذن الله. وبناءً على ما سبق، يمكن صوغ إشكال الورقة في الأسئلة الآتية:
هل كان الغزالي قريبًا في نظريته التأويلية من الطبري؟ كيف تعامل ابن جرير والغزالي مع المسبقات المعرفية وما موقعها ضمن تأويليتيهما؟ وإلى أيّ حد يمكن اعتبار الغزالي أقربَ إلى هيرش من غادامير؟
أولًا: التأويل عند ابن جرير الطبري:
1. ضرورة الالتزام بالبيان النبوي المنقول عن السلف:
لمّا كان الغزالي متكلمًا ومتأثرًا بالفلاسفة، ولمّا كان علم الكلام -كما سنرى- هو العلم الكلي الذي تتأسّس عليه باقي العلوم، ومنها التفسير؛ فإنّ النظر في منهجه التفسيري لا بد أن يأخذ في الاعتبار الأُسس الكلامية التي ينبني عليها. وإذا شئنا المقارنة بين منهج التأويل لدى ابن جرير والغزالي، فلا شكّ أن الجانب الذي سيستأثر باهتمامنا هو حضور المؤثّرات الكلامية في المنهج التفسيري. وتبعًا لذلك، لا بد من النظر في البيئة المعرفية التي نشأ فيها ابن جرير، وتكوينه المعرفي، ومدى صِلته بالمؤثّرات الكلامية في عصره. وقد ذهبت أوليريكا مارتنسون إلى وصف الطبري بكونه أشعريًّا أصغر -أي كان في بدايات نشأة الكلام الأشعري- لكن بالنظر إلى تاريخ الولادة والوفاة، فإنّ ابن جرير وُلِد سنة 224 للهجرة، وتُوفي سنة 310هـ، وأمّا الأشعري، فقد وُلد سنة 260هـ، وقيل: 270هـ[5]، وتوفي سنة 324هـ. أي إنّ ابنَ جرير أسنُّ من الأشعري بأربعين أو خمسين سنة تقريبًا. والأشعري كما تقول كتب التراجم رجع عن اعتزاله بعد أربعين سنة، أي إنه عاد إلى أهل السُّنّة في زمن قريب من وفاة ابن جرير أو بعدها بقليل. وبالتالي، فلا يمكن القول بأشعرية الطبري تاريخيًّا. وأيضًا، فبالنظرِ في الكتب التي ترجمتْ لابن جرير، وفي بيئته العلمية التي نشأ فيها، وشيوخه الذين التقى بهم، وأقرانه من العلماء، فإنّ الباحث لا يجد أيَّ مؤثّرات كلامية في تكوينه المعرفي، وفي مقابل ذلك يجد أنّ ابن جرير عاش في بيئة حديثية، فكان شيوخه من المحدّثين والفقهاء، وقد تجلّى هذا في شخصيته العلمية، إِذْ كان محدثًا ولغويًّا ومؤرخًا وفقيهًا[6] عالمًا بالقراءات واللغة والنحو وأشعار العرب[7]؛ ولم تخرج كتبه عن هذه العلوم، إِذْ كتب في الحديث والفقه والتفسير والقراءات. وتبعًا لذلك، فقد جاء تفسيره على طريقة أهل الأثر والحديث. وقد انعكس تكوينه المعرفي وبيئته العلمية على تفسيره للقرآن، ويتّضح هذا في الشروط التي وضعها لصحة التأويل، إِذْ تعود إلى وجوب الالتزام بالبيان النبوي للمعاني[8]، والمنقول في مرويات السّلف التفسيرية[9]، والترجيح بينها في حالة التعارض باعتماد الروايات الموافقة للسان العرب ومعهودها، ولدلالات السياق وغيرها من المرجّحات... كما تخلو من المسبقات الكلامية التي تتدخل في الفهم وتؤدّي دورًا أساسيًّا في حمل الألفاظ على ظواهرها أو صرفها لمعانٍ أُخَر تنسجم مع هذه المسبقات.
والذي يهمُّنا هنا أن الطبري لم يشترط شرطًا آخرَ خارجًا عن البيان النبوي وتفاسير السّلف الذين عاينوا مواقع التنزيل وأسبابه وسمعوا من النبي -عليه السلام- بيانه، مما يجعل تفسيره سياقيًّا خالصًا، يسعى -بلغة التأويليين المعاصرين- إلى استعادة سياق النص الأصلي، وفَهْمِهِ بنفس الكيفية التي فَهِمَهُ بها المتلقُّون الأوائل للنصّ. ويعزّز هذا الفهم ما سنراه في الفقرة الآتية من سعي الطبري الحثيث إلى تجنّب مختلف أشكال المسبقات والتحرّز عنها.
2. تحرز الطبري عن المسبقات الكلامية:
رأينا أنّ الطبري لم يكن متأثرًا بالسياقات الكلامية التي ظهرت في عصره؛ إِذْ عاش في بيئة حديثية خالصة، ومعلوم أن المحدّثين كانوا ينأون عن الجدل الكلامي المفصّل. ورأينا أيضًا أن ابن جرير في شروطه التي وضعها لصحة التأويل وبلوغ المراد لم يشترط أن تكون الظواهر موافقة للعقل، وإلّا أوّلت وحملت على معانٍ أخرى يحتملها اللفظ. والآن، سنرى كيف تعامل الطبري مع بعض الآيات القرآنية التي أثارت نقاشات كلامية.
- الالتزام بأفق النصّ وسياقه الأصلي:
لننطلق من آية النور التي اعتمدتها الباحثة أوليريكا مارتنسون؛ يلحظ الناظر في تفسير الطبري لهذه الآية تركيزه على أمور ثلاثة هي: تفسير السّلف، واختيار الأرجح منها نظرًا إلى تلاؤمِه مع السياق النصِّي، واستعمالات العرب اللغوية. ففي البداية، أورد الطبري في قوله تعالى: ﴿اللهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ ثلاثة أقوال منقولة عن السَّلَف؛ الأول: أنّ المعنى أنه تعالى هادِي السماوات والأرض. والثاني: أنه مدبرهما. والقول الثالث: أنه ضياء السماوات والأرض. ثم إنه نصر القول الأول ورجّحه على غيره (هادي السماوات والأرض)، انطلاقًا من سياق الآية النصّي؛ يقول:
«وإنما اخترنا القول الذي اخترناه في ذلك؛ لأنه عُقَيب قوله: ﴿وَلَقَدْ أَنْزلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ﴾، فكان ذلك بأن يكون خبرًا عن موقعٍ يقع تنزيله مِن خلقِه. ومَن مدحَ ما ابتدأ بذِكْرِ مدحِه، أولى وأشبه، ما لم يأتِ ما يدلُّ على انقضاء الخبر عنه من غيره. فإذا كان ذلك كذلك، فتأويل الكلام: ولقد أنزلنا إليكم أيها الناس آياتٍ مبيناتٍ الحقَّ من الباطل ﴿وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ﴾، فهديناكم بها، وبيَّنّا لكم معالم دينكم بها؛ لأني هادي أهل السماوات وأهل الأرض، وترك وصل الكلام باللام، وابتدأ الخبر عن هداية خلقه ابتداء، وفيه المعنى الذي ذكرت، استغناء بدلالة الكلام عليه من ذكره، ثم ابتدأ في الخبر عن مثل هدايته خلقه بالآيات المبينات التي أنزلها إليهم، فقال: ﴿مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ﴾ يقول: مَثل ما أنار من الحقّ بهذا التنزيل في بيانه كمشكاة»[10].
فحجّة الطبري هنا سياقية نصّية؛ لأنه نظر إلى سِباق الآية، فوجده يتحدّث عن امتنان الله تعالى على البشر بهدايته لهم وإنزاله آيات بيّنات تظهر الحقّ من الباطل. وهذا يناسب أن يكون معنى النور: الهادي، فامتنان الله تعالى على البشر بالهداية والبيان مناسب لمدحه نفسه بكونه الهادي. ثم انتقل إلى تمثيل هدايته للناس بمثل المشكاة والمصباح. فالسياق هنا هو الذي رجّح أن يكون المراد بالنور: الهادي، وقد قوّى هذا التفسير وعزّزه أنه منقول عن السّلف.
وأمّا بخصوص تفسير التمثيل، فقد سار الطبري على نفس النهج، فعرض الأقوال في تعيين مَن تعود عليه الهاء في قوله تعالى: ﴿مَثَلُ نُورِهِ﴾، وهي أقوال تتراوح بين كونها تعود على المؤمن، أو على محمد عليه الصلاة والسلام، أو على القرآن، أو على الطاعة. ثم نصَر الطبري كونها تعود على القرآن. بعدها انتقل إلى ذِكْر تفسير السّلف للتمثيل والمراد به، ونَصَر أخيرًا القول بأن المراد به تشبيه نور القرآن في قلب المؤمن. والمراد بالمشكاة (العمود الذي يوضع فيه المصباح أو الكوة) صدر المؤمن وجوفه؛ والمصباح القرآن؛ والزجاجة في إضاءتها وصفائها كالكوكب الدري = قلب المؤمن؛ وكون المصباح يوقد من شجرة لا شرقية ولا غربية، فالمراد أن هذه الشجرة ليست شرقية فقط، أو غربية فقط، بل هي شرقية غربية تشرق الشمس عليها وتغرب، وهو أجود لزيتها، وأمّا كون الزيت يكاد يضيء ولو لم تمسسه نار، فهو دالّ على أن حجج الله تكاد تنطق بالهداية، فكيف إذا انضاف إليها نور القرآن والوحي والآيات: ﴿نُورٌ عَلَى نُورٍ﴾[11].
وتأويل الطبري هنا كاشفٌ عن التزامه بالسياق النصِّي ودوره في ترجيح المعاني المرادة بالألفاظ؛ إذ السياق الذي يسبق المثل كان مرتبطًا بالهداية، ووَصْفُ الله تعالى لنفسه بنور السماوات والأرض لمّا كان دالًّا على الهداية، ناسَبَ أن يكون نوره/ هدايته القرآن. وهذه المناسبة المعنوية بين النور والهداية والقرآن، التي رجحها السياق النصي، كانت حجّته في ترجيح الرواية الواردة عن السَّلَف بهذا التفسير، وبالتالي، فقد ظلّ وفيًّا لنهجه الذي أشرنا إليه في التفسير.
- غياب المسبقات/ المقدّمات الكلامية:
يجد الناظر في تفسير الطبري أنه عند التعرّض لآيات الصفات، لا يلجأ إلى تأويلها بناءً على مبدأ التنزيه ونفي التجسيم والتشبيه، بل يفسّرها انطلاقًا من البيان النبوي، ومن الآثار الواردة عن السَّلَف، وتعضيدها بالسياق اللغوي والاستعمال العربي زمن النزول... وفيما يلي بعض الأمثلة التي توضح هذا المنهج؛ يقول مفسرًا قوله تعالى: ﴿يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ﴾: «وفي قوله: ﴿يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ﴾ وجهان من التأويل؛ أحدهما: يد الله فوق أيديهم عند البيعة؛ لأنهم كانوا يبايعون الله ببيعتهم نبيّه صلى الله عليه وسلم. والآخر: قوّة الله فوق قوّتهم في نصرة رسوله صلى الله عليه وسلم؛ لأنهم إنما بايعوا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على نُصرته على العدوّ»[12].
فهنا نجد الطبري يذهب إلى كون الآية تحتمل وجهين من التأويل؛ الأول: أن لله تعالى فعلًا يليق بذاته، وهو أن يده تعالى فوق أيدي المبايعين. والثاني أن الآية دالة على المعيّة والنُّصرة. ففي المعنى الأول، لم ينبّه الطبري -كعادة متأخري المفسِّرين الذين مالوا إلى التأويل- إلى أن اليد هنا لا يمكن أن تكون على ظاهرها؛ لأن الظاهر يشي بالتجسيم، وأنه ينبغي صرفها عن هذا الظاهر إلى التأويل...
وفي سياق آخر، يقول الطبري مفسّرًا قوله تعالى: ﴿مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ﴾: «يقول: أيُّ شيء منعك من السجود ﴿لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ﴾، يقول: لخلْقِ يديّ؛ يخبر تعالى ذِكْره بذلك أنه خلقَ آدمَ بيديه. كما حدثنا ابن المثني، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، قال: أخبرني عبيد المكتب، قال: سمعت مجاهدًا يحدّث عن ابن عمر، قال: خلقَ اللهُ أربعةً بيده: العرش، وعَدْن، والقلم، وآدم، ثم قال لكلّ شيء كن فكان»[13].
فالطبري هنا لا يؤوّل الآية بل يجريها على ظاهرها؛ انطلاقًا من الأثر الوارد عن ابن عمر رضي الله عنه، الذي يذكر فيه الأشياء الأربعة التي خصّها الله بخلقها بيديه. ولم يلجأ هنا إلى قواعد التأويل الكلامية لصرف الآية عن ظاهرها تجنبًا للتجسيم والتشبيه.
وهنا مثال آخر يوضح الفرق أيضًا، ففي تفسيره لاستدلال إبراهيم -عليه السلام- على تفرّد الله بالعبادة، يقول: «قال أبو جعفر: وهذا خبر من الله تعالى ذِكْره عن خليله إبراهيم عليه السلام: أنه لما تبيّن له الحقّ وعرَفه، شهد شهادةَ الحقّ، وأظهر خلافَ قومِه أهلِ الباطل وأهلِ الشِّرك بالله، ولم يأخذه في الله لومة لائم، ولم يستوحش من قِيل الحقِّ والثبات عليه، مع خلاف جميع قومه لقوله، وإنكارهم إياه عليه، وقال لهم: ﴿يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ﴾ مع الله الذي خلقني وخلقكم في عبادته من آلهتكم وأصنامكم، ﴿إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ﴾ في عبادتي إلى الذي خلق السماوات والأرض، الدائم الذي يبقى ولا يفنى، ويُحْيي ويميت = لا إلى الذي يفنى ولا يبقى، ويزول ولا يدوم، ولا يضر ولا ينفع. ثم أخبرهم تعالى ذِكْره: أن توجيهه وجهه لعبادته، بإخلاص العبادة له، والاستقامة في ذلك لربّه على ما يحبُّ من التوحيد، لا على الوجه الذي يوجِّه له وَجْهَه مَن ليس بحنيفٍ، ولكنه به مشرك».
ففي هذا التفسير، لا نرى ابن جرير يؤوّل الأُفُول بأنه إشارة إلى التغير، والتغير دالٌّ على الحدوث، كما هو صنيع المتكلِّمين المتأخِّرين، بل اعتمد على لسان العرب، ففسّر الأُفُول بالزوال والمَغيب، وجعلَ مغيبها دليلًا على كونها لا تستحق العبادة، لكونها ليست حاضرة دائمًا متى احتجْنَا إليها، وأنّ الله تعالى وحده من يستحقّ العبادة، فهو الحاضر الذي لا يغيب ولا يزول.
وفي قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ﴾ يقول مفسِّرًا نوع الرؤية:
«وأَولى الأقوال في تأويل ذلك بالصواب، قولُ مَن قال: عَنى الله تعالى ذكره بقوله: ﴿وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾، أنه أَراه مُلْكَ السماوات والأرض، وذلك ما خلقَ فيهما من الشمس والقمر والنجوم والشجر والدواب وغير ذلك من عظيم سلطانه فيهما، وجلَّى له بواطنَ الأمور وظواهِرَها، لِما ذكرنا قبل من معنى (الملكوت) في كلام العرب، فيما مضى قبل. وأمّا قوله: ﴿وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ﴾، فإنه يعني أنه أراه ملكوت السماوات والأرض؛ ليكون ممن يقرّ بتوحيد الله، ويعلم حقيقة ما هداه له وبصّره إياه؛ من معرفة وحدانيته، وما عليه قومه من الضلالة؛ من عبادتهم الأصنام، واتخاذهم إيّاها آلهةً دون الله تعالى. وكان ابن عباس يقول في تأويل ذلك، ما حدثني به محمد بن سعد قال: حدثني أبي قال: حدثني عمي قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس قوله: ﴿وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ﴾، أنه جلَّى له الأمر سِرَّه وعلانيتَه، فلم يَخْفَ عليه شيء من أعمال الخلائق. فلما جعل يلعن أصحاب الذنوب، قال الله: إنك لا تستطيع هذا! فردَّه الله كما كان قبل ذلك. فتأويل ذلك على هذا التأويل: أريناه ملكوت السماوات والأرض ليكون ممن يوقن علم كلّ شيء حسًّا لا خبرًا»[14].
فابن جرير هنا يذهب إلى أن الله تعالى أرى إبراهيم ما في السماوات والأرض إراءة بصرية حسية، وقد استند في تفسيره لهذه الآية إلى معنى الملكوت إلى الآثار المسندة عن السلف، ولم يورد أيَّ عنصر خارجي عن هذه المرويات، أو عن لسان العرب واستعمالاتها اللغوية.
ثانيًا: التأويل عند الغزالي:
بعد أنْ عرضنا موقف ابن جرير الطبري من توظيف المسبقات في التفسير، ورفضه لها، وحرصه على استعادة السياق الأصلي الذي ورد فيه النصّ، والتزام فهمِ السلف للقرآن، وتقديمه على سائر الأفهام -وإن كانت اللغة تشهد له-، سننتقل فيما يلي من فقرات هذه الورقة إلى بيان موقف الغزالي من المسبقات، وتسويغه المنهجي لها، كما سنسعى إلى مقارنة بعض التأويلات التي قدّمها لبعض الآيات القرآنية مع ما سبق أن رأيناه عند الطبري، لنقف على التأثير الذي مارسه هذا الفارق المنهجي في طريقة التأويل، وفي نتائجه؛ لكن قبل ذلك، نرى ضرورة التمهيد بشروط التأويل وإدراك المراد عند الغزالي:
1. شروط إدراك المراد عند الغزالي:
لا يختلف الغزالي عن الطبري في جعله غاية التفسير والتأويل الوصول إلى قصد المتكلّم ومراده، كما لا يختلف معه في مختلف الآليات التي يوصل بها إلى المراد، كسياقات النزول، وقرائن الأحوال، واعتماد لسان العرب ومعهودها، وتفسير النبي -صلى الله عليه وسلم- إنْ نُقل... بيدَ أنه يضيف القرينة العقلية الكلامية باعتبارها علامةً على كون الظاهر غير مراد، وأنه يجب المصير إلى التأويل؛ يقول الغزالي:
«طريق فهم المراد من الخطاب: ...وكذلك سماع الأمة من الرسول -صلى الله عليه وسلم- كسماع الرسول من الملَك، ويكون طريقُ فهمِ المراد تقدُّمَ المعرفةِ بوضعِ اللغة التي بها المخاطبة. ثم إن كان نصًّا لا يحتمل كَفَى معرفةُ اللغة، وإن تطرّق إليه الاحتمال فلا يُعرف المراد منه حقيقةً إلا بانضمام قرينةٍ إلى اللفظ، والقرينة إمّا لفظ مكشوف، كقوله تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾[الأنعام: 141]، والحق هو العُشر، وإمّا إحالة على دليل العقل، كقوله تعالى: ﴿وَالسَّماَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ﴾[الزمر: 67]، وقوله -عليه السلام-: (قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن). وإمّا قرائن أحوال مِن إشارات ورموز وحركات وسوابق ولواحق لا تدخل تحت الحصر والتخمين، يختصّ بدَرْكِها المشاهدُ لها فينقُلُها المشاهدون من الصحابة إلى التابعين بألفاظ صريحة أو مع قرائن من ذلك الجنس أو من جنس آخر، حتى توجبَ عِلمًا ضروريًّا بفهم المراد أو توجب ظنًّا، وكلُّ ما ليس له عبارة موضوعة في اللغة فتتعين فيه القرائن»[15].
يميز الغزالي في الألفاظ بين ما لا يحتمل وما يحتمل، فالذي لا يحتمل أيّ معنى آخر فهو النصّ، وتكفِي فيه المعرفة بالوضع اللغوي للّفظ، وأمّا الذي ليس بنصّ، فمنه ما يحتاج إلى قرينة عقلية، وهنا يقدّم أمثلة ببعض الآيات والأحاديث المتعلّقة بالصفات، والتي يجب أن تصرف عن ظواهرها نفيًا للتجسيم والتشبيه. ومنه ما يحتاج إلى العلم بقرائن الأحوال، وهو الذي يحتاج فيه إلى النقل عن الصحابة والتابعين.
وما يهمّنا من هذا النصّ هو القسم الثاني الذي يحتاج إلى القرائن العقلية الكلامية؛ إِذْ لا نجد هذا النوع عند الطبري كما أسلفنا، أمّا باقي الشروط من الاعتماد على الأوضاع اللغوية وعلى قرائن الأحوال ومرويات السّلف والصحابة، فموجود عند الطبري. وبالتالي، فالفرق الجوهري بين الطبري والغزالي كامن في اعتماد هذا الشرط؛ وفي ما يلي سنرى تأثيره في الفهم والتفسير لدى الغزالي.
2. حضور المسبقات في تأويلات الغزالي:
- المسبقات الكلامية:
في كتابه الاقتصاد في الاعتقاد، يضع الغزالي قانونًا للتعامل مع أخبار الصفات الإلهية في القرآن وفي السنّة، مفاده أن العوامّ يجب أن لا يخاطَبوا بتفاصيل العقائد، ويجب أن ينبَّهوا إلى نفي التشبيه والتمثيل عن الله تعالى وأنه ليس كمثله شيء؛ وأمّا العلماء، فإنهم يفهمون من تلك الألفاظ معاني تليق بالله عز وجل، ويحملونها على أنواع المجازات والاستعارات: «وإذا سألوا عن معاني هذه الآيات زُجروا عنها... وهذا لأنّ عقول العوامّ لا تتسع لقبول المعقولات ولا إحاطتهم باللغات ولا تتسع لفهم توسيعات العرب في الاستعارات. وأمّا العلماء فاللائق بهم تعريف ذلك وتفهّمه»[16].
وبناءً على هذا التأسيس، راح الغزالي يوضح منهجه في التأويل، ففسّر قوله صلى الله عليه وسلم: (يَنزِل اللهُ تعالى إلى السماء الدنيا...)، بمنهجين:
الأول: «في إضافة النزول إليه وأنه مجاز، وبالحقيقة هو مضاف إلى ملَك من الملائكة، كما قال تعالى: ﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ﴾، والمسؤولُ بالحقيقة أهلُ القرية. وهذا أيضًا من المتداول في الألسنة، أعني إضافة أحوال التابع إلى المتبوع، فيقال: ترك الملِك على باب البلد، ويراد عسكره»[17].
والثاني: «فبالنظر إلى هذه المعاني الثلاثة التي يتردّد اللفظ بينها ما الذي يجوِّزه العقل؟ أمّا النزول بطريق الانتقال فقد أحاله العقل كما سبق، فإنّ ذلك لا يمكن إلا في متحيز، وأمّا سقوط الرتبة فهو محال؛ لأنه سبحانه قديم بصفاته وجلاله ولا يمكن زوال علوّه، وأمّا النزول بمعنى اللطف والرحمة وترك الفعل اللائق بالاستغناء وعدم المبالاة فهو ممكن، فيتعين التنزيل عليه»[18].
فهذا المنهج العامّ في ظواهر القرآن والسنّة متأسِّسٌ على المسبقات الكلامية التي يعتبرها المتكلّم قواطع عقلية، وبالتالي، فواجبٌ صرفُ تلك الظواهر إلى المعاني اللائقة بالله تعالى. وهذا المنهج مغاير لمنهج ابن جرير، الذي رأيناه يضرب صفحًا عن هذه المسبقات، ووجدناه يثبت التعامل مع النصوص وَفق ما نُقل عن السّلف واقتضته اللغة والاستعمال. على أنّ ابن جرير كثيرًا ما نبّه عند إثباته للصفات أنه يثبتها على الوجه اللائق به تعالى، لا على الوجه الذي نعرفه في المخلوقات. فهو يعتبرها صفة، لكن دون الخوض في كيفيتها.
- المسبقات الصوفية والفلسفية:
بالعودة إلى المثال الذي انطلقت منه الباحثة أوليريكا مارتنسون، وهو آية النور، فإنّ تأويل الغزالي لها يكشف عن حضورٍ طاغ للمسبقات الفلسفية، خلافًا للطبري، فالغزالي وظّف المعارف الفلسفية المتعلّقة بالنفس الإنسانية وقُواها الإدراكية ليؤوّل ألفاظ الآية، بناءً على التناسب بين معاني الألفاظ القرآنية وهذه المعاني الفلسفية[19]. بيدَ أن هذا التأويل تعترضه إشكالات عديدة وَفق منظور ابن جرير، منها:
- أولًا: أنّ هذا التأويل لم يرِد عن السَّلَف: إذ وردَت عن السَّلَف تأويلات للمَثل ليس هذا التأويل من بينها. والطبري يرى أن لا يخرج التأويل عن تفاسير السلف.
- وثانيًا: فإن هذا التأويل غير متناسب مع سياق الآية وسِباقها كما بيّن ابن جرير نفسه في ما رأينا.
- وثالثًا: لم يراعِ هذا التأويل دلالات الألفاظ في الاستعمال العربي؛ وهذا شرط أساس في التأويل المجازي لدى البيانيين. وفي هذا السياق، نستحضر اشتراط الرازي للعلاقة بين المعنى الحقيقي والمجازي أن تكون معهودةً للمتلقّي؛ لذلك، فإن كانت العلاقة بعيدة، وجب على المتكلّم أن يستعمل أداة التشبيه، ولا يجوز له استعمال الاستعارة لكونها ستجعل الكلام غامضًا وغير قابل للفهم؛ يقول الرازي: «بالجملة، فكلّما كان وقوع التشبيه أخفى كان التصريح بالتشبيه أحسن. ويخرج منه أن الاستعارة لا تحسن إلا حيث كان التشبيه متقررًا بين الناس ظاهرًا. فأمّا أن يكون خفيًّا يستخرجه الشاعر أو غيره بذهنه، فلا بد فيه من التصريح بالتشبيه، وإلا كان تكليفًا بمعرفة الغيب»[20]. واستعمال المشكاة والمصباح والشجرة والزيت في معاني الروح الحساس، والروح الخيالي، والروح الفكري، والروح العقلي، والروح القدسي، غير معهود للعرب مطلقًا. وهذا الشرط الذي اشترطه البيانيون هو نفسه ما نجده عند الطبري حين اشترط أن تحمل الألفاظ على المعاني التي تعرفها العرب وتستعملها فيه.
وعمومًا، فإنّ هذه الشروط تعود في مجملها إلى إلغاء المسبقات التي يحملها المفسّر، مهما بدت له متناسبة مع الآية، وأن يحرص على الالتزام بالبيان النبوي، وحمل الآية على معهود المخاطبين الأُول بها، وعلى استعمالاتهم اللغوية، وعلى المعاني التي يعرفون. وأمّا تأويل الغزالي، فقد حصل فيه -بلغة غادامير- توظيف لأُفُقه المعرفي الخاصّ في الفهم.
وهنا مثال ثانٍ يُظهِر تأثير المسبقات الفلسفية على الغزالي، فقد رأينا في ما سبق أن ابن جرير فسّر الرؤية في قوله عز وجل: ﴿وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ بأنها رؤية بصرية حسية، اعتمادًا على ما ورد في لسان العرب من معنى الملكوت، وعلى مرويات السَّلف التي وصلت إليه في تفسير الآية. فكيف تعامل الغزالي مع الآية نفسها؟ يقول: «فالقلب جارٍ مجرى العين، وغريزة العقل فيه جارية مجرى قوة البصر... فالموازنة بين البصيرة الباطنة والبصر الظاهر صحيحة من هذه الوجوه، إلا أنه لا مناسبة بينهما في الشرف؛ فإن البصيرة الباطنة هي عين النفس التي هي اللطيفة المدركة وهي كالفارس والبدن... ولموازنة البصيرة الباطنة للبصر الظاهر سمّاه الله تعالى باسمه فقال: ﴿مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى﴾، سمّى إدراكَ الفؤاد (رؤية)، وكذلك قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ وما أراد به الرؤية الظاهرة؛ فإنّ ذلك غير مخصوص بإبراهيم -عليه السلام- حتى يعرض في معرض الامتنان»[21].
فالغزالي هنا فسّر الرؤية بأنها رؤية العقل لا رؤية البصر، انطلاقًا من تصوّره الفلسفي لكون العالم العقلي/ الملكوت أشرف من العالم الحسي؛ وهو تصوّر فلسفي يعود إلى الأفلاطونية المحدثة في صيغتها العربية السينوية. فانطلاقًا من امتنان الآية على سيدنا إبراهيم عليه السلام، رأى الغزالي أن هذه الرؤية يجب أن تكون عقلية؛ لأنّ العقل في نظره أشرف من الحسّ والرؤية الحسية. وهذا التفسير نقيض ما ذهب إليه ابن جرير كما مرّ معنا. فلم يدخل ابن جرير في هذه المضائق، ولم يفاضل في الشرف بين رؤية العين والعقل، ولم يذهب إلى أن الملكوت عالَم عقلي، بل يعتبر الغيب عالمًا حسيًّا محجوبًا عنّا الآن، تبعًا للأوصاف الحسية الواردة في الوحي للملائكة والجنة والنار...
وإليك مثالًا آخر خالف فيه الغزالي ابن جرير، ويرتبط بنفس سياق هذه الآية، أيْ باستدلال إبراهيم -عليه الصلاة والسلام- على استحقاق الله وحده للعبادة؛ فينقُل الرازي عن الغزالي تأويله للكوكب والقمر والشمس تأويلًا فلسفيًّا لم يراعِ مقتضياتِ السياق الداخلي للآيات، ولا السياق الثقافي الذي يلفُّ الحدث؛ كون قوم إبراهيم -عليه السلام- من الصابئة عبَدة الكواكب، ولا دلالةَ اللفظ في المعهود اللغوي العربي؛ يقول الفخر: «تفلسف الغزالي في بعض كتبه وحمل الكوكب على النّفْس الناطقة الحيوانية التي لكلّ كوكب، والقمر على النّفْس الناطقة التي لكلّ فلك، والشمس على العقل المجرّد الذي لكلّ ذلك، وكان أبو عليّ ابن سينا يفسّر الأُفُول بالإمكان، فزعم الغزالي أن المراد بأُفُولها إمكانُها في نفسها، وزعم أن المراد من قوله: ﴿لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ﴾ أنّ هذه الأشياء بأسرها ممكنة الوجود لذواتها، وكلّ ممكن فلا بد له من مؤثّر، ولا بد له من الانتهاء إلى واجب الوجود. واعلم أن هذا الكلام لا بأس به، إلا أنه يبعد حمل لفظ الآية عليه»[22].
ففي المعهود الثقافي العربي، لا تدلّ ألفاظ: الكوكب والشمس والقمر، على هذه الدلالات التي أسندها إليها الغزالي، كما أن العرب لم يكونوا حاملين لهذا التصوّر الكوني ذي الأصول اليونانية، ليصح احتمال دلالة اللفظ عليها؛ فلم يكونوا يعرفون النفس الناطقة ولا النفس الفلكية ولا نظرية العقول.
وقد علّق المفسِّر الأندلسي أبو حيان في تفسيره البحر المحيط على تأويل الغزالي بقوله: «والظاهر والذي عليه المفسِّرون أن المراد من الكوكب والقمر والشمس هو ما وضعته له العرب من إطلاقها على هذه النيرات، وحكي عن بعض العرب ولعلّه لا يصح عنه أن الرؤية رؤية قلب، وعَبّر بالكوكب عن النفس الحيوانية التي لكلّ كوكب، وبالقمر عن النفس الناطقة التي لكلّ فلك، وبالشمس عن العقل المجرّد الذي لكلّ فلك، وكان ابن سينا يفسّر الأُفول بالإمكان، فزعم الغزالي أنّ المراد بأُفولها إمكانُها لذاتها، وكلّ ممكن فلا بد له من مؤثّر ولا بد له من الانتهاء إلى واجب الوجود، ومن الناس من حمل الكوكب على الحسّ، والقمر على الخيال والوهم، والشمس على العقل، والمراد أن هذه القوى المدركة الثلاثة قاصرة متناهية القوة، ومدبر العالم مستولٍ عليها قاهرٌ لها. انتهى. وهذان التفسيران شبيهان بتفسير الباطنية -لعنهم الله- إِذْ هما لغزٌ ورمزٌ يُنزَّه كتابُ الله عنهما، ولولا أنّ أبا عبد الله الرازي وغيره قد نقلهما في التفسير، لأضربتُ عن نقلهما صفحًا إِذْ هما مما نجزم ببطلانه»[23].
فأبو حيان هنا يعود إلى قول المفسِّرين القدامى، وهو كون الرؤية بصرية لا قلبية عقلية، ويرفض تأويل الغزالي والرازي الذي تَبِعَه بكونِ الرؤية قلبيةً، كما رفض تأويل القمر والشمس والكوكب بالنفوس والعقول الفلكية، واعتبر هذا التأويل أقرب إلى طريقة الباطنية، وأن القرآن ينزَّه عن هذه الطريقة.
على أنّ أبا حيان ومعه مفسرو الأندلس كثيرًا ما ينتقدون الاستناد إلى الفلسفيات في التفسير، ويرفضون حمل ألفاظ القرآن على المعاني الفلسفية بطريق الرمز والإشارة. وفي هذا السياق يمكن استحضار مناقشة الشاطبي للرازي -الذي يمكن اعتباره امتدادًا لمنهج الغزالي في التأويل وتلميذًا له- حين انتقد اعتماده على علم الفلك في تأويل القرآن؛ ففي الموافقات يذكر الشاطبي إيرادًا لبعض العلماء في ضرورة تطلُّب كلّ العلوم سواءٌ أتَعلّقَ بها العمل أم لا وأجاز تطلّب السحر والطلسمات؛ والأرجح هنا أنه يقصد الرازي[24]، ثم ساق بعدها مباشرة الحكاية التي ذكرها الرازي في تفسيره عن اليهودي الذي يعلّم المسلم علم الهيئة، ليعقب بانتقاده استدلالَه بها[25]، ذلك أنّ علم التفسير -حسَب الشاطبي- مطلوب «فيما يتوقف عليه فهم المراد من الخطاب، فإذا كان المراد معلومًا، فالزيادة على ذلك تكلف، وهو معنًى إفرادي لا يقدح عدم العلم به في علم المعنى التركيبي في الآية»[26]. ويورد قول عمر بن الخطاب المأثور: «أيها الناس تمسّكوا بديوان شعركم في جاهليتكم فإن فيه تفسير كتابكم»؛ ليستنتج أن «تفسير قوله تعالى: ﴿أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا﴾ بأنّ المقصود به هو علم الهيئة الذي ليس تحته عمل = غير سائغ، ولأنّ ذلك من قَبِيل ما لا تعرفه العرب، والقرآن إنما نزل بلسانها وعلى معهودها»[27].
كما أبطلَ الشاطبي الاستدلال بقوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ﴾، حيث يقول: «وأنّ قوله تعالى لا يدخل فيه من وجوه الاعتبار علوم الفلسفة التي لا عهد للعرب بها، ولا يليق بالأميين الذين بُعث فيهم النبي الأمي -صلى الله عليه وسلم- بملّة سهلة سمحة. والفلسفةُ-على فرض أنها جائزة الطلب- صعبةُ المأخذ وعرةُ المسالك بعيدةُ الملتمس؛ لا يليق الخطاب بتعلّمها كي تُتعرفَ آياتُ الله ودلائلُ توحيده للعرب الناشئين في محض الأمية، فكيف وهي مذمومة على ألسنة أهل الشريعة، منبَّهٌ على ذمِّها بما تقدم في المسألة»[28].
3. مسوغات توظيف المسبقات:
نصل هنا إلى سؤال مهم يتعلّق بالدافع الذي حدَا بالغزالي إلى توظيف المسبقات الكلامية والفلسفية. والحقّ أن ثمة دوافع منهجية وأخرى فلسفية دفعت بالغزالي إلى انتهاج توظيف هذه المسبقات؛ ومن هذه الدوافع:
- إشكال قبلية علم الكلام:
كان للغزالي تأثّرٌ شديد بالمنطق والفلسفة اليونانيّين، ورغم موقفه الحادّ من الفلسفة، إلا أنه تأثر كثيرًا ببعض المقالات الفلسفية، وببعض المباني المنهجية للعلوم الفلسفية. ومن بين القضايا المنهجية التي تأثر فيها بالفلسفة، مسألة العلاقة بين العلوم ونسبة بعضها إلى بعض. وبناءً على هذا الأساس المنهجي، قسم الغزالي العلوم إلى كلية وجزئية، فجَعَل علم الكلام هو العلم الكلي الذي أُوكلت إليه مهمّة إثبات المبادئ الدينية، وجَعَل عِلم التفسير علمًا جزئيًّا مبنيًّا على علم الكلام، يقول أبو حامد: «فالعلمُ الكلي من العلوم الدينية هو الكلام، وسائرُ العلوم من الفقه وأصوله والحديث والتفسير علومٌ جزئية؛ لأن المفسِّر لا ينظر إلا في معنى الكتاب خاصّة... والمتكلّم هو الذي ينظر في أعمّ الأشياء وهو الموجود، فيقسم الموجود أولًا إلى قديم وحادث... ثم ينظر في القديم فيبين أنه لا يتكثّر ولا ينقسم انقسام الحوادث، بل لا بد أن يكون واحدًا وأن يكون متميزًا عن الحوادث بأوصافٍ تجب له وبأمور تستحيل عليه وأحكام تجوز في حقّه ولا تجب ولا تستحيل، ويفرق بين الجائز والواجب والمحال في حقّه. ثم يبين أن أصل الفعل جائز عليه، وأنّ العالم فعله الجائز، وأنه لجوازه افتقر إلى محدث، وأن بعثة الرسل من أفعاله الجائزة، وأنه قادر عليه وعلى تعريف صدقهم بالمعجزات، وأنّ هذا الجائز واقع. عند هذا ينقطع كلام المتكلّم وينتهي تصرف العقل، بل العقل يدلّ على صدق النبي. ثم يعزل نفسه ويعترف بأنه يتلقّى من النبي بالقبول ما يقوله في الله واليوم الآخر مما يستقل العقل بدركه ولا يقضي أيضًا باستحالته فقد يرِد الشرع بما يقصر العقل عن الاستقلال بإدراكه إِذْ لا يستقل العقل بإدراك كون الطاعة سببًا للسعادة في الآخرة وكون المعاصي للشقاوة، لكنه لا يقضي باستحالته أيضًا، ويقضي بوجوب صدق مَن دلّت المعجزة على صدقه، فإذا أخبر عنه صدق العقل به بهذه الطريق فهذا ما يحويه علم الكلام فقد عرفت هذا أنه يبتدئ نظره في أعمّ الأشياء أولًا وهو الموجود، ثم ينزل بالتدريج إلى التفصيل الذي ذكرناه فيثبت فيه مبادئ سائر العلوم الدينية من الكتاب والسنّة وصدق الرسول، فيأخذ المفسِّر من جملة ما نظر فيه المتكلّم واحدًا خاصًّا وهو الكتاب فينظر في تفسيره»[29].
والذي يهمّنا من هذا النصّ الطويل أن نظهر المقدّمات التي تسبق عملية التفسير، فالمفسِّر لا يبدأ تفسيره إلا بعد تيقُّن أنّ القرآن كلام الله، وصحة دعوى إلهية القرآن لا تتأتّى إلا بإثبات وجود الله، وكونه فاعلًا للعالم، وكونه مرسلًا للرسل، وهذا لا يتأتى إلا بالنظر في الوجود وتقسيمه إلى حادث وقديم، ثم النظر في صفات القديم...
وبناءً على هذا التقرير نشأ إشكال التأويل الكلامي والفلسفي، فما أثبته العقل من الصفات الإلهية، وما نفاه العقل عن الذات الإلهية كالجسمية ولوازمها مثلًا، وورد في النصّ الشرعي ما يشي ظاهره بها، فقد وجب إمّا تأويلُ هذه الظواهر أو تفويضُ العلم بها إلى الله مع نفي ما يتبادر منها من الجسمية والتشبيه...
وبالتالي، فالمتكلّم وهو يفسّر القرآن، يفسره وهو حامل لتصور مسبق عن الإله تعالى وصفاته وما يجب وما يجوز وما يستحيل في حقّه. وهذا خلافًا لابن جرير، فلم نجد في تقريره لشروط التفسير كلّ هذه المقدمات/ المسبقات الكلامية، كما لم نجد حضورها في تفسيره لآيات الصفات التي أثارت الخلاف بين أهل الإسلام.
- التأثر ببعض المواقف الفلسفية:
كان اطلاع الغزالي على الفلسفة موجهًا بقصد الردّ والنقض، غير أنه لم يسلم من التأثر ببعض المواقف الفلسفية؛ ومنها: القول بالعالم العقلي في مقابل العالم الحسي، تقسيم الناس إلى طبقات، القول بالتخييل... فبخصوص التمييز بين عالم الحسّ وعالم الأمر، يقول الغزالي: «أمّا سؤالك: ما حقيقة القلب؟ فلم يجئ في الشريعة أكثر من قول الله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبّي﴾... لأنّ الروح من جملة القدرة الإلهية، وهو من عالم الأمر، قال الله عز وجل: ﴿أَلَا لَهُ الخَلْقُ وَالْأَمرُ﴾. فالإنسان من عالم الخلق من جانب، ومن عالم الأمر من جانب؛ فكلّ شيء يجوز عليه المساحة والمقدار والكيفية فهو من عالم الخلق. وليس للقلب مساحة ولا مقدار؛ ولهذا لا يقبل القسمة، ولو قبل القسمة لكان من عالم الخلق، وكان من جانب الجهل جاهلًا ومن جانب العلم عالمًا، وكلّ شيء يكون فيه علم وجهل فهو محال. وفي معنى آخر هو من عالم الأمر؛ لأن عالم الأمر عبارة عن شيء من الأشياء لا يكون للمساحة والتقدير طريق إليه»[30].
فالغزالي هنا يميز بين العالم الحسّي، القابل للمساحة والمقدار، والعالم العقلي غير القابل للانقسام والمنزّه عن المقدار والمساحة (صفات الأجسام). وهو يسمِّي عالمَ الحس بالخلق، والعالمَ العقلي بالأمر؛ تأويلًا لقوله عز وجل: ﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ﴾. والحقّ أن الغزالي هنا أخذ هذا التأويل والتقسيم عن ابن سينا الذي يقول: «الحسّ تصرفه فيما هو من عالم الخلق، والعقل تصرفه فيما هو من عالم الأمر»[31]. ويقول عن النفس الإنسانية: «فإذا أعرَضَتْ عن هذه وتوجّهَت تلقاء عالم الأمر لحَظَت الملكوت واتّصَلَت باللذة العليا»[32]. ولأجل هذا الموقف الفلسفي القائل بأفضلية عالم الأمر والملكوت على عالم الخلق، رأينا كيف أوَّل الغزالي الرؤية والملكوت في قصة إبراهيم بالرؤية العقلية والملكوت بالعالم العقلي.
وبخصوص النّفْسِ وقُواها وأنواعها، وتقسيم الناس إلى طبقات تبعًا لقدراتهم الإدراكية، فقد أخذه الغزالي أيضًا عن ابن سينا وغيره من الفلاسفة، فقد قال بنظرية القُوى النفسانية عند الفلاسفة[33]، وبالنفوس والعقول الفلكية[34]، وقال بالقدرة المخيلة عند الأنبياء، فيقول: «فخيال الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- يرى من المحسوس المعنى المعقول، وهو ما كان صدوره منه أو وروده عليه ومرجعه إليه، فيرى شخصًا في هذا العالم ويحكم عليه أنه تفاحة من الجنة، وشخصًا قُطعت يده في سبيل الله نَبَتَ له جناحان يطير بهما في الجنة، وشخصًا قُتل في سبيل الله حيًّا قائمًا يُرزق فرحًا مستبشرًا بما آتاه الله من فضائله؛ وعلى العكس من ذلك، يرى من المعقول محسوسًا ومن الروحاني جسمانيًّا (هذا جبريل جاءكم يعلمكم أمر دينكم)، ﴿فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا﴾»[35]. وبناءً على هذه المقالات الفلسفية[36]، حمَل الغزالي معنى مَثل النور والمشكاة في سورة النور على القُوى النفسانية كما مَرّ معنا.
ثالثًا: مراد المتكلم بين الطبري والغزالي:
في المحور الأخير من هذه الورقة، يمكننا صوغ أهم الفروق بين منهجَي الطبري الغزالي في النقاط الآتية:
- الاتفاق على ضرورة الكشف عن المراد:
لا يختلف الغزالي عن الطبري في كون الكشف عن المراد غاية المؤوِّل والمفسِّر؛ بيدَ أن الطبري كما رأينا كان يقصر آليات الكشف عن المراد على توظيف البيان النبوي، وتفاسير السَّلَف. وبالتالي، فقد كان أقرب إلى (هيرش)، وهو ما بينته (أوليريكا مارتنسون)؛ إِذْ يظل حمل النصّ على المراد ممكنًا معرفيًّا من خلال تجاوز سلطة التقليد، طالما أنّ بيدِ المفسّر مجموعة من المعارف التاريخية والدينية والثقافية واللغوية التي تنتمي إلى زمن ظهور النصّ. إنّ سلطة التقليد، وضغط أسئلة الواقع الملحّة، وهيمنة بعض الرؤى المعرفية والأخلاقية لا شكّ أنها تمارس ضغطها على المؤوِّل، وتدفعه إلى التجرّد عنها، ومحاربة الهوى، و«تعليق» هذه المسبقات للوصول إلى المراد. وهو ما رأينا ابن جرير يحرص عليه من خلال تجنّبه ما يسميه بـ«الهوى» والالتزام بهُدى القرآن.
أمّا الغزالي، فإنه رغم هذا الإقرار، ورغم انطلاقه -كابن جرير- من ضرورة معرفة المراد والكشف عنه، وهو ما يجعله قريبًا من هيرش إلا أنه -وتبعًا لمسبقاته الكلامية- كان يرى أن بعض الآيات لا يمكن أن يكون المراد منها هو ظاهرها، بل المراد منها معانٍ أُخَر مجازية، كما ذهب إلى أنّ النصّ له مستوى ظاهر وآخر باطن، وسعى إلى التوفيق بين معارفه الفلسفية والنصّ القرآني. وبالتالي، فقد أدخلَ في تأويله أمورًا لم تكن حاضرة في السياق الأصلي للنصّ، وهذه المعارف والمسبقات ناتجة عن تأثره بالسياق المعرفي لعصره، وبهذا فهو يبتعد عن هيرش ويقترب من غادامير.
- الغزالي وانصهار الآفاق:
رغم الإقرار النظري للغزالي -كما أوضحنا بضرورة الكشف عن المراد- إلا أن ممارسته التأويلية في واقع الأمر إنما كانت تؤكد ما ذهب إليه (غادامير) من حضور التقليد في التفسير؛ إِذْ لم يستطع الغزالي التخلّص من سطوة التقليد الفلسفي الكلامي الممزوج بالسينوية في تأويله لآيات النور. وتبعًا لذلك، فقد اضطر إلى اجتراح تقسيم جديد للمعاني القرآنية، ميز فيها بين الظاهر والباطن، مع الحرص على جعل الباطن منسجمًا مع الظاهر لا مناقضًا أو مُلْغِيًا له.
إنّهذا الاجتراح/ التمييز بين الظاهر والباطن قد يعتبر -إنْ تحدثنا باصطلاحات غادامير- شكلًا من أشكال انصهار الآفاق، فتقسيم النصّ إلى ظاهر وباطن، والمتلقّين إلى عوامّ وخواصّ، إنما جيء به للتوفيق بين أفُق النصّ، وبين أفُق الغزالي وتقليده المعرفي؛ فمن خلاله سعى الغزالي إلى صهر أفُقه بأفُق النصّ، وتذويب الفروق بين المعاني التي تنتمي إلى عالم النصّ، والمعاني الفلسفية الحادثة، جاعلًا الأُولى ترتبط بالظاهر المقصور على العوام، والثانية خاصّة بالعلماء الذين يتوصلون إليها بالغوص في الباطن، وتجاوز القشر إلى اللباب. وهنا نتّفق مع تحليل الناقد محمد مفتاح لتأويل الغزالي؛ إذ اعتبره تفسيريًّا تاريخانيًّا وإن كان غير تاريخي. فهو تاريخاني بمعنى أنه يكشف لنا عن الحالة المعرفية لعصره، وهو غير تاريخي؛ لأنه نسب إلى القرآن معاني لم تكن متاحة في عصره، ويمتنع أن يكون النصّ قاصدًا لها. يقول مفتاح:
«موازنات الغزالي هذه إن في صياغتها أو في مضمونها كانت أصعب منالًا من أن يدركها المخاطَبون بالآية أثناء فترات الإسلام الأُولى والفترات اللاحقة، وإنما يمكن أن يفهمها أهل النظر من الفلاسفة الذين يتحدّثون عن الإدراك ومراتبه ودرجات المعرفة. تأويل الغزالي نتيجة لمعرفته المستوعبة لعلوم عصره المختلفة ومؤشّر على مرجعيته العلمية ومعتقداته الفلسفية والصوفية والسياسية، ولم يتخذ الآية إلا ذريعة لعرضها وتبيانها، وبفعله هذا انتزع الآية من سياقها العام الذي تُدُوولَت فيه، كما اجتثّها من مساقها الخطابي العام الذي يمكن أن تفسر على ضوئه. تأويل الغزالي غير تاريخاني، ولكنه تاريخي محض»[37].
- الغزالي؛ بين هيرش وغادامير:
إنّ اقتراب الغزالي من غادامير لا يعني المطابقة بين تأويليتهما، ويمكن القول إن الغزالي يقف بينهما، إِذْ يتفق مع هيرش في أولوية الكشف عن المراد، ويرى إمكان الوصل إليه والقطع به، ومن جهة أخرى تؤكّد ممارسته ما ذهب إليه غادامير في ضغط التقليد وانصهار الآفاق. على أنّ ها هنا فروقًا أساسية يمكن لحظها بين تأويلية غادامير وممارسة الغزالي، وهو في إمكان توظيف التقليد؛ فبخصوص الغزالي، فإنه -ونظرًا إلى اتفاقه مع هيرش في ضرورة الكشف عن المراد أثناء التأويل-، لم يكن يستعين بالتقليد المعرفي إلا بشرط صحته العقلية، وانسجامه مع أفهام السلف للنصّ، انطلاقًا من المبدأ الاعتقادي/ القرآني المتعلق بشمول علم الله، وكونه حقًّا منزهًا عن الخطأ والكذب، وكونه يتوجه إلى البشر جميعًا. وهو ما ينتج عنه أن القرآن يتضمن مستويات دلالية تلائم كلّ صنف من المخاطبين، بشرط أن لا يناقض المستوى الدلالي الأدنى/ الظاهر المستوى الأعلى/ الباطن. وطريق الانتقال بين هذين المستويين هو تأويل الرموز والإشارات.
وأمّا غادامير، فإن مفهوم التقليد عنده ضروري، وشرط لكلّ تأويل، وهو يتيح للنصوص أن تتجدد وتتعدد تأويلاتها، وأن تدخل في حوار مع القرّاء المنتمين لأزمنة مختلفة. ولمّا كان غادامير لا ينطلق من خلفية لاهوتية، فإنه لم يشترط أن تكون هذه التأويلات منسجمة أو متوافقة، خلافًا للغزالي الذي يشترط:
أ- صحة هذه المعرفة في نفسها.
ب- وجود تشابه/ مناسبة بين هذه المعاني والمعاني القرآنية (قياس التمثيل).
ت- أن لا تناقض هذه المعاني الباطنية المعاني الظاهرة ولا تلغيها.
وأيضًا، ثمة فرق آخر بين الغزالي وغادامير، وهو موضوعية التأويل؛ فحَسَب الغزالي، يمكن تحديد المراد والقطع به انطلاقًا من الآليات اللغوية وغيرها، كما يمكن المعايرة بين التأويلات وتحديد أرجحها. ولهذا التحديد أو الترجيح آليات مضبوطة، مَن التزمَها -بغضّ النظر عن عصره وزمنه- أمكنه الوصول إلى مراد المتكلم. والحقّ أن هذا الإقرار بموضوعية التأويل يجعل الغزالي أقرب من هذه الحيثية إلى هيرش منه إلى غادامير. وأمّا غادامير، فإنه يرى أنّ التأويلات تختلف حسَب أفُق المتلقي وعصره وتقليده المعرفي، وبالتالي، فإنّ معاني النصوص ليست ثابتة، بل متغيرة على الدوام، وهذا يجعل التأويل والفهم عنده أكثر نسبية.
- آليات التأويل والكشف عن المراد؛ التشبيه والمجاز والرمز:
رأينا فيما سبق أن ابن جرير كان يستند إلى الاستعمال في فهم الألفاظ والمعاني، مع اعتماد السياق النصِّي أو مرويات السَّلَف في ترجيح أحد الاستعمالات على غيرها. فرأينا كيف أثبت اليدين صفةً لله تعالى انطلاقًا من الأثر المروي، وكيف فسّر اليد في سياقٍ آخر بالمعية والنصرة. ويلحظ الناظر في تفسير الطبري أنه لم يكن يوظف المجاز بالمعنى البلاغي والأصولي؛ فلم يكن يَعتبر الألفاظ موضوعة في الأصل لمعنى ثم تُنقَل منه إلى معانٍ أُخَر لمناسبة أو علاقة من العلاقات المعنوية بين الأصل والمجاز. بل كان يتحدّث عن أن العرب تستعمل اللفظ في كذا وتستعمله في كذا... أمّا الغزالي، فإنه يفسّر هذا التنوع في الاستعمال بنظرية المجاز الأصولية. ومهما يكن التفسير الذي يعتمده الطبري، فإنّ المحصّلة واحدة، وهي أن للّفظ أكثر من استعمال أو معنى.
والفرق المنهجي هنا في القرينة الصارفة: فالطبري لا يدخل المسبقات الكلامية في الاعتبار، ولا يجعلها قرينة صارفة عن المعنى الوضعي إلى المجازي، أو إن بقينا مع استعماله: فهو لا يجعل القرينة العقلية- الكلامية مرجحة لأحد المعاني التي يستعمل فيها اللفظ، إذ المرجح عنده إمّا السياق النصي- الداخلي، أو الآثار المروية فقط. وأمّا الغزالي، فكما مَرّ معنا، يجعل القرينة الكلامية أساسية في حمل الألفاظ على معانيها الوضعية أو صرفها عنها. على أن المجاز في نهاية الأمر خاضع لمعهود العرب وطرقهم في التدليل، إِذْ يشترط فيه أن تكون هناك مناسبة بين المعنيين، مع اشتراط علم المخاطَبين بهذه المناسبة؛ ولا يصح حمل اللفظ على معنى آخر قد تكون بينه وبين المعنى الوضعي مناسبة لكن العرب لا تعرفها.
لكن المأزق هنا في توظيف الرمز والإشارة، (وهو ما اعتبره أبو حيان الأندلسي قريبًا من تفاسير الباطنية). ذلك أن كثيرًا من تفسيرات الباطنية لا تعدم وجهًا من وجوه التناسب بين الألفاظ القرآنية ومعانيها التي تدّعي أنها الباطن المراد. وهذا سينتج عنه أمران ينفر منهما الغزالي: أ- أن هذا سيفتح الباب أمام الباطنية لتحميل القرآن دلالات قد تتعارض مع الظاهر، وهذا ما لا يريده الغزالي طبعًا حين اشترط أن لا يعارض هذا التأويل الباطني ظاهر الآية. ب- والثاني، عدم إمكان الترجيح بين التأويلات؛ فما الذي سيجعل تأويل الغزالي للمَثل في آية النور أَوْلى من تأويل ابن سينا مثلًا؟ أو ما الذي سيجعل تأويليهما أَوْلى من تأويلات الباطنية الإمامية؟
أمّا بالنسبة إلى الطبري، فإنه قد حسم الأمر حين أوجب أن يكون المعنى الذي يُحمل عليه اللفظ معلومًا للعرب، تستعمله في كلامها. ومن هنا، يظهر لنا خطأ الباحثة مارتنسون حين جعلت الطبري والغزالي يقفان على مسافة واحدة في اعتماد الاستعارات والمجازات؛ فأولًا: لم يعتمد الطبري القرينة الكلامية الصارفة. وثانيًا: لم يعتمد الطبري على الرمز والإشارة؛ خلافًا للغزالي.
والآن: ماذا عن تأويل الطبري والغزالي لمَثَل آية النور؟ هل يندرج التأويلان في خانة المجاز أم الرمز؟ بخصوص الطبري، فإنه في تفسيره للمَثل لم يعتمد على المجاز في تفسيره للتمثيل كما رأت (أوليريكا)[38]، بل اعتبره تشبيهًا، والفرق بين التشبيه والمجاز أنّ التشبيه يُبقِي الألفاظ في دلالاتها الوضعية، وهو يقيم علاقة المشابهة بين أمرين لوجه من وجوه الشبه والمناسبة. وأمّا المجاز، فإنه ينقل اللفظ عن معناه الأصلي إلى معنى آخر مجازي، مع وجود قرينة تنبه القارئ إلى هذا النقل والصرف. فالآية هنا تقيم مشابهة صريحة من خلال التصريح بكاف التشبيه: ﴿مَثل نوره كمشكاة﴾. وغاية ما فعل الطبري أنه بحث عن وجه الشبه الذي لم تصرح به الآية، لا أنه حمل ألفاظها على معانٍ لا تحتملها: فكان عنده في خانة المشبه: المؤمن، جوفه/ صدره، قلبه، القرآن. وفي خانة المشبه به: المشكاة، المصباح، الزجاجة، الشجرة اللا شرقية واللا غربية التي يكاد زيتها يضيء. ثم راح يبحث عن وجه الشبه بين كلّ عنصر من المشبه وآخر من المشبه به انطلاقًا من معرفته بصفات كلّ طرف من الأطراف والمقارنة بينها.
وأمّا الغزالي، فإنه أيضًا لم يفسّر الآية تفسيرًا استعاريًّا -بالمعنى البلاغي للاستعارة (من حيث هي مجاز)، بل فسرها تفسيرًا رمزيًّا. صحيح أنه وجد وجهًا للمناسبة بين تأويله وبين ألفاظ التشبيه، لكن هذه المناسبة كما أسلفنا لا تكفي لكي يصح عدُّها استعارة، إِذْ من شرط الاستعارة والمجاز أن تكون العلاقة معهودة لدى العرب، وواردة في كلامهم. وإلا كان الأمر -كما يقول الرازي- تكليفًا بالمعرفة بالغيب. يقول عبد القاهر الجرجاني: «فينبغي أنْ تعلمَ أنه ليس كل شيء يجيء مشبَّهًا به بـ(كافٍ) أو بإضافة (مِثْلَ) إليه، يجوز أن تسلِّطَ عليه الاستعارة، وتُنفِذَ حكمَها فيه، حتى تنقُلَه عن صاحبه وتدّعيه للمشبَّه على حدّ قولك: أبديتُ نورًا؛ تريد علمًا. وسللتُ سيفًا صارمًا؛ تريد رأيًا نافذًا. وإنما يجوز ذلك إذا كان الشَّبه بين الشيئين مما يقرُب مأخذُه وَيَسْهُل متناوَلُه، ويكونُ في الحالِ دليلٌ عليه، وفي العُرف شاهدٌ له، حتى يُمكن المخاطَب إذا أطلقتَ له الاسم أن يعرف الغَرَضَ ويعلم ما أردت، فكلّ شيء كان من الضَّرب الأول الذي ذكرتُ أنك تكتفي فيه بإطلاق الاسم داخلًا عليه حرف التشبيه نحو قولهم: هو كالأسد، فإنك إذا أدخلت عليه حكم الاستعارة وجدت في دليل الحال، وفي العرف ما يُبيِّن غرضك، إِذْ يُعْلَم إذا قلت: رأيت أسدًا، وأنت تريد الممدوح، أنّك قصدت وصْفَه بالشجاعة... فأمّا إذا كان من الضرب الثاني الذي لا سبيل إلى معرفة المقصود من الشبه فيه إلا بعد ذكر الجمل التي يعقد بها التمثيل، فإن الاستعارة لا تدخله لأن وجه الشبه إذا كان غامضًا لم يَجُز أن تقتسر الاسم وتَغْصِب عليه موضعه، وتنقله إلى غير ما هو أهله من غير أن يكون معك شاهدٌ يُنبئُ عن الشَّبه»[39].
وهذا الشرط الذي نبّه عليه الجرجاني هو الذي لم يلتزمه الغزالي، فكان تفسيره أقرب إلى الباطنية قديمًا، وأقرب إلى غادامير حديثًا.
خاتمة:
في نهاية هذه الورقة نصل إلى جملة من النتائج التي توصّلنا إليها، ويمكن إجمالها في النقاط الآتية:
لا نزاع في كون الطبري أقربَ إلى تأويليات قصد المؤلِّف التي تبنّاها هيرش؛ إِذْ رأيناه يجعل الكشف عن المراد هدفًا له، كما وجدناه يلتزم بالبيان النبوي وبفهم السلف للنصّ، ويحرص على استعادة السياق الأصلي للنصّ القرآني، مع التحرّز عن كلّ ما لا ينتمي إلى هذا السياق، ويجعله من الهوى وتحميل النصّ معانِيَ لا يحتملها. وأنّ التفسير الأصح يستلزم التجرّد عن الهوى والأخذ بالبيان النبوي للقرآن وبتفسير السلف وبما تعرفه العرب من المعاني. وكلّ من القول بـ: إمكان الوصول إلى المراد/ وإمكان التجرد من المسبقات وتعليقها؛ يتنافى مع تأويليات غادامير التي تنفي إمكان التجرّد من المسبقات، وتجعل المعنى في سيرورة دائمة وتحوّل وتغير دائمين، وتجعل المعنى حصيلة لاندماج أفُق المؤلِّف مع أفق المتلقي.
أمّا الغزالي، فهو كالطبري، قائل بهذه المسلّمات: مسلّمة إمكان الوصول إلى المراد، وإمكان التجرد من الهوى والمسبقات. بيدَ أنّ هذا التسليم النظري وإن كان يجعله قريبًا من هيرش بعيدًا عن غادامير، إلا أن ممارسته التأويلية في جانب منها تؤكّد فعلًا مدى التأثير الذي يمارسه ما يسميه غادامير بـ: «أفُق المتلقي» في الفهم والتأويل، فوجدنا الغزالي -نظرًا لتسليمه بالصحة العقلية والمعرفية لمسبقاته الفلسفية، ولتسليمه بالمبدأ الفلسفي الباطن، القائل بمخاطبة الله تعالى للناس بحسَب مستوياتهم المعرفية والإدراكية، فقد التزم القول بوجود مستويات باطنة للنصّ القرآني، وهذه المستويات الدلالية تتفق مع مسبقاته المعرفية الفلسفية، وأن النصّ يدلّ عليها بطريق الإشارة والرمز لا التصريح. وهذه الممارسة التأويلية تقرّبه من مفهوم انصهار الآفاق لغادامير، إِذْ إنّ أفُقه الخاصّ تدخّل أثناء التأويل، وسعى لإقامة التوافقات بين أفُقه وبين النصّ.
والنتيجة التي نصل إليها هي أنّ الغزالي يقف في مسافة بين هيرش وغادامير؛ فيقترب من الأول عندما يصرّح بإمكان الوصول إلى المراد والقطعِ به، ويقترب من الثاني حين يوظّف المعارف السائدة في عصره في التأويل ويحرص على جعلها منسجمةً مع النصّ.
[1] وصفت الباحثةُ الطبريَّ بالأشعري الأصغر والغزالي بالأشعري الأكبر. انظر: من خلال عدسة الهيرمينوطيقا، أوليريكا مارتنسون، مركز تفسير للدراسات القرآنية، ص9. tafsir.net/translation/87
[2] جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ابن جرير الطبري، دار التربية، مكة المكرمة، بدون تاريخ النشر، (1/ 8).
[3] المستصفى، أبو حامد الغزالي، تح: محمد عبد السلام عبد الشافي، ط1، 1993، دار الكتب العلمية، بيروت، ص181.
[4] المحصول في أصول الفقه، فخر الدين الرازي، تح: طه جابر علواني، مؤسسة الرسالة، ط3، 1997، (1/ 193).
[5] سير أعلام النبلاء، شمس الدين الذهبي، تح: مجموعة من المحققين تحت إشراف شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، ط3، 1985، (15/ 85).
[6] سير أعلام النبلاء، (14/ 269).
[7] معجم الأدباء، ياقوت الحموي، تح: إحسان عباس، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط1، 1993، (6/ 2451).
[8] انظر: تحرير مسألة التزام الطبري بالبيان النبوي في: حجية تفسير السلف عند ابن تيمية، خليل محمود اليماني، مركز تفسير للدراسات القرآنية، ط1، 2021، ص153 فما بعدها.
[9] جامع البيان، (1/ 74).
[10] جامع البيان، (19/ 178).
[11] انظر: جامع البيان، (19/ 178- 188).
[12] جامع البيان، (22/ 210).
[13] جامع البيان، (21/ 239).
[14] جامع البيان، (11/ 475).
[15] المستصفى، ص185.
[16] الاقتصاد في الاعتقاد، أبو حامد الغزالي، تح: عبد الله محمد الخليلي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 2004. ص38.
[17] الاقتصاد، ص40.
[18] الاقتصاد، ص41.
[19] انظر تفاصيل التمثيل في: مشكاة الأنوار، أبو حامد الغزالي، تح: أبو العلا عفيفي، الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة، ص79- 80.
[20] نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز، فخر الدين الرازي، تح: نصر الله حاجي مفتي أوغلي، دار صادر، بيروت، ط1، 2004، ص143.
[21] إحياء علوم الدين، أبو حامد الغزالي، دار المعرفة، بيروت، (3/ 17).
[22] مفاتح الغيب= مفاتيح الغيب، فخر الدين الرازي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط1، 2000، (13/ 45).
[23] البحر المحيط في التفسير، أبو حيان الأندلسي، تح: صدقي محمد جميل، دار الفكر، بيروت، ط 1420هـ، (4/ 567).
[24] الرازي يرى شرف العلم في ذاته حتى السحر، وألّف فيه: السرّ المكتوم.
[25] الموافقات، أبو إسحاق الشاطبي، تح: محمد عبد الله دراز، مصر، المكتبة التجارية الكبرى، ص55.
[26] الموافقات، ص57.
[27] الموافقات، ص59.
[28] الموافقات، ص65.
[29] المستصفى، أبو حامد الغزالي، تح: محمد عبد السلام عبد الشافي، ط1، 1993، دار الكتب العلمية، بيروت، ص6.
[30]كيمياء السعادة، أبو حامد الغزالي، تح: نجاح عوض صيام، دار المقطم، القاهرة، 2010، ص26.
[31] رسالة: (في القوى النفسانية وإدراكاتها)، تسع رسائل في الحكمة والطبيعيات، ابن سينا، دار العرب للبستاني، ط2، القاهرة، ص66.
[32] في القوى النفسانية، ص64.
[33] معارج القدس في مدارج معرفة النفس، أبو حامد الغزالي، دار الآفاق الجديدة، بيروت، ط2، 1975، ص41.
[34] معارج القدس، ص64.
[35] معارج القدس، ص78.
[36] لمزيد من التفصيل حول علاقة قوى النفس بنظرية التخييل عند الفلاسفة، ينظر دراستنا: استدعاء التصور المشائي لطبيعة الوحي واللغة الدينية في القراءات الحداثية للقرآن، ص7 فما بعدها، مركز تفسير للدراسات القرآنية: tafsir.net/research/56
[37] مجهول البيان، محمد مفتاح، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، ط1، 1990، ص97.
[38] من خلال عدسة الهرمينوطيقا، ص44.
[39] أسرار البلاغة، عبد القاهر الجرجاني، تح: محمود شاكر، مطبعة المدني بالقاهرة، دار المدني بجدة، ص243- 244.
الكاتب:

محمد عبيدة
حاصل على ماجستير النص الأدبي وفنونه، وأستاذ اللغة العربية للتعليم الثانوي التأهيلي.
مواضيع ذات صلة
((المعلومات والآراء المقدَّمة هي للكتّاب، ولا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع أو أسرة مركز تفسير))