(تسهيل التفسير لمحكم آيات التنزيل) للشيخ الصادق بلخير السياري التونسي
تعريف بمؤلِّفه، وبيان أبرز ملامحه
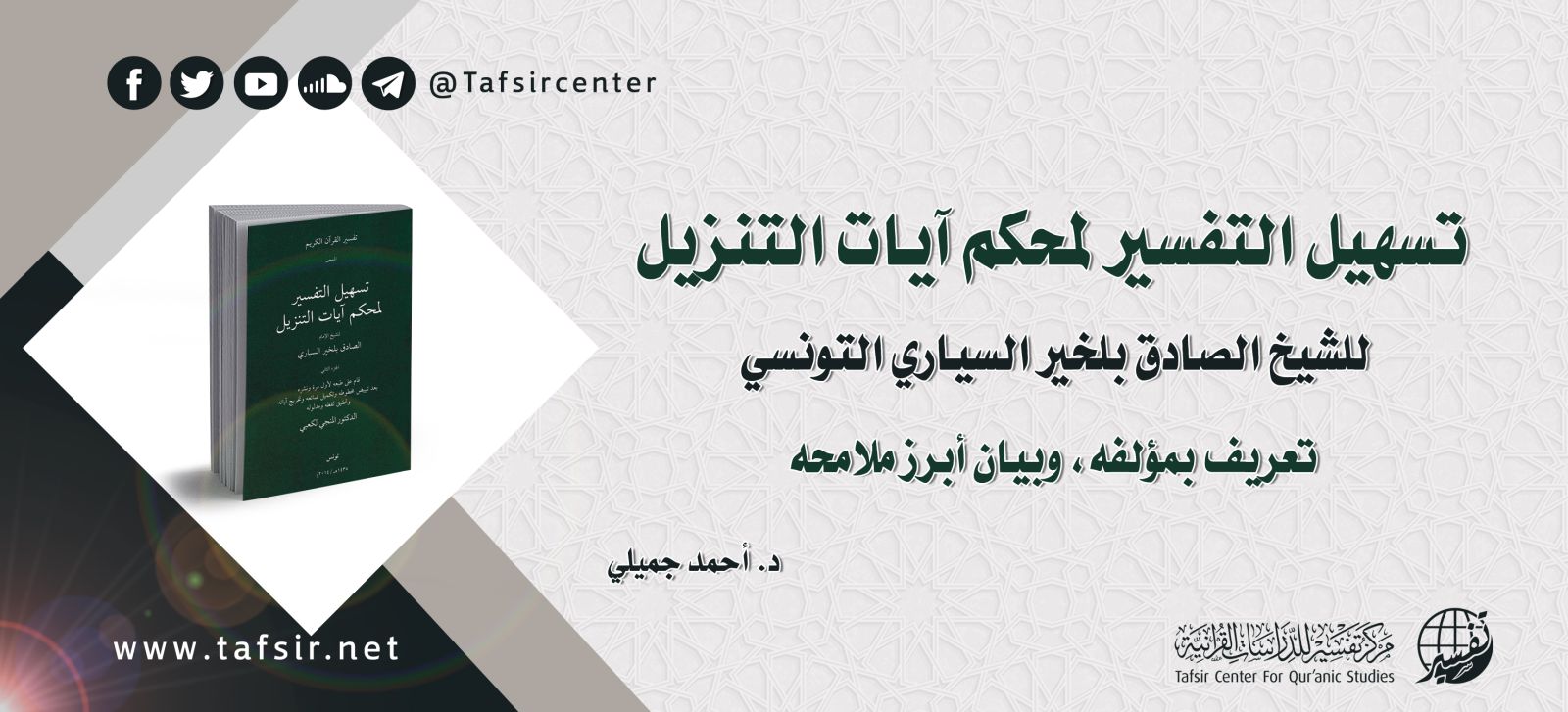
نسعى من خلال هذا المقال إلى التعريف بتفسير (تسهيل التفسير لمحكم آيات التنزيل)، للشيخ الصادق بلخير السياري التونسي، وهو شخصية عِلْمية غير معروفة، ويُعَدّ تفسيره أهمّ إنتاجاته العِلْمية، بل الوحيد، وسأعرض في هذا المقال لذِكْر أهمّ محطّات حياة المؤلِّف العلمية والعملية، ثمّ أركّز على بيان الملامح العامة لتفسيره الذي يُعتبر تلخيصًا وتبسيطًا لتفسير شيخه ابن عاشور[1].
أولًا: الشيخ الصادق بلخير السياري؛ حياته العِلْمية والعَملية:
هو الصّادق بن محمّد الأخضر بن العربي بلخير السيّاري، وُلد بمنطقة ريفيّة تسمّى (بالشّوك)[2] (التابعة لمشيخة زواغة) يوم العاشر من مارس 1918 للميلاد الموافق ليوم الأحد السابع والعشرين من شهر جمادى الأولى سنة 1336 للهجرة في بيئة ريفية؛ إِذْ كان أبوه محمّد الأخضر يمتهن الفلاحة بالطّرق التقليديّة قبل ظهور الآلات وعَصرنة الفلاحة، وكان من عادة الآباء إرسال أبنائهم إلى الكُتّاب، ولـمّا لاحظ أبوه نباهته المبكّرة ونبوغه وحبّه للعلم آثَر إرساله إلى حاضرة تونس ليتعلّم بجامع الزيتونة على حدّ قول ابنه محسن، وكان ذلك في أواخر سنة 1929م على خلاف أترابه ممّن هُم من سِنّه ممّن يقتصر التّعَلّم لديهم على الكُتّاب أو في أحسن الأحوال يلتحقون بالمدارس الحكومية التي تخضع لإدارة السلطات الفرنسية.
وفي جامع الزيتونة تلقّى الشيخ الصادق العِلْم على كبار العلماء والشيوخ وعُرِف بشغفه وحبّه للعلم حتى نهل من مَعِينه الصافي في شتى العلوم؛ كالفقه والمنطق والبلاغة والفرائض وغيرها. فمن شيوخه في القراءات الشيخ الهادي بن محمود، وكذلك الشيخ عثمان بن المكّي الذي حضر حلقاته في شرح حاشية الرهوني على شرح الزرقاني على مختصر خليل، وقد أهداه له قبل وفاته ببضعة أشهر، كما سمع منه كتابه: (القلائد العنبريّة في شرح البيقونيّة)[3]، أمّا فيما يخصّ دروس اللّغة فقد أخذ عنه كتابه: (قطر النّدى)، مع كتاب: (معالم الاهتدا في شرح شواهد قطر النّدى)، وهو ما جعل الشيخ عثمان يعطي نسخة شخصيّة من حاشية الرهوني للشيخ الصادق، وكذلك قرأ عليه شرح المكودي على ألفيّة ابن مالك، وقد تأثّر الشيخ الصادق كثيرًا بشيخه عثمان خاصّة في الجانب العقدي، وذلك من خلال كتابه: (المرآة في إظهار الضّلالات من البدع والمحدثات)؛ ذلك أنّ كثيرًا ممّن حضروا وواكبوا دروس الشيخ قالوا بأنه كان دائم النقد للبدع والشركيّات، رافضًا لقراءة القرآن على الأموات، إلى غير ذلك من المواضيع.
وأمّا في مجال العقيدة والكلام فقد درس الشيخ متن (جوهرة التوحيد)، مع شرحه للسنوسي على الشّيخ محمّد غويلة، وأخذ الفقه وأصوله على ثلّة من مشايخ الجامع الأعظم كالشيخ عبد السلام التونسي، والشيخ عليّ النيفر، والشيخ الهادي العلّاني، والشيخ محمّد الناصر الصدّام. ودرّسه كتاب (المطوّل) للسّعد التفتازاني (مادة البلاغة) الشيخُ محمّد الشاذلي النّيفر. كما درس الشيخ بلخير علم التفسير على ثلّة من العلماء؛ أذكر منهم الشيخ محمّد الزغواني الذي أخذ عنه كتاب (أحكام القرآن) لابن العربي سنة 1941م، أي سنة تخرّجه، وكتاب تفسير البيضاوي.
وتلقّى علم الحديث وشروحه على عدّة علماء؛ كالشيخ محمّد بن الخوجة الذي درس على يده كتاب صحيح البخاري بشرح القسطلاني، ودرس صحيح مسلم بشرح النووي (كتاب المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج) على يد الشيخ محمّد العزيز جعيط، وكذلك من الشيخ محمّد الزغواني وقرأ على الشيخ محمّد الطيب بيرم صحيح البخاري، وأيضًا سمع منه جزأين من كتاب شرح الشفا، كما درس الشيخ الصادق كتاب الموافقات على يد الشيخ بلحسن النجّار، ومختصر منتهى الأصولي للإيجي بشرح العضد على الشيخ إبراهيم النّيفر، كما درس على عدّة مشايخ آخرين منهم الشيخ محمّد الصادق الشطّي الذي درّسه مختصر خليل بشرح الزرقاني، والشيخ محمّد الصادق المحرزي، والشيخ أحمد المختار الوزير (علم النفس ومادّة صناعة التعليم)، والشيخ محمّد العزيز النّيفر، ولا ننسى إمام الجامع وشيخه محمّد الطاهر بن عاشور وذلك رفقة محمّد الفاضل بن عاشور وذلك بمقرّ الخلدونيّة، وقد سمع منه أجزاء من تفسيره وخاصّة كتابه مقاصد الشريعة.
وكان لهذا العلم الذي بثّه في صدره الشيخ ابن عاشور أثره البالغ حيث جعل الشيخ الصادق يمتدح ابن عاشور وتفسيره ويثني على صاحبه حتى لقّبه بخاتمة المحقّقين. وقد تكلّلَت جهود الشاب الصّادق بلخير بالحصول على شهادة التحصيل في العلوم من القسم الشرعي يوم الثامن والعشرين من شهر ربيع الأوّل سنة ألف وثلاثمائة وخمس وخمسين (1355هـ)، الموافق للرابع عشر من شهر جويلية سنة ستّ وثلاثين وتسعمائة وألف (1936م)، وذلك بعد مواظبته على الدراسة لمدة سبع سنوات متتالية.
لكنّ الشاب الصادق بلخير ولشغفه بتحصيل العلم النافع، قرّر إتمام دراسته بالجامع والتحق سنة (1937م) بدرجة العالميّة، إلّا أنّه ونظرًا لبعض الاحتجاجات بالجامع الأعظم انقطع عن الدراسة لمشاركته في المظاهرات الطلّابيّة وزواجه، ليعود إلى الدراسة السَّنَة التي تليها (أي 1938م)؛ ليتحصّل بذلك بعد ثلاث سنوات على شهادة العالميّة من القسم الشرعي في العلوم في الحادي والعشرين من شهر جمادى الآخرة سنة ستّين وثلاثمائة وألف (1360هـ)، الموافق للسادس عشر من جويلية سنة إحدى وأربعين وتسعمائة وألف (1941م)[4]، وقد أُسندت له كذلك شهادة الاستحسان في امتحان العالميّة؛ وذلك لتفوّقه، وأُهدي له كتاب شرح الشفَا (مجلّدان)، وذلك بتوصية من شيخ الإسلام الحنفي محمّد الطيّب بيرم، وهذه الشهادة جعلت الشيخ الصادق مؤهّلًا للتدريس؛ ولذلك لمّا استنجد به مدير الفرع الزيتوني عند فتح فرع باجة للتدريس التحق الشيخ الصادق رفقة عدد من متخرِّجي جامع الزيتونة المتحصّلين على شهادة التحصيل والتطويع والعالميّة، وهؤلاء هم رفاقه في التدريس؛ وهم الشيخ محمّد محسن الطبوبي، والشيخ محمّد بن يوسف الدخلي، والشيخ عمر شويخة، والذي كان يدرّس الجزريّة بشرح الهادي وهو متحصّل على شهادة التطويع في علوم القراءات وقارئ للقرآن بالقراءات السّبع حسب تلميذه حسين الدخلي، والشيخ بلقاسم السّنوسِي الذي كان يدرّس ويشرح متن جوهرة التوحيد.
وقد تخرّج على يد هذه الثلّة من العلماء والمدرّسين الذين ذكرتهم آنفًا عددٌ كبيرٌ من الطّلَبة الزيتونيين الذين اضطلعوا بعد الاستقلال وقبله بأدوار داخل الإدارة التونسية؛ فمنهم من اشتغل بالقضاء والمحاماة، ومنهم من اشتغل بالعدلية، ومنهم من عمل كمُرَبٍّ ومعلّم، أمّا بعد الاستقلال فقد اكتفى الشيخ الصادق بالإمامة والخطابة بجامع معبد بن عبّاس بباجة إلى أن توفي -رحمه الله- سنة 2000م.
ثانيًا: الملامح العامة لتفسير الشيخ الصادق (تسهيل التفسير لمحكم آيات التنزيل):
كتب الشيخ الصادق بلخير تفسيرًا سمّاه: (تسهيل التفسير لمحكم آيات التنزيل)، وممّا يلاحَظ اشتمال عنوان تفسير الشيخ الصادق على عدّة مفردات سأحاول فهم الحكمة والداعي وقَصْد الشيخ الصادق بلخير من إطلاق هذا العنوان: (تسهيل التفسير لمحكم آيات التنزيل) على تفسيره؛ ولذلك سأقوم بشرح هذه الألفاظ ثم أحاول فهم العنوان وشرحه وفهمه فهمًا مقاصديًّا قبل الدخول والغوص والتنقيب في تفسيره.
وأوّل هذه الألفاظ هي (تسهيل) وهي لفظة مشتقة من جذر (س، هـ، ل)، والتسهيل هو التيسير والتساهل والتسامح وهو نقيض الصعوبة[5]، فيمكن ملاحظة التالي أنّ معنى اللفظ الأول الوارد في عنوان تفسير الشيخ الصادق يمكن تفسيره بمعنى تبسيط وتيسير لِما هو صعب، مصداقًا لقول النبي -صلّى الله عليه وسلّم-: (اللهم لا سهل إلّا ما جعلته سهلًا، وأنت تجعل الحَزْن إذا شئت سهلًا)[6]، ثم ذكر لفظ (تفسير) وهو بمعنى الكشف والبيان والإيضاح[7]، ثمّ ذكر لفظ (محكم)، ثمّ نجده يذكر مركّبًا إضافيًّا وهو (آيات التنزيل)، وهو بهذا يثبت أنّ القرآن نزّله الله على نبيه محمّد -صلّى الله عليه وسلّم- بواسطة جبريل، مصداقًا لقوله تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ [الحجر: 9].
وقد ألّف الشيخ الصادق تفسيره بعد استشارة تلميذه حسين الدخلي حول تبسيط واختصار تفسير التحرير والتنوير؛ نظرًا لغزارة مادّته العلمية وعُسْر ألفاظه[8].وقد اعتمد الشيخ الصادق عدّة مصادر في تفسيره هي نفسها التي اعتمدها شيخه (ابن عاشور) في تفسيره؛ أهمّها مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي، وتفسير البيضاوي، والكشاف للزمخشري، وتفسير القرطبي، وتفسير المحرّر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية الأندلسي، وتفسير الإمام محمد بن جرير الطبري، وتفسير الراغب الأصفهاني، وروح المعاني للألوسي، كما اعتمد كثيرًا على كتاب (أحكام القرآن) لابن العربي، وعلى الواحدي في أسباب النزول. وبالنسبة للاستشهاد بالأحاديث النبوية فقد أخذ من صحيح البخاري، وصحيح مسلم، والنسائي، والترمذي، وأبي داود، ومالك، وأحمد بن حنبل، والطبراني، والبزار في مسنده، وابن أبي حاتم، والبيهقي في سننه، والدارقطني، وكان يستشهد في المقام الأوّل من الصحيحين، وموطأ الإمام مالك، ثمّ كُتُب السنن، ثمّ مسند أحمد، وعبد بن حميد، والحميدي.
أمّا في مجال اللّغة؛ فقد اعتمد خاصّة على مؤلّفات أبي عليّ الفارسي، وعبد القاهر الجرجاني، والزجّاج. وكلّ استشهاداته في هذا السياق أخذها من تفسير شيخه ابن عاشور. وقد بدأ الشيخ الصادق بتحبير تفسيره سنة 1987م إلى أن أتمّه يوم الأحد 29 جمادى الآخرة سنة 1412هـ= 5 جانفي سنة 1992م، وعنونه بـ(تسهيل التفسير لمحكم آيات التنزيل)، لكنه لم يستطع طباعة تفسيره وإظهاره للنور لأسباب يجهلها أهله ورفاق دربه، واستمرّ هذا التفسير متروكًا حتى جاء الدكتور منجي الكعبي الذي اهتمّ بتحقيقه، وفرغ من ذلك يوم 25 جانفي 2014م، باذلًا في ذلك جهدًا مضنيًا في قراءة المخطوط والعناية به، رغم أنه كان منقوصًا من 285 صفحة كاملة كما صرّح لي بذلك، أي أنّه منقوص من إحدى الكرّاسات التي لم تظهر حينها كما قال لي هو بنفسه في حوار أجريته معه، حيث إنّه أكمل تفسير ثلاث سور، وهي كالآتي: سورةُ الحجر، وسورة النحل، وسورة الإسراء، وصدرٌ من سورة الكهف (في حدود 55 آية)، وقد قمتُ بمقارنة هذا الجزء بتفسير الشيخ ابن عاشور فوجدته يتّبعه كما قال هو في عبارته: «الحافر بالحافر»، مع كثرة النقول وتبسيط ما ورد في تفسير ابن عاشور وهو ما فعله الشيخ الصادق.
ويتميّز تفسير الشيخ الصادق بعدّة خصائص وأُسُس قام عليها تفسيره، سأذكر منها عشر خصال، وهي كالآتي:
1- طغيان الجانب الدعوي على تفسيره:
يتميّز تفسير الشيخ الصادق بعدّة خصال قَلّ أن تجدها في غيره من التفاسير، وأهمّها خطابه الدعوي والإصلاحي الذي يهدف من خلاله إلى محاربة البدع والشركيات والانتصار لعقيدة التوحيد ومجابهة ظُلْم الحكّام والسلاطين، وهذا نجده مبثوثًا بين ثنايا تفسيره، حيث قال مهاجمًا رئيس تونس الحبيب بورقيبة: «أي: ألقينا فرعون وجنوده في البحر، وهو آتٍ بما يُلام عليه من الكفر والطغيان، وفي هذا إيماء إلى عظمة القدرة الإلهية على إذلال وسوء عاقبة الطغيان والكفر والتطاول على الله والرُّسل المبعوثين لتبليغ رسالة الله إلى عباده بعبادته وحده وتصرّفه في ملكه لا شريك له فيه، وقد حدث لطاغية تونس ما حدث له من الإذلال وسوء العاقبة جزاء تطاوله على الدِّين والقضاء على تعلّمه وتعليمه والتشجيع على الإلحاد والكفر ونكران الألوهية وتربية الأجيال الناشئة على ذلك بعنوان التقدم والحرية، فهو الآن منبوذ يقاسي الآلام البدنية والنفسية لا هو بحيّ ولا هو بالميت»[9].
فالشيخ الصادق عند نقده للحكّام نلاحظ حنقه وأسفه على واقعه، فهو يصفهم بالموالين للكفّار، حيث قال: «وهذا ما وقع فيه حكّام الدول الإسلامية منذ سقوط الدولة الإسلامية القوية، فتسابقوا إلى مصادقة مَن عاداهم في الدِّين مدّعين أنّ ذلك من الحزم ليجدوهم عند الحاجة، فما راعهم إلّا انقلابهم عليهم، وما قصّة فلسطين ببعيد منذ الحرب العالمية الأولى واحتلال أجزاء العالم الإسلامي»[10].
وفي مقابل نقده لأهل السلطة فإنّه كان يشيد بالعدل والديمقراطية، حيث قال: «أي: ما كنتُ متخذةً قرارًا إلّا بعد موافقتكم عليه، وهذا شأن الدول الديمقراطية في كلّ عصر، وهو ما أمر به الإسلام، فقال: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾ [آل عمران: 159]، فلا يستبدّ الحاكم المسلم باتّخاذ القرارات إلّا بعد أخذ رأي أهل الحلّ والعَقد من النزهاء المخلصين لدينهم ولأمّتهم»[11]. كما أشاد الشيخ الصادق بنموذج تقسيم السلطات، وهو بذلك يدعو إلى تطبيق هذا النموذج في واقعه مبينًا وجوب التعاون بين الحكّام والمحكومين لتطبيقه[12]. وبهذا التصوّر يكون الشيخ الصادق قد قام بوضع اللبنة الأولى في مشروع إصلاح النظام السياسي وتقويمه وجَعْله نظامًا عادلًا يقوم على الشورى والتشاور وقبول الرأي المخالف والنصيحة التي فيها خير للحاكم والمحكومين.
2- اعتماده في تفسيره على تفسير القرآن بالقرآن:
ويعتبر تفسير القرآن بالقرآن من أهمّ معالم التفسير بالمأثور، الذي يشتمل كذلك على التفسير بالحديث النبوي وأقوال الصحابة والتابعين، وقد أكّد العلماء على وجوب العمل به وقالوا بأنّه من أصحّ الطرق في التفسير، وفي هذا السياق قال ابن تيمية: «فإن قال قائل: فما أحسن طرق التفسير؟ فالجواب: إنّ أصحّ الطرق في ذلك أن يفسّر القرآن بالقرآن، فما أُجمِل في مكان فإنّه قد فُسِّر في موضع آخر»، وقال الشنقيطي: «إنّ أشرف أنواع التفسير وأجلّها تفسير كتاب الله بكتاب الله؛ إِذْ لا أحد أعلم بمعنى كلام الله -جلّ وعلا- من الله جلّ وعلا»[13].
وقد اعتمد الشيخ السياري هذه الطريقة في تفسيره، حيث كان يكثر من تفسير القرآن بالقرآن، وقد توخّى عدّة طرق في هذا السياق؛ من ذلك تفسير ما جاء موجزًا في موضع بما جاء مبسوطًا في موضع آخر، والأمثله على ذلك كثيرة، ولعلّ أهمّ مثال في هذا السياق تفسيره لقوله تعالى: ﴿صِرَطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ [الفاتحة: 7]، نجده يكثر من الاستشهاد بالقرآن، حيث قال: «أي: أرشِدْنَا إلى السّير في حياتنا إلى طريق الصواب، والمتمثّل في طريق مَن أنعمتَ إليهم بالتوفيق والهداية... من الذين وفَّقَهُم إلى اتّباع ما فيه: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا * فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا﴾ [النساء: 174- 175]، ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [الأنعام: 153]»[14].
واعتمد في المقام الثاني حمل العامّ على الخاص، وذلك عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَة وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [البقرة: 254]، قال الشيخ الصادق في تفسير هذه الآية: «أي: إذا جاء يوم القيامة لم ينفع المالُ صاحِبَه بوجه من الوجوه، فلا فداء به لصاحبه ولو جاء بملء الأرض ذهبًا، ولا صداقةُ صاحبه: ﴿الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ﴾ [الزخرف: 67]، ولا شفاعة مثل ما كان لهم في الدنيا عند الملوك والأمراء»[15].
وثالثًا على حملِ المطلق على المقيَّد، ومثال ذلك ما وردَ في تفسيره لقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [المائدة: 3]، قال الشيخ الصادق في تفسيره للآية : «الثاني: الدم، والمراد به الدم المسفوح كما نصّت عليه آية الأنعام: ﴿دَمًا مَسْفُوحًا﴾ [الأنعام: 145]، الذي يخرج من عروق جسد الحيوان»[16]. وهو بقوله هذا حمل مطلق لفظ الدم على ما ورد مقيدًا في سورة الأنعام؛ وذلك لاشتراكهما في الحكم وهو الحُرْمة، وهو السبب (المقصد) الذي بُني عليه حكم التحريم[17]. كما قام بحمل ما جاء مجملًا في آية معيّنة على ما ورد مبيّنًا وواضحًا في آية أُخرى، وتعتبر هذه الطريقة من أصحّ طرق التفسير كما قال ابن تيمية[18]، ومن أمثلة هذا النوع في تفسير الشيخ الصادق ما ذكره في تفسيره لقوله تعالى: ﴿فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾ [البقرة: 37]، حيث قال: «أي: أُلْهِمَ آدم كلمات طلب التوبة من ربه، وهي قوله: ﴿قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [الأعراف: 23]»[19]، فيمكن ملاحظة أنّ الشيخ الصادق حمل هنا لفظ ﴿كلمات﴾، وهو لفظ مُجْمل، على ما ورد في سورة الأعراف الذي جاء مبينًا وموضحًا ومزيلًا للغموض والإبهام الذي ورد في سورة البقرة، وهذا ما أورده المفسِّرون قبله كالطبري، الذي نسب هذا القول لمجاهد وقتادة وابن زيد[20]، واعتمد الشيخ في تفسيره طريقة حَمل المبهم على المعيّن[21].
3- قلّة استشهاده بالأحاديث الضعيفة:
لقد كان الشيخ الصادق في تفسيره للقرآن يستشهد بالسنّة وهذا ما يمكن لقارئ تفسيره ملاحظته، لكنّه لم يكن كسابقيه الذين يأتون بكلّ الآثار الواردة في تفسير الآية، بل كان يتخيّر، وهذه الميزة جعَلَت تفسيره يكاد يخلو من الأحاديث الضعيفة والموضوعة، وهذا الأمر لم يمنع من وجود ستّة أو سبعة أحاديث ضعيفة أو موضوعة في تفسيره، ومثال ذلك ما أورده في فضائل آية الكرسي، حيث قال: «من قرأها إذا أخذ مضجعه أمّنه الله على نفسه وجاره وجار جاره»[22]. كما يذكر أثرًا وينسبه للرسول -صلّى الله عليه وسلّم-: (اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدًا، واعمل لآخرتك كأنّك تموت غدًا)[23]، وذلك عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ [المنافقون: 9].
4- كثرة اعتماده على تفسير القرآن بأقوال الصحابة:
وهذا الجانب نجده عند كافة المفسّرين للقرآن؛ وذلك لكون الصحابة أعلم الناس بالقرآن؛ لأنّه نزل فيهم وفي زمانهم، وقد أثنى عليهم الرسولُ -صلّى الله عليه وسلّم- في عدّة أحاديث، منها قوله: (يأتي على الناس زمان فيغزو فئامٌ من الناس، فيقولون: فيكم مَن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون لهم: نعم، فيُفتح لهم. ثمّ يأتي على الناس زمان فيغزو فئامٌ من الناس، فيُقال: فيكم مَن صاحب أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم؟ فيقولون: نعم، فيُفتح لهم. ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئامٌ من الناس، فيُقال: هل فيكم مَن صاحب مَن صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم، فيُفتح لهم)[24]؛ ولذلك فقد نصح علماء الأمّة ودعوا إلى الأخذ بأقوال الصحابة في التفسير، وقد ذهب الحاكم إلى أنَّ الشيخين (البخاري ومسلم) يعدّان تفسير الصحابي من قَبِيل المسند (المرفوع)، فقال: «إنّ تفسير الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل عند الشيخين حديث مسند»[25]، وقال ابن تيمية: «وحينئذ إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنّة رجعتُ في ذلك إلى أقوال الصحابة؛ فإنهم أدرى بذلك لِما شاهدوه من القرآن والأحوال التي اختصّوا بها، ولِما لهم من الفهم التامّ والعلم الصحيح والعمل الصالح، لا سيما علماؤهم وكبراؤهم؛ كالأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين وعبد الله بن مسعود»[26]؛ ولذلك نجد الشيخ الصادق يُكثر من الاستشهاد بأقوال الصحابة، ولا يكتفي بإيرادها، بل يتبنّاها في أكثر الأحيان؛ حيث نجده يستشهد بأقوالهم عند بيانه لمسألة فقهية، من ذلك تفسيره لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة: 183]، قال: «وفي الصحيحين عن عائشة -رضي الله عنها- كان يوم عاشوراء يومًا تصومه قريش في الجاهلية»[27]، وقد استشهد بقول عائشة عند بيانه لفرضية الصيام واشتراك الأمم التي جاءت في الصيام. ومن أمثلة ذلك أيضًا بيانه المدّة القصوى لغياب الرجل عن زوجته بسبب الجهاد، حيث قال: «وقد رُوي عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أنّه اتّصل بنساءٍ كان أزواجهن في الجهاد، فسأل بعضًا منهن عن أقصى مدة تقدِر أن تصبر عن زوجها، فأجبن بأنّ أقصى مدّة صبر ذات الزوج أربعة أشهر، فجعل لكلّ المجاهدين المتزوجين الرجوع بعد مضيّ أربعة أشهر إلى أزواجهنّ وتعويضهم بغيرهم»[28]، كما قال في ختام استشهاده بقصة عمر: «وهذا إذا ثبت يقوي اختصاص مدّة الإيلاء بأربعة أشهر»[29]. ومن أمثلة ذلك أيضًا ما ذكره في تفسيره لقوله تعالى: ﴿فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا﴾ [النجم: 62][30]، حيث أوردَ قول زيد بن ثابت عند ذِكْره مسألة سجود التلاوة، حيث قال: «ففي الصحيحين عن زيد بن ثابت، قال: قرأتُ النجم عند النبي -صلّى الله عليه وسلّم- فلم يسجد فيها»[31]. كما نجده عند بيانه لمسألةٍ عقدية؛ وهي وظيفة الملائكة، يستشهد بقول الصحابيَّيْن عليّ وابن عبّاس -رضي الله عنهما- حيث قال في وظيفة الملائكة: «يحفظونه من كلِّ أسباب الهلاك لُطْفًا من الله به، فإذا جاء القدر خلّوا بينه وبينه»[32].
5- كثرة استشهاده بأقوال التابعين خاصّة فيما يتعلّق بأسباب النزول:
والتابعيّ هو مَن لَقِيَ الصحابي[33]، وبهذا التعريف يكون التابعون أقربَ الناس إلى الصحابة، وقد قال الرسول -صلّى الله عليه وسلّم- مادحًا مَن رآه أو رأى أصحابَه: (لا تزالون بخير ما دام فيكم من رآني وصاحَبَني، واللهِ لا تزالون بخير ما دام فيكم مَن رأى مَن رآني وصاحَب مَن صاحَبَنِي)[34]. وقال -صلّى الله عليه وسلّم- أيضًا: (لا تمسّ النار مسلمًا رآني أو رَأَى مَن رآني)[35]. وعلّق عليه المباركفوري: «إنّ ظاهر الحديث تخصيص الصحابة والتابعين بهذه البشارة»[36]؛ ولذلك قال علماء الأمّة بإمامتهم وفضلهم وعِلْمهم بتفسير القرآن، وخير مثال على ذلك أقوال العلماء في مجاهد بن جبر، حيث قالعنه الثوري: «إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به»[37]، وقال عنه يحيى القطان: «وأجمَعَت الأُمّة على إمامة مجاهد والاحتجاج به»[38]، وقال هو عن نفسه: «عرضتُ القرآنَ على ابن عباس ثلاث عرضات، أقف عند كلّ آية، أسأله: فيمَ نزلت؟ وكيف كانت»[39]. ولهذه المكانة التي يحظى بها التابعون فقد كان الشيخ في تفسيره يُكْثِر من أقوالهم في تفسير الآيات؛ وخاصّة مجاهد وقتادة بن دعامة السدوسي في المقام الأوّل، ثمّ مقاتل بن سليمان، ومن أمثلة ذلك ما ذكره في تفسير قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [البقرة: 240]، قال: «المختار في تفسير هاته الآية هو ما فسّره بها مجاهد على ما رواه البخاري[40]، قائلًا في ذلك: إنّ الله شرع العدّة أربعة أشهر وعشرًا، تعتدّ عند أهل زوجها وجوبًا»[41]، فالشيخ الصادق لا يكتفي بالاستشهاد بقول مجاهد، بل إنه قام بترجيحه، وذلك بقوله: «فالمختار في تفسير هاته الآية...». ومن ذلك أيضًا ما ذكره عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَة فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾ [النساء: 11]، حيث قال: «أي: فحظّ الأمّ من التركة السدس من المال، والباقي للأب؛ لأنّه كما[42] قال قتادة: يمونهم وينفق عليهم ويلي نكاحهم»[43]، وهو هنا يستشهد به ويدعم رأيه ويحتجّ به.
ومن أمثلة ذلك أيضًا تفسيره لقوله تعالى: ﴿يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ [الأحقاف: 31]، يقول: «وهذا يقضي أنّ الجنّ مأمورون بالإسلام. قال مقاتل: ولم يَبعثِ الله نبيًّا إلى الجنَّ قبل محمد صلّى الله عليه وسلّم»[44].
وكان الشيخ الصادق يكثر من الاستشهاد بقول التابعين عند بيانه لسبب نزول الآيات والسور، من ذلك ما ذكره عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا﴾ [النساء: 89]، قال: «والآية نزلت -حسب رواية مجاهد- في قوم من أهل مكة أظهروا الإيمان وهاجروا إلى المدينة، ثم استأذنوا في الرجوع إلى مكة ليأتوا ببضاعة يتاجرون فيها وزعموا أنّهم لم يزالوا مؤمنين، فاختلف المسلمون في شأنهم، ففضحهم الله بما أنزل في شأنهم في وصف دخائلهم»[45].
6- نقده للإسرائيليات ودعوته لتنقية كتب التفسير منها:
يمكن تعريف الإسرائيليات بأنّها: «مصطلح مشتقّ من لفظة بني إسرائيل، ويطلق على القصص والحكايات والأخبار الدخيلة على تفسير القرآن الكريم والحديث، ومصدرها التراث اليهودي المتمثل فيما تبقى مع بني إسرائيل من التوراة، وما تبعها من تعاليم والتراث النصراني المتمثِّل أيضًا في مجموعة الأناجيل وشروحها، ويضاف إلى هذا أخبار القصّاص وحكاياتهم، يطلق على هذا التراث الدخيل جميعه لفظة الإسرائيليات من باب التغليب؛ لأنّ أكثره دخل عن طريق اليهود، سواء من أسلم منهم أو من اختلط بالمسلمين»[46].
فالإسرائيليات هي إذن أخبار دخيلة على الإسلام أصلها يهودي، ويمكن إرجاع تسرّب هذه المرويات الدخيلة على الإسلام إلى أسباب اجتماعية ودينية وهو ما ذهب إليه ابن خلدون[47]. وقد كان الشيخ الصادق دائم النقد والتشكيك في هذه الروايات، حيث قال: «الخطاب لرسول الله صلّى الله عليه وسلّم، أي: ما سبق من أمرك بالتوجه إلى المسجد الحرام أنت وأتباعك هو الحقّ الذي لا شكّ فيه، فلا تجلس إليهم لتستمع لِما يثيره المعاندون من الشُّبَه والشكوك ليصرفوا الناس عن اتّباع الإسلام، فإن استمعتَ لِما يثيرونه من الشبهات وانطلَتْ عليك أكاذيبهم فقد صرتَ من الممترين فيما أُنزل عليك من الكتاب، وهذا تحذير من الله تعالى للمؤمنين بأن لا يجلسوا إلى أهل الكتاب ويستمعوا إلى مناقشاتهم السفسطائية بعنوان حرية الفكر؛ للطعن في التشريع الإسلامي وما احتوى عليه من التعاليم الإلهية، ليقنعوا أتباعه بأنّ الإسلام لم يَعُد صالحًا في هذا العصر الحاضر...»[48].
وهو بكلامه هذا يبدو متأثِّرًا بالمدرسة التفسيرية الحديثة والتي من أعلامها محمّد رشيد رضا والمراغي ومحمّد حسين الذهبي، فمثلًا يقول رضا في تفسيره المنار ناقدًا للتفاسير التي يورد أصحابها مثل هذه الأخبار: «كما ولعوا بحشوها بالقصص والإسرائيليات التي تلقّفوها من أفواه اليهود وألصقوها بالقرآن لتكون بيانًا له وتفسيرًا، وجعلوا ذلك ملحقًا بالوحي غير ما تدلّ عليه ألفاظه وأساليبه إلّا ما ثبت بالوحي عن المعصوم الذي جاء به ثبوتًا لا يخالطه الريب»[49]، وقال أيضًا: «فنأخذ القرآن على ما هو عليه لا ندخل فيه شيئًا من الروايات الإسرائيلية التي ذكروها وهي صارفة عن العبرة لا مزيد كمال فيها»[50].
وهذا الكلام نجد له نظيرًا عند الشيخ الصادق عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿قَالَتْ رَبِّ إِنّيِ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [النمل: 44]، حيث ردّ الروايات الواردة في زواج سليمان بملكة سبأ[51]، وقال: «وما يروى في قصّة سليمان معها مما رواه بعض المفسّرين فلا يعتمد عليه ولا اعتماد إلّا على ما ذكره القرآن، من روايتهم تزوُّجها وإنجاب الولد منها؛ إِذْ لا يتعلّق بذلك غرض في أمور الدِّين»[52]، والشيخ الصادق في قوله هذا دعوة صريحة إلى ترك الأخذ بالإسرائيليات، وإشارة إلى خطورتها وضرورة تنقية كتب التفسير منها، وهو ما دعا إليه الدكتور محمد حسين الذهبي[53].
7- قلّة اعتماده على تفسير القرآن باللغة:
يُعتبر تفسير القرآن باللّغة من أهمّ معالم مدرسة التفسير بالرأي، وقد برز منهم علماء متقنون ألّفوا مصنّفات حول مفردات القرآن واللغة؛ كلسان العرب لابن منظور، وأساس البلاغة للزمخشري، ومقاييس اللغة لابن فارس، وتهذيب اللغة للأزهري، كما صنّفوا تفاسير اهتمّت بالجوانب اللغوية والبلاغية ومعاني القرآن؛ ككتاب معاني القرآن للأخفش والفرّاء والزجّاج، وكذلك ألّفت كتب في تفسير غريب القرآن ومفرداته؛ مثل كتاب الغريبين في القرآن والحديث للهروي، وكتاب تفسير المشكل من غريب القرآن العظيم على الإيجاز والاختصار، وكتاب غرائب التفسير وعجائب التأويل للكرماني، وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة، وكتاب المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني، وكتاب تذكرة الأريب في تفسير غريب القرآن الكريم لابن الجوزي، إلى غير ذلك من العلوم. إلّا أنّ الشيخ الصادق كان مقلًّا في هذا الجانب خلافًا لشيخه محمّد الطاهر بن عاشور، ويظهر ذلك في قلّة استشهاده بالشِّعْر، حيث إنّه اكتفى بإيراد استشهادات شِعْرية في ستّة مواضع من تفسيره دون نسبتها إلى أصحابها[54]، من ذلك ذِكْره لبيت شعري عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ﴾ [الجاثية: 24]، يذكر بيتًا شعريًّا معتمدًا نفس المنهج الذي دأب عليه في هذا السياق، حيث قال: «والمؤثِّر في إهلاك الأنفس، كقول شاعرهم[55]:
أشاب الصغير وأفنى الكبير ** كرّ الغداة ومرّ العشيّ[56]
كما استعان الشيخ الصادق في بعض الأحيان بأقوال علماء اللّغة، ومثال ذلك ما أورده عند تفسيره لآية: ﴿إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ [يونس: 61]، نجده يقول: «يعني اللّوح المحفوظ مع علمه تعالى، قال الجرجاني: «﴿إِلَّا﴾ هنا بمعنى واو العطف، والمعنى هو في كتاب مكنون»[57]. ويتميّز تفسير الشيخ في هذا الجانب بإيراد ألفاظ دخيلة على اللّغة العربية هي تنتمي للغة الفرنسية، ومثال ذلك ما ذكره عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا﴾ [الأنفال: 17]، وصفَ المؤمنين الصابرين بقوله: «وكانوا يسمّونهم الجند الذي لا يقهر Les invaincus»ـ[58]، وهو ما ذكره أيضًا عند تفسيره للآية السادسة والعشرين من نفس السورة[59]. كما أنّه عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾ [الأنفال: 31]، يقول: «وهي كلمة أعجمية يقصد بها التاريخ L’histoire»ـ[60].
كما يعتمد الشيخ الصادق في تفسيره بعض الألفاظ من اللهجة العامية التونسية، وذلك راجع حسب رأيي إلى إرادته تبسيط القرآن وتقريبه إلى عامة الناس في مجتمعه خاصّة منهم كبار السنّ الذين تنتشر في أوساطهم الأميّة والجهل، والذين هم لا يستطيعون القراءة والكتابة، ومثال ذلك عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً﴾ [البقرة: 26]، قال: «والبعوضة هي الناموسة في لغة أهل تونس»[61]. وكذلك عند بيانه للفظ قِثّائها، يقول: «قِثّاؤها الفقوس»[62]، كما نجده يذكر ألفاظًا متعارفًا عليها للمحاربين لله ورسوله المفسِدين في الأرض، حيث قال: «وهم المسمَّون بالعامية الجيّاشة الذين يعترضون النّاس في مرورهم بالأماكن المخوفة بالجبال، ويسمّونها خنقة يسمّونها باسم محتلّها كخنقة عرّام بوادي الزرقاء»[63]. كما يذكر لفظًا من العاميّة التونسية عند وصفه لعذاب الكفّار، فقال: «شبّه عذاب الكفّار بدردي الزيت»[64].
8- استعانته بالعلم الحديث في تفسيره:
اعتمد الشيخ الصادق على تفسير الآيات الكونية بالقواعد العلمية والطبيّة والفلكية، وهو في هذا السياق -حسب رأيي- يتّبع الرأي الثالث، وهو رأي الذين يجوِّزون التفسير العلمي بشروط، وهو يتّبع في هذا السياق شيخه ابن عاشور والعلّامة الآلوسي والشيخ محمد رشيد رضا، والأمثلة على ذلك كثيرة[65]. مثل ما أورده عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ﴾ [يس: 38]، التي قال في تفسيرها : «الشمس نجم كالنجوم الأخرى التي تُزيِّن السماء، وهي تبدو من الأرض التي تدور حولها مضيئة لقربها منها مرة في السنة، فالشمس هي القلب النابض للمجموعة الشمسية إلّا أنّها إذا قُورنت بمجموع المليارات من النجوم الأخرى السابحة في الفضاء الكوني تبيّن أنها نجم متوسط الحجم؛ فقطرها 1.392.400 كيلو مترًا ويفوق حجمها حجم الأرض 1.300.000 مرة، وتبلغ مسافة الشمس الوسطى عن كوكبنا الأرض 149.631.000 كيلو مترًا، والضوء الذي يذرع الفضاء بسرعة 297.000 في الثانية يحتاج إلى ثماني دقائق وثلاثة أرباع الدقيقة تقريبًا كي يقطع هاته المسافة، وتشير الدراسات العلمية إلى أنّ مصدر الحرارة في الشمس يأتي من انضغاط سطحها، وأنّها تشعّ منذ ما يقارب 4.500 مليار ونصف، وأنّه يمكن النظر إليها كفرنٍ ذرّي تشبه إلى حدّ بعيد القنبلة الهيدروجينية، والواقع أنّه يجري في باطن الشمس تحوّل مستمرّ للهيدروجين إلى هليوم، ويدرك العلماء أنّه سيأتي على الشمس يوم ينفد فيه الهيدروجين منها وستتوقف عن إصدار الضوء والحرارة: ﴿وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى﴾ [الرعد: 2]، وإذا كان للشمس أجلٌ مسمّى من حيث الزمان، فإنّ لها كذلك مستقرًّا من حيث المكان، ﴿وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا﴾ [يس: 38]، والمستقرّ هي نقطة في فلك هرقل بجوار (فيغا)، تجري الشمس نحوها بسرعة تسعة عشر كيلو مترًا في الثّانية»[66]، وفي نهاية كلامه، قال: «وقد أخذتُ هاته المعلومات من الموسوعة العلمية، المجلّد الأول». وهو بكلامه هذا يثبت دوران الأرض حول الشمس، وأنّ الشمس غير ثابتة بل لها حركة لولبية[67]، فكلام الشيخ الصادق مبني على أحدث الاكتشافات العلمية التي قامت بها وكالة ناسا الأمريكية[68].
9- طغيان البُعد المقاصدي عند بيانه للأحكام الشرعية:
يبدو الشيخ الصادق شديد التأثّر بالشيخ ابن عاشور الذي ركّز على البُعد المقاصدي للشريعة في تفسيره التحرير والتنوير، وكذلك في كتابه مقاصد الشريعة الإسلامية، وهو ما جعله يُولِي أهمية بالغة لهذا الجانب عند تفسيره لآيات الأحكام في عدّة مواضع ذكرتها في بحث الدكتوراه، ومن أمثلة ذلك ما ذكره من مقاصد الصلاة، حيث قال: «فالصلاة تحفظ التوازن بين مطلبي المادة والروح، فالصلاة بالنسبة للروح في أوقاتها المعلومة وجبة روحية مثل وجبة الطعام للجسم، وبذلك علّل نهيها عن الفحشاء والمنكر؛ إِذْ تَرْكها يؤدي إلى تغلّب الماديّة فينزلق الإنسان في الموبقات»[69]، وقال أيضًا: «والصلاة العبادة المعروفة التي هي الاتجاه إلى الخالق سبحانه بطلب المعونة على كلّ ما كلّف به الإنسان لسعادته وهو شاقّ عليه؛ لأنه لولا معونة الله لعبده وتيسير ذلك له لَما استطاع القيام بالتكاليف الشرعية والدوام على ذلك، فالاتجاه بالصلاة للمعبود قوة لضمان واستمرار القيام بما ذكر؛ لأنّ الله مع الذين صبروا...»[70]، والشيخ الصادق محقّ في هذا الجانب، فقد كان الرسول -صلّى الله عليه وسلّم- يقول: (أرحنا بها يا بلال)[71]. كما يُذكِّر بمقاصد وفوائد الصيام، وذلك بقوله: «وهو من العبادات البدنية الراجعة إلى تزكية النفس وتهيئتها لتقوى الله بمراقبته في السرّ والعلانية»[72].
10- انتصاره لعقيدة التوحيد:
لقد انتصر الشيخ الصادق في تفسيره لعقيدة التوحيد، حيث نجده متأثِّرًا بشيخه عثمان بن المكّي التوزري، وكذلك بالمراغي ومحمّد رشيد رضا، وهو ما جعله يتبنّى مواقفهم، فالشيخ ينتصر لتقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام وهي: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصّفات[73]. وقد توخّى الشيخ الصادق في تفسيره لصفات الله تعالى وأسمائه الحسنى طريقة السّلف التي تقوم على إثبات الصفات مع تنزيه الله تعالى عن التجسيم والتشبيه والتكييف، ومثال ذلك: إثباته لرؤية الله في الآخرة، وذلك عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [يونس: 26]، حيث قال: «أي: للذين أحسنوا في الدنيا بالطاعة والخشية من عقاب ربّهم وامتثلوا لكلّ ما أمرهم ربّهم ونهاهم عنه ووقفوا عند حدوده، هؤلاء لهم الحسنى جزاءً وهو الجنّة وما احتوت عليه من النعيم الخالد، وزيادة على ذلك النعيم وهي النظر إلى وجه الله الكريم»[74].
وقال الشيخ الصادق مبينًا الكلام الذي كلّمه الله لموسى: «أي: ميّزه الله بكلام خاصّ مميز له عن غيره من الرسل والأنبياء لا يعلم كيفية ذلك إلا الباري جلّ وعلا، وليس لنا أن نخوض في كيفية ذلك، بل نؤمن بما نصّ عليه القرآن ونُحِيل العلم إلى الله تعالى؛ إِذْ لم يكلّفنا غير ذلك»[75]. وهو ما أكّده عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿قَالَ يَا مُوسَى إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَتِي وَبِكَلَامِي﴾ [الأعراف: 144]، حيث قال: «أي: اخترتك وفضّلتك على جميع أهل زمانك من الناس برسالتي إلى بني إسرائيل وبكلامي لك بلا واسطة ملك، وإن كان من وراء حجاب»[76]. وهو بهذا الكلام يتّبع منهج أهل السنّة الذين أثبتوا لله ما أثبته لنفسه، فقد قالوا بأنّ الله كلّم موسى على الحقيقة دون الخوض في كيفية ذلك، فأثبتوا له -سبحانه وتعالى- الكلام[77]، فكلام الله غير متناه، وهذا ما أثبته الشيخ الصادق عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا﴾ [الكهف: 109]، حيث قال: «ولا تنفد كلمات الله؛ لأنها غير متناهية»[78]، وكلامه -عزّ وجلّ- لا يحتاج إلى ما يحتاج إليه الإنسان من أدوات كاللسان والشفة والحنجرة.
وهو نفس المنهج الذي اعتمده في إثبات استوائه عزّ وجلّ، حيث قال: «نُحِيل عِلْم ذلك إلى مَن أَنزلَ القرآن، ونؤمن ونقول: ﴿كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا﴾ [آل عمران: 7]، والعرش في اللغة الكرسي العظيم الذي يجلس عليه الملك»[79]. وهذا ما فسّر به الإمام مالك قوله تعالى: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ [طه: 5]، حيث قال: «الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة»[80].
كما نجده يقول بزيادة الإيمان ونقصانه، وهذه عقيدة أهل السنّة بخلاف الجبرية، وذلك عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ﴾ [محمد: 17]: «المعنى أنّ الذين اهتدوا بالإيمان والاستماع إلى القرآن زادهم اللهُ بصيرةً وعلمًا وشرحَ صدورهم وأعانهم على تقواه»[81]، في حين المنافقين يطبع الله على قلوبهم، وذلك مصداقًا لقوله تعالى: ﴿أُوْلَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ﴾ [محمد: 16]، يقول الشيخ بلخير: إنّ هؤلاء المنافقين: «طبع الله على قلوبهم فلم يؤمنوا ولم ينتفعوا بما سمعوا من رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- واتّبعوا أهواءهم في الكفر والنفاق فأمات الله قلوبهم فلم تفهم ولم تعقل»[82]، نستشفّ مما سبق ذِكره بأنّ الإيمان يزيد وينقص حتى إنّه يبلى كما يبلى الثوب، ويبتلى صاحبه أيثبت أم يكفر. فالجزاء بالجنّة لا يكون بالمجان، وإنّما الدنيا امتحان صعب، كما امتحن اللهُ المؤمنين في غزوة الأحزاب، حيث يقول الشيخ بلخير في هذا السياق: «بعد انتهاء الامتحان بالثبات حسب وعدِه وبيع المؤمنين أنفسهم في سبيل إعلاء كلمة الله والاتّكال عليه، وجاء بالآية 173 من سورة آل عمران وهو قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾، أي: ما زادتهم رؤية الأحزاب وكثرتهم إلّا قوة إيمان في نصر الله لهم والتسليم لقضائه؛ لأن الامتحان الذي واجهوه في غزوة أحد هذّبهم وربّاهم وأزال عنهم كلّ التباس في الوثوق بنصره للمخلصين في جهادهم، ﴿فَانقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ﴾ [آل عمران 174][83].
وبهذا القول فإنّ الشيخ بلخير لا يخرج عن منهج أهل السنّة الذين يقولون بأنّ الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، حيث قال ابن عبد البرّ: «أجمع أهل الفقه والحديث على أنّ الأيمان قولٌ وعملٌ، ولا عمل إلّا بنيّة، والإيمان عندهم يزيد بالطّاعة وينقص بالمعصية، والطاعات كلّها من الإيمان»[84]، ويقول الأصفهاني[85]: «والإيمان قول وعمل ونيّة، يزيد وينقص، زيادته البرّ والتّقوى، ونقصانه الفسق والفجور».
كما يتبنّى الشيخ الصادق عقيدة أهل السنّة فيما يتعلّق بمآل مرتكب الكبيرة، حيث يقول عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا﴾ [النساء: 48]، أي: لا يؤاخذ على بقية الذنوب المرتكبة من العبد بالتوبة النصوح على من يشاء من عباده؛ لأنّه تعالى غني رحيم لا يريد لعبده إلّا الخير والسعادة؛ ولذلك بعث الرسل لإرشاده إلى طريق السعادة»[86]. كما أنّه ربط خلود العصاة في جهنم بمشيئة الله، وذلك عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ﴾ [هود: 106- 107]، قال: «تفصيل لجزاء الأشقياء بالمكث في جهنّم مع اتّصافهم فيها بالزفير، وهو إخراج الأنفاس بدفع وشدّة بسبب ضغط التنفّس، والشهيق عكسه... ﴿مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ﴾ أي: خلود لا خروج منه ما دامت له سماؤهم التي فوقهم وأرضهم التي تحتهم في جهنم، فما فوقهم سماء وما تحتهم أرض، وليس المراد بالسماوات والأرض الموجودة الآن؛ إِذْ هي عند فناء العالم تُبدَّل غير هاته لـمّا قال: ﴿يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَحِدِ الْقَهَّارِ﴾ [إبراهيم: 48]، ﴿إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ﴾ إخراجه منها وعدم مشيئته الخلود له فيخرج منها بالأسباب التي ييسرها اللهُ لصاحبه من شفاعة أو ما لا يعلمه إلا الله، ﴿إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ﴾ علّة لتعليق الخلود في النار والخروج منها بمشيئته تعالى؛ لأنه يفعل ما يريد لا يُسأل عمّا يفعل في ملكه وخَلقه»[87].
فالشيخ الصادق يقول بأنّ مرتكب الكبيرة في النار؛ ذلك أنّه لا يستحقّ بعمله الجنّة، ولكنه يذهب إلى جواز إخراج الله له منها فهو واقع تحت مشيئته، أو قد يخرج منها بشفاعة النبي -صلّى الله عليه وسلّم- حيث ثبت عن النبي أنّه قال: (يُخرِجُ الله أُناسًا من المؤمنين من النار بعدما يأخذ نقمته منهم. قال: لمّا أدخلهم اللهُ مع المشركين، قال المشركون: أليس كنتم تزعمون في الدنيا أنكم أولياء، فما لكم معنا في النار؟ فإذا سمع اللهُ ذلك منهم، أَذِنَ في الشفاعة فيتشفع لهم الملائكة والنبيّون حتى يخرجوا بإذن الله. فلمّا أُخْرِجوا قالوا: يا ليتنا كنّا مثلهم فتدركنا الشفاعة، فنخرج من النار. فذلك يقول الله جلّ وعلا: ﴿رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ﴾ [الحجر: 2]، قال فيسمّون في الجنة الجهنّميِّين من أجل سواد وجوههم، فيقولون: ربّنا اذهِب عنّا هذا الاسم. قال فيأمرهم فيغتسلون في نهر في الجنة فيذهب ذلك منهم)[88]. وأهل السُنَّة مُجمِعون على عدم خُلود عُصاة المُؤمنين في جَهنَّم. قال ابن أبي العزّ الحنفي: «أهل السُّنَّة كلّهم متّفقون على أنّ مرتكب الكبيرة لا يكفر كفرًا ينقل عن الملّة بالكُليَّة كما قالت الخَوارجُ ... ومُتَّفِقُون على أنّه لا يخرج من الإيمان والإسلام ولا يدخل في الكفر ولا يَستحقُّ الخُلود في النَّار مع الكافرين، كما قالت المعتزلة، فإنّ قولهم باطل أيضًا؛ إِذْ قد جعل اللهُ مُرتَكِبَ الكبيرة من المُؤمنين»[89]، وقال الآمدي: «وقال أهل السُّنَّة: إنَّ مُرتكب الكبيرة لا يخرُجُ عن الإيمان بسبب مَعصيته وفِسقه، فهو مُؤمن مع وجود العصيان منه، ثم هو يدخل الجنّة ولا يخلد في النار، وإن دخلها يعذّب فيها على قدر معصيته»[90].
خاتمة:
عرضتُ في هذا المقال للتعريف بتفسير (تسهيل التفسير لمحكم آيات التنزيل)، للشيخ الصادق بلخير السياري التونسي، فعرَّفتُ أوّلًا بمؤلِّفه، وذكرت أبرز ملامح سيرته العلمية والعملية، ثم عرَّفت بأبرز ملامح تفسيره، والتي اشتملت على التعريف بأهمّ مصادره، وأبرز الخصائص التي يلحظها المطالع لهذا التفسير.
والحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
[1] سيكون هذا التقديم بشكلٍ مختصرٍ، ومن أراد الاستزادة والتوسّع فليراجع بحثي المعنون بـ: (منهج الشيخ الصادق بلخير السياري في التفسير).
[2] تبعد هذه المنطقة خمسة عشر كيلو مترًا إلى الجنوب الشرقي من مركز مدينة باجة، وهي تتبع إداريًّا معتمدية باجة الجنوبية، وتشتهر بإنتاجها الفلاحي كالحبوب والزياتين وغيرها.
[3] حقّقه الدكتور نور الدين الجلّاصي، وأيضًا عليّ حسن عبد الحميد.
[4] كما في شهادة العالميّة الممضاة من طرف شيخ الجامع الأعظم محمّد العزيز جعيط والوزير الأكبر الهادي الإخوة.
[5] لسان العرب (3/ 2134- 2135).
[6] عمل اليوم والليلة لابن السنّي، حديث رقم: 351، ص215. وعلّق محقق الكتاب بقوله: «وهو حديث صحيح». وذكره الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم: 2886.
[7] التحرير والتنوير (1/ 11)، مقاييس اللغة، لابن فارس (1/ 818).
[8] حوار أجريته مع حسين الدخلي يوم 10 جوان 2018م.
[9] تسهيل التفسير (4/ 216).
[10] تسهيل التفسير (4/ 322).
[11] تسهيل التفسير (3/ 244، 245).
[12] تسهيل التفسير (1/ 325).
[13] أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، الشنقيطي (1/ 67).
[14] تسهيل التفسير (1/ 12، 13).
[15] تسهيل التفسير (1/ 183).
[16] تسهيل التفسير (1/ 386).
[17] تسهيل التفسير (1/ 386).
[18] مقدمة في أصول التفسير، ص93.
[19] تسهيل التفسير (1/ 37).
[20] تفسير الطبري (1/ 245)، وانظر تفسير ابن أبي حاتم (1/ 91) برقم: 409.
[21] تسهيل التفسير (2/ 210).
[22] تفسير الكشاف (1/ 146)، تفسير القرطبي (3/ 246)، تفسير الرازي (7/ 5)، مدارك التنزيل وحقائق التأويل للنسفي (1/ 132). وذكره ابن عرّاق (أبو الحسن عليّ بن محمّد الكناني) في كتابه (تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة) (1/ 288)، وقال معلّقًا على الحديث: «...ولا يصحّ؛ في الأوّل حبة العرني، وفيه أيضًا نهشل بن سعيد، وفي الثاني محمد بن حمير، وليس بالقوي تفرّد به عن محمد بن زياد الألهاني». ذكره ابن حجر العسقلاني في كتابه (الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف)، ص22، وقال في تعليقه على الحديث: «في إسناده نهشل بن سعيد، وهو متروك، وكذلك حبة العرني... وإسناده ضعيف».
[23] ذكره الشيخ الصادق في تفسيره (4/ 345). الحديث ذكره الهيثمي، بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث، رقم: 1093، ص983، ونسبه لعبد الله بن عمرو بن العاص، بلفظ: (احرز لدنياك كأنك تعيش أبدًا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدًا). ورواه ابن أبي الدنيا في كتابه إصلاح المال، رقم: 49، ص34، ونسبه لعبد الله بن عمرو بلفظ: (احرث لدنياك...). وذكره السيوطي في الجامع الصغير، ص76، رقم: 1201 ورمز إلى ضعفه بحرف (ض). كما ذكره الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة برقم 8، (1/ 63- 65).
[24] صحيح البخاري، حديث رقم: 3649. صحيح مسلم، حديث رقم: 2532.
[25] مستدرك الحاكم، حديث رقم: 3075، (2/ 645).
[26] مقدمة في أصول التفسير، ص95.
[27] صحيح البخاري، حديث رقم: 2000، ص480. صحيح مسلم، حديث رقم: 1125، (1/ 501).
[28] تسهيل التفسير (1/ 156). ذكره عبد الرزّاق بن همام الصنعاني في مصنّفه، حديث رقم: 12593، (7/ 151، 152)، تفسير ابن كثير (1/ 604 و605)، التحرير والتنوير (2/ 387 و388).
[29] تسهيل التفسير (1/ 156)، والشيخ الصادق يتحرّز من هذه الرواية، والرواية جاءت بهذه الصيغة: «فسأل عمرُ ابنته حفصة: كم أكثر ما تصبر المرأة عن زوجها؟ فقالت: أشهر أو أربعة أشهر. فقال عمر: لا أحبس أحدًا من الجيوش أكثر من ذلك». هذا الأثر وردَ في كتاب عمدة التفاسير (1/ 274، 275)، وقد رُوي هذا من طرق، وهو من المشهورات. انظر: تفسير ابن كثير (1/ 605)، وانظر: الدر المنثور (1/ 487).
[30] تسهيل التفسير (4/ 244 و245).
[31] صحيح البخاري، حديث رقم: 1072. صحيح مسلم، حديث رقم: 577.
[32] تفسير الطبري (16/ 371)، تفسير ابن كثير (4/ 438)، عمدة التفاسير (2/ 319)، تفسير ابن أبي حاتم (7/ 2232 و2233)، برقم: 12196 و12198.
[33] تدريب الراوي، للسيوطي (2/ 701).
[34] مصنّف ابن أبي شيبة، حديث رقم: 32957، (11/ 218)، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (10/ 20)، وقال: «رواه الطبراني من طرق، ورجال أحدهما من طرق رجال الصحيح».
[35] سنن الترمذي، حديث رقم: 3858، وقال: «حسن غريب لا نعرفه إلّا من حديث موسى بن إبراهيم الأنصاري»، ذكره الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (7/ 63)، برقم: 3283.
[36] تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي، للمباركفوري (10/ 243).
[37] تفسير الطبري (1/ 30).
[38] ميزان الاعتدال، للذهبي (3/ 439).
[39] حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، لأبي نعيم الأصبهاني (3/ 279 و280).
[40] صحيح البخاري، حديث رقم: 4531.
[41] انظر: تسهيل التفسير (1/ 174).
[42] انظر: تسهيل التفسير (1/ 295).
[43] تفسير القرطبي (5/ 64).
[44] تسهيل التفسير (4/ 151)، وقد نقل هذا القول من تفسير القرطبي (7/ 78)، وتفسير البغوي (7/ 270).
[45] ذكره الشيخ الصادق في تفسيره (1/ 339)، وقد نقله من كتاب أسباب النزول للواحدي، ص172، برقم: 342 مكرر، وهذا الأثر مرسل.
[46] الموسوعة العربية العالمية (1/ 758).
[47] مقدمة ابن خلدون (2/ 175 و176(
[48] تسهيل التفسير (1/ 97 و98).
[49] تفسير المنار (1/ 175).
50تفسير المنار (2/ 457).
[51] تفسير بن أبي حاتم (7/ 2897). وتفسير الكشف والبيان، للثعلبي (4/ 501). وتفسير مقاتل بن سليمان (3/ 309، 310).
[52] تسهيل التفسير لمحكم آيات التنزيل (1/ 248).
[53] الإسرائيليات في التفسير والحديث، ص167- 170.
54 انظر أطروحتي للدكتوراه، بعنوان: (منهج الشيخ الصادق بلخير السياري في التفسير)، ص206- 208.
[55] تسهيل التفسير (4/ 135).
[56] هذا البيت قاله الصلتان العبيدي وقد نقله الجاحظ في كتاب الحيوان (3/ 230)، وأيضًا ابن قتيبة في كتابه الشعر والشعراء (1/ 478).
[57] تسهيل التفسير (2/ 250)، وهذا الكلام نقله من تفسير القرطبي (8/ 266)، وانظر أيضًا تفسير الرازي (17/ 130)، وتفسير البحر المحيط (5/ 172).
[58] تسهيل التفسير (2/ 117).
[59] تسهيل التفسير (2/ 117).
[60] تسهيل التفسير (2/ 125).
[61] تسهيل التفسير (1/ 30).
[62] تسهيل التفسير (1/ 48).
[63] تسهيل التفسير (1/ 406).
[64] تسهيل التفسير (4/ 124)
65 منهج الشيخ الصادق بلخير السياري في التفسير، ص215- 228.
[66] تسهيل التفسير (4/ 462). وهذا الكلام نجد له نظيرًا في عديد المراجع الحديثة، مثل: المعجزة الخالدة الإعجاز العلمي في القرآن، الصلابي، ص45- 49، وأيضًا: موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنّة المطهّرة، إعداد: يوسف الحاج أحمد، ص305- 307.
[67] كتاب الإعجاز العلمي في القرآن، لعبد السلام اللوح، ص170.
[68] للاستزادة، انظر موقع: www.physicsforums.com/blog.php، وانظر أيضًا كتاب: الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، ص170- 171.
[69] تسهيل التفسير (3/ 309، 310).
[70] تسهيل التفسير (1/ 101).
[71] المعجم الكبير للطبراني، حديث رقم: 6215، (6/ 277) واللفظ له، مسند الإمام أحمد، رقم: 23088، (38/ 178)، سنن أبي داود، رقم: 4985 و4986.
[72] تسهيل التفسير (1/ 120).
[73] منهج الشيخ الصادق بلخير في التفسير، ص267- 278.
[74]تسهيل التفسير (2/ 236).
[75] تسهيل التفسير (1/ 377).
[76] تسهيل التفسير (2/ 68).
[77] الأسماء والصفات لتقيّ الدين عبد السلام بن تيمية، ص72، والرسالة الوافية لمذهب أهل السنّة في الاعتقاد وأصول الديانات، لأبي عمرو الداني، ص152، 153.
[78] تسهيل التفسير (2/ 572).
[79] تسهيل التفسير (2/ 30).
[80] الرسالة الوافية لمذهب أهل السنّة، لأبي عمرو الداني، ص130. وكتاب عقيدة السلف أصحاب الحديث، لأبي عثمان بن إسماعيل الصابوني، ص73، وكتاب العلوّ للعلي الغفّار في إيضاح صحيح الأخبار وسقيمها، لشمس الدين الذهبي، ص169، ونسبه لابن عبد البر في كتابه التمهيد (7/ 151). الأسماء والصفات، لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي، باب ما جاء في قول الله عزّ وجل: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾، حديث رقم: 867.
[81] تسهيل التفسير (3/ 161).
[82] تسهيل التفسير (3/ 161).
[83] تسهيل التفسير (3/ 383).
[84] التمهيد لِما في الموطأ من المعاني والأسانيد، لابن عبد البر (9/ 238).
[85] الحجة في بيان المحجّة، للأصفهاني (2/ 281).
[86] تسهيل التفسير (2/ 386)، و(1/ 319، 320).
[87] تسهيل التفسير (2/ 386)، و(2/ 301).
[88] صحيح ابن حبّان، حديث رقم: 7432.
[89] شرح العقيدة الطحاوية، لابن أبي العز الحنفي الدمشقي (1/ 442).
[90] أبكار الأفكار في أصول الدين، للآمدي (2/ 279).


