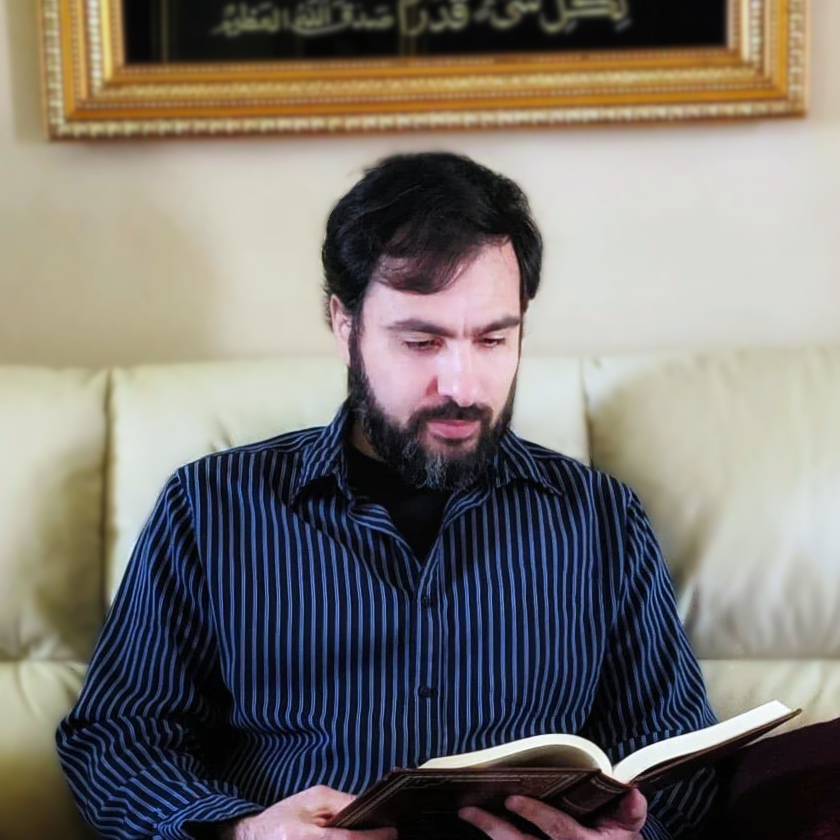قصة أصحاب الكهف
قراءة تحليلية في الدلالات التربوية والهدايات
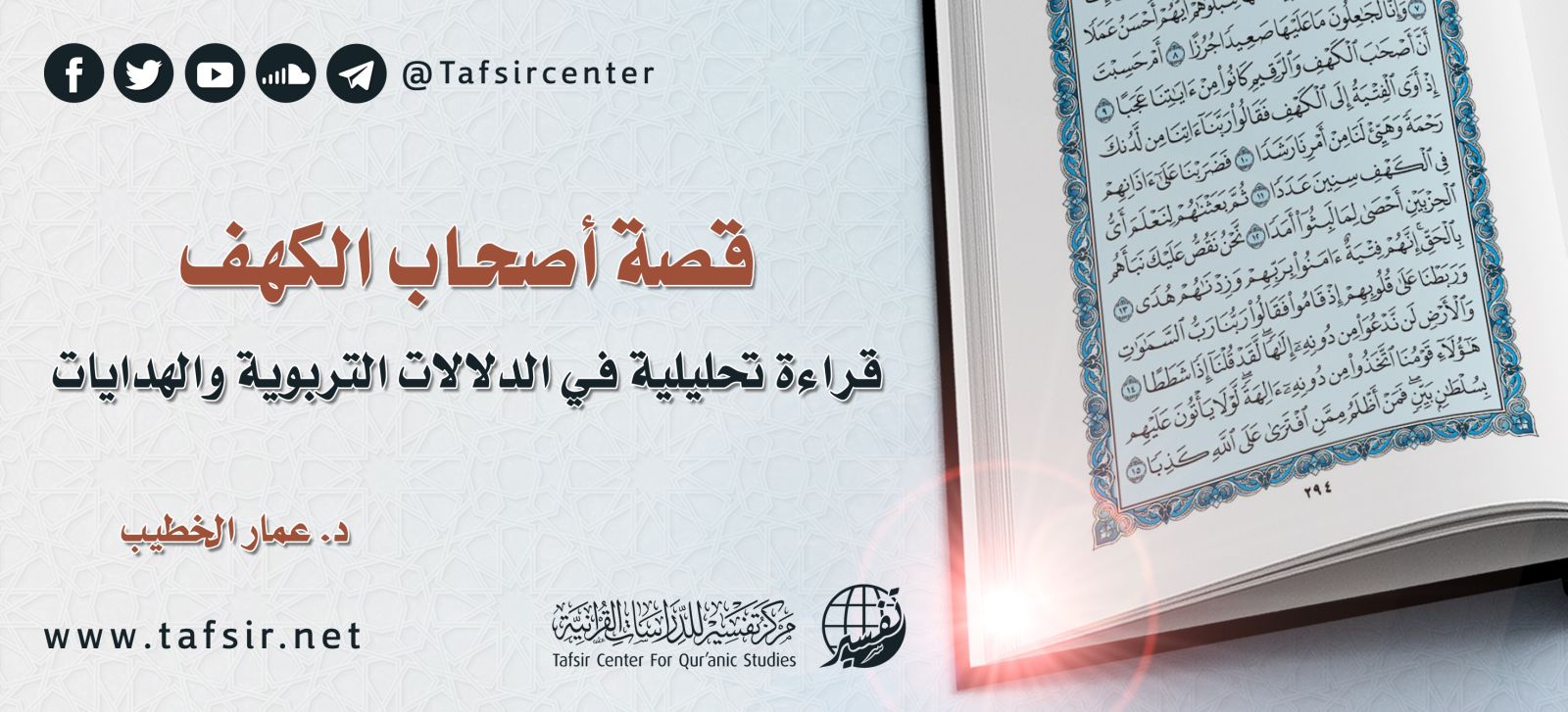
المقدمة:
الحمدُ لله، والصلاةُ والسَّلامُ على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاهُ، أمّا بعدُ:
فإنَّ القصصَ القرآني بحرٌ زاخرٌ بالعِبَر والعِظات، وروضٌ غَنَّاء يستروح المؤمن في ظِلاله لينعم بنسمات الإيمان، ويتفيَّأ بمعانيه ليتنسَّم شذاها، ويقطف من ثمارها الهُدى والبصيرة.
ومِن أبرز تلك القصص العظيمة قصة أصحاب الكهف، الواردة في سورة الكهف (الآيات: ٩- ٢٦)، وهي مِن القصص العجيبة التي تُجسِّد الإيمان في أنقَى صُوَره، والثَّبات على الحقّ في وجه الطغيان، والصَّبر على الأذى في سبيل الله. إنها لوحةٌ قرآنية بديعةٌ تُصَوِّرُ مجموعةً من الفتية آمنوا بربهم في زمنٍ عَلا فيه الكفرُ والطغيانُ، فآثروا الفِرار بدينهم معتصمين بربهم، فلجؤوا إلى كهفٍ مُوحِش، لكنَّ اللهَ -سبحانه وتعالى- جعل لهم فيه ملاذًا ورحمةً وأمنًا، فناموا في كهفهم سنين طويلة، ثم بَعَثهمُ اللهُ ليكونوا آيةً للناس ودليلًا على قُدرته على البعث والنشور، وجَعَلَ قصتهم آياتٍ تُتلَى إلى قيام الساعة.
إنَّ هذه القِصَّةَ العجيبة تَحْمِل في طيَّاتها دلالاتٍ تربويةً عميقةً في ترسيخ العقيدة، وتعليم المؤمن معاني الصَّبر، والتوكّل على الله، والثِّقة به، والالتجاء إليه.
وَمِن هنا تأتي أهميةُ هذه الدراسة التي تهدف إلى إبراز تلك الدلالات، وربطها بواقعنا المعاصر، لتؤكّد أنَّ القصص القرآني ليس مجرّد سَرْدٍ تاريخي، بل هو منهجٌ مُتَجَدِّدٌ للهداية والإصلاح عبر العصور.
وسنتناول في هذه المقالة قصة أصحاب الكهف من خلال قسمين رئيسين:
القسم الأول: عرض تحليلي مختصر لأحداث القصة ومشاهدها الرئيسة.
القسم الثاني: الدلالات التربوية والهدايات المستنبطة منها.
القسم الأول: التحليل التفسيري المختصر لقصة أصحاب الكهف:
يمكن تلخيص قصة أصحاب الكهف في أربعة مشاهد رئيسة:
المشهد الأول: ثبات الفتية على التوحيد وتبرؤهم من الشِّرْك وأهله:
تبدأ القصةُ بمشهدٍ يُصَوِّرُ مجموعةً مِن الفتية آمنوا بربهم في زمنٍ غَلَب فيه الكفرُ وانتشرَتْ فيه عبادةُ الأصنام: ﴿...إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى﴾ [الكهف: ١٣]، ﴿هؤُلاءِ قَومُنَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَولَا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا﴾ [الكهف: ١٥].
لقد أَلْهَمَ اللهُ -سبحانه وتعالى- الفتيةَ الصّبرَ وقوَّى قلوبَهُم بنور الإيمان[1]، فقاموا مُعْلِنين الحقَّ، وصَدَعَتْ ألسنتُهم بكلمةِ التوحيد في موقفٍ صريحٍ واضحٍ لا تَرَدُّدَ فيه ولا تَلَعْثُمَ في مجتمعٍ غارقٍ في عبادة الأوثان ومظاهر الشرك: ﴿...إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَنْ نَدْعُوَ مِنْ دُونِهِ إِلَهًا...﴾ [الكهف: ١٤].
بهذا الموقف المُشَرِّف، سَجَّل الفتيةُ أَوَّلَ فصولِ قِصَّتِهم الخالدة: فصل الإيمان الصادق وبراءتهم من الشِّرك وأهله، فكان ذلك بداية طريق الهجرة إلى الله، ومنطلق الرحلة التي خَلَّدها القرآنُ لتكون عبرةً للمؤمنين في كلّ زمان.
المشهد الثاني: لجوء الفتية إلى الكهف هربًا بدينهم إلى الله[2]:
قال تعالى: ﴿إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا﴾ [الكهف: ١٠].
في هذا المشهد المهيب تتجلّى صورةٌ مِن أعظم صور الثبات على العقيدة واليقين بالله حين اختار الفتيةُ الهجرةَ بدينهم والفرارَ بعقيدتهم إلى كهفٍ في جَبَلٍ، بعيدًا عن أعين الراصدين لهم؛ هَرَبًا بدينهم إلى الله.
لم تكن رحلةُ أصحاب الكهف نُزهةً ترفيهية أو مغامرةً شبابية، بل كانت هجرةً ضرورية نحو حياةٍ يرضاها اللهُ سبحانه وتعالى، حياة الإيمان الخالص والتوكُّل عليه جَلَّ جلاله. لقد تَرَكَ هؤلاء الفتية الأهلَ والأوطانَ والرَّاحةَ والأمانَ خَشيةً مِن فِتنةِ قَومِهم الكُفَّارِ لهم، وهم على يقينٍ بأنَّ مَن تَوَكَّلَ على الله كفاه، وَمَن صَدَقَ في طَلَبِ رضاه آواه.
المشهد الثالث: نوم الفتية سنين طويلة وحِفْظ الله لهم:
﴿فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا﴾ [الكهف: ١١].
﴿وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ... * وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا﴾ [الكهف: ١٧- ١٨].
في هذا المشهد العجيب يُصَوِّرُ لنا القرآنُ الكريمُ كيف ألقَى اللهُ على الفتيةِ النومَ، فناموا ومعهم كلبهم ثلاثمائة وتسعة أعوام! وهيَّأ اللهُ لهم بحِكْمَتِه وقُدْرته أسبابَ البقاء، «ليجتازوا بنومهم حواجز السِّنين، حيث تتهالك الممالك، وتتساقطُ الأنظمة، وتتبدّل أجيال بينما هم في سُبات رهيب لم ينهضوا منه إلّا بعد مئات السنين»[3].
ومِن مظاهر حِفْظ الله لهم في الكهف أنَّ «الشمسَ إذا طلَعَت مِن مشرقها تميل عن كهفهم جهة يمين الداخل فيه، وإذا غابت عند غروبها تعدل عنه جهة شماله فلا تصيبه، فهم في ظلٍّ دائم لا يؤذيهم حَرُّ الشمس، وهم في مُتَّسَع من الكهف ينالهم من الهواء ما يحتاجون إليه»[4]، وكانوا يُقَلَّبون على جُنوبِهم، مرَّةً للجَنبِ الأيمَنِ، ومرَّةً للأيسَرِ، حتى لا تأكلَ الأرضُ أجسادَهم[5]. و«لو اطَّلَعْتَ عليهم في رَقْدَتِهم التي رَقَدوها في كهفِهم، لأدْبَرْتَ عنهم هارِبًا مِنهم فارًّا... لِما كان اللَّهُ ألبَسَهم من الهَيْبَةِ، كي لا يصلَ إليهم واصِلٌ، ولا تَلْمِسَهم يدُ لامِسٍ، حتى يبلُغَ الكتابُ فيهم أجَله، ويوقظهم مِن رَقدتهم قُدْرَتُهُ وسلطانُه في الوقت الذي أراد أنْ يجعَلَهم عبرةً لمن شاء مِن خلقه، وآية لمن أراد الاحتجاج بهم عليه مِن عباده»[6].
المشهد الرابع: بَعْث الفتية وموقف الناس منهم:
﴿وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا * إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا *وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا﴾ [الكهف: ١٩- ٢١].
استيقظ الفتيةُ مِن رقدتهم، وقد حفظ اللهُ أجسامَهم من البِلَى على طول الزمان، وثيابهم من العَفَن على مَرِّ الأيام[7]، وذَلِك بعدَ ثلاثِمِائَةِ سَنَةٍ وَتِسْعِ سِنِينَ؛ ﴿وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا﴾ [الكهف: ٢٥][8]، ولهذا تساءلوا بينهم «عن المدّة التي مَكثوها نائمين، فأجاب بعضهم: مَكثْنَا نائمين يومًا أو بعضَ يوم، وأجاب بعضٌ منهم ممن لم تظهر له مدّة مُكْثِهِم نائمين: ربكم أعلم بمدّة مُكثكم نائمين، ففوِّضوا إليه عِلْم ذلك وانشغلوا بما يعنيكم»[9]. ويستمر المشهدُ وقد استيقظ الفتيةُ جياعًا، فأرسلوا واحدًا منهم إلى المدينة يحمل نقودَهم الفضّيةَ القديمةَ ليشتري طعامًا، وهو يَظُنُّ أنَّ الحالَ كما كان، فَخَرَجَ خائفًا يَتَرَقَّب... وهو لا يعلم أنه غريبٌ في المدينة بعد ثلاثة قرون! «مئاتُ السنين مَرَّتْ على هذه المدينة حيث توالَت العهود وتعاقبَت الملوك، ووَلَّت دولةُ الاستبداد والطغيان، وانحلَّتْ مملكةُ الشرك والأوثان، وحَلَّت دولةُ العلم والإيمان...»[10]، وعندما رأى الناسُ النقودَ القديمة وعرفوا قِصَّتهم، اجتمعوا عليهم وانكشف أَمْرُهم، فكانت قصتهم عبرةً مِنْ أَجَلِّ العِبَر، وبرهانًا ودليلًا حَيًّا على قدرته -سبحانه وتعالى- على البعث والنشور.
القسم الثاني: الدلالات التربوية والهدايات في قصة أصحاب الكهف:
تَزخر قصةُ أصحاب الكهف بمجموعةٍ من الدلالات التربوية والهدايات المهمّة التي تُعَدُّ منهاجًا لبناء الشخصية المؤمنة في كلّ زمان، ومِن أبرزها ما يأتي:
أ. الثبات على العقيدة الصحيحة والهجرة إلى الله:
مِن أبرز الدروس التربوية في قصة أصحاب الكهف أنها تُربِّي المؤمنَ على الإيمان الصادق والثبات على العقيدة الصحيحة، مهما اشتدت الفتن وتكاثرت قوى الشَّر والطغيان.
﴿إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ...﴾: هذه الآية صريحةٌ في الفرار بالدِّين، والهجرة مِن فتنة الطغيان إلى الأمان في كهف الإيمان، قال ابنُ العربي (ت: ٥٤٣هـ): «فيه جواز الفرار من الظالم، وهي سُنَّة الأنبياء والأولياء، وحكمة الله في الخليقة...»[11].
وقد خَرَجَ النبي -صلى الله عليه وسلم- مهاجرًا مِن مكة إلى المدينة فارًّا بدينه مِن أذى المشركين، وكذلك أصحابه الكرام، تركوا ديارهم وأموالهم رجاءَ السلامة بالدِّين والنجاة من فتنة الكافرين.
ب. الشجاعة في قول الحقّ والثبات على المبدأ:
واجَه الفتيةُ قومًا مشركين لا يعرفون لله حقًّا، ومع ذلك لم تأخذهم في الله لومة لائم، فجهروا بكلمة التوحيد وصدعوا بالحقّ في وجه الباطل، ثم اختاروا الهجرة إلى الله حفاظًا على دينهم.
وهذه الشجاعة لم تكن اندفاعًا طائِشًا أو حماسًا عابِرًا، بل كانت ثمرَةَ يقينٍ ثابتٍ وإيمانٍ راسخ، تولَّد من نور الهداية والاعتماد على الله.
وقد ربَّى الرسولُ -صلى الله عليه وسلم- أصحابَه على هذه الشجاعة نفسها، فكانت مدرسةُ النبوّة منارةً في تربية الصحابة على قول الحقّ والثبات عليه مهما كانت التضحيات، فقد رَوى عبادة بن الصامت رضي الله عنه، في الحديث الصحيح: «بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ- علَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ في العُسْرِ وَالْيُسْرِ، وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ، وعلَى أَثَرَةٍ عَلَيْنَا، وعَلَى أَنْ لا نُنَازِعَ الأمْرَ أَهْلَهُ، وعَلَى أَنْ نَقُولَ بالحَقِّ أَيْنَما كُنَّا، لا نَخَافُ في اللهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ»[12].
ج. التوكل الصادق والاعتماد على الله:
﴿رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا﴾ [الكهف: ١٠].
لقد عَبَّر هذا الدعاءُ القصيرُ عن المعنى الصحيح لِمفْهُومِ التوكُّل؛ إذْ لم يطلب الفتيةُ مِن الله مَخْرَجًا مُحَدَّدًا، بل سألوا رحمته وتوفيقه بعد أَنْ بذلوا جهدهم للهجرة من الفتنة والفرار بدينهم، ثم فَوَّضُوا أَمْرَهُم إلى الله مؤمنين أنَّ تدبيرَ اللهِ خيرٌ مِنْ تدبيرهم، وأنَّ ما عنده مِن الفَرَج أعظم مما يرجونه لأنفسهم.
وهكذا يعلّمنا أصحابُ الكهف أهميةَ الجَمْعِ بين العمل والدعاء، وبين الأخذ بالأسباب واليقين بالقدر، وأنَّ التّوكُّلَ ليس تواكلًا وتَرْكًا للأسباب، بل هو اعتمادٌ على الله مع بذل الأسباب المشروعة، ﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ [الطلاق: ٣].
قال شيخ الإسلام ابن تيمية (ت: ٧٢٨هـ): «فالالتفات إلى الأسباب شِرْكٌ في التوحيد، ومحو الأسباب أنْ تكون أسبابًا نَقْصٌ في العقل، والإعراض عن الأسباب المأمور بها قَدْحٌ في الشَّرع؛ فعلى العبد أنْ يكونَ قلبُه مُعْتَمِدًا على الله لا على سَبَبٍ مِن الأسباب، والله ييسر له مِن الأسباب ما يصلحه في الدنيا والآخرة»[13].
د. أهمية الصحبة الصالحة وأخوّة الدِّين:
اجتمع الفتيةُ علَى الإيمان، فكانوا إخوةً في العقيدة يُقوِّي بعضُهم بعضًا، ويشدُّ الواحدُ منهم أزرَ أخيه، فكان اجتماعهم على الحقّ سببًا في ثباتهم ورفعتهم.
وفي ذلك تربيةٌ على أنَّ الصحبةَ الصالحةَ مِنْ أعظم أسباب الثبات على الدِّين، وقد حثَّ الله تعالى على ملازمة الأخيار الصالحين مِنْ عباده، المداوِمين على ذِكْره، حيث قال جل وعلا: ﴿وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ...﴾ [الكهف: ٢٨].
وكما قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم مَن يُخالِل)[14].
قال طرفة بن العبد[15]:
عَنِ المرءِ لا تسأَلْ وَسَلْ عن قرينهِ** فكُلّ قرينٍ بالمقارَن يقتدِي
هـ. التربية الإيمانية للشباب وتوجيه طاقاتهم في حمل رسالة الإيمان والثبات على الحقّ:
إنَّ مرحلةَ الشباب هي مرحلةُ القُوَّة والحماس، والبذل والعطاء، فيها تَتَفَجَّرُ الطاقات وتُبنى الآمال، وهي أهمّ مراحل العمر في بناء الشخصية وتحديد الأهداف والطموحات واكتساب المهارات، وفيها يَتَبَيَّنُ طريقُ الإنسان بين هدايةٍ وضلال، وثباتٍ أو انحراف.
ولقد أكَّدَ الإسلامُ على أهمية استثمار مرحلة الشَّباب؛ لأهميتها وعظيم أمرها، فقال النبيُّ -صلى اللهُ عليه وسلم-: (سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ يَومَ القِيَامَةِ في ظِلِّهِ، يَومَ لا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ... وَشَابٌّ نَشَأَ في عِبَادَةِ اللَّهِ)[16].
وقال -صلى الله عليه وسلم-: (اغْتَنِمْ خَمْسًا قبلَ خَمْسٍ: شَبابَكَ قبلَ هَرَمِكَ...)[17].
ومِن هنا جاءَتْ قِصَّةُ أصحاب الكهف أنموذجًا خالدًا للشَّباب المؤمن الذي جَمَع بين الإيمان الصَّادق، والعزيمة الصلبة، والتَّضحية في سبيل الله.
شبابٌ ذَلَّلُوا سُبَلَ المعالي **وما عرفوا سوى الإسلام دينا[18]
لقد قَدَّم فتيةُ الكهفِ مثالًا رائعًا على أنَّ الشبابَ إذا امتلأ قلبُه بنور الإيمان، صار قُوَّةً دافعة وطاقةً إيجابية تُسْهِمُ في تحقيق الإنجازات وبناء الأوطان، لا طاقةً تُستَهلَك في أحضان الرذائل والفساد والانحلال.
و. التفكر في خَلْق الله:
إنَّ ما خَلَقَ اللهُ مِن السماوات والأرض وما فيهنَّ مِن العجائب والآيات الدالة على قدرته ووحدانيته، أعجبُ وأعظمُ مِن أمر أصحاب الكهف، فقصتهم -على ما فيها من الإعجاز والعِبرة- ليست إلا آيةً مِن آيات الله الكثيرة التي تدلّ على كمال قدرته وعظيم سلطانه سبحانه وتعالى.
وقد افتَتَح اللهُ القِصَّةَ بقوله: ﴿أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا﴾ [الكهف: ٩].
فكأنّ اللهَ سبحانه يلفت أنظارَ عباده إلى أنَّ الكونَ كُلَّهُ كتابٌ مفتوحٌ، تتجلّى فيه أصنافُ العجائب والغرائب والآيات البيِّنات، الدَّالة على قدرة الصانع وإتقانه ودقّة إحكامه وتدبيره.
قال تعالى: ﴿قُلِ انْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [يونس: ١٠١].
قال لبيد بن ربيعة[19]:
وَفِــي كُـلِّ شـَيْءٍ لَـهُ آيَـةٌ ** تَــدُلُّ عَلــى أَنَّــهُ واحِـدُ
وَلِلَّــهِ فِــي كُـلِّ تَحْرِيكَـةٍ ** وَتَســْكِينَةٍ أَبَــدًا شــاهِدُ
وقال الرازي (ت: ٦٠٦هـ): «والدلائل إمّا أنْ تكون مِن عالم السماوات أو من عالم الأرض، فالدلائل السماوية هي حركات الأفلاك ومقاديرها وأوضاعها وما فيها من الشمس والقمر والكواكب، وما يختص به كلّ واحد منها من المنافع والفوائد، والدلائل الأرضية هي النظر في أحوال العناصر العلوية، وفي أحوال المعادن وأحوال النبات وأحوال الإنسان خاصّة، ثم ينقسم كلّ واحد من هذه الأجناس إلى أنواع لا نهاية لها. ولو أنَّ الإنسان أخذ يتفكّر في كيفية حكمة الله سبحانه في تخليق جناح بعوضة، لانقطع عقله قبل أنْ يصل إلى أقلّ مرتبة من مراتب تلك الحكم والفوائد، ولا شك أنَّ الله سبحانه أكثر من ذِكْر هذه الدلائل في القرآن المجيد، فلهذا السبب ذكر قوله: ﴿قُلِ انْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾، ولم يذكر التفصيل، فكأنّه تعالى نبّه على القاعدة الكلية، حتى إنَّ العاقل يتنبّه لأقسامها، وحينئذ يشرع في تفصيل حكمة كلّ واحد منها بقدر القوة العقلية والبشرية، ثم إنه تعالى لمّا أمر بهذا التفكر والتأمّل بَيَّنَ بعد ذلك أنَّ هذا التفكُّر والتدبُّر في هذه الآيات لا ينفع في حقّ مَن حكم الله تعالى عليه في الأزل بالشقاء والضلال»[20].
ز. التذكير بالبعث والحساب واليوم الآخر:
﴿وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِم لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا...﴾ [الكهف: ٢١].
الإيمانُ بيوم الحساب والجزاء ركنٌ مِن أركان الإيمان، يُحاسَبُ فيه العبدُ على عمله، ويُجازَى عليه عدلًا ورحمة، فاللهُ سبحانه مُنَزَّهٌ عن أَنْ يـَخْلُقَ هذا العالم عبثًا، بل أوجده لحكمةٍ بالغةٍ ومعنًى رفيعٍ وغايةٍ مقصودةٍ، قال تعالى: ﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ﴾ [المؤمنون: ١١٥]، وقال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ * أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ * كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ [ص: ٢٧- ٢٩]، وقال تعالى: ﴿إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ * ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ﴾ [الغاشية: ٢٥- ٢٦].
إنَّ الإيمان بيوم الحساب يُنمِّي في النفس ضميرًا حيًّا يقظًا، يراقب الإنسان في سرّه وعَلنه، قبل صدور العمل وبعده؛ لأنه يستحضر دائمًا مشهد الوقوف بين يدي الله وما فيه من ثوابٍ وعقابٍ وجنَّةٍ ونار.
لقد جَعَلَ اللهُ تعالى بَعْثَ أصحاب الكهف بعد نومهم الطويل آيةً على صدقِ وَعْدِه بالبعث والنشور، ليوقن الناسُ أنَّ الذي أحياهم بعد أكثر مِنْ ثلاثمائة سنة قادرٌ على أنْ يُحيي الخلْقَ كلَّهم يوم القيامة، للوقوف بين يدي مالك يوم الدِّين.
وهكذا تُربِّي القِصَّةُ القلوبَ على اليقين بوعد الله، والاستعداد ليوم الجزاء والحساب، ومراقبة الله في السِّرِّ والعَلَن.
﴿وَاتَّقُوا يَومًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ [البقرة: ٢٨١].
ح. دَعْ بُنَيَّات الطريق:
أُنزل اللهُ القرآنَ لِتَدبُّرِ آياته، وفهمِ مقاصده، واستخلاصِ عِبَره، والعملِ بهديه وإرشاداته، لا للخوض فيما لا يضُرّ الجهلُ به، ولا للسؤال عمّا لا ينفع العلمُ به. وقد أشار اللهُ تعالى إلى ذلك في ختام قصة أصحاب الكهف، حين قال: ﴿سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ﴾ [الكهف: ٢٢].
فالعِبرةُ في أَمْرِ أصحاب الكهف حاصلةٌ بالقليل والكثير، والمقصود ليس معرفة عددهم ولا مكان كهفهم ولا تفاصيل قصتهم، وإنما الاتعاظ والاعتبار بثباتهم وصبرهم وإيمانهم؛ ولذلك وَجَّهَ القرآنُ الكريمُ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- إلى تَرْكِ الجدل في شأنهم، فقال سبحانه: ﴿فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا﴾ [الكهف: ٢٢].
إنها توجيهاتٌ قرآنيةٌ إلى صيانة الطَّاقات العقلية مِن أنْ تُبدَّد في الجدل العقيم، أو أنْ تُسْتَنْزَفَ في البحث عمَّا لا يضرُّ جهله ولا ينفع عِلمه، وإلى توجيه الفِكْرِ نحو المقاصد الكبرى، والغايات العليا، والحقائق النافعة.
الخاتمة:
تناولَتْ هذه المقالةُ قصةَ أصحاب الكهف مِن خلال تقديم تحليل تفسيري مختصر لها، ثم بيان ما تحمله مِن دلالاتٍ تربوية ودروسٍ إيمانية.
لقد خَلَّدَ اللهُ ذِكْرَ فتية الكهف ليكونوا مثالًا خالدًا للشباب المؤمن الذي صَدَق مع الله وهاجر إليه في سبيله، فآواهم برحمته، وَرَفَعَ ذِكْرهم بين خَلْقِه.
فسبحان مَن جعلَ مِن كهفٍ صغيرٍ مُوحِشٍ مدرسةً للإيمان، ومِن فتيةٍ قلائلَ قِصَّةً خالدةَ الذِّكْر، ونورًا يُتلَى إلى قيام الساعة، لتبقى قِصَّتُهُم شاهدًا على قوله تعالى: ﴿إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى﴾ [الكهف: ١٣].
وهكذا تظلُّ قصةُ فتيةِ الكهف مدرسةً تربويةً مُتَجَدِّدَة، تُعلِّم الأجيالَ الناشئةَ أنَّ العِزَّةَ تنبع مِن عقيدة التوحيد الصافية التي تُحَرِّرُ الإنسانَ مِن العبودية لغير الله، وأنَّ النجاةَ في الصدق مع الله، وأنَّ مَن صَدَقَ في التوكُّل على الله والاعتماد عليه آواه اللهُ إلى رحمته، وجعل له من كلّ ضيقٍ فَرَجًا، ومن كلّ كهفٍ مظلمٍ نورًا وطمأنينة.
[1] ينظر: تفسير الطبري (١٥/ ١٧٩).
[2] ينظر: تفسير الطبري (١٥/ ١٦٠- ١٦١).
[3] التفسير الموضوعي (٩/ ٣١١).
[4] المختصر في تفسير القرآن الكريم، ص٢٩٥.
[5] ينظر: المختصر في تفسير القرآن الكريم، ص٢٩٥.
[6] تفسير الطبري (١٥/ ١٩٤- ١٩٥).
[7] ينظر: تفسير الطبري (١٥/ ١٩٥).
[8] ينظر: تفسير ابن كثير (٥/ ١٤٥).
[9] المختصر، ص٢٩٥.
[10] التفسير الموضوعي (٩/ ٣١٤).
[11] أحكام القرآن (٣/ ٢٣٢).
[12] صحيح مسلم (١٧٠٩).
[13] مجموع الفتاوى (٨/ ٥٢٨).
[14] أخرجه أبو داود (٤٨٣٣)، والترمذي (٢٣٧٨)، وأحمد (٨٣٩٨)، واللفظ له.
[15] ينظر: ديوان طرفة بن العبد، ص٣٢.
[16] أخرجه البخاري (٦٨٠٦)، ومسلم (١٠٣١).
[17] أخرجه ابن أبي الدنيا في (قصر الأمل) (١١١)، والحاكم (٧٨٤٦)، والبيهقي في (شعب الإيمان) (١٠٢٤٨).
[20] مفاتيح الغيب (١٧/ ٣٠٦).