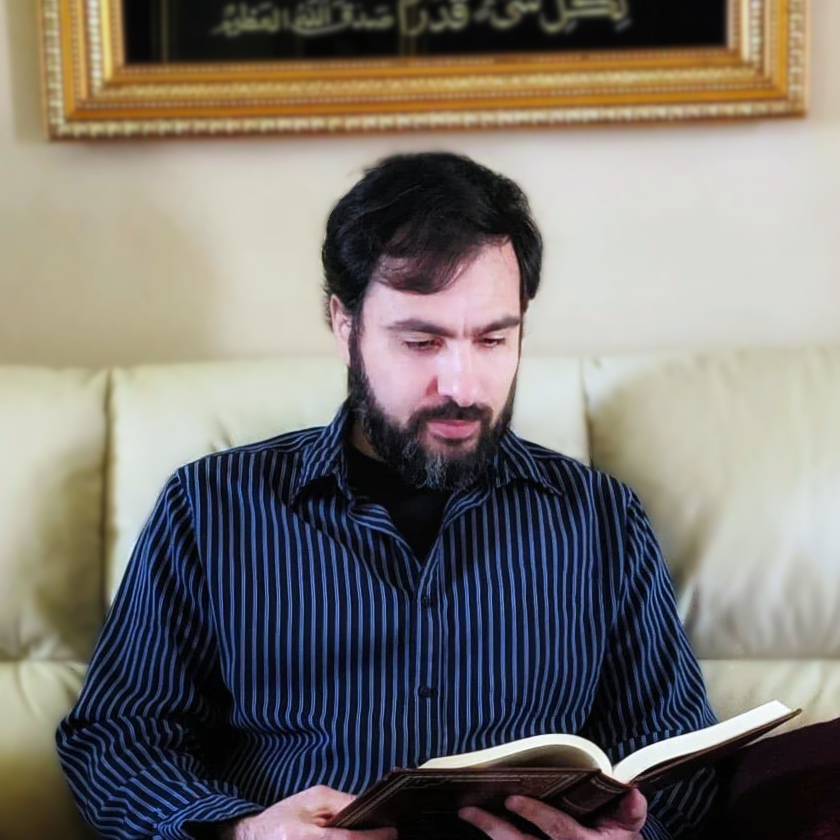قصة صاحب الجنتين في سورة الكهف؛ قراءة تحليلية في الدلالات التربوية والهدايات

المقدمة:
الحمدُ لله، والصلاةُ والسَّلَامُ على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والَاهُ، أمّا بعدُ:
فالقرآنُ الكريم كتابُ هدايةٍ ومنهجُ حياة، وهو نظامٌ تشريعيٌّ خالدٌ متكاملٌ يُنَظِّمُ علاقةَ الإنسان بربّه، وبالناس مِن حوله، وبسائر المخلوقات. وَمِن وجوه إعجازه أنه يضرب الأمثالَ التي تُجسِّد المعاني وتقرِّب الحقائق للنفوس. ومِن أبرز هذه الأمثال البليغة قصةُ صاحب الجنّتين الواردة في سورة الكهف [الآيات: 32- 44]، والتي تُجَسِّدُ الصراعَ الأزليَّ بين الغُرور بالمال وزينة الحياة الدنيا مِن جهة، والتواضع وشُكْر الله والإيمان بالآخرة مِن جهةٍ أخرى.
وتُظْهِرُ القصةُ أنَّ الإنسانَ قد ينخدع بما أُوتي من مالٍ وجاهٍ، فيظنّ أنَّ النعمةَ دائمةٌ لا تزول، بينما هي في حقيقتها ابتلاءٌ عابر قد يذهب في لحظة، ولا يبقى للإنسان إلا ما قَدَّم من عملٍ صالحٍ. وفي المقابل، يَرْسُمُ القرآنُ صورةً مُشْرِقةً للمؤمن الذي يرى في النعمة دليلًا على الـمُنْعِم سبحانه وتعالى، فيزداد بها خضوعًا وشُكْرًا، مُدركًا أنَّ الدنيا دار اختبارٍ لا دار استقرار.
إنَّ هذه القِصَّةَ القرآنيةَ تحمل في طيّاتها دلالات تربوية عميقة في بناء الإيمان والضمير والوعي الأخلاقي، وهدايات واقعية تَتَّصِلُ بالاقتصاد والمجتمع والبيئة والحضارة. ومن هنا تأتي أهميةُ هذه الدراسة التي تهدف إلى إبراز تلك الدلالات، وربطها بواقعنا المعاصر، لتؤكّد أنَّ القصص القرآني ليس مجرّد سَرْدٍ تاريخي، بل هو منهجٌ متجددٌ للهداية والإصلاح عبر العصور.
وسنتناول في هذه المقالة قصة صاحب الجنتين من خلال قسمين رئيسَيْن:
القسم الأول: تحليل تفسيري مختصر للقصة.
القسم الثاني: الدلالات التربوية والهدايات المستنبطة منها.
القسم الأول: التحليل التفسيري المختصر لقصة صاحب الجنتين:
قال تعالى: ﴿وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا * كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا * وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ...﴾ [الكهف: 32- 34].
تأتي هذه القصةُ لِتَضْرِبَ مثلًا بليغًا «للعظة والاعتبار، والتذكرة والاستبصار، وتصحيح المفاهيم، وأنَّ العِبرة بالخواتيم، وأنَّ تَقَلُّبَ الكافرِ في النِّعَم إمهالٌ واستدراج، ومكابدةَ المؤمنِ في الدنيا ابتلاءٌ وتصحيح»[1]. فهي تَعْرِضُ نموذجَيْن متباينَيْن[2]:
1- نموذج الإنسان المغترّ بزينة الحياة؛ الذي خدعته الثروة، وأَعْمَتْه النعمة، حتى نَسِيَ قُدرة الله القاهِرة التي تدبّر شؤون الخَلْق، وظنّ أنَّ ما عنده مِنَ النِّعَمِ خالدٌ لا يَفنى.
2- ونموذج المؤمن المعتزّ بإيمانه؛ الذي يرى في النعمة دليلًا على الـمُنْعِم، فيزداد شكرًا لله وتسبيحًا له، ولا تدفعه النعمةُ إلى الكِبْر أو الجحود.
ويمكن تلخيص القصة في أربعة مشاهد:
المشهد الأول: تصوير النَّعيم والوفرة في الجنّتين:
﴿...جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا * كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا * وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ...﴾ [الكهف: 32- 34].
تبدأ القصة بمشهد الجنّتين، وقد اجتمع فيهما كلُّ أسباب النعيم: أعناب دانية، ونخيل باسقة، وزروع مخضرّة، وثمار يانعة، ونهر جارٍ، في صورةٍ ترمز إلى كمال النعمة ووفرتها. إنه مشهد يجمع الجمال والرخاء والدَّعَة والمال في أبهى صُورة.
المشهد الثاني: غرور صاحب الجنّتين، وظنّه دوام النعمة، وإنكاره للآخرة:
يُصَوِّرُ القرآنُ في هذا المشهد صاحبَ الجَنَّتَيْن وهو يفتخر على صاحبه بكثرة المالِ والخَدَمِ والحَشَمِ والوَلَد[3]: ﴿أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا﴾ [الكهف: ٣٤].
وَيُصَوِّرُهُ أيضًا وهو يقول في كبرياء وغرور:
﴿مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا﴾ [الكهف: 35]، «ظَنَّ أنها لا تفنى... وذلك لقلّةِ عَقْله، وضَعْفِ يقينه بالله، وإعجابهِ بالحياة الدنيا وزينتها، وكُفْرهِ بالآخرة»[4]. وَيَقُولُ: ﴿وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا﴾ [الكهف: 36]، يعني: «وما أظنُّ أنَّ القيامةَ حادثة، إنما هي حياة مستمرة، وعلى فرض وقوعها فإذا بُعِثْتُ وأُرْجِعْتُ إلى ربّي لأَجِدَنَّ بعد البعث ما أرجع إليه مما هو أفضل من حديقتي هذه، فكوني غنيًّا في الدنيا يقتضي أَنْ أكون غنيًّا بعد البعث»[5].
المشهد الثالث: موقف المؤمن الموحِّد ونصيحته البليغة:
حاول الرَّجُلُ المؤمنُ «الذي لا مالَ له ولا نَفَر، ولا جَنَّة عنده ولا ثَمَر»[6]، أَنْ يُذَكِّرَ صاحِبَ الجنتين بالله، وَاعِظًا لَهُ وَزَاجِرًا عَمَّا هُوَ فِيهِ مِنَ الْكُفْرِ بِاللَّهِ والاغتِرارِ:
﴿أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا﴾ [الكهف: 37]، يعني: «خلقَ أباك آدمَ من ترابٍ... ثم أنشأك من نطفة الرجل والمرأة... ثم عَدَلَكَ بشرًا سَوِيًّا رَجُلًا ذكرًا لا أُنثى، يقول: أكفَرْتَ بمَنْ فعل بك هذا أنْ يُعيدك خَلْقًا جديدًا بعد ما تصير رفاتًا»[7].
ثم قال: ﴿وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ...﴾ [الكهف: 39]، ليؤكّد أنَّ كُلَّ نعمةٍ بيدِ الله، وأنَّ الاعترافَ بإنعام الـمُنْعِمِ على وجه الخضوع له والذلّ والمحبة من سبيل دوامها، وأنَّ زوالها ممكنٌ في لحظة.
المشهد الرابع: انهيار النعمة وزوالها، وحسرة الكافر على مالِه وَجَنَّتِه:
وسرعان ما جاء أمرُ الله، فأحاط الهلاكُ بجنّتي الرجل الكافر، وأصاب ثِمَارَها التي كان يفاخر بها ويقول في غروره: ﴿مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا﴾، ﴿وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُروشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِك بِرَبِّي أَحَدًا﴾ [الكهف: ٤٢]. تحوَّل المشهد المليء بالحياة إلى أطلال خاوية، فأصبح الرجلُ يقلِّب كفَّيه حسراتٍ، نادمًا على ما أنفق فيها من مالٍ وجهدٍ يتمنّى لو أنه شكرَ بدلَ أنْ يكفر، وتواضَعَ بدلَ أنْ يتكبّر.
«وما كان له مَنْ يَنصره ويعصمه مِن أمرِ الله، وما كان مُنْتَصِرًا بنفسه»[8]: ﴿وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا﴾ [الكهف: ٤٣].
وهكذا تُقَدِّمُ القِصَّةُ مثالًا حيًّا على أنَّ النعمةَ إذا لم تُشْكَر تَفنى، وأنَّ الغرورَ بالدنيا يقود إلى الهلاك، بينما الشكر والإيمان هما السبيل إلى النجاة، والفوز برضوان الله ورحمته.
القسم الثاني: الجوانب التربوية والهدايات في قصة صاحب الجنتين:
1. الجانب التربوي:
أ- تربية على شكر النعمة:
تُرَسِّخ القصةُ في النفوس مبدَأ أساسيًّا من مبادئ التربية الإيمانية، وهو أنَّ الشُّكر صمامُ الأمان لبقاء النعمة واستمرارها، وأنَّ نِسْبتها إلى النفس ضربٌ من الغرور يقود إلى زوالها، بينما نِسْبتها إلى اللهِ اعترافٌ بفضله وامتنانٌ لعطائه، قال تعالى: ﴿لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ﴾ [إبراهيم: 7].
فصاحب الجنّتين لَمَّا نَسَبَ النعمة إلى نفسه اغترّ بها، فهلكَتْ جنّتاه وزالتْ ثروته. وأمَّا صاحبه المؤمن فقد رَدَّ الفضلَ إلى الله، فأثبتَ صِدق إيمانه وسموَّ تربيته.
وفي عصرنا الحاضر، حيث تَتَجدَّدُ النّعم بأشكالٍ متعدّدة عبر التكنولوجيا الحديثة والاكتشافات العلمية والتطوّرات الطبّية والصناعية، يحتاج الإنسان أكثر من أيّ وقتٍ مضى إلى أَنْ يتذكَّرَ أنَّ هذه الإنجازات ليستْ مِن صُنْعه وحده، بل مِن فضل الله الذي سخَّر له العَقْل والقُدْرة والموارد. وعليه، فإنَّ شُكْرَ النعمة لا يقتصر على اللّسان، بل يَتَمَثَّلُ أيضًا في حُسْنِ توظيف هذه المكتسبات في خدمة البشرية، لا في إفساد الأرض ولا في ظُلْم الإنسان لأخيه الإنسان.
ب- تربية على الإيمان بالآخرة:
إنَّ الإيمانَ بالبعث واليوم الآخر هو الركيزة الكُبرى التي تقوم عليها استقامة الإنسان في الدنيا، فهو ميزانٌ يَرْدَعُ النَّفْسَ عن الظُّلْم، ويضبطها أمام إغراءات المال والجاه والشهوة. فصاحب الجنتين حين أنكر البعثَ ظنَّ أنَّ النعمةَ باقيةٌ لا تزول، فاستسلم للغرور والكِبْر، بينما صاحبه المؤمن، وقد امتلأ قلبُه يقينًا بالآخرة، ظلَّ ثابتًا على الحقّ، مُدْرِكًا أنَّ الدنيا دار فناء وزوال، وأنَّ الحساب آتٍ لا محالة.
وفي واقعنا المعاصر، حيث تغلّبَت المادية على كثير من المجتمعات، وغابت القيم الدينية عن مناهج الحياة، تبدو آثارُ إنكار الآخرة واضحةً في الفساد الأخلاقي، والجشع الاقتصادي، والاستغلال الاجتماعي. فالإنسان إذا اعتقد أنه لا حساب بعد الموت استباح كلَّ شيء، أمّا إذا أيقن أنه سيقف يومًا بين يدي الله صار أكثر عدلًا ورحمة وأمانة.
ولهذا فإنَّ التربيةَ على الإيمان بيوم الحساب ضرورةٌ تربوية وأخلاقية كُبرى؛ فهي تحفظ المجتمعات من الانحراف، وتغرس في القلوب وازعًا حيًّا يراقب الله في السّر والعلن. وهي تربِّي إنسانًا أمينًا في معاملاته، عادلًا في أحكامه، رحيمًا في سلوكه؛ لأنه يستشعر على الدوام أنه ماثلٌ بين يدي ربٍّ عادل لا يغفل ولا ينام.
ج- تربية على الخضوع والاعتراف بفضل الله:
إنَّ كلمة المؤمن لصاحبه: ﴿وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ﴾ [الكهف: 39]، ليستْ مجرّد جملة تجري على اللسان، بل هي تربيةٌ على الشُّكر والتواضع، وخضوعٌ للمُنْعِم سبحانه. وهي تختصر جوهرَ العقيدة: فكلُّ ما يملكه الإنسانُ هِبَةٌ من الله، ونحن الفقراء إليه وهو الغنيّ سبحانه، والقوّة الحقيقية لا تكون إلا في توفيق الله وحده وهدايته. هذه الكلمة العميقة تُطَهِّرُ القلبَ من داء الغرور، وتُوقظ العقل ليدرك أنَّ النِّعَمَ قد تَزول متى شاء الله، وأنَّ الإنسان مهما بلغ مِن قُوَّةٍ أو مكانة يبقى عبدًا ضعيفًا أمام عَظَمة الخالق. فهي بمثابة درع يحمي من الكِبْر، وحصن يصدُّ وَهْمَ الاكتفاء بالنفس.
وفي زماننا هذا، حيث يزداد التفاخر بالمظاهر، وتُقاس قيمة الإنسان بما يحقّقه من إنجازات مادية، تبقى هذه التربيةُ القرآنيةُ صوتًا خالدًا يُذَكِّرُ القلوبَ أنَّ العَظَمَةَ لله وحده، ويُنْذِرُ عاقِبَةَ البَطَرِ والكِبْر، وأنَّ ما بأيدينا مِن نجاحاتٍ وإنجازاتٍ لا قيمةَ لها إن لم تُقْرَن بالحمد والشُّكْر والتواضع.
د- قيمة الصُّحْبَة الصالحة:
كان وجودُ الصاحب المؤمن في القصة نعمةً عظيمةً، فقد واجَه غرور صاحب الجنتين بالنُّصح والتذكير بالله، وتوجيهه إلى الأدب الواجب في حَقِّ الـمُنْعِمِ سبحانه وتعالى. وهذا يُبْرِزُ أهميةَ الصُّحبة الصالحة في حفظ الإنسان من الغفلة وردّه إلى الحقّ. «فكان قصدُ المؤمن مِن حواره: تصحيح المفاهيم، وضبط الموازين، وتأصيل القيم، وذلك ببيان أنَّ العِبْرةَ ليسَتْ بكثرة المال والولد؛ فتلك أعراضٌ فانية، وعاريةٌ مسترَدّة»[9]، وإنما المعيار الحقيقي، والميزان العادل عند الله عزّ وجلّ، هو ميزان التقوى، كما قال سبحانه: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ [الحجرات: 13]. فبالتقوى تُوزَنُ القلوب، وتُعْرَفُ المنازل، وتُفاضَل الدرجات.
وفي واقعنا المعاصر، حيث تغزو القلوبَ المادّياتُ وتكثر الفتنُ، تبقى الرفقةُ الصالحةُ حِصْنًا للإنسان، تُذَكِّرُهُ باللهِ إذا نَسِيَ، وَتُثَـبِّتُهُ على الطريق المستقيم إذا زَلَّتْ قدماه. فالإنسانُ ضعيفٌ بنفسه، قويٌّ بإخوانه الصالحين.
2. الهدايات:
أ- البُعْد الاقتصادي:
الثروة المادّية وحدها لا تُوَفِّرُ الأمانَ المطلق؛ لأنها عُرضةٌ للتقلّب والزوال في أيّ وقت، فصاحب الجنّتين حين اعتمد على مالِه هلك. وفي عصرنا الحاضر نشهد مؤسّساتٍ ماليةً كُبرى تنهار فجأة رغم ما يبدو عليها مِن قوّة. والمغزى واحدٌ في كلّ زمان: أنَّ المالَ إذا لم يُبْنَ على قِيَمٍ روحية وأخلاقية فلن يَضْمَن استقرارًا ولا بقاءً.
ومِن هنا يتّضح أنَّ المالَ لا ينبغي أن يُنظر إليه على أنه غايةٌ أو مقصد، وإنما هو وسيلةٌ مشروعةٌ لتحقيق التنمية، وإعمار الأرض، وتلبية حاجات الإنسان والمجتمع. ولم يأتِ الشَّرْعُ للتنفير منه أو الحثّ على تَرْكه، بل وجَّه إلى الاعتدال في طَلَبه، والالتزام بوجوهه المشروعة، وإنفاقه في مصارفه الصحيحة، مع استحضار شُكْر الله عليه[10].
ب- البُعد البيئي:
إشارةُ القرآنِ إلى الجنّتين الغنّاوَيْن والنَّهْرِ المتدفق تذكيرٌ بأنَّ الزراعةَ والموارد الطبيعية هِبَةٌ من الله سبحانه وتعالى. غير أنَّ انهيارهما المفاجئ يبيّن أنَّ هذه النعم، مهما بلغت قوّتها، قد تزولُ إذا أساء الإنسان رعايتها أو قَصَّر في شُكْر المنعِم عليها. وفي واقعنا المعاصر، حيث يزداد التلوث ويشتد خطر التغيّر المناخي، تتأكّد الرسالة القرآنية: إنَّ غياب الشُّكْر وسوء إدارة الموارد يقود إلى كوارث تُهَدِّد الإنسانَ والحياةَ على الأرض.
ج- البُعد الاجتماعي:
تُجَسِّدُ القِصَّةُ التبايُنَ الواضح بين الغنيّ المغرور الذي أعماه مالُه، والفقير المؤمن الذي ثبّتَه يقينُه بالله، لتؤكّد أنَّ القيمةَ الحقيقية للإنسان لا تُقاس بما يملك، بل بما يحمل من إيمانٍ وخُلُق. وحين سُئِلَ رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: «مَنْ أَكْرَمُ النَّاسِ؟ قالَ: أَتْقَاهُمْ لِلَّهِ»[11]. وفي واقعنا، حيث تُـخْتَزَلُ مكانة الناس في ثرواتهم ومناصبهم، تأتي القصةُ لِتُعِيدَ الميزانَ الصَّحيح؛ فالثروة قد تنهار في لحظة، بينما الإيمان يَحفظ للإنسان كرامته حتى لو فَقَدَ كُلَّ ما يملك؛ لأنَّ المؤمنَ يَعْلَمُ أَنَّ ما عند اللهِ خَيْرٌ وأبقى.
د- البُعد الحضاري:
الحضاراتُ التي تُشيِّد مَجْدَها على أُسُسٍ مادية بحتة، وتغفل عن القيم الروحية والأخلاقية، تُشْبِهُ في مآلها حال صاحب الجنتين، فقد تبدو في ظاهرها قويةً مزدهرة، لكنها في حقيقتها هَشَّة ومعرَّضة للسقوط في أيّ لحظة. وقد قصَّ القرآنُ الكريم علينا مصارعَ أممٍ طغَت بمالها وقوّتها؛ كعادٍ الذين قال الله عنهم: ﴿مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً﴾ [فصلت: 15]، ﴿وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالوَادِ﴾ [الفجر: 9]، وفرعون الذي قال متبجِّحًا مفتخرًا: ﴿أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي﴾ [الزخرف: 51]، فكانت عاقبتهم الهلاك والدَّمار لَمَّا أعرضوا عن الإيمان والهداية، وتخلّوا عن القيم التي تحفظ بقاءَهم.
والتاريخ حافل بأمثلةٍ من حضاراتٍ بلغَت الذروة في قوّتها الاقتصادية والعسكرية، لكنها ما لبثتْ أَنِ انهارت حين تخلّت عن القيم التي تحفظ استقرارها.
وقد لخّص أميرُ الشعراء أحمد شوقي هذه الحقيقة بقوله:
وإنِّما الأُمَمُ الأخلاقُ ما بَقِيَتْ ** فَإِنْ هُمُ ذَهَبَتْ أخلاقُهمْ ذَهَبُوا
فالإيمان والأخلاق والقِيَم هي الضَّمان الحقيقي لبقاء الحضارات، وما عداها مِن مظاهر مادية يبقى عُرْضَةً للزوال.
الخاتمة:
تناولَتْ هذه المقالةُ قصةَ صاحب الجنتين مِن خلال تقديم تحليل تفسيري مختصر لها، ثم بيان ما تحمله من هدايات ودلالات تربوية.
إنَّ قصةَ صاحب الجنتين ليست مجرّد حكاية من الماضي، بل هي رسالةٌ متجدّدة لكلّ زمان ومكان، تضع أمام الإنسان مرآةً يرى فيها حقيقة الدنيا وزيفها. فهي تُذكِّرنا أنَّ النعمةَ لا تدوم إلا بالشُّكر، وأنَّ الإيمانَ هو الكنز الباقي الذي يحفظ للإنسان كرامته ويقيه من الضياع.
لقد أبرزت القصةُ الفرقَ بين قلبٍ اغترّ بزينة الحياة الدنيا، فخسر الدنيا والآخرة، وقلبٍ عامرٍ بالإيمان، رأى في النعمة يدَ الله فتواضَعَ وشَكَر، وفي الفقر بلاءً واختبارًا فَحَمِدَ وَصَبَر.
وفي عصرنا الحاضر، حيث تتسارع خطى المادية، وتُقاس قيمة الإنسان بما يملك لا بما يكون، تأتي هذه القصة القرآنية لتعيدنا إلى الجادَّة: أنَّ العظمةَ لله وحده، وأنَّ الحضارة لا تقوم إلا على الأخلاق، وأنَّ ميزانَ التفاضل والتفاوت بين الخَلْق لا يكون إلا بالتقوى، وأنَّ النجاةَ الحقيقية ليسَتْ بكثرة المال وقوّة السلطان، وإنما بالإيمان بالله والعمل الصالح.
وبذلك تظلُّ قصةُ صاحب الجنتين منبعًا للهداية ودرسًا خالدًا، يغرس في القلوب معاني التواضع والشكر والإيمان، ويقيم في المجتمعات ميزانًا صحيحًا يُوزَنُ به الناس والحضارات. وهي نداءٌ خالد يذكّرنا بأنَّ العُصاةَ مهما تباهَوا بأموالهم، واعتزّوا بأعوانهم، فإنَّ غِبطةَ المؤمن وفرَحَه بإيمانه وتوحيدِه هي أعظمُ زاد، وكفى بذلك رِفعةً وعزًّا[12].
[1] التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم (4/ 334).
[2] في ظلال القرآن (4/ 2270).
[3] تفسير ابن كثير (9/ 136).
[4] تفسير ابن كثير (9/ 137).
[5] التفسير المختصر، ص298.
[6] في ظلال القرآن (4/ 2270).
[7] تفسير الطبري (15/ 263).
[8] التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم (4/ 340).
[9] التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم، ص٣٣٨.
[10] موسوعة التفسير الموضوعي: modoee.com/show-book-scroll/438
[11] أخرجه البخاري (3383)، ومسلم (2378).
[12] ينظر: هدايات القرآن الكريم، ص298.