نقولات ابن عاشور عن جدَّيْه في تفسيره (التحرير والتنوير)
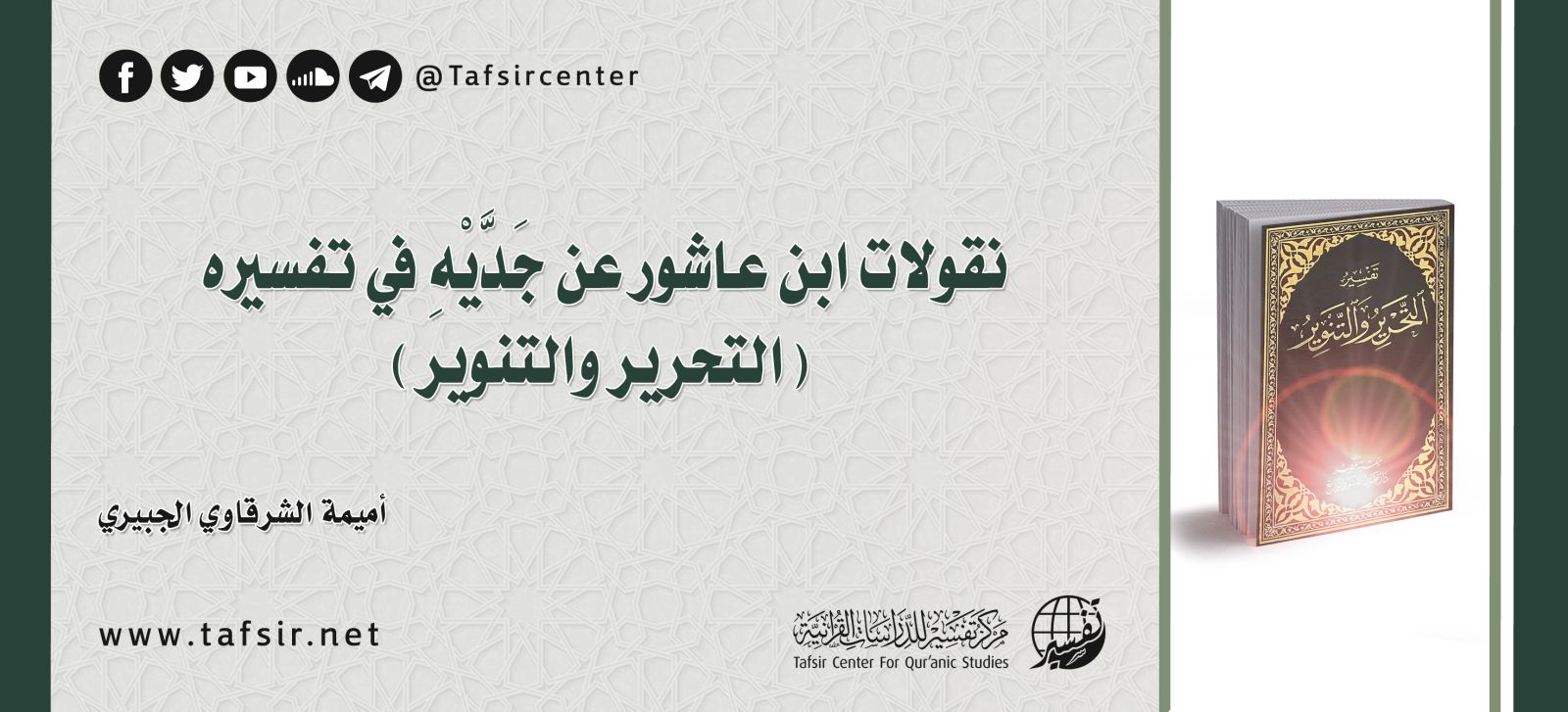
الحمد لله ربّ العالمين حمد الشاكرين، نحمده على عظيم نعمائه، وجميل بلائه، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أمّا بعد:
فيعدّ تفسير القرآن الكريم من أبرز العلوم التي اعتنــى بها العلماءُ على مرّ العصور، حيث سعى كلّ عالمٍ مفسِّر إلى تقديم فَهْم دقيق للنصوص بناء على منهجية علمية، ومن بين هؤلاء العلماءِ العالمُ المفسِّر الكبير العلّامة ابن عاشور، فقد تركَ لنا إرثًا علميًّا بالغ الأهمية من خلال تفسيره (التحرير والتنوير).
فالنبوغ العلمي لا يُولد من فراغ، وإنما ينشأ في بيئة خصبة تهيئ للعقل أن يتفتّح، وللفكر أن يثمر فيحصد، فهذا هو حال العلّامة ابن عاشور الذي نشأ في بيتِ عِلْمٍ عريق، تُتَوارَثُ فيه المعرفة كما تُتَوارَثُ الجواهر، فشَبّ على حُبِّ القرآن، وتشرَّب من أُسرته علم التفسير، حتى صار من أعلامه، وأخرج للأمة تفسيره الماتع، فقد كان لعائلته دورٌ كبيرٌ في بناء شخصيته التفسيرية.
تهدف هذه المقالة إلى إبراز الموروث العائلي في تفسيره لبعض الآيات، وذلك من خلال إبراز جهود جَدَّيْه -جدّه لأبيه وجدّه لأمّه- في التفسير، من خلال استقراء جميع المرويات في تفسير التحرير والتنوير، فهذه النصوص تحمل في طيّاتها مفاتيح لفهمٍ أعمق يبيّن حياة المفسِّر الخاصة وتأثيراتها على تفسيره للنصوص القرآنية، فلا شك أن التعليقات والنقول تمثّل عنصرًا مهمًّا من عناصر التأليف في التراث التفسيري الزاخر، لِمَا لها من أثرٍ إيجابي في خدمتها، وذلك بتوضيح غوامضها، وتقريب مضامينها، وذلك بعد تمهيد نترجم فيه للعلّامة ابن عاشور، وجدّه لأبيه الشيخ ابن عاشور، وجدّه لأمّه العلّامة الوزير محمد العزيز بوعتور، رحمهم الله جميعًا.
تمهيد: التعريف بالعلّامة ابن عاشور وجَدَّيْه:
أولًا: التعريف بالعلّامة ابن عاشور:
العلّامة الإمام الشيخ محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن محمد الشاذلي بن عبد القادر محمد بن عاشور الشريف التونسي[1]، رئيس المفتين المالكيين بتونس، وأحد كبار علمائها، مفسِّر، لغوي، نحوي[2]، من أسرة علمية من الأندلس، حيث هرب جدّه الأكبر محمد بن عاشور من بطش الصليبيين الذي كان يتعرض له المسلمون بعد سقوط الأندلس، واستقر في المغرب الأقصى في مدينة سلا بالمغرب، ثم هاجرت الأُسرة واستقرّت في تونس[3].
شبّ في كنف والده، ثم تربّى تحت رعاية جدّه لأمّه، ثم تعلّم في الكُتّاب حتى أتقن حفظ القرآن، ولمّا بلغ أربعة عشر عامًا التحق بجامع الزيتونة، كان ذا همة عالية في التحصيل العلمي؛ وذلك لتربيته في بيئة علمية، ولذكائه وفطنته الشديدة، بسبب نوعية الشيوخ الذين كانوا يدرِّسونه في جامع الزيتونة، فقد كان لهم الأثر الكبير في النهضة العلمية والفكرية للعلّامة ابن عاشور، مما جعل الإصلاح هاجسًا في نفس الشيخ الطاهر بن عاشور وعقله، الذي جعل لديه قناعةً وإيمانًا بأنّ الدين الإسلامي دين علم وحضارة ومدنية[4].
تُوفي الطاهر بن عاشور في الثالث عشر من رجب سنة ثلاث وتسعين وثلاثمائة وألف، عن عمرٍ ناهز السابعة والتسعين عامًا، ودُفن في مقبرة الزلاج في مدينة تونس، بعد حياة مليئة بالعلم والاجتهاد والإصلاح والتجديد، والهمة العلمية العالية، على المستويين التونسي والعربي، وكذلك على صعيد العالم الإسلامي، رحمه الله رحمة واسعة[5].
ثانيًا: التعريف بالشيخ الجدّ ابن عاشور:
العلّامة أبو عبد الله محمد الطاهر بن محمد بن الشاذلي بن عبد القاهر بن محمد بن عاشور، وهو جدّ العلّامة المفسِّر ابن عاشور، نشأ في حِجْر أبيه وتربية أخيه، وهو من بيتِ شرفٍ وصلاح، وكان الشيخ محمد بن ملوكة التونسي يستنجبه ويقدّمه، ففاض بالعلم حوضه، وأثمر روضه، فتصدّر للتدريس في النحو والبيان والأصول وغيرها من علوم الأدب، فانثالت إليه الناس من كلّ حدب، وجرى منه بالجامع الأعظم سيل الإفادة[6]، رحل إلى دار البقاء نهار يوم الاثنين الحادي والعشرين من ذي الحجة سنة أربع وثمانين ومائتين بعد الألف[7].
ثالثًا: التعريف بالعلّامة الجدّ الوزير:
العلّامة محمد العزيز بن محمد الحبيب بن محمد الطيب بوعتور[8]، وزير من العلماء والكتاب، أصل سلفه من صفاقس من ذرية الشيخ عبد الكافي بوعتور العثماني من سلالة الخليفة الثالث عثمان بن عفان، وُلِد بتونس في رجب، ونشأ في رعاية أبيه الشيخ محمد الحبيب فلقّنه القرآن حتى حفظه على ظهر قلب[9]، وإذا كان للتربية الإسلامية الكاملة والنشأة الأخلاقية الفاضلة مظهرٌ ينطق بسموّ أثرهما في الحياة العلمية، وبرهان يفصح بمبلغ الناشئين عليهما من مقامات الرشد في كلّ ما تولّوا، والنجاح أينما انتهجوا؛ فإنّ في حياة الوزير الخطير والعالم الكبير عِبرة فائقة للمعتبر، فيما بين النشأة الزكية والنجاح في الحياة الاجتماعية من متين الأسباب في حياة من تبوّأ المنزلة السامية من كلّ نظر، وحلّ محلّ الثقة من كلّ فؤاد حتى ترك حديث مقدرته السياسية يملأ الأفواه والآذان، ومأثور أعماله الرشيدة وأقواله الحكيمة تسير بها الركبان[10]، توفي سنة خمس وعشرين وثلاثمائة وألف وقد ناف عن التسعين[11]، وصِلَة القرابة بينه وبين العلّامة ابن عاشور أنّ العلّامة ابن عاشور ابن سِبطه، رحم اللهُ العلماءَ الأفذاذ الذين لا تلين لهم قناة في علوم الشرع واللسان والبيان.
* * *
من الوفاء الذي تأنس به النفوس، وتحمده الشرائع والعقول، أن يُذكر العلماء بخير، وتُروى آثارهم، وتُبَثّ علومهم بين الناس، ولا شك أنّ إحياء ذِكْر العلماء وبثّ علومهم من أسمى الحقوق التي يتعيّن على طلابهم الوفاء بها، فكيف إذا اجتمع في العالم حقّان جليلان: حقّ الأُبوة والنسب، وحقّ المشيخة، فإنّ الوفاء له حينئذ أوجب، والعرفان أعمق، والواجب أبلغ، وقد بلغ مجموع ما حدَّث به العلّامة ابن عاشور عن جدّه الشيخ ابن عاشور أربعة مواضع، وعن جدّه العلّامة الوزير ثمانية مواضع، وفيما يأتي عرضُ تلك المواضع حسب ورودها في التفسير، مع التنبيه على تمييزه بينهما بذِكْره في الثاني لقب الوزير، بخلاف الأوّل الذي يقتصر فيه على قوله: الشيخ الجدّ.
أولًا: النقولات عن الشيخ الجد ابن عاشور:
الموضع الأول: في تفسير قوله تعالى: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ [الفاتحة: 5].
«فإن قلت: كيف أُمِرْنا بأن لا نعبد إلا الله ولا نستعين إلا به حسبما تشير إليه هذه الآية، وقد وردَ في الصحيح أنّ النبي -صلى الله عليه وسلم- لمّا علّم عبد الله بن عباس قال له: (إذا سألْتَ فاسأل الله، وإذا استعنتَ فاستعن بالله)[12]، فلم يأتِ بصيغة قصر، قلتُ: قد ذكرَ الشيخ الجدّ -قدّس اللهُ روحه- في تعليقه على هذا الحديث، أنَّ تَرْك طريقة القصر إيماءٌ إلى أنّ المقام لا يقبل الشركة، وأنّ مِن حقّ السؤال أن لا يكون إلا لله القادر العليم، وقد قال علماء البلاغة: إذا كان الفعل مقصورًا في نفسه، فارتكاب طريق القصر لغوٌ من الكلام. ا هـ.
وأقول تقفيةً على أثره: إنّ مقام الحديث غير مقام الآية، فمقام الحديث مقام تعليم خاصّ لمن نشأ وشبّ وترجّل في الإسلام. فتقرّر قصر الحكم لديه على طرف الثُّمَام؛ ولذلك استغنى عنه، وأمّا مقام هذه الآية فمقام مفتتح الوحي والتشريع واستهلال الوعظ والتقريع، فناسب تأكيد الحكم بالقصر مع التعريض بحال الشِّرْك الشنيع، على أنّ تعليق الأمر بهما في جواب الشرط على حصول أيّ سؤال وأيّة استعانة يفيد مفاد القصر تعريضًا بالمشركين وبراءة من صنيعهم، فقد كانوا يستعينون بآلهتهم، ومن ذلك الاستقسام بالأزلام الموضوعة عند الآلهة والأصنام»[13].
الموضع الثاني: في تفسير قوله تعالى: ﴿صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ [الفاتحة: 7].
«ثم إنّ في اختيار وصف الصراط المستقيم بأنه صراط الذين أنعمت عليهم دون بقية أوصافه تمهيدًا لبساط الإجابة، فإنّ الكريم إذا قلتَ له: أعطني كما أعطيت فلانًا كان ذلك أنشط لكرمه، كما قرّره الشيخ الجدّ -قدّس الله سرّه- فيقوله صلى الله عليه وسلم: (كما صلّيتَ على إبراهيم)[14]، فيقول السائلون: اهدنا الصراطَ المستقيم، الصراطَ الذي هَديْتَ إليه عبيد نِعَمِكَ، مع ما في ذلك من التعريض بطلب أن يكونوا لاحقين في مرتبة الهُدَى بأولئك المنعَم عليهم، وتهمُّمًا بالاقتداء بهم في الأخذ بالأسباب التي ارتقوا بها إلى تلك الدرجات، قال تعالى: ﴿لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الممتحنة: 6]، وتوطئة لِما سيأتي بعدُ من التبرّؤ من أحوال المغضوب عليهم والضالين، فتضمّن ذلك تفاؤلًا وتعوُّذًا»[15].
الموضع الثالث: في تفسير قوله تعالى: ﴿إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ [البقرة: 271].
«وقال الشيخ ابن عاشور جدّي في تعليقٍ له على حديث فضلِ إخفاء الصدقة من صحيح مسلم: "عطف إيتاء الفقراء على الإخفاء المجعول شرطًا للخيرية في الآية -مع العلم بأنّ الصدقة للفقراء- يؤذِن بأن الخيرية لإخفاء حال الفقير وعدم إظهار اليد العليا عليه"، أي: فهو إيماء إلى العلة وأنها الإبقاء على ماء وجه الفقير، وهو القول الفصل لانتفاء شائبة الرياء»[16].
الموضع الرابع: في تفسير قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ [محمد: 33].
«وحمل بعض علمائنا قوله تعالى: ﴿وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ على معنى النهي عن قطع العمل المتقرب به إلى الله تعالى... ونقلَ الشيخ الجدّ في حاشيته على المحلّي عن القرافي في شرح المحصول، ونقل حَلُولُو في شرح جمع الجوامع عن القرافي في الذخيرة: أنّ مالكًا قال بوجوب سبع نوافل بالشروع، وهي: الصلاة، والصيام، والحج، والعمرة، والاعتكاف، والائتمام، وطواف التطوّع، دون غيرها، نحو: الوضوء، والصدقة، والوقف، والسفر للجهاد، وزاد حَلُولُو إلحاق الضحية بالنوافل التي تجب بالشروع، ولم أقف على مأخذ القرافي ذلك، ولا على مأخذ حَلُولُو في الأخير»[17].
ثانيًا: النقولات عن الشيخ الجد العلّامة الوزير:
الموضع الأول: في المقدمة الثانية من تفسيره، في استعمال العرب لعلمي البيان والمعاني وزيادة اختصاصه بعلم التفسير؛ لأنهما وسيلة لإظهار خصائص البلاغة القرآنية.
«وأمّا استعمال العرب، فهو التملي من أساليبهم في خطبهم وأشعارهم وأمثالهم وعوائدهم ومحادثاتهم، ليحصل بذلك لممارسة المولَّد ذوق يقوم عنده مقام السليقة والسجية عند العربي القُحّ، والذّوق كيفية للنفس بها تدرك الخواص والمزايا التي للكلام البليغ، قال شيخنا الجد الوزير: "وهي ناشئة عن تتبّع استعمال البلغاء، فتحصل لغير العربي بتتبّع موارد الاستعمال والتدبّر في الكلام المقطوع ببلوغه غاية البلاغة، فدعوى معرفة الذَّوْق لا تُقبل إلا من الخاصّة، وهو يضعف ويقوى بحسب مُثافَنة ذلك التدبر". ا هـ.
ولله درّه في قوله: "المقطوع ببلوغه غاية البلاغة" المشير إلى وجوب اختيار الممارس لِما يطالعه من كلامهم، وهو الكلام المشهود له بالبلاغة بين أهل هذا الشأن، نحو المعلّقات والحماسة، ونحو نهج البلاغة ومقامات الحريري ورسائل بديع الزمان»[18].
الموضع الثاني: في تفسير قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [البقرة: 178].
«ويبقى بعد هاته التأويلات سؤال قائم عن وجه تخصيص الأنثى بعد قوله تعالى: ﴿الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ﴾، وهل تخرج الأنثى عن كونها حرّة أو أمَة بعد ما تبين أنّ المراد بالحر والعبد الجنسان؛ إِذْ ليس صيغة الذكور فيها للاحتراز عن النساء منهم؛ فإنّ (ال) لمّا صيرته اسم جنس صار الحكم على الجنس وبطل ما فيه من صيغة تأنيث، كما يبطل ما فيه من صيغة جمع إن كانت فيه.
ولأجل هذا الإشكال سألتُ العلّامة الجد الوزير -رحمه الله- عن وجه مجيء هذه المقابلة المشعرة بألّا يُقتص من صنف إلّا لقتلِ مماثِلِه في الصفة، فترك لي ورقة بخطّه فيها ما يأتي: الظاهر -والله تعالى أعلم- أنّ الآية (يعني آية سورة المائدة) نزلَتْ إعلامًا بالحكم في بني إسرائيل تأنيسًا وتمهيدًا لحكم الشريعة الإسلامية؛ ولذلك تضمّنت إناطة الحكم بلفظ النفس المتناول للذكر والأنثى، الحُرّ والعبد، الصغير والكبير، ولم تتضمّن حكمًا للعبيد ولا للإناث، وصُدِّرَت بقوله: ﴿وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيهَا﴾ [المائدة: 45]، والآية الثانية (يعني آية سورة البقرة)، بقوله: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُم﴾، وناط الحكم فيها بالحرية المتناولة للأصناف كلّها، ثم ذكر حكم العبيد والإناث ردًّا على من يزعم أنه لا يقتصّ لهم، وخصّص الأنثى بالأنثى للدلالة على أنّ دمها معصوم؛ وذلك لأنه إذا اقتصّ لها من الأنثى ولم يقتص لها من الذَّكَر، صار الدم معصومًا تارة لذاته غير معصوم أخرى، وهذا من لطف التبليغ حيث كان الحكم متضمنًا لدليله، فقوله:
كَتَبَ الْقَتْلَ وَالْقِتَالَ عَلَيْنَا ** وَعَلَى الْغَانِيَاتِ جَرُّ الذُّيُولِ
حكم جاهلي».[19] ا هـ.
الموضع الثالث: في تفسير قوله تعالى: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ﴾ [البقرة: 197].
«واختلف في المراد بالجدال هنا، فقيل: السباب والمغاضبة، وقيل: تجادل العرب في اختلافهم في الموقف؛ إِذْ كان بعضهم يقف في عرفة وبعضهم يقف في جمعٍ، ورُوي هذا عن مالك.
واتفق العلماء على أنّ مدارسة العلم والمناظرة فيه ليست من الجدال المنهي عنه، وقد سمعتُ من شيخنا العلّامة الوزير أنّ الزمخشري لمّا أتم تفسير الكشاف وضعه في الكعبة في مدّة الحج بقصد أن يطالعه العلماء الذين يحضرون الموسم، وقال: "مَن بدَا له أن يجادل في شيء فليفعل"، فزعموا أن بعض أهل العلم اعترض عليه قائلًا: بماذا فسّرت قوله تعالى: ﴿وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ وأنه وجَمَ لها، وأنا أحسب إِنْ صحّت هذه الحكاية أنّ الزمخشري أعرض عن مجاوبته؛ لأنه رآه لا يفرِّق بين الجدال الممنوع في الحج وبين الجدال في العِلْم»[20].
الموضع الرابع: في تفسير قوله تعالى: ﴿أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ [التوبة: 19].
«وقد كانت سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام من أعظم مناصب قريش في الجاهلية، والمناصب عشرة، وتسمّى المآثر، فكانت السقاية لبني هاشم بن عبد مناف بن قصي، وجاء الإسلام وهي للعباس بن عبد المطلب، وكانت عمارة المسجد، وهي السّدانة، وتسمّى الحجابة، لبني عبد الدار بن قصيّ، وجاء الإسلام وهي لعثمان بن طلحة.
وكانت لهم مناصب أخرى ثمانية أبطلها الإسلام رأيتُها بخط جدّي العلّامة الوزير، وهي: الدّيات والحملات، السّفارة، الراية، الرّفادة، المشورة، الأعنّة والقبّة، الحكومة وأموال الآلهة، الأيسار»[21].
الموضع الخامس: في تفسير قوله تعالى: ﴿إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا﴾ [مريم: 42].
«قال الجد الوزير -رحمه الله- فيما أملاه عليّ ذات ليلة من عام ١٣١٨هــ، فقال: علم إبراهيم أنّ في طبع أهل الجهالة تحقيرهم للصغير كيفما بلغ حاله في الحذق وبخاصة الآباء مع أبنائهم، فتوجّه إلى أبيه بخطابه بوصف الأبوّة إيماءً إلى أنه مخلصٌ له النصيحة، وألقَى إليه حجّة فساد عبادته في صورة الاستفهام عن سبب عبادته وعمله المخطئ، منبهًا على خطئه عندما يتأمّل في عمله، فإنه إن سمع ذلك وحاول بيان سبب عبادة أصنامه لم يجد لنفسه مقالًا، ففطن بخطل رأيه وسفاهة حِلْمه، فإنه لو عبد حيًّا مميزًا لكانت له شبهةٌ ما.
وابتدأ بالحُجّة الراجعة إلى الحسّ، إِذْ قال له: ﴿لِـمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ﴾، فذلك حُجّة محسوسة، ثم أتبعها بقوله: ﴿وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا﴾، ثم انتقل إلى دفع ما يخالج عقل أبيه من النفور عن تلقّي الإرشاد من ابنه بقوله: ﴿يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا﴾ [مريم: 43]، فلمّا قضى حقّ ذلك انتقل إلى تنبيهه على أنّ ما هو فيه أثر من وساوس الشيطان، ثم ألقَى إليه حُجّة لائقة بالمتصلِّبين في الضلال بقوله: ﴿يَا أَبَتِ إِنِّي أَخافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذابٌ مِنَ الرَّحْمنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطانِ وَلِيًّا﴾ [مريم: 45]، أي أنّ الله أبلغَ إليك الوعيد على لساني، فإن كنت لا تجزم بذلك فافرض وقوعه، فإنّ أصنامك لم تتوعدك على أن تفارق عبادتها. وهذا كما في الشعر المنسوب إلى عليّ رضي الله عنه:
زَعَمَ الْمُنَجِّمُ وَالطَّبِيبُ كِلَاهُمَا ** لَا تُحْشَرُ الْأَجْسَامُ، قُلْتُ: إِلَيْكُمَا
إِنْ صَحَّ قَوْلُكُمَا فَلَسْتُ بِخَاسِرٍ ** أَوْ صَحَّ قَوْلِي فَالْخَسَارُ عَلَيْكُمَا
قال: وفي النداء بقوله: ﴿يَا أَبَتِ﴾ أربع مرّات تكرير اقتضاه مقام استنزاله إلى قبول الموعظة؛ لأنها مقام إطناب. ونُظِّر ذلك بتكرير لقمان قوله: ﴿يَا بُنَيَّ﴾ [لقمان: 13، 16، 17] ثلاث مرات، قال: بخلاف قول نوح لابنه: ﴿يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا﴾ [هود: 42] مرّة واحدة دون تكرير؛ لأن ضيق المقام يقتضي الإيجاز، وهذا من طرق الإعجاز. انتهى كلامه بما يقارب لفظه.
وأقول: الوجه ما بُني عليه من أنّ الاستفهام مستعمل في حقيقته، كما أشار إليه صاحبُ الكشاف، ومُكنًّى به عن نفي العلّة المسؤول عنها بقوله: ﴿لِـمَ تَعْبُدُ﴾، فهو كناية عن التعجيز عن إبداء المسؤول عنه، فهو من التورية في معنيين يحتملهما الاستفهام»[22].
الموضع السادس: في تفسير قوله تعالى: ﴿يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ﴾ [الحج: 2].
«والذهول: نسيان ما من شأنه أن لا يُنسى لوجود مقتضى تَذكُّره؛ إمّا لأنه حاضر أو لأنّ عِلْمه جديد، وإنما يُنسى لشاغل عظيم عنه، فذكر لفظ الذهول هنا دون النسيان لأنه أدلّ على شدّة التشاغل. قاله شيخنا الجدّ الوزير، قال: وشفقة الأمّ على الابن أشدّ من شفقة الأب، فشفقتها على الرضيع أشدّ من شفقتها على غيره. وكلّ ذلك يدلّ بدلالة الأَوْلَى على ذهول غيرها من النساء والرجال»[23].
الموضع السابع: في تفسير قوله تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا﴾ [الفرقان: 32].
«ومنه ما قال الجد الوزير -رحمه الله-: إنّ القرآن لو لم ينزل منجمًا على حسب الحوادث لَمَا ظهر في كثير من آياته مطابقتها لمقتضى الحال ومناسبتها للمقام؛ وذلك من تمام إعجازها. وقلت: إنّ نزوله منجمًا أعون لحفّاظه على فهمه وتدبّره»[24].
الموضع الثامن: في تفسير قوله تعالى: ﴿مَن كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا﴾ [فاطر: 10].
«و(مَن) شرطية، وجعل جوابها: ﴿فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا﴾، وليس ثبوت العزة لله بمرتّب في الوجود على حصول هذا الشرط، فتعيّن أنّ ما بعد فاء الجزاء هو علّة الجواب أُقيمت مقامه واستُغني بها عن ذِكْرِه إيجازًا، وليحصل من استخراجه من مطاوي الكلام تقرّره في ذهن السامع، والتقدير: مَن كان يريد العزة فلْيستجِب إلى دعوة الإسلام، ففيها العزة؛ لأنّ العزة كلّها لله تعالى، فأمّا العزة التي يتشبثون بها فهي كخيط العنكبوت؛ لأنها واهية بالية.
وهذا أسلوب متّبع في المقام الذي يُراد فيه تنبيه المخاطب على خطأ في زعمه، كما في قول الربيع بن زياد العبسي في مقتل مالك بن زهير العبسي:
مَنْ كَانَ مَسْرُورًا بِمَقْتَلِ مَالِكٍ ** فَلْيَأْتِ نِسْوَتَنَا بِوَجْهِ نَهَارِ
يَجِدِ النِّسَاءَ حَوَاسِرًا يَنْدُبْنَهُ ** بِاللَّيْلِ قَبْلَ تَبَلُّجِ الْإِسْفَارِ
أراد أن مَنْ سَرّه مقتل مالك فلا يتمتع بسروره ولا يحسب أنه نال مبتغاه؛ لأنه إن أتى ساحة نسوتنا انقلب سروره غمًّا وحزنًا، إِذْ يجد دلائل أخذ الثأر من قاتله باديةً له؛ لأنّ العادة أنّ القتيل لا يندبُه النساء إلا إذا أُخِذَ ثأرُه. هذا ما فسّره المرزوقي وهو الذي تلقيته عن شيخنا الوزير، وفي البيتين تفسير آخر»[25].
الخاتمة:
في ختام هذه المقالة، قُمنا بعرض جميع المواضع التي ذَكَر فيها العلّامةُ ابن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير، النقولاتِ التي نقلها عن جدّه الشيخ ابن عاشور، وجدّه العلّامة الوزير محمد بوعتور، فقد أسهَمَت البيئة الأسرية التي نشأ فيها العلّامة ابن عاشور في تشكيل ملامح من شخصيته العلمية؛ إِذْ نشأ في بيت علمٍ وفضلٍ عريق، تزخر أجواؤه بالاهتمام بالعلوم الشرعية والأدبية والعقلية، فكان لذلك الأثر البالغ في صقل ملكاته وتنمية نبوغه العلمي.
وقد نهل العلّامة ابن عاشور من مَعِينها الصافي مباشرة، من جدَّيْه الفاضلَيْن مشافهةً واستماعًا، فكان يتلقّى عنهما تارة بالسماع المباشر، وتارة أخرى من خلال قراءته لحواشيهما وتعليقاتهما المخطوطة بخطّ أيديهما، أو مما كان يُملَى عليه منهما، فاستفاد بذلك من علمهما، وشبَّ على حُبّ العلم، متشبعًا بروح التحقيق.
ولقد تنوَّعَت نقولات العلّامة ابن عاشور عن جدَّيْه رحمهما الله، فتارة تكون في تعليق على حديث، وتارة في البلاغة، وتارة في الفقه، ومعظمها في التفسير مِن نكتٍ ولطائف، ولم يخالف قول جدَّيْه في شيء من تلك المواضع، بل يذكره ويستحسنه، أو يقفي على أثرهما بقوله وتعليقه.
وبذلك يتّضح أن البيئة الأسرية التي ترعرع في كنفها العلّامة ابن عاشور كانت النواة الأولى التي صاغت اتجاهه التفسيري، حتى أخرج للأمة الإسلامية تفسيره التحرير والتنوير، تفسيرًا يجمع بين أصالة التراث ونضج الفكر، فجزى اللهُ تلك الأسرة العلمية خيرَ الجزاء، وبارك في إرثها المبارك، وصلِّ اللهم وسلِّم وبارك على سيدنا محمد النبي المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين.
[1] تراجم المؤلفين التونسيين، د. محمد محفوظ (ت: 1408هـ)، (3/ 300).
[2] معجم المفسرين من صدر الإسلام وحتى العصر الحالي، د. عادل نويهض، (2/ 542).
[3] شيخ الإسلام الإمام الأكبر محمد الطاهر بن عاشور، د. محمد الحبيب بن الخوجة، (1/ 147).
[4] شيخ الإسلام الإمام الأكبر، د. محمد بن الخوجة (3/ 305).
[5] تراجم المؤلفين التونسيين، د. محمد محفوظ (3/ 307).
[6] إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان، أحمد بن أبي الضياف (ت: 1291هـ)، (8/ 165).
[7] إتحاف أهل الزمان، أحمد بن أبي الضياف (8/ 167).
[8] شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، الإمام محمد بن محمد بن مخلوف (ت: 1360هـ)، (1/ 597).
[9] تراجم المؤلفين التونسيين، د. محمد محفوظ (3/ 355).
[10] مقاصد الشريعة الإسلامية، العلّامة الشيخ محمد الطاهر بن عاشور (ت: 1393هـ)، (1/ 137).
[11] شجرة النور الزكية، الإمام محمد بن مخلوف (1/ 597).
[12] أخرجه الترمذي في سننه، كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في صفة أواني الحوض، حديث رقم (2516).
[13] التحرير والتنوير، العلّامة محمد الطاهر بن عاشور (ت: 1393هـ)، (1/ 185).
[14] أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الدعوات، باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رقم (5997).
[15] التحرير والتنوير (1/ 192).
[16] التحرير والتنوير (2/ 59).
[17] التحرير والتنوير (10/ 398).
[18] التحرير والتنوير (1/ 21).
[19] التحرير والتنوير (2/ 138-139).
[20] التحرير والتنوير (1/ 912).
[21] التحرير والتنوير (5/ 118).
[22] التحرير والتنوير (7/ 74).
[23] التحرير والتنوير (7/ 349).
[24] التحرير والتنوير (8/ 271).
[25] التحرير والتنوير (9/ 223).


