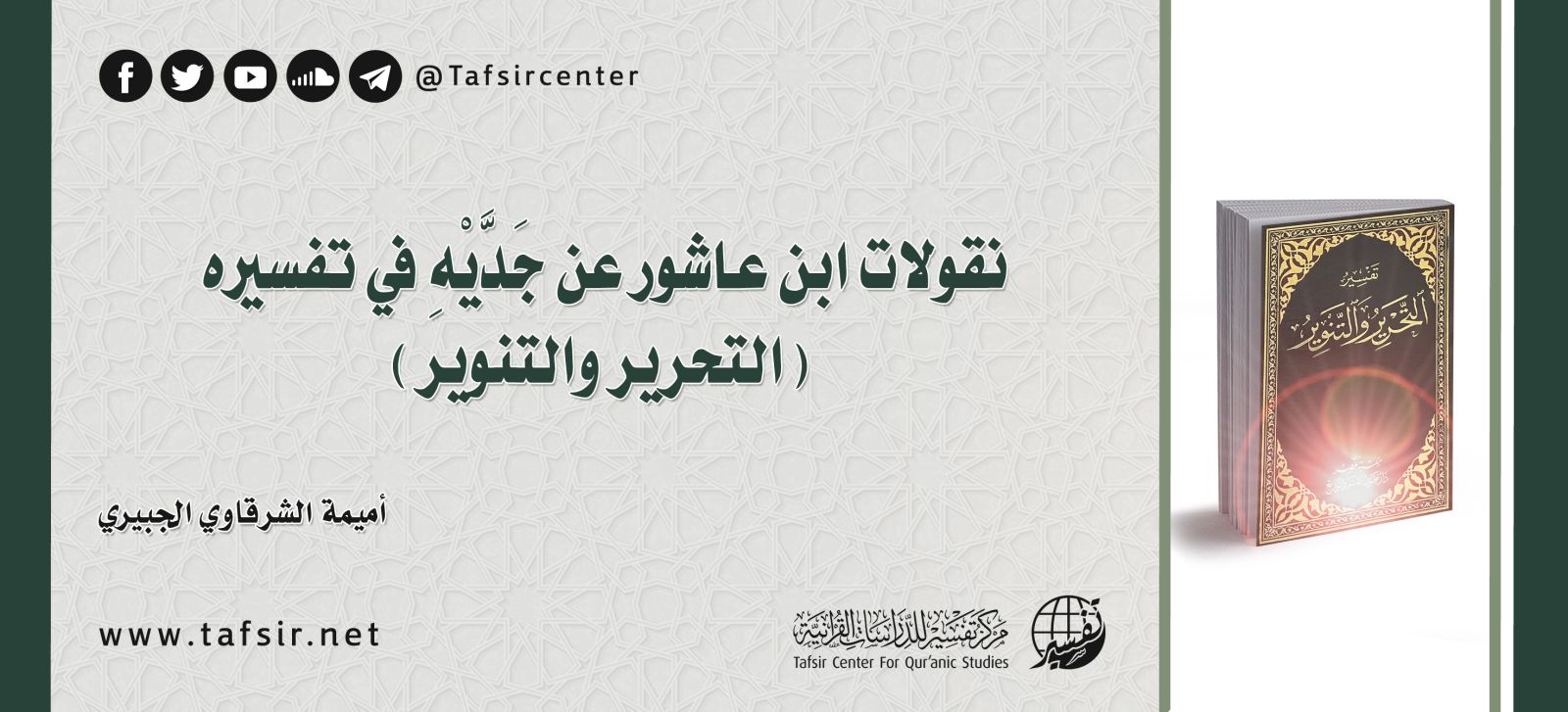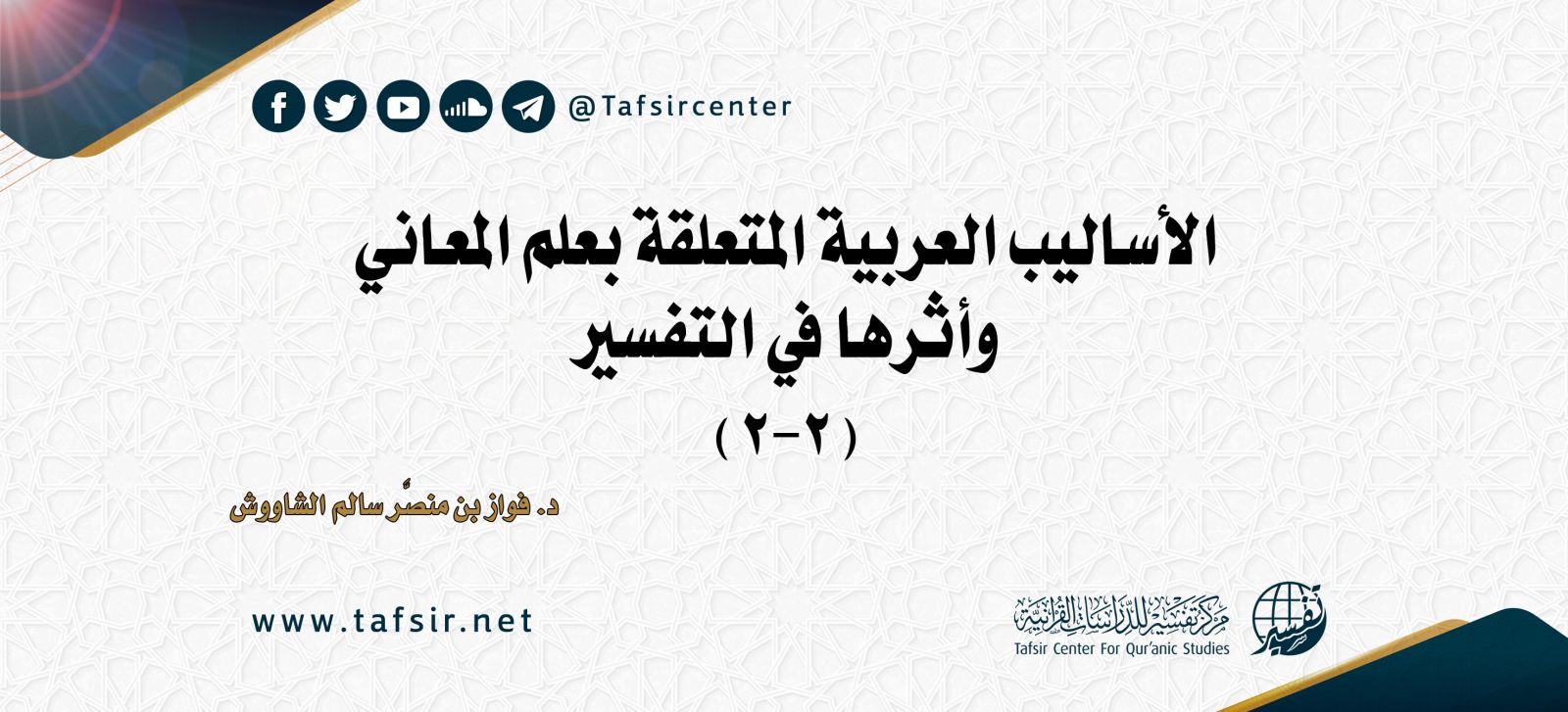أساليب نقد التفسير عند ابن جرير الطبري في تفسيره (جامع البيان)
أساليب نقد التفسير عند ابن جرير الطبري في تفسيره (جامع البيان)
الكاتب: يوسف بن جاسر الجاسر

أساليب نقد التفسير عند ابن جرير الطبري[1]
أولًا: نقد التفسير وبيان الدليل على القول الصحيح:
قـرّر ابن جرير في مقدّمة تفسيره قولًا جامعًا في نقده للتفسير، فقال في مقدّمة تفسيره: «...فأَحَقُّ المفسِّرين بإصابة الحقّ في تأويل القرآن الذي إلى علم تأويله للعباد السبيل: أوضحهم حُجّة فيما تأوّل وفسّر؛ مما كان تأويله إلى رسول الله دون سائر أمّته، من أخبار رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الثابتة عنه:
- إمّا من جهة النقل المستفيض، فيما وجد من ذلك عنه النقل المستفيض.
- وإمّا من جهة نقل العُدول الأثبات فيما لم يكن عنه فيه النقل المستفيض.
- وإمّا من جهة الدلالة المنصوبة على صحته.
وأوضحهم برهانًا فيما ترجم وبَيَّن من ذلك مما كان مدركًا علمه من جهة اللسان: إمّا بالشواهد من أشعارهم السائرة، وإمّا من منطقهم ولغاتهم المستفيضة المعروفة.
كائنًا من كان ذلك المتأوّل والمفسّر، بعد ألا يكون خارجًا تأويله وتفسيره ما تأوّل وفسّر من ذلك عن أقوال السلف من الصحابة والأئمة والخلف من التابعين وعلماء الأمّة»[2].
وقال أيضًا: «وغير جائز إحالة ظاهر التنزيل إلى باطن من التأويل لا دلالة عليه من نصِّ كتابٍ، ولا خبرٍ لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ولا إجماعٍ من الأمّة، ولا دلالة من بعض هذه الوجوه»[3].
ويقرّر ابن جرير القول الصحيح بأساليب ترجع إلى هذا الأصل الجامع، ومنها:
الأول: جمع الأدلة:
يحشد ابن جرير لتقرير القول الصحيح في مقابل الآراء المخالفة أدلته النقلية والنظرية، ففي تأويل قوله تعالى: ﴿إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ﴾ [القصص: 76]، ابتدأ ابن جرير تأويلها، فقال: «وآتينا قارون من كنوز الأموال ما إنّ مفاتحه -وهي جمع مفتح، وهو الذي يفتح به الأبواب، وقال بعضهم: عَنى بالمفاتح في هذا الموضع: الخزائن- تثقل العصبة؛ وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل».
ورواه عن ابن عباس، ومجاهد، وأبي صالح، والضحاك.
ثم حكى اختلاف أهل العلم بكلام العرب في توجيه كيف تنوء المفاتيح بالعصبة، وإنما العصبة هي التي تنوء بها.
ثم عقّب بتصحيح قول بعض أهل العربية[4] الموافق لاختياره، فقال: «وهذا القول الآخرُ في تأويل قوله: ﴿لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ﴾ أولى بالصواب من الأقوال الأُخَرِ؛ لمعنيَين:
أحدهما: أنه تأويل موافق لظاهر التنزيل.
والثاني: أنّ الآثار التي ذكرنا عن أهل التأويل بنحو هذا المعنى جاءت.
وأنَّ قول من قال: معنى ذلك: ما إنّ العصبة لتنوء بمفاتحه- إنما هو توجيهٌ منهم إلى أن معناه: ما إن العصبة لتَنْهَضُ بمفاتحه. وإذا وجه إلى ذلك لم يكن فيه من الدلالة على أنه أُريد به الخبر عن كثرة كنوزه على نحو ما فيه إذا وجِّه إلى أنّ معناه: إنّ مفاتحه تُثْقِلُ العصبة وتُمِيلُها؛ لأنه قد تَنْهَضُ العصبة بالقليل من المفاتح وبالكثير، وإنما قصد جلّ ثناؤُه الخبر عن كثرة ذلك»[5].
وهذا من النماذج التي تبرز عمق قراءة ابن جرير النقدية في جمعها بين الأدلة النقلية والنظرية، وبيان توافقها وتطابقها في بيان المعنى الصحيح[6].
كما يجمع ابن جرير بين النقد الداخلي (كظاهر القرآن، والسياق، واللغة، والعموم، وغيرها)، والخارجي (كالسُّنة، والإجماع، والنزول، وأقوال أهل التأويل، والتاريخ، وغيرها).
ومنه ما ذكره في تأويل قوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ﴾ [البقرة: 143]؛ فقد قرّر ابن جرير تفسيرها بقوله: «وأمّا معناه عندنا؛ فإنه: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا ليعلم رسولي وحزبي وأوليائي من يتبعُ الرسول ممن ينقلبُ على عقبيه، فقال -جلّ ثناؤه-: ﴿لِنَعْلَمَ﴾ ومعناه ليعلم رسولي وأوليائي؛ إِذْ كان رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- وأولياؤه من حزبه.
وكان من شأنِ العرب إضافة ما فعلته أتباع الرئيس إلى الرئيس، وما فعل بهم إليه، نحو قولهم: (فتح عمر بن الخطاب سواد العراق وجَبى خراجها)، وإنما فعل ذلك أصحابه، عن سبب كان منه في ذلك.
وكالذي روَى في نظيره عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: يقول الله جل ثناؤه: (مرضتُ فلم يَعُدْنِي عبدي، واستقرضْتُه فلم يقرضني، وشتمني ولم ينبغِ له أن يشتمني)[7].
فأضاف تعالى الاستقراض والعيادة إلى نفسه، وقد كان ذلك بغيره؛ إِذْ كان ذلك عن سببه»[8].
فقد جمع ابن جرير في نقده واختياره بين النقد الداخلي (اللغة وأساليب العرب في كلامها)، والخارجي (دليل السُّنة)[9].
لكن هذا راجع إلى قوة الخلاف، وإلى ما توافر لنقده من أدلة، وإلا فإنه قد يكتفي ببعض أصوله النقدية في تقرير صحة الأقوال وحجّيتها، قال ابن جرير -بعد نقله لقول الحسن البصري في منع القسم باسم الله (الرحمن)-: «مع أن في إجماع الأمّةِ مِن منعِ التَّسَمِّي به جميع الناسِ، ما يُغْنِي عن الاسْتِشْهادِ على صحة ما قلنا في ذلك بقول الحسن وغيره»[10].
فمن اقتصاره على واحدٍ من أدلته وأصوله النقدية:
أ. النظائر القرآنية:
ففي تأويل قوله تعالى: ﴿فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ﴾ [البقرة: 23]؛ حكى ابن جرير اختلاف أهل التأويل في مرجع الضمير في قوله: (مثله) هل هو عائد إلى القرآن أو إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ثم عقب بقوله: «والتأويل الأوّل، الذي قاله مجاهد وقتادة هو التأويل الصحيح؛ لأن الله جل ثناؤُه قال في سورة أخرى: ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ﴾ [يونس: 38]، ومعلوم أن السورة ليست لمحمد بنظير ولا شبيه فيجوز أن يقال: فأتوا بسورة مثل محمد»[11].
ب. السُّنة النبوية:
وسواء منها: الأحاديث المتواترة؛ كما حكى ابن جرير اختلاف أهل التأويل في معنى (الوفاة) في قوله تعالى: ﴿إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ﴾ [آل عمران: 55]؛ ثم عقّب بنقده واختياره، فقال: «وأَوْلَى هذه الأقوال بالصحة عندنا قولُ من قال: معنى ذلك: إني قابضُك من الأرض ورافعك إليَّ؛ لتَواتُرِ الأخبار عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أَنه قال: (يَنْزِلُ عيسى ابنُ مريمَ، فيَقْتُلُ الدجال، ثم يَمْكُثُ في الأرض -مدّةً ذكَرَها، اخْتَلَف الرواةُ فِي مَبْلَغِها- ثم يموتُ، فيُصَلِّي عليه المسلمون ويدفنونه)[12]»[13].
وكذلك الأحاديث الصحيحة غير المتواترة، ومنه ما ذكره ابن جرير في تأويل قوله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّـمَا غَنِمْتُم مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى﴾ [الأنفال: 41]؛ إِذْ حكى خلاف أهل العلم في المراد بـ(ذي القربي)؛ ثم عقّب بنقده واختياره، فقال: «وأولى الأقوال في ذلك بالصواب عندي قول من قال: سهم ذي القربي كان لقرابة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من بني هاشم وحلفائهم من بني المطلب؛ لأن حليف القومِ منهم، ولصحة الخبر الذي ذكرناه بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم».
ويعني بالخبر: ما رواه بسنده من حديث جبير بن مطعم -رضي الله عنه- مرفوعًا، وفيه: «إنهم لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام، إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيءٌ واحدٌ»، ثم شبّك رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يديه إحداهما بالأخرى[14].
ج. الإجماع:
ومن ذلك ما ذكره في حكم القتال في الأشهر الحرم، وهل هو منسوخ في تأويل قوله تعالى: ﴿وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ﴾ [المائدة: 2]: «وأَولى الأقوال في ذلك بالصحة قول مَن قال: نسخ الله من هذه الآيةِ قولَه: ﴿وَلَا الشَّهْرَ الحَرَامَ وَلَا الْهَدْي وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ﴾؛ لإجماع الجميع على أن الله جل ثناؤه قد أَحَلَّ قتال أهل الشِّرك في الأشهر الحرم وغيرها من شهور السّنَة كلِّها»[15].
د. لغة العرب:
فقد ذكر اختلاف أهل التأويل في المراد بـ﴿حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة: 196]، ثم عقّب بنقده واختياره، فقال: «وأَوْلَى الأقوال في ذلك بالصحة عندنا قولُ من قال: إنّ حاضري المسجد الحرامِ مَن هو حوله ممن بينه وبينه من المسافة ما لا تقصر إليه الصلوات؛ لأنّ (حاضر الشيء) في كلام العرب، هو الشاهد له بنفسه...»[16].
وهكذا في سائر أدلّته وأصوله النقدية.
الثاني: الجمع بين الأدلة:
فقد عُني بنقده -فيما يرويه من الأحاديث والآثار والمرويات المتعارضة- بالجمع بين ما يوهم ظاهره التعارض من الأدلة؛ ليبيّن القول الصحيح، ومن ذلك ما ذكره في تأويل قوله تعالى: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ [المائدة: 96]؛ إذ ذكر اختلاف أهل العلم في حكم الصيد للمُحرِم، وجمع بين الأدلة المتعارضة، فعقّب بنقده واختياره، فقال: «والصواب في ذلك من القول عندنا أن يُقال: إنَّ الله تعالى عمّ تحريم كلّ معاني صيد البرّ على الـمُحْرِم في حال إحرامه، من غير أن يخصّ من ذلك شيئًا دون شيء، فكلّ معاني الصيد حرامٌ على الـمُحْرِم ما دام حرامًا؛ بيعه وشراؤه واصطياده وقتله، وغير ذلك من معانيه، إلا أن يجده مذبوحًا قد ذبحه حلالٌ لحلالٍ، فيحلّ له حينئذ أكله؛ للثابت من الخبر عن رسول الله...، عن عبد الرحمن بن عثمان، قال: كنّا مع طلحة بن عبيد اللهونحن حُرُم، فأُهدي لنا طائر، فمنّا مَن أكَلَ، ومنّا مَن تورّع فلم يأكُلْ، فلمّا استيقظَ طَلحةُ وفَّقَ مَنْ أَكَلَ، وَقَالَ: (أَكَلْنَاهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم)»[17].
ثم بيَّن ما يُعارِض هذا الحديث، ومنهجه في الجمع، فقال: «فإن قال قائل: فما أنت قائل فيما رُوي عن الصعب بن جثّامة، أَنَّهُ أَهْدَى إلى رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- رِجْلَ حِمار وحش يقطرُ دَمًا، فَرَدَّهُ فَقَالَ: (إِنَّا حُرُمٌ)»[18].
وفيما رُوي عن عائشة: «أَنَّ وَشِيقةَ[19] ظَبْيٍ أُهْدِيَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَرَدَّهَا»[20]، وما أشبه ذلك من الأخبار؟
قيل: إنه ليس في واحد من هذه الأخبار التي جاءت بهذا المعنى بيان أنَّ رسول الله ردَّ من ذلك ما ردَّ، وقد ذبحه الذابحُ إِذْ ذَبَحَهُ وَهُوَ حَلَالٌ لِحَلالٍ، ثُمَّ أهداه إلى رسول الله وهو حَرامٌ فردَّه، وقال: «إنه لا يحلّ لنا لأَنَّا حُرُمٌ»، وإنما ذكر فيه أنه أُهدي لرسول الله لحمُ صيدٍ فردَّه، وقد يجوز أن يكون ردّه ذلك من أجل أنّ ذابحه ذبحه، أو صائده صاده من أجلهِ وهو مُحْرِم، وقد بَيَّنَ خبر جابر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بقوله: (لَحْمُ صَيْدِ البَرِّ للمُحْرِمِ حَلَالٌ، إِلَّا مَا صَادَهُ أَوْ صِيدَ له)[21]، معنی ذلك کلّه.
فإذا كان كِلا الخبرَيْن صحيحًا مخرجهما، فواجب التصديق بهما، وتوجيه كلّ واحد منهما إلى الصحيح من وجه، وأن يُقال: ردُّه ما ردَّ من ذلك من أجلِ أنه كان صِيْدَ مِن أجلِه. وإِذْنُهُ في كلّ ما أذن في أكله منه، من أجل أنه لم يكن صِيدَ لِمُحرِم، ولا صادَه مُـحرِم، فيصحّ معنى الخبرَين كليهما[22].
الثالث: مراعاة الأصل:
فيقدّم الظاهر على الباطن، والعموم على الخصوص، والإحكام على النسخ، وفق أصوله وقواعده النقدية.
فمن تقديم الإحكام على النَّسْخ ما ذكره في تأويل قوله تعالى: ﴿فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾ [المائدة: 42]، فقد حكى الخلاف في نَسْخ حكم الآية، ثم عقّب بنقده وتقريره، فقال: «وأَوْلَى القولَيْن في ذلك عندي بالصواب قولُ من قال: إنّ حكم هذه الآية ثابت لم يُنْسَخ، وإن للحُكّام -مِن الخيار في الحكم بين أهل العهد إذا ارْتَفَعُوا إليهم فاحْتَكَمُوا، وتَرْكِ الحكم بينهم والنظرِ- مثل الذي جعله الله لرسوله من ذلك في هذه الآية.
وإذا لم يَكُنْ في ظاهرِ التنزيل دليلٌ على نسخِ إحدى الآيتين الأخرَى، ولا نفيِ أحد الأمرين حُكْمَ الآخر، ولم يَكُنْ عن رسولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- خبر يَصِحُّ بأنّ أحدهما ناسخٌ صاحبَه، ولا من المسلمين على ذلك إجماع -صحَّ ما قُلنا من أنّ كِلا الأمرَيْن يُؤَيِّدُ أحدُهما صاحبَه، ويُوافِقُ حكمُه حكمَه، ولا نسخ في أحدهما للآخر»[23].
ومن تقديم العموم على الخصوص، ما ذكره في بيان معنى (الزُّور) في تأويل قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ﴾ [الفرقان: 72]؛ إِذْ قرّر الأخذ بالعموم، فقال: «وأصلُ الزُّورِ تحسينُ الشيء، ووَصْفُه بخلافِ صفته، حتى يُخيَّل إلى مَن يسمعه أو يراه أنه بخلاف ما هو به، والشركُ قد يَدخُلُ في ذلك؛ لأنه مُحسَّنٌ لأهله، حتى قد ظنُّوا أنه حقٌّ، وهو باطلٌ، ويدخُلُ فيه الغِناءُ؛ لأنه أيضًا مما يُحسِّنُه ترجيعُ الصوتِ، حتى يَستحلِيَ سامعُه سماعَه، والكذبُ أيضًا قد يدخل فيه، لتحسين صاحبه إياه، حتى يظنَّ صاحبه أنه حقٌّ، فكلّ ذلك مما يدخُلُ في معنى الزُّورِ.
فَإِذْ كان ذلك كذلك؛ فأَولى الأقوال بالصواب في تأويله أن يقال: والذين لا يشهدون شيئًا من الباطل؛ لا شركًا، ولا غناءً، ولا كذبًا، ولا غيره، وكلّ ما لزمه اسم الزور؛ لأن الله عَمّ في وصفه إياهم أنهم لا يشهدون الزور، فلا ينبغي أن يُخَصَّ من ذلك شيء إلا بحجةٍ يجب التسليم لها من خبرٍ أو عقل»[24].
وهكذا يقرّر ابن جرير الأخذ بالظاهر دون الباطن إلا بحجة ثابتة، فقال: «...فغير جائز أن يُتْرَكَ المفهوم مِن ظاهرِ الكتاب -والمعقولُ به ظاهرٌ في الخطاب والتنزيل- إلى باطنٍ لا دلالة عليه من ظاهرِ التنزيل، ولا خبر عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- منقول، ولا فيه من الحجة إجماع مُسْتَفِيض»[25].
الرابع: التوجيه والتحليل والتعليل:
مما تميز به ابن جرير في نقده للتفسير أنه يجمع إلى حُسن عرضه للآراء العناية بنقدها: تحليلًا وتوجيهًا وتعليلًا؛ ففي تأويل قوله تعالى: ﴿كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ﴾ [الأعراف: 29]؛ ذِكر الخلاف في معنى الآية، ثم قرّر اختياره بمراعاة المخاطبين، فقال: «وأَوْلَى الأقوال في تأويل ذلك بالصواب: القولُ الذي قاله من قال: معناه: كما بدأكم اللهُ خلقًا بعد أن لم تَكُونوا شيئًا، تَعُودون بعدَ فَنائِكم خلقًا مثلَه، يحشدكم إلى يوم القيامة؛ لأن الله تعالى أمرَ نبيَّه -صلى الله عليه وسلم- أَن يُعْلِمَ بما في هذه الآية قومًا مشركين أهلَ جاهلية، لا يُؤْمِنون بالـمَعادِ، ولا يُصَدِّقون بالقيامة...»[26].
ثم قرّر صحّة قوله بما رواه بسنده عن ابن عباس، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «يُحشَر الناسُ عُرَاةً غُرْلًا[27]، وأوّلُ مَن يُكْسَى إبراهيمُ». ثم قرَأَ: ﴿كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ﴾ [الأنبياء: 104][28].
ومن ذلك ما ذكره في تأويل قوله تعالى: ﴿وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولِئْكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾ [الزمر: 33]؛ فقد قال: «والصوابُ من القول في ذلك أن يقال: إنّ الله تعالى ذِكْره عَنى بقوله: ﴿وَالَّذِى جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ﴾ كُلَّ مَن دعا إلى توحيد الله، وتصديق رسوله، والعمل بما ابتعث به رسوله؛ من بينِ رسولِ الله وأتباعِه والمؤمنين به، وأن يقال: الصدقُ هو القرآنُ، وشهادة أن لا إله إلا الله، والمُصَدِّقُ به المؤمنون بالقرآن، من جميعِ خلقِ اللهِ كَائنًا مَن كان مِن نبيِّ الله وأتباعِه.
وإنما قلنا ذلك أَولى بالصواب؛ لأن قوله تعالى ذِكْره: ﴿وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ﴾ عَقِيبَ قوله: ﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ﴾ [الزمر: 32]، وذلك ذمٌّ مِن الله الـمُفْتَرِينَ عليه، الـمُكذِّبين بتنزيله ووحيه، الجاحدينَ وحدانيتَه، فالواجب أن يكون عَقِيبَ ذلك مدحُ مَن كان بخلاف صفة هؤلاء المذمومين»[29].
فهو يراعي في نقده ما يُعرف بعلم النقد المعاصر: السياق الداخلي والخارجي للنصّ[30].
الخامس: الإجمال فيما لم يأتِ به بيان:
وهو ما قرّره ابن جرير في نقده للتفسير، خاصّة منها ما جاء في الأخبار والإسرائيليات، ففي تأويل قوله تعالى: ﴿فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا﴾ [البقرة: 73]، قرّر ابن جرير هذا الأمر، فقال: «والصواب من القول في تأويل قوله عندنا: ﴿فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا﴾، أن يقال: أمَرَهُم الله جل ثناؤه أن يضربوا القتيل ببعض البقرة لِيحيا المضروبُ. ولا دلالة في الآية، ولا خبر تقوم به حُجَّةٌ، على أيِّ أبعاضها التي أُمِرَ القومُ أن يضربوا القتيل به. وجائزٌ أن يكون الذي أُمِرُوا أن يضربوه به هو الفَخِذَ، وجائزٌ أن يكون ذلك الذَّنَبَ وغُضْرُوفَ الكَتِفِ وغيرَ ذلك من أبعاضِها. ولا يَضُرُّ الجهلُ بأيِّ ذلك ضربوا القتيل، ولا ينفَعُ العلم به، مع الإقرار بأنّ القوم قد ضرَبُوا القتيل ببعض البقرة بعدَ ذَبْحِها، فأحياه الله»[31].
فهذه بعض أساليب التفسير التي اعتمدها ابن جرير لنقد التفسير، والاستدلال على صحة الأقوال عنده.
ثانيًا: نقد التفسير، وتضعيف الأقوال المخالفة:
تعدّدَت أساليب ابن جرير في نقد التفسير لتقرير الأقوال بين ما كان منها لتصحيح القول الصواب -وهو ما سبق بحثه في المبحث السابق-، وما كان منها لتضعيف الأقوال المخالفة؛ ليتقرّر القول الصحيح[32].
وهذا هو ما قرّره ابن جرير؛ كما في تأويل قوله تعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [البقرة: 185]، فقد ذكر في الآية أقوالًا ثلاثة، ثم عقّب بنقد القولين بالسُّنة المتظاهرة والإجماع؛ ثم أوْرَد الأحاديث في خروج النبي -صلى الله عليه وسلم- عام الفتح من المدينة في شهر رمضان، بعدما صام بعضه، فأفطر، وأمرَ أصحابَه بالإفطار[33].
ثم عقّب بقوله -لتقرير هذا الأسلوب-: «فإذ كان فاسدًا هذان التأويلان؛ بما عليه دلّلنا من فسادهما، فبيِّنٌ أن الصحيح من التأويل: هو الثالث، وهو قول من قال: فمن شهد منكم الشهر فليصم جميع ما شهد منه مقيمًا، ومن كان مريضًا أو على سفرٍ فَعِدَّةٌ من أيامٍ أُخَرَ»[34].
فهذا هو الأول من الأساليب: تقرير القول الصحيح بإبطال الأقوال المخالفة.
الثاني: تقرير القول الصحيح لإبطال الأقوال المخالفة:
والفرق بينه والذي قبله أنّ الأول كانت مقدمته هي إبطال الأقوال المخالفة، لإثبات نقيض الحكم، وهنا العكس؛ حيث يقرّر القول الصحيح بما يبطل مخالفه، وهذا الأسلوب يُكثِر ابن جرير من استعماله في تقرير العقائد والأحكام في التفسير، سواء من جهة تقرير الدليل أو تقرير الدلالة؛ أمّا من جهة الدليل: فما ذكره في تأويل قوله تعالى: ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ [الفاتحة: 6]، حيث استدلّ ابن جرير بظاهر الآية والإجماع على إبطال قول القدرية[35]، فقال: «وفي أمرِ الله -جلّ ثناؤُه- عبادَه أن يقولوا: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ [الفاتحة: 5] -بمعنى: مسألتهم إياه المعونة على العبادة- أدلّ الدليل على فساد قول القائلين بالتفويض من أهل القدر الذين أحالوا أن يأمر الله أحدًا من عباده بأمرٍ أو يكلفه فرض عملٍ، إلا بعد إعطائه المعونة والقدرة على فعله وعلى تركه.
وفي إجماع أهل الإسلام جميعًا على تصويب قول القائل: اللهم إنّا نستعينك. وتخطئتهم قول القائل: اللهم لا تَجُرْ علينا، دليل واضح على خطأ ما قال الذين وصفت قولهم؛ إذ كان تأويل قول القائل عندهم: اللهم إنّا نستعينك: اللهم لا تترك معونتنا التي تَرْكُها جَوْرٌ منك»[36].
وأمّا من جهة الدلالة، فما ذكره ابن جرير في تأويل قوله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا﴾ [البقرة: 165]، إِذْ قال: «وإذ كانت الآية على ذلك دَالَّة، صحّ التأويلُ الذي تَأَوَّلَه السُّدِّيُّفي قوله: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا﴾ أَنَّ (الأَنْدَاد) في هذا الموضع إنما أُريد بها الأنداد من الرجال الذين يُطيعونهم فيما أمروهم من أمرٍ، ويَعْصُون الله في طاعتِهم إيَّاهم، كما يُطِيعُ اللهَ المؤمنون ويَعْصُون غيرَه - وفَسَد تأويل قولِ مَن قال: ﴿إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا﴾ [البقرة: 166]، أنهم الشياطينُ تَبَرَّؤُوا من أوليائهم من الإنس؛ لأنَّ هذه الآيةَ إنما هي في سياق الخبر عن مُتَّخِذي الأندَاد»[37].
وقد يدمج ابن جرير بين الأسلوبين، ففي تأويل قوله تعالى: ﴿تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ﴾ [المائدة: 106]، حكى ابن جرير الخلاف في تعيين الصلاة في الآية، ثم عقّب بنقده واختياره، فقال: «وأَولى القولين في ذلك بالصواب عندنا قول من قال: تحبسونهما من بعد صلاة العصر؛ لأنّ الله تعالى عرَّف الصلاة في هذا الموضع بإدخال الألف واللام فيها، ولا تُدْخِلُهما العربُ إلا في معروف، إمّا في جنس، أو في واحد معهودٍ معروف عند المخاطبين.
فَإِذْ كان ذلك كذلك، وكانت الصلاة في هذا الموضع مُجْمَعًا على أنه لم يُعْنَ بها جميع الصلواتِ، لم يَجُز أن يكونَ مُرادًا بها صلاةُ المُسْتَحْلَفِ من اليهود والنصارى؛ لأنّ لهم صلوات ليست واحدةً فيكون معلومًا أنها الـمَعْنِيَّةُ بذلك. فَإِذْ كان ذلك كذلك، صح أنها صلاةٌ بعينها من صلوات المسلمين. وإِذْ كان ذلك كذلك، وكان النبي -صلى الله عليه وسلم- صحيحًا عنه أنه إذ لاعَنَ بينَ العَجْلانِيَّين، لاعَنَ بينهما بعد العصر دون غيرها من الصلوات[38]، كان معلومًا أن التي عُنيت بقوله: ﴿تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ﴾، هي الصلاة التي كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يَتَخَيَّرُها لاستحلافِ من أراد تغليظ اليمين عليه. هذا مع ما عند أهلِ الكفر بالله من تعظيم ذلك الوقت، وذلك لقربه من غروب الشمس»[39].
الثالث: جمع الأدلة لردّ القول أو دليله:
وابن جرير في تقرير الأقوال وتضعيف الأقوال المخالفة يتنوّع أسلوبه بين بسط الأدلة وتفصيلها، وبين الاختصار والاقتصار: تبعًا لقوة القول المخالف ومأخذه، أو صاحب القول، أو مراعاة تقرير القول؛ فإنه ربما اكتفَى بالإجمال في نقض قول المخالف بأحد أصوله النقدية، ومن ذلك ما ذكره من الاختلاف في حكم الاستنثار في الوضوء في تأويل قوله تعالى: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ [المائدة: 6]؛ فقد قرّر استحباب الاستنثار، ثم ردّ القول بالوجوب بالإجماع، فقال: «فإن ظَنَّ ظانٌّ أنّ في الأخبار التي رُوِيَت عن رسولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (إِذا تَوَضَّأَ أَحَدُكُم فَلْيَسْتَنثِر)[40]، دليلًا على وجوب الاستنثارِ، فإنّ في إجماع الحُجّة على أنّ ذلك غيرُ فَرْضٍ واجبٍ يَجِبُ على مَن تَرَكه إعادة الصلاةِ التي صلَّاها قبلَ غَسْلِه، ما يُغْنِي عن إكثار القول فيه»[41].
وهكذا في تأويل قوله تعالى: ﴿وَيُثَـبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ﴾ [الأنفال: 11]؛ فقد قال: «وقد زعم بعض أهل العلم بالغريب من أهل البصرة[42]، أنّ مجاز قوله: ﴿وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ﴾: ويفرغ عليهم الصبر، وينزله عليهم، فيثبتون لعدوِّهم»، ثم قال: «وذلك قولٌ خلافٌ لقولِ جميع أهل التأويل من الصحابة والتابعين، وحسب قول خطأ أن يكون خلافًا لقول مَن ذكرنا. وقد بينّا أقوالهم فيه، وأن معناه: ويثبّت أقدامَ المؤمنين بتلبيدِ المطرِ الرملَ حتى لا تسوخ فيه أقدامهم وحوافر دوابّهم».
وقد روى الطبري في تأويل قوله تعالى: ﴿وَيُثَـبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ﴾ عن أهل التأويل من الصحابة والتابعين كابن عباس، وسعيد بن المسيب، والشعبي، وقتادة، والسدي، ومجاهد، وابن زيد، والضحاك، أنّ المعنى: ويثبّت أقدام المؤمنين بتلبيد المطرِ الرملَ حتى لا تسوخ فيه أقدامهم وحوافر دوابّهم، كما أطفأ الله به الغبار[43].
لكنه قد يجمع الأدلة نقضًا لقول ضعيف؛ تطلُّبًا لتقرير القول الصحيح؛ ففي قوله تعالى: ﴿وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ﴾ [الأعراف: 46]، نقل الأحاديث والآثار في تفسير الآية ثم نقل قول التابعي أبي مِجْلَز لاحق بن حميد في تفسيرها، فقال: «رجالٌ من الملائكة يَعرفون الفريقين جميعًا بسيماهم؛ أهل النار وأهل الجنة، وهذا قبل أن يَدخُل أهلُ الجنةِ الجنةَ»[44].
ثم عقّب بقوله: «والصواب من القول في أصحاب الأعراف أن يُقال كما قال الله -جلّ ثناؤه- فيهم: هم رجالٌ يعرفون كلًّا من أهل الجنة وأهل النار بسيماهم. ولا خبر عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- یصح سنده، ولا آية متّفق على تأويلها، ولا إجماع من الأمّة على أنهم ملائكة.
فإِذْ كان ذلك كذلك، وكان ذلك لا يدرك قياسًا، وكان المتعارف بين أهل لسان العرب أنّ الرجال اسمٌ يجمع ذكور بني آدم دون إناثهم، ودون سائر الخلق غيرهم. كان بيِّنًا، أنّ ما قاله أبو مِجْلَز من أنهم ملائكة، قول لا معنى له، وأن الصحيح من القول في ذلك ما قاله سائر أهل التأويل غيره، هذا مع من قال بخلافه من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ومع ما رُوي عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في ذلك من الأخبار، وإن كان في أسانيدها ما فيها»[45].
فقد اعتمد ابن جرير أسلوب جمع الأدلة لنقض قول أبي مجلز، مع أنه وصفه بأنه لا معنى له؛ وذلك لتقرير صحة قوله.
وكذلك يجمع الأدلة فيما يكون القول المخالف محتملًا؛ لتقرير اختياره، وردِّ ما خالفه، ومن ذلك ما ذكره في تأويل قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضٌبُ مِنْ رَبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ﴾ [الأعراف: 152]؛ فقد رَوَى عن ابن جريج قال: هذا لِـمَنْ مات ممن اتَّخَذ العجل قبل أن يرجع موسى، ومَن فرَّ منهم حينَ أمرهم موسى أن يَقتل بعضُهم بعضًا.
ثم عقّب بنقده، فقال: «وهذا الذي قاله ابنُ جُرَيْجٍ، وإن كان قولًا له وجهٌ، فإنّ ظاهر كتاب الله مع تأويل أكثرِ أهل التأويل بخلافه؛ وذلك أنّ الله -جل ثناؤه- عمَّ بالخبر عمَّن اتَّخذ العجل أنه سيناله غضبٌ مِن رَبِّهِ وذِلَّةٌ في الحياة الدنيا، وتظاهرت الأخبار عن أهل التأويل من الصحابة والتابعين بأنّ الله -إذ رجع إلى بني إسرائيل موسى- تابَ على عَبَدةِ العجل مِن فعلِهم، بما أخبر به عن قيل موسى لهم في كتابه، وذلك قولُه: ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ﴾ [البقرة: 54]، ففعلوا ما أمرهم به نبيُّهم، فكان أمرُ اللَّهِ إِيَّاهم بما أمرهم به مِن قتلِ بعضهم أنفُسَ بعض، عن غضبٍ منه عليهم لعبادتهم العجل، فكان قتلُ بعضهم بعضًا هَوانًا لهم، وذلةً أذلَّهم الله بها في الحياة الدنيا، وتوبةً منهم إلى اللهِ قَبِلَها، وليس لأحدٍ أن يجعل خبرًا جاء الكتاب بعمومه في خاصٍّ مما عمّه الظاهر بغيرِ بُرهانٍ مِن حُجَّةِ خبرٍ أو عقل، ولا نعلم خبرًا جاء يوجِبُ نقل ظاهرِ قوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِنْ رَّبِّهِمْ﴾ [الأعراف: 152]، إلى باطنٍ خاصّ، ولا من العقل عليه دليلٌ، فيجب إحالةُ ظاهرِه إلى باطنه»[46].
فقد ردّ ابن جرير قول ابن جريج -مع وجاهته- من جهتين: النقد الداخلي (ظاهر التلاوة، العموم)، مع النقد الخارجي (قول أكثر أهل التأويل).
كما يعتمدُ هذا الأسلوبَ في نقد أقوال غير أهل التأويل، مثل أهل العربية، ففي تأويل قوله تعالى: ﴿وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً﴾ [البقرة: 51]، قرّر في معناها أن المقصود: ﴿أَرْبَعِينَ لَيْلَةً﴾ بتمامها.
ثم عقّب بنقل قول بعض نحويي البصرة[47]، وأن معناه: وإذ واعدنا موسى انقضاء أربعين ليلةً، أي: رأسَ الأربعين. ومثَّل ذلك بقوله: ﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ﴾ [يوسف: 82].
ثم ردّ هذا القول من جهتين: النقد الداخلي (ظاهر التلاوة)، والخارجي (قول أهل التأويل)، فقال: «وذلك خلافُ ما جاءت به الرواية عن أهلِ التأويل، وخلافُ ظاهرِ التلاوة. فأمّا ظاهرُ التلاوة، فإن الله -جلّ وعزّ- قد أخبر أنه واعَدَ موسى أربعين ليلةً، فليس لأحدٍ إحالة ظاهرِ خبره إلى باطنٍ بغيرِ بُرْهَانٍ دالٍّ على صحته.
وأمّا أهل التأويل، فإنهم قالوا في ذلك ما أنا ذاكره...»[48].
ثم رَوَى عن أبي العالية، والربيع بن أنس، والسدّي، وابن إسحاق ما يقرّر اختياره.
كذلك يعتمد ابن جرير جمع الأدلة لردّ دليل القول وتضعيفه، ومن ذلك ما ذكره ابن جرير في تأويل قوله تعالى: ﴿أَوْ يَجْعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلًا﴾ [النساء: 15]، فقد قرّر اختياره بأدلّته المتنوّعة؛ ليبيِّن تضعيف دليل القول الآخر، فقال: «وأَوْلَى الأقوال بالصحة في تأويل قوله: ﴿أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا﴾: قولُ مَن قال: السبيلُ التي جعلها الله -جل ثناؤُه- للثَّيِّبَيْنِ المُحْصَنَيْنِ: الرجمُ بالحجارة، وللبِكْرَيْنِ: جَلْدُ مائةٍ ونفيُ سنَةٍ؛ لصحة الخبر عن رسولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنه رَجَمَ ولم يَجْلِد[49]، وإجماع الحُجَّةِ التي لا يجوز عليها فيما نقلته مجمِعةً عليه الخطأ والسهو والكذب، وصحة الخبر عنه أنه قضى في البِكْرَيْنِ بجلدِ مائةٍ ونَفْيِ سَنةٍ، فكان في الذي صح عنه مِن تركِهِ جَلْدَ مَن رُجِمَ من الزُّناةِ في عصره دليلٌ واضحٌ على وَهَاءِ الخبر الذي رُوِي عن الحَسَنِ، عن حِطَّانَ، عن عُبادةَ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (السبيلُ للثَّيِّبِ الـمُحْصَنِ: الجلدُ والرجمُ)[50]»[51].
الرابع: السبر والتقسيم[52]:
حيث يُبدِع ابن جرير بتحليل الأقوال عن طريق السبر والتقسيم، فيبطل المعاني الفاسدة، ويقرّر المعنى الصحيح، ومن ذلك ما ذكره في تأويل قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ﴾ [المائدة: 12]؛ فقد ذكر الطبري في تفسير قوله تعالى: ﴿وَعَزَّرْتُمُوهُمْ﴾ أقوالًا، هي:
القول الأول: أنّ المعنى: نصرتموهم. ورواه عن مجاهد، والسدي.
القول الثاني: أنه بمعنى: الطاعة والنُّصرة. ورواه عن عبد الرحمن بن زيد.
القول الثالث: أنه بمعنى: أثنيتم عليهم. ورواه عن أبي عبيدة معمر بن المثنى عن يونس بن حبيب الضبي[53].
القول الرابع: أنه بمعنى: نصرتموهم وأَعنتموهم ووقّرتموهم وعظمتموهم وأيدتموهم. ونقله عن أبي عبيدة.
القول الخامس: أنه بمعنى: الردّ، تقول: عزّرته: رددته إذا رأيته يظلم، فقلت: اتق الله أو نهيته، فذلك العَزْر. ونقله عن الفراء[54].
ثم عقّب ابن جرير باختياره عن طريق تحليل الأقوال، وإبطال الفاسد؛ ليتقرر المعنى الصحيح، فقال: «وأَولى هذه الأقوال عندي في ذلك بالصواب قول من قال: معنى ذلك: نصرتموهم. وذلك أن الله -جل ثناؤه- قال في سورة الفتح: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا * لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾ [الفتح: 8- 9]، فالتوقير هو التعظيم، وإذا كان ذلك كذلك، كان القول في ذلك إنما هو بعض ما ذكرنا من الأقوال التي حكيناها عمن حكينا عنه، وإذا فسد أن يكون معناه التعظيم[55]، وكان النصر قد يكون باليد واللسان؛ فأمّا باليد فالذبُّ بها عنه بالسيف وغيره، وأمّا باللسان، فحُسن الثناء والذبّ عن العِرض؛ صحّ أنه النصر، إِذْ كان النصر يحوي معنى كلّ قائل قال فيه قولًا مما حكينا عنه»[56].
الخامس: عدم النظير:
فيستدلّ بعدم النظير على إبطال القول، وتصحيح نقيضه، ففي تأويل قوله تعالى: ﴿فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ﴾ [المائدة: 107]؛ فقد قرّر قوله بدفع القول الآخر؛ لعدم النظير، فقال: «والصواب من القول في ذلك عندنا أن الشاهدين أُلْزِمَا اليمين في ذلك باتهام ورثة الميت إياهما فيما دفع إليهما الميت من ماله...
وإنما قلنا: ذلك أَوْلَى الأقوال في ذلك بالصحة؛ لأنّا لا نَعْلَمُ مِن أحكامِ الإسلامِ حكمًا يَجِبُ فيه اليمين على الشهود، ارتِيب بشهادتهما أو لم يُرْتَبْ بها، فيكون الحكم في هذه الشهادةِ نظيرًا لذلك، ولا -إذْ لم نَجِدْ ذلك كذلك- صحّ بخبرٍ عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا بإجماع من الأمّة؛ لأنّ استخلاف الشهود في هذا الموضع من حكم الله تعالى ذِكْره، فيَكونُ أَصلًا مُسَلَّمًا، والمقولُ إذا خرجَ من أن يكون أصلًا أو نظيرًا لأصلٍ فيما تَنَازَعَت فيه الأمّةُ، كان واضحًا فسادُه».
ثم قرّر بعدُ أن هذا هو «التأويل الذي وردت به الأخبار عن بعض أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قضى به حين نزلَت هذه الآيةُ، بينَ الذين نزلَت فيهم وبسببهم»[57].
كما يعتمد هذا الأسلوبَ في قضايا العربية، ففي تأويل قوله تعالى: ﴿إِنَّ رَبِّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾ [الأنعام: 117]، حكى ابن جرير اختلافَ أهل العربية في موضع (مَنْ) في قوله: ﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ﴾؛ فقال بعضُ نحويي البصرة[58]: موضعُه خفضٌ بنيَّةِ الباء. قال: ومعنى الكلام: (إِن رَبَّكَ هُو أَعلَمُ بِـمَنْ يَضِلُّ).
وقال بعض نحويي الكوفة[59]: موضعه رفع؛ لأنه بمعنى (أيّ)، والرافع له (يَضِلّ).
ثم عقّب ابن جرير باختياره بمراعاة الاستدلال بعدم النظير، فقال: «والصواب من القول في ذلك: أنّه رُفِعَ بـ(يَضِلُّ)، وهو في معنى (أيٍّ)، وغيرُ معلوم في كلام العرب اسمٌ مخفوضٌ بغير خافض، فيكون هذا له نظيرًا»[60].
ثالثًا: تقديم واختيار القول الصحيح على غيره:
تنوّعت أساليب ابن جرير في تقرير اختيار الأقوال، مما قدّمه واحتمل ما يخالفه بأصوله وقواعده النقدية:
الأول: تقديم الدليل الصحيح على غير الصحيح مع احتماله:
ومن ذلك ما ذكره ابن جرير من اختلاف أهل التأويل في المراد بـ(الدخان) في قوله تعالى: ﴿فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ﴾ [الدخان: 10]؛ فذكر قولين:
القول الأول: أنه آية حصلَت، حين دعا النبي -صلى الله عليه وسلم- على قريش أن يأخذهم بالسنين كسِني يوسف، فأُخِذُوا بالمجاعة. ورواه عن ابن مسعود[61]، وأبي العالية، ومجاهد، والضحاك، وغيرهم.
القول الثاني: أنّ (الدخان) آية من آيات الله مرسلة على عباده قبل قيام الساعة. ورواه عن أبي سعيد الخدري، وابن عباس، وابن عمر، وغيرهم.
وقد اختار ابن جرير القول الأول بمراعاة السياق، مع احتمال القول الآخر، فقال ابن جرير: «وأَوْلَى القولين بالصواب في ذلك ما رُوي عن ابن مسعود، مِنْ أَنّ الدُّخَان الذي أمر اللهُ نبيَّه أن يرتقبه، هو ما أصاب قومه من الجَهْدِ بدعائه عليهم، على ما وصفه ابن مسعود من ذلك، إن لم يكن خبر حذيفة[62] الذي ذكرناه عنه عن رسول الله صحيحًا، وإن كان صحيحًا، فرسول الله -صلى الله عليه وسلم- أعلمُ بما أَنْزَلَ اللهُ عليه، وليس لأحدٍ مع قوله الذي يصحّ عنه قولٌ...».
ثم بيَّن ابن جرير عِلّة حديث حذيفة رضي الله عنه.
ثم عقّب باختياره؛ فقدّم حديث ابن مسعود لصحّته، مع دلالة السياق على مضمون حديث حذيفة مع احتماله[63].
الثاني: الجمع بين الأدلة المحتملة:
ومن ذلك ما ذكره ابن جرير في تأويل قوله تعالى: ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ﴾ [النساء: 31]، فقد حَكى اختلافَ أهل التأويل في معنى (الكبائر)، ثم عقّب بقوله: «والذي نَقولُ به في ذلك ما ثبت به الخبر عن رسول الله...».
ثم رَوَى أحاديث في ذكرِ الكبائر عن عددٍ من الصحابة، منها: عن أنس بن مالك[64]، وعن ابن مسعود[65]، وغيرهما.
ثم عقّب باختياره بالجمع بين الأحاديث الواردة، فقال: «وأَوْلَى ما قيل في تأويل الكبائر بالصحة، ما صحّ به الخبر عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- دون ما قاله غيره، وإن كان كلُّ قائلٍ فيها قولًا من الذين ذَكَرْنا أقوالهم، قد اجتهد وبالَغَ في نفسه، ولقولِه في الصحة مذهبٌ...
وإذ كان ذلك كذلك، صحّ كلُّ خبرٍ رُوِي عن رسولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- في معنى الكبائر، وكان بعضُه مصدِّقًا بعضًا؛ وذلك أن الذي رُوِي عن رسولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (هي سَبْعٌ)، يَكُونُ معنى قوله حينئذٍ: (هي سَبْعٌ) على التفصيلِ، وَيَكُونُ معنى قوله في الخبر الذي رُوِي عنه أنه قال: (هي الإشراكُ بالله، وقتلُ النفس، وعقوقُ الوالدين، وقولُ الزُّورِ) على الإجمال؛ إِذْ كان قوله: (وقولُ الزُّورِ) يَحْتَمِلُ معانِيَ شَتَّى، وأَن يَجْمَعَ جميعَ ذلك قولُ الزُّور»[66].
وكما يختار ابن جرير بمراعاة الجمع بين الأدلة، فإنه يقدّم القول المختار عند الجمع بين الأقوال، وهو:
الثالث: الجمع بين الأقوال المحتملة:
- وسواء منها ما كان مع احتمال الأقوال كلها؛ كما في تأويل قوله تعالى: ﴿وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ﴾ [غافر: 43]؛ فقد قرّر ابن جرير معناها بقوله: «وأنّ المشركينَ بالله الـمُتَعَدِّينَ حدودَه القتلةَ النفوس التي حرّم الله قتلها هم أصحابُ نار جهنم عند مرجعنا إلى الله.
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل على اختلافٍ منهم في معنى المسرفين في هذا الموضع».
ثم ذكر أقوال أهل التأويل، وعقّب بقوله: «وإنما اخترنا في تأويل ذلك في هذا الموضع ما اخترنا؛ لأن قائل هذا القول لفرعونَ وقومِهِ إنما قَصَدَ فرعونَ به لِكُفْرِه، وما كان هَمَّ به مِن قتلِ موسى، وكان فرعون عاليًا عاتيًا في كفره، سفّاكًا للدماء التي كان محرَّمًا عليه سفكها، وكلّ ذلك من الإسراف؛ فلذلك اخترنا ما اخترنا من التأويل في ذلك»[67].
- أو يكون الجمع بين الأقوال مع تقديم أحدها؛ كما في تأويل قوله تعالى: ﴿وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا﴾ [البقرة: 205]؛ فقد اختار ابن جرير الأخذ بالأقوال جميعها، مع تقديم أحدها؛ فقال: «والصواب من القول في ذلك أن يقال: إنّ الله وصفَ هذا المنافق بأنه إذا تولَّى مُدبِرًا عن رسولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- عَمِل في أرض الله بالفساد، وقد يَدخُلُ في الإفسادِ جميعُ المعاصي، وذلك أنّ العملَ بالمعاصي إفسادٌ في الأرضِ، ولم يَخْصُصِ اللهُ وصْفَه ببعض معاني الإفسادِ دون بعض. وجائزٌ أن يكون ذلك الإفسادُ منه كان بمعنى قطعِ الطريق، وجائزٌ أن يكون كان يقطعُ الرحم ويَسفِكُ الدماء، وجائزٌ أن يكون كان غيرَ ذلك، وأيُّ ذلك كان منه فقد كان إفسادًا في الأرض؛ لأنّ ذلك كان منه لله معصيةٌ، غير أنّ الأشْبَهَ بظاهر التنزيل أن يكون كان يقطعُ الطريق، ويُخِيفُ السبيل؛ لأن الله وصَفَه في سياق الآية بأنه: ﴿سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ والنَّسْلَ﴾، وذلك بفعل مُخيفِ السَّبِيلِ، أشبهُ منه بفعلِ قَطَّاعِ الرَّحِمِ»[68].
الرابع: التعقيب على الراجح باختياره:
فابن جرير يقرّر في تأويله القول الصحيح بدليله، ثم يعقّب باختياره من الأقوال الواردة مما لا يخالف ترجيحه، ففي تأويل قوله تعالى: ﴿وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النور: 2]؛ قال ابن جرير: «وأَولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: أقلُّ ما ينبغي حضور ذلك من عددِ المسلمين: الواحد فصاعدًا. وذلك أَنَّ اللهَ عَمَّ بقوله: ﴿وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ﴾، والطائفةُ قد تقع عند العرب على الواحدِ فصاعدًا...، غير أنّي -وإن كان الأمرُ على ما وَصَفْتُ- أستَحِبُّ أن لا يُقصَّرَ بعددِ مَن يحضُرُ ذلك الموضع عن أربعِ أنْفُس، عددَ مَن تُقبَل شهادته على الزِّنَى؛ لأنَّ ذلك إذا كان كذلك، فلا خلاف بينَ الجميع أنه قد أدَّى المقيمُ الحدَّ ما عليه في ذلك، وهم فيما دون ذلك مختلفون»[69].
الخامس: تقديم الأكثر احتمالًا على غيره:
فابن جرير يجمع الأقوال المحتملة الواردة في تأويل الآية بحسب أصوله النقدية، ويردّ ما سواها، ثم يختار منها الأكثر احتمالًا، ففي تأويل قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا﴾ [الإسراء: 57]؛ فقد قدّم ما رواه عن ابن مسعود -رضي الله عنه- أن المعنيين: هم نفرٌ من الجنّ، فقال: «وأَوْلَى الأقوال بتأويل هذه الآية قولُ عبد الله بن مسعود، الذي رويناه عن أبي معمر عنه، وذلك أن الله -تعالى ذِكره- أخبر عن الذين يدعوهم المشركون آلهةً أنهم يبتغون إلى ربهم الوسيلةَ في عهدِ النبي -صلى الله عليه وسلم-، ومعلومٌ أنّ عُزيرًا لم يكُنْ موجودًا على عهد نبيّنا فيبتغي إلى ربه الوسيلة، وأنَّ عيسى قد كان رُفِع، وإنما يبتغي إلى ربه الوسيلةَ من كان موجودًا حيًّا يعمل بطاعةِ اللهِ ويتقرَّبُ إليه بالصالح من الأعمال، فأمَّا مَن كان لا سبيل له إلى العملِ، فَبِمَ يبتغي إلى ربِّه الوسيلة؟! فإِذْ كان لا معنى لهذا القول، فلا قولَ في ذلك إلا قولُ من قال ما اخترنا فيه من التأويل، أو قولُ مَن قال: هم الملائكةُ، وهما قولان يحتملهما ظاهرُ التنزيل»[70].
وهكذا ما قاله ابن جرير -أيضًا- في أحد اختياراته: «والذي قاله مجاهد وإن كان مذهبًا من التأويل تحتمله الآية، فإنّ الذي هو أشبه بظاهر التنزيل من التأويل ما ذكرنا عن السدّي؛ فلذلك اخترناه»[71].
[1] هذه المقالة من كتاب: (الصناعة النقدية في تفسير ابن جرير الطبري)، الصادر عن مركز تفسير سنة 1443هـ، تحت عنوان: (صيغ نقد التفسير عند ابن جرير)، (1/ 80) وما بعدها. (موقع تفسير)
[2] جامع البيان (1/ 88- 89).
[3] جامع البيان (8/ 679).
[4] هو: الفراء، معاني القرآن (2/ 311).
[5] جامع البيان (18/ 312- 319).
[6] وينظر: تفسير سورة البقرة (260) (4/ 368)، وسورة هود (28) (12/ 382) وغيرها.
[7] الحديث رواه مسلم (2569)، وأمّا الشطر الأخير: (وشتمني ولم ينبغِ له أن يشتمني)، فرواه البخاري (4690) بنحوه.
[8] جامع البيان (2/ 640).
لكن ذهب جمعٌ من المفسرين -منهم الزجاج في معاني القرآن (1/ 223)، والواحدي في الوسيط (1/ 226)، والسمعاني في تفسيره (2/ 226)، والبغوي في معالم التنزيل (1/ 160)، والزمخشري في الكشاف (1/ 318)، والقرطبي في تفسيره (2/ 157)، وابن تيمية في مجموع الفتاوى (8/ 496)، والشنقيطي في أضواء البيان (1/ 150)- إلى اختيار تفسير قوله: ﴿إِلَّا لِنَعْلَمَ﴾ بأنه هو العلم الذي يتعلق به الثواب والعقاب والمدح والذم.
[9] ينظر -أيضًا-: المائدة (114) (9/ 131)، والأعراف (152) (10/ 463) وغيرها.
[10] جامع البيان (1/ 134).
[11] جامع البيان (1/ 397- 398).
[12] الحديث رواه مسلم (1252) عن أبي هريرة، وأورد ابن جرير طرقه وشواهده.
[13] جامع البيان (5/ 451).
[14] جامع البيان (11/ 196)، والحديث رواه البخاري (3140).
[15] جامع البيان (8/ 39).
[16] جامع البيان (3/ 442).
[17] رواه مسلم (1197).
[18] رواه البخاري (1825)، ومسلم (1193).
[19] والوشيقة: ما طُبِخ وقُدِّد. لسان العرب، مادة: (و ش ق) (15/ 218).
[20] رواه عبد الرزاق في مصنفه (8324)، وأحمد في مسنده (6/ 40 و225)؛ وإسحاق بن راهويه في مسنده (1109)، وأبو يعلى في مسنده (4616)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (3504).
قال الهيثمي في المجمع (3/ 519): «رجال أحمد رجال الصحيح».
[21] رواه أحمد (14937)، وأبو داود (1851)، والنسائي (2827)، والترمذي (846)، وصححه ابن خزيمة (4/ 180)، وابن حيان (9/ 248)، والحاكم (1/ 621)، لكن أعلّه البخاري وأبو حاتم والترمذي بالانقطاع. وينظر: التلخيص الحبير (2/ 525).
[22] جامع البيان (8/ 746).
[23] جامع البيان (8/ 444- 445).
[24] جامع البيان (27/ 521- 526).
[25] جامع البيان (2/ 70- 73).
[26] جامع البيان (10/ 146).
[27] الغرل؛ جمع الأغرل: وهو الأقلف غير المختون، والغرلة: القلفة. النهاية (3/ 362).
[28] رواه البخاري (3349، 3447، 4626).
[29] جامع البيان (20/ 206- 207). وينظر -أيضًا-: الرحمن (6) (22/ 12).
[30] ينظر: دلالة السياق، للدكتور ردّة الله الطلحي.
[31] جامع البيان (2/ 127)، وينظر -أيضًا-: النمل (20) (18/ 32)، والقصص (7) (18/ 157).
[32] وهذا الاستدلال يسمّى عند الأصوليين: قياس الخلف، ودليل الخلف، وهو إثبات المطلوب بإبطال نقيضه، وقد جاء في القرآن، كما في قوله تعالى: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾ [الأنبياء: 22]، وقوله تعالى: ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ [النساء: 82]؛ وتقرير هذا الدليل: إذا ثبت أن هذا القرآن ليس فيه اختلاف ولا تضارب في مقرراته ولا عباراته، فإنه يثبت النقيض، وهو أنه من عند الله تعالى. المعجزة الكبرى لمحمد أبو زهرة، ص401، وينظر في هذا الدليل: البحر المحيط، للزركشي (7/ 291)، ومناهج الجدل في القرآن الكريم، د. زاهر الألمعي، ص77.
[33] الحديث رواه ابن جرير بسنده عن ابن عباس، وهو في البخاري (1944)، ومسلم (1113)، ورواه مسلم (1116) عن أبي سعيد الخدري.
[34] جامع البيان (3/ 201).
[35] القدرية: ومنهم المعتزلة، وهي من أكبر الفِرَق، من أهم أقوالها المخالِفة: القول بنفي القدر، ونفي الصفات وغيرها، ومن أشهر الشخصيات أبو الهذيل العلّاف، والنظّام، والجاحظ، والقاضي عبد الجبار. ينظر: الفَرْق بين الفِرَق، للبغدادي، ص20، والمِلَل والنِّحَل، للشهرستاني (1/ 50).
[36] جامع البيان (1/ 161- 162)، وينظر -أيضًا-: الأعراف (16) (10/ 92- 93)، والأنفال (16) (11/ 82-83).
[37] جامع البيان (3/ 25).
[38] أخرج هذه القصة الدارقطني (3/ 277)، والبيهقي (7/ 398).
[39] جامع البيان (9/ 79)، وفي الباب، ما ثبت عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بطريق يمنع منه ابن السبيل، ورجل بايع رجلًا لا يبايعه إلا للدنيا فإن أعطاه ما يريد وفَى له، وإلا لم يفِ له، ورجل ساوم رجلًا بسلعة بعد العصر، فحلف بالله لقد أُعطي بها كذا وكذا، فأخذها)، رواه البخاري (2527) وبوّب عليه: اليمين بعد العصر؛ ومسلم (108).
[40] رواه البخاري (161)، ومسلم (237) من حديث أبي هريرة.
[41] جامع البيان (8/ 182).
[42] أراد الطبري أبا عبيدة، مجاز القرآن (1/ 242).
[43] جامع البيان (11/ 62- 68).
[44] جامع البيان (10/ 220)، والأثر رواه ابن المبارك في الزهد (1373)، وسعيد بن منصور في سننه (958- تفسير)، وابن أبي حاتم في تفسيره (5/ 1486) (8507)، وعزاه السيوطي في الدر المنثور (3/ 88، 89) إلى عبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ.
[45] جامع البيان (12/ 221). قال ابن كثير -بعد أن أوردَ الأحاديث المرفوعة- والله أعلم بصحة هذه الأخبار المرفوعة، قصاراها أن تكون موقوفة. تفسير ابن كثير (3/ 419).
[46] جامع البيان (10/ 462- 463).
[47] هو الأخفش، معاني القرآن (1/ 72).
[48] جامع البيان (1/ 666- 667).
[49] رواه البخاري (6814)، ومسلم (1692) من حديث جابر رضي الله عنه.
[50] رواه مسلم (1690)، فالحديث صحيح، لكنه منسوخ، ينظر: زاد المعاد (5/ 26)؛ وأضواء البيان (5/ 395).
[51] جامع البيان (6/ 498).
[52] ينظر: أضواء البيان (3/ 491- 508)، فقد أطال الشنقيطي في تقرير هذا الدليل، وينظر كذلك: البحر المحيط، للزركشي (5/ 258).
[53] مجاز القرآن (1/ 156- 157).
[54] لم أجده في معانيه، لكن في تفسير آية الفتح نقل عن الكلبي أن معنى: ﴿عَزَّرْتُمُوهُمْ﴾: نصرتموهم. معاني القرآن (3/ 65).
[55] اختار القولَ بأنّ معنى (التعزير): التعظيم، أبو عبيد القاسم بن سلّام، غريب الحديث (5/ 26)، وتابعه مكي بن أبي طالب، تفسير المشكل، ص68؛ والعمدة في غريب القرآن، ص120.
[56] جامع البيان (8/ 244- 245)، وقد تابع ابن جرير في تقريره واختياره: الزجاج في معاني القرآن (2/ 157)، والنحاس في معاني القرآن (2/ 279).
[57] جامع البيان (9/ 86- 87)، وينظر: تفسير ابن كثير (3/ 220)، فقد قرّر صحة نزول هذه الآية، واشتهارها بين السلف.
[58] لم أجد صاحب هذا القول، لكنه بمعناه عن الأخفش، نقله الأزهري في تهذيب اللغة (4/ 345) في تقرير حذف الجر عنه، ولم أجده في معانيه.
[59] هو: الفراء، في معاني القرآن (1/ 352).
[60] جامع البيان (9/ 510). وينظر في استدلال أهل اللغة بهذا الأسلوب: الخصائص لابن جني (1/ 197)؛ والاقتراح للسيوطي، ص104.
[61] الحديث عن ابن مسعود: رواه البخاري (4822)، ومسلم (2798).
[62] يعني ابن جرير بالخبر ما رواه بسنده عن حذيفة بن اليمان -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (أول الآيات الدجال، ونزول عيسى ابن مريم، ونارٌ تخرج من قعر عدن أبين، تسوق الناس إلى المحشر، تقيل معهم إذا قالوا، والدخان - قال حذيفة: يا رسول الله، وما الدخان؟ فتلا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الآية: ﴿فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ * يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [الدخان: 10- 11]، يملأ ما بين المشرق والمغرب، يمكث أربعين يومًا وليلةً، أما المؤمن فيصيبه منه كهيئة الزكام، وأما الكافر فيكون بمنزلة السكران، يخرج من منخريه وأذنيه ودبره)، والحديث ضعّفه الطبري، وعنه ابن كثير (7/ 247)، ووافقه الزيلعي في تخريج الكشاف (3/ 226). وابن كثير في تفسيره (7/ 247)، قال ابن كثير: «وقد أجاد ابن جرير في هذا الحديث هَهُنا؛ فإنه موضوعٌ بهذا السند... وفيه منكرات كثيرة جدًّا». وقال ابن حجر في الفتح (8/ 436): «وإسناده ضعيف».
[63] جامع البيان (21/ 20- 21).
[64] رواه ابن حبان (3247)، والحاكم (1/ 23).
[65] رواه البخاري (6468)، ومسلم (86).
[66] جامع البيان (6/ 640- 660).
[67] جامع البيان (20/ 234- 235).
[68] جامع البيان (3/ 582).
[69] جامع البيان (17/ 149).
[70] جامع البيان (14/ 631- 632).
[71] جامع البيان (3/ 583)، سورة البقرة (205).
كلمات مفتاحية
الكاتب:

يوسف بن جاسر الجاسر
حاصل على الدكتوراه من جامعة الملك سعود، وله عدد من الجهود العلمية.
مواضيع ذات صلة
((المعلومات والآراء المقدَّمة هي للكتّاب، ولا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع أو أسرة مركز تفسير))