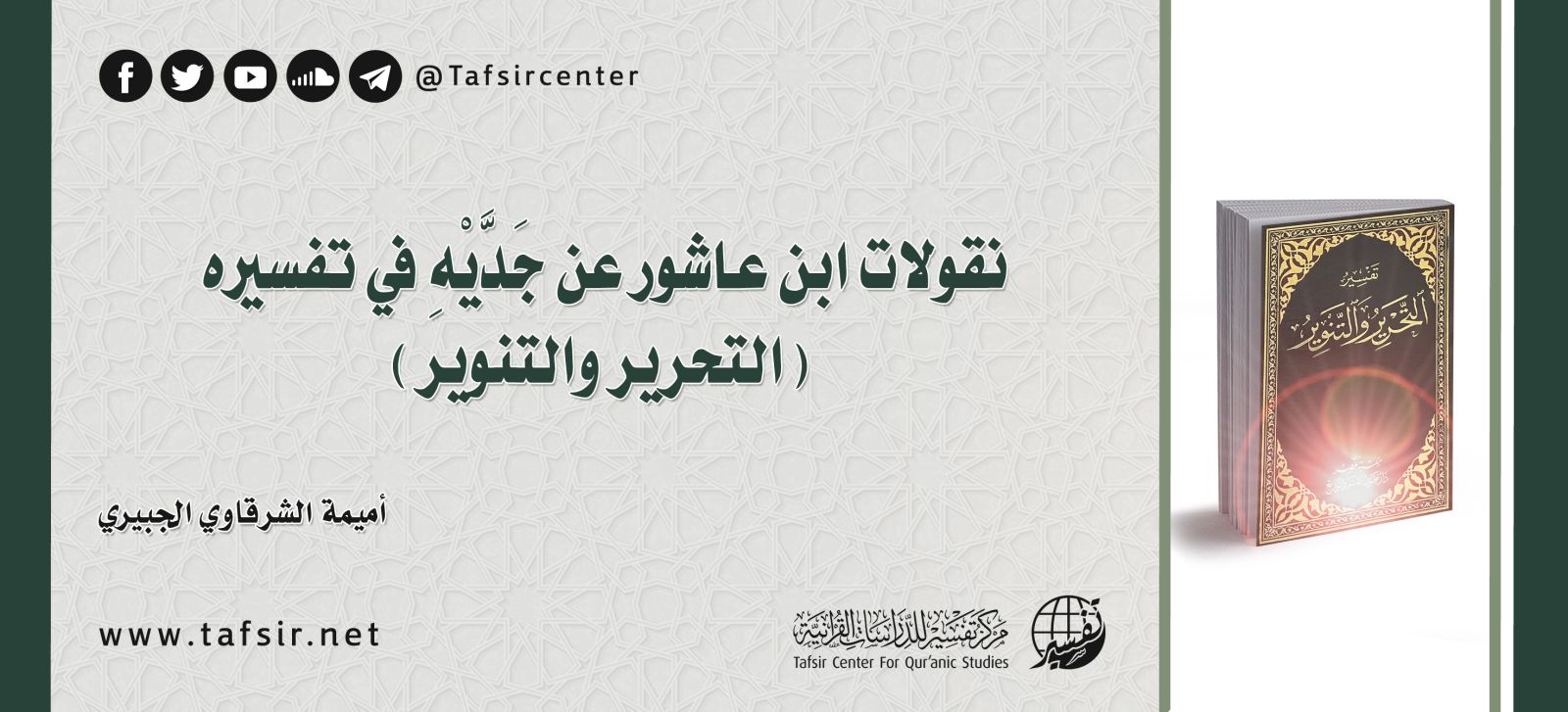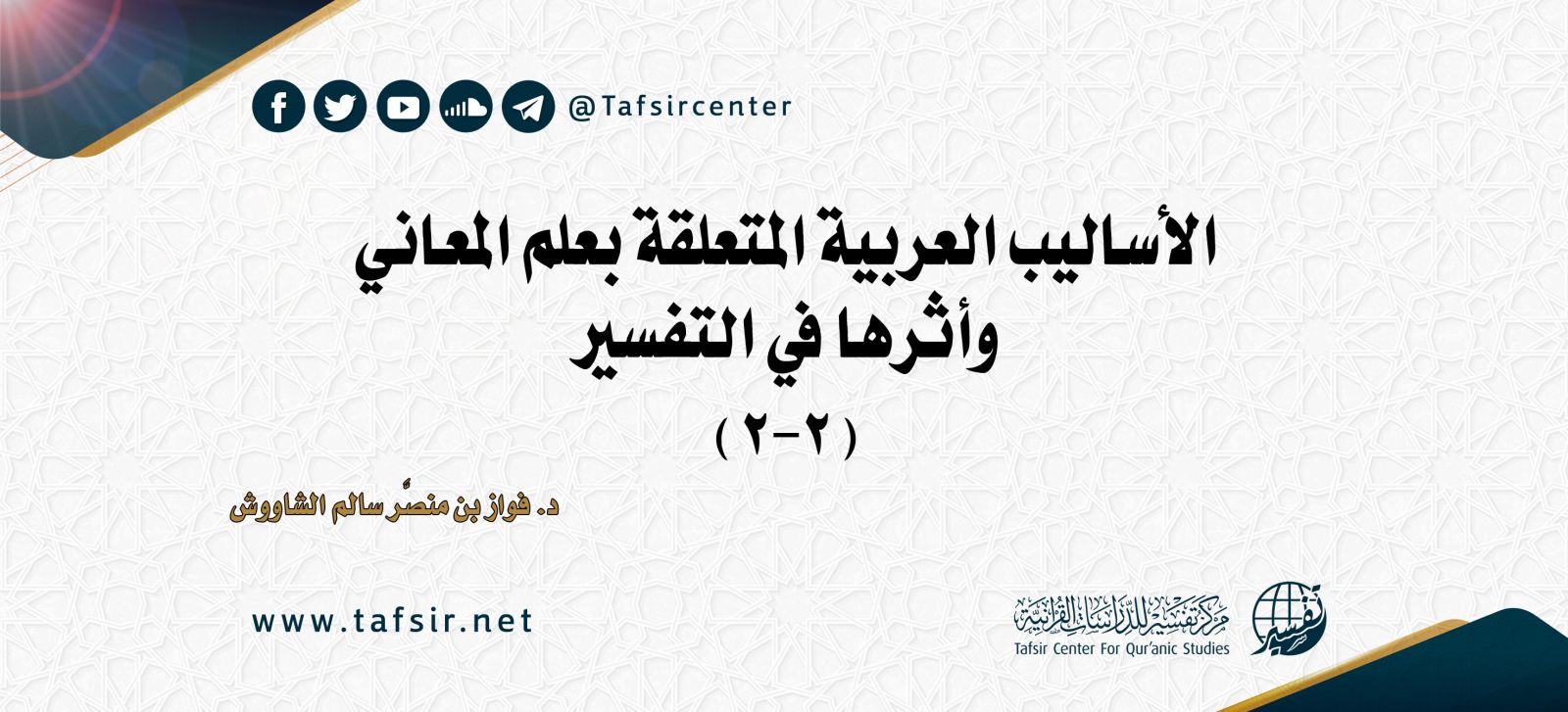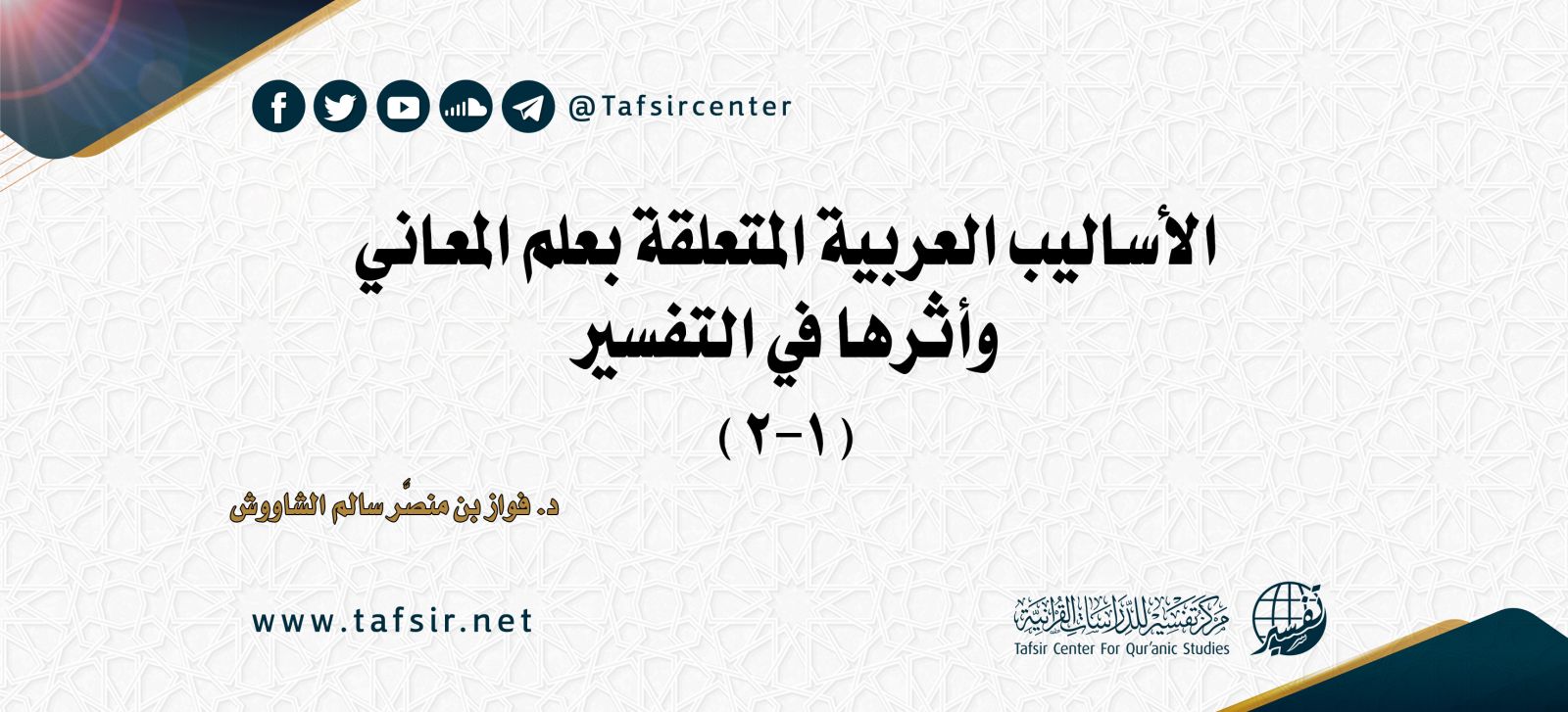تداولية المجاز وقواعد التفسير عند ابن تيمية
تداولية المجاز وقواعد التفسير عند ابن تيمية
الكاتب: فريدة زمرد

تداولية المجاز وقواعد التفسير عند ابن تيمية[1]
ليس بالإمكان الفصل بين موقف ابن تيمية من المجاز وبين قواعد التفسير عنده وبين سائر مكونات النَّسَق اللغوي والعقدي لديه. لقد جعل ابن تيمية من التفسير -علمًا ومنهجًا- مجالًا لتطبيق نظريّته في الحقيقة والمجاز، بل ميدانًا يعرض من خلاله أصول العقيدة وعلوم الإسلام ومنهج التفكير.
ففي القرن السادس وبداية القرن السابع للهجرة، حين كانت جحافل الفِكْر الباطني تأخذ من التفسير سلاحًا لها ملوِّحة بالمجاز والإشارة، ظهر ابن تيمية «إمامًا في التفسير وما يتعلّق به»[2]، أمّا سبب هذه الإمامة، فيرجع حسب ابن كثير إلى ذكائه وكثرة حِفْظه[3]، أمّا مظاهرها، فمنها: قوّته العجيبة في استحضار الآيات من القرآن الكريم وقت الدليل بها على المسألة[4]، ومنها غلبة ذَوْق التفسير عليه إلى حَدّ لا يخلو أيّ كتاب من كتبِه من مواد التفسير[5]، ومنها: اشتمال تفسيره على نفائس جليلة ونكت دقيقة بَيَّن من خلالها «مواضع كثيرة أشكلَت على خَلْقٍ من علماء أهل التفسير»[6]، حتى كانت «معرفته بالتفسير إليها المنتهى»[7]. وكان آخر عهدٍ له بالدرس والتأليف في محبسه الأخير في القلعة يتعلّق بالتفسير[8]. على أنّ أكبر مظهر لإمامته تلك، إنجازه لرسالة هي الأُولى من نوعها في تاريخ التفسير الإسلامي[9]، هدفها تأصيل أصول علم التفسير وتقعيد قواعده الكلية التي «تُعِين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره، والتمييز في منقول ذلك ومعقوله بين الحقّ وأنواع الأباطيل»[10].
لقد تضمَّنَت رسالة ابن تيمية في أصول التفسير خمسَ قواعد، لكلّ واحدة منها علاقة بَيِّنة بموقفه من مسألة الحقيقة والمجاز، وهذه القواعد هي:
1- قاعدة شمول البيان النبوي للقرآن الكريم كلّه.
2- قاعدة قلّة الخلاف بين الصحابة في التفسير.
3- قاعدة الخلاف المذموم عند الخلَف.
4- قاعدة أصحّ طرق التفسير.
5- قاعدة التفسير بالرأي المجرّد.
القاعدة الأولى: «النبيّ بَيَّنَ لأصحابه معاني القرآن كما بَيَّنَ لهم ألفاظه»[11]:
إن كانت فكرة تقسيم الكَلِم الإلهي إلى حقيقة ومجاز قد تسنّى لها أن تنتشر مع مذاهب التفسير الكلامي وإشارات الصوفية والفلاسفة، قاصدة فتح أبواب التأويل، لِـمَا تقتضيه فكرة المجاز ذاتها من عدم شمول البيان النبوي لكلّ ألفاظ القرآن ومعانيه، فإنّ ابن تيمية اتّخذ من مبدأ شمول هذا البيان لكلّ آي القرآن لفظًا ومعنى -قاعدةً تدعم التفسير على منهج السَّلَف، وتهدم ثنائية التفسير بالحقيقة والمجاز، وما بُني عليها من ثنائيات ملازمة لها؛ كالظاهر والباطن، والخاصّة والعامّة، والحقيقة والشريعة، والظواهر والأسرار.
تقتضي هذه القاعدة، أنّ البيان النبوي للقرآن الكريم شامل لمستويين: بيان ألفاظ، وبيان معانٍ؛ وذلك لأنّ المفسِّرين المذهبيين كانوا على صنفين: أحدهما يرى أنّ النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يبين كلّ ألفاظ القرآن، بل فسّر بعضها دون بعض، والثاني يرى أن النبي فسّر كلّ الألفاظ، ولكن على نحو ظاهري يلائم العامة، وترك المعاني الحقيقية الباطنية للخواصّ. واتّخذ الفريقان من المجاز (أو الرمز) مبدأ (لغويًّا) لتدعيم موقفيهما؛ لذا يرى ابن تيمية أن التفسير النبوي للقرآن الكريم شامل كلِّي بحسب المكلّفين[12]، وبحسب جميع الآيات: ألفاظها ومعانيها. والأدلة على ذلك من وجوه:
الأول: قوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [النحل: 44]، فالآية تجعل بيان القرآن الكريم شطر الرسالة المكلّف بتبليغها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ولا يمكن للرسول أن يقصّر في تبليغِ شطرٍ من رسالته؛ لذا فالنبيّ بَيَّن لصحابته ولأُمّته كلّ القرآن: ألفاظه ومعانيه.
الثاني: أنّ القرآن الكريم رسالة موجّهة إلى العالَـمِين، لا يُستساغ حِفْظها دون فَهْم معانيها وألفاظها؛ لذلك ثبتَ أن الصحابة -وهم أحفظ الخَلْق للقرآن بعد رسول الله- كانوا لا يتجاوزون حِفْظ بضع آيات منه حتى يفهموا معانيها وألفاظها[13]، وقد ثبتَ أيضًا أن الصحابة حفظوا القرآن كلّه، وعبر صدورهم وصل إلينا بالتواتر محفوظًا -بحفظ الله له-.
الثالث: أنّ العادة تمنع -حسب ابن تيمية- أن يقرأ قوم كتابًا في أيّ فنّ من الفنون دون أن يستشرحوه، بل كلّ كلام إنما المقصود منه فهم معانيه وألفاظه معًا، فمَا بالك إذا كان الكلام كلام الله تعالى، والكتاب كتاب الله الذي به عصمة هذه الأمّة ونجاتها[14]؟
بيدَ أن هذا الموقف عند ابن تيمية قد يَرِدُ عليه اعتراض من مثبتي المجاز في التفسير، وهو اعتراض من وجهين: نقلي وعقلي، فأمّا من جهة النقل: فقد أُثر عن ابن عباس قوله: «التفسير على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يُعْذَر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله»[15]، فثبتَ أنّ من القرآن ما تُرك بدون بيان واستأثر اللهُ بعلمه. وأمّا من جهة العقل، فقد أُمِرْنَا بإعمال الفِكْر في فهمِ القرآن والاجتهاد في ذلك، وقد جَعل اللهُ الأجر للمجتهد سواء أخطأ أم أصاب، فثبت أن من القرآن ما تُرك بيانه للاستنباط بالبحث والنظر.
ويرى ابن تيمية أنّ كِلا الوجهين لا يمنعان البيان النبوي الشامل للقرآن الكريم.
فأمّا من جهة النقل: فإنّ التفسير الذي لا يعلمه إلا الله لا يدخل أصلًا في ما يستطيع الإنسان فهمه وعقله، أي هو خارج عن نطاق ما ينظر فيه الآن؛ لأنّ هذا الجزء من التفسير «لا يعلمه وقتًا وقدرًا ونوعًا وحقيقة إلا الله، وإنما نعلم نحن بعض صفاته بمبلغ عِلْمنا لعدم نظيره عندنا»[16]، وذلك مثل الساعة فقد أخبر الله تعالى عنها بقوله: ﴿قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي﴾ [الأعراف: 187]، أي: لا يعلم حقيقة ذلك الغيب ومتى يقع إلا الله[17]. أمّا نحن فنعلم أماراتها وبعض صفاتها فقط؛ كخروج الدجّال وطلوع الشمس من مغربها...؛ فهذا لم يبيّنه الرسول -صلى الله عليه وسلم- لأنه ليس في مقدوره ولا من اختصاصه -وهو الرسول البَشَر- أن يبيّنه، وإنما بَيَّن مقدار ما يُعقل منه وما يفيد، وهذا القَدْر الذي لم يبيّنه لا يتعارض مع القَدْر المبيَّن إطلاقًا.
وأمّا الوجه الثاني للاعتراض الذي من جهة العقل، فقد تمسّك به طائفةٌ من العلماء الذين رأوا أنّ في القرآن الكريم متّسعًا لذوي الأفهام ومجالًا لمن له مؤهّلات الفهم والاستنباط أن يُعْمِل العقل في تفسيره بشرط عدم مخالفة النصّ الصريح، وقد حكى هذا الرأي الشيخ محمد أبو زهرة في كتابه عن ابن تيمية منسوبًا إلى الغزالي[18]، وهذا الرأي هو عمدة ما ذهب إليه السيوطي أيضًا في الإتقان، حيث اعتبر الجزء المبيَّن من القرآن الكريم هو من قبِيل «شرح الألفاظ الوجيزة»[19]، والمتروك بدون بيان من قبِيل «ترجيح بعض الاحتمالات على بعض»[20]، وإلى هذا ذهب الخويي أيضًا حين رأى أنّ الآيات التي فسّرها النبي -صلى الله عليه وسلم- بعد سؤال الصحابة عنها «آيات قلائل»، أمّا ما بقي «فالعلم بالمراد يُستنبَط بأمارات ودلائل»[21]، والحكمة في ذلك «أنّ الله تعالى أراد أن يفكّر عباده في كتابه، فلم يأمر نبيّه بالتنصيص على المراد في جميع آياته»[22]، والدليل على ذلك قوله تعالى: ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا﴾ [محمد: 24]، وآيات كثيرة أخرى تحثُّ على تدبّر القرآن الكريم.
وبناء على هذا القول يقسم القرآن إلى ظاهر وباطن: ظاهر بيّنه الرسول الكريم بشرح الألفاظ الوجيزة، وفَهِمَه الصحابة منه بعد سؤالهم عنه. وباطن لم يبيّنه الرسول وتركه للاستنباط والتدبّر. وهو ما قاله السيوطي حين رأى أن الصحابة «يعلمون ظواهره وأحكامه، أمّا دقائق باطنه فإنما كان يظهر لهم بعد البحث والنظر»[23]. وقد ردّ ابن تيمية هذا الوجه من الاعتراض بدليلَيْن:
الأول: أنّ الآية التي استدلّ بها على التدبّر، وهي ما جعلوه سببًا في وجود ما لم يبيّن في القرآن الكريم، فإنها في نظر ابن تيمية حُجّة عليهم لا لهم، فقوله تعالى: ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا﴾ [محمد: 24]، يعني أن الرسول والصحابة فهموا معانيه وألفاظه؛ إذ المفروض امتثالهم للأمر، و«تدبُّر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن»[24]. ولهذه الآية نظائر، ففي قوله تعالى: ﴿وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [الحشر: 21]، حضّ «على تدبّره وفقهه وعقله والتذكّر به والتفكّر فيه، ولم يَستثنِ من ذلك شيئًا، بل نصوص متعدّدة تصرِّح بالعموم فيه، مثل قوله: ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ [النساء: 82]، ومعلوم أنّ نفي الاختلاف عنه لا يكون إلا بتدبّره كلّه، وإلا فتدبّر بعضه لا يوجب الحكم بنفي مخالفه ما لم يتدبّر»[25]. وإذا لم يتدبره الرسول ومعه الصحابة، وهم أقرب الناس إلى فهمه بما شاهدوه من الأحوال المقترنة بنزوله، وبما علموه من عادة اللغة التي خاطب بها، وبما لهم من شرف العلم الصحيح والعمل الصالح، فمَن؟!
الثاني: إن القول بعدم شمول البيان النبوي للقرآن الكريم يعني قصور النبي -صلى الله عليه وسلم- عن رسالة التبيين، والثابت العكس، يقول تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ﴾ [المائدة: 67]، كما يعني أن الصحابة لم يفهموا القرآن الكريم كلّه والثابت العكس أيضًا، فقد رُوي عن مجاهد قوله: «عرضتُ القرآن على ابن عباس من أوّله إلى آخره مرات، أقف عند كلّ آية وأسأله عنها»[26]، ويعلق ابن تيمية قائلًا: «فهذا ابن عباس حَبْر الأمّة وهو أحد من كان يقول: (لا يعلم تأويله إلا الله)، يجيبُ مجاهدًا عن كلّ آية في القرآن»[27]. وهذا دليل على تلقّي التابعين تفسير القرآن كلّه على يد الصحابة[28].
وعلى العموم «فالسَّلَف من الصحابة والتابعين وسائر الأمة قد تكلموا في نصوص القرآن... وفسّروها بما يوافق دلالتها وبيانها»[29]، ولم يمتنع «أحد منهم عن تفسير آية من كتاب الله، ولا قال: هذه من المتشابه الذي لا يُعْلم معناه، ولا قال قطّ أحد من سلف الأمّة، ولا من الأئمة المتبوعين: إنّ في القرآن آيات لا يَعلم معناها ولا يفقهها رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- ولا أهلُ العلم والإيمان جميعهم»[30].
أمّا ما يُروى عن امتناع بعض الصحابة عن تفسير بعض آيات القرآن الكريم أو عن تفويض بعض الأئمة لمعاني بعض الآيات، فإنّ ذلك يدخل في ما لا يعلم حقيقته ووقوعه وقَدْرَه إلا الله، أي: التأويل[31] الذي لا يعلمه إلا الله؛ مثل: كيفية الاستواء، وميقات الساعة...
لكن إذا كان النبيّ قد بيَّن للصحابة القرآن كلّه، ففهموا معانيه وألفاظه، فلماذا اختلفوا في تفسيره؟ إنّ الجواب على هذا السؤال يصوغه ابن تيمية في القاعدة الآتية:
القاعدة الثانية: «الخلاف بين السَّلَف في التفسير قليل، وخلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في التفسير، وغالب ما يصحّ عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوّع لا اختلاف تضاد»[32]:
لـمّا كان ابن تيمية قد ذكر أن القول بالمجاز ظهر مع النزاعات العقدية التي قادتها الطوائف الكلامية في القرن الثالث للهجرة، وكان وهو يشاهد مصارع الوحدة الإسلامية تترى منذ الهجوم الباطني على خراسان أواخر القرن الخامس، واستفحال التأويلات المجازية والإشارية للقرآن الكريم مع الصوفية والشيعة والمتفلسفة، يؤسّس لمنهج فكري أصيل يقوم على مبدأ (الموافقة) بدل المنافرة، و(درء التعارض) بدل نشر التنابذ. مذهب قوامه (اقتضاء الصراط المستقيم)، وطريقه (منهاج السنّة)، وهدفه (الفرقان بين الحق والباطل) و(بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان)، ولـمّا كان قد برهن في القاعدة السابقة أن البيان النبوي الشامل لنصّ القرآن الكريم يلغي فرضية المجاز، فإنّ صاحب (الموافقة) يؤكد في هذه القاعدة أساسًا يدعم أفضلية ذلك البيان على غيره: وهو تميزه بالغنى والخصوبة اللذين يلزمان من ميزة (اختلاف التنوّع) التي تطبعه.
لقد درس ابن تيمية ظاهرة الاختلاف بعمق يعزّ نظيره، مستفيدًا مِن تبحّرِه في العقائد والمذاهب، وثقافته الأصولية الواسعة، وقسَمه إلى نوعين: اختلاف تضاد واختلاف تنوّع. أمّا الأول «فهو القولان المتنافيان إمّا في الأصول وإمّا في الفروع عند الجمهور الذين يقولون: المصيب واحد، وإلا فمَن قال: كلّ مجتهد مصيب؛ فعنده هو من باب اختلاف التنوّع»[33]، والاختلاف المنهيّ عنه في القرآن هو من هذا النوع. وأمّا الثاني، فهو ما كان «كلّ واحد من المختلفين مصيب فيه بلا تردّد، لكن الذمّ واقع على مَن بغى على الآخر فيه، وقد دلّ القرآن على حمدِ كلّ واحدة من الطائفتين في مثل هذا إذا لم يحصل من إحداهما بغي»[34]، فهذا هو الذي عليه الصحابة في التفسير وله مظاهر متنوّعة[35] أهمها:
1- اختلاف التعبير عن المسميات[36]: وهو «أن يعبّر كلّ واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه تدلّ على معنى في المسمَّى غير المعنى الآخر، مع اتحاد المسمَّى»[37]، فها هنا مسمّى واحد هو مرجع العبارة، وهو ذاتٌ واحدة، لكن تتعدّد معاني العبارة بتعدّد أوصاف الذات المسمّاة. «فالسلف كثيرًا ما يعبّرون عن المسمّى بعبارة تدلّ على عينه، وإن كان فيها من الصِّفة ما ليس في الاسم الآخر»[38]، مثال ذلك تفسيرهم للصراط المستقيم؛ فقال بعضهم: هو اتّباع القرآن، وقال آخرون: هو الإسلام، وقيل: هو السنّة والجماعة، أو هو طريق العبودية، وقيل: هو طاعة الله ورسوله... «فهؤلاء كلّهم أشاروا إلى ذات واحدة، لكن وصَفَها كلٌّ بصفة من صفاتها»[39].
والحقّ إن هذه الأسماء تدخل في مباحث الألفاظ من الأصول والكلام واللغة، وقد رأينا أنّ ابن تيمية وضع تصنيفًا خاصًّا للأسماء ركّز فيه على بعض الأنواع من الأسماء كالمتواطئة والمتكافئة. فهذا المظهر من الاختلاف -إذن- يرجع إلى الاختلاف في الألفاظ المتكافئة «التي تقع بين المترادفة والمتباينة»[40]، وهي الأسماء التي تعبّر عن معاني تدلّ على مسمّى واحد.
وهذا الاختلاف يعمّ التفسير وغيره؛ إِذْ يتضمّن الاختلاف في ألفاظ الحدود والتعريفات وصيغ الأدلة...[41]، حيث تتنوّع (جهات القول) و(المقول عليه واحد)، فهذا اختلاف تنوّع لا اختلاف تضاد.
2- اختلاف التخصيص: وهو «أن يذكر كلّ منهم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل، وتنبيه المستمع على النوع لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه»[42]، ومثاله أن يفسّر بعضهم (المقتصِد) في قوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ﴾ [فاطر: 32]، بأنه الذي يصلّي في أثناء الوقت، ويفسّره بعضهم الآخر بأنه الذي يؤدي الزكاة المفروضة ولا يأكل الربا، «فكلّ قول فيه ذِكْر نوع داخل في الآية، وإنما ذكر لتعريف المستمع بتناول الآية له وتنبيهه به على نظيره، فإنّ التعريف بالمثال قد يسهل أكثر من التعريف بالحدّ المطابق. والعقل السليم يتفطّن للنوع كما يتفطن إذا أُشير له إلى رغيف فقيل له: هذا هو الخبز»[43].
ويدخل في هذا الباب اختلافهم في أسباب النزول، فهنا مسألتان من الأصول والحديث: فأمّا من جهة الأصول، يقول ابن تيمية: «والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب هل يختصّ بسببه أم لا؟ فلم يقل أحد من علماء المسلمين إنّ عمومات الكتاب والسنّة تختصّ بالشخص المعيّن، وإنما غاية ما يُقال: إنها تختصّ بنوع ذلك الشخص، فيعمّ ما يشبهه ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ»[44]. وأمّا من جهة علم الحديث فهو يقول: «قد تنازَع العلماء في قول الصاحب: (نزلت هذه الآية في كذا)، هل يجري مجرى المسند؟ والبخاري يدخله في المسند، وغيره لا يدخله في المسند، وأكثر المسانيد على هذا الاصطلاح كمسند أحمد وغيره، بخلاف ما إذا ذكر سببًا نزلت عقبه فإنهم كلّهم يدخلون مثل هذا في المسند، وإذا عُرف هذا فقول أحدهم: نزلت في كذا، لا ينافي قول الآخر: نزلت في كذا، إذا كان اللفظ يتناولهما كما ذكرنا في التفسير بالمثال، وإذا ذكر أحدهم لها سببًا نزلت لأجله، وذكر الآخر سببًا، فقد يمكن صدقهما بأن تكون نزلت عقب تلك الأسباب، أو تكون نزلت مرتين؛ مرة لهذا السبب ومرة لهذا السبب»[45].
هذا، ويدخل في هذا الاختلاف أن يكون نفس اللفظ يحتمل الأمرين لكونه مشتركًا على مذهب من يثبت الاشتراك، أو متواطئًا في الأصل لكن يراد به أحد النوعين أو أحد الشيئين[46]، كما أنّ السّلَف قد يختلفون في التفسير بالألفاظ المتقاربة لا المترادفة[47]، كتفسير الـمَوْر بالحركة، والوحي بالإعلام، والقضاء بالإعلام[48]، «فهذا كلّه تقريب لا تحقيق، فإن الوحي هو إعلام سريع خفيّ، والقضاء إليهم أخصّ من الإعلام، فإنّ فيه إنزالًا إليهم وإيحاءً لهم»[49].
على أنّ عوامل الاختلاف عند السَّلَف في التفسير قد ترجع إلى خفاء الدليل، أو الذهول عنه، أو عدم سماعه، أو لغلط في فهم النصّ، أو لاعتقاد معارض راجح[50]، والواجب إذن: «جَمْع عبارات السلف... لأنّ مجموع عباراتهم أدلّ على المقصود من عبارة أو عبارتين، ومع هذا فلا بدّ من اختلاف محقّق بينهم، كما يوجد مثل ذلك في الأحكام»[51].
يقتضي ذلك أن الاختلاف المحقّق بين السَّلَف اختلاف تنوّع تكون كلّ الأقوال والأفعال والطرق فيه حقًّا مشروعًا صحيحًا[52]، فالقيم الصدقية لعباراتهم ليست ثنائية بالضرورة تتراوح بين الصدق والكذب أو الصواب والخطأ فقط، بل الصواب درجات وأشكال مختلفة ومتفاضلة وكلّ ذلك حقيقة، ومقامات الحقيقة تتنوّع حسب مساق اللفظ وسياقه؛ ارتباطًا بالنظرية المنطقية لابن تيمية ومنهجه الفكري العام. جمع عبارات السلف على صعيد واحد يزيده الاختلاف خصوبة وغنى، وهو دليل على شمول البيان النبوي للقرآن الكريم، فقد تدارس الصحابة القرآن في مدرسة النبوّة، وكان خلافهم لا يرجع إلى التأويل الذي نُهُوا عنه سلفًا؛ لأنه من قبِيل الخوض في الآيات وضرب بعضها ببعض، لقد أخذوا تفسير القرآن كله من مشكاة النبوّة، ولم يعصمهم في النزاع في الآيات غيرها، ثم تلقّاه التابعون عنهم ونقلوه إلى مَن بعدهم، حتى انتهى خير القرون واستبدّ الظلم والجهل -وهما أساس اختلاف التضاد-[53] بطوائف من الناس، فطغى الرأي على الشرع، والعقل على النقل، ونبتَ التأويل في قلب الأهواء والنزاع الباطل، وغذاه المجاز... واتسع الخرق على الرّاقع حين دخل الاختلاف المذموم ميدان التفسير: تفسير كتاب الله الحبل المتين.
ولكن، كيف السبيل إلى العلم بالضلال الموجود في تفاسير الخلف؟ إنه تمييز النقل السقيم من الصحيح، والاستدلال الفاسد من الصريح. وتلك قاعدة ثالثة في أصول التفسير عند ابن تيمية.
القاعدة الثالثة: «الاختلاف [عند الخلف] في التفسير على نوعين: منه ما مستنده النقل فقط، ومنه ما يعلم بغير ذلك؛ إذ العلم إمّا نقل مصدق، وإمّا استدلال محقّق»[54]:
تُعرَف أسباب الاختلاف المذموم عند الخلف[55]، في نظر ابن تيمية، من طريقين: النقل، والاستدلال:
1- فأمّا التفسير الذي مستنده النقل: فإنّ أغلب المفسِّرين -فيما يرى ابن تيمية- وأغلب دعاة التفسير المجازي منهم، هم بين جاهل بعِلْم الحديث وأهله لا يميز بين الصحيح منه والضعيف، فيشكّ في الصحيح ويعتمد الضعيف، وهؤلاء أغلبهم من أهل الكلام، وبين مدّعٍ للعلم الحديث يقبله بمجرّد الظنّ أنه صحيح[56]. ومن كِلتا الجهتين دخل الغلط إلى الحديث ومنه إلى التفسير حيث اعتمدت فيه أحاديث موضوعة[57]. ودرءًا لكلّ تنازع ينشأ عن التأويلات المذمومة والتي مصدرها النقل السقيم، فإنّ التفسير الذي مستنده النقل يجب التمحيص فيه من جهة صحّة هذا النقل أو عدم صحّته، ولـمّا كانت أغلب النقول المعتمدة في التفسير هي نقول بدون أسانيد، أي مراسيل، فإنّ ابن تيمية يفضّل منها ما ينقل عن أهل مكة؛ لأنهم أصحاب ابن عباس المدعو له بعِلْمِ التأويل من قِبَل الرسول الكريم، ثم ما ينقل عن أهل الكوفة أصحاب ابن مسعود، أمّا أهل المدينة وأهل الشام فعلمهم بالمغازي أكثر من علمهم بالتفسير[58].
وعمدة التمييز بين صحيح هذه المراسيل وضعيفها أن تتعدّد مع خلوّها «عن المواطأة قصدًا أو الاتفاق بغير قصد»[59]، فإنّ الحديث إذا جاء من جهتين أو أكثر، وعُلِمَ أن أصحابه يستحيل تواطؤهم على الكذب أو اتفاقهم على اختلافه، وعُلم أنه صحيح، خاصة إذا كان المنقول عنه الصحابة؛ كابن مسعود وأبيّ بن كعب وعبد الله بن عمر، فإنّ «الواحد من هؤلاء لم يكن ممن يتعمّد الكذب على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فضلًا عمّن فوقهم»[60]. وكذلك الأمر بالنسبة للتابعين فإنّ منهم من يُعْلم قطعًا أنهم لم يكونوا ممن تعمّدوا الكذب في الحديث، فهؤلاء تُقْبَل مروياتهم. إلا أن هذا لا يمنع من حصول الغلط والنسيان بالنسبة للطبقتَيْن معًا، وهو غالبًا ما يكون في الأحاديث الطويلة المروية من جهتين مختلفتين، لكنه وإن وقع في بعض أجزائها فهو لا يقدح في صحتها عمومًا، وذلك مثل حديث اشتراء النبي -صلى الله عليه وسلم- البعير من جابر، فإنّ من تأمَّل طرقه علم قطعًا أن الحديث صحيح، وإن كانوا قد اختلفوا في مقدار الثمن»[61].
وإلى جانب المراسيل يشكِّل خبر الآحاد أحد مستندات النقل في التفسير، ومعلوم أن خبر الواحد «إذا تلقّته الأمّة بالقبول تصديقًا له أو عملًا به»[62] فهو يوجب العلم، وهو ما أجمع عليه المصنّفون في أصول الفقه من المذاهب الأربعة. ومهما كان إجماع أهل العلم على تصديق أخبار الآحاد، فإنّ الكثير منها وخاصّة المروية عن المجهول أو السيّئ الحفظ تؤخذ للاعتبار والاستشهاد فقط[63].
وعلى العموم، فهناك قاعدة يذكرها ابن تيمية في منهاج السُّنّة في معرض ردوده على ادّعاءات الحِلِّي فيقول: «المنقولات فيها كثير من الصدق وكثير من الكذب، والمرجع في التمييز بين هذا وهذا إلى علم الحديث، كما نرجع إلى النحاة في الفرق بين نحو العرب وغير نحو العرب، ونرجع إلى علماء اللغة فيما هو من اللغة وما ليس من اللغة، وكذلك علماء الشِّعْر والطبّ وغير ذلك، فلكلّ علم رجال يُعرفون به»[64]، والحقّ أنّ كلّ من تصدّى للتفسير من «أهل الأهواء كالمعتزلة والخوارج يقصِّرون في معرفة هذا [علم الحديث]»[65]، «والرافضة أقلّ معرفة بهذا الباب»[66]، فمَعَ أنهم موافقون على التفسير بالمنقول إلا أنهم يملؤون تفاسيرهم بالنقول الكاذبة، «فالأصل في النقل أن يُرجع فيه إلى أئمة النقل وعلمائه ومن يشركهم في علمهم علم ما يعلمون، وأن يستدلّ على الصحة والضعف بدليل منفصل عن الرواية، فلا بد من هذا وهذا، وإلّا فبمجرد قول القائل: رواه فلان، لا يحتج به...»[67]، فإنّ كثيرًا من مفسِّري أهل الأهواء يضعون تفاسير من عند أنفسهم ثم ينسبونها إلى صحابة أو إلى أئمة ثقاة، وهم منها براء، مثل ما نسبه الرافضة لجعفر الصادق مثلًا، حيث «نُسب إليه أنواع من تفسير القرآن على طريقة الباطنية كما ذكر ذلك عنه أبو عبد الرحمن السلمي في كتاب (حقائق التفسير)، فذكر قطعة من التفاسير التي هي من تفاسيره، وهي من باب تحريف الكَلِم عن مواضعه وتبديل مراد الله تعالى من الآيات بغير مراده، وكلّ ذي علم بحاله يعلم أنه كان بريئًا من هذه الأقوال والكذب على الله في تفسير كتاب الله العزيز»[68]، ومثله ما نُسب إلى عليّ وابن عباس -رضي الله عنهما- من أحاديث «يرويها أهل المجهولات الذين يتكلّمون بكلام لا حقيقة له، ويجعلون كلام عليّ وابن عباس من جنس كلامهم»[69].
2- أمّا التفسير الذي مستنده الاستدلال: فإنّ الاختلاف فيه يعود إلى الخطأ الذي حدث فيه بعد طبقة الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان، وهو خطأ من جهتين: إمّا باعتقاد معانٍ يُحمل القرآن عليها وإن لم يدلّ عليها، أو بتفسير القرآن بمجرّد ما تدل عليه ألفاظه من غير نظر إلى المتكلِّم بالقرآن والمنزل عليه والمخاطب به»[70].
أمّا الجهة الأُولى لهذا الخطأ فقد مثّله قوم حملوا ألفاظ القرآن على معانٍ اعتقدوها، فراعوا مجرّد المعنى «دون نظر إلى ما تستحقّه ألفاظ القرآن من الدلالة والبيان»[71]، وهؤلاء سقطوا في نفي ما تدلّ عليه ألفاظ القرآن الكريم، كما سقطوا في إثبات دلالةٍ وحمل ألفاظ القرآن عليها وإن لم تكن مرادة، «وفي كِلا الأمرين قد يكون ما قصدوا نفيه أو إثباته من المعنى باطلًا؛ فيكون خطؤهم في الدليل والمدلول»[72]، وهذا نجده في تفسير «طوائف من أهل البدع اعتقدوا مذهبًا يخالف الحقّ... وعمدوا إلى القرآن وتأوّلوه على آرائهم؛ تارة يستدلّون بآيات على مذهبهم ولا دلالة فيها، وتارة يتأوّلون ما يخالف مذهبهم بما يحرفون به الكَلِم عن مواضعه، ومن هؤلاء فِرق الخوارج والروافض والجهمية والمعتزلة والقدرية والمرجئة وغيرهم»[73].
ويركّز ابن تيمية في هذا الباب على تفاسير المعتزلة الذين أجروا معاني أصولهم الخمسة على ألفاظ القرآن الكريم رغم مخالفتها لمدلول تلك الألفاظ، فهم «اعتقدوا رأيًا ثم حملوا ألفاظ القرآن عليه، وليس لهم سَلَف من الصحابة والتابعين ولا من أئمة المسلمين لا في رأيهم ولا في تفسيرهم، وما من تفسير من تفاسيرهم الباطلة إلا وبطلانه يظهر من وجوه كثيرة... تارة من العلم بفساد قولهم، وتارة من العلم بفساد ما فسّروا به القرآن»[74].
أمّا الجهة الثانية للخطأ الذي كان سببًا في الاختلاف المذموم في التفسير، فعند طائفة من الصوفية والوعاظ والفقهاء[75] الذين «راعوا مجرّد اللفظ وما يجوز أن يريد به العربي من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلّم به وسياق الكلام»[76]، فإنّ للقرآن الكريم معانيَ قصدها بألفاظ معيَّنة تدلّ عليها بنفسها وبما يحفّها من سياق وبما يُفهم من عادة المتكلّم بها، وهذه الألفاظ ملازمة لتلك المعاني وأدقّ تعبيرًا عنها من غيرها، وخطأ هذه الطائفة ينشأ من تفسيرها لهذه الألفاظ بمعانٍ لا تدلّ عليها وإن كانت صحيحة، وهو خطأ في الدليل لا في المدلول، لكنها حين تفسِّر هذه الألفاظ بمعانٍ لا تدلّ عليها وباطلة فإن الخطأ حينئذ يكون في الدليل والمدلول معًا، كما هو حال الطائفة الأُولى، وذلك مثل ما ذكره السلمي في (حقائق التفسير)[77].
وعلى العموم فإنّ كِلتا الطائفتين ومَن نحا منحاهما، وكلّ «مَن عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئًا ذلك، بل مبتدِعًا، وإن كان مجتهدًا مغفورًا له خطؤه. ونحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة والتابعون وتابعوهم، وأنهم كانوا أعلم بتفسيره ومعانيه... فمَن خالف قولهم وفسّر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعًا»[78].
القاعدة الرابعة: «إذا لم تجد التفسير في القرآن، ولا في السُّنة، ولا وجدته عند الصحابة، فقد رجع كثير من الأئمة إلى أقوال التابعين»[79]:
تُسمَّى هذه القاعدة بقاعدة: (أصحّ طرق التفسير) أو أحسنها. والحقّ أن هذه الطرق هي أيضًا مصادر للتفكير والتشريع عند ابن تيمية، وعليها المعوَّل في حلّ إشكالات العقيدة والفقه...
الطريق الأول: تفسير القرآن بالقرآن: وهذه أحسن الطرق على الإطلاق؛ لأنها تقتضي فهم النصّ من خلال استقراء جامعٍ لكلّ الآيات، وهي أساس التفسير الموضوعي للقرآن الكريم، وقد وردَت هذه القاعدة أثناء وقفة لابن تيمية مع قوله تعالى: ﴿مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ﴾ [الزمر: 23]، وقفة هي واحدة من مظاهر إِمامة ابن تيمية في علم التفسير، فيقول: «مَن تدبَّر القرآن وجد بعضه يفسِّر بعضًا؛ فإنه كما قال ابن عباس في رواية الوالبي: مشتمل على الأقسام، والأمثال، وهو تفسير: ﴿مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ﴾؛ ولهذا جاء كتاب الله جامعًا... قال تعالى: ﴿كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ﴾ فالتشابه يكون في الأمثال، والمثاني في الأقسام، فإنّ التثنية في مطلق التعديد، كما قد قيل في قوله: ﴿ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ﴾ [الملك: 4]... وكما يقال: فعلتُ هذا مرّة بعد مرّة، فتثنية اللفظ يُراد به التعديد؛ لأنّ العدد ما زاد على الواحد، وهو أوّل التثنية، وكذلك: ثنيت الثوب، أعمّ من أن يكون مرتين فقط أو مطلق العدد، فهو جميعه متشابه، يصدِّق بعضه بعضًا، ليس مختلفًا، بل كلّ خبر وأمر منه يشابه الخبر؛ لاتحاد مقصود الأمرين ولاتحاد الحقيقة التي إليها مرجع الموجودات»[80].
لا ينبغي أن تُوحي عبارة شيخ الإسلام عن (اتحاد المقصود)، و(اتحاد الحقيقة) بأيّ بُعد صوفي حلولي، فغاية ابن تيمية أن يدلّنا على أنّ كلام الله تعالى من حيث هو لفظ ومعنى ومرجع، فإنّ المعاني المقصودة والحقائق الموجودة التي تحيل عليها، شأنها شأن الألفاظ، مصدرها الله تعالى، فالله صاحبها، واحد على عرشه، فكيف يكون بينها اختلاف أو تناقض[81]؟ وإلّا فإنّ «الحقائق في نفسها: منها المختلف ومنها المؤتلف، والمختلفان بينهما اتفاق من وجه وافتراق من وجه، فإذا أحاط الكلام بالأقسام المختلفة والأمثال المختلفة كان جامعًا»[82]، وذلك على عادة ابن تيمية في الإقرار بتنوّع الحقيقة ونسبيّـتها، وعلاقة ذلك بتمايز الألفاظ أو تواطئها، وما ينجم عن ذلك من رفض القول بحقيقة أصلية واحدة للّفظ يكون المجاز انحرافًا أو انزياحًا عنها؛ لذا، يقتضي وصف الباري -جلّ وعزّ- لكلامه بأنه ﴿مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ﴾ رفع التناقض عن معانيه المقصودة، وهذه الوحدة في المقصود لا ينبئك عنها إلا تتبّع كلّ ألفاظه واستقراؤها وتفسير بعضها ببعض. فَلِمَ افتراض المجاز وكلّه حقائقُ متشابهةٌ مَثَانٍ؟!
إنّ «هذا في المعاني مثل الوجوه والنظائر في الألفاظ»[83]،وعليه فالقرآن يفسِّر بعضه بعضًا ألفاظًا ومعانيَ. وبيان ذلك، أنّ «ما أُجمل في مكان فإنه قد فُسِّر في موضع آخر، وما اختُصر في مكان فقد بُسط في موضع آخر»[84]، فثبت على ذلك عدم الحاجة إلى بناء التفسير على قِسمة المجاز والحقيقة.
الطريق الثاني: تفسير القرآن بالسُّنة: يترتب هذا الطريق في التفسير على قاعدة شمول البيان النبوي للقرآن الكريم كلّه: ألفاظه ومعانيه، وهو ما أنكره دعاة المجاز، واحتجّوا لذلك بآية آل عمران عن المتشابه، وتأويل الراسخين في العلم. وقد رأى ابن تيمية في (تفسير سورة الإخلاص) أنه يجب القطع بعكس ذلك، و«أنه لا يجوز أن يكون اللهُ أنزل كلامًا لا معنى له، ولا يجوز أن يكون الرسولُ -صلى الله عليه وسلم- وجميع الأمّة لا يعلمون معناه»[85]، فمِنَ القدحِ في الرسول القول بأنه لم يكن على معرفة بالأمور العلمية الواردة في القرآن الكريم أو كان يعرفها ولم يبيّـنها، إن هذا باطل قطعًا[86]، لقد قال تعالى: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ [النساء: 59]، ويلاحظ ابن تيمية أنّ «أوّل النزاعِ النزاعُ في معاني القرآن، فإن لم يكن الرسول عالمًا بمعانيه امتنع الردّ إليه، وقد اتفق الصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر أئمة الدِّين على أن السُّنة تفسِّر القرآن وتبيِّـنه، وتدلُّ عليه وتعبِّر عن مُجْمَله، وأنها تفسِّر مُجْمَل القرآن في الأمر والخبر»[87]، وليست أقواله -صلى الله عليه وسلم- فقط هي ما يفسِّر القرآن في السُّنة، بل أفعاله أيضًا فيها تفسير لكثير من آيات القرآن الكريم[88].
إنّ ابن تيمية يشير هنا إلى حُجِّيَّة السنّة التي اتّفق الأصوليون المعتبرون عليها، فلا يقدَّم رأيٌ على السُّنّة بحجة المجاز، وقد ظهرت حُجّة السنّة التي تبيِّن القرآن وتدلُّ عليه وتعبِّر عنه، فترفع دلالة الآية على المعاني الباطلة[89]،فالسنّة «شارحة للقرآن وموضحة له؛ ولهذا قال رسول الله: (ألَا إنِّي أُوتيتُ القرآنَ ومِثله معه)»[90].
الطريق الثالث: تفسير القرآن بأقوال الصحابة: ثبتَ في القاعدة الأُولى أن الصحابة فسّروا القرآن كلّه؛ لذلك إذا تعذَّر وجود تفسير في القرآن والسنّة يُنْظَرُ في أقوال الصحابة، «فإنهم أدرى بذلك؛ لِمَا شاهدوه من القرآن والأحوال التي اختصّوا بها، ولِمَا لهم من الفهم التامّ والعلم الصحيح، لا سيّما علماؤهم وكبراؤهم كالأئمة الأربعة والخلفاء الراشدين والأئمة المهديين»[91]، إلا أنّ الأخذ بأقوال الصحابة يحتاج في بعض الأحيان إلى النظر، وذلك حين يتعلّق الأمر ببعض مروياتهم عن أهل الكتاب، فمعلوم أن الإسرائيليات باب دخل منه الكثير من الأمور إلى التفسير، وخاصّة في الطبقة التي تلي الصحابة والتابعين، وهي أمور في الغالب لا قيمة علمية لها ولا أحكام تترتّب عليها، ومعلوم أيضًا أنّ الصحابة وإنْ تعاملوا مع أهل الكتاب يهودًا كانوا أو نصارى، غير أنهم لم يسألوا أهل الكتاب عن كلّ شيء، ولم يأخذوا عنهم كلّ شيء، وكانت أول قاعدة اتّبعوها في التعامل مع هذه الإسرائيليات أنها «تُذكر للاستشهاد لا للاعتقاد»[92]،وهي على أقسام منها «ما عَلِمْنا صحته ممّا بأيدينا ممّا يشهد له بالصدق؛ فذاك صحيح»[93]، ومنها «ما عَلِمْنا كذبه بما عندنا ممّا يخالفه»[94]، وهذا لا يؤخذ لفساده، ومنها ما هو «مسكوت عنه، لا من هذا القبِيل ولا من هذا القبِيل فلا نؤمن به ولا نكذِّبه... وغالب ذلك ممّا لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني»[95].
الطريق الرابع: الرجوع إلى أقوال التابعين: إذا تعذَّر وجود التفسير في القرآن والسُّنّة أو أقوال الصحابة «فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين»[96]؛ كمجاهد بن جبر، وعكرمة، وسعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح، والحسن البصري، والربيع بن أنس، وقتادة، والضحاك... فإنّ هؤلاء قد أخذوا العلم بالقرآن عن الصحابة، بل إنّ منهم من عاصر الصحابة ولو لفترة وجيزة، وترجع قيمة أقوال التابعين في التفسير إلى مدى إجماعِهم، وإجماعُهم لا يَعني بالضرورة اتّفاق ألفاظهم وتماثلها في التعبير، فقد يقع في عباراتهم تبايُن في الألفاظ يحسبها مَن لا علم له اختلافًا، وليست كذلك «فإنّ منهم مَن يعبِّر عن الشيء بلازمه أو نظيره، ومنهم من ينصّ على الشيء بعينه، والكلّ بمعنى واحد في كثير من الأماكن»[97].
أمّا إذا ثبتَ الاختلاف بينهم، فإنّ أقوالهم لا تكون حُجّة في التفسير، وحينئذ «يُرجع... إلى لغة القرآن أو السُّنّة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك»[98]، ولا يَعني هذا أنَّ (لغة العرب) تشكِّل طريقًا مستقلًّا من طرق التفسير، فتفسير القرآن بالقرآن أو السنّة أو أقوال الصحابة هو تفسير للقرآن بلغة القرآن أو بلغة النبيّ وصحابته. يقول ابن تيمية: «والقرآن نزل بلغة قريش الموجودة في القرآن، فإنها تفسّر بلغته المعروفة فيه إذا وجدت، لا يعدل عن لغته المعروفة مع وجودها»[99].
تؤول هذه القاعدة -إذن- إلى ما سبق الحديث عنه في البُعد اللغوي عن ضرورة تفسير اللغة بربطها بالمتكلِّم بها والمخاطب بها... ولهذا يستعمل ابن تيمية كلمة التفسير (بالمعروف) أكثر من كلمة (بالمأثور). وقد تنبّه بعض الباحثين المعاصرين إلى ما في اصطلاح (التفسير بالمأثور) من إجمالٍ وغموضٍ وبُعدٍ عن الدقة؛ لأنه لا يدخل تحته تفسير القرآن بالقرآن، وقد يدخل فيه تفسير القرآن بما أُثر عن طبقات أخرى بعد التابعين، وهذا يؤدي إلى أن المقابلة بين التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي غير صحيحة[100]؛ولهذا احتاط ابن تيمية فقيَّد الرأي بالتجريد كما سيأتي في القاعدة الخامسة، واستعمل كلمة (المعروف) عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والصحابة والتابعين.
إنّ تفسير النصّ القرآني عند ابن تيمية يتطلّب -إذن- وضع مساق النصوص القرآنية والحديثية -رواية ودراية- وسياق نزولها، وتفسيرات الصحابة المستمعين إليها والمنفِّذين لمقتضياتها؛ لهذا فالآية ينبغي أن تُفهم على ضوء الوضعية الكلية التي نزلت فيها، أي: حال الخطاب، فالنبيُّ والصحابة والتابعون هم أعرفُ الخلق بالنصوص التي نزلت بلغتهم لِيَفْهَموها ويُفْهِموها لأُممٍ أخرى؛ لذا، لم يكن ابن تيمية بعيدًا عن مطالب (علم تفسير النصوص الحديث)، الذي اعتَبر فهم النصّ لا يتمّ بعيدًا عن السياق التداولي الذي وُجد فيه.
إنّ التفسير بالمأثور، هذا الوصف الذي ألصقه الدارسون بالتفسير المعتمد على هذه الطرق، والذي رآه دعاة المجاز منهجًا قاصرًا عن فهم القرآن الكريم، هذا التفسير ليس إلا وضع القرآن في السياق اللغوي والاجتماعي والثقافي الذي وُجد فيه، وهو باعتراف دارسي علوم النصّ وأحوال الخطاب، أصحّ طريق لتفسير نصٍّ ما، فقد لاحظ د. طه عبد الرحمن أنّ ابن رشد -مثلًا- لم يكن أقرب الفلاسفة العرب فهمًا لنصوص أرسطو إلا بتطبيقه لمبادئ (التفسير بالمأثور) على هذه النصوص، فقد كان ابن رشد «يُشير إلى عادة اليونانيين في الاستعمال»[101]، كما قام بربط النصّ الأرسطي بأقرب الشرّاح إليه من فلاسفة المدرسة الهيلينستية مثلًا[102]... مستفيدًا في ذلك من «مفسِّري القرآن، وخاصّة في ترتيب أصولهم... [لذا] لا يُستغرب بعد هذا أن يحيط ابن رشد بمعاني أرسطو، ولو أدخل بها نصّ الترجمة، وأن يمنع عنها تصرّف فلاسفة الإسلام والمتكلِّمين»[103]. لقد راعَى ابن رشد المجال التداولي للنصّ الأرسطي ففسّره على ضوء أقرب تلامذة المدرسة الأرسطية نفسها، وراعَى ابن تيمية المجال التداولي للنصّ القرآني، فدعا إلى تفسيره على ضوء أقرب تلامذة المدرسة النبوية: الصحابة والتابعون وتابعوهم؛ إِذ «الذين يعاصرون النصّ في نشأته الأُولى هم أَوْلى الناس بفهمه»[104].
لقد كان التفسير المجازي، أو التفسير بالمجاز، أحد المعاول الهدّامة لطرق التفسير السابقة الذِّكر، وقد لاحظ هنري لاووست أنّ تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز قد سمح «في شكله المطلق، ومع بعض القيود، بإجازات للتفسير الشخصي الذي يميل إلى أن يحلّ محلّ الإدراك التاريخي[105] لمضمون كلام الله ورسوله؛ ولهذا نقده ابن تيمية»[106]، وقد نشأ عن هذا التقسيم الذي ظهر في أوساط المعتزلة والجهمية «فقدان معنى التاريخ ومقاييس الزمان والمكان؛ لأنه [تقسيم] يتجاهل النظر في أنّ اللفظ يرجع في آنٍ واحدٍ إلى طريقة استخدامه في مجموعة اجتماعية معيّنة (قوم)، والمعنى الخاصّ الذي يقصده الفرد الذي يستخدمه، فيتحدّد معنى كلّ كلمة بمضمون النصّ كاملًا وتفسّره الظروف التي تبرّر هذا الاختيار، إنّ المتكلِّم وليس المفسِّر هو الذي يحدّد للكلمة معناها الخاصّ أو العام، الحقيقي أو المجازي»[107].
إنّ مفهوم قياس الزمان والمكان أو الإدراك التاريخي لمضمون النصّ أو المجال التداولي للنصّ يقضي في نظر لاووست على التعارض المزعوم بين الآيات القرآنية المحكَمة والآيات المتشابهة؛ ذلك أن بعض الآيات التي قد تبدو مستغلقة على بعض العقول فإنها واضحة جليّة أمام عقول أخرى، أمّا بقية الآيات التي قد تبدو غير معقولة فإن السبب هو جهلنا، ولا ينطبق ذلك على النبي -صلى الله عليه وسلم- الذي كان وحده يستطيع أن ينفذ إلى المعنى الكامل للقرآن[108]. لا يكون الإقرار بالتفسير المجازي أو الإشاري للآيات القرآنية -إذن- إلا تعبيرًا عن جهل المفسِّر بشروط التفسير الموضوعي للنصّ (وهي ربطه بسياقاته المختلفة)، وتغطيةً لهذا الجهل بالآراء الذاتية الخاصّة. من هنا تَكمُن قيمة ما دعا إليه ابن تيمية في هذه القاعدة، يقول لاووست: «لقد أتاحت هذه المبادئ لابن تيمية أن يرسي قواعد جديدة لمنهجٍ للتفسير جعله يحتلّ مركزًا مرموقًا بين المفسِّرين المسلمين، فهو يقول إنه لكي نفهم القرآن فهمًا دقيقًا ينبغي تأمّله تأملًا شاملًا ودائمًا (تدبّره)... والهدف من هذا التدبر هو التهيئة لإدراك معنى كلام النبيّ إدراكًا عميقًا، وبناءً عليه فإن ابن تيمية يطلب من المفسِّر أن يتمكّن من لغة النبيّ الاصطلاحية، وكذلك لغة معاصِريه، وأن يستكمل هذا العمق في فقه اللغة بدراسته لظروف الوحي ولسيرة الرسول، وهذا يدلّ على أن ابن تيمية كان يتمتّع بذوق لا ينكر للتاريخ، وبموضوعية فريدة تمسّك بها دائمًا»[109].
القاعدة الخامسة: «أمّا تفسير القرآن بمجرّد الرأي فحرام»[110]:
هذه القاعدة تنحلّ بها كلّ إشكالات أصول العقيدة والفقه، وتقطع دابر الخلاف في كثير من مسائلها، وترفع الإبهام عن كثير من قضاياها، ومردّ ذلك إلى جودة الصياغة التي كفلها تقييد الرأي (بالتجريد) في العبارة. إنّ من الثابت أنّ الصحابة والتابعين ومن بعدهم «اعتمدوا التفسير بالرأي وقالوا به»[111]، ومن الثابت أنّ كبار المفسِّرين المعتمَدِين كالطبري، لم يقتصروا على إيراد ما رُوي عن الصحابة والتابعين فقط، بل تعدّوا ذلك إلى اجتهادات ترجيحية خاصّة[112]، كما أنه من الثابت أن هؤلاء الصحابة والتابعين قد وردَ عنهم ذمُّ مَن قال في القرآن برأيه بغير عِلْم[113].
وقد تنبّه ابن تيمية إلى أنه لا خلاف بين الأَمْرَيْن؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- والسَّلَف إنما ذَمُّوا القولَ على الله بغير عِلْم ولم يذمُّوا كلّ قولٍ بإطلاق، إِذ الأحاديث المروية في الباب تحذِّر من القول في القرآن بالرأي بغير علم. وإذا كان الصحابة توقّفوا في تفسير بعض الآيات فلافتقارهم العلم بها، أمّا الآيات التي فسّروها «فليس الظنّ بهم أنهم قالوا في القرآن وفسّروه بغير عِلْم أو مِن قِبَل أنفسهم»[114]، بل هم إنما فسّروا القرآن فيما لهم به عِلْم وسكتوا عمّا لا عِلْم لهم به؛ لذا كان التنصيص على لفظ (الرأي المجرد) مِن قِبَل ابن تيمية له دلالته[115]، فالرأي المجرّد إنما هو الرأي المجرّد من العلم، ولكن أيّ علم؟
يقول ابن تيمية: «من تكلّم [في تفسير القرآن] بما يعلم من ذلك لغةً وشرعًا فلا حرج عليه»[116]، ولا شكّ أن العلم باللغة والشرع ومقتضياتهما لا يبقي للهوى في التفسير سبيلًا، فالتفسير من جهة العلوم الشرعية واللغوية يقتضي كما أَوصى أبو مسلم بن يسار -فيما يُورده ابن تيمية- أن تقف حتى تنظر ما قبله وما بعده[117]، كما يقتضي الالتزام بأصول التفسير وقواعده. ذلك يعني فهم الألفاظ حسب سياقها وحسب ما أُثِر عن الرسول والصحابة والتابعين فيها، وبعد ذلك: إعمال الفهم في الترجيح بين الأقوال واستنباط عِلَل الأحكام واستخراج المقاصد، مع الاعتماد على آراء السَّلَف في ذلك وما يُفهم من الآيات، بهذا يكون الرأي عقلًا صريحًا معضدًا بالنقل الصحيح، ويتم (درء تعارض العقل والنقل) وتنحل عقدة (الحقيقة والمجاز) في تفسير القرآن الكريم، ويصير التفسير الباطني المترتّب عليها رمادًا تذروه الرياح.
ذلك ما جعل ابن تيمية يتحدّى مُناظره -الداعي إلى التفسير المجازي الباطني- بأن يحقّق مقامات أربعة، فما استطاع[118]، وهي: إثبات أنّ المراد هو المعنى المجازي «وإلّا فيمكن كلّ مبطِل أن يفسِّر أيّ لفظ بأيّ معنى سنحَ له وإن لم يكن له أصل في اللغة»[119]، وإثبات الدليل على صرف اللفظ من حقيقته إلى مجازه، وأن يَسْلَم ذلك الدليل من المعارض، وأن يكون النبي -صلى الله عليه وسلم- بَيَّن للأمّة أنه لم يُرِد بذلك اللفظ حقيقته بل مجازه، سواء عيَّنه أم لم يُعيِّنه.
فهو العلم بالأدلة الشرعية واللغوية أثناء التفسير -إذن- وإلا فليس ثمة إلا مبطِل يفسِّر اللفظ بأيّ معنى سنحَ له متّكئًا على دعامة المجاز، فلا يملك دعاة التفسير الباطني غير فرضية المجاز، ولا يملك مثبتو المجاز غير التأويل بالرأي المجرّد؛ لذا يقول ابن تيمية وهو يردُّ التفسير المجازي لبعض الآيات عند مثبتي المجاز بأن هؤلاء «يفسّرون القرآن برأيهم ومعقولهم وما تأوّلوه من اللغة... فلا يعتمدون لا على سُنّة ولا على إجماع السَّلَف وآثارهم، وإنما يعتمدون على العقل واللغة، وتجدهم لا يعتمدون على كتب التفسير المأثور والحديث وآثار السَّلَف، وإنما يعتمدون كتب الأدب وكتب الكلام التي وضعتها رؤوسهم»[120]، إنهم «يجعلون الألفاظ التي أحدثوها ومعانيها هي الأصل، ويجعلون ما قاله الله ورسوله تبعًا لهم، ويردّونها بالتأويل والتحريف إلى معانيهم، ويقولون: نحن نفسّر القرآن بالعقل واللغة»[121].
التفسير بمجرّد الرأي -إذن- طريقة أهل البدع وطريقة الملاحدة[122]، وتحريم التفسير بالرأي المجرّد هو طريقة أهل العلم من السَّلَف والأئمة الأعلام، وذلك اتجاه أصيل في فكر ابن تيمية، وليس -فقط- ردًّا على الزحف الباطني سدًّا لذريعة الفساد[123].
لم يقتصر كلام ابن تيمية في مقدّمة التفسير على تأصيل قواعده فحسب، بل سعى أيضًا إلى نقد كتب التفسير الموجودة في أيدي الناس، وتصنيفها والنظر إليها من جهتي النقل والاستدلال: فما كان منها ضابطًا لأصول النقل، متحريًا الصحة في المنقولات؛ كان أسلم من الفساد الذي منشؤه النقل. وما كان منها ملتزمًا بعقيدة السَّلَف مبتعدًا عن الرأي المجرّد من العلم؛ كان أسلم من جهة الرأي والاستدلال.
لذلك فإنّ أصحَّ التفاسير عند ابن تيمية وأبعدها عن شبهتي النقل والرأي، هي التي أُثِرت عن التابعين وتابعيهم والأئمة المجتهدين؛ مثل تفسير بقي بن مخلد، وابن أبي حاتم، وابن المنذر، وعبد الرحمن بن إبراهيم دحيم، وتفسير ابن حنبل، وابن راهويه، فإنّ هؤلاء لا يذكرون في تفاسيرهم الأحاديث الموضوعة[124]، ولا بدع الرأي؛ لأنهم كانوا «أعلم أهل الأرض بالتفاسير الصحيحة عن النبي وآثار الصحابة والتابعين»[125]، إلا أنّ ابن تيمية يحذِّر من الأخذ بكلّ ما أُثِر من تفاسير هذه المرحلة المتقدّمة قبل تمحيصها؛ كالتفسير المنسوب لابن عباس، وخاصّة ما جاء عن طريق رواية الكلبي عن أبي صالح[126].
ويأتي تفسير ابن جرير الطبري في مقدّمة التفاسير المعتبرة عند أهل العلم، فقد صانه صاحبه من بدع العقل والنقل معًا، فهو «يذكر مقالات السَّلَف بالأسانيد الثابتة، وليس فيه بدعة، ولا ينقل عن المتَّهَمِين»[127]، وكذلك ابن عطية فهو «أتْبَع للسُّنة والجماعة، وأسلم من البدعة»[128]، والقرطبي كذلك «أقرب إلى طريقة أهل الكتاب والسنّة، وأبعد عن البدع»[129]، وبنفس المعيار يحكم ابن تيمية على تفسير البغوي «الذي صان تفسيره عن الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة»[130]، وإن كان قد اختصره من تفسير الثعلبي الذي عُرف بمنقولاته الضعيفة[131]، فإنّ الثعلبي مع ضعفِ معرفته بالحديث كان أعلم بأقوال المفسّرين والنحاة وقصص الأنبياء؛ لذلك نقل عنه البغوي هذه الأمور، دون الأحاديث الموضوعة، لِعِلْمِه بالحديث والفقه[132]. ونفس الشيء نجده في تفاسير الواحدي (البسيط والوسيط والوجيز)، فمع ما فيها من فوائد جليلة فإنها تحتوي على الكثير من المنقولات الباطلة[133].
ولم يكن فساد التفسير سببه ضعف العلم بالحديث فحسب، بل أيضًا ضعف الرأي واتّباع الهوى والمذهب، أمّا إذا اجتمع الأمران معًا، فتلك -ولا شكّ- الطامّة الكبرى، وهو ما يراه ابن تيمية في تفاسير أهل الفِرَق بصفة عامة؛ كالروافض والشيعة والمتصوّفة والمتكلّمين، ويخص منهم بالحكم -هنا- تفاسير من اعتقدوا مذاهب المعتزلة؛ كعبد الرحمن بن كيسان الأصم، وأبي عليّ الجبائي، والقاضي عبد الجبار، وعليّ بن عيسى الرماني، والزمخشري[134]. ويركّز ابن تيمية على تفسير الزمخشري نظرًا للطريقة التي يعرض بها آراءه وتأويلاته، حيث يصعب على الكثير كشف ما تحتويه القوالب اللغوية الفصيحة من معانٍ وآراء مخالفة لعقيدة السلف، «حتى إنه يَرُوج على خَلْقٍ كثير [ممن لا يعتقد الباطل من تفاسيرهم الباطلة ما شاء الله]»[135]، مع أنّ تفسيره «محشو بالبدعة وعلى طريقة المعتزلة من إنكار الصفات والرؤية والقول بخَلْق القرآن، وأنكر أنّ الله مريد للكائنات وخالق لأفعال العباد، وغير ذلك من أصول المعتزلة»[136]، هذا مع ما فيه من الأحاديث الموضوعة والمنقولات المكذوبة عن الصحابة والتابعين[137]، فيكون صاحبه قد جمع فيه بين بِدَع النقل وبِدَع الرأي معًا؛ حيث عرض الأُولى في شكل أحاديث موضوعة لا قيمة لها -رواية ودراية-، وعرض الثانية في قوالب بيانية كان المجاز أحد أعمدتها، إن لم نقل أهمّها على الإطلاق.
إنّ ابن تيمية وهو يُصدِر أحكامه هذه ويقرّر قيمة التفاسير الموجودة في أيدي الناس، لم يغفل عن حقيقة علمية ومنهجية تتجلَّى في مبدأ الإنصاف في الحُكم: ذلك أنّ كلّ واحد من هذه التفاسير «لا بدّ أن يشمل على ما يُنقد، لكن يجب العدل بينها وإعطاء كلّ ذي حقّ حقّه»[138]، وبذلك يكون ابن تيمية قد برئ ممّا نُسب إليه مِن (تطرّف) في الرأي و(تعصّب) في الحُكم على مخالفيه[139]، ويكون -كما أشار إلى ذلك لاووست- قد حقّق أكبر قدر من الموضوعية في هذه الأحكام كما تقدّم في القاعدة الرابعة.
* * *
وخلاصة القول: إنه إذا كان منهج التفسير عند بعض المتأخِّرين، وخاصة أصحاب المذاهب الكلامية والصوفية والفلسفية، لا يرى قيام تفسير دون الارتكاز على ثنائية الحقيقة والمجاز، فإنّ منهج ابن تيمية في التفسير يقوم على قواعد شاملة ترفع الحاجة إلى فرض المجاز في التفسير، وتستبدل به مقاييس الزمان والمكان -على حدّ تعبير هنري لاووست- مع تأمّل شامل لنصوص القرآن، فلا يمكن فهم القرآن إلا من خلال لغته، وفقه لغة القرآن لا ينفصل عن بيان النبي -صلى الله عليه وسلم- وصحابته والتابعين المخاطبين بها. وعليه، فلا يقولَنّ أحدٌ: إنّ تفسير السّلَف أَسْلَم، وتفسير الخلَف أحْكَم؛ فإنّ الحكمة إن لم تكن على لسان النبيّ وصحابته فلن تظهر على أيّ لسان البتة. إنه لا توجد آية في القرآن الكريم ليس فيها قول للنبي -صلى الله عليه وسلم- أو لصحابي أو لتابعي؛ لذا وعلى «عكس ما هو متداول في الأدب عن خوف بعض المفسِّرين الأوائل [الصحابة] من العمل التفسيري، فإنّ النصوص التي وصَلَتْنَا كنصوص ابن عباس وتلامذته، كانت تتميز بِجرأة[140]تفسيرية عَزّ نظيرها»[141]، وليس هذا بالكشف الجديد[142]، وإنما هي قاعدة فكرية أصيلة كان ابن تيمية قد سطرها منذ الرُّبع الأول من القرن الثامن الهجري.
[1] هذه المقالة من كتاب (الأبعاد التداولية لنظرية المجاز عند ابن تيمية)، الصادر عن مركز تفسير، سنة 1439هـ، ص489 وما بعدها. (موقع تفسير)
[2] البداية والنهاية (14/ 137).
[3] البداية والنهاية (14/ 137).
[4] الكواكب الدرية، ص145.
[5] الحافظ أحمد بن تيمية، الندوي، ص238.
[6] العقود الدرية، ص145.
[7] العقود الدرية، ص22- 23.
[8] الحافظ أحمد بن تيمية، ص111.
[9] الحافظ أحمد بن تيمية، ص284، وهي رسالة: (مقدّمة في أصول التفسير)، منشورة ضمن الفتاوى (13/ 329- 376)، ثم نُشرت محققة من قِبل: د. عدنان زرزور، 1978؛ ثم بتحقيق: فريال علوان، دار الفكر اللبناني. ط1، 1992، وهي الطبعة المعتمدة في هذا المقال مقابلة بنشرة الفتاوى.
[10] مقدمة في أصول التفسير، ص5.
[11] أصول التفسير، ص19. وقد وردت هذه القاعدة في مواضع كثيرة من كتابات ابن تيمية، فهي أساس في العقيدة يلخصه كتاب (معراج الوصول) ومبدأ نظري شامل في الردّ على الفلاسفة والمتكلّمين والصوفية، وفي بناء نظرية الموافقة بين العقل والنقل.
[12] فجميع الناس مخاطَبون بالبيان النبوي لا يُستثنى من ذلك متكلّم ولا فيلسوف ولا وليّ، ولا فرق في ذلك بين عامة وخاصة، ولا بين جمهور وعقلاء، فآي الكتاب والسنّة والإجماع شامل أمر الثقلين الجنّ والإنس إلا مَن رُفع عنه القلم من صبي أو مجنون أو بهيمة. ينظر: مختصر الفتاوى المصرية، ص639- 645.
[13] أصول التفسير، ص19.
[14] أصول التفسير، ص20.
[15] أصول التفسير، ص75. وقول ابن عباس رواه ابن جرير الطبري في جامع البيان (1/ 62).
[16] رسالة الإكليل في المتشابه والتأويل، ص18.
[17] رسالة الإكليل، ص18.
[18] ابن تيمية: حياته وعصره، آراؤه وفقهه، محمد أبو زهرة، مطبعة عليّ أحمد مخيمر، 1952، ص227. وينظر: إحياء علوم الدين، أبو حامد الغزالي، (1/ 291- 293).
[19] الإتقان في علوم القرآن السيوطي (2/ 174).
[20] الإتقان (2/ 174).
[21] الإتقان (2/ 174).
[22] الإتقان (2/ 174).
[23] الإتقان (2/ 174، 175).
[24] أصول التفسير، ص20.
[25] الإكليل في المتشابه والتأويل، ص45- 46.
[26] الإكليل، ص22. ورَوى هذا القول ابنُ جرير بلفظ مقارب عن مجاهد، قال: «عرضتُ المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات من فاتحته إلى خاتمته، أوقفه عند كلّ آية منه وأسأله عنها»، جامع البيان (1/ 31).
[27] الإكليل، ص22.
[28] أصول التفسير، ص20- 21.
[29] الإكليل، ص47.
[30] الإكليل، ص23.
[31] التأويل هنا بمعنى وقوع الشيء وتحقّقه لا بالمعنى الاصطلاحي المعروف.
[32] أصول التفسير، ص22. وتوجد هذه القاعدة مبثوثة في رسائل عدة لابن تيمية، فقد كان ابن تيمية مِن أهمّ مَن تصدّر لمسائل الخلاف، وهي قاعدة أساسية بَنى عليها (رفع الملام) و(اقتضاء الصراط المستقيم) وجزءًا كبيرًا من نظراته الفكرية والسياسية في (الموافقة) و(المنهاج) و(الفرقان)، وغيرها.
[33] اقتضاء الصراط المستقيم، ص38.
[34] اقتضاء الصراط المستقيم، ص38.
[35] قد ذكر ابن تيمية وجوه اختلاف التنوع في اقتضاء الصراط المستقيم، ص37- 38، ولكن ما يرتبط منها بالتفسير حرره بتفصيل في مقدمة أصول التفسير، ص22- 38.
[36] اقتضاء الصراط المستقيم، ص38.
[37] أصول التفسير، ص22.
[38] أصول التفسير، ص25.
[39] أصول التفسير، ص26. وينظر: تفسير سورة النور، ابن تيمية، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1404هـ= 1983م، ص178- 179.
[40] أصول التفسير، ص22.
[41] اقتضاء الصراط المستقيم، ص38.
[42] أصول التفسير، ص26.
[43] أصول التفسير، ص28.
[44] أصول التفسير، ص28.
[45] أصول التفسير، ص32.
[46] أصول التفسير، ص32- 34.
[47] أصول التفسير، ص34.
[48] أصول التفسير، ص34. وذلك في قوله تعالى: ﴿يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا...﴾ [الطور: 9]، وقوله: ﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ...﴾ [النساء: 163]، وقوله: ﴿وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ...﴾ [الإسراء: 4].
[49] أصول التفسير، ص34.
[50] أصول التفسير، ص38.
[51] أصول التفسير، ص36.
[52] اقتضاء الصراط المستقيم، ص37- 38.
[53] اقتضاء الصراط المستقيم، ص37- 38.
[54] أصول التفسير، ص39، وترتبط القاعدة بامتحان أقوال الخلف ومذاهبهم على ضوء العقل والنقل، ومن ثم لا يخلو كتاب من كتب ابن تيمية منها حتى أمست أصلًا من أصوله الفكرية.
[55] يقصد بالخلَف الطبقة التي تلي طبقة الصحابة والتابعين وتابعيهم.
[56] أصول التفسير، ص48- 49.
[57] أصول التفسير، ص49.
[58] أصول التفسير، ص42.
[59] أصول التفسير، ص44.
[60] أصول التفسير، ص44.
[61] أصول التفسير، ص45- 46. والحديث في صحيح البخاري كتاب البيوع، باب شراء الدواب والحمير (2/ 10- 11).
[62] أصول التفسير، ص46.
[63] أصول التفسير، ص47.
[64] منهاج السنّة النبوية (4/ 10).
[65] منهاج السنّة النبوية (4/ 10).
[66] منهاج السنّة النبوية (4/ 10).
[67] منهاج السنّة النبوية (4/ 12).
[68] منهاج السنّة (4/ 146). والسلمي هو محمد بن الحسن أبو عبد الرحمن السلمي، صوفي مفسِّر ومؤرخ، من كتبه: (حقائق التفسير)، قال فيه الذهبي: «أتى فيه بتأويلات الباطنية». ترجمته في: تذكرة الحفاظ للذهبي (3/ 1046- 1047)، طبقات الشافعية للسبكي (3/ 60- 62)، لسان الميزان لابن حجر (5/ 140- 141)، معجم المؤلفين (9/ 258 – 259).
[69] منهاج السنّة (4/ 155).
[70] أصول التفسير، ص51- 52.
[71] أصول التفسير، ص52.
[72] أصول التفسير، ص52.
[73] أصول التفسير، ص52- 53.
[74] أصول التفسير، ص54.
[75] أصول التفسير، ص59.
[76] أصول التفسير، ص52.
[77] أصول التفسير، ص59.
[78] أصول التفسير، ص59.
[79] أصول التفسير، ص67.
[80] مجموع الفتاوى (16/ 523).
[81] مجموع الفتاوى (16/ 523).
[82] مجموع الفتاوى (16/ 524).
[83] مجموع الفتاوى (16/ 524).
[84] أصول التفسير، ص60.
[85] تفسير سورة الإخلاص، ص119.
[86] تفسير سورة الإخلاص، ص339.
[87] تفسير سورة الإخلاص، ص146.
[88] دراسات في أصول تفسير القرآن، محسن عبد الحميد، دار الثقافة، ط2، 1984، المغرب، ص8.
[89] الفرقان بين الحق والباطل، مجموع الفتاوى، (13/ 29).
[90] أصول التفسير، ص60، والحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند (1/ 96)، وسنن أبي داود، كتاب السنّة، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، القاهرة، ط2، 1950، (4/ 259).
[91] أصول التفسير، ص62.
[92] أصول التفسير، ص64.
[93] أصول التفسير، ص64.
[94] أصول التفسير، ص64.
[95] أصول التفسير، ص64.
[96] أصول التفسير، ص67.
[97] أصول التفسير، ص68.
[98] أصول التفسير، ص68.
[99] مجموع فتاوى، (15/ 88).
[100] التفسير بالمأثور، نقد للمصطلح وتأصيل، مساعد بن سليمان الطيار، مجلة البيان، عدد 76، سنة 1994، ص8- 16. وقد لاحظ صاحب المقال أن تعبير شيخ الإسلام بكلمة (معروف) أسلم من التعبير بكلمة (مأثور).
[101] لغة ابن رشد الفلسفية من خلال عرضه لنظرية المقولات، طه عبد الرحمن، أعمال ندوة ابن رشد ومدرسته في الغرب الإسلامي، جامعة محمد الخامس، دار النشر المغربية، البيضاء، 1979، ص171.
[102] لغة ابن رشد الفلسفية من خلال عرضه لنظرية المقولات، ص172.
[103] لغة ابن رشد الفلسفية من خلال عرضه لنظرية المقولات، ص172.
[104] اللغة والتفسير والتواصل، مصطفى ناصف، ص76.
[105] يقصد لاووست بالإدراك التاريخي لمضمون النصّ: المجال التداولي للنص أو السياق الاجتماعي والثقافي.
[106] أصول الإسلام... لاووست، ص115.
[107] أصول الإسلام... لاووست، ص115- 116.
[108] أصول الإسلام... لاووست، ص115- 116.
[109] أصول الإسلام... لاووست، ص116- 117.
[110] كالنزاع في إشكال العقل والنقل، والخلاف بين الفقهاء والمحدِّثين، والنزاع في القياس بالرأي، والتفسير بالرأي والمأثور.
[111] التفسير بالمأثور، نقد للمصطلح وتأصيل، مساعد بن سليمان الطيار، ص14.
[112] التفسير بالمأثور، نقد للمصطلح وتأصيل، مساعد بن سليمان الطيار، ص14. وينظر: جدل العقل والنقل، ص521- 522.
[113] ذكر ابن تيمية جملة من الآثار في ذلك وهو يحرّر هذه القاعدة، ينظر: أصول التفسير، ص69 وما بعدها.
[114] أصول التفسير، ص70.
[115] مقدمة في أصول التفسير، تح: عدنان زرزور، دار القرآن الكريم، ط1،1978، ص106، هامش رقم 1.
[116] أصول التفسير، ص74.
[117] أصول التفسير، ص74.
[118] الرسالة المدنية في الحقيقة والمجاز في الصفات، مجموع الفتاوى، (6/ 360- 361).
[119] الرسالة المدنية في الحقيقة والمجاز في الصفات، مجموع الفتاوى، (6/ 360).
[120] كتاب الإيمان، ص107.
[121] سورة الإخلاص، ص98.
[122] كتاب الإيمان، ص107.
[123] كما ذهب إلى ذلك الشيخ أبو زهرة في (ابن تيمية: حياته وعصره)، ص226.
[124] منهاج السنّة (4/ 4)، تفسير سورة النور، ص175.
[125] مجموع الفتاوى (6/ 389). وينظر تفسير سورة النور، ص175.
[126] مجموع الفتاوى (6/ 389).
[127] أصول التفسير، ص76. وينظر تفسير سورة النور، ص175.
[128] أصول التفسير، ص54.
[129] أصول التفسير، ص78.
[130] أصول التفسير، ص50.
[131] أصول التفسير، ص76.
[132] منهاج السنة (4/ 25).
[133] أصول التفسير، ص74.
[134] أصول التفسير، ص53.
[135] أصول التفسير، ص55. والزيادة بين المعقوفين محذوفة في أصول التفسير بتحقيق فريال علوان، ومثبتة في مجموع الفتاوى (13/ 359).
[136] أصول التفسير، ص77.
[137] أصول التفسير، ص78.
[138] أصول التفسير، ص78.
[139] وهذه هي النظرة الاستشراقية إلى ابن تيمية كما نجدها مثلًا عند جولدتسيهر. ينظر: مذاهب التفسير الإسلامي، ص367.
[140] ما هي بِجرأة ولكنه تعليم نبوي مقيَّد بالعلم كما ذكر في القاعدة الخامسة.
[141] ينظر: Hermenologie. ... A.Alaoui.p.241coranique et argumentation
[142] يرى أحمد العلوي أن (جرأة) الصحابة في التفسير أطروحة خاصة به لم تُكتشف من قبل. ينظر: نفس المرجع السابق، ص241.
كلمات مفتاحية
الكاتب:

فريدة زمرد
أستاذ التعليم العالي بمؤسسة دار الحديث الحسنية للتعليم العالي والبحث العلمي، بالرباط.
مواضيع ذات صلة
((المعلومات والآراء المقدَّمة هي للكتّاب، ولا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع أو أسرة مركز تفسير))