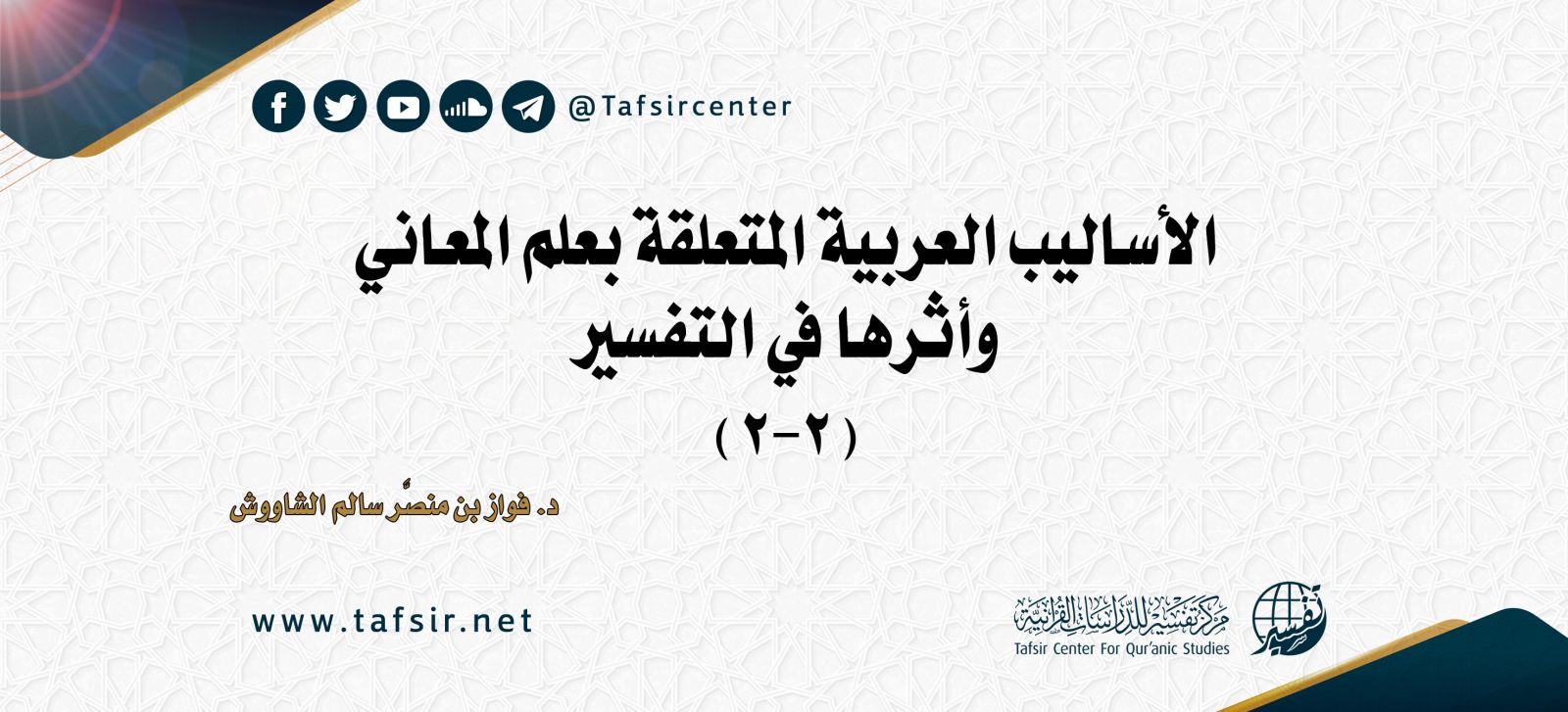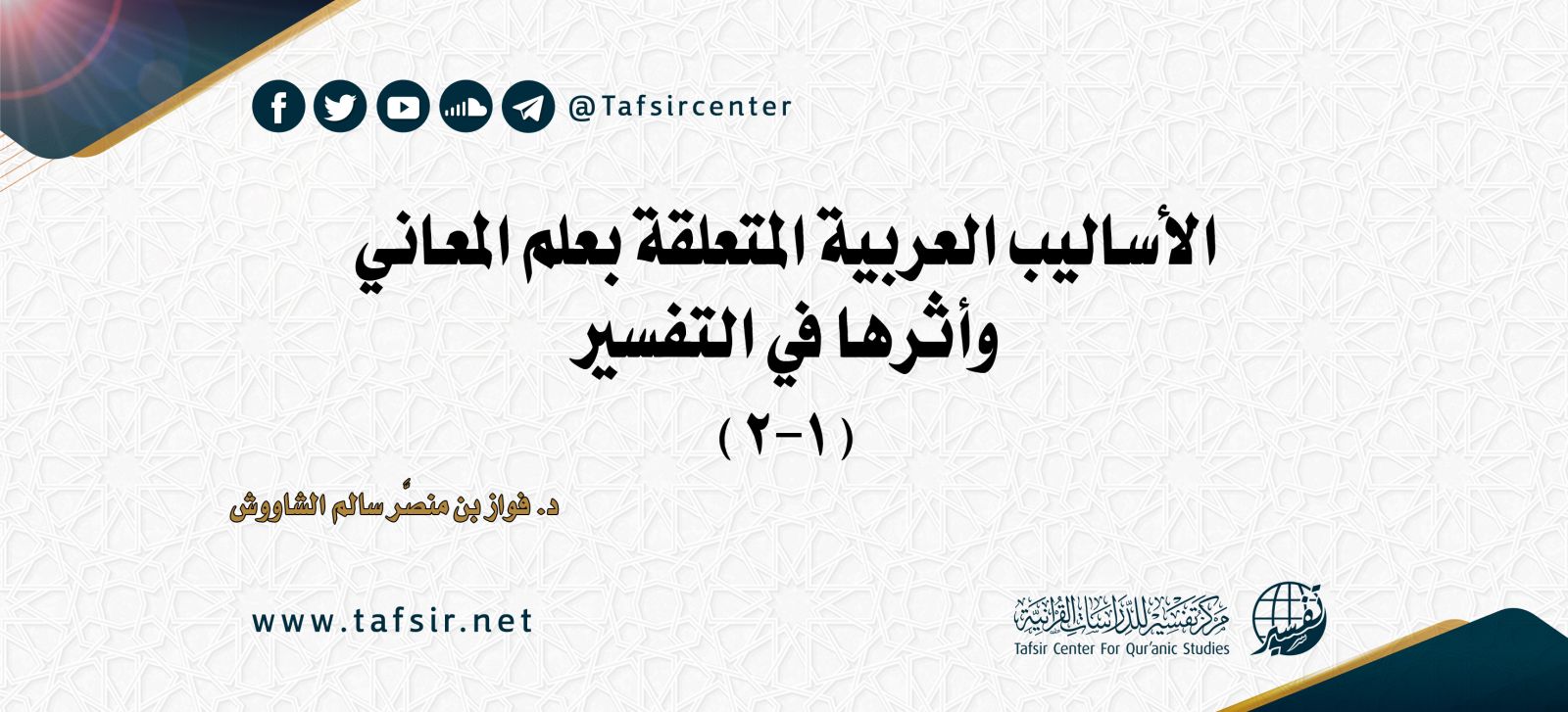قواعد التعامل مع التفسير النبوي
قواعد التعامل مع التفسير النبوي
الكاتب: نورة بنت خالد العرفج

قواعد التعامل مع التفسير النبوي[1]
وضع المفسِّرون عدّة قواعد للتعامل مع التفسير النبوي في تفاسيرهم، وهذه القواعد إمّا أنهم صرّحوا بذِكْرها، أو استُفِيدت مِن تتبّعِ مناهجهم في التعامل مع التفاسير النبوية، والمراد هنا إبراز القواعد التي يلزم المفسّر الالتزام بها، والنظر فيها حين يَرِد تفسير نبوي في الآية.
ومن أهمّ هذه القواعد:
1- إذا ثبت التفسير النبوي لا يُصار إلى قول آخر مناقِض له:
هذه القاعدة من أهمّ وأبرز القواعد التي ذكرها المفسِّرون في التعامل مع التفسير النبوي، وهي أساس جميع القواعد التي تُذكر في الحديث عن التفسير النبوي، فإذا ثبت التفسير النبوي لا يُصار إلى غيره من الأقوال المناقضة له، حتى لو كانت هناك دلالة قوية تدلّ على القول الآخر؛ لأنّ «الخبر متى ثبت صار أصلًا من الأصول، ولا يحتاج إلى عرضه على أصل آخر»[2].
فالتفسير النبوي -إذا ثبت- لا يُحاكم إلى أقوال السَّلَف، ولا إلى قواعد اللغة والأصول، ولا إلى غيرها، وهذه القاعدة لا تُنَازَع ولا تُعارَض بغيرها من القواعد.
ومن الأمثلة على ذلك:
- ما جاء عن أبي سعيد الخدري، قال: دخلتُ على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في بيت بعض نسائه، فقلتُ: يا رسول الله، أيّ المسجدين الذي أُسّس على التقوى؟ قال: فأخذ كفًّا من حصباء، فضرب به الأرض، ثم قال: «هو مسجدكم هذا»، لِمَسْجد المدينة[3].
وقد ورَدَ في هذه الآية سبب نزول يدلّ على أنّ المسجدَ مسجدُ قباء، إلا أنّ التفسير النبوي ثابت في أنّ المراد به مسجده -صلى الله عليه وسلم-، فهنا يلزم تقديم القول الموافق للتفسير النبوي الدالّ على أنّ المسجدَ مسجدُه -صلى الله عليه وسلم-، وردّ ما سواه من الأقوال الـمُخالفة له، حتى لو عُضدت هذه الأقوال بأدلّة قوية، قال الطبري: «وأَوْلَى القولين في ذلك عندي بالصواب: قول من قال: هو مسجد الرسول -صلى الله عليه وسلم-؛ لصحة الخبر بذلك عن رسول الله»[4].
ويدخل في هذه القاعدة قاعدة أخرى تعدّ جزءًا منها، وهي:
2- التسليم للتفاسير النبوية -إذا صحّت- وإن لم تبلغها العقول:
إذا صحّ التفسير عن النبي -صلى الله عليه وسلم- فإنه يجب التسليم له حتى وإن لم تبلغه العقول؛ فالأصل أنّنا «لا نعارض سُنّة النبي -صلى الله عليه وسلم- بالمعقول؛ لأن الدِّين إنما هو الانقياد والتسليم، دون الردّ إلى ما يوجبه العقل؛ لأنّ العقل ما يؤدي إلى قبول السُّنة، فأمّا ما يؤدي إلى إبطالها فهو جهل لا عقل»[5]، فإذا ورَدَ تفسير نبوي يتوهّم منه مخالفة العقل أو العلم فإنه يجب التسليم له؛ لأن العقول مهما بلغت فإنها تعجز أحيانًا عن إدراك بعض الأمور، فلا يصح الاعتماد عليها، وتقديمها على النقل الصحيح الثابت.
ومن الأمثلة على ذلك:
- ما جاء عن أبي ذر -رضي الله عنه- قال: سألتُ النبي -صلى الله عليه وسلم- عن قوله: ﴿وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا﴾ [يس: 38]، قال: «مستقرّها تحت العرش»[6].
فظاهر هذا التفسير النبوي قد يُوقع في إشكال؛ لأنه يدلّ على توقّف حركة الشمس، إلّا أنه من التفاسير النبوية التي يجب التسليم لها؛ لصحتها، سواء أدرك المفسِّر المعنى المراد أم لم يدركه؛ لذا قال ابن باز عن هذا القول: «والقول الأول هو الأصح؛ لأنّ النبي -صلى الله عليه وسلم- فسَّر المراد بمستقرّها، ولا يجوز العدول عن تفسير النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى تفسير غيره»[7].
وهذه القاعدة تدلّ على قاعدة أخرى، وهي:
3- كلّ قول ناقَض التفسير النبوي الصحيح فهو قول مردود:
ولا يُرَدّ القول المخالف للتفسير النبوي إلا إذا كانت المخالفة مخالفة تضادّ، بحيث لا يمكن الجمع بينهما.
4- إذا ورد في الآية أكثر من تفسير نبوي فإنه يُجْمَع بينها، فإذا تعذَّر الجمع يرجّح بالأصح إسنادًا:
ممّا يجب التنبه له هنا: أنه لم يقع تعارض واختلاف بين تفسيرَيْن نبويَّيْن ثابتَيْن، وأيضًا «لم يقع اختلاف بين التفسير النبوي وكلامه -صلى الله عليه وسلم- في غير التفسير؛ لأنّ هذا يدلّ على التناقض، والرسول -صلى الله عليه وسلم- منزَّه عن مثل هذا، فلا يُمكن أن يفسِّر آية بمعنى ثم يذكر في سُنَّتِهِ معنى يناقض هذا المعنى»[8].
وإنما يقع الاختلاف بين التفاسير النبوية إذا كان في أسانيدها ضعف؛ سواء كان الضعف في جميع التفاسير النبوية، أو في بعضها.
ومن الأمثلة على إمكانية الجمع بين التفاسير النبوية:
- ورود أكثر من تفسير نبوي في بيان المراد بالنعيم الوارد في قوله تعالى: ﴿ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ﴾ [التكاثر: 8]، إلا أنّ هذه التفاسير لا تَعَارُض بينها، ويمكن حمل الآية عليها باعتبار أن هذه التفاسير النبوية جاءت على سبيل التمثيل؛ لذا قال الآلوسي بعد ذِكر أحد هذه التفاسير النبوية: «وليس المراد في هذا الخبر حصر النعيم مطلقًا فيما ذُكر، بل حصر النعيم بالنسبة إلى ذلك الوقت الذي كانوا فيه جياعًا، وكذا فيما يصح من الأخبار التي فيها الاقتصار على شيء أو شيئين أو أكثر، فكلّ ذلك من باب التمثيل ببعض أفراد خصّت بالذِّكْر لأمرٍ اقتضاه الحال»[9].
فهنا بَيَّن الآلوسي أن التفاسير النبوية المذكورة تُحْمَل على التمثيل، ولا تَعَارُض بينها، وهذا أصل في التعامل مع التفاسير النبوية.
ومن الأمثلة على تعذُّر الجمع بين التفاسير النبوية:
- ورود أكثر من تفسير نبوي في بيان المراد بـ: ﴿يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ﴾ [التوبة: 3]، وهذه التفاسير لا يمكن الجمع بينها؛ لأن المراد من الآية تعيين يوم الحج الأكبر، وهو يوم واحد، وقد جاءت تفاسير تدلّ على أنه يوم عرفة، وتفاسير تدلّ على أنه يوم النحر، فهنا يلزم الترجيح بين التفاسير النبوية بصحّة الإسناد؛ لذا قال الشوكاني بعد ذِكْر هذه التفاسير النبوية: «ولا يخفاك أنّ الأحاديث الواردة في كون يوم النحر هو يوم الحج الأكبر هي ثابتة في الصحيحين وغيرهما من طرقٍ، فلا تقوَى لمعارضتها هذه الرواياتُ المصرِّحةُ بأنه يوم عرفة»[10].
5- يصح الترجيح بالتفسير النبوي الضعيف بشروط:
أ- صحة معناه.
ب- موافقته لسياق الآية، وقواعد اللغة.
ج- ألّا يُعارَض بما هو أقوى منه.
د- ألّا يكون الحديث موضوعًا أو شديد الضعف.
فإذا توفّرت هذه الشروط يصحّ الترجيح بالحديث الضعيف -والله أعلم-، وكذا إذا عُضد الحديث الضعيف بوجه آخر للترجيح فالترجيح به سائغ؛ لأن هذا مِن تَعاضُدِ وجوه الترجيح.
ومن الأمثلة على ذلك:
- الترجيح بحديث أبيّ بن كعب -رضي الله عنه- في تفسير قوله تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: 4]، فقد جاء عن أبيّ بن كعب -رضي الله عنه- قال: لـمّا نزلت هذه الآية: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾، قال: قلتُ: يا رسول الله، المتوفَّى عنها زوجها والمطلَّقة؟ قال: «نعم»[11].
فهذا الحديث ضعيف إلا أن الترجيح به سائغ -والله أعلم-؛ لتوفّر شروط الترجيح فيه، وموافقته لأوجه أخرى من أوجه الترجيح.
6- التمييز بين قصد النبي -صلى الله عليه وسلم- للتمثيل وقصده للحصر والتخصيص:
هناك عدّة أمور تُعِين المفسِّر على تمييز ذلك، وهي[12]:
أ- وجودُ بعض الألفاظ في التفسير النبوي الدالّة على التمثيل، كما في قوله -صلى الله عليه وسلم- في تفسير النعيم: «فهذا من النعيم»[13]، أو الدالّة على التخصيص، كما جاء عنه أنه حين سُئل عن المسجد الذي أُسّس على التقوى، أخذ كفًّا من حصباء، فضرب به الأرض، ثم قال: «هو مسجدكم هذا»، لِمَسْجد المدينة[14].
ب- إذا كان لفظ الآية أو سياقها يُحتِّم تعيين معنى واحد، فيكون في ذلك دلالة على أن التفسير النبوي الوارد في الآية للحصر لا التمثيل، كما في قوله تعالى: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾ [البقرة: 238]، فالتفسير النبوي الذي فسّر الصلاة الوسطى بالعصر يُحْمَل على التخصيص؛ لأن سياق الآية ولفظها يُحَتِّمان أن يكون المعنى واحدًا.
ج- إذا ورَدَ عن النبي -صلى الله عليه وسلم- عدّة تفاسير غير متعارضة فإنها تُحْمَل على التمثيل، كما سبق في بيان معنى النعيم.
د- فهمُ الصحابة -رضي الله عنهم- للتفسير النبوي، فإذا ورَدَ عنهم ما يدلّ على أن التفسير النبوي من باب التمثيل أو الحصر حُمِل التفسير النبوي على ما ورَدَ عنهم؛ لأنهم أقدر الناس على إدراك مراد النبي -صلى الله عليه وسلم-؛ لشهودهم التنزيل، ومعرفتهم مناسبةَ النزول، وحال مَن نزلَ فيهم القرآن، واطّلاعهم على الملابسات التي أحاطتْ بالتفسير النبوي حين تفسير النبي -صلى الله عليه وسلم- به، كما في تفسير ابن عباس -رضي الله عنهما- للكوثر بالخير الكثير[15]، وكان النبي -صلى الله عليه وسلم- قد فسّره بأنه نهر في الجنة[16]، ولو أنّ ابن عباس -رضي الله عنهما- فهمَ من هذا التفسير النبوي التخصيص لَمَا خالف نصَّ التفسير النبوي، فهذا التفسير منه للآية يدلّ على أنه فهمَ أن التفسير النبوي للتمثيل.
7- الالتزام بما وَرَدَ عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- في تفسيره للغيبيات دون خوض في الكيفيات:
ذكَرَ اللهُ -عز وجل- في القرآن بعض الغيبيّات، ولا سبيل إلى معرفة هذه الغيبيات إلا ببيان الرسول -صلى الله عليه وسلم-، وإذا ورَدَ عنه -صلى الله عليه وسلم- بيان لبعض الغيبيّات يلزم التوقّف عندها وعدم الخوض فيها.
ومن الأمثلة على ذلك:
- ما جاء عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في تفسير الصُّور بأنه: «قَرْنٌ يُنْفَخ فيه»[17]، وهذا بيان لأمرٍ غيبي لا نُدْرِك كيفيته.
قال الماتريدي: «ومنهم من يقول: هو قَرْنٌ يُنْفَخ فيه، كقرن كذا، أو بوق كبوق كذا، لكنّا لا نفسِّر شيئًا مما ذُكر من النفخ والصُّور أنه كذا، ولا نُشِير إلى شيء أنه ذا، إلا إذا ثبتَ شيء من التفسير عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيُقَال به، وليس هو بشيء يوجب العمل به فنكلّف صحّته أو سقمه، إنما هو شيء يجب التصديق به، فنقول بالنفخ والصُّور على ما جاء، ولا نُفسِّره -والله أعلم-»[18].
8- لا يُحكَم بصحة القراءة الموافقة للتفسير النبوي إذا خالفت قراءة الجمهور:
إذا ورَدَ تفسير عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، وكان هذا التفسير على معنى قراءة أخرى مخالفة لقراءة الجمهور، فلا يُحْكَم بصحّة هذه القراءة، وإنما يُستفاد منها في التفسير، ولا يُجزم بصحتها إلا بتوفّر شروط القراءة الصحيحة فيها[19]، فإنْ أمكنَ الجمع بينها وبين قراءة الجمهور جُمِع بينهما، وإلا رُجّح المعنى الموافق لقراءة الجمهور.
ولا تَعارُض بين قراءة صحيحة ثابتة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وتفسير صحيح عنه؛ لأن هذا يدلّ على التناقض كما سبق، ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- مُنَزَّه عنه.
ومن الأمثلة على ذلك:
- تفسير الرسول لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ﴾ [المؤمنون: 60]، بأنه: «الرجل يصوم ويصلِّي ويتصدَّق ويخاف ألّا يُقْبَل منه»[20].
وهذا التفسير منه -صلى الله عليه وسلم- لا يوافق قراءة الجمهور؛ لأنه فسّر الآية بفعل الطاعة، والخوف من عدم قبولها، وهو موافق لقراءة عائشة -رضي الله عنها-: (يَأْتُونَ مَا أَتَوْا) بدون مدّ؛ من الإتيان، وهو فعلُ الشيء.
وهنا لا تُـثبت هذه القراءة، إلا أنّ معناها لا يُرَدّ، وإنما يُستفاد منها في تفسير الآية.
[1] هذه المقالة من كتاب (سؤالات الصحابة -رضي الله عنهم- للرسول -صلى الله عليه وسلم- واستشكالاتهم في التفسير)، الصادر عن مركز تفسير سنة 1439هـ، (1/ 189) وما بعدها. (موقع تفسير)
[2] نقله ابن حجر في فتح الباري (4/ 336) عن ابن السمعاني.
[3] رواه مسلم (1398).
[4] جامع البيان (11/ 685).
[5] الحجة في بيان المحجة، لأبي القاسم الأصبهاني (2/ 549).
[6] رواه البخاري (4803)؛ ومسلم (159).
[7] نقل هذا القول عنه: الدكتور حسين الحربي في قواعد الترجيح عند المفسِّرين (1/ 182).
[8] شرح مقدمة التسهيل لعلوم التنزيل، للدكتور/ مساعد الطيار، ص166.
[9] روح المعاني (29/ 306).
[10] فتح القدير، ص685.
[11] أخرجه الشاشي في مسنده (1458)، وابن جرير (23/ 56) بنحوه؛ قال ابن حجر في الفتح (8/ 654): «هذا المرفوع وإن كان لا يخلو شيء مِن أسانيده عن مقال، لكن كثرة طُرقه تُشْعِر بأنّ له أصلًا، ويعضّده قصة سُبَيْعَة المذكورة».
[12] ينظر: استدراكات السلف في التفسير في القرون الثلاثة الأُولى (دراسة نقدية مقارنة)، لنايف الزهراني، ص378؛ واختلاف السلف في التفسير، ص79.
[13] رواه ابن ماجه (3181) مختصرًا، وأبو يعلى في مسنده (78) مطولًا.
[14] رواه مسلم (1398).
[15] رواه ابن أبي شيبة (11/ 440)، وأحمد (5913)، والترمذي (3361)، وابن ماجه (4334)، وابن جرير (24/ 689)، وصححه الترمذي.
[16] رواه مسلم (400).
[17] رواه أحمد (6507)، وأبو داود (4742)، والترمذي (2599)، والحاكم (3631)، وابن جرير (15/ 416- 417)؛ قال الترمذي: «هذا حديث حسن»، وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرِّجاه»، وأورده الألباني في الصحيحة (1080).
[18] تأويلات أهل السُّنة (8/ 140- 141).
[19] وهذه الشروط، هي: موافقة اللغة العربية ولو بوجهٍ من الوجوه، وموافقة الرسم العثماني ولو احتمالًا، وصحة السند. ينظر: المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز، لأبي شامة، ص171- 172، والنشر في القراءات العشر، لابن الجزري (1/ 9).
[20] رواه أحمد (25263)، والترمذي (3449)، وابن ماجه (4198)، والحاكم (3486)، وابن جرير (17/ 71)، وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يُخَرِّجاه». وقال العراقي عَقِب كلام الحاكم، ص1511: «بل منقطع بين عائشة وبين عبد الرحمن بن سعد بن وهب». وأورده الألباني في الصحيحة (162).
كلمات مفتاحية
الكاتب:

نورة بنت خالد العرفج
حاصلة على الدكتوراه من كلية الشريعة والقانون قسم الدراسات الإسلامية - جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، ولها عدد من الأعمال العلمية المنشورة.
مواضيع ذات صلة
((المعلومات والآراء المقدَّمة هي للكتّاب، ولا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع أو أسرة مركز تفسير))