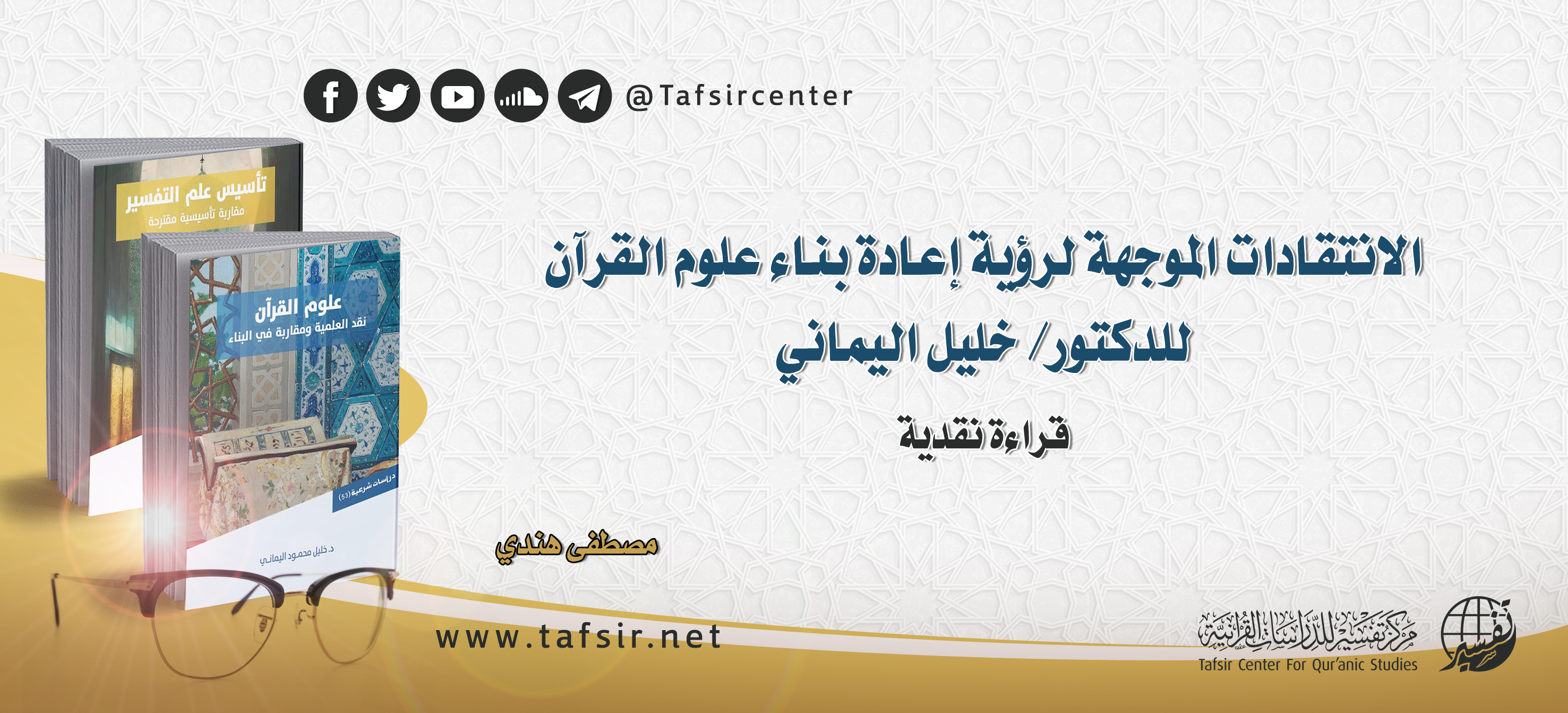دعاوَى نزع القدسيَّة عن القرآن عند الحداثيين؛ عرضٌ ونقد
عرضٌ ونقد
الكاتب: خالد عبد الله بريه

مفتتح:
شَغَل النصُّ القرآني عنايةَ الدّارسين في القديمِ والحديث، فكانَ جُلُّ عنايتهم فَهْمَه، والإحاطةَ بأسراره، فوَجَّهُوه توجيهاتٍ متعددةً بما يتّفقُ مع قداستِه، وخصوصيتهِ القارَّةِ فيه، ومقاصدِه الكُبرى، فأغنَت تأويلاتُهم الدَّرْسَ اللغويَّ فضلًا عن إغنائها الثَّقافةَ الإسلاميَّة.
وشكَّل لهم القرآنُ الكريمُ مَعِينًا لا تنقطعُ عجائبه، ولا تنضبُ أسراره، فكُتِبَت العلومُ، والفنون، وتفتَّقَ الذّهن البشري عن بدائعَ من القول، والتحبِير، والتصنِيف، والتقعِيد؛ خدمةً له. وقد توجَّه إلى المتلقي برسالةٍ كاملةٍ لا تُغْفِلُ مَنزعًا من منازعِ الحياة والوجود؛ لتحريره من هيمنةِ الخرافة، ورَبْطِه بخالقِه وبعوالمِ الغَيْب، ولهذا انفرَدَ الخطاب في نموذجه المتعالي، بحيويةٍ زاخرة تصدر عنها السّياقات القرآنية؛ للارتقاءِ بمتلقِّيه إلى معاقِدِ الإفهام.
وقد اكتسب النصُّ القرآني في المنظومةِ المعرفيةِ الإسلامية أهميةً منقطعة النَّظير؛ فالعلوم الإسلامية كلّها نشأت وتشكَّلَت لفَهْمِه، والتَّفريع عليه، وتثويره، وبناء منظومة معرفيَّة منبثقة عنه، ترومُ إظهار بيانه، وخدمته، باعتباره النصَّ المؤسِّس، بالتَّأمل في نصوصِه، وبيانِ كيفية التَّعبّد بها، وكيفية اعتمادها موجّهة لمختلف أعمال المسلِم؛ ولذلك صار محلّ اهتمام متميز في الخطابِ الحداثي العربيِّ المعاصر. وقد ألمح أبو زيد لذلك عند قوله: «إنَّ النصَّ القرآني احتلَّ في الثَّقافة الإسلامية مركز الدَّائرة، واعتبر الكشف عنه كشفًا عن آلياتِ إِنتاج المعرفة؛ لأنَّ النصَّ الديني صار المولّد لكلِّ أو لبعضِ أنماط النُّصوص»[1].
ومِن الأسئلةِ المهمَّة عن النصِّ القرآني، سؤال القُدْسِيَّة، ماذا تعني قَداسة القرآن؟ وما هو أساس القدسيّة ومنشؤها؟ هل القُدسية تكمن في الخطاب أم هي راجعة إلى ما وراء الخطاب؟ وإن كانت راجعة إلى ما وراء الخطاب، فكيف تتجلَّى في الخطاب؟ وكيف تسحب إلى النصّ الحاضن للخطابِ المكتوب؟
هذه أسئلةٌ مشروعة، غير أنَّ الجوابَ عنها ليسَ سهلًا، ليسَ بسبب بُعدها الدّيني والمعرفي فحَسْب، وإنّما الاجتماعي أيضًا كما يقرّر ذلك الباحث محمَّد مصطفوي[2].
ولا يخفى على الباحث أنَّ منشأ هذا التساؤل، وأحد أسبابه؛ هو تغوّل الفكر الحداثي، ومحاولة تفعيل أدواته في فهمِ القرآن، وتطبيق بعضِ آلياته للتمييز بينَ الواقعي والغيبي، والمشروط والمطلق، وبتعبيرٍ أوضح، الفصل بينَ ثنائية: (المادِّي والغَيبي) (الواقعي والمتعالي) (المشروط والمطلق)، وإعطاء الأولويَّة للمادِّي والواقعي والمشروط، على حسابِ الغيبي والمتعالي والمطلق، وهذا التَّصور أفرزَ حالةً شبه سائدة لدى كثيرٍ من الحداثيين، في النَّظر إلى القرآن باعتباره منتَجًا بشريًّا بعيدًا عن التَّعالي والتَّقديس، يُؤخَذُ منه ويُرَدُّ، يُصيب ويُخطِئ، شأنه شأن أيِّ فكرٍ ونصٍّ بشري.
وقد صرَّحَ عليّ حرب، أنَّ من أهداف القراءة الحداثيَّة، نزع القداسة عن النصِّ، وعبَّر عن ذلك بقوله: «فكيف نقرأ النصوص قراءة نقدية تاريخية، ونزعم أنّنا لا ننزع عنها صفة التَّعالي والقداسة؟ لا مجال إذًا للمداورة والالتفات، بل الأحرى والأَوْلَى مجابهة المشكلة بدلًا من الدوران حولها»[3]، وبهذا التصوّر، فالنصّ القرآني ظاهرة تاريخيَّة حدَثَتْ في زمنٍ ما، لا تحمل أيّ طابعٍ مقدَّسٍ يلزمُ التّمَسُّك بها، وهذا ما يؤكِّدُه هاشم صالح تلميذ أركون ومترجم كتبه، عند قوله: «آنَ الأوانُ للكشفِ عن تاريخيّة النصّ القرآني وإنزاله من تعاليه الفوقي إلى الواقع الأرضي المحسوس، آنَ الأوانُ للكشفِ عن علاقته بظروف محدَّدة تمامًا في شبه الجزيرة العربية وفي القرن السابع الميلادي»[4]، وأحاديث بعض الحداثيين متضافرة على نزعِ القداسة عن النصِّ القرآني، وإِنْ بدرجاتٍ متفاوتةٍ بينهم، وفي هذه المقالة نحاول تناول بعض الدَّعاوَى التي تنزع القداسة عن القرآن الكريم، ونقاشها بما يسمحُ به المقام.
البعد اللغوي والقرآني للمفردة:
القُدْس -بسكون الدَّال وضمّها- هو الطُّهْر، من النَّاحِية اللغوية، اسمٌ ومصدر، ومنه قيل للجَنَّة: (حظيرة القُدس)، ورُوح القُدس: هو المَلَاك جِبريل. والتَّقديس: التَّطهير. والأرض المقدَّسة: المطهَّرة، ومنه بيتُ المقدِس[5]. ويُقال: إنَّ (القادسية) دعا لها إبراهيم -عليه السَّلام- بالقُدس وأن تكون محلَّة الحاج[6]. ويرى ابن فارس (ت: 395) أنَّ «القاف والدَّال والسِّين أصل صحيح، وهو يدلُّ على الطُّهْر»[7].
فالتَّقدِيس يُطلَقُ في اللغةِ إذًا على معنيَيْن، ففي حقِّ الله أطلق وكانَ بمعنى التنزيه، فقولك تقدَّس الله، أي: تنزَّه، فتقدِيسُ الله تنزِيهُهُ كما قاله الخليل بن أحمد الفراهيدي، ومنه سُمِّي اللهُ بالقدُّوس كمَا ورَدَ في القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿هُوَ اللهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ﴾ [الحَشر: 23]، أي: ننزِّهُك عمّا لا يليقُ بِك. وتُطلَقُ ويرادُ بها التطهِير وهو قريبٌ من المعنى الأول وربما عُبِّر بأحدهما عن الآخر في معاجمِ اللغة[8].
وانطلاقًا من المفهوم اللغوي ورَدَ في القرآنِ عن القرآنِ أنه: ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ [الواقعة: 79]، أي: لا يفهمه أو لا يلمسه: (إلا المطهَّرون) على اختلافٍ في تفسير الكلمة؛ نظرًا إلى الاستعمالِ اللغوي والقرآني[9].
وأمَّا في القرآن، فقد ورَدَت مشتقَّاتُ الكلمة بمفهومٍ قريبٍ من المفهوم اللغويِّ، أي: بمعنى التَّنزِيه، والمبارَك، والطُّهْر، والتَّعظيم، والتَّمجيد، في مثل: ﴿وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ﴾ [البقرة: 30]، وفي الآية: ﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ﴾ [الحشر: 23]، وفي الآية: ﴿إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى﴾ [طه: 12]، وفي غيرها من الآيات[10].
وقدسِيّةُ النصِّ القرآني راجعةٌ إلى «الخطاب ذاته ومصدره»، حيثُ إنَّ الله -بحسب الصِّفات الجماليَّة والجلالية التي يتصفُ بها- مطلقٌ في الكمال، ومنزَّهٌ عن كلِّ عيبٍ ونُقصان، وهو ما يدعو إلى تقديسِه وتقديسِ ما يصدرُ عنه، وأمَّا بالنسبةِ إلى الخطاب والنصّ الحاوي له، فمِن بابِ الملازَمة. فإنَّ القدسِيَّة بالنسبةِ إلى الله أمرٌ ذاتيٌّ ولا يحتاجُ إلى دليل؛ إِذْ إنه مِن قَبِيل القضايا التي قياسها معها؛ ولذلكَ نجد أنَّ القرآن لا يقيمُ دليلًا على صفاتِ الله، وإنما يقيم الدَّليل على وجوده (تعالى)، وبعد ثبوتهِ، فإنه لا يمكن أن يثبت إلا وهو موجِدٌ لجميعِ الصفات، وعليه، فإنَّ الحديثَ القرآني عن صفاتِ الله من باب التَّعريف والإخبار، وأمَّا القدسية بالنسبةِ إلى الآخرين، بما فيهم الأنبياء والمرسلون، فتحتاج إلى الدليل؛ ولذلك نجد في القرآن التركيز على وجوب طاعة النبي -صلى الله عليه وسلم- والتقيُّد بأوامره ونواهيه[11].
والحديث عن قداسةِ النصِّ القرآني يأخذ أهميته لاعتباراتٍ عدّة، منها بيان حُجج مَن تسمَّى بالمدرسةِ العقليَّةِ الحديثة، التي ترى -في غالبها- أنَّ النصَّ القرآني منذ لحظةِ نزوله تحوَّلَ من كونه (نصًّا إلهيًّا) وصار فَهْمًا (نصًّا إنسانيًّا). وأنَّ النصَّ كان مقدَّسًا في مستواه الوجودي الأول، أي: وجوده الميتافيزيقي، وهو كذلك حينما أُنزِل منجَّمًا على النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، لكن مباشرةً بعد لحظةِ نُزولهِ على النبي -صلى الله عليه وسلم- فَقَدَ قدسيته وصار نصًّا تاريخيًّا، وهو ما عبَّر عنه الطيِّب تيزيني بلحظة تقاطع الميتافيزيقا مع التاريخ، عندها مالَ النصُّ إلى التَّشَظِّي التاريخي، وساعته فَقَدَ قدسيته وصار نصًّا تاريخيًّا[12]. في حين أنَّ النصَّ القرآني تحوَّل من كونه (نصًّا إلهيًّا) إلى (خطابٍ مُعْجِز) لا يمكن التَّعاطِي معه أو فهمه إلا من خلال خاصيَّة الإعجاز، وهي خاصيَّةٌ قامَت على الخَرْقِ والإبداع بحسَب قواعد اللغة ونظامها[13][14].
توظيف مفهوم القداسة:
وقد وَظَّفَ المسلِمونَ وتعاملوا مع النصِّ القرآني باعتباره (مقدَّسًا) في ذاته؛ وذلك لطبيعته: فهو كلامُ الله -عزَّ وجلَّ-، فقدسيته من مصدره، كما أنَّ قدسيته في غايته وهي بيان الحقيقةِ العليا التي هي الأُلوهية كما بيَّنَها هذا النصُّ الكريم. وتوظيف هذا النصِّ والتَّعامُل معه في الحياةِ الإسلامية مما تضمّنه النصُّ ذاته؛ ولذلك حدَّد القرآن كيف يتعامل معه، كما حدَّدَت السُّنة النبوية كيفية التَّعَامُل معه أيضًا، ويكون ذلك عملًا مقدَّسًا؛ أي: عبادة يُؤجَر عليها المسلِم[15].
ويظهر هذا التوظيف المقدَّس -كما قلتُ- في طبيعة هذا النصِّ أوّلًا، وفي مصدره، فالقرآن الكريم كلام الله -عزَّ وجلَّ-، والكلام في المعتقد الإسلامي صفة من صفاتِ الله -عزَّ وجلَّ-، وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية (ت: 728): «الكلام صفة المتكلم، والقول صفة القائل، وكلام الله ليسَ بائنًا منه»[16]. وما دام أنَّ النصَّ كلام الله -عزَّ وجلَّ- فلا ينبغي أن يكون التَّعامُل معه كالتَّعامُل مع أيِّ كلامٍ آخر ولا توظيفه أيضًا.
ولهذا، يتجلَّى التَّوظيف المقدَّس للنَّص القرآني بأمورٍ متضافرة؛ منها حماية حِياض النصِّ مِن العبثِ من خلالِ التَّأسيس والتَّأصيل والتَّقعيد المتواصل لضبطِ بوصلة الفَهْم عن القرآن، وتخليصه من الأهواءِ واللامنهجيّة، وما ذلكَ إلّا لِما يمثّله في أنظارِ متلقِّيه مِن قداسةٍ مغايرةٍ عن أيِّ نصٍّ آخر. ومِن لطيفِ تجلِّيات توظيف المقدَّس للنصِّ القرآني، «كيفية تلاوته، وآداب تلك التّلاوة، والحثّ على المواظبةِ على تلاوته وتعلُّمه، واستحباب خَتْمِه كلَّ أسبوع، وغير ذلك من الأمور التي تؤكّد التَّوظيف المقدَّس للنصِّ القرآني»[17].
وإنَّ هذه الآداب المختلفة التي يأخذ بها المسلِم في تعامله مع النصِّ القرآني، تؤكّد أنه نصٌّ مقدَّسٌ في ذاته؛ لذا يقول الزركشي (ت: 794): «التَّالِي للكلامِ بمنزلةِ المكالم لذي الكلام، وهو غاية التَّشرِيف من فضلِ الكريم العلّام»[18]. وقد وجَدْنَا كيف أنَّ هذه الآدابَ منصوصٌ عليها في القرآنِ الكريم، وفي السُّنة النَّبوية التي تؤكِّد تَـمَيُّز النصِّ القرآني عن غيره وبيان قدسيته في ذاته.
التوظيف الحداثي:
تتوجَّه غالب الرُّؤى الحداثية إلى أنَّ القداسة التي تميَّزَ بها النصُّ القرآني ليست نابعة منه، بل هي تاريخيَّة؛ فنصر حامد أبو زيد -مثلًا- يَعتبِر أنَّ النصَّ القرآني طَرأَ عليه تحوُّلٌ، فبعدما كانَ في طبيعته الأصليَّة «نصًّا لغويًّا» تحوَّل إلى شيءٍ له قداسته بوصفه شيئًا؛ أي: حينما تحوَّلَ المصحف إلى أداةٍ للزينة[19]. ويُفْهَم مِن هذا أنَّ قدسية النصِّ ليست ذاتية، بل أُضِيفَت إليه، وهو الموقف والرؤية التي نجدها تتكرّر في الخطابِ الحداثي مع محمَّد أركون وعزيز العظمة والطيب تيزيني، وغيرهم، وقد شَذَّ عنهم هشام جعيط، فقال بقدسيةِ القرآن الكريم واعتبره مقدَّسًا بالمعنى الدقيق للكلمة سواء آمَن الإنسان بمصدره الإلهي أم لم يؤمن[20]. وإن كان يبدو أنَّ جعيط خلال إثباته لقدسية النصِّ القرآني يريد ربطه بالكتابِ المقدَّس في إطار علمِ مقارنةِ الأديان.
وبناءً على هذه الرؤية، يرى بعضُ الباحثين: أنَّ حُجُبَ القداسة والتَّبجيل التي أُسْدِلَت على القرآن الكريم على تراخِي الزَّمن؛ هاجسٌ مؤرِّقٌ للقراءةِ المعاصرة، وهَمٌّ ثقيلٌ يصاحبها ويماسّها، فلا تجد منه خلاصًا إلا بهتْكِ هذه الحُجُب، وإسقاط الهيبة، عن طريق النَّقد الحُر، والإيغال في عوالمِ التَّفكيك، واستزراع المناهج الغربية المطبَّقَة على نصوص التَّوراة والأناجيل في حَقْل الدَّرسِ القرآني[21]. دون مراعاةٍ لخاصيّة التَّقديس الملتصقةِ به، وإنزاله مكان أيّ كتابٍ آخر تجري عليه يد النَّقد والتفكيك بأدواتٍ لا تنظر إلى خصوصيته القارَّةِ فيه[22]. لا كمَا يقول طيِّب تيزيني عن النصِّ القرآني من أنّه «نصٌّ لغويٌّ تاريخيٌّ مثل أيّ نصٍّ آخر، وكونه ذا أصل إلهيّ لا يتيح النَّظر إليه على أنه ذو خصوصية منهجية تنْأَى به عن مناهج البحث العلمي المعتادة، لتلحّ على منهجٍ إلهيٍّ خاصٍّ به»[23]. ولا يخفى التَّصور الجليّ الذي ينطلقُ منه تيزيني في نظرته للقرآنِ الكريم، وعدم تحرُّجه من إخضاعه لمطارقِ النَّقد، كأيِّ نصٍّ آخر؛ لأنه يرى أنَّ القدسيَّة ليست خاصيَّة ذاتيَّة في القرآن الكريم، بل هي خاصيَّة مضفاة عليه في التَّاريخ.
وحاصل الأمر في تصوّراتهم أن يصبح «القرآن موضوعًا للتساؤلات النَّقدية المتعلِّقة بمكانته اللغوية، والتاريخية، والأنثروبولوجية، والثيولوجية الفلسفية»[24]، وهـذا يقتضي في نظر أركون «معاملة مزدوجة: فأوّلًا ينبغي القيام بنقدٍ تاريخي لتحديد أنواع الخلط والحذف والإضافة والمغالطات التَّاريخية التي أحدثتها الروايات القرآنية بالقياسِ إلى معطيات التَّاريخ الواقعي المحسوس. وثانيًا: ينبغي القيام بتحليل التبيين كيف أنَّ القرآن ينجز أو يبلور شكلًا ومعنى جديدًا»[25].
وإذا كان أركون قد نزَعَ منزع المماثلة بينَ القرآن الكريم ونصوص التَّوراة والأناجيل من حيث طروء التَّحريف والتبديل، انطلاقًا من إثارة إشكال التَّدوين، والانتقال من الشَّفاهي والكتابي، وتدخّل السّلطة الرسمية في الحذفِ والإضافة، فإنَّ نصرًا ينزعُ إلى مماثلة موازية هي التسوية بينَ النصِّ الإلهي والنصِّ البشري باعتبارهما نصًّا لغويًّا خاضعًا لمطارق النَّقد الأدبي، يقول: «إنَّ النصَّ القرآني وإن كان نصًّا مقدَّسًا إلا أنه لا يخرج عن كونه نصًّا؛ فلذلك يجب أن يخضع لقواعد النَّقد الأدبي كغيره من النُّصوص الأدبية»[26].
ويقول أيضًا: «إنَّ أُلوهية مصدر النصِّ لا تنفي واقعية محتواه ولا تنفِي -مِن ثمَّ- انتماءَه إلى ثقافة البَشَر»[27].
في حين أنَّ أُلوهية مصدر النصِّ لا تنفِي واقعية محتواه، وهذا حقٌّ لا ريبَ فيه، ولكنها تنفِي انتماءَه إلى ثقافة البَشَر بالمعنى الذي يقصده أبو زيد وأضرابه، أو تنفِي أن يكونَ من إنتاجِهم، من غير أن تنفِي ملاءَمَته لهم وصلاحيته في أن يكون ثقافةً للبَشر. وهذا أمر كان يجب على نصر حامد أنْ يجعله فرقًا ويقيمه بينَ الأطروحتَيْن: أطروحةُ واقعيةِ النصِّ، وأطروحةُ انتماءِ النصِّ إلى ثقافة البَشَر، واللتان تعنيان أنَّ البَشَر هم الذين يصنعونَ نصوصهم في مختبر أنساقهم الثَّقافية واللغوية.
وفي معرِضِ تعليقه على أطروحة أبو زيد، يقول العيَّاشي: «ولذا نجد أنَّ القرآن إزاء هذا الأمر، يقول: ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ﴾، (أي لو كان ينتمي إلى ثقافةِ البَشَر) ﴿لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ [النساء: 82]. وكأَنَّ هذه القضية كانت قد طُرحت في زمنِ نزولِ القرآن؛ فرَدَّ القرآن عليهم في هذا إزالةً للبس، ولا ندري كيف فات هذا الأمر نصر حامد أبو زيد»[28].
وهكذا، يتّضح أنَّ السِّلاح الأثير للقراءةِ المعاصرة في غارتها على قداسةِ القرآن وربّانيته، هو الشَّك الهدَّام الذي عُمِّمَ على مستويات النصِّ القرآني جميعها، بدءًا من التَّدوين، ومرورًا بالمضمون، وانتهاءً إلى المقاصد[29]. وقد رفع أنصار الحداثة الغالية هذا الشَّك إلى رتبة القانون الشَّامل، وانساقوا وراءه انسياق عَمَهٍ وضلالٍ، دونَ تمحيص فعاليته المنهجية، أو اختبار مناسبته للمحلّ المنزل عليه، ولو أنهم استقلّوا بهذا النَّظر؛ لأدركوا أنَّ آلة الشَّك «لا توصل إلى الحقيقة في كلّ شيء، وإنما تقتصر فائدتها في مجال واحدٍ بعينه، هو مجال الظواهر؛ أمَّا الآيات القرآنية التي هي ليست من هذا المجال، وإنّما هي من مجال القيم، فلا ينفع في الوصول إلى الحقيقة بشأنها إلا سلوك طريق يضادّ طريق الشَّك»[30]؛ وغنيٌّ عن البيان أنه هو طريق الإيمان واليقين؛ إِذْ كلما زاد الإيمان بالقيمة، زاد انكشافها للمؤمنِ بها، وكلّما نقص إيمانه بها، نقص انكشافها، حتى تضمحل عند تمامِ الارتياب بها.
ومِن مسالكهم في خطاباتهم التَّأويلية لنزعِ القداسة عن النصِّ القرآني، تجاوز مفهوم الإعجاز في القرآن الكريم الذي ثبتَ إعجازه ليس على المستوى اللغوي فحَسْب، بل على مستويات أخرى من الإعجاز كالإعجاز بأخباره الغيبية أو تشريعاته الحكيمة، وهذا التَّجاوز لمفهوم الإعجاز تنوّعت صوره، لكن يجمعها الهدف من هذا التَّجاوز وهو محاولة نزع القداسة عن القرآن الكريم ولو كان ذلك على حساب المغالطة العلمية؛ ولذلك نجد عبد المجيد الشَّرفي وهو يتحدّث عن موضوع الإعجاز وأنَّ مردّه: «ليس لأنه معجِز ببلاغته بقدر ما هو راجعٌ إلى مصدره الإلهي الذي ليسَ في متناول البشر.. مع أنَّ الآثار الفنية الراقية شعرًا كانت أو نثرًا أو رسومًا أو منحوتات أو روائع موسيقية أو غيرها، كلّ أثر منها معجِز بطريقته الفريدة، ولا سبيل إلى الإتيان بمثلها رغم بشريّـتها»[31]. ومراده هنا أنَّ الإعجاز يرجعُ لعاملٍ خارجيّ، وهو (المصدر الإلهي)، وليس لذاتِ النصِّ، ولعلّ قوله هذا أقرب إلى القول (بالصَّرْفَة) من بعضِ الوجوه، والصَّرْفة من مفاهيمها «أنَّ الله صَرَفَ هِمَم العرب عن معارضةِ القرآن»[32]، أي: أنَّ ذلك كان في مقدورهم، لكنَّ عامِلًا خارجيًّا حالَ دونَ ذلك، والحائل هنا، هو المنعُ الإلهي لهم عن معارضةِ القرآن.
النصّ القرآني نصٌّ مفارق:
وإنه لحسَنٌ أن نستحضرَ في هذا المقام ما يسمَّى بـ«مفارقةِ الحضور» التي يتصفُ بها النصُّ القرآني، وهي تنتظم في فكرةِ القداسة والفرادة للنصِّ القرآني وتميُّزه عن غيره؛ لأنَّ للنُّصوص عند كلّ الشُّعوب حضورًا يتوزّع على أنواع معيّنة ما بين نثرٍ وشِعْرٍ، وإذا كانت هذه النصوص بحضورها نماذج بناءٍ ولغات، تنقسم عند الشعوب إلى نوعَيْن، فإنَّ النصوص في حضورها عند العرب تنقسم إلى ثلاثةِ أنواع؛ نوعان منها يتقاسمهما العرب وغير العرب، وهما: التَّداولي والأدبي، ونوعٌ ثالثٌ لا وجودَ له إلا عند العرب، وهو القرآن الكريم[33]. وتعليقًا على هذا التَّقسيم، يعلِّق منذر عياشي بقوله: «وإذا كانَ الأوّل والثَّاني يتكرَّرانِ وجودًا، ويتقلَّبانِ تغيُّرًا يومًا بعدَ يوم؛ فإنَّ الثَّالث، أي القرآن، ثابت لا يتكرَّر وجودًا إلا في قُرّائِه، ولا يتقلَّب تغيُّرًا وإِنْ تغيَّر قُرّاؤه وتقلَّبُوا، ولا سبيل معه غير هذه السَّبِيل»[34]. ومن هنا، فقد كان القرآن، نموذجًا في حضوره لحضور غيرِه مفارقًا بناء ولغة، وهو لا يجري عليه معتاد ما يجري على سواه. ألا وإنَّ هذا الأمر ليؤكّد، بيقينٍ قاطع، أنه لا يجوز أن يُقارن القرآن بنصٍّ آخر في حضوره ولا أنْ يماثلَ بسواه.
فالقرآن إذن نصٌّ مفارق، بمقتضى لوازم الوجود وسننه، نصٌّ مختلفٌ ومغايرٌ لغيره، ولغته لغة مباينة، وهو بالمفهوم التَّداولي، يمثّل اللغة كما هي مستعمَلة عند مستعْمِلِها، وبما أنَّ مستعملها ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيءٌ﴾، فإنَّ لغته على مثاله ليس كمثلها شيء.
إذن، نرجع لنؤكّد أنَّ القرآن نصٌّ من النصوص، لكنه ذو طبيعـة خاصَّـة فهـو نصٌّ مقدَّس؛ معانيه قديمة قِدَم قائِلهِ عزَّ وجَلّ، وهذا يقتضي أحكامًا خاصَّـة يـجـبُ مراعاتها والاهتمام بها، فهو وإن كان نصًّا لغويًّا باعتبار الدَّال هو أيضًـا صـفة من صفاتِ کمال الله تعالى وجلاله باعتبارِ المدلول. وهذا الأمر هو الرُّوح السَّاري في كتابِ الله تعالى، وهـو الـذي جعلـه يتميّز على سائر الكلام من اقتصادٍ في العبارة، ووفاءٍ في المعنى، وقدرةٍ على مخاطبة بني الإنسان في سائرِ عصورهم، وعلى قدر أفهامهم وسائر المتغيرات الزَّمانية والمكانيَّة، فالتَّسلِيم بإلهيَّة مصدره مع إنكار لازمه -أعـني القدرة على استيعاب حاجات النَّاس على اختلافِ مداركهم- تناقضٌ يتنافى مع الإيمان بالله الذي لا حدودَ لقدرته[35].
مآلات نزع القدسيَّة عن النصّ القرآني:
مآلات دعاوَى نزع القدسيَّة عن النصّ القرآني، تفضِي إلى مفهوم (الأنسنة)، وهي تفضي إلى القول ببشرية النصوص الدينية على وجه العموم، والقرآن الكريم على وجه الخصوص، فهذه النصوص قد (تأنسنت) منذ تجسَّدت في التَّاريخ واللغة، وتوجَّهت بمنطوقها إلى البَشَر في واقعٍ تاريخيٍّ محدَّد. فمنذ أنْ نَزَلَ القرآن إلى البَشر أصبحَ نصًّا تاريخيًّا؛ لأنه تحوَّل من «كتـابِ تنزيـل إلى کتابِ تأويل، فأصبحَ كتابًا بشريًّا تاريخيًّا واجتماعيًّا وتراثيًّا»[36]؛ومن لوازمِ الأنسنة: القول بتاريخيةِ القرآن الكريم[37]، فهو لديهم أسير بيئته التاريخية والجغرافية والنظام الاجتماعي الثقافي والذهنية السَّائدة إبّان نزوله، وقد ظهرَ القرآن الكريم إجابةً عن أسئلةٍ شتى طرحتها الثقافة في المجتمعِ العربي الإسلامي الأوّل، فلا يتعدّاها[38]. وإذا كان القرآن نصًّا بشريًّا غير مقدّس وقد تأنسن وكان نصًّا تاريخيًّا كسائر الوثائق الأثرية والمستحاثات، فإنّ النتيجة الحتمية لذلك أن يتناوله معول النَّقد. فلا يخفَى -بناءً على هذا التصور- أنَّ القراءة التَّاريخية من أخطرِ القراءاتِ المعاصرة مساسًا بقدسيَّة النصِّ القرآني، والعبَث به، ونقضًا لدلالاته القاطعة ومعانيه الكبرى، وتصييره نصًّا بشريًّا لغويًّا أدبيًّا صاغته حوادثُ الزَّمن، ونسجته ظروف البيئة المحيطة به.
وفي كتابه معايير القبول والردّ، يرى عبد القادر حسين، أنه لا سبيلَ إلى مناقشةِ اتجاه (نزع القداسة عن النصّ القرآني) في الجزئيات قبل أنْ يسلِّموا بالكليَّات؛ فالإيمان بالقرآنِ الكريم فرعٌ عن الإيمانِ بـمُـنْزِلهِ، وما دام مُنْزِلُه هـو الخالقُ القدير عزَّ وجَلَّ فهذا يلزم منه أَنْ يكون قادرًا قدرة مطلَقة على كلّ شيء ممكن، ومخاطبة النَّاس جميعًا بخطابٍ واحدٍ على اختلافِ مداركهم من قبِيل الممكن العقلي؛ فلا حرجَ منه ولا مانعَ من ذلك[39]. وهذا ملمحٌ مهمٌّ في تناوُلِ نقدِ اعتراضات القوم، ونقضِ تصوراتهم عن القرآن الكريم الذي أخذوه مجرَّدًا عن مصدره.
ولعلَّ من المهم أن نؤكّد في هذا السياق: أنَّ القدسية صفة ملازمة للنصِّ القرآني، وليسَت ملازمة لما ينتجه المفسِّر من آراء تفسيرية عند قراءته للنصِّ[40]، وخير دليلٍ على عدم وجود تلكَ الملازمة إمكان نقضِ ومناقشة ودحض الآراء التَّفسيرية بخلافِ النصِّ القرآني؛ ومع إيماننا بأنَّ الفهوم لا تحمل قداسة القرآن الكريم، ولا تقاربه إلا أنه يجبُ على مَن يتصدى لتفسيره أن يتمسَّك بقواعدِ الفَهْم والاستنباط التي أشار إليها أهل العلم، في تضاعيفِ الدَّرس التَّفسيري والأُصولي؛ حتى لا يُصوَّر الوحي بأنَّه قطعة نصيَّة من المتشابهات لا يقبل الانضباط، وكذا التَّأكيد على «بطلان التَّصوّر الذي يحيلُ النصَّ القرآني كلّه إلى طبيعةٍ سيَّالة لا يمكن استثبات معانيه أبدًا»[41].
كما أنَّ القدسية ليست أمرًا معرفيًّا بحتًا؛ لأنها لا تستند إلى المقال فقط، بل إلى القائل بشكلٍ رئيس[42]، وخصوصية القائل تهيمنُ على النصوص المقدَّسة، فمَن يقرأ نصًّا مقدَّسًا أو يفسّره بمعزلٍ عن القائل، فهو قاتلٌ للنصِّ وليسَ قارئًا له[43]، ومن هنا، فإنَّ أهمية التَّأويل تستند إلى القائلِ وليس إلى المقالِ فحَسْب؛ وذلك باعتبار أنَّ اللغة ليست لازمًا ذاتيًّا لِلْبَاثّ/ المرسِل، وإنما هي وسيلة لإيصال الرِّسالة من خلال النصِّ/ الرسالة.
الختام:
استوردَت المدرسةُ العقليةُ الحداثيةُ المناهجَ الحديثةَ، وعملوا جاهدين في الدَّعوة إلى توظيفها وتطبيقها على نصوصِ القرآن الكريم مطلقًا؛ دونَ اعتبار ولو مِن بعيد للقواعدِ والأُصول المنهجيَّة، وقدسية النصّ، والمحدِّدات والضَّوابط المرجعية المرعيّة. وبهذا، يتبيّن للقارئ أنَّ التأويلات المعاصرة للقرآن الكريم تدور حول النصّ القرآني ولا تقربه، فَلا تَتَّخِذُ بالضَّرورة منهجًا لقراءة النصّ القرآني؛ لأنها لا تتمتع بمرجعيّةٍ كافيةٍ تُبَوِّئها المقْعَد اللائق في تفسير دلالات النصّ وتأويلها، إلّا بالقدر الذي تلتزم بخصوصيّةِ هذا النصّ.
كما تبيّن أنَّ حُجُب القداسة والتَّبجِيل التي أُسْدِلَت على القرآنِ الكريم على تراخي الزَّمن؛ هاجسٌ مؤرِّقٌ للقراءةِ المعاصرة، فلا تجد منه خلاصًا إلا بهتكِ هذه الحُجُب، وإسقاط الهيبة، عن طريقِ النَّقد الحُر، والإيغال في عوالمِ التَّفكيك تارة، واستزراع المناهج الغربيَّة المطبَّقة على نصوصِ التَّوراة والأناجيل في حَقْل الدَّرسِ القرآني تارة أخرى، دونَ مراعاة لخاصيَّة التَّقديس الملتصقةِ به، وإنزاله مكان أيّ كتابٍ آخر تجري عليه يد النَّقد والتفكيك بأدواتٍ لا تنظر إلى خصوصيته القارَّةِ فيه.
[1] ينظر: النصّ والسلطة والحقيقة، نصر حامد أبو زيد، (الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، 1995)، ط1، ص149.
[2] ينظر: أساسيات المنهج والخطاب في درس القرآن وتفسيره، محمد مصطفوي، (بيروت: مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي، 2017)، ط2، ص279.
[3] نقد النص، عليّ حرب، (الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، 2005)، ص77.
[4] الإسلام والانغلاق اللاهوتي، هاشم صالح، (بيروت: دار الطليعة للطباعة والنشر، 2010)، ص375.
[5] ينظر: مختار الصحاح، أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي، تحقيق: يوسف الشيخ محمد، (بيروت- صيدا: المكتبة العصرية- الدار النموذجية، 1420هـ= 1999م)، ط5، ص249.
[6] ينظر: مختار الصحاح، أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي، ص249.
[7] معجم مقاييس اللغة، أبو الحسين أحمد بن فارس، تحقيق: عبد السَّلام محمَّد هارون، (بيروت: دار الفكر، 1399هـ= 1979م)، (5/ 63).
[8] ينظر: دَرْج الدُّرر في تَفسِير الآيِ والسُّوَر، أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الفارسي الجرجاني، دراسة وتحقيق: (الفاتحة والبقرة) وَلِيد بن أحمد بن صالِح الحُسَيْن، (وشاركه في بقية الأجزاء): إياد عبد اللطيف القيسي، (مجلة الحكمة، بريطانيا: 1429هـ= 2008م)، ط1، (1/ 355).
[9] يقول طه جابر العلواني: تشير -الآية- إلى عملية الوصول إلى المعنى، وليس اللّمس الحسّي كما ذهب إلى ذلك بعض الفقهاء. وإنما مسُّ المعنى المكنون والوصول إليه، وقد وضَعَ اللهُ -تبارك وتعالى- كلمة: (المطهَّرون)، بصيغة اسم المفعول لكي ينبّه إلى أنَّ عملية التطهير تجري من الخارج، يعني المطهَّر هو من طَهَّرَه غيره. ذلك يعني أنَّ المطهَّرين هم أولئك الذين طهَّرهم الله -تبارك وتعالى- وهيَّأ عقولهم وقلوبهم ووجدانهم لِلَمْسِ معاني القرآنِ الكريم والوصولِ إليها. ينظر: تفسير القرآن بالقرآن، طه جابر العلواني (فرجينيا: المعهد العالمي للفكر الإسلامي، 2020)، ط1، ص31.
[10] ينظر: جامع البيان في تأويل القرآن، محمد بن جرير الطبري، تحقيق: أحمد محمَّد شاكر، (بيروت: مؤسسة الرسالة، 1420هـ= 2000م). (1/ 506)؛ زاد المسير في علم التفسير، أبو الفرج عبد الرحمن بن عليّ بن محمد الجوزي، تحقيق: عبد الرزاق المهدي، (بيروت: دار الكتاب العربي، 1422هـ)، ط1، (1/ 51).
[11] ينظر: أساسيات المنهج والخطاب في درس القرآن وتفسيره، مصطفوي، ص280.
[12] ينظر: الإسلام وأسئلة العصر الكبرى، الطيب تيزيني، ص134- 135.
[13] ينظر: أنسنة النصّ القرآني عند الحداثيين النظام اللغوي (عربية النصّ) أنموذجًا، حاكم حبيب الكريطي، حكيم سلمان السلطاني، (د.م)، ص12.
[14] وإذا حاوَلْنا نفي خضوع النصِّ القرآني خضوعًا تامًّا للنظام اللغوي من خلال خصيصة الإعجاز؛ فإنَّ النظام اللغوي هو الآخر غير خاضعٍ تمامًا للثقافة والواقع، بل قد يكون هو مؤثرًا فيه؛ فالقرآن الكريم المعجِز بنَظمه وأسلوبه أحدث تغييرًا معرفيًّا في ثقافةِ العرب وأسلوب تفكيرها، فبفضله تحوَّلَت العرب من البداوة إلى الحضارة، ومن الشَّفاهية بكلِّ ما تحمل من ثقافة البديهة والارتجال إلى الكتابية بما تحمله من التأمُّل والرويَّة؛ فأصبح القرآن بالنسبة للعربي ليس مجرّد قراءة جديدة للعالم والكون فقط، بل هو قطيعة حقيقية لِما سبَقَهُ، وهو في الوقت نفسِه تأسيسٌ لنمطٍ مختلفٍ في التفكير.
[15] ينظر: إشكالية تاريخية النص الديني في الخطاب الحداثي العربي المعاصر، (بيروت: منشورات ضفاف، 2012)، ط1، ص25.
[16] مجموعة الرسائل والمسائل، ابن تيمية، تعليق: رشيد رضا، (لجنة التراث العربي)، مرزوق العمري، (3/ 163).
[17] إشكالية تاريخية النصّ الديني في الخطاب الحداثي العربي المعاصر، مرزوق العمري، ص25.
[18] البرهان في علوم القرآن، الزركشي (1/ 459).
[19] مفهوم النص، نصر حامد أبو زيد (الدار البيضاء، بيروت: المركز الثقافي العربي، 2014)، ط1، ص12.
[20] وذلك عند قوله: «القرآن، إذن، كتابٌ مقدَّس بالمعنى الدقيق للكلمة، سواء آمَن بألوهيته الإنسانُ -المسلمون وحتى غيرهم- أم لم يؤمن، فاعتبره تراثًا دينيًّا يدخل بالتالي في سلسلة الكتب المقدَّسة المعتمدة على علاقة مع الإله، أي: على وحي. على أنَّ مفهوم الكتاب المقدس أوسع من مفهوم الكتاب الموحَى به révélé؛ لأنّ الأديان مثل البوذية ما يستبعد فكرة الإله جملة». ينظر: في السيرة النبوية القرآن والوحي والنبوة، هشام جعيط، (بيروت: دار الطليعة، 1999)، ص18.
[21] ينظر: النص القرآني من تهافت القراءة إلى أفق التدبر «مدخل إلى نقد القراءات وتأصيل علم التدبر القرآني»، د. قطب الريسوني، (المملكة المغربية: منشورات وزارة الأوقاف والشؤون المغربية الإسلامية، 2010)، ص411.
[22] ولا يعني هذا الإحجام والامتناع عن الاستفادة من أيِّ أدواتٍ قديمة كانت أو حديثة، تسهِمُ في فهم النصِّ القرآني، وتساعد في عمليةِ التَّدبر، والاستنباط، وتحقِّقُ المقصد، دون المساسِ بقداسته.
[23] ينظر: النصّ القرآني، الطيب تيزيني، ص373- 374، 379؛ نقد الخطاب الديني، نصر حامد أبو زيد، (القاهرة: مكتبة مدبولي، 2003)، ص174- 175.
[24] الفكر الإسلام: قراءة علمية، محمد أركون، ترجمة: هاشم صالح، (بيروت: مركز الإنماء القومي، 1996)، ط2، ص246.
[25] الفكر الإسلامي: قراءة علمية، محمد أركون، ترجمة: هاشم صالح، ص250.
[26]مفهوم النص، نصر أبو زيد، ص24.
[27] مفهوم النص، نصر أبو زيد، ص24.
[28] القرآن من بناء النصّ إلى بناء العالم، منزر عياشي، ص38- 39.
[29] وقد جاءت «غالب» أطروحاتهم مشكّكة في سلامةِ القرآن الكريم من الزيادة والنقصان، في خرق سافر لخاصية حفظ القرآن الكريم من الزيادة والنقصان. والتشكيك في كونه مُنزَّلًا من عند الله عزّ وجَلّ، بل القول ببشريته. ينظر: القراءة التاريخية للقرآن الكريم، عبد الحافظ صحبوض، شبكة الألوكة، تاريخ الإضافة: 25/ 9/ 2017م = 4/ 1/ 1439هـ، ص7.
[30] النص القرآني من تهافت القراءة إلى أفق التدبر، قطب الريسوني،ص412.
[31] الإسلام بين الرسالة والتاريخ، عبد المجيد الشرفي، (بيروت: دار الطليعة للطباعة والنشر، 2008)، ط8، ص51؛ وينظر: ظاهرة التأويل الحديثة في الفكر العربي المعاصر، خالد بن عبد العزيز سيف، ص389.
[32] بيان إعجاز القرآن (ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن)، أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي، تحقيق: محمد خلف الله أحمد، د. محمد زغلول سلام، (القاهرة: دار المعارف)، (د.ت)، ط4، ص22.
[33] القرآن من بناء النص إلى بناء العالم، منذر عياشي (سورية، دمشق: دار نينوى، 2015)، ط1، ص38- 39.
[34] القرآن من بناء النص إلى بناء العالم، منذر عياشي، ص38- 39.
[35] ينظر: معايير القبول والردّ لتفسير النص القرآني، عبد القادر محمد الحسين، تقديم: د. عليّ جمعة، (دمشق: دار الغوثاني للدراسات القرآنية، 2012)، ط2، ص437.
[36] الإسلام والعصر تحديات وآفاق، الطيب تيزيني، ص111.
[37] هي محاولة مقاربة النصِّ القرآني وتوظيفه حداثيًّا، من خلال دراسته بالمنهج التاريخي، باعتباره ظاهرةً تاريخيةً، ونصًّا لغويًّا تشكَّلَ في الثقافة واكتسَبَ سلطته في الواقعِ، وأُضيفت عليه القداسة (ولم يكن مقدَّسًا في ذاته)، ومنتجًا ثقافيًّا مرتبطًا بالزمان الذي حدثَ فيه (القرن السَّابع الميلادي)، والمكان الذي تجلّى فيه وهو مكة المكرمة، وكذلك بيان خصائص البيئة الجغرافية والثقافية التي ظهرَ فيها، ثمَّ دراسة أهم الأشخاص الذين كانوا وراء تلك الحادثة التاريخية، وهم ما يصطلح عليهم من منظور (أركون) بالفاعلين التاريخيين. ينظر: إشكالية تاريخية النص الديني في الخطاب الحداثي العربي المعاصر، مرزوق العمري، ص41. القراءة التاريخية للقرآن الكريم، عبد الحافظ صحبوض، شبكة الألوكة: تاريخ الإضافة 25/ 9/ 2017، ص4.
[38] ينظر: المنهج الأنثروبولوجي في دراسة مصادر الفكر الإسلامي، ضم مجموعة بعنوان: موافقات في قراءة النص الديني، المنصف عبد الجليل، (تونس: الدار التونسية للنشر، 1990)، ص42.
[39] عبد القادر حسين، معايير القبول والردّ، عبد القادر حسين، ص443.
[40] ينظر: أساسيات المنهج والخطاب في درس القرآن وتفسيره، مصطفوي، ص281.
[41] ينبوع الغواية الفكرية، عبد الله العجيري، (الرياض: مجلة البيان، 1434هـ)، ط1، ص205.
[42] وهذا بخلاف ما تقتضيه نظرية «موت المؤلِّف» التي انبثقت مع توجّه الفيلسوف (نيتشه) إلى رفعِ القيود عن العقل والخروج عن عالم المعقول إلى عالم اللامعقول والتركيز بشكل مستمرّ على سلطة الإنسان الخارق وصحوة انفلاته من الإله.
[43] وهذا مما تفارق فيه «نظرية التلقِّي» المعاصرة النصَّ القرآني؛ لأنها تُعْلِي من شأن القارئ/ المتلقِّي في المقامِ الأوّل، دون اهتمامٍ كاملٍ بالكاتب/ المرسِل. بخلاف القرآن الذي يمثّل حالة خاصة في النصِّ ومرسِله.
كلمات مفتاحية
الكاتب:

خالد عبد الله بريه
حاصل على الدكتوراه من جامعة كارابوك – تركيا، وله عدد من المؤلفات والأعمال المنشورة.
مواضيع ذات صلة
((المعلومات والآراء المقدَّمة هي للكتّاب، ولا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع أو أسرة مركز تفسير))