السَّجْعُ وتناسُب الفواصل، وما يكون من ذلك في القرآن الكريم
وما يكون من ذلك في القرآن الكريم
الكاتب: عبد الرحمن تاج
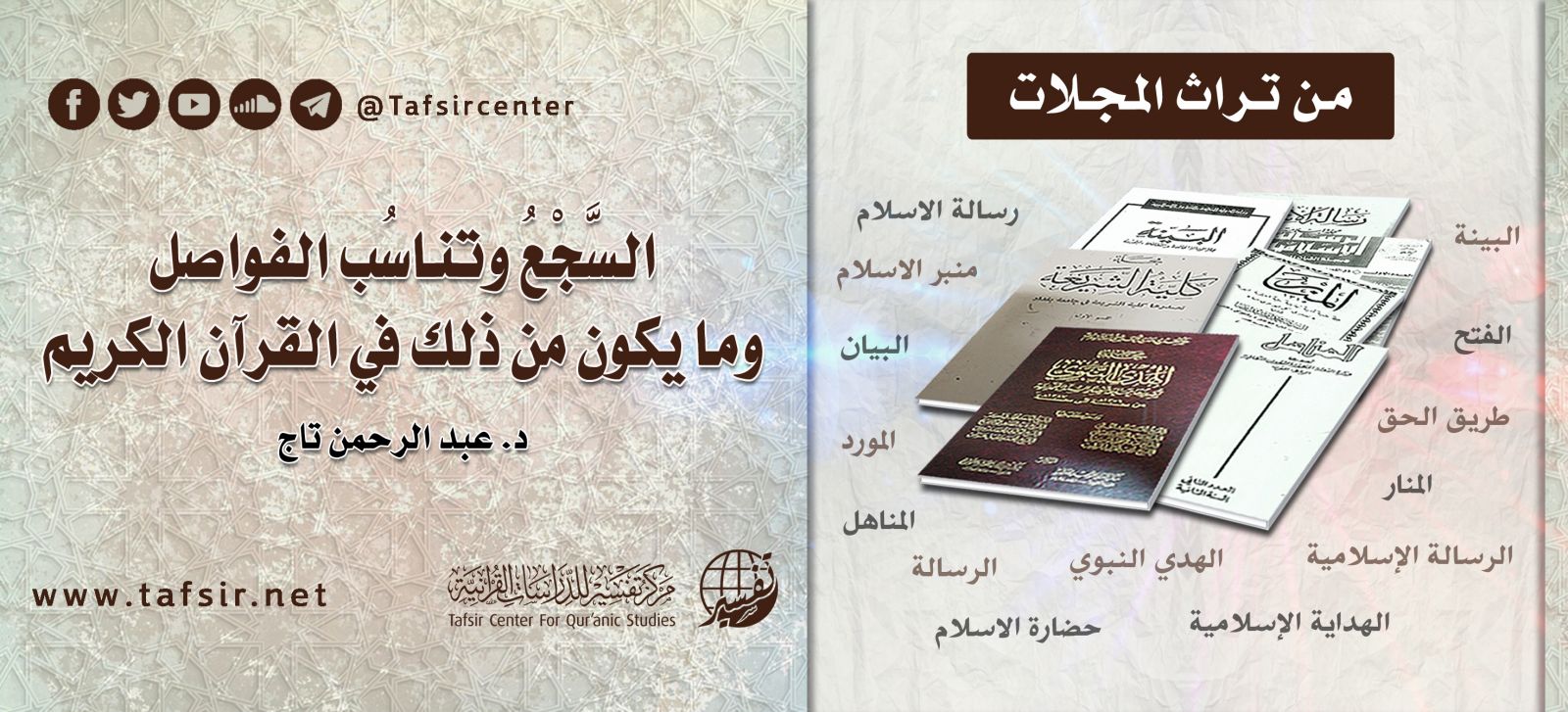
السَّجْعُ وتناسُب الفواصل
وما يكون من ذلك في القرآن الكريم[1]
يتنوّع الكلام من حيث نَظْمِه إلى ثلاثة أنواع: شِعْر، وسَجْع، وكلام مرسَل.
وإن شئت قلت: هو -من حيث النظم- نوعان أصليان: يندرج تحت أحدهما قسمان فرعيان: النوع الأول الشِّعْر، والنوع الثاني النثر. ويندرج تحت النثر فرعان: هما السجع، والكلام المرسل.
ويمتاز الشِّعْر عن النثر بفرعيه بأوزانه الخاصة، وبحوره وتفاعيله المعروفة.
أما السجع فإنه ينفصل عن قسميه (النثر غير المسجوع) بالتقفية، وهي أن تكون الفقرة من الكلام منتهية بمقطع تنتهي به فقرة بأخرى أو عدّة فقرات.
والكلام المسجوع أي المقفى لا يدخل بهذه التقفية في نطاق الشِّعْر؛ لأنه تعوزه مقومات الشِّعْر، وهي تلك الأوزان -أو البحور المعروفة- التي جعلت لها عناوين خاصة.
فالكلام المسجوع مقفَّى بما يشبه قافية الشِّعْر، لكنه ينقصه وزنه، أما الكلام المرسل غير المسجوع فهو خالٍ من الوزن والقافية جميعًا.
هذا وإن القرآن كلام عربي لا يخرج عن نطاق تلك الأنواع، ولا يصح أن يُقال: إنه يمكن أن يجانبها جميعها.
وإذًا فأيّ شيء من تلك الأنواع يمكن أن يُقال: إنه أسلوب القرآن الكريم أو يكون قد وقع في أسلوبه؟
وجواب ذلك: هو أن القرآن ليس بشِعْر، ولا ينبغي أن يُوصف شيء منه بأنه من الشِّعْر، وهذه حقيقة لا شك فيها ولا شبهة.
لكن هل يمكن أن يحكم بأنه خالٍ أيضًا من التقفية، وأنه ليس فيه شيء من النثر المسجوع؟ وإذا كان الأمر كذلك فماذا يُقال في آيات كثيرة جدًّا من سور كثيرة أيضًا من القصار وغير القصار قد خُتمت بفواصل متناسبة لا تختلف في شيء عن تقفية السجع؟
إنه إذا كان من الحقائق التي لا شك فيها ولا شبهة أن القرآن ليس شِعْرًا، وليس فيه ما قصد وصله بشيء من موازين الشِّعْر، فإنه من الحقائق التي لا شك فيها ولا شبهة أيضًا أن كثيرًا من السور القرآنية قد بُنيت آياته كلّها أو أغلبها على تناسب الفواصل.
وإذًا فالقرآن في أسلوبه العام -فيما عدا تلك السور والآيات ذات الفواصل المتناسبة- هو من الكلام المرسل.
هذا، والفواصل في القرآن قد تكون من نوع واحد من أنواع مختلفة:
1- فسورة الضحى: قوله تعالى: ﴿وَالضُّحَى * وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى * مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى * وَلَلآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الأُولَى﴾ [الضحى: 1-4] قد بُنِيَت في أغلب آياتها على فاصلة الألف، وهي من قصار السور.
2- وكذلك سورة (طه) -وهي من السور المتوسطة بين الطوال والقصار- قد جاءت آياتها أغلبها على فاصلة الألف: ﴿طه * مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى * إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَنْ يَخْشَى * تَنزِيلًا مِمَّنْ خَلَقَ الأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلى * الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى * لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى﴾ [طه: 1-6].
- ومن السورة نفسها قوله تعالى: ﴿إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى * قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يَا مُوسَى * قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى * قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الأُولَى * قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لا يَضِلُّ رَبِّي وَلا يَنسَى﴾ [طه: 48-52].
وقد تخرج مجموعة من الآيات عن الفاصلة الغالبة إلى فاصلة أخرى، كما جاء في هذه السورة أيضًا في قوله تعالى: ﴿قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي * وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي * وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي * يَفْقَهُوا قَوْلِي * وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي * هَارُونَ أَخِي * اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي * وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي﴾ [طه: 25-32].
- وعقب هذه الآيات نجد مجموعة ثالثة من ثلاث آيات ختمت بفاصلة غير ما ختمت به المجموعتان الأوليان، وذلك قوله تعالى: ﴿كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا * وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا * إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا﴾ [طه: 33-35]، ثم تعود السورة إلى الفاصلة الغالبة فاصلة الألف.
3- وكذلك سورة النَّجم، أغلب آياتها على فاصلة الألف: ﴿وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى * مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى * وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى * عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى * ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى * وَهُوَ بِالأُفُقِ الأَعْلَى * ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى * فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى﴾.
وهكذا إلى قرب ختام السورة فتخرج الآيات إلى فاصلة في مجموعة من آيتين؛ وذلك في قوله تعالى: ﴿أَزِفَتِ الآزِفَةُ * لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ﴾، ثم إلى فاصلة ثالثة في مجموعة ثالثة في قوله تعالى: ﴿أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ * وَتَضْحَكُونَ وَلا تَبْكُونَ (60) وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ﴾.
4- وكذلك الحال في سورة مريم، والفرقان، والصافات، والملك، والقلم، والحاقة، والتكوير، والانشقاق، وكثير غيرها.
5- بل إن في القرآن سورًا قد بنيت آياتها جميعها من أوّلها إلى آخرها على نوع واحد من الفواصل لم تخرج عنه إلى غيره.
أ- وذلك مثل سورة الشمس: ﴿وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا * وَالْقَمَرِ إِذَا تَلاهَا * وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا * وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا * وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا * وَالأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا﴾.
ب- ومثل سورة الليل: ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى * وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى * وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالأُنْثَى * إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى﴾.
جـ- وكما في سورة القمر التي هي أكبر من هاتين السورتين: ﴿اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ * وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ * وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌّ﴾. وهكذا قد بنيت السورة كلّها على الراء.
إنه لا شك أن ذلك الذي قدمنا له تلك الأمثلة ليس من نوع الشِّعْر المعهود، ثم لا شك أيضًا أنه ليس من قسم النثر المرسل الذي لم يُبْنَ على تقفية وتناسب فواصل؛ فلم يبقَ إلا القسم الآخر الذي هو النثر المسجوع.
فإذا لم تكن تلك الآيات والسور من طبيعة السجع فمن أي طبيعة تكون؟
هنا يقول بعض الباحثين -مستندًا على ما هو مقرّر من انحصار الكلام في تلك الأنواع الثلاثة- يقول: ولا يرى في ذلك شيئًا من الحرج: إنّ ذلك الذي ذكر من الآيات والسور المعتمدة على تناسب الفواصل هو السجع بعينه في معناه وحقيقته.
لكن فريقًا آخر من الباحثين لا يجيز أن يُقال: إن القرآن فيه سجع. ولماذا؟
هل يرون أن حقيقة السجع وماهيته تأبى أن تنطبق على الفواصل المتناسبة في مثل ما قدّمناه من السور والآيات؟ وما هي هذه الحقيقة التي لا تنطبق على تلك الفواصل؟
إنّ هؤلاء المانعين الذين لا يقولون بالسجع في القرآن لم يبينوا بيانًا شافيًا أصل ذلك المنع، ولم يعينوا النقطة التي ينفصل عندها السجع عن تناسب الفواصل القرآنية حتى يتضح السبيل ويزول الإبهام ويستقيم الأمر في إطلاق الألفاظ على معانيها الخاصة.
إننا إذا راجعنا الكلام المسجوع الذي كان ينشئه الخطباء والكتّاب في الجاهلية أو في صدر الإسلام أو فيما بعد ذلك، وبحثنا فيه من حيث فقراته: مقاديرها وفواصلها، وتقارب هذه الفواصل أو تباعدها واتحادها في الكلام الواحد أو اختلافها فإننا نستطيع أن نستخلص الأمور الآتية:
1- إنه لم يكن حتمًا أن تقوم الخطبة كلّها أو الرسالة جميعها على فاصلة واحدة، بل كان يخرج الخطيب أو الكاتب بعد عدّة فقرات يبنيها على فاصلة معينة -إلى فاصلة أخرى- يبني عليها مجموعة أخرى من الفقرات، ثم قد يخرج أيضًا من الفاصلة الثانية إلى ثالثة ورابعة، وهكذا على حسب ما يسمح به المقام.
2- لا يلزم في المجموعة الثانية أو ما بعدها أن تكون عدة فقراتها مساوية لفقرات المجموعة الأولى، فإنها قد تزيد عليها، وقد تنقص عنها.
3- إن فواصل كلّ مجموعة من الفقرات تكون -في أغلب الأمر- متقاربة، إذ كانوا يميلون إلى أن تكون الفقرات قصيرة، ولكن ذلك ليس معناه أن تضبط كلمات كل فقرة أو حروفها بعدد معين تتساوى فيه تلك الفقرات، بل يكفي ألا يكون بينها في ذلك تفاوت بَيِّن.
4- إنّ بعض من كانوا يعنون من أولئك الخطباء والكتاب بأمر السجع ويلتزمونه في بعض خطبهم وكتبهم كثيرًا ما كانوا ينظرون إلى السّجع في المقام الأول، أما المعنى فقد كان نظرهم إليه في المنزلة الثانية.
وقد يضطرهم الشغف بالسجع والتزامه إلى تكلفات يصير بها معنى بعض الفقرات غامضًا مبهمًا أو قليل الجدوى.
وهذا في أغلب الأمر هو شأن الكلام الذي تكون العناية فيه بالمعنى وراء العناية باللفظ، على حين أن الكلام الجيد هو الذي يكون فيه اللفظ تابعًا للمعنى.
5- إنّ السجع قد يطلق إطلاقًا خاصًّا بدلالة المقام ومعونة القرائن على ما يكون من الكهان الذين يرجمون فيه بالغيب ويحدثون به عن المستقبل، يدَّعون به معرفة أسرار الأقدار، ويتخذون في ذلك وسائل من الخداع والتمويه بما يودعون أسجاعهم من الإبهام والغموض، واستخدام الألفاظ التي تحتمل أكثر من معنى.
هذه الأمور الخمسة التي قدمناها منها الثلاثة الأولى لا يتبيّن منها فارق ذو شأن يمكن أن يفصل بين السجع وفواصل آيات القرآن الكريم؛ فإن من الآيات القرآنية ذات الفواصل المتناسبة ما تكون فواصله -كما علمنا- متقاربة بسبب قصر تلك الآيات، وذلك كما قلنا في السجع.
ومنها ما تكون مجموعة منها على فاصلة، ثم تخرج مجموعة بعدها إلى فاصلة أخرى. وقد تخرج مجموعة ثالثة إلى فاصلة ثالثة كما هو الحال في الكلام المسجوع.
أما الأمران الأخيران فهما اللذان يصحّ الفصل بهما بين السجع وفواصل آيات القرآن؛ فإن هذه الفواصل مبرأة مما هو سبب ذمّ السجع على ما أشير إليه في هذين الأمرين.
لكن قد يُقال: إن المحذورات التي من أجلها كان ذمّ السجع ليست ذاتية له، ولا ناشئة من طبيعته، وإنما هي أمور عارضة يمكن أن ينفصل عنها ويتجرّد منها فلا يكون مذمومًا.
فتكلّف السجع -وهو الذي أُشير إليه في الأمر الرابع من الأمور الخمسة- عيب مذموم، والعناية فيه بأمر اللفظ أكثر من الاهتمام بالمعنى حتى تجيء بعض العبارات غامضة مبهمة أو قليلة الجدوى عيب آخر أشدّ من الأول وأقبح منه.
وكذلك ما أُشير إليه من الأمر الخامس من التكهّن بالسَّجْع والرَّجْم فيه بالغيب وهو عيب من أشد العيب وأولاه بالذم.
لكن ذلك كلّه ليس بمستحيل أن يجرد منه الكلام، فإنه -كما قلنا- من الصفات العارضة وليس من الذاتيات الملازمة، فالسَّجْع المتكلّف وسجع الكهانة ليس شيء منها مذمومًا من حيث إنه سجع وتنسيق فواصل، وإنما هو مذموم من حيث إنه تكلّف أو إسراف في التكلّف، أو من حيث إنه تكهّن بالتحدّث عن المستقبل والرجم فيه بالغيب، فهو كذب ودخل وغشّ وخداع، وذلك شيء ليس من لوازم تنسيق الكلام ومراعاة التناسب بين فواصله، وإذا كان الأمر كذلك فما الذي يمنع أن يقال: إن القرآن فيه سجع؟
قد يقال هذا، وهو كلام له في ذاته وجهة نظر قوية.
ويمكن الجواب عنه: بأن ما قدمناه من البيان قد يتّضح به سبيل القول ويتجلّى وجه الحكم فيما ينبغي أن يُقال في شأن السجع من جهة وقوعه أو عدم وقوعه في القرآن الكريم.
وذلك أنه قد خلص من ذلك البيان فيما أشير إليه في الأمرين (الرابع والخامس) أن ذمّ ذلك السجع والنعي على ما فيه من عيب ليس لأنه مطلق سجع، وإنما هو لأنه سجع متكلّف أو سجع كهانة.
فإذا كان الشأن الغالب فيما أثر من سجع بعض الخطباء والكتّاب الشغوفين به والمفرطين فيه أنه مفتعل متكلّف، قد عُنوا فيه بأمر اللفظ أكثر مما عنوا بأمر المعنى حتى جاءت بعض العبارات فيه صورًا بغير قلب، وقشورًا بغير لب، فإنه يكون حينئذٍ معيبًا مذمومًا، فإذا نظر إلى هذه الحالة أمكن أن يُقال: إنه ينبغي ألا يطلق اسم السجع على ما يكون في القرآن الكريم من الفواصل المتناسبة؛ تجنبًا للفظ الذي ينبئ عن العيب والذم.
وكذلك ينبغي أن يتجنّب إطلاق لفظ السجع على تلك الفواصل القرآنية من أجل أن الكلمة كثيرًا ما تُطلق على سجع الكهانة الذي لا يخلو من الخداع والتمويه والكذب.
هذا هو الذي نراه مانعًا من إطلاق لفظ السجع على فواصل القرآن الكريم. وليس المانع هو ما تدلّ عليه كلمة السجع من أنه قول متناسب الفواصل، فإن تناسب الفواصل في القرآن حقيقة واقعة وردتْ وتكررتْ في مواطن كثيرة من سوره وآياته.
رأي الباقلاني في المسألة:
القاضي أبو بكر الباقلاني ينكر ورود السّجع في القرآن الكريم، وينعى على من يقول: إنّ القرآن فيه سجع. يشتد في الإنكار حتى يصل به ذلك إلى درجة أنه لا يرى في تناسب الفواصل الذي استفاض أمره في السور والآيات القرآنية أنه مقصود أن يكون تناسب فواصل؛ فهو يقول: إنّ المقصود بذلك إنما هو إظهار وجه من وجوه الإعجاز القرآني من حيث مجيء القصة الواحدة في أساليب مختلفة، يقدم في بعضها من مفردات الجملة ما يؤخّر في بعض آخر، ومع المحافظة على المعنى وعلى قوّة النَّظْم وروعة الأسلوب، وذلك دليل الاقتدار وآية البراعة والبلاغة.
هكذا يقول الباقلاني في (إعجاز القرآن)، وهكذا ينقله السيوطي مبسوطًا في كتاب (الإتقان)، وبهذا يرد على أنصار القول بالسجع في القرآن الكريم، إِذْ قالوا: إنّ الدليل على وقوع السجع في القرآن ما جاءت به الآيات في الحديث عن موسى وهارون، فإنه قد مضى الاتفاق على أن موسى أفضل من أخيه هارون، فإذا اقترنا في الذِّكْر كان الأصل أن يقدم موسى، لكن من أجل مراعاة السجع في بعض الآيات قدم عليه هارون، وذلك في قوله تعالى: ﴿فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى﴾ [طه: 70]، فإن الفواصل في هذه السورة مبنية على الألف.
ثم لما كانت الفواصل في آيات أخرى قد بنيت على الواو والنون، أو الياء والنون قُدّم فيها اسم موسى على هارون، كما في قوله تعالى: ﴿قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ * رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ * قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ [الشعراء: 47-49].
هذا ما قاله أنصار السجع في القرآن، وهو كلام قوي ووجيه.
ونحن نضيف إليه ما يزيده قوة ووجاهة؛ أنه ورد في القرآن عشرات المرات ذكر الأرض مقرونة بالسماء مفردة ومجموعة، وفي هذه المرّات جميعها نجد أن السماء أو السماوات مقدّمة على الأرض في مواضع قليلة جدًّا قد قدم فيها ذِكْر الأرض ويتجلّى في موضعين؛ وذلك من أجل تناسب الفواصل.
فمن ذلك في قوله تعالى: ﴿تَنزِيلًا مِمَّنْ خَلَقَ الأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلى * الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ [طه: 4-5]، فإن فواصل السورة على الألف، ومراعاة للتناسب بين هذه الفواصل قدمت الأرض على السماوات التي وصفت بوصف ﴿الْعُلى﴾ المختوم بالألف.
ولذلك لما انتهى هذا الاقتضاء وجاء الجمع مرة أخرى بين الأرض والسماء في الآية التالية للآيات السابقة مباشرة عاد الاقتران إلى أصله فقدّمت السماوات على الأرض: ﴿لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى﴾.
ومن ذلك أيضًا قوله سبحانه: ﴿رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الأَرْضِ وَلا فِي السَّمَاءِ * الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ﴾ [إبراهيم: 38-39].
فقد قدمت الأرض على السماء في هذه الآية؛ لأنه أريد تناسب الفاصلة فيها مع الفواصل الأخرى المبنية على الهمزة بعد مَدَّة الألف.
ويجيب الباقلاني على هذا بقوله: «وأما ما ذكروه من تقديم موسى على هارون في موضع وتأخيره عنه في موضع آخر لمكان السجع وتساوي مقاطع الكلام فليس بصحيح؛ لأن الفائدة عندنا غير ما ذكروه، وهي أن إعادة القصة الواحدة بألفاظ مختلفة تؤدي معنى واحدًا من الأمر الصعب الذي تظهر فيه الفصاحة، وتتبين فيه البلاغة؛ ولهذا أعيد كثير من القصص في مواضع مختلفة على ترتيبات متفاوتة، تنبيهًا بذلك على عجزهم عن الإتيان بمثله مبتدأ به ومتكررًا». ثم قال: «فعلى هذا يكون المقصد بتقديم بعض الكلمات على بعض وتأخيرها إظهار الإعجاز على الطريقتين جميعًا دون السجع الذي توهّموه».
هذا هو ما أجاب به الباقلاني على ذلك الدليل القوي الذي استدل به أنصار السجع في القرآن.
وغريب جدًّا من الباقلاني أن ينفي أن يكون مقصودًا ذلك السجع أو تناسب الفواصل في الآيات التي قُدِّم فيها اسم موسى على هارون مرة، وأُخِّر عنه مرة أخرى، وأن يجعل ذلك التقديم والتأخير لمحض إظهار الإعجاز بتغيير النَّظْم والأسلوب في الحديث عن القصة الواحدة مع المحافظة على المعنى.
ولماذا تكون إرادة ذلك المعنى الذي يرجع إلى إظهار البلاغة مانعة من أن يكون في تلك الآيات أيضًا سجع أو تناسب فواصل مقصود؟
إنه لا شك في براعة القرآن وقوّته في تنويع الحديث بأساليب مختلفة عن الغرض الواحد والمعنى الواحد.
ولكن لا شك أيضًا في أن الآية التي قدّم فيها اسم هارون على موسى قد قصد فيها القرآن أن تكون على فاصلة الألف تحقيقًا للتناسب بينها وبين بقية الآيات، وأنه في الآية الأخرى التي قدم فيها موسى على هارون قد قصد هذا التقديم مراعاة للتناسب مع الآيات التي بنيت على فاصلة الواو والنون، مع كون ذلك هو الأصل أيضًا.
هذا شيء لا ينبغي إنكاره، وإذا كان الأمر كذلك فليس هناك ما يمنع القول بأن تلك الآيات فيها سجع أو فيها تناسب فواصل، مع إفادة ذلك المعنى الذي هو إظهار البلاغة، وذلك على خلاف ما ذهب إليه الباقلاني من إفراد هذ المعنى وجعله هو المقصود وحده بالتقديم والتأخير في تلك الآيات.
لا، بل نحن نستطيع أن نقول: إنّ ذلك التقديم والتأخير قد قصد به السجع وتناسب التقديم والتأخير قد قصد به السجع وتناسب الفواصل وحده، أما إظهار البلاغة والبراعة بتنويع الحديث عن المعنى الواحد فهو فيما وراء ذلك؛ فإن هذا التنويع كان يمكن أن يكون بالتقديم والتأخير في اسمي هارون وموسى على غير الوجه الذي وردت به الآيات؛ وذلك بأن يقدم هارون على موسى في آية الشعراء حيث فواصل الآيات مختومة بالواو والنون، ويقدّم موسى على هارون في آية طه حيث الفواصل مختومة بالألف.
فالتنويع الذي يقول الباقلاني إنه مظهر البلاغة كان يتحقّق بهذا الوجه من التقديم والتأخير، ولكن كان يفوت به حسن المقاطع وجمال الأسلوب، فالتقديم والتأخير الذي وردت عليه الآيات القرآنية هو الذي يحقّق ذلك الحسن، ويمكّن للأسلوب جماله وروعته.
وإذًا يكون السجع وحده أو تناسب الفواصل وحده -على اختلاف التعبير- هو المقصود بذلك التقديم والتأخير في آيات هارون وموسى، وكذا في آيات الأرض والسماء.
ولذلك نجده موقفًا غريبًا الذي يقفه القاضي الباقلاني في مسألة السجع أو تناسب الفواصل في القرآن الكريم.
فبماذا يفسر موقفه هذا الذي ينكر به إنكارًا شديدًا أن يكون في القرآن سجع أو تناسب فواصل؟
نظن -وليس كلّ الظنّ من الإثم- أن سبب ذلك هو الارتباط المذهبي، وشدة التعلّق والاستمساك بما يحكى في المسألة أنه مذهب الشيخ أبي الحسن الأشعري.
نعم، فقد نقل عن الشيخ -ورواه الباقلاني في كتابه (إعجاز القرآن)- أنه يقول بنفي السجع في القرآن الكريم. وأنه صرّح بذلك في عدّة مواضع من كتبه. ومن هنا أريد لهذه المسألة أن تحتل مكانًا بين المسائل التي اشتد فيها الخلاف بين الأشاعرة وغيرهم من مسائل العقائد وفلسفة الإلهيات.
والمطالِع لكلمات هؤلاء الأشاعرة التي ينفون بها وقوع السجع في القرآن الكريم إذا غفل قليلًا عن أن هذا السجع هو موضوع الحديث فإنه لا يرى إلا أنه في جو مسألة أخرى غير مسألة السجع؛ هي مسألة (خلق القرآن) وما جرى فيها من الخلاف القديم الذي كان شؤمًا على فريق من الناس، وفتنة لآخرين.
وليس في هذا الذي نقوله شيء من المبالغة، فهذا بعض ما يقولونه في تلك الكلمات. هل يجوز استعمال السجع في القرآن؟ خلاف، والجمهور على المنع؛ لأن أصله من سجع الطير فَشَرُفَ القرآن عن أن يستعار لشيء منه لفظ أصله مهمل؛ ولأجل تشريفه من مشاركة غيره من الكلام الحادث في وصفه بذلك، ولأن القرآن من صفاته تعالى فلا يجوز وصفه بصفة لم يرد الإذن بها. هذه كلماتهم بنصِّها ليست في حاجة إلى شرح أو تعليق، غير أنّنا نقول: إنها لم تسعد بالانتصار أو الغلبة حتى في أصل موطنها، وهو موضوع (خلق القرآن).
ثم إنّنا لا ندري لماذا تكون مسألة السجع في القرآن محلّ خلاف بين العلماء؟
شيء من إحكام النظر في الأمور ذاتها وتفهمها على حقيقتها، مع الإنصاف في القول والاعتدال فيه كفيل بأن يكشف كلّ شبهة، ويزيح كلّ لبس، ولا يسمح في مثل هذه المسألة أن يقع فيها أدنى خلاف.
إنّ السجع إذا كان مقصودًا لذاته، وكان متكلّفًا عسرًا يأتي فيه النظر إلى المعنى وراء الاهتمام باللفظ، فإنه يكون سجعًا مذمومًا مكروهًا، ومحال أن يقع مثله في كلام الله العليم الحكيم، وحينئذٍ لا يسع أحدًا أن يجيز القول به في الكتاب العزيز.
أما إذا كان سهلًا ليِّنًا مطاوعًا، يقصد إليه مع تمام المعنى واتقافه وإحكام روابطه واستكمال مقتضيات البلاغة فيه فإنه يكون سجعًا رائعًا وحسنًا جميلًا لا ينبغي لأحد أن يجادل في حسنه وروعته، وهذا هو سجع القرآن.
فسجع القرآن وتناسب فواصله مبرأ من التكلّف والعسر، ومبرأ من أن يكون مقصودًا لذاته بحيث يكون الاهتمام به أعظم من الاهتمام بالمعنى؛ ولذلك لا يُسار إليه في القرآن من طريق إرادة معنى بعيد الاحتمال، أو معنى يكون غيره أقرب منه وأولى بالمقام، ومحال أن تستخدم في سبيله ألفاظ جوفاء أو ألفاظ ملتوية لا تستقيم في دلالتها على المعنى المراد.
وإذا كان الأمر كذلك فمن الذي ينكر أن يكون مثل هذا السجع مما يقع في الكتاب العزيز؟
هذا، والقرآن الكريم قد يحدّث عن المغيبات ويخبر بالمكنونات التي لا سبيل أن يصل إلى علمها أحد من الناس، ويكون مدًّا في آيات وفقرات مسجوعة وغير مسجوعة، ثم إنه في حديثه وجميع إخباراته لا يقول إلا الحقّ ولا يخبر إلا بالصدق، وهذا أمر يجب اعتقاده والإذعان له والتسليم به، ولا يكون مؤمنًا من يشك فيه أو في شيء منه.
أما سجع الكهانة فهو السجع المذموم لما يقوم عليه من الغش والكذب والخداع، وهو رجم بالغيب الذي اختص الله به ولا يطلع عليه أحدًا إلا من ارتضى من رسله.
وهذا هو السجع الذي ذمَّه الرسول -صلى الله عليه وسلم- وعاب على من تشبَّه بأهله. وقال لمن سجع له: (أسجعًا كسجع الكهان؟!)، أو (أسجاعة كسجاعة الجاهلية؟!). أنكر الرسول -صلى الله عليه وسلم- بذلك على من عارض حكم الإسلام في وجوب الدية على عاقلة امرأة اعتدت على أخرى كانت حاملًا فألقت جنينًا ميتًا، إِذْ قال ذلك الساجع: «كيفَ أغْرَمُ ما لا أكَلَ ولَا شَرِبَ، ولَا نَطَقَ ولَا اسْتَهَلَّ، ومِثْلُ ذلكَ يُطَلُّ؟!».
فالرسول -عليه الصلاة والسلام- لم يذم السجع بإطلاق، وإنما ذم منه ما يكون على طريقة الكهان وأهل الجاهلية، فإنه -صلى الله عليه وسلم- قد أتى في بعض أقواله بالسجع القوي المستملح إذ قال: (أيها الناس، أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصِلُوا الأرحام، وصلّوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام).
أفبعد هذا يصح أن يكون في مسألة وقوع السجع في القرآن خلاف بين أشاعرة وغير أشاعرة؟!
إنه إذا كان الذين ينسب إليهم إنكار السجع في القرآن قصارى ما عندهم أنهم يتحرّجون من إطلاق لفظ السجع على ما يكون في القرآن من تناسب فواصل من أجل أن الكلمة تستعمل أحيانًا كثيرة أو قليلة في السَّجْع المستكره المتكلّف أو سجع الكهنة الكذّابين المخادعين، فقد هاب الخطب ولان الصعب، وأصبحت مسألة السجع في القرآن لا يعدو الخلاف فيها أن يكون خلافًا لفظيًّا أي قائمًا على اختيار لفظ بدل لفظ آخر وكفى الله المؤمنين القتال.
تناسب الفواصل في القرآن الكريم وبيان أنواعه:
تناسب الفواصل في القرآن الكريم يأتي على وجوه كثيرة، أهمها ما يلي:
1- يكون بإحدى هيئتين للجملة الواحدة أي بالتقديم والتأخير في بعض كلماتها من غير أن يزاد عليها شيء أو ينقص منها شيء، فيتحقّق التناسب المطلوب بإحدى الصورتين وترجح بذلك على الصور الأخرى، وذلك كما في قوله تعالى: ﴿قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يَا مُوسَى﴾ [طه: 49]، فإنه يمكن -لأداء أصل المعنى- أن يقال: «قال يا موسى فمن ربكما»، كما قيل في آية أخرى: ﴿قَالَ يَا مُوسَى أَتُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالأَمْسِ﴾ [القصص: 19].
لكنه اختير النَّظْم الذي جاءت عليه الآية -مع تساوي النظمين في أداء أصل المعنى- لأنه هو الذي يكون به تناسب الفواصل المطلوب في ذلك المقام، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا * فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا﴾ [الشمس: 7-8]، فإن قوله سبحانه: ﴿فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا﴾ يمكن أن تؤدي معناه بأن يقال: «فألهمها تقواها وفجورها»، لكن قد رجح النَّظْم الذي جاءت عليه الآية لأنه هو الذي يتحقّق به المقصود من التناسب، وفي ذلك يقول الجلال: «وأخَّر التقوى رعاية لرؤوس الآي». ومن هذا القبيل أيضًا قوله تعالى: ﴿وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا﴾ [مريم: 51]، وقوله -عَزَّ وَجَل-: ﴿وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا﴾ [مريم: 54]، وذلك أن الرسالة أخصّ من النبوّة، والمعهود في الكلام المرسل الذي يجمع فيه بين عام وخاصّ أن يقدّم الأول على الثاني، لكنه قدم في هاتين الآيتين الخاصّ على العام مراعاةً لتناسب الفواصل مع اتحاد المعنى؛ فإنّ السورة بنيت على فاصلة الياء المشددة التي بعدها ألف: سويًّا، مليًّا، حفيًّا، عليًّا، نجيًّا، وهكذا.
2- ويكون بالاختصار في الجملة بحذف جزء معلوم حقّ العلم من المقام، كما في قوله تعالى: ﴿قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى﴾ [طه: 50]، فإنه إذا كان الأصل عدم الحذف وأن يقال: «قال ربنا الذي أعطى كلّ شيء خلقه ثم هداه»، فإن المعنى لا يختلف بما جاءت عليه الآية، ثم يرجح نظمها بأنه هو الذي يتحقّق به التناسب المطلوب.
ومثل ذلك قوله تعالى: ﴿وَالضُّحَى * وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى * مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى﴾ [الضحى: 1-3]، وقوله سبحانه: ﴿أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى * وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى * وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى﴾ [الضحى: 6-8]، فإن الأصل قبل الحذف هكذا: «ما ودعك ربك وما قلاك»، «ألم يجدك يتيمًا فآواك، ووجدك ضالًّا فهداك، ووجدك عائلًا فأغناك».
لكنه حذف المفعول تحقيقًا لتناسب الفواصل المطلوب مع تساوي الطريقتين: (الذكر والحذف) في الدلالة على المعنى الأصلي المقصود.
3- ويكون التناسب بإيثار إحدى صيغتين للفظ مع تساوي الصيغتين في الدلالة على المعنى المراد، كما في قوله تعالى: ﴿مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ﴾ [القمر: 8]. فإنه كان يمكن أن يقال: «هذا يوم عسير» بدل ﴿عَسِرٌ﴾، وهو بمعناه من غير فرق، وقد جاء كذلك في آيات أخرى مثل قوله تعالى: ﴿فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ * عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ﴾ [المدثر: 9-10] إذ كان يتحقّق التناسب هناك بين الفواصل بالصيغة الثانية (عسير)، وقوله سبحانه: ﴿وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا﴾ [الفرقان: 26]؛ لأن ذلك يتطلبه التناسب المقصود في هذه السورة أيضًا.
ومن ذلك قوله تعالى: ﴿وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا﴾ [المزمل: 8]، فإن ﴿تَبْتِيلًا﴾ وضعت موضع تبتلًا وقد أُوثرت عليها؛ لأنّ بها يتحقق تناسب الفواصل.
وفي هذا يقول الإمام الزمخشري في (الكشاف): «﴿وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ﴾ وانقطع إليه». ثم قال: «فإن قلت: كيف قيل: ﴿تَبْتِيلًا﴾ مكان تبتلًا؟ قلت: لأن معنى (تبتَّل) بتَلْ نفسك، فجيء به على معناه مراعاة للفواصل».
هذا وقد قال بعض العلماء: إنّ من ذلك قوله تعالى: ﴿كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ﴾ [القمر: 9]، قالوا: إنه قد غيَّر فيه الصوغ لتحقيق التناسب بين الفواصل؛ فإن المعنى -على ما قال أولئك العلماء- أن قوم نوح كذبوه وقالوا: إنه مجنون وازدجروه؛ أي أهانوه وشتموه وتوعدوه، ولكن قيل في الآية: ﴿وَازْدُجِرَ﴾ بالبناء للمجهول لأنه هو الذي يكون به التناسب مع دلالة المقام على الفاعل المطوى.
هكذا قالوا، ولكن هذا ليس هو المعنى الذي ينبغي أن تُحْمل عليه الآية، فإن الراجح أن الازدجار ليس من فعل قوم نوح الذين كذبوه وكفروا به، وإنما هو مما تفعله الجنّ بالمجنون، فإن قوم نوح قد رموه بالجنون الشديد، وقالوا في ذلك: إنه مجنون وازدجرته الجنّ وتخبطته وذهبت بعقله وطارت بلُبِّه.
ولا شك أن هذا المعنى أرجح في ذاته مما قاله أولئك العلماء؛ فإنّ تخبط المجنون واضطراب نفسه واختلال عقله هو مما عُهد أن يسند إلى الشيطان ويضاف إلى فعله، كما قال تعالى: ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ﴾ [البقرة: 275].
وفوق أنه المعنى الراجح من حيث ذاته هو الذي تستقيم عليه بوضوح صيغة المعنى للمفعول (ازدُجر) ثم يتحقّق بها معه تناسب الفواصل من غير حاجة إلى أن يُقال: إن الصيغة قد حُوِّلَت من المعلوم إلى المجهول لتحقيق ذلك التناسب؛ فإنّ الصيغة قد وقعت موقعها واشتهرت في الدلالة على معناه مبنية للمجهول، وإنه لمعهود أن يُقال: «رجل ممسوس، ورجل مصروع ومخبول» على معنى أنه مسَّته الشياطين وصرعته وخبلته، فإذا قيل: «مجنون وازدجر» كان معناه ازدجرته الشياطين، ولا يحتاج في ذلك إلى التصريح بالفاعل، ولأنه متعين معلوم.
وبهذا يُعلم أن القرآن لا ينظر إلى تحصيل اللفظ قبل ما ينظر إلى إتقان المعنى.
ولا يصح أن يُفهم أن قد يسير إلى تحقيق تناسب الفواصل من طريق معنى بعيد أو معنى غيره أقرب منه.
كذلك لا يصح أن يُفهم أن القرآن قد يعدل -في سبيل تحقيق التناسب بين الفواصل- عن اللفظ الصريح المعهود في الدلالة على معناه إلى لفظ غير صريح أو غير معهود كذلك، فإن ذلك يكون تغليبًا لرعاية الألفاظ على رعاية المعاني على حين أن رعاية المعاني هي التي يجب -كما قلنا- أن يكون لها في أسلوب القرآن الكريم المقام الأول.
قد يقال: إنّ هذ التقرير يعترضه ما جاءت عليه بعض الآيات القرآنية من مثل قوله تعالى: ﴿وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ﴾ [القمر: 13] فإن المراد به -من غير شك- الإخبار بأن الله تعالى قد امتن على نوح -عليه السلام- فحمله على سفينة نجّاه بها من الغرق، وأنقذه من ذلك الطوفان.
ولا شك أيضًا أن لفظ (سفينة) وهو اللفظ الصريح والمعهود القريب في الدلالة على المعنى المراد، وهو اللفظ الموضوع لهذا المعنى في اللغة، وقد استعمله القرآن في هذا المعنى في قصة نوح ذاتها في قوله: ﴿فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ﴾ [العنكبوت: 15]، وكذلك لفظ (الفلك) لفظ صريح وموضوع في اللغة لهذا المعنى ومعهود استعماله فيه، وقد جاء في القرآن في عدة مواضع في قصة نوح أيضًا مستعملًا في ذلك المعنى، قال تعالى: ﴿وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ﴾ [هود: 37]، ﴿وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ﴾ [هود: 38]، ﴿فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا﴾ [المؤمنون: 27]، ﴿فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ [المؤمنون: 28].
ثم إنّ كلا اللفظين: (سفينة وفلك) كلمة واحدة هي بالضرورة أخصر وأوضح دلالة من الوصف بعبارة مركبة من ألفاظ ثلاثة ﴿ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ﴾.
فالعدول عن اللفظ الواحد المعهود والمعين للمعنى بوضع اللغة إلى الوصف ذي الألفاظ الثلاثة قد يظنّ أن فيه تغليبًا للاعتبارات اللفظية على الاعتبارات المعنوية، وأنه قصد بذلك مجرد تحقيق التناسب بين الفواصل.
والجواب: أنه لا يصح أن يُظَنّ في القرآن الكريم أنه قد يُغلِّب الناحية اللفظية على الناحية المعنوية، وأنه اختار التعبير عن المعنى المراد بوصف ذي ألفاظ ثلاثة بدلًا من اللفظ الواحد الصريح، وأنه فعل ذلك لتحقيق التناسب اللفظي بين الفواصل، لا يصح أن يُظَنّ ذلك؛ فإن اختياره التعبير بالوصف ذي الألفاظ الثلاثة قد أُريد به الإشارة إلى ناحية معنوية جديرة أن يلتفت إليها وأن تقدر قدرها في الحديث عن امتنان الله تعالى على نوح -عليه السلام-، وتفضله عليه بهدايته إلى صناعة الفلك، فصنعه تحت عين الله وعنايته. وكان ذلك هو الوسيلة الوحيدة لنجاته ونجاة من آمن به من قومه من ذلك الطوفان العظيم الذي عمَّ وطمَّ وقضى على جميع القوم.
فقوله تعالى: ﴿وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ﴾ ليس اختياره ليحقق به تناسب الفواصل، وإنما هو لذلك الأمر المعنوي ذي الشأن الكبير، وذلك هو بيان أن نجاة رسول الله نوح -عليه السلام- ومن معه من طغيان الطوفان كانت بقوة الله وقدرته وعظيم عنايته؛ إِذْ حمله على ﴿ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ﴾، ألواح خشبية مربوطة بدُسُر؛ أي بخيوط من ليف أو نحوه، أو موصول بعضها ببعض بمسامير، وسواء أكان هذا أم ذاك فتلك الألواح الخشبية المربوطة بخيوط أو المسمرة بمسامير كانت لذلك في غاية الضعف وما كانت في ذاتها لتقوى على قطع الأمواج الهائجة، والتغلّب على أهوالها وشدائدها العاتية القاسية، لكن عناية الله هي التي خلقت من ذلك الضعف قوّة، وجعلت تلك الأداة الهيّنة الضعيفة تنفذ في تلك الأمواج وتتغلب على تلك الأهوال، وتصل بنوح -عليه السلام- إلى شاطئ الأمان.
وهذا المعنى لا يظهره التعبير بلفظ (فلك) أو (سفينة) وإنما يُجلّيه تمام التجلية ما جاءت به الآية: ﴿وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ﴾.
وقد أشار الفخر الرازي إلى ذلك فقال قوله سبحانه: ﴿وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ * تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا﴾ ما نصّه: «أي حذف الموصوف وأقام الصفة مقامه إشارة إلى أنها كانت من ألواح مركبة موثقة بدسر، وكان انفكاكها في غاية السهولة، ولم يقع، فهو بفضل الله».
ومن هذا يتبيّن أن التعبير في هذه الآية عن السفينة والفلك بالوصف ذي الألفاظ الثلاثة قد اقتضاه النظر إلى هذا المعنى، وليس لمجرد مراعاة التناسب بين الفواصل، ثم يأتي التناسب بين الفواصل مرادًا حتمًا ومقصودًا قطعًا، ولكن في المرتبة الثانية بعد مراعاة ما يقتضيه المعنى كما بينَّا.
آية ثانية:
آية ثانية قد يعترض بها على ما قرّرناه من أن القرآن لا ينظر إلى اللفظ قبل أن ينظر إلى المعنى، وأنه لا يستعمل لفظًا بعيد الدلالة على المعنى المقصود ويرجّحه على اللفظ قريب الدلالة على ذلك المعنى من أجل الوصول إلى تحقيق التناسب بين الفواصل، هذه الآية هي قوله تعالى: ﴿فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ﴾ [عبس: 12].
وذلك أن الزمخشري في (الكشاف) قد جعل الضمير المنصوب في هذه الآية راجعًا إلى ﴿تَذْكِرَةٌ﴾ في قوله سبحانه في الآية السابقة: ﴿كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ﴾ [عبس: 11]، ثم أراد أن يسوغ عود الضمير المذكّر إلى ذلك المرجع المؤنث فقال: «وذكر الضمير لأن التذكرة في معنى الذِّكر والوعظ». ومعنى هذا أن القرآن قد عدل عن الضمير المؤنث الذي مرجعه مؤنث إلى الضمير المذكر بذلك الضرب من التأويل؛ ليتحقّق تناسب الفواصل في هذه الآيات: ﴿فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ * فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ * مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ * بِأَيْدِي سَفَرَةٍ * كِرَامٍ بَرَرَةٍ * قُتِلَ الإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ * مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ﴾ [عبس: 12-18]. وهكذا إلى آيات أخرى متناسبة الفواصل مع هذه الآيات.
وعلى هذا يكون القرآن قد رجَّح النظر إلى اللفظ على النظر إلى المعنى، فإنه لو كان قد راعى المعنى ولم يرجح مراعاة اللفظ عليه لقال: «كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكرها في صحف مكرمة»، وإذًا يفوت تناسب الفواصل المطلوب.
والجواب: أن هذا الاعتراض لا يتم إلا بالبناء على الزمخشري الذي يجعل الضمير في الآية ﴿فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ﴾ [عبس: 12] راجعًا إلى ﴿تَذْكِرَةٌ﴾ في الآية السابقة وهو رأي ليس بمتعين أن يؤخَذ به، بل هناك ما هو أجود منه، وهو ما أشار إليه الجلال المحلِّي إِذْ يقول في تفسير الآية ﴿فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ﴾: «إن المعنى حفظ ذلك فاتعظ به»، فهو يجعل الضمير عائدًا على ما ذكر هو (ذلك) المذكور.
وأصرح من هذا أن يُقال: إن الضمير عائد على القرآن، وهو إن لم يَجْرِ له ذِكْر في هذا المقام فهو معهود معلوم على كلّ حال.
ويؤيّد هذا ما جاءت به الآيات التالية في قوله تعالى: ﴿فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ * مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ * بِأَيْدِي سَفَرَةٍ * كِرَامٍ بَرَرَةٍ﴾ فإن المعهود المعروف أنّ هذه أوصاف للقرآن الكريم.
النتيجة أنه لا يكون في الآية وضع ضمير المذكّر موضع ضمير المؤنث ليُقال: إن ذلك قد اختير لأنه يحقق تناسب الفواصل.
آية ثالثة:
وآية ثالثة، قوله تعالى: ﴿قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ﴾ [الشعراء: 136].
تحكي هذه الآية مقالة قوم عاد التي واجهوا بها رسولهم هودًا -عليه السلام- لما أمرهم بتقوى الله ودعاهم إلى الإيمان بالله وحده ونبذ الشركاء، ووعظهم وحذّرهم من سوء عاقبة العناد والكفر، وقال لهم: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ * وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ * أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ * وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ * إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ [الشعراء: 131-135] فقالوا له: ﴿سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ﴾ [الشعراء: 136] أي لا تظنّ أن يكون لما تقول تأثير على نفوسنا، ولا تطمع أن نترك ما نحن عليه إلى ذلك الذي تدعونا إليه.
وهنا يُقال: إنّ الأصل في المقابلة أن تكون هكذا: «قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تعظ» فإن عبارة «أم لم تعظ» هي العبارة القريبة المختصرة الدالة بوضوح على نفس المعنى الذي أُريد بالمقابل الوارد في الآية الكريمة وهو ﴿أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ﴾ مع ما فيه من الطول ومخالفة الأصل في التعبير، فعدول الآية عن المقابل الأصلي القريب المختصر إلى ما جاءت به لا يظهر له وجه إلا أن يكون هو مراعاة التناسب بين الفواصل.
والجواب: أن المقابل الذي وردت به الآية قد تحقّق به تناسب الفواصل من غير شك، ولكن هذا التناسب لم يقصد إليه من طريق مخالفة الظاهر والعدول عن اللفظ الأصلي القريب المختصر إلى خلافه مع اتحاد معنى اللفظين كما يظنّ خطأ؛ فإن المعنى ليس واحدًا فيهما.
ذلك أن قوم هود -عليه السلام- أرادوا أن يقطعوا كلّ أمل له في قبولهم دعوته، فقالوا: إنه يستوي عندهم أن يعظهم وأن يكون من غير الواعظين، أي وأن يكون غير أهل للوعظ أصلًا. وهذا أبلغ في الإقناط والإيئاس من ذلك المقابل المختصر، وأن يقال: «وعظت أم لم تعظ».
وقد نبَّه الزمخشري في (الكشاف) إلى هذا المعنى إذ يقول: «فإن قلت: لو قيل: أوعظت أم لم تعظ كان أخصر والمعنى واحد. قلت: ليس المعنى بواحد، وبينهما فرق؛ لأن المراد: سواء علينا أفعلت هذا الفعل الذي هو الوعظ أم لم تكن أصلًا من أهله ومباشرته، فهو أبلغ في قلّة اعتدادهم بوعظه من قولك: (أم لم تعظ)»[2].
4- وما قلناه في تلك الآية من سورة الشعراء يُقال في نظائر لها من مثل قوله تعالى: ﴿قَالَ سَنَنظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ﴾ [النمل: 27].
فإنه إذا كان مقتضى الظاهر في المقابلة أن يقال: (سننظر أصدقت أم لم تصدق) أو (أصدقت أم كذبت) فقد عدل عنه إلى ما وردت به الآية، وهو يدل على معنى أقوى من ذلك وأبلغ، فإن المراد بيان أن الهدهد لا يجرؤ على الكذب على سليمان -عليه السلام- فيما يخبر به عن ملكة سبأ، إلا إذا كان الكذب ديدنًا له متأصلًا فيه، وهذا المعنى هو الذي يفيده الصوغ الذي جاءت به الآية الكريمة: ﴿قَالَ سَنَنظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ﴾، ثم هو الذي يتحقق به في المرتبة الثانية تناسب الفواصل.
وفي هذا يقول الزمخشري: «وأراد بقوله ﴿أَصَدَقْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ﴾ أصدقت أم كذبت إلا إن ﴿كُنتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ﴾ فهو أبلغ؛ لأنه إذا كان معروفًا بالانخراط في سلك الكاذبين كان كاذبًا لا محالة، وإذا كان كاذبًا اتُّهم بالكذب فيما أخبر به، فلم يوثق به»[3].
5- ومن النظائر التي خُولف فيها مقتضى الظاهر لمراعاة أمر معنوي أقوى منه، ولم تكن المخالفة فيه لمجرّد السجع ومراعاة الفواصل كما يتوهّم، قوله تعالى: ﴿إِنْ نَشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ﴾ [الشعراء: 4] ذلك أنه لو قيل: إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلّوا لها خاضعين. لما كان هناك محلّ لسؤال ولا جواب، لكن الآية قد وسطت الأعناق في الحديث وأسندت إليها الخضوع؛ لأن الخضوع له آثار تظهر في الأعناق كالتطامن والانحناء، كما تظهر فيها أيضًا آثار القوّة والنشاط، ومن ذلك ما قيل: (وسالت بأعناق المطيّ الأباطح). وهنا يُقال: إذا كان الأمر كذلك فلماذا لم يقل: (فظلت أعناقهم لها خاضعة) مع أن هذا هو الأصل والظاهر؟ أليس العدول عنه إلى صيغة (خاضعين) يكون من أجل السجع ومراعاة الفواصل؟ وحينئذ يحقّ لمدعٍ أن يقول: إن القرآن قد يعمد إلى السجع ولو من طريق بعيد أو طريق غيره أقرب منه.
والجواب: أن إيثار صيغة خاضعين -وهي جمع السلامة للعقلاء- ليس لتحقيق السجع، وإنما حكمته أن الأعناق لما وصفت بالخضوع الذي هو خاص بالعقلاء صح أن يجري عليها من أجل ذلك أحكام العقلاء فجمعت جموعهم؛ وذلك كما في قوله تعالى: ﴿إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ﴾ [يوسف: 4].
أما مراعاة السجع وتناسب الفواصل فقد أتت في المرتبة الثانية، وليست هي التي من أجلها كان العدول عن (خاضعة) إلى ﴿خَاضِعِينَ﴾.
نقد وتحليل:
قد نقل الجلال السيوطي في كتابه (الإتقان) عن الشيخ شمس الدين بن الصائغ الحنفي أنه جمع في كتابه (إحكام الرأي في أحكام الآي) نحو أربعين وجهًا لتناسب الفواصل في القرآن الكريم وقد أوردها السيوطي في كتابه مع أمثلتها. ورأينا في هذه الوجوه أن كثيرًا منها لا يرجع السبب الأصلي في مجيئه على النحو الذي جاء عليه إلى إرادة تحقيق التناسب بين الفواصل، وإنما سبب ذلك هو النظر إلى المعنى وتحقيق ما يقتضيه من مراعاة الاعتبارات البلاغية المختلفة ثم يجيء تناسب الفواصل في المرتبة الثانية.
1. ومن أمثلة ذلك ما قال في الوجه الأول، وهو تقديم المعمول على العامل نحو قوله تعالى: ﴿أَهَؤُلاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ﴾ [سبأ: 40]، وقوله سبحانه: ﴿وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ [الفاتحة: 5] فإنه جعل تقديم المعمول في ذلك على العامل من أجل تحقيق التناسب بين الفواصل.
ولكننا نرى أن تقديم المعمول في الآية الأولى لا ينظر إليه من أول الأمر على أنه من أجل تناسب الفواصل، وإنما ذلك لأمر معنوي هو الاهتمام بشأن المقدم وبيان أن محط الإنكار هو توجيه العبادة إلى الملائكة، أما تناسب الفواصل فإنه يأتي في المرتبة الثانية.
وأما قوله سبحانه: ﴿وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ فإنّ المقرّر والمعروف فيه أن تقديم المعمول فيه على العامل إنما هو لإفادة قصر الاستعانة على الله -سبحانه وتعالى-، فهو لتحقيق أمر معنوي قبل أن يكون لتناسب الفواصل الذي هو تحسين لفظي.
2. ومن الأمثلة قوله في (الخامس) من تلك الوجوه، وهو تقديم الصفة الجملة على الصفة المفردة في قوله تعالى: ﴿وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا﴾ [الإسراء: 13]، فإن ذلك مبني على أن ﴿مَنشُورًا﴾ صفة ثانية للكتاب وأن الأصل في الصفة المفردة أن تتقدّم على الصفة الجملة، لكنها في الآية قد أخرت عنها من أجل تناسب الفواصل.
ولكنَّا نقول: إنّ أحسن الوجهين في الإعراب وأجودهما من حيث المعنى هو أن ﴿مَنشُورًا﴾ حال من الضمير المنصوب في ﴿يَلْقَاهُ﴾، وذلك أنه لو كان صفة ثانية للكتاب كما قيل، وهي صفة مفردة شأنها أن تقدم على الصفة الجملة، لأمكن أن يُقال في غير التلاوة: (ونخرج له يوم القيامة كتابًا منشورًا يلقاه)، ولا شك أن مجيء وصف ﴿يَلْقَاهُ﴾ هكذا في آخر الكلام يورث النَّظْم هبوطًا ويضعف معناه، وذلك ما لا يليق أن يفهم في القرآن الكريم، لكن النظر الذي جاءت به الآية الكريمة يفيد أن الإنسان حينما يعطى في الآخرة كتاب أعماله يعطاه منشورًا أو يجده منشورًا غير مطويّ، فتواجهه منه أعماله المسطرة فيه فيعرفها من غير عناء ولا تعب.
فالملحوظ في هذا أولًا هو إحكام المعنى وإتقانه ومجيئه على ما تقتضيه الاعتبارات البلاغية، ثم يأتي الاعتبار اللفظي الذي يرجع إلى تناسب الفواصل.
3. ومن ذلك قوله في الوجه (العشرين) وهو الاستغناء بالإفراد عن التثنية في قوله تعالى: ﴿فَلا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى﴾ [طه: 117]: ومعنى هذا أنه يريد أن يقول: إن الأصل هو (فتشقيا) ولكن قيل: ﴿فَتَشْقَى﴾ لتناسب الفواصل.
ولكن أجود الرأي في هذا هو ما قاله أعلام المفسرين: أن الإفراد في قوله سبحانه: ﴿فَتَشْقَى﴾ إنما هو للدلالة على أن آدم هو الأصل فيما يجري عليه من الشقاء بسبب خروجه من الجنة، ثم يثبت ذلك لغيره بطريق التبعية، وإن من الشقاء أيضًا ما يرجع إلى تحمل المتاعب في تحصيل ضرورات المعيشة، والرجال هم الأصل في ذلك لأن هذه هي أهم وظائفهم في الحياة.
فهذا هو سِرّ إفراد الضمير في الآية، ثم يجيء الاعتبار اللفظي الذي يرجع إلى تحسين الصورة أو تفخيمها بمراعاة تناسب الفواصل.
4. ومنها قوله في الوجه (التاسع والثلاثين) وهو العدول عن صيغة المُضِي إلى صيغة الاستقبال في نحو قوله تعالى: ﴿فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ﴾ [البقرة: 87] قال: والأصل: (قتلتم).
ومن العجيب أن يحصر المؤلِّف نظره في الزاوية الضيقة، ولا يتجه ببصيرته إلى الأفق الواسع الذي تتجلى فيه روائع الأسلوب القرآني وفخامته وأسرار بلاغته.
إنّ التعبير بالمضارع في ختام هذه الآية له سِرُّه وحكمته التي ترجع إلى الإخبار بالأمر على ما كانت عليه حقيقته الواقعية، أو تقرير ما أُريد به على حسب ما تقتضيه أصول البلاغة القرآنية.
أما الأول فالملحوظ فيه أن اليهود قد وقع منهم في الماضي قتل أنبيائهم، ثم إن طبيعة الشر الغالبة عليهم قد ورثها من بعدهم أبناؤهم، فكان المعاصرون منهم لرسول الإسلام -عليه الصلاة والسلام- يكيدون له ويدبرون للفتك به، وأصدق شاهد على ذلك قوله -عليه الصلاة والسلام- وهو في مرض موته: (ما زالتْ أكْلَةُ خيبرَ تعادُنِي كلَّ عامٍ، حَتَّى كَان هَذَا أوانُ قطْعِ أَبْهَرِي)، وفي رواية: (تُعَاودُنِي).
فاليهود قتلوا الأنبياء والرسل في الماضي، واليهود كانوا يعملون على قتل محمد -صلى الله عليه وسلم- فيما بعد ذلك، والعبارة التي تستقيم للدلالة على الأمرين: (الماضي وما يراد في المستقبل) هي صيغة الاستقبال.
وأما الأمر الثاني -وهو ما يرجع إلى المعنى البلاغي الذي هو في أعلى مستويات البلاغة- فهو أن التعبير بالمضارع قد أُريد به استحضار الصورة الفظيعة التي كانت من اليهود حال ارتكابهم جرائم قتلهم أنبياءهم وتصوير هذه الحالة البشعة في النفوس لتدرك مدى تلك الجرائم اليهودية الشنيعة. وهذا الاستحضار لا ينال بالتعبير بالماضي، وإنما سبيله المضارع.
ومن ذلك قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الأَرْضُ مُخْضَرَّةً﴾ [الحج: 63]؛ فقد أريد بهذا استحضار الحالة البديعة الجميلة؛ حالة اخضرار الأرض بالنبات على فور نزول المطر من السماء، وتصوير هذه الحالة في النفوس أحسن تصوير.
أما بعد، فإننا قصدنا بإيراد هذه الأمور الأربعة مجرّد التمثيل، ولم نرد الحصر والاستقصاء، فإن كثيرًا غير هذه الأربعة لا يسلم فيه ما يريده مؤلِّف كتاب (إحكام الرأي في أحكام الآي). والله أعلم.
كلمات مفتاحية
الكاتب:

عبد الرحمن تاج
شيخ الأزهر الأسبق، وعضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، ومجمع اللغة العربية بالقاهرة
مواضيع ذات صلة
((المعلومات والآراء المقدَّمة هي للكتّاب، ولا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع أو أسرة مركز تفسير))









