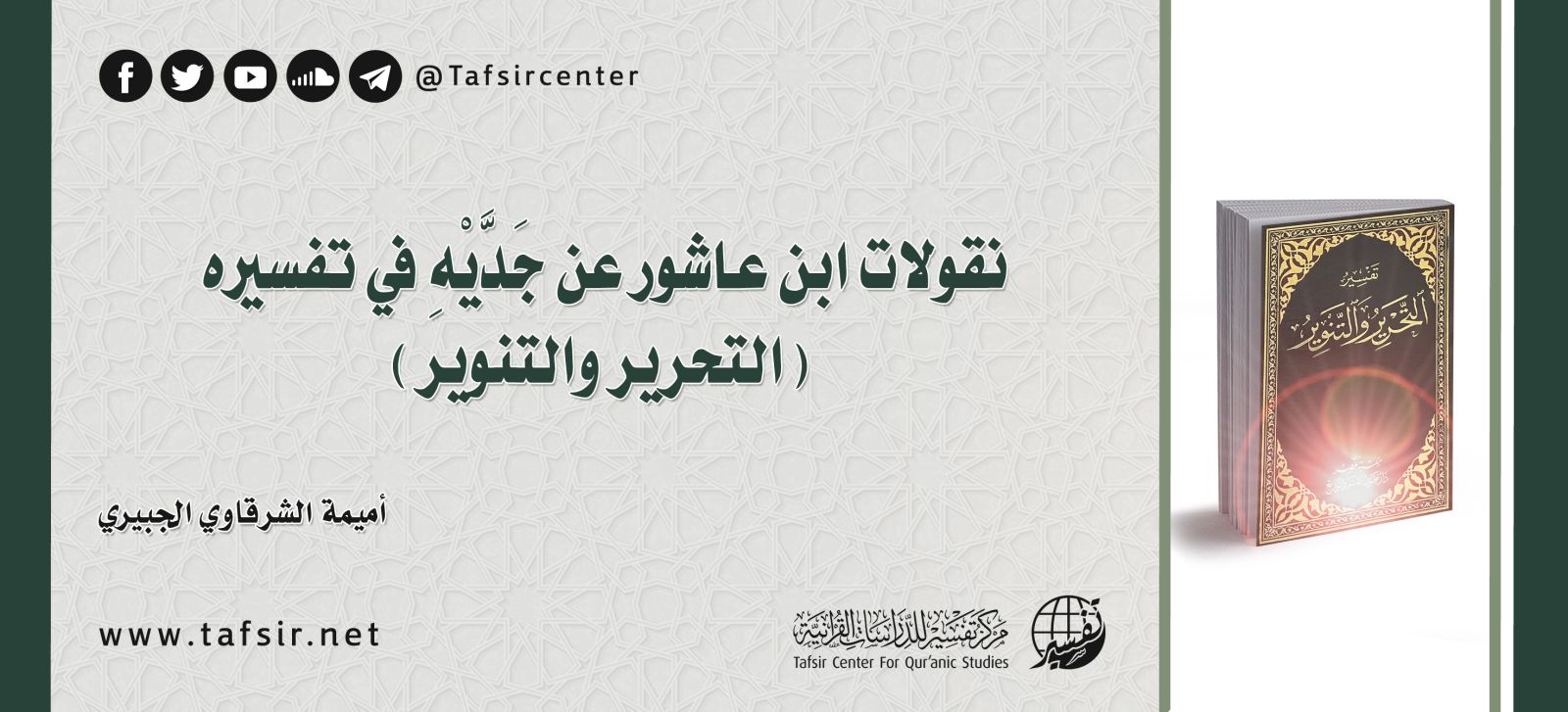عناية ابن عاشور بالدلالة الإفرادية للألفاظ القرآنية؛ نظرات وتأملات (2/2)
عناية ابن عاشور بالدلالة الإفرادية للألفاظ القرآنية؛ نظرات وتأملات (2/2)
الكاتب: مصطفى فاتيحي

ما زِلْنَا في رحاب الدلالات الإفرادية للألفاظ القرآنية وبيان عناية ابن عاشور بها في تفسيره (التحرير والتنوير)، وقد بينّا قبلُ أنّ الدلالات الإفرادية منها ما هو عامّ ومنها ما خاصّ، وبعد أنْ عالجنا في المقال السابق عنايةَ ابن عاشور بالدلالات الإفرادية العامّة وبينّا تحريراته في ذلكم الصّدَد[1]، نعالج في هذا المقال عناية هذا المفسِّر الجليل بالدلالات الإفرادية الخاصّة للمفردات التي اكتسبت معاني جديدة في الاستعمال القرآني لها، ويتعلّق الأمر بعادات القرآن ومبتكراته والتطوّر الدلالي للّفظ، وبيان ذلك على النحو الآتي.
أولًا: عادات القرآن:
مِن أهمّ ما يَحْفظ للخطاب القرآني وحدته وتماسكه أن ينطلق الدّارس معتبرًا ومتفقّهًا لطبيعة هذا الخطاب، من داخله وفي بنيته ونسقه، من ذلك ما اصطلح عليه (عادات القرآن) فهي «وسيلة تعصم المفسِّر من أن يقول على الله بلا عِلْم، وهي مقدّمة تؤدّي إلى نتيجة صحيحة، وهي عاصمٌ من الخطأ والانحراف في بيان الأسلوب القرآني، فلا يمكن أن يتكلّم في القرآن مَنْ لم يعرف عادات القرآن، من خلال استقرائه، وتتبّع عاداته في ألفاظه ومعانيه»[2].
لقد أَوْلَى ابنُ عاشور «عادات القرآن» عنايةً فائقة لِمَا لها من أهمية في البيان والتفسير، وأحسب أن هذا الاصطلاح مِن وضعِه، إِذْ لم يتسنّ لي العثور على مَن استعمله قبله وإن كانت فحواه واردة عند غيره.
يقول ابن عاشور: «فغرض المفسِّر بيان ما يصل إليه أو ما يقصده من مراد الله تعالى في كتابه بأتمّ بيان يحتمله المعنى ولا يأباه اللّفظ، من كلّ ما يوضح المراد من مقاصد القرآن، أو ما يتوقف عليه فهمه أكمل فهم، أو يخدم المقصد تفصيلًا وتفريعًا، مع إقامة الحُجّة على ذلك إن كان به خفاء، أو لتوقّع مكابرة من معاندٍ أو جاهل، فلا جرم كان رائد المفسِّر في ذلك أن يعرف على الإجمال مقاصد القرآن مما جاء لأجله، ويعرف اصطلاحه في إطلاق الألفاظ، وللتنزيل اصطلاح وعادات»[3].
ثم أضاف: «يحقّ على المفسِّر أن يتعرّف عادات القرآن من نَظْمِه وكَلِمه... وقد استقريتُ بجهدي عادات كثيرة في اصطلاح القرآن»[4].
وإذا تتبّعنا كيف طبّق ابن عاشور هذا التنظير في تفسيره نجده ينسجم تمامًا مع القاعدة المنهجية الآتية: «إعمال الأغلب في القرآن وتقديم المفهوم الجاري في استعماله أَوْلَى»[5].
يقول ابن القيم: «للقرآن عُرْفٌ خاصّ ومعانٍ معهودة لا يناسب تفسيره بغيرها ولا يجوز تفسيره بغير عُرْفِهِ والمعهود من معانيه، فإنّ نسبة معانيه إلى المعاني كَنِسْبَة ألفاظه إلى الألفاظ بل أعظم، فكما أنّ ألفاظه ملوك الألفاظ وأجلّها وأفصحها ولها من الفصاحة أعلى مراتبها التي يعجز عنها قدر العالمين، فكذلك معانيه أجلّ المعاني وأعظمها وأفخمها، فلا يجوز تفسيره بغيرها من المعاني التي لا تليق به، بل غيرها أعظم منها وأجلّ وأفخم. فلا يجوز حمله على المعاني القاصرة بمجرّد الاحتمال النحوي الإعرابي. فتدبّر هذه القاعدة، ولتكن منك على بال فإنك تنتفع في معرفة ضعف كثير من أقوال المفسِّرين وزيفها وتقطع أنها ليستْ مراد المتكلم تعالى بكلامه»[6].
ومن النماذج التي تُعَدّ من عادات القرآن عند ابن عاشور ما يأتي:
- هؤلاء: «وهؤلاء إشارة إلى كفار قريش؛ لأنّ تجدُّد دعوتهم ووعيدهم وتكذيبهم يومًا فيومًا جعلهم كالحاضرين، فكانت الإشارة مفهومًا منها أنها إليهم، وقد تتبعتُ اصطلاح القرآن فوجدته إذا استعمل هؤلاء ولم يكن معه مُشار إليه مذكور: أنه يريد به المشركين من أهل مكة»[7].
- الناس: «فالمراد بـ(الناس): أهل مكة جريًا على مصطلح القرآن في إطلاق هذا اللفظ غالبًا»[8].
- الفاسقين: «فالأظهر أنّ المراد من الفاسقين اليهود، وقد أطلق عليهم هذا الوصف في مواضع من القرآن»[9].
- الإنفاق: «{الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ} فإنها أعظم الأعمال البدنية، ثم أُتْبِعَت بعمل عظيم من الأعمال في المال وهي الإنفاق، والمراد بالإنفاق حيثما أُطلق في القرآن هو الصدقات واجبُها ومستحبُّها، وما ورد الإنفاق في السور المكية إلا والمراد به الصّدقات المستحبّة، إِذْ لم تكن الزكاة قد فُرِضَتْ أيامئذٍ، على أنه قد تكون الصدقة مفروضة دون نصاب ولا تحديد ثم حُدّدت بالنِّصاب والمقادير. وجيء في جانب إقامة الصلاة والإنفاق بفعل المضيّ؛ لأنّ فرض الصلاة والصدقة قد تقرّر وعملوا به فلا تجدّد فيه، وامتثال الذي كلفوا به يقتضي أنهم مداومون عليه»[10].
- لمحضرون:
«والمحضَرون: المجلوبون للحضور، والمراد: محضَرون للعقاب، بقرينة مقام التوبيخ، فإن التوبيخ يتبعه التهديد، والغالب في فعل الإحضار أنْ يُراد به إحضار سوء، قال تعالى: {وَلَوْلا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ}[الصافات: 57]؛ ولذلك حذف متعلّق (مُحْضَرون)، فأمّا الإتيان بأحدٍ لإكرامه فيُطلَق عليه المجيء. والمعنى: أنّ الجنّ تَعْلَم كَذِبَ المشركين في ذلك كذبًا فاحشًا يجازَون عليه بالإحضار للعذاب، فجعل (محضَرون) كناية عن كذبهم؛ لأنهم لو كانوا صادقين ما عذّبوا على قولهم ذلك. وظاهره أنّ هذا العلم حاصل للجنّ فيما مضى، ولعلّ ذلك حصل لهم من زمان تمكّنهم من استراقِ السّمع. ويجوز أن يكون من استعمال الماضي في موضع المستقبل لتحقيق وقوعه، مثل: {أَتَى أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ}[النحل: 1]، أي: ستعلم الجِنّة ذلك يوم القيامة. والمقصود: أنهم يتحقّقون ذلك ولا يستطيعون دفع العذاب عنهم؛ فقد كانوا يعبدون الجنّ لاعتقاد وجاهتهم عند الله بالصّهر الذي لهم»[11].
تكمن أهمية هذه التحقيقات عند ابن عاشور في تمكين المفسِّر من البناء على الدلالة الغالبة في الاستعمال القرآني للّفظة، مع استحضار الاستثناءات والإمكانات المعنوية الأخرى بمراعاة القرائن والسياقات الحالية والمقالية.
ثانيًا: التطوّر الدلالي للّفظ في الاستعمال القرآني:
ويرتبط بعادات القرآن في الاصطلاح قضية التطوّر الدلالي التي اعتنى بها ابن عاشور عناية جليّة باعتبارها «التغيّر الذي يطرأ على المفردة، سواء أكان المعنى المتطوّر دلاليًّا جديدًا، أم كان قريبًا من الدلالة السابقة، أو حتى لو انقرض المعنى الأساسي للكلمة، ويكون إطلاق لفظ التطوّر على هذه الحالة باعتبار كون المفردة تنتقل من طور إلى طور، أي: من حال إلى حال»[12].
والأمثلة على ذلك كثيرة يمكن إيراد ما يأتي منها:
- الفاسق:
«والفاسق لفظ من منقولات الشريعة، أصله اسم فاعل من الفسق بكسر الفاء، وحقيقة الفسق خروج الثمرة من قشرها وهو عاهة أو رداءة في الثمر، فهو خروج مذموم يعدّ من الأدواء»[13].
- المحراب:
قال ابن عاشور: «والمحاريب: جمع محراب، وهو الحصن الذي يحارَب منه العدو والمهاجِم للمدينة، أو لأنه يُرمى من شرفاته بالحِراب، ثم أُطلق على القصر الحصين. وقد سمّوا قصور غُمْدان في اليمن محاريب غُمْدان... ثم أُطلق المحراب على الذي يُخْتَلَى فيه للعبادة، فهو بمنزلة المسجد الخاصّ، قال تعالى: {فَنادَتْهُ الْمَلائِكَةُ وَهُوَ قائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرابِ}[آل عمران: 39]... وأمّا إطلاق المحراب على الموضع من المسجد الذي يقف فيه الإمام الذي يؤم الناس، يُجعل مثل كوّةٍ غير نافذة واصلةٍ إلى أرض المسجد في حائط القبلة يقف الإمام تحته، فتسمية ذلك محرابًا تسمية حديثة ولم أقف على تعيين الزمن الذي ابتُدِئ فيه إطلاق اسم المحراب على هذا الموقف»[14].
- الزحف:
قال ابن عاشور: «والزحف أصله مصدر زَحَفَ من باب مَنَعَ، إذا انبعث من مكانه متنقلًا على مقعدته كما يزحف الصبي. ثم أُطْلِق على مَشْي المقاتل إلى عدوّه في ساحة القتال زحفٌ؛ لأنه يدنو إلى العدو باحتراس وترصُّد فرصة، فكأنه يزحف إليه.
ويُطْلَق الزّحف على الجيش الدَّهْم، أي الكثير عدد الرجال؛ لأنّه لكثرة الناس فيه يثقل تنقُّله فوصف بالمصدر، ثم غلب إطلاقه حتى صار معنى من معاني الزحف، ويُجمع على زُحُوف»[15].
- المنتهى:
يقول ابن عاشور: «والمنتهى: أصله مكان انتهاء السّيْر، ثم أُطلق على المصير لأنّ المصير لازم للانتهاء، قال تعالى: {وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى}[النجم: 42]، ثم تُوُسِّع فيه فأُطلق على العِلْم، أي: لا يعلمها إلا الله، فقوله: {مُنْتَهَاهَا}[النازعات: 44]، هو في المعنى على حذف مضاف، أي: علم وقت حصولها، كما دلّ عليه قوله: {أَيَّانَ مُرْسَاهَا}[النازعات: 42]، ويجوز أن يكون {مُنْتَهَاهَا} بمعنى: بلوغ خبرها، كما يقال: أنهيتُ إلى فلان حادثة كذا، وانتهى إليَّ نبأ كذا»[16].
- الآيات:
يقول ابن عاشور: «والآيات: الدلائل على ما تتطلّب معرفته من الأمور الخفية.
والآيات حقيقة في آيات الطريق، وهي علامات يجعلونها في المفاوز تكون بادية لا تغمرها الرمال لتكون مرشدة للسائرين، ثم أُطلقت على حجج الصدق، وأدلة المعلومات الدقيقة. وجمع الآيات هنا مراعى فيه تعدّدها وتعدّد أنواعها، ففي قصة يوسف -عليه السلام- دلائل على ما للصبر وحسن الطوية من عواقب الخير والنّصر، أو على ما للحسد والإضرار بالناس من الخيبة والاندحار والهبوط. وفيها من الدلائل على صِدْق النبي -صلى الله عليه وسلم- وأنّ القرآن وحيٌ من الله، إِذْ جاء في هذه السورة ما لا يعلمه إلا أحبار أهل الكتاب دون قراءة ولا كتاب وذلك من المعجزات»[17].
وعليه لا بد من التمييز بين الدلالة الأصلية للكلمة، وكذا ما حصل لها من تطوّر دلالي أضاف لها معاني جديدة، لا تخرج من طبيعة الحال عن سنن اللغة العربية، ولكن نجد فيها محمولات ومشمولات جديدة، ولو تأملت هذه القضية لما ذهب بعضهم إلى إعمال قاعدة معهود العرب لأرخنة معاني القرآن وحصرها بمنتهى التعسّف في سياق نزولها.
وإذا استصحبنا غزارة المعاني التي تنطوي عليها الألفاظ والكلمات، واختلاف الكلمة حسب تطوّرها الدلالي، أدركنا صعوبة ترجمة معاني القرآن، وأدركنا أنّ الأمر محفوف بكثير من المخاطر. هذا إذا كان المترجم سليم القصد، أمّا إن انطلق من خلفيات أيديولوجية فالأمر يصبح أكثر سوءًا وأكثر فداحة، كما فعل (جاك برك)[18].
ثالثًا: مبتكَرات القرآن:
وهي ألفاظ واصطلاحات لم تكن مستعملة قبل القرآن، وهذه التسمية أيضًا من ابن عاشور وإن كان المضمون مذكورًا عند مَن سلفه.
وفيما يأتي نماذج للكلمات التي قال عنها ابن عاشور أنها مبتكرات:
- حسومًا:
{سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ}[الحاقة: 7].
قال: «و(حسوم) يجوز أن يكون جمع حاسم مثل قعود جمع قاعد، وشهود جمع شاهد، غلب فيه الأيام على الليالي؛ لأنها أكثر عددًا إذ هي ثمانية أيام، وهذا له معانٍ: أحدها أن يكون المعنى: يتابع بعضها بعضًا، أي: لا فصل بينها كما يقال: صيام شهرين متتابعين.
قيل: والحسوم مشتقّ من حسم الداء بالمكواة إِذْ يُكْوَى ويُتَابَع الكَيّ أيامًا، فيكون إطلاقه استعارة، ولعلّها من مبتكرات القرآن.
المعنى الثاني: أن يكون من الحسم وهو القطع، أي حاسمة مستأصلة. ومنه سمي السيف حسامًا لأنه يقطع، أي حسمتهم فلم تُبْقِ منهم أحدًا، وعلى هذين المعنيَيْن فهو صفة لـ{سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ}، أو حال منها.
المعنى الثالث: أن يكون حسوم مصدرًا كالشكور والدخول فينتصب على المفعول لأجله وعامله سخرها، أي: سخرها عليهم لاستئصالهم وقطعِ دابرهم.
وكلّ هذه المعاني صالح لأن يُذْكَر مع هذه الأيام، فإيثار هذا اللفظ من تمام بلاغة القرآن وإعجازه»[19].
ومما يلفت الانتباه عند ابن عاشور أنه شديد الميل إلى تضمين اللفظ ما وسع من المعاني، ما دامت محتملة ومقبولة، ومنطلقه في ذلك إعجاز القرآن وتمام بلاغته.
- سلسبيلًا :
في قوله تعالى: {عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا}[الإنسان: 18].
قال ابن عاشور: «و(سلسبيل): وصفٌ قيل مشتق من السلاسة وهي السهولة واللين فيقال: ماء سلسل، أي: عذب بارد. قيل: زِيدت فيه الباء والياء (أي زيدتَا في أصل الوضع على غير قياس...وعندي أنّ هذا الوصف رُكِّب من مادتي السلاسة والسَّبالة، يقال: سَبَلَت السماء، إذا أمطرت. فسبيل فعيل بمعنى مفعول، رُكِّب من كلمتي السلاسة والسبيل لإرادة سهولة شربه ووفرة جريه. وهذا من الاشتقاق الأكبر وليس باشتقاق تصريفي. وقال ابن الأعرابي: لم أسمع هذه اللفظة إلا في القرآن، فهو عنده من مبتكرات القرآن الجارية على أساليب الكلام العربي»[20].
- الوتين:
قال ابن عاشور: «والوتين: عِرْقٌ معلّق به القلب ويسمى النِّياط، وهو الذي يسقي الجسد بالدّم ولذلك يقال له: نهر الجسد، وهو إذا قُطِع مات صاحبه وهو يُقْطَع عند نحر الجَزُور. فقطعُ الوتين من أحوال الجزور ونحرِها، فشَبّهَ عِقابَ من يُفْرَض تقوُّلُه على الله بجَزُور تُنحر فيُقطع وتينُها. ولم أقف على أن العرب كانوا يكنُّون عن الإهلاك بقطعِ الوتين، فهذا من مبتكرات القرآن»[21].
- الثقلان:
قال ابن عاشور: «والثقلان: تثنيةُ ثَقَلٍ، وهذا المثنى اسم مفرد لمجموع الإنس والجنّ.
وأحسب أن الثّقَل هو الإنسان لأنه محمول على الأرض، فهو كالثّقل على الدابة، وأن إطلاق هذا المثنى على الإنس والجنّ من باب التغليب، وقيل غير هذا مما لا يرتضيه المتأمّل. وقد عُدّ هذا اللفظ بهذا المعنى مما يستعمل إلا بصيغة التثنية فلا يطلق على نوع الإنسان بانفراده اسم الثقل؛ ولذلك فهو مثنى اللفظ مفرد الإطلاق. وأظنّ أن هذا اللفظ لم يُطلق على مجموع النوعين قبل القرآن فهو من أعلام الأجناس بالغلبة، ثم استعمله أهل الإسلام»[22].
نستطيع على إثر ما تمّ بيانه آنفًا من أمثلة ونماذج لعناية ابن عاشور بقضايا المعجم، أن نستنتج أن التحرير والتنوير يضم مادة غزيرة لدراسة وتمحيص المفردة القرآنية من زوايا مختلفة بنفَس لا يكلّ ولا يملّ، فلم تتقاصر همّة ابن عاشور عن الرجوع إلى أساطين اللغة وأئمتها وأعلامها، للاستدلال على ما يرجح لديه من معاني، فلا تكاد تمرّ على صفحة من صفحات التحرير إلا وتخرج منها بفوائد ونكت لغوية تدلّ على علوّ كعبه ورسوخ قدمه في هذا الميدان.
ولا ريب أن هذا المسلك صعب المرتقى لا ينال إلا بالطلب، والتخرّج من خلال العكوف على الأمهات وأصول المظانّ، وهو ما يفسّر تبرم أصحاب القراءات المعاصرة من قضية التأصيل، واستنكافهم عن الضبط المنهجي، والصرامة العِلْمِيّة، آية ذلك أن كلّ جهودهم مجتمعة لم تثمر إلا تساؤلات واستشكالات يتفنّنون في طرق عرضها، أمّا أن يسمَّى ذلك تفسيرًا فهو أمرٌ دونه خَرْطُ القَتاد.
بعد هذه السياحة مع نماذج لدراسة ابن عاشور لقضايا المعجم أودّ التنبيه إلى مسألة أساسية، أنّ هذا التقسيم تقتضيه دواعٍ منهجية، ذلك أن ابن عاشور لا يفصل بين الاهتمام بالمعجم والعناية بالتركيب، بل يبدأ بالتأصيل المعجمي ليصل إلى الدراسة التركيبية.
ولقد اهتم العلماء والباحثون قديمًا وحديثًا بقضية تشكُّل المعنى والانتقال من الكلمة إلى الجملة كبنية متكاملة تتضافر مجموعة من العناصر داخلها وخارجها، مِن أجلِ سبك المعاني ونَظْمِها في قوالب قابلة للفهم والاستيعاب، وقد أثمرتْ جهودهم الحثيثة ما سُمّي بنظرية النَّظْم في القرآن الكريم التي تُعَدُّ وجهًا من أوجه الإعجاز، هذه النظرية جلّت الكثير مما تنطوي عليه الآيات القرآنية من أسرار من حيث ثراء المعنى بأقلّ ما يمكن من الكلمات، وكيفية انسياب الدلالات بما لا يناقض السابق مع اللاحق، بل يجعله متعاضدًا معه كاللّحمة والسدى.
يقول (الجرجاني): «أعجَزتْهم مزايا ظهرت لهم في نَظْمِه، وخصائص صادفوها في سياق لفظه، وبدائع راعَتْهم من مبادئ آيه ومقاطعها، ومجاري ألفاظها ومواقعها، وفي مضرب كلّ مثل ومساق كلّ خبر، وصورة كلّ عظة وتنبيه، وإعلام وتذكير، وترغيب وترهيب، ومع كلّ حُجّة وبرهان، وصفة وتبيان. وبهرهم أنهم تأمّلوه سورة سورة، وعشرًا عشرًا وآية آية، فلم يجدوا في الجميع كلمة ينبو بها مكانها، ولفظة ينكر شأنها أو يرى أن غيرها أصلح هناك أو أشبه أو أحرى وأخلق. بل وجدوا اتّساقًا بهر العقول وأعجز الجمهور ونظامًا والتئامًا وإتقانًا وإحكامًا لم يَدَع في نفس بليغ منهم -ولو حكّ بيافوخه السماء- موضع طمع، حتى خرسَت الألسن عن أن تدّعي وتقول، وخَلَدَت القروم فلم تملك أن تصول»[23].
وللتعليق على قول الجرجاني لا أجد أفضل من (عبد الله دراز) حيث يقول: «هذا الذي حدثناك عنه من عظمة الثروة المعنوية في أسلوب القرآن على وجازة لفظه، يضاف إليه أمر آخر هو زينة تلك الثروة وجمالها. ذلك هو تناسُق أوضاعها، وائتلاف عناصرها، وأخْذُ بعضها بحُجَزِ بعض، حتى إنها لتنتظم منها وحدة محكمة لا انفصام لها. وأنت تعرف أن الكَلِم في الشأن الواحد إذا ساء نَظْمه انحلّت وحدة معناه فتفرّق من أجزائها ما كان مجتمعًا، وانفصل ما كان متصلًا»[24].
وكما هو متوقَّع فإنّ الشيخ ابن عاشور له اليدُ الطّولى والقِدْحُ الـمُعَلَّى في تتبع نَظْم القرآن ودوره في تشكُّل المعنى وتبلوره وهو يتابع ذلك بنفَس عَزَّ نظيره، فكثيرًا ما تلفت الناظر عبارته: (ونَظْم الكلام - أو: لا ينبو عنه النَّظْم - أو: وينبو عنه النَّظْم - أو: الجاري مع نَظْم الكلام).
وقد صار على هذا المهيع تنظيرًا وتطبيقًا، يقول: «وإنما كان التحدّي بسورة ولم يكن بمقدار سورة من آيات القرآن؛ لأنّ من جملة وجوه الإعجاز أمورًا لا تظهر خصائصها إلا بالنّظر إلى كلام مستوفى في غرض من الأغراض وإنما تنزل سور القرآن في أغراض مقصودة فلا غنى عن مراعاة الخصوصيات المناسبة لفواتح الكلام وخواتمه بحسب الغرض، واستيفاء الغرض المسوق له الكلام، وصحّة التقسيم، ونكت الإجمال والتفصيل، وأحكام الانتقال من فنّ إلى آخر من فنون الغرض، ومناسبات الاستطراد والاعتراض والخروج والرجوع، وفصل الجُمَل ووصلها، والإيجاز والإطناب، ونحو ذلك مما يرجع إلى نكت مجموع نَظْم الكلام، وتلك لا تظهر مطابقتها جليّة إلا إذا تمّ الكلام واستوفى الغرض حقّه، فلا جرم كان لنَظْم القرآن وحسن سبكه إعجاز يفوت قدرة البشر هو غير الإعجاز الذي لجُمله وتراكيبه وفصاحة ألفاظه. فكانت السورة من القرآن بمنزلة خُطبة الخطيب وقصيدة الشاعر لا يحكم لها بالتفوّق إلا باعتبارات مجموعها بعد اعتبار أجزائها»[25].
خاتمة:
من خلال ما سبق في هذه المقالة وسابقتها نصل إلى الاستنتاج الآتي: أنّ الطاهر بن عاشور بلغ شأوًا كبيرًا في تدقيق المصطلح القرآني، والنماذج التي أوردتُها تشكِّل النّزر اليسير، ولكنها تكشف عن القدرات اللغوية الهائلة التي يتملّكها، والخبرة الواسعة التي أَهّلته إلى التقاط أدقِّ المعاني وأنفَسِها، ولا بدّ للباحث من أن يقرّ -بكلّ تجرد- بصحّة دعوى ابن عاشور أنه سوف يتتبّع المصطلحات بأسلوب تخلو منه حتى المعاجم اللغوية. كما أنّ القارئ يفيد إفادات جمّة وهو يتابع هذا المفسّر الفذّ في شرح الكلمة والاستدلال على المعنى الذي يترجح لديه، وكلما طال احتكاكه مع هذا السِّفْر الضخم يحسّ بأن لسانه بدأ يدرب على حسن التعبير، كما يسلس له قياد كثير من المفاهيم والمصطلحات.
ولذلك أحسن (محمد المالكي) التعبير عما يختلج في الصدر حين قال: «وفي إطار المقارنة بين صنيع المفسِّرين وصنيع المعجميين يمكن الإشارة إلى ظاهرة منهجية أساسية، هي أنّ المادة المعجمية الواردة في المعاجم العربية تأتي في جملتها على نحو من التناثر والتفرّق إذا صحّ التعبير، كما أنها تأتي على نحو مجرّد ثابت، بمعنى أنها تَذْكُر جميع الدلالات المحتملة التي تَرِد عليها اللّفظة من دون مراعاة مدلول معيّن هو أَوْلَى بالمعنى من غيره من المدلولات الأخرى، على حين أنّ هذه المادة تأتي عند المفسِّرِين بشكلٍ يتنامى ويتطوّر، ويتعيّن وينحصر معه مدلول الألفاظ المفردة، من خلال تفاعل مجموعة من العناصر اللغوية وغير اللغوية، ولا يقف عند الدلالة العامة التي للكلمة في لغة العرب، وإنما يتجاوز ذلك إلى بيان دلالتها القرآنية الخاصّة»[26].
وهذا خيرُ دليل على أنّ عِلْمَ التفسير ملتقى لدقيق العلوم عامِّها وخاصِّها؛ ولذلك يعزّ أن تجد مفسِّرًا من المفسِّرين المعتبرين دون أن تكون له مشاركة متنوّعة في صنوف العلوم ومختلف الفنون، وعلى رأسهم إمام المفسِّرين أبو جعفر الطبري الذي كانت له إضافات قيمة في حقول معرفية مختلفة، فقد كان صاحب مذهب واختيارات ومواقف واستدراكات. كما نجد أنّ العلماء الراسخين لا يشرعون في التفسير إلا بعد رحلة عِلْمِيّة شاقّة من التحصيل والطلب وطول العكوف والجمع والتحقيق.
وبناء عليه يمكن القول إن الثروة المعجمية التي ينطوي عليها التحرير والتنوير جديرة بأن يستخرج منها ملامح نظرية عامة في تحديد المصطلح القرآني، بالنظر إلى الغنى والتوسّع في إيراد الدلالات المختلفة والمرامي البعيدة والقريبة. وبالنظر إلى أسلوب ابن عاشور المتّبع الذي يتّسم بمجموعة من السمات العِلْمِيّة الرصينة، ومن أهمها الاستقراء سواء ما تعلّق منه باستقراء محامل المفردة في الاستعمال القرآني في سياقاته المختلفة أو الاستعمال العربي شِعْرًا ونثرًا وأمثالًا، وأسعفه في ذلك فقهه الواسع للسان العربي وعلومه.
وهو مطمح يحتاج إلى جهد جماعي لاستخراج المادة المعجمية على طول التفسير وتصنيفها وتبويبها، وبيان إمكانات استثمارها، وتأمُّل منهج ابن عاشور وأسلوبه في تحرير المادة اللغوية والبحث في مصادره المعتمدة وكذا استدراكاته على مَن قبله من اللغويين والمفسِّرين. ولا ريب أن صنيع ابن عاشور يسهم في تفكيك الخلاف القديم حول العلاقة بين اللفظ والمعنى.
[1] للاطلاع على المقال السابق: tafsir.net/article/5387.
[2] ينظر عادات القرآن الأسلوبية، ص41.
[3] التحرير والتنوير، (1/ 39).
[4] التحرير والتنوير، (1/ 122).
[5] قواعد التفسير، حسين الحربي، ص172.
[6] التفسير القيم، (1/ 278).
[7] التحرير والتنوير، (23/ 124).
[8] التحرير والتنوير، (26/ 150).
[9] التحرير والتنوير، (1/ 362).
[10] التحرير والتنوير، (22/ 160).
[11] التحرير والتنوير، (23/ 94- 95).
[12] التطور الدلالي للّفظ القرآني عند ابن عاشور، ص152.
[13] التحرير والتنوير، (1/ 360).
[14] التحرير والتنوير، (22/ 29).
[15] التحرير والتنوير، (9/ 43).
[16] التحرير والتنوير، (30/ 86).
[17] التحرير والتنوير، (12/ 22).
[18] حيث أثبتت زينب عبد العزيز في كتابها (ترجمات معاني القرآن إلى أين؟ وجهان لجاك بيرك) حجم التلبيس والتحريف في ترجمة جاك بيرك.
[19] التحرير والتنوير، (29/ 108).
[20] التحرير والتنوير، (29/ 368).
[21] التحرير والتنوير، (29/ 135).
[22] التحرير والتنوير، (27/ 257).
[23] دلائل الإعجاز، الجرجاني، (1/ 49- 50).
[24] النبأ العظيم، ص142.
[25] التحرير والتنوير، (1/ 331).
[26] دراسة الطبري للمعنى، ص234.
كلمات مفتاحية
الكاتب:

مصطفى فاتيحي
حاصل على الدكتوراه من جامعة القاضي عياض بمراكش - المغرب، وأستاذ التعليم التأهيلي الثانوي.
مواضيع ذات صلة
((المعلومات والآراء المقدَّمة هي للكتّاب، ولا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع أو أسرة مركز تفسير))