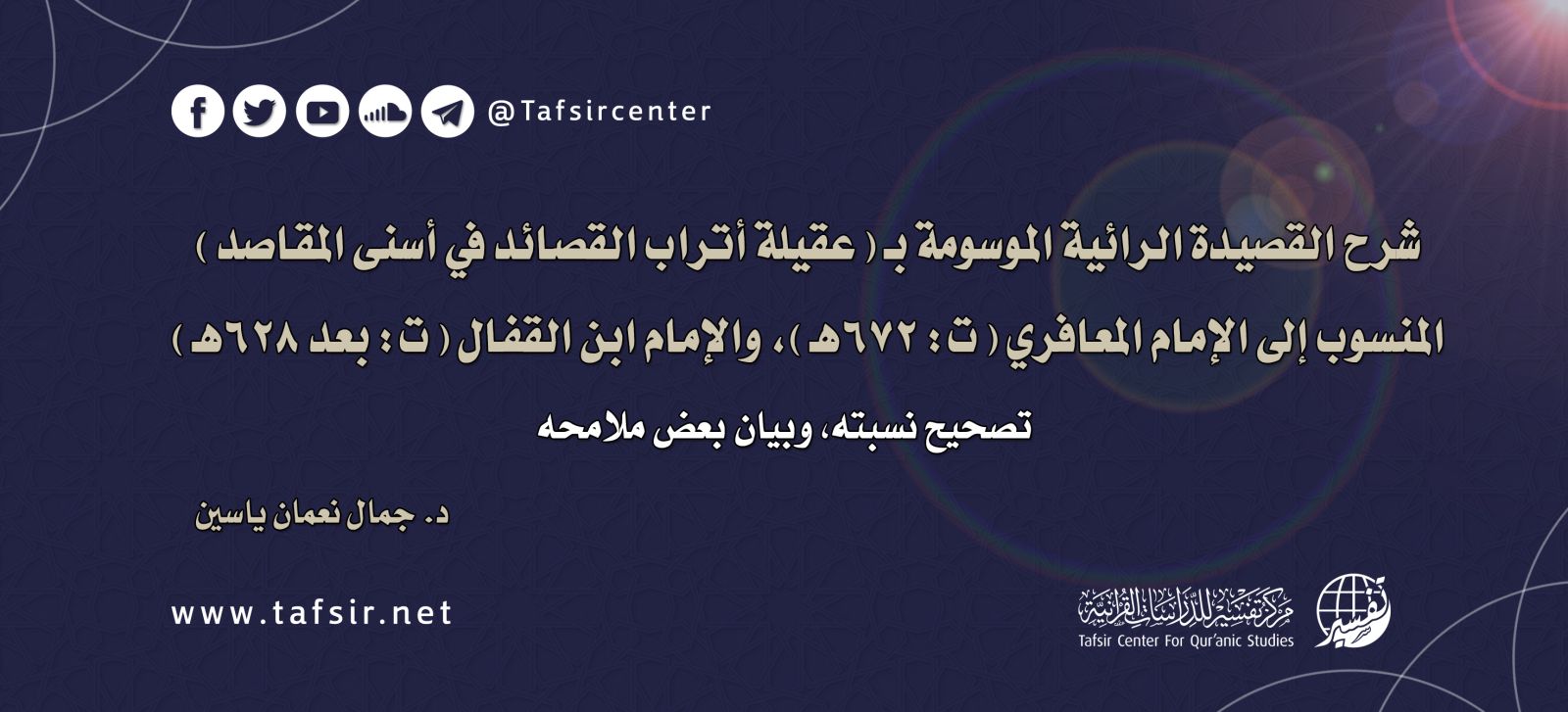تصحيح المفاهيم من خلال سورة الفجر
تصحيح المفاهيم من خلال سورة الفجر
الكاتب: إبراهيم لبيب

تمهيد:
الحمد لله القائل في كتابه: {كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ}[إبراهيم: 1].
والصلاة والسلام على نبيّنا وحبيبنا محمد -صلى الله عليه وسلم- الذي خاطبه ربُّه في مُحْكَم تنزيله قائلًا: {... وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ}[الشورى: 52].
فالحمد لله الذي أرسل إلينا خيرَ الرّسل، وأنزل معه خيرَ الكتب؛ ليهدي به العبادَ إلى طريقه المستقيم، وليخرج الناسَ من الظُّلمات إلى النور، من ظُلمات الكُفْر إلى نور الإيمان، ومن ظُلمات الضلالة إلى نور الهدى، ومن ظُلمات الشكّ إلى نور اليقين.
وفي هذا المقال، سنسلِّط الضوءَ على سورة عظيمة من كتاب الله اتَّسَمَت من أوّلها إلى آخرها بأنها تصحِّح بعضَ المفاهيم المغلوطة عند كثير من بني آدم، منكِرة على من يَظُنّ بالله ظنّ السّوء، مُذَكِّرة إياه بقدرته -سبحانه وتعالى- وشديد بطشه على من كفر به وطغى في البلاد وأكثر فيها الفساد، وبيّنَت إحاطته بخلقه ورصده لجميع أعمالهم، مع تذكرتهم بيوم القيامة، يوم الجزاء العظيم.
ولا شكَّ أن من تدبَّر هذه المعاني العظيمة في سورة الفجر حقّ التدبُّر؛ فستتغيّر نظرته للحياة تمامًا ومن ثمَّ سيتغيَّر سلوكه، وهذا حال مَنْ سَلَّم نفسه للقرآن ودار حيث دار، كيف لا واللهُ -سبحانه وتعالى- يقول: {إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يِهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ}[الإسراء: 9].
بين يدي سورة الفجر:
بدأ اللهُ -سبحانه- السورةَ بالقَسَم، والقَسَمُ من الأساليب القرآنية المستخدَمة بكثرة في القرآن، ولـمّا كان القرآن نزل بلغة العرب، وكان من أساليب العرب أنها تُقْسِم بالأشياء المهمَّة، فقد أَقْسَم اللهُ -سبحانه وتعالى- في هذه السورة بهذه الخمسة.
{وَالْفَجْرِ * وَلَيَالٍ عَشْرٍ * وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ * وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ}[الفجر: 1- 4].
فالفجر: هو أوّل الصبح، وقيل: صلاة الفجر، وقيل: المقصود به فجرٌ مخصوص؛ فهو فجرُ يوم النَّحْرِ، الذي هو أفضل الأيام عند الله.
والليالي العشر: على قول جمهور المفسِّرين، هي عشر ذي الحجة، وأقسم اللهُ بها لِعِظَمِ شأنها.
والشفع والوتر: قيل: يوم عرفة هو الوتر، ويوم النَّحْر هو الشّفع، وقيل: المقصود بالشفع هم جميع الخلق، والوتر هو الله الواحد الأحد؛ وإنما أطلق على الخلق شفع لأنّ الخَلق بُني على مبدأ الزوجية، يقول تعالى: {وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا}[النبأ: 8]، وهذا ليس قاصرًا على الإنسان فقط، بل أيضًا على الحيوانات والنباتات، كما قال تعالى: {سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ}[يس: 36].
والليل إذا يسرِ: أي: إذا يمضي، أو إذا جاء وأقبَل.
ثم بَيَّن تعالى أنّ هذا القَسَم إنما فيه كفاية لذي حِجْر، أي: عقل. وسُمِّي العقل حِجْرًا؛ لأنه يمنع الإنسان مما لا يليق به، ومن ذلك قالوا: حَجَرَ الحاكمُ عليه، إذا مَنَعَه من التصرّف في ماله.
وعلى هذا فإنّ ما سبق من قَسَم وما سيأتي من آيات تحتاج إلى حِجْرٍ يَحْجُرُ صاحبَه عن الغفلة واتّباع الهوَى، ويحمله على اتباع الرُّسُل؛ لئلا يصيبه ما أصاب قوم عاد وثمود وفرعون، الذين طغوا بما أعطاهم الله من نِعَمٍ وأكثروا الفساد.
ثم بَيَّن تعالى عاقبة هؤلاء المكذِّبين بأنْ صَبّ اللهُ عليهم سوطَ عذابه، وبَيَّن -سبحانه- أنه يرصد جميع أعمال الظالمين ولا يغفل عنها.
ثُمَّ ذكَر اللهُ بعدها ابتلاءه للإنسان إمّا بالتوسعة أو التقتير، وأخبر -سبحانه- أنْ توسعته على من وَسَّع عليه لا يدلُّ على أنَّه كريمٌ عنده، وأنَّ تقتيره على من قتَّر عليه لا يدلُّ على إهانته له وسقوط منزلته عنده؛ بل يوسِّع ابتلاءً وامتحانًا، ويقتِّر ابتلاءً وامتحانًا، فيبتلي بالنِّعَم كما يبتلي بالحرمان منها.
ثُمَّ ذَكَر -سبحانه- حالَ الإنسان في معاملته للضعفاء؛ كاليتيم والمسكين، فلا يُكْرِمُ هذا، ولا يَحُضُّ على إطعام هذا.
ثُمَّ ذكَر حِرْصَ الإنسان على جَمْعِ المال وأكْلِه، وحُبِّه له، وأكلِه للميراث، وأنّ ذلك هو الذي أوجب له عدمَ رحمته لليتيم والمسكين.
ثُمَّ خُتمت السورة بذكر يوم القيامة، وندم الإنسان على ما فرّط في جنب الله، ثم تذكر حال النفوس الطيبة المطمئنة التي استضاءت بنور الوحي، ونظرتْ إلى الأمور بمنظار القرآن، فنجَتْ من هذه المفاهيم المغلوطة واطمأنّت بذكر الله ووحيه، فكان جزاؤها: {يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ * ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً * فَادْخُلِي فِي عِبَادِي * وَادْخُلِي جَنَّتِي}[الفجر: 27- 30].
ونبدأ بعون اللهِ بِذِكْرِ سبعة مفاهيم مغلوطة عند الناس صَحَّحَتْهَا سورةُ الفجر؛ فنقول وباللهِ التّوفيق:
1- مهما أُوتي أهل الباطل من قوّة فإنهم ضعفاء أمام قدرة الله:
إنّ أول المفاهيم الخاطئة التي تصحِّحها سورة الفجر هو اعتقاد أهل الباطل أنّ القوَّة التي معهم ستعصمهم من الله؛ وتناسوا أن الإنسان مهما بلغ من القوَّة فإنّه ضعيف تمام الضّعف أمام قوّة الخالق القهّار سبحانه وتعالى. ونتيجة لهذا الاغترار بالقوة يتمادى الظالمُ في ظُلْمِه ظنًّا منه أنه على حَقّ.
ولو تأملتَ في الأمثلة الثلاثة التي ذكرها اللهُ لنا في هذه السورة:
1- {أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ * إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ * الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ}[الفجر: 6- 8].
2- {وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ}[الفجر: 9].
3- {وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ}[الفجر: 10].
ستجد أنّ القاسم المشترك بينهم جميعًا هو: اغترارهم بقوَّتهم وسلطانهم وأموالهم، وأنهم قالوا بلسان الحال، بل وبلسان مقال قوم عاد في سورة فصلت: {مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً}[فصلت: 15].
قال ابن القيم -رحمه الله-: «وتضمَّنَتْ هذه السورةُ ذَمَّ من اغترَّ بقُوَّته، وسُلطانِه، ومالِه، وهم هؤلاء الأُمَم الثلاثة:
(قوم عاد): اغترُّوا بقوَّتهم.
و(ثمود): اغترُّوا بجِنَانهم، وعيونهم، وزروعهم، وبساتينهم.
و(قوم فرعون): اغترُّوا بالمال والرِّياسَة.
فصارت عاقبتهم إلى ما قَصَّ اللهُ علينا، وهذا شأنه دائمًا مع كلِّ من اغترَّ بشيءٍ من ذلك، لا بُدَّ أن يُفْسِدَهُ عليه، ويسْلُبَهُ إيَّاه»[1].
فأمّا عاد الذين قالوا: {مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً}[فصلت: 15]، نسوا أن الله -عز وجل- الذي خلقهم هو أشدّ منهم قوة: {... أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ}[فصلت: 15].
فجمعوا بين الكفر بالله وجَحْدِ آياته والاستكبارِ في الأرض وظُلْمِ العباد؛ اغترارًا بما عندهم من القوَّة.
فعاقبهم اللهُ بريح عظيمة شديدة، لها صوت مرعب كالرعد القاصف: {فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا}[فصلت: 16].
وسخّرها الله عليهم: {سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ}[الحاقة: 7].
فسبحان الله القويّ العظيم!
وأمّا ثمود الذين جابوا الصخر بالواد، أي: يقطعونها وينحتونها ويخرقونها، كما قال تَعالَى: {وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ}[الشُّعَراء: 149]، فكذَّبوا رسولهم صالحًا -عليه السلام- الذي كان يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، فاختاروا الكُفْرَ على الإيمان والضّلال على الهدى، واغترُّوا بقوّتهم وما مكّنهم اللهُ فيه؛ فعُوقبوا بالصَّيْحَة.
وأمّا فرعون ذو الأوتاد، أي: الجنود الذين كانوا يثبِّتون مُلْكَه، فقد قَصَّ اللهُ لنا قصتهم في مواضع كثيرة من كتابه، وكيف كانوا يظلمون ويقتلون المؤمنين، ولم يَسْلَم من أذاهم حتى الأطفال الصغار، فكانوا يُذَبِّحون أبناءهم ويستحيون نساءهم، ثم كان عاقبة فرعون وجنوده أن أغرقهم الله ونجَّى موسى ومَن معه من المؤمنين.
فهؤلاء جميعًا؛ عاد وثمود وفرعون: {طَغَوْا فِي الْبِلادِ * فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ}[الفجر: 11- 12]، فتمرّدوا وسَعَوا في الأرض بالإفساد، وظُلْمِ العباد، فكانت النتيجة: {فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذابٍ}[الفجر: 13]، فأنزل اللهُ بهم عذابه وأحلّ بهم عقوبته، وذلك جزاء الظالمين.
فهل نفعتهم قوَّتهم؟! لقد عوقبوا بالريح والصوت والماء، أسباب كانوا يعايشونها في حياتهم، ما تخيَّلوا يومًا أنهم سيُهْلَكون بها، وما كان لهم من الله من واقٍ.
فالذي يكفر بالله مغترًّا بما عنده من قوّة أو سلطان أو مال هو في الحقيقة محدود النظر، فلينظر مثلًا إلى حجمه بالنسبة للأرض التي نعيش عليها، ثم لينظر لحجم هذه الأرض بالنسبة للسماء الدنيا، ونحن في العصر الحديث قد تكشَّفَتْ لنا حقائق كثيرة عن هذا الكون الفسيح ومدى اتساعه، فمَن تأمّل في خلق السماوات والأرض وحجمه بالنسبة لهذا الكون الذي خلقه الله، سيعلم حقيقة كم هو ضعيف ذليل أمام قوة الملك -سبحانه وتعالى- الذي وَسِع كرسيّه السماوات والأرض: {وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ}[الزمر: 67].
فقوله تعالى: {فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ * إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ}[الفجر: 13- 14]، وإن كانت قد جاءت تعقيبًا على الأمثلة الثلاثة المذكورة؛ وهم قوم عاد وثمود وفرعون، إلّا أنها لا تعني أنها خاصّة بهم، بل تشمل كلَّ من تمرَّد على الخالق -سبحانه وتعالى-؛ فإن عقوبته قد تنزل بهم في أيّ وقت.
2- {إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ}:
ومن المفاهيم التي تُصَحِّحها السورة: الظنُّ الخاطئ لبعض الناس أنّ إمهالَ الله للظالمين دليلٌ على عدم مؤاخذتهم بما فعلوا، أو أن الله راضٍ عن أفعالهم!
وهذا ناتج من تزيين الشيطان وتلبيسه على العُصاة والظالمين، وهو أيضًا من سوء الظنِّ بالله؛ لأنّ الله من سنّته الإمهال، فلا يعجل بالعقوبة، كما قيل: «أَمْهَلَهُمْ حَتَّى ظَنُّوا أَنَّهُ أَهْمَلَهُمْ!»[2].
ولذلك أخبرنا اللهُ في هذه السورة تعقيبًا على إهلاكه للطاغين قائلًا: {إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ}[الفجر: 14].
فالله -سبحانه وتعالى- لا يغفل عن ظُلْمِ الظالمين ولا عن مكر الماكرين بأهل الحقّ.
قال تعالى: {وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ}[إبراهيم: 42].
فهو -سبحانه- عليم بما يصنعون، وهو قادر على أن يعجِّل العقوبة لهم في الدنيا، ولكن حكمته اقتضَت إمهال الظالمين، وابتلاء المؤمنين، قال تعالى: {ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ}[محمد: 4].
قال السعدي: «{وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ}، ليقوم سوق الجهاد، ويتبيّن بذلك أحوال العباد، الصادق من الكاذب، وليؤمن مَن آمن إيمانًا صحيحًا عن بصيرة، لا إيمانًا مبنيًّا على متابعة أهل الغَلَبة، فإنه إيمان ضعيف جدًّا، لا يكاد يستمر لصاحبه عند المحن والبلايا»[3].
فهكذا إذن اقتضَتْ حكمة الله تعالى أن يجعل هذه الدنيا دار ابتلاء وامتحان، كما سيأتي، فلا ينبغي للمؤمن في خضمِّ صراعه مع الباطل أن ينسى حقيقة الأمور، أن الله على كلّ شيء قدير، وأنه لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض، وأن الله يرصد جميع أعمال العباد خيرها وشرّها.
قال الطبري -رحمه الله- في تفسير قول الله: {إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ}:
«يقول -تعالى ذِكْرُه- لنبيّه محمّدٍ -صلّى الله عليه وسلّم-: إنّ ربّك يا محمد لهؤلاء الّذين قصصتُ عليك قصصهم، ولضربائهم من أهل الكُفْر به، لبالمرصاد يرصدهم بأعمالهم في الدّنيا، وفي الآخرة على قناطر جهنّم، ليكردسهم فيها إذا وردوها يومَ القيامة»[4].
فالمقصود أنّ الله -سبحانه وتعالى- بالمرصاد، يحصِي جميعَ أعمال العباد، وهو قادر على أخذهم متى شاء وكيف شاء، فقد يعجّل العقوبة في الدنيا، أو يؤخّرها ليوم القيامة، ولا يظلم ربك أحدًا.
فالناس وإن نسوا أعمالهم؛ فإنّ الله لا ينساها؛ بل يُحْصِي جميع الأعمال حتى وإن نسيها العباد، كما قال تعالى: {يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ}[المجادلة: 6].
وقد أخبرَنا اللهُ في كتابه في مواضع مختلفة أنّه وكَّل على بني آدم حَفَظَة من الملائكة يحفظون أعمال العباد ويكتبونها تامّة، وأدلة هذا في القرآن كثيرة، فمن ذلك:
قَالَ تَعَالَى: {وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ * كِرَامًا كَاتِبِينَ * يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ}[الانفطار: 10- 12].
وَقَالَ تَعَالَى: {مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ}[ق: 18].
وَقَالَ تَعَالَى: {هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ}[الجاثية: 29].
وهكذا فإنّ كلّ الأعمال مرصودة صغيرها قبل كبيرها، وإنّ الظالمين أنفسهم سيعترفون يوم القيامة بذلك: {وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا}[الكهف: 49].
بل إنّ الأرض التي نعيش عليها ستُحَدِّثُ بِمَا عَمِلَ الْعَامِلُونَ عَلَى ظَهْرِهَا، كما قال تعالى: {يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبارَها}[الزلزلة: 4].
«عن أبي هريرة قال: قَرَأَ رسولُ اللّه -صلى اللّه عليه وسلم- هذه الآية: {يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا} قال: (أَتَدْرُون ما أخبارها؟) قالوا: اللهُ ورسوله أعلم. قال: (فإنّ أخبارها أنّ تشهد على كلّ عبدٍ وأمَةٍ بما عمل على ظهرها، أن تقول: عمل كذا وكذا يوم كذا وكذا، فهذه أخبارها)»[5].
هذا عن شهادة الأرض، أمّا عن شهادة الجوارح؛ فقد أخبرنا رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- أنّ مِن أهل النار مَن سيعترض على شهادة غيره عليه، فحينها ستنطق الأعضاء وتشهد على الإنسان بما اقترفه، وحُقّ لها أن تشهد: {وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ}[فصلت: 21].
3-العطاء والمنع ابتلاءٌ من الله:
مِن أهمِّ المفاهيم المغلوطة التي تصحِّحها سورة الفجر: ربطُ الإنسان بين إنعام الله عليه وحبّه له ورضاه عنه.
فيعتقد الإنسانُ -جهلًا وغرورًا- أنّ الله -عز وجل- حين يُنْعِم عليه بأيّ نعمة: مال، صحة، سُلْطة، تقدُّم حضاري، وغيرها من نِعَمِ الدنيا؛ فإنّ هذا دليل على أن له كرامة عند الله. فيقول في نفسه: لولا أنّ اللهَ يحبُّني ويرضى عَنِّي لَمَا وَسَّع عليَّ في رزقي، ولَما أعاطني كلّ هذه النّعم، وبعضهم يذهب إلى أبعد من هذا؛ فينسب الفضل لنفسه دون ذِكْر فضل الـمُنْعِم سبحانه.
وفي المقابل إذا حُرِم من بعض هذه النّعم؛ وضُيِّق عليه في الرّزق أو أصابته بعض المصائب في نفسه أو أهله وماله؛ فإنه يظنُّ أنّ هذا دليل على إهانة الله له.
ولا شكّ أن هذه النّظرة القاصرة تضيّع على الإنسان آخرته؛ لأنه يزن الأمور بميزان المادة، لا بميزان الخالق سبحانه وتعالى.
قال تعالى: {فَأَمَّا الْإِنْسانُ إِذا مَا ابْتَلاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ * وَأَمَّا إِذا مَا ابْتَلاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهانَنِ * كَلَّا...}[الفجر: 15- 17].
وقد أجابت السورة عن هذين التصوّرَيْن الخاطئَيْن بكلمة واحدة، هي: {كَلَّا}. أي: ليس الأمر كما تزعمون!
قال ابن القيم: «فَرَدّ اللهُ -سبحانه- على مَنْ ظنّ أنّ سعة الرّزق إكرامٌ، وأنّ الفقر إهانةٌ، فقال: لم أَبْتَلِ عبدي بالغِنَى لكرامته عَلَيَّ، ولم أَبْتَلِهِ بالفقر لهوانه عَلَيَّ، فأخبر أنّ الإكرام والإهانة لا يدوران على المال وسَعة الرّزق وتقديره، فإنّه -سبحانه- يُوَسِّع على الكافر لا لكرامته، ويُقَتِّر على المؤمن لا لإهانته، إنّما يُكْرِم مَنْ يكرمه بمعرفته ومحبّته وطاعته، ويُهِين مَنْ يُهِينه بالإعراض عنه ومعصيته، فله الحمد على هذا وعلى هذا، وهو الغنيّ الحميد، فعادتْ سعادة الدّنيا والآخرة إلى: {إيّاك نعبد وإيّاك نستعين}»[6].
وتأمَّل المثالَيْن المذكورين في السورة جيدًا، وأَعِدْ قراءتهما مرة أخرى، ستجد أن القرآن ذكر كلمة (الابتلاء) في المثالين، ففي حال الإكرام بالنِّعم الدنيوية سمَّاه اللهُ -عز وجل- ابتلاءً: {... ابْتَلاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ...}[الفجر: 15].
وفي حال تقدير الرّزق سمّاه الله -عز وجل- أيضًا ابتلاءً: {... ابْتَلاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ...}[الفجر: 16].
السّرُّ الذي يجعل المؤمن يرى الأمور على حقيقتها:
إنّ السِّرَّ الذي يجعل الإنسانَ يرى الأمور على حقيقتها كما أراد الله، هو أن يعلم أن فترة وجودنا في هذه الحياة الدنيا إنما هي للابتلاء، وهذا المعنى واضح جدًّا لكلّ من اتخذ القرآن منهجًا للحياة.
قال تعالى: {تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ * الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ}[الـمُلك: 1- 2].
وقال تعالى: {إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا}[الكهف: 7].
ففي المنهج القرآني تجد أنّ هذا الأمر واضح جدًّا؛ الدنيا للاختبار ثم الفناء، أمّا الآخرة فهي للجزاء والبقاء، كما قال مؤمن آل فرعون لقومه: {يَا قَوْمِ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ}[غافر: 39].
قارِنْ هذا مع النظرة الغربيّة للحياة، إنهم يظنّون أنهم وُجِدُوا في هذه الحياة فقط للاستمتاع بملذّاتها!
وليت هؤلاء المساكين -وفق هذا التصوُّر والنظرة القاصرة للحياة- استطاعوا أن يعيشوا بسعادة حقيقة؛ إِذ الـمُشاهَد أنّ الذي يلهث وراء مُتَع الدنيا لا يشبع منها أبدًا، فهو دائم البحث عن الأمتع والأمتع ولا يشبع أبدًا حتى يفجأه الموت؛ فتصبح وسيلة سعيه إلى السعادة هي نفس سبب الشقاء.
وهكذا فإنّ نظرة المؤمن الصحيحة للحياة واستحضار قضية الابتلاء في كلّ الأمور من خيرٍ أو شرّ؛ تجعله مطمئنًّا وراضيًا بكلّ ما يحدث له، فهو يعلم:
أنّه في غِناه مُبْتَلَى، هل سيشكر؟!
وأنه في فقره مُبْتَلَى، هل سيصبر؟!
وأنه في صحته مُبْتَلَى، هل سيستعمل هذه النعمة في الخير، وهل سيتواضع؟!
وفي مرضه كذلك مُبْتَلَى، هل سيتسخّط ويَقْنَط؟!
قال تعالى: {وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ}[الأنبياء: 35].
والمؤمن الصادق يكون حريصًا أشدَّ الحرص أن يُرِيَ اللهَ منه عبوديته الخاصّة بالحالة التي عليها أيًّا كانت.
أمّا من اتخذ غير القرآن منهجًا، فإنه إذا تعرّض لابتلاء أو مصيبة كبيرة فوق احتماله؛ فإنه يكون من ضِمْن خياراته المنطقيّة بالنسبة له هو الانتحار، إِذ الدنيا بالنسبة له هي جَنَّته التي لا يَعرف غيرها؛ فإذا تحوَّلتْ إلى جحيم فلا فائدة منها.
ومن أهمية تصحيح هذا المفهوم أنه يحفظ للإنسان دِينَه ويثبِّته على الحقّ؛ ذكَر أحدُ الدّعاة المسنِّين الذين نحسبهم من المخلِصين، نسأل اللهَ أن يتقبَّله في الصالحين، أنه ذات مرّة قال كلمة حقّ، فدخل السجن، فأصابه الغَمّ لذلك في بادئ الأمر، ولكنه بعد أنْ دخل السجن وَجَدَ جُملة مكتوبة أمامه على أحد جدران الزنزانة؛ ويظهر أنها كُتِبَتْ من أحد الذين سُجنوا في هذا السجن مِن قبل، كانت الجملة هي:
«اعلم أنك قد بِعْتَ نفسك لله؛ فإنْ شاء وَضَعَها في قصر، وإن شاء وضعها في سجن»[7].
هذه العبارة كانت بَرْدًا وسلامًا على هذا الداعية، فقال: إنها كانت سببًا عظيمًا في ثباته في محنته، ولعلّها كانت شعارًا له في حياته فيما بعد، إِذْ إنّ الدروس المستفادة بطريقة عملية ممزوجة بالألم أثبتُ في القلب من الدّروس المستفادة بطريقة نظرية، فسبحان الله العظيم، الذي يثبِّت عباده بالقول الثابت في الحياة الدنيا، ولا ندري فقد يكون اللهُ -عز وجل- قَدَّر له هذا البلاء ليثبِّته على طاعته إلى يوم يلقاه، وأنه لولا هذا البلاء لرَكَن إلى الدنيا واطمأنَّ بها وكفى بذلك إثمًا مبينًا.
4- الدنيا ونعيمها لن يدوم لأحد:
في خضمّ انشغال الإنسان بالدنيا وحُطَامها؛ خاصةً المال الذي تملَّك حبُّه شغافَ قلبه، ظنَّ -وساء ما ظنَّ- أنّ هذه النِّعم ستدوم له، أو يدوم هو لها.
ونتج عن هذا الظنّ الخاطئ أنه بخلَ بماله عن اليتيم، ولم يَحُضَّ على طعام المسكين؛ ليتمتع بماله أقصى تنعُّم ممكن في أطول مدّة ممكنة!
بل بلغ به الحرص على المال والانشغال به أنه لم يتفكَّر في حِلِّه وحُرمته: {وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا * وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا}[الفجر: 19- 20].
فيجمع المالَ من أيّ طريق حتى ولو بأكلِ ميراث الضعفاء واليتامى، كما قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لَيَأتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالَ؛ أَمِنْ حَلَالٍ أَمْ مِنْ حَرَامٍ»[8].
في خِضَمِّ هذا كلّه يذكِّرنا اللهُ أن هذه الدنيا لن تدوم، ولن يبقى حالها هكذا.
فيقول -سبحانه-: {كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا}[الفجر: 21].
فتصحِّح السورة مفهومًا خاطئًا يتملَّك الإنسانَ حال استغراقه في النّعم وجَمْعِه للمال، فيظنّ أنّ حاله هذا سيدوم، فيذكّرنا اللهُ بأنّ هذا المفهوم ليس صحيحًا، وأنه سيأتي على الأرض يوم تُزَلْزَل فيه زلزالًا عظيمًا وتُدَكُّ دكًّا رهيبًا.
والشعور بدوام النّعم هذا من الأمور العجيبة التي تتملَّك الإنسان. وقد قصَّ اللهُ علينا قصة عظيمة النّفع لمن تدبَّرها وعاش معها، وهي قصة صاحب الجنَّتَيْن في سورة الكهف:
تلك القصة التي تصف حال الإنسان حال النّعم، وكيف أنه ينسى الـمُنْعِم -سبحانه وتعالى- وينسى أنّ ما به من نعمة فإنما هي بفضل الله وحده، ثم بعد أن ينسى الـمُنْعِم؛ يبدأ في التفاخر بهذا المال كما في القصة: {أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا}[الكهف: 34]. ثم بعدها جاءه هذا الشعور العجيب بأنّ هذا النعيم الذي امتنّ اللهُ عليه به من الجنتين والثمار والنهر وسائر النعم ستدوم أبدًا: {وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا}[الكهف: 35]. ثم تعدَّى الأمر إلى تكذيبه بلقاء الله، فقال: {وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً}[الكهف: 36]. بل إنه تجرّأ على الله، وزعم أنه لو فُرِض أنّ هناك يومًا للحساب والجزاء، فإنّ هذه النّعم سيكون له أفضل منها: {وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا}[الكهف: 36].
وهذا الشعور والتفاخر حالَ النّعمِ ذكَرَه اللهُ في عددٍ من المواضع من كتاب الله، فيردّ القرآن على هذا بحقائق لا تقبل الجدال.
{كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا}[الفجر: 21]. أي: كَلّا أيها الإنسان، ليس الأمر كما زعمتَ. بل سيأتي يوم وتُدَكُّ فيه هذه الأرض دكًّا دكًّا، نَعَم سَتُدَكُّ بما فيها من زينة وزخارف ونِعَم وأموال. أو ربما يأتي يوم قبلها وتزول أنت عن هذا النعيم بالموت.
5-الخسارة الحقيقية هي خسارة النفس في نار جهنم:
من المفاهيم الخاطئة اعتقاد بعض الناس -لقلّة إيمانهم- أنّ الخسارة تكون في خسارة شيء من متاع الدنيا، أو الحرمان من أيّ نِعَم كانوا يأملونها، وأنه حينما يرى الظالم يعيش في الترف بلا عقوبة أنه أفلَتَ بجُرْمه، وأنه لم يخسر شيئًا.
وهذا المفهوم الخاطئ ينغّص على الإنسان عيشته، لكن من ارتدى نظارة الإسلام ونظر إلى الأمور على حقيقتها ووَزَنَها بميزان القرآن، سيعلم تمامًا أنّ الخسارة الحقيقية ليست في خسارة شيء من متاع الدنيا، بل في خسارة النفس والأهل في النار والعياذ بالله.
قال تعالى: {قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ}[الزمر: 15].
فتوجِّه سورةُ الفجر الإنسانَ بأنّ الدنيا ليست دار الجزاء، وأنه يوجَد يوم عظيم يحاسَب فيه الناس أمام الواحد الديّان.
ولو تأملتَ في بداية السورة ستجد أنّ الله -عز وجل- ذكَرَ لنا ما حَلَّ بقوم عاد وثمود وفرعون من العقوبة في الدنيا، وأنّ اللهَ -عز وجل- صبّ عليهم سوط عذاب، وأنه بالمرصاد.
لكن في النصف الثاني منها ذَكَر -سبحانه- ألوانًا أخرى من المعاصي، ولم يذكر لها عقوبة في الدنيا، بل نقلَتْنا السورة بعدها مباشرة إلى يوم القيامة.
{كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا * وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا * وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى}[الفجر: 21- 23].
وهكذا يأتي يوم القيامة، يوم الجزاء، قال تعالى: {وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ}[الزمر: 68].
فيخرج الناس -كلّ الناس- من قبورهم، لقد أحصاهم اللهُ وعَدَّهم عدًّا؛ مليارات البشر يخرجون جميعًا بأمر الله دون أن يُغَادِر منهم أحدًا.
{يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ}[ق: 44].
{خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنتَشِرٌ}[القمر: 7].
ليس البشر فقط مَن سَيُحْشَرون، بل ستُحْشَر جميع الخلائق، حتى الوحوش: {وَإِذَا ٱلْوُحُوشُ حُشِرَتْ}[التكوير: 5].
وستذلُّ جميعُ الخلائق لله -سبحانه وتعالى- لا يخفى على الله من أعمالهم شيء: {يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ}[غافر: 16].
تخيَّل نفسك في هذا اليوم الطويل العصيب، في زحمة الخلائق، وهم خاشعة أبصارهم وأصواتهم: {وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا}[طه: 108].
ستتغير السماوات والأرض تمامًا:
السماوات ستنشق: {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ}[الانشقاق: 1].
الشمس ستتكوّر: {إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ}[التكوير: 1].
النجوم لن تدوم هكذا: {وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ}[التكوير: 2].
الجبال ستكون هباءً منثورًا: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا}[طه: 105].
وهكذا يقف الخلق جميعًا في يوم العَرْض، كلّ إنسان لا يفكِّر إلّا في نفسه.
ثم يؤتَى بجهنَّم ولها سبعون ألف زمام، ومع كلّ زمام سبعون ألف مَلَك يجرُّونها: {وَجِيء يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذّكْرَى}[الفجر: 23].
تصوّر هذا جيدًا بقلبك وعقلك، هذا الموقف الرهيب، حينها ستجثو كلُّ أمّة على رُكَبِهَا من هَوْل المشهد.
كلّ إنسان مشغول بنفسه، لن يَسْأَل عن أقاربه ولا حتى مَن كان أقربهم إلى قلبه في الحياة الدنيا: {يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ * وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ * وَصَاحِبَتِهُ وَبَنِيهِ * لِكُلّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ}[عبس: 34- 37].
أقوى علاقة إنسانية عَرفها البشر على وجه الأرض، هي علاقة الأم بولدها، انظر ماذا يحدث لها: {يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ}[الحج: 2].
ثم تُوزَن الأعمال وتتطاير الصحف، وتتطاير معها القلوب، الجميع يريد أن يعرف مصيره: {فَأَمَّا مَنْ أُوتِىَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ * فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا * وَيَنقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا * وَأَمَّا مَنْ أُوتِىَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ * فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا * وَيَصْلَى سَعِيرًا}[الانشقاق: 7- 12].
إنه يوم القيامة، يوم الحسرة والندامة، يوم الدِّين، وما أدراك ما يوم الدِّين، يوم لا تملك نفسٌ لنفس شيئًا والأمر يومئذ لله.
قال تعالى: {وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ}[مريم: 39].
في هذا اليوم العصيب سيوقن كلُّ إنسان أنّ الخسارة الحقيقية ليست في خسارة شيء من حُطَام الدنيا، بل الخسارة الحقيقية هي خسارة النّفس في عذاب الله: {قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ}[الزمر: 15].
6- الحياة الحقيقية إنما هي حياة الآخرة:
من المفاهيم الخاطئة التي جاءت السورة بتصحيحها: اعتقاد أنّ الدنيا هي الحياة الحقيقية، بل الحياة الوحيدة ولا حياة بعدها!
ونتج عن اعتقادهم ذلك أنْ توسّعوا في الفجور؛ لتحصيل كلّ الملذّات الممكنة في الحياة الوحيدة في نظرهم!
قال تعالى: {بَلْ يُرِيدُ الْإِنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ}[القيامة: 5]: «أيْ: بَلْ يريدُ ليدومَ على فجورِه فيمَا بين يديهِ من الأوقاتِ وما يستقبلُه من الزمانِ، لا يرعوي عنه»[9].
قال الحَسَنُ: «لَا يُلْقَى ابْنُ آدَمَ إِلَّا تَنْزِعُ نَفْسُهُ إِلَى مَعْصِيَةِ اللَّهِ قُدُمًا قُدُمًا، إِلَّا مَنْ عَصَمَهُ اللَّهُ»[10].
ولهذا فإنّ من الأمور المهمّة التي ترسّخها سورة الفجر: معرفة حقيقة الحياة الدنيا وحقيقة الحياة الآخرة.
{يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي}[الفجر: 24].
قد يقول قائل: ما هذا؟! ألَسْنا الآن في حياة؟! فلماذا إذن سيقول الإنسان إنّ الحياة الآخرة هي حياته وكأنّه لا حياة غيرها؟!
الجواب: أنّ هذه السورة العظيمة تصحِّح لنا مفهومًا مُهِمًّا؛ وهو أنّ هذه الحياة التي نحياها الآن بالنسبة للحياة الآخرة ليست حياة حقيقية؛ لأنها فانية، ولذلك سيعلن كلّ إنسان يوم القيامة صراحةً قائلًا: {يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي}.
وظاهر الآية أنّ الذي سيقول ذلك كلُّ إنسان وليس الكافر فقط، فالله يقول: {يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى * يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي}[الفجر: 23- 24].
فالمؤمن والكافر سيُقِرَّان بهذه الحقيقة، وكلاهما سيحصل له الندم.
أمّا ندم الكافر فظاهر ومعلوم؛ فهو قد خَسِرَ نفسَه خسرانًا مبينًا، فهو خالدٌ مخلّد في النار، والعياذ بالله.
وأمّا المؤمن فإنه سيندم؛ لأنه لم يزدد من الأعمال الصالحة، ولأنه سيرى بعينه أهوال يوم القيامة؛ إِذْ ليس الخبر كالمعاينة، فحينها سيحقر جميع أعماله، كما قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لو أنَّ رجلًا يَخِرُّ على وَجْهِه من يومِ وُلِدَ إلى يومِ يَموتُ هَرمًا في مَرضاةِ اللهِ، لَحقَرَه يومَ القيامةِ»[11].
التأكيد على أنّ الحياة الحقيقية هي الحياة الآخرة يؤكّده كذلك قوله تعالى: {وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ}[العنكبوت: 64].
إِذْ كيف نقارن بين هذه الحياة القصيرة والحياة الخالدة الأبدية، قال تعالى: {قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ * قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْأَلِ الْعَادِّينَ * قَالَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ}[المؤمنون: 112- 114].
وقال تعالى: {وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ}[الروم: 55].
وقد بَيَّن الله تعالى حقيقة الدنيا وانشغال الناس بها، ثم مآلهم يوم القيامة بعد انقضائها، كلّ ذلك في آيةٍ، فقال سبحانه: {اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ}[الحديد: 20].
ففي هذا السياق يفهم كُلُّ أحد أنّ الدنيا محقَّرة عند الله، وأنّ الذي ينشغل بهذه الزينة واللهو والتفاخر وينسى الحياة الأبدية التي تبقى ولا تفنى إنما هو مغبون؛ لأنه: {وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ}، ثم ختم اللهُ الآيةَ بحقيقة الدنيا ووصفها بأنها متاع الغرور.
وقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إذا دخل أهلُ الجنةِ الجنةَ يُنادِي منادٍ: إنَّ لكم أن تصِحُّوا فلا تسقَموا أبدًا، وإنَّ لكم أنْ تحيَوا فلا تموتوا أبدًا، وإنَّ لكم أنْ تَنْعَموا فلا تبأَسوا أبدًا؛ وذلك قولُ الله -عز وجل-: {وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ}[الأعراف: 43])[12].
7- لا اطمئنان إلا بالاستسلام لله وحده لا شريك له:
وأخيرًا من المفاهيم الخاطئة: اعتقاد بعض الناس أنّ الطمأنينة يمكن تحصيلها بمعزل عن وحي الله، وأنّ الركون إلى المال أو الجاه أو غير ذلك من حُطَام الدنيا يجلب السعادة والطمأنينة.
وهذا وَهْمٌ شنيع، فلا بد أن يوقن الإنسان أنه لا اطمئنان له إلا بالرجوع لخالقه والإيمان بالله تعالى، والاستسلام والانقياد له والتوكُّل عليه والإنابة إليه والخشوع له وحده لا شريك له.
فحينما تعيش مع سورة الفجر من أوّلها؛ ستجد أنّ الآيات حدَّثَتْنا عن فئة من الناس لم تطمئنَّ قلوبهم إلّا بالقوة والسُّلْطة والمال، وقد جعلَت الدنيا هي غايتها وركَنَتْ إليها واطمأنَّتْ بها، وجعلتها معيارَ كلِّ شيء؛ فإذا أنعم اللهُ -عز وجل- عليها في الدنيا استدلَّت بذلك على خيريَّتها وكرامتها.
ثمّ صحَّحت السورةُ هذا المفهوم الخاطئ وأخبرَتْنا أنّ هذا التصوُّر كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماءً؛ إِذْ لا اطمئنان ولا أمان إلا للمؤمنين الموقِنين.
ولهذا كان ختام هذه السورة العظيمة بهذه الآيات الكريمة: {يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ * ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً * فَادْخُلِي فِي عِبَادِي * وَادْخُلِي جَنَّتِي}[الفجر: 27- 30].
فهؤلاء هم المطمئنّون حقيقةً؛ وما عَداهم في حيرة وشكّ وأمرٍ مريج.
فالطمأنينة والحياة الطيبة لا تكون إلّا للمؤمن، قال تعالى: {مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ}[النحل: 97].
قال أحدُ الصالحين: «لو عَلِمَ الملوكُ وأبناءُ الملوكِ ما نحن فيه من السّرور والنّعيم؛ إذًا لجَالَدُونَا على ما نحن فيه بأسيافهم»[13].
وقال ابن تيمية -رحمه الله-: «إنّ في الدّنيا جَنَّةً مَنْ لم يَدْخُلْهَا لم يَدْخُلْ جَنَّةَ الآخرة»[14].
وقال أيضًا: «ما يصنع أعدائي بي؟ أنا جنّتي وبستاني في صدري، إنْ رُحْتُ فهي معي لا تفارقني؛ إنَّ حَبْسِي خلوة، وقَتْلِي شهادة، وإخْرَاجي من بلدي سياحة»[15].
قال أحدُ السلف: «مساكين أهلُ الدنيا؛ خرجوا منها وما ذاقوا أطيبَ ما فيها. قيل: وما أطيبُ ما فيها؟ قال: محبةُ الله، والأُنْسُ به، والشوقُ إلى لقائِه، والتنعُّم بذِكْرِه، وطاعته»[16].
قل لي بربِّك، مَن عاش بهذه النفسية وهذا التسليم لقضاء الله وأمره، هل سيرى بؤسًا في حياته؟!
كَلّا واللهِ، إنما النعيم نعيم القلب والرُّوح، والمؤمن وإنْ أصابه ما أصابه من البلاء فهو في جَنَّة وسعادة وطمأنينة.
وهكذا، فإنّ ختام السورة بذِكْرِ النفوس المطمئنة؛ يبيِّن لنا أن الذي يُوقن بجميع ما جاء فيها هو الوحيد الذي سينعم بنعمة الطمأنينة.
ففي الدنيا: فهو يعيش في أمن وسلام: {الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ}[الأنعام: 82][17].
وعند الموت: فتبشره الملائكة بلقاء الله، فيقول له مَلَك الموت: اخرجي أيتها الروح الطيّبة كانت في الجسد الطيب، أَبْشِري بِرَوحٍ وريحان وربٍّ غير غضبان، اخرجي راضية مرضية.
وأمّا في الآخرة: فينادَى على رؤوس الأشهاد: أنْ يا فلان بن فلان قد سَعِدْتَ سعادةً لن تشقى بعدها أبدًا.
هكذا إذن جزاء النفوس المطمئنة في الدنيا والآخرة.
خاتمة:
اعتنتْ سورة الفجر بذِكْر بعض الأمور التي بمثابة تصحيح للكثير من المفاهيم المغلوطة في حياتنا، وقد قُمْنَا في هذه المقالة بعرض هذه الأمور، وبينَّا كيف أنّ هذه السورة الكريمة فيها ما يُعِين على تصحيح العديد من تصوّراتنا الخاطئة، وإعادة بناء هذه التصوّرات على نحو صحيح يحقّق للإنسان الخير والبركة والنماء، ويُكْسِبه الطمأنينة والسكينة.
ونسألُ اللهَ تعالى أن يجعلنا من أهل النفوس المطمئنة بالإيمان، وأن يوفّقنا لتدبّر كتابه وفهمه والعمل به؛ إنه وليُّ ذلك والقادر عليه.
[1] التبيان في أَيْمَان القرآن، ص33.
[2] البحر المحيط (5/ 469).
[3] تفسير السعدي، ص784.
[4] تفسير الطبري (24/ 374).
[5] رواه أحمد (8867)، والترمذي (2429)، والنسائي في الكبرى (11693)، وقال الترمذي: «هذا حديثٌ حَسَنٌ غريبٌ صحيحٌ»، وضعّفه الألباني في الضعيفة (4834).
[6] مدارج السالكين (1/ 101، 102).
[7] وهو يعني بهذه العبارةِ قولَ الله: {إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ}[التوبة: 111].
[8] رواه البخاري (1918).
[9] تفسير أبي السعود (9/ 65).
[10] تفسير ابن كثير (8/ 276)، تفسير الطبري (23/ 475).
[11] رواه أحمد (17649)، وحسّنه الألباني في صحيح الجامع (5249).
[12] رواه مسلم (2837) من حديث أبي سعيدٍ الخدري رضي الله عنه.
[13] حلية الأولياء (7/ 370)، الزهد والرقائق للخطيب البغدادي، ص115.
[14] مدارج السالكين (1/ 452).
[15] الوابل الصيب (1/ 67).
[16] إغاثة اللهفان (1/ 72).
[17] وفي القراءة غير المتواترة: {وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللهِ يَهْدَأْ قَلْبُهُ}، أي: يسكُن ويطمئنّ. تفسير القرطبي (18/ 140).
كلمات مفتاحية
الكاتب:

إبراهيم لبيب
حاصل على ليسانس الآداب - جامعة القاهرة، وله عدد من المشاركات العلمية.
مواضيع ذات صلة
((المعلومات والآراء المقدَّمة هي للكتّاب، ولا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع أو أسرة مركز تفسير))