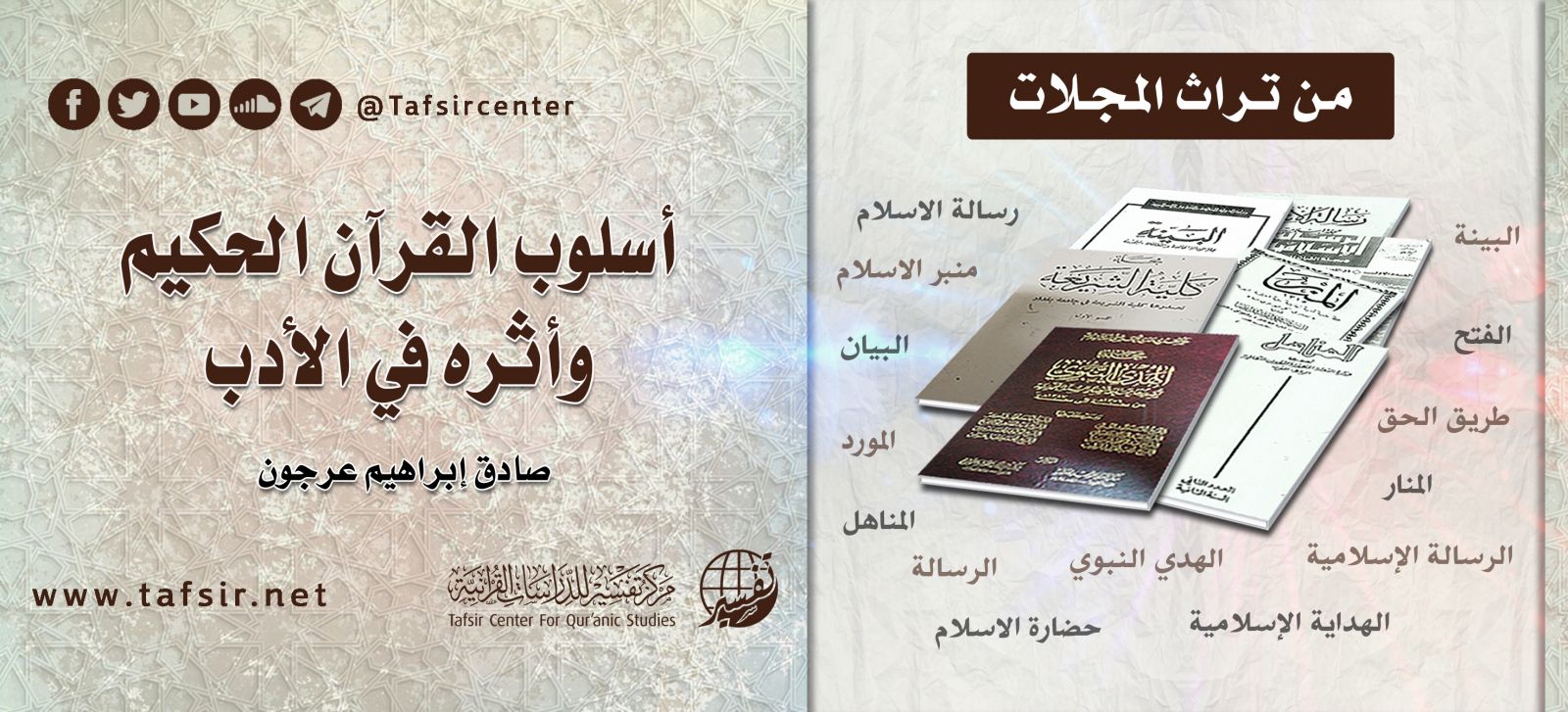نظرات في فاتحة الكتاب الحكيم
نظرات في فاتحة الكتاب الحكيم
الكاتب: محمد عبد الله دراز

نظرات في فاتحة الكتاب الحكيم[1]
{بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ * إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ * اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ}[الفاتحة: 1- 7].
خير ما تفتتح به الأعمال، وتستنجح به المقاصد؛ التوجّه إلى الله العليِّ القدير، ثناءً عليه بما هو أهله، واستمدادًا للمعونة من قوّته، واستلهامًا للرشد من هدايته؛ وتلك هي الخطوط البارزة في سورة الفاتحة: {الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ}[الفاتحة: 2] ثناءٌ على الله تعالى، {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ}[الفاتحة: 5] استعانة بالله سبحانه، {اهْدِنَا الصِّرَاطَ المُسْتَقِيمَ}[الفاتحة: 6] استرشادٌ بنور الله تعالى.
عند هذه النظرة العابرة يقف أكثر الذين يتلون هذه السورة، أو الذين يستمعون إليها، ولعلَّ كثيرًا منهم لا يدركون مِن تسميتها بالفاتحة إلا أنها تحلُّ المكان الأول في صدر المصحف.
ولكن هلمَّ بنا نُلقِ على هذه السورة الكريمة نظرتين أخريين: نظرة في موادِّها ومقاصدها مقارنة بموادِّ القرآن ومقاصده، ونظرة في وجهة خطابها مقارنة بوجهة الخطاب القرآني. وسنجد لها بذلك شأنًا أهمَّ وأعظم.
ولنبدأ بالنظر في إحصاء المقاصد الكلية للقرآن الكريم، وفي مدى احتواء الفاتحة على هذه المقاصد.
فالشؤون التي تناولها القرآن الكريم، على تنوُّعها وكثرتها، نستطيع أن نجملها في أربعة مقاصد، هي في الحقيقة كلّ مطالب الدّين والفلسفة والأخلاق، مقصدان نظريان، هما: معرفة الحقّ، ومعرفة الخير. ومقصدان عمليّان تُثمرهما هاتان المعرفتان إذا قُدِّر لهما أن تُثمِرَا؛ فثمرة معرفة الحقّ هي: تقديس الحقّ واعتناقه، وثمرة معرفة الخير هي: فعلُ الخير والتزامه.
فالقصد النظري الأساسي للقرآن الحكيم هو: تعريفنا بالحقيقة العُليا، صعودًا بنا إليها على معراج من الحقائق الأخرى، فهو يعرِّفنا بالله -تعالى- وصفاته عن طريق توجيه أنظارنا إلى آياته في ملكوت السموات والأرض: في خلق الإنسان والحيوان والنبات، في سير الشمس والقمر والنجوم، في تكوين السحاب، في تسخير الطير، في تصريف الرياح، في ظاهرتي الحياة والموت، وفي سائر الظواهر النفسيَّة والكونيَّة الخارجة عن إرادتنا، وعن إرادة الكائنات كلّها، والتي لا يستطيع العقل السليم أن يفسِّر وجودها، ولا بقاءها ولا تناسقها وتماسكها ووحدة نظامها، إلا بوجود قوة عاقلة قديرة مدبِّرة حكيمة، تقبض على زمام الأمر كلّه، وتوجه العالم كلّه على هذا النحو الموحَّد المعيَّن، المختلف المؤتلف دون ملايين الملايين من الأوضاع الممكنة التي لا بدَّ لها من أن تتناوب على الكون في كلّ لحظة لو ترك أمره لمحض المصادفة والاتفاق، أو لو ترك أمره لقوَّة عمياء صمَّاء طائشة، لا عقل لها، أو لقوَّة مخربة مدمرة باطشة لا رحمة لها، أو لقوَّة عابثة لاهية لاعبة لا هدف لها.
والقرآن حين يرينا صُنع الله -تعالى- في ملكوته لا يقف بنا عند هذه اللوحة العالمية في صورتها الحاضرة، ولكنه يوجِّه نظرنا إلى طرفي الزمان الكوني، فيطلُّ بنا على صورة العالم في ماضيه وفي مستقبله، في بدايته وفي نهايته، كما يوجّه نظرنا إلى طرفي الزمان الإنساني، فيرينا صورةً من صنيع الله في الأفراد والأمم: في ماضيها وفي مستقبلها القريب والبعيد، في إسعادها وإشقائها، في إبقائها وإفنائها، في مثوبتها وعقوبتها.
هذه النظرة الشاملة إلى صنع الله في الأنفس والآفاق، وهذه المعرفة بالله في مظهري عدله وفضله، في صفتي جلاله وجماله إذا وقعت موقعها من النفس تقاضتها حتمًا أن تتخذ لها موقفًا عمليًّا تجاه هذه الحقيقة المقدّسة العليا، وما ذلك إلا موقف التوقير والخشوع أمام هذا العدل والجلال، وموقف الولاء والحب أمام هذا الفضل والجمال، فمَن عرف الله -تعالى- خشعت له نفسه، واطمأنَّ له قلبه، وذلك هو روح العبادة وجوهرها، الخشوع التام عن طوع واختيار، وعن رضى ومحبة.
فإذا كان هذا الأصل النظري الأول، هو معرفة الله تعالى، فالأصل العملي الأول الذي يثمره هذا الأصل؛ هو توقير الله تعالى، ومن جملة هذين الأصلين يتألّف الجانب الإلهي بعنصريه النظري والعملي، والقرآن يفصِّله تفصيلًا، وسورة الفاتحة تجمله إجمالًا في شطرها الأول: {بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ * الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ}[الفاتحة: 1- 4]، وهذه هي المعرفة الأساسية. {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ * اهْدِنَا الصِّرَاطَ المُسْتَقِيمَ}[الفاتحة: 5، 6]، وهذا هو الموقف العملي الذي تثمره تلك المعرفة.
وقبل أن ننتقل إلى الجانب الإنساني، الذي يتناوله الشطر الثاني من السورة، يجمُل بنا أن نقف وقفة يسيرة أمام هذه الحبَّات الدريَّة التي يتألف منها هذا الجناح الأول من السورة لكي نمتّع عقولنا وقلوبنا بتذوّق معانيها، وإجلاء جمال مواقعها، ولنبدأ بهذه الصفات الحسنى: {رَبِّ الْعَالَمِينَ * الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ}[الفاتحة: 2- 4]، شذرات ثلاث انتظمت أركان العقيدة القرآنية الثلاثة، في ترتيبٍ بالغٍ الغايةَ في الإبداع والإحكام: المبدأ، فالواسطة، فالمعاد (التوحيد)، فالنبوّة، فالجزاء.
{رَبِّ العَالَمِينَ}[الفاتحة: 2]: ليس إله قبيلة أو شعب، ليس إله خير أو شرّ، أو إله نور أو ظلام فحسب، ولكنه ربُّ كلّ شيء: بارئه ومصوِّره، منقِّله في أطواره، مبلِّغه غايته، ممدُّه بحاجاته، مبتليه أو معافيه، وبالجملة مربّي كلّ شيء بأنواع التربية الظاهرة والباطنة، هذا هو التوحيد الخالص، وهذا هو ركن المبدأ.
{الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}[الفاتحة: 3]: ليس رحمانًا رحيمًا فحسب، ولكنه هو الرحمن الرحيم، ليس واحدًا من جملة الراحمين، ولكنه -سبحانه- هو المصدر الوحيد للرحمة.
ثم هو ليس ذا رحمة واحدة، ولكنهما رحمتان مفسَّرتان في القرآن: رحمة وسعت كلّ شيء، ورحمة يختص بها من يشاء، فالرحمة الأولى: وسعت الإنسانية جميعها، لا أقول وسعتها بنعمة الوجود والحياة والرزق المادي فحسب، ولا أقول وسعتها بنعمة الهداية الفطرية وكفى، ولكن بنعمة الهداية السماوية نفسها وذلك بإرسال الرسل إلى كلّ الأمم: {وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا}[النحل: 36]، {وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ}[فاطر: 24]. هذه هي الرحمة الأولى؛ الرحمة الأساسية العامَّة، التي هو بها (رحمن) ممتلئ الخزائن بالرحمة، باسط اليدين بالنعمة: {وَآَتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللهِ لَا تُحْصُوهَا}[إبراهيم: 34].
ورحمة أخرى: خصوصية إضافية، علاوة يمنحها -سبحانه- لمن يستحقها، تلك هي رحمة الاصطفاء والاجتباء، والقيادة والإمامة والتوفيق والرشاد، والمزيد من الفضل: {اللهُ يَصْطَفِي مِنَ المَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ}[الحج: 75]، {اللهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ}[الأنعام: 124]، {اللهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ}[الشُّورى: 13]، {وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى}[محمد: 17]، {يَزِيدُ فِي الخَلْقِ مَا يَشَاءُ}[فاطر: 1]، {يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ}[الرعد: 26]. وهذه هي الرحمة التي هو بها رحيم، على هاتين الرحمتين يقوم ركن النبوَّات فهو رحمة عامَّة للمرسَل إليهم، ورحمة خاصَّة للمرسَلين ومَن اهتدى بهديهم، وهذا هو الواسطة بين المبدأ والمعاد.
{مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ}[الفاتحة: 4]: إليه وحده -سبحانه- ترجع الأمور، وبيده تعالى تقرير المصير الأخير، يقف الخلق جميعًا بين يديه مسؤولين، فيدينهم ويجزيهم بما كانوا يعملون، وهذا هو الركن الثالث والأخير، ركن المعاد والجزاء.
عرفنا الآن مغزى هذه الصفات الثلاث ومواقعها فيما بينها، فلننظر إلى موقعها مما حولها، لنرى كيف وقعت بين قضيتين: {الحَمْدُ للهِ} و{إِيَّاكَ نَعْبُدُ}. فكانت تأييدًا لما قبلها، وتمهيدًا لما بعدها، فمنزلتها من قضية الحمد منزلة البرهان من الدعوى، ومنزلتها من قضية العبادة منزلة القوة المحرِّكة من الحركة المطلوبة.
وفي الحقّ أنه إذا كان الله -تعالى- وحده هو الذي أعطى كلّ شيء خَلْقه، وهو الذي كفَل كلّ شيء وتعهده بالإمداد آنًا فآنًا حتى أبلغه مداه، وإذا كان هو -سبحانه- وحده الذي يملك خزائن الرحمة والنعمة كلّها، وهو -تعالى- الذي ينفق منها، وهو -جلّ وعلا- الذي يضاعفها لمن يشاء، وإذا كان هو وحده -تعالى- الذي بيده فصل القضاء، وتقرير المصير، فأيّ شيء أحقّ منه تعالى بنعوت الجمال والجلال؟! بل أيّ شيء غيره -سبحانه- يستحقّ هذا الثناء والإجلال؟! الحمدُ والثناء كله حقٌّ مستحق، خالصٌ مخلصٌ لله تعالى... تلك إذن قضية معها برهانها.
هذا البرهان الاستقرائي، الذي يستقصي مظاهر العظمة والرحمة كلّها في الأزمنة الثلاثة: الماضي، والحاضر، والمستقبل، فيحصرها في الله -تعالى-، هو -سبحانه- في الوقت نفسه قوة دافعة تأخذ بأقطار نفسك وتوجهك إلى غاية معيَّنة عمليَّة؛ فإنَّ نظرة إلى ماضيك وقد أتى عليك حينٌ من الدهر لم تكن شيئًا مذكورًا فتعهَّدك الخلَّاق العظيم في مختلف أطوارك حتى بلغْتَ أشُدَّك وأصبحت سميعًا بصيرًا خصيمًا مبينًا، مستأهلًا لخلافة الأرض، لا بدَّ أن تتقاضاك حقّ الاعتراف له -تعالى- بالفضل والجميل، قيامًا بواجب الرضاء، ونظرة إلى حاضرك وإلى مستقبلك القريب وأنت تتقلب كلّ آنٍ في رحمته، وتطمع كلّ آنٍ في المزيد من نعمته، لا شك تثير فيك نحوه -سبحانه- باعثة الحب والرجاء، ونظرة إلى مستقبلك البعيد وأنت واقف أمامه -تعالى- في ساحة القضاء، وقد علق مصيرك في كفتي ميزانه، لا بدَّ أن تنفث في رُوعك مزيجًا من الرغبة والرهبة والاستحياء.
ماذا يكون موقفك إذن من هذه الحقيقة المحيطة الغامرة، وأنت كلما التفَتَّ إلى أمسِكَ أو إلى يومِكَ أو إلى غَدِك لم تَرَ إلا يدَ جلالها أو يدَ جمالها؟!
النتيجة الطبيعيّة التي لا تستطيع دفعها عن نفسك بعد هذه المقدمات الثلاث، هي أن يضمحلَّ في عينك كلّ ما ترى في الوجود من مظاهر زائفة، وظواهر زائلة، وأن ترتفع فوق العالم كلّه بهامتك، وأن تتحول كلّ رغبتك ورهبتك، إلى هذا المنبع الأول والوحيد لكلّ قوة ورحمة، وهنالك لا يسعك إلا أن ينطلق لسانك في حبّ خاشع قائلًا: أيها الحقّ الجامع المانع، لك كُلِّي، لك صلاتي ونسُكي، ولك محياي ومماتي، إياك أعبد، ولك وحدَك أركع وأسجد. على أنك لو كنت أوسع أفقًا وأيقظ قلبًا، لوجدت نفسك لستَ وحيدًا في هذا الموقف، ولرأيتَ العالم كلّه حولك راكعًا ساجدًا أمام هذه العظمة الباهرة، لا تقل إذن: إياك أعبد، ولكن قل: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ}[الفاتحة: 5]، وهذه هي النتيجة الحقيقية التي أعلنها القرآن الحكيم: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ}[الفاتحة: 5]، لا نعبد إلا إياك، ولا نستعين إلا بك!
ماذا أقول؟ لا نستعين إلا بك! إني لأكاد أسمع من يَهْمس في أذني همسًا يقول لي: أمّا {إِيَّاكَ نَعْبُدُ} فقد فقهناها، وأما {إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} ففي النفس منها شيء؛ إذ مَنْ ذا الذي يطيق هذا الاستغناء الكُلِّي عن معونة الخَلْق؟ أليس الناس كلهم يُعِين بعضهم بعضًا، ويستعين بعضهم ببعض؟ أليس التعاون هو أساس الحياة؟ أليس القرآن نفسه يقول: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقْوَى}[المائدة: 2]؟
بلى أنا أستعين بك، وأنت تستعين بي، ولكننا كأُمَّة والناس والعالم أجمع، بمن نستعين وراء طاقاتنا المحدودة، وحِيَلنا المعدودة؟ ثم إني حين أستعين بك وتستعين بي، فمَن ذا الذي يبعث الباعثة في قلبك لمعونتي وفي قلبي لمعونتك؟ ومَن ذا ييسر لي ولك وسائل هذه المعونة؟ ومَن ذا الذي يُنجِح هذه المعونة ويُؤتيها ثمرتها؟ الله -تعالى- وحده في الحقيقة وفي النهاية هو المستعان.
{إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ}[الفاتحة: 5]: باجتماع هاتين الكلمتين بطل الشرك كلّه: شرك العبادة لغير الله تعالى، وشرك الاستعانة والاستشفاع بما لم يأذن به الله -سبحانه-. وباجتماع هاتين الكلمتين بطلت العقائد المتطرفة كلها: بطلت عقيدة الجبر المحض الذي ينكر قدرتنا ومسؤوليتنا، وبطلت عقيدة الاختيار المحض الذي يدَّعي الاستغناء عن معونة ربنا؛ فنحن نعمل ونتوكل، نعبد ونستعين.
نعبد أولًا.. ونستعين ثانيًا.. نؤدي واجبنا، ثم نطالب بحقوقنا. ألا فليستمع أولئك الذين لا يفتؤون يطالبون بحقوقهم، ولا يبدؤون بأداء واجباتهم.. إنهم لم يتأدبوا بأدب القرآن.. ألا فليصححوا موقفهم من فاتحة الكتاب، التي يردِّدونها في صلاتهم كلّ يوم سبع عشرة مرة على الأقل.
هكذا عرفنا الله -تعالى- بصنيعه في الآفاق وفي أنفسنا، عرفناه فيما صنع، وفيما يصنع وفيما سوف يصنع، عرفناه بعقولنا وقلوبنا، ثم توجَّهنا إليه -سبحانه- بعزائمنا وبرغائبنا.
هذا الجانب الإلهي: نظريّهُ وعمليّهُ، يمثل نصف المهمّة القرآنية، وقد رأينا كيف جمعَتْه سورة الفاتحة في شطرها الأول.
غير أنَّ الإنسان ليس كائنًا روحيًا محضًا، حتى تكون كلّ رسالته في الحياة أن يتأمَّل في صنع الله -تعالى-، وأن يمتلئ إعجابُه به -سبحانه-، إنَّه كائن مزدوج: عبدٌ لله -تعالى-، وسيد للكون، إنَّه خليفة في الأرض، مسؤول عن عمله في خلافته، كما هو مسؤول عن موقف عبوديته.
الله -تعالى- يخلق ويصنع، والإنسان يعمل ويكتسب: حياته الطبيعيَّة تتقاضاه أن يعمل، وحياته النفسيَّة تتقاضاه أن يعمل، وحياته في أسرته وفي بيئته وفي أُمَّته وفي الأسرة الإنسانية وفي علاقته الروحية، كلّ هذه جميعًا تتقاضاه أن يعمل.
فلننتقل إلى هذا الجانب الإنساني، إلى عمل الإنسان، هو جانب يتألّف كذلك من عنصرين: عنصر نظري تعليمي، نرى فيه نماذج الأعمال الإنسانية في مختلف صورها؛ جميلها ودميمها، حميدها وذميمها. وعنصر عملي تنفيذي، هو صدى تلك المعرفة، وثمرة تحريكها لعزائمنا.
ولنبدأ بالعنصر النظري: كيف عرض القرآن علينا صور العمل الإنساني؟
إنَّه يتبع في ذلك مَنْهجًا مُزدوجًا، يجمع بين القيم الذاتيَّة والقيم العرضية للأخلاق والسلوك، منهج القيم الذاتية الذي يخاطب الضمير، يدعو إلى الفضيلة باسم الفضيلة، مصورًا ما فيها من جمال واعتدال، وينهى عن الرذيلة باسم الرذيلة، مبينًا ما فيها من دنَس وانحراف.
ومنهج القيم العرَضية الذي يخاطب العاطفة؛ يُرغِّب في الفضيلة، ويُنفِّر من الرذيلة باسم المصلحة الحقيقية، ويحكمُ النَّظر إلى عواقب الأمور وآثارها في العاجل والآجل، ويضرب لذلك الأمثال الكثيرة، ويقصُّ من أجل ذلك السير التاريخية في مختلف العصور.
والعجيب من شأن سورة الفاتحة أنَّها على فرط إيجازها قد انتظمت المنهجين جميعًا في كلمتين! ذلك أنها حين حبَّبت إلينا طريق الفضيلة بيَّنت لنا -أولًا- قيمته الذاتية، فوصفته بالاعتدال والاستقامة: {الصِّرَاطَ المُسْتَقِيمَ}[الفاتحة: 6]، ثم بيَّنت ما في عاقبته من نفع وجدوَى، فوصفته بأنَّه الطريق الموصل إلى رضوان الله -تعالى- ونعمته، وأشارت في الوقت نفسه إلى مُثُله التاريخية في سيرة أهله الذين نصَّبوا أنفسهم للقدوة الحسنة: {صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ}[الفاتحة: 7]، من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.
ثم لم تكتفِ بذلك بل وضعَتْ مِعْيارًا لأنواع الطرق المنحرفة فبيَّنَت أنَّ الانحراف على ضَرْبين: انحراف عن قصد وعلم؛ عنادًا واستكبارًا، واتِّباعًا للهوى، وهذا هو طريق: {المَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ}[الفاتحة: 7]، الذين رأوا سبيل الرشد فلم يتخذوه سبيلًا، ورأوا سبيل الغيِّ فاتخذوه سبيلًا. وانحراف عن جهل وطيش، وهذا هو طريق {الضَّالِّينَ}[الفاتحة: 7] الذين لا يتوقفون عند الشكّ، بل يقتفون ما ليس لهم به علم، فيخبطون خبط عشواء، دون تثبُّت ولا تبصُّر.
لا ريب أنَّ كِلا الضَّرْبين مذموم، وإنْ كان بعضهما أسوأ من بعض: العالِم المنحرف مأزور، والجاهل المنحرف غير معذور، والعالِم المستقيم هو المبرور المأجور.
هذه المشارب الثلاثة نجد دائمًا أمثلتها في الناس، لا في الخلق والسلوك فحسب، بل في كلّ شأن من الشؤون: في الاعتقاد، والرأي، والتعليم، والإخبار، والفُتيا، والحكم، والقضاء. وهكذا جاء في الحكمة النبويَّة: «قاضٍ في الجنة وقاضيان في النار؛ فالقاضي الذي في الجنة رجل عرف الحقّ فقضى به، واللذان في النار رجل عرف الحقّ فقضى بخلافه، ورجل قضى للناس على جهل».
من استحكمت معرفته بهذا الأصل النظري، وتبيَّنَت له مسالك الهدى والاستقامة، ومسارب الاعوجاج والضلالة، ماذا يكون موقفه العملي منها؟
لا ريب أنَّ العاقل الرشيد يلتمس من هذه الطرق أقومها، ويطلب أسلمها، ويتوجه بعزيمته إلى أحسنها.
وهذا الالتماس والطلب والتوجه هو الذي ترجمته لنا سورة الفاتحة في كلمة واحدة: {اهْدِنَا}، اهدنا الصراط المستقيم.
وهكذا نرى السورة الكريمة قد انتظمت المقاصد القرآنية الأربعة: الجانب الإلهي نظريّه وعمليّه، والجانب الإنساني نظريّه وعمليّه، كلّ ذلك في أوجز عبارة وأحكم نسق.
سورة الفاتحة إذن هي خريطة القرآن وفهرست موادّه، إنها جوهرة القرآن ونواته ولبُّ لبابه، فهي بحقٍّ (أُمّ القرآن).
كانت هذه هي النظرة الأولى، قارنَّا فيها بين موادّ الفاتحة ومواد القرآن.
وبقيت نظرة ثانية سريعة، نقارن فيها بين أسلوب الخطاب في الفاتحة، وأسلوب الخطاب في القرآن، ماذا نرى في هذين الأسلوبين؟
نرى اتجاهين مختلفين تمام الاختلاف:
فسورة الفاتحة هي السورة الوحيدة، التي وضعت أول الأمر، لا على لسان الربوبيَّة العليا، ولكن على لسان البشريَّة المؤمنة؛ تعبيرًا عن حركة نفسيَّة جماعيَّة مُتطلعة إلى السماء، بينما سائر السور تعبِّر عن الحركة المقابلة، حركة الرحمة المرسلة من السماء إلى الأرض، وهكذا حين ننظر إلى القرآن في جملته نراه يتمثَّل أمامنا في صورة مُناجاة ثنائيَّة، الفاتحة أحد طرفيها، وسائر القرآن طرفها الآخر، الفاتحة سؤال، وباقي القرآن المطلوب.
فلننفذ بهذه النظرة إلى نهايتها، فإنَّها ستعود إلينا بحصيلة ثمينة من العِبَر النفيسة، أول ما نلتقطه من هذه العبر أنَّ القرآن (وهو دستور الإسلام) لو جاءنا بدون الفاتحة لكان دستورًا وافدًا على الأُمَّة، طارئًا عليها، يعرض نفسه عليها عرضًا، أو يفرض عليها فرضًا، أو يمنح لها منحة، فليكن مع ذلك حقًّا كلّه، وخيرًا كلّه، وهدًى كلّه.
لكنه لو لم تطلبه الأمة، ولو لم تعلن حاجتها إليه، لكان لها أن تستقبله كما تستقبل البضاعة المعروضة بغير طلب، وأن تقول له زاهدة فيه: لا حاجة بي إليك، أمّا الآن فالموقف يختلف كلّ الاختلاف.
إنَّ موقع الفاتحة هنا موقع القرار الجماعي الذي تُعلِن به الأُمَّة المؤمنة حاجتها إلى هذا الدستور وتؤكِّد مُطالبتها به، وإنّ موقع القرآن كلّه بعد الفاتحة هو موقع القبول والاستجابة لهذا المطلب، فما هو إلا أن أعلن المؤمنون مَطْلبهم هذا قائلين: {اهْدِنَا الصِّرَاطَ المُسْتَقِيمَ}[الفاتحة: 6]، وإذا بالقرآن يزفُّ إليهم هديته وهدايته قائلًا لهم: دونكم الهدى الذي تطلبونه، فكانت أول كلمة في القرآن بعد الفاتحة هي: {ذَلِكَ الكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ}[البقرة: 2]، وهكذا جاءهم على ظمأ وتعطش، فكان أنفع لغلَّتهم، وكان أكرم في نفسه وعلى الناس مِن أن يتعرَّض للمُعرِضين عنه، أو أن يُلزِم مَن هم له كارهون، وكان فوق ذلك كلّه أقطع لحججهم ومعاذيرهم في إهماله ونسيانه لو أهملوه أو نسوه فيما بعد، ذلك أنَّه لم يُلزِمهم إلا بما التزموا، ولم يجئهم إلا بما طلبوا، وخير الدساتير ما نبع من حاجة الأمَّة، وكان تحقيقًا صريحًا لمطامحها الرشيدة.
لم تكتفِ الأمَّة المؤمنة بأنها طالبت بهذا الدستور، ولكنها اختارت وحدَّدت السلطة التي تقوم بوضع هذا القانون الأساسي، وتوجَّهت بخطابها إلى هذه السلطة نفسها، ونصَّت في صلب قرارها على المؤهلات الممتازة التي كانت سببًا في هذا الاختيار والتحديد، فلقد طلبت أن يكون هذا التشريع من عمل المشروع الأعظم الأكرم، المعروف بخبرته التامَّة في التربية العالمية: {رَبِّ العَالَمِينَ}[الفاتحة: 2]، وبعطفه الشامل على مَطَالب الرعيَّة {الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}[الفاتحة: 3]، ثم أعلنت في صلب قرارها أنَّ المسؤوليَّة النهائيَّة لجميع السلطات التنفيذيَّة ستكون أمام هذه السلطة التشريعيَّة العليا: {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ}[الفاتحة: 4].
ثم لم تكتفِ الأمَّة المؤمنة بهذا كله، بل إنَّها وضعت الإطار الذي يَلزم أن يقع هذا التشريع في داخل حدوده، ورسمت المبادئ الأساسيَّة التي يجب أن يقوم عليها، فطالبت بأن يكون تشريعًا لا يَميل مع الهوى يَمْنةً أو يَسْرةً، وتشريعًا لا يقوم على فكرة المحاباة لفرد أو لطائفة أو لشعب، ولكن يمثل العدل الصارم، والصراط المستقيم.
وأخيرًا: لم تقنع في وصف هذا التشريع بتلك الأوصاف العامّة والألقاب الكليَّة، بل حدَّدت نموذجه ومثاله من الواقع التاريخي، فطالبت بأن يكون من فصيلة التشريعات الفاضلة المعروفة التي جرّبت فائدتها، وتحقّق حسن عاقبتها، شرعة الذين أنعم الله عليهم بالتوفيق والرشاد.
إذا نظرنا إلى الفاتحة من هذه الزاوية فإنه يحقُّ لنا أن نقول: إنَّ القرآن إذا كان هو الدستور، فالفاتحة هي أساس الدستور.. بل لو صحَّ هذا التعبير، لقلنا إنَّها دستور الدستور.
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم
[1] نشرت هذه المقالة في مجلة (المجلة)، العدد 7، ذو الحجة 1376هـ، 1957م. (موقع تفسير).
كلمات مفتاحية
الكاتب:

محمد عبد الله دراز
أحد أعلام الأزهر الشريف، وعضو هيئة كبار العلماء، وله عدد من المؤلفات.
مواضيع ذات صلة
((المعلومات والآراء المقدَّمة هي للكتّاب، ولا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع أو أسرة مركز تفسير))