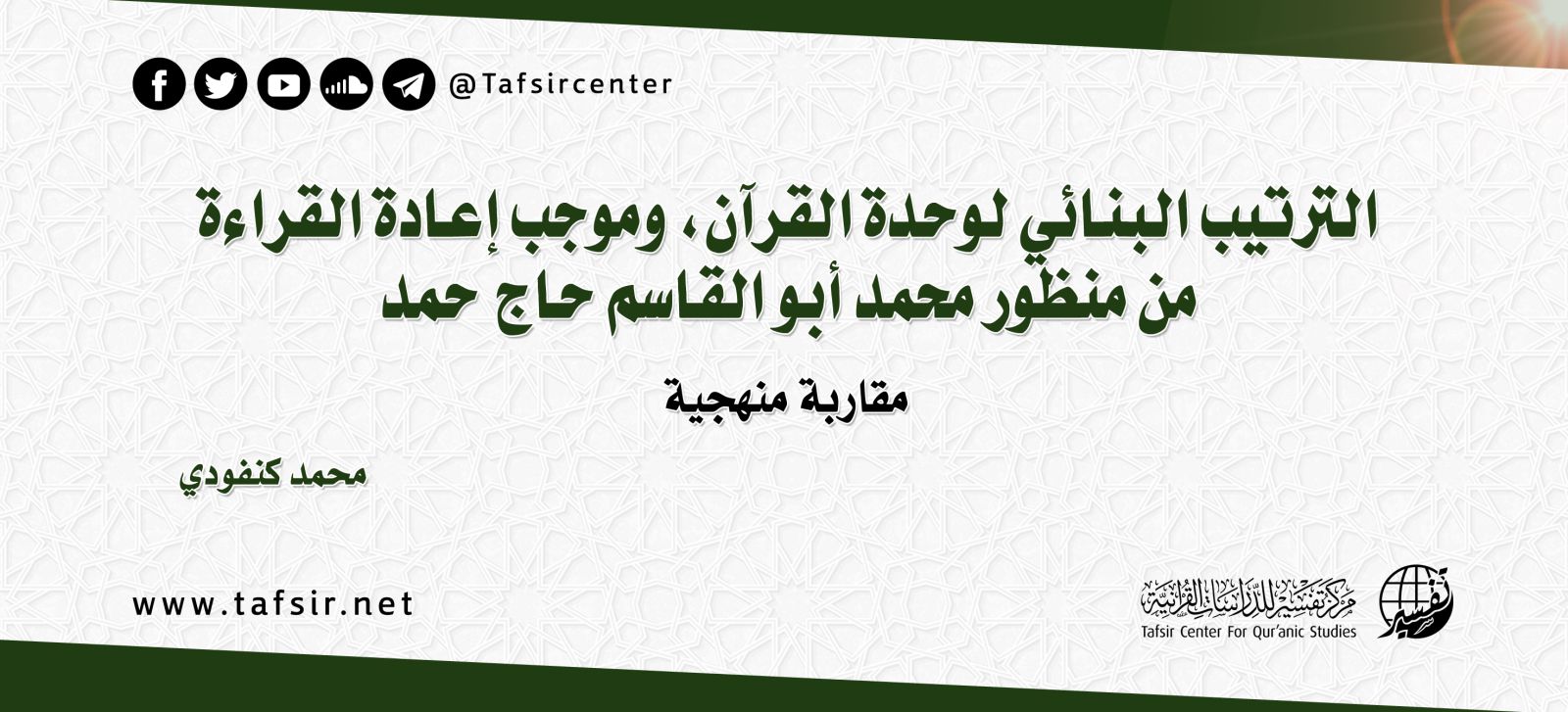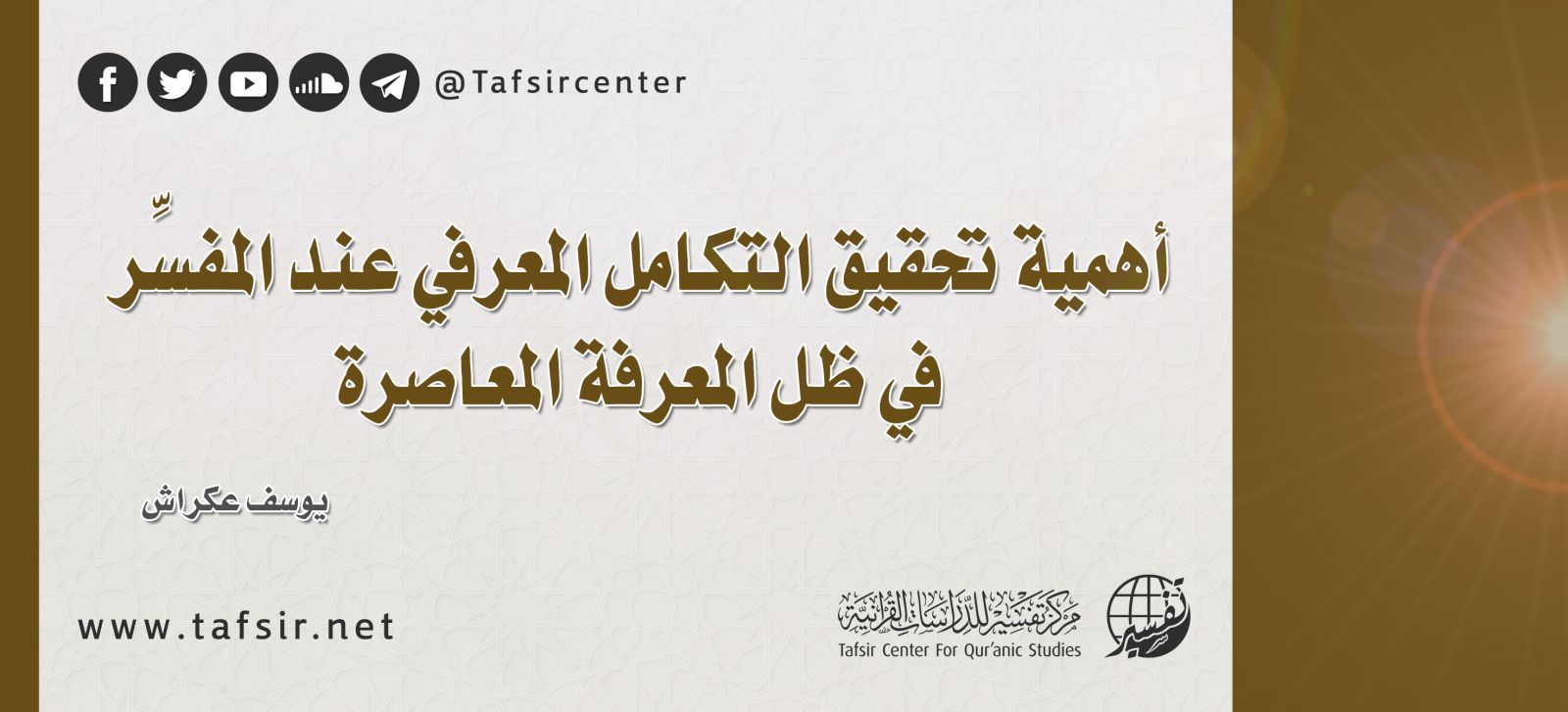القراءة المعاصرة للقرآن لمحمد شحرور (2-4)
الضوابط المنهجية للقراءة
الكاتب: محمد كنفودي

تسهيم:
يقول محمد شحرور: «لا يسعني ما وسع الصحابة في فهم الكتاب والقرآن؛ لأنّ أرضيتي العلمية تختلف عن أرضيتهم، ومناهج البحث عندي تختلف عمّا كان عندهم، وأعيش في عصر مختلف تمامًا عن عصرهم، والتحديات التي أواجهها تختلف عن تحدياتهم... وأكون متوهّمًا إذا قلتُ أو قبلتُ بأنه يسعني ما وسِعَهم»[1].
مقدمة:
نتناول في هذه المقالة بالعرض والتحليل، الضوابط المنهجية التي تتأسّس عليها القراءة المعاصرة لنصوص التنزيل الحكيم من منظور محمد شحرور، بوصفها نموذجًا إمكانيًّا، قصد التعرف على ماهياتها القائمة جمعًا على ناظم (المعاصرة) أو صفة (الجديدة)، ما دام أنه رفض جملة الضوابط المنهجية لعلم التفسير الذي أسّسه أهل التفسير التراثي في عدّة أزمنة متتالية، بالنظر إلى جملة المآخذ التي أخذها على النموذج التراثي في تفسير النصّ القرآني، كما ظهر ذلك في المقالة الأولى[2]، ومن أهم الضوابط المنهجية التي تشكّل عَصَب منهج القراءة المعاصرة لمحمد شحرور، نورد ما يلي:
أولًا: نَصّ الوحي المنزل ليس تُراثًا ولا جُزءًا من التراث، ولا يَتَعيّن النظرُ إليه كالنظر إلى نُصُوص التراث الإسلامي أو الإنساني:
اعتبر محمد شحرور أنّ نصّ الوحي المنزل لا علاقة له بما هو تراثي زمنًا وإنشاءً للأقوال لا من قريب ولا من بعيد، إلا على مستوى أنه أنزل في زمكانٍ معيّن. وخصيصة التعالي التي له بالأصل الأول تخلّصه من كلّ ذلك جملةً وتفصيلًا، ومن كلّ ما يوحي بكونه رهين ارتباط زمكاني أو شخصي، وترفعه إلى مقام كأنه أنزل علينا الآن[3]. وفي المقابل، يعدّ كلّ ما أنتجه الناس حوله وفي ظلاله تراثًا محضًا، خاضعًا لمحض النقد التاريخي؛ سواء صدر عن الرسول -عليه الصلاة والسلام-، أو عن الصحابة، أو عن التابعين، أو عن غيرهم[4]؛ بوصف كلّ ذلك هو تفاعل تاريخي مرحلي نسبي محض، أما التمسك بنصوص تفسيرية تراثية معيَّنة، بدعوى أنها مما (اتفق عليه الجمهور) أو (العلماء)؛ فقد أدى ذلك إلى نتيجتين في غاية الخطورة، وهما: استبدال النصّ الثاني (المذهب أو الرأي) بالنصّ المؤسِّس (التنزيل الحكيم)[5]، تحويل الاجتهادات التفسيرية التاريخية إلى نقلية محضة، بدل النظر إليها بوصفها مجرد إمكان عقلي اجتهادي، من جملة إمكانات عقلية اجتهادية عديدة، مما حوّلها إلى نصوص مقدّسة أكثر من المقدّس نفسه، وكلّما بعُد الزمن عن لحظتها الثقافية ازدادت قداسةً، فماتت أو ضعفت النظرة النقدية إلى النصوص التراثية في تاريخ الفكر الإسلامي[6].
ثانيًا: لا نَاسخ ولا مَنسوخ بين نُصُوص الوحي المنزل حُكمًا ودلالةً:
يُسلِّم محمد شحرور بدايةً أنّ النسخ كما أصَّلته العلوم المنهجية للتفسير التراثي، تعريفًا وتقسيمًا وتنويعًا[7]، لا وجود له إطلاقًا داخل فضاء نصّ الكتاب المنزل؛ إِذْ لكلّ حكم من أحكام الآيات حقل ومجال للعمل به إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها[8]، وهو إنْ وجد، فهو متحقّق الوجود حصرًا بين الرسالات السماوية في ما بينها، فالرسالة اللاحقة: (مثل رسالة محمد عليه الصلاة والسلام)، تنسخ بعض أحكام الرسالة أو الرسالات السابقة عليها: (مثل رسالة موسى وعيسى عليهما السلام)،[9] ومما يدلّ على ذلك:
1. يقول الله تعالى: {مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ * مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ}[البقرة: 105، 106].
2. يقول أيضًا: {...وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ}[آل عمران: 50].
3. يقول أيضًا: {...وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ...}[الأعراف: 157].
والنسخ بين أحكام الرسالات السماوية المنزلة ليس من باب إلقاء الحبل على الغارب، بل لا يكون ولا تتحقق ماهيته الموضوعية إلا بشروط محددة، منها:
1. أن يكون النسخ واقعًا على آيات الأحكام (أُمّ الكتاب تحديدًا) دون غيرها[10].
2. أن تكون الآية المنسوخة عينية مشخصة، والآية الناسخة تقترب من التجريد؛ لتتناسب مع تطوّر الإنسانية من (التشخيص إلى التجريد).
3. أن يكون التشريع في الآيات الناسخة متجهًا نحو التخفيف فيما يتعلق بالعقوبات، وليس نحو التشديد، ونحو توسيع الحلال على حساب تضييق الحرام[11].
انطلاقًا من آية البقرة (106) السالفة الذِّكْر، تبيّن لمحمد شحرور أنها تنصّ على ثلاثة أنواع من النسخ، متحقّقة في علاقة ما أنزل على محمد -عليه الصلاة والسلام-، بما أنزل على موسى -عليه السلام- من آيات تتعلق بالأحكام، وهي:
1. أحكام من شريعة موسى -عليه السلام-، يوجد ما يماثلها في أُمّ الكتاب (نسخة طبق الأصل): {أَوْ مِثْلِهَا}[12].
2. أحكام من شريعة موسى -عليه السلام-، يوجد خير منها في الكتاب المنزل (وفي الموضوع نفسه): {نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا}[13].
3. أحكام من شريعة موسى -عليه السلام-، ظلّت سارية المفعول في عهد الرسول -عليه السلام- وطبّقها، ثم أنزل في أُمّ الكتاب خير منها، اتجهت نحو التخفيف والتجريد (الإنساء): {أَوْ نُنْسِهَا}[14].
وللتدليل أكثر على منظور محمد شحرور القائم على انتفاء النسخ بين أحكام آيات أُمّ الكتاب من نصّ التنزيل الحكيم، نسوق المثال الآتي:
رأى أهل القول بالنسخ أن قوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ}[النور: 2] نَسَخ قوله تعالى: {وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا * وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا}[النساء: 15- 16]. أما محمد شحرور فيرى أن لا ناسخ ولا منسوخ بين نصّ سورة النور ونصّ سورة النساء، وللنصوص ساحة اتباع في كلّ زمان ومكان؛ ذلك أن الآية (15) من سورة النساء، تتناول مفهوم الفاحشة بين النساء حصرًا، وهو ما يسمى بـ(السحاق)، ونصّت على عقوبة الإمساك في البيوت. أما الآية (16) من سورة النساء، فتتناول مفهوم الفاحشة بين الرجال حصرًا، وهو ما يسمى بـ(اللواط)، وقد تركت تحديد العقوبة العينيّة الحدّية لاجتهاد التشريع الإنساني. أما آية النور [2] فتتناول مفهوم الزنى بين ذكر وأنثى دون عقد شرعي، وقد نصَّت على عقوبة الجلد (مائة جلدة)[15].
ثالثًا: تَنزيهُ نَصّ الوحي المنزل عن الترادف بين مُفرداته وتَراكيبه، والتناوب بين حُروفه، والزائد زيادة حَشو في نصوصه:
استقرّت علوم منهجية التفسير الموروث على أن مركبات نصّ التنزيل الصغرى والكبرى، تتطابق من حيث الدلالة تطابقًا كليًّا، فأدى القول بذلك إلى وجود الترادف بين المفردات، ومقتضاه «وجود العديد من مفردات التنزيل الحكيم لها نفس الدلالة»، مثل: الأب والوالد، الجُبّ والبئر، جاءَ وأتَى، القول والنطق، وقِس على ذلك جملة تراكيب. وأيضًا التناوب بين الحروف، ومقتضاه «وجود العديد من حروف نصّ الكتاب المنزل تؤدي نفس الوظيفة». مثل: (في) مكان (على)، (الباء) مكان (عن)، (اللام) مكان (على) ونحو ذلك[16]. والقول بذلك كان يتناسب مع النظام المعرفي السائد وقتئذٍ، إِذْ كان في الغالب يقوم على المَرويات[17]، القائمة على الرواية بالمعنى، وهي تعبر عن نفس المعنى بصيغ تعبيرية عديدة ومتعدّدة، بالنظر إلى الراوي أو الناطق؛ لذا يتعين القطع مع كلّ ذلك كليًّا؛ لكون القول به أدى إلى أن فَقَدَ نصُّ التنزيل متانته وبيانه[18]. فإذا كان العلم الذي هو صناعة إنسانية محضة لا يقبل بذلك، إِذْ يعطي لكلّ مدلول دلالة، ولكلّ مُكوّن اسمًا خاصًّا لا يشاركه فيه أحد سواه، من باب مراعاة الدّقة العلمية، فكيف نقبل ذلك في كلام الله رب العالمين الصادر عن الحكيم الخبير؟! وعليه؛ فإنّ دقة نصّ التنزيل لا تقلّ أبدًا عن دقّة العلوم الفيزيائية والكيميائية والرياضية وغيرها[19]، علاوةً على أنّ القول به -كما يصرح محمد شحرور- يعدّ من أعظم آثار الاستبداد على دلالات وأحكام نصّ التنزيل الحكيم[20].
بناءً على ما سبق، نعمد إلى تقديم النموذج لتوضيح المنظور، وهو:
يقول الله تعالى: {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ[21] الْهَوَى إِنْ هُوَ[22] إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى}[النجم: 3، 4]. يرى محمد شحرور أنّ منهج تعامل التفسير التراثي مع نصّ التنزيل، لمّا سلَّم بوجود الترادف فيه؛ سواء على مستوى المفردات أو التركيب، فاته الكشف عن فَرادة نصّ الكتاب؛ إفرادًا وتركيبًا واستعمالًا ودلالةً، ومما يدلّ على ذلك أنّ أهل التفسير التراثي انطلقوا من مبدأ الترادف بين (القول) و(النطق) لكي يبرهنوا على أن الوحي وحيان: وحي الكتاب ووحي السنة، وهذا الأمر تأسّس ابتداءً من الشافعي في الرسالة، فصار بمثابة ما هو مُسلَّم/مقدَّس لا يعاد فيه النظر؛ لكونه قد أحكمت حوله سياجات دوغمائية مغلقة[23]. ومن باب إعادة النظر وتأصيل الأصول من جديد، اعتبر محمد شحرور أن الوحي هو وحي الكتاب فقط دون سواه؛ بمعنى القطع المطلق مع كون السنة وحيًا مستقلًّا نظير وحي الكتاب، وتأصيله للمسألة انطلق من الأسس الآتية:
أ. إنكار الترادف بين مفردة (القول) ومفردة (النطق) في نصوص التنزيل الحكيم. مع التأكيد على ضرورة التمييز بينهما دلاليًّا؛ فمفردة (النطق) مفادها: البيان بطريقة إبلاغ صوتية مباشرة، برباط منطقي عقلاني بين الألفاظ، بوجود مسند ومسند إليه، وهو ما يطلق عليه (الجانب النحوي في الكلام). فالنطق رهين بإخراج أصوات الحروف لفظًا من الفم لتؤلِّف مفردات ثم جُمَلًا ثم نصًّا، وهو قوة تكوينية أوجدها الخالق -سبحانه- في المخلوق، تتم من خلال الشفاه والأوتار الصوتية، وغايته الإسماع، ولا يحتاج معها المخلوق الإنساني إلى وحي لكي ينطق[24]، ومنه جاء المنطوق، وهو اللفظ المسموع المعقول الذي يحمل معنى. والنطق بهذا المعنى: {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى}، هو وظيفة الرسول -عليه الصلاة والسلام-، فهو ناطق بمعنى مُسمِعٍ غيرَه ما أُوحِي إليه من قِبل الله تعالى، عن طريق جبريل -عليه السلام-، فهو بالتبَع مُتَّبِع. أما (القول) فمفاده: مادة الكلام الأصلي الأول، الحامل لمعنى المراد من البيان العلَني، من المتكلم إلى السامع، وغايته الإفهام، لتحقيق التكليف به[25]. وعليه؛ فإنّ نصّ التنزيل قائله الله تعالى، وقد نطق به الرسول -صلى الله عليه وسلم-، بمعنى لا دخل للرسول في ذلك، إلا على مستوى التبليغ والبيان كشفًا وإظهارًا. يقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ}[المائدة: 67]. وقوله سبحانه: {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ}[النحل: 44]. وقوله أيضًا: {وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ}[النحل: 64].
ب. توجيه دلالة قوله تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا}[الحشر: 7]. استدلّ أصحاب نظرية أن الوحي وحيان؛ وحي الكتاب ووحي السنة، بهذه الآية للتدليل على وحي السنة النبوية. لكن محمد شحرور يرى أن الآية أعلاه لا تحمل أيّ وجه من وجوه الاستدلال على ما ذهبوا إليه، لِما يلي:
* إنّ سياق النصّ يتحدث عن توزيع الفيء، ولا علاقة له بمفهوم السنة بالمعنى المعهود. يقول الله تعالى: {مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ}[الحشر: 7]. وعليه؛ فما قضى به الرسول -عليه السلام- أخذًا ومنعًا (التوزيع)، وجب التقيد به؛ بوصفه اجتهادًا من (مقام النبوة)، وهو اجتهاد مرحلي تاريخي، مقيد بما كان سائدًا وقتئذ[26].
* إنّ انطلاقهم من مبدأ الترادف بين مفردة (جاء) و(أتى)، أبعدهم عن التوصل إلى إدراك دقائق دلالات نصّ التنزيل. ومن باب (لا ترادُفَ في نصّ الكتاب)، اعتبر محمد شحرور أن مفردة (أتى) تعني أن يكون التنصيص عن الحكم للفعل صادرًا من الداخل/من الذات؛ ذلك أن الرسول -عليه السلام- أصدر حكمه في طريقة تقسيم الفيء، انطلاقًا من اجتهاده الشخصي من (مقام النبوة). أما مفردة (جاء) فتعني أن يكون التنصيص عن الحكم للفعل صادرًا من خارج الذات، ويكون بذلك الرسول -صلى الله عليه وسلم- مبلِّغًا ومبيِّنًا. يقول تعالى: {يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا}[مريم: 43][27].
ج. إنّ القول بوحي السُّنة؛ بمعنى أنها من عند الله وحده مثل نصّ الكتاب المنزل، ولا دخل للرسول في ذلك إلا على مستوى التبليغ، وأنها تتميز بمثل ما يتميز به، يطرح إشكالًا مفاده: هل وحيها جاء إلى الرسول -عليه السلام- باللفظ والمعنى، أم بالمعنى والنبي -عليه السلام- صاغه بلغته زمن النزول، ولو كان الأمر كذلك، لَتعيَّن القول قبل النطق بحديثٍ ما: (قال الله) لا قال الرسول، وعند الانتهاء (صدق الله) لا صدق الرسول، ولو كان الأمر -ثانيًا- كذلك، لماذا لم يتم حفظ وحي السنة، كما تم حفظ وحي الكتاب من التلاعب، تحريفًا ووضعًا، ولو كان الأمر -ثالثًا- كذلك، لكان وحي السنة قد وصلنا كلّه، مثل ما وصلنا وحي الكتاب كلّه محفوظًا[28].
رابعًا: قراءة نَصّ الوحي المنزل مَفصولًا عن كلّ ما قيل في شأنه من تفسيرات:
مُنذ انتهاء (زمن النزول) بوفاة الرسول -عليه الصلاة والسلام-، تعاقبت على نصّ الكتاب المنزل العديد من (أزمنة التأويل)، وكلّ (زمن تأويلي) يكون محكومًا في الغالب بأدوات وأرضية معرفية معيّنة، ونظام فكري محدّد لمجمل الرؤى والنظريات. وعندما يقارن الناظر في المتن التفسيري بين مراحله[29]، يلاحظ الفرق جليًّا، فأدّى ذلك بالتّبَع إلى اختلاف المقاييس التفسيرية، أو قل: تنوعها وتكوثرها.
وفي المرحلة المعاصرة ظهرت مدرسة إسلامية، انصبّ اهتمامها على ما يسمى: (بالقراءات الجديدة لنصّ الوحي المنزل)، ومن بينها القراءة المعاصرة لمحمد شحرور؛ نظرًا لتغيّر النظام والأدوات المعرفية، فيتعيّن بالتبَع تجديد النظر بشكلٍ جذري، وليس فقط بشكلٍ استثنائي. كلّ ما تراكم في مجال التفسير من نصوص؛ سواء كانت تأسيسية أو تقليدية أو تجديدية، يتعيّن -كما يرى محمد شحرور- أن لا تؤخذ وسائط لقراءة نصّ الكتاب، إِذْ في هذا الحال يبقى الهمّ المعرفي منصبًّا على تسويغ التفسيرات المرحلية أو المذهبية، وإن استقامت بالنظر إلى مرحلتها وأفقها العامّ، يكون كمن قرأ النصّ بمناظير خارجية مُحملة، أو قل: إسقاطية؛ لذلك قطعَ محمد شحرور في قراءته المعاصرة مع كلّ التراث الإسلامي الذي نشأ في ظلال التنزيل الحكيم قطيعةً كلّية على مستوى الأدوات، ومن ثمة القطع مع إنتاجاتها، ما دام أن من المسلَّم به (أن المعرفة رهينة أو أسيرة أدواتها)؛ كلّما تغيّرت الأدوات تغيّرت المعرفة بشكل جدلي، كما هو منظور محمد شحرور[30]. ومنطق القطع مع التراث التفسيري تحديدًا، لا يعني التنقيص أو التبخيس من تراث الأمة الإسلامية؛ فالفضل لمن سبق، بل يعني أنه لم يَعُد مناسبًا لنا اليوم، أو أنه قد استنفد أغراضه وفَقَدَ صلاحيته؛ سواء على مستوى الأدوات أو المضامين المعرفية، مما يستوجب الاحترام الكلي التامّ[31]، إِذْ هو ما زال يشكِّل هوية وتاريخ أمة وازنة، بإمكانها أن تواصل إمكانات شهود رسالتها لقيادة مجريات الحضارة المعاصرة، بعيدًا عن التيه والطغيان والاستبداد. ولا يعني ذلك أيضًا رفض السنة النبوية والسيرة العطرة، بل يعني الاجتهاد في إبداع مناظير جديدة للتعامل مع نصّ التنزيل وتأسيس الأحكام والنظريات، وإعادة تأصيل الأصول كما فعل السابقون من سلف الأمة الإسلامية[32].
وعليه؛ فإنّ ما سلف لا يتحقق من منظور محمد شحرور إلا بالانطلاق من معايرة كلّ شيء بنصّ التنزيل الحكيم[33]، فما وافقه قُبِل، وإلا رُفض من أيّ جهة صدر؛ سواء انتمى إلى سياقه، أو إلى خارج سياقه. فما دام أنه -القرآن- (كينونة) فهو مكتفٍ بذاته، لا يحتاج إلى ما هو خارجي عنه لتدرَك حقائقه ودقائقه، فهو إذًا كــ(كلمات الله)/(الوجود الموضوعي) بالتمام والكمال[34]؛ ولذلك يتعيّن أن يُقرأ من داخله، ومن خلال الأدوات التي حددها هو لا من ينطق عنه بالوكالة، أو مما هو مجرّد تاريخي عابر كاللسان العربي وتأصيلاته، والتمذهب وتفريعاته، وإلا أسهمنا في تحنيط نصّ الكتاب المنزل في ما هو مرحلي ظرفي[35]. ومما يسوّغ كلّ ما سبق مسلَّمة من مسلمات محمد شحرور المنهجية، وهي: أن «النص ثابت والمعنى متحرك»[36]. ولا يتم للنصّ الثابت أن تتحرك معانيه إلا بفتح أبواب الاجتهاد عَبر أدوات معرفية جديدة منبثقة من العصر وتطوراته المعرفية والعلمية[37]. والدالة على كلّ ما سبق، أن محمد شحرور أسّس تصوراته وكأنَّ نصّ التنزيل الحكيم أُنزل الآن، أو كأنه أرضٌ بكر لم توطأ أبدًا من قبلُ، غير ملتفت إلى ما أُسّس منذ النزول وإلى الآن من مذاهب وأنساق معرفية في تاريخ الفكر الإسلام؛ إِذْ لم يتَبَنَّ في الغالب أيّ نظرية أو مضمون معرفي تراثي؛ سواء في مجال التفسير والأحكام، أو في مجال التأصيل والأدوات المعرفية؛ لأنّ كلّ ذلك من منظوره ارتبط بهُموم أو بلحظات ثقافية، وهي تاريخية محضة، وإن استقامت بالنظر إلى مرحلتها وتوافقت مع نصّ التنزيل من مناظير أصحابها، فهي حتمًا ليست بالضرورة صالحة لنا اليوم، أو متوافقة مع نصّ الوحي من منظورنا.
خامسًا: لا علاقة لنَصّ الوحي المنزل بنُصُوص اللسان العَربي:
قطع محمد شحرور بأنّ الشعر العربي الجاهلي لا يمكّن من فهم نصّ التنزيل الحكيم فهمًا سليمًا كما يليق؛ للاعتبارات الآتية:
1. إنّ الكلام العربي المتمثّل في قصائد الأشعار، جاء كاستجابة للأرضية المعرفية السائدة ومشاغل الناس وقتئذٍ، فتجلَّى كلّ ذلك فيه، ما دامت اللغة الإنسانية قلّما تنفصل عن وقائع العمران الإنساني واهتماماته. أما الكتاب المنزل فهو وإن نزل في مدّة ومرحلة تاريخية محددتَيْن، فإنه بحكم خصيصة التعالي (تعالي قائله) لا ترتبط لغته بزمنٍ ما أدنى رابطة، إلا رابطة النزول ذاتها، وإن حاولَتْ منهجية التفسير ربطه بزمن النزول بواسطة مرويات أسباب النزول، إلا أنه يمكن حملها على باب من أبواب الإدراك الأمثل وقتئذٍ لا أكثر.
2. إنّ التسليم بكون نصّ التنزيل الحكيم أنزل على وَفق قوانين اللسان العربي قبل وأثناء النزول، كما دأبت على ذلك منهجية التفسير الموروث، فإنّ ذلك بقدر ما يُحوِّل نصّ الكتاب من كونه نصًّا إنسانيًّا عالميًّا خاتمًا ونصَّ رحمةٍ أيضًا، إلى كونه مجرد نصٍّ تاريخي معبِّر عن هموم معرفية واجتماعية وغيرها لزمنٍ مضى، أو قل: هو أقرب إلى النصوص التاريخية، أو قل: التاريخانية المُحايثة منها إلى النصوص المنزلة، أو قل: المتعالية المفارقة، بقدر ما ينفي عن التنزيل صفة (الإعجاز) أيضًا[38]، الذي يجعله دومًا نصًّا تجد فيه الذات الباحثة بصدقٍ وبتجردٍ ما يلبي طموحات الناس، كلٌّ حسب قدرته الاجتهادية؛ لذا جاءت دلالاته عبارة عن طبقات بعضها فوق بعض، أو قل: جاء حاملًا لما سمّاه محمد شحرور بظاهرة (التشابه)[39]، بمعنى ثبات النصّ وحركة المحتوى، وجاءت أحكامه أيضًا (حنيفية)؛ بمعنى تحمل مرونة التطابق مع المتغيرات الزمكانية في تحركها بين الحدود الدنيا والحدود العليا، تاركة المجتمع يحدد ويختار من بينها ما يُلائم تطوره.
3. مقارنة نصّ التنزيل الحكيم بالكلام العربي المعهود والمنصوص عليه في المعاجم والقواميس اللغوية، تجعل الباحث -كما ينصّ متن محمد شحرور- يتوصّل إلى أن نصّ الكتاب المنزل يحمل تطورًا لغويًّا غير معهود في نسق الكلام والفكر الجاهلي، حتى بالنظر إلى مكوناته الصغرى (المفردات)، إذ تجده يشتمل على مفردات من لغات عديدة، ومفردات من نسجه الخاصّ. فضلًا عن أن أسلوب التنزيل المتميّز بنظمه الفريد يخرجه عن كلية النظم الإنساني، بما في ذلك الشعر العربي[40].
4. إذا كنّا نسلّم بوجود تطابق بين اللسان العربي ونصّ الكتاب المنزل زمن النزول؛ سواء على مستوى المفردات أو التراكيب، فإنّ الاستعمال الدلالي رهين بالسياق النصي أو النظم أو الحقل الدلالي[41]، إِذْ المعاني موجودة في النظم وليس في الألفاظ فقط، فالمعاني هي المتحكمة والمالكة لسياسة الألفاظ، والنظم هو المتحكم والمالك لسياسة المعاني[42]؛ لذا فإنّ منهجية التفسير الموروث عملت على تغييب السياق أو النظم أو الحقل الدلالي بشكلٍ صريح جليّ، ويتجلى ذلك في أنّ المفردة أو التركيب الواحد من نصّ الكتاب المنزل، يُحمَّل ما لا نهاية من المعاني والدلالات، كلٌّ حسب نوع الكلام العربي الذي انطلق منه، وحسب المرجعية المذهبية المتحكمة في تأصيلاته، قد يكون ذلك موضوعيًّا إذا جرّدتَ المفردة أو التركيب عن سياقه، إِذْ يمكن أن يُحمّل العديد من المعاني، أما مراعاة النظم والسياق فإنّ المعنى محدد، يحدّده السياق النصِّي الكلِّي أو الجزئي أو النّفَس العامّ، وإلا ضاعت ماهية نصّ التنزيل؛ لذا استنتج محمد شحرور أنّ مصنفات الثقافة المعجمية التي تعب اللغويون في جمعها وتصنيفها، غير كافية لفهم نصٍّ لغوي عادي اليوم، فما بالك إذا كان النصّ هو نصّ التنزيل الحكيم[43].
سادسًا: القراءة المُعاصرة لنصّ الوحي المنزل قائمة على أساس الاهتداء بالعلوم والمناهج الغربية المعاصرة:
محمد شحرور الذي وَسم قراءته للتنزيل الحكيم بالمعاصرة، نسبة إلى العصر الجديد؛ بحيث جعل من أهم الضوابط المؤطّرة لها، اتّباع إبداعات العلوم الغربية المعاصرة، كالتوسّل باللسانيات والسيميائيات والرياضيات وعلوم الآثار والاجتماع والنفس والتاريخ ومقارنة الأديان وغيرها من العلوم الإنسانية والكونية. بناءً عليه؛ تجده قد قعّد قاعدة مفادها: «إذا تعارض ظاهر نصّ قرآني مع حقيقة علمية، وجب اللجوء إلى التأويل»[44]. والاعتماد عليها على العموم، رهين بأن لا تُناقِض نصًّا من نصوص التنزيل الحكيم[45]. ومن أهم ما يجسد توسله بها، اعتماده عليها في عدّة مواضيع؛ كموضوع القصص القرآني، كما سنبين في المقالة الرابعة.
سابعًا: قراءة نَصّ الوحي المنزل رَهين باتّباع منهج الترتيل/التفسير المَوضوعي-التوحيدي:
أقام محمد شحرور قراءته على ما سمّاه بـ(قاعدة الترتيل)، لتجاوز الأعطاب المنهجية في القراءة والتفسير. وقاعدة الترتيل، تُعَدُّ من أهم قواعد البحث العلمي، ومن دونها لا يمكن لأيّ بحث علمي أن يحقق نتائج مفيدة. فعند تنزيلها على نصّ الكتاب المنزل، نعمد إلى انتخاب موضوع الدراسة في أيّ مجال من مجالاته، ثم نقوم باستخراج النصوص المتعلقة بالموضوع؛ تعلقًا كليًّا أو جزئيًّا، ثم تُرَتَّب النصوص ترتيبًا نسقيًّا، الواحد تلو الآخر، ليتم بعد التفحُّص والنظر المُخمر؛ الاهتداء إلى الدلالة الموضوعية الكلية للموضوع المختار[46].
تهدف قراءة الترتيل المنصوص عليها في قوله تعالى: {وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا}[الفرقان: 32]. وقوله سبحانه: {وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا}[المزمل: 4][47]، إلى:
1. أن تكون الدلالات المستفادة محددة من قبل نصّ التنزيل؛ إِذْ ما دام أنه نصّ فهو حامل لدلالات معينة، مفصح عنها بطريقته هو لا بطريقة من ينطق عنه بالوكالة، المحمل بقَبْليات لا علاقة لها به لا من قريب ولا من بعيد في الغالب.
2. أن يكون المتعامل مع كتاب الله تعالى قراءةً وتفسيرًا، كلما استحضر منهج الترتيل تمكّن من تعطيل مسبقاته المذهبية أو التاريخية، وخصوصًا المنضبطة منها اتجاه موضوع الدراسة والتدبر.
3. إنّ منهج الترتيل يجعل البحث الدلالي في نصّ الكتاب المنزل مفتوحًا على مطلق ما هو مستقبلي؛ إِذ التسليم بكونه نصًّا عالميًّا وإنسانيًّا وخاتمًا ونصَّ رحمةٍ، يقتضي أنه حامل لمطلق مشكلات الناس ما يصلحها ويوجهها، فضلًا عن أن ذلك يجعل دلالاته غير مستنفدة، في ما قدمه هذا الجيل أو ذاك من أجيال التلقي والتأويل في تاريخ الأمة الإسلامية[48].
ثامنًا: مُراعاة مَواقع النجوم أسٌّ ضروري للفهم الأسلَم لنُصُوص الوحي المنزل:
أُنزل كتاب الله تعالى على الرسول -عليه السلام- منجَّمًا طيلة مدّة مقدَّرة بنحو ثلاث وعشرين سنة على القول المختار، مقسّمة بين العهد المكي نحو ثلاث عشر سنة، والعهد المدني نحو عشر سنين، ولم يتم إنزاله دفعة واحدة شأن الكتب السماوية السابقة، وهذا ما لاحظه أهل زمن النزول/زمن الإنزال، كما يقصّ الله تعالى في قوله: {وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا}[الفرقان: 32]. بل تم إنزاله منجمًا، يقول تعالى: {وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا * وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا}[الإسراء: 105، 106]. إذا كانت تلك هي دلالة مفهوم (التنجيم)، كما هو معهود في تراث علوم القرآن، فإنّ القراءة المعاصرة لا تقبلها، وتعوِّضها بأنَّ كلّ آية من آيات التنزيل الحكيم مختومة بفاصلة. وفواصل الآيات يطلق عليها محمد شحرور (مواقع النجوم)، وهي المقصودة بقوله تعالى: {فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ * وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ}[الواقعة: 75-76][49]. والناظر في مواقع النجوم يتوصل إلى أنها تحمل أسرارًا ومفاتيح تأويلية، تُعِين بشكلٍ مِفصليٍّ على فهم الكتاب المنزل من داخله، وهي تعدّ دلائل مادية مباشرة على أنّ القرآن الذي جاء به محمد -عليه الصلاة والسلام- هو وحي من عند الله تعالى وحده دون سواه، وفي حالة سقوط نجم- فاصلة، يصبح الخبر في الآيات كاذبًا بدل أن يكون صادقًا. وحين نربط بين القسم في قوله تعالى: {وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى}[النجم: 1]. وجواب القسم في قوله سبحانه: {مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى * وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى}[النجم: 2- 4]. يطرح السؤال: ما النجم الذي إذا هوى ضلّ صاحبنا وغوى ونطق عن الهوى ولم يُوحَ إليه ما أُوحِي؟! خصوصًا إذا حمل مفهوم النجم على النجم الكوني بالمعنى المعروف، كما في قوله تعالى: {وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ}[الرحمن: 6]. أو كما في قوله أيضًا: {وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ}[التكوير: 2]. محمد شحرور حمل مفهوم سقوط النجم على تغيير فواصل الآيات، الذي يترتب عنه تغيير معاني الآيات؛ فذلك هو كون نجم الآيات قد هوى، ومن مصاديق ذلك، تجد قوله تعالى: {وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ * ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ}[المؤمنون: 12، 13]. إنّ مراعاة وجود التنجيم بين الآيتين، يدلنا على أنّ الآية الأولى حلقة من بين حلقات من التطور، ثم قفزة جاءت متأخرة عن الأولى ولا تليها مباشرة، فإذا هوى النجم بين الآيتين أصبح الخبر كاذبًا، وهذا الأمر كما يؤكد محمد شحرور لا يوجد إلا في نصّ الكتاب المنزل، ولا علاقة لمطلع سورة النجم بالسنة النبوية، كما رسخت ذلك منهجية التفسير الموروث[50].
ومن الأمثلة الدالة على ذلك أيضًا: قوله تعالى: {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ * خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ * اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ * الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ * عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ}[العلق: 1- 5]. هذه الآيات البيّنات تُظهِر أهمية مواقع النجوم لفهمها كما ينبغي؛ فقوله: {الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ * عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ}[العلق: 4، 5]، يدلّ على أنّ وسيلة التعليم هي (القلم)، لكلّ شيء في الوجود؛ الإنسان الملائكة الحيوان والجماد-{الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ}-{وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا}[البقرة: 31] بالقلم. فالقلم إذًا هو وسيلة التعليم المهمّة في الوجود؛ سواء للإنسان أو غيره[51].
تاسعًا: القراءة المُعاصرة لنصّ الوحي المُنزل مَنُوطة بالابتعاد عن منهج التعضية:
الابتعاد عن منهج (التعضية) يأتي مكملًا للالتزام بمنهج (الترتيل)، فإذا كان الأخير على وجه الإجمال، هو النظر في نصّ الكتاب المنزل بعد اختيار موضوع الاشتغال والاهتمام لرصد الآيات التي تتناول أو تتقاطع في الموضوع المحدّد، قصد لمّ شمل نسق التنزيل تجاه الموضوع؛ فإن منهج التعضية أن نعمد إلى قسمة ما لا ينقسم من الآيات الدالة على موضوع أو موضوعات محددة؛ بمعنى أن الآية الواحدة إذا كانت تحمل فكرة واضحة كاملة، تعيّن منهجيًّا أن ننظر إليها كلّية دون تقسيم أو تجزيء مكوناتها. وإذا كانت أيضًا مجموعة آيات حاملة لفكرة واضحة كاملة، تعيَّن أخذها كلّها بعين الاعتبار؛ درءًا لتقسيم ما لا ينقسم من الآيات أو مجموعة آيات، أو كأنْ نُلحق آية بعدة آيات أو بموضوع لا علاقة لها بها أو به، وكأنْ نُلحق آية أو مجموعة آيات تتناول موضوع الخلق، بأخرى تتناول موضوع التشريع، أو آيات قصصية بأخرى موضوعها العقيدة وقِس على ذلك[52].
الابتعاد عن منهج التعضية، هو المراد بقوله تعالى: {الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ * فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ * عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ}[الحجر: 91- 93]. ومنه جاء قوله -عليه السلام-: «لا تعضية لوارث»، أو «لا تعضية في ميراث، إلا فيما حمل القسم»[53]، والمقصود بالتعضية في الميراث: إذا ترك الهالك مَا لَا ينقسم؛ كالحبة الواحدة من الجوهر ونحوها، فلا تقسم درءًا للضرر، بل تُباع ويقسم ثمنها جلبًا للنفع، وعليه؛ فإنّ الله تعالى بثّ الموضوع بوصفه وحدةً في عدّة آيات، أو قسمه إلى عدّة آيات من باب التكامل[54].
مما يكمل الابتعاد عن منهج (التعضية) تجد محمد شحرور يركّز على ما سمّاه بمنهج «تقاطع المعلومات»، وهو قائم على التسليم بانتفاء أيّ تناقض دقيق أو جليل بين دلالات آيات التنزيل الحكيم؛ سواء في التعليمات (خطاب النبوة)، أو في التشريعات (خطاب الرسالة)[55].
عاشرًا: القرَاءة المعاصرة لنَصّ الوحي المنزل قائمة على أساس نَزع مَهابة التقديس عنه:
يرى محمد شحرور أنّ من أهم ضوابط منهج البحث العلمي الموضوعي المتعلق بآيات كتاب الله تعالى، تجد ضرورة أن تتم دراسة النصّ بلا عواطف جياشة، من شأنها أن توقع الدارس في الوهم[56]؛ بمعنى كون نصّ التنزيل الحكيم وحيًا من الله تعالى أو كونه مقدسًا لا يمنع البتة من الجرأة في البحث والطرح من داخل النصّ؛ إِذْ نصّ الكتاب المنزل ليس مثله مثل ما سبقه من كتب منزلة، على أيّ مستوى من مستويات المقارنة[57]، فضلًا عن أن جرأة البحث لا تعني بأيّ وجه من الوجوه نفي صفة الوحي أو القداسة عنه، ولا تعني أيضًا تسويته بغيره من النصوص التي من جنسه، أو التي ليست من جنسه، ما دام أن صفة كون نصّ التنزيل الحكيم وحيًا من الله تعالى إلى محمد -عليه السلام- لم تثبت له بالاعتبار الإنساني، بل هي ثابتة له بالاعتبار الإلهي، وكذا باعتبار ما يَحمل؛ سواء على مستوى الصياغة النصيّة، أو على مستوى المحمولات الدلالية، أو على مستوى القدرة على توجيه الأحداث وريادة المستجدات. وعليه؛ فإنّ كون هذا الباحث أو ذلك المفكر قد نفى صفة الوحي عن الكتاب المنزل، فهو لا ينفيها إلا في اعتباره الذهني، ولا يتسنى له بأيّ وجه من الوجوه أن ينفيها عنه بالاعتبار الموضوعي. وهذا -حقيقةً- هو سرّ إعجاز كتاب الله تعالى، الذي أراده الله -سبحانه- أن يكون إنسانيًّا وعالميًّا وخاتمًا ورحمةً للناس جميعًا في سائر أقطار العلم كله[58].
خاتمة:
حاولنا في هذه المقالة إلقاء الضوء على الضوابط التي تشكّل قوام منهج القراءة المعاصرة لنصّ التنزيل الحكيم من منظور محمد شحرور، والتي هي عبارة عن اجتهاد سعى من خلاله إلى:
1. بناء منهجِ مسلكٍ جديد أو معاصر للنظر في نصّ وحي التنزيل الحكيم، مخالفٍ لمعهود منهج التفسير التراثي.
2. تسطير جملة دلالات وأحكام جديدة أو معاصرة بِناءً على مقتضيات منهج النظر في نصّ التنزيل الحكيم، ولو كانت مخالفة لمعهود اجتهادات الفكر الإسلامي فقهيًّا كان أو تفسيريًّا أو غيرهما.
3. جعل مسلك (القطيعة)، التي ليست مطلقة وإن كانت غالبة، خصوصًا مع التراث الإسلامي التفسيري المتصل رأسًا بنصّ وحي التنزيل منهجيًّا ومعرفيًّا ناظمه الكلي في القراءة.
4. الاعتداد بالاجتهاد الشخصي في قراءة نصوص التنزيل وتأسيس الدلالات والأحكام، مع السعي الحثيث لتجاوز وتخطي ما عداه من اجتهادات، خصوصًا التراثية.
5. استثمار بعض اجتهادات أو مقررات الفكر الغربي الحديث والمعاصر، وسيتضح هذا الأمر أكثر في المقالة الرابعة المتعلقة بالقصص القرآني.
[1] السنة الرسولية والسنة النبوية رؤية جديدة، ص71.
[2] يمكن الاطلاع على المقالة الأولى ضمن هذه السلسلة على هذا الرابط: tafsir.net/article/5183
[3] الإسلام والإيمان، ص20.
[4] السنة الرسولية والسنة النبوية، ص71.
[5] الكتاب والقرآن، ص182.
[6] نفسه، ص35، 209.
[7] انظر مختلف مصنفات علوم القرآن كالبرهان للزركشي، والإتقان للسيوطي، ومناهل العرفان للزرقاني وغيرها.
[8] تجفيف منابع الإرهاب، ص38.
[9] الدين والسلطة، ص102، والسنة الرسولية والسنة النبوية، ص64، والقصص القرآني، ج1، ص20، وتجفيف منابع الإرهاب، ص38.
[10] نفس الشرط منصوص عليه في مصنفات علوم القرآن. انظر: العقل وفهم القرآن، ص359 وما بعدها. الناسخ والمنسوخ، ص12. نواسخ القرآن، ص20 وما تلاها.
[11] الدولة والمجتمع، ص272- 274. نفس الشرط منصوص عليه في مصنفات علوم القرآن. انظر: العقل وفهم القرآن، ص359 وما بعدها. الناسخ والمنسوخ، ص12. انظر أيضًا: دراسات الإحكام والنسخ في القرآن الكريم، محمد حمزة، دار قتيبة، ط1، ص135 وما بعدها.
[12] مثل قوله تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ...}[المائدة: 45]. الدولة والمجتمع، ص282.
[13] قارن قوله تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا...}، بقوله تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً...}[النساء: 92]، وبقوله أيضًا: {وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا...}[الإسراء: 33]. نفسه، ص283.
[14] قارن حكم الزانية والزاني في التوراة وفي التنزيل الحكيم: [النور: 2]. نفسه، ص286.
[15] نفسه، ص276، 277. أما التأسيس التراثي فهو قائم على أنّ آية النور نسخت آيتي النساء، من باب التدرّج المفضي للنسخ، أي: انتهاء العمل بالحكم السابق. نواسخ القرآن، ص109- 111. وقيل: إن حكمي آيتي النساء نُسِخَا بقوله -عليه السلام-: «خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلًا؛ الثيب بالثيب جلد مائة ورجم بالحجارة، والبكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة». نواسخ القرآن، ص111. الرسالة، ص152- 155. الناسخ والمنسوخ، ص89، 90. الحديث أخرجه مسلم، حديث رقم 1690. يرى محمد شحرور أن عقوبة الرجم المتعلقة بزنى الإحصان تراثية فقهية، لا علاقة لها بنصّ التنزيل الحكيم، بل تم أخذها من الإسرائيليات. أما الأحاديث الواردة في الباب فهو يشكك فيها، ما دام أنها تنصّ على أحكام لم ترد في التنزيل، فضلًا عن كونها أشدّ مما ورد في التنزيل. الدين والسلطة، ص119، 120. مع العلم أنها وردت في الصحاح، كموطأ مالك وصحيح البخاري ومسلم، منها قوله -عليه السلام-: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة». متفق عليه؛ صحيح البخاري، حديث رقم 6878، وصحيح مسلم، حديث رقم 1676.
[16] تأويل مشكل القرآن، ص507 وما بعدها.
[17] يقول ابن تيمية: «ومن هنا غلط من جعل بعض الحروف يقوم مقام بعض...». مقدمة أصول التفسير، ص279.
[18] الدين والسلطة، ص16.
[19] تجفيف منابع الإرهاب، ص32، والسنة الرسولية والسنة النبوية، ص88.
[20] الدولة والمجتمع، ص324.
[21] استعملت (عن) بمعنى (الباء)، كما يرى ابن قتيبة. تأويل مشكل القرآن، ص509.
[22] الضمير المنفصل يعود على التنزيل، لا على النطق، كما يرى محمد شحرور. تجفيف منابع الإرهاب، ص289.
[23] الرسالة، ص60- 72- 76- 108- 111- 113- 114- 115.
[24] السنة الرسولية والسنة النبوية، ص56، وتجفيف منابع الإرهاب، ص288- 290.
32 نفسه، ص286- 288.
[26] الدين والسلطة، ص198.
[27] تأمل نصوص التنزيل الآتية: يقول تعالى: {وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ}[البقرة: 88]. وقوله: {فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ}[الأعراف: 130]. وقوله: {قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى}[طه: 46]. وقوله: {فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ}[النمل: 13 ].
[28] تجفيف منابع الإرهاب، ص289.
[29] يرى محمد أركون أن الفكر الإسلامي مرّ بمرحلتين أساسيتين هما: (مرحلة الإبداع) والمتمثلة في العصر الكلاسيكي، و(مرحلة التقليد والاجترار) والمتمثلة في عصر الانحطاط أو ما سمّاه: (بعصور المحافظة). تحرير الوعي الإسلامي، ص161-163.
[30] الدين والسلطة، ص309، والدولة والمجتمع، ص34، 204، 236، والسنة الرسولية والسنة النبوية، ص71.
[31] الإسلام والإيمان، ص139، والدولة والمجتمع، ص204، 236.
[32] تجفيف منابع الإرهاب، ص155، والإسلام والإيمان، ص51.
[33] نفسه. ووسيلة ذلك هي ما سماه بـ(قراءة الترتيل) كما سنتعرف. الكتاب والقرآن، ص194، 196.
[34] تجفيف منابع الإرهاب، ص26، 27، 52.
[35] السنة الرسولية والسنة النبوية، ص44، والدين والسلطة، ص18.
[36] الكتاب والقرآن، ص36، وتجفيف منابع الإرهاب، ص28، 35، والسنة الرسولية والسنة النبوية، ص72.
[37] القصص القرآني، ج1، ص119، 120. يرى محمد شحرور أنّ (الرجعي) في دراسة نصّ التنزيل، هو من يعتمد على أدوات ومناهج معرفية تاريخية انتهت صلاحيتها بانتهاء زمان أهلها. أما(التقدمي) فهو الذي يعتمد ما استجدّ من مناهج ومعارف. الدين والسلطة، ص312.
[38] تجفيف منابع الإرهاب، ص41.
[39] الدولة والمجتمع، ص40، وتجفيف منابع الإرهاب، ص30.
[40] تجفيف منابع الإرهاب، ص41.
[41] بَيّن إيزوتسو أن منطق الدلالة مرتبط بالحقل الدلالي. وبالتبع، فإن الفرق لا يطوى بين دلالة الكلمة في الشعر الجاهلي وفي النص القرآني، وقد مثّل لذلك بمجموعة من الأمثلة دالة على ضرورة مراعاة الحقل أو المجال للفهم الدلالي الموضوعي. انظر: الله والإنسان في القرآن، ص43، 44، 56، 76- 83.
[42] الدولة والمجتمع، ص35، 36، وتجفيف منابع الإرهاب، ص30.
[43] الدولة والمجتمع، ص35، 36.
[44] القصص القرآني، ج2، ص51.
[45] الكتاب والقرآن، ص44، والإسلام والإيمان، ص97، والقصص القرآني، ج1، ص15، 72، 285، والسنة الرسولية والسنة النبوية، ص183.
[46] القصص القرآني، ج1، ص251، 252، والكتاب والقرآن، ص25، 197، 198.
[47] نفسه. التفسير التراثي لا يخرج (الترتيل) عن معنى التزيين والتجويد، فالراغب الأصفهاني حمل مفردة (رتل) على إخراج كلمات القرآن بطريقة مستقيمة وسهلة. مفردات ألفاظ القرآن، ص204. والشيء نفسه تجده عند معظم أهل اللغة، كأساس البلاغة لجار الله الزمخشري، ومختار الصحاح للرازي وغيرهما.
[48] من أهم الذرائع المتخذة لشرعنة القراءات الجديدة لنصّ التنزيل، تجد -كما ينصّ محمد شحرور- في قوله: «لا يمكن لإنسان واحد أو مجموعة بشرية في جيل واحد، أن يفهم النصّ القرآني بشكلٍ كاملٍ مطلقٍ كما أراده قائله، وإلا أصبح شريكًا لله في المعرفة». تجفيف منابع الإرهاب، ص30، والدولة والمجتمع، ص40. وفي قوله أيضًا: «إنّ المجتمعات هي التي تشارك في صنع المعاني حسب تطوّر معارفها، لكن هذه التطورات نفسها محسوبة في التنزيل؛ بحيث مهما امتدت واتسعت، فسيجد الإنسان أنها منسجمة مع النصّ القرآني، مصدقة له، ودائرة في فلَكه». تجفيف منابع الإرهاب، ص35.
[49] الكتاب والقرآن، ص198، 199.
[50] تجفيف منابع الإرهاب، ص288، والدولة والمجتمع، ص234، 235، والكتاب والقرآن، ص198، 199.
[51] نفسه، ص200، 201. مفهوم القلم جاء من (التقليم)، وليس دالًّا على الأداة المعروفة. والتقليم بوصفه المبدأ الأول من مبادئ المعرفة الإنسانية، هو «تمييز الأشياء بعضها عن بعض»، عبر وسيلة اللسان والشم والبصر والسمع والعقل. يتبعه مبدأ (التسطير-التصنيف)، يقول تعالى: {ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ}[القلم: 1]. وقوله: {وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ}[القمر: 53]. وقوله أيضًا: {وَالطُّورِ * وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ}[الطور: 1، 2]. فهو «ضم الأشياء بعضها إلى بعض في نسق». تجفيف منابع الإرهاب، ص36. والمعرفة الإنسانية خط صاعد إلى الأعلى، محوره القلم (التمييز). نفسه، ص53.
[52] القصص القرآني، ج1، ص252، والكتاب والقرآن، ص198.
[53] أخرجه الدارقطني في السنن وابن أبي حاتم. حكم عليه أهل الشأن بكونه حديثًا لم يصح، ما دام أنه مرسل (الذهبي).
[54] الكتاب والقرآن، ص198، 202.
[55] الكتاب والقرآن، ص203، والقصص القرآني، ج1، ص286، والسنة الرسولية والسنة النبوية، ص44، والدين والسلطة، ص364، والكتاب والقرآن، ص194، 196، وتجفيف منابع الإرهاب، ص36.
[56] الكتاب والقرآن ص30.
[57] تجفيف منابع الإرهاب، ص31.
[58] الدين والسلطة، ص107 وما بعدها.
كلمات مفتاحية
الكاتب:

محمد كنفودي
باحث مغربي حاصلٌ على إجازة في الدراسات الإسلامية، درجة الماجستير في فقه المهجر أصوله وقضاياه وتطبيقاته المعاصرة، وله عدد من المؤلفات العلمية والمقالات المنشورة في مجلات ودوريات ومراكز بحثية.
مواضيع ذات صلة
((المعلومات والآراء المقدَّمة هي للكتّاب، ولا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع أو أسرة مركز تفسير))