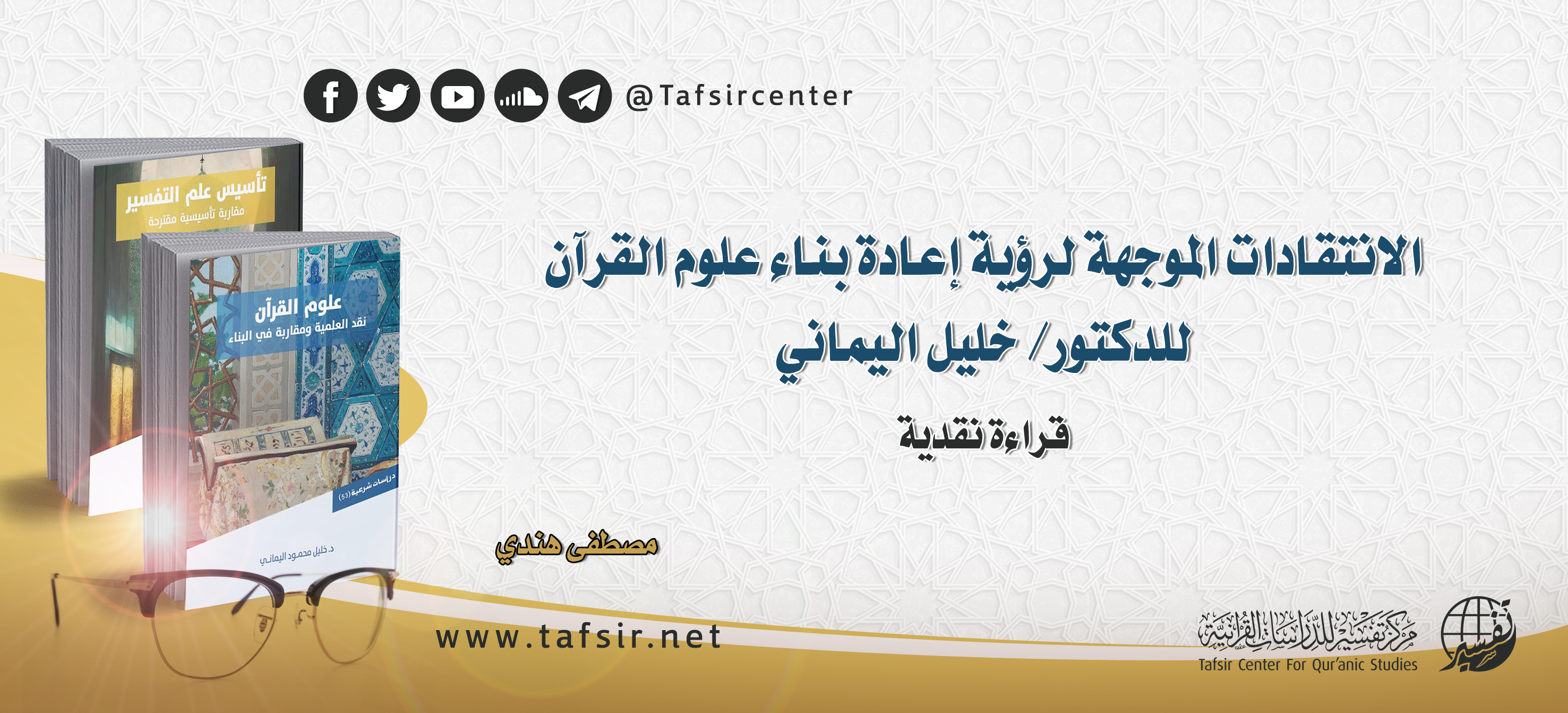القرآن المجيد؛ وسؤالا المصدرية والتحريف (1): مصدرية القرآن
أولًا: مصدرية القرآن
الكاتب: عمرو الشرقاوي

مقدمة:
يُعَدُّ القرآن الكريم محور الرسالة الإسلامية ومركزها الرئيس، ولا غَرْوَ! فهو كلام الله تعالى الذي أنزله على نبيه محمد -صلى الله عليه وسلم- ليكون دستورًا جامعًا لهذه الرسالة، وحاويًا لمضامينها وتعاليمها؛ ومِن هاهنا كان القرآن -ولا يزال- لسان التعريف بالإسلام والدعوة إليه وشرحه.
ولما كان القرآن بهذه المثابة التي لا تخفى في تمثيله لعصب الرسالة الإسلامية اتجهت إليه سهامُ المفترين والمكذِّبين منذ قديم، وتعدَّدت شبهاتُهم حوله، والتي كان مِن أهمها: ما يتعلق بقضيتي المصدرية والتحريف، فهاتان الشبهتان لطالما دندن حولهما خصوم الإسلام في محاولة منهم لإبطال شأن القرآن، عبر التشكيك في أنه كلام الله تعالى، والادّعاء بأنه من كلام البشر سواء أكان من النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- أم من غيره، وكذا من خلال الطعن في سلامته والادّعاء بطروء التحريف عليه كما حدث مع الكتب السابقة عليه، والتي طالتها أيدي الناس بالتغيير والتبديل، مما سجَّله القرآن ذاته على هذه الكتب، كما هو معلوم.
ولا شك عندنا في أن القرآن هو كلام الله الذي تكفَّل بحفظه، إلا أننا سنحاول جاهدين مناقشة هاتين الشبهتين، وبيان ما فيهما من دعاوى خاطئة؛ إحقاقًا للحق، وتبصيرًا لطلاب الحقيقة، وتثبيتًا لمن آمن وزيادة في إيمانه.
وسوف نجتهد في نقاشنا لهاتين الشبهتين في اتباع مسلك النقاش العلمي والمحاورة العقلية بتجرُّد وموضوعية، وسرد الاحتمالات الممكنة والسير معها، والتركيز في ذلك الغرض دون سواه، وهو ما نستهلُّه في مقالتنا هذه بمناقشة موضوع مصدرية القرآن، وبيان الحجج على كونه كلام الله -عزّ وجلّ-، وبيان ذلك على النحو التالي.
سؤال مصدرية القرآن في القرآن:
إنّ الناظر في القرآن الكريم يجده كثير الحديث عن نفسه بصورة ظاهرة وملحوظة، حيث يكشف القرآن بنفسه عن مصدره، وعن الواسطة والطريقة التي نزل بها، وعلى مَن أُنزل، وكذلك يُخبر عن اللغة التي نزل بها، وعن أغراضه ومقاصده، ويحدد الأوصاف التي تميزه عن غيره، وغير ذلك مما يتعلق بالقرآن، ومن هاهنا فالمطالع للقرآن يستطيع أن يُدرك كلَّ شيء يحتاجه للتعرف على هذا الكتاب دون معرِّف خارجي[1].
وفيما يتعلق بموضوع المصدرية، فإنها كانت أحد أبرز الأمور التي أفاض فيها القرآن؛ فقد ناقش القرآن بذاته موضوع مصدريته، وأفاض في الإجابة عن هذه القضية وتقريرها، وهو ما نلحظه في العديد من المواطن والآيات؛ منها ما جاء في سورة الشعراء، حيث قال القرآن: {وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ * نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ * عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ} [الشعراء: 192- 194].
فالقرآن هاهنا يُخبرنا بنفسه أنه تنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين، وهو جبريل -عليه السلام-، على قلب محمد -صلى الله عليه وسلم-، ليكون للعالمين نذيرًا.
كما أخبر القرآن كثيرًا أن ليس لمحمد -صلى الله عليه وسلم- في القرآن إلا الوعي والحفظ، ثم الحكاية والتبليغ، ثم البيان والتفسير، وأخيرًا: التطبيق والتنفيذ.
يقول الله تعالى: {إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ * وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ * وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ * تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ * وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ * لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ * ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ * فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ * وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ * وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ * وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ * وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ * فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ} [الحاقة: 40- 52].
وقال تعالى: {وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا * وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا * قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا}[الفرقان: 4- 6].
وقال سبحانه: {وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ * قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ} [يونس: 15، 16].
الحجج على كون القرآن هو كلام الله، لا كلام أحد سواه:
لو انطلقنا لإثبات قضية مصدرية القرآن الكريم، فلَنا أن نتساءل عن الحجج التي بها ندفع أن يكون القرآن من كلام محمد -صلى الله عليه وسلم-.
ومجمل الحجج التي ندفع بها أن يكون القرآن من كلام محمد -صلى الله عليه وسلم- ما يلي[2]:
أولًا: الإقرار:
لقد أقر النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- على نفسه أن القرآن الذي جاء به ليس من كلامه، وإنما هو وحيٌ من ربه إليه.
وحجية هذا الإقرار: أن القرآن حجَّ العربَ، وعجزوا أمامه، فالمصلحة تقتضي أن يَنسب محمد القرآن له؛ لتروج زعامته، ويعلو قدره عند هؤلاء القوم، ولم يفعل، وحاشاه أن يفعل.
فأيُّ مصلحة له في هذا الإقرار غير الإخبار بالصدق، والشهادة بالحق؟!
فإن قال قائل: إنه لم يفعل ذلك إلا ليستجلب مزيدًا من الأتباع بنسبة هذا الكلام للرب، ويستدعي لنفسه طاعة وسلطانًا.
فنقول: هذا الكلام فاسد من جهة ذاته، ومن جهة أساسه.
1- فأما فساده من جهة ذاته؛ فلأن القرآن نفسه أوجب على الناس طاعة محمد -صلى الله عليه وسلم-، وجعل طاعته من طاعة الله تعالى.
2- وأما فساده من جهة أساسه؛ لأنه مبني على افتراض باطل، هو أن يكون محمد -صلى الله عليه وسلم- قد سوّغ لنفسه أن يصل إلى مقصده، ولو بالكذب والتمويه.
وهذا باطل؛ لأن سيرة محمد -صلى الله عليه وسلم-، وأحواله تأبى ذلك. فإن صفاته وشمائله قبل النبوة وبعدها تأبى أن يكون كاذبًا، فقد كان أعداؤه قبل أصحابه يشهدون له بالصدق والأمانة، ولم يقل أحد منهم قط: إنه كاذب[3].
ثانيًا: أميَّة النبي -صلى الله عليه وسلم-:
لم يكن النبي -صلى الله عليه وسلم- ممن يرجع بنفسه لكتب العلم ودواوينه؛ لأنه باعتراف الخصوم ولد أُميًّا، وفي القرآن نفسه: {وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ}[العنكبوت: 48][4].
فإن قال قائل: إنه استنبط القرآن بالذكاء الفطري الذي كان يتمتع به.
فنقول: إننا لا ننكر الذكاء الفطري الذي كان يتمتع به محمد -صلى الله عليه وسلم-، ولكنا نقول: إنّ في القرآن ما لا يستنبط بالعقل ولا بالتفكير، وفيه ما لا يدرك بالوجدان ولا بالشعور.
ومن ذلك:
1- الوقائع التاريخية:
إنّ الوقائع التاريخية لا يمكن وضعها بإعمال الفكر والفِراسة، ولقد كان ملاحدة الجاهلية أصدق تعليلًا لهذه الظاهرة من ملاحدة العصر؛ إذ قالوا عن هذه الأخبار: {أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا}[الفرقان: 5]، وقد أجاب القرآن عنهم إجابة بليغة، فقال: {قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ}[يونس: 16].
2- الحقائق الدينية الغيبيّة:
لقد فصَّل القرآن ذكر حدود الإيمان، ووصف الجنة ونعيمها، والنار وعذابها، ووصف عوالم أخرى كالملائكة والجن، بل ذكر بعض الأرقام في ذلك المجال؛ كعدد الملائكة الموكلة بالنار.
أبعد هذا شك أن يكون القرآن قد افتُرِي من دون الله؟! إن القرآن تصديق الذي بين يديه، وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين.
3- أنباء المستقبل الجازمة:
من الغيوب المستقبلية التي أخبر بها، والتي تكفي في صدقه، وصدق ما جاء به، ما أخبر عنه القرآن في قوله: {يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ}[المائدة: 67]، فأيّ ضمان هذا؟!
وليس هذا فحسب، وإنما وقع هذا موقعه، فترك النبي -صلى الله عليه وسلم- اتخاذ الحراس بعد هذه الآية، وثبتت هذه العصمة له في غير موطن[5].
ثالثًا: عدم أخذ القرآن عن معلِّم:
فإذا ثبت أنه لم يكن يقرأ ويكتب، فقد يُظَن أنه أخذ القرآن عن معلِّم، ولو بحثنا في البيئة المحيطة به، علَّنا نجد ذلك المعلِّم، فسنجد أن البيئة المحيطة به تنقسم إلى أقسام:
1- قومه:
ومن المستحيل أن يكون قد أخذ القرآن عنهم؛ إذ هم أُمَّة أُميَّة، وهذا لا شبهة فيه لأحد، فلا يمكن أن يكون قد أخذ عنهم؛ إذ لو فعل لبادروا لفضحه بدلًا من مصاولته، ودخول هذه الحروب معه[6].
2- العلماء الذين التقى بهم؛ كبحيرى الراهب، وورقة بن نوفل:
ومعلوم أن لقاءه بهما لم يكن بمنأى عن الناس، فقد شاهده عمّه أبو طالب، وزوجه خديجة، ولم يكن لقاؤه بهما إلا يسيرًا، فماذا حدّثنا التاريخ عن هذا اللقاء، وما الذي يمكن أن يكون قد تحمَّله في هذه الدقائق؟! أيكون هذا العلم أجمع؟!
ثم إنّ خصومه الألدّاء لم يستخدموا هذا السلاح، ولا شهروه في وجه محمد، وقد كان هذا السلاح أقرب إليهم وأمضى من كلّ ما لجؤوا إليه.
على أن التاريخ قد أخبرنا أن هذين الرجلَين، استبشرا بلُقيا محمد -صلى الله عليه وسلم-، وتوقع له أحدُهما شأنًا عظيمًا، وتمنى الآخر أن يشهد بعثته فيكون من أنصاره!
3- أهل الكتاب.
من المستحيل أن يكون القرآن قد أُخِذ عن اليهود والنصارى، ولينظر قائل تلك المقالة إلى حديث القرآن عن أهل الكتاب، وذِكره لهم، وكيف يصور القرآن علومهم بأنها الجهالات، وعقائدهم بأنها الخرافات، وأعمالهم بأنها الجرائم والمنكرات.
ولقد كان القرآن بمثابة الأستاذ الذي يصحح لأهل الكتاب من اليهود والنصارى أغلاطهم، وينعى عليهم سوء حالهم.
ويضاف لذلك كله ما كان عليه أهل الكتاب من كتمانٍ للحق، وتحريفٍ للكلم عن مواضعه.
ثم إن في القرآن ما لا يوجد في كتب أهل الكتاب، كقصة هود وشعيب -عليهما السلام-، فمن أين أتى بها؟!
وأما الراسخون في العلم من أهل الكتاب فقد آمنوا بالقرآن.
4- رحلاته للشام:
ولا يمكن التعويل عليها؛ لأمور:
- مشاغله التي كان ذاهبًا لها.
- أنه مع قومه ورفقائه.
- أن اللغة الأجنبية مثّلت حاجزًا مهمًّا.
- أن معارضيه لم يستخدموا هذه الحجة، وهي أقرب لهم مما افتروه.
وفي دراسة التاريخ الكنَسي في هذا الوقت ما يدفع هذه الفرية من أساسها.
هذا إذًا هو المشهد الحي الذي يمتد أمام نظر المشاهد، فحيثما اتجه وجد ضلالًا يحتاج إلى الهداية، وانحرافًا يتطلب التقويم، ولن يجد أبدًا نموذجًا أخلاقيًّا ودينيًّا يصلح لأن ينقله محمد أو ينبني عليه نظامه الإصلاحي.
5- الأخذ المباشر عن الكتب المقدسة:
أما الاتصال بالكتب المقدسة فغير ممكن؛ لأمور:
- أن محمدًا -صلى الله عليه وسلم- لم يكن يقرأ ويكتب، وليس هناك ما يدل على أنه قرأ كتابًا قط.
- أن الكتب السماوية في ذلك الوقت لم تكن مكتوبة بالعربية.
6- الأخذ عن بعض شعراء العرب كأميّة بن أبي الصَّلْت:
ولا يمكن أن يكون القرآن قد أُخِذ عن شِعر بعض العرب كأميّة بن أبي الصَّلْت وغيره؛ لأمور:
- قد نفى القرآن أن يكون شِعرًا، وبالتأمل في شعر بعض الشعراء سنجد أنهم كانوا يَصِفُون أمورًا كشرب الخمر، وهو ما لا نجد له أثرًا في القرآن.
- أن العرب الذي هم أهل الفصاحة والمعرفة، لم يدَّعِ أحدٌ منهم أن القرآن مسروق أو منحول من الشعر الموجود في ذلك العصر أيًّا كان قائله.
رابعًا: التحدي وعجز العرب:
لقد تحدى القرآنُ العربَ، وكرر التحدي عليهم أن يأتوا بمثل القرآن، وظلّ يتدرج بهم إلى أن وصل أن يأتوا بسورة من مثل القرآن؛ فعجزوا.
أفإن كان القرآن من كلام محمد، فلِمَ عجزت العرب عنه؟!
إنّ أحدًا منهم لم يستطع أن يجاريه، ولا أن يطعن في عربيّته؛ ولذا: فإن أيّ طعن يوجّه للقرآن من جهة عربيّته من طاعن متأخر عن أبي جهل وأبي لهب وأضرابهم، فاعلم أنه باطل في ذاته؛ إذ لو كان صحيحًا لما غفل عنه هؤلاء الأعداء، وهم أبصر الناس باللغة، وأحرصهم على الطعن في القرآن.
ولا يصح القول أن العرب انصرفت هممهم عن معارضة القرآن؛ لأمور:
1- لأن الأسباب الباعثة على المعارضة كانت موفورة متضافرة، سيما مع استثارة حميتهم، والدعوة التي تكررت لهذه المعارضة، ولهي أهون عليهم مما قاموا به[7].
2- أن العرب قعدوا حتى عن تجربة المعارضة، ولم يشرع منهم إلا أقلّهم عددًا، وأسفههم رأيًا، إذًا فلقد كانوا في غنى بهذا العلم الضروري عن طلب الدليل عليه بالمحاولات والتجارب.
لقد كان القرآن نفسه مثار عجبهم وإعجابهم، ولقد كانوا يخرون سُجَّدًا لسماعه.
خامسًا: نزول الوحي:
لم يكن الوحي حالة اختيارية تعتري محمدًا -صلى الله عليه وسلم-، بل كان حالة غير اختيارية، وهذا -لمن يؤمن بالغيب- دليل على كون القرآن من عند الله.
فقُوَّة الوحي قوة خارجية؛ لأنها تتصل بنَفْس محمد حينًا بعد حين، وهي قوة عالمة، وهي قوة أعلى من قوته؛ لأنها تُحدِث آثارًا في بدنه، وهي قوة خيِّرة معصومة، لا توحي إليه إلا الحق.
فماذا عسى أن تكون تلك القوة إن لم تكن قوة ملَك كريم؟!
لقد كان الوحي نقطة تحَوُّل في علم الرسول -صلى الله عليه وسلم-. إن الرسول -صلى الله عليه وسلم- كان يمتلك أخلاقًا حسنة في حياته قبل البعثة، شهد بها خصومه، بل كان يُعرف بينهم بالصادق الأمين، ولم يكن هو نفسه يتوقع أن يُكلَّف بدور المرسَل من عند الله. لكن حياته تحوَّلت يوم نزل عليه الوحي.
وفي إدراك خصائص الوحي إدراكٌ لمصدره أيضًا:
1- لقد كان الوحي ينزل منجّمًا ومجزّءًا، ولم يكن النبي -صلى الله عليه وسلم- يصطنع الوحي، بل كان ينزل عليه بلا معرفة سابقة منه، بل ولا تهيُّؤ[8]!
2- وكان النبي -صلى الله عليه وسلم- يقف من الوحي موقف التعظيم، ويخشى أشد الخشية أن ينسب لله تعالى ما لم يقله، {قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي}[يونس: 15].
3- ولم يكن الوحي يعكس شخصية الرسول -صلى الله عليه وسلم-، ففي أكثر الأوقات لا يذكر عنه شيئًا، وتأمل -مثلًا- حين مات عمّه أبو طالب، وزوجته خديجة، وحزن لذلك حزنًا شديدًا، ومع ذلك لم يُشِر الوحي إلى ذلك. بل نجد في الوحي آيات اللوم والعتاب له -عليه الصلاة والسلام.
4- ولا يمكن أن يكون الوحي نابعًا من الإخلاص الشخصي للنبي -صلى الله عليه وسلم-، أو أنه من الأوهام اللاشعورية، وأنه اجترار لمعارف قديمة كانت طيّ النسيان؛ وذلك لأمور:
- لأننا لا نجد في التاريخ ما يمكن أن ينهض ليفسر استقامة الخط الذي اتّبعه القرآن، وتفسير خطواته الجازمة الفاصلة.
- لا يوجد أدنى علامة تشير من قريب أو بعيد لخللٍ عقلي، بل العكس هو الصحيح.
ولأنه لا يمكننا التعرض لتجربة الوحي لنتأكد من صحتها، إلا أنه يمكننا التحقق من صحة الوحي بأمور، منها:
1- الاتفاق في جوهر تعاليمه مع ما قرره الأنبياء السابقون، وهذا التطابق يفتح أعين الغافلين على صدقهم وصحة مبادئهم التي تناولت بالوصف الحقائق العليا من زوايا مختلفة.
2- الحقائق العلمية -المتفقة تمام الاتفاق مع المُشاهَد الحسِّي والواقع العلمي- المبثوثة في القرآن[9].
3- الأخبار المستقبلية، والتي أخبر القرآن بتحققها، ووقعت كما أخبر.
إنّ منهج القرآن الكامل ينهض دليلًا كافيًا على مصدره الرباني؛ لقد انتشرت الدعوة القرآنية في البداية في الجزيرة العربية بين العرب، ولكن غايتها هي أفرادُ البشرية أجمعون.
سادسًا: إعجاز القرآن (الإعجاز البياني):
ويندرج تحت هذه الحُجة عدّة أمور:
1- اختلاف الأسلوب القرآني عن الأسلوب النبوي:
إنّ لغة القرآن لتختلف عن لغة مبلِّغ القرآن، وهو الرسول -صلوات الله وسلامه عليه-، نحن نرى الأسلوب القرآني فنراه ضَرْبًا وحده، ونرى الأسلوب النبوي، فنراه ضربًا وحده لا يجري مع القرآن في ميدان إلا كما تجري محلِّقات الطير في جوّ السماء لا تستطيع إليها صعودًا، ثم نرى أساليب الناس فنراها على اختلافها ضربًا واحدًا لا تعلو عن سطح الأرض، فمنها ما يحبو حبوًا، ومنها ما يشتد عدوًا، ونسبة أقواها إلى القرآن كنسبة هذه (السيَّارات) الأرضية إلى تلك (السيَّارات) السماوية.
بل يمكن أن يستريب البليغ العالم في لفظة من الألفاظ النبوية، تشتبه عنده بألفاظ الصحابة والتابعين، لكنه لا يستريب البتة في الأسلوب القرآني؛ فإن له طابعًا لا يلتبس بغيره.
2- الخصائص البيانية في القرآن:
لقد تعددت الخصائص البيانية في القرآن الكريم، ومنها:
- القصد في اللفظ، والوفاء بالمعنى: فإنك تجد في القرآن بيانًا قد قُدِّر على حاجة النفس أحسن تقدير، يؤدي من كلّ معنى صورة نقية وافية؛ وكتاب الله لو نُزِعَتْ منه لفظة، ثم أُدير لسان العرب على لفظة أحسن منها، لم توجد.
- الجمع بين خطاب العامّة والخاصة: فهو قرآن واحد يراه البلغاء أوفى كلام بلطائف التعبير، ويراه العامة أحسن كلام وأقربه إلى عقولهم، لا يلتوي على أفهامهم، ولا يحتاجون فيه إلى ترجمان وراء وضع اللغة، فهو متعة العامّة والخاصّة على السواء، ميسَّر لكلّ مَن أراد.
- إقناع العقل، وإمتاع العاطفة: في النفس الإنسانية قوتان: قوة تفكير، وقوة وجدان، وحاجة كلّ واحدة منهما غير حاجة أختها.
وفي القرآن وفاء هاتين الحاجتين على التمام، اقرأ مثلًا قوله تعالى: {لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ}[الأنبياء: 22]، وانظر كيف اجتمع الاستدلال والتهويل والاستعظام في هذه الكلمات القليلة.
بل الدليل نفسه جامع بين عمق المقدمات اليقينية، ووضوح المقدمات المُسلَّمة، ودقة التصوير لما يعقب التنازع من (الفساد) الرهيب، فهو برهاني خطابي عاطفي معًا.
- الجمع بين البيان والإجمال: وهذه عجيبة أخرى تجدها في القرآن ولا تجدها فيما سواه، تقرأ القطعة من القرآن فتجد في ألفاظها من الشفوف والملاسة والإحكام والخلوّ من كلّ غريب عن الغرض ما يتسابق به مغزاها إلى نفسها دون كدِّ خاطر ولا استعادة حديث، كأنك لا تسمع كلامًا ولغات بل ترى صورًا وحقائق ماثلة، وهكذا يخيّل إليك أنك قد أحطت به خُبرًا، ووقفت على معناه محدودًا. هذا ولو رجعْتَ إليه كَرَّة أخرى لرأيتَكَ منه بإزاء معنى جديد غير الذي سبق إلى فهمك أول مرة، وكذلك.
- الوحدة الموضوعية: لا يُستراب أن القرآن نزل مفرَّقًا حسب الوقائع والدواعي، وأن ترتيبه إنما وقع بوحي من الله، ولا شك أن القرآن أكثره يتناول شؤون القول، ويتنقل بين تلك الشؤون من وصف، إلى قصص، إلى تشريع، إلى جدلٍ، إلى ضروب شتى.
ومع ذلك، وكون هذا الانفصال الزماني والاختلاف الذاتي يستتبعان تفكيك الكلام وتقطيع أوصاله؛ إلا أنَّا نجد السورة من القرآن كالشيء الواحد لا انفصام بين قطعة وأخرى، ولا بين مُفتتَح وختام.
إنه لا يجرؤ في قرارة الغيب على وضع هذه الخطة المفصّلة المصممة إلا أحد اثنين: جاهل جاهل في حضيض الجهل؛ أو عالم عالم فوق أطوار العقل. لا ثالث.
إنك لتقرأ السورة الطويلة المنجَّمة يحسبها الجاهل أضغاثًا من المعاني حُشيت حشوًا، وأوزاعًا من المباني جُمعت عفوًا؛ فإذا هي -لو تدبرت- بِنْيَة متماسكة قد بُنِيَت من المقاصد الكلية على أسس وأصول، وأقيم على كلّ أصل منها شُعَب وفصول، وامتدّ من كلّ شُعبة منها فروع تقصر أو تطول؛ فلا تزال تنتقل بين أجزائها كما تنتقل بين حجرات وأفنية في بنيان واحد قد وُضع رسمه مرة واحدة، لا تحسّ بشيء من تناكر الأوضاع في التقسيم والتنسيق، ولا بشيء من الانفصال في الخروج من طريق إلى طريق، بل ترى بين الأجناس المختلفة تمام الألفة، كما ترى بين آحاد الجنس الواحد نهاية التضامِّ والالتحاق.
كلّ ذلك بغير تكلفة ولا استعانة بأمر من خارج المعاني أنفسها، وإنما هو حسن السياقة ولطف التمهيد في مطلع كلّ غرض ومقطعه وأثنائه، يريك المنفصل متصلًا، والمختلف مؤتلفًا[10].
ومن خلال هذه الحُجج الستّ وما يندرج تحتها، تتبين أسباب التسليم بمصدرية القرآن، وكونه من كلام الله -عزّ وجلّ-، لا من كلام النبي محمد -صلى الله عليه وسلم-، ويتبقّى الكلام حول سلامة النصّ القرآني من التحريف، والحُجج عليها، وهذا ما نتناوله في مقالتنا القادمة بإذن الله تعالى.
[1] يمكن الإلمام بطرف من تعريف القرآن بنفسه من الكتب التالية:
1- حديث القرآن عن القرآن، للشيخ د. محمد الراوي، ط. دار العبيكان.
2- أسماء القرآن وأوصافه في القرآن الكريم، د. عمر الدهيشي، ط. دار ابن الجوزي.
ويمكن أن يختم المؤمن القرآن ختمة؛ ليتعرف من خلال هذه الختمة على القرآن، وكيف تحدث عن نفسه.
[2] آثرنا ألَّا نثبت النقل في هذا المبحث منعًا للتشتت، وننبه أن الكلام مأخوذ من كتابي العلامة د. محمد دراز -رحمه الله-، مع إعادة الصياغة في بعض الفقرات، وتقديم وتأخير، فمن أراد المزيد فلينظر:
1- النبأ العظيم، للدكتور محمد عبد الله دراز، بعناية: عمرو الشرقاوي.
2- مدخل إلى القرآن، د. محمد عبد الله دراز، ط. دار القلم.
وانظر، أيضًا: براهين النبوة، د. سامي عامري، مركز تكوين للدراسات والأبحاث.
[3] ويلحق بهذه الحجة:
1- تأخر نزول الوحي عليه في الحوادث المهمّة، والتي تتعلق بشأنه الخاصّ، كحادثة الإفك، والآيات التي تشتمل على عتابه عليه الصلاة والسلام، وتوقفه في تأويل بعض الآيات حتى ينزل الوحي، وسائر أموره العامة؛ كلّ ذلك دليل على بطلان أن تكون هذه الشخصية من الشخصيات التي تتوصل إلى مرادها بالكذب والتمويه.
إن صاحب هذا الخلق العظيم وصاحب تلك المواقف المتواضعة بإزاء القرآن، ما كان ينبغي لأحد أن يمتري في صدقه حينما أعلن عن نفسه أنه ليس هو واضع ذلك الكتاب، وأن منزلته منه منزلة المتعلم المستفيد، بل كان يجب أن نسجل من هذا الاعتراف البريء دليلًا آخر على صراحته وتواضعه.
2- ومما يضاف لهذا: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم ينسب كلّ أقواله إلى القرآن، بل إننا نعلم الفرق بين القرآن، وبين الأحاديث القدسية والنبوية، فلو كان القرآن مختلقًا من عنده، فلِمَ لم ينسب جميعها إليه؟!
[4] وليست القراءة والكتابة قيمة ذاتية، وإنما قيمة القراءة والكتابة قيمة غائية تهدف إلى تحصيل العلم، وهو حاصل لمحمد -صلى الله عليه وسلم- عندنا بالوحي.
ومع دلالة الآية السابقة على هذه المسألة، إلا أنه مما يؤكد تلك القضية أمور، منها:
1- اتخاذه كُتَّابًا للوحي من خاصة صحبه.
2- أنه لم يعرف موقع اسمه المكتوب في صلح الحديبية.
3- الشهرة المستفيضة بعدم معرفته للكتابة.
وعلى أيَّة حال، فإن من المتفق عليه؛ كونه -صلى الله عليه وسلم- لم يكن يمارس القراءة والكتابة قبل بعثته.
[5] انظر: صحيح البخاري: (4136)، والترمذي: (3046).
[6] لما ضاقت بالمشركين دائرة الجد، ما وسعهم إلا فضاء الهزل، فادّعوا أن محمدًا تعلم من غلام في مكة، وقد كان هذا الغلام نصرانيًا تعرفه الحوانيت والأسواق، أعجمي اللسان مع ذلك!
ولنا أن نقول: ما الذي منع قومه -إن كان قولهم الحق- من أن يأخذوا كما أخذ محمد، والغلام بين ظهرانيهم، وبذلك يستريحون من عنائهم بمحمد، ويداوونه من جنس دائه، بل ما الذي منع الغلام نفسه من أن يتبوأ هذه المنزلة، أو يتولى بنفسه تلك القيادة؟! إن ذلك لا يفسر إلا بشيء واحد؛ أنه من تخرصات الجاهليين، إذ لم يجدوا ما يمكن أن يدحض الحجة الساطعة إلا بمثل هذا الهزل من القول.
[7] لقد ذهبوا في محاربته كلّ مذهب: أيخادعونه عن دينه لِيَلِين لهم ويركن قليلًا إلى دينهم، أم يساومونه بالمال والملك ليكف عن دعوته، أم يتواصون بمقاطعته وبحبس الزاد عنه وعن عشيرته الأقربين حتى يموتوا جوعًا أو يُسلموه، أم يمنعون صوت القرآن أن يخرج من دور المسلمين خشية أن يسمعه أحد من أبنائهم، أم يلقون فيه الشبهات والمطاعن، أم يتهمون صاحبه بالسحر والجنون ليصدوا عنه مَن لا يعرفه من القبائل القادمة في المواسم، أم يمكرون به ليثبتوه أو يقتلوه أو يخرجوه، أم يخاطرون بمُهَجهم وأموالهم وأهليهم في محاربته، أفكان هذا كله تشاغلًا عن القرآن وقلة عناية بشأنه؟! ثم لماذا كلّ هذا وهو قد دلَّهم على أن الطريق الوحيد لإسكاته هو أن يجيئوه بكلام مثل الذي جاءهم به؟ ألم يكن ذلك أقرب إليهم وأبقى عليهم لو كان أمره في يدهم؟ ولكنهم طرقوا الأبواب كلها إلا هذا الباب، وكان القتل والأسر والفقر والذلّ كلّ أولئك أهون عليهم من ركوب هذا الطريق الوعر الذي دلهم عليه. فأي شيء يكون العجز إن لم يكن هذا هو العجز؟!
[8] كحادثة الإفك.
[9] قال الدكتور دراز تحت عنوان: حقائق علميّة: «ولكن القرآن في دعوته إلى الإيمان والفضيلة لا يسوق الدروس من التعاليم الدينية والأحاديث الجارية وحدها، وإنما يستخدم في هذا الشأن الحقائق الكونية الدائمة، ويدعو عقولنا إلى تأمل قوانينها الثابتة، لا بغرض دراستها وفَهْمِها في ذاتها فحسب؛ وإنما لأنها تذكِّر بالخالق الحكيم القدير، ونلاحظ أن هذه الحقائق التي يقدّمها تتفق تمامًا مع آخر ما توصّل إليه العلم الحديث»، ثم ذكر -رحمه الله- أمثلة لذلك.
وعلّق على ذلك بقوله: «عند اختيارنا للآيات التي استشهَدْنا بها في هذه الفقرة، حرَصْنا على تلافي ما يُعاب به على الطريقة التوضيحية المعروفة بالتأويل، والتي تتلخص في تفسير آيات القرآن بحيث تتفق نتائج التفسير مع النتائج العلمية المقررة.
ولكن الحماس دفع بعض المفسرين المُحدَثين إلى المبالغة في استخدام هذه الطريقة التوفيقية لصالح القرآن، بحيث أصبحت خطرًا على الإيمان ذاته؛ لأنها إما أن تقلل من الاعتماد على معنى النصّ باستنطاقه ما لا تحتمله ألفاظه وجُمَله، وإما أن تعوّل أكثر مما يجب على آراء العلماء، وحتى على افتراضاتهم المتناقضة، أو التي يصعب التحقيق من صحتها.
وبعد أن نستبعد هذه المبالغات عن البحث، نرى أن من مقتضيات الإيمان -التي لا غنى عنها- أن نضاهي الحقائق الفورية التي نجدها في القرآن مع نتائج العلماء المنهجية البطيئة».
[10] وملخص هذه الحجة -إن استطلتها- أن القرآن جاء نموذجًا لا يبارَى في الأدب العربي، إنه المثل الأعلى لما يمكن أن يسمى أدبًا بوجه عام، فلغته تأخذ بالقلوب، وتفحم بالحجة، وتجلب السرور الهادئ لا الصاخب.
1- لغة القرآن مادة صوتية، تبعد عن طراوة لغة أهل الحضر، وخشونة لغة أهل البادية، إنها تجمع بين رقّة الأولى، وجزالة الثانية.
2- إنها ترتيب في مقاطع الكلمات في نظام أكثر تماسكًا من النثر، وأقل نظمًا من الشعر.
3-كلماته منتقاة، لا توصف بالغريب إلا نادرًا، تمتاز بالإيجاز العجيب، والنقاء في التعبير.
4- إنه أسلوب يجمع بين العقل والعاطفة على رغم ما بينهما من تباعد.
5- وهو في وحدة سوره، وترتيبها، وتناسق أجزائها آية، وأيّ آية!
الكاتب:

عمرو الشرقاوي
باحث في التفسير وعلوم القرآن، شارك في عدد من الأعمال العلمية المنشورة.
مواضيع ذات صلة
((المعلومات والآراء المقدَّمة هي للكتّاب، ولا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع أو أسرة مركز تفسير))