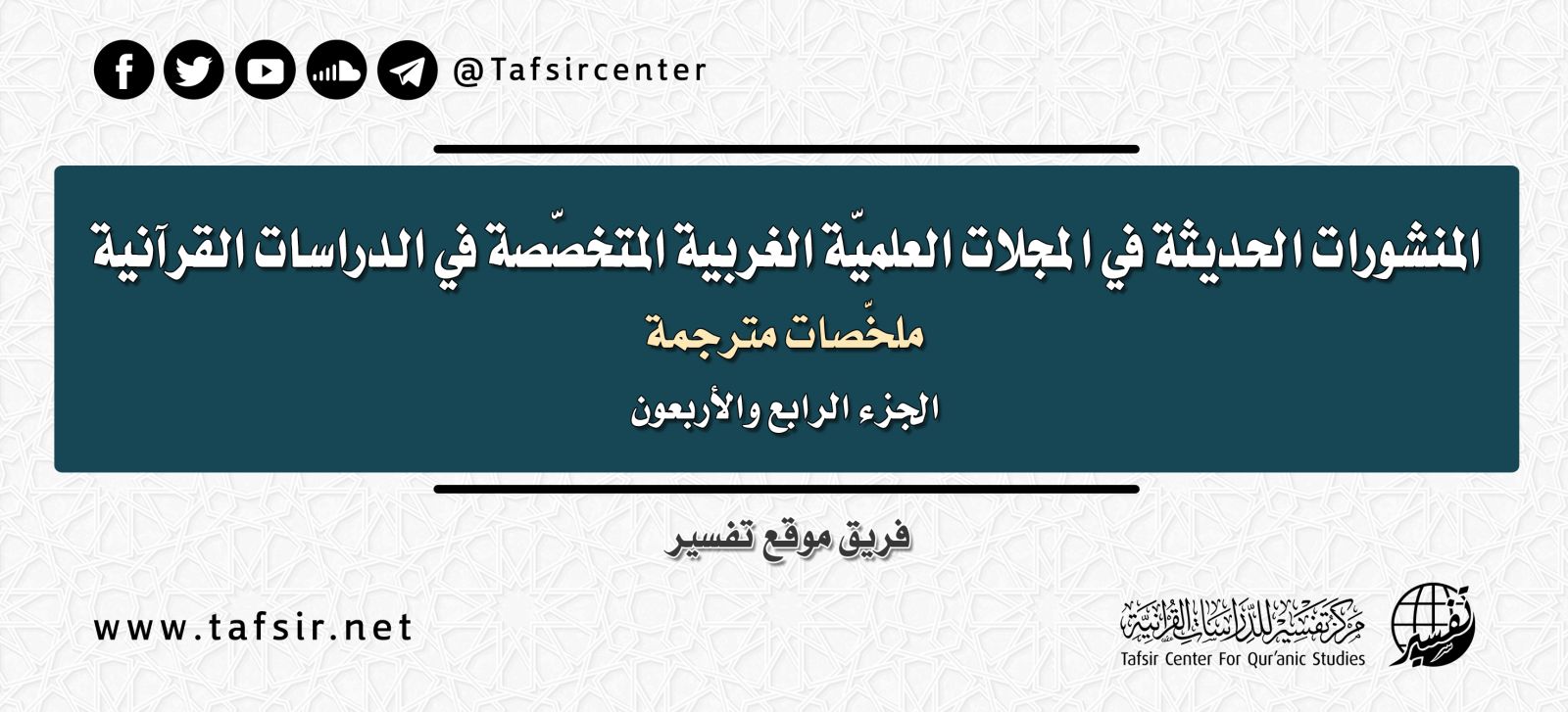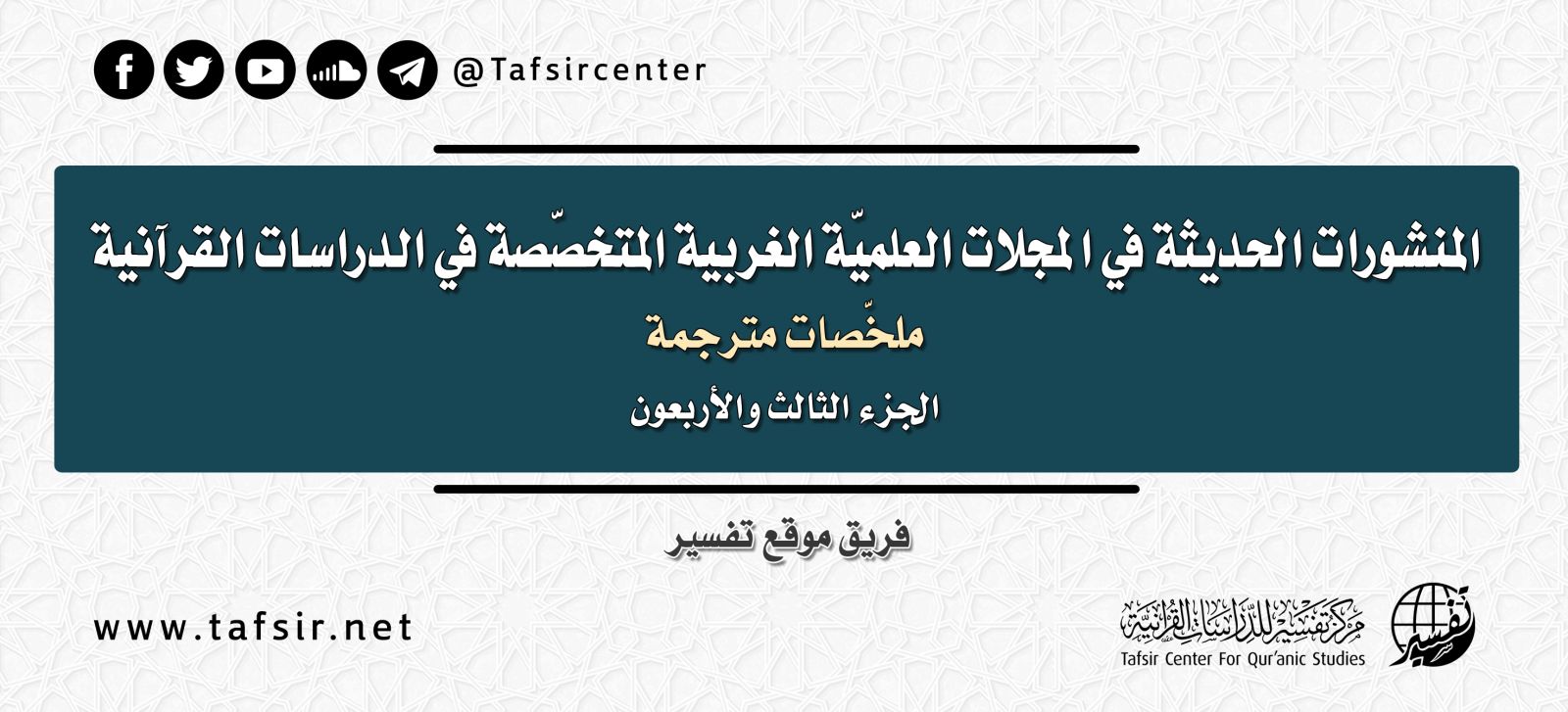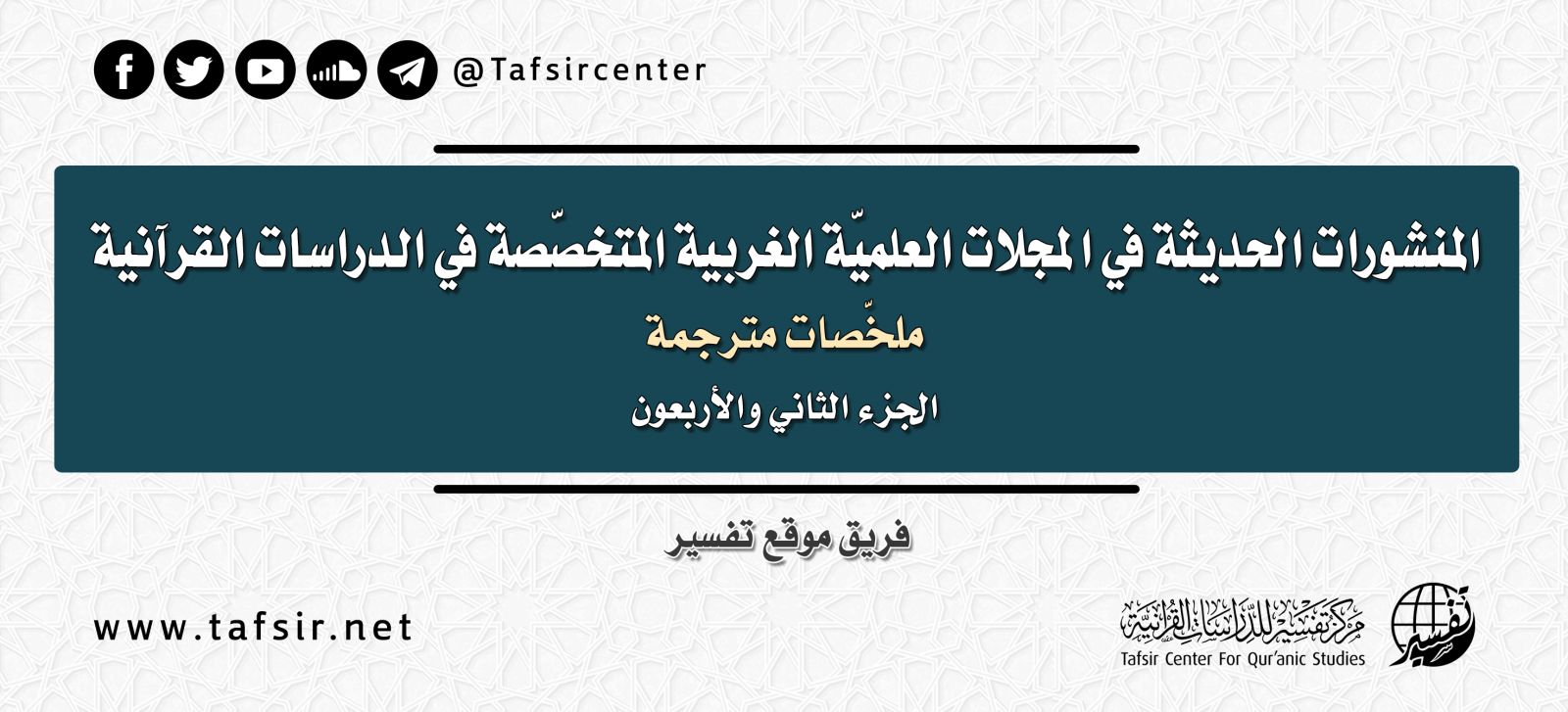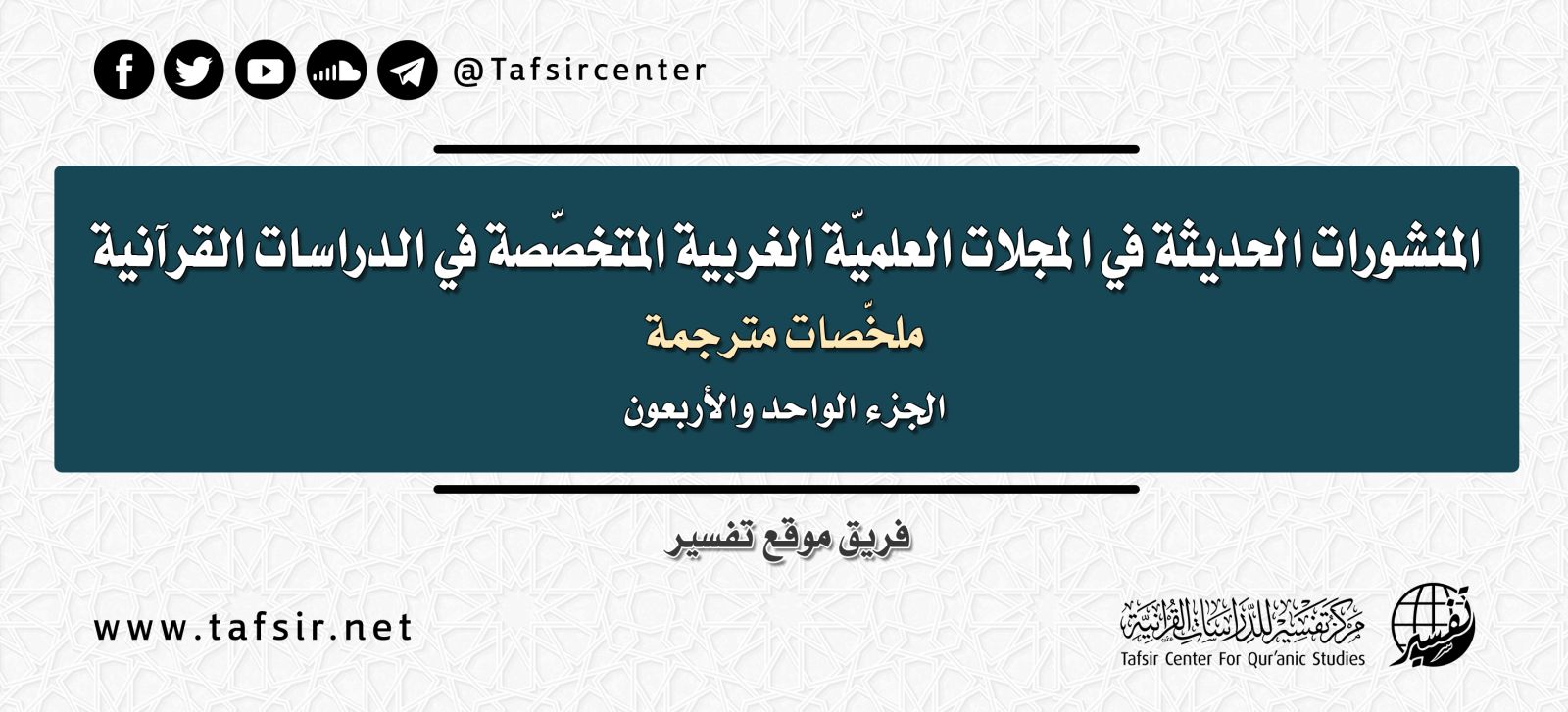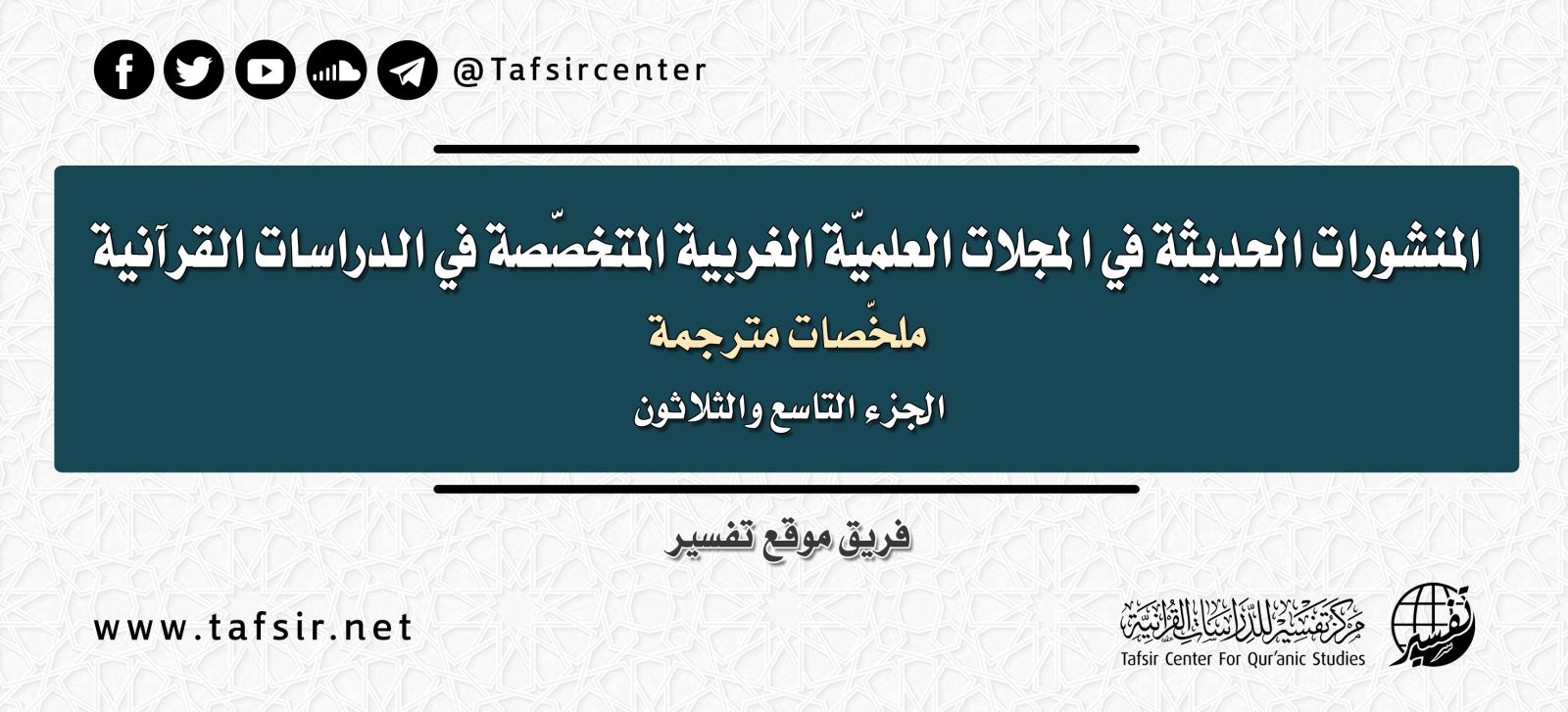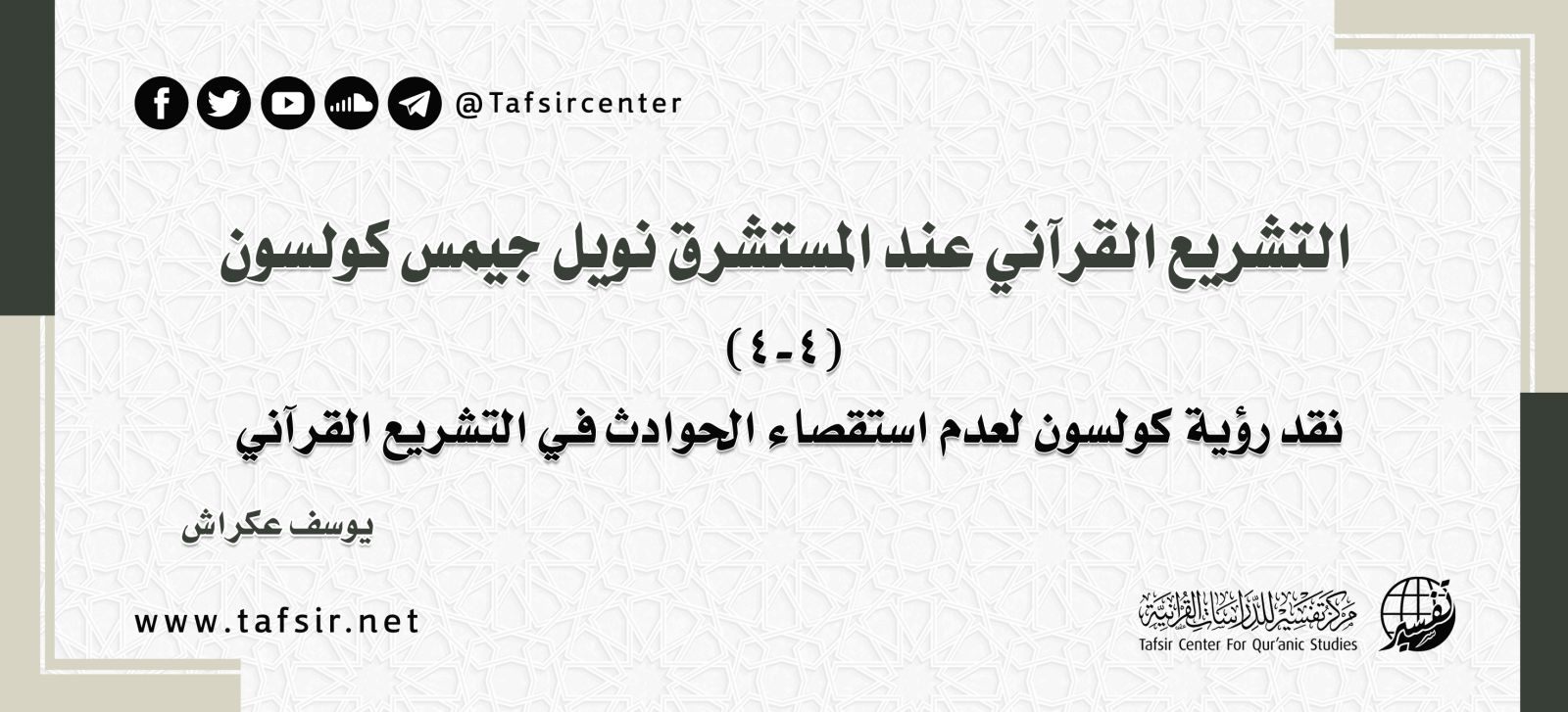عرض كتاب: من وراء القرآن، تفسيرات حول نشأة القرآن وموقف اليهودية والإسلام من بعضهما لـ«حي بر- زئيف»
من وراء القرآن، تفسيرات حول نشأة القرآن وموقف اليهودية والإسلام من بعضهما
لـ«حي بر- زئيف»
الكاتب: أحمد صلاح البهنسي

حاز القرآنُ الكريم مكانةً مهمّة وبارزة من بين موضوعات الاستشراق الإسرائيليّ واهتماماته؛ سواء بالدراسة، أو الترجمة، أو النقد والتحليل، وفي إطار هذا الاهتمام يأتي الكتاب الماثل للعرض (מאחוריהקוראן من وراء القرآن) لمؤلفه حي بر- زئيف، والذي تنبع أهميته من عدّة اعتبارات؛ لعلّ أهمها أنه يعكس الرؤية الاستشراقية الإسرائيلية المعاصرة للقرآن الكريم وما تنطوي عليه من تكرار واستمرارية للسردية الاستشراقية عامّة واليهودية خاصّة، القائلة بأنّ القرآن مقتبَس من المصادر الدينية اليهودية لا سيّما التوراة.
يزيد من أهمية الكتاب أنه يؤكّد فكرة أنّ الاستشراق الإسرائيلي بمثابة (ذراع علمي) لصانع القرار الإسرائيلي؛ إِذْ يبدو واضحًا جَمْع الكتاب بين تناوله الشامل للقرآن ولعدّة موضوعات تتعلق به: (النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الآيات المدنية والمكية، موقف القرآن من اليهود، تأثُّـر القرآن باليهودية والنصرانية)، وبين تأثير ذلك على الواقع السياسي المعاصر بالمنطقة، لا سيّما تأثير القرآن على هذا الواقع خاصّة ما يتعلق بما سمّاه مؤلّف الكتاب بالحركات الإسلامية المتشدّدة أو الأصوليين الإسلاميين، فيما يعدّ دليلًا واضحًا على أنّ الكتاب بمثابة دراسة علمية مقدّمة للمستوى السياسي الإسرائيلي حول الشؤون الإسلامية وعلاقة القرآن بها.
رغم التزامنا في العرض بالسّرد الوصفي الموضوعي لأهمّ محتويات الكتاب، إلا أننا حرصنا على التركيز على الأفكار والموضوعات التي تعكس رؤى مؤلِّفه وانتماءاته الفكرية وأغراضه الأيديولوجية؛ ومن أبرزها معالجته لـتأثير القرآن على الصراع العربي الإسرائيلي والواقع الإسلامي المعاصر، وكذا التعريف بمؤلِّفه، وسرد أهمّ الآراء حتى تلك التي كتبها مؤلِّف الكتاب نفسه حول الكتاب ومحتوياته، علاوة على التعريف بمنهج الكتاب ونقده.
أولًا: بيانات الكتاب ومحتوياته:
عنوان الكتاب: من وراء القرآن، تفسيرات حول نشأة القرآن وموقف اليهودية والإسلام من بعضهما.
المؤلف: حي بر- زئيف.
جهة وسنة النشر: دار نشر «أوريون» الإسرائيلية، 2010.
عدد الصفحات: 281 صفحة.
أمّا عن محتويات الكتاب، فقد قسَّمه المؤلِّف إلى ثمانية فصول مصدَّرة بمقدّمة، وهي كالآتي:
(مصطلحات رئيسة)، يسرد ويحلّل بعض المصطلحات الأساسية في مجال الأديان تتعلّق باليهودية والإسلام، ويحتوي على جزء سمّاه بمداخل من التوراة موجودة في القرآن، كما يتعرّض لفرائض القرآن والخطوات الأُولى لنشأته ودخول ما سمّاها بـ(الأرثوذكسية الإسلامية) للقرآن.
(محمد بمكة- تلميذ متفانٍ لحاخام يهودي)، يتلخّص حول السردية الاستشراقية اليهودية القديمة- الجديدة القائلة بتعلُّم محمد القرآن من حاخام يهودي، لا سيّما ما يتعلّق ببني إسرائيل وكيفية نزول التوراة عليهم. كما يتعرّض لرحلة الإسراء والمعراج في القرآن والمسجد الأقصى والكَتبة الأطهار ومصطلحات قرآنية أخرى.
(محمد في المدينة تلميذ لقسّ)، يركّز على أنّ القرآن مقتبَس من أجزاء بالإنجيل، ويقارن بين شخصية يسوع المسيح في القرآن وفي التلمود، وكذا تأثُّـر القرآن بالانتقادات الإنجيلية لليهود.
(محمد أصبح نبيًّا)، يتعرّض لِمَا رَصَدَهُ القرآن من جدلٍ حول أفكار دينية بين محمد ويهود المدينة، ونظرة القرآن لليهود وتبنّي محمد لدين إبراهيم، متسائلًا: هل يحاول القرآن إثبات نبوّة محمد؟
(زراعة دين جديد)، يتعرّض لِمَا اعتبره مفاهيم قرآنية وضعها محمد للتفريق بين دينه الجديد واليهودية والنصرانية، ومحاولة محمد التنصُّل من هاتين الديانتَيْن وأَتْباعِهما، وادّعاء تعرُّضهما للعقاب الإلهي.
(الإسلام بمواجهة اليهودية)، يُبرز فكرة أنّ القرآن يشرح علاقة اليهود بأنبيائهم بصورة جزئية.
(تراثان)، يتعرّض للحديث النبوي الشريف، وكذا الفوارق بين نقد العهد القديم عند اليهود وعند المسلمين.
(فترتنا الحالية وأمل المستقبل)، يستعرض رؤية القرآن وكذا النصرانية لبعض الأفكار والرؤى الدينية؛ مثل فكرة (آخر الأيام)، وكذا رؤية الحركات الإسلامية المتشدّدة للقرآن ولكلام أنبياء بني إسرائيل.
ويذيّل الكتاب بخاتمة تلخّص أهمّ الأفكار الواردة فيه، وكذا ملحق يتضمّن شرح ومناقشة أسماء شخصيات وردَت في القرآن؛ مثل النبي صالح، وأبي لهب، والسامري، ويشرح أيضًا قضية الحروف في بداية عدة سور قرآنية، ثم يختتم الكتاب ببليوغرافيا لأهم المصادر والمراجع.
ثانيًا: مؤلف الكتاب وأهدافه:
(حي بر- زئيف): كاتب يهودي -إسرائيلي- فرنسي، وهو بالأساس مُعلِّم للدراسات اليهودية في فرنسا وباحث في الأديان عامّة والإسلام خاصّة، ووفقًا للمعلومات المتوفرة، فإنّ مؤلِّف الكتاب استخدم اسمًا مستعارًا وَضَعَهُ على كتابه الماثل للعرض، خوفًا من أن يتعرّض للقتل أو المطاردة بسبب الأفكار الواردة فيه، وبالتالي فإنّ المعلومات الببليوغرافية المتاحة عن (زئيف) تعدّ قليلة جدًّا أو شبه معدومة.
رغم ذلك فإنّ المعلومات عن الكتاب ودوافع مؤلِّفه لكتابته متوافرة؛ ومِن أبرزها تصريح المؤلِّف أنه هَدَفَ من وراء كتابه استبيان الجذور الدينية لِمَا سمَّاه بالصراع اليهودي - العربي من زاوية أخرى؛ إِذْ رأى أنّ كتابه يُلْقِي الضوء على الدوافع وراء كراهية المسلمين لليهود والتي تعود لجذور دينية وتاريخية، وهو ما يُفسِّر قول بعضهم أنّ الكتاب كَشَفَ عن الدوافع التي تحرِّك الحرب الإسلامية ضد اليهود، وأنه كشفَ عن أنها خليط من الدوافع الثيولوجية تعود لزمن محمد وتنعكس في القرآن .
كما ذكَرَت كتابات أخرى حول الكتاب أنه يُفنِّد الأُسُس التي قام عليها الإسلام ويكشف عن وجود دماء يهودية لدى محمد مؤسِّس الإسلام، ويرفض أن يكون القرآن وما ارتبط به من تراث شفوي هو من نتاجِ محمد، رادًّا إياها إلى مصادر يهودية سواء بشرية أو فكرية.
بتحليل المعلومات سالفة الذِّكْر عن الكتاب ومؤلِّفه، نراها تجسيدًا قويًّا لأهمّ السِّمَات التي تميز الاستشراق الإسرائيلي عن غيره من المدارس الاستشراقية الأخرى، فيتّضح جليًّا فيها سمة (التكرار والاستمرارية)؛ إِذْ يمثّل الكتاب استمرارًا وتكرارًا لأفكار ومناهج المدارس الاستشراقية الغربية نفسها حول القرآن الكريم لا سيّما اليهودية منها، والتي تتخذ من فكرة تأثُّـر أو اقتباس القرآن من اليهودية أساسًا فكريًّا لها.
كما تتّضح (غلبة الطابع السياسي) على الكتاب من خلال تصريح مؤلِّفه أنه هَدَفَ لاستبيان جذور الصراع العربي اليهودي، ما يعني أنه رغم أنّ موضوع الكتاب (ديني) بحت؛ إِذْ ينصبُّ حول القرآن، إلا أنّ هدفه (سياسي) بحت؛ نظرًا لانتماء مؤلِّفه لمرحلة الاستشراق الإسرائيلي المرتبطة بكيان سياسي هو إسرائيل، وتهدف لتقديم خدمات علمية ومعرفية لهذا الكيان.
تظهر كذلك سمة (التعددية اللغوية) بكتابات الاستشراق الإسرائيلي من خلال هذا الكتاب، فهو ترجمة للعبرية قام بها مؤلِّفه لكتابه بالفرنسية بعنوان: (القرآن.. قراءة يهودية)، ما يعني أننا أمام مستشرق إسرائيلي يكتب بالفرنسية والعبرية علاوة على معرفته بالعربية، وهي صفة موجودة في غالبية المستشرقين الإسرائيليين الذين يكتبون بعدّة لغات ولا يكتبون بالعبرية فقط اللغة الأُولى والرسمية في إسرائيل.
ثالثًا: الأفكار المركزية للكتاب:
1- القرآن.. الأُسس والنشأة:
قسَّم مؤلِّف الكتاب النصَّ القرآني إلى ثلاثة موضوعات رئيسة؛ الأول: اقتباسات عدة من مصادر يهودية لا سيما ما يتعلق بمفهوم التوحيد، الثاني: عدة مداخل من العهد الجديد، الثالث: عِظات ومناقشات خاضها محمد مع العرب واليهود والنصارى.
وحصرَ المؤلّف عدة قصص واردة بالقرآن وردَّها إلى أسفار التوراة الخمسة؛ ومن أبرزها قصة الخلق، وقصة آدم وحواء في جنة عدن، وقصة الخطايا، وقصة قابيل وهابيل، وقصة إبراهيم وخلافه مع أبيه، وقصة موسى، وقصة الضربات العشر التي أصابت بني إسرائيل واجتيازهم البحر الأحمر.
أمّا عن فرائض القرآن فحَصَرَها في الخوف من الله خالق العالم، وعدم إشراك إله آخر معه، والصلاة له، واحترام الأبوين، والرحمة بالجار واليتيم والأرملة، وإخراج الصدقة، وقول الحقّ والسعي للسلام. إلا أنه أشار إلى أن القرآن يدعو إلى الحرب المقدّسة ضد الكافرين بالله والأنبياء، والرعايا اليهود والنصارى، أمّا الذين يَقْبَلُون بالإسلام فلا يجب قَتْلُهم لكن يجب عليهم دفعُ الجزية.
وعن التعريف بنشأة القرآن قال مؤلِّف الكتاب إنه يُقسَّم إلى سور، والتي تنقسم إلى قسمين؛ الأول: الخُطب التي قالها محمد بمكة من سنة 610 إلى 622 ميلادية، والثاني: الخُطب التي قالها منذ هجرته إلى المدينة وحتى وفاته بها، من سنة 622 وحتى 632. ولفَتَ إلى أنّ القرآن نفسه لم يُصنِّف هذه السور وفقًا لمكان نزولها، لكن المسلمين والمستشرقين قاموا بذلك، علمًا بأنّ هناك بعض الأجزاء تنتمي لفترات تاريخية مختلفة عمّا نُسبت إليها.
كما أشار إلى أن هناك اختلافًا كبيرًا بين السور المكية والمدنية، ورأى أن الفرق بينهما في أن الأُولى يَطغى عليها الوعظ بالإيمان بالإله وغيرها من العقائد الـمُقتبَسة من اليهودية، أمّا السور المدنية فمليئة بعدة مفاهيم من العهد الجديد وبها عدة اتهامات ضد اليهود، ولا شكّ أن هذه السور تأثَّـرت بالنصرانية.
2- تأثر القرآن باليهودية:
تحت عنوان: (محمد في مكة.. تلميذ متفانٍ لحاخام يهودي)، أسهبَ مؤلِّف الكتاب في فكرة تأثُّـر محمد بالأفكار اليهودية في القرآن من خلال تتَلْمُذِهِ على يدي حاخام يهودي خلال فترة تواجده في مكة؛ إِذْ رأى أنّ محمدًا استخدم اليهود وتوراتهم لدعم دينه الجديد وإقناع عرب مكة والجزيرة العربية به، وضرب الكتاب مثلًا بالآية 16 من سورة الجاثية: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾، كدليل على محاولة محمد التقرب للعرب من خلال اعترافه باليهود واقتباسه من كتابهم وموروثهم الديني.
وأضافَ مؤلِّف الكتاب أنّ مُعلِّم محمدٍ اليهوديَّ كتبَ له أجزاءً من القرآن بالعربية، إضافةً إلى اقتباسات أخرى مأخوذة من التوراة والعهد القديم والتلمود، وأن هناك أجزاءً أخرى كانت في القرآن يظهر بها التأثير اليهودي بشكلٍ أقوى، لكن الخليفة عثمان بن عفان أخفاها عند جمع القرآن أو دمَّرها، ولربما أحد آخر قبل عثمان قام بذلك.
ووفقًا لـ(زئيف) فإنه رغم وجود خلاف في الصيغة النصّية بين القرآن والتوراة، إلا أن هناك تشابهًا في الكثير من المضامين؛ مثل قصة تكليم الربّ لموسى وإعطاء بني إسرائيل التوراة.
يُلحظ كذلك في هذا الجزء من الكتاب أن مؤلّفه ركّز على تأثُّـر القرآن في المراحل الأُولى باليهودية واقتباسه من التوراة متبنِّيًا فكرة أن القرآن يتكوّن من جزأين: الأول هو الذي كتبه معلِّم محمد اليهودي باللغة العربية، والثاني يمكن وصفه باليوميات والتي تتضمّن أنشطة محمد وحياته والأحداث المختلفة التي مرّ بها.
كما أشار إلى أنّ محمدًا خلال فترة تواجده بمكة اعتمد كثيرًا على اليهود لإقناع العرب بديانته الجديدة، وأنه في حالة ما كان يدخل في جدل مع العرب عبدة الأصنام كان يلجأ إلى التوراة لاقتباس قصص منها لإسكات العرب، ثم اقترح عليه معلِّمُه اليهودي بعد ذلك أن يكتب كتابًا بالعربية يَقْتَبِس فيه كلَّ قصص التوراة، وذلك بعدما أصرَّ العرب على مطالبة محمد أن يُريهم الكتاب الأصلي الذي يَقتبِس منه أفكاره.
يدلّل مؤلِّف الكتاب على كلامه بعدّة اقتباسات من القرآن ويردّها إلى العهد القديم، لعلّ مِن أبرزها قصة أصحاب الأخدود الواردة في سورة البروج؛ إِذْ يردّها إلى سفر دانيال الذي يحكي عن ثلاثة يهود أُلقوا في أخدود نار بعدما رفضوا السجود إلى الملك نبوخذ نصر، إلا أنّ معجزة أنقذتهم وخرجوا من النار بسلام.
3- تأثر القرآن بالنصرانية:
أشار مؤلِّف الكتاب إلى أنه مع فرض أنّ كلّ ما جاء في القرآن هو من تأليف محمد فمِن الواضح أنّ مُعلِّمَه في المدينة كان قسًّا أو يهوديًّا تنصَّر، ذا معرفة إلى حدٍّ ما باليهودية، وفقيهًا في المجادلات الدينية الكلاسيكية بين اليهود والنصارى، لكن يبدو أنّ هذا المعلِّم قد مات أو ترك محمدًا، وجاء بدلًا منه معلِّم آخر، فقد كان واضحًا أن المجادلات الدينية التي سجَّلها القرآن لم تخرج من فمِ محمد لكن من نصارى غيورين على دينهم أو من يهود تنصّروا؛ فقد أورد القرآن هذه المجادلات بشكلٍ غير واضح.
فسَّر مؤلِّف الكتاب ذلك بأن دعوة محمد لاستمالة يهود المدينة لم تنجح، فلجأ لكسبِ ودِّ النصارى عن طريق القول بأنّ يسوع المسيح تلقَّى إذنًا من السماء بأن يأخذ النصارى جزءًا من التوراة؛ نظرًا لأن اليهود لم يفهموا التوراة ولم يحافظوا عليها.
حدّد الكتابُ ثلاثةَ أمور اقتبَسَها القرآن من الإنجيل؛ الأول: هو أنه يمكن للمرء أن يتهوّد بدون أن يَقْبَل بكل قوانين وأحكام التوراة فيما يتعلّق بالمحرّمات من الطعام، الثاني: هو أن محرمات الطعام من الأكل التي فُرضت على اليهود هي بسبب أنهم أشرار وخطّاؤون، الثالث: أن يسوع المسيح حصل على إِذْنٍ مِن خالقِ العالم بإبطال هذه المحرمات.
كما رأى مؤلِّف الكتاب أن القرآن اقتبسَ أحد الخلافات القوية بين مؤسّسي النصرانية واليهود وهي المتعلقة بادّعاء (بولس) بأنّ (موسى) لم يحصل على قوانين المحرمات من الطعام من ربِّ العالمين، ولكن أضافها من عنده. ورأى مؤلِّف الكتاب أيضًا أن القرآن يبرّر رأي المسيح في اليهود المعاصرين له؛ إذ وصَفَ مَن آمنوا به بالصِّدِّيقِين، في حين وصَفَ من لم يؤمنوا به بالأشرار.
ويُلحظ الجانب الأيديولوجي الديني لدى مؤلِّف الكتاب في هذا الجزء؛ إِذْ يدافع في كلّ جزئية عن موقف اليهود من المسيح ويؤكّد في نهاية هذا الجزء أنّ هناك فارقًا تاريخيًّا بين أنبياء بني إسرائيل على مرّ أجيال وبين المسيح، وأن هذا التاريخ أثبتَ أنّ لأنبياء بني إسرائيل إرثًا أخلاقيًّا كبيرًا حافظوا عليه، وأنهم أظهروا حكمةً وصِدقًا، وأنهم قادوا الأجيال اليهودية وكشفوا عن الأشرار واحترموا الحكماء والصِّدِّيقِين والأخيار من الأمّة.
4- موقف القرآن من اليهود واليهودية:
تعرّض الكتاب كذلك لموقف القرآن من اليهود واليهودية، ورأى مؤلِّفه أن القرآن طالب يهود المدينة بالإيمان بمحمد ورسالته؛ إلا أنهم نظرًا لمعرفتهم بنزول التوراة على موسى وعدم تأمين مكانة جديدة وقيمة لهم في المدينة رفضوا ذلك.
لفَتَ مؤلِّف الكتاب إلى أنّ محمدًا قال إنّ صيغة التوراة ليست هي الصيغة الصحيحة، ومع ذلك اعترف القرآن بأن اليهودي الذي يقيم التوراة هو اليهودي الحقيقي، واعترف القرآن بوجود مثل هؤلاء اليهود. وفي جزء آخر قال مؤلِّف الكتاب إنه حينما يـئس محمد من إيمان اليهود بقرآنه قال لهم على الأقلّ أن يؤمنوا بدين إبراهيم الذي اعترف به محمد، ويضيف أنّ واضعي القرآن لم يعرفوا أن اليهودية في حدِّ ذاتها تدعو جميع الأمم لقبول دين إبراهيم، إلا أن اليهود يعتقدون أن محمدًا يغيّر هذا الدين.
وأضاف الكتابُ أنّ محمدًا اعترف في القرآن أنه لم يأتِ لإنهاء الخلاف بين اليهودية والنصرانية، بل إنه دعا الله أن يحكم بينهما، ورأى مؤلِّف الكتاب أنّ القرآن اعتبر أنّ هذا الخلاف يعود لدوافع مشوّهة، وأنّه نتيجةُ رفْضِ اليهود والنصارى بعضهما لبعض.
تعرّض مؤلِّف الكتاب كذلك إلى ما اعتبرها اتهامات قرآنية لليهود؛ ومنها انتهاكهم لحُرمة يوم السبت، واعتبر أنّ التلميحات القرآنية لهذه القصة ليست أصيلة به، بل أُدخلت في وقت متأخّر للقرآن، وذلك بتأثيرٍ من آباء الكنيسة.
في جزء آخر يرى مؤلِّف الكتاب أن القرآن يعرض علاقة اليهود بأنبيائهم بصورة جزئية، إِذْ عرض القرآن بشكل منهجي صورة سيئة لتعامل اليهود مع أنبيائهم على مرّ الأجيال، ويردّ المؤلِّف على ذلك بالقول إنّ العهد القديم أورَدَ أنّ اليهود في كثير من الأحيان تأثّروا في ذلك بالشعوب المجاورة لهم من عبدة الأصنام، وحينما جاء أنبياء حقيقيون اعترض اليهود عليهم نتيجة هذا التأثر.
كما علّق مؤلّف الكتاب على ما ورَدَ في القرآن من لعنة اليهود بسبب خطاياهم بأنه ادَّعاء سطحي ولا أساس له، فالتوراة تثبت العكس، فحينما سار شعبُ بني إسرائيل في الطريق الصحيح لم يتمّ لعنتهم.
5- (الأصولية الإسلامية) والقرآن:
كان لافتًا أن يخصّص مؤلِّف الكتاب جزءًا عن ما سمّاهم بالأصوليين الإسلاميين وموقفهم من القرآن، قائلًا إنهم يشجعون المسلمين على الحرب ضد دولة إسرائيل، ويؤكدون لهم أنهم سيقضون عليها، واعتبر أن ذلك بمثابة كفر من جانب هؤلاء بما جاء في القرآن نفسه والذي يؤكد على كلام بني إسرائيل أنه بعد خراب الهيكل اليهودي مرتين وتهجير بني إسرائيل فسيقوم الربّ بإعادتهم مرة أخرى إلى أرضهم مستشهدًا في هذا الصدد بالآيات 4- 6 من سورة الإسراء: ﴿وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا * فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا * ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا﴾. مشيرًا إلى أن هذا يتطابق مع ما ورَدَ في الإصحاح 30 الفقرات 1- 5 من سفر التثنية: «ومتَى أَتَتْ عليك كلُّ هذه الأمور؛ البركةُ واللعنةُ، اللَّتَانِ جَعَلْتُهُمَا قُدَّامك، فَإِنْ رَدَدْتَ في قلبك بين جميع الأمم الذين طردك الربُّ إِلهُكَ إِلَيْهِم، 2 ورجعْتَ إلى الرَّبِّ إلهِكَ، وَسَمِعْتَ لصَوْتِهِ حَسَبَ كلِّ ما أنا أُوصِيكَ به اليوم، أنت وبنوك، بكلِّ قلبك وبكلّ نفسِك، 3 يَرُدُّ الرَّبُّ إِلهُكَ سببك ويرحمك، ويعود فيجمعك منْ جميع الشُّعُوبِ الذين بَدَّدَكَ إليهم الرَّبُّ إِلهُكَ. 4 إِنْ يَكُنْ قَد بَدّدَكَ إلى أَقْصَاءِ السماوات، فَمِنْ هناك يجمعك الربُّ إِلهُكَ، ومن هناك يأخذك، 5 ويأتي بك الربُّ إِلهُكَ إلى الأرض التي امتلكها آبَاؤُكَ فتمتلكُها، وَيُحْسِنُ إليك وَيُكَثِّرُكَ أَكْثَرَ منْ آبائك».
وأضافَ مؤلِّف الكتاب أنّ الأصوليين الإسلاميين يؤمنون أنّ الربّ لن يحافظ على شعب إسرائيل، الذي يرونه كافرًا، وهو الأمر الذي يخالف القرآن لتأكيده أنّ الله يغفر لمن أخطأ خطيئة عن دون قصد، مستشهدًا في هذا الصدد بالآية 173 من سورة البقرة: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾.
انتقدَ مؤلّف الكتاب كذلك رؤية ما سمّاهم بالإسلاميين تارة وبالسلفيين تارة أخرى لليهود ولدولة إسرائيل، مشيرًا إلى أنهم يرون ضرورة إخضاع شعب إسرائيل تحت حكم الإسلام، لا سيّما وأن دولة إسرائيل يوجد بها الكثير من اليهود الذين لا يقيمون أحكام التوراة كما هي، وتشبه حياتهم حياة عبدة الأصنام. ولفت مؤلِّف الكتاب إلى أنّ السلفيين يرون أنّ هذه الأفكار مصدَّق عليها في القرآن الذي يرسم صورة مشابهة لذلك لليهود بين آياته.
رابعًا: منهج الكتاب ونقده:
كان منهج (التأثير والتأثُّر) هو الأكثر استخدامًا من جانب مؤلِّف الكتاب في دراسته وتحليله للنصّ القرآنيّ، شأنه في ذلك شأن غالبيَّة المستشرقين اليهود والإسرائيليِّين في استخدامهم لهذا المنهج. كما يأتي استخدام (زئيف) لهذا المنهج من جهة كونه الأكثر شيوعًا واستخدامًا لدى المستشرقين كافّة؛ وبخاصَّة اليهود منهم؛ لأنَّه الأفضل في تحقيق أيديولوجيّتهم الاستشراقية المتمثِّلة في ردِّ المادَّة القرآنية إلى مصادر يهودية، الأمر الذي دفع كثيرًا من نقَّاد الأعمال الاستشراقية إلى اعتبار أنَّ كلَّ الدراسات والموسوعات التي كتبها المستشرقون تسير على هذا المنهج ولا تعدوه[1].
وإذا كان هذا المنهج ينقسم إلى قسمين؛ الأول: (تأثير وتأثُّـر معنوي) يتعلق بالمصطلحات والرؤى والأفكار، والثاني: (تأثير وتأثُّـر لفظي) يتعلّق بالألفاظ واللغة، فإنّ استخدام (زئيف) لهذا المنهج قد تمحور على القسم الأول؛ مثال ردّه قصص إبراهيم، وآدم وزوجه وولديه، وأصحاب الأخدود، إلى قصص توراتية، وغيرها من الموضوعات والرؤى والأفكار القرآنية الأخرى التي ردّها لمصادر يهودية.
يتلخّص نقد هذا المنهج في أنه يقوم على محاولة تفريغ الظاهرة الفكرية من مضمونها؛ محاولًا ردّها إلى عناصر خارجية في بيئات ثقافية أخرى، من دون وضع أيّ منطق سابق لمفهوم التأثير والتأثُّـر، بل بإصدار هذا الحكم دائمًا لمجرَّد وجود اتِّصال بين بيئتين أو ثقافتين، وظهور تشابه بينهما، مع أنَّ هذا التشابه قد يكون كاذبًا وقد يكون حقيقيًّا، وقد يكون لفظيًّا وقد يكون معنويًّا[2].
يؤخذ على الذين يستخدمون هذا المنهج من المستشرقين -ومن ضمنهم زئيف- أنَّهم لا يأخذون في الاعتبار أربعة عوامل مهمَّة؛ وهي: العامل الفضائيّ (المكانيّ)، العامل اللغويّ والثقافيّ، العامل الزمنيّ، وعامل الأعاجم الذين اعتنقوا الإسلام؛ إذْ إنَّه من الطبيعيّ أن تحدث عملية التأثير والتأثُّـر، غير أنَّ العوامل الثلاثة الأُولى تعمل لصالح التأثير من جانب الإسلام في غيره، والعامل الأخير وحده يطرح إمكانية تأثُّـر الإسلام بغيره[3].
وباختصار فإنّ عملية التأثير والتأثُّر المتبادل هي في الأساس عمليَّة حضاريَّة معقَّدة تحصل على مستويات عدَّة: اللغة، والمعنى، والشيء، فلو كان هناك اتِّصال تاريخيّ بين حضارتين وظهر تشابه بين ظاهرتين، فإنَّ ذلك قد يكون في اللغة، وفي هذه الحالة لا يكون تأثُّرًا، بل استعارة، فعادة ما يحدث أن تُسْقِط الحضارة الناشئة ألفاظها القديمة وتستعير ألفاظ الحضارة المجاورة وتستخدمها للتعبير عن المضمون القديم[4]. أمَّا إذا حدث تشابه في المضمون بين ظاهرتين من حضارتين مختلفتين، فإنَّ ذلك -أيضًا- لا يمكن تسميته تأثيرًا وتأثُّرًا من دون تحديدٍ لمعنى الأثر؛ فإمكانية التأثُّـر من اللاحق بالسابق موجودة؛ لأنَّ الشيء نفسه موجود ضمنًا في الظاهرة اللاحقة[5].
فيما يتعلّق باستخدام (زئيف) نفسه لهذا المنهج فقد اتسم بـ(السطحية الشديدة)، فبمجرد وجود أيّ تشابه بين قصتين أو شخصيتين واردتين في القرآن وفي مصدر يهودي آخر رأى فيه تأثرًا أو اقتباسًا حتى لو كان هناك اختلاف واضح في المضمون أو السياق أو حتى جوهر القصة وطبيعة تناولها في المصدرَيْن؛ مثال قصة ولدَيْ آدم أو قابيل وهابيل، فرغم أنَّ الخطوط العامَّة لقصَّة وَلَدَيْ آدم القرآنية متشابهة -بشكلٍ عامّ- مع ما ورَدَ في التوراة حول هذه القصَّة، غير أنَّ القصَّة التوراتية سمَّـتْهما باسم «קײןוהבל» (قايين وهابيل)، وأوضحت أنَّ قايين هو الذي قتل هابيل، كما أنَّ قصَّة الغراب الموجودة في القرآن الكريم بثنايا هذه القصَّة، الواردة في السورة نفسها: ﴿فَبَعَثَ اللّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَـذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ﴾ [المائدة: 31]، اختفَت من التوراة ولا وجود لها.
تبرزُ الاختلافاتُ -أيضًا- في أنَّ شخصيَّة هابيل في التوراة غائبة؛ إلَّا في الجانب السلبيّ، بينما نرى أنَّ هابيل في القرآن الكريم شخصيَّة عاقلة ومؤمنة أيضًا؛ لأنَّه قال لقابيل: إنْ نويتَ قتلي فلن أنوي قتلك: ﴿لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَاْ بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لَأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ﴾ [المائدة: 28]، وهذا يعني أنَّ هابيل كان تقيًّا، وقابيل لم يكن كذلك، وهو ما لم يكنْ واضحًا في التوراة[6].
خاتمة:
من خلال عرضنا السابق للكتاب تتبدّى أهمية قراءته ودراسة أهم محتوياته بدقّة؛ إِذْ إنه لا يعكس رؤية الفكر الاستشراقي الإسرائيلي للقرآن وحسب، بل يُجسّد أيضًا انعكاس هذه الرؤية وتأثيرها على المستوى السياسي لربطه بين القرآن والصراع العربي - الإسرائيلي ومحاولته تحليل هذه الصِّلَة المفترضة وانعكاسها على الواقع السياسي المعاصر للمسلمين وعلاقتهم باليهود ودولتهم على حدّ رؤية مؤلِّف الكتاب؛ فرغم أنّ الكتاب يتعلّق بموضوع أو نصّ ديني وهو القرآن الكريم، إلا أنّ مؤلِّفه هَدَفَ لأغراض سياسية بحتة؛ ومن أهمها استبيان ما اعتبرها الجذور الدينية للصراع العربي - الإسرائيلي، وعلاقة القرآن بذلك.
كما اتضح مِن عرضِ الكتاب أنّ الأفكار الاستشراقية حول القرآن الواردة به رغم أنها متكررة إلا أنها تعكس نمطًا فكريًّا استشراقيًّا جديرًا بالنقد والدراسة؛ فالجديد فيه هو إسقاط هذه الأفكار الاستشراقية على الواقع السياسي المعاصر؛ ما يعني أنه يجمع بين الهدف الديني/ الجدلي والسياسي.
يزيد من أهمية دراسة الكتاب أنّ مؤلِّفه مُعلِّم للدراسات اليهودية وقام بترجمة كتابه من الفرنسية إلى العبرية، ما يعني أننا أمام مستشرق إسرائيلي ينشر أفكاره بلغة أجنبية أوروبية واسعة الانتشار وهي الفرنسية ولديه القدرة على نقلها إلى العبرية محدودة الانتشار والاستخدام، أي أنّ تأثير أفكاره يتجاوز إسرائيل والقارئ العبري، كما أنه نظرًا لخوفه مما طرحه من أفكار معادية للإسلام وكتابه المقدّس فقد استخدم اسمًا مستعارًا لوضعه على كتابه، ما يعني أنّه من الأهمية بمكان الكشف عن هذه الأفكار ودحضها بالحُجّة وبالأسلوب العلمي الموضوعي.
ولعلّ التوصية الأهمّ لدراسة الكتاب ونقد أفكاره لا تنبع من ضرورة الدفاع عن الإسلام ومقدساته وفي مقدمتها القرآن الكريم وحسب، لكن أيضًا تنطلق من ضرورة التصدِّي علميًّا وفكريًّا لتلك الأفكار الاستشراقية الإسرائيلية التي تُطوّع سياسيًّا لخدمة الطرف الإسرائيلي، وتتمحور حول أنّ ما اعتبره الكتاب الإرهاب أو التشدد الإسلامي منبعه القرآن، ما يعني أنّ رصد ذلك ودحضه علميًّا وفكريًّا لا يمثّل التزامًا وواجبًا دينيًّا وحسب، بل سياسيًّا وقوميًّا أيضًا.
[1] مناهج البحث في الإسلاميّات لدى المستشرقين وعلماء الغرب، محمد بشير مغلي، الرياض، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، 2002م، ص97- 101.
[2] التراث والتجديد، موقفنا من التراث القديم، حسن حنفي، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، بدون تاريخ، ص78.
[3] مناهج البحث في الإسلاميّات لدى المستشرقين وعلماء الغرب، محمد بشير مغلي، ص97- 101.
[4] التراث والتجديد، موقفنا من التراث القديم، حسن حنفي، ص80.
[5] التراث والتجديد، موقفنا من التراث القديم، حسن حنفي، ص81.
[6] القرآن والتوراة أين يتَّفقان وأين يفترقان؟ حسن الباش، دار قتيبة للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، بدون تاريخ، (1/ 95).
الكاتب:

أحمد صلاح البهنسي
حاصل على الدكتوراه في الآداب، تخصص الديانة اليهودية وتاريخ الأديان، وله عدد من المؤلفات والمشاركات العلمية.
مواضيع ذات صلة
((المعلومات والآراء المقدَّمة هي للكتّاب، ولا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع أو أسرة مركز تفسير))