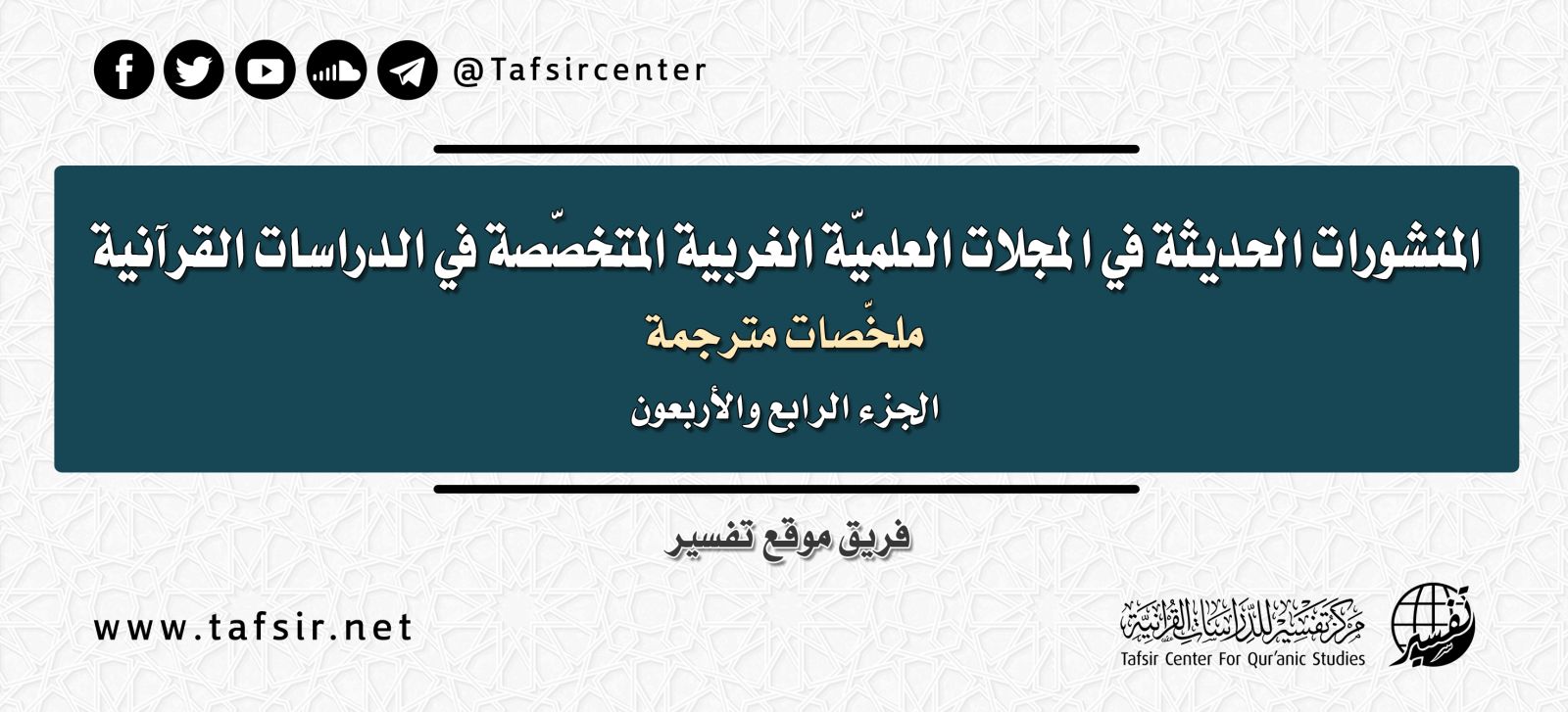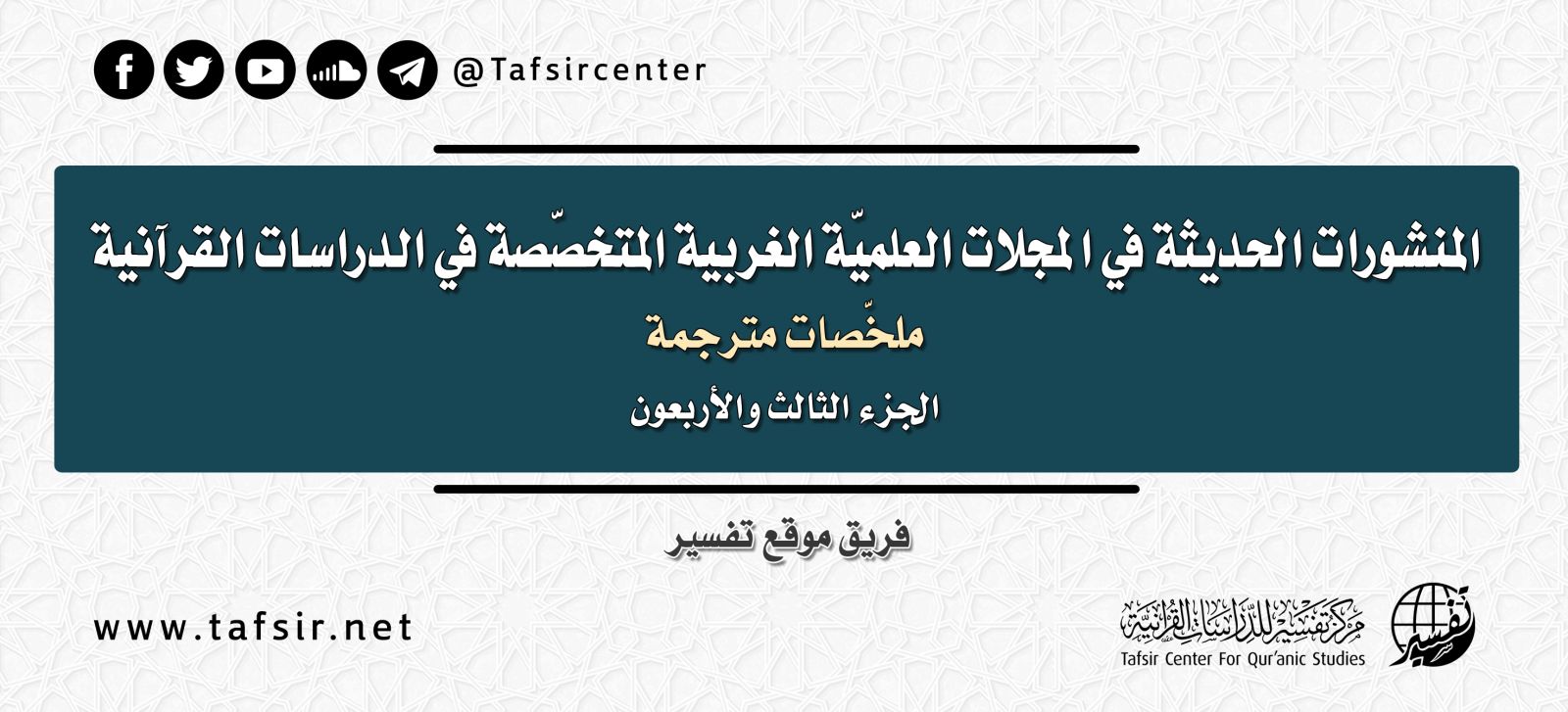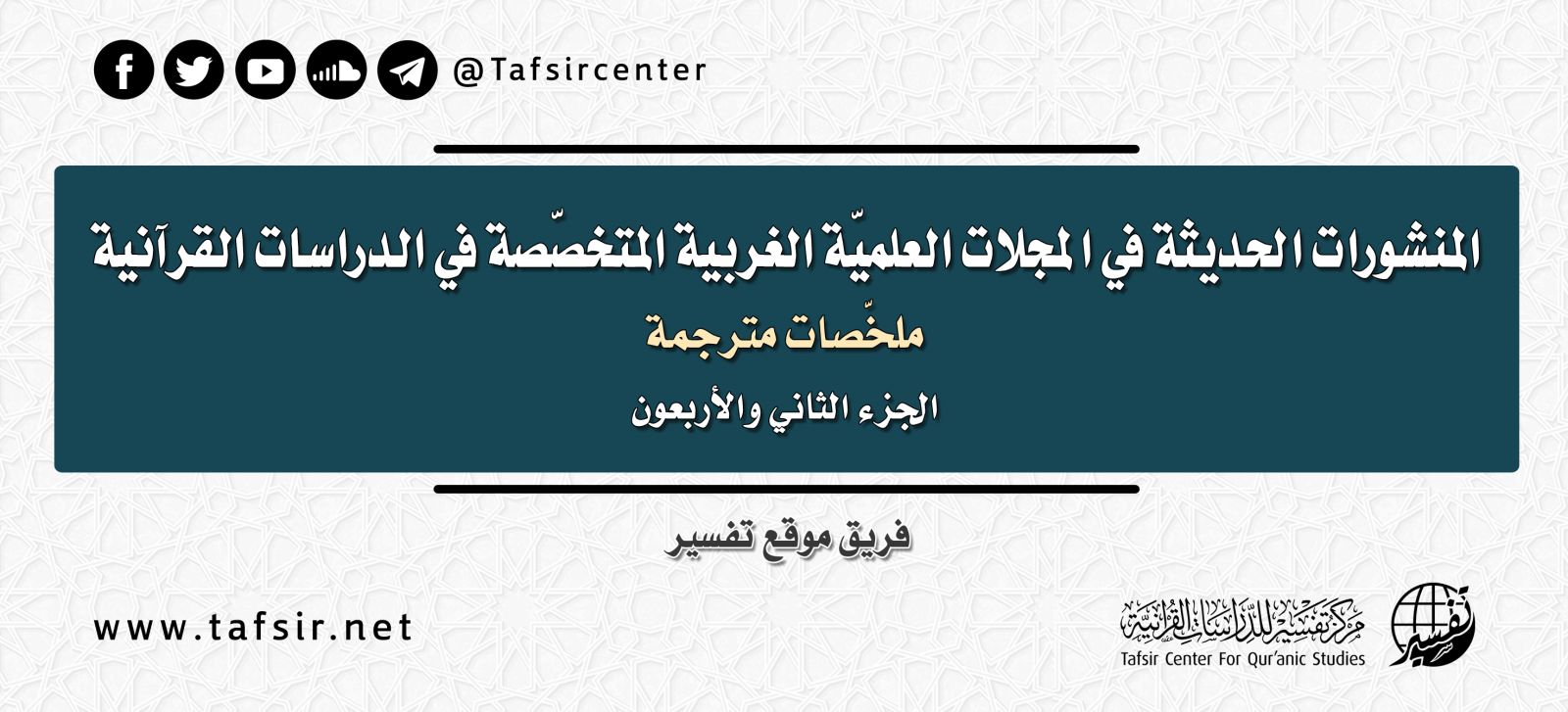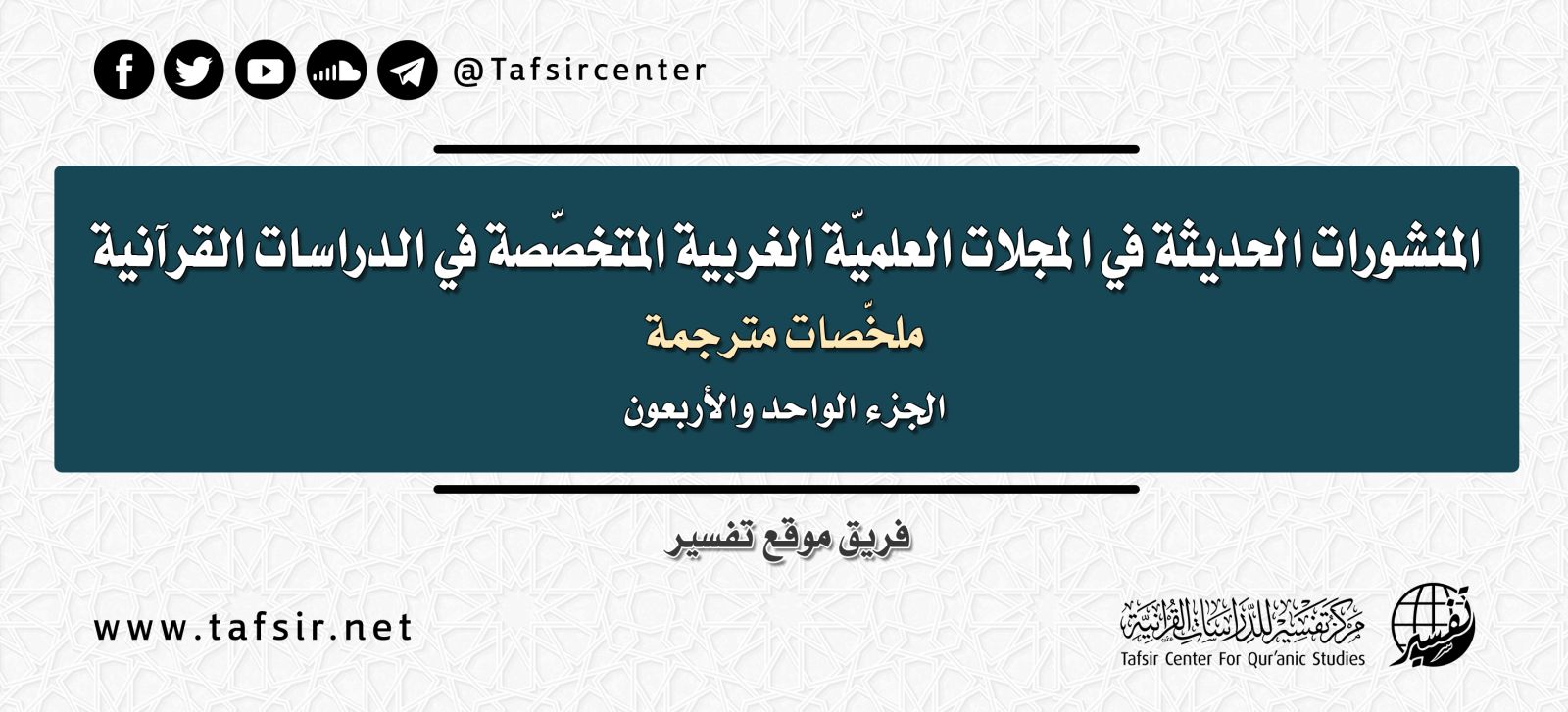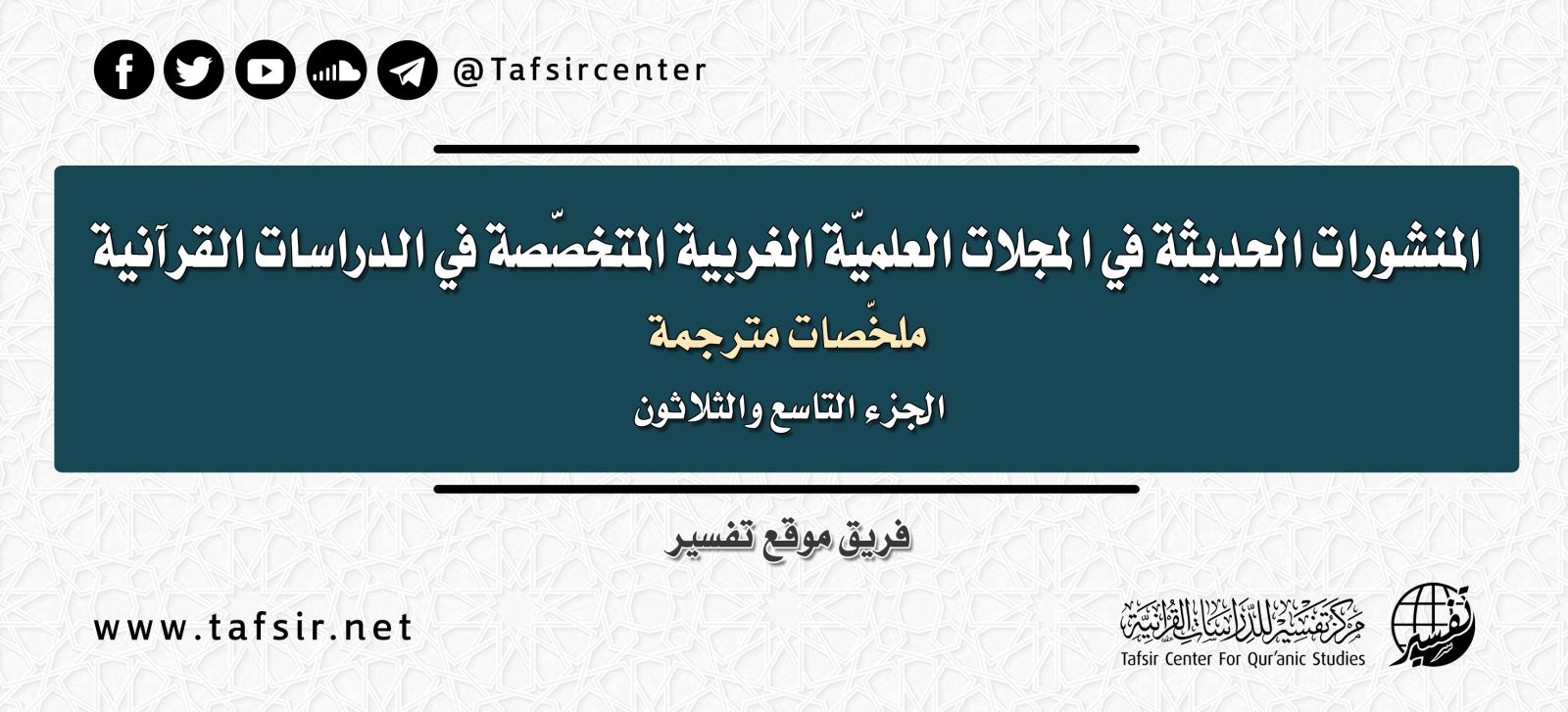المنعطف المعاصر في الدراسات الغربية للقرآن والاتجاهات البحثية المتولّدة عنه
والاتجاهات البحثية المتولّدة عنه
الكاتب: طارق محمد حجي

مقدمة:
لا يتوقف النتاج الغربي حول القرآن عن التنامي المستمر، خصوصًا في العقود الأخيرة، إلا أنّ ما نلاحظه في سياق الكتابات العربية حوله، أنها لم تستطع بعد الالتفات لهذا التنوّع الكبير الذي يشهده هذا النتاج المعاصر، وكذلك لهذا الاختلاف الواضح بين هذا النتاج والنتاج الكلاسيكي السابق عليه؛ على مستوى المرتكزات والبنى النظرية والمنهجية[1]، ونظنّ أن أيّ دراسة جزئية لإحدى مساحات هذا النتاج، لا يمكن لها أن تنضبط من حيث قدرتها على الفهم والمناقشة الواعية الناقدة والمستفيدة، إلا عبر فهم السياقات الكلية التي تتحرك فيها هذه المساحات الجزئية أولًا؛ لذا فإنّ هدفنا في هذا المقال، هو محاولة الخروج من التعامل الجزئي مع هذا النتاج إلى تعامل أكثر كلية يمكن أن يُعِين على تصوّر الصورة الكلية لهذا الحقل في صورته المعاصرة، وأكثر عمقًا كذلك بحيث يلتفت بالأساس للأبعاد المعرفية والمنهجية له، وبحيث يقف على تطوّر إشكالاته المعرفية وتطور منهجياته في إجاباته على الأسئلة المركزية لحقل الدراسات القرآنية الغربي.
واشتغالنا هنا مُحدَّد بالدراسات المعاصرة منذ سبعينيات القرن الماضي، حيث يعتبر الكثير من الباحثين الغربيين أن فترة السبعينيات من القرن الماضي قد مثَّلت انعطافة رئيسة في تاريخ الدراسات الغربية للقرآن، حيث برز فيها تغيُّرٌ كبيرٌ في ملامح اشتغال هذا الدرس، وحيث شهدت بداية بلورة اتجاهات منهجية جديدة ومتنوّعة في دراسة القرآن وفي تناول الموروث الاستشراقي ذاته، ما يجعل هذه الفترة موضعًا أساسيًّا لفهم طبيعة الاتجاهات المعاصرة في دراسة القرآن، ولتبيُّن مدى اختلافها واتفاقها مع الدراسات الكلاسيكية السابقة على هذه الانعطافة.
في هذا السياق ومن أجل فهم الصورة المعاصرة للدراسات الغربية للقرآن بشكلٍ أكثر عمقًا وكلية، فإنّنا سننطلق بالأساس من محاولة فهم طبيعة هذه الفترة أو ما سنطلق عليه «منعطف السبعينيات»، فنحاول استكشاف طبيعة التغيّرات في هذه الفترة، وكيف أثّرت على حقل الدراسات القرآنية؛ كيف تركت أثرًا على بنية الحقل النظرية والمنهجية الأساسية، وكيف حفّزت على استكشاف مساحات جديدة للدرس، وكذلك كيف نتج عنها تغيير في طبيعة دراسة المساحات المركزية ضمن الاشتغال الاستشراقي على القرآن.
وفي تناولنا لهذا النتاج المعاصر سنحاول الاستفادة من التقسيم الثلاثي لمساحات دراسة القرآن الذي طرحناه في بحث سابق (ما قبل القرآن، القرآن، العالم الذي يخلقه القرآن أمامه) في استكشاف وتأطير مسارات البحث المعاصرة على ساحة الدراسات الغربية للقرآن، حيث يستطيع هذا التأطير أن يكشف عن التنوّع الذي تشهده الدراسات المعاصرة في كلّ مساحة من هذه المساحات، كما يكشف عن ملامح التغيُّر في طبيعة هذه الدراسات -عن تلك الكلاسيكية- ضمن قضاياها العلمية الأساسية المتعلّقة بدراستها للقرآن، نتيجة التغيرات التي طالت أساس هذا الحقل النظري والمنهجي، وبالتالي يساعدنا هذا على وضع بداية لتصوّر أشمل وأعمق لطبيعة الدراسات الغربية المعاصرة للقرآن.
لذا سينقسم هذا المقال لثلاثة أجزاء أساسية، في الجزء الأول نتناول طبيعة التغيرات النظرية والمنهجية التي ظهرت في سبعينيات القرن الماضي ذات التأثير على حقل الدراسات القرآنية، ثم في الجزء الثاني نتناول التغيرات التي شهدها هذا الحقل والتي تنقسم إلى ثلاثة تمظهرات: تغيرات في أُسس الحقل النظرية والمنهجية، مناهج جديدة في دراسة القرآن، تغيرات في دراسة مساحات القرآن الثلاث (ما قبل النصّ، النصّ، ما أمام النصّ)، ثم في الجزء الثالث نحاول تدقيق طبيعة التغيّر في الدراسات المعاصرة للقرآن بناءً على التناول له ضمن الخطاطة الثلاثية، يلي هذا خاتمة نجمل فيها اشتغال المقال.
الانعطافة المعاصرة في تاريخ الدراسات القرآنية الغربية؛ طبيعتها وأسبابها:
كما أسلفنا فإنّ فترة السبعينيات تُمثِّل وَفق كثيرٍ من الباحثين إحدى المنعطفات المهمّة في تاريخ الدراسات الغربية للقرآن، حيث شهدت هذه الفترة بروز الكثير من الرؤى والاتجاهات والمناهج الجديدة التي تصل حدّ المراجعة الجذرية للبنى النظرية والمنهجية الاستشراقية وفتح الباب لمنهجيات جديدة غير معهودٍ تطبيقها على القرآن[2]، مما أدّى إلى نظر الباحثين لهذه الفترة كبداية لمرحلة جديدة من الدراسات الغربية؛ سواءٌ تم تثمين هذه المرحلة باعتبارها انعطافة مُنعِشَة في تاريخ حقل فَقَدَ الكثير من بريقِه بعد مرحلة ركودٍ عاشها منذ نهاية الحرب العالمية[3]، أو تم النظر لها باعتبارها علامة انحلال هذا الحقل وسقوطه في الفوضى المنهجية والنظرية.
إلا أنّ ما يهمّنا هنا وقبل استعراض هذا الشكل المعاصر لحقل الدراسات القرآنية بكلّ تنوّعه، هو محاولة فهم طبيعة هذه الفترة ذاتها؛ أي فهم طبيعة هذه التغيرات التي حدثت ضمن هذه الفترة، والتي أدّت لبروز هذه الاتجاهات والمناهج الجديدة، حيث إن فهم طبيعة هذه الفترة المهمّة هو وحده ما يستطيع أن يساعدنا على تكوين رؤية أكثر كليةً وعمقًا للشكل المعاصر للدراسات القرآنية.
نستطيع القول أنّ فترة السبعينيات قد شهدت عددًا من التغيّرات النظرية والمنهجية والتي كان لها الأثر الكبير على بنية حقل الدراسات القرآنية الغربي وأُسسه النظرية والمنهجية، ونستطيع تقسيم هذه التغيرات إلى تغيرات في المصادر المتاحة لدراسة القرآن وسياقه التاريخي وتاريخ تدوينه، وتغيرات في المنهجيات المتاحة لدراسة القرآن والمُرشَّحة للاندراج ضمن العدّة الاستشراقية المنهجية الكلاسيكية.
أمّا عن النقطة الأولى، فإن تزايد الكتابات والبحوث حول (مخطوطات قمران) أو مخطوطات البحر الميت، وكذلك اكتشاف (مخطوطات صنعاء)[4]، مثّلَا بدايةً لتغيُّر كبير في نمط الدراسة الغربية للقرآن في إحدى أهم مساحات اشتغالها، أي (مساحة ما قبل القرآن) بما يشمله هذا من دراسة للسياق التاريخيّ النصيّ للقرآن، وكذلك دراسة تاريخ تدوين النصّ وجمعه في نسخةٍ قياسية معتمدة.
فقد شكّل التوسّع في دراسة مخطوطات البحر الميت «وهي مجموعة من الكتابات الدينية غالبًا ما ترجع لمجموعة من المتدينين (طائفة الأسينيين) في نهاية القرن الأول قبل الميلاد والقرن الأول الميلادي»[5]، واكتشاف كتابات دينية تحضر ضمن الاستعمال الديني لدى مجتمعات اليهودية عشية المسيحية، وليست جزءًا من الكتاب المقدّس العبري المعتمد المعروف، بدايةً لتغير كبير في فهم تاريخ (الكتاب المقدّس العبري)، وفي فهم عملية اعتماد النصوص الدينية ذاتها، وفي فهم مسار تشكُّل نصّ مقدّس معتمد بداية من كونه نصًّا نبويًّا prophetic text إلى كونه نصًّا مقدّسًا scripture إلى كونه نصًّا معتمدًا ذا سلطة canonized text على المجتمع وعلى غيره من النصوص، حيث بدا أن مجتمعات هذه الفترة كانوا يستخدمون طيفًا أوسع من النصوص الدينية والتي لم تكن قد خضعت لواقعة اعتماد بعد (ميدراشات- بيشرات- كتب ليتورجية- الكتاب المفسّر- تراجيم...)، وكذلك كانوا يستخدمون هذه النصوص ويفسِّرونها ويستعيدونها ويدمجونها ضمن نصوصٍ أخرى، بطرق مختلفة عمّا استقرّ من طرق تعامل مع الكتاب المقدّس بعد واقعة اعتماد لائحة محدّدة من نصوصه باعتبارها وحدها canon «الكتاب المقدّس المعتمد».
كذلك فقد تم اكتشاف الكثير من النصوص التي كانت تخضع في عملية استحضارها وتلاوتها وتمثُّلها لعملية إعادة تفسير ودمج ضمن نصوص أخرى في عملية استعادة وتفسير دائمة، وهذا كان له أثره كذلك على تصوُّر الدارِسين للكتابات الدينية في سياق الشرق الأدنى القديم المتأخِّر، سواءٌ من حيث حجم هذه الكتابات وتنوّعها وسلطتها وأولويتها، أو من حيث طبيعة تعامل هذا العصر مع النصوص الدينية، حيث بدا هذا العصر الديني ذا ملامح خاصّة في تداول هذه النصوص.
لذا فقد باتت موضع اختبار تلك الفكرة المركزية في سياق العمل الاستشراقي على النصوص الدينية وعلاقاتها، وهي فكرة «التأثُّر والتأثير»، الموروثة من نمط الاشتغال الفيلولوجي للقرن التاسع عشر -والمتأثرة كذلك بمنزع البحث عن الأصول[6]-، والتي شكّلَت المنظور والإطار المنهجي الأساسي لنظرة الاستشراق الكلاسيكي لعلاقة القرآن بالكتب السابقة، حيث القرآن ليس سوى نصٍّ يقتبس من النصوص السابقة بشكلٍ مشوَّه أحيانًا[7]، فقد صارت هذه الفكرة موضع اختبار بسبب ما أظهرته المكتشفات الأخيرة من اتساع كبير في المدونات الدينية للشرق الأدنى القديم، وكذلك ما بينته هذه المكتشفات من دور ووظيفة هذه النصوص ضمن المجتمعات الدينية لهذه الفترة، وكذلك ما كشفته من كون العلاقة بين النصوص في هذا العصر كانت علاقة أكثر تعقيدًا حيث تشمل إستراتيجيات عِدَّة -الاستعادة وإعادة البناء والتفسير وإعادة التفسير- تجعل من غير الممكن أن تخضع قراءتها لهذا التبسيط الذي يحصرها في كونها علاقة أثر وتأثُّر، ولعلّ هذا ما جعل نمط المقاربة المعاصر لهذه العلاقة بين القرآن والكتب السابقة يتغير؛ سواءٌ من حيث اعتماده في عملية التسييق النصِّي على مدونات أوسع، أو من حيث انطلاقه من نظر أكثر تعقيدًا للصلات بين النصوص (الاستعادة- التفسير- التناص...)، أو كذلك من جهة التفاته لأهمية الوسائط الشفهية والليتورجية (الشعائرية) في فهم هذه العلاقة وعدم الانحصار في النصوص المكتوبة وأسئلة التاريخ والأصل المعهودة في الكتابات الكلاسيكية مع شباير وجايجر[8] وغيرهم.
كذلك فإنّ حدثًا مثل اكتشاف مخطوطات صنعاء كان له أثر حاسم على طبيعة الدراسة الاستشراقية لتاريخ القرآن، حيث يُعَدّ مشروعُ بناء «نسخة نقدية من النصّ» مشروعًا استشراقيًّا قديمًا وأثيرًا لدى الدراسات الغربية منذ منجانا وبرجستراسر وشبيتلر[9]، إلا أن المخطوطات المكتشفة لم تكن يومًا قادرة على تحقيق هذا المشروع، وكان اكتشاف هذا الكمّ من المخطوطات في المسجد الكبير بصنعاء في سبعينيات القرن الماضي بداية لأملٍ جديد بتحقيق هذا المشروع، خصوصًا بعد ما حفّز هذا الاكتشاف -كما يُعبِّر دونر- الكشف عن مخطوطات برجستراسر والتي تم الإدعاء مسبقًا بكونها قد ضاعت في قصفٍ ضمن الحرب العالمية، كما أدّى هذا الاكتشاف لاهتمامٍ أوسع ببناء تاريخ القرآن على قاعدة أركيولوجية هذه المرّة وليس على قاعدة أدبيّة تتعلّق بالمرويات الإسلامية التقليدية كما هو الحال في معظم الدراسات الغربية الكلاسيكية لتاريخ تدوين القرآن.
أمّا بخصوص النقطة الثانية، أي ما يتعلق بالمناهج المتاحة لدراسة القرآن والمًرشَّحة لإحداث توسُّع في العدّة الاستشراقية المنهجية الكلاسيكية لدراسته، فإنّ هذه الفترة شهدت كذلك تطورًا في المنهجيات الأدبية، وتطورًا في المنهجيات الكتابية، وتطورًا في تطبيق المناهج الأدبية على الكتاب المقدّس، وقد أدّى هذا لمحاولة تطبيق هذه المنهجيات التي أثبتت كفاءة في دراسة الكتاب المقدّس على القرآن أيضًا[10]، وهذا في سياق مُحدَّد، هو ازدياد النقد للدراسات الغربية للقرآن بكونها لا تُطبِّق المناهج الحديثة على القرآن والإسلام -وهو نقد نستطيع أن نرى صداه بوضوح في ندوة رودنسون حول الاستشراق بعد كتاب سعيد[11]-، وكونها تميل لعزله عن سياق هذه المنهجيات، فكما تقول نويفرت فإنّ القرآن عُومِل دومًا باعتباره خارجًا عن النصوص المقدّسة التوحيدية، وبالتالي لم تُطبَّق عليه هذه المناهج التي أثبتت كفاءة في دراسة الكتاب المقدّس، وقد بدأت في هذه الفترة بعض محاولات لنزع «غيرية القرآن المزعومة» -بتعبير العظمة- بدمجه ضمن هذه المنهجيات[12]، كذلك تم تطبيق هذه المنهجيات على المدونات الإسلامية التراثية المبكّرة مثل السيرة والتفسير بالذات، في محاولة لفهم بنيتها ووظائفها في سياقها الذي تشكَّلت فيه، ولاحقًا تم تناول القرآن من خلال بعض المفاهيم والمنهجيات الكتابية مثل مفهوم التيبولوجي والرؤيوية كما أشار ستيورات[13].
هذا التغيّر على مستوى المصادر وعلى مستوى المناهج كان له أثر حاسم في حقل الدراسات القرآنية الغربية وفي الشكل الحالي الذي تكوّنت عليه هذه الدراسات، ونستطيع أن نرى هذه التأثيرات في ثلاثة تمظهرات رئيسة؛ الأول: هو خضوع أُسس الحقل ذاته النظرية والمنهجية لتشكيك كبير ظهر في أوصاف الفوضى والفوضى الميؤوس منها التي وُصِفَت بها الحالة المعاصرة للحقل من قِبَل بعض الدارسين مثل نويفرت وكرون ودونر، وتطلَّب هذا التشكيك ربما إعادة بناء هذا الحقل نظريًّا ومنهجيًّا. الثاني: نشأة بعض اتجاهات جديدة لدراسة القرآن بطرق غير معهودة في الدرس الاستشراقي الكلاسيكي. الثالث: خضوع المساحات المركزية التي يتم دراستها في الدراسات الغربية القرآنية والتي شكَّلت أساس انطلاق هذا الدرس منذ القرن التاسع عشر (السياق التاريخي للقرآن، تاريخ تدوين القرآن) لتغيير كبير في طبيعة دراستها -ضمن التغير في دراسة مساحات النصّ في العموم-.
الشكل المعاصر للدراسات القرآنية الغربية بعد منعطف السبعينيات:
أولًا: أُسس حقل الدراسات الغربية والمسارات الجديدة:
لطالما انطلقت الدراسة الغربية الكلاسيكية للقرآن من قبول إجمالي لمعظم ملامح السردية الإسلامية التقليدية عن تاريخ القرآن وتاريخ الإسلام الـمُبكِّر؛ لذا فإنّ النظريات الغربية الكلاسيكية حول تاريخ النصّ وتاريخ تشكُّله -مركز بناء سردية حول تاريخ الإسلام المُبَكِّر-، كانت تميل للتحرّك ضمن إطار ذات السردية التقليدية، فكانت تنبني عليها وتنطلق منها، والخلاف ما بين الباحثين في هذا الصدد (حيث قول شفالي بجمع القرآن في عهد عثمان، وطرح كازانوفا ومنجانا أن النصّ جُمِع في عهد مروان بن عبد الملك) كان خلافًا ظاهريًّا سببه -وكما وضح سيناي- الاختلاف في مفهومهم حول المقصود بإغلاق النصّ والمقصود بتعديل النصّ وتحريره، في حين يُجمِع الجميع على كون (المصحف المجرّد) -أو ما يعبّر عنه سيناي بـ«نموذج النصّ القرآني المعتمد الأوّليّ أو الناشئ» قد كُتِب ونُشِر في القرن الأول، فـ«القول الذي يعارض بشدّة التأريخ المشهور للرسم القياسي للقرآن يتمثّل فيما يبدو في الفرضية التي تقول بأنّ النصّ القرآني رغم اكتسابه شكلًا محدّدًا بحلول عام 660 إلا أنه ظلّ عرضة للتنقيح والتعديل حتى قرابة سنة 700»[14]، فضلًا عن انطلاق هذه النظريات -موافقةً التقليد الإسلامي- من كون هذا النصّ/ القرآن تشكَّل في (القرن السابع) في (وجود محمد) مُوجَّهًا إلى (أمّة من المسلمين) وكُتِب بـ(اللغة العربية).
ولا شك أنّ المصادر الإسلامية التقليدية كانت قد خضعت لبعض التشكيك الغربي منذ القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، حيث ظهر ما تسميه حياة عمامو بـ«المقاربة النقدية» للتراث الإسلامي[15]، مع نولدكه ثم بلاشير، ثم تمظهر هذا النقد بصورة أكبر في نظريات جولدتسيهر ومرجليوث وشاخت حول الحديث النبوي والسيرة، حيث اعتبروا جُلَّ هذه المرويات الحديثية والسيرية مرويات متأخرة يفصلها قرنان على الأقل عن الأحداث التي ترويها، وبالتالي لا يمكن الوثوق في الكثير من تفاصيلها، إلا أن هذا النقد لم يمنع كون السردية الإسلامية -حول تاريخ القرآن- ظلّت مع هذا مقبولة عند الدارسين الغربيين ولو في ملامحها العامّة والكليّة، وظلّت جزءًا أساسيًّا من بناء الدراسات الغربية لتاريخ القرآن وتاريخ الإسلام المبكّر.
لكن ومنذ السبعينيات من القرن الماضي، فإنّ هذه السردية كاملة بتفاصيلها كما بملامحها العامّة قد خضعت للتشكيك الجذري لأول مرة تقريبًا بعد صدور كتاب وانسبرو (الدراسات القرآنية، 1977)، وهذا الكتاب ينطلق من تطبيق المناهج الأدبية ومنهجيات «نقد الشكل» على المدونات الإسلامية التقليدية (السيرة والتفسير)، ويصل بهذا لكون هذه المدونات لا تُقدِّم سردًا تاريخيًّا دقيقًا لتاريخ الإسلام المبكّر وتاريخ القرآن[16]، بل إنها تقدّم ما أسماه وانسبرو بـ«تاريخ خلاص»، أو تاريخي ديني، حيث لا تعدُو كونها أكثر من «تزييف وَرِع للتاريخ» تمت بلورته في سياق لاحق لتأسيس الإمبراطورية الإسلامية، وهو ما يعني -وَفقًا له- ضرورة لَفْظ كلّ هذه السردية، ولَفْظ النظريات الغربية المنبنية عليها كذلك، والبحث من جديد عن إجابات جديدة لما يسميه دونر بالأسئلة الخمسة الرئيسة لحقل الدراسات القرآنية «1- هل ممكن تعقُّب (القرآن الأصلي)؟ 2- ما طبيعة هذا القرآن في أصله، (هل كان يعِظ مجموعة من المسلمين بالفعل أم لا، هل هو نصّ ليتورجي، هل هو نص شفهي)؟ 3- بأيّ لغة كُتب القرآن؟ 4- كيف انتقل لنا القرآن (قضايا الجمع والتحرير)؟ 5- كيف نشأت سلطته، وعلاقة هذا بالجمع؟»[17]، والبحث كذلك عن منهجيات جديدة تمامًا تختلف عن تلك الكلاسيكية لإيجاد إجابات أكثر دقة لهذه الأسئلة المركزية.
وظهر في إثر كتاب وانسبرو ما بات يُعرف لاحقًا بـ(الاتجاه التنقيحي)، وهو الاتجاه الذي انطلق مِن نقدِ وانسبرو للمصادر الإسلامية التقليدية ومِن رفضِ النظريات الغربية الكلاسيكية حول تاريخ القرآن وحول الإسلام المبكّر، وبدأ هذا الاتجاه في المقابل في محاولة بلورة نظريات جديدة، واعتمد في هذا على اقتراح منهجيات جديدة يستطيع الباحثون الاعتماد عليها في بناء تاريخ الإسلام المبكّر، وقد اعتمد الباحثون في بناء هذه السردية الجديدة المفترضة على طريقين رئيسين؛ الأول: هو المعطيات الأركيولوجية، مثل النقوش والمخطوطات. والثاني: هو الكتابات غير العربية المعاصرة للقرن السابع (الكتابات البيزنطية والأرمنية وغيرها...).
ورغم أنّ الفرضيات التنقيحية حول تاريخ القرآن والإسلام المبكّر غير متفق عليها بشكلٍ كبيرٍ عند من يُعتبرون رواد هذا الاتجاه، حيث لا يتفق الباحثون على تعيين تاريخ وسياق نشأة الإسلام (ما بين بلاد الرافدين أو سوريا أو الحبشة)، وحيث كذلك ثمة جدالات منهجية عميقة بين أعمالهم كما نرى في نقدِ هوتنج لأحد الكتب المركزية لهذا الاتجاه «البدايات المبهمة» بسبب التعسف المنهجي وتحكم المسبقات في بعض ما بلوره من نتائج[18]، أو نقد بريمار لمنهجية الاعتماد على المخطوطات غير العربية باعتبارها كذلك قد تمثّل في ذاتها «تاريخ خلاص»[19]، مما حدا ببعضٍ مثل رينولدز للقول بأنّ الكتابات التنقيحية يصعب وصفها بكونها اتجاهًا واحدًا متسقًا بسبب هذه الاختلافات[20]، إلا أن ما يجمع بين كلّ هذه الكتابات ويجعلها تُمثِّل (اتجاهًا) هو الموقف المنهجي المبدئي المتمثل في رفض السردية التقليدية حول تاريخ القرآن وبالتالي وَضْع الأساس النظري والمنهجي لحقل الدراسات القرآنية الغربية موضع نقد ومسائلة وفَتْح الباب لإعادة تأسيس نظرية ومنهجية جديدة لهذا الحقل.
ويُشكِّل هذا الاتجاه في ذاته أحد الفضاءات المعاصرة في العمل على تاريخ القرآن وتاريخ الإسلام المُبكِّر، كما أنّ له أثرًا بارزًا على بقية الدراسات في مجمل الحقل، حيث لم يَعُد بالإمكان لأيٍّ من الباحثين الغربيين تقبُّل السردية الإسلامية التقليدية كما هي، ولا استخدام مضامين المرويات الإسلامية بشكلٍ براغماتي رغم اللفظ النقدي لمعظمها -كما كان يفعل الكثير من الباحثين الغربيين لحدود الستينيات في شكلٍ متناقض تمامًا-، ولا حتى أصبح مقبولًا وضعُ نظريات غير مقنعة مثل نظرية مونتجمري وات -والتي تُفرِّق دون أساس منهجي أو علمي واضح بين نواة ممكن قبولها من مرويات السيرة، وروايات يمكن لفظها-، كنوع من إبداء الاعتراض المنهجي على المدوّنات التقليدية وموثوقيتها دون المساس بأُسس حقل الدراسات القرآنية الغربي في ذات الوقت، بل وكما يقول موتسكي «وجد الباحثون أنفسهم وطالما قرّروا الاعتماد على مضمون الأحاديث والمرويات الإسلامية، وبالتالي إعطاءها قيمة معينة، مضطرّون إلى إعادة تأسيس هذه المدونات التقليدية كمصادر»[21]، حيث يتم البحث بشكل أكثر دقة في مدى إمكان الاعتماد عليها كمصادر تاريخية موثوقة قبل استخدامها بالفعل، وهو ما قام به أمثال موتسكي وشولر وغيرهم -وسنصفه تفصيلًا بعد قليل-.
كذلك فقد أدّى هذا التشكيك الكبير في السردية الإسلامية التقليدية إلى تضاعف التشكيك في مدى أهمية التفسير في إضاءة معنى النصّ القرآني، فإذا كانت الدراسات الغربية وبالأساس تفصل فصلًا صارمًا بين دراسات القرآن والتفسير، حيث لا تنظر للتفسير إلا باعتباره تشويهًا لمعنى النصّ، مع ما يكشفه هذا من تصوّرات راسخة ضمن البناء المعرفي الغربي المؤسّس للاستشراق والذي يحيل المعرفة غير الغربية لمحض معرفة ذاتية لا تضيء الظواهر (القرآن هنا) بل تتحوّل هي ذاتها لظاهرة أدبية تخضع للتحليل! وحيث تقوم الدراسة الغربية للقرآن -وكما يقول المسكيني- على نقل القرآن من أفق الذات والتأويل لأفق الموضوع والتاريخ[22]، إلا أنّ هذا اللفْظَ للتفسير وإقصاءَه من أن يكون «بُعدًا من أبعاد فهمنا للنصّ» =قد تضاعف بصورة كبيرة بعد نقد وانسبرو للمدوّنات المبكّرة للتفسير كتفسيرات تعمل كجزء من بناء سردية خلاص، ونتج عن ذلك أن محاولات تطبيق المناهج الأدبية على النصّ والتي -وكما أسلفنا- قد تزامنت مع النقد التنقيحي تم التركيز فيها على المناهج التي تتعامل مع النصّ وحده معزولًا عن سياق تلقّيه، حيث يُمثِّل هذا من جهة، دراسة للنصّ متماشية مع المنجزات الأدبية والكتابية بما يعنيه هذا من تجاوز عزل القرآن عن المناهج الحديثة ذات الكفاءة، لكنه في ذات الوقت يُمثِّل من جهة أخرى عزلًا استشراقيًّا تقليديًّا للنصّ عن سياق المتلقّين له[23] لكنه مؤسَّس هذه المرة على كون هذا النتاج الطويل لا يعدو أن يكون محض أدبيات ترسم تاريخَ خلاص أو تزييفًا ورعًا للتاريخ[24].
ولعلّ هذا ما يجعل هذه الدراسات الأدبية الغربية للقرآن[25] أقرب للقراءات البروتستانتية للكتاب المقدّس كما رأى زاده[26]، حيث تقوم هذه الدراسات على عزل كامل للنصّ عن سياقات تلقّيه وتاريخه في رؤية بروتستانتية لـ(الإسلام)[27] نفسه، كما يكشف تركيزها على المناهج البنيوية بالذات ضمن السياق الأوسع لمناهج دراسة النصوص عن كونها تهدف لتقديم قراءة لنصّ مُعاد تركيبه كنصٍّ خالٍ من أيّ فضاء تلَقٍّ.
ولأنّ هذا الأثر الكبير الذي تركه هذا التغير في سياق المناهج والمصادر على بنية هذا الحقل قد طال مرتكزاته الرئيسة النظرية والمنهجية وعرَّضها للاهتزاز الكبير، مما جعل بعض الباحثين يصف هذا الحقل بأنه قد ذهب أدراج الرياح وتحوّل لفوضى لا يمكن ضبطها كما تقول كرون[28]، فإنّ هذا الأثر وبطبيعة الحال تغلغل ضمن فضاء الدرس الاستشراقي للقرآن بأكمله، حيث يظهر بكلّ وضوح حين نتأمل المساحات التي تشتغل عليها الدراسات الغربية من القرآن منذ بدايتها، حيث لم تَعُد أيّ قضية من هذه القضايا الرئيسة المدروسة تُدْرَس بذات الشكل الذي كانت تُدْرَس به في السياق الكلاسيكي قبل هذا المنعطف الحاصل في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي!
ثانيًا: المساحات المركزية ضمن الدرس الاستشراقي للقرآن؛ شكل جديد:
كما وضحنا في بحث سابق فإننا نستطيع تقسيم القرآن لثلاث مساحات للدراسة: ما قبل القرآن (سياق النصّ التاريخي، وتاريخ تدوين القرآن)، القرآن، العالم الذي يخلقه القرآن أمامه[29].
وكما وضحنا هناك فإنّ الدراسة الغربية المعاصرة للقرآن يتركَّز اشتغالها بصورة كبيرة في المساحتين الأولى والثانية[30]، في هذا الجزء من مقالنا سنتناول كيف تغيَّر شكل الدراسة الغربية للقرآن في هذه المساحات مقارنةً بالدراسات الكلاسيكية، وسنضيف كذلك مساحة دراسات التفسير أو مجمل الدراسات التي يمكن وضعها ضمن مساحة «العالم الذي يخلقه القرآن أمامه» فنتناول التغيّر في طبيعتها.
1) تاريخ القرآن: وهو يشمل مساحتي؛ سياق القرآن التاريخي، وتاريخ تدوين القرآن:
أ) سياق القرآن التاريخي:
فبالنسبة لسياق القرآن، يمكننا ملاحظة مسارين رئيسين لقراءة القرآن في سياقه، نتجَا عن هذا التغير المنهجي والمصدري الذي حاولنا وصفه بالأعلى:
المسار الأول:البحث عن (قرآن أصلي) أو عن (أصل القرآن):
فرضية (القرآن الأصلي) والتي تفترض وجودَ نصّ قرآني أصلي بلغةٍ أخرى هو أصل القرآن الحالي الذي بين أيدينا، هي فرضية تزامَنَ ظهورها مع ظهور كتاب وانسبرو، حيث برزت بصورةٍ مكتملة في كتاب لولينغ (حول القرآن الأصلي، مقاربات لإعادة بناء التراتيل المسيحية قبل الإسلام في القرآن، 1977)، ثم ظهرت في كتابات معاصرة أشهرها كتاب لكسنبرج (قراءة آرامية سريانية للقرآن، مساهمة في فكّ شيفرة لغة القرآن، 2000)، وتأتي هذه الفرضية من رفضٍ أوَّلي للسردية الإسلامية التقليدية حول نشأة القرآن، وتعتمد في محاولتها بناء سردية حول تاريخ نشأته على قراءة فيلولوجية للنصّ نفسه في ضوء الكتب السابقة في منأى عن أيّ مصادر أدبية.
وقد اعتبر لولينغ أن تحليل النصّ يكشف عن وجود أربع طبقات رئيسة، حيث تُمثِّل الطبقة الأولى والأعمق فيه مجموعة ترانيم مسيحية تخصّ مسيحيي مكة فيما قبل النبي محمد، ثم طبقة ثانية تحوي التعديلات التي تمّت في عهد محمد لتنسجم مع مبادئ الإسلام الناشئ، ثم طبقة ثالثة تحوي الإضافات الإسلامية في عهد محمد، ثم طبقة رابعة تحوي تلك التعديلات التي قام بها المسلمون في ما بعد محمد أثناء تحرير الخط العربي.
أمّا لكسنبرج ومع تشابه فرضيته مع فرضية لولينغ -رغم عدم إشارته له!-، فقد اعتمد بشكلٍ أساسي في فرضيته على الفيلولوجي حيث حاول البحث عن ما يعتبره «معجمًا سريانيًّا- مسيحيًّا» داخل القرآن، وهو المعجم المخفي والذي يحتاج في فكّ شيفرته إلى البحث عن شكل الكلمات والحروف قبل عملية التحرير، وعلى افتراض طبيعة خاصة للغة الجزيرة العربية ولمجتمعها الديني في القرن السابع كمجتمع يضم جماعات مسيحية أو يهودية- مسيحية تُشكِّل جماعة دينية منظمة، جعلته يَعتبر أنّ القرآن الحالي هو في أصله عبارة عن نصّ (مسيحي أو يهودي) كُتِب بـ«لغة مزيج» من السريانية والعربية ثم تم تحريره لاحقًا في ضوء تطوّر الكتابة العربية، وأن قراءة النصّ وَفق هذه الفرضية تستطيع وَفقًا له أن تكشف الكثير من معاني النصّ الأصلية.
وفرضية (القرآن الأصلي) تُعَدّ فرضية أكثر جذرية من الفرضية الكلاسيكية حول تاريخ القرآن وصلته بالكتب السابقة، حيث تنزع هذه الفرضية أصالة القرآن بشكلٍ كامل، فلا تنظر للقرآن كنصٍّ مستعير أو ناقل من النصوص السابقة أو متأثّر بها، بل تعامله هو ذاته كمجرد تحرير لنصٍّ آخر تمامًا، مما يجعل هذه الفرضية إمعانًا في نزع أصالة النصّ وسلبًا لميراث الأمة المؤمنة به (نزع ما يؤسِّس المجتمع المسلم ويمثّل الكنز الأعظم له كما يُعبِّر ماديغان)[31]، حيث تنقلهم من كونهم «ورثة الكتاب» لكونهم مجرّد لصوص ومُزيِّفين للتاريخ، أمّا من ناحية منهجية فإن هذه الفرضية لا تعدو -وكما يقول شتيفان فيلد- أكثر من كونها فرضيات مثيرة نشأت في «فراغ منهجي» بعد التشكيك التنقيحي الذي خلخل البنية النظرية لحقل الدراسات الغربية للقرآن، حيث لا يوجد أيّ أساس منهجي لهذه الفرضيات[32]؛ فلا يمكن إثبات وجود مسيحية منظمة في مكة لها كتب مدونة ومنظمة، -من هنا اعتبر الكثيرون أن عمل لولينغ عملًا أيديولوجيًّا أكثر منه عملًا علميًّا- كما يكشف التحليل الفيلولوجي عدم دقة عمل لكسنبرج؛ سواء جزئيًّا فيما يتعلق ببعض الكلمات والمفاهيم والتي لا يمكن اعتبارها سريانية إلا بكثير من التعسّف -خصوصًا مع كونها تشبه صوتيًّا بعض الكلمات الأخرى اليونانية والعبرية لو أن مجرد التشابه الصوتي يُمثِّل معيارًا منهجيًّا منضبطًا من الأساس-، أو حتى كليًّا في افتراضه لطبيعة اللغة في سياق الجزيرة باعتبارها (لغة مزيج)، حيث يَعتبر بعض الباحثين كون هذه الفرضية «اللغة المزيج» ومن شدة غموضها ولا تحددها ليست إلا هربًا من تحديد علاقةٍ صارمة يمكن امتحانها وَفق قواعد العلاقات بين اللغات في علم اللغات الساميّة، مما يجعل الغرض من هذا المفهوم وكما يرى دونر «جَعْل هذه الكلمات في القرآن التي تقارب صوتيًّا كلمات المعجم الآرامي غير خاضعة لأيّ بنية قواعدية عربية أو آرامية، مما يفتح الباب (لظنون نزوية)»، فهذا المفهوم يبدو وَفق دونر «كذريعة يستخدمها لكسنبرج من أجل تفسير مستبد للنصّ»[33]. وبعد هذه الفرضية غير المحددة لا يفعل لكسنبرج سوى أن «يتلاعب بعلامات النَّقْط والشَّكْل في النصّ التقليدي، لينشئ قرآنًا جديدًا بالكامل، ثم يسعى لفكّ شفرته بمعاونة معرفته بالسريانية (المذبذبة جدًّا في الغالب)». وكما يؤكّد دي بلوا فإنه لا شك «في أنه بدون علامات النَّقْط والشَّكْل يصير القرآن بالفعل نصًّا مبهمًا للغاية، ولا شكّ كذلك أن إمكانية إعادة نقطه وشكله تحتمل عددًا لا نهائيًّا من فرص تأويل النصّ المقدّس، بالعربية أو أيّ لغة أخرى يختارها المرء»[34].
فضلًا عن كون مثل هذه الفرضيات تقوم على تناقضٍ جوهري وأصيل، حيث تفترض من جهة أن القرآن أو «القرآن الأصل» قد مثَّل كتابًا شعائريًّا لأمّة يهودية أو مسيحية أو يهودية- مسيحية، مما يعني استمرار تقليد شفهي لتلاوته (لكسنبرج يرفض وجود التقليد الشفهي وهذا تناقض مضاعف!)، إلا أنهم من جهة ثانية يفترضون كون تحرير خطّه قد أدّى لأخطاء، والسؤال كيف يمكن أن يقع هذا الخطأ المفترض مع وجود تقليد شفهي ضابط[35] أو مع التلاوة الشعائرية المستمرة له ككتاب شعائر.
وهذه الفرضيات حول «قرآن أصلي» مخفي أو محتجب[36] خلف أستار القرآن المعاصر، ليست إلا أكثر المساحات سطوعًا ضمن طيف واسع معاصر من قراءة القرآن في ضوء «تأثُّره» بالكتب السابقة، والذي يمكن اعتباره امتدادًا لنمط دراسة الدراسات الكلاسيكية للعلاقة بين القرآن والكتب السابقة كعلاقة تأثُّر، إلا أنّ هذا الاشتغال يعتمد في السياق المعاصر على مدوّنات أوسع من المدونات المتاحة في الدراسات الكلاسيكية ويستحضر وسائط انتقال للمعارف أكثر اتساعًا من المدونات المكتوبة بكلّ أنواعها (معتمدة، أبو كريفيا)، كما يظهر فيه -وبسبب هذا الاتساع ذاته ربما وما كشفه من وجودِ طيفٍ واسعٍ من القصص المتشابهة أو النسخ المختلفة من ذات القصص- وعيٌ ببعض الإشكالات المنهجية التي تسقط فيها المقارنات العامّة بين القرآن والكتب السابقة كتلك التي نجدها في كتابات جايجر وشباير الكلاسيكية؛ حيث نجد في السياق المعاصر وعيًا أكبر بالسؤال حول لغة القرآن واللغة التي يتحدّثها العرب عشية الإسلام، كذلك الوعي بالسؤال عن المدونات المتاحة للعرب في هذه الفترات سواءٌ على أساس مكتوب أو كوسائط شعرية وليتورجية، إلا أنه ورغم هذه الاختلافات فإنّ هذه الطروحات تظلّ سائرة في اتجاه شبيه بالاتجاه الكلاسيكي القائم على التأثُّر كإطار أساسي لدراسة العلاقة بين القرآن والكتب السابقة، ويمكن التمثيل في هذا السياق ببعض الدراسات المهتمة بتسييق القرآن في سياق المسيحية السريانية مثل عمل عمران البدوي.
يهتم البدوي بالأساس بالعلاقة بين القرآن وإنجيل متّى الآرامي- السرياني، ويهتمّ بشكلٍ كبيرٍ بوضع عددٍ من الأُسس المنهجية لعمله والتي تُفرِّقُه عن الاشتغال الكلاسيكي كنتاج للوضعية الحالية من التغيّر، فيوضح البدوي سبب مقارنته بين القرآن وبين إنجيل متّى السرياني بالذات، حيث يَعتبر أنه من الضروري وفي ضوء تنوّع وكثرة المدونات تحديد المقارنة بين القرآن والكتب السابقة بكتاب بعينه حتى يمكن ضبط هذه المقارنة وإثبات مدى دقّتها النصية والتاريخية -وهذا هو أحد مواضع انتقاده للكسنبرج، أنّ الأخير لا يوضح مساحة معينة للمقارنة-، فيوضح البدوي أنّ اهتمامه بالذات بإنجيل متّى يرجع لرؤيته أن القرآن يبرز في صلته باليهود تشابهًا مع نمط تعامل إنجيل متّى بالذات (إنجيل اليهودية المتنصّرة) مع اليهود، كما يحاول وعبر اختيار موضوعات مركزية مثل (الإدانة- إدانة الكتبة، إدانة الكهنة، إدانة قتل النبيين، إدانة الرياء...)، تجاوز التعامل المشتّت والمشذّر لآيات القرآن والذي شاع في بعض الكتابات الكلاسيكية، ليتحدّث عن تقاطع مع «الحكمة السريانية» في سياق الشرق الأدنى القديم أكثر مِن تأثّرٍ أو نقلٍ لمقاطع نصية بعينها، كذلك يحاول البدوي طرح سؤال كيفية وصول هذه الكتابات لسياق الجزيرة، ويَعتبر أن الوسائط الليتورجية والشعائرية قد تكون هي وليس المدونات المكتوبة حوامل هذه الأفكار لسياق الجزيرة، ويرى البدوي أن الطبيعة اللغوية لمسيحيي الجزيرة كانت عبارة عن «لغة مشتركة» في الحياة اليومية، فضلًا عن لغة سريانية طقسية خاصّة[37]، وبالتالي يرى إمكان تداول هذه النصوص والمعارف -مثل أعمال إفراهاط وإفرام ويعقوب السروجي- في سياق الجزيرة.
كما يصف البدوي عمله بكونه عملًا ليس منتهيًا، بل هو عمل قابل للتطوّر، كما أنه لا يثبت علاقة نهائية وجامدة بين القرآن وإنجيل متّى الآرامي، بل يجعل هذه العلاقة جزئية ومرحلية تقوم على مدى إمكان إثبات علاقات ذات نسبة محدّدة بين النصين، فضلًا عن رفضه مسألة التأثيرات الخطية والأحادية والتي لا تناسب وَفقًا له تركيب سياق القرآن، ولا أصالة النصّ -«كنصّ قائم بذاته» كما يقول غريفث- التي لا يمكن إنكارها[38].
وهذا يجعل عمل البدوي -ورغم كونه يبحث عن تأثير لنصٍّ سابقٍ في القرآن- مختلفًا عن السياق الكلاسيكي كذلك، هذا في كونه يحمل هيكلًا منهجيًّا منتظمًا ممكن مساءلته بوضوح ونقاشه، وكونه يبتعد في تناول العلاقة بين القرآن والإنجيل الآرامي عن الإهدار الكامل لأصالة النصّ وعن السقوط في المقارنات الجزئية والتشذِيرية، وهو ما يجعل عمله أبعد عن الربط المتسرِّع والمُتشذِّر الذي شهدته بعض الأعمال الكلاسيكية، كما أنّ عمله يستطيع أن يخرج بهذا التحديد عن عملية العشوائية الشديدة في الربط التي تشهدها بعض الكتابات المعاصرة مثل كتاب رينولدز (القرآن والكتاب المقدّس) كما يصف ليمان بحقّ[39]، وعن البعد التام عن الحدود المنهجية والذي نشهده في عمل لكسنبرج ولولينغ[40].
إلا أنّ النزع الأكبر لأصالة القرآن تتم في السياق المعاصر لا بإرجاع القرآن لـ«نصٍّ أصلي» كما نجد في فرضيات لكسنبرج ولولينغ، ولا بتفسير بعض أفكاره ورؤاه عبر ربطه ببعض النصوص بعينها مثل عمل البدوي أو كارلوس سيغوفيا أو غيرهما، وإنما تتم هذه المرة بنفيه خارج أرض العرب، أي اعتباره نصًّا يخصّ جماعة أخرى تمامًا في وسط ديني طائفي مناهض للتثليث في بلاد الرافدين أو في سوريا أو في النقب، سواءٌ كان هذا الوسط يهوديًّا أو مسيحيًّا أو مسيحيًّا- يهوديًّا، وهذا هو أساس الفرضيات التنقيحية الكبرى مع باتريشيا كرون ويهودا دي نيفو وجيرالد وهوتنج وغيرهم، والتي تَعتبر أن الأفكار والرؤى القرآنية تنتمي حصرًا لسياق كتابي خارج الجزيرة هو ما يمثّل «أصلها» الوحيد المفترض.
المسار الثاني: القرآن في الفضاء المعرفي "التأويلي" للعصور القديمة المتأخرة:
في المقابل فإنّ ثمة مسارًا ثانيًا ناشئًا في هذه الوضعية والذي يقرأ القرآن في سياقه كذلك، لكن بشكلٍ مختلف تمامًا عن الشكل الكلاسيكي في دراسة هذه العلاقة، حيث تقوم دراسة هذا السياق باعتباره يُمثِّل ظَرْفَ خطابِ النصّ ويُمثِّل بناءً لوضعية المحاوَرِين بالقرآن، ويكون البحث في سياق القرآن محاولة لفهم كيف فهم المخاطبون الأوائل النصّ في ضوء معرفتهم بهذه النصوص التي يحاورها ويستدعيها ويعيد بناءها القرآن؛ لذا فإن أصحاب هذا الاتجاه ينطلقون من وعي بأصالة النصّ القرآني تجاه النصوص السابقة، ويربطونه بهذه النصوص ضمن ذات العلاقات التي اكتشفوا وجودها بين النصوص في الشرق الأدنى القديم، أي إستراتيجيات الاستعادة والتفسير وإعادة البناء وغيرها من إستراتيجيات نصِّية.
ويضُمّ هذا الاتجاه عددًا من الباحثين منهم -وكما يقول زاده- «جابرييل رينولدز (2010)، وعمران البدوي (2011)، وجوزيف ويتزتم (2011)، وفي المجلدات المحررة لأمثال جون ريفز (2003)، وجابرييل رينولدز (2008، 2011)، وتيلمان ناجل (2010)، وأنجيليكا نويفرت وآخرون (2010)»[41].
وكما يقول زاده فإنّ هذا النشاط العلمي المتنامي «يسعى بمزيد من الدقة النظرية لاستقصاء الأساليب المتنوعة التي انخرط بها القرآن في حوار مع مجموعة واسعة من مواد المصادر. وقد خلت هذه المناقشات إلى حدٍّ كبير من لغة الاقتراض والسرقة؛ تم استبدالها بشكلٍ منعش بالتركيز على المجتمعات التاريخية المضمّنة في النصّ القرآني ونقاط الاتصال النصية التي تجمعها معًا وتفصل بينها. وغالبًا ما يتماشى مع هذا المنهج التركيز على التناص القرآني والإحالة الذاتية المنتشرة في بيئة طائفية أوسع»[42].
وتُعَدّ أنجيليكا نويفرت أهم الأسماء التي تدرس القرآن وعلاقته بالكتب السابقة باعتبارها علاقة استعادة وتفسير وإعادة بناء قائم على حوار أو تفاوض مع المجتمعات الدينية، وهذا عبر اهتمامها الكبير بدراسة بنية النصّ وتركيبيته وأصالته وكذلك بربطه بالسياق التاريخي والنصِّي له، وكذلك باهتمامها الكبير بسياق الشرق الأدنى القديم المتأخر، ونظرتها لهذا العصر لا كمجرد مرحلة تاريخية تالية للعصور القديمة وسابقة على العصور الوسطى، بل كـ«عصر معرفي» ذي طبيعة خاصة تبرُز في انضوائه على عملية استعادة واسعة للمدونات الدينية والفلسفية الكبرى ضمن نقاشٍ ديني موسّع ومستمر[43]، وحيث يحضر الكتاب المقدس في هذا العصر وَفقًا لها عبر عدد واسع من الأشكال -«الكتاب المقدس المفسّر» وَفق فرضية كوجل ثم عبر «الترجوم»-، وحيث تقوم النصوص المقدسة ضمن الفضاء المعرفي لهذا العصر على إعادة تفسير ذاتها باستمرار ضمن انشغالات الأمم (الطوائف) المؤمنة المتحلقة حول الكتب المقدسة.
ونويفرت تدرس النصّ القرآني بنيويًّا وتاريخيًّا على خطى دراسة نولدكه، حيث تنطلق من تقسيم القرآن لأربع فترات، ثلاث مكية (مبكّرة- وسطى- متأخرة) وفترة مدنية، وتقوم بتسييق القرآن ضمن هذه الحقب، وتحاول في كتاباتها إبراز التماسك الموضوعي والأدبي واللغوي القرآني، بل إن نويفرت تبرز هذا التماسك كخصيصة مركزية في بناء أصالة النصّ، حيث تربط هذا التماسك لا فقط بطبيعة النصّ الأدبية، بل أيضًا بكون النصِّ هو نصّ توحيدي يُبرِز التماثل في الكون والبيان لا كحلية أدبية أو بلاغية أو حتى شعائرية حيث (غالبًا ما يُتغافل عن الطابع الشعري للقرآن باعتباره مجرّد «زخرفة خارجية»، مما يشكّل عقبة تمنع القارئ من استيعاب الرسالة من ورائه على الفور) بل كأدلة على حضور الله وعلى طبيعة الكلمة والكون، فوَفقًا لها «هناك ازدواجية متأصلة في اللاهوت الطبيعي للقرآن؛ فقد خلق اللهُ العالمَ لإظهار حضوره كما لو كان نصًّا منظورًا يتجلّى فيه بطريقة لا تقلّ عن تجليه بالقول في الوحي المقروء، وأنه خلق الإنسان ليفهم تجلّيه في كلٍّ من وحيه المقروء، وخَلْقه المنظور. وتكتسب كلتا القراءتين ضرورتيهما من هدفهما الأخروي...؛ فبتأكيدها على التماثل والبنى المزدوجة يبدو أنها تبرز هذا الهدف اللاهوتي»[44].
وتَعتبر نويفرت أنّ السورة القرآنية تمثّل وحدة قرآنية أدبية فريدة؛ لذا فإنها تستخدمها كوحدة مركزية في التحليل، وتربط نويفرت القرآن بسياق الأمة المؤمنة، وبسياق المخاطبين، حيث تفترض كون القرآن يُمثِّل حوارًا وتفاوضًا مستمرًّا مع المخاطبين به وتوقعاتهم ورؤاهم.
ومن هنا نفهم الاهتمام الشديد الذي تُولِيه نويفرت لوانسبرو وكتابه (الدراسات القرآنية) رغم اختلافها الشديد مع الفرضيات التنقيحية، حيث تَعتبر نويفرت أن كتاب وانسبرو أعاد الاهتمام بالقرآن ذاته بدلًا عن (مؤلّفه - محمد في الرؤية الاستشراقية)، وأعاد الاهتمام بسياق الأمة المؤمنة بالنصّ وسياق المخاطبين بالنصّ، والذي تَعتبره نويفرت أفضل استثمار لعمل نولدكه[45]، والذي لم يتم بسبب انخراط الدراسات القرآنية لاحقًا -في الفترة ما بين الحرب العالمية وأواسط القرن العشرين، أو فترة الركود وفق تحقيب ديفين ستيوارت للدرسات الغربية للقرآن- في بناء سيرة النبي بدلًا من دراسة النصّ نفسه؛ لذا فرغم عدم اقتناع نويفرت بأنّ القرآن كُتِب في عقود طويلة وحُرِّر من نصوص مختلفة، وبأنّ النصّ عبارة عن نتاج لوسط طائفي غير حجازي كما هو طرح وانسبرو، إلا أنها تَعتبر أنّ هذا الوسط الطائفي في سياق الجزيرة قد شكّل الفضاء الذي حاوره النصّ في سياق بنائه لذاته وللأمّة المؤمنة، جنبًا إلى جنب مع محاورته للسياق الجاهلي الوثني كذلك، فالقرآن وَفقًا لها «لم يُضْفِ الكتابية على الموروث العربي فحَسْب، بل عرَّب الموروث الكتابي كذلك».
في هذا السياق فإنّ نويفرت لا تقرأ علاقة القرآن بالكتب السابقة باعتبارها نَسْخًا أو تعديلًا للكتب السابقة، ولا تأتي محاولتها لقراءة القرآن في سياق هذه النصوص بحثًا عن أصلٍ كتابي ما مخفي في طيات القرآن، بل إنها تَعتبر أنّ هذه «النصوص الضمنية sub-texts»[46] داخل القرآن، مَثَّلَت فضاءً للتواصل والخطاب مع المخاطبين بالقرآن؛ حيث تُبرِز المفاهيم الكتابية والقصص الكتابي بنسخته القرآنية الخاصّة منطقًا قرآنيًّا أصيلًا واعيًا بموقعه الخاصّ ضمن أو تجاه الرؤى التي تقدّمها هذه الكتب والفلسفات، كما تكشف وَفقًا لها عن حدود ودور ووظيفة وسلطة هذه الشخصيات والموضوعات الكتابية في القرآن وَفق رؤيته الخاصّة ووَفق تمرحلاته في تاريخ الأمّة.
ويختلف حضور القصص والمفاهيم الكتابية داخل القرآن -كجزء من علاقة القرآن بالكتاب المقدس- وَفق نويفرت في ضوء تمرحل القرآن ومراحل بنائه للأمة المؤمنة، حيث تتحوّل هذه العلاقة من كونها علاقة انطلاق أو استناد في المرحلة المكية المبكّرة، إلى علاقة تغلغل في هذا الفضاء الكتابي في المرحلتين الوسطى والمتأخِّرة، حيث «ازداد الوعي على المستوى الطوبوغرافي والزماني. واتسعت طوبوغرافيا التاريخ الكتابي فيما وراء مكة لتشمل أرض الرّسل السابقين، كما برزت الأرض المقدّسة التي شهدت تاريخ بني إسرائيل كمنطقة مباركة. وفي وقتٍ ما خلال هذه الفترة، أُعيد توجيه الأمة إلى (الحرم الأقصى) في القدس على المستوى التعبدي، فاتخذت القدس قِبلة لها...، وكذلك اتسع الإطار الزمني للرسالة عندما عدّت الأمة نفسها واحدة من متلقّي الكتب التي تقصّ تاريخ سلسلة من الأسلاف الروحيين، وتبنّت في النهاية الذاكرة التاريخية لأصحاب الأرض المقدّسة»[47]، إلى علاقة سيطرة على هذا التراث في المرحلة المدنية. وحيث تحضر صورة بعض الأنبياء في السياق المكي وبصورة محدّدة «مثل شخصية موسى كأساس للتغلغل في السياق الكتابي والسردية التوراتية»، ثم تختلف هذه الصورة في المدينة «فموسى الذي كان نبيًّا غير منازع خلال الفترة المكية يحجبه شخص الرسول الذي يكتسب زخمًا سياسيًّا جديدًا بصفته مبلغًا لكلام الله والسنن الإلهية»[48]، وكذلك شخصية مريم في سورة (مريم) والتي تمت إعادة قراءتها وفقًا لنويفرت في سورة (آل عمران) من أجل تجريد اليهود من حصرية الخلاص والاستئثار بتلقي الوحي الإلهي[49].
يتماشى هذا مع التصوّر الذي تفترضه نويفرت عن تطوّر صلة القرآن بالأمّة المؤمنة، والتي تتوازى مع تحوّله من «كتاب ليتورجي» مرتبط بأداء الشعائر في مرحلته الأولى، إلى كتاب مستقلّ عن الشعائر (انتقال الأمة من الاستمرارية الطقسية إلى الاستمرارية النصية) يدمج هذه الأمة ضمن سردية خلاص أوسع وأعمق في تاريخ الدين الكتابي، والذي يتوازى كذلك مع عملية سحر القرآن للعالم (بالمعنى الفيبري)[50] ثم نزعه جزئيًّا، وهي العملية التي قام بها القرآن بالأساس وَفقًا لنويفرت بالمجادلة مع وضعية الأماكن والشخوص التوراتية في مكة والمدينة خصوصًا (موسى) و(إبراهيم) و(القدس) و(مكة).
ونستطيع القول بأنّ هذه الصيغة التفسيرية والاستعادية والتضمينية -حيث يحضر الكتاب المقدس كـsub text- كإطار للعلاقة بين القرآن والنصوص السابقة -في مقابل السرقة والانتحال-، وكذلك الصيغة الحوارية أو التفاوضية كإطار للعلاقة مع مجتمعات الشرق الأدنى الدينية -في مقابل اعتبار المجتمع المسلم الأول ظلًّا أو إسقاطًا متأخرًا من خيال الرواة-، تُمثِّل عمل بعض هؤلاء الباحثين المذكورين في حديث زاده وغيرهم، وإن لم تكن بالضرورة بنفس التعقيد داخل رؤية نويفرت الخاصّة، إلا أنّ مبادئ أساسية مثل أصالة النصّ واستقلال رؤيته واعتماد المنظور الحواري والتناصي في فهم علاقته بالنصوص الأخرى وبالمجتمعات الدينية في سياقه تُعَدّ منطلقًا أساسيًّا لاشتغال هؤلاء الباحثين ضمن هذا المسار -بدرجاتٍ متفاوتة-.
ب) تدوين القرآن:
كما أسلفنا فإنّ مساحة تاريخ تدوين القرآن هي مساحة مركزية للعمل الاستشراقي منذ انطلاقته، إلا أنّ هذه الدراسة لتاريخ النصّ قد خضعت لتغير كبير في السياق المعاصر بسبب التغير الذي وصفنا في طبيعة المنهجيات المستخدمة والمصادر المتاحة للباحثين حول حقبة تاريخ الإسلام المبكّر أو حقبة الشرق الأدنى القديم الديني والنصِّي.
ونستطيع الحديث عن أربعة مسارات رئيسة شهدها هذا الاشتغال المعاصر حول تاريخ تدوين القرآن:
المسار الأول: التشكيك في تاريخ اعتماد نسخة قياسية/ معتمدة من القرآن:
وقد تشكّل هذا المسار نتيجة التشكيك التنقيحي في المصادر الإسلامية واعتبار أنها غير موثوقة تاريخيًّا، وهذه المصادر هي التي بنى عليها وبشكلٍ كبيرٍ نولدكه وبلاشير وكازانوفا وجيفري وغيرهم رؤيتهم لتاريخ القرآن، سواءٌ بالتماشي مع السردية التقليدية حول جمع ونشر القرآن في نسخة قياسية ملزمة (مصحف إمام) في عهد عثمان، أو برفض هذه السردية، أو قبول سردية مُعَدَّلة عن نصٍّ ظلّ منفتحًا على الإضافة إلى عهد الحجّاج، أي ما أسماه سيناي «نموذج النصّ القرآني المعتمد الناشئ»، إلا أنّ التشكيك في هذه المصادر أدّى لظهور رؤى مغايرة تمامًا عن تاريخ تدوين القرآن، ربما أشهر هذه النظريات هي نظريتي وانسبرو وبورتون.
تعود نظرية وانسبرو بعملية إصدار نسخة قياسية معتمدة من القرآن إلى القرن الثالث تقريبًا، وهي تَعتبر أنّ القرآن في البداية لم يكن أكثر من مجموعة نصوص منعزلة أو أقول نبوية معزولة prophetic logia، تم جمعها لاحقًا وتنقيحها بشكلٍ متدرِّج على مدى قرنين، تم هذا في وسط ديني طائفي يهودي ومسيحي مناهض للتثليث على الأغلب، وهذا يعود بالطبع لتطبيق مناهج (نقد الشكل) على القرآن والتي تكشف وَفقًا له عن أن بنية القرآن «والتي تتميّز بجمعها بين التقاليد المختلفة لا تشير إلى عمل نفّذه رجلٌ واحد أو فريقٌ من الرجال، بل هي نتاج تطوّر عضوي من أصل قوامه مرويات متفرّقة خلال فترة طويلة من النقل الشفوي»[51]، وكذلك يعود هذا الطرح إلى التأثُّر بما كشفت عنه مخطوطات قمران من مسار لتشكّل الكتاب العبري المقدّس، حيث اعتبر أن مرويات جمع القرآن هي مرويات لاحقة على غرار المرويات الحاخامية عن الكتاب المقدّس الأصلي، وهذا الأثر لتاريخ الكتاب المقدّس العبري ومسار تشكُّله على رؤية وانسبرو لتاريخ تدوين القرآن لاحظه وانتقده الكثير من الباحثين، إلا أنه وفي العموم فإن فرضية وانسبرو لم تَعُد مقبولة في هذه النقطة تحديدًا، حيث يملك الباحثون من المخطوطات ما يرجِّح العكس ويتوافق مع السردية التقليدية للمسلمين عن مصحف «مجموع ومُلْزِم وقياسي/ إمام» في القرن السابع، إلا أنّ ثمة بعض الباحثين المعاصرين مثل سيناي ومع قبولهم بنتائج المخطوطات في عزو (المصحف المجرد) القياسي لعصر عثمان، إلا أنهم يتفقون مع فرضية وانسبرو حول ظهور (سلطة النصّ)؛ حيث يميلون لكون القرآن لم يتحوّل إلى (canon)، أي: نصّ تشريعي مقدس ومعتمد إلا في القرن الثالث.
تقف أطروحة بورتون على النقيض من أطروحة وانسبرو، حيث يَعتبر أنّ النصّ قد جُمِع كاملًا وحُرِّر وظهرتْ نسخته القياسية في عهد النبوّة ذاته، ومثل شاخت ووانسبرو يَعتبر بورتون أنّ الجدالات الفقهية اللاحقة كان لها أثرٌ في عملية بناء تاريخ القرآن مع ظهوره كسلطة في القرون اللاحقة، ومن هنا يَعتبر بورتون أنّ الحديث اللاحق حول الجمع وكذلك حول القراءات القرآنية ليس إلا محاولة لشرعنة الخلافات الفقهية، والتي لم يكن لها أن تترسّخ إلا بافتراض وجود سند قرآني، ولمّا لم يَعُد هذا السند قائمًا في المصحف الحالي، تم تزييف عملية تنقيح عثمانية سابقة هي المسؤولة عن ضياع هذه القراءات[52]!
ولعلّ مسألة زيف وعدم أصالة القراءات القرآنية وارتباطها بالخلافات اللاحقة لعلماء أصول الفقه والفقهاء مثلما يفترض بورتون متابعًا شاخت =تأتي على عكس ما وصل إليه باحثون مثل روبين بتحليل الخلافات التفسيرية المبكّرة حول بعض الآيات القرآنية الوارد فيها عدد من القراءات ﴿لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ﴾، حيث توصّل لكون القراءات التي ربما تُمثِّل معضلًا تفسيريًّا قد يمكن التخلّص منه قد استمرت بالفعل، مما يدلّ على أصالتها، وأن «تقليد الانتقال الصارم للنصّ القرآني، الذي تتبعه القرّاء، مستقلّ عن الاعتبارات السياسية والفقهية»[53]، فضلًا عن أن نتائج المخطوطات تُثْبِت عدم دِقّة طرح بورتون عن مصحف نهائي ومغلق ومعتمد يعود إلى عصر النبوّة.
المسار الثاني: إعادة بناء المصادر:
في مقابل هذا المسار، نشأ مسار جديد يخالف هذا الرفض المبدئي والمجاني للمدونة التراثية الإسلامية، واعتبر أن عملية اللّفْظ هذه ليست دقيقة من الناحية المنهجية التأريخية، حيث يتركّز عمل المؤرخ بالأساس في ضرورة بحث أصالة وموثوقية المدونات من أجل إثبات أو نفي موثوقيتها ومن أجل تحديد إطار لإمكان الاستفادة منها، كما يُرجِع بعض الباحثين هذا الرفض الجذري المُستحدَث لأُسس أقدم وأعمق ضمن البناء المعرفي للدراسات الغربية، حيث يَعتبر لمبارد أن هذا الرفض ينبع من تقسيم المعارف إلى معارف موثوقة وغير موثوقة وَفقًا للصلة بالمنهجيات الغربية، حيث يتم افتراض وجود خطّ فاصل بين المعارف المقبولة وغير المقبولة، وهو خط جغرافي بالأساس فيما يشبه أن يكون عملية رسم لـ(خرائط معرفية)، حيث تُرْسَم حدود المعارف غير المقبولة حتمًا ضمن النتاج العلمي غير الغربي، وتصبح عملية رسم الخرائط هذه جزءًا مما تسمّيه نيجرين «الاستعمار المعرفي»"epistemic colonization"، (وفيه تتعرض المنهجيات التي تقدّم بديلًا مناسبًا للنظريات المعرفية الأوروبية إلى التهميش، في حين يتمُّ طمس كافة أشكال المعرفة الأخرى، حتى يتم احتواء أيّ صورة من صور المعارضة للنظريات المعرفية السائدة، وتحويلها إلى مجرد أشكال فنيّة تُعرض في المتاحف كمثال للمعرفة التراثية).
وقد حاول بعض الباحثين أن يقدّموا رؤية مغايرة لهذه الرؤية، تقوم على إعادة دراسة المصادر الإسلامية لامتحان مدى موثوقيتها من عدمه، على رأس هؤلاء غريغور شولر وهارالد موتسكي.
يدرس شولر بالأساس عمليات التدوين في العصر الجاهلي وعصر صدر الإسلام، والعلاقة بين الكتابة والشفاهة، وطبيعة نقل الشِّعْر والأحاديث والقرآن، وطبيعة تدوين المعارف والعلوم الإسلامية، وعبر المقارنة بين عملية تدوين القرآن وعملية تدوين السنّة من حيث دوافعها وعوائقها وآليتها، يعتبر شولر أنّ جمع القرآن قد مثّل النموذج لعملية تدوين العلوم الإسلامية لاحقًا[54].
كما حاول شولر دراسة السردية الإسلامية التقليدية حول الجمع، بكلّ مراحله، البَكريّ والعثماني ثم التحرير الحجّاجي/ المرواني، ومن خلال المقارنة بين المرويات، توصّل شولر إلى كون المرويات الإسلامية في المدونات التراثية تحمل بالأساس (نواة صلبة/ أصيلة/ صحيحة) من المرويات، حتى لو أنّ بعض تفاصيل هذه السردية غير دقيق وَفقًا له، إلا أن مهمة المؤرخ وَفقًا له، هي محاولة الوصول لهذه (النواة الأصيلة genuine core ) والاعتماد عليها كأساس لبناء سردية موثوقة حول تاريخ القرآن.
ويختلف تحديد شولر لهذه النواة عن اقتراح مونتغمري وات الشبيه الذي أشار إليه موتسكي، حيث وعلى خلاف وات فإنّ شولر قام بفحص دقيق للمرويات ومقارنة لها ببعضها، وكذلك قام باستحضار السياقات العقدية لعصر صدر الإسلام والخلافات السنّية الشيعية والنظرة لبني أميّة عند الشيعة، ليصل لكون بعض الأحداث التي ترويها هذه المرويات، مثل نسبة الجمع لعثمان، هي «نواة أصيلة» يصعب تمامًا أن تكون مُختلَقَة ويخالف المنطق كون الخلافات التفصيلية حول الحدث أو توابعه عبارة عن سلسلة من موضوعات تستمر في الازدياد في مقابل بساطة إعلان عدم صحة الحدث الأصلي[55]!
كذلك درَس موتسكي مرويات جمع القرآن، ودراسته لها جاءت على غرار منهجية شاخت في نظريته الشهيرة (نظرية المدار)، إلا أنّ موتسكي وحين طبّق هذه المنهجية على مرويات جمع القرآن ومع استفادته من جونيبول ودراساته حول الإسناد، وجد أن الحديث عن تأخُّرها إلى حقبة البخاري -كما افترض منجانا سابقًا- غير دقيق، وأنها تعود إلى ما قبل ذلك -إلى عهد الزهري-، مما يعني أن الرؤية الاستشراقية القائمة على طرح شاخت حول الأحاديث والتي مدّت هذه الرؤية على استقامة أكبر مع التنقيحيين لتضع تاريخ المرويات في زمانٍ متأخّر، تجاهلتْ كمية المصادر الجديدة المكتشفة والتي تُبرِز كون الكتابة والتدوين لم يتأخرَا إلى هذا الحدّ، كما تُبرِز دراسة موتسكي كون مدار الإسناد الشاختي ربما يعود إلى قبل ما حدّده بكثير لو تم تفعيل نفس نظريته في ضوء المكتشفات الجديدة (مدونات عبد الرزاق وابن أبي شيبة وتاريخ المدينة لعمر بن شبة)[56].
فدراسات شولر وموتسكي تكشف عن كون النظريات الغربية حول تأخُّر تدوين المدونات الإسلامية في الحديث والسيرة هي نظريات غير دقيقة، كما تكشف عن ضرورة تطوير منهجيات أكثر دِقّة في بحث ودراسة المنهجيات الإسلامية والتراثية وتقييم موثوقيتها، كذلك تكشف ضرورة الالتفات للمكتشفات الحديثة من مصادر مبكّرة، كما أنها وتحديدًا في مسألة جمع القرآن تُبرِز إمكان الاستفادة من المرويات الإسلامية في بناء سردية موثوقة حول تاريخ هذا الحدث.
المسار الثالث: دراسة المخطوطات:
وقد خرج هذا المسار عن التشكيك التنقيحي (المسار الأول) وكذلك عن الردّ المنهجي عليه (المسار الثاني)، وهذا عبر دراسة تاريخ هذه المرحلة عن طريق المخطوطات، ورغم أن هذا يبدو تماشيًا مع الرؤية التنقيحية المنهجية حيث ينطلق لبناء تاريخ القرآن على الأدلة الأركيولوجية بدلًا عن المدونات التاريخية التي خضعت للنقد والتشكيك، إلا أنّ هذه الدراسة لم يكن لها ذات التحفُّز تجاه المرويات الإسلامية والذي أدّى لتجاهل بعض التنقيحيين لأدلة واضحة قدّمتها المخطوطات بالفعل[57].
ومثّلت مخطوطات صنعاء إحدى أهم مساحات الدراسة المعاصرة لهذا المسار، حيث مثّل حدث إتاحتها للدراسة حدثًا مهمًّا وتهافَت الباحثون على دراستها ومحاولة الوصول عبرها لتأريخ أكثر دقة لتاريخ المصحف، مثل جودارزي وصادقي وفان بوتين، وتعدّ أهم هذه المخطوطات التي اهتم بها الدارسون هي طرس صنعاء 1، حيث اهتم الباحثون بدراسة الكتابة السفلية والعلوية للطرس في محاولة بناء تاريخ تدوين القرآن وتاريخ نشأة (النسخة القياسية/ المصحف الإمام).
كذلك قام صادقي وبيرجمان بمحاولة مقارنة الكتابتين كنوع من الموازنة بين النسخة القياسية المعتمدة (المصحف الإمام) والنسخ الأخرى التي كانت تُمثِّل مصاحف بعض الصحابة، ليصلا لكون المصحف العثماني (القياسي) مَثَّل أقرب نسخة وأدقّ نسخة من القرآن المدوّن وقت النبوّة.
كما شملت هذه الدراسات محاولات استفادة من تاريخ تدوين النصوص الكبرى في الحضارات الأخرى مثل الحضارة اليونانية، في محاولة لبناء تصوّر حول طبيعة الاختلافات بين النُّسَخ، وتقديم تفسير لهذه الاختلافات، وكذلك اقتراح علاقات بين النُّسَخ المكتشفة، كما حاول كوك من خلال هذا بلورة تصور عن العلاقة بين مصاحف الأمصار، في دراسة مثّلَت في ذاتها إعادة قراءة للأدبيات الإسلامية التقليدية حول المصاحف في ضوء المكتشفات الحديثة[58].
وفي هذا السياق انطلقت كذلك عددٌ من المشاريع لاستئناف هذا المشروع المؤجَّل، حيث بناء «نسخة نقدية من النصّ»، على رأسها مشروع كوربس كوارنيكوم، وهو «عبارة عن برنامج ثلاثي الأجزاء ذي إطار زمني مقداره عشرون سنة؛ الجزء الأول: يُعنى بتوثيق نقدي للنصِّ القرآني بجميع رواياته وَفق تعاليم القرآن العربي، وعلى مقتضى الروايات للقراءات الشفهية، علاوة على المخطوطات المتاحة وهي الأهمّ. أمَّا الجزء الثاني: فيوفّر بنكًا من البيانات يشتمل على النصوص السابقة والمعاصرة للقرآن، والتي كان لها بالغ الأثر في تشكيل الإطار الثقافي لدى الجمهور الأول الذي تلقَّى القرآن. أمَّا الجزء الثالث: فهو تعليقٌ أدبي يحاول كشف النقاب عن البنية الداخلية للنصّ وتاريخه بمعزل عن شكله (المعتمد) الذي دوّن في 114 سورة»[59]، وهذا المشروع اعتمد كذلك على مخطوطات برجستراسر والتي كانت بحوزة أنطون شبيتلر وآلت إلى نويفرت.
وفي سياق ذات الجهود نجد مشروع أماري (فرنسوا ديروش وسيرجيو نوسيدا) الذي نشر أجزاءً من مصحف Parisiono-Petropolitanus، والذي يضم أربع مجموعات: مجموعة الورقات المحفوظة في المكتبة الوطنية الباريسية، ومخطوط المكتبة الوطنية الروسية في سانت بطرسبرج، ومخطوط مكتبة الفاتيكان، ومجموعة نادر داود خليلي للفن في لندن، تصل إلى 98 ورقة تضمّ حوالي 45% من المصحف، والتي درسها تفصيلًا فرنسوا ديروش، سواء خطوطها أو تاريخ كتابتها والذي يعود إلى القرن الأول الهجري[60].
ولا يتوقف الأمر على المخطوطات وحدها، بل توسّع الاهتمام ليشمل كذلك كلّ الأدلة الأثرية المتاحة، مثل النقوش والعملات، من هنا نفهم هذا التوسُّع الكبير في دراسة نقوش قبة الصخرة[61]، ودراسة شواهد القبور والنقوش على الجبال والصخور، كجزء من محاولة بناء تصوُّر حول تاريخ هذه الفترة وتاريخ اللغة العربية وتاريخ التدوين.
ولا شك أنّ هذا التطوّر الكبير في المناهج الكوديكولوجية وفي دراسة مخطوطات القرآن والأدلة الأثرية لا يمكن فهمه إلا في ضوء الخلاف الذي أثاره التشكيك التنقيحي في الأدبيات الإسلامية التقليدية وكذلك في ضوء المكتشفات الحديثة من مخطوطات قرآنية ومخطوطات إسلامية مبكّرة[62].
المسار الرابع: الدراسة المفاهيمية لنشأة النسخة المعتمدة من القرآن:
هذا المسار الأخير الناشئ ضمن دراسة مساحة تدوين القرآن يُعَدّ مسارًا حديثًا نسبيًّا، وهو متأثّر بشكلٍ كبيرٍ بتطبيق المناهج الأدبية والكتابية على القرآن، وينطلق من دراسة البنية المفاهيمية للقرآن كجزء من دراسة عملية جمعه في نسخة معتمدة قياسية.
فالدراسة الكلاسيكية لتاريخ القرآن ظلّت بالأساس دراسة تاريخية معتمدة على المرويات وليس على القراءة الداخلية التركيبية للنصّ؛ لذا فلم تتمّ دراسة طبيعة النصوص الدينية وعملية جمعها وعملية إصدار نسخة قياسية معتمدة ذات سلطة منها بشكل نظري، وظلّت هذه المفاهيم (النصّ المعتمد- القياسي- الموحد- الجمع- التدوين- النصّ التشريعي) سواءٌ في ذاتها أو في تطبيقها على القرآن =عُرضةً للاختلاف وعدم الدقة ضمن الدراسة الكلاسيكية، بل كذلك ضمن بعض مساحات الدراسة المعاصرة كما يرى سيناي وآن سيلفي بواليفو والتي تُرجِع كثيرًا من التشعّب في الآراء حول تاريخ القرآن لغياب الدقة في استخدام هذه المصطلحات.
إلا أنّ الانفتاح على الدراسات الأدبية والكتابية وكذلك تزايد الدراسات حول مخطوطات قمران، والتعرّف بصورة أدقّ على تاريخ الكتاب المقدّس العبري قبل المعتمد pre- canonical Hebrew text، أدّى لتغير في النظر لهذه المساحة بشكلٍ كبيرٍ، حيث بالأساس تم التعرف على ثلاث مساحات رئيسة ضمن تاريخ الكتب المقدسة، على ما وصف ريفز وفايرستون، حيث يبدأ النصّ كنصّ نبوي، ثم يتحوّل لنصّ مقدّس ذي سلطة أولية، ثم يتحوّل لاحقًا لعملية اعتماد تنتهي بإصدار لائحة من النصوص المعتمدة ذات السلطة المطلقة والتي لا تقبل الزيادة أو النقصان أو التغيير.
أقام الباحثون هذه النماذج المقترحة لتاريخ تطوّر الكتاب المقدّس العبري على أساس مراقبة الإستراتيجيات النصِّية في التفسير والاستعادة والاقتباس وإعادة الصياغة، الشائعة والمتطورة في سياق الشرق الأدنى، والتي تُبْرِز طريقة التعامل مع النصوص وعلاقة هذا بسلطة هذه النصوص تجاه النصوص الأخرى وتجاه المستمعين إليها[63]، ولعلّ هذا ما حدا ببعض الباحثين المعاصرين إلى محاولة فهم عملية تدوين القرآن وبروزه كنصّ معتمد ذي سلطة من خلال هذا المسار أو النموذج، وأصبح تناول القرآن لمفاهيم الكتاب واللوح المحفوظ والتنزيل وغيرها من إحالات ذاتية مرجعية للقرآن عبارة عن باب لمحاولة فهم كيفية تعامل القرآن مع فكرة النصّ المدون والنصّ ذي السلطة داخل نسيجه، حيث لفت نظر كثير من الباحثين مثل وليم جراهام أن هذه الموضوعات والتي لم تكن موضوعات للنصوص السابقة بقدر ما كانت موضوعات لمجتمعاتها، التي -وَفقًا له- لم تناقش هذه القضايا وتقرأ في ضوئها نصوصهم الدينية إلا بأثرٍ رجعي؛ هي موضوعات مركزية داخل القرآن نفسه تمثّل مفاهيم مرجعيته الذاتية.
ومن خلال تحليل هذه المفاهيم تزامنيًّا (من داخل النصّ)، ودياكرونيًّا (في تتابعها التاريخي وصلتها بسياق الدعوة)، وتناصيًّا (تحليل علاقاتها بالكتب السابقة وبالتالي تحليل توقعات السامعين)، رأى الكثير من الباحثين كون القرآن يُبرِز وعيًا واضحًا بسلطته، والتي حددتها بواليفو بكونها «سلطة مطلقة، تقضي بأن نرى من الواجب اعتقاد كلّ ما يقول، وأن نُكِنّ له الاحترام المطلق»، وأنّ هذا الوعيَ (وكما ترى نويفرت، وكما أثبتت بواليفو من خلال تحليلها للسور المكية المبكرة وإستراتيجيتها في إسناد القول) حاضرٌ -وإن لم يكن بالوضوح التام- ومنذ مرحلة مبكّرة من تاريخ القرآن المكي[64].
وترى بواليفو أنّ القرآن له إستراتيجيات خاصّة في تأسيس سلطته هذه تجاه الكتب السابقة، حيث يحيل إلى دلالة القداسة والسلطة للكتب المقدّسة السابقة، وهذا إمّا بطريقة مباشرة عبر إعلان المصدر الإلهي والمفارق لهذه الكتب وسلطتها على متلقّيها، وكون القرآن متنزّلًا من ذات المصدر المفارق، أو عبر الإحالة الضمنية للكتب السابقة عبر تشابه بعض الألفاظ، مثل: «قرآن» و«مثاني» مع «قريانا» و«مشنا»، وأنّ هذه الإستراتيجيات القرآنية لا تقف عند حدّ إعلان سلطة للقرآن مشابهة لهم عبر فعل التوازي والاستيعاب/ الهيمنة، بل إنها تصل حدّ إعلان الانفراد التام بهذه السلطة، فالقرآن وبعد إعلان هذه السلطة يتّهم الكتب السابقة بالتحريف، مما يعني أنّ القرآن يتحدّث عن -أو قُلْ يؤسّس- «سلطة كتابية» هو وحده المستفيد من استحضارها كما تعبّر بواليفو[65].
واهتمت أنجيليكا نويفرت بشكلٍ أساسي بهذه القضية، حيث اعتبرت أن القرآن يُبرِز سلطة تجاه النصوص وتجاه المجتمع، ومنذ سور مكية مبكّرة، وفي هذا السياق وضعت تفريقًا مهمًّا بين مرحلتين من مراحل الـcanonization، مرحلة من أعلى داخل النصّ تتم عبر النصّ نفسه، ومرحلة من أسفل تتم بفعل المجتمع المستعد لحسم الخلافات بين نسخ نصّ ثبتت قداسته وسلطته بالفعل[66].
وفي ذات السياق قدّمَت بواليفو تفريقًا أوسع حيث قسّمت عملية إعلان السلطة لثلاث مراحل، تعدّ مرحلة الجمع والتدوين والإعلان الفعلي نهايتها فحَسْب، فـ«جمع النصّ وتحريره» وَفق الباحثة الفرنسية يمثل الخطوة الثالثة ضمن خطوات ثلاث، أي تلك التي تقوم فيها الأمة بتثبيت النصّ تفعيلًا لسلطته في المجتمع بعد تقبّله لها بالفعل (في الخطوة الثانية)، وبعد الإعلان عن سلطته وحجيته داخل نسيجه الخاصّ (في الخطوة الأولى، والتي نصل لها بالتحليل السانكروني للنصّ الذي يثبت وحدة بنيته الحجاجية والاستدلالية)، فكتابة النصّ وتثبيته وتحريره بشكلٍ نهائي -وَفقًا لنويفرت وبواليفو- هو مجرّد «تثبيت فعلي» يُعَدّ كامتداد طبيعي لإعلان النصّ سلطته منذ البدء[67].
كما أدّى هذا لتزايد الدراسة للمفاهيم المركزية للقرآن المتعلقة بطبيعته (مفاهيم المرجعية الذاتية) مثل مفاهيم (الكتاب) و(التنزيل) و(القرآن)، بصورة تختلف عن الصورة الكلاسيكية التي كانت تعود بهذه المفاهيم لكونها مجرّد مفاهيم سريانية أو غيره، لتُقرأ بدلًا عن هذا وَفق وظيفتها ودورها ضمن بناء النصّ القرآني وضمن بناء القرآن لسلطته في مواجهة الكتب السابقة وتأسيس موقعه ودوره، وربما أبرز الكتابات في هذا كتاب دانييل ماديغان حول مفهوم الكتاب القرآني (الصورة الذاتية للقرآن: كتاب الإسلام المقدس، 2001)، والذي وصل فيه لكون هذا المفهوم -بشكل يوافق نتائج بواليفو- مرتبطًا بطبيعة القرآن وسلطته أكثر من تعلّقه بمصيره المدون، كذلك مرتبط بدلالات أكثر اتساعًا داخل القرآن لمفهوم الكتاب تغيب حين يتم التعامل مع هذه المفهوم باعتباره مرادفًا لمعنى الكتاب في حديثنا المعاصر[68]، ذات الأمر مع سيناي ونويفرت اللذَيْن نظرَا للمفهوم في ضوء توقّعات السامعين عن طبيعة النصّ المقدّس، حيث تحضر وَفقًا لنويفرت شفاهة النصّ كتأسيس لنمط خاصّ من الشفاهية ومن التعاطي مع النصوص المقدّسة بشكل يتوازى مع الاستجابة لتوقعاتهم بنصٍّ مكتوب.
هذه النظرة المفاهيمية لتاريخ القرآن وتحويل عملية دراسته من عملية تاريخية صِرفة إلى عملية لا بد من أن تستحضر طبيعة القرآن وعلاقته بالكتب السابقة، ونظرته لهذه الكتب، عبر التنبه للبنية المفاهيمية التي تحضر داخله وتبرز طبيعته وتبرز طبيعة علاقته بالكتب السابقة، هي نظرة جديدة وحديثة نسبيًّا، إلا أنها تُعبِّر عن انعطاف حقيقي في نمط مقاربة هذه القضية المهمّة، خصوصًا أنها لا تعارض الدراسة التاريخية ولا الدراسة الأركيولولجية المعتمدة على المخطوطات -بل تستفيد منها في حقيقة الأمر-، لكنها قادرة على ضبط النقاش فيها بشكلٍ نظري وفتح آفاق نظرية ومفاهيمية وتاريخية لا توجد ضمن هذه المسارات[69].
2) مساحة النصّ:
كما أسلفنا فإنّ تطبيق المنهجيات الأدبية على الكتاب المقدّس وما أدّى إليه هذا من نتائج مهمّة قد دفع بعض الباحثين المعاصرين إلى تطبيق هذه المنهجيات على القرآن ذاته، في محاولةٍ للكشف عن بنيته الخاصّة، وقد تماشى هذا كما أسلفنا مع هدف عزل القرآن عن سياق التلقي بعد النقد التنقيحي لمدونات الإسلام المبكّر.
وقد نشأ في هذا السياق اتجاه منهجي جديد لدراسة القرآن، هو الاتجاه السانكروني أو التزامني، والذي ينظر للقرآن في كليته كنصّ، وبرز على ساحة هذا الاتجاه عددٌ كبيرٌ من المنهجيات الأدبية والكتابية والتي تم تطبيقها على القرآن للوصول لبنيته الكلية ولبنيته الأدبية الأدنى وللعلاقات بين وحداته الأدبية[70]، وكذلك لمحاولة اكتشاف تماسكه الأدبي والتركيبي والموضوعي، والربط بين مساحاته بطرق أكثر علمية ودقة[71].
ولا شك فإنّ هذا الاتجاه يُمثِّل ثورة على الرؤية الاستشراقية الكلاسيكية التي كانت غالبًا ما تنظر للقرآن كنصّ مفكَّك غير منتظم موضوعيًّا وأسلوبيًّا، وصعب المقروئية، وكانت تنتهي لإعادة بنائه على أساس تاريخي يُضفِي عليه معقولية غائبة!
إلا أنّ هذا التحقيب التاريخي للقرآن والذي برزت ذروته مع نولدكه، يُمثِّل وللمفارقة أساس الدراسة الأدبية المعاصرة للنصّ، حيث اهتم نولدكه بتحقيب القرآن على أساس أسلوبه «فكرة تطوّر الأسلوب والتراجع الأسلوبي»، وهذا ما أعطى ترتيبه موضوعيةً وتماسكًا غابا عن تحقيبات أخرى مثل هيرتشفيلد أو ريتشارد بل[72]، ونتج عن هذا تحقيب أدبي للنصّ يجمع السور القرآنية ضمن فترات تاريخية على أساس الموضوعات والأسلوب والبنى التركيبية الدقيقة -مع إصرار نولدكه أحيانًا على أنّ هذا التماسك ليس بالدقة الكافية نتيجة انطلاقه من معايير الخطاب اليوناني-؛ لذا فإننا لا نستغرب كون أحد أهم الدارسين المنافحين عن وحدة النصّ التركيبية اليوم، أي أنجيليكا نويفرت، تتبع بالأساس وتنطلق من تحقيب نولدكه ذاته.
ويمكن تقسيم هذه المدارس المعاصرة ضمن الاتجاه (التزامني) المهتم باستكشاف بنية النصّ وبشكلٍ نظري لصنفين رئيسين؛ الأول: هو المدارس التي تنطلق من المناهج الأدبية البنيوية بصفة عامة. والثاني: هو المدارس التي تنطلق من مناهج أدبية محدّدة ذات صلة وثيقة بالكتاب المقدّس ودراساته.
ويعدّ أبرز ممثل عن الصنف الأول أنجيليكا نويفرت ونيل روبنسون ومستنصر مير، حيث يتم تطبيق مناهج تحليل بنيوية وأدبية عامة في تحليل بنية القرآن التركيبية والبلاغية والأسلوبية، ويعدّ أبرز كتاب ضمن هذا الاشتغال هو كتاب (تركيب السور المكية، 1981) لنويفرت، والذي ينطلق من التقسيم الثلاثي للسور المكية، ويَعتبر أن السورة وحدة قرآنية فريدة، ويدرس بنية هذه السور في المراحل المكية، وقد توسعت نويفرت لاحقًا وطبّقت منهجها على بعض السور المدنية، مثل سورة آل عمران، وتَعتبر نويفرت أن السور القرآنية ذات بنية ثلاثية (مقدّمة ابتهالية أو تمجيدية، متن قصصي، خاتمة تؤكد على أهمية الرسالة)، وأن السور القرآنية مثلها مثل القرآن يصعب قراءتها خطيًّا، حيث يمثل القرآن وسوره عملية توسعة دائمة لبنية أساسية أو نواة أساسية.
ويمتاز منهج نويفرت عن غيرها بكونها تستحضر علاقة القرآن بالأمة الناشئة حوله، وبوظائف النصّ ضمن الـsitz im leben أي: السياق الاجتماعي والحياتي للنصّ، فضلًا عن اهتمامها -وكما أسلفنا- بتسييق النصّ في السياق النصِّي والديني والفلسفي للشرق الأدنى بشكل يكشف حوارية النصّ القرآني وَفقًا لها، كما يمتاز منهج نيل روبنسون بالالتفات لمسألة شفهية النصّ واستحضارها ضمن عملية استكشاف تقسيم السورة لوحداتها الأدبية الأدنى.
ولا يمكن تجاهل الأثر الكبير الذي تركته ترجمة أعمال الفراهي وإصلاحي على هذه المدرسة بالذات ضمن الاتجاه التزامني العام، وكذلك الدراسات التي قدّمها مستنصر مير حول أعمالهما، حيث نجد اهتمامًا لدى روّاد هذه المدرسة مثل روبنسون بأفكار النَّظْم وعمود السورة ومسألة التماسك التركيبي والموضوعي للسور بل والعلاقة بين السور، والذي طرحه العلّامتان الهنديان.
ويعدّ أبرز ممثل عن الصنف الثاني ميشيل كويبرس والذي يقرأ القرآن من خلال منهج التحليل البلاغي/ منهج البلاغة الساميّة، وهذا المنهج هو حصيلة اشتغال دارسي الكتاب المقدّس لطريقة نَظْم هذا الكتاب وكيفياتها، وقد استطاع مؤخرًا رولان مينيه صوغ هذه الحصيلة في إطار منهجي متكامل، وهذا المنهج يقوم على تحليل النصوص وَفقًا لمجموعة من المبادئ الخاصّة بالبلاغة الساميّة، بذات النسق الذي استخرجه دارسو الكتاب المقدّس من خلال تحليلهم لنصوص الكتاب المقدّس. وهذه البلاغة الساميّة يرى دارسو الكتاب المقدس أنها مغايرة تمامًا في طريقة نَظْم نصوصها لذلك النمط القائم في ما يعتبرونه بالبلاغة اليونانية التي يتشكّل فيها الخطاب من (مقدّمة وعرض وخاتمة)، وتقوم هذه البلاغة الساميّة بالأصالة على مبدأ التناظر والتوازي، وتعتمد صور معيّنة من النظم؛ كالبناء المحوري والبناء المتوازي والبناء المعكوس.
وهذا المنهج يتميز بكونه ذا بنية تقنية دقيقة، حيث يشمل مجموعة من المفاهيم والمصطلحات والأدوات القابلة للتطبيق كجهاز منهجي على النصّ، وكذلك فهو يهتم بالبدء من الجزء إلى الكلّ، حيث يبدأ من تحليل الوحدات النصِّية الدنيا (المفردة، المفصل، الفرع، القسم، الجزء)، ثم العليا (المقطع، السلسلة، الشعبة، الكتاب)، ويضم عددًا من (مؤشّرات النّظْم)، أي تلك الروابط الدلالية التي تكشف عن تقسيم النصّ وترتيبه (التشابه في الناحية الدلالية، التشابه في الصيغ الحوارية والتركيبية، الجمل الحكمية والتشريعية)، والتي يستخدمها حتى يتم استنطاق بنية النصّ ووصفها بصورة دقيقة.
وقام كويبرس بتطبيق هذا المنهج على القرآن، لا فقط سوره المكية القصيرة، بل كذلك حاول إثبات حضور هذا المنهج ضمن السور المدنية الطويلة، مثل سورة المائدة، ويعتبر كويبرس أنّ السور القرآنية تبرز تناظرًا يظهر على أنماط ثلاثة (المتوازي والمحوري والمعكوس).
ويَعتبر كويبرس أن إدراك هذه البنى ودراسة القرآن من خلالها يُظْهِر غياب التفكّك عن النص القرآني، وأن هذا الوصف المنتشر في كثير من الرؤى الغربية يأتي من عدم فهم أنماط النَّظْم التي يتركب وَفقها القرآن، وإخضاعه لأنماط أخرى من التركيب، أو قراءته ضمن أفق انتظار مختلف كما تعبر زهراء دلاور ابربكوه[73].
ويُشكِّل الاشتغال التزامني على النصّ فضاءً لاشتغال عددٍ من الباحثين العرب والمسلمين المعاصرين مثل: سلوى العوا ونيفين رضا ومحمد عبد الحليم وغيرهم، والذين قدّموا عددًا من الدراسات التي تعتمد على الموروث العربي الإسلامي وكذا الاستشراقي في استكشاف بنيات النصّ.
وتُمثِّل هذه المدرسة فضاءً مناسبًا لاشتغال الكتب التقديمية الغربية للقرآن، حيث بدأت كثير من هذه الكتابات اعتمادها على هذه المدرسة في محاولة بناء رؤية موضوعية تقديمية وتبسيطية للإسلام للقارئ الغربي، تحاول الابتعاد عن عملية الانتقاء الموضوعي الذي ساد في الكتابات الموضوعية التقديمية القديمة القليلة[74].
كذلك تمثّل هذه المدرسة جدالًا دائمًا مع الاتجاه التنقيحي، يبرُز في كون الخلاف بين المدرستين هو -وكما تصفه وتحدّده نويفرت- خلاف فيلولوجي، حيث تنشأ الرؤية لتفكيك النصّ على عقود وقرون من غياب القراءة الأدبية للنصّ، فترى نويفرت أن هذه القراءة تكشف في المقابل عن التماسك النصِّي والموضوعي والأسلوبي للقرآن بشكلٍ يستحيل معه كون عملية كتابته استمرّت لقرون أو أنه مُجمَّع ومُحرَّر من نصوص معزولة كما يفترض التنقيحيون.
وتتعرّض هذه المدرسة إلى بعض الانتقادات التي تتعلّق بطبيعة المنهجيات المستخدمة ومدى التعسّف في تطبيقها على القرآن، كذلك على غياب بعض الأطر المنهجية أو عدم انضباطها كأساس لهذه الدراسة، في هذا السياق تَعتبر رايتشل فريدمان أنّ هذه الدراسة المنطلقة من الأفق البنيوي غالبًا ما تُخْضِع القرآن لثنائيات حدّية جاهزة تُفْقِد القرآنَ ثراءَه، كما تتجاهل شفاهيته بمعاملته كنصّ مكتوب فقط، كذلك فإنّ هذه الدراسات وَفق فريدمان تحصُر المعنى في فضاء مُحَدَّد يتجاهل اتساع المعنى القرآني وعدم خضوعه للمنطق اللغوي البنيوي وحده، مما يجعل القراءة البنيوية وَفقًا لها حصرًا للقرآن في سياق المعقولية الأدبية المعاصرة فحَسْب وهو ما يمثّل وَفقًا لها (مخاطرة أنطولوجية)[75]، في نفس السياق فقد نظر زاده لهذا التأطير الأدبي للقرآن باعتباره علمنة له وتخليصًا من أبعاده اللاهوتية، أي أنه لا يعدو أن يكون حصرًا للنصّ في المجال العلماني الوحيد الممكن قراءته فيه.
كذلك طرح فلاورز استشكالًا منهجيًّا أوسع حول عدم انضباط مسألة النوع الأدبي، وعدم الاتفاق بين الباحثين على التقسيمات البنيوية للنصّ، وغياب الاستفادة من دراسات النوع والسرد التي قدّمها باختين وميلر وغيرهما في ضبط فضاء هذه الدراسة بحيث تستطيع التحوّل لدراسة منضبطة قائمة على أساس معرفة دقيقة بطبيعة «النوع الأدبي القرآني» وبالعلاقة الدقيقة بين وحداته الأدبية «أنواعه الأدبية الدنيا»[76].
وتمثّل هذه المساحة المتنامية إحدى أهم مساحات الاشتغال الغربي المعاصرة على القرآن، ذات التأثير كذلك على دراسة كلّ المساحات الأخرى[77].
3) مساحة ما أمام القرآن:
يشهد الشكل المعاصر لمساحة «ما أمام القرآن» اختلافًا عن الشكل الكلاسيكي بسبب تطوّر المنهجيات الأدبية، وكذلك بسبب اكتشاف بعض المخطوطات لبعض الكتابات الإسلامية المبكرة.
فبسبب تطبيق المناهج الأدبية والكتابية على الأدبيات التفسيرية المبكّرة ومنذ وانسبرو، فقد حاول الكثير من الباحثين المعاصرين الخروج من حيِّز الدراسات الكلاسيكية للتفسير، والتي تميل للتعامل معه بشكلٍ خارجي دون تعمُّقٍ في بنيته الخاصة وفي الطبيعة الأدبية الدقيقة لبنائه ولتوظيف المصادر داخله وللعلاقة بين التخصّصات العلمية داخل تكوينه، في مقابل هذا حاولَت هذه الدراسات المعاصرة معتمدة على تطبيق المنهجيات الأدبية أن تُقدِّم رؤية أدقّ لهذا الحقل، تقف على أبعاده الخاصّة وطريقة بناء متونه والطبيعة الداخلية لهذه المدونات وما يفرقها عن العلوم الإسلامية الأخرى، يتركز هذا الاهتمام بصورة كبيرة في كثير من الكتب المعاصرة حول التفسير، مثل كتاب كارين باور (أهداف ومناهج وسياقات كتب التفسير)، والكتاب الذي حررته يوهانا بينك واندرياس جورك (تاريخ التفسير وتاريخ الفكر الإسلامي، استكشاف حدود النوع/ الحقل)، والتي تهتم كثير من بحوثهما ببحث الطبيعة الخاصة لعلم التفسير والعلاقة بينه وبين العلوم الإسلامية الأخرى التي تتبدى في طريقته الخاصّة في توظيف المرويات الحديثية والأدوات اللغوية والبيانية[78].
وفي ظلّ هذا الاهتمام بالنظر للتفسير وفق بنائه الخاصّ، وكذلك في ضوء تطور بحث العلاقة بين القرآن والكتب الدينية في سياق الشرق الأدنى القديم، فقد اهتم بعض الباحثين برصد الصلة بين القرآن والكتب السابقة داخل كتب التفسير، فنجد باحثين مثل وليد صالح ويونس ميرزا اهتمّا بمسألة توظيف المفسِّرين في الحقبة الكلاسيكية والوسيطة للمرويات الإسرائيلية وللكتاب المقدس في محاولة فهم دلالة بعض الآيات، وكذلك بمحاولة تتبع الجدل الإسلامي العلمي التفسيري حول هذه القضية في المرحلة الكلاسيكية ثم الوسيطة[79].
كذلك يهتم بعض الباحثين مثل جوردون نيكل بتحليل الصلة بالكتاب المقدس في ضوء أوسع هو علاقة المسلمين باليهود والمسيحيين في صدر الإسلام، حيث يهتم نيكل برصد هذه العلاقة وتحليلها وتحليل الأدوات المستخدمة من متديني هذا العصر للنقاش حول مرتكزاتهم العقدية الأعمق، ويبدو تأثير وانسبرو شديدًا على أعمال مثل أعمال نيكل، حيث تنطلق من الدور الكبير الذي لعبته المدونات المبكّرة -ومنها التفسير- في تأسيس سلطة الكتاب الإسلامي داخل سردية الخلاص الكتابية، كما يظهر في كتابه الرئيس حول مقولة (التحريف) في القرآن والتفاسير[80].
وأيضًا هناك بعض المحاولات للاستفادة من التفاسير في تصوّر طبيعة الكتاب المقدّس في الشرق الأدنى القديم، حيث نجد بعض الباحثين مثل جون سي ريفز والمهتم أساسًا بمخطوطات قمران وما بين العهدين، يهتم اهتمامًا كبيرًا للتفسير؛ حيث يرى فيه كثيرًا من أصداء هذه النصوص التي لم تَعُد لاحقًا جزءًا من الكتاب المقدّس العبري الماسوري، فعلى سبيل المثال في تحليله لتفسير القرطبي في ما يتعلّق بشخصية إدريس، يَعتبر ريفز أن القرطبي يستخدم قصة من قصص الكتاب المقدّس تشابه قصة مذكورة في سفر أخنوخ -أحد مكتشفات قمران-، ويَعتبر أنّ الاختلاف بين القصتين قد لا يعود لخطأ في النقل -كما قد يرى أيّ باحث غربي-، بل ربما قد يشير لنسخة مختلفة من القصة كانت قائمة مسبقًا ومتاحة عبر الشفاهة في سياق عمل المفسِّرين الأوائل!
كذلك فإنّ محاولة استخدام المكتشفات المعاصرة في تراث ما بين العهدين والتراث المتنوّع للشرق الأدنى القديم المتأخر في فهم بعض دلالات القصص القرآني والمفاهيم القرآنية أظهرت اتجاهًا للبحث في تطوّر المعاني التفسيرية ما بين الدلالات (الأخروية) و(التاريخية)، ونجد أسماء مثل روبين وسيلفرستاين وغورك[81] وغيرهم ممن يكثّفون بحثهم في هذه المساحة، ورغم أنّ الانطلاق من الانفصال بين الدلالتين له عيوبه المنهجية، وكذلك فإنّ الانطلاق من فرضية تطوّر حتمي من المعنى الإسكاتولوجي للمعنى التاريخي في ضوء تطوّر التصوّرات حول المعجزات النبوية أو حول عجائبية الإسلام المبكّر كما نجد في دراسات روبين كثيرًا ما لا ينضبط مع نتائج البحث الدقيق التطبيقي على تفاسير بعض الآيات[82] إلا أنّ هذا المسار في البحث يتنامى بشكلٍ واضح ويستفيد بصورة كبيرة من المكتشفات الكتابية.
وفي المجمل تبدو مساحة دراسة التفسير من أكثر المساحات تأثرًا بالاهتزاز المنهجي والنظري الذي أصاب حقل الاستشراق، حيث إننا نجد بكلّ وضوح محاولات حثيثة للخروج عن الأطر النظرية والمنهجية الكلاسيكية في التعامل مع التفسير، ورغبة في إعادة بناء هذه الدراسة في آفاق منهجية أوسع، حيث نجد عددًا كبيرًا من الكتب والبحوث التي تفترض طرقًا جديدة لتحقيب التفاسير التراثية والمعاصرة، حيث نجد اتجاهًا في دراسة التفسير التراثي للخروج من الانحصار في التفاسير السنّية بالتوسّع في دراسة التفاسير الشيعية والصوفية، واتجاهًا في دراسة التفسير المعاصر للخروج من الانحصار تفاسير مصر وتركيا والهند، بالتوسّع في دراسة التفاسير في الصين وإفريقيا وإيران[83]، كذلك نجد اهتمامًا بالقضايا النظرية المتعلقة بتحقيب التفاسير خصوصًا التراثية، كما نجد لدى بعض الباحثين مثل وليد صالح ويوهانا بينك وأندرياس جورك وبيتر كوبينز وغيرهم محاولةً للخروج من اللفظ الموروث للمدونات الكلاسيكية، أو النظر الموروث للمدونات ما بعد الكلاسيكية (الوسيطة) باعتبارها مجرد تكرار، في محاولة لفهم أوسع لتاريخ التفسير[84]!
وربما هذا الاهتزاز وهذا التحرّر المنهجي هو ما يجعل هذه المساحة هي أكثر المساحات التي تُبرِز تشغيلًا للمنهجيات الاجتماعية والأنثروبولوجية، وهو ما نتج عنه اشتغال على مساحات أوسع من التفسير المكتوب، حيث تتنامى تلك الدراسات والتصنيفات التي تدرس التفسير الشفهي وأنماط الاستدعاء الشعائري والجسدي والجمالي للقرآن كذلك، مما يعني تحوُّلَ مسألة الاهتمام بتلقّي القرآن من كونه تلقيًا تفسيريًّا فقط لكونه تلقيًا أشمل وأوسع، حيث تتم دراسة التفسير بما هو ممارسة أشمل من التفسير كنوع خاص في التأليف أو حقل له حدوده الخاصة[85]، وهو تغيير عميق في بنية الدراسة الاستشراقية حيث يعني هذا الخروجَ ولو قليلًا عن الولع الفيلولوجي بالنصوص الكبرى والذي ميّز هذه الدراسة منذ بداياتها.
يظهر هذا كذلك في دراسة الترجمة، والتي باتت لا تنحصر في دراسة الترجمات الأوروبية والأمريكية الكبرى والخاضعة للقيود الفيلولوجية الحديثة، بل أصبحت هذه الدراسة تشمل الترجمات في العالم الإسلامي غير العربي قبل الحداثة، والترجمات إلى العاميّة، وكذلك الترجمات الأوروبية والأمريكية في بدايات التعرف على الإسلام وقبل تطور الاستشراق كحقل علمي.
إلا أنه، وكما يبدو، ورغم كلّ هذه التغيرات في مساحة الدراسة أو عمقها أو البنية المنهجية لها، إلا أنّ معظم الدراسات الغربية حول التفسير لا تزال تتبنّى هذا الفصل المبدئي بين دراسات القرآن ودراسات التفسير، حيث لا تميل للاهتمام بالتفسير كجزء من فهم معنى النصّ، وحين تضم هذه المساحة كأحد أبعاد النصّ، فإن هذا يكون بشكل تأطيري يفتقد الدقة والعمق[86]، ولا يحضر هذا الاهتمام بالتفسير كجزء من فهم دلالة النصّ إلا بشكلٍ قليل في بعض الدراسات التي كما أسلفنا تقارن بين بعض الدلالات الحاضرة في كتب التفسير والدلالة المُحصَّلة عبر تسييق النصّ في تاريخ مدونات الشرق الأدنى بشكل غالبًا ما يميل لإدانة التفاسير التقليدية التي لا تتفق مع هذه الدلالة باعتبارها تزييفًا متأخرًا يعود لأسباب (غير تفسيرية)، مما يعني استمرار تجاهل إمكان الاستفادة من هذه التفاسير على مستوى كشف المعنى، وتجاهل دراسة عملية بناء/ كشف المعنى داخل هذه التفاسير.
الدراسات القرآنية الغربية في السياق المعاصر
ما قبل القرآن | القرآن | العالم الذي يخلقه القرآن أمامه | |
سياق القرآن | تاريخ القرآن | ||
1. البحث عن (النصّ الأصلي) و(أصل النصّ). 2. النصّ و(النصّ الضمني) والحوار مع المجتمعات الدينية للشرق الأدنى القديم. | 1. الاتجاه التنقيحي. 2. إعادة بناء المصادر الإسلامية. 3. دراسة المخطوطات. 4. الدراسة المفاهيمية لعملية جمع النص في نسخة قياسية معتمدة/ مصحف إمام. | - الاتجاهات التزامنية: 1. الاتجاهات البنيوية العامة. 2. الاتجاهات ذات الصلة بالكتاب المقدس. | 1. التفسير المبكّر. 2. التفسير والكتاب المقدس. 3. توسّع دراسة التفاسير والترجمات مساحةً وعمقًا. 4. مساحات جديدة للاهتمام (التلقي الجمالي والأدبي والشعائري). |
الدراسات الغربية الكلاسيكية والمعاصرة، رؤية لطبيعة التغير:
يرى شتيفان فيلد في مقدّمة كتابه (القرآن كنصّ)، أن ثمة تغييرًا حاسمًا قد حدث في الدراسات الغربية المعاصرة للقرآن في العقود الأخيرة، يبرُز في كون هذه الدراسات (ومع انتقالها من الاهتمام المركزي بتاريخ النصّ إلى الاهتمام بالنصّ نفسه كما هو معطى) قد باتت أكثر اقترابًا من الرؤية التي يُقدِّمها الباحثون المسلمون[87]، إلا أنّ هذا لا يبدو دقيقًا، حتى داخل كتاب فيلد نفسه، فكما يُعبِّر ماديغان في عرضه للكتاب، فإنّ الدراسة التاريخية والتسييقية للنصّ -والتي تُمثِّل خصيصة استشراقية مُستهجَنَة لدى الباحثين المسلمين- ظلّت قائمة ومركزية حتى داخل كتاب فيلد نفسه بدراسات باحثين لا تزال هذه المساحة هي محور اشتغالهم[88]، كذلك فإنّ حديث فيلد يأتي وكأنه يُهْمِل طبيعة وأسباب التغيّر في هذه الدراسات، فيبدو وكأنه يُقدِّم في المقابل عملية إسقاط تاريخي، حيث يقرأ السياق الحالي والذي ينفتح فيه كثير من الباحثين على النتاج الغربي لتنوّعه واتساعه وعدم اقتصاره على مساحة تاريخ النصّ، على فترة ظهور هذا التحوّل وأسبابه وطبيعته ومداه كذلك.
في ذات السياق يرى زاده أن الدراسات القرآنية الغربية تمرّ بمنعطف حاسم في دراسة العلاقة بين القرآن والكتب السابقة، تتمثَّل في تجاوز لغة السرقة والاقتراض إلى استكشاف العلاقات الأكثر تعقيدًا بين النصوص والمجتمعات الدينية، ونستطيع كذلك توجيه نقدٍ لزاده شبيهًا بنقدِ ماديغان لفيلد، حيث وكما حاولنا أن نوضح فإننا نجد بعض الكتابات التي لا تزال تشتغل داخل رؤية شبيهة بالرؤية الكلاسيكية، بل أحيانًا تفوقها في نزع أصالة القرآن، سواءٌ بنزع القرآن عن سياقه مكانًا وزمانًا، أو بتصوّر وجود نصّ أصلي سابق على القرآن، أو بربط النصّ بشكل شبيه بالدرس الكلاسيكي ببعض النصوص السابقة.
ونظنّ أن هذه الإطلاقات في تغيُّر نمط الدراسة الغربية على مستوى موضوع الدراسة أو على مستوى مقاربة إحدى المساحات يظلّ غير دقيق وغير قادر على تصور وضع الدراسات القرآنية الغربية المعاصر بدِقّة، حيث يتميّز هذا الوضع بنوعٍ كبيرٍ من التنوّع والاتساع وأحيانًا بالتعارض في تناول كلّ مساحة من مساحات درس القرآن كما حاولنا أن نصف داخل هذا المقال، كذلك فإن محاولة تنظيم تنوّع هذا الفضاء تستطيع أن تُخْرِجنا من الإطلاقات اليائسة كذلك عن وضع هذا الحقل، كتلك التي نجدها في كتابات كرون أو حتى نويفرت حول فوضى هذا الحقل[89] مقارنةً بسلفه الكلاسيكي.
فالنظر لهذا الحقل وَفق الخطاطة الثلاثية (ما قبل النصّ، النصّ، ما يخلقه النصّ أمامه)، وباستحضار طبيعة التغيرات المنهجية والمصدرية التي حدثت منذ السبعينيات، يُبْرِز لنا كون كلّ مساحة من هذه المساحات باتت تشمل أكثر من طريق للبحث، يمكن النظر لهم كاستجابةٍ حينًا أو كردّ حينًا آخر على الأثر الذي تركته هذه التغيرات على بنية هذا الحقل، وتقترب هذ الطرق وتبتعد عن السياق الكلاسيكي في دراسة القرآن، فلا تُمَثِّل انقلابًا تامًّا عليه ولا تمثِّل كذلك مجرّد امتداد خطّي له، بل تُبْرِز العلاقة معه قدرًا لا يمكن تجاهله من التعقيد، مما يجعلنا بهذا نستطيع تكوين صورة أكثر شمولًا واتساعًا وتنوعًا لطبيعته المعاصرة.
وبالطبع فإنّ تطوُّر حقلٍ معرفي لا يمكن قصره على مساحة التغيّرات المعرفية في المصادر والمناهج، حيث يُشكِّل هذا الحقل جزءًا من خطاب أوسع -بالمعنى الفوكوي «نظام اجتماعي مرتبط بالتاريخ ينتج المعرفة والمعنى»-، وحيث يرتبط كذلك بسياقات سياسية واجتماعية بل وديموغرافية تؤثِّر في بنيته وفي طبيعته -على سبيل المثال يذكر ستيورات أن تزايد الاهتمام بالتفسير والذي نلاحظه في تزايد المصنفات المهتمة به في العقود الأخيرة بدأ بالأساس في محاولة إيجاد نمط من دراسة الإسلام أقل مصادمة، من أجل تطوير الحوار المسيحي الإسلامي-، إلا أنّ دراسة الجانب المعرفي تُبرِز بقدر كبير عملية التطوّر ضمن سياق الأسئلة المعرفية والأجوبة المطروحة والطرق المنهجية لإجاباتها.
فمحاولتنا في هذا المقال تظلّ تتعلّق بكيف يمكن النظر بصورة أكثر دِقّة للشكل المعاصر من الدراسات الغربية، كخطوة نحو تأريخ منهجي لهذا الحقل.
خاتمة:
حاولنا في هذا المقال إلقاء الضوء على الشكل المعاصر للدراسات الغربية للقرآن للوقوف على الطبيعة الخاصة لهذا الحقل في صورته المعاصرة، فبدأنا بتناول التغيرات النظرية والمنهجية في سبعينيات القرن الماضي، تلك الفترة التي يعتبرها الكثيرون أساسًا لانعطاف الدراسات الغربية ونشأة الحقل بصورته المعاصرة، فوضّحنا التغيّرات في المصادر والمناهج ضمن هذه الفترة، وأثر هذا على حقل الدراسات القرآنية الغربية والذي تمظهر في ظهور نقد كلّي وجذري للحقل أدّى إلى إعادة تأسيس الحقل ذاته، كما أدى لظهور منهجيات جديدة في قراءة النصّ، وكذلك إلى تغيّر في طبيعة دراسة مساحات القرآن الثلاث، وحاولنا توضيح الشكل الذي أضحت عليه هذه الدراسات والذي يُبرِز كونها لا تمثّل استمرارًا خطيًّا للدراسات الكلاسيكية، كما أنها لا تمثّل كذلك قطعًا تامًّا مع هذه الدراسات.
[1] نشيرهنا على سبيل المثال إلى دراسة السيد ولد أباه حول التأويلية القرآنية، حيث اعتبر أن الدراسات القرآنية في الغرب تتمحور حول مسلكين كبيرين: الاتجاه النقدي- التاريخي والاتجاه البلاغي- الأدبي، أوّلهما يُشكِّل امتدادًا للمشروع الفيلولوجي الاستشراقي في تطبيق مناهج نقد النصّ التي طُبِّقَت على النصّ المقدس اليهودي- المسيحي، وثانيهما يندرج في سياق المنهجيات اللسانية والسيمولوجية الجديدة في تحليل الخطاب والنصّ، وهذا التوصيف يُغيِّب الكثير من الاتساع والتداخل والتنوع الذي تشهده هذه الدراسات كما سنوضِّح. انظر: التأويلية القرآنية: الإشكاليات المنهجية (حصيلة أولية)، عبد الله السيد ولد أباه، ضمن مجلة (التأويل)، العدد 2، يونيو 2015، الرابطة المحمدية للعلماء، المغرب، ص162.
[2] انظر: أشكال الفهم الأكاديمي المعاصر لتماسك النصّ القرآني، أندرو ريبين، ترجمة: إسلام أحمد، موقع تفسير. وانظر: الكتاب المقدس والقرآن، نسق أدبي واحد، ميشيل كويبرس، ترجمة: عبير عدلي، موقع تفسير، ص11، 12. وانظر: ثلاث محاضرات حول القرآن؛ المحاضرة الأولى: تاريخ القرآن، لماذا لا نحرز تقدمًا؟ شتيفان فيلد، ترجمة: د/ حسام صبري، موقع تفسير، ص15.
[3] يُحقِّب ديفين ستيوارت تاريخ الدراسات الغربية للقرآن إلى خمس حِقَب، ويعتبر أن الحقبة الرابعة والتي تلت الحقبة الثالثة (الكلاسيكية)، تمتد منذ الحرب العالمية الثانية إلى نهايات القرن العشرين، ثم تبدأ الحِقبَة الخامسة مع نهايات القرن وحتى السياق الحالي، ويعتبر أن الحِقبَة الرابعة (منذ نهاية الحرب العالمية إلى قرب نهاية القرن العشرين) مثَّلت ركودًا في مسار هذه الدراسات، ثم تم استعادة حيوية هذا الحقل في الحِقْبَة الخامسة، ويتجاهل ستيوارت كون كثير من المنهجيات المعاصرة والدراسات ذات التأثير في طبيعة الحقبة المعاصرة لم تنشأ في نهايات القرن بل نشأت قبلها بعقود، فكتابات وانسبرو ولولينغ وأنجيليكا نويفرت وكذلك الدراسات الأدبية للقرآن كانت قد بدأت بالفعل منذ نهاية الستينيات وبداية السبعينيات، مما يعني أن السياق الحالي هو نتاج لهذه المرحلة التي لا يمكن اعتبارها جزءًا من مرحلة الركود. انظر: Reflections on the State of the Art in Western Qurʾanic Studies, Devin Stewart، منشورة ضمن كتاب Islam and its Past: Jahiliyya, Late Antiquity, and the Qur'an, Carol Bakhos (ed.), Michael Cook (ed.), Oxford University Press, 2017, p: 6-8, 14-17
[4] يُعطى هذا الاكتشاف أهمية كبيرة ضمن الاهتمام برصد التحوّل في الدراسات القرآنية، ويرجع هذا للأهمية الكبيرة المعطاة ضمن هذا الدرس لمسألة إيجاد نسخة نقدية من النصّ، وإرجاع كثير من ضعف الحقل في مقارنته بحقل الدراسات الكتابية إلى عدم وجود نسخة نقدية من القرآن. انظر: القرآن: مقاربات جديدة، مهدي عزيّز، ترجمة: عبد العزيز بومسهولي، ألباب، العدد (6)، ص35، 36، وانظر: Reflections on the History and Evolution of Western Study of the Qur’ān, from ca. 1900 to the Present,FRED M. DONNER، ضمن كتاب TRENDS AND ISSUES IN QUR’ANIC STUDIES, Munʾim Sirry, editor, Lockwood Press, Atlanta, Georgia, 2019, p: 29
[5] يختلف الباحثون في تحديد أصحاب مخطوطات قمران، لكن معظمهم يميلون لرأي فيرمس بكونها تخصّ الطائفة الدينية التي كانت تدعى بالأسينيين، إلا أنّ كون حدود هذه الطائفة الدينية هي ذاتها محلّ جدل كبير بين الباحثين، حيث تتعارض بعض النتائج الواردة عن تحليل مخطوطات قمران مع الملامح التي حدّدها المؤرخون الرومان مثل يوسفيوس وبليني وفيلون لهذه الجماعة الدينية، خصوصًا مسألة الموقف من الحرب ومن النساء، قد أدى لتشعّبٍ في الآراء حول العلاقة بين المخطوطات والأسينيين، فقد مال بعضهم إلى اعتبار أنّ جماعة الأسينيين هي فضاء ديني أوسع من تحديدات المؤرّخين القدامى، حيث تمثّل جماعة أكثر انتشارًا واتساعًا، وبالتالي رأَى ألرجو أن مخطوطات قمران تخصّ أحد أفرع هذه الحركة الواسعة فحَسْب، في حين رأَى بعضهم الآخر مثل وايزنمان ومايكل وايز أن هذه اللفائف ربما لا تخصّ الأسينيين من الأساس، ورأَى ويلسون أنها ربما تخصّ المسيحية المبكّرة. ويعود هذا الاختلاف في الآراء عن مَن هُم أصحاب مخطوطات قمران لعدّة أسباب، فإلى جانب وجود بعض الاختلافات بين توصيف المؤرِّخين القدامى للأسينيين ومحتوى المخطوطات، وكذلك وجود بعض هذه المخطوطات لدى مجموعات أخرى غير الأسينيين مثل الغيورين «شهداء ماسادا»، فإنّ ثمة خلافات في تفسير المقصود بـ«الأسينيين» وفي فهم مجموعة المصطلحات القريبة منها مثل النصارى (المحافظون على العهد) وكذلك تحديد كون الكلمة آرامية أو يونانية أو عبرية، حيث يغير هذا معناها مما قد يربطها ببعض الجماعات الأخرى مثل «المعالجين» -وهي طائفة يهودية أخرى في نظر بعضهم، أو ربما أحد أفرع الأسينيين في نظر آخرين-، ويرتبط كلّ هذا الخلاف بالخلاف في تحديد طبيعة المجتمعات الدينية لهذه الفترة والعلاقة بين هذه الجماعات ومعنى انتماء الفرد إلى إحداها. للتوسع انظر: الطوائف اليهودية في زمن كتابة العهد الجديد، راندال إيه. وايس، ترجمة: د. عادل زكري، مدرسة الإسكندرية، ط3، القاهرة، 2019، ص200-206، وانظر: أهل الكهف، مخطوطات البحر الميت، هالة العوري، رؤية، ط1، القاهرة، 2021، ص 33-41، 55-61، 70، 71، 74075 ، وانظر: مقدمة كتاب، التوراة، كتابات ما بين العهدين، مخطوطات قمران- البحر الميت، 1، الكتب الأسينية، حُقق بإشراف: أندريه دوبون- سومر ومارك فيلوننكو، ترجمة: موسى ديب الخوري، دار الطليعة الجديدة، ط1، سوريا، 1998.
[6] كما يرى إلياد فإنّ هذا العصر -أي القرن التاسع عشر- سيطر عليه ما أسماه بـ«الحنين للأصول» أي سيطرة النزعات الباحثة عن تفسير كلّ الظواهر بردّها إلى أصل تاريخي سابق يفسِّرها ويمنحها معنى ويكشف عن دورها ووظيفتها، على كلّ مساحات الدرس التاريخية واللغوية والأنثروبولوجية والنفسية والطبيعية لهذه الفترة، انظر: البحث عن التاريخ والمعنى في الدين، مرسيا إلياد، ترجمة: سعود المولى، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، ط1، 2007، ص115، 116
[7] انظر: تاريخ القرآن: لماذا لا نحرز تقدمًا؟ شتيفان فيلد، ترجمة: د/ حسام صبري، موقع تفسير، ص21.
[8] كانت الدراسات الكلاسيكية منقسمة حول سؤال أي التقاليد أكثر تأثيرًا في القرآن، اليهودية أم المسيحية، ويُلاحَظ أن الاهتمام بالجانب الشفهي كان غالبًا على أصحاب الرؤية التي تُغلِّب التأثير المسيحي مثل تيسدال، حيث يُعَدّ الأثر الأكبر وفقًا له على الإسلام نابعًا من الإرساليات التبشيرية المسيحية أو حتى من العلاقة بين النبي ومارية القبطية، في السياق المعاصر أصبح الاهتمام الأكبر بالجانب الليتورجي والشفهي ضمن رؤية أوسع تعتبر أن الكتب المقدسة في الشرق الأدنى القديم المتأخر كانت تحضر بأشكال مُتّسعة من التفسير وإعادة التفسير والتي لا تقتصر على المدونات المكتوبة. انظر: المصادر الأصلية للقرآن، سان كلير تيسدال، ترجمة: عادل جاسم، منشورات الجمل، ط1، بغداد- بيروت، 2019، ص116-120، 144، 145.
[9] انظر: تاريخ القرآن: لماذا لا نحرز تقدمًا؟ شتيفان فيلد، ترجمة: د/ حسام صبري، موقع تفسير، ص18، 19، 20.
[10] أشكال الفهم الأكاديمي المعاصر لتماسك النصّ القرآني، أندرو ريبين، ترجمة: إسلام أحمد، موقع تفسير.
[11] انظر: جاذبية الإسلام، ماكسيم رودنسون، ترجمة: إلياس مرقص، دار التنوير، القاهرة، ص79، 80، 85.
[12] الاستشراق في الدراسات الإسلامية، الدراسات القرآنية نموذجًا، أنجيليكا نويفرت، ترجمة: طارق عثمان، موقع تفسير، ص7، 8.
[13] سيبرز هذا لاحقًا بصورة دقيقة في أعمال أنجيليكا نويفرت ونيل روبنسون وتود لاوسون، راجع على سبيل المثال: مريم وعيسى، موازنة الآباء التوراتيين، قراءة جديدة لسورة مريم في ضوء سورة آل عمران، أنجيليكا نويفرت، ترجمة: د/ حسام صبري، موقع تفسير،الثنائية والتقابل والتيبولوجي في القرآن من منطلق رؤيوي، تود لاوسون، ترجمة: د/ حسام صبري، موقع تفسير.
[14] متى أصبح القرآن نصًّا مغلقًا؟ نيكولاي سيناي، ترجمة: د/ حسام صبري، ضمن ترجمات ملف (مخطوطات القرآن في الدراسات الغربية المعاصرة)، موقع تفسير، ص16.
[15] انظر: السيرة النبوية، مناهج، نصوص وشروح، حياة عمامو، التنوير، بيروت، ط1، 2014، المحور الأول: السيرة النبوية بين المصنفين القدامى والدارسين المحدَثين، ص51 وما بعدها.
[16] ويطبق وانسبرو هنا ذات المنهج الذي طبقه بولتمان على الأناجيل في عشرينيات القرن الماضي.
[17] القرآن في أحدث البحوث الأكاديمية، تحديات وأمنيات، فرد دونر، ضمن كتاب (القرآن في محيطه التاريخي)، تحرير: جبريل سعيد رينولدز، ترجمة: سعد الله السعدي، منشورات الجمل، بيروت- بغداد، ط1، 2012، ص95.
[18] انظر: عرض كتاب (البدايات المبهمة للإسلام)، جيرالد هوتنج، ترجمة: هند مسعد، ضمن ملف (الاتجاه التنقيحي)، موقع تفسير.
[19] مسألة لفظ المصادر العربية بدعوى أنها تمثّل تاريخ خلاص، واللجوء بدلًا عن هذا لمصادر غير عربية، يخضع لنقد كبير حتى من الباحثين التنقيحيين مثل بريمار، حيث يرى بريمار أن المصادر غير العربية المسيحية واليهودية يحضر ضمن أهداف كتابها بناء سردية خلاص كذلك، بل نستطيع القول أنّ هذا مؤثر فيها بصورة أكبر بكثير من المصادر العربية الإسلامية، وهذا لأنّ حدث ظهور الإسلام نفسه مثّل إشكالًا لاهوتيًّا يبحث عن تفسير بالنسبة للمتدينين بالكتب السابقة، مما جعل تفسير ظهورهم بل وانتصارهم يتمّ من خلال دمجهم تأويليًّا ضمن السردية الكتابية، -كما يظهر من دراسات جودون نيكل لدور الفتوحات في الكاريجما الإسلامي-، كذلك يرى بريمار أنه من الصعب اختزال أهداف كتابة المصادر العربية على هدف بناء سردية خلاص، فالرغبة في بناء تاريخ دقيق لهذه الفترة حضر كأحد الأهداف الرئيسة لهذه الكتابات وَفق بريمار، كذلك فإنّ مسألة تفوّق التأريخ الغربي قبل الحديث على التأريخ العربي ورغم تحرك العمليتين ضمن نفس التصور تقريبًا للزمان الدائري لا الخطّي، يبرز تحيزًا واضحًا ضد التأريخ العربي بالذات كما يرى تريو. انظر: تأسيس الإسلام بين الكتابة والتاريخ، لويس دى بريمار، ترجمة: عيسى محاسبي، دار الساقي، ط1، بيروت، 2009، ص26، وانظر: القوة في القصة، ميشيل تريو، ضمن كتاب (كيف نقرأ العالم العربي اليوم؟ رؤى بديلة في العلوم الاجتماعية)، ترجمة: شريف يونس، دار العين، مصر، ط1، 2013.
[20] الدراسات القرآنية ومسائلها الخلافية، جبرئيل سعيد رينولدز دونر، ضمن كتاب (القرآن في محيطه التاريخي)، تحرير: جبرئيل سعيد رينولدز، ترجمة: سعد الله السعدي، منشورات الجمل، بيروت- بغداد، ط1، 2012، ص29.
[21] جمع القرآن، إعادة لتقييم المقاربات الغربية في ضوء التطورات المنهجية الحديثة، هارالد موتسكي، ترجمة: مصطفى هندي، ضمن ترجمات ملف (مخطوطات القرآن في الدراسات الغربية المعاصرة)، موقع تفسير، ص17.
[22] تحرير القرآن، أو الإيمان في زمن المراجعين، منشورة ضمن كتاب (الإيمان الحر، أو ما بعد المِلّة، مباحث في فلسفة الدين)، فتحي المسكيني، مؤمنون بلا حدود، بيروت، ط1، 2018، ص440.
[23] انظر: موضعة القرآن في الفضاء المعرفي للعصور الكلاسيكية المتأخرة، أنجليكا نويفرت، ترجمة: أمنية أبو بكر، موقع تفسير.
[24] لعلّ عملية دمج القرآن داخل الدراسات الكتابية، ومع ذلك الإصرار على عملية العزل الاستشراقية الكلاسيكية للقرآن عن سياق تلقيه كأنه نصّ أحفوري يخصّ أمة منقرضة، هو ما حدا بالمسكيني لاعتبار أن اشتغال بعض الباحثين المعاصرين الذين يصرّون على هذا الدمج، هو بصورة ما شكل أكثر لطفًا ودبلوماسية لذات التعامل الاستشراقي مع القرآن أكثر من كونه تغييرًا حقيقيًّا خضعت له الدراسة المعاصرة. انظر: تحرير القرآن، أو الإيمان في زمن المراجعين، منشورة ضمن كتاب (الإيمان الحر، أو ما بعد المِلّة، مباحث في فلسفة الدين)، فتحي المسكيني، مؤمنون بلا حدود، بيروت، ط1، 2018، ص440.
[25] يربط فرد دونر بين نشأة القراءة الأدبية للقرآن وبين تزايد الفروض التنقيحية منذ السبعينيات، ويضع تطور هذه القراءة بالفعل ضمن هذا المنعطف، لكنه لا يقدم تفسيرًا واضحًا لهذا الارتباط بين القراءة الأدبية وبين نشأة التشكيك في السردية الإسلامية والمصادر الإسلامية، بل يعتبرها وكأنها ناتجة كردّ فعل تجاه الرؤى التي تُفتِّت النصّ والتي تزايدت مع الفروض التنقيحية، ونظنّ أن الجدل بين التنقيحيين وروّاد الاتجاه التزامني كما نجده عند نويفرت أو كويبرس حول تماسك النصّ هو جدل لاحق على تبلور الاتجاهين بالفعل؛ لذا فإن تفسير هذه النشأة للاتجاه الأدبي بمقاومة الرؤى القائلة بشذرية النصّ هو إسقاط لجدل لاحق على مرحلة نشأة هذه الاتجاهات، ونظن أن العلاقة الدقيقة التي تربط الدراسة البنيوية للقرآن بالاتجاه التنقيحي، هي أن القراءة الأدبية البنيوية تُمثِّل في عمقها اتفاقًا مع الفرضية التنقيحية ومع التشكيك في المصادر الإسلامية، حيث مثَّلت قراءة القرآن بنيويًا مضاعفة لعملية عزل القرآن في الدرس الغربي عن التقليد الإسلامي التفسيري، ولعل هذا يتضح في اللفظ أو الرفض للتفسير من قِبَل رواد هذا الاتجاه، كذلك فإن الجدل بين التيارين لاحقًا والذي يشير له دونر، يتعلّق بمسألة أعمق من الدفاع عن تماسك النصّ، حيث يتعلّق بمسألة البناء المنهجي للاستشراق كما يراه بعض هؤلاء المنتقدين، فكما أوضحت نويفرت مِرارًا فإن رواد الاتجاه التنقيحي يتجاهلون في قراءتهم القرآن كون القراءة الفيلولوجية الأدبية هي إحدى دعامات الدراسة الغربية القرآن.
انظر:Reflections on the History and Evolution of Western Study of the Qur’ān, from ca. 1900 to the Present, FRED M. DONNER، ضمن كتاب TRENDS AND ISSUES IN QUR’ANIC STUDIES, Munʾim Sirry, editor, Lockwood Press, Atlanta, Georgia, 2019, p: 38..
[26] الدراسات القرآنية والمنعطف الأدبي، ترافيس زاده، ترجمة: هدى عبد الرحمن النمر، موقع تفسير.
[27] سواء كان الحديث عن الإسلام بمعنى الدين أو الإسلام بمعنى السياق التاريخي أو سياق التجربة التاريخية الإسلامية، وبالطبع فإنّ ثمة جدلًا معاصرًا طويلًا حول مدى إمكان استخدام مصطلح إسلام في وصف التجربة التاريخية، وكذلك جدلًا حول إمكان الفصل بين الإسلام كدين والإسلام كتجربة تاريخية، وكيف يمكن أن يتم هذا الفصل وبأيّ طريقة، وقد اقترح كثير من الدارسين كثيرًا من التفريقات لوصف هذه العلاقة، أشهرها تقسيم هودنجسون بين الإسلام والإسلاماتي، وفي ذات السياق طرح شهاب أحمد تصوره عن تعريف للإسلام يستطيع شمول تركيبيته وتعددية ودينامية تجربته التاريخية، للتوسع: راجع: ما الإسلام؟ في مغزى أن تكون منتميًا إلى الإسلام، شهاب أحمد، ترجمة: بدر الدين مصطفى، محمد عثمان خليفة، مؤمنون بلا حدود، ط1، بيروت، 2020.
[28] انظر: ثلاث محاضرات حول القرآن، المحاضرة الأولى: تاريخ القرآن، لماذا لا نحرز تقدمًا؟ شتيفان فيلد، ترجمة: د/ حسام صبري، موقع تفسير، ص15.
[29] عالم ما قبل النصّ: وينقسم لقسمين؛ 1) دراسة السياق التاريخي للقرآن بموضعة النصّ ضمن فضاء الشرق الأدنى القديم المتأخر الديني والنصِّي (ويدخل فيه سياق الجزيرة العربية). 2) دراسة تشكُّل النصّ، منذ كان مجموعة من البلاغات الشفهية ضمن تاريخ الدعوة، إلى أن دُوِّن ثم جُمِع في «مصحف إمام»/ نسخةٍ قياسية معتمدة ذات سلطة، فهو يشمل المساحتين الأولى والثانية عند فضل الرحمن وإن كان بمفاهيم أكثر تعقيدًا تناسب تعقُّد طبيعة دراسة هاتين المساحتين في السياق المعاصر.
عالم النصّ، يدرس النصّ موضوعيًّا وتركيبيًّا وأسلوبيًّا ويدرس لغته وطبيعتها، وطبيعته النصّية، والوحدات النصية الأدنى التي يتشكَّل منها، والعلاقات بين هذه الوحدات.
وثمة مساحة مشتركة بين هاتين المساحتين هي دراسة مسألة (إعلان سلطة النص canonization)، فلا يمكن فهم هذه المساحة بالوقوف عند حدود دراسة العملية التاريخية للتدوين والجمع، حيث تتعلَّق في جانب مركزي منها ببعد مفاهيمي مرتبط ببناء النصّ ومفرداته حول ذاته (مفردات المرجعية الذاتية)، (القرآن- البيان- الذِّكْر- اللوح المحفوظ...)، وتشترك دراستها مع دراسة تاريخ طويل لمفهوم (النصّ المقدس scripture) ضمن الأديان الكتابية، مما يعني أنها لها بعدٌ مفاهيمي ونصي وديني.
العالم الذي يخلقه النصّ أمامه، ونقصد به (العالم الديني) المخلوق أمام النصّ كأعمق دلالة لأفق النصّ أو (شيء النصّ اللا محدود) بتعبيرات ريكور، ويتضمن هذا العالم كذلك مجمل المعاني المُنتجة سابقًا حول القرآن، والترجمات الإسلامية للقرآن قبل الحداثة، والترجمات الغربية للقرآن بعدها، والتفاسير الشفهية، ومجمل أنماط التلقي للقرآن الجمالية والجسدية والشعائرية.
[30] في تقديم كتاب (القرآن، مقاربات جديدة) يقسم عزيّز المقاربات المعاصرة ضمن منظور ثلاثي يضم: تاريخ النصّ وتدوينه، السياق التاريخي للقرآن، دراسة البنية الأدبية للقرآن. انظر: القرآن: القرآن، مقاربات جديدة، مهدي عزيّز، ترجمة: عبد العزيز بومسهولي، ألباب، العدد (6)، ص47، 48، 49.
[31] TRENDS AND ISSUES IN QUR’ANIC STUDIES, Munʾim Sirry, editor, Lockwood Press, Atlanta, Georgia, 2019, p: 2
[32] ثلاث محاضرات حول القرآن، المحاضرة الأولى: تاريخ القرآن، لماذا لا نحرز تقدمًا؟ ترجمة: د/ حسام صبري، موقع تفسير، ص17.
[33] انظر: القرآن في أحدث البحوث الأكاديمية: تحديات وأمنيات، فرد دونر، ضمن كتاب (القرآن في محيطه التاريخي)، تحرير: جبريل سعيد رينولدز، ترجمة: سعد الله السعدي، دار الجمل، كولونيا (ألمانيا)، بغداد، ط1، 2012، ص73.
[34] انظر: عرض كتاب (قراءة آرامية سريانية للقرآن، المساهمة في فك شفرة لغة القرآن)، فرنسوا دي بلوا، ترجمة: هدى عبد الرحمن النمر، ضمن ترجمات ملف (الاتجاه التنقيحي)، موقع تفسير.
[35] يميل بعض الباحثين المعاصرين لافتراض وجود نسخة مكتوبة من القرآن (أصل عثماني مكتوب) هي التي مثّلَت أساس عملية نسخ المصاحف، وقد أبرز بوتين أدلة مقنعة على هذا بدراسته لخواص الرسم المشتركة في المصاحف المبكرة. انظر: خواص الرسم المشتركة في مخطوطات المصاحف المبكرة، برهان على أصل علمي مكتوب، ماراين فان بوتين، ترجمة: د/ حسام صبري، ضمن ملف (مخطوطات القرآن في الدراسات الغربية المعاصرة)، موقع تفسير.
[36] لا شك أن فكرة كشف الحجب، هي فكرة استشراقية كلاسيكية تمامًا، بل هي تعود لما قبل تكوّن الاستشراق كحقل علمي، وترتبط بشكل أوسع بالرؤية الغربية للشرق ضمن الكتابات الوسيطة والرومانسية، والتي كانت تنظر للشرق كفضاء ساحر محجوب، ويتمظهر هذا الاهتمام بكشف الحجاب في الاهتمام الاستشراقي بالقصر السلطاني كفضاء لتمثيل الشرق، حيث حضر بشكلٍ كبيرٍ في المسرحيات الوسيطة والرومانسية، حيث المسرح ذاته يشكّل بستائره تمثيلًا لغموض الشرق المراد اكتشافه، وهذه الصورة في النظر للشرق والتي تسبق مرحلة (الموضعة) و(التمثيل) التي ظهرت مع الاستشراق كحقل علمي، ظلّت مؤثرة في هذه الفترة كذلك، حيث ظهرت في لوحات المستشرقين المموضعة للشرق كأنثى مراقبة يتم كشف غموضها/ حجابها، ونخاطِر بالقول بأنّ البحث عن قرآن أصلي محتجب هو في أحد أبعاده صورة من صور استمرار هذا التصور.
[37] يهتم البدوي في دراساته بذكر الرؤى الكلاسيكية والمعاصرة لمسألة علاقة اللغة العربية بالسريانية وحضور الثقافة الآرامية والسريانية في محيط الجزيرة، فيتعرض لآراء نولدكه جيفري وفلورز وغريفث وغيرهم. انظر: الإدانة في القرآن وإنجيل متّى السرياني، عمران البدوي، ترجمة: أمنية أبو بكر، موقع تفسير، ص10- 18.
[38] الإدانة في القرآن وإنجيل متّى السرياني، عمران البدوي، ترجمة: أمنية أبو بكر، موقع تفسير، ص25.
[39] كما يلاحظ أوليفر ليمان فإن المدونات السابقة على القرآن وبسبب كثرتها وتشعبها وتشابه بعض مساحاتها -خصوصًا مع إعادة التفسير والبناء والدمج كخصيصة معرفية للعصور القديمة المتأخرة- فإنّ عملية ربطها بالقرآن تفقد أحيانًا أيّ تماسك ممكن، حيث يمكن مقارنة أيّ آية بالقرآن بأيّ موضع ضمن هذا التراث الشاسع، وإن لم يمكن سنعتبر هذا -وكما يقول- قراءة مجازية من القرآن لإحدى هذه المساحات كذلك. انظر: عرض كتاب: القرآن والكتاب المقدس؛ النص التفسير، أوليفر ليمان، ترجمة: هند مسعد، موقع تفسير.
[40]من الممكن الإشارة في هذا السياق لكتاب هولجر زلنتين حول علاقة القرآن بالدسقولية، حيث إننا نجد قراءة للآداب الشرعية في القرآن في ضوء الدسقولية، لكن دون محاولة إثبات أيّ علاقة تأثير خطية واضحة بين النصّيْن، أو بين الجماعات الدينية الإبيونية وبين الإسلام، حيث يعدّ الربط الخطي والأحادي مخاطرة منهجية كانت تشيع في بعض الكتابات الكلاسيكية لكن يتخوّف من السقوط فيها الكثير من المعاصرين بسبب الإدراك المعاصر للتعقد التي تنطوي عليه الصلات بين الجماعات والنصوص الدينية لهذه الفترة، وهذا يجعلنا نختلف مع ستيوارت حول توصيف هذا الاتجاه (ما يسميه بالمنطعف السرياني the Syriac turn) والذي يجسده بشكلٍ كبيرٍ كتاب (The Syriac milieu of the Quran : the recasting of biblical narratives) الذي يضمّ بحوث زلنتين والبدوي وسيغوفيا وغيرهم، باعتباره مجرد امتداد للاتجاه الكلاسيكي مع شباير وجايجر. انظر: عرض كتاب الآداب الشرعية في القرآن، الدسقولية كنقطة انطلاق، عمران البدوي، ترجمة: هند مسعد، موقع تفسير، وانظر: Reflections on the State of the Art in Western Qurʾanic Studies, Devin Stewart، منشورة ضمن كتابIslam and its Past: Jahiliyya, Late Antiquity, and the Qur'an, Carol Bakhos (ed.), Michael Cook (ed.), Oxford University Press, 2017, p: 21-22..
[41] لا نتفق مع زاده في بعض الأسماء التي يذكرها باعتبارها ممثلة لهذا النمط الحواري، خصوصًا رينولدز وعمران البدوي، فعمران البدوي ينتمي للتسييق المسيحي السرياني للقرآن، كما يعدّ عمل رينولدز الأكثر بُعْدًا عن الصرامة المنهجية والوقوع في التشذِير وإهدار أصالة النصّ القرآني.
[42]الدراسات القرآنية والمنعطف الأدبي، ترافيس زاده، ترجمة: هدى عبد الرحمن النمر، موقع تفسير.
[43]مفهوم العصور القديمة المتأخرة يعود لبيتر براون في كتابه الشهير عصر البلاغة، وهو مصطلح يصف الفترة ما بين القرن الثاني قبل الميلاد والقرن السادس الميلادي تقريبًا، وتختلف رؤية نويفرت لهذا العصر، حيث لا تنظر له كعصر تاريخي لاحق للعصور القديمة وسابق على العصور الوسيطة، بل يمثّل وَفقًا لها عصرًا معرفيًّا ذا ملامح خاصة. انظر: قراءة القرآن في الفضاء المعرفي للعصور القديمة المتأخرة، أنجيليكا نويفرت، ترجمة: أمنية أبو بكر، موقع تفسير.
[44]نظرتان للتاريخ والمستقبل البشري، الوعود الإلهية في القرآن والكتاب المقدس، أنجيليكا نويفرت، ترجمة: مصطفى هندي، موقع تفسير، ص26، 27.
[45] Quran in context, historical and literary investigation into Quranic milieu, edited by: Angelica neuwirth, Nicolai Sinai, and Michael Marx, pages 10,11,12.
[46] النصّ الضمني هو عبارة عن نصّ يوجد داخل نصّ أوسع ويُشكِّل أحد عناصر بناء هذا النصّ، لكن لا تتم الإشارة لهذا بالضرورة داخل النصّ، ولا يظهر للقارئ مباشرة بل يحتاج لتحليل لاستكشافه.
[47] الدراسات القرآنية والفيلولوجي التاريخي النقدي، انطلاق القرآن من التراث الكتابي وتغلغله فيه وهيمنته عليه، أنجيليكا نويفرت، ترجمة: محمد عبد الفتاح، موقع تفسير، ص21.
[48] الدراسات القرآنية والفيلولوجي التاريخي النقدي، انطلاق القرآن من التراث الكتابي وتغلغله فيه وهيمنته عليه، أنجيليكا نويفرت، ترجمة: محمد عبد الفتاح، موقع تفسير، ص31.
[49] موازنة الآباء التوراتيين، قراءة جديدة لسورة مريم في ضوء سورة آل عمران، أنجيليكا نويفرت، ترجمة: د/ حسام صبري، موقع تفسير.
[50] في كتابها الصادر مؤخرًا (كيف سحر القرآن العالم؟)، تصف نويفرت مفهوم نزع السحر الفيبري في محاولة فهم أحد أبعاد علاقة القرآن بالكتاب المقدس في مكة والمدينة، حيث تَعتبر نويفرت أن القرآن في العهد المكي قام بعملية سحر للمكان والزمان والأمة عبر سحر البيان القرآني وكذلك عبر دمج الأمّة المؤمنة في تاريخ خلاص كتابي يتجسد في استحضار موسى بشكل محوري وكذلك في ربط مكة بالقدس (محور القداسة أو المحور الحرام)، بالصلاة ناحية بيت المقدس، ثم وَفقًا لها قام القرآن بفك هذا السحر جزئيًّا بالتوجه ناحية مكة، وبالاهتمام بصورة أكبر بإبراهيم ومكة في صورة أكثر أرضية وتاريخية تبرز دورهم في الحياة التاريخية للأمّة المؤمنة، راجع: كيف سحر القرآن العالم؟ أنجيليكا نويفرت، ترجمة: صبحي شعيب، دار البحر الأحمر، ط1، القاهرة، ص56، 57.
[51] جمع القرآن، إعادة تقييم المقاربات الغربية في ضوء التطورات المنهجية الحديثة، هارالد موتسكي، ترجمة: مصطفى هندي، موقع تفسير، ص31.
[52] جمع القرآن، إعادة تقييم المقاربات الغربية في ضوء التطورات المنهجية الحديثة، هارالد موتسكي، ترجمة: مصطفى هندي، موقع تفسير، ص33.
[53] انظر: إيلاف قريش، يوري روبين، ضمن كتاب، مكة قبل الإسلام، فريق من الباحثين، ترجمة: هشام شامية، ص217، 245.
[54] جمع القرآن كعمل مدون، هل يمثل براديغم لتدوين الحديث والعلوم الإسلامية، غريغور شولر، ترجمة: مصطفى الفقي، موقع تفسير.
[55] تدوين القرآن، تعليق على أطروحتي وانسبرو وبورتون، غريغور شولر، ترجمة: د/ حسام صبري، موقع تفسير، ص21، 22.
[56] جمع القرآن، إعادة تقييم المقاربات الغربية في ضوء التطورات المنهجية الحديثة، هارالد موتسكي، ترجمة: مصطفى هندي، ص41، 43، 44.
[57] على سبيل المثال ما يذكره موتسكي حول تجاهل وانسبرو لبعض الأدلة التي تناقض نظريته، انظر: تفكيك الاستعمار في الدراسات القرآنية، جوزيف لمبارد، ترجمة: د/ حسام صبري، موقع تفسير، ص13
[58] مصاحف الأمصار، قراءة في المصاحف المنتسخة في صدر الإسلام، ترجمة: مصطفى الفقي، موقع تفسير.
[59] ثلاث محاضرات حول القرآن؛ المحاضرة الأولى: تاريخ القرآن، لماذا لا نحرز تقدمًا؟ ترجمة: د/ حسام صبري، موقع تفسير، ص18.
[60] مصاحف الأمويين، نظرة تاريخية في المخطوطات القرآنية المبكرة، فرنسوا ديروش، ترجمة: د/ حسام صبري، مركز نهوض، ط1، بيروت- لينان، 2023، ص57-58، وفي مقدمة الكتاب يسرد ديروش بشكل سريع تاريخ دراسة المخطوطات في الدراسات القرآنية الغربية.
[61] اهتم كثير من الباحثين المعاصرين بدراسة نقوش قبة الصخرة، حيث افترض بعض التنقيحيين أن نمط الاقتباس الوارد فيها قد يؤكّد افتراضاتهم حول تأخّر إعلان نسخة قياسية ملزمة من النصّ، ونجد اهتمامًا كبيرًا بها لدى بريمار وكروب وإستل ويلان وغيرهم، وعلى خلاف الرؤى التنقيحية فقد حاول بريمار وويلان تقديم تفسيرات مغايرة لنمط الاقتباس في هذه النقوش حيث تعود وَفقًا لهم إلى بعض السياقات السياسية والثقافية والاجتماعية، وترى ويلان أن تحليل النقوش ونمط اقتباسها وكذلك قراءتها في ضوء غيرها من النقوش وتحليل نمط رسمها ونقشها يكشف عن وجود تقليد أقدم من نُسَخ القرآن، كذلك يكشف عن تكرس النسخة القياسية والمعرفة بها في فترة سابقة على النقوش، مما جعلها تعتبرها دليلًا على التدوين المبكّر للنص! راجع: خفايا الإسلام وبداياته، إعادة قراءة في النقوش والمسكوكات، فولكر بوب، ترجمة: هشام شامية، المركز الأكاديمي للأبحاث، ط1، العراق- تورنتو- كندا، 2021، الفصل الثاني: عبد الملك، يسوع هو محمد، وراجع: الشاهد المغفول عنه، دليل على التدوين المبكر للقرآن، إستل ويلان، ترجمة: محمد عبد الفتاح، موقع تفسير.
[62] وقد تطوّر في العقود الأخيرة اهتمام عربي وإسلامي بدراسة المخطوطات القرآنية المبكّرة، يمكن ملاحظته في أعمال بعض الدارسين مثل غانم قدوري الحمد وبشير الحميري وغيرهم، وهذه الدراسات تحاول الاستفادة مما كشفت عنه الدراسات الغربية المعاصرة في إعادة طرح الأسئلة العلمية ضمن علم الرسم والمصاحف التراثية، والدمج بين دراسة المعطيات التي تقدّمها الكتب التراثية حول المصاحف وبين النتائج التي تقدّمها الدراسات المعاصرة.
[63] THE PROBLEMATIC OF PROPHECY ,Reuven Firestone, International Qur’anic Studies Association. 2015, p.7
SCRIPTURAL AUTHORITY IN EARLY JUDAISM, John C. Reeves, p.15- 19
[64] للتوسّع، انظر: حديث القرآن عن ذاته في السور المكية الأولى، آن سيلفي بواليفو، ترجمة: مصطفى أعسو، منشورة على موقع تفسير.
[65] عرض كتاب (القرآن من خلال القرآن: مصطلحات وحجج الخطاب القرآني حول القرآن)، ميشيل كويبرس، ترجمة: أمنية أبو بكر، منشور على موقع تفسير.
[66] انظر: القرآن في أحدث البحوث الأكاديمية، فرد دونر، منشور ضمن، القرآن في محيطه التاريخي، تحرير: جبريل سعيد رينولدز، ترجمة: سعد الله السعدي، منشورات الجمل، بيروت، بغداد، ط1، 2012، ص76.
[67] إعلان سلطة القرآن من خلال القرآن، آن سيلفي بواليفو، ترجمة: مصطفى أعسو، موقع تفسير، ص30، 43.
[68] عرض كتاب، الصورة الذاتية للقرآن، الكتاب الإسلامي المقدس، يامنة مرمر، ترجمة: هدى عبد الرحمن النمر، موقع تفسير.
[69] رغم اهتمام كثير من القراءات العربية المعاصرة ضمن برامجها التأويلية بقضية جمع القرآن وعلاقة الجمع بالسلطة والتأويل، إلا أننا لا نجد أيّ توظيف أو إدراك لهذه المساحة في نقاش هذه المسألة! انظر: الدراسات العربية والغربية المعاصرة حول القرآن الكريم، قراءة في منجز تصنيف الدراسات، وطرح تصنيف جديد، واستكشاف واقع الدراسات، طارق حجي، موقع تفسير، ص50، 51، 52.
[70] يرجع بعض الباحثين نشأة هذا الاتجاه إلى فضل الرحمن مالك في كتابه (المسائل الكبرى في القرآن)، وإيزوتسو في كتابه (الله والإنسان في القرآن)، وفي ظننا يصعب دمج الدراستين ضمن تطور العمل الغربي على بنية القرآن، فكتاب فضل الرحمن هو محاولة لبلورة تأويلية للقرآن أكثر من كونه كتابًا في الدراسة الأدبية البنيوية للنصّ، أما الدراسة اللسانية البنيوية التي قدّمها إيزوتسو فإنه لا يمكن اعتبارها جزءًا من الدراسة الغربية للقرآن من الأساس. انظر: WESTERN STUDIES OF THE QUR’ANIC NARRATIVE: from the Historical Orientation into the Literary Analysis, Munirul Ikhwan,Al-Jami‘ah, Vol. 48, No. 2, 2010 M/1431 H, p: 401
[71] حيث يرى كثير من الباحثين المعاصرين أنّ عملية القراءة الموضوعية للقرآن والتي تمّت في السياق العربي والإسلامي المعاصر، بما فيها من محاولات دقيقة مثل محاولات الفراهي والإصلاحي لتحديد (عمود السورة)، هي محاولات يسيطر عليها الذاتية وعدم الدقة، وأنّ تحديد تركيب السورة القرآنية لا بد أن يتمّ وَفق أدوات أكثر موضوعية تتعلق بالبنى والتراكيب وأدوات الربط والتقسيمات النصية البنيوية المعهودة في الدراسات الأدبية والكتابية.
[72] للتوسع، انظر: القرآن خطيًّا، دراسة الترتيب الزمني للقرآن في كتاب (تاريخ القرآن)، إيمانويل ستافينديز، ترجمة: د/ حسام صبري، موقع تفسير.
[73] جمالية تلقي القرآن عند ثيودور نولدكه، زهراء دلاور ابربكوه، مجلة دراسات استشراقية، العدد 30، 2022، موقع المركز الإستراتيجي للدراسات الإسلامية.
[74] الدراسات القرآنية والمنعطف الأدبي، ترافيس زاده، ترجمة: هدى النمر، موقع تفسير.
[75] مساءلة التفسير البنيوي للقرآن، رايتشل فريدمان، ترجمة: أمنية أبو بكر، ص36.
[76] راجع: إعادة النظر في النوع الأدبي للقرآن، آدم فلاورز، ترجمة: أمنية أبو بكر، موقع تفسير.
[77] بدأت في السنوات الأخيرة بعض الدراسات العربية والإسلامية الاهتمام بهذه المدرسة ونتاجها، خصوصًا اشتغال ميشيل كويبرس، حيث نجد بعض البحوث حول منهج كويبرس، والتي يقوم بعضها بمساءَلة إمكانية تطبيق هذا المنهج على القرآن، ومدى ملاءمته للنصّ، وهل تطبيق كويبرس لمنهجه على القرآن يتمّ بشكل يناسب طبيعة القرآن بحيث يكون هذا التوافق ناتجًا عن تحليل بنية النصّ أم يفرض كويبرس منهجه على القرآن بشكلٍ لا يخلو من تعسف، كما تحاول بعض هذه الدراسات الإفادة من هذا المنهج واستثماره في دراسة نَظْم القرآن مع بعض تعديلات، وبعضها يفيد من نتائج اشتغاله ويستثمرها في طرح فرضيات جديدة حول طريقة نَظْم القرآن، لإقامة حوار بين اشتغال كويبرس والاشتغال الإسلامي التراثي والمعاصر عن النَّظْم؛ بحثًا عن تسييق لإشكال النَّظْم داخل سياق الإشكالات الإسلامية المتعلّقة بعلم التفسير
نذكر في هذا السياق، بعض الدراسات:
1- دراسة نظم القرآن، قراءة في المنجز وآفاق الاشتغال، مع طرح فرضية لنَظْم القرآن، خليل محمود اليماني.
2- منهج البلاغة الساميّة في دراسة بنية القرآن الكريم؛ دراسة وصفية تحليلية، محمد يسلم المجود.
3- منهج البلاغة الساميّة في دراسة بنية القرآن الكريم؛ دراسة تطبيقية على سورة الحجرات، محمد يسلم المجود.
والدراسات الثلاث منشورة على موقع تفسير.
4- مناهج المستشرقين في دراسة القرآن، التحليل البلاغي لميشيل كويبرس أنموذجًا، وهي أطروحة دكتوراه غير منشورة بجامعة الأزهر، للباحث/ خليل محمود اليماني، وقد اعتنت بتقويم منهج التحليل البلاغي وهل يمكن تطبيقه على القرآن أم لا؟ وقد اطّلعت عليها من خلال تواصلي مع الباحث.
[78] انظر: عرض كتاب (أهداف كتب التفسير ومناهجها وسياقاتها؛ القرون: الثاني/ الثامن- التاسع/ الخامس عشر)، تحرير: كارين باور، أولريكا مارتنسون، ترجمة: هدى النمر، موقع تفسير. وانظر: عرض كتاب التفسير وتاريخ الفكر الإسلامي واستكشاف حدود النوع، بيتر كوبينز، ترجمة: مصطفى هندي، موقع تفسير.
[79] للتوسع راجع: قراءة في معالجة ابن تيمية لبيان والد زوج موسى، والرسل في سورة يس، ترجمة: مصطفى هندي، موقع تفسير.
[80] تمثل قضية الإسرائيليات وقضية حضورها ضمن كتب التفسير أحد الإشكالات الرئيسة للدراسات القرآنية العربية المعاصرة، حيث ومنذ عصر النهضة نجد أنه قد تشكّل نوع من الرفض تجاه هذا الحضور، برَز في دعوات التنقية والتنقيح لهذا التراث التفسيري من حضور هذه المرويات، وتم النظر لحضورها باعتباره زائدًا عن حاجة التفسير، وتم إرجاعه إمّا إلى الدسّ والإقحام أو إلى سمات الثقافة العربية الوسيطة، إلا أننا في الآونة الأخيرة نجد بعض الطروحات العربية التي حاولت إعادة النظر في حضور المرويات الإسرائيلية داخل التفسير، وتقديم نقاش أكثر اتساعًا حولها، نذكر في هذا السياق:
1- مراجعات في الإسرائيليات، مركز تفسير.
2- ملف الإسرائيليات في التفسير على موقع تفسير.
3- توظيف الإسرائيليات في التفسير؛ دراسة تحليلية تأصيلية، خليل محمود اليماني، مركز تفسير، 2022م.
[81] راجع: مَن هم أصحاب الأخدود، آيات سورة البروج في سياق الشرق الأدنى، آدم سيلفرستاين، ترجمة: مصطفى الفقي، موقع تفسير.
الصورة القرآنية وما بعد القرآنية لنبي الإسلام، دراسة مقارنة من خلال تفسير الآيات: 10- 11 من سورة الدخان، أوري روبين، ترجمة: مصطفى الفقي، موقع تفسير.
[82] راجع: الصورة القرآنية وما بعد القرآنية لنبي الإسلام، دراسة مقارنة من خلال تفسير الآيات: 10- 11 من سورة الدخان، ترجمة: مصطفى الفقي، موقع تفسير.
[83] تهتم الكثير من الدراسات الغربية المعاصرة حول التفسير بالتفسير خارج مصر وتركيا والهند، فتهتم بالتفسير في الصين وإفريقيا، كما لا تُوقِف اهتمامَها عند التفاسير المكتوبة بل تتوسع لتشمل التفاسير الشفهية، والتفاسير ضمن الخطب والدروس، ومما صدر في هذا:
Approaches to the Qur'an in Sub- Saharan Africa
Edited by Zulfikar Hirji,OUP, 2019
Approaches to the Qur'an in Contemporary Iran
Edited by Alessandro Cancian, OUP, 2019
Approaches to the Qur'an in Contemporary Indonesia, Abdullah Saeed, OUP, 2006
كذلك فالكثير من الدراسات الغربية المعاصرة تهتم بدراسة التفاسير غير السنّية، مثل التفاسير الشيعية والصوفية، ومما صدر في هذا:
Sufi Hermeneutics,
The Qur'an Commentary of Rashid al- Din Maybud, Annabel Keeler, OUP in association with the Institute of Ismaili Studies, 2006
Sufi Master and Qur'an Scholar
Ab ul- Qasim al- Qushayr i and the Lata'if al- Ish ar at, Martin Nguyen, OUP, 2012
The Spirit and the Letter
Approaches to the Esoteric Interpretation of the Qur'an, Annabel Keeler and Sajjad H. Rizvi, OUP, 2016
[84] للتوسُّع يُراجَع: ترجمات ملف (علم التفسير)، وترجمات ملف (التفسير الإسلامي في الدراسات الغربية) على قسم الترجمات بموقع تفسير.
[85] راجع: التفسير باعتباره خطابًا، المؤسسات، والمصطلحات والسلطة، يوهانا بينك، ترجمة: مصطفى هندي، موقع تفسير.
[86] كما رأينا هذا في تصنيف روتليدج في كتابه الصادر العام الماضي، حيث تم النظر للتفسير كأحد أبعاد النصّ، لكن تم حصر هذا التفسير في التفسير الفقهي والكلامي، وكذلك لم تُبرِز الدراسات داخل الكتاب اهتمامًا باستخدام التفسير في إضاءة المعنى القرآني ذاته. انظر: الدراسات العربية والغربية المعاصرة حول القرآن الكريم، قراءة في منجز تصنيف الدراسات، وطرح تصنيف جديد، واستكشاف واقع الدراسات، طارق حجي، موقع تفسير، ص21، 22، 23.
[87] كثير من الدارسين يعرضون رؤى شبيهة بهذه الرؤية، على سبيل المثال يذكر أن الدراسات المعاصرة وعلى عكس الكلاسيكية، أصبحت تهتم لترك القرآن "يتحدث عن نفسه"، انظر: WESTERN STUDIES OF THE QUR’ANIC NARRATIVE: from the Historical Orientation into the Literary Analysis, Munirul Ikhwan, Al-Jami‘ah, Vol. 48, No. 2, 2010 M/1431 H, p:401
[88] انظر: عرض كتاب القرآن كنصّ، دانيل ماديغان، ترجمة: هدى عبد الرحمن النمر، موقع تفسير.
[89] الدراسات القرآنية والمنعطف الأدبي، ترافيس زاده، ترجمة: هدى عبد الرحمن النمر، موقع تفسير.
كلمات مفتاحية
الكاتب:

طارق محمد حجي
باحث مصري له عدد من المقالات البحثية والأعمال المنشورة في مجال الدراسات القرآنية.
مواضيع ذات صلة
((المعلومات والآراء المقدَّمة هي للكتّاب، ولا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع أو أسرة مركز تفسير))