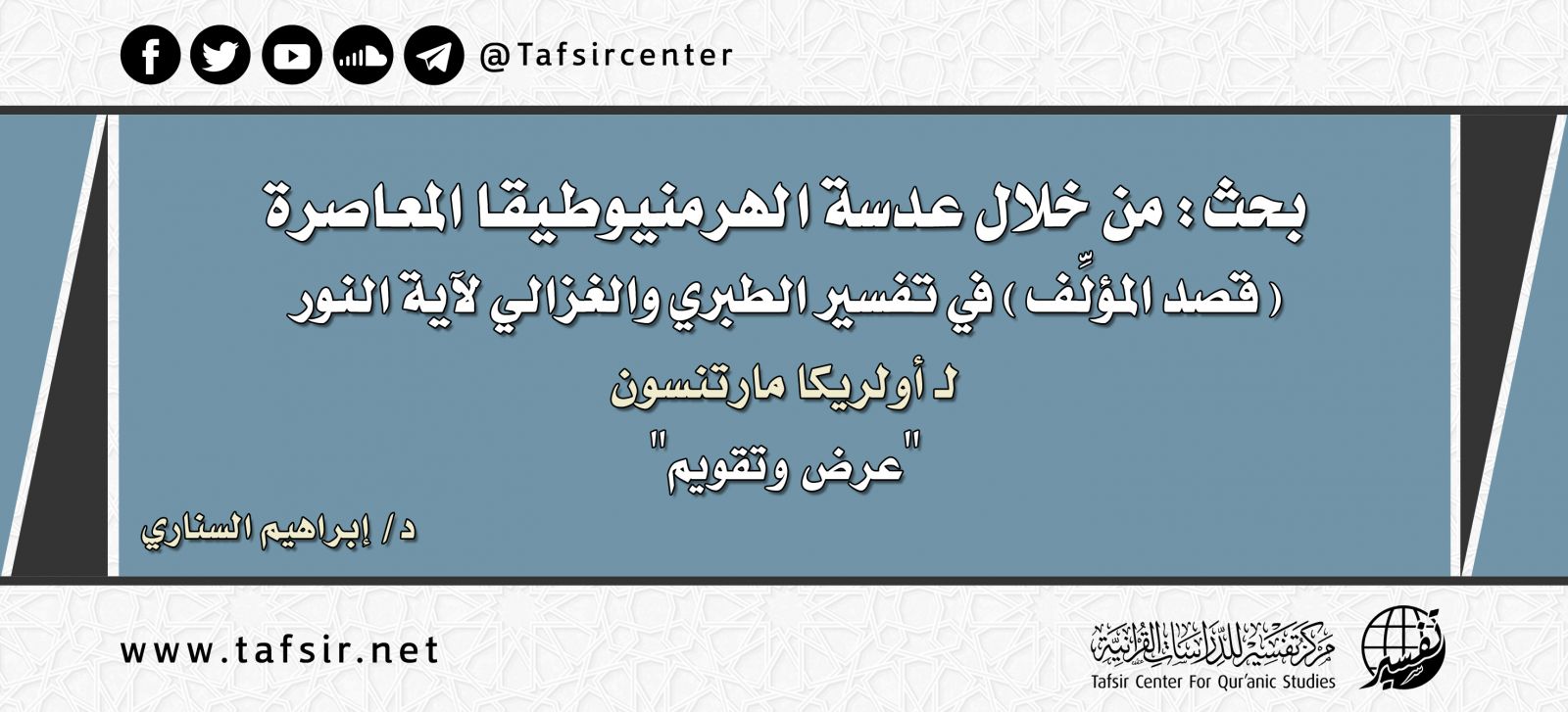بحث: مَنْ هم أصحاب الأخدود؟ آيات سورة البروج في سياق الشرق الأدنى لآدم سيلفرستاين
بحث: مَنْ هم أصحاب الأخدود؟ آيات سورة البروج في سياق الشرق الأدنى لآدم سيلفرستاين
الكاتب: محمد عبيدة

مقدّمة:
تأتي هذه المقالة لتقدّم مراجعة لدراسةِ (مَن هم أصحاب الأخدود؟) للباحث الأمريكي آدم سيلفرستاين. وتهدف هذه المقالة إلى مساءلة الاقتراح الذي قدّمه الباحث، والمتمثّل في ربط قصة أصحاب الأخدود القرآنية بقصة نبوخذ نصر والرجال الثلاثة في الإصحاح الثالث من سفر دانيال؛ من خلال النظر في الحُجَج التي قدّمها، وطريقته في التناول. كما تسائل المقالة بعض المسلّمات الوضعية التي تستند إليها الدراسة في الربط بين القرآن والأسفار الكتابية، وتفسير التشابه بالأخذ والاقتباس.
أولًا: أبرز قضايا الدراسة:
يسعى الباحثُ إلى قراءة الآيات من 4 إلى 10 من سورة البروج في سياق التراث الديني والثقافي في الشرق الأدنى؛ لفهم المقصود بأصحاب الأخدود من جهة تاريخية، ولفهم الرسالة الدينية للآيات من جهة أخرى. وقد سعى الباحث إلى ترجيح ارتباط الآيات المشار إليها بسفر دانيال، من خلال عدّة مقارنات نصيّة بين عناصر القصّتين في سفر دانيال وفي القرآن.
ينطلق الباحث من مبدأ أساس في دراسته، وهو صعوبة فهم رسالة القرآن دون اللجوء إلى التراث الديني للشرق الأدنى، ودون تسييق لآيات القرآن ضمن هذا التراث؛ وللبرهنة على هذا المبدأ، اتخذ الباحث أنموذجًا لدراسته الآيات من 4 إلى 10 من سورة البروج. ويرى الباحثُ أن هذه الآيات قُرِئت في السياقَيْن الإسلامي والغربي قراءة تاريخيّة، في حين جنحتْ دراسات أخرى إلى قراءتها إسكاتولوجيًّا، وأمّا الباحث فرأى أنّ كلتا القراءتين ضرورية لفهم الآيات.
وقد جاءت الورقة في جزأين؛ خصّص الباحث الجزءَ الأول منها لتعيين المرجع التاريخي الذي تحيل إليه الآيات. وأمّا الثاني، فخصّصه لإبراز استدعاء القرآن لبعض التشبيهات والأساليب اللغوية الواردة في الإصحاح الثالث من سفر دانيال للإشارة إلى عقاب غير المؤمنين في جهنم.
ففي القسم الأول؛ بدأ الباحث بمناقشة الاحتمالات الدلالية لقوله تعالى: {قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ}[البروج: 4]: هل هي جملة إنشائية جاءت بمعنى اللعن، أم هي جملة خبرية تخبر عن واقعة مقتل أصحاب الأخدود في الماضي. وهذا الاحتمال الدلالي أربك برأيه ترجمات الآية؛ فبينما ترجمها بعضهم كعبارة إنشائية، ذهبت ترجمة أخرى لاعتبارها جملة خبرية.
وهذا الاحتمال أرخى بظِلاله على المقصود بأصحاب الأخدود: هل هم المؤمنون الذين حُرقوا؟ أم الذين حَفروا الأخدود وسجروه نارًا؟ وهنا نحن أمام الاحتمالات الآتية:
- أصحاب الأخدود هم الذين عَذّبوا المؤمنين وحرقوهم في الأخدود، وبالتالي لُعنوا في الآية: {قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ}، وهي بذلك جملة إنشائية.
- أصحاب الأخدود هم الذين أرادوا تعذيب المؤمنين بالنار، لكن ارتدّ الأمر عليهم، فقُتلوا بنارهم، وبالتالي فالآية: {قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ} خبرية، لا إنشائية.
- أصحاب الأخدود هم المؤمنون الذين قُتلوا بالنار، وبالتالي فالآية خبرية.
بعد هذا التحديد للاحتمال، ينتقل الباحث إلى إبراز الإشكال المعجمي الذي يعترض الباحثين عند تحديدهم لدلالة: الأخدود، مرجحًا أن «السبب الوحيد»[1] الذي دفع المفسّرين إلى اعتباره خندقًا مسجورًا نارًا؛ هو الربط التاريخي للآيات بواقعة تحريق المؤمنين، مشيرًا إلى أن المفسّرين والغربيين ربطوا الآيات بواقعتَيْن: شهداء نجران من النصارى، وتحريق نبوخذ نصر للرجال الثلاثة في سفر دانيال.
وبخصوص كون أصحاب الأخدود هم شهداء نجران، فإنّ الباحث اعترض عليه بما أثبته المستشرق الألماني يوسف هوروفيتس في بحثه التاريخي أنّ شهداء نجران صُلبوا وقُتِلوا في كنائسهم لا في أخاديد؛ وهو نفس موقف أبراهام جايجر أيضًا[2].
بعد هذا، انتقل الباحث إلى إثبات أنّ المقصود بالآيات هم الرجال المذكورون في سِفر دانيال، ويمكن إجمال أبرز حججه التي قدّمها في:
- التمايز بين نبوخذ نصر والرجال الثلاثة واضح على مستوى الإيمان، فهو مشرك وهؤلاء موحدون، وأمّا الملك النواس فهو يهودي، وكذلك الشهداء نصارى، فالتمايز بينهما إيمانيًّا غير واضح؛ والباحث يقصد هنا أنّ النصارى واليهود شبه متساوين إيمانيًّا، فلا سبيل لاعتبار أحدهما كافرًا ظالمًا والآخر مؤمنًا.
- في سفر دانيال، قُتِل الذين حَفروا الأخدود وسجروه، وهذا ينسجم مع الاحتمال الذي أشرنا إليه في الأعلى، وهو أنّ أصحاب الأخدود هم غير المؤمنين، وأن دلالة {قُتِلَ} تعني مات واحترق، وبالتالي، لاقوا جزاءهم في الدنيا.
- التناظر اللساني بين عبارة: الأخدود+ النار ذات الوقود، وما ورد في سفر دانيال: أتون+ نور+ يقد. وهذا يعني استدعاء القرآن للعبارة الواردة في السِّفر.
- التشابه بين عبارة: {إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ}[البروج: 6]، وما ورد في أحد الأوعية السحرية المكتشفة التي تتضمن رواية للسّفر، حيث وُصف الرجال بأنهم جالسون في فوهة الأتون.
بعد هذا، انتقل الباحث إلى إبراز الرسالة اللاهوتية التي توخَّى القرآن إبلاغها عبر هذه القصة، وهي أنّ الذين يضطهدون المؤمنين سيلقون مصيرهم في الدنيا لا في الآخرة، وذلك بالاعتماد على كون سورة البروج سورة مكية، وكون السور المكية تحدّثت عن كثير من الأقوام الذين لاقوا الهلاك في الدنيا قبل الآخرة. وتتعزّز هذه الرسالة اللاهوتية للقرآن بما ورد في التراث اليهودي والإيراني والعربي قبل الإسلام، وقد أورد الباحثُ كثيرًا من الشواهد من هذا التراث في بحثه. ويرى الباحث أنّ مسألة الاستشهاد وكون الكافرين يَلُون العذاب في الآخرة لا في الدنيا تظلّ مسألة مسيحيّة خالصة.
كما طرح الباحث أيضًا في دراسته مسألةَ ارتباط القرآن بالتراث الديني للشرق الأدنى، واقتباسه منه، حيث افترض -بناء على التشابه بين قصة أصحاب الأخدود القرآنية وما ورد في سفر دانيال إلى جانب مصادر أخرى، أن هذا التراث الديني قد شكّل مصادر تم الاعتماد عليها في تأليف القرآن. وقد استند الباحث في سبيل سعيه لتفسير انتقال قصة الفتية الثلاثة مع نبوخذ نصر من سفر دانيال إلى القرآن الكريم إلى تأكيد انتشار القصة في الشرق الأدنى؛ فسعى أولًا إلى إثبات انتشار القصة في الشرق الأدنى، وخصوصًا بين المسيحيين الناطقين بالسريانية، ليبني عليه مسألة اقتباس القرآن من السفر؛ إِذْ إنّ هذه القصة «توفّر قناة انتقال معقولة بين سفر دانيال 3 وسورة البروج». كما افترض أيضًا «أنها كانت متداولة في كلّ من فلسطين والعراق، عشية ظهور الإسلام وإبان فترة وجيزة من ظهوره أيضًا»، استنادًا إلى ورود رواية أخرى في فصول الحاخام اليعازر «التي عاصرتْ أوائل العصر الإسلامي»[3].
ومن الدلائل على هذا الانتشار أيضًا: «أنّ هذه الأحداث -أحداث القصة- قد استعملت كهيستوريلا في الأوعية السحرية المنقوشة باللغة الآرامية في العصور القديمة المتأخرة، كما نوقش آنفًا، يدعم الفكرة القائلة أنّ الرسالة اللاهوتية لسفر دانيال كانت منتشرة على نطاقٍ واسع بين اليهود عشية ظهور الإسلام»[4].
وأمّا في القسم الثاني من الدراسة، فقد سعى فيه الباحث إلى تقديم قراءة إسكاتولوجية للآيات؛ فذهب إلى أنّ موقف القائلين بالاكتفاء بالقراءة الأخروية التي تربط بين الأخدود والجحيم الأخروي ليس سديدًا، إِذْ يمكن الجمع بين القراءتين: التاريخية، والإسكاتولوجية. ولكي يعلّل الباحث الجمع بين القراءتين، ذهب إلى أنّ وصف الجحيم يعتمد أساسًا على المشاهدات الأرضية، ولا ينفصل عنها. وقد ضعّف الباحث المعنى العربي المقترح للكلمة، وهو الشقّ في الأرض، وذهب إلى أن لفظة الأخدود -في حدود اطلاعه- لم تُعْرَف في لسان العرب قبل الإسلام، وأنها ظهرت في العصر الأُموي[5]، كما ضَعّف أيضًا المحاولات الإيتيمولوجية الاستشراقية التي قُدّمت لِلَفظة الأخدود؛ ليستقر أخيرًا على ربط لفظة الأخدود بـ: «بيت خدودو» التي تدلّ على الجحيم الذي أُلقي فيه الشيطان.
ثانيًا: منهجيّة البحث:
اعتمد الباحث على عُدَّةٍ منهجية تجمع بين التحليل النصّي المقارن، والبحث التاريخي، والبحث الصوتي والدلالي، وذلك لتعدّد جوانب بحثه؛ فمن جهة، سعى إلى المقارنة بين قصة أصحاب الأخدود القرآنية وما ورد في سفر دانيال، وقصة شهداء نجران. ومن خلال تحليله لعناصر القصص الثلاثة، توصّل إلى أولوية ربط القصة القرآنية بسفر دانيال، لكثرة التشابهات بين القصتين، ولكون سياق القصّة القرآنية يقترب كثيرًا من القصة الواردة في سفر دانيال. ومن جهة أخرى، اعتمد على البحث في الوثائق والنصوص التاريخية التي تعود إلى ثقافات الشرق الأدنى فيما قبل الإسلام، ليسيِّق الآيات القرآنية ضمنها. ومن جهة ثالثة، سعى إلى التحليل الصوتي والدلالي المقارن للفظة أخدود، ليربطها بأتون النار الواردة في سفر دانيال.
وبالعودة إلى المنهج التاريخي عند الباحث، فالملاحظ أنه سلك عدّة خطوات منهجية لإثبات اقتباس القرآن من سفر دانيال، فاعتمد على مبدأ التشابه، من خلال مقارنته بين عناصر قصة أصحاب الأخدود القرآنية، وسفر دانيال؛ كما استند إلى السبق التاريخي للنصوص الكتابية، من خلال بيان أسبقية المصادر الكتابية على تاريخ ظهور القرآن، ذلك أن أسبقيتها تعزّز فرضية الأخذ والنقل؛ ووظّف التحليل الصوتي، وأرجع الصورة الصوتية لكلمة الأخدود القرآنية لـ: «بيت خدودو»[6].
ثالثًا: تعقيبات منهجية:
ثمة مجموعة من الملاحظات التي تنقدح في ذهنِ القارئ لهذه الدراسة، ومن أبرز هذه الملاحظات:
1. ارتباط القصة القرآنية بسِفر دانيال:
رام الباحث من خلال منهجه التحليلي المقارن أن يثبت أنّ ما ورد في سفر دانيال أقرب إلى القصة القرآنية من واقعة شهداء دانيال، والناظر في عناصر القصّتين، أعني الرجال الثلاثة وشهداء نجران، سيلحظ بوضوح مدى اقتراب القصة القرآنية من سفر دانيال، غير أنّ هذا التشابه مع ذلك تعترضه بعض الصعوبات التي يصعب معها القول بكون أصحاب الأخدود هم المذكورون في سفر دانيال. ويمكن إجمال هذه الصعوبات في ما يأتي:
أ- الأخدود شقٌّ في الأرض:
تتحدّث القصة عن الأخدود؛ وقد أجمع المفسّرون على أنّ الأخدودَ شقٌّ في الأرض، وهو ما لا نجده في قصة الرجال الثلاثة؛ فثمة فرقٌ بين الأتون والأخدود. وقد كان الباحث واعيًا بهذه الصعوبة التي تمثّل العقبة الأساس في طرحه؛ الأمر الذي دفعه إلى إعادة البحث في دلالة اللفظ، ليصرفه عن معنى الشقّ إلى معنى يتوافق مع ما في سفر دانيال. غير أن الحجج التي ضعّف بها كون كلمة الأخدود تعني الشقّ حججٌ ضعيفة. فقد زعم أنّ كلمة الأخدود ليس لها أصل اشتقاقي ثلاثي عربي، كما زعم أيضًا أن السبب الوحيد الذي دفع المفسّرين إلى تفسيرها بالأخدود هو المرويات التي تحدّثت عن تحريق المؤمنين بالنار. غير أنّ هذا الزعم غير صحيح من الكاتب؛ فكلمة الأخدود كلمة عربية وردت في الشعر الجاهلي، في بيتٍ لأوس بن حجر:
لدى كلِّ أخدودٍ يُغادِرْنَ دارعًا .. يُجَـرُّ كما جُرّ الفصيلُ المقرَّعُ[7]
كما أنّ زعمه أنّ الكلمة ليس لها أصل اشتقاقي زعمٌ خاطئ؛ يقول اللغوي الكبير الجوهري في صحاحه: «فصل الخاء: [خدد] الخَدُّ في الوَجْه، وهما خَدَّانِ والمِخدَّةُ بالكسر؛ لأنّها توضع تحت الخَدّ. والمِخَدَّةُ أيضًا: حَدِيدةٌ تُخَدُّ بها الأرض، أي تُشَقّ. والأُخْدود: شقٌّ في الأرض مستطيل. وخدّ الأرضَ يخدُّها. وضَرْبَةٌ أُخْدودٌ، أي خَدَّتْ في الجِلْد. والخُدَّةُ بالضم: الحُفْرَةُ. قال الفرزدق: وتَرى بها خُدَدًا بكلّ مجال»[8]. وأمّا ما ذهب إليه من وجود الخلاف حول كون كلمة الأخدود مفردًا أم جمعًا، فهذا الخلاف لم يرِد عند اللغويين أصلًا، والباحث لم يُحِلْ على الموضع الذي وجد فيه أنّ كلمة أخدود جمع[9]؛ وهذا بعيد لكون صيغة (أُفْعُول) من صيغ المفرد لا الجمع! والحاصل أنّ الكلمة لها أصل اشتقاقي ثلاثي وهو: خدد، ومن هذا الأصل اشتُقّت ألفاظ تدور حول الأثر الذي يُترك في السطح: الضربة في الجلد، والشقّ والحفرة في الأرض. هذا من حيث اللغة؛ وأمّا من حيث علاقة لفظة الأخدود ببيت خدودو، فهذا لا يكفي لإثبات ما رامه الباحث؛ فلا بد من إثبات أن الرسول -عليه السلام- اطلع على الأسفار ونقل اللفظ إلى القرآن وعرّبه بهذه الصيغة؛ وهذا أمر سنناقشه في فقرة موالية بإذن الله تعالى.
ب: مقتل المؤمنين:
وإلى جانب هذا الإشكال الذي يعترض هذا الربط بين قصة الرجال الثلاثة وقصة أصحاب الأخدود، ثمة عنصر آخر من عناصر الاختلاف: وهو أنّ القصة القرآنية لم تذكر مصير المؤمنين: هل نجوا من القتل أم لا، غير أنّ المفسرين مُجْمِعون على أن المؤمنين قُتلوا فعلًا، كما ورَد في المرويات والأحاديث الشريفة[10]؛ ولم يذكروا مطلقًا أنهم نجوا بمعجزة. أمّا الباحث فإنه افترض أنّ المؤمنين نجوا بناء على ما ورد في السفر فقط، ولم يتطرّق لمصيرهم في القرآن؛ وهذه ثغرة في بحثه، غير أنّه استند إلى ما في القرآن من قتلٍ لأصحاب الأخدود، فكأنه ربط بين هلاك غير المؤمنين وقتلهم وبين نجاة المؤمنين، ثم بنى على هذا أن القرآن منسجم مع الرسالة اللاهوتية القاضية بنجاة المؤمنين بمعجزة. غير أنّنا نرى أن الباحث هنا جانَبَ الصواب حين ذهب إلى أن الاستشهاد والجزاء الأخروي مسألة مسيحية خالصة، في حين أنّ القرآن يتحدّث عن التدخّل الإلهي المعجز لإنقاذ المؤمنين. والحال أنّ القرآن يجمع بين الأمرين؛ ففي حين نجد قصصًا كثيرة أنقذ اللهُ فيها عباده المؤمنين وأهلك أعداءه في الدنيا، نجد قصصًا أخرى استشهد فيها الأتقياء، لينالوا جزاءهم في الآخرة؛ والمثال الأبرز هنا: ما لاقاه نبيَّا الله تعالى: زكريا ويحيى -عليهما السلام-. بل إن القرآن ينسب لليهود قتلهم للأنبياء بغير حقّ، كما في سورة آل عمران: {إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ}[آل عمران: 21]، وقوله تعالى في السورة نفسها: {لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ}[آل عمران: 181].
وإن قيل -جريًا على الطرح الاستشراقي ومعطياته- إنّ هذه الآيات وردتْ في سورة مدنية، وفيها كان احتكاك القرآن بالنصارى، وبالتالي تأثّر بمفهوم الاستشهاد المسيحي؛ فإنّ ثمة آيات مكية ورد فيها هذا المفهوم: منها ما ورد في سورة يس؛ حين قُتل العبد الصالح ثم هلك قومه من بعدِه: {وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ * أَأَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونِ * إِنِّي إِذًا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ * إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ * قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ * بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ * وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ * إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ} [يس: 22- 29].
وأيضًا، ما جاء في سورة طه من هلاك لفرعون بعد تعذيبه للسّحَرة الذين آمنوا، في قوله تعالى: {قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى} [طه: 71].
وإذن، فلا تلازم بين هلاك الذين آذوا المؤمنين وبين نجاة المؤمنين في الدنيا كما ذهب إليه الباحث. وإذن، فمن خلال الإشكالَيْن السابقَيْن -أعني دلالة الأخدود على الشقّ في الأرض، وكون المؤمنين قُتلوا ولم ينجوا- يظهر لنا صعوبة الربط بين ما ورَد في سفر دانيال وقصة أصحاب الأخدود؛ إِذْ لم يعذّب الرجال في السّفر في الأخدود، وهم نجوا ولم يُقتلوا.
2. مسألة الاقتباس من قصص أهل الكتاب:
لا شك أن القارئ يلاحظ أن إستراتيجية الباحث ارتكزت على مصادرات بحثية؛ ففي سعيه إلى البحث عن مصادر محتملة للقصة القرآنية، راح يبحث عن النصوص الكتابية السابقة على القرآن، وافترض أنها كانت شائعة في الحجاز زمن البعثة. وهذا الافتراض منه لا يكفي حقيقة لإثبات اطلاع النبي -صلى الله عليه وسلم- عليها؛ لذلك افترض أنها كانت شائعة في صورة شفهية، وهو ما أتاح لمحمد -عليه الصلاة السلام- أن يطّلع عليها، ويعيد تركيبها لبناء القصص القرآني. وهذا الافتراض يروم تجاوز الصعوبات التي تطرحها أُمِّيَّة النبيّ -عليه الصلاة والسلام- أوّلًا، وكونه غير عالم بلغات هذه النصوص؛ إِذْ يتطلّب الأمر إثبات أن النبيّ -عليه السلام- كان مطّلعًا على هذه النصوص، ومتقنًا للسان العبري والآرامي ولربما اليوناني، أو على الأقلّ أنه اطلع على ترجمات عربية لها.
لكن: هل تكفي هذه الافتراضات لإثبات وقوع النقل؟ الحقّ أنّ هذه الافتراضات لا يمكن الأخذ بها عقلًا -لو جَارَيْنَا المعطيات الاستشراقية- إلا إذا وَجدت ما يعزّزها من الواقع التاريخي لبيئة الحجاز، وثبت أنها بيئة راجتْ فيها النصوص الكتابية، وأنها كانت مترجمة إلى العربية، أو أنّ محمدًا كان يتقن تلك اللغات التي كُتبت بها تلك النصوص. لكن هذا كان شبه غائب في الدّراسة، وتعترضه صعوبات هائلة، ليس أقلّها تكذيب كاملِ المصادر الإسلامية، وتكذيب ما نعرفه عن بيئة الحجاز من أنها بيئة وثنية، وأنها بيئة أُمّية، وأن الكتابة فيها نادرة جدًّا.
وإذن، فالباحث لا يستند في تفسيره للنقل والتركيب والبناء على (حقائق) تاريخية تفيد النقل، وإنما يقدّم (تفسيرًا) وضعيًّا للتشابه بين هذه النصوص والقصة القرآنية. لكن ما الذي يعطي لهذا التفسير (وجاهته) و(علميته) من وجهة نظر استشراقية؟
تتأسّس علمية هذه الافتراضات على المبدأ الوضعي القائل بضرورة أن يكون التفسير (ماديًّا) بالمعنى الذي يقابل التفسير الغيبي؛ والمقصود به أن يكون التفسير بشريًّا، وفق التجربة البشرية، المحكومة بالقوانين الصارمة، بعيدًا عن أيّ نزوع نحو الأسطرة، وافتراض تفسيرات غيبية مفارقة لما هو بشري. وهذا المبدأ الوضعي هو ما سنسعى لتوضيحه في الفقرة الآتية:
لا بدّ في نقاش الموقف الاستشراقي من النظر في الأساس المعرفي الذي يوجّه النظر الاستشراقي في مسألة علاقة القرآن الكريم بالنصوص الكتابية السابقة، وفي ظاهرة الوحي عمومًا. ذلك أن معرفة الأساس المعرفي يمكّن من مناقشة الأصول والكليات، ويجعل النقاش مثمرًا.
بداية، من المعلوم أنّ كلّ اشتغال معرفي يتأسّس على أصول معرفية كلية؛ توجّه هذه الأصول عمليات التأويل والتفسير التي يقترحها الباحث؛ وتتدخّل في ترجيحاته. من هنا، تأتي أهمية الكشف عن هذه الأصول في الدراسات البحثية، قبل مناقشة التفاصيل البحثية المتأسّسة عليها.
إنّ العلم التجريبي وإن كان يركّز على الاستقراء والتجربة والانطلاق من الوقائع إلا أنه يتأسّس على فرضيات مسبقة ليست تجريبية؛ كوجود واقع موضوعي مستقلّ عن الوعي، وككون هذا الواقع الموضوعي قابلًا للفهم والإدراك، وأنّ الواقع الموضوعي المحسوس هو الواقع النهائي والوحيد. ويهمّنا في هذه الفرضيات الفرضية الثالثة، ذلك أنها تؤدي دورًا خطيرًا في عملية التفسير المقدّم للظواهر؛ إِذْ يُعَدّ كلّ تفسير يتجاوز الواقع المادي تفسيرًا غير علمي، وخرافيًّا أو أسطوريًّا.
وهذا التصوّر لا يقتصر على العلوم التي تدرس الظواهر الطبيعية، بل يمتد إلى الظاهرة الإنسانية نفسها وما يتعلّق بها من علوم ومعارف. ويهمّنا هنا تأثير التصوّر الوضعي في علم التاريخ، وتأثيره في البحث الاستشراقي، فيما يتعلّق بتاريخ القرآن، وعلاقته بالنصوص الدينية الكتابية السابقة عليه.
وفي ما يتعلّق بالبحث الاستشراقي الحديث والمعاصر، فإنّه في المجمل ينهض على التصوّر العلمي-الوضعي. وهذا التصوّر هو الذي يوجّه عملية تفسير التشابه بين القرآن والقصص الكتابي. ففي ظلّ هذا التصوّر، يعدّ كلّ تفسير مادي تفسيرًا علميًّا؛ وكلّ تفسير غير مادي يعتبر تفسيرًا غير علمي، وبالتالي يُستبعد تلقائيًّا. فعندما ينطلق المستشرق من واقعة معيّنة، وهي تشابه النصّ القرآني بالقصص الكتابي، يتم طرح فرضيات تفسيرية تفسّر سِرّ هذا التشابه؛ وبخصوص فرضية الوحي، فإنها تظلّ مستبعدة لكونها غير علمية، ومتجاوزة للأسباب المادية-الطبيعية؛ ولا يتبقى إلا الفرضيات المتعلّقة بالنقل والتناص والأخذ؛ من هنا، يبحث المستشرق في النصوص الدينية التي يمكن أن يكون محمد -عليه الصلاة والسلام- قد اطّلع عليها، أو كونها أُضيفت لاحقًا للقرآن من خلال سلسلة من التعديلات والإضافات، كما تطرح فرضيات تعلُّم النبيّ -عليه السلام- للقراءة والكتابة وأنه لم يكن أُميًّا، أو أن هناك ترجمات عربية لهذه النصوص... وحتى في ظلّ غياب المؤشرات التاريخية على هذه الفرضيات، يستمر البحث الاستشراقي في طرح فرضيات بديلة؛ أملًا في العثور على الدليل المادي-التاريخي على مسألة النقل، لأنّه ما من تفسير مقبول آخر. ففي ما سبق، نلحظ كيف أنّ الباحث استنتَجَ -من خلال بعض النصوص القديمة- كون قصة أصحاب الأخدود كانت شائعة في الشرق الأدنى، مع أنه ما من داعٍ لهذا الاستنتاج، ما دام لم يثبت في النصوص العربية المنحدرة من العصر الجاهلي ذكرٌ لهذه القصص، أو لعناصرها وأسماء شخصياتها وأحداثها، وما في أيدينا من هذه النصوص العربية لا يكاد يوجد فيه أثر لها. لكن، قد يقال: إنّ المسلمين تخلّصوا من هذه النصوص ومنعوها من الانتشار، فيقال في الجواب: إنّنا نجد القرآن ينسب للعرب صراحةً جهْلَهم بهذا القصص: {مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا}[هود: 49]. وليس من المعقول أن يَكْذِب النبيّ على العرب وهو يدعوهم للإيمان به وتصديقه حين ينسب لهم الجهل بما يعلمونه، إِذْ هو نقيض غرضه ومراده. ومثل هذا الأمر سَيَئِد الدعوة في مَهدها وينسف أهم مبدأ في النبوّة، وهو صدق الخبر.
وأيضًا، فالقرآن يجادل العرب بوصفهم مشركين-وثنيّين، وهذه شهادة تاريخية على وثنية أهل مكة والعرب، كما أنه يخبر عنهم أنهم أُميّون لم يكن لهم كتاب ولا نبيّ قبل محمد -صلى الله عليه وسلم-؛ ومن غير المعقول أن يحاجج القرآن أفكارًا لخصوم متوهَّمين وغير موجودين، أو أن ينسب إليهم أمورًا غير موجودة فيهم، وإلا فَقَدَ مصداقيته أمامهم. وأيضًا، فإنّ إنكار وثنية البيئة العربية سيجعلنا نلغي نصوصًا ووثائق كثيرة تفيد وثنية العرب، سواء في ما تواتر عن العرب، أو في ما ورد من نقوش ونصوص عُثر عليها حديثًا[11].
وهذه الحجج تستمدّ قوّتها من كون القرآن نجح في دعوته، وجعل أهل مكة يُسْلِمون، فهذا يعني صدقه في ما نسبه إليهم من كونهم وثنيّين أوّلًا، ومن كونهم لا يعلمون بهذه القصص ثانيًا؛ إِذْ ليس من المنطقي أن يخاطروا بالإيمان برجلٍ يعلمون جزمًا كذبه، ويضحّوا بحياتهم وأموالهم ويتركوا ديارهم لأجل رجلٍ كاذبٍ لا يملك ما يعوضهم به. وهذه الحجة التي تردُّ تهمة كون محمد كاذبًا -كما يلاحظ رضا زيدان حين أورد اعتماد مونتجمري وات لها- ليس شرطًا أن يكون المرء مؤمنًا للاقتناع بها؛ إِذْ كثير من المستشرقين رَدُّوا هذه التهمة لأنها «غير معقولة؛ وذلك لأنها لا تفسّر لنا بصورة مرضية لماذا كان محمد -صلى الله عليه وسلم- في الفترة المكية مستعدًّا لتحمُّل جميع صنوف الحرمان، ولماذا فاز باحترام رجالٍ شديدِي الذكاء ذوي أخلاق مستقيمة، كما أنّ ذلك لا يجعلنا نفهم كيف نجح في تأسيس ديانة عالمية أنجبت رجالًا قداستهم واضحة للعيان. لا يُفَسَّر ذلك بصورة مرضية إلا إذا افترضنا صدق محمد، أي: أن نعتقد بأنه كان معتقِدًا حقًّا بأنّ القرآن ليس ثمرة خياله، بل إنّ كلّ ما نزل عليه كان من الله، فهو بذلك حقّ»[12].
وبالتالي، فإذا ثبت أنّ بيئة العرب كانت وثنية، وأنّ وجود مخطوطات النصوص الكتابية لا يعني بالضرورة ذيوع القصص التي تتضمنها وانتشارها، وإذا انضاف إلى هذا كون الكتابة نادرة في العرب، وكون محمد -عليه السلام- لم يكن يتقن ألسُن النصوص الكتابية المتعدّدة (وإلا لكان هذا أدعى لتكذيبه)، لزم إذن كون محمد -عليه السلام- غير ناقل عن أهل الكتاب، ولزم البحث عن تفسير آخر بدل الزعم بالنقل؛ وهنا يبرز مأزق المنطلق الوضعي الذي يحصر التفسيرات المقبولة في ما هو مادي-طبيعي، ما يجعله عاجزًا عن إيجاد تفسير مقبول لظاهرة الوحي ضمن حدوده الخاصّة. وسنزيد توضيح هذا المأزق في مقالة مقبلة بإذن الله تعالى.
خاتمة:
حاول المستشرقُ الأمريكي آدم سيلفرستاين دراسةَ آيات سورة البروج في سياق مدوّنات الشّرق الأدنى القديم، هادفًا من وراء ذلك إلى تحديد المقصودِين بأصحاب الأخدود. وقد اجتهدْنَا في عرض سياق اشتغال سيلفرستاين، وقُمْنَا بمساءَلة الاقتراح الذي قَدّمه الباحثُ، والمتمثّل في ربط قصة أصحاب الأخدود القرآنية بقصة نبوخذ نصر والرجال الثلاثة في الإصحاح الثالث من سفر دانيال، وقد كَشفتْ لنا مناقشة سيلفرستاين عن صعوبة الرّبط بين قِصّتي أصحاب الأخدود والرجال الثلاثة، نظرًا لبعض الإشكالات التي لم تستطع دراستُه الإجابةَ عنها، خاصّة ما تعلّق منها بدلالة الأخدود على الشقّ في الأرض، وبمصير المؤمنين في القصة القرآنية.
[1] مَن هم أصحاب الأخدود؟ آيات سورة البروج في سياق الشرق الأدنى، آدم سيلفرستاين، ترجمة: مصطفى الفقي، مركز تفسير للدراسات القرآنية، ص16. tafsir.net/translation/65
[2] مَن هم أصحاب الأخدود؟ آيات سورة البروج في سياق الشرق الأدنى، ص19.
[3] مَن هم أصحاب الأخدود؟ آيات سورة البروج في سياق الشرق الأدنى، ص40.
[4] مَن هم أصحاب الأخدود؟ آيات سورة البروج في سياق الشرق الأدنى، ص42.
[5] مَن هم أصحاب الأخدود؟ آيات سورة البروج في سياق الشرق الأدنى، ص86.
[6] مَن هم أصحاب الأخدود؟ آيات سورة البروج في سياق الشرق الأدنى، ص100.
[7] العين، الخليل بن أحمد الفراهيدي، تحقيق: مهدي المخزومي، إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال، (1/ 155).
[8] الصحاح، أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين، ط4، بيروت، 1987، (2/ 468).
[9] مَن هم أصحاب الأخدود؟ آيات سورة البروج في سياق الشرق الأدنى، ص15.
[10] جامع البيان في تأويل القرآن، محمد بن جرير الطبري، تحقيق: أحمد شاكر، مؤسسة الرسالة، 2000، (24/ 340).
[11] في شأن وثنية العرب، انظر: عرض كتاب: فكرة الوثنية ونشأة الإسلام من الجدل إلى التاريخ، وليد صالح، ترجمة: أمنية أبو بكر، مركز تفسير للدراسات القرآنية، tafsir.net/translation/88.
[12] الاقتباس لمونتجمري وات، نقلًا عن رضا زيدان، موثوقية السنّة عقلًا، مركز دلائل، دار وقف دلائل للنشر، 2020، ص147.
كلمات مفتاحية
الكاتب:

محمد عبيدة
حاصل على ماجستير النص الأدبي وفنونه، وأستاذ اللغة العربية للتعليم الثانوي التأهيلي.
مواضيع ذات صلة
((المعلومات والآراء المقدَّمة هي للكتّاب، ولا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع أو أسرة مركز تفسير))