تأصيل موضوعات علوم القرآن
تعريفها - أساميها - ضابطها - تعيين عددها
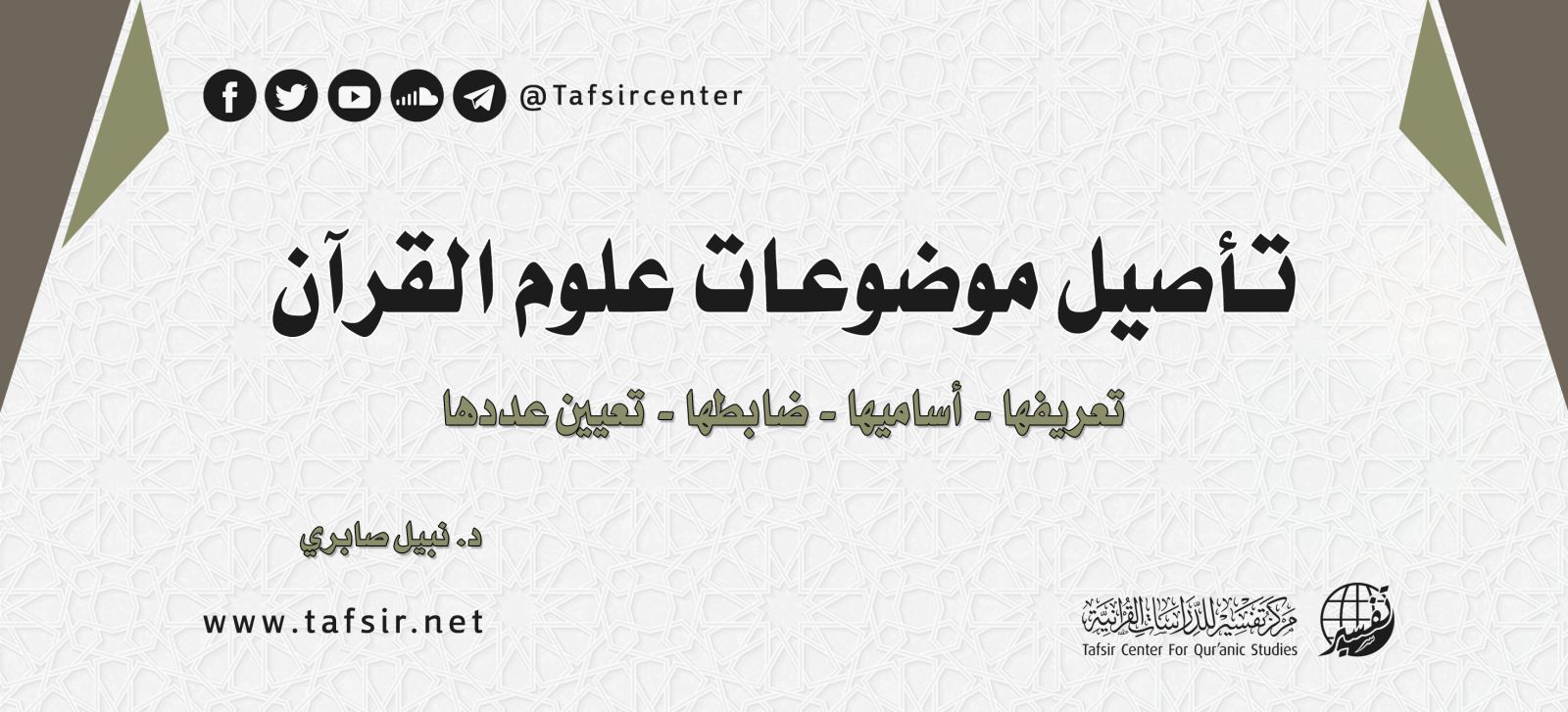
تأصيل موضوعات علوم القرآن
تعريفها - أساميها - ضابطها - تعيين عددها[1]
يهتم هذا المقال بتأصيل موضوعات علوم القرآن، وذلك من ناحية تحديد تعريفها، وتعدُّد أساميها، وكذا ضابطها، وتعيين عددها.
أولًا: تعريف الموضوعات:
يتشكّل علم القرآن الإجمالي من أقسامٍ كلية لموضوعات جامعة لمسائل متفرّقة يجمعها موضوع منطقيّ واحد؛ إِذ التنظيم له مستويان: المستوى الأول: تنظيم المسائل المتناسبة المبدّدة تحت المواضيع الجامعة، والمستوى الثاني: تنظيم المواضيع الجامعة تحت الأقسام الكلية.
ومما يمكن أن يُذكر في تعريف الموضوع أنه عبارة عن: «باب جامع للمسائل القرآنية المتناسبة في عِلْم معيّن على وجه الإجمال»؛ كتعريف النَّسْخ وشروطه وأنواعه وأقسامه وحكمه وأمثلته، حيث يجمعها لتناسبها موضوعٌ واحدٌ يسمَّى بالنَّسْخ، أو الناسخ والمنسوخ.
ومما يُحترز من الخلط فيه: التفريق بين موضوعات القرآن وموضوعات علوم القرآن، ولا شكّ أن زيادة المبنى تدلّ على زيادة المعنى، فموضوعات القرآن هي المحاور الإجمالية التي تدور عليها جميع آيات القرآن، أمّا موضوعات علوم القرآن فهي المحاور الإجمالية التي تدور عليها جميع علوم القرآن.
فموضوعات علوم القرآن أعمّ؛ لأنها تتعلّق بالقرآن من نواحيه الإجمالية كلّها، والتي أحد أفرادها موضوعات القرآن المتعلّقة به من جزئية واحدة فقط، وهي من ناحية النظر في موادّه، كما جاء عن الدهلوي حصره للعلوم الأساسية التي يشتمل عليها القرآن، حيث قال: «ليعلم أنّ المعاني التي يشتمل عليها القرآن لا تخرج عن خمسة علوم»[2]، ثم ذكر: عِلْم الأحكام، عِلْم الجدل، عِلْم التذكير بآلاء الله، عِلْم التذكير بأيام الله، عِلْم التذكير بالموت وما بعد الموت.
ومما يُستحضر في هذا المقام إطلاق العلماء مصطلح عِلْم القرآن على محاور القرآن وموادّه كما تكرّر مرارًا في نصوص التوثيق، ومنه قول ابن العربي: «اعلم أنَّ علومَ القُرآنِ ثلاثةُ أقْسَامٍ: تَوْحِيدٌ، وتَذْكِيرٌ، وأَحْكَامٌ»[3]، فمحاور القرآن تنضوي تحت علوم القرآن لشمولية المصطلح، كما ثبتَ في استعمال بعض العلماء إضافةُ طائفةٍ من مواضيع القرآن لأنواع علوم القرآن، ومثاله: أمثال القرآن، قصص القرآن، جدل القرآن، أقسام القرآن.
ثانيًا: أسامي الموضوعات:
اختلفت أسامي الموضوع بين المؤلِّفين في أنواع علوم القرآن، وليس لهم في ذلك منهج متبّع، أو إطلاق مقصود، فبعضٌ منهم لم يسمّه أصلًا، كما جاء في: دراسات في التفسير وعلوم القرآن لمحمد بن بكر آل عابد، ودراسات في علوم القرآن الكريم لمحمود البستاني، وذات الأفنان في علوم القرآن لوليد المنيسي، وعلوم القرآن لإبراهيم النعمة، وبعضهم الآخر أَطلق عليه أسامي متباينة، يمكن إرجاعها إلى ما يأتي:
1- الباب: كفنون الأفنان لابن الجوزي، والمرشد الوجيز لأبي شامة، والواضح في علوم القرآن لديب البغا وديب مستو.
2- الفصل: كالتبيان للصابوني، والـمُيَسَّر في علوم القرآن لعبد الرسول الغفاري، والمختار من علوم القرآن الكريم لأبي الوفاء، والتبيان لطاهر الجزائري، والمحرّر لمساعد الطيار.
3- المبحث: كإجمال البيان لعبد الله أحميد، وبحوث منهجية في علوم القرآن الكريم لموسى إبراهيم الإبراهيم، وموارد البيان في علوم القرآن لمحمد عفيف الدين دمياطي.
4- النوع: كالبرهان للزركشي، والمواقع للبلقيني، والتحبير والإتقان للسيوطي، والزيادة والإحسان لابن عقيلة.
5- العلم: كموسوعة علوم القرآن لعبد القادر منصور.
6- الدرس: كالوجيز في علوم القرآن لرياض الحكيم، ودروس في علوم القرآن لنذير الحسني، ودروس في علوم القرآن لطلال الحسن.
7- المحاضرة: كمحاضرات في علوم القرآن لأحمد ياسين الخياري.
8- المقالة: كعنوان البيان في علوم التبيان لمحمد حسنين مخلوف.
إنّ الواقف على أسامي الموضوع في فهارس مصنّفات الفنّ ليجد من الاختلاف ما يدلّ على إهماله؛ فمنهم من يجمع تحت الفصل جُملة من المباحث، وتحت كلّ مبحث مجموعة من المواضيع أو المطالب، في حين أنها كلّها مواضيع، ومنهم من يكمل في الدرس الثاني بقية الدرس الأول، ومنهم من يركّب بين المحاور الكلية وأدنى فروعها، ومنهم من يفكّك بين المسائل وجوامعها وفق أُسس غير منطقية، بل منهم من يسمي أحيانًا ويهمل التسمية أحيانًا أخرى، أو يسمي في الثاني باسم مغاير لِما سمّى به في الأول.
يسوق هذا الخلط إلى تنوّع طرائق عرض المعلومات، وشكليات تقاسيم الكتب، بل غياب بوصلة تحديد الفروع من الأصول، وفرز المسائل من الموضوعات، كما يجرّ إلى اختلاف عدّ الموضوعات؛ فمن اعتمد تسمية المباحث أو الأنواع أو العلوم تسلسل في الترقيم غالبًا، ومن اعتمد تسمية الباب أو الفصول أعاد الترقيم داخل كلّ قسم، وإِنْ تسلسل في الترقيم بينها.
إنّ التنوّعَ في الأسامي قديمٌ بقِدَمِ الموضوعات، وفَرْض أحدٍ منها على سبيل الاحتكام إليه وطرح ما عداه تضييقٌ لواسع، فالحقيقة أنّ مثل هذا الاختلاف سائغ، وهو من اختلاف التنوّع، ومما يصح القول فيه: لا مشاحّة في الاصطلاح، ولن يضرّ اختلاف العرض أو العَدّ بقدر ما يضرّ اختلاط الفروع بالأصول؛ لذلك يجب أن يُراعى فيه ما يأتي:
- أن يسمَّى باسم معيّن ولا يُترك مهملًا.
- أن يُفهم منه استيعاب المسائل المتناسبة والتفصيلات لا المواضيع والأنواع.
- أن يلتزم باسم واحد في جميع الكتاب.
ثالثًا: ضابط الموضوعات:
تقرّر أنّ كلّ مَن كَتَبَ في علوم القرآن من الناحية الإجمالية أو التفصيلية صحّ إطلاق مصطلح عِلْم القرآن على مكتوبه، بغضّ النظر عن كمِّه وكيفِه، إلا أنّ الكتابة في الأنواع تحتاج إلى خطوط واضحة، وقواعد صارمة، تنتهج عند الخوض فيه؛ لأن سعة القرآن وامتداده وقيام جميع العلوم عليه جعله فضاء للسّابح، وموجًا للراكب، مما أدى لحدوث اختلافات جذرية بين الكاتبِين في أنواعه إلى درجة تعذَّر معها الحكم بالاشتراك التامّ بين جميع كتب الأنواع في موضوع واحد، بخلاف الكتابة الحرّة في العملية التفصيلية التي ترجع لاختيار المؤلِّف وتخصّصه، ويُوَظَّف في وضعها مختلف المناهج والآلات والعلوم.
ولسائل أن يتساءل عن جدوى معيارية العِلْم ووجوب تجديده وتحديد ضوابطه في ظلّ اتساع المفهوم لكلّ ما تعلّق به، بل عدم الحاجة أصلًا لتنظيمه وفق نمط تكاملي، هذا على فرض كونه علمًا له حدود وقيود، والجواب أنّ تكوين المفهوم من شقّ إجمالي وآخر تفصيلي يوجب تأسيسه وفق أصول ومرتكزات علمية، حيث يتّجه البناء للعلوم الإجمالية؛ لأنه يسهل تقييدها وحصرها، أمّا العلوم التفسيرية وباقي العلوم التفصيلية سواء بالتمثيل أو التطبيق الموسّع فهي غنية عن التحديد والتصنيف.
ومنه ينفذ الجواب أيضًا إلى عدم سلامة صنيع المضيّقين للمفهوم رغبة تحويل العلم إلى فنّ منضبط له معاييره الخاصة؛ لأنّ التحديد متاح في ظلّ التقسيم السابق، كما أنه مخالف لما جرى عليه العمل طيلة قرون.
وبالرغم من أهمية التحديد البالغة، إلا أنه لم يلتفت إليه في الدراسات الحديثة، وظلّ الاصطفاء يجري في المؤلّفات من غير مبادئ ثابتة، وسنن معمول بها، وقد أشار إلى غياب التحديد الدكتور مساعد الطيار، بقوله: «وقبل الدخول في تصنيف علوم القرآن وترتيبها أذكر مسألتَيْن متعلقتَيْن بهذا الموضوع، وهما؛ الأولى: متى يُعَدُّ علمٌ ما أنه من علوم القرآن؟»، ثم قال بعد ذلك: «ومن خـلال تـتبّع بعـض علوم القرآن التي جـمعها الـزركـشي (ت: 794هـ) في كـتاب (البرهان في علوم القرآن)، والسيوطي (ت: 911هـ) في كتاب (الإتقان في علوم القرآن)، وما أحدثه الباحثون المعاصرون من علوم مستقلّة طرحوها في كتبهم لم أجد ضابطًا واضحًا في إدخال عِلْم من العلوم الجزئية في علوم القرآن»[4]، وقال في موطن آخر: «والموضوعات المعدودة في علوم القرآن بحاجة إلى تحرير، لكثرة التشقيق فيها؛ إِذْ تجد مجموعة من هذه العلوم يمكن أن تدخل في مسمًّى واحد، ولكن المؤلِّفين في علوم القرآن يجعلونها عدّة علوم، حتى لقد ادّعى بعضهم أنّ علوم القرآن لا تُحصى عددًا»[5].
لذلك لا بدّ من اقتراح ضوابط ووضع أُطر محكمة يمكن الاقتراب بوساطتها إلى توحيد المواضيع فتسهيل مسالك الدراسة ومناهج البحث بشكلٍ عامّ، وما الاختلاف في توحّد الكتابات إلا مردّه لغياب الحدود الفاصلة.
فمثلًا ضاعف السيوطي في التحبير تنويع البلقيني، معللًا صنيعه بقوله: «هذا آخر ما ذكره القاضي جلال الدين في الخطبة، ثم تكلّم في كلّ نوع منها بكلام مختصر يحتاج إلى تحرير وتتمّات وزوائد مهمات، فصنّفتُ في ذلك كتابًا سمّيته: (التحبير في علوم التفسير)، ضمّنته ما ذكر البلقيني من الأنواع مع زيادة مثلها، وأضفتُ إليه فوائد سمَحَت القريحة بنقلها»[6]، وقوله أيضًا: «فظهر لي استخراج أنواع لم يُسبق إليها، وزيادة مهمّات لم يُستوف الكلام عليها»[7]، ثم لمّا ألّفَ الإتقان هذّب صنيعه الأول مستدركًا عليه وعلى كتاب البرهان للزركشي، قائلًا: «فوضعتُ هذا الكتاب العليّ الشأن، الجلي البرهان، الكثير الفوائد والإتقان، ورتبتُ أنواعه ترتيبًا أنسب من ترتيب البرهان، وأدمجتُ بعض الأنواع في بعض، وفصّلت ما حقّه أن يُبان، وزدته على ما فيه من الفوائد والفرائد والقواعد والشوارد ما يشنّف الآذان»[8]، وقال أيضًا: «فهذه ثمانون نوعًا على سبيل الإدماج، ولو نوّعت باعتبار ما أدمجته في ضمنها لزادت على الثلاثمائة»[9].
وبعد سنوات عاد ابن عقيلة المكّي لِما استقرَّ عند السيوطي، ففكَّكَهُ وزاد عليه حتى أوصله إلى قرابة الضعف، وقال: «فشرعتُ في هذا الكتاب، وأودعتُ فيه جُلّ ما في الإتقان، وزدتُ عليه قريبًا من ضعفه من المسائل الحسان، واخترعتُ كثيرًا من الأنواع اللطيفة والفوائد الشريفة، هذا على سبيل الإدماج والإجمال، ولو فصّلتها لزادت على أربعمائة نوع»[10].
ثم انكمش العدد إلى الربع والعشر بعد مضي حوالي قرنين، وتوارت التشقيقات لتحلّ محلّها المختصرات، مع أن العلم أجاد بزيادات وتجديدات، واختزل السؤال الكبير بين طيّات الزمن وتضاعيف المؤلَّفات.
ما يدلّ دلالة قوية على أنّ اختراع الأنواع أو دمجها أو نسخها لا يخضع لحدود واضحة بقدر ما يصدر من اجتهاد المؤلِّف ورؤيته الخاصّة المستقلّة، كما قال السيوطي: «فظهر لي»، و«سمحت القريحة بنقلها»، وكما قال ابن عقيلة: «واخترعتُ كثيرًا من الأنواع»، وقول مناع القطان: «لكنني بذلتُ جهدي ما استطعتُ في اصطفاء موضوعاته، واستخلاص لبّها، وانتقاء المفيد منها، وصُغت ذلك بأسلوب عذب شائق، وعبارات واضحة جليّة، وترتيب محكم دقيق»[11].
إنّ حاجة الموضوع للتأصيل ألحُّ من المسألة؛ لأنه عنقودها، ويشكّل انتماؤه أجزاء العلم، ويكوّن طبقته العريضة، بخلاف المسائل التي تحضر وتحتجب، وتبرز وتضمر، من غير أن تؤثّر على قاعدته وصُلبه، وقد يتسامح معها ويتساهل في الإدخال والإخراج، إضافةً ليُسْرِ تحديدها.
وقد سار البحث في ضبط محدّدات الموضوعات إلى تقسيمها وفق نوعين رئيسين:
أولًا: محددات جوهرية:
وهي الأركان التي في ضوئها ينتسب أو يرفض الموضوع، ولتقريب المسافة في وضعها وتسهيل عملية استنتاجها يمكن سلوك طريق ملاحظة القواسم المشتركة للمواضيع المتداولة في الغالب، والغرض من ذلك تصوّرها تصوّرًا صحيحًا لاستنباط مشخصاتها والقياس عليها في التفعيل، فالاستعانة بمثلها مما يختصر الطريق في التعرّف على شكل الموضوع وعناصره المكّونة له، عوض أن تُستقرأ آلاف المسائل لينظر من خلالها إلى الأواصر والوشائج المستثمرة في معرفة موضوعات علم القرآن، عِلْمًا أن الموضوع يشترك في مفهومه الأوّليّ مع المسألة، ولكن يزيد عليها بما يصيّره جامعًا لمنثورها في موطن واحد، وقد انتهت نتيجة النظر مع ابتداع أصول جديدة فرضها التدقيق في الانتساب إلى اقتراح الضوابط الآتية لكلّ موضوع:
1- الصِّلة القوية للمفهوم التاريخي:
بعد وضع مقاربة جديدة لمفهوم علوم القرآن وفق واقعه التاريخي، فإنه لا بدّ أن تُستغل نتائج الاستقراء والتحليل في ضبط المواضيع وتحديدها، علمًا أن غاية توحيد الفهوم هو الانضباط بالفهم الصحيح الموسوعي، أمّا العصمة من التغاير والاختلاف الموضوعي فهو قاصر عنها، وإلا فما سبب التباين الكبير الحاصل بين ابن الجوزي والزركشي والبلقيني والسيوطي وابن عقيلة مثلًا رغم تماثلهم في المفهوم؟
ولا ينفي هذا أنّ المعاصرين الذين توافقوا على مفهوم جديد لعلوم القرآن -إلى حدٍّ بعيد- لم يتقاربوا في اختيار المواضيع وعددها، بل تشابهتْ مباحثهم ودنتْ من التطابق، وما ذاك إلا مردّه لتقليص دائرة علوم القرآن الواسعة، وإخراج كثير من مباحث علوم القرآن التاريخية من مفهومه، وخير شاهد عليه أن المواضيع في نقصان منذ زمن ابن عقيلة، حتى إنّ العصر الحاضر قد عرف نقلة تمييزية في السنوات الأخيرة، حيث أخرج البعض كثيرًا من العلوم التي كانت تمثّل عماد الفنّ في وقت أبي دقيقة وأقرانه إلى علوم أخرى.
فبناء على المفهوم التاريخي تمسّ موضوعات علوم القرآن كلّ ما انبثق من القرآن وشمله من ناحية التفسير والقراءات والإعراب والرسم والأحكام والأدوات وغيرها؛ كأسباب النزول، وأنواع التفسير، والوحي، فلا يمكن بحال نفي موضوع قرآني ينتمي مفهوميًّا لمفهوم علوم القرآن؛ لأنه بعضه، وإن الذي يومئ إليه هذا المفهوم أن تكون الموضوعات وفيرة، غير مقتصرة على مفاتيح التفسير، أو ما يتعلّق بالمتن دون السند، كما قال البلقيني عن سعة الأنواع: «وقد صنّف في علوم الحديث جماعةٌ في القديم والحديث، وتلك الأنواع هي في سنده دون متنه، وفي مسنديه وأهل فنّه، وأنواع القرآن شاملة، وعلومه كاملة»[12]؛ ولذلك عسر تحديدها.
وأمّا ما لم يستوفه المفهوم التاريخي في استعمالاته فإنه دخيل عليه، فالشمولية ليست مفتاحًا لحشد ما ليس بشرعي[13] من العلوم؛ كجمهرة العلوم الطبيعية من علوم الكون والهندسة والطب والجغرافيا والصيدلة والفيزياء والحساب والأحجام وعجائب المخلوقات وغيرها؛ لأنّ ضابط المفهوم التاريخي يمنعها من الاعتبار، وفي هذا يقول الشاطبي: «ما تقرّر من أميّة الشريعة، وأنها جارية على مذاهب أهلها وهم العرب، ينبني عليه قواعد؛ منها: أنّ كثيرًا من الناس تجاوزوا في الدعوى على القرآن الحد، فأضافوا إليه كلّ علم يُذكر للمتقدمين أو المتأخرين، من علوم الطبيعيات، والتعاليم، والمنطق، وعلم الحروف، وجميع ما نظر فيه الناظرون من هذه الفنون وأشباهها، وهذا إذا عرضناه على ما تقدّم لم يصح، وإلى هذا، فإن السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومَن يليهم كانوا أعرف بالقرآن وبعلومه وما أُودع فيه، ولم يَبلُغْنَا أنه تكلّم أحد منهم في شيء من هذا المدّعَى»[14].
وقال الزرقاني: «ولكن بعض الباحثين طاب لهم أن يتوسّعوا في علوم القرآن ومعارفه، فنظموا في سلكها ما بدا لهم من علوم الكون، وهم في ذلك مخطئون ومسرفون، وإن كانت نيتهم حسنة، وشعورهم نبيلًا، ولكن النية والشعور مهما حَسُنَا لا يسوّغان أن يحكي الإنسانُ غير الواقع، ويحمل كتابَ الله على ما ليس من وظيفته، خصوصًا بعد أن أعلن الكتابُ نفسُه هذه الوظيفة وحدّدها مرّات كثيرة، منها قوله سبحانه: ﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: 2]»[15].
لا يناقش أحدٌ أنّ القرآن الكريم أشار إلى أصول كثير من تلك العلوم، ونبّه إلى بعض جزئياتها، وتعرّض لمختلف مقاصدها[16]، ولكن لا يستلزم الاحتواء أن تُحشر جميع علوم الدنيا تحت سقف علوم القرآن، بداعي أنّ القرآن أُمّ العلوم، وفي مناهج السَّلَف والخَلَف غُنية؛ إِذْ لا يعثر على مسارد أقحمت العلوم الوافدة في أنواع علوم الفرقان، وحتى لو أقحمت عنوة فإنّ العلم سيعجز عن حملها.
ولقد أحسن السيوطي حين جعل تلك العلوم في نوع المستنبطات من القرآن، إشارة منه إلى أن العلوم الحكمية يمكن أن يبسط الكلام عليها في التفاريع، أمّا أن يفرد لكلّ علم نوع من الأنواع فهذا مما لا قِبَل لأحد به.
وعليه فإنّ القرابة المفهومية القوية تضمن انتماء الموضوعات القرآنية المنبثقة منه، واستقالة الموضوعات الوافدة عليه من خارج الدائرة الشرعية؛ لأنها غريبة عنه، وأمّا العلوم الشرعية المتداخلة[17] معه فإنها تحتاج لمزيد تأمّل وبيان؛ لأنه لو نُظِر إليها باعتبار أساس حدوثها وسبب تخلّقها لعُدّت من أدواته وآلاته، ولو رُوعي فيها واقع وجودها وموطن حضورها لاعتبرت من مسائله وممدّاته[18]، وبكِلَا الاعتبارين يجب أن تنصهر بجميعها في موضوعاته لشمولية المصطلح، ما يصيِّر علم القرآن نطاقًا حاملًا لجميع العلوم الشرعية، عقيدتها وفقهها وحديثها ولغتها وأصولها، إضافة للعلوم القرآنية المنبثقة منه والتي لا تنتمي إلى غيره من العلوم، وبذلك تلتقي موضوعات جميعها في موضوعات علوم القرآن، ويضحَى الفنّ مزيجًا غير ممتاز.
وفي هذا يقول ابن جزي: «اعلم أنّ الكلام على القرآن يستدعي الكلام في اثني عشر فنًّا من العلوم، وهي: التفسير، والقراءات، والأحكام، والنَّسْخ، والحديث، والقصص، والتصوّف، وأصول الدِّين، وأصول الفقه، واللغة، والنحو، والبيان؛ فأمّا التفسير فهو المقصود بنفسه وسائر هذه الفنون أدوات تُعين عليه أو تتعلّق به أو تتفرّع منه»[19]، ويقول النيسابوري في فاتحة تفسيره: «المقدّمة الحادية عشرة في كيفية استنباط المسائل الكثيرة من الألفاظ القليلة: إذا شرعنا مثلًا في تفسير قول القائل: (أعوذُ باللهِ مِن الشيطانِ الرجيمِ)، فههنا مباحث لفظية ومباحث معنوية؛ أمّا اللفظية فمنها ما يتعلّق بالقراءة، ومنها ما يتعلّق باللغة، ومنها ما يتعلّق بعلم الاشتقاق، ومنها ما يتعلّق بعِلْم الصّرف، ومنها ما يتعلّق بالنحو، ومنها ما يتعلّق بعلم البديع أعني المحسنات اللفظية، وأمّا المعنوية فمنها ما يتعلّق بالمعاني، ومنها ما يتعلّق بالبيان، ومنها ما يتعلّق بالاستدلال، ومنها ما يتعلّق بأصول الدِّين، ومنها ما يتعلّق بأصول الفقه، ومنها ما يتعلّق بالفقه، ومنها ما يتعلّق بعلم الأحوال»[20].
انطلاقًا من اقتراض علوم القرآن وتقاطعه الذي يفرض منهجيًّا أن تتزاوج موضوعاته مع جميع موضوعات التخصّصات الشرعية المتداخلة معه، كما تجسّدت مسائلها داخل مسائله ولفّقت معه في تفعيلات المصطلح عبر القرون؛ إِذْ عماد الموضوعات المتداخلة قائم على النظر في المسائل، واحترازًا من ذوبان تلك العلوم فيه وضمّها جميعًا إليه والمفضي للامتزاج والثقل الموضوعي، ينبغي تقييدها بما يناسبها من الانحلال، ويلائمها من الاستعارة، وهذا هو الإشكال العميق الذي يجب طَرْحُه والتوقّف عنده، وليس هو إمكانية التداخل وأثر عدم التمثّل له وكمّه، أو أسبابه ودوره وتاريخه.
ولفكّ الإشكال لا بدّ أوّلًا من الإقرار بأنّ العلوم المتداخلة معه نشأتْ أصلًا لغاية معيّنة، وهدف واضح؛ إِذْ هي علوم آلية بالنظر الأول، وذلك لمحورية النصّ القرآني ومرجعيته في التقارب، ولكن عوامل الزمن أبدلتْ أدوارها وحرّفتْ مسارها، فأضحت علومًا مستقلّة، لها أدواتها ومناهجها ومصادرها وأقلامها.
كما أنّ عِلْم القرآن التفصيلي والذي يتجلّى بصورة واضحة في تفسير القرآن، بدأ في قالب بسيط، يدور في رحاب معاني الآيات، ويزيل عنها الغموض والإشكال بقدر الحاجة، ولكن أدخل المفسِّرون فيما بعد بحسب طبائعهم الغالبة عليهم ما هو فضلة عن الأصل، واستطردوا بَعِيدين عن مهمّة التفسير الأساسية، ناقلين إلى جنباته منظومة متكاملة من العلوم، وأودية لا قِبَل لها بصُلبه.
ولتلافي التشابك القائم، يجب ضبط العلوم المتداخلة معه لاعتبارها أو نفيها بعرضها على المهمّة الأولى التي أُنيطت بها، واستبعاد فرعها وحشوها، فكما يُقال مثلًا أنّ فروع العلوم في التفسير من الفضلات، يُقال مثلها في الموضوعات؛ إِذْ كلّ الفنون تقف على تقاطعاتها مع غيرها، خاصّة والقرآن يُعَدّ الصخرة التي تفتَّقت عليها جميع العلوم، ولكن لا بدّ من التقيّد بحدود المهمّة الأُولى، وترتّب الغرض الأصلي، أو ما يعبّر عنه بالتعلّق القوي، والصِّلَة القريبة المباشرة؛ لتُحَال الزيادات إلى محاضنها، وتنضوي تحت أصولها.
وفي هذا الصّدد يقول ابن خلدون: «وأمّا العلوم التي هي آلة لغيرها مثل العربيّة والمنطق وأمثالهما فلا ينبغي أن يُنظر فيها إلّا من حيث هي آلة لذلك الغير فقط، ولا يوسّع فيها الكلام ولا تفرّع المسائل؛ لأنّ ذلك مخرج لها عن المقصود، إِذ المقصود منها ما هي آلة له لا غير، فكلّما خرجتْ عن ذلك خرجتْ عن المقصود وصار الاشتغال بها لغوًا»[21]، فإذا كان الاشتغال بزيادات العلوم المسدّدة داخل أصلها من اللغو، فما بال الاشتغال بها خارج سربها.
ويقول أبو حيان في شرح آية النَّسْخ: «وقد تكلَّم المفسِّرون هنا في حقيقة النَّسْخ الشرعي وأقسامه، وما اتُّفق عليه منه، وما اختُلف فيه، وفي جوازه عقلًا، ووقوعه شرًعا، وبماذا يُنسخ، وغير ذلك من أحكام النّسخ ودلائل تلك الأحكام، وطوّلوا في ذلك، وهذا كلّه موضوعه عِلْم أصول الفقه، فيُبحث في ذلك كلّه فيه، وهكذا جرت عادتنا: أنّ كلّ قاعدة في علم من العلوم يرجع في تقريرها إلى ذلك العلم، ونأخذها في علم التفسير مسلّمة من ذلك العلم، ولا نطوِّل بذِكْر ذلك في علم التفسير، فنخرج عن طريقة التفسير... وقد ذكرنا في الخطبة ما يحتاج إليه علم التفسير، فمن زاد على ذلك، فهو فضول في هذا العلم»[22].
وعليه فضبط العلوم المتداخلة بقيد التعلّق القويّ هو المسلك الأظهر والأدقّ، وإن كان فيه جانب من الصعوبة والتفاوت الراجع للاجتهاد التقديري.
إنّ الغرض العام من عِلْم القرآن بالاستناد إلى مفهومه المستنبط من القراءة التاريخية هو خدمة القرآن، سواء كان ذلك بتعظيمه ومعرفته، أو الاحتراز عن الخطأ فيه والتنقيص منه، فغرض موضوع التجويد مثلًا: صون اللِّسان عن اللَّحن في كلام الله تعالى، وهو داخل تحت الاحتراز عن الخطأ فيه، أو التنقيص منه، وغرض عِلْم التفسير: الاطلاع على عجائب كلام الله سبحانه وتعالى وامتثال أوامره ونواهيه، وهو مندرج تحت تعظيم القرآن ومعرفته.
فلو حملت المواضيع المتداخلة على النظر في صِلَتها القريبة وترتّب الغرض الأوّلي عليها لتبيّن حالها، ولقد سلمتْ كتب الأنواع في الغالب من الموضوعات البعيدة الصِّلَة؛ كأنواع الفعل، أو أحوال الأبنية، أو أدوات التشبيه، أو أقسام الحديث، أو المغانم، أو المواريث، أو غيرها مما اختصّ كلّ بإطاره الأصلي، ولكنها لم تَسْلَم من الموضوعات القريبة البينيّة التي تخدمها ولكن تقصّيها مخرج عن المقصود؛ كفروع علم البلاغة، من تشبيه واستعارة وتورية، وفروع دلالة اللفظ وأقسامه، من عام وخاصّ ومطلق ومقيّد ومحكم ومتشابه، والسبيل الأوسط في التعامل معها هو الاقتصار على الربط المباشر وتأدية الوظيفة اللازمة؛ وذلك باعتماد أصولها وكلياتها، دون فروعها وأجزائها، وعليه فإنّ الصِّلَة القوية يتمحور إجراؤها في الإخراج بتوظيفها على العلوم الوافدة والمتداخلة دون المنبثقة التي يسمح مفهومها بإدخالها واستيعابها كلّها.
وفي كتب الأنواع التي كثر فيها الاقتراض والتداخل إشارات إلى وجود روابط بين العلم المقترَض والفضاء الذي انتقل إليه، كما قال السيوطي مثلًا عن بعض العلوم البلاغية المقترضة: «التشبيه نوع من أشرف أنواع البلاغة وأعلاها»[23]، وقال: «في الإيجاز والإطناب؛ اعلم أنهما من أعظم أنواع البلاغة»[24].
2- أن يكون إجماليًّا:
وذلك حتى لا يعمّ الموضوع جميع مشتملات المفهوم الإجمالية والتفصيلية؛ بل يقتصر على الشقّ الإجمالي الكلي الذي وفق حدوده ورسومه يتوقّف إلحاق المسائل، وقد قال الزركشي في البرهان: «ولكن اقتصرنا من كلّ نوع على أصوله والرمز إلى بعض فصوله»[25]، وكما قال السيوطي عن كتاب الإتقان موضحًا اتجاهه فيه: «والمقصود في جميع أنواع هذا الكتاب إنما هو ذِكْر القواعد والأصول لا استيعاب الفروع والجزئيات»، وقال أيضًا: «وأكثره قواعد كلية»، وقال في النوع الحادي والمائة (أسماء مَن نزل فيهم القرآن): «وكنتُ عزمتُ على سردهم هنا مرتّبين على حروف المعجم، ثم رأيتُ أنه يلزم منه تكرار كثير؛ لأنّ غالب مَن نزل فيه القرآن ذكر في هذا الكتاب خصوصًا في المبهمات»[26]، وجاء عن محمد سلامة قوله في مطلع كتابه بعد أن بَيّن منهج المتقدمين: «وأمّا منهجنا في هذا المؤلَّف فهو ذِكْر أحكام كلية للجزئيات المتناسبة، وليس غرضنا استيعاب الجزئيات»[27].
وقد جاء التعبير بالإجمالي عوض النظري؛ لأنّ النظري يقابله التطبيقي، وقد ثبت انتماء مواضيع إجمالية مجرّدة من التطبيقات لحقل موضوعات علوم القرآن؛ كمعرفة الحفاظ، وشروط المفسِّر، وطبقات المفسِّرين؛ إِذْ لها عناية إجمالية كلية، ولكن تنعدم فيها التطبيقات على آي القرآن. وعلم القرآن كما هو معلوم شقّان: إجمالي، وتفصيلي.
فعِلم القرآن الإجمالي يتعلّق بالقرآن حسب الموضوعات الجامعة للمسائل، وأما التفصيلي فيتعلّق بالقرآن حسب الترتيب المصحفي غالبًا، والمسألة القرآنية في كلتا الحالتين لا تخرج عن رؤوس الموضوعات، ولكن تنتظم في الإجمالي وفق مجموعات مرتبة، وتتوزّع في التفصيلي على مواقع الآيات في المصحف، وذلك كعلم أسباب النزول؛ إِذْ منه إجمالي ومنه تفصيلي، أمّا الإجمالي فمحلّه في كتب الأنواع، وأمّا التفصيلي فمحلّه في تفسير الآيات أو الكتب المستقلّة بسبب النزول.
ولا يعني هذا أنّ التفصيلي خالٍ من الأصول والتقسيمات، أو أن الإجمالي خالٍ من الفروع والتنزيلات، بل قد تشترك المسألة الواحدة بين الجانبين معًا، ولكن يتحدّد موضعها بحسب احتياجها والنظرة التي ينظر إليها من خلالها، خاصّة إذا استصحبت العلاقة القائمة بينهما، حيث إنّ جُلّ استمداد العلم الإجمالي من العلم التفصيلي، بل هو زبدته وخلاصته، وجوهره وعصارته، كما أنّ العلم التفصيلي استحضار تلك القواعد والأُسس الإجمالية لتفعيلها في الشرح، ومزجها بالتحليل والاستنباط، فالتمييز إذن قائم على المساق الكلي والرؤية الغالبة.
وعليه فيلزم أن تكون الموضوعات الشاملة لِما تعلّق بالقرآن إجمالية، غير مستوعبة لتفصيلات المسائل الدقيقة ومستقصية لجزئياتها، وإلا امتنعت موضوعيتها في العُرف الخاصّ لعلم القرآن الإجمالي، فعِلْم أسباب النزول مثلًا عِلْم من علوم القرآن الكريم، ولكن لمّا أُلحِق بالعلم الجامع استُغني عن تفصيلاته، واحتُفِظ بأصوله الإجمالية، ويُستثنى منه الموضوعات التي تقلّ فروعها؛ كعدد آيات كلّ سورة.
3- أن يكون أصلًا جامعًا للمسائل المتناسبة:
يُشترط للموضوع حتى يكون عِلْمًا مستقلًّا ونوعًا متميزًا أن يجمع ما تناسب من المسائل المتناثرة في موطن واحد، بحيث يكون رأسًا لأفراد متعدّدة متجانسة، سواء كانت قواعد وتعريفات، أم اختلافات واستدراكات، أم تفصيلات وتقسيمات، أم فوائد شتى وتنبيهات.
يعتبر هذا الركن محدّدًا فاصلًا، ومسبارًا دقيقًا، تفحص به الموضوعات وتمتحن على ميزانه؛ إِذْ لا يكفي الانتماء المفهومي مع الاعتناء الإجمالي، بل لا بدّ من انضواء جملة من المسائل المتناسبة تحت الموضوع، وإلا جاز إطلاق مصطلح الموضوع على كلّ مسألة قرآنية إجمالية، عِلْمًا أنّ إعمال قانون الجامعية خاصّ بالعلوم المنبثقة؛ لأنّ الوافدة لا يُجرى عليها العمل أصلًا لغربتها، وأمّا المتداخلة فإنّ قيد الصِّلَة القوية متضمّن لإلحاق الفروع المستطردة بأصولها المعتمدة، ولا يعترض على القيد بالتكرار كون الصِّلَة القوية متضمّنة لإلحاق الأدنى بالأعلى؛ لأنّ الصِّلَة القوية لا تنزّل على المواضيع المنبثقة أصلًا، لشدّة وصلها وظهور ربطها.
يقود الإخلال بهذا العنصر إلى كثرة التشقيقات، والإفراط في التنويعات، رغم إمكانية تلافيها، والذي بدوره ينعكس على تداخل الموضوعات والمسائل بين المؤلِّفين، فما يكون مسألة عند أحدهم، يكون موضوعًا عند آخر، وبذلك تنفلت الحدود، وتختلط الأصول بالفروع، كما أفرد ابن عقيلة مثلًا النوع الخامس عشر (علم الآيات المكية في السور المدنية والآيات المدنية في السور المكية)، والسادس عشر (علم ما نزل بمكة وحكمه مدني وبالعكس)، بأنواع مستقلة، بينما جعلها السيوطي مسائل تابعة لعِلْم المكي والمدني[28].
وللخلوص من التداخل الحاصل بكثرة التنويعات، ووضع حدّ للتزايد المستمر، يتعيّن إلحاق الأنواع الفرعية بأمّها، وإرجاعها لمنبعها، فكثير من المسائل لا ترقى لأنْ تكون موضوعًا يجمع مسائل؛ لأنها ليست بأصل جامع، وعدّها من قبيل الموضوع إغراق ومغالاة.
ويمكن التدليل عليه بما جاء في الزيادة والإحسان مثلًا، حيث ادّعى ابن عقيلة أنه ابتكر كلًّا من الأنواع الآتية: النوع الثاني (علم وحي القرآن وحقيقة الوحي)، والثالث (علم أنواع الوحي)، والرابع (علم بدء الوحي وما ابتدئ به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من الوحي)، والخامس (علم صفة حال النبي -صلى الله عليه وسلم- حين ينزل عليه الوحي)، والسادس (علم كيفية استعجال النبي -صلى الله عليه وسلم- بحفظ الوحي قبل أن يتمّمه جبريل، ونهي الله تعالى له عن ذلك)[29]، في حين أنه فَصَل بينها فقط؛ إِذْ هي مجرّد مسائل فرعية لموضوع النزول، ولا ترتقي لدرجة الأصل الجامع؛ لخلوّها من المتناسبات، ما يتمخض عنه أنّ الموضوع عنده هو كلّ مسألة قرآنية إجمالية، سواء جمعت عددًا من المسائل المتناسبة أو لم تجمع.
ولسائل أن يتساءل عن مقدار المسائل التي يحصل بها الإشباع الموضوعي؟ والجواب عن السؤال يتمثّل في القول أنّ الجزم بعدد معيّن من المسائل لم يدلّ عليه دليل تصريحي في كتب أنواع العلوم، فالمتعارف عليه في اصطلاح الموضوعات المشتهرة أنها كليات أساسية تنصهر في مضمونها جملة من المتناسبات على أساس المفهوم الخاصّ الذي تحمله عناوينها، وعليه فالأمر نسبي، ولا يخضع لقانون حسابي، بحيث متى استوفاها انتقل من المسألة إلى الموضوع بالعملية الرياضية، إلا أن الذي يظهر أنه كلّما كثرت المتناسبات اشتد لحاقها بالموضوع، وكلّما قلّت تأكّد بقاؤها في حدود المسألة.
على أنّ في ذلك نوعًا من الصعوبة؛ إِذْ لا يستقيم عادة القول بالجامعية إلا بَعد النظر في كلّ العلوم والمقارنة بينها للجزم بأنّ النوع المدروس آهل بالأصلية.
وفي ذلك أمارة خفية من تلميحات الزركشي التي تكررت منه في البرهان، فالغالب أنه في مدخل كلّ نوع يصدّره بما أُلِّف فيه؛ إشارة لاستحقاقه الفصل، وصلوحيته للانتماء، إِذْ لم يُفرد بالتأليف إلا وله مسائل كثيرة تندرج تحته، وتشقيقات عديدة تنبثق منه، وإن كانت هناك أسباب أخرى داعية للتمييز الموضوعي.
وقد سار على خطاه السيوطي في الإتقان مقلّدًا له، حيث قال في المقدمة: «وسترى في كلّ نوع منه -إن شاء الله تعالى- ما يصلح أن يكون بالتصنيف مفردًا»، وقال: «وغالب هذه الأنواع فيها تصانيف مفردة وقفتُ على كثير منها»[30]، وأنموذج ذلك أنه لمّا ذكر النوع السابع والثلاثين (فيما وقع فيه بغير لغة الحجاز)، مع أنه فرع لموضوع السادس عشر (في كيفية إنزاله) ويجب أن يلتحق به، قال: «تقدّم الخلاف في ذلك في النوع السادس عشر، ونُورد هنا أمثلة ذلك، وقد رأيتُ فيه تأليفًا مفردًا»[31]، وكما قال عن النوع العاشر (فيما أنزل من القرآن على لسان بعض الصحابة)، مع إمكانية انخراطه في النوع التاسع (معرفة سبب النزول): «هو في الحقيقة نوع من أسباب النزول، والأصل فيه موافقات عمر، وقد أفردها بالتصنيف جماعة»[32]، ولمّا رأى غياب التصنيف في النوع التاسع والعشرين (في بيان الموصول لفظًا المفصول معنى) قال: «وهو نوع مهمّ، جدير أن يُفرد بالتصنيف، وهو أصلٌ كبيرٌ في الوقف»[33]، وقال عن نوع (المدرج): «وسأفرد في هذا النوع -أعني المدرج- تأليفًا مستقلًّا»[34]، فالاستقلالية عنده في كتاب الإتقان عادة ما ترتبط باتساع الموضوع واستيعابه لكوكبة من المتناسبات، أمّا إذا شحَّت مُدرجاته فالأولوية في انضمامه لِما هو أعلى منه، على أنّ ذلك ليس بقاعدة مطّردة، حيث ثبت عنه عدم فصل موضوع متّسع الأطراف بنوع مفرد، كما جاء في ضمن النوع الرابع والثلاثين (في كيفية تحمله): «فصل: من المهمّات تجويد القرآن، وقد أفرده جماعة كثيرون بالتصنيف»[35].
وهنا يفترق عن ابن عقيلة الذي يَعتبر الاستقلالية كامنة في قيمة المسألة، بِغَضّ النظر عن توابعها ولواحقها؛ لذا كثرت الأنواع عنده ورَبَتْ على مائة وخمسين نوعًا، فكلّ مسألة ذات شأن لزم فصلها، ومنه يقول في النوع السابع (علم نزول القرآن من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا): «ولم يُفْرِد هذا النوعَ الحافظُ السيوطي أيضًا -رحمه الله تعالى- بل ذكره ضمنًا في بعض الأنواع وهو حقيق بالإفراد»[36]، وقد ذكره السيوطي ضِمن النوع السادس عشر (في كيفية إنزاله)[37].
والملاحظ أنّ السيوطي كان على هذا المذهب في التحبير رغم وقوفه على المواقع الذي كان يشابه البرهان في ذِكْر المؤلّفات؛ إِذْ كثير من الأنواع التي أضافها من عنده زيادة على المواقع كان ينصّ على أهميتها وشدّة الاحتياج إليها، أو لطفها وتمام النفع بها، من غير ذِكْر مراجعها غالبًا، ولكن اعتدل بعدها في الإتقان لمّا وقف على البرهان وقلّده، حيث ارتكز في الانتقاء على ما لها سَعة وجامعية؛ لذلك كان من بين أسباب رجوعه في عدّها من اثنين ومائة نوع إلى الثمانين، مع أنه أضاف كثيرًا من الزيادات؛ ولذا قال: «فهذه ثمانون نوعًا على سبيل الإدماج، ولو نوّعت باعتبار ما أدمجته في ضمنها لزادتْ على الثلاثمائة»[38].
ومما يساعد في معرفة الموضوع الجامع النظرُ في الفروع؛ ولذا فإن المواضيع التي تنعدم فيها الأمثلة أو تعزّ وتندر، يحسن جعلها فصلًا أو فائدة في موضوعٍ ما، كما جاء مثلًا عند السيوطي في التحبير في النوع الخامس والستين (ما كان واجبًا على واحد فقط)، حيث قال فيه: «إلّا أن أمثلته إنما توجد كثيرة في الحديث»[39].
هذه الثلاثة الأركان من شأنها أن تكفل ببيان شروط التحاق علم بساحة موضوعات علم القرآن أو ابتعاده عنها، فمتى استوفاها صحّ عدّه منها.
ثانيًا: محدّدات شكلية:
وهي المحدّدات المكملة لصورة الموضوعات، والمعدلة لبنيتها، حيث تعتني بجماليات الموضوع وسيمائه، عِلْمًا أن غياب بعضها لن يؤثر في انتسابه وانتمائه كحال المحدّدات الجوهرية، بل ينقص من تمامه، وقد ظهر التفريق بين فرعين منها:
أ- محدّدات شكلية حالة الإفراد: أي حالة النظر فيه مستقلًّا عن غيره، وهي ترجع إلى ناحيتين:
1- باطن الموضوع: المقصود به مضمونه، وحتى يجود لا بد أن ينضوي على المحسِّنين الآتيين:
- الاختصار.
- ترتيب المسائل.
2- ظاهر الموضوع: المقصود به اسمه الذي يعنون به، فهو شكله الخارجي الذي يظهر عليه ويُعرف به، وحتى يتحدّد تحديدًا حسنًا لا بدّ أن يتّسم بالدّقة.
ب- محدّدات شكلية حالة الجمع: أي حالة النظر فيه ملتصقًا بغيره؛ فهي نظرة علوية شاملة. وحتى تكتمل صورة الموضوعات المجتمعة شكليًّا لا بدّ من اشتمالها على الآتي:
1- أن تكون الموضوعات جامعة.
2- أن تدمج الموضوعات المتقابلات والمتشابهات في العناوين.
3- أن تقسم وفق أقسام كلية مع مراعاة الترتيب بينها.
رابعًا: عدد الموضوعات:
تعدّدت الآثار المتعلقة بعدد علوم القرآن، إلا أن تلك الكثرة خلّفت إشكالًا ليس في الرقم العددي لها، وإنما في المقصود بها أولًا، وحصرها من عدمه ثانيًا، وللإجابة على الإشكال -وقبل الخوض في أقاويل العلماء- لا بدّ من التحاكم لمفهوم المصطلح وإطلاقاته في السياق التاريخي، واستحضار الفرق بين المسائل والموضوعات، فهمَا مفتاحَا الباب.
تبيّن فيما مضى أن علوم القرآن في الاصطلاح السائد للمتقدِّمين والمتأخِّرين يُراد به كلّ ما تعلّق به من مسائل قرآنية، وقد يُراد به في المنزلة التي تليه بعض المسائل والموضوعات، أو أحد أفراده، على سبيل التنوّع لا التناقض، فهو مصطلح متبعّض، هذا من جهة، ومن جهة ثانية تبيّن كذلك أنّ المسائل هي منثورات الموضوعات، وأن مجالها الرحب في التداول هو عِلْم القرآن التفصيلي، بحيث تتفرع وتتشعّب، وليس ذلك ككلياتها الإجمالية التي تخضع لمعايير دقيقة.
فعلى الأصلَيْن السابقَيْن مدار التوفيق بين النصوص التي ظاهرها التعارض من حيث تعدّد علوم القرآن وخروجه عن نطاق الحصر أو حصره في أنواع معيّنة، وكذا بيانها، وليس كما يذكر من أن مردّه للتفريق بين المعنى اللغوي والاصطلاحي لعلوم القرآن، والذي هو بالأساس تفريق باطل، وعليه فدلالات النصوص تختلف تبعًا للقصد، فمَن رام المسائل لم يحصرها، ومن رام غيرها حصرها؛ وفيما يأتي زيادة تفصيل لمرادات العدد:
1- المسائل: ما أكثر الأقوال الحاكية لسعة علوم القرآن، وغزارة ما يحويه من المعارف، والمعاني والمستنبطات، والعلوم المستودعة فيه والمنتزعة منه، لدرجة بلغت فيه الآلاف، ولا عجب في هذا إذا استحضر مفهوم عِلْم القرآن الشامل، وفي هذا الصّدد يقول ابن أبي الدنيا: «وَعُلُومُ الْقُرْآنِ وَمَا يُستنبط مِنْهُ بَحْرٌ لَا سَاحِلَ لَهُ»[40]، ويقول الواحدي: «وبعد هذا فإنّ علوم القرآن غزيرة، وضروبها جمّة كثيرة، يقصر عنها القول وإن كان بالغًا، ويتقلّص عنها ذيله وإن كان سابقًا»[41]، ويحكي ابن العربي قولًا لأحد العلماء بقوله: «وقد ركّب العلماء على هذا كلامًا، فقالوا: إنّ علوم القرآن خمسون علمًا وأربعمائة علم، وسبعة آلاف، وسبعون ألفَ عِلْمٍ على عدد كَلِمِ القرآن، مضروبة في أربعة، إِذْ لكلّ كلمة منها ظاهر وباطن، وحدّ ومطلع، هذا مطلق دون اعتبار تركيبه، ونضد بعضه إلى بعض وما بينها من روابط على الاستيفاء في ذلك كلّه، وهذا مما لا يُحصى، ولا يعلمه إلا الله تعالى»[42]، وقال في المسالك: «ولكنّا بعون الله وتأييده وتوفيقه وتسديده؛ في كتابه نتكلّم، وبذِكْره سبحانه نبدأ ونختتم، ومتناولنا القول في جُمَل من علوم القرآن، وإِذْ كانت علومه لا تُحصى، ومعارفه -كما سبق بيانه مِنّي- لا تُستقصى»[43].
وقال الزركشي بعد أن ذَكَر مجموعة من الآثار المتعلّقة بثروة القرآن: «ولمّا كانت علوم القرآن لا تنحصر ومعانيه لا تُستقصى»، وقال: «واعلم أنه ما من نوع من هذه الأنواع إلا ولو أراد الإنسان استقصاءه لاستفرغ عمره ثم لم يُحكم أمره»[44]، وقال طاش كبري زاده: «واعلم أنّ علم القرآن بحر لا تنقضي عجائبه، وطود شامخ لا تتناول غرائبه، وله فروع لا تُحصى، وفنون لا تُستقصى»[45].
2- الموضوعات: لـمّا كان بناء موضوعات علوم القرآن قائمًا على الإجمال والإدماج وغيرهما، فإنه لا بدّ أن تكون أضبط، وأقلّ؛ ولذا فإنّ النصوص المحصية للأنواع والعادّة لها يحمل مفهوم مصطلحها على هذا المعنى، وقد تفاوتت فيما بينها كثرة وقلّة، وأبلغها ما جاء في كتاب الزيادة لابن عقيلة؛ حيث أوصلها إلى أربعة وخمسين ومائة نوع.
قال هبة الله البارزي: «هذا كتاب البستان في علوم القرآن، قصدتُ فيه الاختصار مع البيان... ويشتمل على ثمانية أنواع من علوم الكتاب العزيز»[46]، وقال السيوطي: «فهذه ثمانون نوعًا على سبيل الإدماج، ولو نوّعت باعتبار ما أدمجته في ضِمنها لزادت على الثلاثمائة»[47]، وقال ابن عقيلة: «فشرعتُ في هذا الكتاب، وأودعتُ فيه جُلّ ما في الإتقان، وزدتُ عليه قريبًا من ضِعْفه من المسائل الحسان، واخترعتُ كثيرًا من الأنواع اللطيفة والفوائد الشريفة، هذا على سبيل الإدماج والإجمال، ولو فصّلتها لزادت على أربعمائة نوع»[48].
فالمواضيع يمكن ضبطها بالحصر عادة، بغضّ النظر عن عددها، إلا أنّ في كلام البلقيني إشكالًا، حيث قال متحدثًا عن قسم منها: «ومن الأنواع ما لا يدخل تحت الحصر؛ الأسماء والكنى والألقاب، المبهمات»[49]، والمراد بما لا يدخل تحت الحصر جريًا على التفريق السابق وجمعًا بين نصوصه؛ ما لا يدخل تحت الأقسام الستة الكلية؛ لعدم تناسبها وإمكانية جمعها في إطار يحدّها، ولقد قال قبلها: «فإنّ علوم القرآن لا يقدر على حصرها إلا العالم بلفّها ونشرها، أو مَن ألهمه سبحانه الطريق إلى بعض معانيها، واستخراجها من مبانيها»[50]؛ ولذا أفردها في النهاية على شاكلة كتب الفقه التي تفرد في الأخير كتاب الجامع ليضمّ جملة من المتفرّقات الغير منضوية تحت أصلها.
أو أن المراد به ما لا يدخل تحت حصري وعلمي؛ كإشارة لكثرة الأنواع وتجدّدها وترشحها للزيادة، ولقد قال قبلها: «فأردت أن أذكر في هذا التصنيف، ما وصل إلى علمي مما حواه القرآن الشريف، من أنواع عِلمه المنيف»[51]، وإن كان التوجيه الأول أقرب؛ لأنه مثّل لبعض الأنواع، كالمبهمات، والأسماء والكنى والألقاب، ويؤكّده كلام السيوطي في شرحه للنقاية -وهي اختصار المواقع-: «من أنواع هذا العلم ما لا يتعلّق بما تقدّم وهو كالذيل له والتتمة»[52].
ملاحظة:
وُجِدَت بعض الآثار الأخرى الحاصرة لعلوم القرآن في عددٍ معيّن، وهي لا تدلّ على الموضوعات أو الأنواع، ورغم قلّة عددها إلا أنه يحسن التنبيه عليها، ويمكن التمييز بينها بإرجاعها إلى سياقها، وهي:
1- نواحي المقاصد (المحاور والمضامين): قال ابن العربي: «اعلم أنَّ علومَ القُرآنِ ثلاثةُ أقْسَامٍ: تَوْحِيدٌ، وتَذْكِيرٌ، وأَحْكَامٌ»[53]، وقال: «إِذْ لا تخلو آية منه بل حرف عن هذه الأقسام الثلاثة»[54].
وقال المناوي: «﴿قٌلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ﴾ [الإخلاص: 1] تعدل ثلث الْقُرْآن؛ لأنّ عُلُومَ الْقُرْآن ثَلَاثَةٌ: علم التَّوْحِيد، وَعلم الشَّرَائِع، وَعلم تَهْذِيب الْأَخْلَاق؛ وَهِي مُشْتَمِلَة على الأوّل»[55].
وقال أبو إسحاق الشاطبي: «وذلك أنه محتوٍ من العلوم على ثلاثة أجناس هي المقصود الأول؛ أحدها: معرفة المتوجَّه إليه، وهو الله المعبود سبحانه، والثاني: معرفة كيفية التوجُّه إليه، والثالث: معرفة مآل العبد ليخاف اللهُ به ويرجوه. وهذه الأجناس الثلاثة داخلة تحت جنس واحد هو المقصود، عبّر عنه قوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾[الذاريات: 56]»[56].
ونقل الزركشي عن بعضهم في شرح حديث السبعة أحرف: «الْمُرَاد عِلْمُ الْقُرْآنِ يَشْتَمِلُ عَلَى سَبْعَةِ أَشْيَاءَ: عِلْم الْإِثْبَاتِ وَالْإِيجَادِ... عِلْم التوحيد... عِلْم التنزيه... عِلْم صفات الذات... عِلْم صفات الفعل... عِلْم العفو والعذاب... عِلْم الحشر والحساب... وعِلْم النبوّات... والإمامات»[57]، وحكى أقوالًا أخرى في صدر كتابه[58]، والمراد التمثيل فحسب.
2- أقسام المفاهيم: قال ابن النقيب: «واعلم أنّ علوم القرآن ثلاثة أقسام؛ الأول: عِلْم لم يُطلِع الله عليه أحدًا مِن خلقِه، وهو ما استأثر به من علوم أسرار كتابه؛ من معرفة كنه ذاته وغيوبه التي لا يعلمها إلا هو، وهذا لا يجوز لأحد الكلام فيه بوجه من الوجوه إجماعًا. الثاني: ما أطلعَ اللهُ عليه نبيَّه من أسرار الكتاب واختصه به، وهذا لا يجوز الكلام فيه إلّا له -صلى الله عليه وسلم- أو لمن أذن له، قال: وأوائل السور من هذا القسم، وقيل من القسم الأول. الثالث: علوم علّمها اللهُ نبيَّه مما أودع كتابه من المعاني الجليّة والخفيّة وأمره بتعليمها»[59].
3- أنواع الأحكام: قال معاذ بن جبل: «عِلْم الْقُرْآن على ثَلَاثَة أَجزَاء: حَلَال فَاتّبعهُ، وَحرَام فاجتنبه، ومتشابه يُشكل عَلَيْك فكِلْه إِلَى عالمه»[60].
4- درجات المعرفة: قال ابن جزي: «ودرجاتُ عُلُوم الْقُرْآن أَرْبَعة: حِفْظه، ثمَّ معرِفَة قِرَاءَته، ثمَّ معرفَة تَفْسِيره، ثمَّ تَفْسِيره، ثمَّ مَا يفتح الله تَعَالَى فِيهِ من الْفَهم والْعِلْم لمن يَشَاء، وَإِنَّمَا يحصل هَذَا بعد تَحْصِيل الأدوات، وملازمة الخلوات، وتطهير الْقُلُوب من الْآفَات»[61].
5- الدوحات الكلية للموضوعات: قال عبد القادر آل غازي: «ومن هنا تعلم أن العلوم المتعلّقة بالقرآن أربعة: الأول: ما يتعلق بكتابته، وهو علم الرسم. الثاني: ما يتعلق بالأداء، وهو علم القراءات السبع. الثالث: ما يتعلق بكيفية الأداء، وهو علم التجويد. الرابع: ما يتعلق بالألفاظ، وهو عِلْم الإعراب والبناء والتصريف والبيان والبديع والمعاني»[62].
[1] هذه المقالة من كتاب (علوم القرآن بين المصطلح والموضوع؛ دراسة تحليليَّة)، الصادر عن مركز تفسير سنة 1446هـ، ص149 وما بعدها. (موقع تفسير)
[2] الفوز الكبير، ص29.
[3] ينظر قوله، ص42، ص540.
[4] تصنيف العلوم المتعلقة بعلوم القرآن، موقع (ملتقى أهل التفسير) الإلكتروني.
[5] أنواع التصنيف المتعلقة بتفسير القرآن الكريم، ص12.
[6] الإتقان (1/ 18).
[7] التحبير، ص48.
[8] الإتقان (1/ 27).
[9] الإتقان (1/ 31).
[10] الزيادة والإحسان (1/ 90).
[11] مباحث في علوم القرآن، ص3.
[12] مواقع العلوم، ص255.
[13] أقصد بالشرعي؛ العلوم المعروفة في المنظومة الدينية، سواء كانت شرعية محضة أو لغوية أو تاريخية.
[14] الموافقات (2/ 127)، ينظر بقية كلامه.
[15] مناهل العرفان (2/ 354).
[16] ينظر: الكامل في القراءات، يوسف الهذلي، ص37، الإتقان، عبد الرحمن السيوطي (2/ 127)، التراتيب الإدارية، محمد الكتاني (2/ 121)، البلغة، صديق القنوجي، ص229، التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور (1/ 41)، وله وقفات مع كلام الشاطبي السابق.
[17] التداخل هو اشتراكٌ بين عِلْمَيْن شرعيّين متمايزَيْن أو أكثر في دراسة مسألة معيّنة، وعليه فالموضوع المتداخل بين علوم القرآن والعلوم الأخرى هو ما اشتركَا عليه في بعض المضمون بغضّ النظر عن الواضع الأول؛ كالإيجاز والإطناب، والعام والخاصّ، والنّسخ، والاعجاز.
[18] كلّ عِلم له أصول تمدّه، وعلوم تسهم في تشكّله وتكوينه، ومعنى الاستمداد؛ «ما منه مدد هذا العلم»، التقرير والتحبير، محمد بن الموقت الحنفي (1/ 65)، وللطاهر بن عاشور رأي في المسألة، إِذْ يقول في ممدّات التفسير: «ليس كلّ ما يذكر في العلم معدودًا من مدده، بل مدده ما يتوقّف عليه تقوُّمه، فأمّا ما يورد في العلم من مسائل علوم أخرى عند الإفاضة في البيان، مثل كثير من إفاضات فخر الدين الرازي في (مفاتيح الغيب) فلا يعدّ مددًا للعلم»، التحرير والتنوير (1/ 18). وبغضّ النظر عن كلام ابن عاشور فإنّ علوم القرآن بمعناه المصطلحي يستمدّ قوامه من: القرآن الكريم، السنّة النبوية، آثار الصحابة والتابعين، علوم اللغة العربية، علم الأصول، علم الفقه، علم الحديث، علم العقيدة، وأمّا تغييب علم التفسير والقراءات في ممدّاته لأنها منه، وهذا دَوْر، وبالنسبة للعلوم المتداخلة معه فإنه يتوقّف مدده على أصلها، وأمّا زياداتها فإنها فضلة.
[19] التسهيل (1/ 15).
[20] غرائب القرآن ورغائب الفرقان (1/ 55).
[21] المقدّمة (1/ 739).
[22] البحر المحيط (1/ 547).
[23] (3/ 142).
[24] (3/ 179).
[25] البرهان (1/ 12).
[26] الإتقان (2/ 308)، قطف الأزهار (1/ 89)، التحبير، ص557.
[27] منهج الفرقان (1/ 26).
[28] الزيادة والإحسان (1/ 219) وما بعده، الإتقان (1/ 36).
[29] (1/ 109) وما بعده.
[30] (1/ 27، 31).
[31] الإتقان (2/ 106).
[32] الإتقان (1/ 127).
[33] الإتقان (1/ 309).
[34] الإتقان (1/ 266).
[35] الإتقان (1/ 346).
[36] الزيادة والإحسان (1/ 152).
[37] الإتقان (1/ 146).
[38] (1/ 31).
[39] ص337.
[40] الإتقان، عبد الرحمن السيوطي (4/ 216).
[41] أسباب النزول، عليّ الواحدي، (حميدان)، ص8.
[42] قانون التأويل، ص540.
[43] (1/ 101) وما بعده.
[44] البرهان (1/ 9، 12).
[45] مفتاح السعادة (2/ 344).
[46] البستان، ص54.
[47] الإتقان (1/ 31).
[48] الزيادة والإحسان (1/ 90).
[49] المواقع، ص257.
[50] المواقع، ص251.
[51] المواقع، ص255.
[52] إتمام الدراية، ص51.
[53] الجواهر الحسان، عبد الرحمن بن مخلوف (2/ 300).
[54] القبس، ص1047.
[55] التيسير (1/ 102).
[56] الموافقات (4/ 204).
[57] البرهان (1/ 224)، وينظر أيضًا: حجة الله البالغة، أحمد الدهلوي (1/ 110).
[58] (1/ 16) وما بعده.
[59] الإتقان، عبد الرحمن السيوطي (4/ 220).
[60] الفردوس، شيرويه الديلمي (3/ 41)، جامع الأحاديث، عبد الرحمن السيوطي (14/ 226).
[61] القوانين الفقهية، ص279.
[62] بيان المعاني (2/ 320).


