نقد التفسير بمجرّد اللغة عند ابن جرير الطبري في تفسيره (جامع البيان)
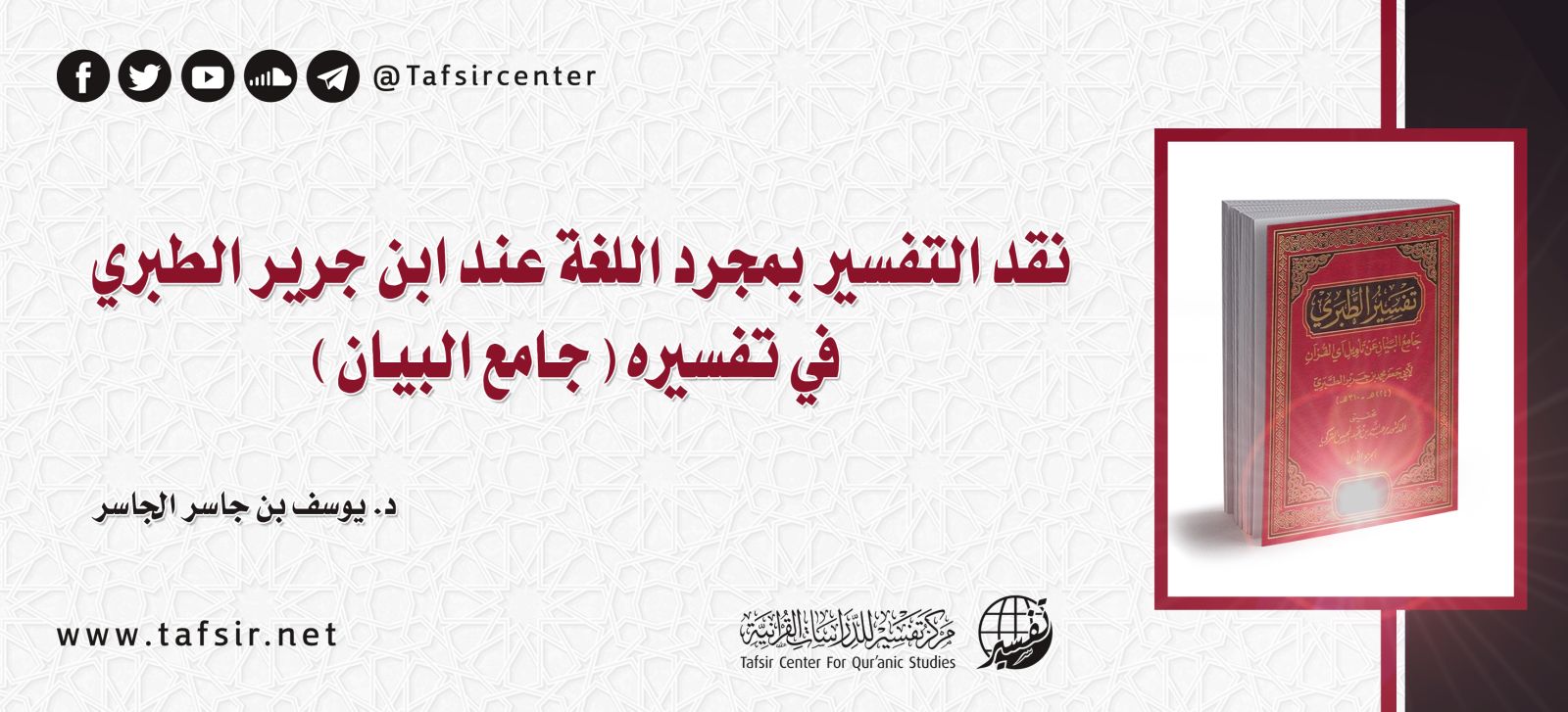
نقد التفسير بمجرّد اللغة عند ابن جرير الطبري في تفسيره (جامع البيان)[1]
إنّ من أهمّ الأصول التي بنى عليها ابنُ جرير تفسيره، وقرّر فيها اختياره في التأويل، وأجرى من خلالها نقده للأقوال؛ مراعاة اللغة العربية، وذلك «أنَّ كتاب الله الذي أنزله إلى نبيِّنا محمد -صلى الله عليه وسلم- بلسان محمد -صلى الله عليه وسلم-، وإِذْ كان لسان محمد -صلى الله عليه وسلم- عربيًّا، فبيِّنٌ أنّ القرآنَ عربيٌّ، وبذلك أيضًا نطقَ مُحْكَمُ تنزيل ربِّنا، فقال جلّ ذِكْره: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ [يوسف: ٢]، وقال: ﴿وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ * نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ * عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ * بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ﴾ [الشعراء: ۱۹۲- ١٩٥]. وإِذْ كانت واضحةً صحةُ ما قلنا -بما عليه اسْتَشْهَدْنَا مِنَ الشَّواهِدِ، ودلَّلْنا عليه من الدلائل- فالواجب أن تكون معاني كتابِ اللهِ المُنَزَّلِ على نبيّنا محمد -صلى الله عليه وسلم- لمعاني كلامِ العرب موافقةً، وظاهره لظاهر كلامها ملائمًا، وإنْ بايَنَه كتابُ الله بالفَضيلةِ التي فَضَلَ بها سائرَ الكلامِ والبَيانِ»[2].
ومِن وجوه التأويل عند ابن جرير ما مرجعه لسان العرب ألفاظًا وتراكيب، أو اختلاف أساليب العرب في كلامها، فيما قدّمه ابن جرير في مقدّمة كتابه.
لكن قد نبّه ابنُ جرير على شرط صحّة ذلك مما كان «مدركًا عِلْمه من جهة اللسان؛ إمّا بالشواهد من أشعارهم السائرة، وإمّا من منطقهم ولغاتهم المستفيضة المعروفة، كائنًا من كان ذلك المتأوّل والمفسِّر، بعد ألّا يكون خارجًا تأويله وتفسيره ما تأوّل وفَسّر من ذلك عن أقوال السَّلَف من الصحابة والأئمة، والخلف من التابعين وعلماء الأمة»[3].
ويقرّر ابنُ جرير منهجه في التفسير والتأويل مع مراعاة أقوال أهل اللغة، فيقول في تأويل قوله تعالى: ﴿يَا مُوسَى لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ * إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [النمل: ۱۰- ۱۱]؛ فقد ابتدأ ابن جرير تفسيرها بقوله: «يقول تعالى ذِكْره: فناداه ربُّه: يا موسى، لا تخف من هذه الحيّة ﴿إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ﴾. يقول: إني لا يخافُ عندي رُسلي وأنبيائي الذين أَختصُّهم بالنبوّة، إلّا مَن ظلم منهم، فعمل بغير الذي أُذِن له في العمل به. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويل».
ثم روَى عن ابن جريج، قال: «قوله: ﴿يَا مُوسَى لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ * إِلَّا مَنْ ظَلَمَ﴾. قال: إني إنما أخفتُك لقتلك النفس. قال: وقال الحسن: كانت الأنبياء تُذنِبُ فتُعاقَب، ثم تُذنِبُ واللهِ فتُعاقَب».
ثم عرض لخلاف أهل العربية في وجه دخول ﴿إِلَّا﴾ في هذا الموضع، وهو استثناءٌ مع وعد اللهِ الغفران المستثنى من قوله: ﴿إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ﴾، بقوله: ﴿فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾. وحكمُ الاستثناء أن يكون ما بعده بخلاف معنى ما قبله؛ فقال بعض نحويي البصرة[4]: «أُدخِلَت ﴿إِلَّا﴾ في الموضع؛ لأنّ ﴿إِلَّا﴾ تدخل في مثل هذا الكلام، كمثل قول العرب: ما أشتكي إلّا خيرًا. فلم يجعل قوله: إلا خيرًا، كأنه قال: ما أذكر إلّا خيرًا».
وقال بعض نحويي الكوفة[5]: «يقول القائل: كيف صُيِّر خائفًا مَنْ ظَلَمَ، ثم بدّل حُسنًا بعد سوء، وهو مغفور له؟ فأقول له: في هذه الآية وجهان؛ أحدهما، أن يقول: إنّ الرسل معصومة، مغفور لها، آمنة يوم القيامة، ومَن خلط عملًا صالحًا وآخر سيئًا فهو يخافُ ويرجو. فهذا وجه. والآخر، أن يجعل الاستثناء من الذين تُرِكوا في الكلمةِ؛ لأنّ المعنى: لا يخافُ لديّ المرسلون، إنما الخوف على مَن سواهم. ثم استثنى فقال: ﴿إِلَّا مَنْ ظَلَمَ﴾. يقول: كان مشركًا فتاب من الشرك، وعمل حُسنًا، فذلك مغفور له، وليس بخائف».
قال: وقد قال بعضُ النحويين[6]: «إنّ (إلّا) في اللغة بمنزلة (الواو)، وإنما معنى هذه الآية: لا يخاف لديّ المرسلون، ولا مَن ظلم ثم بدَّل حُسنًا. قال: وجعلوا مثله، كقول الله: ﴿لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ﴾ [البقرة: ١٥٠]».
ثم عقّب باختياره بتحليل أسلوبي عميق وبديع، مراعيًا أصوله النقدية بمراعاة أقوال أهل التأويل، وقواعده النقدية بمراعاة نسق الكلام والتأويل الصحيح، فقال: «والصواب من القول في قوله: ﴿إلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ﴾ عندي غير ما قاله هؤلاء الذين حكينا قولهم من أهل العربية، بل هو القول الذي قاله الحسن البصري وابن جريج، ومَن قال قولهما؛ وهو أنّ قوله: ﴿إِلَّا مَنْ ظَلَمَ﴾ استثناء صحيح من قوله: ﴿لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ﴾ إلا مَنْ ظَلَم منهم فأتَى ذنبًا، فإنه خائف لديه من عقوبته.
وقد بَيَّن الحسن -رحمه الله- معنى قيلِ اللهِ لموسى ذلك، وقوله: قال: إني إنما أخفتُك لقتلك النفس».
ثم أجاب ابن جرير عن الإشكالات التي تَرِد على هذا الأسلوب (الاستثناء المتصل)، فقال: «فإن قال قائل: فما وجه قيله إنه كان قوله: ﴿إِلَّا مَنْ ظَلَمَ﴾ استثناءً صحيحًا، وخارجًا مِن عداد مَن لا يخاف لديه مِن المرسلين؟ وكيف يكون خائفًا من كان قد وُعِد الغفران والرحمة؟
قيل: إنّ قوله: ﴿ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ﴾ كلام آخر بعد الأوّل، وقد تناهى الخبر عن الرّسل ممن ظَلم منهم ومَن لم يَظلم عند قوله: ﴿إِلَّا مَن ظَلَمَ﴾. ثم ابتدأ الخبر عمّن ظَلم من الرّسل، وسائر الناس غيرهم. وقيل: فمن ظَلَم ثم بدّل حُسنًا بعد سوءٍ فإني له غفور رحيم.
فإن قال قائل: فعلام تعطفُ -إن كان الأمر كما قلت- بـ﴿ثُمَّ﴾، إن لم يكن عطفًا على قوله: ﴿ظَلَمَ﴾؟
قيل: على متروكٍ استغنى بدلالة قوله: ﴿ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ﴾ عليه عن إظهاره؛ إِذْ كان قد جرى قبل ذلك من الكلام نظيره، وهو: فمَن ظلم من الخلق».
ثم بيَّن ابن جرير وجه الخطأ في كلام أهل العربية؛ بعدم وقوفهم عند التأويل الصحيح للآية، وانتزاعهم معنى مخالفًا، وتكلّفهم في أسلوبها؛ فقال: «وأمّا الذين ذكرنا قولهم من أهل العربية، فقد قالوا على مذهب العربية، غير أنهم أغفلوا معنى الكلمة، وحملوها على غير وجهها من التأويل، وإنما ينبغي أن يحمل الكلام على وجهه من التأويل، ويُلتمس له على ذلك الوجه للإعراب في الصحة مخرجٌ، لا على إحالة الكلمة عن معناها ووجهها الصحيح من التأويل»[7].
إنّ هذا النموذج يبرز عمق منهج ابن جرير النقدي، وشموله، واستكماله أدوات النقدية، واستيعابه أقوال أهل اللغة، مع التوجيه والتحليل؛ لكنه يعالجها وفق الأصول والقواعد النقدية للأقوال، مع الشرح والبيان، ليوضح آلية ابن جرير في التعامل النقدي بين أقوال التأويل وأهل العربية.
وما اختاره ابن جرير هو قول طائفة من اللغويين والمفسِّرين، منهم: يحيى بن سلام، وابن قتيبة، ومكي بن أبي طالب، وابن عاشور، وغيرهم[8].
بينما ذهب كثيرٌ من اللغويين والمفسِّرين إلى أنه منقطع، منهم: الفرّاء[9]، والزجّاج، والزمخشري، والقرطبي، وابن جزي، وأبو حيان، وابن كثير، والخازن، وأبو السعود، والجمل، وغيرهم[10].
لكن ابن جرير لا يقصد بتقديم قول أهل التأويل إلى رَدِّ قول أهل العربية، بل هو يُعنى بالتوجيه والتحليل والتعليل، وهذا يبرزه ما ذكره في تأويل قوله تعالى: ﴿وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَئًا﴾ [يوسف: ۳۱]، إذ ابتدأ معنى الآية ببيان معنى (المتّكَأ) بأنه هو مجلس الطعام، وما يُتّكَأ عليه من النمارق والوسائد. ورواه عن أهل التأويل، منهم: ابن عباس، وسعيد بن جبير، والحسن.
ثم بَيَّن وجه الروايات الواردة بأنّ (المتّكَأ): الطعام، والأُترج[11]، فقال: «فهذا الذي ذكرنا عمّن ذكرنا عنه من تأويل هذه الكلمة، هو معنى الكلمة وتأويل المتّكَأ، وأنها أعدّت للنسوة مجلسًا فيه متّكأ وطعامٌ وشرابٌ وأُترج. ثم فسّر بعضُهم المتّكَأ بأنه الطعام، على وجه الخبر عن الذي أُعِدَّ من أجله المتّكَأ، وبعضهم عن الخبر عن الأترج[12]، إذا كان في الكلام: ﴿وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِّينًا﴾؛ لأنّ السكين إنما تُعَدّ للأترج وما أشبهه مما يُقطع به، وبعضهم على البَزْمَاوَرْد»[13].
ثم نقلَ قولَ أبي عبيدة، ونَقْدَ أبي عبيد القاسم بن سلام، وانفصل إلى توجيه قول أبي عبيدة وتقديمه، فقال: «وقال أبو عبيدة معمر بن المثنى: المتّكَأ هو النمرق يُتّكَأ عليه. وقال: زعم قوم أنه الأترج. قال: وهذا أبطل باطل في الأرض، ولكن عسى أن يكون مع المتّكَأ أُترج يأكلونه»[14].
وحكى أبو عبيد القاسم بن سلام قول أبي عبيدة هذا، ثم قال: «والفقهاء أعلم بالتأويل منه». ثم قال: «ولعلّه بعض ما ذهب من كلام العرب، فإنّ الكسائي كان يقول: قد ذهب من كلام العرب شيءٌ كثيرٌ انقرض أهله»[15].
والقولُ في أنّ الفقهاء أعلم بالتأويل من أبي عبيدة، كما قال أبو عبيد لا شك فيه، غير أنّ أبا عبيدة لم يبعد من الصواب في هذا القول، بل القولُ كما قال: «مِن أنّ مَن قال للمتكأ: هو الأترج، إنما بَيَّن المعدّ في المجلس الذي فيه المتّكَأ، والذي من أجله أُعطين السكاكين؛ لأن السكاكين معلوم أنها لا تعدّ للمتكَأ إلا لتخريقه، ولم يُعطين السكاكين لذلك. ومما يبيِّن صحة ذلك القول الذي ذكرناه عن ابن عباس، من أنّ المتكأ هو المجلس».
ثم روَى بسنده عن مجاهد، عن ابن عباس: ﴿وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَئًا وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِّينًا﴾. قال: أعطتهن أُترجًّا، وأعطتْ كلّ واحدة منهنّ سكينًا.
ثم عقّب بقوله: «فبيَّن ابن عباس في رواية مجاهد هذه ما أعطت النّسوة، وأعرض عن ذِكْر بيان معنى المتكأ؛ إِذْ كان معلومًا معناه».
ثم أوردَ الروايات التي فيها تفسير المتكأ بالطعام عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وقتادة وابن زيد، ثم روَى عن ابن عباس وابن زيد وابن إسحاق في قوله تعالى: ﴿وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِّينًا﴾ أي: أعطتهنّ أترجًّا، وأعطت كلّ واحدة سكينًا ليحززن الترنج بالسّكين، ثم عقّب بقوله: «قال الله -تعالى ذِكْره- مخبرًا عن امرأة العزيز والنسوة اللاتي تحدّثْنَ بشأنها في (متّكأ). وذلك أنّ الله -تعالى ذِكْره- أخبر عن إيتاء امرأة العزيز النسوة السكاكين، وترك ما له آتتهن السكاكين؛ إِذْ كان معلومًا أن السكاكين لا تُدْفَع إلى من دُعِيَ إلى مجلس إلّا لقطع ما يؤكَل إذا قُطع بها، فاستغنى بفهم السامع بذِكْر إيتائها صواحباتها السكاكين، عن ذِكْر ما له آتتهن ذلك، فكذلك استغنى بذِكْر اعتدادها لهنّ المتكأ عن ذِكْر ما يُعتدّ له المتكأ، مما يحضر المجالس من الأطعمة والأشربة والفواكه وصنوف الالتهاء؛ لفهم السامعين بالمراد من ذلك، ودلالة قوله: ﴿وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَئًا﴾ عليه. فأمّا نفس المتكأ، فهو ما وصفنا خاصّة دون غيره»[16].
وما اختاره ابن جرير وقرّره تواطأت عليه كلمة أكثر اللغويين، منهم: الفرّاء، والزجّاج، والنحّاس، والأزهري[17].
كما هو قول عامة المفسِّرين، منهم: البخاري، والسمرقندي، ومكي بن أبي طالب، والزمخشري، والقرطبي، وابن كثير، وابن جزي، والآلوسي، ورشيد رضا، وابن عاشور، وغيرهم[18].
وتبيّن بهذا النموذج تقرير ابن جرير تقديم قول أهل التفسير في بيان مفردات القرآن على أهل اللغة، لكن مع الاحتفاء بسعة العربية في أساليب كلامها، بمراعاة سياقاتها وأحوالها، مع البصر والنفاذ بلطائف معانيها.
إنّ ابن جرير في نقده لأقوال أهل العربية في التفسير -ممن لا يراعي أقوال أهل التأويل سواء في المفردات أو التراكيب، أو الإعراب، أو الأسلوب- يراعي أصوله وقواعده النقدية.
ففي تأويل قوله تعالى: ﴿ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ﴾ [يوسف: ٤٩]؛ ذكر ابن جرير قولين لأهل التفسير في معنى ﴿يَعْصِرُونَ﴾:
القول الأول: أي: يعصرون السمسم دهنًا، والعنب خمرًا، والزيتون زيتًا.
ورواه عن ابن عباس، ومجاهد، والسدي، والضحاك، وقتادة.
القول الثاني: أي: يحلبون.
ورواه عن ابن عباس -أيضًا- من طريق عليّ بن أبي طلحة.
وقد اختار ابن جرير القول الأول، وعقّب بنقد قول بعض اللغويين، فقال: «وكان بعض من لا عِلْم له بأقوال السَّلَف من أهل التأويل[19]، ممن يفسِّر القرآن برأيه على مذهب كلام العرب يوجّه معنى قوله: ﴿وَفِيهِ يَعْصِرُونَ﴾ إلى: وفيه ينجون من الجدب والقحط بالغيث، ويزعم أنه من العصر، والعصر[20] التي بمعنى المنجاة، من قول أبي زبيد الطائي[21]:
صاديا يستغيث غير مُغاثِ ** ولقد كان عُصرة المَنْجُودِ
أي: المقهور».
ثم قال: «وذلك تأويل يكفي من الشهادة على خطئه، خلافُه قولَ جميعِ أهل العلم من الصحابة والتابعين».
ثم ثنّى بنقد القول الآخر، فقال: «وأمّا القول الذي روَى الفرج بن فضالة عن عليّ بن أبي طلحة، فقول لا معنى له؛ لأنه خلاف المعروف من كلام العرب، وخلاف ما يُعرف من قول ابن عباس رضي الله عنهما»[22].
فقد توجّه نقد ابن جرير إلى هذين القولين بمعاييره النقدية، أمّا الأول؛ فقد توجّه النقد إلى منهج أبي عبيدة من جهات:
١. ما ذكره ابن جرير من عدم عِلْمه بأقوال السَّلَف في التفسير؛ ولذا جاء قوله مخالفًا لقول جميع السَّلَف من الصحابة والتابعين.
٢. الخطأ في تفسيره باللغة دون مراعاةٍ لشروط التفسير المعتبرة.
وأمّا القول الآخر، فأجرى نقده من جهتين:
١. أنّ هذا القول خلاف الأصحّ من قول ابن عباس.
٢. أنّ هذا القول خلاف المعروف من لغة العرب.
وقد وافق ابنَ جرير في نقده: النحاسُ[23]، كما ذهب جمهور المفسِّرين[24] إلى موافقته في اختياره، منهم: ابن قتيبة، والبغوي، وابن عطية، وأبو حيان، وابن كثير، والقاسمي، وابن عاشور، وغيرهم[25]. لكن قد اختار بعض اللغويين قول أبي عبيدة، منهم: مكيّ بن أبي طالب[26].
وهكذا في تأويل قوله تعالى: ﴿فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ [آل عمران: ٣٩]؛ فقد أورد ابن جرير معنى قوله: ﴿بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ﴾، أي: عيسى عليه السلام.
ثم رواه عن ابن عباس رضي الله عنهما، ومجاهد، وعكرمة، والحسن، وقتادة، والربيع، والسدّي.
ثم عقّب بقوله: «وقد زعم بعض أهل العلم بلغات العرب من أهل البصرة[27] أنّ معنى قوله: ﴿مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللهِ﴾ بكتابٍ من الله، من قول العرب: أَنْشَدَنِي فلانٌ كلمةَ كذا، يراد به قصيدة كذا، جهلًا منه بتأويل الكلمة واجتراءً على ترجمة القرآن برأيه»[28].
وما قرره ابن جرير هو قول الجمهور -كما قال الرازي وأبو حيان[29]-، وقرّره: الزجّاج، والنحاس، والبغوي، وابن عطية، وابن كثير، وابن عاشور[30].
ولنستعرض أهم الأصول والقواعد النقدية التي اعتمدها ابنُ جرير في نقده للتفسير بمجرد اللغة:
١. مراعاة السُّنّة النبوية:
ففي تأويل قوله تعالى: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبَضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [الزمر: ٦٧]، قرّر ابن جرير تفسيرها بحسب الظاهر؛ على ما اقتضته الأحاديث والآثار من إثبات صفة اليد لله عزَّ وجَلَّ، فروى بسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: «أتى النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- رجلٌ من أهل الكتاب، فقال: يا أبا القاسم، أبلغك أنّ اللهَ يحمل الخلائق على إصبع، والسماوات على إصبع، والأرضين على إصبع، والشجر على إصبع، والثرى على إصبع؟! قال: فضحك النبي -صلى الله عليه وسلم- حتى بدت نواجذه، فأنزل الله: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ﴾ إلى آخر الآية»[31].
ثم عقّب بنقد قول بعض أهل اللغة، فقال: «قال بعض أهل العربية من أهل البصرة: ﴿وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ﴾. يقول: في قدرته؛ نحو قوله: ﴿وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [النساء: ٣٦]. أي: وما كانت لكم عليه قدرة. وليس المِلْكُ لليمين دون سائر الجسد. قال: وقوله: ﴿قَبْضَتُهُ﴾. نحو قولك للرجل: هذا في يدك، وفي قبضتك. والأخبار التي ذكرناها عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وعن أصحابه وغيرهم، تَشهد على بُطول هذا القول»[32].
وقد وافق ابنَ جرير في اختيارهِ، واعتمادِ الحديث في تفسير الآية دون تأويل جماعةٌ من المفسرين، منهم: عبد الرزاق، والبخاري، والبغوي، وابن كثير، وغيرهم[33].
۲. مراعاة الإجماع:
ففي تأويل قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ﴾ [البقرة: ٢١٧]؛ أوردَ ابن جرير الخلاف في إعراب ﴿وَصَدٌّ﴾ ورافعه؛ فابتدأ بتقرير تأويلها بما رواه عن ابن عباس، ومجاهد، والضحاك، فروى بسنده عن الضحاك قال: «كان أصحاب محمد -صلى الله عليه وسلم- قتلوا ابنَ الحَضْرَمِيّ في الشهر الحرام، فعَيَّر المشركون المسلمين بذلك، فقال اللهُ: قتالٌ في الشهر الحرام كبيرٌ، وأكبرُ من ذلك صدٌّ عن سبيل الله وكفرٌ به وإخراجُ أهلِ المسجدِ الحرام من المسجد الحرام».
ثم بَيَّن الوجه الصحيح في الإعراب، فقال: «وهذان الخبران اللذان ذكرناهما عن مجاهد والضحاكِ يُنْبِئان عن صِحَّةِ ما قُلْنا في رفع (الصدّ) به، وأنّ رافِعَه: ﴿أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ﴾. وهما يُؤكِّدان صحّة ما روَينا في ذلك عن ابنِ عباس، ويدلّان على خطأ مَن زعم أنه مرفوع على العطف على (الكبير). وقول مَن زعَم أنّ معناه: وكبيرٌ صدٌّ عن سبيلِ الله. وزعَم أنّ قوله: ﴿وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللهِ﴾، خَبَرٌ مُنقطع عمّا قبله مبتدأ».
ثم عقّب بنقد قول أهل العربية من جهة إجماع أهل الإسلام، فقال: «وأمّا أهل العربية فإنهم اختلفوا في الذي ارْتَفَع به قوله: ﴿وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾. فقال بعضُ نَحْويي الكوفيين[34]: في رفعه وجهان: أحدُهما، أن يكونَ (الصدّ) مَرْدُودًا على (الكبير)، تُرِيدُ: قُل: القتالُ فيه كبيرٌ وصدٌّ عن سبيلِ اللهِ وكُفْرٌ به. وإن شئتَ جعلتَ الصدَّ كبيرًا، تُرِيدُ به قُلْ: القتالُ فيه كبيرٌ، وكبيرٌ الصدُّ عن سبيل الله والكفرُ به.
قال: فأخطأ -يعني الفرّاء- في كِلَا تأويلَيه، وذلك أنه إذا رفع (الصّدّ) عطفًا به على ﴿كَبِيرٌ﴾، يَصِيرُ تأويل الكلام: قُل: القتالُ في الشهر الحرام كبيرٌ، وصدٌّ عن سبيل الله وكفرٌ بالله. وذلك من التأويل خلافُ ما عليه أهلُ الإسلام جميعًا؛ لأنه لم يدَّعِ أحدٌ أن الله -تبارك وتعالى- جعلَ القتالَ في الأشْهُرِ الحُرمِ كُفْرًا بالله، بل ذلك غير جائز أن يُتَوهَّمَ على عاقلٍ يَعْقِلُ ما يقولُ أن يقوله، وكيف يجوز أن يقوله ذو فِطرةٍ صحيحة، والله -جل ثناؤُه- يقولُ في أثر ذلك: ﴿وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ﴾.
وأمّا إذا رفع (الصدّ) بمعنى ما زعم أنه الوجهُ الآخرُ -وذلك رفعُه بمعنى: وكبيرٌ صدٌّ عن سبيلِ اللَّهِ، ثم قيل: ﴿وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ﴾- صار المعنى إلى أنّ إخراجَ أهلِ المسجدِ الحرامِ مِن المسجد الحرام، أعظمُ عندَ اللهِ مِن الكفر باللهِ والصد عن سبيله وعن المسجد الحرام. ومُتأوِّلُ ذلك كذلك داخَلَ مِن الخَطأ في مثلِ الذي دخَلَ فيه القائلُ القولَ الأَوَّلَ؛ مِن تَصْييره بعضَ خِلالِ الكُفْرِ أَعظَمَ عِندَ اللَّهِ من الكفر بعينه، وذلك مما لا يُخيلُ على أحدٍ خَطؤه وفساده»[35].
وقد وافق ابنَ جرير في اختياره الزجّاجُ، والنحّاسُ، وابن عطية، والقرطبي، وغيرهم[36].
٣. مراعاة أقوال أهل التأويل:
ومنه ما ذكره ابن جرير في تأويل قوله تعالى: ﴿وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ﴾ [القصص: ٧٦]؛ فقد ابتدأ تأويلها، فقال: «وآتينا قارون من كنوز الأموال ما إنّ مفاتحه -وهي جمع مفتح، وهو الذي يفتح به الأبواب، وقال بعضهم: عَنى بالمفاتح في هذا الموضع: الخزائن- تُثْقِل العُصبة؛ وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل».
ثم حكى اختلافَ أهلِ العلم بكلام العرب في توجيه كيف تنوء المفاتح بالعصبة، وإنما العصبة هي التي تنوء بها؟ فذكر أقوالًا:
القول الأول: قال بعضُ أهل البصرة[37]: مجاز ذلك: ما إنّ العُصبة ذوي القوة لتنوء بمفاتح نِعَمِه، قال: ويقال في الكلام: إنها لتنوء بها عجيزتها، وإنما هي تنوء بعجيزتها، كما ينوء البعير بحمله، قال: والعرب قد تفعل مثل هذا، قال الشاعر[38]:
فديتُ بنفسِه نفسِي ومالِي ** وما آلُوكَ إلا ما أُطِيقُ
والمعنى: فديتُ بنفسِي وبمالي نفسَه.
القول الثاني: قال آخرُ من البصريين[39]: ﴿مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ﴾ يريد: الذي إنّ مفاتحه، قال: وهذا موضع لا يكاد يبتدأ فيه ﴿إِنَّ﴾، وقد قال تعالى: ﴿قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ﴾ [الجمعة: ۸]، وقوله: ﴿لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ﴾، إنما العُصبة تنوء بها، وفي الشِّعْر:
تنوء بها فتثقلها عجيزتها[40]
وليست العجيزة تنوء بها، ولكنها هي تنوء بالعجيزة. وقال الأعشي[41]:
ما كنتُ في الحرب العَوَان مُغَمِّرًا ** إذ شبَّ حرُّ وقودِهـا أجـذالَهـا
القول الثالث: قال بعض الكوفيين[42]: قوله: ﴿لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ﴾ نَوؤُها بالعصبة أن تُثقِلَهُم، وقال: المعنى: ما إنّ مفاتحه لَتُنِيءُ العصبةَ، تميلهم من ثقلِها، فإذا أدخلت الباء قلت: تنوء بهم، كما قال: ﴿قَالَ آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا﴾ [الكهف: ٩٦].
وقد اعتمد ابنُ جرير منهجه النقدي بمراعاة أصوله: (قول أهل التأويل)، و(الأخذ بالظاهر)، و(النظر الصحيح)؛ فقال: «وهذا القولُ الآخرُ في تأويل قوله: ﴿لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ﴾ أَوْلَى بالصواب من الأقوال الأُخَرِ؛ لمعنيين؛ أحدهما: أنه تأويل موافق لظاهر التنزيل. والثاني: أنّ الآثار التي ذكرنا عن أهلِ التأويل بنحو هذا المعنى جاءت، وأنَّ قولَ مَن قال: معنى ذلك: ما إنّ العصبة لتنوء بمفاتحه. إنما هو توجيهٌ منهم إلى أنّ معناه: ما إنّ العُصبة لتَنْهَضُ بمفاتحه. وإذا وُجِّه إلى ذلك لم يكن فيه من الدلالة على أن أُريد به الخبرُ عن كثرة كنوزه على نحو ما فيه إذا وُجِّه إلى أنّ معناه: إنّ مفاتحه تُثْقِلُ العُصبة وتُمِيلُها؛ لأنه قد تَنْهَضُ العُصبة بالقليل من المفاتح وبالكثير، وإنما قصَد -جلَّ ثناؤُه- الخبرَ عن كثرة ذلك، وإذا أُريد به الخبر عن كثرته، كان لا شكّ أن الذي قاله مَن ذكرنا قوله، من أنّ معناه: لتنوء العصبة بمفاتحه؛ قول لا معنى له، هذا مع خلافه تأويل السَّلَف في ذلك»[43].
وهذا من النماذج التي تبرز عُمق قراءة ابن جرير النقدية في جَمْعها بين الأدلة النقلية والنظرية، وبيان توافقها وتطابقها في بيان المعنى الصحيح، وردّ الأقوال المخالفة للتفسير الصحيح مع التحليل والتوجيه والتعليل.
وهكذا في تأويل قوله تعالى: ﴿وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى * فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى﴾ [الأعلى: 4- 5]؛ إذ ذكر قول أهل التأويل في معنى الآية عن ابن عباس ومجاهد وقتادة وابن زيد؛ فروى عن ابن زيد في قوله: ﴿فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى﴾. قال: «كانَ بَقْلًا ونباتًا أخضر، ثم هاج فيبس، فصار غُثاءً أَحْوَى، تَذهَبُ به الرياحُ والسُّيولُ».
ثم نقل قولًا آخر، فقال: «وكان بعضُ أهل العِلْم بكلام العربِ[44] يَرَى أَنَّ ذلك مِن المُؤخَّرِ الذي معناه التقديم، وأنَّ معنى الكلامِ: والذي أَخْرَجَ المَرْعَى أحوى. أي: أخضر إلى السوادِ، فجعله غثاءً بعد ذلك. ويَعْتَلّ لقوله ذلك بقول ذي الرُّمَّة[45]:
حَوَّاءُ قَرْحَاءُ أَشْراطِيَّةٌ وَكَفَتْ ** فيها الذَّهابُ وحَفَّتْها البَرَاعِيمُ[46]».
ثم عَقّب بنقده بمراعاة قول أهل التأويل، والأصل في الكلام من جهة الترتيب، فقال: «وهذا القول -وإن كان غير مدفوع أنْ يكونَ ما اشتدَّتْ خضرتُه من النبات، قد تُسمِّيه العربُ أسْوَدَ- غيرُ صواب عندي؛ لخلافه تأويل أهلِ التأويل في أنَّ الحرف إنما يُحتالُ لمعناه المُخْرَجِ بالتقديم والتأخير، إذا لم يكن له وجهٌ مفهوم إلا بتقديمه عن موضعه أو تأخيره، فأمّا وله في موضعه وجهٌ صحيحٌ، فلا وجه لطلب الاحتيال لمعناه بالتقديم والتأخير»[47].
وقد تابع ابنَ جرير في تقريره طائفةٌ من المفسِّرين، منهم: الرازي، وأبو حيان، والسمين الحلبي، والقاسمي، وابن عاشور[48]، بينما ذهب آخرون إلى تصحيح القولين معًا، منهم: ابن عطية، والزمخشري، والقرطبي، وغيرهم[49].
٤، ٥. مراعاة النزول، مراعاة السياق:
ومن أصوله النقدية التي اعتمدها في نقد التفسير بمجرد اللغة: مراعاة النزول، والسياق، ومن ذلك ما ذكره في تأويل قوله تعالى: ﴿وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ﴾ [المائدة: ١٣]؛ فقد ذكر ابنُ جرير معنى ﴿خَائِنَةٍ﴾، واشتقاقها، فقال: «والخائنة في هذا الموضع الخيانة، وهو اسمٌ وُضع موضع المصدر، كما قيل: خاطئة للخطيئة، وقائلة للقيلولة[50].
وقوله: ﴿إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ﴾ استثناء من الهاء والميم اللتين في قوله: ﴿عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ﴾.
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل».
ثم روَى عن مجاهد وعكرمة وقتادة، أنها في يهود، الذين هَـمُّوا بخيانة النبي -صلى الله عليه وسلم-.
ثم نقل قول بعض أهل اللغة، فقال: «وقال بعض القائلين[51]: معنى ذلك: ولا تزال تطّلع على خائن منهم. قال: والعرب تزيد الهاء في آخر المذكَّر، كقولهم: هو راوية للشِّعر، ورجل علّامة، وأنشد[52]:
حَدَّثْتَ نفسكَ بالوفاءِ ولم تكن ** للغـدر خـائـنـةً مُغِلَّ الإصبع
فقال: خائنة. وهو يُخاطب رجلًا».
ثم عقّب بنقد هذا القول بمراعاة أسباب النزول والسياق، فقال: «والصواب من التأويل في ذلك: القول الذي رويناه عن أهل التأويل؛ لأن اللهَ عنى بهذه الآية القوم من يهود بني النضير الذين همّوا بقتل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه، إِذْ أتاهم رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- يستعينهم في دية العامريَّين، فأطلعه الله -عزّ ذِكره- على ما قد همّوا به، ثم قال -جلّ ثناؤه- بعد تعريفه أخبار أوائلهم، وإعلامه منهج أسلافهم، وأن آخرهم على منهاج أوّلهم في الغدر والخيانة؛ لئلا يكبر فعلهم ذلك على نبيّ الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال جلّ ثناؤه: ولا تزال تطلع من اليهود على خيانة وغدر ونقض عهد. ولم يُرِد أنه لا يزال يطلع على رجلٍ منهم خائن؛ وذلك أن الخبر ابتُدِئ به عن جماعتهم، فقيل: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ﴾ [المائدة: ١١]. ثم قيل: ﴿وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ﴾. فإِذْ كان الابتداءُ عن الجماعة فالختمُ بالجماعة أَوْلى»[53].
وقد تابَع ابنَ جرير في اختياره كثيرٌ من اللغويين والمفسِّرين، منهم: ابن قتيبة، والزجاج، والنحاس، ومكيّ بن أبي طالب، وابن كثير، وابن عاشور، وغيرهم[54].
وما ذكره ابن جرير هو الأَوْلى في معنى الآية، وقد ذكره أبو عبيدة أيضًا، لكن القول الذي ردّه هو محتمل أيضًا عند كثير من أهل اللغة والمفسِّرين، وذلك على جهة المبالغة في الصفة، و(خائنة): نكرة؛ لتشمل كلّ من يصدق عليه وصف الخيانة.
وهذا ما احتمله غير واحدٍ من اللغويين والمفسِّرين، منهم: ابن قتيبة، والقرطبي، وأبو حيان، وغيرهم[55].
٦، ٧. مراعاة الظاهر، مراعاة التاريخ:
ومن ذلك ما ذكره في تأويل قوله تعالى: ﴿وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً﴾ [البقرة: ٥١]؛ فقد ابتدأ ابن جرير تأويلها، فقال: «ومعنى ذلك: وإِذْ واعدنا موسى أربعين بتمامها. فالأربعون ليلةً كلها داخلة في الميعاد».
ثم عقّب بنقد قول بعض أهل اللغة، فقال: «وقد زعم بعض نحويي البصرة[56] أنّ معناه: وإِذْ واعدنا موسى انقضاء أربعين ليلة، أي: رأس الأربعين. ومَثَّل ذلك بقوله: ﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ﴾ [يوسف: ۸۲]، وبقولهم: (اليوم أربعون منذ خرج فلان)، أي: يوم تمام أربعين».
وقد تعقّبه ابن جرير بظاهر الآية، وبدلالة التاريخ على وفق ما جاء في الروايات عن أهل التأويل، فقال: «وذلك خلاف ما جاءت به الرواية عن أهل التأويل، وخلافُ ظاهر التلاوة.
فأمّا ظاهر التلاوة، فإنّ الله -جلّ ثناؤه- قد أخبر أنه واعد موسى أربعين ليلة، فليس لأحد إحالة ظاهر خبره إلى باطن، بغير برهان دالّ على صحّته».
ثم روَى عن أبي العالية، والربيع، والسدي، وابن إسحاق آثارًا تبيِّن أنّ الأربعين كلّها داخلة في الميعاد[57].
وقد تابع ابنَ جرير في نقده واختياره ابنُ عطية، فقال: «وهذا ضعيف، وكلّ المفسِّرين على أنّ الأربعين كلّها ميعاد»[58].
وهكذا ما ذكره في تأويل قوله تعالى: ﴿وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا﴾ [الأعراف: ۱۳۷]؛ فقد بَيَّن معنى ﴿مَشارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا﴾ بما أورده من الآثار عن الحسن، وقتادة، فقال: «مشارق الأرض: الشام، وذلك ما يلي الشرق منها، ومغاربها التي باركنا فيها، يقول: التي جعلنا فيها الخير ثابتًا دائمًا لأهلها».
ثم عقّب بنقد بعض اللغويين، فقال: «وكان بعضُ أهل العربية[59] يزعُمُ أنّ مشارق الأرض ومغاربها نَصْبٌ على المحلّ، بمعنى: وأورثنا القوم الذين كانوا يُستضعفون في مشارقِ الأرض ومغارِبِها، وأنّ قوله: ﴿وَأَوْرَثْنَا﴾، إنما وقع على قوله: ﴿الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا﴾. وذلك قولٌ لا معنى له؛ لأنّ بني إسرائيل لم يكن يستضعِفُهم أيامَ فرعونَ غيرُ فرعون وقومه، ولم يكن له سلطانٌ إلا بمصر، فغيرُ جائز والأمر كذلك أن يُقال: الذين يُستضعفون في مشارقِ الأرض ومغارِبها.
فإن قال قائل: فإنَّ معناه: في مشارق أرض مصر ومغاربها. فإن ذلك بعيد من المفهوم في الخطاب، مع خروجه عن أقوال أهل التأويل والعلماء بالتفسير»[60].
فقد تبيَّن أنّ ابن جرير يعتمد أصوله وقواعده لنقد التفسير بمجرّد اللغة، وهي: السُّنة، والإجماع، وأقوال أهل التأويل، وأسباب النزول، والسياق، والظاهر، والتاريخ.
لكنه يعتمد -أيضًا لمعرفته الواسعة بلغة العرب، وعميق نظره وبصره النافذ بأساليبها- قواعده النقدية المتعلقة بالاستدلال باللغة، ومن ذلك:
ما قرّره في تأويل قوله تعالى: ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ﴾ [هود: ۱۰۸]، فقد حكى اختلافَ أهل التأويل والعربية في معنى الاستثناء، فذكر لأهل التأويل قولين:
القول الأول: معنى ذلك: ﴿إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ﴾؛ من قدرِ ما مكثوا في النار، قبل دخولهم الجنة، قالوا: وذلك فيمَن أُخرج من النار من المؤمنين فأُدخل الجنة.
ورواه عن الضحاك.
القول الثاني: معنى ذلك: ﴿إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ﴾ من الزيادة على قدرِ مدّة دوام السماوات والأرض، قالوا: وذلك هو الخلود فيها أبدًا.
ورواه عن أبي مالك عن أبي سنان.
ثم أتبع ابنُ جرير كلامَ أهل التأويل بأقوال أهل العربية، فذكر أربعة وجوه، فقال: «واختلف أهل العربية في وجه الاستثناء في هذا الموضع:
فقال بعضهم[61]: في ذلك معنيان؛ أحدهما: أن تجعله استثناء يستثنيه ولا يفعله، كقولك: والله لأضربنَّك، إلا أنْ أرَى غير ذلك. وعزمُك على ضربِه، قال: فكذلك قال: ﴿خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ﴾، ولا يشاؤه.
والقول الآخر: أنّ العرب إذا استثنت شيئًا كثيرًا مع مثله، ومع ما هو أكثر منه، كان معنى (إلّا)، ومعنى (الواو) سواءً. فمن ذلك قوله: ﴿خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ﴾، سوى ما شاء الله من زيادة الخلود. فيجعل (إلّا) مكان (سوى) فيصلحُ، وكأنه قال: خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض سوى ما زادهم من الخلود والأبد... وهذا أحبُّ الوجهين إليَّ؛ لأنّ الله لا خُلْفَ لوعده. وقد وصل الاستثناء بقوله: ﴿عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ﴾، فدلّ على أنّ الاستثناء لهم في الخلود غير منقطع عنهم.
وقال آخرون[62] منهم بنحو هذا القول، وقالوا: جائز فيه وجهٌ ثالث، وهو أن يكون استثنى من خلودهم في الجنة احتباسهم عنها ما بين الموت والبعث؛ وهو البرزخ، إلى أن يصيروا إلى الجنة، ثم هو خلود الأبد، يقول: فلم يغيبوا عن الجنة إلا بقدرِ إقامتهم في البرزخ.
وقال آخرون[63] منهم: جائز أن يكون دوام السماوات والأرض بمعنى: (الأبد)؛ على ما تعرف العرب وتستعمل، وتستثنى المشيئة من دوامها؛ لأنّ أهل الجنة وأهل النار قد كانوا في وقت من أوقات دوام السماء والأرض في الدنيا، لا في الجنة، فكأنه قال: خالدين في الجنة وخالدين في النار دوام السماء والأرض، إلا ما شاء ربُّك من تعميرهم في الدنيا قبل ذلك».
وقد عقّب ابن جرير بمراعاة قواعده النقدية في اللغة: مراعاة الأشهر في العربية، فقال: «وأَوْلى الأقوال في ذلك عندي بالصواب القول الذي ذكرته عن الضحاك؛ وهو: ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ﴾ من قدرِ مُكثهم في النار، من لَدُن دخولها، إلى أن أُدخلوا الجنة، وتكون الآية معناها الخصوص؛ لأنّ الأشهر من كلام العرب في (إلّا) توجيهها إلى معنى الاستثناء، وإخراج معنى ما بعدها مما قبلها، إلا أن يكون معها دلالة تدلّ على خلاف ذلك، ولا دلالة في الكلام -أعني في قوله: ﴿إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ﴾- تدلّ على أن معناها غير معنى الاستثناء المفهوم في الكلام، فيُوجّه إليه»[64].
وكما أجرى ابن جرير نقده بمراعاة الأشهر في العربية من جهة الأسلوب، فهو يعتمد المعروف في لغة العرب لنقد ما ذكره بعض اللغويين في معنى الكلمات، ومن ذلك ما ذكره في تأويل قوله تعالى: ﴿لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا﴾ [النبأ: ٢٤]؛ فقد حكى قول أهل التأويل في أنّ البرد هو ما يبرد عنهم حرّ جهنم.
ثم عَقّب ابن جرير بقولٍ آخر حكاه عن بعض اللغويين، فقال: «وقد زعم بعضُ أهل العلم بكلام العرب[65] أنّ البردَ في هذا الموضع النَّوْمُ، وأن معنى الكلام: لا يذوقون فيها نومًا ولا شرابًا. واستشهد لقيله ذلك بقول الكندي[66]:
برَدَتْ مراشِفُها عليَّ فصَدَّني ** عَنها وعَن قُبُلاتِها البَرْدُ
يعني بالبرد: النعاس.
ثم تعقّبه ابن جرير بمراعاة القاعدة النقدية: المعروف في كلام العرب، فقال: «والنومُ إن كان يُبرِدُ غليل العطش، فقيل له من أجل ذلك: البرد. فليس هو باسمه المعروف، وتأويلُ كتاب الله على الأغلب من معروف كلام العرب دون غيره»[67].
وما ذهب إليه أبو عبيدة تابعه فيه كثيرٌ من اللغويين، منهم: ابن قتيبة، وثعلب -نقله عنه السمعاني-، والكسائي ومعاذ النحوي -نقله عنهما ابن عطية-، وابن الأنباري، والراغب، وهو قول بعض المفسِّرين؛ كالسمعاني، ومكي بن أبي طالب[68].
بينما ذهب الجمهور -كما ذكر الماوردي وأبو حيان- إلى أنّ البرد هو المعروف، واستدلّوا بأن هذا هو الظاهر والأغلب في استعمال العرب؛ ذكر ذلك: النحاس، وأبو حيان، وابن جزي، وغيرهم[69].
وابن جرير مع اعتماده الأصول النقلية في التأويل، ونقد ما خالفها، فإنّ هذا لا يقلّل من تقديره وعنايته بكُتُب أهل المعاني -خاصّة الكتب الأربعة منها: معاني القرآن للفراء، ومعاني القرآن للأخفش، ومجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثنى، وتأويل مشكل القرآن لابن قتيبة-، سواء كان ذلك من جهة الاقتصار على بيان المعاني من خلالها، أو الجمع بينها وبين أقوال أهل التأويل، أو احتمالها.
فمن الأولى، ما ذكره -مثلًا- في تأويل قوله تعالى: ﴿وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ [الأنعام: ١١٩]؛ فقد بَيَّن معنى الآية بكلام أهل اللغة مكتفيًا بها، فقال: «اخْتَلَف أهل العلم بكلام العرب في تأويل قوله: ﴿وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا﴾؛ فقال بعضُ نحويي البصريين[70]: معنى ذلك: وأيُّ شيءٍ لكم في ألّا تَأْكُلوا؟ قال: وذلك نظير قوله: ﴿وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ﴾ [البقرة: ٢٤٦]...
وقال غيره[71]: إنما دخَلَت (لا) للمنعِ؛ لأنّ تأويل (ما لك)، و(ما منعك) واحدٌ: ما منَعك لا تَفْعَلُ ذلك، وما لك لا تفعل. واحدٌ؛ فلذلك دخلَت (لا). قال: وهذا الموضعُ تَكونُ فيه (لا)، وتكونُ فيه (أنْ) مثل قوله: ﴿يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا﴾ [النساء: ١٧٦]، و(أَنْ لا تَضِلُّوا): يَمْنَعُكُم مِن الضلالِ بالبيان».
ثم عقّب باختيار القول الثاني من جهة سياق السورة والنظر الصحيح، فقال: «وأَوْلَى القولين في ذلك بالصواب عندي قولُ مَن قال: معنى قوله: ﴿وَمَا لَكُمْ﴾ في هذا الموضع: وأيُّ شيءٍ يَمْنَعُكُم أن تَأْكُلوا مما ذُكِرَ اسمُ الله عليه. وذلك أنّ الله -تعالى ذِكْره- تقدَّم إلى المؤمنين بتحليل ما ذُكر اسمُ الله عليه، وإباحة أكل ما ذُبح بدينه أو دين من كان يَدِينُ ببعضِ شَرائع كتبه المعروفة، وتحريم ما أُهِلَّ به لغيره من الحيوانِ، وزَجْرِهم عن الإصغاء لما يُوحِي الشياطين بعضُهم إلى بعض مِن زُخرف القولِ في الميتةِ والمُنْخَنِقَةِ والمُتَرَدِّيةِ وسائر ما حرَّم الله من المطاعم، ثم قال: وما يَمْنَعُكُم مِن أكلِ ما ذُبح بديني الذي ارْتَضَيْتُه وقد فصَّلْتُ لكم الحلال من الحرام فيما تَطْعَمُون، وبيَّنْتُه لكم بقولي: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ إلى قوله: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإِثْمٍ﴾ [المائدة: ٣]. فلا لَبْسَ عليكم في حَرامِ ذلك مِن حلالِه؛ فتَتَمَنَّعُوا من أكلِ حَلالِه حَذَرًا مِن مُواقعةِ حَرامِه».
ثم قرّر هذا القول من جهة النظر، فقال: «فإذْ كان ذلك معناه، فلا وجه لقول مُتأوِّلي ذلك: وأيّ شيءٍ لكم فى أن لا تأكلوا؟ لأنّ ذلك إنما يُقال كذلك لمن كان كفَّ عن أكله رجاءَ ثوابٍ بالكفّ عن أكله، وذلك يَكونُ ممَّن آمن بالكفِّ؛ فكفَّ اتِّباعًا لأمر الله، وتسليمًا لحكمه، ولا نَعْلَمُ أَحَدًا مِن سلفِ هذه الأمّة كفَّ عن أكل ما أَحَلَّ اللهُ مِن الذبائح رجاءَ ثوابِ الله على تركه ذلك، واعتقادًا منه أن اللهَ حرَّمه عليه، فبيِّنٌ بذلك، إِذْ كان الأمر كما وصَفْنا، أنّ أَوْلَى التأويلين في ذلك بالصواب ما قلنا»[72].
وأمّا الجمع بين الأقوال؛ فمن ذلك ما ذكره في تأويل قوله تعالى: ﴿فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ﴾ [الإسراء: ٥]؛ فقد ذكر ابن جرير في تفسير قوله تعالى: ﴿فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ﴾ قولين:
القول الأول: ما رواه عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنّ المعنى: مَشوا.
القول الثاني: ما نقله عن بعض أهل المعرفة بكلام العرب من أهل البصرة، بقوله: وكان بعض أهل المعرفة بكلام العرب من أهل البصرة[73] يقول:
معنى (فجاسوا): قتلوا، ويستشهد لقوله ذلك ببيت حسان[74]:
ومنّا الذي لاقَى بسيفِ محمدٍ ** فجاسَ به الأعداءَ عُرْضَ العَساكِر
وممن ذكرَ أنه بمعنى (قتلوا): الفرّاء، وابن قتيبة، والنحاس -وعزاه لأهل اللغة-، وأبو حيان[75].
ثم أحسن الطبري الجمع بين ما رواه عن ابن عباس -رضي الله عنهما- وما نقله عن أبي عبيدة، فقال: «وجائز أن يكون معناه: فجاسوا خلال الديار فقتلوهم ذاهبين وجائِين، فيصح التأويلان جميعًا»[76].
وقال القرطبي عن هذا الجمع: «فجمع بين قول أهل اللغة»[77].
وممن سلك جمع الطبري بين القولين الزجّاجُ بقوله: «أي: فطافوا في خلال الديار ينظرون هل بقي أحد لم يقتلوه؟ والجوس: طلب الشيء باستقصاء»[78]، والواحدي إِذْ قال: «الجوس يحتمل هذه المعاني التي ذكروها»[79].
وقال ابن عاشور: «والجوس: التخلّل في البلاد وطرقها ذهابًا وإيابًا لتتبّع ما فيها، وأُريد به هنا تتبع المقاتلة، فهو جوس مضرّة وإساءة بقرينة السياق»[80].
وأمّا احتمال القول، فمنه ما ذكره في تأويل قوله تعالى: ﴿وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ﴾ [القلم: ٢٥]؛ فقد ذكر ابن جرير في معنى (حَرْدٍ) من قوله تعالى: ﴿وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ﴾ أقوالًا، هي:
القول الأول: معناه: على قدرةٍ في أنفسهم وجدٍّ.
ورواه عن ابن عباس -رضي الله عنهما-، ومجاهد، والحسن، وقتادة، وابن زيد.
القول الثاني: إنّ المعنى: وغدوا على أمرٍ قد أجمعوا عليه بينهم واستَسرُّوه وأسرُّوه في أنفسهم.
ورواه عن مجاهد، وعكرمة.
القول الثالث: إنّ المعنى: وغدوا على فاقةٍ وحاجة.
ورواه عن الحسن.
القول الرابع: إنّ المعنى: على حنقٍ وغضب.
ورواه عن سفيان الثوري.
ثم عقّب بقول أبي عبيدة، فقال: «وكان بعض أهل المعرفة بكلام العرب من أهل البصرة[81] يتأوّل ذلك: وغدوا على منعٍ، ويوجّهه إلى أنه من قولهم: حارَدَت السَّنَة، إذا لم يكن فيها مطرٌ، وحارَدَت الناقة، إذا لم يكن لها لبنٌ[82]، كما قال الشاعر[83]:
فإِذَا ما حَارَدَت أو بَكَأَت ** فُتَّ عن حاجبِ أُخرَى طِينُهَا».
لكنه تعقّب قول أبي عبيدة مع احتماله، فقال: «وهذا قول لا نعلم له قائلًا من متقدِّمي العلم قاله، وإن كان له وجه، فإذا كان ذلك كذلك، وكان غير جائز عندنا أن يتعدّى ما أجمعت عليه الحُجّة، فما صح من الأقوال في ذلك إلا أحدُ الأقوال التي ذكرناها عن أهل العلم»[84].
وما قرّره ابنُ جرير في نقد التفسير بمجرّد اللغة هو ما تتابعَتْ عليه كلمة المحقّقين من العلماء والمفسِّرين، فقد ذكر ابن تيمية في رسالته في التفسير في الكلام على الخطأ في التفسير من جهة الاستدلال، في الوجه الثاني من سبيلِ الخطأ، أنهم «قوم فسَّروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده مَن كان من الناطقين بلغة العرب بكلمه، من غير نظر إلى المتكلِّم بالقرآن، والمنَزَّل عليه، والمخاطَب به»[85].
وقال أبو حيان: «ينبغي أن يُحْمَل [أي: القرآن] على أحسنِ إعراب، وأحسنِ تركيبٍ؛ إِذْ كلام الله تعالى أفصحُ الكلام، فلا يجوزُ فيه جميع ما يُجَوِّزُه النحاة في شِعْرِ الشَّمَّاخ والطِّرِمَّاحِ وغيرهما، من سلوكِ التَّقادير البعيدة، والتراكيب القلقة، والمجازاتِ المُعقَّدة»[86].
وقال ابن القيم: «لا يجوز أن يُحمَل كلامُ الله -عَزَّ وجَلَّ- ويفسَّرَ بمجرَّدِ الاحتمال النحوي الإعرابي الذي يحتمله تركيب الكلام، ويكون الكلام به له معنى ما، فإنَّ هذا المقام غَلِطَ فيه أكثرُ المعرِبين للقرآن، فإنَّهم يفسِّرون الآية ويعربونها بما يحتمله تركيب تلك الجُملة، ويُفهم من ذلك التركيبِ أَيُّ معنى اتفق، وهذا غلطٌ عظيمٌ يقطعُ السَّامعُ بأنَّ مرادَ القرآنِ غيرُه... بل للقرآنِ عُرْفٌ خاصّ، ومعانٍ معهودة، لا يُناسِبُه تفسيره بغيرها، ولا يجوز تفسيره بغير عُرفه والمعهود من معانيه، فإنَّ نسبة معانيه إلى المعاني كنسبة ألفاظه إلى الألفاظ، بل أعظم.
فكما أنَّ ألفاظه ملوكُ الألفاظ وأجلُّها وأفصحها، ولها من الفصاحة أعلى مراتبها التي يعجز عنها قدر العالمين، كذلك معانيه أجلّ المعاني وأعظمها وأفخمها، فلا يجوز تفسيره بغيرها من المعاني التي لا تَليق به، بل غيرُها أعظمُ منها وأجَلُّ وأفخم، فلا يجوز حمله على المعاني القاصرة بمجرَّدِ الاحتمالِ النحوي الإعرابي.
فتدبَّر هذه القاعدة، ولتكن منك على بالٍ، فإنَّكَ تنتفع بها في معرفة ضَعْفِ كثير من أقوال المفسِّرين وزيفها، وتقطع أنها ليست مراد المتكلّم -تعالى- بكلامه»[87].
[1] هذه المقالة من كتاب (الصناعة النقدية في تفسير ابن جرير الطبري)، الصادر عن مركز تفسير سنة ١٤٤٣هـ، تحت عنوان: (صيغ نقد التفسير عند ابن جرير)، (١/ ٢٢٧) وما بعدها. (موقع تفسير)
[2] جامع البيان (١/ ١٢).
[3] جامع البيان (۱/ ۸۸).
[4] هو قول الأخفش، معاني القرآن (٣/ ١٩).
[5] هو الفرّاء في معاني القرآن (۲/ ۲۸۷).
[6] نقله الفرّاء في معاني القرآن (۲/ ۲۸۸)، ولم يعزه إلى أحد.
[7] جامع البيان (١٨/ ١٦- ١٩).
[8] تفسير القرآن العظيم (٢/ ٥٣٥)، وتأويل مشكل القرآن، ص٢١٩- ٢٢١، والهداية إلى بلوغ النهاية (٨/ ٥٣٧٥)، والتحرير والتنوير (٢٠/ ٢٢٩).
[9] هذا ما يظهر من كلام الفرّاء في معاني القرآن (٧/ ٥٧)، ونقله القرطبي، بيد أنّ الأستاذ عضيمة ذكر في كتابه الحافل (دراسات لأسلوب القرآن الكريم) (١/ ١/ ٣٠٦) أنّ ظاهر اختيار الفرّاء أنه متصل، والله أعلم.
[10] معاني القرآن (۲/ ۲۸۸)، (٤/ ۱۱۰)، والكشاف (٣/ ١٣٤)، وتفسير القرطبي (١٣/ ١٥٠)، والتسهيل (٣/ ٩٣)، والبحر المحيط (٧/ ٥٧)، وتفسير ابن كثير (٦/ ١٨٠)، وتفسير الخازن (٣/ ٤٢)، وإرشاد العقل السليم (٤/ ١٢٤)، وحاشية الجمل (٣/ ٢٠١).
[11] الأُترج ثمر معروف، كالليمون الكبار، طيّب الرائحة، حامض الماء. ينظر: المعجم الوسيط، مادة (أترج).
[12] قال ابن قتيبة: هو استعارة، ووافقه الأزهري، والزمخشري، وابن الجوزي، والآلوسي، أو هو كناية، كما ذكر الزمخشري، والآلوسي، ينظر: تأويل مشكل القرآن، ص۱۸۰، وتهذيب اللغة (۱۰/ ۳۳۳)، والكشاف (٣/ ٢٧٦)، وزاد المسير (٤/ ٢١٦)، وروح المعاني (١٢/ ٢٢٨).
[13] البزماورد والزماورد: طعام من البَيض واللحم، معرب، القاموس المحيط مادة (ورد). وقال الشهاب الخفاجي: وهو الرقاق الملفوف باللحم... وفي كتب الأدب: هو طعام يُقال له: لقمة القاضي، ولقمة الخليفة. ينظر: شفاء العليل، ص۱۱۳.
[14] مجاز القرآن، ص۳۰۹.
[15] والأمر كما قال الشافعي: «ولسان العرب أوسع الألسنة مذهبًا، وأكثرها ألفاظًا، ولا نعلمه يحيط بجميع عِلْمه إنسانٌ غير نبي، ولكن لا يذهب منه شيء على عامتها، حتى لا يكون موجودًا فيها من يعرفه، والعلم به عند العرب كالعلم بالسُّنّة عند أهل الفقه؛ لا نعلم رجلًا جمع السّنن فلم يذهب منها عليه شيء»، الرسالة، ص٤٣.
[16] جامع البيان (١٣/ ١٢٤- ١٣٠).
[17] معاني القرآن (٢/ ٤٢)، ومعاني القرآن وإعرابه (٣/ ١٠٥)، ومعاني القرآن (٣/ ٤٠٢)، وتهذيب اللغة (١٠/ ٣٣٣).
[18] صحيح البخاري (٩/ ٣٥٨ فتح)، وبحر العلوم (٢/ ١٥٩)، والهداية (٥/ ٣٥٥٠)، والكشاف (٣/ ٢٧٦)، وتفسير القرطبي (٩/ ١٥٦)، وتفسير ابن كثير (٤/ ٣٨٥)، والتسهيل (۲/ ۱۱۸)، وروح المعاني (۱۲/ ۲۲۸)، وتفسير المنار (١٢/ ٢٤١)، والتحرير والتنوير (١٣/ ٢٦٢).
[19] أراد الطبري أبا عبيدة، مجاز القرآن (١/ ٣١٣- ٣١٤).
[20] هكذا في جامع البيان، وفي مجاز القرآن: العصرة التي.
[21] ينظر: جمهرة أشعار العرب، ص۱۳۸، وصاديًا: عطشان، القاموس (صدي) (٤/ ٣٥١)، المنجود المكروب، القاموس (نجد) (١/ ٣٤٠).
[22] جامع البيان (١٣/ ١٩٦- ١٩٨).
[23] معاني القرآن (٣/ ٤٢٤).
[24] حكاه عنهم: ابن عطية في المحرر الوجيز (٥/ ١٠٠)، وأبو حيان في البحر المحيط (٥/ ٣٦٥).
[25] تفسير غريب القرآن، ص۲۱۸، ومعالم التنزيل (٤/ ٢٤٧)، والمحرر الوجيز (٥/ ١٠٠)، والبحر المحيط (٥/ ٣١٥)، وتفسير ابن كثير (٤/ ٣٩٣)، ومحاسن التأويل (٩/ ٣٥٤٩)، والتحرير والتنوير (١٣/ ٢٨٧).
[26] تفسير المشكل من غريب القرآن، ص١١٥.
[27] أراد الطبري أبا عبيدة، مجاز القرآن (۱/ ۹۱).
[28] جامع البيان (٥/ ۳۷۳).
[29] التفسير الكبير (۸/ ۳۹)، والبحر المحيط (٢/ ٤٤٧).
[30] معاني القرآن (١/ ٤٠٦)، ومعاني القرآن (۱/ ۳۹۱)، ومعالم التنزيل (٢/ ٣٤)، والمحرر الوجيز (۲/ ۲۰۹)، وتفسير ابن كثير (٢/ ٣٧)، والتحرير والتنوير (٣/ ٢٣٩).
[31] رواه البخاري (٧٤١٥)، ومسلم (٢٧٨٦).
[32] جامع البيان (٢٠/ ٢٤٦- ٢٥٣).
[33] تفسير عبد الرزاق (٢/ ١٧٤)، وصحيح البخاري (٦/ ١٢٦)، ومعالم التنزيل (۷/ ۱۳۱)، وتفسير ابن كثير (۷/ ۱۱۳).
[34] هو الفرّاء كما سيصرّح به المصنف، وينظر: معاني القرآن (١/ ١٤١).
[35] جامع البيان (٣/ ٦٤٨- ٦٦٢).
[36] معاني القرآن (۱/ ۲۸۹)، ومعاني القرآن (١/ ١٦٨)، والمحرر الوجيز (١/ ٥٢٢)، وتفسير القرطبي (٣/ ٤٣).
[37] هو أبو عبيدة، مجاز القرآن (۲/ ۱۱۰).
[38] هو: عروة بن الورد، ديوانه، ص٢٠٥.
[39] هو الأخفش، معاني القرآن (٢/ ٤٣٤).
[40] قائله: امرئ القيس، ينظر: ملحق دیوانه، ص٤٦٦، ويُنسب لعبد الله بن قيس الرقيات، ديوانه، ص۳۲، وعجزه: مشي الضعيف ينوء بالوسق. والوسق: ستون صاعًا.
[41] دیوانه، ص۳۱، بتحقيق وشرح الدكتور محمد حسين، والحرب العوان: التي قُوتل فيها الثانية بعد الأُولى. والمُغَمِّر: الذي لم يجرِّب الأمور. والأجذال: جمع جذل: وهو أصل الشجرة.
[42] هو الفراء، معاني القرآن (۲/ ۳۱۱).
[43] جامع البيان (۱۸/ ۳۱۲- ۳۱۹).
[44] هو قول الفراء -على الاحتمال- معاني القرآن (٣/ ٢٥٦)، وتابعه ابن الأنباري، الأضداد، ص٣٥٢، وثعلب، مجالس ثعلب، ص۳۷۰، والزجاج، معاني القرآن (٥/ ٣١٥).
[45] دیوان ذي الرمّة (۱/ ۳۹۹).
[46] روضة قرحاء: في وسطها نَوْرٌ أبيضُ. وقيل: القرحاء: التي بدا نبتُها. أشراطية: مُطِرَتْ بالشَّرَطَيْن، وهما نجمان من الحَمَل وهما قرناه، وإلى جانب الشمالي منهما كوكب صغير. وكَفَتْ: قَطَرَتْ. والذَّهاب: جمع ذِهْبَةٍ وهي المطرةُ، وقيل: المطرةُ الضعيفة. ينظر: اللسان: المواد: (ق ر ح)، (ش ر ط)، (و ك ف)، (ذ هـ ب).
[47] جامع البيان (٢٤/ ٣١٣- ٣١٤).
[48] التفسير الكبير (١٦/ ١٢٧)، والبحر المحيط (٨/ ٤٥٨)، والدر المصون (١٠/ ٧٦٠)، ومحاسن التأويل (١٧/ ٦١٣٠)، والتحرير والتنوير (٣١/ ٢٧٨).
[49] المحرر الوجيز (٨/ ٥٩١)، والكشاف (٦/ ٣٥٧)، وتفسير القرطبي (٢٠/ ١٦).
[50] ينظر في هذه المسألة: الكتاب (١/ ٣٤٦)، والمقتضب (٣/ ٢٩٦)، والخصائص (٢/ ٤٨٩)، وشرح المفصل (٦/ ٥٠)، ومغني اللبيب، ص٥٢٩.
[51] هو أبو عبيدة في مجاز القرآن (١/ ١٥٨).
[52] نسبه في مجاز القرآن (۱/ ۱٥۸) إلى الكلابي، وفي إصلاح المنطق، ص٢٦٦، والكامل، للمبرد (١/ ٣٥٩) غير منسوب.
[53] جامع البيان (٨/ ٢٥٢- ٢٥٤).
[54] تأويل مشكل القرآن، ص٤٧٧، ومعاني القرآن (٢/ ١٦٠)، (۲/ ۲۸۲)، وتفسير المشكل من غريب القرآن، ص٦٩، وتفسير ابن كثير (٣/ ٦٦)، والتحرير والتنوير (٦/ ١٤٥).
[55] تفسير غريب القرآن، ص١٤٢، وتفسير القرطبي (٦/ ٧٦)، والبحر المحيط (٣/ ٤٤٦).
[56] هو الأخفش، معاني القرآن (۱/ ۹۷).
[57] جامع البيان (٦٦٦- ٦٦٨).
[58] المحرر الوجيز (١/ ٢١٦)، وما ذكره من إجماع المفسِّرين إن أراد به أهل التأويل -كما ذكر ابن جرير- فصحيح، وإلا فالقول الذي قاله الأخفش قد تابعه عليه كثير من المفسِّرين، منهم: الواحدي في الوسيط (۱/ ۱۳۷)، والسمعاني (١/ ٤٨١)، والبغوي (١/ ٩٤)، وغيرهم.
[59] هو الفراء، معاني القرآن (۱/ ۳۹۷).
[60] جامع البيان (١٠/ ٤٠٤- ٤٠٦).
[61] معاني القرآن، للفراء (۲/ ۲۸).
[62] نقله الزجاج في معاني القرآن (۳/ ۷۹- ۸۰)، ولم ينسبه إلى أحد.
[63] هو قول ابن قتيبة، تأويل مشكل القرآن، ص٧٦- ٧٧.
[64] جامع البيان (١٢/ ٥٨٥- ٥٨٨).
[65] نسبه محققو الطبري إلى الفرّاء في معاني القرآن (۳/ ۲۲۸)، والظاهر أن المقصود أبو عبيدة كما في مجاز القرآن (۲/ ۲۸۲)؛ لأنّ الفراء حكى الوجهين، وقدّم القول المشهور وأسنده عن ابن عباس -من طريق الكلبي-؛ بينما اكتفى أبو عبيدة بذكر القول الثاني مع رواية البيت.
[66] هو امرؤ القيس، والبيت في ديوانه، ص٢٣١.
[67] جامع البيان (٢٤/ ٢٧).
[68] وتفسير غريب القرآن، ص٥٠٩، وتفسير السمعاني (٦/ ١٣٩)، والمحرر الوجيز (٨/ ٥١٩)، والأضداد، ص٦٣، والهداية، لمكي بن أبي طالب (١٢/ ٨٠٠٠)، والعمدة له، ص٣٣١، والمفردات، للراغب، ص١١٧.
[69] إعراب القرآن (٥/ ۱۳۱)، والنكت والعيون (٦/ ١٨٧)، والبحر المحيط (٨/ ٤١٤)، والتسهيل (٤/ ١٧٤).
[70] هو الأخفش، معاني القرآن (١/ ٢٤٨)، ووافقه الزجاج، معاني القرآن (٢/ ٢٨٦).
[71] هو: الفراء. معاني القرآن (١/ ١٦٣- ١٦٥).
[72] جامع البيان (٩/ ٥١٢- ٥١٣).
[73] أراد الطبري أبا عبيدة، مجاز القرآن (۱/ ۳۷۰).
[74] لم أجده في ديوانه بعد البحث.
[75] ينظر: معاني القرآن (٢/ ١١٦)، تفسير غريب القرآن، ص۲۱۳، معاني القرآن (٤/ ١٢٣)، تحفة الأريب، ص٩١.
[76] جامع البيان (١٤/ ٤٧١).
[77] الجامع لأحكام القرآن (١٠/ ٢١٦).
[78] معاني القرآن وإعرابه (۳/ ۲۲۷)، وانظر: عمدة الحفاظ (١/ ٣٥٩).
[79] البسيط (۱۳/ ۲٥۸)، ونقله وارتضاه الرازي، التفسير الكبير (٢٠/ ١٥٧).
[80] تفسير التحرير والتنوير (١٥/ ٣١)، وانظر: لسان العرب (٦/ ٤٣).
[81] أراد الطبري أبا عبيدة، مجاز القرآن (٢/ ٢٦٥- ٢٦٦).
[82] ينظر: الصحاح (٢/ ٤٦٤)، لسان العرب (٣/ ١٤٥).
[83] قائله: عدي بن زيد، ينظر اللسان (حرد) (٣/ ١٤٦)، يتحدث عن إناء نفد ما فيه، (حاردت): نفد شرابها، (بكأت): قلَّ ما فيها، القاموس (بكأ) (۱/ ۸)، (فتّ) شق، القاموس (فتت) (١/ ١٥٣)، (طينها) ما يختم به، القاموس (طين) (٤/ ٢٤٥).
[84] جامع البيان (٢٣/ ١٧٦- ١٧٩).
[85] مجموع الفتاوى (١٣/ ٣٥٦)، وينظر: الإتقان، للسيوطي (٤/ ١٧٩).
[86] البحر المحيط، لأبي حيان (١/ ١٢).
[87] بدائع الفوائد (٣/ ٥٣٨).


