صيغة المفردة وعلاقتها بتوجيه مشكل القرآن
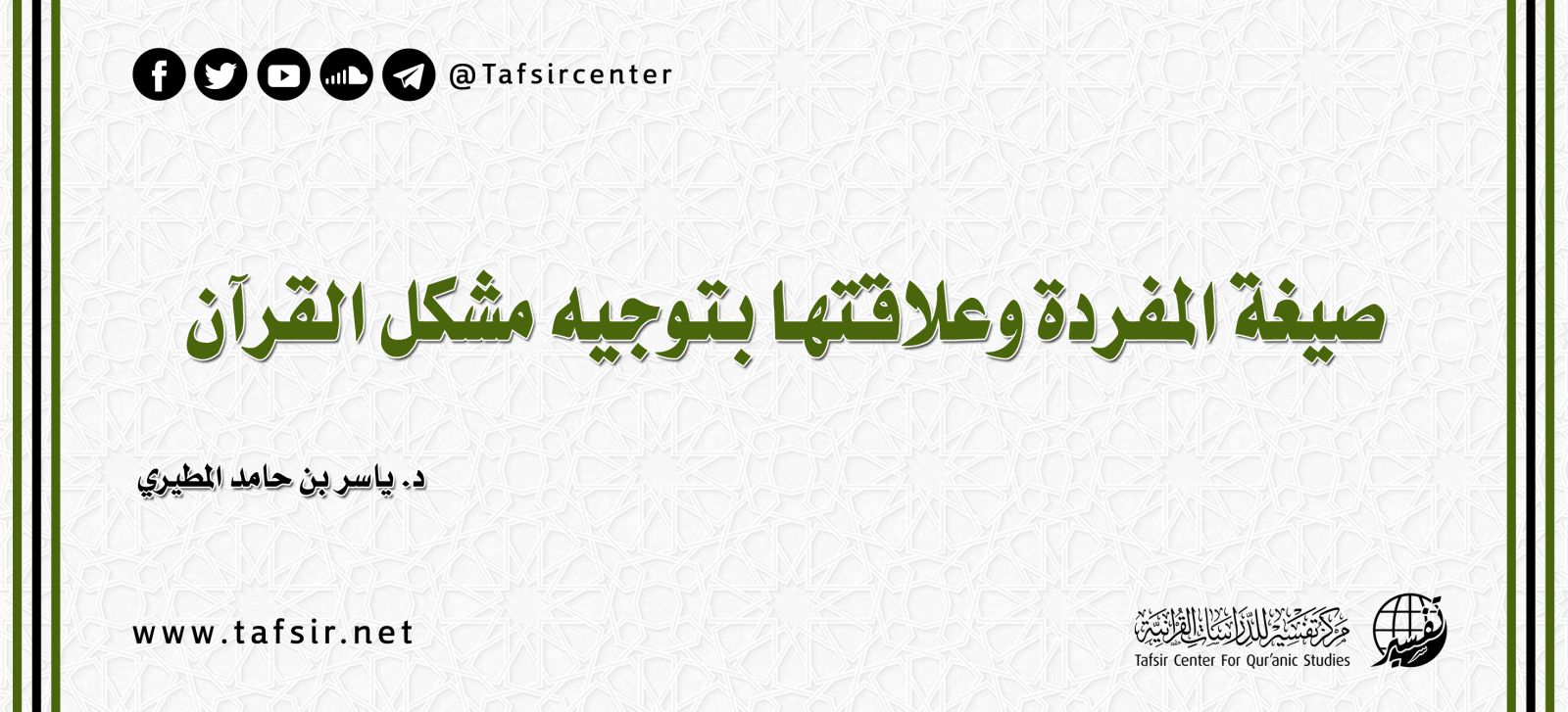
صيغة المفردة وعلاقتها بتوجيه مشكل القرآن[1]
في هذا المقال رصدٌ لصِيَغ الكلمة وهيئاتها، وأثرها في توجيه المشكل، وذلك من خلال أربعة محاور:
الأول: الإفراد والتثنية والجمع، وأثره في توجيه المشكل.
الثاني: صِيَغ الأفعال والمشتقّات، وأثرها في توجيه المشكل.
الثالث: التعريف والتنكير، وأثرهما في توجيه المشكل.
الرابع: التذكير والتأنيث، وأثرهما في توجيه المشكل.
أولًا: الإفراد والتثنية والجمع:
من وجوه التصرّف في القول في كتاب الله اختلافُ صِيَغ المفردات إفرادًا وتثنيةً وجمعًا، ومن اللافت للنظر أنّ بعض الكلمات لم تَرِد في القرآن إلا مجموعةً، وأخرى لم تَرِد إلا مفردةً، وطائفةً راوحتْ بين الصّيغتين، وقد خُولف مقتضى الظاهر في بعضها؛ فتارةً يكون الظاهرُ مقتضيًا للإفراد أو التثنية ولكنَّ اللفظ القرآني آثر الجمع، وتارةً يُعَبَّر بالإفراد والظاهرُ يقتضي التثنية أو الجمع، ولِدِقَّةِ ذلك وتنوُّعه حسب سياق الكلام وأغراضه دار حوله كثيرٌ من المشكل، لا سيما عند مَن يقرأ القرآن كالقابس العجلان، فلا يكاد يَنِضُّ له بشيء، حتى إذا رَجَع البصرَ، وأعاد النظرَ، وراضَ نفسَه بكلام العرب، انجلى كلُّ مشكل، وانفتح كلُّ مغلق، ووقف على ما يَبْهَرُ العقل، وعَلِم يقينًا أنَّه كلامٌ معجِز، ﴿لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ﴾ [فصلت: 42].
ومما يجدر التنبيه عليه، أنَّ هذا الموضوع لم يَلْقَ ما يستحقّ من عنايةٍ في كتب البلاغة، وإنما عقد ابن جنّي بابًا سمّاه: (شجاعة العربية)، وجعل من أقسامه: (الحمل على المعنى)، قال فيه: «وذلك كتأنيث المذكَّر وتذكير المؤنَّث، وتصوير معنى الواحد للجماعة، والجماعة للواحد»[2]. فتبعه فيه ابن الأثير، ثم قال: «وهذا القسم من التأليف دقيق المسلك، بعيد المذهب، يحتاج إلى فضل معاودة وزيادة تأمّل، وقد وردَ في القرآنِ الكريم وفصيحِ الكلام منثورًا ومنظومًا»[3]. وأشار إليه كذلك البهاء السبكي إشارة عابرة[4].
وهاهنا نماذج من المشكل العائد إلى الإفراد والتثنية والجمع، وبيان أثر البلاغة في توجيهه:
۱- قوله تعالى: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ﴾ [الأنعام: 1].
الإشكال ووجهه[5]:
لِـمَ جمعَ الظُّلمة وأفرد النور؟
توجيه الإشكال:
وردَت كلمتا (الظلمات والنور) مجتمعةً في اثني عشر موضعًا من كتاب الله، ولهما حيث وردَا معنيان؛ قال الواقدي: «كلّ ما في القرآن من (الظلمات والنور) فالمراد منه الكفر والإيمان، غير التي في سورة الأنعام: ﴿وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ﴾، فالمراد منه الليل والنهار»[6]. على أحد القولين في تفسير الآية، وهو الأظهر؛ لأنَّ اللفظ إذا دار بين الحقيقة والمجاز وجبَ حمله على الحقيقة. وقد جُمع لفظ (الظلمات) وأُفرِد (النور) حيثما وردَا في القرآن، ولبيان وجه ذلك نقول:
أمّا على المعنى المجازي لـ(الظلمات والنور) وهو الكفر والإيمان، فوجه إفراد النور فيه أنَّ طريق الحقّ واحد؛ إِذْ مَرَدُّه إلى الله الملك الحقّ، وسبب جمع الظُّلمات تعدّد طرق الباطل وتشعّبها؛ فإنها لا ترجع إلى شيءٍ واحد، كما قال تعالى: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ﴾ [الأنعام: 153]. فإفراد الصراط يشير إلى أنَّ منهج الله تعالى واحد، والسائر على طريقه لا تتوزّعه الأهواء، ولا تضلّ به المسالك، وجَمْعُ (السُّبل)[7] يومئ إلى تعدّد طرق الغواية والضلال، والسائر عليها تعبث برأسه الهواجس، وتتنازعه الظنون والأوهام.
وتبعًا لذلك تعدّدت ولاياتُ الضلال واتحدت ولاية الحقّ: ﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ﴾ [البقرة: 257]. فللمؤمنين وليٌّ واحد تتجه إليه قلوبهم، وتتّحد حوله مقاصدهم، والكافرون تتوزّعهم الولايات بتعدّد ضلالاتهم وأهوائهم؛ لذا أفرد وليّ المؤمنين، وجمع وليّ الكافرين.
ومن هذا الباب أيضًا جاء قوله تعالى: ﴿عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ﴾ [النحل: 48]؛ لمّا كانت اليمين جهة الخير والفلاح وأهلها هُم الناجون أُفردت، ولمّا كانت الشمال جهة أهل الباطل وهم أصحاب الشمال جُمعت[8].
وأمّا (الظلمات والنور) بالمعنى الحقيقي وهو الليل والنهار، كما في آية الأنعام، فوجه الإفراد والجمع فيها يرجع إلى أمور:
الأول: ذهب الزمخشري إلى أنَّ إفرادَ النور للقصد إلى الجنس، وجَمْعَ الظلمات لكثرة أسبابها، فما من جنس من أجناس الأجرام إلا وله ظِلٌّ، وظِلُّه هو الظلمة، بخلاف النور فإنه من جنس واحد وهو النار[9].
وفيه نظر، فإنَّ النور متعدِّدَةٌ أسبابه أيضًا، فقد ذكر الزمخشري نفسه في موضع آخر أنّ النور «ضوء كلِّ نَيِّر»[10]؛ كالنار والشمس والقمر والنجوم.
الثاني: أنّ «النور شفيفٌ رقيق، والظلام كثيفٌ ثقيل.. هكذا موقعهما على العين.. الظلامُ كأنه ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أقبل عليها النور أزاحها طبقةً طبقةً.. هذا في واقع الحِسّ»[11]؛ فلذلك ناسَب إفراد النور وجمع الظلمات.
يضاف إلى ذلك أنّ في إفرادِ النور وجمعِ الظلمات مقابلةً حسنةً مع إفراد الأرض وجمع السماوات في قوله سبحانه: ﴿خَلَقَ السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾[12].
وبقي رأيٌ لابن عاشور يخالف ما سبق، حيث قال: «أفردَ النور وجمعَ الظلمات اتِّبَاعًا للاستعمال؛ لأنّ لفظ (الظلمات) بالجمع أخفّ، ولفظ (النور) بالإفراد أخفّ، وهما معًا دالّان على الجنس، والتعريف الجنسي يستوي فيه المفرد والجمع، فلم يبقَ للاختلاف سبب [إلا اتِّباع][13] الاستعمال»[14].
ويلاحَظ فيه أمران:
الأول: أنه يصلح توجيهًا لـ(الظلمات والنور) على المعنيين معًا الحقيقي والمجازي.
الثاني: لو صَحَّ هذا التوجيه انتفى ما عداه؛ إِذْ هو يقوم على نقضها.
إذا علم ذلك فنقول: ما ذكره الشيخ محلّ مناقشة؛ فقد بناه على دليل (السبر والتقسيم)[15]، وهو حصرُ أوصاف المحلّ ثم إبطال ما ليس صالحًا للتعليل، فيتعيّن الوصف الباقي؛ فقد عُلِم بالاستقراء أنّ علّة الجمع والإفراد (الظلمات والنور) إمّا عائدة إلى المعنى، أو إلى اللفظ، وقد ثبت أنَّ (الظلمات والنور) اسمَا جنس، واسمُ الجنس يستوي فيه المفرد والجمع، فبطل العود إلى المعنى، ولم يبقَ إلا مراعاة اللفظ، فيتعيَّن.
وهذا المسلك متعقَّب بكون الوصف الباقي باطلًا في نفسه؛ فإنّ الجمع (الأنوار) لفظ خفيف على اللسان، ليس فيه ثقلٌ يستدعي العدول عنه من أجله في أكثر من عشرين موضعًا في كتاب الله، وليس بين حروفه تنافر، كما أنه على وزن (أفعال) وهذا الوزن مستعمل بكثرة في كتاب الله، لفظ (الأبصار) في قوله تعالى: ﴿وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ﴾ [الملك: 23]. فلم يعدل عنه إلى (البَصَر) مع مناسبته لإفراد (السمع).
ولأجل ذا استعمله أبو الطيب في قوله:
وما انتفاع أخي الدنيا بناظِرِه ** إذا استوت عنده الأنوارُ والظُّلَمُ[16]
ثم الأصل أنّ تغيُّر اللفظ تبع لتغيُّر المعنى.
فدلّ جميع ذلك على أنّ العلّة عائدة إلى المعنى، وهي التي سبق ذكرها.
وأمّا كون (الظلمات والنور) اسمَي جنس فهو صحيح، ولكنه لا يدفع الإشكال؛ إِذْ يبقى السؤال: لِـمَ خُولف بين الصيغتين؟ والجواب ما تقدّم ذِكْره.
۲- قوله تعالى: ﴿إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ﴾ [ق: 17].
الإشكال ووجهه[17]:
كيف قال تعالى: ﴿عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ﴾، ولم يقل: قعيدان، وهو وصف للمَلَكَيْن اللذَيْن سبق ذكرهما بقوله تعالى: ﴿إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ﴾؟
توجيه الإشكال:
أُجيب عن هذا الإشكال بجوابَيْن[18]:
الأول: أنَ المعنى: (عن اليمين قعيد وعن الشمال قعيد)، إلا أنه حُذِف من أحدهما لدلالة المذكور عليه، كما قال قيس بن الخَطيم:
نحن بما عندنا وأنت بما ** عندك راضٍ والرأيُ مُختَلِفُ[19]
الثاني: أنَّ (فعيلًا) كثيرًا ما يستوي فيه المفرد والمثنى والجمع، ومنه قوله تعالى: ﴿وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ﴾ [التحريم: 4].
فعلى القول الأول يكون الغرض من الحذف الإيجاز.
وعلى القول الثاني يُقال: إنما لم يقل: قعيدان؛ رعايةً لفواصل السورة.
٣- قوله تعالى: ﴿فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الشعراء: 16].
الإشكال ووجهه[20]:
كيف قال تعالى: ﴿إِنَّا رَسُولُ﴾ فأُفرد، وهما اثنان؟
توجيه الإشكال:
وردَ في سورة طه قوله تعالى: ﴿فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ﴾ [طه: 47]، وهو واردٌ على الأصل فلا إشكال فيه، وإنما الإشكال المتوهّم في آية الشعراء، وقد أُجيب عنها بعدّة أجوبة:
الأول: أنّ (الرسول) هنا مصدر، فساغ إفراده مع إرادة المثنى أو الجمع، ومنه قول أبي ذؤيب الهذلي:
أَلِكْنِي إِليها وخَيْرُ الرَّسُو ** لِ أَعلَمُهُمْ بِنَواحِي الخَبَر[21]
أي: وخير الرُّسُل، فعبّر به عن الجماعة.
ومن إطلاق (الرسول) بمعنى المصدر وهو الرسالة قول العباس بن مرداس:
ألا مَن مُبْلِغٌ عَنِّي خُفَافًا ** رسولًا بيتُ أهلك مُنْتَهَاها[22]
فعلى ذلك يكون تقدير الآية: (إنَّا رسالة ربّ العالمين).
وفائدة التعبير بالمصدر: المبالغة، كما في قولك: رجلٌ عدلٌ[23].
الثاني: أنّ (فعولًا) يستوي فيه المفرد والمثنى والجمع، مثل: عدوّ، كما في قوله تعالى: ﴿فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ﴾ [الشعراء: 77][24].
الثالث: أنّ (رسول) مفرد مضاف إلى معرفةٍ فَيَعُمُّ.
وعلى هذين الوجهين (الثاني والثالث) يُقال: عُبِّر بـ(رسول) لنكتتَيْن:
إحداهما: أنهما لاتفاقهما في الأُخُوَّة والشريعة والرسالة والمرسَل إليه، فكأنهما رسولٌ واحد[25].
والأخرى: أنّ موسى -عليه السلام- كان الأصل في الرسالة، وهارون كان تبعًا له، فَأُفْرِدَ؛ إشارةً إلى ذلك[26]، ومنه قوله تعالى: ﴿قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يَا مُوسَى﴾ [طه: 49]. فخاطبهما معًا، ثم خَصَّ موسى بالنداء؛ لأنه هو الأصل في الرسالة. وقوله تعالى: ﴿فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى﴾ [طه: 117]، فخاطبهما بقوله: ﴿فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا﴾، ثم خصّ آدم بالخطاب فقال: ﴿فَتَشْقَى﴾.
الرابع: أن التقدير: كلُّ واحدٍ مِنَّا رسولُ رَبِّ العالمين، كقول البُرْجُمي:
فَمَنْ يَكُ أمسَى بالمدينةِ رَحْلُهُ ** فَإِنِّي وَقَيَّارًا بِهَا لَغَرِيبُ[27]
والأصل: لغَرِيبان.
وفائدته: الإشارة إلى أنّ كلًّا منهما مأمور بتبليغ ذلك ولو منفردًا[28].
وعلل د. فاضل السامرائي الإفرادَ بالنظر إلى السياق، فذكر أنّ القصة في سورة الشعراء مبنيّة على الوحدة لا على التثنية، فقد قال تعالى على لسان موسى: ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ * وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَى هَارُونَ * وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ * قَالَ كَلَّا فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ * فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ * أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ [الشعراء: 12- 17]، ثم ينتقل إلى الوحدة: ﴿قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ﴾ [الشعراء: 18]، ويستمر النقاش مع موسى وحده: ﴿قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ * قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا﴾... الآيات [23- 35]. وهذا بخلاف سورة طه التي بُنيت على التثنية: ﴿اذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي * اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى﴾ [طه: 42- 43] إلى آخر الآيات[29].
٤- قوله تعالى: ﴿أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ﴾ [ق: 24].
الإشكال ووجهه[30]:
كيف قال تعالى: ﴿أَلْقِيَا﴾[31]، والخطاب لواحد، وهو (مالك) خازن النار؟
توجيه الإشكال:
اختلف المفسِّرون في المخاطَب بقوله تعالى: ﴿أَلْقِيَا﴾:
فقيل: هما الملَكَان (السائق والشهيد) المتقدّم ذِكْرهما في قوله: ﴿وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ﴾ [ق: 21].
وقيل: هو القرين الوارد في قوله: ﴿وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ﴾ [ق: 23].
وهو الملَك الموكَّل به؛ مالك خازن النار أو غيره.
وبناءً على هذين القولين اختُلف في توجيه الإشكال؛ فأمّا على القول الأول وهو أنّ الخطاب للسائق والشهيد، فلا يَرِد الإشكال؛ إِذْ يكون الخطاب لاثنين حقيقةً.
وأمّا على القول الثاني وهو أنّ الخطاب لواحدٍ فهو مشكلٌ، وقد أُجيب عنه من وجوه:
الأول: نُقل عن المبرد أنّ تثنية الفاعل نزلَت منزلة تثنية الفعل لاتحادهما، كأنه قيل: (ألقِ ألقِ) للتأكيد[32].
الثاني: أنّ العرب أكثر ما يرافق الرجل منهم اثنان، فكثر على ألسنتهم أن يقولوا: خليليَّ، وصاحبيَّ، وقِفَا، حتى صار عرفًا في المخاطبة، وإن كان يخاطب واحدًا[33].
قال البقاعي: «والسِّرُّ فيه -إذا كان المخاطَب واحدًا- إفهامُه أنه يُراد منه الفعل بِجِدٍّ عظيم تكون قوّته فيه معادلةً لقوة اثنين»[34].
وفي هذا الوجه نظر؛ لقوله بعد ذلك: ﴿فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَدِيدِ﴾ [ق: 26].
فهو يدلّ على أنَّ المخاطب اثنان حقيقةً، فإنّ العرب لا تكرّر مخاطبة الواحد بخطاب الاثنين إلا بنصب قرينة على ذلك، وإلا وقع السامعُ في لَبْسٍ[35]، ومنه قول سويد بن كراع:
فإنْ تزجراني يا ابنَ عَفَّان أنزجر ** وإن تدعاني أَحْمِ عِرْضًا مُمَنَّعَا[36]
وقول امرئ القيس:
قِفَا نَبْكِ من ذِكرَى حبيبٍ ومنزِلِ
إلى قوله:
أَصاحِ تَرَى برقًا أُرِيكَ وَمِيضَه[37]
الثالث: أنّ الألِف في قوله: ﴿أَلْقِيَا﴾، مبدلة من نون التوكيد الخفيفة[38]، وفيه نظر؛ فإنّ الكلام هنا موصول، والإبدال إنما يكون في حال الوقف، كما قال ابن مالك:
وَأَبْدِلَنْهَا بعدَ فَتْحٍ أَلِفًا وَقِفَا ** كمَا تقولُ في قِفَنْ: قِفَا[39]
أو هو من إجراء الوصل مجرى الوقف.
وأقرب الأقوال أنّ الخطاب للسائق والشهيد، فإنّه حملٌ للكلام على الحقيقة، وهو الواجب، ولا يعدل عنه إلى المجاز إلا بقرينة، كيف وقد دلَّت القرينة على إرادة الحقيقة، وهي قوله: ﴿فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ﴾ [ق: 26].
ولا يعارضه قوله: ﴿وَقَالَ قَرِينُهُ﴾ فإن (القرين) هنا مفرد مضاف فيعمُّ السائق والشهيد.
٥- قوله تعالى: ﴿فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ * وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ﴾ [الشعراء: 100- 101].
الإشكال ووجهه[40]:
كيف جمع الشّافع ووحّد الصديق؟
توجيه الإشكال:
سرّ ذلك يظهر من وجهين:
الأول: كثرة الشفعاء في العادة وقلّة الصديق، ألا ترى أنّ الرجل إذا امتُحِن بإرهاق ظالم نهضَتْ جماعة وافرة من أهل بلده لشفاعته؛ رحمةً له وحسبة، وإن لم يسبق له بأكثرهم معرفة، كما أنّ الشفعاء يوم القيامة متعدّدون، كما في حديث أبي سعيد الطويل، وفيه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (شَفَعَت الملائكة، وشفع النبيّون، وشفع المؤمنون، ولم يبقَ إلا أرحم الراحمين...) رواه مسلم[41].
وأمّا الصديق -وهو الصادق في ودادك الذي يهمّه ما أهمك- فأعزُّ من بَيْضِ الأَنُوق[42][43]، وقد سُئل روحُ بنُ زِنْبَاع عن الصديق، فقال: «لفظٌ بلا معنی»[44]، على حدِّ قول الشاعر:
اسمُ الصَّديقِ على كثيرٍ واقعٌ ** وقد اختَبَرْتُ فَمَا وجدتُ فتًى يفي
كعجائب البحر التي أسماؤُها ** مشهورةٌ وشخوصُها لم تُعرَفِ[45]
الثاني: ذهب ابن عاشور إلى أن المشركين أرادوا بالشافعين الآلهة الباطلة، وكانوا يعهدونهم عديدين، فجرى على كلامهم ما هو مرتسم في تصوّرهم، وأمّا إفراد الصديق فلأنه أُريد أن يُجرَى عليه وصفُ ﴿حَمِيمٍ﴾، فلو جيء بالموصوف جمعًا لاقتضى جمعَ وصْفِه، وجمعُ ﴿حَمِيمٍ﴾ فيه ثِقَلٌ لا يناسب منتهى الفصاحة، ولا يليق بصورة الفاصلة، مع ما حصل في ذلك من التَّفَنُّن الذي هو من مقاصد البلغاء[46].
وهذان الوجهان مؤتلفان، والنكت لا تتزاحم.
وذهب بعض العلماء إلى أنّ لفظ ﴿صَدِيقٍ﴾ هنا يراد به الجمع، ويظهر ذلك من ثلاثة أوجه:
الأول: أنه اسمٌ على وزن (فَعِيل) فشُبِّه بالمصدر الآتي على (فَعِيل)؛ كالحنين والصهيل[47].
الثاني: أنّ المفرد إذا كان اسم جنس يكثر إطلاقه مرادًا به الجمع، سواء مع تنكيره -كما في هذه الآية- أم مع تعريفه، كما في قوله تعالى: ﴿أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ﴾ [النور: 61]. ومنه قول جرير:
نَصَبْنَ الهوَى ثم ارتَمَيْنَ قلوبَنا ** بأعينِ أعداءٍ وهُنَّ صديقُ[48]
يعني: صديقات.
وقول الصِّمَّة القُشَيري:
لعمري لئن كنتم على النَّأي والقِلَى ** بكم مِثل ما بي إنَّكم لَصديقُ[49]
أي: أصدقاء[50].
الثالث: أنَّ ﴿صَدِيقٍ﴾ نكرة في سياق النفي، فتدلّ على العموم.
هذه لمحاتٌ دالَّةٌ على أهمية هذا الباب، وأثر البلاغة في توجيهه.
قال ابن القيم: «فمثل هذا الفصل يُعَضُّ عليه بالنواجذ وتُثنى عليه الخناصر؛ فإنه يُشرِفُ بك على أسرارٍ وعجائب تجتنيها من كلام الله، والله الموفِّق للصواب»[51].
ثانيًا: صيغ الأفعال والمشتقات:
إنّ النظر في صيغة المفردة مِمّا تمسّ الحاجة إليه في علم البلاغة؛ إِذْ تنجلي به الفروق اللطيفة بين الاستعمالات، وتَبِينُ المعاني الخَفِيَّة، ويُعلم الموضع الذي هي به أليق، وهو إليها أحوج، فمما يلزم البلاغي أن يُعْنَى بالفروق الدقيقة بين الصّيغ، من جهة كون المفردة اسمًا أو فعلًا، ثم يدقّق في صِيَغ الاسم نفسه؛ كالمصدر واسم الفاعل واسم المفعول وغيرها، كما ينظر في أنواع الفعل، ودلالة كلّ نوع.
ومن الأصول المهمّة في هذا الباب التي ينصّ عليها البلاغيون: معرفة الفرق بين الاسم والفعل، وقد أبانه أحسن إبانة الشيخ عبد القاهر الجرجاني، فذكر أنَّ الاسم يدلُّ على ثبوت المعنى للشيء من غير أن يقتضي تجدّده شيئًا بعد شيء، وأمّا الفعل فيدلُّ على تجدّد المعنى شيئًا بعد شيء، فالاسم يدلُّ على الحدث مجرّدًا عن الزمن، والفعل يقترن بالزمن.
فقولك: (زيدٌ منطلقٌ)، يدلُّ على إثبات الانطلاق له، من غير دلالة على تجدد وحدوث شيء بعد شيء، فهو كالمعنى في قولك: (زيد طويل)، و(عمرو قصير). وقولك: (زيد ينطلق)، يدلُّ على أنّ الانطلاق يقع منه شيئًا فشيئًا. ومما يجلّي الفرق بينهما قول الشاعر:
لا يَأْلَفُ الدِّرْهَمُ المضروبُ صُرَّتَنا ** لكنْ يَمُرُّ عليها وهو منطلِقُ[52]
فعبّر بالاسم لأنه المناسب لمقامِ الافتخار، وَوَصْفِ الكريم المتلاف، ولو قيل: (وهو ينطلق) لَدَلّ على أنَّ الدراهم تنطلق تارة، وتقف تارةً، وهذا المعنى لا يليق بمقام الافتخار.
ومما يدلُّ على أنَّ أحدهما لا يصلح في موضع صاحبه قوله تعالى: ﴿وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ﴾ [الكهف: 18]، فَعُبِّر بالاسم ﴿بَاسِطٌ﴾؛ لأنَّ المقصود بيان حال الكلب وهيئته وصفته، وأنها صفة ثابتةٌ مستمرّة، وهذا هو المناسب لحال الراقد. أمّا لو عُبِّر بالفعل (يبسط) لاقتضى ذلك مزاولةً وتجددًا، وأنه يبسط يده تارةً ويقبضها تارةً أخرى، وهو غير مراد؛ لأنّ أهل الكهف رقودٌ لا أيقاظ.
ومن ذلك ما إذا قلت: (زيدٌ طويلٌ)، و(عمروٌ قصير) فإنه لا يصلح مكانه (يطول)، وإنما تقول ذلك إذا كان الحديث عن شيءٍ يزيد وينمو كالشجر والنبات والصبي ونحو ذلك، ومما يتجدّد فيه الطولُ أو يَحْدثُ فيه القِصَر، فأمّا وأنتَ تُحدِّثُ عن هيئةٍ ثابتة، وعن شيءٍ قد استقرّ طوله، ولم يكن ثمّ تَزايد وتجدّد، فلا يَصْلُح فيه إلا الاسم.
فهذا الفرق بين الاسم والفعل إذا ثبت في هذه الشواهد ونحوها، فإنه قد يخفى في شواهد أخرى، فلا تقضِ حينئذ بانتفاء الفرق، بل تيقن وجوده، وتأمّل، وقِس الخَفِيَّ على الجليّ[53].
ولا ينبغي للبلاغي أن يقف هنا، بل عليه أن يدقّق في صيغتي الاسم والفعل:
فأمّا الاسم فينظر إلى صيغته من جهة كونه مصدرًا أو اسم فاعل أو صيغة مبالغة أو اسم مفعول أو صفةً مشبهةً أو غير ذلك، فلكلٍّ منها محله الذي لا يصلح في غيره.
وأمّا الفعل فوروده يقتضي تقييده بأحد الأزمنة الثلاثة، المضيّ أو الحال أو الاستقبال، وقد يُراد به الاستمرار بمعاونة القرائن.
هذا كلّه من جهة الأصل، وقد يُعدل عنه لِسِرّ بلاغي، فَيُعَبَّرُ بالمضارع عن الماضي، أو عكسه، وبالمضارع عن الأمر، أو عكسه، وباسم الفاعل أو اسم المفعول عن المضارع أو غير ذلك، أو يُخالَف بين الصِّيَغ في السياق الواحد.
قال ابن الأثير: «واعلم أيها المتوشِّح لمعرفة عِلْمِ البيان، أنَّ العدول عن صِيغة من الألفاظ إلى صيغةٍ أخرى لا يكون إلا لنوع خصوصيةٍ اقتضت ذلك، وهو لا يتوخّاه في كلامه إلا العارفُ برموز الفصاحة والبلاغة، الذي اطلع على أسرارها، وفَتّش عن دفائنها، ولا تجد ذلك في كلّ كلام، فإنه مِن أشكل ضروب علم البيان، وأدقّها فَهمًا، وأغمضها طريقًا»[54].
ولدقَّةِ هذا الباب وغموضه كان مَوْرِدًا لجملة من (الأسئلة) في كتب المشكل، وسأذكر هنا نماذج من ذلك مع توجيهها، ليُستدَلَّ بها على سواها.
۱- قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النُّشُورُ﴾ [فاطر: 9].
الإشكال ووجهه[55]:
كيف جاء ﴿فَتُثِيرُ﴾ مضارعًا دون ما قبله وما بعده؟
توجيه الإشكال:
كان مقتضى الظاهر بَعْدَ الفعل الماضي ﴿أَرْسَلَ﴾، أن يعطف عليه بالماضي؛ فيقال: (فأثارَت)، لكن عُدِل عنه إلى المضارع ﴿فَتُثِيرُ﴾، ثم عُقِّبَ بفعل ماض: ﴿فَسُقْنَاهُ﴾. فما السِّر في التعبير بالمضارع بين ماضيَيْن؟
للبلاغيين في ذلك أقوال:
الأول: عُبِّر بالمضارع لاستحضار تلك الصورة البديعة الدالّة على قدرة الله، حتى كأنَّ القارئ يشاهدها وقت التلاوة، وهكذا يفعل البُلَغاء في كلّ فعلٍ ماضٍ فيه خصوصية بحال تستغرب وتهمّ السامع عبّروا عنه بالمضارع، ومنه قول تَأبَّطَ شَرًّا:
بأنِّي قد لَقِيتُ الغُولَ تَهْوِي ** بِسَهْبٍ كالصَّحيفة صَحْصَحَانِ
فأضربُها بِلا دَهَشٍ فَخَرَّتْ ** صَرِيعًا لِليَدَيْنِ وَلِلْجِرَانِ[56]
لأنه قصد أن يصوّر لقومه الحالة التي تَشَجَّعَ فيها على ضَرْبِ الغُول، كأنه يُبَصِّرُهم إياها ويطلعهم على كُنْهِهَا، مشاهدةً للتعجيب مِن جرأته على كلّ هول، وثباته عند كلّ شِدَّة، ولو قال: (فضربتها) لسقطت هذه الفائدة[57].
وهاهنا أمر يحسن التنبيه عليه حول معنى (استحضار الصورة الماضية)، نبّه إليه ابن يعقوب المغربي فقال: «ومعنى حكاية الحال: أن يُقدِّرَ المعنى الماضي حاضرًا الآن، أو يقدِّر المتكلّم نفسَه حاضرًا فيما مضى، فيعبر عن ذلك المعنى بصيغة الحضور وهي صيغة المضارع؛ لأنها تدلُّ في الأصل على أنَّ المعنى موجود حال التكلّم»[58].
ومؤدّاهما واحد، فإمّا أن يُستدعى الماضي إلى الحاضر، أو ينتقل المتكلّم إلى الزمن الماضي ليشهد ذلك الحدث، والمقصود على المعنيين: شهود الحدث.
الثاني: يرى الرازي في سر التعبير بالمضارع، أنّه لَمّا أُسنِدَ فِعْلُ الإرسال إلى الله -وما يفعلُ الله يكون بقوله: (كُن) فلا يبقى في العَدَمِ زمانًا ولا جزءًا من الزمان- عبّر بالماضي؛ إشارةً إلى وجوب وقوعه وسرعة كونه، ولَمّا أُسنِدَ فِعْلُ الإثارة إلى الريح، وهي تُؤلَّفُ في زمانٍ عُبِّر بالمضارع[59].
وفيه نظر، بدليل قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِى يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ﴾ [الأعراف: 57]، حيث عُبّر عن الإرسال بالمضارع. والآيات التي جاءت بالمضارع مع إسناد الفعل إلى الله، وجاءت بالماضي مع إسناده إلى المخلوق =كثيرة.
الثالث: جَوَّزَ البيضاوي أن يكون اختلافُ الأفعال للدلالة على استمرار الأمر، أي: أمر الإرسال والإثارة والسَّوْق والإحياء، وأنّ ذلك لا يختصّ بزمان دون زمان، وذلك لأنّه لا يصحّ المضيُّ والاستقبال في شيء واحد إلا إذا قصد ذلك[60].
قال القونوي: «وهذا لا يخلو عن كَدَر؛ لأنَّ المعتبر لمّا كان زمان الحكم لا زمان التكلُّم، يكون اختلافُ الأفعال بناءً على أنَّ الفعل الثاني مستقبَلٌ بالنسبة إلى الفعل الأول»[61].
وأورد السبكي على هذا القول إشكالًا وأجاب عنه، فقال: «فإن قلت: لو أُريد الاستمرار لأتى بالفعل المضارع في الجميع؟ قلتُ: وكذلك إذا أُريد الاستحضار (أي: استحضار المستقبَل)؛ إلا أن يُقال: أتى بالفعل الماضي أوّلًا؛ لأنه لو أتى بالمضارع لم يبقَ ما يدلّ على أنّ المراد الإخبار عن الماضي»[62].
ويمكن أن يكون معنى الاستمرار مستفادًا من لفظ ﴿فَتُثِيرُ﴾ فقط، لكن يدلُّ على أنَّ المستمرّ هو معنى الإثارة فقط، والأول يدلّ على أنَّ الاستمرار لمجموع هذه الأفعال[63].
الرابع: عبّر بالمضارع لأنَّ الإثارةَ خَاصِّيَّةٌ للرياح، وأثرٌ لا يَنْفَكّ في الغالب عنها، فلا يوجد إلا بعد إيجادها، فيكون مستقبلًا بالنسبة إلى الإرسال، بدليل فاء السببية في قوله: ﴿فَتُثِيرُ﴾، وعلى هذا يكون استعمال المضارع على ظاهره وحقيقته من غير تأويل؛ لأنَّ المعتبر زمانُ الحكم لا زمان التكلّم[64].
ويشكِل على هذا التقرير قوله بعد ذلك: ﴿فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ﴾ [فاطر: 9]، فإنَّ السَّوْق والإحياء لا يكونان إلا بعد إرسال الرياح وإثارة السحاب، وقد اقترنَا أيضًا بفاء السببية، ومع ذلك جاءَا بالماضي.
وبعد استعراض آراء العلماء يتبيّن أنَّ الأقربَ القولُ الأول، وهو جارٍ على المشهور عند البلاغيين في الغرض من التعبير بالمضارع موضع الماضي، وهو استحضار الصورة الماضية أو حكاية الحال حتى كأنها مشاهدة للسامع، وليس ذلك مما يثيره الفعل الماضي؛ لأنَّ سامعه يكتفي بِتَخَيُّلِ فِعْلٍ قد مضى، ولا يستحضرُ صورته في الحال. ويضافُ إلى هذا الغرض التَّفَنُّنُ في أسلوب الخطاب الذي يستدعي انتباهَ السامع، ويوقظُ إصغاءه.
۲- قوله تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ﴾ [الأعراف: 145].
الإشكال ووجهه[65]:
كيف قال: ﴿فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا﴾، وهم مأمورون بالعمل بكلّ ما في التوراة؟
توجيه الإشكال:
مفهوم قوله: ﴿وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا﴾ أنهم غير مأمورين بأخذ الحسن، ومفهوم الصفة حُجّة، لكنه غير مرادٍ قطعًا؛ لأنَّ الله تعالى أنكر على مَن آمن ببعض الكتاب وكفر ببعضه.
إذا تقرّر هذا فقد أجاب العلماء عن هذا الإشكال بعدّة أجوبة[66]:
الأول: أنَّ (أحسَن) صِلَةٌ، والمعنى: وأمر قومك يأخذوا بها.
قال أبو حيان: «وهو ضعيف؛ لأنّ الأسماء لا تُزاد»[67].
الثاني: أنّ الشريعة فيها الحسن والأحسن، فإذا اعترضَا أخذوا بالأحسن منهما؛ كالقصاص والعفو، والانتصار والصبر. وقيل: أحسنها الفرائض والنوافل، وحسنها المباح، وقيل: الأحسن المأمور به دون المنهيّ عنه.
وعلى هذا القول فاسم التفضيل على بابه.
الثالث: أنَّهم أُمِرُوا أن يأخذوا بحَسَنِها، فالشريعة حسنةٌ كلّها.
وعلى هذا القول فاسم التفضيل ليس على بابه من الدلالة على الاشتراك والتفضيل، وإنما يُراد به الوصف[68]، وقد عبّر به لإفادة المبالغة في الحُسْن، كقوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا﴾ [الأحقاف: 16]، أي: نتقبل حسن أعمالهم، فالآية وردَت في مقام المدح والامتنان، فلا يمكن حمل المعنى على أن الله تعالى لا يتقبل عنهم حسن أعمالهم، وكقوله تعالى: ﴿وبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾ [البقرة: ۲۲۸]، وغير الزوج لا حقّ له في ذلك.
٣- قوله تعالى: ﴿وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [التوبة: 121].
الإشكال ووجهه[69]:
كيف قال تعالى: ﴿لِيَجْزِيَهُمُ اللهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾، مع أنهم يُجزَون بِحَسَنِه أيضًا؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ [الزلزلة: 7]؟
توجيه الإشكال:
أُجيب عن ذلك بأجوبة:
الأول: أنّ ﴿أَحْسَنَ﴾ من صفة فِعلهم، وفيها الواجب والمندوب والمباح، والله تعالى يجزيهم على الأحسن، وهو الواجب والمندوب، دون المباح[70].
قال الشهاب الخفاجي: «وهو ناءٍ عن المقام مع قلّة فائدته؛ لأنَّ حاصله أنه تعالى يجزيهم على الواجب والمندوب وأنَّ ما ذُكر منه، ولا يخفى ركاكته، وأنه غير خفيّ على أحد. وقد يُقال: إنه كناية عن العفو عمّا فَرَط منهم في خلاله إن وقع؛ لأنَّ تخصيص الجزاء به يشعر بأنه لا يجازي على غيره»[71].
الثاني: أنّ ﴿أَحْسَنَ﴾ صفةٌ للجزاء، أي: يجزيهم جزاءً هو أحسن من أعمالهم وأجلّ وأفضل، وهو الثواب[72].
وقد أورد أبو حيان على هذا القول إشكالًا، فقال: «إذا كان الأحسن من صفة الجزاء فكيف أُضيف إلى الأعمال وليس بعضًا منها؟ وكيف يقع التفضيل إذ ذاك بين الجزاء وبين الأعمال ولم يُصَرَّح فيه بـ(مِن)؟»[73].
الثالث: أنّ المعنى: «ليجزيهم الله أحسن جزاء الذي كانوا يعملون؛ لأن عملهم له جزاء حَسَن وله جزاء أحسن، وهنا الجزاء أحسن جزاء»[74]. وعلى هذا القول فـ﴿أَحْسَنَ﴾ مفعول مطلق.
وهذا الجواب الثالث هو الأقرب؛ لمناسبته للسياق، فإن الآية سِيقت لحثّ المتخلّفين عن الجهاد مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على اللحاق به، ثم ذكرت الأجر العظيم الوافر الذي يلقونه: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطَئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ * وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [التوبة: 120- 121]، أي: ليجزيهم اللهُ أحسن جزاء وأوفاه، وبذلك ينتظم آخر الآية مع أوّلها، بخلاف الوجهين الأوّلَين ففيهما بُعْدٌ عن السياق. والله أعلم.
٤- قوله تعالى: ﴿وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ...﴾ [إبراهيم: 22].
الإشكال ووجهه[75]:
كيف قال تعالى: ﴿وَقَالَ الشَّيْطَانُ...﴾، بلفظ الماضي، وذلك القول من الشيطان لم يقع بعدُ، وإنما هو مُترقَّب مُنتظَر يقولُه يوم القيامة؟
توجيه الإشكال:
كان مقتضى الظاهر التعبير عن ذلك القول بصيغة المستقبَل، ولكن عدل عنه بذِكْر صيغة الماضي تنبيهًا على تحقّق الوقوع[76]، حتى كأنَّ الأمر قد مَضَى وانقضى، «وإنما يُفعل ذلك إذا كان الفعل المستقبَل من الأشياء العظيمة»[77]؛ ولذلك كثيرًا ما يقع هذا الأسلوب في القرآن عند الحديث عن الغيبيات؛ كأحوال يوم القيامة، فإنَّ إنكار الكافرين، وارتياب المنافقين، أكثر ما يقع في أمور الغيب؛ لأنها غير مشاهدة، بل ليس من المبالغة أن نقول: إنه لا يكاد يكون في القرآن الكريم آية أو آيات تتحدّث عن القيامة وأهوالها ومقدّماتها بصيغة المضارع إلا وفي تلك الآية أو سياقها فعلٌ ماضٍ، حتى إنَّ بعض المفسِّرين جعل التعبير بصيغة الماضي عن أحداث القيامة أصلًا؛ لأنه عدول عن المعهود في طريقة القرآن، وهو ما نجده عند ابن عاشور عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ﴾ [الحج: 2]. إِذْ يقول: «عدل عن فعل المضيّ إلى المضارع في قوله: ﴿وَتَرَى﴾ لاستحضار الحالة والتعجيب»[78]. فقد جرى على أنَّ الماضي في هذا الموضع هو الأصل؛ نظرًا لعادة القرآن[79].
وعلى ضوء ما تقدّم جاء قوله تعالى: ﴿وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ...﴾، بالتعبير بالماضي عن أمرٍ مستقبَل؛ وذلك ليستيقن المرتاب ويزداد المؤمن إيمانًا بأنَّه واقع لا محالة، فيحاسِب نفسه ويعمل لغدِه.
٥- قوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ [النساء: 103].
الإشكال ووجهه[80]:
كيف قال: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾، و(كان) لفظٌ دالٌّ على المضيّ، والصلاة فرضٌ مؤقَّت على المؤمنين في المضيّ والمستقبَل إلى يوم القيامة؟
توجيه الإشكال:
اختلف النحاة في دلالة (كان) على استمرار خبرها وانقطاعه[81] على أقوال:
القول الأول: أنَّها تقتضي الانقطاع وعدم الدوام كسائر الأفعال الماضية، وهو رأي أبي حيان، ونسبه إلى أكثر النحاة، فقال: «أكثر النحاة ذهبوا إلى أنّ (كان) تدلّ على الزمان الماضي المنقطع، وكذلك سائر الأفعال الماضية، ومَنْ تعقل حقيقة المضيّ لم يشكّ في الدلالة على الانقطاع، لكن مثل قوله تعالى: ﴿وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [النساء: 96]، وإنْ دلَّ على الماضي المنقطع، فإنه يُعلَمُ أنَّ هذه الصفة ثابتةٌ له في الأزمان كلّها مِن دليل خارج لا من حيث وضع اللفظ»[82].
وفي هذا القول نظر؛ وهو مخالف للكثير من الشواهد التي جاءت معها (كان) دالةً على الدوام.
القول الثاني: أنَّ الأصل في (كان) أن تدلّ على الدوام، ولا تدلّ على الانقطاع إلا بقرينة، وهو مذهب ابن معطي، فقد قال في ألفيته:
و(كان) للماضي الذي ما انقطعا[83]
وهذا القول مقابل للقول الأول، وهو مخالف للدلالة الأصلية للفعل الماضي، وتردُّه أيضًا الكثير من الشواهد، بل أنكره بعض العلماء؛ قال الزركشي: «سمعتُ شيخنا أبا محمد بن هشام -رحمه الله- ينكره عليه [أي: على ابن الخباز في شرح ألفية ابن معطي] ويقول: غَرَّه فيه عبارة ابن معطي، ولم يَصِر إليه أحد»[84].
القول الثالث: أنَّ الأصل في (كان) أن تدلّ على المضيّ فحسب، ولا تدلُّ على انقطاع أو استمرار إلا بقرينة، وهو ظاهر قول سيبويه: «وأمّا الفعل فأمثلة أُخِذَت من لفظ أحداث الأسماء، وبُنِيَتْ لِمَا مضَى، ولِمَا يكون ولم يقع، وما هو كائنٌ لم ينقطع»[85]. وهو اختيار الزمخشري[86]، وابن مالك حيث يقول: «الأصل في (كان) أن يُدَلَّ بها على حصول معنى ما دخلت عليه فيما مضى، دون تعرُّض لأوّليّةٍ ولا انقطاع -كغيرها من الأفعال الماضية- فإن قصد الانقطاع ضُمِّن الكلام ما يدلّ عليه، كقوله تعالى: ﴿وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ﴾ [آل عمران: 103]، وقد يقصد بها الدوام كما يقصد بـ(لم يزل)، كقوله تعالى: ﴿وَكَانَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا﴾ [الأحزاب: 27]»[87].
ويلحظ من خلال هذه الأقوال أنَّ دلالة (كان) على المضي قَدْرٌ متفقٌ عليه، وإنما الخلاف في دلالتها على الاستمرار أو الانقطاع، والأقرب وهو أنها قد تأتي لهما بقرينة، وبه يُجمَع بين النصوص الواردة دون تكلُّف.
وهنا يرِد السؤال: ما النكتة في استعمال (كان) بمعنى الدوام والاستمرار، مع أنها لا تدلّ بأصل وضعها على ذلك؟
والجواب: أنّ هذا الأسلوب يدلّ على تمكّن الصفة في الموصوف، وأنها صفة قديمة راسخة، فإنّ الصفات القديمة أثبتُ من الصفات العارضة الحديثة العهد؛ فإنّ قولك: (لم يزل محمد كريمًا) أبلغ وأعظم في الثناء مما لو قيل: (محمد كريم)؛ ولذلك تكرّر هذا الأسلوب في القرآن في صفات الله تعالى، كما في الآيات: ﴿وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ [النساء: 17]، ﴿وَكَانَ اللهُ عَفُوًّا غَفُورًا﴾ [النساء: 99]، ﴿وَكَانَ اللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا﴾ [النساء: 126]، وغيرها من الآيات. فهو يدلّ على أنه -سبحانه وتعالى- لم يزل كذلك منذ الأزل، وأنه لم يخلُ في زمن من الأزمان عن الاتصاف بصفات الكمال، وعلى هذا تصبح (كان) من المؤكِّدات.
وفي ضوء ما تقدّم يتضح وجه قوله: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾، وأن استعمال (كان) هنا يدلّ على أنَّ مِن شأنِ المؤمنين مُذ كانوا المحافظةَ على الصلاة في وقتها، ويدلّ على ذلك أنَّ الصلاة كانت من شرائع الأنبياء مِن قبلنا، كما قال تعالى عن إبراهيم وإسحاق ويعقوب -عليهم السلام-: ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ﴾ [الأنبياء: 73]، وقال عن إسماعيل -عليه السلام-: ﴿وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ﴾ [مريم: 55]. وعن عيسى -عليه السلام-: ﴿وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ﴾ [مريم: 31]. وغيرها من الآيات، ففي استعمال (كان) هنا مناسبة للمعنى.
وأمرٌ آخر، وهو أنَّ هذه الآية وردَت بعد الأمر بصلاة الخوف، وأنه يجب أن تصلَّى الصلاة في وقتها، حتى عند ملاقاة العدوِّ؛ لأنها ما زالت على المؤمنين كتابًا موقوتًا.
هذه خمسة نماذج نكتفي بها في بيان أثر صيغ الأفعال والمشتقّات في توجيه المشكل[88].
ثالثًا: التعريف والتنكير:
مما يجب على البليغ أن يراعيه صيغة المفردة تعريفًا وتنكيرًا، فلكلّ منهما دلالة خاصّة تختلف باختلاف السياق، فإنَّ جملتي: (زيدٌ منطلقٌ) و(زيدٌ المنطلقُ)، لكلٍّ منهما مقام؛ فالتنكير يكون مع مَن لم يعلم أنَّ انطلاقًا كان، فتفيده ذلك ابتداءً، وأمّا التعريف فيكون مع مَن عَلم أنَّ انطلاقًا كان، غير أنه لا يعلم أكان من زيدٍ أم من عمرو، فتُعلِمُهُ أنه كان من زيد دون غيره[89].
يقول الزملكاني: «قد يظنّ ظانٌّ أنَّ المعرفة أجلى، فهي من النكرة أَوْلَى، ويخفى عليه أنَّ الإبهام في مواطن خليق، وأنّ سلوك الإيضاح ليس بسلوكٍ للطريق.. وعلّة ذلك أن النكرة ليس لمفردها مقدار محصور، بخلاف المعرفة، فإنه لواحدٍ بعينه يثبت الذهن عنده، ويسكن إليه»[90].
وهذا الباب (التعريف والتنكير) وإن بحثه النحاة من قبل، إلا أن أصل عمل النحوي هو التمييز بينهما، ثم يأتي البلاغي فيعتني بموقع كلٍّ منهما، ويستشرف آفاقًا جديدة؛ فمن ذلك ما ذكره النحاة من أنَّ المعارف ستة أنواع، كما قال ابن مالك:
وغيره معرفة كَهُمْ وذي ** وهندَ وابني والغلامِ والذي
فجاء البلاغيون فعقدوا لكلّ نوع بابًا، وذكروا أغراض التعريف به[91].
فالنحوي ينظر إلى المعرفة والنكرة من الناحية الشكلية، والبلاغي ينظر إليهما من الناحية الوظيفية، ويرى أنه «يتعلّق بكلّ واحدٍ منهما معانٍ دقيقةٌ متعلقةٌ بأسرار البلاغة»[92].
ولأجل تلك المعاني الدقيقة، دار حول التعريف والتنكير شيء من المشكل، وهذه نماذج منه:
۱- قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ﴾ [الزخرف: 84].
الإشكال ووجهه[93]:
ظاهره يقتضي تعدّد الآلهة؛ لأنَّ النكرة إذا أُعيدَت تعدّدَت، كقوله تعالى: ﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا * إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾ [الشرح: 5- 6]؛ ولهذا قال عمر -رضي الله عنه-: «لن يَغلب عسرٌ يُسرَيْن».
توجيه الإشكال:
إذا أُعيدت النكرة بلفظها فالثانية غير الأُولى، فإن كانت الثانية معرفةً فهي الأُولى، ألا ترى أنك لو أكرمت رجلًا وكسوته كانت العبارة عنه: أكرمتُ رجلًا وكسوته، ولو أكرمت رجلًا وكسوت غيرَه كانت العبارة: أكرمتُ رجلًا وكسوتُ رجلًا، وعلى ذلك ورَدَ قوله تعالى: ﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا * إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾ [الشرح: 5- 6]؛ ولهذا قال عمر -رضي الله عنه- وغيرُه: «لن يَغلب عسرٌ يُسرَيْن»[94].
ومنه قوله تعالى: ﴿وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ﴾ [سبأ: 12]، فالشهر الثاني غير الشهر الأول، فيكون المجموع شهرين.
وقد ذكر هذه القاعدةَ كثيرٌ من العلماء كالفرّاء والزجّاج وغيرهما[95]، وخَرَّج عليها الفقهاء -ومنهم الحنابلة- بأنَّ مَن قال لزوجه: (أنتِ طالقٌ نصف طلقة وثلث طلقة وسدس طلقة) طُلّقت ثلاثًا[96].
ورَدَّها آخرون كأبي علي الجرجاني، والزمخشري، وأبي حيان، وابن هشام، وابن عاشور[97]، قالوا: إنما هو تكرار قُصد منه المبالغة والتوكيد. وأورد ابن هشام آيتين تخالفها، وهما قوله تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً﴾ [الروم: 54]، وقوله: ﴿وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ﴾ [الزخرف: 84].
ويمكن التَّفَصِّي عن اعتراضهم بأحد جوابين:
الأول: أن يُقال: إنّ هذه القاعدة في تكرار النكرة ليست على إطلاقها، قال البهاء السبكي: «هذه القاعدة الظاهر أنها غير محرّرة»، ثم قسَّمها ليس باعتبار التعريف والتنكير، بل باعتبار العموم والخصوص، وخَلَص إلى أنَّ النكرتين إذا كانتَا عامّتين فالثانية هي الأولى؛ وذلك لأنَّ مِن ضرورة العموم أن يكون الثاني هو الأول؛ لأنهما مستوفيان لجميع الأفراد، فالعام لا يتعدّد، وإن كانتا خاصّتين فالثانية غير الأولى؛ لأنه لو كان إياه، لكان إعادة النكرة وضعًا للظاهر موضع المضمر، وهو خلاف الأصل، ويحتمل خلافه. وإن كانت إحداهما عامةً والأخرى خاصةً، دخلت إحداهما في الأخرى؛ ضرورةَ اشتمال العام على الخاص[98].
الثاني: أنَّ هذه القاعدة إنما يُصار إليها مع عدم القرينة، فإن وُجدت قرينةٌ وجب المصير إليها، قال السعد التفتازاني: «واعلم أنّ المراد أنّ هذا هو الأصل عند الإطلاق وخلوّ المقام عن القرائن، وإلا فقد تُعَادُ النكرةُ نكرةً مع عدم المغايرة؛ كقوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ﴾ [الزخرف: 84]، وقوله: ﴿وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنَزِّلَ آيَةً﴾ [الأنعام: 37]، وقوله: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً﴾ [الروم: 54]، يعني قوّة الشباب، ومنه: باب التوكيد اللفظي»[99]. ومنه: تكرار (ويل) في سورة المرسلات في قوله تعالى: ﴿وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ﴾.
ومع أنَّ ابن هشام قد رَدَّ القاعدة إلا أنه أشار إلى قوّة هذا الجواب، فقال: «فإذا ادُّعي أنَّ القاعدة فيهنَّ إنما هي مستمرةٌ مع عدم القرينة، فأمّا إن وُجدتْ قرينة فالتعويل عليها، سَهُلَ الأمر»[100]. قال الدسوقي: «لا يرتاب في أنَّ هذا قصدهم، ولا يجوز حَمْل كلامهم على غيره»[101].
وحينئذٍ نرجع إلى الآية موضع البحث، وهي قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ﴾، فالنكرة وإن تكرّرت هنا إلا أنها بمعنى واحدٍ قطعًا، فالربّ -سبحانه وتعالى- واحد لا شريك له، فيُجاب عن القاعدة من وجوه:
الأول: أن يُقال: إنّ هذه القاعدة غير صحيحة أصلًا، وأنَّ التكرار إنما هو للتوكيد، وهو مذهب أبي علي الجرجاني وغيره كما سبق، ولا يَرِدُ الإشكال على هذا الرأي.
الثاني: أن يُقال: إنّ القاعدة إنما يُعمل بها عند عدم القرينة -كما ذكر السعد- أمّا إن وُجدت فيجب المصير إليها، وقد دلّت القرينة في هذه الآية، بل الدليل القاطع على أن النكرة الثانية هنا هي الأُولى.
الثالث: أنه يشترط في إعمال القاعدة: أن لا يُقصد التكرار، فإن كان مقصودًا كان الثاني هو الأول، كما في هذه الآية. ذكره الطيبي[102]. وهو يرجع إلى القول الثاني؛ فإنَّ قَصْدَ التكرار من جملة القرائن.
الرابع: أنَّ ﴿إِلَهٌ﴾ في الآية بمعنى: (معبود)، فالاسم المشتقّ إنما يُقصد به ما تضمّنه من الصفة، فصار المعنى: وهو الذي في السماء معبود وفي الأرض معبود، والمغايرة ثابتةٌ بين معبودِيَّته في السماء ومعبودِيَّته في الأرض؛ لأنَّ العبودية من الأمور الإضافية، فيَكفي في تغايرهما التغاير من أحد الطرفين، فإذا كان العابد في السماء غير العابد في الأرض، صدق أن معبوديّته في السماء غير معبوديّته في الأرض، مع أنَّ المعبود واحد[103].
وهذا أحسنُ الوجوه.
وهذه الآية نظير آية الأنعام: ﴿وَهُوَ اللهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ﴾ [الأنعام: 3]، وهو كما تقول: زيد في الشرق خليفة وفي الغرب خليفة.
قال ابن عاشور: «عطف قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ﴾، على جملة: ﴿قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ...﴾ [الزخرف: 81]، والجملتان اللتان بينهما اعتراضان، وقُصد من العطف إفادة نفي الشريك في الإلهية مطلقًا، بعد نفي الشريك فيها بالبُنُوَّة، وقصد بذكر السماء والأرض الإحاطة بعوالم التدبير والخلق؛ لأنَّ المشركين جَعلوا لله شركاء في الأرض وهم أصنامهم المنصوبة، وجعلوا له شركاء في السماء وهم الملائكة؛ إِذْ جعلوهم بناتٍ لله تعالى، فكان قوله: ﴿فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ﴾، إبطالًا للفريقين مما زعمت إلهيتهم». وإفادة نفي الشريك مستفاد من قوله: ﴿وَهُوَ الَّذِي﴾ أي: لا غيره؛ فهو قصر بتعريف الطرفين[104].
۲- قوله تعالى: ﴿وَلَيَالٍ عَشْرٍ﴾ [الفجر: 2].
الإشكال ووجهه[105]:
قال تعالى: ﴿وَالْفَجْرِ * وَلَيَالٍ عَشْرٍ * وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ * وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ﴾ [الفجر: 1- 4]، لِـمَ وردَت الليالي العشر منكَّرة دون سائر ما أقسَم الله به؟
توجيه الإشكال:
الليالي العشر: هي ليالي أيامِ العشر الأُوَل من ذي الحجة في قول أكثر المفسِّرين. وقيل: هي العشر الأواخر من رمضان[106]. فهي بلا شكّ ليالٍ عظيمةٌ، فقد أقسم اللهُ له بها، وقد اختلف أهل العلم في وجه تنكيرها على ثلاثة أقوال:
فقيل: للتفخيم والتعظيم[107]، فنُكِّرت لفضيلتها من بين ما أقسَم اللهُ به.
وقيل: للتقليل.
وقيل: للتعيين.
وهذان القولان (التقليل والتعيين) احتملهما قول الزمخشري: «نُكِّرَتْ لأنها ليالٍ مخصوصةٌ من بين جنس الليالي، العشرُ بعضٌ منها».
فقد فهم الطيبي وابن التمجيد أنه أراد أنَّ التنكير للتقليل[108].
وفهم ابن عرفة أنه أراد أنَّ التنكير للتعيين، ثم قال: «فَرُدَّ عليه بمنافاة التنكير للتعيين. وأُجيب بأنها لشرفها وعِظَمِها صارت معلومات في الذِّهْن فلم تحتج إلى تعريف»[109].
وظاهر اللفظ يؤيّد قول ابن عرفة، ولكن يبعد أن يريده الزمخشري، فإنَّ النكرة لا تأتي قطُّ للتعيين، بل تدلُّ في أصل وضعها على ضدّه وهو الإبهام أو العُموم؛ إمّا العموم الشمولي كالنكرة في سياق النفي، أو العموم البدلي كالنكرة في سياق الإثبات، وهو معنى لا يفارقها، ثم تأتي مع ذلك لمعانٍ أخرى تستفاد من السياق، ليس التعيينُ أحدَها[110].
والجواب الذي ذكره ابن عرفة متكلَّف.
وأظهر الأقوال أنَّ التنكير في الآية جاء للتفخيم والتعظيم؛ فإن وصف الليالي بكونها عشرًا، دلّ على التقليل والتعيين، فلم يبقَ إلا التعظيم.
فإن قيل: وكذلك قد دلَّ القَسَم على تعظيمها؟
فيقال: هذا صحيح، ولكنّها حينئذٍ مساوية للفضل بما أقسَم اللهُ به قبلها وبعدها، فلما نُكِّرت زاد فضلها على أخواتها، لا سيما أنَّ المراد بها على الصحيح عشر ذي الحجة، وهي أعظم الأيام عند الله، فعن ابن عمر -رضي الله عنهما- أنّ النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (ما مِن أيامٍ أعظم عند الله -سبحانه وتعالى- ولا أحبّ إليه العمل فيهنَّ من هذه الأيام العشر). رواه أحمد[111].
قال ابن حجر: «الذي يظهر أنَّ السبب في امتياز عشر ذي الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادة فيه؛ وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج، ولا يتأتّى ذلك في غيره»[112].
فإذا كانت هذه الأيام بهذه المكانة، كان تنكيرها دالًّا على تعظيمها، ومجيء التنكير لذلك كثير، كقوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً﴾ [النحل: 65]، و﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً﴾ [آل عمران: 13]، و﴿إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَارًا﴾ [النبأ: 31].
قال ابن القيم: «وإنما كان التنكير للتعظيم؛ لأنه صُوِّر للسامع بمنزلة أمرٍ عظيم لا يدركه الوصف، ولا يناله التعبير»[113].
وثمة نكتتان أخريان ناسب معهما التنكير:
الأولى: أنَّ الليالي وردَت مجموعةً، والتنكير في الجمع أخفّ[114].
الثانية: أنَّ اللامات في (الفجر والشفع والوتر) للجنس، ولو عُرِّفت (ليال) لكانت اللام فيها للعهد «والأحسن أن تكون اللامات متجانسة؛ ليكون الكلام أبعد من الألغاز والتَّعْمِية»[115].
٣- قوله تعالى: ﴿عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ﴾ [التكوير: 14].
الإشكال ووجهه[116]:
كيف أثبتَ العلمَ لنفسٍ واحدة، مع أنَّ كلَّ نَفْسٍ تعلم ما أَحْضَرت يوم القيامة، بدليل قوله تعالى: ﴿يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرِ مُحْضَرًا﴾ [آل عمران: 30]؟
توجيه الإشكال:
لا شكّ أنَّ النكرة هنا تدلّ على العموم، بدليل آية آل عمران، ولكن الإشكال في وجه عمومها، وقد اختلف العلماء في توجيه ذلك على سبعة أقوال:
القول الأول: أنَّ النكرة هنا مثبتة، والقاعدة: (أنَّ النكرة في سياق الإثبات تدلّ على الإطلاق لا على العموم)، ولكن استثنَى منها الأصوليون ما لو دلّ الدليل على إرادة العموم فإنها تكون عامة، كما في هذه الآية، واستعمالها حينئذٍ مجازٌ مرسلٌ، مِن إطلاق النكرة وإرادة الجنس[117]، أو من إطلاق بعض أفراد العام وإرادة العام[118].
وإلى هذا القول ذهب الأصوليون، وارتضاه البيضاوي في تفسيره فقال: «﴿نَفْسٌ﴾ في معنى العموم»[119]، ولم يقل: للعموم؛ ليدفع بذلك هذا الإشكال، وهو أنها نكرة في سياق الإثبات.
القول الثاني: أنّ هذا من قبيل حذف المضاف، والتقدير: كلُّ نفس[120]، فهو من الإيجاز بالحذف، بدليل قوله تعالى: ﴿يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا﴾ [آل عمران: 30]، حيث جيء بكلمة العموم ﴿كُلُّ﴾ مع أنَّ المقصود واحد في الآيتين.
القول الثالث: أنها عامة بعموم العلّة[121].
وعلى هذا القول فهي في لفظها ليست عامةً، وإنما استُفيد عمومها بطريق القياس، فإن العلة تعمِّم معلولها، فإذا ثبت بالنصّ أنَّ نفسًا واحدةً تعلم ما أحضرت فتقاس عليها باقي النفوس، والعلّة هنا هي اجتماع تلك الأمور من تكوير الشمس وانكدار النجوم... وذلك يوم القيامة، فحينها تستوي جميع النفوس بالعِلْم بما أحضرت.
القول الرابع: أنَّ هذا من باب عكس الكلام، كما ذهب إليه الزمخشري، حيث قال: «هو من عكس كلامهم الذي يَقصدون به الإفراط فيما يُعْكَسُ عنه، ومنه قوله عزّ وجلّ: ﴿رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ﴾ [الحجر: 2]، ومعناه: معنی (كم)، وأبلغ منه. وقول القائل:
قد أتركُ القِرْنَ مُصْفَرًّا أَنامِلُهُ[122]
وتقول لبعض قُوّاد العساكر: كم عندك مِن الفرسان؟ فيقول: رُبَّ فارسٍ عندي، أو لا تعدم عندي فارسًا، وعنده المَقَانِب، وقَصْدُه بذلك التَّمادي في تكثير فرسانه، ولكنه أراد إظهار براءته من التزيد، وأنه ممن يُقَلِّلُ كثير ما عنده، فضلًا أن يتزيد، فجاء بلفظ التقليل، ففهم منه معنى الكثرة على الصحة واليقين»[123].
فيرى الزمخشري أنَّ قوله: ﴿نَفْسٌ﴾ تفيد القلّة، لكنها وُضعت موضع الكثرة تعكيسًا، لإرادة الإفراط في الكثرة. وقد نَبَّه الطيبي إلى أنَّ العكس في الكلام إنما يُصار إليه للمبالغة إذا لم يُنازَع المتكلّم فيما عُكِس عنه، وأنَّ مرادَه كالمجمع عليه بقرائن الأحوال[124].
وبَيَّن ابن المنيِّر وجه دلالة هذا الأسلوب على المبالغة، وهو أنَّ الشيء إذا بلغ منتهاه انعكس إلى ضدّه، قال: «المقصود في ذلك: الإيذان بأن المعنى قد بلغ الغاية حتى كاد أن يرجع إلى الضد، وذلك شأن كلّ ما انتهى لنهايته أن يعود إلى عكسه، وقد أفصح أبو الطيب عن ذلك بقوله:
ولَجُدْتَ حتى كدتَ تبخلُ حائلًا ** للمنتهى ومِن السُّرور بكاءُ»[125].
وجعله الفارسي القزويني (تلميذ الطيبي) من قبيل الاستعارة، فقال: «الأصل في هذا الباب أنَّ استعارة أحد الضدّين للآخر تفيد المبالغة للتعكيس، ولا تختصّ بالتهكُّم والتمليح على ما يوهمه ظاهر لفظ صاحب المفتاح في موضع»[126].
ونازع بعضُ العلماء الزمخشريَّ، كأبي السعود، فقد ذهب إلى أنَّ هذه الآية لا يصح تطبيق الكلام المعكوس عليها، فقال: «الكلام المعكوس عنه فيما ذُكِرَ من الأمثلة مما يَقبلُ الإفراط والتمادي فيه، فإنّه في الأول كثيرًا ما يودُّ، وفي الثاني كثيرًا ما أتركُ، وفي الثالث كثيرٌ من الفرسان، وكلُّ واحدٍ من ذلك قابل للإفراط والمبالغة فيه لعدم انحصار مراتب الكثرة، أمّا فيما نحن فيه فالكلام الذي عُكِسَ عنه عَلِمَتْ كُلُّ نفسٍ ما أحضرتْ -كما صرَّحَ به القائل- وليس فيه إمكانُ التكثيرِ حتّى يُقصد بعكسه المبالغةُ والتَّمادِي فيه، وإنما الذي يمكنُ فيه من المبالغة ما ذكرناه، فتأمّل»[127].
القول الخامس: أنَّ النكرة هنا عامةٌ لوقوعها في سياق التخويف والتحذير. قاله البقاعي[128].
ولم أرَ من ذكره من الأصوليين، ويمكن أن يُورَد على البقاعي قوله تعالى: ﴿وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ﴾ [الحشر: 18]، فقد حَكَم هو بكونها عامةً[129] مع أن السياق هنا ليس سياق تخويف، فدلّ على أنَّ العموم ليس مستفادًا منه.
القول السادس: أنَّها عامة لوقوعها في سياق الشرط. نُسِبَ إلى الشيخ زادَهْ[130]، وأومَأ إليه ابن عاشور[131].
وفيه نظر؛ لأنَّها واردةٌ في جواب الشرط، وهو خارج عن مراد الأصوليين بالسياق، فبين الشرط وجوابه فرقٌ في هذا الباب، لأنَّ الشرط في معنى الكلام المنفي، بخلاف الجواب، وقد قال ابن عاشور بعد ذلك: «واستفادة العموم من النكرة في سياق الإثبات تحصل من القرينة الدالّة على عدم القصد إلى واحدٍ من الجنس، والقرينة هنا وقوع لفظ ﴿نَفْسٌ﴾ في جواب هذه الشروط التي لا يخطر بالبال أن تكون شروطًا لشخص واحد». وهذا هو الصحيح -وهو القول الأول المتقدّم- وهو مُغْنٍ عن تعليله بالشرط في صدر حديثه.
القول السابع: عمومها مستفاد من وقوعها في سياق النفي، أو معنى النفي، وهذا القول أشار إليه الشهاب الخفاجي[132]. ومقصوده أنّ ﴿عَلِمَتْ﴾، أي: لم تجهل، فهي بمعنى النفي.
وهذا القول ليس بشيء -كما يقول الآلوسي- وإلا لَعَمَّتْ كلُّ نكرة في الإثبات بنحو هذا التأويل[133].
هذا هو مجموع ما قيل في وجه عموم النكرة في الآية، وأظهرُ الأقوالِ الأربعةُ الأُولى، وأمّا سائرها فهو متعقَّب كما تقدّم.
وأيًّا ما كان، فالنكرة هنا عامة، وإذا ثبت عمومها فما نكتة تنكيرها؟
في ذلك أربعة أقوال:
الأول: للتكثير، وهو جارٍ على مذهب الزمخشري الذي يرى أنَّ الآية من قبيل (الكلام المعكوس)، فنكِّرت ﴿نَفْسٌ﴾ للدلالة على الكثرة مبالغةً[134].
الثاني: للتقليل والتحقير: فسياق الآيات فيه تهويل لذلك اليوم وإظهار لكبرياء الله تعالى وعظمته، حتى كأنَّ جميع النفوس البشرية في جنب ما خلقه اللهُ من الأجرام العظام أمورٌ قليلةٌ ونفوس حقيرة[135].
قال ابن عطية: «ووقع الإفراد لتنبيه الذِّهن على حقارة المرء الواحد وقِلّة دفاعه عن نفسه»[136].
الثالث: للتخويف: قال البقاعي: «ولعلّه نُكِّرَ إشارةً إلى أنه ينبغي لمن وهبه اللهُ عقلًا أن يجوِّز أنه هو المرادُ فيخاف»[137].
وهذه الأقوال تأتلف ولا تختلف؛ فإن النفس في ذلك الحين، وقد انقلبت أحوال الكون، وزلزلت الأرض، وذهب ضوء الشمس، وتساقطت الكواكب، وتفتت الجبال، وتأججت البحار نارًا، وتلاقت الوحوش، ونُشرت الصحف، ونُصبت الموازين... إلى آخر تلك الأهوال =في غاية القلة والذلّة والخوف. اللهم آمِن روعنا يوم الفزع.
الرابع: للتنويع، والمعنى: علمت نفس كافرة، ووجه ذلك: أنَّ الكفار كانوا يُتعِبون أنفسهم في الأشياء التي يعتقدونها طاعات، ثم بدَا لهم يوم القيامة خلافُ ذلك[138].
وهذا القول مبنيّ على أن المقصود بالنفس في الآية: النفس الكافرة، وهو وإن كان يؤيده الظاهر، فإنّ التنكير هنا الأصل فيه أنه للإفراد أو النوعية، إلا أنه مردود بدلالة السياق، والنصّ كما في قوله: ﴿يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا﴾، كما أنه من المعلوم أنَّ عِلْمَ النفوس بما أَحضرت يوم القيامة لا يختصّ بأفراد دون آخرين، بل ما ثبت للبعض ثبت للكلّ، فالنكرة هنا عامة كما تقدّم.
فإن قيل: إذا كانت النكرة هنا مفيدة للعموم فَلِـمَ لَمْ تأتِ ابتداءً بلام التعريف؟
فيقال: لو أتي بها كذلك لذهبت فائدة التنكير، ولتُوهِّمَ نفسٌ معهودة.
٤- قوله تعالى: ﴿وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ﴾ [الفلق: 4].
الإشكال ووجهه[139]:
كيف عرَّف سبحانه ﴿النَّفَّاثَاتِ﴾، ونَكَّرَ ما قبلها ﴿غَاسِقٍ﴾، وما بعدها وهو ﴿حَاسِدٍ﴾، مع أن الجميع مُستعاذ منه؟
توجيه الإشكال:
عُرّفت ﴿النَّفَّاثَاتِ﴾ لإفادة العموم، فاللام فيها للاستغراق، وتنكير ﴿غَاسِقٍ﴾ و﴿حَاسِدٍ﴾ للتبعيض. قال الزمخشري: «عُرّفت ﴿النَّفَّاثَاتِ﴾؛ لأَنَّ كُلَّ نَفَّاثَةٍ شِرِّيرةٌ، ونُكِّر ﴿غَاسِقٍ﴾ لأنَّ كلَّ غاسق لا يكون فيه الشر، إنما يكون في بعضٍ دون بعض، وكذلك كلّ حاسد لا يضرُّ، وربَّ حَسَدٍ محمود، وهو الحسد في الخيرات، ومنه قوله: (لا حسدَ إلا في اثنتين...)[140]»[141].
فالنفث: السحر، وهو شرٌّ محض لا خير فيه، ولا فلاح لصاحبه، كما قال تعالى: ﴿وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى﴾ [طه: 69]، فقد نُفي عنه الفلاح مطلقًا، وأُكِّد بعمومين؛ عموم المضارع المنفي، وعموم ﴿حَيْثُ﴾، وهكذا جاء قوله تعالى: ﴿النَّفَّاثَاتِ﴾، فقد عُرِّف بلام التعريف للدلالة على شمول الشرّ لجميع أفرادهنّ، وعلى تمحضهنَّ فيه؛ ولذلك لم تأتِ الاستعاذة من النفث، بل من النفّاثات أنفسهنّ، كما أنها جاءت بصيغة المبالغة للإشارة إلى أنَّ النافث لا يكون إلا نَفَّاثًا، فهي خَلَّةُ سُوءٍ غالبة، ولأجل ذا جاءت الاستعاذة منهنَّ مطلقةً لم تُقيَّد بظرف، بخلاف الغاسق والحاسد فقد قُيِّدَا؛ أمّا الغاسق فإنّه الليل إذا أظلم، وليس الشر منه لذاته؛ إنما لأنه سترٌ لذوي الشر؛ لاحتجابهم بظُلْمته عن أعين الناس، ولذلك قيل: «الليل أخفَى للويل»[142]، فالشر فيه لا منه، ألا ترى أنه لأهل الخير رحمةٌ ونعمةٌ، قال تعالى: ﴿وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ﴾ [القصص: 73]، فنسبة الشر إليه من تلك الجهة فحسب، والإضافة تكون بأدنى ملابسة، وأمّا الحاسد فإنَّ القائم بنفسه من هذه الصفة قبل أن يمضَى يمكن أن يُنفِذَها حسدًا ويمكن أن يُنفِذَها غبطةً، فلا يتبين كونه حسدًا إلا بعد أن يمضى ويوقع، ألا ترى أنَّ أول ما يقوم بالنفس من هذه الصفة هو أن يتمنى نعمةً رآها على غيره، فإن أراد زوالها عنه فهذا هو الحسد المذموم، وإن لم يرِد زوالها عنه فهذه هي الغبطة وهو الحسد المحمود، فقد وضح أنه إنما يكون حسدًا ويوصف بتلك الصفة عند ظهوره ووقوعه على الصفة المذمومة، وأمّا قبل ذلك فليس بشَرٍّ ولا فيه شرّ[143].
وقيل: بل التعريف في ﴿النَّفَّاثَاتِ﴾ للعهد الذهني، ذكره ابن عاشور حيث يقول: «وتعريف ﴿النَّفَّاثَاتِ﴾ تعريف الجنس وهو في معنى النكرة، فلا تفاوت في المعنى بينه وبين قوله: ﴿وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ﴾، وقوله: ﴿وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ﴾، وإنما أُوثر لفظ ﴿النَّفَّاثَاتِ﴾ بالتعريف؛ لأن التعريف في مثله للإشارة إلى أنه حقيقة معلومة للسامع.. وتعريف ﴿النَّفَّاثَاتِ﴾ باللام إشارة إلى أنهنَّ معهودات بين العرب»[144].
ومراد ابن عاشور بـ(تعريف الجنس) العهد الذهني، ولا يريد لام الجنس التي هي لام الحقيقة، وإن كان لفظه يوهِم ذلك، لكنه تابع الزمخشري على هذا الاصطلاح، وانتُقِد عليه[145].
والقول الأول هو الأقرب، وذلك لأنّ الأصل حمل اللام على الاستغراق عند الجمهور، إلا إذا وُجدت قرينة على إرادة العهد فيحمل عليه إجماعًا[146]، ولا قرينة هنا.
فإن قيل: لو كان التعريف هنا للاستغراق لجيء باللفظ مفردًا، فإنَّ «استغراق المفرد أشمل من استغراق الجمع» كما يقول السكاكي وتبعه القزويني[147].
فيقال: هذا صحيح في النكرة المنفية، أمّا المعرَّف باللام فاستغراق المفرد والجمع فيه سواء؛ ولهذا لا خلاف في صحة قولك: (جاء العلماء إلا زيدًا)، والاستثناء معيار العموم.
وما ذهب إليه السكاكي مخالفٌ لِمَا ذكره أكثر أئمة الأصول والنحو، ودلّ عليه الاستقراء، وصَرَّح به أئمة التفسير في كلّ ما وقع من التنزيل من هذا القبيل، وحُكي إجماعًا للصحابة[148]، وقد حقّقه السعد بما لا مزيد عليه[149]، فالمتعيّن أنَّ استغراق المفرد والجمع في المعرَّف باللام سواء، وإنما يُعبّر بالإفراد تارةً وبالجمع تارةً حسب ما يقتضيه الحال.
وهناك احتمال ثالث: أن تكون اللام في ﴿النَّفَّاثَاتِ﴾ هي الموصولة، وهي تفيد العموم، وتفيد عِلِّيَّةَ الحكم، أي: سبب الاستعاذة من شر النفاثات هو نفثهنَّ.
٥- قوله تعالى: ﴿وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ...﴾ [البقرة: 25].
الإشكال ووجهه[150]:
اللام في ﴿الصَّالِحَاتِ﴾ تعمّ كلَّ أفراد الصالحات، فعلى هذا لا تكون البشارة إلا لمن فعل كلّ الصالحات، وهو غير ممكن.
توجيه الإشكال:
اللام في ﴿الصَّالِحَاتِ﴾ محتملة من جهة اللغة عدّة احتمالات:
الأول: أن تكون للاستغراق الحقيقي، وهو محلّ الإشكال، وليس بمرادٍ قطعًا؛ إِذْ لا يمكن لأحدٍ أن يعمل جميع الصالحات، وقد قال تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: 286].
فإن قيل: يمكن أن تكون اللام هنا للاستغراق الحقيقي، لكن ليس على سبيل طلبها من كلّ فرد، بل من المجموع، فإنَّ مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة أفرادًا.
فيُقال: يرِد على هذا إشكال آخر، وهو أنَّ كلَّ فردٍ حينئذ يكفيه عمل صالح ولو تركَ سائرَها، وهو غيرُ مراد.
الثاني: أن تكون للاستغراق العُرفي، نحو: (جمع الأمير الصّاغَة) أي صاغة بلده، لا صاغة الدنيا، ويكون المعنى: أنَّ كلّ واحدٍ عَمِلَ جميع الأعمال الصالحة التي تجب عليه بحسب حاله، والقرينة على هذا المعنى اختلافُ أحوال المكلَّفين[151]. وهو أحسن ما قيل.
الثالث: أن تكون للجنس، وهو رأي الزمخشري ومَن تبعه[152]، والمعنى: عملوا جملةً من الأعمال الصالحة الواجبة على المكلَّف على حسب حاله، فمَن ليس له مال لم تجب عليه الزكاة، وغير المستطيع لا يجب عليه الحج، وهكذا.
ورُدَّ بأنَّ الجمعية وكذا تعلق العمل بها يدلان على أنَّ المقصود الأفرادُ دون الجنس والحقيقة، وحتى لو كان الجنس يصدق على الأفراد، فإنّ مقتضاه أنه يكفي ثلاثة من الأعمال الصالحة أو اثنان[153].
الرابع: جوَّز الشهاب الخفاجي أن تكون للعهد[154]، أي: العهد الذهني.
قال القونوي: «وهو ضعيف؛ لأنه إن أراد بالنسبة إلى كلّ فرد بالنسبة إلى حاله فلا يخفى فساده؛ إذ الجموع بالنظر إلى حاله معتبَر البتة، وإن أراد بالنسبة إلى كلّ مكلَّف بدون تقييد بالنظر إلى حاله فذلك البعض متفاوت في المكلَّفين، فيؤول إلى الاستغراق العُرفي؛ إِذْ لا أحد يجب عليه بعض الأحكام بدون ملاحظة حاله، فإذا لوحظ حاله يكون ذلك البعض كُلًّا بالنظر إليه»[155].
وبهذه النماذج الخمسة يمكن ملاحظة أثر البلاغة في توجيه ما أشكل مما يرجع إلى التعريف والتنكير، وكيف أنها بمعاونة غيرها من العلوم ترجح الراجح، وتقف على مواطن الوهن في الآراء[156].
رابعًا: التذكير والتأنيث:
من الظواهر اللغوية التي عُنِي بها العلماء: ظاهرة التذكير والتأنيث، فقد بحثها علماء اللغة والنحو، وهي في الأصل من مباحث علم اللغة، فإنها قائمة على تعداد الألفاظ؛ ولذلك أُلّفت فيها معاجم كثيرة[157]، لكن لمّا كثرتْ ألفاظها وعَسُر جمعُ أطرافها اجتهد النحاةُ والصرفيون في وضع أصول وقواعد تضبط الباب وتجمع ما تَفَرَّق[158].
والألفاظ من حيث التذكير والتأنيث ثلاثة أقسام:
١- ما يجب تذكيره.
٢- ما يجب تأنيثه.
٣- ما يجوز فيه الوجهان.
فأمّا القسمان الأوّلان فمخالفتهما لحن وغلط، كالغلط في رفع المنصوب أو نصب المرفوع[159]، وأمّا القسم الثالث فيجوز فيه الأمران، وهو محلّ نظر البلاغي، فينظر في أنسبهما للسياق، مع التنبه إلى أن البلاغيين لم يعنوا بهذا الباب، ولم أقف على مَن أشار إليه سوى أنَّ ابن جني عقد بابًا أسماه: (شجاعة العربية)، وجعل من أقسامه: (الحمل على المعنى)، قال فيه: «وذلك كتأنيث المذكر، وتذكير المؤنث، وتصوير معنى الواحد للجماعة والجماعة للواحد»[160]. فتبعه فيه ابن الأثير، ثم قال: «وهذا القِسم من التأليف دقيق المسلك، بعيد المذهب، يحتاج إلى فضل معاودة وزيادة تأمّل، وقد وردَ في القرآن الكريم، وفصيحِ الكلام منثورًا ومنظومًا»[161].
وقد وردَت أسئلةٌ فى كتب المشكل عن ألفاظ قرآنية يجوز تذكيرها وتأنيثها عند العلماء أو عند بعضهم، فيوردُ البلاغي السؤال عن سبب إيثار إحدى الصيغتين دون الأخرى، وهو ما نحاول بحثه من خلال النماذج الآتية:
۱- قوله تعالى: ﴿السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا﴾ [المزمل: 18].
الإشكال ووجهه[162]:
كيف قال تعالى: ﴿السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ﴾، ولم يقل سبحانه: (منفطرة به) والسماء مؤنثة؟
توجيه الإشكال:
قال تعالى: ﴿فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا * السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ﴾ [المزمل: 17- 18]، معنى الآية: كيف تَقُون أنفسَكم -إن كفرتم بالله وبرسوله- عذابَ يومٍ عظيم تشيب لهوله الولدان، وتتشقق لشِدَّته السماء.
وقد اختلف العلماء في سبب تذكير ﴿مُنفَطِرٌ﴾، وهو خبر عن السماء وهي مؤنثة، كما قال تعالى: ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ﴾ [الانفطار: 1]، وقال تعالى: ﴿أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ﴾ [ق: 6]. وقد أُنِّثَ معها الفعل في جميع مواقع ورودها في القرآن[163]، وأمّا في هذه الآية فَعُدِلَ عن التأنيث، وقبل أن أذكر التوجيه البلاغي يحسن ذِكْر التوجيه اللغوي والنحوي، فأقول: وُجِّه ذلك بستة توجيهات:
الأول: أن (السماء) تُذكَّر وتؤنث. قاله الفرّاء[164]، واستشهد بقول الشاعر:
فلَو رَفَعَ السَّماءُ إليه قومًا ** لحِقْنَا بِالسَّمَاءِ مع السَّحَابِ
وعلى ذلك فالسماء واردةٌ على أصل، فلا تأويل، وأكثر العلماء على أنَّ السماء مؤنثة؛ ولهذا احتاجوا إلى التأويل كما في الأقوال الآتية.
ويشكل على هذا القول أنَّ البيت المذكور للفرزدق، وروايته في ديوانه: (ولو رفع الإله)[165]، ولا شاهد فيه على هذه الرواية، والدليل إذا تطرّق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال.
الثاني: أنَّ السماء هنا بمعنى السقف، فَذُكِّرَت حملًا على المعنى، تقول: هذا سماء البيت. وهو قول أبي عمرو بن العلاء، وأبي عبيدة والكسائي[166].
الثالث: أنَّ السماء اسم جنس جمعي، مفرده: سَمَاءة، ومعلوم أنَّ أسماء الأجناس يجوز فيها التذكيرُ نظرًا إلى اللفظ، والتأنيثُ نظرًا إلى معنى الجماعة الداخلة تحت اسم الجنس، ونظيره: ﴿جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ﴾ [القمر: 7]، ﴿نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ﴾ [القمر: 20]، ﴿الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ﴾ [يس: 80]، وهو قول أبي عليّ الفارسي[167].
الرابع: أنه على معنى النسب، والتقدير: ذات انفطار، كقولهم: امرأة مرضع، أي: ذات رضاع. وهو قول الخليل، والمبرد[168].
وفيه نظر؛ فإنَّ هذه الصيغة ﴿مُنْفَطِرٌ﴾ الأصل أن تكون اسم فاعل، ويحتمل أن تكون على النَّسَب، وهي من قبيل الشاذ، ودليلهم على أنها هنا للنسب عدم التأنيث، فيلزم منه الدَّوْر، لأن مؤدّاه: ذُكِّرَتْ لأنها على النَّسَب، وهي على النسب لأنها ذُكِّرت.
ثم لو صح قولهم فإنه لا يدفع الإشكال؛ ولذا قال الشاطبي: «ذلك لا يُنجِي؛ إذ الضمير المرفوع في ﴿مُنْفَطِرٌ﴾ ضمير مؤنث، ورفعه على الفاعلية، ولم تلحق الصفةَ علامةٌ، فالسؤال واردٌ»[169].
الخامس: أنَّ تأنيث السماء مجازي، والمؤنث المجازي يجوز تذكيره وتأنيثه، قياسًا على الفعل المسند لمؤنث مجازي التأنيث في جواز اقترانه بتاء التأنيث وتجريده منها، إجراء للوصف مجرى الفعل[170].
ويمكن أن يعترض على هذا بأنَّ الفعل يجوز تأنيثه إذا أُسند إلى اسم ظاهر مجازي التأنيث، نحو: انهدم الدار، أمّا إذا أُسند إلى ضميره فيجب تأنيثه، نحو: (الدار انهدمت)؛ وذلك لأنّ الراجع ينبغي أن يكون على حسب ما يرجع إليه؛ لئلا يُتَوَهَّمَ أن هناك فاعلًا مذكَّرًا منتظرًا، نحو: (الدار انهدم سَقْفُها)[171].
السادس: أنَّ ﴿مُنْفَطِرٌ﴾ صفةٌ لموصوف مذكّر محذوف، تقديره: شيء، أي: السماء شيء منفطر[172].
ويناقش: بأن التقدير خلاف الأصل.
هذا توجيه التذكير لغةً ونحوًا، وأمّا سِرُّ التعبير به من جهة البلاغة، فقد تلمّس أهل العلم عدة نكات للعدول عن الاستعمال الشائع:
الأُولى: أنَّ التذكير لإفادة عموم انفطار السماوات[173]، ولو أنّث لكان ظاهرًا في واحدة من السماوات، وهو متفرّع عن كون (السماء) اسم جنس.
ولكن يشكل على هذا قوله تعالى: ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ﴾ [الانفطار: 1]، وقوله: ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ﴾ [الانشقاق: 1]، حيث أنّثَ الفعل مع إرادة العموم.
الثاني: أنه لزيادة تهويل اليوم الذي تنفطر به السماء؛ لأنَّ الذَّكَر في كلِّ شيءٍ أشدُّ من الأُنثى[174].
الثالث: أنه «للتنبيه على أنه تبدّلت حقيقة السماء، وزال عنها اسمُها ورسمُها، ولم يبقَ منها إلا ما يُعَبَّرُ عنه بالشيء»[175]. وهو مبني على القول بأن ﴿مُنْفَطِرٌ﴾ صفة لموصوف محذوف تقديره: (شيء).
الرابع: في التذكير إيثار للتخفيف؛ فإنَّ صيغة (مُنفَعِل) مشتملة على حرفي زيادةٍ، فإذا زِيدت هاء التأنيث ثَقُلَت الكلمة ثقلًا يجنبه غاية الفصاحة، ألا ترى أنها لم تجرِ على التذكير في قوله عز وجل: ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ﴾ [الانفطار: 1]؛ إِذْ ليس في الفعل إلا حرفٌ مزيد واحد وهو النون؛ إِذْ لا اعتداد بهمزة الوصل لأنها ساقطة في حالة الوصل، فجاءت بعدها تاء التأنيث[176].
ويؤيده قول سيبويه: «واعلم أن المذكَّر أخفّ عليهم من المؤنث؛ لأنَّ المذكّر أوّل، وهو أشدُّ تمكُّنًا، وإنما يخرج التأنيثُ من التذكير»[177].
۲- قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ﴾ [الصف: 6].
الإشكال ووجهه[178]:
كيف قال تعالى: ﴿فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ﴾، ولم يقل سبحانه: (هذه)، والمُشَارُ إليه (البينات)، وهي مؤنثة؟
توجيه الإشكال:
يحتمل أنَّ المشار إليه عيسى، بدليل قراءة حمزة والكسائي: ﴿قَالُوا هَذَا سَاحِرٌ مُبِينٌ﴾[179]، فعلى هذا فاسم الإشارة هنا يطابق المشار إليه في التذكير، وقد وُصِف بالسحر مبالغةً.
وأمّا على القول بأنَّ المشار إليه (البينات)، فهو مشكل، ويمكن توجيهه بتوجيهين:
الأول: الحمل على المعنى، فالمشار إليه (ما أتى به) أو (ما جاء به)[180].
الثاني: أنَّ (البينات) فُصِلَ بينها وبين فِعْلِها بالمفعول، وحينئذ (يجوز) تذكير الفعل وتأنيثه، كقوله تعالى: ﴿وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ﴾ [آل عمران: 86]، وقوله: ﴿إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ﴾ [الممتحنة: 10]. وفي ذلك يقول ابن مالك:
وقد يُبِيحُ الفَصْلُ تَرْكَ التَّاءِ في ** نحوِ أَتَى القَاضِيَ بنتُ الواقِفِ
أو يقال: (البينات) جمع، والجموع سوى المذكر السالم يجوز في فعلها التذكير والتأنيث، وهو مذهب الكوفيين، واختاره ابن مالك حيث قال:
والتَّاءُ مَعْ جَمْعٍ سِوَى السَّالِمِ مِنْ ** مذكَّرٍ كالتاء مع إحدى اللَّبِنْ
والبصريون على خلافه، وتابعهم في التسهيل[181].
والمقصود أنه إذا جاز ذلك في الفعل جاز في اسم الإشارة من باب القياس. وفي هذا الجواب نظر، والأول هو المتعيّن.
وأمّا السِّر البلاغي في ذلك: فذكر البقاعي أنَّ في التذكير إشعارًا بأنه لا شيء أقوى من بيانه، ولا شيء أشدُّ من ظهوره[182]؛ إذ الذَّكَرُ في كلّ شيءٍ أَشدُّ من الأُنثى.
ويمكن أن يناقش بقوله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ﴾ [البقرة: 253]، فقد جاءت مؤنثة.
وللدكتور فاضل السامرائي رأي رآه من خلال التأمّل في سياقات ورود (البيِّنات) في القرآن، فذكر أنَّ كلمة (البيِّنات) إذا كانت بمعنى العلامات الدالة على المعجزات أُنِّث الفعل، وإذا كانت بمعنى الأمر والنهي ذُكِّر[183].
وفيه نظر؛ فإنّه منتقضٌ بآية الباب، وبقوله تعالى: ﴿قَالُوا لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ﴾ [طه: 72]. حيث إنّ (البيّنات) في الآيتين بمعنى العلامات الدالّة على صدق النبوّة، ومع ذلك عُوملتْ معاملة المذكَّر.
ثم لو اطَّرد قوله فإنه لم يذكر السبب في علاقة هذين المعنيين بالتذكير والتأنيث.
ولم يظهر لي فيها شيء، فالله أعلم.
٣- قوله تعالى: ﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾ [التوبة: 36].
الإشكال ووجهه[184]:
كيف قال تعالى: ﴿فِيهِنَّ﴾ والشهرُ مُذَكَّرٌ، فقياسه: (فيها)؟
توجيه الإشكال:
اختلف المفسِّرون في مرجع الضمير في قوله: ﴿فِيهِنَّ﴾ على قولين: فقيل: يعود إلى الاثني عشر شهرًا. قاله ابن عباس. والمقصود منعُ الإنسانِ من الإقدام على الفساد مطلقًا في جميع العمر.
وقيل: يعود إلى الأشهر الأربعة الحُرُم، وهو قول الأكثرين، واختاره ابن جرير؛ وذلك لوجهين:
الأول: أنَّ الأصل عَود الضمير إلى أقرب مذكور.
الثاني: أنه تقرّر في العربية أنَّ جمع القِلّة (وهو من ثلاثة إلى عشرة) يُعامَل معاملة الجماعة المؤنثة فَيُعَادُ إليه الضمير بالنون، وجمع الكثرة (وهو ما زاد عن العشرة) يُعامَل معاملة المفرد المؤنث، فتقول: (الأسياف انكسَرْنَ) و(السيوف انكسَرَتْ)، وتقول العرب عندما تؤرِّخ: (فعلنا ذلك لثلاث ليالٍ خلوْنَ، ولثلاث عشرة خلَتْ). وعلى ذلك فلما قال هنا: ﴿فِيهِنَّ﴾ عُلِم أَنَّ المراد الأشهر الأربعة.
وقد تعكس العرب فتستعمل الهاء مع جمع القلّة، ولكنه غير مشهورٍ في كلامها، وتوجيه كلام الله إلى الأفصح الأعرف أَوْلى من توجيهه إلى الأنكر.
وقد نهَى -سبحانه وتعالى- عن الفساد فيها تشريفًا لها وتعظيمًا بالتخصيص بالذِّكْر، وإن كان الفساد منهيًّا عنه في كلّ زمان، وليكون كفُّهم فيها عن المعاصي ذريعةً إلى استدامة الكفّ في غيرها؛ توطئةً للنفس على فراقها، لطفًا منه -سبحانه وتعالى- بعباده[185].
وبذلك يندفع الإشكال، ويُعلم أنَّ قوله: ﴿فِيهِنَّ﴾ جارٍ على سَنَن العرب في كلامها.
فإن قيل: وما السِّر البلاغي في ذلك؟
فيقال: البلاغة لا تُعَلَّلُ الوضعَ اللغويّ إذا جرى على الأصل، ولم يكن بد منه، وإنما تبحث حال العُدول عنه، وقد جرى الضمير هنا على المشهور في استعمال العرب.
ومع ذلك فهاهنا نكتة لطيفة في سبب ذلك، وهو أنَّ هذه الأشهر الحرم لعِظَمِ شأنها وشريف منزلتها كان المفسد فيها كالمفسد في جميع العام.
وفي الجملة فإنَّ كون العرب هنا عاملت القلة معاملة الجماعة، والكثرة معاملة المفرد =لأمر يستدعي العجب، وسِرُّها الإشارة إلى تهوين الاعتداد بالأعداد، والإعلاء من شأن الأفراد، فمَعه تغدو القِلَّةُ كثرةً، ودونه تنحلُّ الكثرة قلّةً، وهذا إنما هو شيء نستحسنه، وهو من مُلَحِ اللغة لا من متين العِلم.
٤- قوله تعالى: ﴿تَنْزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ﴾ [القمر: 20].
الإشكال ووجهه[186]:
لِـمَ قيل: ﴿مُنْقَعِرٍ﴾ ولم يُقَل: (منقعرة)؟
توجيه الإشكال:
قال تعالى: ﴿كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ * إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ * تَنْزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ﴾ [القمر: 18- 20]، والمعنى: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا﴾، وهي الباردة شديدة العُصوف، لِصَوْتِها صَرِيرٌ، أرسلناها في يوم شؤم مستمر عليهم بالعذاب والهلاك، تقتلع الناس من مواضعهم على الأرض فتتركهم كالنخل المنقلع من أصله، فقد شُبِّهوا لِطُولِ قاماتهم حين صَرَعَتْهُم الريح وكبَّتْهم على وُجُوهِهم بالنخيل الساقطة على الأرض التي ليس لها رؤوس[187].
ووجه قوله: ﴿مُنْقَعِرٍ﴾ أَنَّ (النخل) اسم جنس جمعي، مفرده: نخلة، وأسماء الأجناس يجوز فيها التذكيرُ نظرًا إلى اللفظ، والتأنيثُ نظرًا إلى معنى الجماعة الداخلة تحت اسم الجنس، ومن الحمل على اللفظ هذه الآية، ومن الحمل على المعنى قوله: ﴿كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ﴾ [الحاقة: 7].
وسِرُّ التذكير هنا يعود إلى أمرين: معنوي، ولفظي:
فأمّا المعنوي: فيتضح من خلال سياق الآيات، قال تعالى: ﴿اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ * وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ﴾ [القمر: 1- 2]، فقد افتتحت السورة بذكر معجزة انشقاق القمر الدالّة على صِدْق النبي -صلى الله عليه وسلم-، فكذَّب بها المشركون وأعرضوا عنها، كشأنهم مع كلِّ معجزة، ﴿وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌّ * وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ﴾ [القمر: 3- 4]، ولمّا كان هذا حالهم ذَكَّرهم اللهُ بمصارعِ خمسٍ مِن الأُمم المكذِّبة -فَيُلاحَظ أنّ سياق الآيات هو وعظ المكذِّبين وزجرهم- فذكر أحوالًا مفزعة لأولئك الأقوام، فقال عن قوم ثمود: ﴿فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ﴾ [القمر: 31]، أي: فكانوا بعد نَضَارتهم وحُسْنهم كالزرع اليابس المحترق سريع الانكسار. وقال عن قوم لوط: ﴿فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ﴾ [القمر: 37]، أي: صَيَّرْنَاها كسائر الوجه ليس لها شقّ. وقال عن قوم عاد: ﴿كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ﴾ [القمر: 20]، وهي النخيل الساقطة بلا رؤوس، وفي ذلك تفظيعٌ لحالهم.
وهذا بخلاف قوله تعالى: ﴿كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ﴾ [الحاقة: 7]، فقد وردَت هذه الآية في سورة الحاقة، والمحور الأساس الذي تهتمّ به السورة هو اليوم الآخر؛ ولذلك افتُتحت بذِكْر أحد أسمائه وهو الحَاقَّةُ، وفيها ذُكِر مآلُ قومِ عاد في ضمن تكذيبهم به، فالمقصود هنا مُجرَّد السقوط؛ فلذلك قال: ﴿خَاوِيَةٍ﴾، ونظيره قوله تعالى: ﴿أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا﴾ [البقرة: 259].
وأمّا اللفظي: فهو مراعاة الفاصلة.
٥- قوله تعالى: ﴿قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الأعراف: 61].
الإشكال ووجهه[188]:
لِـمَ قال نوح -عليه السلام-: ﴿لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ﴾ بالتاء، ولم يقل: (ليس بي ضلالٌ)، كما وَصَفَهُ قومُه به، وذلك أشدُّ مناسبةً؛ ليكون نافيًا عينَ ما أثبتوه؟
توجيه الإشكال:
اختُلف في وجه ذلك على قولين:
القول الأول: أنَّه للمبالغة في النفي؛ وذلك لأنَّ الضلالة أخصُّ من الضلال، فكانت أبلغ في عموم النفي، كأنه قال: ليس بي ضلالةٌ واحدةٌ فضلًا عن ضلال، كما لو قيل لك: ألك تمرٌ؟ فقلت: ما لي تمرة؛ فبالغ -عليه السلام- في النفي كما بالغوا في الإثبات. ذكره الزمخشري وتابعه جماعة[189].
وزاد ابن الأثير هذا القول بيانًا، فقال: «فإن قيل: لا فرقَ بين الضلالة والضلال، وكلاهما مصدر قولنا: ضَلَّ يَضِلُّ ضَلالًا وضلالةً، كما يقال: لَذَّ يَلَذُّ لَذَاذًا ولَذَاذَةً.
فالجواب عن ذلك: أن الضلالة تكون مصدرًا كما قلت، وتكون عبارة عن المرة الواحدة، تقول: ضلّ ضلالة، أي: مرّة واحدة، كما تقول: ضرب يضرب ضربة، وقام وأكل يأكل أكلة. والمراد بالضلالة في هذه الآية إنما هو عبارة عن المرة الواحدة من الضلال، فقد نفى ما فوقها من المرتين والمِرار الكثيرة»[190].
وما ذهب إليه هؤلاء الفضلاء نوقش من وجهين:
الأول: نَبَّه ابن المنيِّر على أنَّ التعليل لكون نفيها أبلغ بأنّ نفي الأخصّ أبلغ من نفي الأعم =غير صحيح، بل الصحيح العكس، فنفي الأعمّ أبلغ من نفي الأخصّ، مثال ذلك: أنّ الإنسان أخصّ من الحيوان، فإذا قلت: هذا ليس بإنسان، لم يستلزم ذلك أن لا يكون حيوانًا، فالتحقيق التعليل بكون الضلالة أدنى من الضلال لا أخصّ، ونفي الأدنى أبلغ من نفي الأعلى[191].
وأُجيب بأنَّ هذا تدقيق حَسَن في اللفظ، لكنه جارٍ على اصطلاح أهل المنطق في معنى الأخصّ والأعمّ.
الثاني: ما ذكره ابن الأثير ردَّه ابنُ أبي الحديد بأنَّ هذا لا يصح، سواء كانت ﴿ضَلَالَةٌ﴾ مصدرًا، أو دالّةً على المرة الواحدة:
فأمّا إن كانت مصدرًا فالمصدرُ يدلّ على نفي الماهية فقط، فلا فرق حينئذ بين الضلال والضلالة، ولا يكون أحدهما أبلغ من الآخر.
وأمّا إن كانت تدلّ على المرة، فأيضًا لا دلالة فيها على نفي الجماعة؛ إِذْ نفي الواحد لا يلزم منه نفي الجماعة، فلو قال قائل: (ما عندي تمرة)، بمعنى تمرة واحدة، وعنده تمرٌ كثيرٌ؛ صَحَّ ذلك، ولم يكن كاذبًا. فالمثال الذي ذكره يدلّ على عكس ما أراده.
فقول نوح -عليه السلام-: ﴿لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ﴾، لو كان يريد به نفي ضلالة واحدة، لم يكن نافيًا لكونه ضالًّا؛ لأنّ الضلالة مختلفة الأنواع، فإذا قال: ليس بي ضلالةٌ واحدةٌ فقط، لم يكن هذا اللفظ مفيدًا لانتفاء كونه ضالًّا.
وذكر أنّ قول ابن الأثير: (إذا نفى عن نفسه المرة الواحدة من الضلال، فقد نفى ما فوقها من المرتين والمِرار الكثيرة)، كلام مَن لم يمعِن النظر في قوله: (المرة الواحدة)؛ إِذْ معناها: ليس معها غيرها، فعلى ذلك مَن وُجدت عنده ضلالات فقد وُجدت عنده ضلالةٌ واحدة[192].
وما ذكره ابن أبي الحديد تعقّبه الطيبي بأنَّ هذا كلام من لم ينظر في المقام، قال: «فإنّ الزمخشري إنما يتكلّم بمقتضى الحال ومطابقة الجواب للسؤال، ولا يَعتبر مفردات اللفظ، وبيانه أن القوم لما أثبتوا له نوعًا مِن الضلال وهو كونه ضلالًا مبينًا لا مطلق الضلال كما توهّموه، والجواب إنما يطابق إذا كان أبلغ منه، فإذا لم تحمل الضلالة على ما قَدَّرَه، فمِن أين تفيده الأبلغية؟ ولو لم تُرَدِ المبالغة لكان مقتضى الظاهر أن يُقال في جواب: ﴿إِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾: (ليس بي ضلالٌ)، فلمّا أثبتوا النوعَ نفى الوَحْدة... فظهر أن التركيب إنما يفيد المطلوب إذا وقع جوابًا مع إرادة المبالغة لا بالنظر إلى اللفظ من حيث هو، ألا ترى أن قوله تعالى: ﴿اللهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ﴾ إِنما كان أبلغ من قوله: ﴿إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ﴾ [البقرة: 14- 15]. من حيث كونه وقع جوابًا له، ولو نظر إلى اللفظ فقط كان هو أحطّ منه بدرجات كثيرة»[193].
القول الثاني: أنه من باب التفنُّن؛ دفعًا لإعادة اللفظ الأول بعينه، فالضلال والضلالة كلاهما مصدر بمعنى واحد ويُراد بهما نفي الماهية، وبه تنتفي الضلالة انتفاءً مطلقًا[194].
وتُعُقِّب بأنَّ القول بالتفنُّن يعني أنه تحسين شكلي لا أثر له في المعنى، وهو خلاف الأصل، لا سيما مع ما تقتضيه بلاغة القرآن، فالمعنى هو المهيمن على اللفظ، والعدول عن بعض الألفاظ لا بدّ أن يكون مراعاةً للمعنى، ولا يمنع مع ذلك أن تقترن نكات أخرى شكلية.
والقول الأول أظهر القولين، وذلك بدلالة السياق؛ فإنّ التاء في قوله: ﴿ضَلَالَةٌ﴾ يُحتَمل أن تكون للتأنيث المحض أو للوحدة، وإذا كان الكلام محتملًا لمعنيين على السواء فهو من قبيل المجمل، والمجمل يجب التوقف فيه حتى تدلّ قرينة على ترجيح أحد المحتملين، وقد وُجدت قرينةٌ هنا وهي السياق، فمَن تأمّله قطع بأن المقصود بها الوحدة، فقد قال له قومه: ﴿إِنَّا لنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ [الأعراف: 60]، فجعلوا ضلاله مبينًا ظاهرًا، فقال: ﴿لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ﴾ [الأعراف: 61]، أي: ضلالةٌ واحدةٌ فضلًا عن ضلال مبين، فلمّا بالغوا في الإثبات بالغَ في النفي، فصار الجواب مطابقًا، ومحال أن يكون المعنى: ليس بي ضلالة ولكن ضلالات، فإن هذا المعنى وإن احتمله اللفظ في أصل اللغة لكنه لمّا وقع في هذا المقام -وهو مقابلةُ قولهم- عُلِم أنه غيرُ مراد.
هذه صور من أثر البلاغة في توجيه المشكل المتعلّق بالتذكير والتأنيث، وهو -أعني التذكير والتأنيث- موضوع جدير بأن يُخَصَّ بالدراسة، فقد شَحَّت فيه الدراسات البلاغية.
وبقيت أمثلة أخرى تطبيقية للتذكير والتأنيث أكتفي بالإحالة إليها[195].
[1] هذه المقالة من كتاب: (أثر البلاغة في توجيه مشكل القرآن)، الصادر عن مركز تفسير سنة ١٤٤٤هـ، ص٦١ وما بعدها. (موقع تفسير)
[2] الخصائص (٢/ ٤١٣).
[3] الجامع الكبير، ص١٠٦، وينظر: مقدمة تفسير ابن النقيب، ص٢١٤، جوهر الكنز، لابن الأثير الحلبي، ص١٢٣.
[4] ينظر: عروس الأفراح (۱/ ۲۹۳).
[5] أنموذج جليل، ص۱۳۲، الروض الريان (١/ ٤٢)، فتح الرحمن، ص١٥٧.
[6] معالم التنزيل، للبغوي (١/ ٣١٥).
[7] وأمّا جمع السُّبل في قوله: ﴿سُبُلَ السَّلَامِ﴾ [المائدة: ١٦]. فيُراد بها شرائع الإسلام. فطريق الحق واحد وهو الإسلام، وإنما المتعددة شرائعه.
[8] البحر المحيط (۲/ ۲۸۳)، تفسير ابن كثير (۳/ ۲۳۹)، بدائع الفوائد (۱/ ۲۰۹)، الإعجاز البياني، ص۳۳.
[9] الكشاف (٢/ ٣).
[10] الكشاف (۱/ ۷۳).
[11] التفسير القرآني (٤/ ١٢٤).
[12] روح المعاني (٤/ ٧٩).
[13] في الأصل: (لاتّباع)، وهو تحريف، والصواب ما أثبت.
[14] التحرير والتنوير (٧/ ١٢٧).
[15] هذا الدليل وإن كان يذكره الأصوليون في (مسالك العلة) من القياس، فإنه في الأصل مسلك عقليّ جارٍ في كلّ عِلْم؛ ولذلك يبحثه المناطقة ويسمونه: (الشرطي المنفصل). ينظر: الرد على المنطقيين، ص٢٠٥، مذكرة أصول الفقه، ص٤٠٠.
[16] ديوان المتنبي، ص۳۲۳.
[17] تأويل مشكل القرآن، ص۱۷۸، أنموذج جليل، ص٤٧٥، الروض الريان (٢/ ٤٣٠)، فتح الرحمن، ص٥٣١.
[18] تفسير الطبري (٢٢/ ٣٤٢)، إعراب القرآن، للنحاس (٤/ ١٤٩).
[19] الكتاب، لسيبويه (١/ ٧٤).
[20] تأويل مشكل القرآن، ص۲۸٤، أنموذج جليل، ص٣٦٧، الروض الريان (١/ ٢٨٥)، فتح الرحمن، ص٤٠٧.
[21] ديوان الهذليين (١/ ١٤٦).
[22] لسان العرب (رسل).
[23] مجاز القرآن، لأبي عبيدة (٢/ ٨٤)، غريب القرآن، لابن قتيبة، ص٣١٦، تفسير الطبري (١٧/ ٥٥٤)، الكشاف (٣/ ٣٠٣)، الجامع لأحكام القرآن (١٣/ ٩٤)، روح المعاني (١٠/ ٦٧).
[24] الكتاب (٣/ ٦٣٨)، الصحاح (قعد)، البديع، لابن الأثير (٢/ ١٤٢)، اللسان (رسل).
[25] الكشاف (٣/ ٣٠٥).
[26] أنموذج جليل، ص٣٦٧.
[27] الكتاب، لسيبويه (١/ ٥٧).
[28] الكشاف (٣/ ٣٠٥)، روح المعاني (١٠/ ٦٧)، دفع إيهام الاضطراب، ص۲۹۱.
[29] بلاغة الكلمة في التعبير القرآني، ص۷۸.
[30] تأويل مشكل القرآن، ص٢٩١، أنموذج جليل، ص٤٧٦، الروض الريان (٢/ ٤٣٠)، فتح الرحمن، ص٥٣٢.
[31] الكشاف (٤/ ٣٨٧)، المحرر الوجيز (٥/ ١٦٣).
[32] معاني القرآن، للزجاج (٥/ ٤٦)، الكشاف (٥/ ٣٨٧).
[33] معاني القرآن، للفراء (۳/ ۷۸) تفسير الطبري (٢١/ ٤٣٧)، معاني القرآن، للزجاج (٥/ ٤٦).
[34] نظم الدرر (١٨/ ٤٢٦).
[35] ينظر: شرح الملوكي، لابن يعيش، ص٤٢١.
[36] لسان العرب (جزز).
[37] ديوان امرئ القيس، ص١٤٣.
[38] الكشاف (٤/ ٣٨٧).
[39] الألفية بشرح ابن عقيل (۲/ ۲۹۱).
[40] أنموذج جليل، ص۳۷۳، الروض الريان (۱/ ۲۹۰)، فتح الرحمن، ص٤١٤.
[41] صحيح مسلم، ح۳۰۲.
[42] الأَنُوق: الرَّخمة، وعَزَّ بَيْضُها لأنّ أوكارها في رؤوس الجبال. مجمع الأمثال (٢/ ٤٤).
[43] الكشاف (۳/ ۳۲۲)، جامع البيان، للإيجي (٣/ ١٨٨).
[44] الصداقة والصديق، لأبي حيان، ص۷۱.
[45] البيتان مما علق بالذاكرة، وقد بحثت عن مصدرهما فلم أقف عليه بعد.
[46] التحرير والتنوير (١٩/ ١٥٥).
[47] تفسير البيضاوي (٤/ ١٤٣).
[48] ديوان جرير (۱/ ۳۷۲).
[49] ديوان الصمة القشيري، ص۱۱۷.
[50] أضواء البيان (٤/ ٢٧٢).
[51] بدائع الفوائد (١/ ٢٠۸).
وينظر نماذج أخرى في: تأويل مشكل القرآن، ص۲۸۲- ۲۸۸، الفوائد في مشكل القرآن، ص٣٩، أنموذج جليل، ص١٤٦، ۱۷٥، ۱۹۷، ۱۹۹، ٢٠٥، ٢٢٤، ٢٥٣، ٢٦٤، ٢٦٩، ٢٩٣، ٢٩٩، ٣٤٤، ٣۷۸، ٤٠٢، ٤٠٣، ٤١٦، ٤٥٦، ٤٧٧، ٤٨٤،٤٨٨، ٤٩٢، ٢٦٥، ٥١۸، الروض الريان (۱/ ٤۱، ٦١،۱۱۰، ۱٦۱، ۱۹۳، ۲۰۰)، (٢/ ٤٣١، ٤٦٣، ٤٦٤، ٢٧٦، ۳۱۸، ۳۲۰، ٤٤۹)، فتح الرحمن، ص٤٨، ١٨٦، ٢٥٠، ٢٥٢، ٢٦٠، ٣٠٠، ٣١٠، ٣١١، ٣٤٠، ٣۸١، ٤٤۸، ٤٦٢، ٥٤٢، ٥٤٦، ٥٠٩، ٥٣٣، ٥٣۸، ٥٥٢، ٥۷٢، ٥۷٥.
[52] البيت للنضر بن جؤية أو غيره. ينظر: معاهد التنصيص (١/ ٢٠٧).
[53] ينظر: دلائل الإعجاز، ص١٧٤.
[54] المثل السائر (٢/ ١٤٥).
[55] تأويل مشكل القرآن، ص٢٩٦، أنموذج جليل، ص٤٢١، فتح الرحمن، ص٤٦٨.
[56] ديوان تأبط شَرًّا، ص٢٢٤. وقوله: تهوي: من الهُوِي وهو العَدْو السريع. السهب: الفلاة. والصَّحْصَحَان: المستوية الواسعة العارية من النبت. والجِرَان: مُقَدَّمُ العُنُق.
[57] الكشاف (٣/ ٦٠١)، الإيضاح (۲/ ۱۲۷)، المثل السائر (٢/ ١٤٧)، المطول، ص١٧٣.
[58] مواهب الفتاح (٣/ ١٣٤).
[59] تفسير الرازي (٢٦/ ٢٢٥).
[60] تفسير البيضاوي مع حاشية ابن التمجيد (١٦/ ٢٢).
[61] حاشية القونوي على البيضاوي (١٦/ ٢٣).
[62] عروس الأفراح (١/ ٣٥٧).
[63] حاشية ابن التمجيد على البيضاوي (١٦/ ٢٣).
[64] تفسير البيضاوي مع حاشية الشهاب (۷/ ۲۱۸)، حاشية الدسوقي على مختصر السعد (٢/ ۸٩).
[65] الفوائد في مشكل القرآن، ص١٦٠، أنموذج جليل، ص١٥٧، فتح الرحمن، ص٢٠٨.
[66] المحرر الوجيز (٢/ ٤٥٣)، زاد المسير (٢/ ١٥٣)، البحر المحيط (٥/ ١٧١).
[67] البحر المحيط (٥/ ١٧١).
[68] ينظر: دراسات لأسلوب القرآن الكريم (٢/ ٤/ ١٢٢، ١٥٣).
[69] أنموذج جليل، ص١٩١، فتح الرحمن، ص٢٤٢.
[70] تفسير الرازي (١٦/ ١٧٠).
[71] حاشية الشهاب على البيضاوي (٤/ ٣٧٦).
[72] تفسير الرازي (١٦/ ١٧٠).
[73] البحر المحيط (٥/ ٥٢٤).
[74] البحر المحيط (٥/ ٥٢٤).
[75] أنموذج جليل، ص٢٤٢.
[76] الإيضاح (١/ ١٤٧).
[77] المثل السائر (٢/ ١٤٩).
[78] التحرير والتنوير (١٧/ ١٩١).
[79] ينظر: بلاغة القرآن، للعمري، ص۲۸۹، ۳۰۳.
[80] أنموذج جليل، ص٩٦، الروض الريان (١/ ٣٠).
[81] هناك مسألة أخرى بحثها الأصوليون ولم يتعرّض لها النحاة، وهي: (دلالة كان على التكرار)، ولهم فيها ثلاثة أقوال، وهم يبحثونها ضمن مسألة العموم في الأفعال، والعلماء جميعًا متفقون على أنَّ الماضي يعني حصول الفعل مرة واحدة، فهذا قدر متفق عليه، وإنما اختلفوا في الزيادة على ذلك، وهو الاستمرار والدوام كما يعبّر النحاة، أو التكرار كما يعبّر الأصوليون، فيتداخل البحثان في محلّ واحدٍ وهو الاستمرار؛ إذ كلُّ استمرار تكرار، من غير عكس.
[82] ارتشاف الضرب (٣/ ١١٨٤)، التذييل والتكميل (٤/ ٢١٢).
[83] شرح ألفية ابن معطي (٢/ ٨٦٤)، البرهان، للزركشي (٤/ ١٢٢).
[84] البحر المحيط (٣/ ٢٥٤).
[85] الكتاب (١/ ١٢).
[86] الكشاف (١/ ٤٠٠).
[87] شرح التسهيل (١/ ٣٦٠).
[88] وتنظر أمثلة أخرى في تأويل مشكل القرآن، ص۲۹٥، أنموذج جليل، ص٤٣، ٦٥، ١١١، ٢٠٥، ٣٠٢، ٣٨٤، ٤٥٥، ٥١٧، الروض الريان (۱/ ۱۲۷)، فتح الرحمن، ص٦٠، ٦٤، ٩٤، ١٣٦، ٢٦٠، ٣٤١، ٤٢٥، ٥٠٨، ٥٧١.
[89] دلائل الإعجاز، ص۱۷۷. وينظر: كتاب سيبويه (١/ ٤٨).
[90] البرهان، ص١٣٦.
[91] ينظر: دلائل الإعجاز، ص۱۷۷- ۱۹٥، الإيضاح (١/ ٦٢- ۷٩، ١٥٣).
[92] الطراز (۲/ ۸).
[93] أنموذج جليل، ص٤٦١، فتح الرحمن، ص٥١٥.
[94] رواه ابن أبي الدنيا في الفرج بعد الشدة (۱/ ۲۸). قال ابن حجر في تغليق التعليق (٤/ ٣٧٢): «إسناده حسن». وصح أيضًا عن ابن مسعود وقتادة والحسن. ورُوي عن ابن عباس ولا يصح. وروي مرفوعًا ولا يصح. ينظر: فتح الباري، لابن حجر (۸/ ۷۱۲).
[95] تهذيب اللغة، للأزهري (٢/ ٤٩)، معاني القرآن وإعرابه (٥/ ٣٤١)، أمالي ابن الشجري (۳/ ۸۸)، أمالي ابن الحاجب (۲۷۲)، الدر المصون (١١/ ٤٦).
[96] المغني، لابن قدامة (١٠/ ٥١٠).
[97] التفسير البسيط، للواحدي (٢٤/ ۱۳٢)، الكشاف (٤/ ۷۷۱)، البحر المحيط (١٠/ ٥٠١)، مغني اللبيب، ص۸۱۹، التحرير والتنوير (٣٠/ ٤١٥).
[98] عروس الأفراح (۱/ ۲۰۷).
[99] التلويح على التوضيح (١/ ٥٧).
[100] مغني اللبيب، ص٨٢٠.
[101] حاشية الدسوقي على مغني اللبيب (٢/ ٢٨٤).
[102] التبيان، للطيبي (٧٥).
[103] الطبري (٢٠/ ٦٥٩)، أنموذج جليل، ص٤٦١، عروس الأفراح (١/ ٢١١).
[104] التحرير والتنوير (٢٥/ ٢٦٧).
[105] أنموذج جليل، ص٥٥٩، الروض الريان (٢/ ٥٨٣)، فتح الرحمن، ص٦١٠.
[106] ينظر: تفسير الطبري (٢٤/ ٣٤٥)، البسيط، للواحدي (۲۳/ ٤٨٥)، تفسير ابن كثير (۸/ ۳۹۰).
[107] الكشاف (٤/ ٧٤٦)، تفسير الرازي (٣١/ ١٤٩)، تفسير البيضاوي (٥/ ٣٠٩).
[108] فتوح الغيب (١٦/ ٤١٧)، حاشية ابن التمجيد على البيضاوي (٢٠/ ٢٤٦).
[109] تفسیر ابن عرفة (١/ ٢٤٦).
[110] وأمّا قولهم: (شَرٌّ أَهَرَّ ذا ناب) فهو للتخصيص لا للتعيين، ثم التخصيص فيه مستفاد من تقديم المسند إليه لا من تنكيره، وتنكيره للتعظيم، والمعنى: ما أهرَّ ذا نابٍ إلّا شرٌّ عظيم.
[111] مسند أحمد، (ح٥٤٤٦).
[112] فتح الباري (٢/ ٤٦٠).
[113] التبيان في أيمان القرآن، ص۳۱۷.
[114] حاشية القونوي على البيضاوي (٢٠/ ٢٤٧).
[115] الكشاف (٤/ ٧٤٦).
[116] أنموذج جليل، ص٥٤٩، فتح الرحمن، ص٦٠٠.
[117] الإبهاج (١/ ٣١٠).
[118] التقرير والتحبير (٢/ ٦).
[119] تفسير البيضاوي (٥/ ٢٩٠). وينظر: المطول، ص٨٤.
[120] عروس الأفراح (٢/ ١٤١).
[121] البرهان، للزركشي (٢/ ١٣٢).
[122] صدر بيتٍ لعبيد بن الأبرص، عجزه: كأنَّ أثوابها مُجَّت بفِرصاد. ديوانه، ص٥٦.
[123] الكشاف (٤/ ٧٠٩).
[124] فتوح الغيب (١٦/ ٣١٤).
[125] الانتصاف فيما تضمّنه الكشاف (٢/ ٥٦٩).
[126] روح المعاني (٧/ ٢٥٥).
[127] تفسير أبي السعود (٩/ ١١٦).
[128] نظم الدرر (۲۱/ ۲۸۳، ۳۰۱).
[129] نظم الدرر (١٩/ ٤٥٧).
[130] كما في حاشية الجمل على الجلالين (٨/ ٢٦٥)، ولم أجده في حاشية زاده على البيضاوي (٤/ ٦٢٧).
[131] التحرير والتنوير (٣٠/ ١٥٠).
[132] حاشية الشهاب على البيضاوي (٤/ ٨٠).
[133] روح المعاني (١٥/ ٢٦١).
[134] ينظر: فتوح الغيب (١٦/ ٣١٤).
[135] الكشف عن مشكلات الكشاف، ص٣٦١/ ب.
[136] المحرر الوجيز (٥/ ٤٤٣).
[137] نظم الدرر (۲۱/ ۳۰۱).
[138] تفسير الرازي (٣١/ ٦٧)، جامع البيان، للإيجي (٤/ ٤٥١).
[139] أنموذج جليل، ص٥٩٠، فتح الرحمن، ص٦٣٣.
[140] رواه البخاري، (ح٥٣)، ومسلم، (ح٢٦٦).
[141] الكشاف (٤/ ٨٢٢).
[142] مجمع الأمثال (١/ ٢٥٥).
[143] ينظر: ملاك التأويل (٢/ ٥١٧)، نكت وتنبيهات، للبسيلي (٣/ ٦٥٨).
[144] التحرير والتنوير (٣٠/ ٦٢٩).
[145] الكشاف مع حاشية ابن المنير (١/ ٩).
[146] البرهان، للجويني (۱/ ۲۳۳)، شرح التسهيل، لابن مالك (١/ ٢٥٧)، المحصول، للرازي (١/ ٢/ ٥٤٨)، الإيضاح (١/ ٨٨)، نشر البنود (١/ ٢١٥).
[147] المفتاح، ص٢١٦، الإيضاح (١/ ٨٩).
[148] العدة، لأبي يعلى (٢/ ٤٩٢).
[149] المطول، ص٨٤.
[150] الفوائد في مشكل القرآن، ص٤٣.
[151] حاشية زاده على البيضاوي (١/ ٢٠٦).
[152] الكشاف (١/ ١٠٥)، تفسير البيضاوي (١/ ٥٩)، البحر المحيط (۱/ ۱۸۱)، تفسير أبي السعود (١/ ٦٨).
[153] حاشية زاده (١/ ٢٠٦)، حاشية القونوي (٢/ ٤٧٨).
[154] حاشية الشهاب (١/ ٣٠٢).
[155] حاشية القونوي (٢/ ٤٧٨).
[156] وتنظر نماذج أخرى في: أنموذج جليل، ص۲۲، ۲۷۳، ٣٧٦، ٣٩١، ٥٠٥، ٥٦١، ٥۷٣، الروض الريان (١/ ٦٤، ١٧١)، (٢/ ٥٩١، ٦١٤)، فتح الرحمن، ص١٧، ٣١٨، ٤٣٦، ٥٥۸، ٦٢٢، فتح الرحمن، ص٦٠٥، ٦١٣.
[157] ينظر: المخصص، لابن سيده (٥/ ٥٥)، معجم المعاجم، ص٢٦٤- ٢٧١.
[158] ينظر: شرح المفصل، لابن يعيش (٣/ ٣٥٢)، شرح ابن عقيل على الألفية (٢/ ٣٩٣).
[159] ينظر: المذكر والمؤنث، لابن الأنباري (١/ ٥١).
[160] الخصائص (٢/ ٤١٣).
[161] الجامع الكبير، ص١٠٦. وينظر: مقدمة تفسير ابن النقيب، ص٢١٤، جوهر الكنز، لابن الأثير الحلبي، ص١٢٣.
[162] أنموذج جليل، ص٥٣١، الروض الريان (٢/ ٥٣٠)، فتح الرحمن، ص٥٨٥.
[163] دراسات لأسلوب القرآن (٨/ ٤٥٣)، (١١/ ٢٤٥).
[164] المذكر المؤنث، للفراء، ص۱۰۲.
[165] ديوان الفرزدق (۱/ ۳۳).
[166] مجاز القرآن (٢/ ٢٧٤)، البحر المحيط (١٠/ ٣١٨).
[167] البحر المحيط (١٠/ ٣١٨).
[168] المذكر والمؤنث، للمبرد، ص۱۲۱.
[169] المقاصد الشافية (٢/ ٥٨٠).
[170] المحرر الوجيز (٥/ ۳۸۹)، التحرير والتنوير (٢٩/ ٢٧٦).
[171] ينظر: شرح المفصل (٣/ ٣٦٠)، شرح ابن عقيل على الألفية (١/ ٤٣٥).
[172] الكشاف (٤/ ٦٤٢).
[173] نظم الدرر (۲۱/ ۲۷).
[174] نظم الدرر (۲۱/ ۲۷).
[175] روح البيان (۱۰/ ۲۱۸).
[176] التحرير والتنوير (٢٩/ ٢٧٦).
[177] الكتاب (١/ ٢٢).
[178] أنموذج جليل، ص٥٠٩.
[179] النشر، لابن الجزري (٢/ ٢٥٦).
[180] تفسير البيضاوي (٥/ ٢٠٩).
[181] شرح التسهيل (۲/ ۱۱۳)، شرح التصريح (١/ ٤١٠).
[182] نظم الدرر (٤/ ٤٧٦).
[183] لمسات بيانية، ص٤٦٥.
[184] أنموذج جليل، ص۱۷۸.
[185] معاني القرآن، للفراء (١/ ٤٣٥)، تفسير الطبري (١١/ ٤٤٣)، زاد المسير (٢/ ٢٥٧)، تفسير الرازي (١٦/ ٤٣).
[186] أنموذج جليل، ص٤٨٩، فتح الرحمن، ص٥٤٣.
[187] تفسير الطبري (۲۲/ ۱۳۲)، التفسير البسيط (٢١/ ١٠٦).
[188] أنموذج جليل، ص١٥١، الروض الريان (١/ ٦١).
[189] الكشاف (۲/ ۱۱۳)، تفسير الرازي (١٤/ ٢٩٦)، تفسير البيضاوي (٣/ ١٨)، البحر المحيط (٥/ ٨٢).
[190] المثل السائر (٢/ ١٦٧).
[191] الانتصاف من الكشاف (٢/ ١١٣).
[192] الفلك الدائر، ص٢٢٠.
[193] فتوح الغيب (٦/ ٤٢٢).
[194] الفلك الدائر، ص۲۲۱، التحرير والتنوير (٨/ ١٩٢).
[195] ينظر: أنموذج جليل، ص٤٩٥، ٥٢٥، ٣٦٣، ٣١٦، ٥٤٥، الروض الريان (١/ ٥٣)، (٢/ ٥٥١)، فتح الرحمن، ص٥٧٨، ٤٠٦، ٣٥٤، ٥٩٦.


