مدخل إلى علم أماكن نزول القرآن
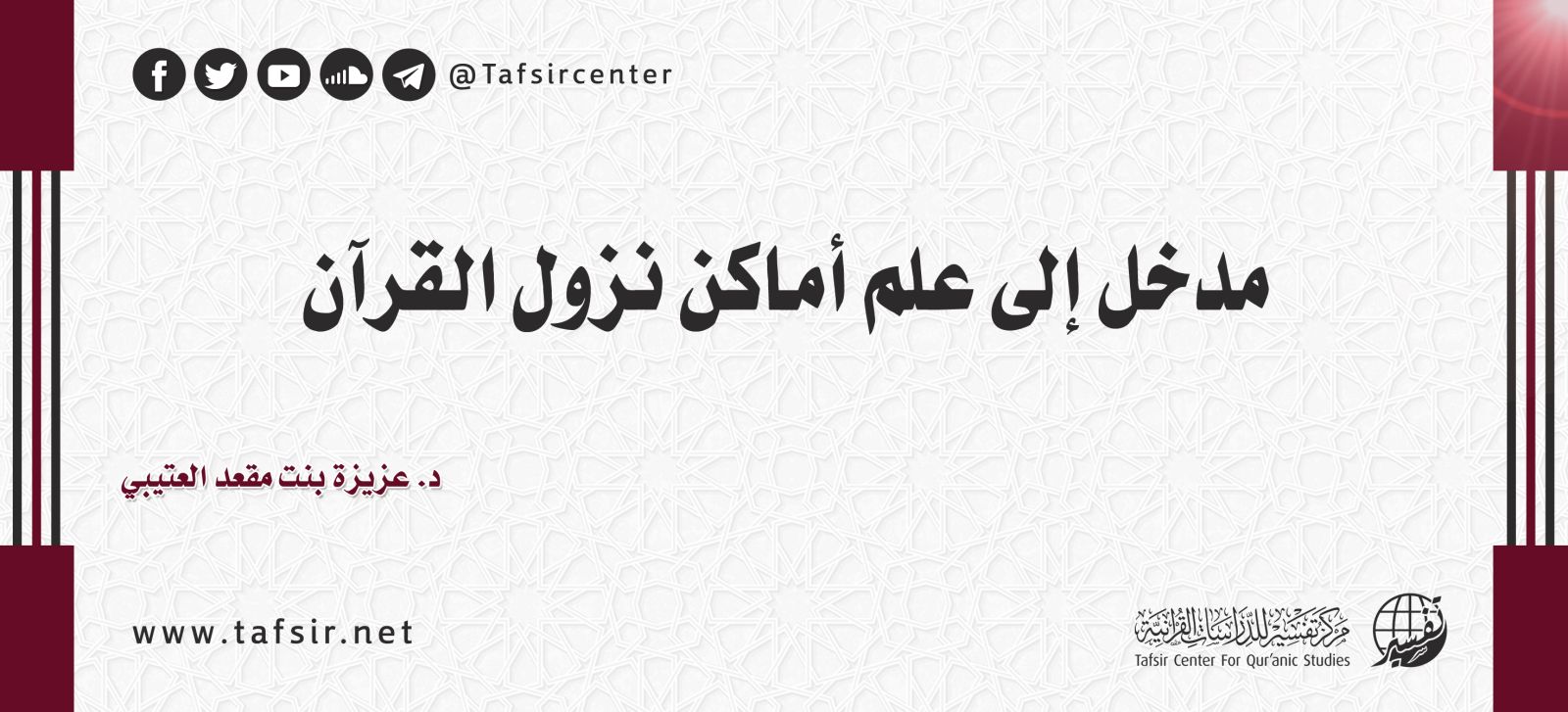
مدخل إلى علم أماكن نزول القرآن[1]
أولًا: التعريف بعلم أماكن نزول القرآن وأسمائه ونسبته:
أ- تعريف أماكن النزول:
جرت العادة بتعريف المصطلحات لغةً واصطلاحًا، ولكن لمّا كان معناه اللغوي -وهو المؤلَّف من كلمتين: الأماكن والنزول- ظاهرًا وواضحًا لم أشتغل بذِكْره.
أمّا تعريفه اصطلاحًا فلم أستطع -حسب بحثي- الوقوف على تعريفات لعِلْم أماكن نزول القرآن، ناهيك عن تعريف علمي محرّر له، وخاصّة في كتب أوائل مَن صنَّف في هذا العلم أو مَن عُرفوا بتحريره كالزركشي والبلقيني والسيوطي ونحوهم، وكذلك الحال عند المعاصرين، غير أنني وقفت على قولٍ لأحد المعاصرين عرَّف فيه أماكن نزول القرآن -وقد عبّر عنها بجهات نزول القرآن- فقال: «...جهات نزل القرآن، نعني بالجهات: الأماكن التي نزل فيها القرآن على النبي -صلى الله عليه وسلم- وهي كثيرة»[2]، والحقيقة أن هذا التعريف -إذا اعتبرناه تعريفًا- فليس فيه إضافة علمية، أو تحرير معرفي، أو تمييز لهذا العلم.
وعليه فيمكن التعريف بعلم أماكن نزول القرآن تعريفًا تقريبيًّا بأنه: (العلم الذي يُعنى بأماكن نزول القرآن).
ب- أسماء علم أماكن النزول:
لهذا المصطلح أسماء كثيرة، ومما وقفتُ عليه في الكتب المؤلفة في علوم القرآن ما يأتي:
- أماكن أو أمكنة النزول.
- مواقع التنزيل.
- وجهات نزول القرآن.
- وتنزُّلات القرآن.
- والمكي والمدني، وهو من أشهر أسماء هذا العلم، وهو شامل لكل ما نزل في مواضع من مكة والمدينة ولا يخرج منه إلا ما نزل على النبي -صلى الله عليه وسلم- في أسفاره.
وهذان المصطلحان -أعني: المكي والمدني- يتجاذبهما عِلْمَان من علوم القرآن، وهما: علم أمكنة النزول، وعلم أزمنة النزول. قال د. مساعد الطيار عن مصطلحي المكي والمدني: «المكي والمدني مصطلحان مرتبطان بالمكان والزمان، وعليهما وقعت عبارات العلماء رحمهم الله»[3].
ولم يكن هناك مشكلة عند العلماء السابقين، وكانوا يستخدمون المصطلحَيْن معًا دون جعلهما قولَيْن متقابلَيْن يحتاجان إلى ترجيحٍ بينهما، ولم يظهر جعلهما قولين متقابلين إلا عند الزركشي ثم من جاء بعده، وهذا محلّ بحث ليس هذا البحث مكانًا له.
جـ- التفريق بين علم أماكن النزول وعلوم القرآن المشابِهة له:
وينبغي التفريق بين هذا العلم (علم أماكن نزول القرآن) وبين علوم القرآن الأخرى المتعلقة بنزوله والمشابِهة لهذا العلم.
فمن تلك العلوم المشابِهة لعِلْم أماكن النزول في بعض الجوانب؛ علم أحوال نزول القرآن، ومن مباحثه المشابِهة لعلم أماكن النزول ما يُسمَّى بـ: الحضري والسفري، وكذلك النومي والفراشي، وكذلك السمائي والأرضي... إلخ، فهذه المباحث تتعلق بأحوال نزول القرآن وما يقارن ذلك من صفات وأحوال ومتعلقات.
وهذه المباحث المتعلّقة بعلم أحوال نزول القرآن في الغالب ليس فيها كبير أثر وفائدة في التفسير ونحوه، وإنما فيها بركة الاشتغال بأحوال القرآن ودقائقه وتفاصيله، بخلاف علم أماكن النزول (المكي والمدني)؛ فإنّ له أثرًا كبيرًا في جوانب عدة كما سيأتي بيان ذلك.
ومن تلك العلوم المشابهة لعلم أماكن نزول القرآن في بعض الجوانب، علم أزمنة نزول القرآن، فـ«علم أزمنة النزول القرآني يرتبط ارتباطًا لصيقًا بعلم أمكنته وتحديد مواقعه، لكنهما ينفصلان لاعتبارات فنية أخرى؛ فالزمن له اعتبار، والمكان له اعتبار، ولكلّ منهما اهتمامات لدى الناس. وهذان العِلْمَان مما خُصّ بهما القرآن الكريم، عن سابقه من كتبٍ إلهيّة، بل ويعدّان أيضًا من نقاط التمايز التنزيلي الإلهي على الأنبياء والمرسلين»[4].
ومصطلح المكي والمدني يتجاذبه عِلْمَان: علم مكان النزول، وعلم زمان النزول. ويتضح مما سبق أنه لا مشاحّة في الاصطلاح، وأنه يمكن إجمال الفَرْق بين أماكن نزول القرآن الكريم والمكي والمدني فيما يأتي:
- أنّ المكي والمدني باعتبار زمان النزول، وأماكن نزول القرآن الكريم باعتبار المكان.
- أنّ بينهما علاقة عموم وخصوص وعلاقة جزء مِن كلّ، وذلك؛ أنّ معرفة المكان أخصّ من المكي والمدني؛ فالمكان جزء من المكي والمدني ولا يرتبط المكي والمدني بالمكان؛ لأنهما قد يُعرفان بالزمان، وهو المعتمد عليه غالبًا في التفسير.
- أنّ الزمان متضمِّن المكان.
د- نسبة علم أماكن نزول القرآن:
من المباحث المهمّة التي ينبغي أن تُبحث في كلّ علم معرفة نسبته، ونسبة كلّ علم هي من المبادئ العشرة التي يُبدأ بتعلُّمها قبل دراسة أيّ علم، ولذلك قيل:
«إنَّ مـبادي أيّ علـم عَشَرَةْ ** الحـدُّ، والموضُـوعُ، ثم الـثَّمَرَةْ
ونسـبةٌ، وفضـلُهُ، والواضِـعْ ** والاسْمُ، الاستمدادُ، حكمُ الشارِعْ
مـسائلٌ، والبعض بالبعض اكتفَى ** ومَن دَرَى الجميعَ حازَ الشّرَفَـا»[5].
والنسبة مأخوذ من النَّسَب، وهو إذا عزا الشيء إلى الشيء، أو نما الشيء إلى الشيء. فالمراد بنسبة العلم هو عزوه إلى العلم الذي ينتمي إليه، ويمكن أن يقال باختصار، هي: التصنيف العلمي للفنّ وبيان العلم الذي يدخل فيه، ثم الأبواب التي يدخل فيها من ذلك العلم.
وعليه؛ فيقال في علم أماكن نزول القرآن عند نسبته ما يأتي:
أولًا: عِلْم أماكن نزول القرآن هو عِلْمٌ من العلوم الشرعية، وذلك من جهة النظر إلى انقسام العلوم إلى شرعية وغير شرعية، ويشارك علم أماكن نزول القرآن في هذه النسبة جميع العلوم الشرعية.
ثانيًا: عِلْم أماكن نزول القرآن هو عِلْمٌ من علوم الوسائل والآلة، وذلك من جهة النظر إلى انقسام العلوم الشرعية من حيث مكانتها إلى علوم مقاصد وأصول وغاية، وعلوم وسائل وتتمّات وآلة، ويشارك عِلْم أماكن نزول القرآن في هذه النسبة جميع علوم الآلة والوسائل.
ثالثًا: عِلْم أماكن نزول القرآن هو علمٌ من علوم القرآن، وذلك من جهة النظر إلى انقسام العلوم الشرعية من حيث المتعلّقات والموضوعات، ويشارك علم أماكن نزول القرآن في هذه النسبة جميع علوم القرآن.
رابعًا: عِلْم أماكن نزول القرآن هو عِلْمٌ من علوم القرآن المتعلّقة بنزوله، وذلك من جهة النظر إلى انقسام علوم القرآن باعتبار موضوعاتها، ويشارك عِلْم أماكن نزول القرآن في هذه النسبة جميع علوم القرآن المتعلّقة بالنزول؛ كأسباب النزول، وأوائل وأواخر النزول، ونحوها.
خامسًا: عِلْم أماكن نزول القرآن هو عِلْمٌ من علوم القرآن المتعلقة بمكان نزوله، وذلك من جهة النظر إلى انقسام علوم نزول القرآن وتنوعها باعتبار موضوعاتها.
وعلم أماكن نزول القرآن يرتبط بأنواع كثيرة من أنواع علوم القرآن، وبينه وبينها ارتباطُ تناسُبٍ أو تداخُل، وغير ذلك من أنواع العلاقات بين العلوم:
- فمن ذلك: علم (نزول القرآن)؛ فإنَّ علم أماكن نزول القرآن يُعتبر فرعًا عنه من فروع علم نزول القرآن.
- ومن ذلك: علم (الناسخ والمنسوخ)؛ فإنّ علم أماكن نزول القرآن يُعتبر من دلائل علم الناسخ والمنسوخ؛ لأن المتقدم ينسخ المتأخّر، ومما يُعرف به ذلك معرفة مكان النزول.
ومن ذلك: علم (أسباب النُّزول)؛ فإنّ علم أسباب النزول يعتبر من دلائل علم أماكن نزول القرآن، فإذا صح نزول آية في الحَدَث، فإنّ مكان وقوع الحَدَث سببٌ في معرفة علم أماكن نزول القرآن[6].
- ومن ذلك: علم (أسماء السور)، فإنّ علم أسماء السور يُعتبر من دلائل علم أماكن نزول القرآن، فاسم السورة ودلالاته يدل على مكان وسبب النزول؛ فسورة الأنفال تتعلق بالأنفال والغنائم المتعلقة بمعركة بدر، فدَلَّ اسم السورة على مكان نزوله وزمانه، وسورة الأحزاب تتعلق بمعركة الأحزاب وغزوة الخندق، فدَلَّ اسمها على مكان نزولها وسببه وزمانه[7].
ثانيًا: منزلة علم أماكن نزول القرآن وأهميته:
عِلْم أماكن نزول القرآن له منزلة عظيمة وأهمية كبيرة ومكانة رفيعة، وفي هذا المبحث سنسلِّط الضوء في عجالة على شيء من منزلته وأهميته:
أ- إقسام الله -تعالى- بأماكن نزول القرآن:
وذلك في قوله تعالى: ﴿فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ * وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ﴾[الواقعة: 75- 76].
ومواقع النجوم هي أماكن نزول القرآن في أحدِ الأقوال في معناها، وفيه خلاف، قال ابن القيم: «وقد اختُلف في النجوم التي أقسم بمواقعها؛ فقيل: هي آيات القرآن، ومواقعُها: نزولُها شيئًا بعد شيء، وهذا قول ابن عباس -رضي الله عنهما- في رواية عطاء، وقول سعيد ابن جبير، والكلبي، ومقاتل، وقتادة،...»[8]. وقال بهذا القول -أيضًا- كثير من أئمة التفسير من السلف كـ: عكرمة، ومجاهد، والسُّدِّي، وأبو حَزْرَة[9].
قال السمعاني: «وهو قول جماعة كثيرة من التابعين»[10].
وقال الشنقيطي -مرجِّحًا لهذا القول-: «أظهر الأقوال عندي وأقربها للصواب في نظري - أنّ المراد بالنجم إذا هوى هنا في هذه السورة، وبمواقع النجوم في الواقعة: هو نجوم القرآن التي نزل بها المَلَكُ نجمًا فنجمًا، ...ولا شك أنّ القرآن الذي هو كلام الله أنسب لذلك من نجوم السماء ونجم الأرض. والعلم عند الله تعالى»[11].
ولعظيم قَدْرِ منازل القرآن أقسم الله بها، ومعلوم أنه «يَرِدُ القَسَمُ ويُراد به تعظيم المقسَم به أو المقسَم عليه»[12].
ثم قال -تعالى- عن هذا القَسَم: ﴿وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ﴾، قال الواحدي: «والمعنى: وإنّ القَسَم بمواقع النجوم لَقَسَمٌ عظيم لو تعلمون»[13].
قال السمعاني -مبينًا سبب عظمة القَسَم بها-: «لأنَّ قَسَم الله عظيم، وكلّ ما أقسَم به. ويقال: إنَّ تخصيصه هذا القسَم بالعِظَمِ؛ لأنه أقسَم بالقرآن على القرآن؛ قاله القفال الشاشي»[14].
وقال الشنقيطي -في معرض ذِكره لأوجه ترجيح معنى منازل القرآن على غيره-: «كون المقسَم به المعبّر بالنجوم هو القرآن العظيم أنسب؛ لقوله بعده: ﴿وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ﴾؛ لأن هذا التعظيم من الله يدلّ على أن هذا المقسَم به في غاية العظمة»[15].
وفي قوله: ﴿لَوْ تَعْلَمُونَ﴾ حذف المتعلّق، وحذف المتعلّق دليل على العظمة والسعة والكثرة والتفخيم[16]، قال ابن كثير: «وإنّ هذا القَسَم الذي أقسمتُ به لقَسَمٌ عظيم، لو تعلمون عظمته لعظمتم المقسَم به عليه»[17].
قال المراغي: «وإنّ هذا القسم عظيم لو تعلمون ذلك، وفي هذا تفخيم للمقسَم به»[18].
وفيه دليل على أهمية العلم به والحرص على ذلك، قال المحلي: «لو كنتم من ذوي العلم لعلمتم عِظَم هذا القسَم»[19].
وقال ابن عثيمين: «قوله: ﴿لوَ تَعْلَمُونَ﴾؛ إشارة على أنه يجب أن نتفطّن لهذا القسَم وعظمته حتى نكون ذوي عِلْم به»[20].
وقد جاء الإقسام بأماكن نزول وحي الله على رسله عمومًا، في قوله تعالى: ﴿وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ * وَطُورِ سِينِينَ * وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ﴾ [التين: 1- 3]، قال النسفي: «الأوّلان[21] قَسَمٌ بمهبط الوحي على عيسى، والثالث على موسى، والرابع على محمد، عليهم السلام»[22]، وقد قرّر غير واحد من المفسِّرين ذلك وأشار إليه[23].
ب- اعتناء السلف به من الصحابة والتابعين ومَن بعدهم بعلم أماكن نزول القرآن:
«تُولِي الأمم اهتمامها البالغ بالمحافظة على تراثها الفكري ومقومات حضارتها، والأمة الإسلامية أحرزت قصب السبق في عنايتها بتراث الرسالة المحمدية التي شرفت به الإنسانية جمعاء؛ لأنها ليست رسالة علم أو إصلاح يحدّد الاهتمام بها مدى قبول العقل لها واستجابة الناس إليها، وإنما هي -فوق زادها الفكري وأُسسها الإصلاحية- دين يخامر الألباب ويمتزج بحبات القلوب، فنجد أعلام الهدى من الصحابة والتابعين ومَن بعدهم يضبطون منازل القرآن آيةً آية ضبطًا يحدّد الزمان والمكان، وهذا الضبط عماد قويّ في تاريخ التشريع يستند إليه الباحث في معرفة أسلوب الدعوة، وألوان الخطاب، والتدرج في الأحكام والتكاليف»[24].
و«لهذا عُني المسلمون عناية فائقة بتتبع ما نزل بمكة وما نزل بالمدينة، بل عُني بعضهم بتتبع جهات النزول في أمكانها وأوقاتها المختلفة، وبذلوا في ذلك جهودًا مضنية، وفي ذلك دليل على سلامة القرآن من أيّ تغيير أو تحريف، فقد تلقّاه الجمع الغفير من التابعين عن الجمع الغفير من الصحابة، وتلقّاه الأواخر عن الأوائل بالمشافهة والتلقين مع الوقوف على أماكن نزوله وأوقاته وأسبابه، وغير ذلك مما يتصل بألفاظه ومعانيه ومقاصده»[25].
فـ«لم يكتفوا بحفظ النصّ القرآني فحسب، بل تتبّعوا أماكن نزوله، ما كان قبل الهجرة وما كان بعدها، ما نزل بالليل وما نزل بالنهار، ما نزل في الصيف وما نزل في الشتاء، إلى غير ذلك من الأحوال»[26].
فـ«مِنْ عبقرية الصحابة -رضي الله عنهم- [ومَن بعدهم من السلف] أنهم حرصوا على معرفة مواقع التنزيل زيادة في التوثيق القرآني، وتقوية للإيمان، وكانت العرب يومئذ أمّة أميّة، أبناؤها يعتمدون على تخزين الأحداث في الحافظة الذهنية، فكانت حافظتهم هي المدوّنة، فماذا دوّنت حافظة الرجال إذًا؟! لقد دوّنت مواقع عجيبة غريبة، لا تخطر ببال أحدٍ إلّا هُم؛ لوعيهم الكبير، واهتمامهم العظيم»[27].
قال الباقلاني: «فأمّا المكي والمدني من القرآن فلا شُبهة على عاقلٍ في حفظ الصحابةِ والجمهورِ منهم إذا كانت حالهم وشأنهم في حفظ القرآن وإعظامه وقدره من نفوسهم ما وصفناه لِما نزل منه بمكة ثم بالمدينة، والإحاطة بذلك والأسباب والأحوال التي نزل فيها ولأجلها»[28].
فعلوم نزول القرآن كعِلْمِ أمكنة النزول وأزمنة النزول وأسباب النزول وغيرها من علوم القرآن المتعلّقة بنزوله خاصّة من العلوم التي اعتنى بها السلف من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين[29]، وسأذكر جملة من كلامهم فيما يأتي تدلّ على هذا، فالمقصود أنه «كان للسلف عناية خاصة بمكان نزول القرآن»[30].
فإذا تقرّر هذا؛ فإليك جملة من الآثار الواردة عن السلف التي تدلّ على اعتنائهم بعلم مكان النزول:
فعن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: «والذي لا إله غيره، ما أُنزلت سورة من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت، ولا أُنزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فِيمَن أُنزلت، ولو أعلم أحدًا أعلم منِّي بكتاب الله تبلغه الإبل لركبتُ إليه»[31].
وعن عليّ بن أبي طالب -رضي الله عنه- قال: «والله ما نزلت آية إلا وقد علمتُ فِيمَ أُنزلت، وأين نزلت، إنّ ربي وهب لي قلبًا عقولًا ولسانًا سؤولًا»[32].
وعنه -رضي الله عنه- قال: «سلوني عن كتاب الله، فوالله ما مِن آية إلا أنا أعلم أبليلٍ نزلت أم بنهار؛ أم في سَهْلٍ نزلت أم في جبل»[33].
وعن طارق بن شهاب أن أُناسًا من اليهود قالوا: لو نزلت هذه الآية فينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدًا. فقال عمر: أيّة آية؟ فقالوا: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ [المائدة: 3]، فقال عمر: «إني لأعلمُ أيّ مكان أُنزلت؛ أُنزلت ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- واقف بعرفة»[34].
وعن أيوب، سأل رجل عكرمة عن آية من القرآن، فقال: «نزلت في سفح ذلك الجبل»، وأشار إلى سَلْع[35].
ج- أهمية العلم بأماكن نزول القرآن في تفسيره وفهمه:
مما يدلّ على أهمية العلم بأماكن النزول أن العلم به من أكثر ما يُعِين على فهم القرآن، ومن أهمّ ما يفيد في معرفة معانيه، وكذا العلم بنوع سوره وسياقات آياته والمخاطبين بها، «وقد حاول الباحثون أن يتتبعوا ما نزل في هذه الأماكن وغيرها، معتمدين في ذلك على الروايات الصحيحة، ليستعينوا بمعرفة جهات النزول على فهم الأحكام الشرعية التي تضمنتها الآيات، وليعرفوا الناسخ منها والمنسوخ، وغير ذلك من الفوائد التي سيأتي بيانها»[36].
قال د. فهد الرومي: «الاستعانة به في تفسير القرآن الكريم؛ فإن معرفة مكان النزول يُعِين على فهم المراد بالآية، ومعرفة مدلولاتها وما يَرِد فيها من إشارات أحيانًا»[37].
ولذا كان العلم بأمكنة نزول القرآن ممن لا يسع المفسّر جهلُه، ومما يلزمُ مَن تصدَّى إلى تفسير كتاب الله أن يُعنى به، قال أبو القاسم الحسن بن محمد بن حبيب النيسابوري في كتاب (التنبيه على فضل علوم القرآن): «من أشرفِ علومِ القرآن علمُ نزوله وجهاته،... -ثم عدّ أنواعها ثم قال- ...فهذه خمسة وعشرون وجهًا من لم يعرفها ويميز بينها لم يَحِلَّ له أن يتكلّم في كتاب الله تعالى»[38].
قال يحيى بن سلام البصري: «ولا يَعرف تفسير القرآن إلا مَن عرفَ اثنتي عشرة خصلة: المكي والمدني، والناسخ والمنسوخ... إلخ»[39].
وقال السيوطي: «قال بعض الأقدمين: أُنزل القرآن على ثلاثين نحوًا، كلّ نحو منه غير صاحبه. فمن عرف وجوهها ثم تكلَّم في الدِّين أصاب ووُفِّق، ومن لم يعرفها وتكلَّم في الدِّين كان الخطأ إليه أقرب، وهي: المكي والمدني، والناسخ والمنسوخ... إلخ»[40].
وقال مرعي الكرمي: «ويجب أنْ نعلمَ ما نزل بمكة من السور والآيات وما نزل بالمدينة؛ لأنه أصل كبير في معرفة الناسخ والمنسوخ، لأن الناسخ المنزل بمكة إنما نسخ ما قبله من المنزل بها، والمنزل بالمدينة نسخ ما قبله من المدني والمكي، ونزول المنسوخ بمكة كثير ونزول الناسخ بالمدينة كثير»[41].
«وقد اهتم الكثير من علماء التفسير وعلماء الفقه والأصول بمعرفة جهات النزول، وهي الأماكن التي نزل فيها على النبي -صلى الله عليه وسلم- كمكة والمدينة والجحفة وبيت المقدس والطائف والحديبية وتبوك وغيرها. وبذلوا جهدًا مشكورًا في هذا البحث معتمدين على الروايات الصحيحة التي نقلها التابعون عن أئمة الصحابة وعلمائهم؛ ليستعينوا بمعرفتها على فهم الأحكام الشرعية التي تضمنتها الآيات، وليعرفوا الناسخ منها والمنسوخ وغير ذلك»[42].
د- تخصيص أماكن نزول القرآن بالتأليف:
مما يدلّ على أهمية العلم بأماكن نزول القرآن تخصيصُها بكتابة المؤلَّفات المتعلقة بها، وإفرادها بالمصنَّفات المبيِّنة لها، مما يدلّ على أهميتها، وهذه المصنفات من عهد التابعين إلى زماننا هذا، وبعضها ذات عناوين مصرّحة بأماكن النزول ككتاب: (الكلام على أماكن من التنزيل) لابن أبي شريف برهان الدين أبي إسحاق إبراهيم بن محمد الشافعي (ت: 923هـ)، وإليك جملة مما صُنّف في ذلك:
- کتاب: (نزول القرآن)، للضحّاك بن مزاحم الهلالي (ت: 104هـ).
- وكتاب: (نزول القرآن)، لعكرمة أبي عبد الله القرشي البربري (ت: 105هـ).
- وكتاب: (نزول القرآن)، للحسن بن أبي الحسن البصري (ت: 110هـ).
- وكتاب: (تنزيل القرآن)، لمحمد بن مسلم بن شهاب الزهري (ت: 124هـ).
- وكتاب: (التنزيل في القرآن)، لعليّ بن الحسن بن فضال الكوفي (ت: 224هـ).
- وكتاب: (فضائل القرآن وما أُنزل من القرآن بمكة وما أنزل بالمدينة)، لأبي عبد الله محمد بن أيوب بن الضريس البجلي (ت: 294هـ).
- وكتاب: (بيان عدد سور القرآن وآياته وكلماته ومكيّه ومدنيّه)، لأبي القاسم عمر بن محمد بن عبد الكافي (ت: 400هـتقريبًا).
- وكتاب: (تنزيل القرآن)، لأبي زرعة عبد الرحمن بن زنجلة المقرئ (ت: 403هـ).
- وكتاب: (التنزيل وترتيبه)، لأبي القاسم الحسن بن محمد النيسابوري (ت: 406هـ).
- كتاب: (المكي والمدني)، لمكي بن أبي طالب القيسي (ت: 437هـ).
- وكتاب: (المكي والمدني في القرآن واختلاف المكي والمدني في آيِه)، لأبي عبد الله محمد بن شريح الرعيني المقرئ (ت: 476هـ).
- وكتاب: (يتيمة الدرر في النزول وآيات السور)، لأبي عبد الله محمد بن أحمد الحنبلي المقرئ (ت: 656هـ).
- وكتاب: (المكي والمدني في القرآن)، لعبد العزيز بن أحمد الديريني (ت: 694هـ).
- وكتاب: (الأرجوزة المتضمنة معرفة المكي والمدني من سور القرآن الكريم)، لبدر الدين محمد بن أيوب التاذفي الحنفي (ت: 705هـ).
- وكتاب: (تقريب المأمول في ترتيب النزول)، لبرهان الدين إبراهيم بن عمر الجعبري المقرئ (ت: 732هـ).
- وكتاب: (الكلام على أماكن من التنزيل)، لابن أبي شريف برهان الدين أبي إسحاق إبراهيم بن محمد الشافعي (ت: 923هـ).
- وكتاب: (المكي والمدني والناسخ والمنسوخ وعدد الآي)، لمحمد بن أحمد العوفي (ت: 1050هـ).
- وكتاب: (أرجوزة في القرآن المكي والمدني وما في تعداده من الخلاف)، لمحمد بن أحمد بوزان الخزاني (كان حيًّا 1216هـ)[43].
ناهيك عمّا صنّفوه من المؤلفات التي خَصّصَت بابًا لعلم المكي والمدني، وهي كثيرة جدًّا.
ثالثًا: تاريخ علم أماكن نزول القرآن:
يمكن تقسيم تاريخ علم أماكن نزول القرآن، أو ما يعبّر به بعضهم عنه بعِلْم المكي والمدني؛ إلى مرحلتين:
المرحلة الأولى: مرحلة التلقين والرواية:
وتبدأ هذه المرحلة في عصر الصحابة وليس في عهد النبوّة، «أمّا النبي -صلى الله عليه وسلم- فلم يَرِد عنه بيان للسور المكية والسور المدنية؛ لأن هذا مما يشاهده ويحضره الصحابة -رضي الله عنهم- فكيف يخبرهم عن شيء يعلمونه! فالمكي والمدني يُعرف بغير نصّ من الرسول -صلى الله عليه وسلم-»[44].
وقد أورد الزركشي سؤالًا فقال: «ويقع السؤال أنه: هل نَصَّ النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- على بيان ذلك؟» ثم أجاب بقول الباقلاني الآتي[45]:
قال الباقلاني: «لم يكن من النبي -عليه السّلام- في ذلك قولٌ ولا نصّ، ولا قال أحد ولا رَوَى أنه جمعه، أو فِرقةٌ عظيمةٌ منهم تقوم بهم الحجة، وقال: اعلموا أنّ قَدر ما أُنزل عليّ من القرآن بمكة هو كذا وكذا، وأنّ ما أُنزل بالمدينة كذا وكذا، وفصّله لهم وألزمهم معرفته، ولو كان ذلك منه لظهر وانتشر، وعُرفت الحال فيه. وإنما عدل -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك؛ لأنه مما لم يُؤمر فيه، ولم يجعل الله تعالى عِلْم ذلك من فرائض الأمّة، وإنْ وجبَ في بعضه على أهل العلم»[46].
فلم يظهر هذا العلم ظهورًا واضحًا جليًّا إلا في عهد الصحابة، ومما يجدر التنبيه إليه أنّ العلم بمكان النزول عند السلف كان أشهر وأكثر من العلم بزمان النزول[47]، وأكثر ما برز هذا العلم على يد الصحابة. قال د. مساعد الطيار: «...ولقد كان للسَّلَف طريقتان في التعبير عن النُّزول... وفي كلتا الطريقتين لم يقع منهم نصّ مباشر على الزمان (قبل الهجرة، وبعد الهجرة). بل كان الوارد عن بعض الصحابة التنبيه على معرفة المكان دون الزمان كالوارد عن ابن مسعود -رضي الله عنه-[48]... وقد ورَدَ هذا المعنى عن غيره من السلف»[49].
فـ«الظاهر في عبارات السلف -وهم العمدة في هذا الباب- اعتبار المكان والنصّ عليه، واعتبار المكان في عباراتهم يتضمّن اعتبار الزمان بدهيًّا؛ لأنّ أسفار النبي -صلى الله عليه وسلم- لم تكن إلا في العهد المدني، فإذا قيل: نزلَت سورة الفتح في الحديبية، فقد أفاد هذا القول الأمرين معًا: (المكان والزمان)؛ لأنّ أمر الحديبية إنما كان بعد الهجرة. أمّا لو عُبّر بالزمان فقط، فإنه لا يفيد في تحديد المكان، فلو قيل: سورة الفتح مدنية نزلت بعد الهجرة، فإنّ هذا القول لا يفيد في تعيين المكان الذي نزلت فيه، ولا شكّ أن في تحديد المكان فائدة زائدة على اعتماد الزمان فقط. وإذا كان الأمر كذلك، فإنّ الأفضل في مثل هذا الحال أن يعبّر عن المكان، ثم يتبع بالزمان إن كان الأمر يحتاج إلى ذلك»[50].
وقال د. مساعد الطيار -أيضًا- بعد أن ذَكَر روايات وآثار السلف في بيان حال السور: «فهذه الروايات وغيرها تدلّ على أنَّ السَّلَف كانوا يعنون بذِكْر المكان الذي نزلت فيه السورة أو الآية، لكن لا يعني هذا أنهم كانوا يغفلون الزمان الذي ضبطه بعض أتباع التابعين بضابط الهجرة، فما كان قبل الهجرة فهو مكّي، وما كان بعد الهجرة فهو مدني، فهذا الضابط، وإن لم ينصوا عليه إلا أنهم يعملون بفحواه، فهل يتصوّر أن يكون نزول آية إكمال الدين في مكة قبل الهجرة؟ بالطبع لا، فقول عمر -رضي الله عنه- أُنزلت ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- واقف بعرفة[51]، يتضمّن نزولها بعد الهجرة؛ لأنّ حجة الوداع كانت بعد الهجرة قطعًا، ولم يكن هناك داعٍ لأن يقول عمر: نزلت بعد الهجرة، ولا كان من مصطلحات الصحابة والتابعين وكثير من أتباع التابعين، وأول من رأيته نصَّ على هذا الضابط الزماني يحيى بن سلام البصري... [فـ]السلف كانوا يعتنون بذِكْر المكان، ويعملون بالزمان في تطبيقاتهم التفسيرية، ومما يدل على ذلك ما يأتي: قال سعيد بن منصور: حدّثنا أبو عوانة عن أبي بشر، قال: سألت سعيد بن جبير عن قوله تعالى: ﴿وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ﴾ [الرعد: 43]، أهو عبد الله بن سلام؟ فقال: كيف، وهذه السورة مكية؟![52] ويمكن تلخيص القول في هذه المسألة بأن يُعتبر المصطلحان معًا بحيث يكون في ذِكْر مكان النزول إشارة إلى ضابط الزمان إن احتاج الأمر إلى ذلك»[53].
المرحلة الثانية: مرحلة التدوين والكتابة:
وقد ابتدأت مرحلة التدوين والكتابة في عِلْم أماكن النزول في مرحلة مبكّرة، وذلك في عهد التابعين، فإنّ من أوائل ما ألّف في هذا العلم في عهد التابعين كتاب (نزول القرآن) للضحّاك بن مزاحم الهلالي (ت: 104هـ)، وكتاب (نزول القرآن) لعكرمة أبي عبد الله القرشي البربري (ت: 105هـ)، وكتاب (نزول القرآن) للحسن بن أبي الحسن البصري (ت: 110هـ). وهؤلاء معدودون في طبقة التابعين، وممّا أُلِّف في عهد أتباع التابعين كتاب (تنزيل القرآن) لمحمد بن مسلم بن شهاب الزهري (ت: 124هـ).
ويمكن تقسيم ما أُلِّف في علم أماكن نزول القرآن بعد ذلك إلى قسمين:
1) التأليف في علم أماكن نزول القرآن ضمنًا، وهي المؤلَّفات التي تضمّنت الكلام عن علم أماكن نزول القرآن؛ ككتب التفاسير أو فضائل القرآن أو علوم القرآن، مثل كتاب (فضائل القرآن وما أنزل من القرآن بمكة وما أنزل بالمدينة)، لأبي عبد الله محمد بن أيوب بن الضريس البجلي (ت: 294هـ).
2) التأليف في علم أماكن نزول القرآن استقلالًا، وهي المؤلَّفات التي أُفردت بالكلام عن علم أماكن نزول القرآن، مثل كتاب (الكلام على أماكن من التنزيل)، لابن أبي شريف برهان الدين أبي إسحاق إبراهيم بن محمد الشافعي (ت: 923هـ).
رابعًا: قواعد في علم أماكن نزول القرآن:
لعلم أماكن نزول القرآن قواعد مهمّة وأصول وضوابط ينبغي الوقوف عليها والتنبه إليها والعناية بها، وإليك جملة من تلك القواعد المهمة:
- القاعدة الأولى: إنما يُعرف مكان النزول بنقل من شاهدوا التنزيل:
الأصل في هذا العلم أنه مبنيّ على النقل والسماع، والنقل والسماع يكون ممن شاهدوا التنزيل وهم الصحابة، قال السيوطي: «قال القاضي أبو بكر في الانتصار: إنما يُرجع في معرفة المكي والمدني إلى حفظ الصحابة والتابعين، ولم يرِد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في ذلك قول؛ لأنه لم يؤمر به، ولم يجعل الله عِلْم ذلك من فرائض الأمة، وإن وجبَ في بعضه على أهل العلم معرفة تاريخ الناسخ والمنسوخ فقد يُعرف ذلك بغير نصّ الرسول»[54].
فـ«مردّ العلم بالمكي والمدني هو السماع عن طريق الصحابة والتابعين»[55].
- القاعدة الثانية: لا تعارض بين المعنى الزماني والمعنى المكاني لمصطلح (المكي والمدني):
يتكلّف بعض المتأخِّرين في حكاية الخلاف في ضابط المكي والمدني، وأنّ القول بأنّ ضابطه الزمان (الهجرة)، مخالف لمن يذكر المكان كما هو حال غالب السّلف، والحقيقة أنّ ذِكر المكان لا يلزم منه مخالفة الزمان، فما نزل بمكة بعد الهجرة مكي مكانًا ومدني زمانًا، قال د. مساعد الطيار: «...وقد زاد بعض المعاصرين الاستدلال والاحتجاج، ورجَّح اعتبار الزمان الذي رجّحه بعض المتقدِّمين كابن حجر العسقلاني والسيوطي وغيرهما. لا تعارض بين مذهب السلف في التعبير عن النزول بالمكان، وما ذهب إليه المتأخرون من العلماء من أنّ ما نزل قبل الهجرة فهو مكي، وما نزل بعد الهجرة فهو مدني؛ لأن السلف كانوا يعتنون بذِكْر المكان، ويعملون بالزمان في تطبيقاتهم التفسيرية، ومما يدلّ على ذلك ما يأتي: قال سعيد بن منصور: حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر قال: (سألتُ سعيد بن جبير عن قوله تعالى: ﴿وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ﴾ [الرعد: 43]، أهو عبد الله بن سلام؟ فقال: كيف، وهذه السورة مكية؟!)[56]، ويمكن تلخيص القول في هذه المسألة بأن يُعتبر المصطلحان معًا بحيث يكون في ذِكْر مكان النزول إشارةً إلى ضابط الزمان إن احتاج الأمر إلى ذلك، وإذا تأمّلت ذلك وجدت:
1- أنّ كلّ ما وُصِف من القرآن بأنه مدني فلا يدخله اللَّبس، فما وُصِف بالمدني فهو بعد الهجرة لا قبلها قطعًا.
2- أنَّ الأماكن التي ثبت أنّ الرسول -صلى الله عليه وسلم- إنما ذهب إليها بعد الهجرة؛ كبعض غزواته: غزوة بني المصطلق، وغزوة تبوك، لا يمكن أن يقال: إنها من المكي؛ لأنها بعد الهجرة.
3- يبقي الأمر في بعض السور والآيات التي نزلت بمكة بعد الهجرة، وهي قليلة بالنسبة لسور وآيات القرآن. وإذا كان الأمر كذلك فلا حاجة إلى الترجيح بين المصطلحَيْن كما ذهب إليه بعض مَن كتب في المكي والمدني لأمنِ اللّبس في أغلب نزول القرآن من هذه الجهة، والله أعلم»[57].
- القاعدة الثالثة: قد يلزم من ذِكْر المكان معرفة الزمان لا العكس:
قد يدلّ مكان النزول غالبًا على زمان النزول، ولا يدل الزمان على المكان، قال د. مساعد الطيار: «الظاهر في عبارات السلف -وهم العمدة في هذا الباب- اعتبار المكان والنص عليه، واعتبار المكان في عباراتهم يتضمن اعتبار الزمان بدهيًّا؛ لأن أسفار النبي -صلى الله عليه وسلم- لم تكن إلا في العهد المدني، فإذا قيل: نزلت سورة الفتح في الحديبية، فقد أفاد هذا القولُ الأمرين معًا: (المكان والزمان)؛ لأنّ أمر الحديبية إنما كان بعد الهجرة. أمّا لو عُبِّر بالزمان فقط، فإنه لا يفيد في تحديد المكان، فلو قيل: سورة الفتح مدنية نزلت بعد الهجرة، فإن هذا القول لا يفيد في تعيين المكان الذي نزلت فيه، ولا شكّ أنّ في تحديد المكان فائدة زائدة على اعتماد الزمان فقط. وإذا كان الأمر كذلك، فإن الأفضل في مثل هذا الحال أن يُعبّر عن المكان، ثم يُتبع بالزمان إن كان الأمر يحتاج إلى ذلك»[58].
- القاعدة الرابعة: كلّ مدني مكانًا فهو مدني زمانًا، لا العكس:
كلّ قرآنٍ كان مكان نزوله بالمدينة النبوية فيلزم منه كونه قرآنًا مدنيًّا زمانًا، أي: نازلًا بعد الهجرة، فإنّ المدني ما نزل على النبي -صلى الله عليه وسلم- في المدينة بعد الهجرة، وليس كلّ ما نزل على النبي بعد الهجرة (المدني زمانًا) يكون مدنيًّا مكانًا، فقد يكون نازلًا بمكة؛ كآية المائدة أو غيرها.
- القاعدة الخامسة: كلّ ما نزل في غزوات النبي -صلى الله عليه وسلم- فهو مدني زمانًا:
كلّ غزوات النبي -صلى الله عليه وسلم- وقعت بعد الهجرة، فكلّ ما أُنزل عليه من القرآن في مغازيه في أيّ مكان كانت الغزوة ولو كانت فتح مكة أو صُلح الحديبية، فإن يعتبر قرآنًا مدنيًّا باعتبار الزمان، لا باعتبار المكان، قال د. مساعد الطيار: «الأماكن التي ثبت أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- إنما ذهب إليها بعد الهجرة؛ كبعض غزواته: غزوة بني المصطلق، وغزوة تبوك، لا يمكن أن يقال: إنها من المكي؛ لأنها بعد الهجرة»[59].
- القاعدة السادسة: كلّ ما نزل بضواحي مكة فهو مكيّ مكانًا، وكلّ ما نزل بضواحي المدينة فهو مدني مكانًا، ثم ينظر في زمانه:
للعلماء في تقسيم السور والآيات باعتبار مكان النزول ثلاثة مناهج:
المنهج الأول: القسمة الرباعية: إذ يُقسّم بعضهم السور باعتبار مكان نزول القرآن إلى أربعة أقسام:
1. ما نزل بمكة، وهو المكّي المحض.
2. ما نزل بالمدينة، وهو المدني المحض.
3. ما نزل بعضه بمكة وبعضه بالمدينة، وهو المتبعض.
4. ما لم ينزل بمكة ولا المدينة.
قال ابن النقيب في مقدّمة تفسيره: «المنزل من القرآن على أربعة أقسام: مكي، ومدني، وما بعضه مكي وبعضه مدني، وما ليس بمكي ولا مدني»[60].
المنهج الثاني: القسمة الثلاثية: إذ يُقسِّم بعضهم السور باعتبار مكان نزول القرآن إلى ثلاثة أقسام:
1. المكي.
2. المدني.
3. ما نزل في غيرهما.
قال السيوطي وهو يذكر هذا القول في معنى المكي والمدني ويبين أقسامه: «الثاني: أن المكي ما نزل بمكة ولو بعد الهجرة؛ والمدني ما نزل بالمدينة، وعلى هذا تثبت الواسطة فما نزل بالأسفار لا يطلق عليه مكّي ولا مدني»[61].
ومما رُوي في ذلك حديث أبي أمامة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (أُنزل القرآن في ثلاثة أمكنة: بمكة، والمدينة، والشام)[62].
المنهج الثالث: القسمة الثنائية: إذ يُقسِّم بعضهم السور باعتبار مكان نزول القرآن إلى قسمين:
١. المكي.
٢. المدني.
سواء كان الاعتبار في هذا التقسيم الثنائي الزمان أو المكان، فأمّا التقسيم المبنيّ على الزمان المستند الهجرة فلا إشكال فيه.
وأمّا التقسيم المبنيّ على المكان فيُورَد عليه ما نزل بغير مكة وبغير المدينة، قال د. مناع القطان: «ويترتّب على هذا الرأي عدم ثنائية القسمة وحصرها، فما نزل بالأسفار أو بتبوك أو ببيت المقدس لا يدخل تحت القسمة، فلا يُسمَّى مكيًّا ولا مدنيًّا»[63].
ولكن ينتبه إلى القسم الثالث باعتبار هذا التقسيم للمكي والمدني فإنه إذا كان من ضواحي مكة أو المدينة ألحقوه بهما، قال السيوطي: «ويدخل في مكة ضواحيها؛ كالمُنزَّل بمنى وعرفات والحديبية، وفي المدينة ضواحيها؛ كالمُنزَّل ببدرٍ وأُحُدٍ وسَلْع»[64].
وهذا التقسيم الثنائي المبنيّ على المكان هو الذي جاءت القاعدة في تقريره، ولكن ما زال الإشكال قائمًا وواردًا فيما نزل في غير مكة والمدينة ولا يُعتبر من ضواحيهما؛ كالذي نزل بتبوك. وعليه، فتكون القاعدة أغلبية لا كلية مطردة.
- القاعدة السابعة: العِبرة في الحكم على السور بكونها مكية أو مدنية هو أكثر آياتها:
قد تكون هناك بعض الآيات في السورة المدنية مكية أو العكس، ولكن العِبرة في وصف السورة هو أغلب آياتها، قال ابن حجر: «فلا يلزم من نزول آية أو آيات من سورة طويلة بمكة إذا نزل معظمها بالمدينة، أن تكون مكية»[65].
- القاعدة الثامنة: غالب القرآن المكي زمانًا فهو مكي مكانًا:
وهذه -أيضًا- قاعدة أغلبية، وتوضيحها أنّ النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يخرج بعد بعثه ومكوثه في مكة إلا إلى الطائف وبيت المقدس في إسرائه، فكلّ ما نزل عليه من القرآن في مكة قبل الهجرة فأغلبه مكي مكانًا.
والقرآن المكي قسَّمه بعضهم إلى قسمين باعتبار المكان:
1. المكي الأول؛ وهو ما نزل في مكة قبل الهجرة، وهو مكي مكانًا وزمانًا.
2. المكي الأخير؛ وهو ما نزل فيها بعد الفتح، وهو مكي مكانًا ومدني زمانًا[66].
[1] هذه المقالة من كتاب: (الأماكن التي نزل بها القرآن غير مكة والمدينة)، الصادر عن مركز تفسير سنة 1444هـ = 2023م، ص15 وما بعدها. (موقع تفسير).
[2] دراسات في علوم القرآن، محمد بكر إسماعيل، ص41.
[3] المحرر في علوم القرآن، ص101.
[4] موسوعة علوم القرآن، لعبد القادر محمد منصور، ص44.
[5] الأبيات لأبي العرفان محمد بن عليّ الصبان، في حاشيته على شرح شيخه الْمَلَّوِي على السُّلَّم المنورق، ص35.
[6] ينبغي التنبّه إلى أنّ بعض أسباب النزول قد يكون من باب التفسير وما يدخل في معنى الآية، فهو من باب التفسير بالمثال، وليس سببًا صريحًا في النزول، وعليه فلا يكون مما يفيد في معرفة مكان أو زمان النزول.
[7] انظر: المحرر في علوم القرآن، د. مساعد الطيار، ص100.
[8] التبيان في أيمان القرآن، ص321.
[9] انظر: تفسير مقاتل (3/ 317)، وجامع البيان (22/ 359- 360)، وتفسير القرآن العظيم (7/ 544).
[10] تفسير السمعاني (5/ 358).
[11] أضواء البيان (7/ 463- 464).
[12] التبيان في أيمان القرآن، ص13.
[13] البسيط (4/ 239).
[14] تفسير السمعاني (5/ 359).
[15] أضواء البيان (7/ 463- 464).
[16] انظر: فوائد حذف المتعلق: القواعد الحسان للسعدي، ص43.
[17] تفسير القرآن العظيم (7/ 544).
[18] تفسير المراغي (27/ 150).
[19] تفسير الجلالين، ص717.
[20] تفسير الحجرات - الحديد، ص347.
[21] أي: التين والزيتون.
[22] مدارك التنزيل وحقائق التأويل (3/ 660).
[23] انظر: تفسير القرآن العظيم (8/ 434)؛ وتفسير المنار، لرشيد رضا (9/ 303)؛ وتفسير جزء عم، د. مساعد الطيار، ص127.
[24] مباحث في علوم القرآن، د. مناع القطان، ص49.
[25] دراسات في علوم القرآن، محمد بكر إسماعيل، ص51.
[26] المكي والمدني، لمحمد شفاعت رباني، ص4.
[27] موسوعة علوم القرآن، لعبد القادر محمد منصور، ص60.
[28] الانتصار للقرآن (1/ 247).
[29] انظر: علوم القرآن عند الصحابة والتابعين، د. بريك القرني (1/ 245).
[30] المحرر في علوم القرآن، د. مساعد الطيار، (ص:101).
[31] أخرجه البخاري، برقم: (5002).
[32] أخرجه ابن سعد، الطبقات الكبرى (2/ 257)؛ وأبو نعيم في حلية الأولياء (1/ 67- 68).
[33] أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (2/ 195)؛ وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (6/ 191)؛ والحاكم في المستدرك برقم: (3788)؛ وابن سعد في الطبقات (2/ 338).
[34] صحيح البخاري برقم: (4407)؛ وأخرجه أيضًا مسلم برقم: (3017).
[35] أخرجه أبو نعيم في الحلية (3/ 327).
[36] دراسات في علوم القرآن، محمد بكر إسماعيل، ص41.
[37] دراسات في علوم القرآن الكريم، د. فهد الرومي، ص133.
[38] نقلًا عن الإتقان، للسيوطي (1/ 36).
[39] تفسير ابن أبي زمنين (1/ 113- 114)؛ وتفسير هود بن محكم (1/ 69).
[40] معترك الأقران (1/ 172).
[41] قلائد المرجان، ص37.
[42] الموسوعة القرآنية المتخصصة، لمجموعة من الأساتذة والعلماء المتخصصين، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمصر، ص600.
[43] انظر: المكي والمدني لمحمد شفاعت رباني، ص5.
[44] دراسات في علوم القرآن د. فهد الرومي، ص126.
[45] البرهان (1/ 191).
[46] الانتصار للقرآن (1/ 247).
[47] انظر كثيرًا من آثار الصحابة المعتنية بمكان النزول: علوم القرآن عند الصحابة والتابعين، د. بريك القرني (1/ 247).
[48] تقدم تخريجه.
[49] المحرر في علوم القرآن، د. مساعد الطيار، ص101.
[50] شرح مقدمة التسهيل لعلوم التنزيل، لابن جزي، د. مساعد الطيار، ص67.
[51] تقدم تخريجه.
[52] سنن سعيد بن منصور (5/ 442).
[53] المحرر في علوم القرآن، د. مساعد الطيار، ص103- 105.
[54] الإتقان (1/ 38)، وانظر: قواعد التفسير، د. خالد السبت (1/ 77).
[55] مناهل العرفان، د. الزرقاني (1/ 196).
[56] سنن سعيد بن منصور (5/ 442).
[57] المحرر في علوم القرآن، د. مساعد الطيار، ص103- 105.
[58] شرح مقدمة التسهيل لعلوم التنزيل، لابن جزي، د. مساعد الطيار، ص67.
[59] المحرر في علوم القرآن، د. مساعد الطيار، ص105.
[60] نقلًا عن الإتقان، للسيوطي (1/ 37).
[61] الإتقان (1/ 37).
[62] أخرجه الطبراني في المعجم الكبير برقم: (7717)، وضعّفه الهيثمي، انظر: مجمع الزوائد (7/ 160).
[63] مباحث في علوم القرآن، ص61.
[64] الإتقان (1/ 38).
[65] فتح الباري (9/ 41). انظر: المكي والمدني، لعبد الرازق أحمد (1/ 42).
[66] انظر: الناسخ والمنسوخ، هبة الله بن سلامة المفسر البغدادي، ص322- 323.


