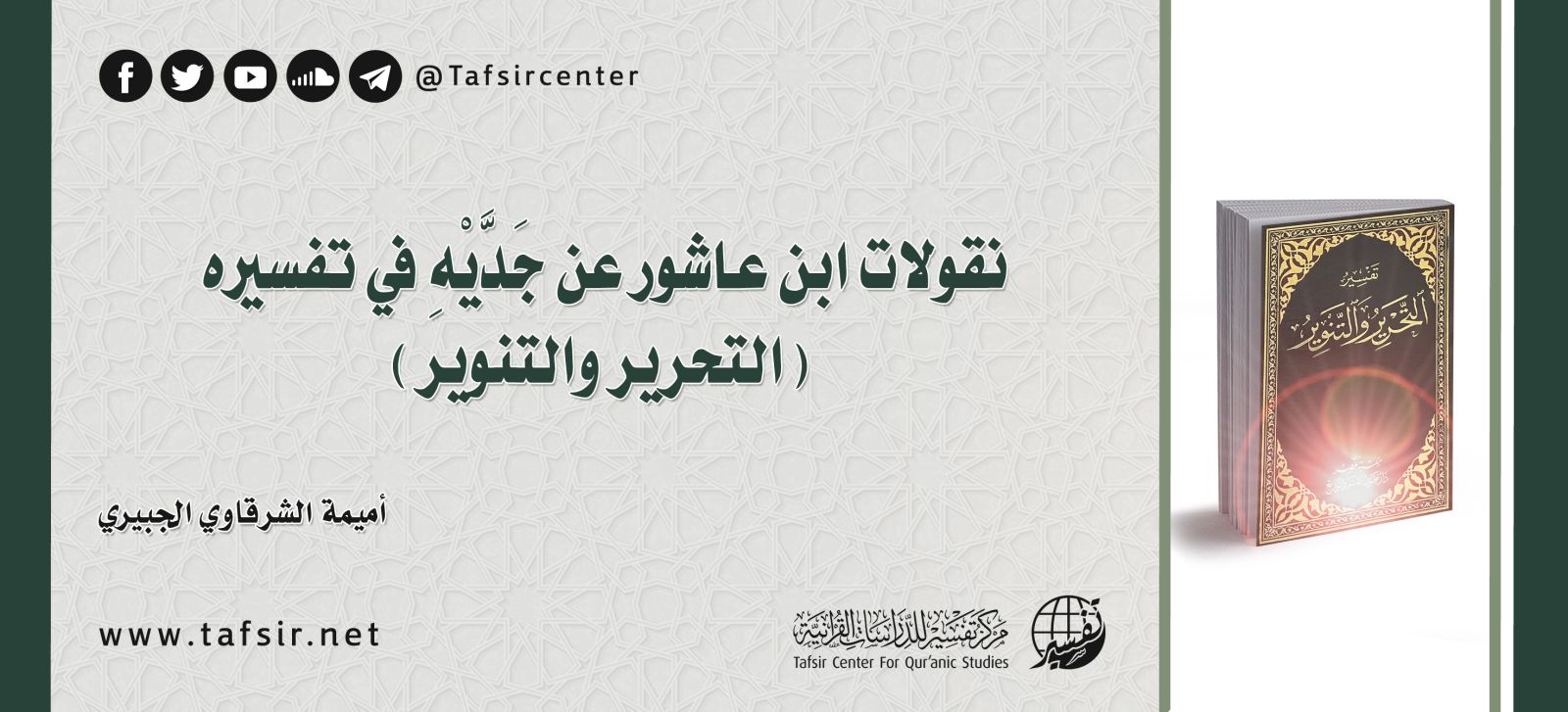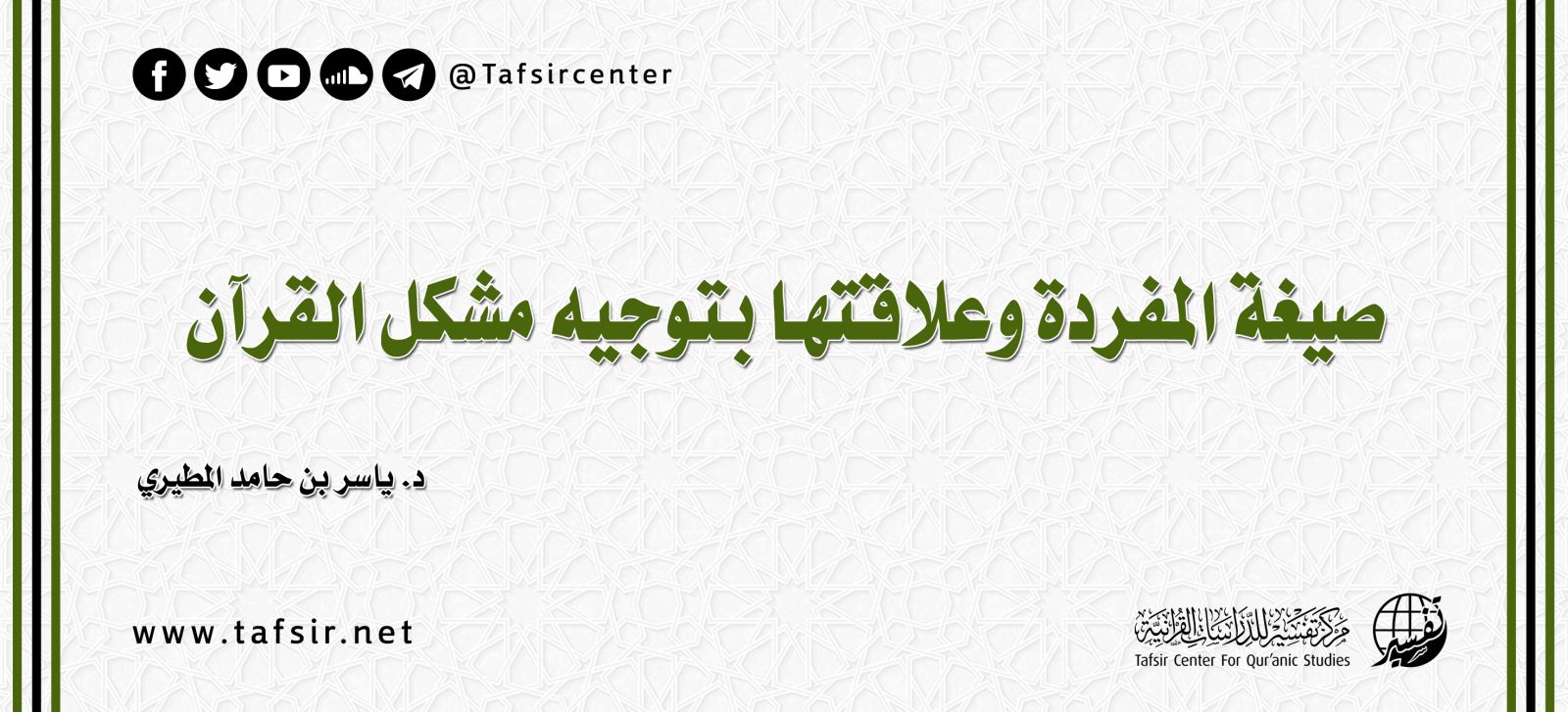توجيه أقوال المفسرين عند ابن عطية
توجيه أقوال المفسرين عند ابن عطية
الكاتب: محمد صالح سليمان

توجيه أقوال المفسِّرين عند ابن عطية[1]
توجيه أقوال المفسِّرين من أهم الموضوعات التي يتأسّس عليها بنيان النقد، وتقوم عليها دعائمه، وتنضبط على وفاقه موازينه، ومَنْ أحكَمَ هذا الموضوع، وضَبَط أصوله، وحَلّ ألغازه، وفتحَ أقفاله =كان نقدُه متينًا، ورأيه سديدًا، وحُكمه سليمًا، ومَن نبذَه وراء ظهره =غلَب الفساد على حُكمه، والخطأ على رأيه ونقدِه.
إنّ توجيه أقوال المفسِّرين علمٌ دقيق جدًّا، يستلزم التحليق في أجواء عقول القائلين، والغوص في أعماقهم، والدراية التامّة بأحوالهم وأعرافهم، والخبرة الواسعة بأقوالهم وآرائهم.
ما هو المقصود بتوجيه أقوال المفسرين في هذا البحث؟
بعدَ النظر في كثير من توجيهات ابن عطية، والتأمُّل في أحوالها يمكننا القول بأنّ: توجيه أقوال المفسِّرين هو: بيان الأوجه التي تتَخرَّج عليها أقوال المفسِّرين وتُفْهَم من خلالها.
الغاية من التوجيه: الفهم السليم للقول بدراسة محتمَلاته وأحواله وأوجهه المختلفة، والأُسُس التي استند إليها قائله، بغضّ النظر عن قبول قوله أو ردّه؛ فالتوجيه بمثابة الدفَّة التي توجِّه سيرَ الأقوال، وتحدّد مسارها، وتبين وجهتها، وتوضح غامضها.
لفظة التوجيه عند ابن عطية:
لقد وردَت لفظة: وَجْه ووجَّه وما اشتُق منهما عند الإمام ابن عطية في كثير من المواطن مرادًا بها المعنى السالف ذِكْره؛ من بيان وجهة قول المفسِّر، والمخرج الذي يتخرَّج عليه كلامه، والعلّة التي تأسَّس عليها، أو بيان أنّ القول لا وجه له.
فمن ذلك لفظة: (وَجه)[2]، و(وَجهُه)[3]، و(يتّجه)[4]، و(يتوجّه)[5]، و(توجيه)[6].
صلة النقد بالتوجيه:
يُعَدُّ التوجيه بمثابة التمهيد للنقد؛ إِذْ هو سابق عليه، وغايته إبراز الأقوال في صورتها الكاملة؛ ليتهيّأ للناقد الحكم عليها بموضوعية تضمن سلامة نقده؛ فالتوجيه هو المرآة التي تتجلَّى فيها الصورة الكاملة للأقوال قبل انتقادها. والمتصدّر لنقد أقوال المفسِّرين لا بد أن يكون ذا فهمٍ ثاقب، وبصرٍ نافذ، خبيرًا بطرائق المفسِّرين، بصيرًا بمقاصدهم، عارفًا بمناهجهم في بيان معاني الآيات؛ حتى يحسن فهم أقوالهم، وينزل كلّ قول منزلته، ثم يقيم على فهمه الثاقب وبصره النافذ حكمه النقدي؛ ليكون نقده نقدًا موضوعيًّا، مؤسّسًا على فهمٍ وبصرٍ وإدراك؛ إِذْ فهم الأقوال سابق على انتقادها، وبمقدار الإصابة في الفهم تكون الإصابة في النقد، والعكس بالعكس.
قال الهادي بن إبراهيم بن الوزير[7]: «فإنّ مِن حقّ الناقض لكلام غيره أن يفهمه أولًا، ويعرف ما قصد به ثانيًا، ويتحقّق معنى مقالته، ويتبين فحوى عبارته؛ فأمّا لو جمع بين عدم الفهم لقصده، والمؤاخذة له بظاهر قوله =كان كمَن رمَى فأَشْوَى[8] وخَبط خَبْط عَشْوَا[9]، ثم إنْ نَسَبَ إليه قولًا لم يعرفه، وحمَّله ذنبًا لم يقترفه؛ كان ذلك زيادة في الإِقصا، وخلافًا لِما به اللهُ تعالى وصَّى، قال تعالى: ﴿وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا﴾[الأنعام: 152]، وقال تعالى: ﴿قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ﴾[الأعراف: 29]، وقال تعالى: ﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾[المائدة: 8]؛ إلى أمثالها من الآيات... فأمّا مجرد البُهت الصُّراح؛ فلا يليق بذوي الصَّلاح»[10].
إنّ توجيهَ الأقوال، وبيان مقاصد قائليها، وتعديد الاحتمالات التي تتخرج عليها أقوالهم =بابٌ دقيق من أبواب العلم لا يُفتح إلا لمَن أدمَن النظر، وداوَم التأمل، وأجهد الذهن، واستنفر القوى، واستنهض الفكر، ونظر إلى خبايا الأقوال، وتغلغل في زواياها، وهو جهد عظيم وطريق طويل شاقّ، شقّ ابنُ عطية فيه دروبًا، وقطع فيه أشواطًا، ورفع فيه منارات ودلائل يهتدي بها السالكون، ويستضيء بها المسترشدون. وتفسير ابن عطية زاخر بكثير من التوجيهات والتأويلات التي وجَّه بها أقوال المفسِّرين، وهي صالحة لأن تكون في رسالة علمية مستقلّة تعالج هذا الموضوع الشائك الشائق، وتؤصِّل لهذا العلم العزيز؛ تستخرج لآلئه، وتستكشف كنوزه، وحسبنا هنا أن نقتبس من أنوار توجيهاته ما أمكن الوقوف عليه، مما يلزم الناقد معرفته، وتمسّ حاجته إليه، وتتوقّف صحة انتقاده عليه.
قاعدة التوجيه العامة:
من خلال التتبُّع والتقصِّي وجدتُ أصول التوجيه تقوم على قاعدة عامة، انطلقَتْ منها توجيهاتُ ابن عطية؛ وهي: تحاشي الانتقاد إلا بيقين جازم أو ظنّ غالب.
وهي قاعدة حريّ بنا أن نهتم بها، ونطبقها في بحوثنا ومسيرتنا العلمية؛ فليست تخطئة العلماء وتسفيه آرائهم هدفًا يسعى الناقد إليه ولا غاية يرمي إليها، ولا مطلبًا يطمح لتحقيقه، وإلا كان جاهلًا بمبادئ النقد وبدهياته؛ لأنّ قوّة الناقد الحقيقية كامنة في عدم انتقاده لقول إلا بعد تعذُّر قبوله، واستحالة تصحيحه، بحيث يصير ردّ الأقوال وانتقادها المحطة الأخيرة التي لا يحطُّ الناقدُ فيها رحاله إلا وقد أَيِسَ من النزول بغيرها، والحلول بساحةٍ سواها؛ ولذا فإنّ مَن رزقه الله إنصافًا وتجرّدًا ومحبةً للحقّ لا يسارع إلى انتقاد العلماء إذا أشكل عليه قولٌ من أقوالهم، وإلا أفسد من حيث أراد التصويب، ولكنه -والحالة هذه- ينزل إلى رحاب التوجيه؛ فيدرس كلّ ما ارتبط بأقوالهم واحتفَّ بها من سياق وردت فيه، أو مناسبة قيلت فيها، أو حدث ارتبط بها، أو اعتبارات أُسِّسَت عليها، أو رجال رَووها، أو أحوال بيئية أو تاريخية أو سياسية أثَّرت فيها، ثم يخلص من هذه الدراسة العميقة، وقد تكوّنت لديه صورة متكاملة عن الأقوال؛ تجعل لحكمه اعتباره، ولانتقاده منزلته، وتصونه عن التردِّي في انتقادات كان الحقّ فيها مع مَن انتقده، والصواب مع مَن خالفه؛ ولذا فلا يجوز لنا المبادرة إلى نقدِ قول، أو إصدار حُكم عليه، ما لم نتبيَّن الظروف والمؤثّرات والضغوط التي أنتجته؛ فعندها فقط يكون نقدُنا عادلًا وموضوعيًّا[11].
إِذْ إنّ ظهورَ صواب أقوال العلماء بعد انتقادها وصمةٌ في جبين الناقد، وبيان لتسرُّعه وتقصيره؛ ولذا قال ابن تيمية: «ومن أعظم التقصير نسبة الغلط إلى متكلِّم مع إمكان تصحيح كلامه»[12]. ومَن طالع تفسير ابن عطية ووازنه بكثير من التفاسير =وجد له مزية على كثير منها بتحريره للأقوال، وغوصه في مقاصد قائليها، ودراسته لما ارتبط بالأقوال من أحوال ومناسبات واعتبارات، وعدم مسارعته إلى تخطئة قول إلا وقد تعذَّر لديه قبوله، أو تخطئة مفسِّر إلا وقد استحال نفي الخطأ عنه.
طرق التوجيه:
كلّ قول يتكوّن من أركان يقوم عليها، ولا يبرز للوجود إلا من خلالها؛ وهذه الأركان هي:
* (قائل).
* (قول).
* (ناقل).
وهذه الأركان تقوم على أساسها طرقُ توجيه الأقوال، فكلّ من أراد أن يستبين وجود وجهة للقول، أو انعدامها؛ لزمه أن ينظر في هذه الأركان الثلاثة، فينظر إلى الكلمات والعبارات؛ ليدرس محتملاتها وتأويلاتها، وينظر إلى القائل ليتبين غرضه، ويعرف زمان ومكان وسياق كلامه والأحوال التي احتفَّت به، وينظر إلى الناقل ليستبين دقّة نقله وصواب فهمه؛ فمَن أحكم النظر إلى هذه الجهات الثلاث؛ انكشفت أمامه الأقوال، فعرف ما له منها وجهة وما خلا من ذلك، وغلب على توجيهه السداد والإصابة، ومن لم يحكم النظر إليها لم تنكشف له وجهتها، ولم تستبِنْ له مقاصدُها، وتردَّى في الخطأ والمغالطة؛ فألصَق خطأ الناقل بالقائل، أو حَكَم بانعدام الوجهة مع وجودها وظهورها.
فتحصل أن توجيه الأقوال له ثلاثة طرق رئيسة؛ وهي:
* توجيه الأقوال بالنظر إلى القول ذاته.
* توجيه الأقوال بالنظر إلى القائل.
* توجيه الأقوال بالنظر إلى الناقل.
وقد كانت توجيهات ابن عطية وتخريجاته للأقوال هي التي أرشدتني لتلك التقسيمات، وبصَّرتني بتلك الطرق؛ فوجدتُ غالب توجيهاته لا تخرج عن تلك الطرق، وأنّ ما يُظَنُّ خروجه عنها يعود إليها؛ كتوجيه استدلال القائل مثلًا، فهو يعود إمّا إلى توجيه قول القائل، أو توجيه القول نفسه.
وهذه الطرق الثلاثة بينها تداخل وترابط، بحيث يتعسّر أحيانًا تمييز أيّ طريق منها وقع عليه التوجيه؛ ولذا فقد عدَلْتُ عن الالتزام بتمييز الأصول التوجيهية المتعلِّقة بكلّ طريق منها؛ لشدّة ما بينها من تداخل واشتراك أحيانًا، وآثرتُ سرد الأصول التوجيهية دون تخصيص لها بهذا الطريق أو ذاك، مع كون ذلك لا يمنع أن تكون بعض تلك الأصول ظاهرة الخصوصية بطريق دون البقية.
أصول التوجيه:
لقد كان إمامُنا ابنُ عطية رائدًا من الروّاد، عارفًا بمسالك المفسِّرين وطرقهم، ذا فهم ثاقب لأقوالهم، لا يسارع إلى انتقاد قول قبل تفهُّم معناه، وبيان وجهته، ومقصد قائله، وطريقته التي سلكها في التفسير، فأسّس للتوجيه أصولًا، ورسم للتعامل مع الأقوال منهجًا، وشقّ لفهمها دروبًا.
وأصول التوجيه في الحقيقة ما هي إلا أصول لفهم الأقوال، وبيان لكيفيات التعامل معها، وتقليب النظر في جهاتها المختلفة؛ ولذا اهتم بها ابن عطية وسلَّط الضوء عليها، وفتح بها للعقول آفاقًا، وللفكر دروبًا، وقد حرصتُ على أنْ أُبرِزَ بعضَ هذه الأصول من خلال تتبُّعي لكثير من توجيهات ابن عطية، ولستُ أدَّعِي أنه التزمها بترتيب معيَّن، أو راعى مجموعها في كلّ قول انتقده، ولكنه اهتم بها في مجموع ما ينتقده، واستعملها بصور متفاوتة بحسب تفاوت الأقوال وما يناسبها، ولكنها في النهاية تبقى منارات لا غنى عنها لكلّ مَن طرقَ باب النقد، أو سلكَ سبيله، أو بلغ به التِّيه مبلغه في غياهب النقد ومجاهله؛ ومن هذه الأمور ما يأتي:
الأصل الأول: معرفة الأُسس والمنطلقات التي تأسَّس عليها المعنى:
تُعَدُّ من أهمّ الأمور التي يقف عليها الناظر في تفسير ابن عطية =عنايته الشديدة واهتمامه البالغ ببيان الأساس الذي تأسَّس عليه المعنى التفسيري والرّحِم التي تولَّد عنها حتى يكون مصيبًا في نقده، ومنصفًا في حُكمه؛ إذ انتقاد الأقوال دون معرفة الاعتبار الذي بنيت عليه، والوجهة التي تخرَّجَت عليها؛ يجرِّد النقد من موضوعيته، ويضيِّق أُفق الناقد في التعامل مع الأقوال، فيردُّ كثيرًا مما يمكن قبوله، ويدَّعِي التعارُض والتضاد لِما قد يكون سالمًا منه؛ ولذا يتعيَّن على المتصدِّي لنقد الأقوال والحُكم عليها فهمُ الاعتبارات والأُسس التي قامت على أساسها الأقوال، وخرَجَت من رَحِمِها الآراء؛ حتى يكون نقده مصيبًا هدفه، ومحققًا غايته.
وإنّ المتعامل مع أقوال المفسِّرين إذا استطاع بالأناة والصبر وطول البحث والمعاناة استكشاف ما وراء الأقوال من اعتبارات بُنيت عليها أقوالهم، واتجاهات أُسِّسَت عليها آراؤهم =انفتحَتْ له أبواب من العلم لم تُفتح لغيره، وانكشف له ما لم ينكشف لسواه، ووُفِّق إلى فهم كثير مما أشكل على غيره، وإلى قبول ما تعذَّر على غيره قبوله، وصار يرى بعينٍ أخرى غير العين التي يرى بها سواه؛ وسيتضح ذلك من خلال الأمثلة التي سنسوقها من تفسير ابن عطية.
فمِن الأمثلة على ذلك: ما ذكره ابن عطية في تفسير قوله تعالى: ﴿انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا﴾[التوبة: 41]، قال: «وذكرَ الناسُ من معاني الخفّة والثقل أشياء لا وجه لتخصيص بعضها دون بعض؛ بل هي وجوه متفقة... وقيل: الشجاع هو الخفيف، والجبان هو الثقيل -حكاه النقاش-، وقيل: الرجل هو الثقيل، والفارس هو الخفيف، قاله الأوزاعي. قال القاضي أبو محمد: وهذان الوجهان الآخران ينعكسان، وقد قيل ذلك، ولكنه بحسب وطأتهم على العدو؛ فالشجاع هو الثقيل وكذلك الفارس، والجبان هو الخفيف وكذلك الراجل، وكذلك ينعكس الفقير والغنيّ، فيكون الغني هو الثقيل بمعنى صاحب الشغل، ومعنى هذا أنّ الناس أُمِرُوا جملةً»[13].
فقد نقلَ -رحمه الله- أقوالَ العلماء في المراد بالثقل والخفّة، وكان منها قولان أحدهما فسَّر الثقيل بالشجاع والخفيف بالجبان، والآخر عكس ففسَّر الثقيل بالجبان وفسَّر الخفيف بالشجاع، وهكذا الأمر في الفارس والراجل. وأنت في هذا المثال ترى إبداعًا من إبداعات ابن عطية؛ فترى عقله يجول ويصول في ثنايا الأقوال، فيكشف لك عن خباياها، ويميط لك اللثام عن زواياها، حتى يكشف لك عن مقاصد قائليها، بحسِّه النقدي، وعقله اليقظ، وذهنه المتَّقِد، ثم يجمع بين أطرافها، ويبيِّن التئامها -بعد توهُّم اختلافها وتعارضها- في مهارة عقلية نادرة، وتحرير علمي ناصع؛ فقد بيَّن أنَّ كِلا القولين معتبَر، وأن لا تعارض بينهما، وذلك لانفكاك الجهة التي فسَّر بها كلّ مفسِّر، واختلاف الوجهة التي نحَى إليها؛ فمَن فسَّر الثقيل بالشجاع إنما أراد ثقل وطأته، وشدّة بأسه على الأعداء، ومَن فسَّر الخفيف بالشجاع إنما أراد خفّة نفسه وقوة عزمه؛ فالأول نظر إلى حاله مع العدو، والثاني نظر إلى حاله في نفسه، فصح أن يُقال: الشجاع هو الثقيل والشجاع هو الخفيف؛ ولا تعارض، وهكذا الحال في تفسير الثقيل بالجبان تارة، والخفيف بالجبان تارة أخرى، فقد قال رحمه الله: «وقيل: الشجاع هو الخفيف، والجبان هو الثقيل -حكاه النقاش-، وقيل: الرجل هو الثقيل، والفارس هو الخفيف، قاله الأوزاعي. قال القاضي أبو محمد: وهذان الوجهان الآخران ينعكسان، وقد قيل ذلك، لكنه بحسب وطأتهم على العدو؛ فالشجاع هو الثقيل، وكذلك الفارس، والجبان هو الخفيف، وكذلك الراجل»[14]. فكِلا القولين لم يَرِدَا على محلّ واحد، ولم ينهجَا نهجًا متحدًا، وإنما راعَى كلًّا منهما اعتبارًا، ونهج نهجًا؛ فلم يصح -والحالة هذه- ادّعاء التعارض والاختلاف بينهما، لاختلاف الوجهة التي أسَّس عليها كلًّا منهما؛ إذ شرط التعارض اتحاد الجهة، فإذا انفكَّت فلا تعارض.
ومن الأمثلة على ذلك أيضًا: ما استدركه ابن عطية على الطبري في تفسير قوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ﴾[المائدة: 48]، قال: «وقال مجاهد: قوله تعالى: ﴿وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ﴾ يعني محمدًا -صلى الله عليه وسلم-؛ هو مؤتمَنٌ على القرآن. قال القاضي أبو محمد: وغلط الطبري -رحمه الله- في هذه اللفظة على مجاهد؛ فإنه فسَّر تأويله على قراءة الناس مهيمِنًا بكسر الميم الثانية فبَعُدَ التأويل، ومجاهد -رحمه الله- إنما يقرأ هو وابنُ محيصن: ﴿وَمُهَيْمَنًا عَلَيْهِ﴾ بفتح الميم الثانية؛ فهو بناء اسم المفعول، وهو حال من الكتاب معطوفة على قوله: ﴿مُصَدِّقًا﴾، وعلى هذا يتجه أنّ المؤتمَنَ عليه هو محمد -صلى الله عليه وسلم-، و﴿عَلَيْهِ﴾ في موضع رفع على تقدير أنها مفعول لِما لم يُسَمَّ فاعله، هذا على قراءة مجاهد»[15]. فقد استدرك ابن عطية على الطبري انتقاده لقول مجاهد: أنّ المراد بقوله تعالى: ﴿وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ﴾[المائدة: 48] محمد -صلى الله عليه وسلم-؛ يعني أنه مؤتمَنٌ على القرآن، ثم بيَّن أن انتقاد الطبري كان منصبًّا على قراءة غير القراءة التي أسَّس عليها مجاهد قوله؛ إذ انتقاد الطبري منصَبٌّ على قراءة: ﴿وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ﴾ بكسر الميم الثانية، بينما كان مجاهد يقرأ بفتح الميم الثانية لا بكسرها وعليها بَنَى قوله.
ولا شكّ أن الناظر في هذا المثال سيظهر له بجلاء أهمية هذا الأصل من أصول التوجيه وأثره في فهم الأقوال، وأنّ معرفة ما تأسَّسَتْ عليه الأقوالُ من قراءة بَنَى عليها المفسِّر، أو وجهة نحَى إليها، أو اعتبارٍ مَالَ إليه؛ من أهمّ ما يَلْزَمُ الناظرَ في الأقوال معرفتُه قبل التعرُّض لنقدها.
ملحوظة:لا يُعَدُّ بَيانُ القراءة التي بُنِيَ عليها القول توجيهًا لها؛ بل ذُكِرَت لِيُعْلَم أنّ القول تأسَّس عليها وقام على مقتضاها، وأمّا توجيه القراءة فهو: تبيينُ وجوه وعِلل القراءات والإيضاح عنها والانتصار لها[16].
الأصل الثاني: معرفة أساليب المفسِّرين وطرق تعبيرهم عن المعنى:
يسلكُ المفسِّرون في التعبير عن المعنى طرقًا متنوّعة وأساليب متعدّدة، ومن الضروري أن يعرف كلُّ ناظرٍ في تفاسيرهم الأساليبَ والطرقَ التي انتهجوها في تفسيرهم لكتاب الله -عز وجل- حتى يستطيعَ فهْمَ أقوالهم؛ وَيُحْسِنَ التعامُلَ معها؛ إِذْ بدون معرفة أساليبهم والبصَرِ بطرُقِهم في التفسير يَقَعُ الباحِثُ في مزالق كثيرة، ويتوهّم توهّماتٍ لا واقعَ لها ولا أثر؛ إِذْ تُعَدُّ هذه الأساليب بمثابة الأصول التي يدور عليها تفسيرهم، والقواعد التي تؤسَّس عليها أقوالهم، فمَن رامَ فهْمَ أقوالهم لزمه معرفة أصولهم.
وهذه الأساليب يمكن حصرها في:
الأول: التفسير اللفظي: وهو أنْ يفسِّر المفسِّر اللفظة بالمعنى المراد منها في لغة العرب.
الثاني: التفسير على المعنى: وهو أن يذكر المفسِّر المعنى المراد من الآية دون التعرُّض إلى معنى الألفاظ في اللغة؛ ويندرج تحته التفسير بالمثال، والتفسير بجزء المعنى.
الثالث: التفسير بالقياس: وهو إدخال المفسِّر في دلالة الآية معنى غير معناها الظاهر؛ لوجود شبه بين المعنيين[17].
وأهمّ ما يلزم معرفته لتوجيه الأقوال من هذه الأساليب =التفسير على المعنى؛ لكثرة استعماله، واندراج بعض الأنواع تحته، وأمّا التفسير اللفظي فيندر أن يشكل منه شيء، وأمّا التفسير بالقياس فهو قليل الوقوع، ويتداخل أحيانًا مع بعض أنواع التفسير على المعنى.
التفسير على المعنى:
مِن أهمّ ما يلزم معرفته في التفسير على المعنى معرفة الأنواع الداخلة تحته؛ وأهمها نوعان:
أ- التفسير بالمثال.
ب- التفسير بجزء المعنى.
وسيتبيَّن المراد بهما فيما يأتي عند الكلام عن أثر معرفتهما في توجيه الأقوال.
أولًا: توجيه الأقوال ببيان أنها خارجة مخرج المثال:
كثيرًا ما يَعْدِل المفسِّر عن بيان المعنى العام للآية المفسَّرة إلى تفسيرها بمثال أو أكثر مما يندرج تحتها؛ لكون المثال أظهر في الدلالة على المقصود وأقرب إلى ذهن السامع. وقد كان توجيه كثير من أقوال المفسِّرين على أنها تفسير بالمثال، أو خارجة مخرج التمثيل =سمةً بارزة في تفسير ابن عطية وأصلًا من أصول توجيه الأقوال لديه، وقد ظهر مِن تتبُّع استخدام ابن عطيّة لهذا الأسلوب عدّة أمور متعلّقة بالتوجيه جديرة بالبيان:
أولها: الجهل بالتفسير بالمثال يوهم وقوع الاختلاف بين الأقوال:
بيَّن ابنُ عطيّة أن الناظر في أقوال المفسِّرين دون معرفة أصول توجيه الأقوال، والمخارج التي تتخرّج عليها -والتي منها التفسير بالمثال- سيقع في ادّعاء الخلاف بين أقوالٍ هي في حقيقتها متّفقة؛ وسيدّعِي وجود أقوال لا حقيقة لها؛ فقال -رحمه الله- عند تفسيره للفظة المحروم من قوله تعالى: ﴿لِلسَّائِلِ والْمَحْرُومِ﴾[الذاريات: 19]: «واختلف الناس في المحرُوم اختلافًا هو عندي تخليط من المتأخِّرين؛ إذ المعنى واحد وإنما عَبَّر علماء السَّلَف في ذلك بعبارات على جهة المثالات؛ فجعلها المتأخِّرون أقوالًا وحصَرَها مكيٌّ ثمانية[18]. والمحرومُ هو الذي تبعد عنه ممكنات الرزق بعد قربها منه فيناله حرمانٌ وفاقة، وهو مع ذلك لا يَسأل، فهذا هو الذي له حقّ في أموال الأغنياء كما للسائل حقّ، قال الشّعبِي: أعياني أن أعلمَ ما المحروم؟ وقال ابنُ عباس: المحروم: الـمُحارَف[19]؛ الذي ليس له في الإسلام سهم مال، فهو ذو الحرفة المحدود. وقال أبو قلابة: جاء سيل باليمامة فذهب بمال رجل؛ فقال رجل من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم-: هذا المحروم. وقال زيد بن أسلم: هو الذي أُجيحت ثمرتُه؛ من المحرومين، والمعنى الجامع لهذه الأقوال: أنه الذي لا مال له لحرمانٍ أصابه»[20].
وَمَنْ خبر التفسير بالمثال وعَرَفَ أهميته في توجيه الأقوال، وفي الجمع بين ما يُظَنّ تعارضه، وفي تصحيح كثير من الأقوال التي يُتوهّم خطؤها وفي قابليته لاستيعاب كثرةٍ متكاثرةٍ من الأقوال، وفي دوران كلّ الأقوال الداخلة تحته في إطار المعنى العام دون تعارض أو تناقض =أدرك سرَّ اهتمام ابن عطيّة به، واعتماده عليه، وتوجيه الأقوال على أساسه.
ثانيها: تصحيح القول على أنه تفسير بالمثال أَوْلَى مِن ردِّه:
كان التفسير بالمثال من أهم ما اعتمد عليه ابن عطيّة في توجيه أقوال المفسِّرين؛ فقد أثبتَ بهذا الأصل صحة أقوالٍ تُـخُيِّلَ ضعفُها، ووجَّه على أساسه أقوالًا تخفى وجوه توجيهها، وجمع به بين أقوال تُصُوِّر اختلافها، ووسع باستعماله آفاق النظر في أقوال المفسِّرين، وشقّ به للفكر مجالات ودروبًا في كيفية التعامل مع أقوال المؤوِّلين في دقّة وحذق وفطنة ومهارة.
ومَن طالعَ تفسيره وجد ذلك واضحًا جليًّا؛ فهو يصحِّح الأقوالَ المفسِّرة للآيات المدنية بأحداث مكية وقعت قبل نزولها، والآيات المكية بأحداث مدنية وقعت بعد نزولها؛ بل ويصحِّح أقوالًا ترى تنزيلَ الآيات على أشخاص ووقائع وأحوال لم تكن في زمن النزول أصلًا، بناء على كونها مثالًا من الأمثلة الداخلة في عموم المعنى.
ومن النماذج الرائعة في توجيه الأقوال:
ما ذكره ابن عطية في قوله تعالى: ﴿وَإِنْ يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ﴾[الأنفال: 71]، قال: «وأمّا تفسير هذه الآية بقصة عبد الله بن أبي سرح فينبغي أن يحرّر؛ فإن جُلِبَت قصةُ عبد الله بن أبي سرح على أنها مثال كما يمكن أن تُجلَب أمثلةٌ في عصرنا من ذلك فحَسن، وإن جُلِبَت على أن الآية نزلَت في ذلك فخطأ؛ لأنّ ابن أبي سرح إنما تبيّن أمره في يوم فتح مكة، وهذه الآية نزلت عقيب بدر»[21]. وهذا النموذج يوضّح مدى اهتمام ابن عطية بتحرير المراد من أقوال المفسِّرين، وإيجاد المخارج، وتعديد الاحتمالات التي يمكن تصحيح الأقوال عليها، كما يوضح أيضًا أنّ المعاناة الحقيقة للناقد ليست في ردِّ قول أو تضعيفه؛ بل هي التأمّل في خباياه، والنظر في زواياه؛ بغيةَ التماس مخرج صحيح يتخرّج عليه ويُعتبر به. ولا شك أن هذه المعاناة في تصحيح الأقوال لها أثرها الكبير في الحفاظ على الثروة التفسيرية من الإهدار والنقص، كما أنّ لها أثرًا بالغًا في تعليم طرائق التفكير النقدي مع أقوال المفسِّرين، وبيان كيفياته وأُسُسه؛ مما يساعد على تربية ملَكة النقد لدى دارسي التفسير.
ومن أمثلة ذلك أيضًا: ما ذكره ابن عطية عند قوله تعالى: ﴿فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ﴾[التوبة: 12]؛ قال: «أي رؤوسهم وأعيانهم الذين يقودون الناس إليه، وقال قتادة: المراد بهذا أبو جهل بن هشام، وعتبة بن ربيعة، وغيرهما. قال القاضي أبو محمد: وهذا إن لم يُـتأوَّل أنه ذَكَرَهم على جهة المثال ضعيف؛ لأنّ الآية نزلَت بعد بدر بكثير»[22]. فهذه آية من سورة التوبة، وقد اشتهر بين عموم المسلمين مدنية السورة، وتأخُّر نزولها، وقد أدخل قتادة فيها أناسًا ماتوا قبل نزولها بكثير، وقد كان من الميسور على ابن عطية تخطئته بمخالفة قوله للتاريخ، ولكن الملَكة النقدية الواعية لدى ابن عطية تأبَى ذلك، وخاصّة مع اشتهار تأخُّر نزول السورة، واشتهار قتادة بالإمامة في التفسير؛ مما يجعل خفاءَ مثل ذلك عليه احتمالًا بعيدًا وضعيفًا، فكان توجيه قوله على أنه أراد التمثيل بأُناس يدخلون تحت عموم الوصف المذكور -وهو الإمامة في الكفر- بغضّ النظر عن تاريخ النزول =هو الأصوب والأليق. وهكذا يظهر التفسير بالمثال كرافد مهمّ من روافد التوجيه التي وجّه ابن عطية كثيرًا من الأقوال على ضوئها[23].
ثالثها: أهمية بيان المعنى العام الذي يندرج المثال تحته:
اعتنى ابن عطية بالتنصيص على المعنى العام، وتقديمه على ما عَداه عند توجيهه لقول أو لأقوال بأنها خارجة مخرج المثال؛ وكان ذلك منه لأمرين؛ الأول: ذكر المعنى العام الذي تدل عليه الآية. الآخر: الإشارة إلى صحة التفسير بالمثال لاندراجه تحت المعنى العام. فمن ذلك مثلًا: ما ذكره في المراد من النعمة في قوله تعالى: ﴿يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ﴾[البقرة: 40]؛ قال: «وخصّص بعض العلماء النعمة في هذه الآية؛ فقال الطبري: بعثة الرسل منهم، وإنزال المنّ والسلوى، وإنقاذهم من تعذيب آل فرعون، وتفجير الحَجر. وقال غيره: النعمة هنا أن دَرَكَهُم[24] مدة محمد -صلى الله عليه وسلم-. وقال آخرون: هي أن منحهم عِلم التوراة وجعلهم أهله وحمَلَته. قال القاضي أبو محمد -رحمه الله-: وهذه أقوال على جهة المثال، والعموم في اللفظة هو الحسن»[25].
ومن ذلك أيضًا: ما ذكره عند تفسير قوله تعالى: ﴿وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى﴾[الأعلى: 3]، قال: «وقوله تعالى: ﴿فَهَدَى﴾ عام لوجوه الهدايات... قال مقاتل والكلبي: هدى الحيوان إلى وطءِ الذكور الإناث، وقيل: هدى المولود عند وضعه إلى مصّ الثدي، وقال مجاهد: هدى الناس للخير والشر، والبهائم للمراتع. قال القاضي أبو محمد: وهذه الأقوال مثالات، والعموم في الآية أصوب في كلّ تقدير؛ وفي كلّ هداية»[26].
رابعها: بيان علّة اختيار المفسِّر للمثال الذي فسّر به ما أمكن ذلك:
لم يكتفِ ابن عطية ببيان أنّ أقوال المفسِّرين خرجَت مخرج المثال؛ بل كان يشفع ذلك في بعض الأحيان ببيان العلّة التي من أجلها اختار المفسِّر مثالًا بعينه، كأنْ يكون المثال المفسِّر به متوافقًا مع آية من القرآن، أو مع سياق الآيات، أو لكون المعنى فيه أظهر، أو للتنبيه على صور لا ينتبه لها، إلى غير ذلك من العِلل. فمن ذلك مثلًا: ما ذكره عند تفسير قوله تعالى: ﴿وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ﴾[آل عمران: 134] قال: «والعفو عن الناسِ من أجَلِّ ضروب فعل الخير، وهذا حيث يجوز للإنسان ألّا يعفو، وحيث يتجه حقه، وقال أبو العالية: ﴿وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ﴾ يريد المماليك. قال القاضي أبو محمد: وهذا حسَن على جهة المثال؛ إذ همُ الخَدَمَة فهم مذنبون كثيرًا، والقدرة عليهم متيسِّرة، وإنفاذ العقوبة سهل؛ فلذلك مثَّل هذا المفسَّر به»[27].
فقد بيَّن ابن عطية أن مَن فسَّر «العَافِينَ عَنِ النَّاسِ» بالمماليك إنما قصد التمثيل، ثم بَيَّن علّة التمثيل بالمماليك خاصّة؛ لكون معنى الآية أظهر فيهم لتوافر أسباب العقوبة منهم، وانتفاء موانعها عنهم، فالعفو عنهم -والحالة هذه- بالغٌ أرقى درجة من درجات العفو عن الناس. ومن ذلك أيضًا: ما ذكره في تفسير الزيادة في الخلق في قوله تعالى: ﴿يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ﴾[فاطر: 1]، قال: «ورُوي عن الحسَن وابن شهاب أنهما قالَا: المزيد هو حُسن الصوت، وقيل: الزيادة الخَط الحسَن، وقال قتادة: الزيادة ملاحة العينين. قال القاضي أبو محمد: وقيل غير هذا؛ وهذه الإشارة إنما ذكرها مَن ذكرها على جهة المثال، لا أن المقصود هي فقط، وإنما مثّل بأشياء هي زيادات خارجة عن الغالب المعتاد الموجود كثيرًا»[28].
ومما سبق لُوحظ أنّ إِمامنا -رحمه الله- قد نقل عدة أقوال، ثم بيَّن أنها من قبِيل التفسير بالمثال، ثم بيَّن أن العلة في اختيار هذه الأمثلة المذكورة التنبيه عليها والإشارة إليها؛ لقلة الانتباه لها بخروجها عن الغالب الموجود.
ثانيًا: التفسير بجزء المعنى:
التفسير بجزء المعنى أسلوب من أساليب التفسير يقصد به: «أن يذكر المفسّر جزءًا من المعنى الذي يحتمله اللفظ»[29]؛ لأغراض ومقاصد يقصدها. وقد كان التفسير بجزء المعنى رافدًا من روافد التوجيه التي أقام ابن عطية توجيه كثير من أقوال المفسِّرين عليها، وأساسًا استند إليه في تخريج أقوالهم وبيان مقاصدهم، فأظهر به قوّة الأقوال بعد توهُّم ضعفها، وأبَان به عن مقاصد المفسِّرين بعد خفائها، وفتح به نوافذ الفكر على آفاق رحبة، وميادين متّسعة في فنّ التعامل مع الأقوال وطُرق فهمها وكيفية توجيهها، بما يجعل الناقد يسلك بالأقوال طريقًا يَبَسًا لا يخاف نَقْدَ ناقد، ولا يخشى اعتراض معترِض؛ لقوّة حجته، ونصاعة أدلّته.
والأمثلة على هذا الأصل من أصول التوجيه كثيرة، منها:
ما ذكره ابن عطية عند تفسير قوله تعالى: ﴿وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ﴾[البقرة: 27]؛ قال: «واختُلِفَ ما الشيء الذي أُمِرَ بوصله؛ فقال قتادة: الأرحام عامة في الناس، وقال غيره: خاصة فيمَن آمنَ بمحمد صلى الله عليه وسلم، كان الكفار يقطعون أرحامهم. وقال جمهور أهل العلم: الإشارة في هذه الآية إلى دين الله وعبادته في الأرض، وإقامة شرائعه وحفظ حدوده. قال القاضي أبو محمد: وهذا هو الحقّ، والرحم جزء من هذا»[30].
ففي هذا المثال تظهر آفاق ابن عطية الممتدة، وعقله الواسع في حُسن الاستفادة من كلّ الأقوال المروية، وحسن التوفيق بينها دون تعسُّف أو تكلُّف. فقد نقل عن قتادة وعن غيره من أهل العلم: أن المراد بقطع الكفار لِما أمَر الله به أن يوصل هو قطع الأرحام، ثم نقل قول الجمهور في عموم القطع، وعدم اختصاصه بالرّحم وحدها، ثم بَيَّن أنّ الحمل على عموم القطع أَوْلَى وأنه هو الحقّ، ولكنه فَطِنَ إلى أنّ الناظر لترجيحه هذا سيَظُنّ بُطلان قول مَن فسَّر القطع بقطع الرحم، خصوصًا مع استعماله لكلمة (الحقّ) في ترجيح العموم؛ ولذا كرَّ على هذا الظن بالإبطال، وبيان الوجهة التي يحمل عليها تفسير القطع بقطع الرحم؛ فقال: «والرحم جزء من هذا»، فأبان بقوله ذلك اندراج هذا القول تحت العموم الذي رجّحه، وعدم معارضته أو مناقضته له؛ لكونه جزءًا منه، وأنّ قائليه لم يقصدوا تخصيص المعنى بالرحم؛ بل أرادوا التنبيه على جزء من أهم أجزاء العموم لكثرة احتفاء الشرع به، وكثرة وقوع الناس فيه.
ومن أمثلة ذلك أيضًا: ما ذكره عند قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ﴾[البقرة: 105]، قال: «والرحمة في هذه الآية عامّة لجميع أنواعها التي قد منحها الله عباده؛ قديمًا وحديثًا، وقال قوم: الرحمة هي القرآن، وقال قوم: نبوّة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه أجزاء الرحمة العامة التي في لفظ الآية»[31].
فقد صدَّر الكلام ببيان عموم الرحمة وشمولها لجميع أنواعها، ثم أتى بأقوال أخرى يُوهِم ظاهرُها المخالفةَ للعموم، وهي قول مَن قال: الرحمة هي القرآن، أو الرحمة نبوّة محمد صلى الله عليه وسلم، فبيَّن -رحمه الله- أنّ هذه الأقوال لا تخالف العموم ولا تعارضه؛ بل هي دائرة في إطاره، ومنطوية تحته؛ لكونها أجزاء له، فقال: «وهذه أجزاء الرحمة العامة التي في لفظ الآية»[32]. ولعلّ السر في اختيار هذين الجزأين من عموم الرحمة؛ كونهما أهمّ ما رحم الله به عباده وأنعم عليهم به، وكذا كونهما أصلًا للرحمة ومنبعًا لها؛ فنصّ عليهما من فسَّر الرحمة تنويهًا بأهميتهما ومكانتهما، وتفرّع كثير من أجزاء الرحمة عنهما، لا حصرًا للمعنى في هذا أو ذاك. وهكذا يظهر جليًّا أثر المعرفة بأساليب المفسِّرين وطرقهم في توجيه الأقوال، وأثر الجهل بها، أو عدم التنبّه لها في تخطئة المفسِّرين، ورميهم بما هم منه براء.
الأصل الثالث: دراسة ما احتفّ بالتفسير أو المفسِّر من أحوال ومقامات:
إذا كان كثير من المتعلمين ينظر إلى أقوال العلماء بمنظاره الخاصّ الذي كوَّنته ثقافته وبيئته، وما تراكم لديه من رصيد المعلومات والثقافة؛ فإنّ الناقد الذي استوعب أمانة النقد، ووقف على كنهه وحقيقته، وأدرك خطورته وأثره؛ لا يقنعه إلا الخلاص من ذاتيته، والتخلّي عن رغباته؛ ليبدأ رحلة الغوص في أعماق القائل، والحلول بساحات فِكره، ومحاولة العيش في واقعه، وتلَمُّس الأحوال التي احتفّت بكلامه؛ فهو يجتهد غاية الاجتهاد في أن يرى بعين القائل، ويسمع بسمعه، ويعقل بعقله، ويشاهد ما احتفّ بكلامه من أحوال ومقامات، وظروف وملابسات؛ بل ويتمكّن من تمييز الكلام الصادر عنه من الكلام المنسوب إليه كذبًا وزورًا، ثم يعود بعد تلك الرحلة إلى ذاته ومقاييسه التي اعتمدها كناقد؛ ليحكم على هذا القول أو ذاك حكم المتمكِّن الحاذق الذي خبر الأقوال وحرّرها، وانكشف له كثير من مقاصد قائليها؛ فيكون حكمه أكثر دقّة وإصابة من غيره. وما ذكرته إنما هو توصيف يسير لما كان يعانيه ابن عطية في نقد الأقوال وتوجيهها، وهو عين ما يجب أن يعانيه كلّ سالك لهذا الدرب. ففي قوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ﴾[البقرة: 216]؛ قال ابن عطية: «واستمر الإجماع على أنّ الجهاد على أمة محمد فرض كفاية، فإذا قام به مَن قام مِن المسلمين سقط عن الباقين، إلا أنْ ينزل العدوّ بساحةٍ للإسلام؛ فهو حينئذ فرض عين. وذكر المهدوي وغيره عن الثوري أنه قال: الجهاد تطوّع، وهذه العبارة عندي إنما هي على سؤال سائل، وقد قِيمَ بالجهاد، فقيل له: ذلك تطوع»[33].
فقد ذكر ابن عطية حكم الجهاد موجزًا؛ ومتى يكون فرض عين، ومتى يكون فرض كفاية، ثم ذكر أنّ المهدوي نقل عن الثوري ما يُوهِم مخالفته لما ذكره في حكم الجهاد.
وقد كان ميسورًا على ابن عطية أن ينتقد الثوري، ويبيِّن مخالفة قوله لِما عليه جماهير العلماء؛ لكن نظره الفاحص، وحِسّه الناقد لم يقنع بذلك؛ إِذْ سفيان الثوري سيد من سادات المحدِّثين والعلماء، فهو أجَلّ مِن أن يُخطئ في مثل هذا أو أن يخفى عليه، وهنا انطلقت الملَكة النقدية لابن عطية لتجوب آفاق سفيان الثوري، وتلتمس القرائن والأحوال التي احتفّت بكلامه، فهَدَتْه بصيرته النقدية إلى أنّ هذا القول من الثوري إنما كان جوابًا لسؤالِ سائلٍ عن حكم الجهاد في وقتٍ قام فيه جمعٌ من المسلمين بواجب الجهاد، وأسقطوا بقيامهم به وجوبَه عن الباقين، فأجابه الثوري بأنّ الجهاد في حقّه -والحالة هذه- تطوّع. ومن ذلك أيضًا: ما ذكره عند تفسير قوله تعالى لإبليس: ﴿قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ﴾[الأعراف: 12] الآية؛ فقد ذكر أنه رُوي عن الحسن وابن سيرين أنهما قالا: «أوّل من قاسَ إبليس»[34]، وظاهر الفهم الأوّليّ أن هذا القول إنكار منهما للقياس وتعريض بشناعة مستخدميه، ولكنك عندما تأوِي إلى رحاب ابن عطية تجده يعود بهذا القول إلى سياقه الزمني الذي ورد فيه وحالته التاريخية التي صدر عنها فتجلَّى له مرادهما وفهم مقصدهما بخلاف ما يبدو للناظر لأول وهلة، يقول رحمه الله: «ولا يتأوّل عليهما إنكار القياس، وإنما خرج كلامهما نهيًا عمّا كان في زمنهما من مقاييس الخوارج وغيرهم؛ فأرادَا حمل الناس على الجادّة»[35].
فتأمّل تلك الأناة في تفهُّم الأقوال، وكيف كان لها دور رئيس في انتقال ابن عطية إلى أفق أعلى في تفهُّم قول هذين العالمَين الكبيرَين؛ فقد سافر بعقله مستحضرًا السياق الزمني للقول والأحوال المحتفة به من ظهور بدعة الخوارج وغيرهم، ومستحضرًا كذلك جلالة الحَسَن وابن سيرين وأنهما من رؤوس أهل السُّنة في ذلك الوقت، وأنّ مِن أكبر ما يشغلهما تحذير الناس من البدع وتنفيرهم من مسالك المبتدعة وطرقهم المخالفة للهدي النبوي؛ فحمل كلامهما على ما اقتضاه سياق زمنه وجلالة قائليه.
فقد تبيَّن مما سبقَ من صنيع ابن عطية ضرورة يقظة الناقد وتنبّهه لما احتفّ بأقوال المفسِّرين من مقامات ومناسبات وأحوال، وأنَّ عزل الأقوال عن الواقع الذي احتفّ بها، والأحوال التي قارنتها، والظروف المحيطة بها، والأحداث التاريخية المؤثرة فيها =قد يُوقع الناقد في الوهم والخطأ، كما قد يوقعه في تضعيف ما يمكن تصحيحه، وردّ يمكن قبوله.
الأصل الرابع: التأكد من إصابة الناقل قبل اتهام القائل:
قال إمامُ الحرمَينِ: «قال العلماء: كلّ قول شاذّ عن إمام ففي نقله خَلل»[36]، وهذا كلام في غاية الإصابة نقله إمام الحرمين عن بعض العلماء، وذلك وإن كان له مستثنيات إلا أنّ هذا لا يخرم القاعدة، ولاحظ في العبارة قوله: «عن إمام»؛ لأنه لو ثبتت عليه كثرة الشذوذ لا يصير إمامًا، وقد أكّد إمام الحرمين هذه القاعدة بما أتبعه إياها من أقوال شاذة نُسبت لبعض الصحابة.
وهذا يعني أن أقوال أهل العلم من المفسِّرين وغيرهم يجاذبها طرفان؛ قائل وناقل، وإن كثيرًا ممن يتصدر لنقد الأقوال، ينشغل بالقائل عن الناقل، مع أنّ احتمال خطأ الناقل أكثر من احتمال خطأ القائل؛ لِما قد يعتري الناقل من غفلة، أو ذهول، أو سوء فهم، ولكثرة الوسائط التي تزداد احتمالات وقوع الخطأ معها، لا سيما عند بُعدها عن مصدر القول. وقد تكون غرابة القول أو ظهور نكارته سببًا في انصراف نقد الناقد إلى القائل مباشرة، وذهوله عن خطأ الناقل؛ فتزِلّ قَدمه وتتعثّر خُطاه.
ومَن تتبَّع انتقادات ابن عطية وجده ناقدًا حصيفًا، لم ينشغل بقائل عن ناقل، ولا بناقل عن قائل؛ بل كان يقلب النظر في جميع الزوايا المحتفة بالقول، ويُعمِل الفكر في كلّ الاحتمالات التي يحتملها، ويقتحم بذهنه الطرق المتشعّبة والمسالك المتداخلة؛ بغية النجاة من شِراك النظرة الأحادية؛ لمعاينة الحقائق، وتجلية الغوامض، وتسليط الضوء على مواطن القصور والخلل، وبيان كيف وقعت، ولماذا وقعت، وممن وقعت. وإنما جعلت هذا من ضمن أصول التوجيه حتى مع ثبوت خطأ الناقل؛ لأن غاية التوجيه -كما أسلفتُ- بيان خلوّ قول المفسِّر من وجهة، أو إثبات أن لقوله وجهة، فإذا ثبت خطأ الناقل بانَ خلوّ القول من وجهة يعتمد عليها أو أساس يستند إليه، وتلك غاية من غايات التوجيه المطلوبة.
وبمراعاة ابن عطية لهذا الأصل نجده قد راعى عدّة أمور هي غاية في الأهمية، جنّبته كثيرًا من مزالق التسّرع وعدم التثبُّت، منها:
1- التثبت من سلامة قول المفسِّر من التصحيف:
إنّ الحكم النقدي الذي يصدره الناقد على هذا القول أو ذاك مسبوق بخطوات ومراحل لا بد للناقد أن يخطوها، وأن يضع قدمه عليها؛ حتى يطمئنّ في نهاية المطاف إلى سلامة حُكمه ونزاهة نقده.
ومن أهمّ هذه الخطوات: التثبّت من عبارات وكلمات القول المنسوب لمفسِّر أو عالم بحيث يحصل له اليقين التام، أو ما يقاربه بسلامة العبارات والكلمات المنسوبة إليه من تصحيف طرأ عليها، أو تحريف مسَّ حروفها، وإنّ إهمال الناقد لتلك الخطوة يوقعه في إساءة الفهم لأقوال العلماء، وانتقادهم بما ليس فيهم، واتهامهم بما لم يقولوه، وهذا يدير عجلة النقد على صاحبها، ويجعل نقده ساقطًا لا قيمة له. وقد لقيَتْ هذه الخطوة عناية من ابن عطية؛ إِذْ لم يغفلها ساعة نظره وتعامله مع أقوال المفسِّرين، وإنما جعل مجرّد الشك في حصول تصحيف أو تحريف في الأقوال المنقولة سبيلًا لتبرئة المفسِّرين من الخطأ، وتنزيه ساحتهم من الانتقاد؛ إِذْ نسبة الخطأ إلى تصحيف الناقل أَوْلَى من نسبته لقول القائل.
ففي قوله تعالى: ﴿وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ﴾[البقرة: 203]، قال ابن عطية: «وأمَر الله تعالى عباده بذكره في الأيام المعدودات؛ وهي الثلاثة التي بعد يوم النحر وهي أيام التشريق، وليس يوم النحر من المعدودات، ودلّ على ذلك إجماع الناس على أنه لا يَنفِر أحد يوم القَرَّ[37]،وهو ثاني يوم النحر؛ فإنّ يوم النحر من المعلومات، ولو كان يوم النحر في المعدودات لساغ أن يَنفِر مَن شاء متعجلًا يوم القَرِّ؛ لأنه قد أخذ يومين من المعدودات، وحكى مكي والمهدوي عن ابن عباس أنه قال: المعدودات هي أيام العشر، وهذا إمّا أن يكون من تصحيف النَّسَخَة، وإمّا أن يريد العشر الذي بعد يوم النحر، وفي ذلك بُعد»[38]؛ ففي هذا المثال قدّم ابن عطية ببيان المراد بالأيام المعدودات، ثم نفى أن يكون يوم النحر منها؛ معللًا ذلك بإجماع الناس على عدم جواز النَّفْرِ يوم القَرِّ؛ إِذْ لو كان يوم النحر من الأيام المعدودات لجاز النَّفْرُ يوم القرّ؛ لقوله تعالى: ﴿وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾[الـبقرة: 203]. ولمّا كان ظاهر الآية وإجماع العلماء يدلّ على ذلك، فقد وجد ابن عطية في القول الذي حكاه مكي والمهدوي عن ابن عباس أن المعدودات هي أيام العشر ما يخالف ظاهر الآية وإجماع العلماء، ووقوع ذلك من ابن عباس مستبعَد؛ ولذا وجّه ابن عطية قول ابن عباس باحتمالين ينزِّهان ساحة ابن عباس من الانتقاد والخطأ:
أولهما -وهو ما مال إليه-: أن يكون الخطأ من النُّسّاخ الذين كتبوا قول ابن عباس، فصحَّفوا قوله: «المعلومات» إلى لفظة «المعدودات»؛ لاشتباههما وتقاربهما حروفًا ونطقًا؛ فأصل قول ابن عباس: «المعلومات هي أيام العشر»، فصُحِّفَت إلى «المعدودات»، ونسبة الخطأ إلى تصحيف النُّسّاخ أصحّ من نسبة ابن عباس لمخالفة ظاهر القرآن وإجماع العلماء؛ إذ مثل هذا الخطأ مستبعَد وقوعه من الحبر البحر.
ثانيهما -وهو ما استبعده-: أن يكون ابن عباس أراد بالعشر المعلومات العشر التي تلي يوم النحر.
ومن الأمثلة على ذلك أيضًا:
ما ذكره ابن عطية عند قوله تعالى: ﴿وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ﴾[يوسف: 88]، حيث ذكر أقوال المفسرين في معنى ﴿مُزْجَاةٍ﴾، ثم قال: «وحكَى مكّي أنّ مالكًا -رحمه الله- قال: المزجاة؛ الـجائزة»[39].
قال القاضي أبو محمد: «ولا أعرف لهذا وجهًا، والمعنى يأباه، ويحتمل أنْ صُحِّف على مالك، وأن لفظه بالحاء غير منقوطة وبالراء»[40]،فقد نقل حكاية مكّي لقول مالك في معنى ﴿مُزْجَاةٍ﴾، وأنه فسَّرها بالجائزة، ثم علق ابن عطية بأنه لا يعرف لها وجهًا، وأن المعنى يأبى أن يكون مرادهم أن بضاعتهم جائزة مقبولة؛ لكون القصة والسياق يدلان على اعتذارهم من نقص بضاعتهم وخِسَّتها، وإذا كان الأمر كذلك فبعيد أن يفسِّر الإمام مالك تلك اللفظة بهذا التفسير الذي يجافي السياق وظاهر الآيات، فأشار ابن عطية إلى احتمال وقوع التصحيف، وأنّ الإمام مالكًا -رحمه الله- لم يقل: جائزة؛ بالجيم والزاي، وإنما قال: حائرة؛ بالحاء والراء، ومعنى الحائرة أنها لا خير فيها[41]، فَتُصُحِّفَت «الحائرة» بـ(الجائزة) عند نقل قول الإمام مالك؛ لتشابه حروفهما.
ولا شك أنّ احتمالَ التصحيف قوي، وحَمْل الخطأ عليه أَوْلَى من تخطئة الإمام بدون برهان بيِّن، أو دليل واضح، وقد أشكل قول مالك هذا على ابن العربي أيضًا، وتوقَّف في فهم المراد منه[42].
2- التثبت من سلامة قول المفسِّر من اختلاط الناقل:
ومن صور اختلاط الناقل التي أشار إليها ابن عطية:
أ-أن يختلط على الراوي آية بآية؛ لوجود تشابه بينهما في بعض ألفاظهما، فيحمل تفسير المفسِّر على الجميع، أو على الآية التي لم يقصد المفسِّر تفسيرها.
ومن الأمثلة البديعة على ذلك: ما ذكره ابن عطية عند قوله تعالى:
﴿قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ﴾[الأنعام: 58]، قال: «وقوله تعالى: ﴿قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي﴾ الآية، المعنى: لو كان عندي الآيات المقترَحة، أو العذاب على التأويل الآخر؛ ﴿لَقُضِيَ الْأَمْرُ﴾، أي: لوقع الانفصال وتم التنازع... وقال بعض الناس: معنى ﴿لَقُضِيَ الْأَمْرُ﴾، أي: لذُبِـحَ الموت. قال القاضي أبو محمد: وهذا قول ضعيف جدًّا؛ لأن قائله سمع هذا المعنى في قوله تعالى: ﴿وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ﴾]مريم: 39[، وذَبْحُ الموت هنا لائق، فنقَلَه إلى هذا الموضع دون شَبَه، وأسند الطبريُّ هذا القول إلى ابن جريج غير مقيَّد بهذه السورة، والظنُّ بابن جريج أنه إنما فسَّر الذي في يوم الحسرة»[43].
فقد بَيَّن أن المراد بقوله تعالى: ﴿لَقُضِيَ الْأَمْرُ﴾ ظهور الآيات أو نزول العذاب، ثم ذكر قولًا عن بعض الناس: أنّ المراد بقضاء الأمر ذبحُ الموت، ثم صرّح بضعفه مبينًا أنّ سبب تضعيفه خطأ الراوي في نقل كلام المفسِّر، وإدراجه تحت آية غير الآية التي فسّرها؛ فقد اشتبهت عليه لفظة: ﴿لَقُضِيَ الْأَمْرُ﴾ في سورة الأنعام بلفظة: ﴿قُضِيَ الْأَمْرُ﴾ في سورة مريم، فأدخل تفسير المفسِّر لموضع مريم تحت موضع الأنعام لتشابه الجملتين، ثم بيَّن ابنُ عطية أنّ تفسير قضاء الأمر بذبحِ الموت هو اللائق بموضع سورة مريم، وأن جلالة قدر ابن جريج، وسعة علمه، تستوجب إحسان الظنّ به، وعدم تخطئته بمثل هذا الخطأ الذي لا يتوقع صدوره من مثله لظهور شناعته، وفرط غرابته.
ب-ومن صور اختلاط الناقل -أيضًا-: أن يختلط عليه اسم رجل قصَدَ المفسِّر ذِكْره باسم رجل آخر لم يذكره المفسِّر فيجعل هذا مكان ذاك. ففي قوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ﴾[يس: 77]؛ قال ابن عطية: «هذه الآية قال فيها ابن جبير: إنها نزلت بسبب أن العاصي بن وائل السهمي جاء إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- بعظم رميم ففَتَّه، وقال: يا محمد؛ مَن يحيي هذا؟ وقال مجاهد وقتادة: إن الذي جاء بالعظم النخر أميّة بن خلف، وقاله الحسن وذكَرَه الرماني.
وقال ابن عباس: الجائي بالعظم هو عبد الله بن أُبيّ ابن سلول. قال القاضي أبو محمد: وهو وهمٌ ممن نسبه إلى ابن عباس؛ لأن السورة والآية مكية بإجماع؛ ولأنّ عبد الله بن أُبيّ لم يجاهر قط هذه المجاهرة، واسم «أُبيّ» هو الذي خلط على الرواة؛ لأنّ الصحيح هو ما رواه ابن وهب عن مالك، وقاله ابن إسحاق وغيره، من أنَّ أُبيّ بن خلف أخا أمية بن خلف هو الذي جاء بالعظم الرميم بمكة ففتَّه في وجه النبي -صلى الله عليه وسلم- وحياله، وقال: مَن يحيي هذا يا محمد؟...»[44].
فقد بَيَّن ابن عطية وَهْم مَن نسَب لابن عباس القول بنزولها في عبد الله بن أُبيّ ابن سلول، وبَيَّن أنّ من أسباب وَهْمِه حصول الاشتباه لديه بين (أُبيّ بن خلف) و(عبد الله بن أُبيّ) فنسَب لابن عباس القول بنزولها في (عبد الله بن أُبيّ)، مع أن الصحيح نزولها في (أُبيّ بن خلف)، وكان سبب الاشتباه وحصول الوَهْم لدى الناقل الاشتراك بين الرجلين في اسم (أُبَيّ).
وهكذا يظهر حرص ابن عطية على عدم تخطئة مفسِّر إلا بعد استيفاء قوله لشروط التخطئة وانتفاء موانعها عنه؛ ضبطًا للأمور ووضعًا لها في نصابها، وتمييزًا للمخطئ من المصيب، وبيانًا للمنهج الأمثل في التعامل مع الأقوال. ويظهر جليًّا أثر تفطُّن ابن عطية لتلك الدقائق، وخبرته بتلك المسالك في استكشاف موطن الخطأ، وتحديد سببه، وتعيين فاعله، وبيان أثره، ونحو ذلك مما يحفظ للعلماء مقامَهم، ولأقوالهم حُرمتها، ويُظهِر أمانة الناقد وتحرّزه من العجَلة والطيش، ويصون صناعة النقد من تطرُّق الهوى والميل، ويبرز عمق النقد ووعورة طريقه ودقّة موازينه وتشعُّب مسالكه، وغير ذلك مما يُسهِم في صيانة حِمَى النقد من تسَوُّر المتسوّرين، وتطفُّل المتطفلين، وتقحُّم[45] غير المتأهلين.
الأصل الخامس: التثبت من موافقة قول المفسِّر لمنهجه ومعتقده قبل انتقاده:
ينبغي على الناقد الحاذق قبل انتقاد أقوال العلماء والحكم بخطئهم التثبتُ من موافقة الأقوال المنسوبة إليهم لمعتقداتهم، واتفاقها مع مناهجهم، والتئامها مع طرقهم في التفسير، وعدم خروجها عن الإطار العام لِما عُرف عنهم في تلك الجوانب؛ فإنْ وقَفَ على ما يخالف معتقدهم ومنهجهم ولم يجد له تأويلًا سائغًا ولا مخرجًا صحيحًا؛ فبراءتهم منه أَوْلى من اتهامهم به؛ إِذْ مجافاة تلك الأقوال لأصولهم العامة ومناهجهم المعروفة كافٍ في تضعيف نسبتها إليهم، أو إلصاقها بهم.
وقد كان ابن عطية -رحمه الله- ينهج ذلك النهج في التعامل مع تلك الأقوال التي اتسمت بهذه السِّمات؛ فكان ينتقد نسبتها إليهم، ويضعف صحتها عنهم، ويَعُدّ ذلك افتراءً عليهم، ومجافيًا للمعروف من معتقدِهم ومنهجهم، ويجعل مجرّد تلك المخالفة كافية في تنزيه ساحتهم عن مثلها. ففي قوله تعالى: ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ﴾[فاطر: 10]، نقَل ابن عطية اختلاف أهل العلم في مرجع الضمير في لفظة ﴿يَرْفَعُهُ﴾ وكان مما أورد قوله: «وقال ابنُ عباس وشهرُ بن حوشب ومجاهد وقتادة: الضمير في ﴿يَرْفَعُهُ﴾ عائد على (الكَلِم) أي أنّ العمل الصالح هو يرفع الكَلِم. قال القاضي أبو محمد: واختلفت عبارات أهل هذه المقالة، فرُوي عن ابن عباس: أن العبد إذا ذكَر الله وقال كلامًا طيبًا وأدّى فرائضه ارتفعَ قوله مع عمله، وإذا قال ولم يؤدِّ فرائضه رُدّ قوله على عمله، وقيل: عمله أَولى به. قال القاضي أبو محمد: وهذا قول يردُّه معتقد أهل الحقّ والسُّنة، ولا يصح عن ابن عباس، والحقّ أن العاصي التارك للفرائض إذا ذكر الله تعالى وقال كلامًا طيبًا؛ فإنه مكتوب له متقبّل منه وله حسناته وعليه سيئاته، والله تعالى يتقبل مِن كلّ مَن اتقى الشِّرك، وأيضًا فإنّ (الكلم الطيب) عمل صالح»[46]، فقد أبانَ ابنُ عطية في هذا المثال عن منهجه الذي أسلفتُ، ففهم من القول المنسوب لابن عباس -في كون العمل الصالح يرفع الكلم الطيب- أنّ مَن تكلم بالكلام الطيب مع تأدية الفرائض رُفـِع قولُه وعملُه، ومَن تكلم بالكلام الطيب مع تركِ الفرائض رُدّ قولُه وعملُه، ثم بيَّن أنّ ذلك يخالف معتقَد أهل السُّنة؛ ولذا صار لزامًا على ابن عطية بناءً على منهجه النقدي أن ينزِّه ساحة ابن عباس من هذا القول أو يبيِّن وجهته، وهو ما فعله حيث قال: «ولا يصح عن ابن عباس»[47]؛ لاستحالة أن يفسِّر ابن عباس كتاب الله بما يخالف معتقَد أهل السُّنة؛ ولذا فالأقوال المنسوبة إليه مما يدلّ على مخالفته لمعتقَد أهل الحقّ تنادِي على نفسها بالبطلان، وتوجِب على الناقد ردَّها وبيان تهافتها عند تعذُّر تأويلها والتماس تخريج صحيح لها. ومن أمثلة ذلك أيضًا: ما ذكره ابن عطية عند قوله تعالى: ﴿وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا﴾[الأنعام: 59]، قال: «وحكَى النقّاش عن جعفر بن محمد قولًا أنّ (الورقة) يُراد بها السّقْطُ من أولاد بني آدم، و(الحبّة) يُراد بها الذي ليس بسقطٍ، و(الرَّطب) يُراد به الحيّ، و(اليابِس) يُراد به الميت. وهذا قول جارٍ على طريقة الرموز، ولا يصح عن جعفر بن محمد رضي الله عنه، ولا ينبغي أن يُلتفَت إليه»[48]. فقد نقَل ابن عطية حكاية النقاش لقول غريب عن جعفر بن محمد فيه تفسير للآية بخلاف ما يدلّ عليه ظاهرها وتدلّ عليه معاني ألفاظها، وبإشارات ورموز لم تجرِ العادة عند المفسِّرين باستعمالها؛ فكان هذا وحده عند ابن عطية كافيًا في الحكم بعدم صحة هذا القول عن جعفر بن محمد، وبيان براءته منه ومجانبته لمنهجه وطريقته في التفسير التي هي طريقة الأئمة المعتبَرِين[49].
الأصل السادس: التماس التأويلات التي يمكن تصحيح الأقوال عليها:
إنّ المعاناة التي يعانيها الناقد المتجرِّد المنصِف الحريص على صيانة الثروة التفسيرية والعلمية من الإهدار والنقص، لا يعرف مقدارها إلا من عايشها، وسلك دروبها المتسعة وآفاقها الممتدة؛ متضلعًا بمسئولياتها العريضة، ومستوعبًا لتبعاتها الثقيلة وأمانتها الكبيرة، وقد يُتاح لمن اقترب من النقاد وعايشهم، وعكف على تراثهم متأمّلًا متبصرًا متعلمًا =الاطلاع على شيء من تلك المعاناة وإدراك بعض جوانبها.
وإنّ المعاناة الحقيقية ليست في مجرّد الحكم النقدي الذي يطالعه القارئ في كلمتين، وإنما هي في ذلك الحكم، وما سبقه من مراحل وخطوات أوصلت إليه؛ فإنّ أمانة النقد تقتضي أن لا يردّ الناقد الأقوال إلا بعد تعذُّر قبولها، واستحالة تصحيحها، بحيث يجعل جُلّ اهتمامه منصبًّا على التماس مخارج صحيحة لأقوالهم، وطاقات فِكره مستنفذة في البحث عن تأويل سائغ لآرائهم؛ فينكشف له في كثير من الأحيان ما كان خافيًا، وينجلي له ما كان غامضًا، فيَقبل كثيرًا مما ردَّه غيرُه، ويصحّح أقوالًا طالما خطّأَها سواه، وتلك حقًّا هي المعاناة، وما أمتعها من معاناة! وقد أَوْلى ابن عطية هذا الجانب من التوجيه عناية كبيرة واهتمامًا بالغًا، فكنتَ تراه بين الأقوال كأنه في ميدان قتال؛ يجلِّي غوامضَها، ويُظهِر كوامنَها، ويوجِّه مشكلها، ويدفع الاعتراضات عنها، يتلمس التأويلات التي تصحح وجهتها، ويعدّد الاحتمالات التي تحتملها، ويبيِّن المخارج التي تتخرَّج عليها، يدافع عن كلّ قول كأنه قائله، ويُبرِز مقصده كأنه صاحبه، آبيًا أن يفرِّط في قول منها ما لم تقوَ رماح الانتقاد الموجهة إليه، أو تكثر سهام التخطئة المصوَّبة عليه.
وقد انطلق ابن عطية في منهجه هذا من عدّة ثوابت؛ منها:
1) توجيهه لقول المفسِّر بتخريجه على الأكثر الغالب:
كان مِن أهمّ الثوابت التي اعتمدها ابن عطية في توجيه الأقوال =بيانُ أن المفسِّر لم يقصد التخصيص ولا حصر المعنى فيما فَسَّر؛ وإنما خرج تفسيره مخرج الأكثر الغالب.
مثال ذلك: ما ذكره ابن عطية عن عليّ بن أبي طالب -رضي الله عنه- في المراد من: ﴿أَرْذَلِ الْعُمُرِ﴾[الحج: 5]، فقد قال: «والردّ إلى أرذل العمر هو حصول الإنسان في زَمَانة[50] واختلال قوة؛ حتى لا يقدر على إقامة الطاعات، واختلال عقل؛ حتى لا يقدر على إقامة ما يلزمه من المعتقدات، وهذا أبدًا يلحق مع الكِبَر، وقد يكون ﴿أَرْذَلِ الْعُمُرِ﴾ في قليل من السِّن بحسَب شخصٍ ما لحقته زَمَانة، وقد ذكر عن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه: ﴿أَرْذَلِ الْعُمُرِ﴾ خمس وسبعون سنة، وهذا فيه نظر، وإن صح عن عليّ فلا يتوجه إلا أن يريد على الأكثر»[51].
فقد ذكر ابن عطية المراد بأرذل العمر، ثم ذكر قولًا عن عليّ -رضي الله عنه- أنّ أرذل العمر يكون ببلوغ خمس وسبعين سنة، ولمّا كان الصواب أنّ هذا الوصف يتعلّق بأحوال وتغيّرات تطرأ على الإنسان، ولا يرتبط بسِنٍّ معيّن؛ فقد بيَّن ابن عطية أنّ هذا يُشْكَل على قول عليّ رضي الله عنه، لكنه التمس لقوله تأويلًا يتخرّج عليه -إن صح ثبوت القول عنه- وذلك أن يكون مراده ذِكر السنّ الذي يكثر ويغلب فيه حدوث هذا الوصف، لا التفسير الكامل للوصف -أرذل العمر- ولا حصر معناه فيما فسّر.
2) بيان احتمال اللفظة المفسَّرة لمعنى يستقيم عليه كلام المفسِّر:
ثراء اللغة العربية سِمة من أهم السِّمَات التي تتميز بها تلك اللغة، وهذا الثراء لا يختصّ بجانب منها دون جانب؛ بل هو شامل لألفاظها وجُمَلها وتراكيبها المختلفة، «فاللغة العربية واسعة الألفاظ والمعاني؛ ففيها المشترك الذي يحمل أكثر من معنى، سواء كان ذلك في المفردات أو التراكيب، وسواء كانت المعاني متضادة أو غير متضادة، وفيها التعبير المرِن الفضفاض الذي تتعدّد احتمالاته لسبب أو لآخر، وفيها ما يدلّ على المراد بالمنطوق وما يدلّ بالمفهوم، وفيها العام والخاص، وغير ذلك مما يحتاج إلى فهم وإتقان؛ فهي أوسع من غيرها وأفصح»[52].
وقد جاء القرآن فزادها ثراء ومرونة واتساعًا؛ إذ جاءت ألفاظه حاملة لصور متعددة من المعاني، وتراكيبه قابلة لصور متنوعة من التأويلات، وهو الذي عبّر عنه الصحابي الجليل أبو الدرداء- رضي الله عنه- بقوله: «إنك لن تفقَه كلَّ الفقه حتى ترى للقرآن وجوهًا»[53]. وفهم المفسِّر لتلك القضية يفتح له أبوابًا واسعة من توجيه الأقوال، وتشقيق المحتملات والتماس التأويلات للأقوال التي يتسارع الكثير إلى ردّها.
وقد كان وَعْيُ ابن عطية بهذه القضية وفهمه لأصولها من أهم الأمور التي أسَّس عليها منهجه في نقد الأقوال؛ فقد اعتنى ببيان المحتملات التي تحتملها ألفاظ الآية، وتصحيح ما يتوافق منها، وربما تأوَّل بعضُ المفسِّرين الآية على معنى من المعاني أو نازلة من النوازل، فيذكر ابن عطية من الاحتمالات ما يوافق تأوُّلَه، وربما فَسَّر مفسِّر الآية بخلاف ما يلوح من ظاهرها، فيصحّح ابن عطية ما يدلّ عليه ظاهرها، ثم يبيِّن احتمال الكلام للمعنى الآخر، وإمكان قبوله على أنه أحد المحتملات، أو يردّه عند تعذُّر قبوله.
ففي قوله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ﴾[البقرة: 207]، قال ابن عطية: «و﴿يَشْرِي﴾ معناه: يبيع، ومنه: ﴿وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ﴾[يوسف: 20]... ومن هذا تَسمَّى الشُّراة، كأنهم الذين باعوا أنفسهم من الله تعالى. وحكى قوم أنه يقال: شَرى بمعنى اشترى، ويحتاج إلى هذا مَن تأوَّل الآية في صهيب؛ لأنه اشترى نفسه بماله، ولم يبعها، اللهم إلا أن يُقال: إنَّ عَزْم صهيب على قتالهم بيعٌ لنفسه من الله تعالى، فتستقيم اللفظة على معنى باع»[54].
فقد بيَّن ابنُ عطية أنَّ ﴿يَشْرِي﴾ معناها يبيع، واستدلّ على صحة ذلك المعنى، ثم نقل عن قوم أنهم فسّروا شَرى باشترى، وذكر أنّ تفسير شَرى باشترى إنما يحتاجه مَن جعل الآية في حق صهيب -رضي الله عنه- لأنه لمّا أدركه المشركون أثناء هجرته افتدى نفسه بماله، فكان صنيعه هذا شراءً لنفسه، فأمّا من يقول إنّ ﴿يَشْرِي﴾ بمعنى باع؛ فلا يستقيم قوله مع القول بنزول الآية في حادثة صهيب إلا بنوع تأوُّل، وهو ما أشار ابن عطية إليه بقوله: «اللهم إلا أن يقال: إنَّ عَزْم صهيب على قتالهم بيعٌ لنفسه من الله تعالى؛ فتستقيم اللفظة على معنى باع»[55].
وهنا نرى أنّ ابن عطية تأوَّل عَزْم صهيب -رضي الله عنه- على قتال المشركين بيعًا لنفسه من الله، توجيهًا للقول بنزولها في صهيب -رضي الله عنه- وبيانًا لكيفية استقامة ذلك.
والمتأمّل في هذا المثال يظهر له مدى دقّة ابن عطية في الإمساك بدفَّة التوجيه، وتملُّكه لزمامه؛ إِذْ وجَّه القول، وسوَّغ قبوله على كِلا الاحتمالين اللذَيْن يحتملهما لفظ (شَرَى)[56].
3) التماس قيد يصحّح به كلام المفسِّر:
يبذل الناقد قُصارى جهده في فهم الأقوال، واستيعاب مقاصد قائليها، ومعرفة ما احتفّ بها، والتماس تأويل لها تُصحَّح بمقتضاه؛ وذلك تحاشيًا للوقوع في شِراك تخطئة ما يمكن تصحيحه، وردّ ما يمكن قبوله.
ومما يدخل في ذلك الباب أن يأتي كلام المفسِّر مطلقًا فيقيّده الناقد، أو يرى الناقد بعد تكرار النظر أن المفسِّر لم يقصد الإطلاق، ولكنه ساق تفسيره في مقام معيَّن، أو في حادثة بعينها، أو في ظرف تاريخي معيّن، أو قصَد به حالًا من الأحوال، أو طائفةً من الطوائف، أو ركَنَ إلى معرفة السائل أو السامع بمقصده، وغير ذلك من القرائن التي توجب تقييد ما أطلقه المفسِّر.
ولم يُغفِل ابنُ عطية ساعة توجيهه للأقوال مثلَ ذلك الأمر، بل أعطاه حظًّا من عنايته ونصيبًا من فِكره، وأزال به ما اعترض بعض إطلاقات المفسِّرين من إشكالات، والتمس قيودًا لها يصححها على ضوئها، ويقبلها بمقتضاها.
ومن الأمثلة على ذلك: ما ذكره ابن عطية عند قوله تعالى: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ﴾[آل عمران: 106]؛ فقد قدَّم ابن عطية ببيان أنّ قوله تعالى: ﴿بَعْدَ إِيمَانِكُمْ﴾ يقتضي أنّ لهؤلاء المخاطبين إيمانًا متقدمًا، ثم ذكر اختلاف أهل العلم في تعيين هؤلاء ثم قال: «ورُوي عن مالك أنه قال: الآية في أهل الأهواء. قال القاضي: إن كان هذا ففي المُجَلِّحين[57] منهم القائلين ما هو كفر»[58]، فقد أورد عن مالك أنّ الآية في أهل الأهواء، وقوله هذا مشكِل؛ لأنّ أهل الأهواء لم يصدر منهم كفر بعد سبق إيمان، وهنا تتدخَّل حاسة ابن عطية النقدية لتبيِّن أنه ليس مقصود مالك أهل الأهواء عامة، وإنما المراد مَن كابرَ وعانَد الحقّ، وقال بالكفر منهم، فيصدق فيمن هذا حالهم أنهم كفروا بعد إيمانهم، وعلى هذا يتوجَّه قول مالك ويظهر مراده.
4) بيان ما يلزم من قول المفسِّر أو ما يؤول إليه:
لكلّ قول معانٍ يتضمّنها، ونتيجة يؤول إليها، ولوازم تترتب عليه، وإنَّ نقد الأقوال دون معرفة لوازمها، والتفطُّن لمآلاتها ونتائجها، والتبصُّر بما استبطنته ألفاظها، وطوَته كلماتها تجرؤٌ على النقد، ودخولٌ إلى ميدانه من غير بابه، وتجاسرٌ على أصوله الثابتة ودعائمه القائمة؛ إذ الحكم على الشيء فرعٌ عن تصوُّره[59]، وما النقد إلا حُكم؛ فمَن تمّ تصوّره للأقوال صح -في الغالب- حُكمه، ومَن قَصُرَ تصوّره قَصُر حُكمه.
وإذا كان الناقد حاكمًا فإنّ مِن المتعيّن عليه -قبل إصدار حكمه- معرفة لوازم الأقوال ومآلاتها عند اتفاقها أو اختلافها؛ فلازم الأقوال قد يصحّح وهمًا، أو يزيل لبسًا، أو يبين خطأً لغويًّا أو شرعيًّا أو تاريخيًّا أو واقعيًّا، أو يخصّص عامًّا، أو يدلّ على فائدة، أو ينبّه على بطلان ما تُوُهِّم صحته، أو صحة ما ظُنَّ خطؤه؛ ولهذا فالبصر به ومعرفته يحفظ الناقد من انتهاك حُرَم الأقوال دون مسوِّغ نقدي، أو التعدي على بنات الأفكار دون برهان قوي.
ولذا اجتهد ابن عطية -رحمه الله- في تسليط أشعة الفكر على ما طوَته عبارات المفسِّرين واستبطنته ألفاظهم، فوقف في محراب أقوالهم متأملًا متعلِّمًا، فنطقت له إشاراتهم، وتكلّمت بين يديه إيحاءاتهم، وانكشفت له مقاصدهم، وبانت له أغراضهم؛ فعايَن مآلات أقوالهم، ولوازم آرائهم، وبيَّن آثارها ونتائجها.
فمِن أمثلة ما كان معرفة لازمه مبينًا صحّته بعد تَوَهُّم خطئه: ما ذكره ابن عطية عند قوله تعالى: ﴿وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ﴾[البقرة: 109]؛ فقد أوردَ عن ابن عباس أنّ المراد بـ: ﴿كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ﴾ ابنا أخطب: حُيَيّ وأبو ياسر.
ولا شك أن هذا القول ظاهره مشكِل؛ إذ اللفظة تعطي أنّ كثيرين من أهل الكتاب يتمنون أن يرتد المسلمون عن دينهم، وتفسير ابن عباس يخالف ذلك؛ فقد فسَّر الكثير المنصوص عليه في الآية أن المراد به رجلان اثنان، والكثير لا يُطلق على اثنين.
وقد علق ابن عطية على هذا القول بتعليق بديع نفيس وجيز، أزال به الإشكال، وبيَّن به مراد ابن عباس -رضي الله عنه- فقال: «وفي الضِّمْن الأتْبَاع؛ فتجيء العبارة متمَكّنة»[60]، وهو تعليق في غاية النفاسة يدلّ على صفاء الفطرة النقدية، ودقّة النظر عند ابن عطية؛ فقد أدرك -رحمه الله- ببصيرته النقدية أنّ ابن عباس -رضي الله عنه- لم يُرِد تفسير الكثير باثنين، ولا حصره في هذين الرجلين؛ وإنما أراد الدلالة بمن ذَكر على من لم يَذكر، والاستغناء بذِكر السادة عن ذِكر تابعيهم، ولمّا كان حُيَيّ بن أخطب وأخوه أبو ياسر قادةً لليهود وسادةً، اكتفى ابن عباس بذِكرهما عن الإشارة للجميع؛ إذ مِن لازمِ فعلِ الكُبَراء لأمرٍ أو محبتهم له، اتّباع مَن وراءهم لهم غالبًا.
ومن أمثلة ما أبان لازمه خطأ تعميمه وضرورة تخصيصه:
ما ذكره ابن عطية عن قتادة في تفسير قوله تعالى: ﴿وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا﴾[آل عمران: 83]، حيث قال: «قال قتادة: الإسلام كرهًا هو إسلام الكافر عند الموت والمعاينة، حيث لا ينفعه. قال الفقيه الإمام: ويلزم على هذا أنّ كلّ كافر يفعل ذلك، وهذا غير موجود إلا في أفراد»[61]. فبصيرة ابن عطية النقدية لمّا تبصَّرَت بلازم قول قتادة، انكشف لها خطأ تعميمه، ووجوب قصره وتخصيصه على بعض أفراده، وأظهرت أن قائله لو أراد التعميم لنَطق بخلاف الواقع، وقال بخلاف المُشاهَد، بخلاف ما إذا قصَرَ قوله على بعض الأفراد، وخصّصه ببعض الأحوال؛ صح حينئذ قوله، وظهرت وجاهته.
ومن أمثلة ما اختلف المفسِّرون فيه فاختلف لازم أقوالهم:
ما ذكره ابن عطية في المراد من (الفتنة) عند قوله تعالى: ﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ﴾[الأنفال: 39]؛ حيث قال: «والفتنة: قال ابن عباس وغيره: معناها: الشرك، وقال ابن إسحاق معناها: حتى لا يُفتَن أحد عن دينه كما كانت قريش تفعل بمكة بمَن أسلم؛ كبلالٍ وغيره، وهو مقتضى قول عروة بن الزبير في جوابه لعبد الملك بن مروان، حين سأله عن خروج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من مكة مهاجرًا... وقال الحسن: حتى لا يكون بلاءٌ، وهذا يلزم عليه القتال -في فتن المسلمين- الفئة الباغية، وعلى سائر ما ذكرناه من الأقوال يكون المُعتزِل في فسحة، وعلى هذا جاء قول عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-: أمّا نحن فقد قاتلنا حتى لم تكن فتنة، وأمّا أنت وأصحابك فتريدون أن نقاتل حتى تكون فتنة. قال القاضي أبو محمد: فمذهب ابن عمر أنّ (الفتنة) الشرك في هذه الآية، وهو الظاهر. وفسَّر هذه الآيةَ قولُ النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أُمِرْتُ أن أُقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله؛ فإذا قالوها عصموا منِّي دماءَهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله)[62]. ومن قال: المعنى: حتى لا يكون شرك؛ فالآية عنده يريد بها الخصوص فيمَن لا تُقبَل منه جزية، قال ابن سلام: وهي في مشركي العرب»[63].
ففي هذا المثال نقل ابن عطية قول ابن عباس وغيره في أنّ المراد بالفتنة الشرك، ثم نقل عن الحسَن أن المراد بالفتنة البلاء، ثم بيَّن ما يترتب على كِلا القولين من الأحكام، وما ينبني عليهما من اللوازم؛ فذكر أنّ اللازم على قول الحسن وجوبُ القتال، ولزومه على المسلم في الفتن التي يقع فيها اقتتال بين المسلمين، فيتعيَّن عليه ساعتها قتال الفئة الباغية، ولا يترتب هذا المعنى على قول ابن عباس لكونه فسَّر الآية بالشرك، فيلزم القتال لدفع الشرك، فإذا ارتفع ووقع بين المسلمين فمعتزله والتارك له في فسحة، ولا يلزمه قتال ولا يأثم بتركه.
ثم انتقل إلى بيان أنّ مَن فسَّر الفتنة بالشرك يلزمه تخصيص قوله بمَن لم تُقبَل منه الجزية، فيكون تفسير الفتنة بالشِّرْك عامًّا مرادًا به خصوص من لم تُقبَل منه الجزية.
وهكذا يجول الناقد في لوازم الأقوال ومآلاتها، ويغوص إلى أعماقها مستكشفًا غوامضها، مبينًا خباياها، مميزًا لمتداخلها ومشتبهها بحيث تنكشف له الأقوال، وتتجلَّى أمامه اللوازم، وتتضح أمامه المقاصد، فيحكم عليها حُكم مَن رأى وعايَن، لا حُكم من سمع؛ مما يَطبع نقدَه بطابع القوة والجزالة، ويُبعِد عنه تطرُّق الهوى والميل، فيبقى قائمًا بالقِسط بين الأقوال وحاكمًا بالعدل بين القائلين[64].
5) تكثير المحتمَلات التي تحتملها الأقوال وتوجيهها:
نصّ ابن عطية في مقدمة تفسيره على اعتنائه بذِكْر محتملات الألفاظ، فقال: «واعتمدت تبيين المعاني وجميع محتملات الألفاظ»[65]، وقد وفَّى ابن عطية بما اعتمده فأكثر من ذكر المحتملات التي تحتملها الآية، ولكنه لم يقنع في كثير من الأحيان بمجرّد ذكرها، وأبَى إلا بيان مخارجها وأُسُسِها، والتفنّن في توجيهها.
مثال ذلك: ما ذكره في معنى ﴿دَائِبَيْنِ﴾ من قوله تعالى: ﴿وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ﴾[إبراهيم: 33]؛ فقد قال: «وظاهر الآية أن معناه: دائبين في الطلوع والغروب، وما بينهما من المنافع للناس التي لا تُحصَى كثرة. وحكى الطبريُّ عن مقاتل بن حيان يرفعه عن ابن عباس أنه قال: معناه: دائبَين في طاعة الله، وهذا قول إن كان يُراد به أنّ الطاعة انقياد منهما في التسخير، فذلك موجود في قوله: (سَخَّرَ)، وإن كان يُراد أنها طاعة مقصودة كطاعة العبادة من البشر؛ فهذا جيد، والله أعلم»[66].
فبعد ذِكره لظاهر الآية ذكَرَ قولًا منسوبًا لابن عباس: أنّ الشمس والقمر دائبَين في طاعة الله، ثم بَيَّن أنّ طاعتهما تحتمل أمرين:
الأول: أن تكون طاعة انقياد لا اختيار فيها ولا قصد، وهذا يفيده لفظ (سَخَّرَ) الذي في أول الآية.
الثاني: أن تكون طاعة اختيار وقصد؛ كعبادة البشر.
وقد بيَّن اقتضاء لفظ (سَخَّرَ) للأوّل، وحَكم على الآخر بالجودة.
ومن ذلك أيضًا: ما ذكره عند قوله تعالى: ﴿ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ﴾[الأنعام: 91]، قال: «ثم أمَرَه بتركِ مَن كفرَ وأعرَض، وهذه آية منسوخة بآية القتال إن تَأَوَّلْتَ موادعة، وقد يُحتمل أن لا يدخلها نسخ إذا جُعِلَت تتضمن تهديدًا ووعيدًا مجردًا من موادعة»[67].
فقد أبانَ في هذا المثال عن أثر التوجيه للأقوال في إثبات دعوى النسخ أو دفعها؛ فقد يثبتها توجيه، ويدفعها آخر بحسب ما يترجح لدَى كلّ ناظر؛ فمَن رجَّح في الآية هنا أنها تأمر بموادعة الكفار حتى يشرع القتال =جعلها منسوخة بآيات القتال، ومَن أخرجها عن كونها موادعة، وجعلها خارجة مخرج التهديد والوعيد =لم يحكم بكونها منسوخة[68].
لطائف في التوجيه:
اللطيفة الأولى: أغراض التوجيه:
للتوجيه أغراض كثيرة مهمّة نحاول تلخيصها فيما يأتي:
أولًا: بيان وجهة الأقوال وإبراز الاعتبارات والأُسُس التي اعتمَدَتْ عليها.
ثانيًا: محاولة الوصول إلى مقاصد المفسّرين والوقوف عليها.
ثالثًا: معرفة العِلل التي دفعَت المفسِّر لاختيار قولٍ أو أسلوبٍ معيَّن.
رابعًا: تصحيح الأقوال وبيان وجاهتها، ولكن ليس معنى ذلك ادّعاء التلازم بين الْتِماس التوجيهات للأقوال وقبولها واعتبارها؛ فقد يوجِّه العلماء قولًا مع معرفتهم وتصريحهم بضعفه لبيان وجهة قائله، أو للإشارة إلى إمكان قبوله على مضضٍ[69].
خامسًا: توسيع آفاق البحث والنظر، وتربية ملَكة العقل والفكر.
سادسًا: صيانة الناقدِ نفسَه عن تخطئة قولٍ دون إحاطةٍ بأسبابه ودوافعه ومعرفة محتملاته ومخارجه.
اللطيفة الثانية: توجيه استدلال المفسِّر على قوله:
من لطائف ما وقفتُ عليه من توجيهات ابن عطية؛ توجيهه لاستدلالات المفسِّرين، وبيان كيفية استدلالهم بها.
ومما لا شك فيه أنّ قوّة القول تكمن في قوّة استدلال قائله عليه؛ فإذا قوي استدلاله قوي قوله، والعكس بالعكس، وقد يخفَى وجه الدلالة من القول، فيردُّه مَن تعجَّل النظر، مدَّعيًا ضعف الدليل، أو انعدامه، فيأتي الناقد ليبيِّن وجهة الدليل، ويزيل خفاءه، ويُخرِّج استدلال القائل على الوجه الذي يتناسب مع مقصده وغرضه.
وغاية الناقد في توجيه الاستدلال ليست قبول القول، ولا الحكم بصحّته، وإنما هي بيان وجه الاستدلال ومقصِد المستدِلّ؛ إذ التوجيه ليس حكمًا، وإنما هو مدخل إليه، وتمهيد له ببيانه للقول، وتجليته لمتعلقاته؛ بغية وقوف الناقد على الصورة التامة للقول قبل إصدار نقده والإدلاء بحكمه.
وقد كان لتوجيه الاستدلال حظٌّ مع ابن عطية -رحمه الله- فقد اعتنى باستدلالات بعض المفسِّرين، وبيَّن وجهتها، وحدّد مواطنها، وبيَّن المعاني التي تأسّست عليها، والاحتمالات التي تتوافق معها.
ومن ذلك: توجيهه لاستدلال أبي عليّ الفارسي على ما رجحه في معنى لفظة ﴿السَّمَاءِ﴾ عند قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ﴾[الأنعام: 125]؛ قال ابن عطية: «و﴿فِي السَّمَاءِ﴾ يريد مِن سفلٍ إلى علوّ في الهواء، قال أبو عليّ: ولم يُرِد السماء المظلّة بعينها، وإنما هو كما قال سيبويه: (والقيدود الطويل في غير سماء)[70]؛ يريد في غير ارتفاع صعدًا، قال: ومِن هذا قوله -عز وجل-: ﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ﴾[البقرة: 144]؛ أي: في وجهة الجوّ.
قال القاضي أبو محمد: وهذا على غير مَن تأوَّل تقلُّب الوجه أنه الدعاء إلى الله -عز وجل- في الهداية إلى قِبلةٍ؛ فإنّ مع الدعاء يستقيم أن يقلِّب وجهه في السماء المظلّة، حسب عادة الداعين؛ إذ قد ألِفُوا مجيء النعم والآلاء من تلك الجهة»[71]، فقد نقل ابن عطية قول أبي عليّ الفارسي في أن لفظة السماء لم يُرد بها السماء المظلة بعينها، وإنما أراد الجو الذي يعلو الأرض، وأنّ اسم السماء يقال للفضاء الذاهب في الارتفاع، واستدل على ذلك بقوله تعالى: ﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ﴾[البقرة: 144]؛ أي: في وجهة الجو.
ثم بَيَّن ابنُ عطية أنّ استدلال أبِي عليّ بالآية على أن السماء إنما يُراد بها الفضاء الذاهب في الارتفاع؛ إنما يصح على قول مَن أوَّل تقلُّب الوجه بغير الدعاء، بأنْ يُراد به تحويل الوجه، وترديد العين في جهة السماء، وأن السماء على قوله ستطلق على الجو الذي يعلو الأرض، وليس يصحّ ذلك المعنى على قول مَن تأوَّل تقليب الوجه بأنه الدعاء في الهداية إلى القِبلة؛ لأنه ساعتها يكون مرادًا بها السماء المظلة، بحسب عادة الداعين في ارتفاع أبصارهم إلى السماء.
ففي هذا المثال وجّه ابن عطية استدلال أبي عليّ مبينًا أنه يصح تنزيله على بعض المعاني التي فسَّر بها تقليب الوجه، ولا يصحّ على بعضها الآخر، ولمّا كانت الآية المستدلّ بها محتملة لأكثر من معنى، وكان قول أبي عليّ مؤسّسًا على معنى واحد منها؛ فمِن الخطأ البالغ انتقاد أبي عليّ دون معرفة المحتملات التي تحتملها الآية، وتعيين الاحتمال الذي بنَى عليه استدلاله؛ ولذا حرص ابن عطية على الإشارة لمحتملات الآية، والتصريح بالاحتمال الذي لا يتناسب مع قول أبي عليّ؛ تحديدًا لموطن الاستدلال، وبيانًا لجهته، وإبرازًا لمقصد قائله؛ دفعًا لانتقاده في غير مُنتقَد، أو الطعن عليه بغير مَطْعَن، أو التعجُّل بفهمِ كلامه على غير وجهه.
هذه هي أهمّ المعالم التي أمكن الوقوف عليها والإشارة إليها في توجيه أقوال المفسِّرين، عسى أن تكون مسهمة في تجلية بعض جوانب هذا الموضوع لمَن وفَّقه اللهُ للبحث فيه.
[1] هذه المقالة من كتاب: (الصناعة النقدية في تفسير ابن عطية)، الصادر عن مركز تفسير سنة 1437هـ = 2016م، ص99 وما بعدها. (موقع تفسير).
[2] من مثل قول ابن عطية: «وهذا ضعيف لا وجه له» (1/ 472، سورة البقرة: 196)، وقوله: «ولا وجه لكون (أَمَّرْنَا) من الإمارة» (5/ 454، سورة الإسراء: 16)، وقوله: «ولا وجه لهذا التخصيص» (6/ 374، سورة النور: 30)، (7/ 19، سورة الروم: 24)، وغيرها.
[3] من مثل قول ابن عطية: «ويلتمس وجهه» (1/ 100، سورة البقرة: 1)، وقوله: «ووجهه عندي أنّ موسى عليه السلام» (5/ 637، سورة الكهف: 72).
[4] من مثل قول ابن عطية: «وعليه يتجه قول قتادة: إنّ الفضل الإسلام، والرحمة القرآن»، «ويتجه أيضًا» (1/ 240، سورة البقرة: 64)، «وهذا يتجه على بعض التأويلات التي ذكرناها دون بعض» (2/ 318، سورة آل عمران: 110)، «ولا يتجه أن يكون العبد نوحًا إلا على تحامل في تأويل نسق الآية» (8/ 435، سورة الجن: 19)، وغيرها.
[5] من مثل قول ابن عطية: «أما أن هذه النازلة بعينها يتوجه عندي أن يُقال فيها» (2/ 492، سورة النساء: 16).
[6] من نحو قول ابن عطية: «ولا يجوز أن يكون (ينظرون) هنا من نظر العين إلا على توجيه غير فصيح»، (2/ 279، سورة آل عمران: 88)، وقوله: «والأظهر عندي في توجيه هذا التأويل» (5/ 649، سورة الكهف: 80)، وقوله: «فهذا توجيه فصاحة هذه العبارة» (5/ 651، سورة الكهف: 82).
[7] الهادي بن إبراهيم بن عليّ بن المرتضى الحسني، جمال الدين ابن الوزير، باحث من علماء الزيدية باليمن، أقام بصنعاء، ورحل إلى مكة، تُوفي 1356هـ، من كتبه: كفاية القانع في معرفة الصانع. ينظر: الأعلام (8/ 58)، معجم المؤلفين (13/ 125).
[8] الشوى: الأطراف، وكلّ ما ليس مقتلًا، ويقال: رميت الصيد فأشويته، إذا أصبت شَواه، وهي أطرافه، ورماه فأشواه: أي أصاب شواه، ولم يُصِب مقتله، ثم استُعمل في كلّ مَن أخطأ غرضًا وإن لم يكن له شوًى ولا مقتل. ينظر: معجم مقاييس اللغة (3/ 224)، لسان العرب (4/ 2368) [مادة شوى].
[9] خبطَ خبْطَ عشواء: مثلٌ يُضرب للمتحيِّر الذي يركب رأسه ولا يهتم لعاقبته، كالناقة العشواء التي لا تُبصِر، فهي تخبط بيديها كل ما مرت به. ينظر: لسان العرب (4/ 2960) [مادة عشا].
[10] مقدمة تحقيق كتاب العواصم والقواصم لابن الوزير (1/ 38- 40) بتصرف.
[11] بناء العقل النقدي، ص75.
[12] مجموع الفتاوى (31/ 114).
[13] المحرر الوجيز (4/ 319، 320، سورة التوبة: 41).
[14] المحرر الوجيز (4/ 319).
[15] المحرر الوجيز (3/ 183، سورة المائدة: 48)؛ سقتُ هذا المثال لبيان هذا الأصل من أصول التوجيه بغضّ النظر عن كون الراجح هو قول ابن عطية أو قول الطبري، ولمزيد بيانٍ حول هذا الاستدراك وأيّ الإمامَيْن يرجح قوله يراجع: الدر المصون، للسمين الحلبي (4/ 290). استدراكات ابن عطية على الطبري، د. شايع الأسمري (1/ 550). وينظر أمثلة أخرى حول هذا الأصل في المحرر الوجيز (1/ 339- 341، سورة البقرة: 124)، (2/ 167 سورة آل عمران: 12)، (3/ 279، سورة المائدة: 110)، (4/ 139، سورة الأنفال: 5)، (5/ 105، سورة يوسف: 53)، (5/ 364، سورة النحل: 48)، (5/ 481، سورة الإسراء: 37)، (8/ 607، سورة الفجر: 7).
[16] ينظر: مقدمة شرح الهداية للمهدوي؛ ت: د. حازم حيدر، ص18.
[17] ينظر في بيان هذه الأساليب والكلام عنها: التبيان في أقسام القرآن، ص57. التفسير اللغوي، ص653.
[18] الهداية إلى بلوغ النهاية (12/ 7714، 7715).
[19] والمحارَف هو الذي قد حورف كَسْبه؛ فمِيل به عَنهُ أي ضُيّق عليه. ينظر: جمهرة اللغة )1/ 517). وفي تهذيب اللغة للأزهري (5/ 13) قال الشافعي: المُحَارَفُ: الذي يحترف بيديه قد حرم سهمه من الغنيمة لا يغزو مع المسلمين فبقي محرومًا يُعطَى من الصدقة ما يسدّ حرمانه. اهـ.
[20] المحرر الوجيز (8/ 68).
[21] المحرر الوجيز (4/ 245).
[22] المحرر الوجيز (4/ 270).
[23] ينظر أمثلة أخرى في المحرر الوجيز: (5/ 666 سورة الكهف: 104)، (7/ 483 سورة فصلت: 33)، (8/ 282، سورة الممتحنة: 7).
[24] أي: أدركهم زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، ودَرَك معدول عن أدرك. ينظر: جمهرة اللغة (2/ 637).
[25] المحرر الوجيز (2/ 194).
[26] المحرر الوجيز (8/ 590، 591). وينظر أمثلة أخرى: (5/ 144، سورة يوسف: 90)، (6/ 235، سورة الحج: 25)، (6/ 268، سورة الحج: 62)، (7/ 458 سورة غافر: 78)، (8/ 621، سورة البلد: 10).
[27] المحرر الوجيز (2/ 359).
[28] المحرر الوجيز: (7/ 201، 202) مختصرًا، وينظر أمثلة أخرى في: (2/ 527، سورة النساء: 28)، (3/ 235، 236، سورة المائدة: 83)، (5/ 144، سورة يوسف: 90).
[29] فصول في أصول التفسير، ص83 بتصرف يسير.
[30] المحرر الوجيز (1/ 159، 160).
[31] المحرر الوجيز (1/ 308).
[32] المحرر الوجيز (1/ 308). وينظر أمثلة أخرى في المحرر الوجيز: (1/ 359، سورة البقرة: 135)، (2/ 79، سورة البقرة: 269)، (7/ 222، سورة فاطر: 34)، (7/ 484 سورة فصلت: 34)، (8/ 159، 161، سورة الرحمن: 4)، (8/ 191، سورة الواقعة: 10).
[33] المحرر الوجيز (1/ 519).
[34] المحرر الوجيز (3/ 522).
[35] المحرر الوجيز (3/ 522).
[36] نهاية المطلب، لإمام الحرمين الجويني (9/ 355).
[37] يوم القَر هو ثاني أيام النحر، وسمي بذلك؛ لأن أهل الموسم يوم التروية ويوم عرفة ويوم النحر في تعب من الحج، فإذا كان الغد من يوم النحر استقرّوا بمنى. ينظر: أسنى المطالب في شرح روض الطالب، لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي (1/ 496)، المجموع شرح المهذب، لمحيي الدين بن شرف النووي (6/ 442) (8/ 83).
[38] المحرر الوجيز (1/ 493، 494).
[39] الهداية إلى بلوغ النهاية (5/ 3626).
[40] المحرر الوجيز (5/ 142).
[41] قال في القاموس: «والحائر: المهزول... والحائرة: الشاة والمرأة لا تَشِبَّان أبدًا، وما هو إلا حائرة من الحوائر، أي: لا خير فيه»، القاموس المحيط لمحمد بن يعقوب الفيروزآبادي [مادة حور]، والمعجم الوسيط [مادة حار].
[42] ينظر: أحكام القرآن لابن العربي (3/ 76).
[43] المحرر الوجيز (3/ 375، 376).
[44] المحرر الوجيز (7/ 267).
[45] يقال: فلان يتقحم الأمور: أي يدخل فيها بغير تثبُّت ولا رويّة. ينظر: الزاهر في معاني كلمات الناس لابن الأنباري (2/ 174). النهاية في غريب الحديث والأثر (4/ 36).
[46] المحرر الوجيز (7/ 206).
[47] المحرر الوجيز (7/ 206).
[48] المحرر الوجيز (3/ 377). وينظر أمثلة أخرى: (1/ 183، سورة البقرة: 35)، (5/ 198، سورة الرعد: 17).
[49] البحث إنما يعرض وجهة نظر ابن عطية تجاه الأقوال، ويحلل مراده؛ وإلا فقول جعفر يمكن إدخاله تابعًا للمعنى الأصلي تحت ما اصطلح أهل العلم على تسميته بالتفسير الإشاري بشروطه التي ذكرها أهل العلم. ينظر الكلام عن التفسير الإشاري وضوابطه في: الصواعق المرسلة لابن القيم (2/ 693). البرهان في علوم القرآن (2/ 170). الإتقان في علوم القرآن للسيوطي (6/ 2309). مناهل العرفان (2/ 67).
[50] الزمَانة: العاهة، والمرض الذي يدوم ويطول زمنه؛ فهو مأخوذ من طولِ الزمن، يقال: أزمَن المرض: طال زمانه واتسم بالتكرار، ومنه يقال: مرض مُزمِن، علة مُزمِنة. وكذلك: أزمن الشيء: طال عليه الزمن. ينظر: القاموس المحيط، ص1203. معجم اللغة العربية المعاصرة، د. أحمد مختار (2/ 997).
[51] المحرر الوجيز (6/ 216).
[52] أثر اللغة في اختلاف المجتهدين، ص4.
[53] إسناده صحيح، أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى: (2/ 499). وابن أبي شيبة في مصنفه: (10/ 255، برقم: 30667)، وعبد الرزاق في مصنفه: (11/ 255، برقم: 20473)، من طرق عن أيوب السختياني عن أبي قلابة عن أبي الدرداء.
[54] المحرر الوجيز: (1/ 503).
[55] المحرر الوجيز (1/ 503).
[56] ينظر في ذلك أيضًا: المحرر الوجيز: (5/ 91، سورة يوسف: 42).
[57] المجالح: المكابر، والمجاهر. جالحت الرجل بالأمر: إذا جاهرته به، والمجالحة: المكاشفة بالعداوة والمكابرة. ينظر: تاج العروس من جواهر القاموس (6/ 341) [مادة جلح].
[58] المحرر الوجيز (2/ 314). وينظر أمثلة أخرى: (2/ 114، سورة البقرة: 282)، (6/ 286، سورة المؤمنون: 18).
[59] شرح الكوكب المنير (1/ 50).
[60] المحرر الوجيز (1/ 319).
[61] المحرر الوجيز (2/ 275).
[62] أخرجه البخاري في صحيحه بلفظ «بحقّه» في باب: وجوب الزكاة برقم (1399) وباب: الاقتداء بسنن رسول الله (7284) وغيرهما. وأخرجه مسلم بلفظ «بحقّه» في باب: الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله. برقم (32). وبلفظ «بحقّها» رقم (35)، (36).
[63] المحرر الوجيز (4/ 19). وينظر أمثلة أخرى: (1/ 462، 463)، سورة البقرة: (19)، (6/ 650، 651)، سورة العنكبوت (46).
[64] وينظر أمثلة أخرى في بيان ابن عطية للوازم الأقوال وما يترتب عليها: المحرر الوجيز (5/ 495، سورة الإسراء: 53)، (6/ 287، سورة المؤمنون: 20)، (6/ 314، سورة المؤمنون: 76)، (7/ 75، سورة السجدة: 15)، (8/ 441، سورة المزمل: 3).
[65] المحرر الوجيز (1/ 34). وقضية ذكر المحتمَلات سمة بارزة في تفسير ابن عطية لا تكفيها مثل هذه الإشارة؛ بل تحتاج إلى بحث مستقل، ولكن البحث هنا يشير إلى هذه القضية لتعلقها بنقد الأقوال وبيان ارتباطها به، وأمّا منهج ابن عطية في ذكرها والأصول التي اعتمدها في بيانها فبحث واسع لا يقتضيه المقام.
[66] المحرر الوجيز (5/ 252).
[67] المحرر الوجيز (3/ 417).
[68] ينظر أمثلة أخرى في ذكر الاحتمالات وتوجيهها في المحرر الوجيز: (3/ 170، سورة المائدة: 41)، (3/ 229، 230، سورة المائدة: 80)، (3/ 417، سورة الأنعام: 91)، (4/ 455، يونس: 9).
[69] ينظر أمثلة على ذلك في المحرر الوجيز: (1/ 319، سورة البقرة: 108)، (1/ 359، سورة البقرة: 159).
[70] ينظر أمثلة على ذلك في المحرر الوجيز: (1/ 319، سورة البقرة: 108)، (1/ 359، سورة البقرة: 159).
[71] المحرر الوجيز (3/ 458)، وينظر (3/ 512، سورة الأعراف: 4).
كلمات مفتاحية
الكاتب:

محمد صالح سليمان
دكتوراه في التفسير وعلوم القرآن- جامعة الأزهر، ومدير الشؤون العلمية بمركز تفسير، أشرف على عدد من المشروعات العلمية المنشورة.
مواضيع ذات صلة
((المعلومات والآراء المقدَّمة هي للكتّاب، ولا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع أو أسرة مركز تفسير))