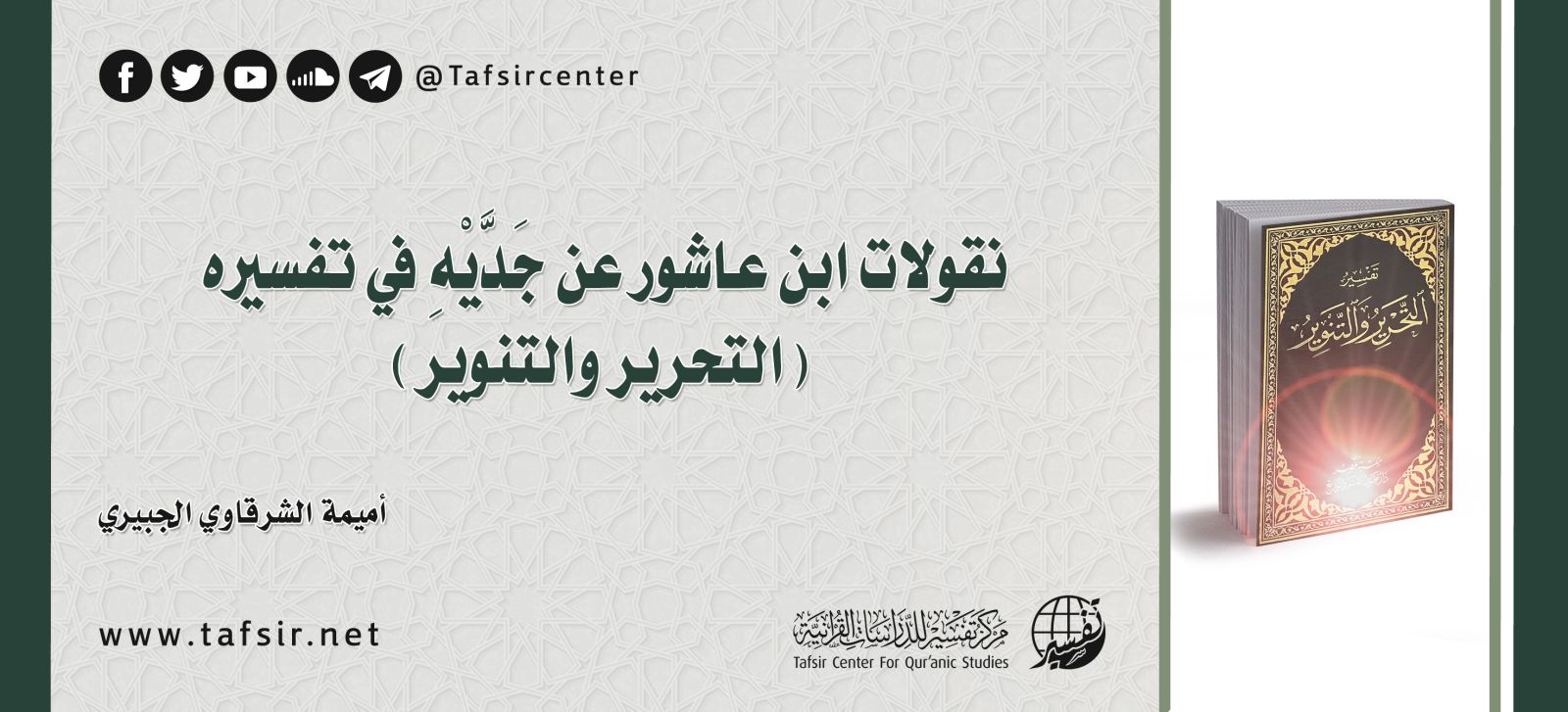سمات ابن عطية ناقدًا؛ من خلال تفسيره (المحرر الوجيز)
من خلال تفسيره (المحرر الوجيز)
الكاتب: محمد صالح سليمان

سمات ابن عطية ناقدًا
من خلال تفسيره (المحرر الوجيز)[1]
المقصود بهذا الموضوع: بيان أبرز السِّمَات والصِّفات التي يلمحها المتأمِّل في شخصية ابن عطية النقدية، بحيث تكون هذه الصفات جليّة واضحة يتحلَّى بها السالكون لدروب النقد، والسائرون في طريقه؛ سواء منها ما ارتبط مباشرة بالنقد أو ما كان لازمًا له أو سابقًا عليه منتلك الصفات، وسأحاول قدر المستطاع إبراز السِّمَات الكلية الكبرى التي تتضمّن الكثير من السِّمَات الفرعية الجزئية.
السمة الأولى: الإخلاص في خدمة التخصّص:
إنّ الإخلاص لله -عز وجل- وابتغاء وجهه أساسُ الإصابة في الأقوال والأفعال، وإذا كان التحلِّي بالإخلاص لازمًا لكلّ مسلم فهو لطالب العلم أشدّ لزومًا، وهو للناقد أشدّ تحتُّمًا؛ فالناقد إذا أخلص لله قَصْدَه، وخلَّص نيّته من الشوائب والأكدار؛ منعه ذلك من تخطئة العلماء دون تبصُّر أو رويّة؛ إِذْ هو لا يتخذ من انتقاد العلماء مَعْـبَرًا يتسلّـقه إلى الشُّهرة، أو سبيلًا يسلكه إلى الرفعة.
وإذا كان الإخلاص أمرًا غيبيًّا لا يطّلع عليه أحد إلا الله، وهو سرٌّ بين العبد وربّه، فإنّ كلامنا عن هذه السمة مخصصٌ بإخلاصِ ابن عطية لتخصصه وتجرُّدِه في خدمة التفسير، فهذا هو القَدْر الذي صرَّح به أو ظهرت آثار تصريحه لنا، وهو الذي يمكننا التأسيس عليه هنا؛ فمَن تأمَّل تفسير ابن عطية، وأدمن النظر في كلامه، وتدبّر صنيعه في كتابه، ونظر إلى بعض نصوصه =أدرك ظهور هذه السِّمَة عنده، ولعلّ كلّ ما سيأتي ذِكْره من سمات ابن عطية النقدية في هذا المبحث مرجعه إلى تلك السِّمة، فهي السِّمة الكبرى التي تتفرّع عنها بقية السِّمات؛ ولذا فإيرادها هنا لا يعني تخصيص نقد ابن عطية بها، بل المقصود أنّ هذه السمة أصلٌ عام في تفسير ابن عطية، ظهر مصداقها في النقد وغيره. والحديث عن تلك السمة عند ابن عطية حديث يطول، ولكني سأكتفي هنا بثلاث نقاط تبين المقصود، ولن أتحدث فيها عن ابن عطية كثيرًا، وإنما سأفسح المجال لابن عطية نفسه ليتحدّث هو عن نفسه.
أولًا: استفراغ الوسع والطاقة في خدمة تفسيره:
لقد سخَّر ابن عطية كلَّ طاقاته وإمكاناته لخدمة علم التفسير وخدمة مصنَّفه فيه، وبلغت عنايته به أنْ جعل تفسيره ثمرةَ وجوده، وهمّه الأوّل في حياته، وعانَى مِن أجلِ تجويده وإتقانه أشدّ المعاناة، وقد حدّثنا عن انقطاعه للتفسير واهتمامه به، فقال: «فلما أردتُ أن أختار لنفسي، وأنظر في علم أُعِدُّ أنواره لِظُـلَمِ رَمْسِي؛ سَبَرْتُها بالتنويع والتقسيم... فوجدتُ أمتنَها حبالًا، وأرسخها جباًلا، وأجملها آثارًا، وأسطعها أنوارًا =علم كتاب الله جلَّت قدرته؛ فثنيتُ إليه عِنَان النظر، وأقطعتُه جانبَ الفِكر، وجعلته فائدةَ العُمر، وما ونيتُ -عَلِمَ الله- إلا عن ضرورة، بحسب ما يلمّ في هذه الدار من شُغُوب، ويمسّ من لُغُوب، أو بحسب تعهُّد نصيب من سائر المعارف»[2].
وقال مبينًا عنايته بتفسيره: «وأنا وإن كنتُ من المقصِّرين؛ فقد ذكرتُ في هذا الكتاب كثيرًا من علمِ التفسير، وحملتُ خواطري فيه على التعب الخطير، وعمرتُ به زَمَنِي، واستفرغت فيه مُنَنِي[3]؛ إِذْ كتاب الله تعالى لا يتفسَّر إلا بتصريف جميع العلوم فيه، وجعلتُه ثمرةَ وجودي، ونخبةَ مجهودي، فليُستصوَب للمرء اجتهاده، وليُعْذَر في تقصيره وخطئه»[4].
ثانيًا: جَعْلُ النفع الأخرويّ هو المعيار في اختيار التخصّص:
لم تكن نظرة ابن عطية للتخصّص في فنّ من فنون العلم نظرة دنيوية قاصرة؛ بل كان النفع الأخروي هو المعيار الذي صرّح بنظره إليه، واعتماده في اختيار التخصّص عليه، وقد بَيَّن ذلك بقوله: «فلما أردتُ أن أختار لنفسي، وأنظر في علم أُعِدُّ أنواره لِظُـلَمِ رَمْسِي[5]؛ سَبَرْتُها[6] بالتنويع والتقسيم... فوجدتُ أمتنها حبالًا، وأرسخها جبالًا، وأجملها آثارًا، وأسطعها أنوارًا =علم كتاب الله جلَّت قدرته، وتقدّست أسماؤه... وأيقنتُ أنه أعظمُ العلوم تقريبًا إلى الله تعالى، وتخليصًا للنيّات، ونهيًا عن الباطل، وحضًّا على الصالحات؛ إِذْ ليس من علوم الدنيا فيَخْتِل[7] حاملُه من منازلها صيدًا، ويمشي في التلطف لها رويدًا، ورجوتُ أنَّ الله تعالى يُـحرِّم على النار فِكرًا عَمَرْتُه -أكثر عمره- معانيه، ولسانًا مَرِنَ على آياته ومثانيه، ونَفْسًا ميَّزَت براعةَ رَصْفِهِ ومبانيه»[8].
ثالثًا: تحقّق أمنيته وإجابة دعوته:
لقد كان التخصّص في علمٍ من العلوم، وإتقان أصوله، وإحكام فصوله، ومعرفة دقائقه، والإلمام بمسائله؛ أمنية تمنّاها ابن عطية ليكون مرجعًا في ذلك العلم، يصدر الناس عن قوله، ويستندون إلى رأيه، وقد حدّثَنا هو عن تلك الأمنية، فقال: «...ثم رأيتُ أنَّ من الواجب على من احتبَى[9]، وتخيّر من العلوم واجتبَى، أن يعتمد على علمٍ من علوم الشرع، يستنفد فيه غاية الوسع، يجوب آفاقه، ويتتبع أعماقه، ويضبط أصوله، ويحكم فصوله، ويلخِّص ما هو منه أو يؤول إليه، ويفي بدفع الاعتراضات عليه؛ حتى يكون لأهل ذلك العلم كالحصن المشيد، والذخر العتيد؛ يستندون فيه إلى أقواله، ويحتذون على مثاله»[10].
وقد حقّق الله له ما تمنَّى؛ فصار ابن عطية عَلَمًا من أعلام المفسِّرين، يرجع الباحثون إليه، ويعتمد المحقّقون عليه على مرّ الأزمنة والعصور، وتوالي الأيام والدهور.
وإذا كنّا نشهد بأعيننا تحقّق أمنيته، فنحن نشهد بأعيننا كذلك إجابةَ دعائه أن يبارك الله فيه وينفع به؛ فقد توجّه ابن عطية إلى ربه داعيًا لتفسيره بالبركة والنفع، فقال: «وأنا أسال اللهَ جَلَّت قدرتُه أن يجعل ذلك كلّه لوجهه، وأن يبارك فيه وينفع به»[11].
السِّمَة الثانية: الأدب الجمّ:
لقد كان الأدب الجمّ سمة من أهم السِّمَات التي اتسم بها نقد ابن عطية؛ فقد كان ناقدًا عفيف اللسان، واسع الصدر، حَسَن الخُلُق، ينتقي ألفاظه، ويَـزِن كلماته، ويتروَّى في اختيار عباراته، وينتقد كلَّ قولٍ بحسب ما يليق به دون شَطَط أو تجاوز.
ومظاهر الأدب في نقد ابن عطية متنوّعة وعديدة، نقتصر منها علىما يأتي:
1) دعاؤه بالرحمة والمغفرة لمن انتقدهم:
كان ابنُ عطية يكثر من الدعاء بالرحمة والمغفرة ساعة انتقاده رأي الإمام أو عالم من العلماء، وأمثلة ذلك كثيرة؛ فمن ذلك: قوله: «وشذّ مجاهد -رحمه الله- فقال: إنّ هذه الآية من قوله: ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ﴾، إلى قوله: ﴿فَضْلٍ عَظِيمٍ﴾ [آل عمران: 173- 174]، إنما نزلَت في خروج النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى بدر الصغرى»[12]. ومن ذلك أيضًا: أنه لمّا ذكر أقوال العلماء في المراد بالمحروم من قوله تعالى: ﴿لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾ [المعارج: 25]؛ قال: «وقال الشعبي: أعياني أنْ أعلمَ ما المحروم، وحكى عنه النقاش أنه قال وهو ابن سبعين سنة: سألتُ عنه وأنا غلام؛ فما وجدتُ شفاء، قال القاضي أبو محمد: يرحم الله الشعبي؛ فإنه في هذه المسألة محروم، ولو أخذه اسم جنس فيمَن عَسُرَت مطالبه بَانَ له، وإنما كان يطلبه نوعًا مخصوصًا كالسائل»[13]، وعند انتقاده لطريقة المهدوي في التفسير قال: «ورأيتُ أنّ تصنيف التفسير كما صنع المهدوي -رحمه الله- مفرِّق للنظر، مشعِّب للفِكر»[14].
ومن ذلك أيضًا قوله في انتقاده قولًا لأبي عليّ الفارسي: «فهذه نزعة اعتزالية، غفر الله له»[15]. وابن عطية بصنيعه هذا يعطي درسًا عمليًّا للسالكين في دروب النقد، الذين تستهويهم الحماسة غير المنضبطة، وتدفعهم العاطفة الملتهبة إلى الانطلاق من قيود الأدب، والتحرّر من عفّة اللسان، فيتحوّل نقدُهُم إلى ميدان قتال وساحة عراك، يكثر فيها السَّبّ واللعن، والنَّـيْل من المخالفين، والانتقاص منهم.
2) تبجيل أهل العلم ومعرفة أقدارهم:
إنَّ الباحث الصادق المخلص لا يعنيه تخطئة العالم بقدر ما يعنيه الوصول إلى الحقّ، فهو طالب للحقّ دائر معه حيث دار -حسب إمكانه وطاقته- ومِن ثَم فإنه لا يتخذ من انتقاده للعلماء أو استدراكه عليهم جسرًا يَعْبُر عليه لتحصيل شهرة، أو سُلَّمًا يتسلّق عليه ابتغاء رفعة، بل مقصده إصابة الحقّ، دون مجاملةٍ للعلماء على حساب الحقّ، ودون مجافاةٍ للأدب معهم ساعة بيانه للحقّ.
وأمّا أدعياء العلم فحالهم كما قال القائل: «رأيتُ أكثر الـمُتحلِّين بالأدب في زماننا هذا على خلاف ما عهدتُ عليه القدماء الماضين والعلماء الأستاذين؛ يطلب الرجل منهم فنًّا من فنون الآداب فيُقسَم له حظّ فيه، وينال درجة منه، فلا يرى اسم العالِـم يتمُّ له، ولا أنّ الرياسة تنجذب إليه إلا بالطعن على العلماء، والوضع من ماضيهم، والاستحقار لباقيهم، ويكثر ذلك على لسانه حتى يكون أجَلَّ فوائده، وأكثرَ ما يمرّ في مجلسه»[16].
وقد كان تبجيلُ أهل العلم وتقديرهم واحترام مكانتهم سمةً ظاهرة في نقد ابن عطية، ونستطيع استجلاء ذلك من خلال ما يأتي:
أ) إحسان الظن بالعلماء:
إحسانُ الظنّ بالعلماء مِن أهمّ ما يجب أن يحرص عليه العلماء، والمتعلِّمون عامة، والنقّاد منهم خاصّة، وهي سمة جليلة لا يتّسم بها إلا من انتفع بعِلْمه، وقد بَيَّن ذلك ابن رجب بقوله: «... وأمّا مَن عِلْمُه غير نافع فليس له شغل سوى التكبُّر بعِلْمِه على الناس، وإظهار فضل عِلْمِهِ عليهم ونسبتهم إلى الجهل وتنقُّصهم ليرتفع بذلك عليهم، وهذا من أقبح الخصال وأرداها، وربما نسب من كان قبله من العلماء إلى الجهل والغفلة والسهو، فيوجب له حبُّ نفسِه وحبُّ ظهورها إحسانَ ظنّه بها، وإساءة ظنّه بمن سَلَف. وأهل العلم النافع على ضدّ هذه؛ يُسِيئون الظنّ بأنفسهم، ويُحسِنون الظَّنّ بِمَنْ سلف من العلماء، ويُقرّون بقلوبهم وأنفسهم بفضل مَن سلف عليهم، وبعجزهم عن بلوغ مراتبهم والوصول إليها أو مقاربتها»[17].
وقد كان ابن عطية على درجة عالية من إحسان الظنّ بالعلماء، والابتعاد عن إساءة الظنّ بهم، وضَرَبَ أروع الأمثلة في ذلك، فلم يتّهِم نواياهم، ولم يُنَقِّب عن خفاياهم. ولم يكن حُسن ظنّه بالعلماء مانعًا له من انتقاد ما ظهر خطؤه من أقوالهم، ورَدّ ما ثبت بطلانه من تفسيرهم؛ لأنه ينتقد الأقوال لا الرجال. وقد نصّ ابن عطية في أول تفسيره على قاعدةٍ سار عليها والتزمها، وهي: أنّ من اشتهر بالمعرفة والعلم، فنُسِبَت إليه أقوالٌ تخالف منهجه، وآراء تجافي طريقته؛ فإنه ينتقد نسبتها إليه وينبّه على ضعفها عنه إحسانًا للظنّ به ودفعًا للباطل عنه، فقال: «وأُثبِتُ أقوالَ العلماء في المعاني منسوبة إليهم، على ما تلقَّى السَّلَف الصالح -رضوان الله عليهم- كتاب الله من مقاصده العربية السليمة مِن إلحاد أهل القول بالرموز، وأهل القول بعلم الباطن وغيرهم، فمَتى وقع لأحد من العلماء الذين قد حازوا حُسن الظن بهم لفظٌ ينحو إلى شيء من أغراض الملحدين نبَّهتُ عليه»[18].
وقد طبّق ابن عطية تلك القاعدة في مواطن كثيرة من تفسيره، نقتصر منها على ما ذكره عند قول الله تعالى: ﴿أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا﴾ [الرعد: 17]، قال ابن عطية: «رُوي عن ابن عباس أنه قال: قوله تعالى: ﴿أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً﴾ يريد به الشرعَ والدِّين، وقوله: ﴿فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ﴾ يريد به القلوب؛ أي أخذ النبيل بحظّه، والبليد بحظه. قال القاضي أبو محمد: وهذا قول لا يصحّ -والله أعلم- عن ابن عباس؛ لأنه ينحو إلى أقوال أصحاب الرموز»[19].
ب) إعذاره للمفسِّرين:
لقد كان ابن عطية وغيره من النقّاد على وعيٍ كاملٍ ويقينٍ تامّ بقاعدتين مهمّتين في باب النقد، تأسّس عليهما اعتذاره عن المفسِّرين وغيرهم من أهل العلم:
القاعدة الأولى: أنه لا عِصْمة لعالِـم -مهما كَثُر عِلْمه- من الخطأ.
القاعدة الثانية: أنه ليس في أهل العلم الثقات من يتعمّد الخطأ.
وهذا يعني أنّ «مهمة الناقد غربلة الآثار لا غربلة أصحابها، والناقد الذي لا يميز بين شخصية المنقود وبين آثاره الكتابية ليس أهلًا لأن يكون من حاملي الغربال»[20]، وقد كان ابن عطية في نقده قائمًا بحقّ العلم، وبحقّ العلماء؛ فأمّا حقّ العلم فبانتصاره لأصحِّ الأقوال وأقومِها وردّه لباطلِ الأقوال وأرذلها، وأمّا حقّ العلماء فالاعتذار لهم عمّا صَدَر منهم من أقوال باطلة لم يتعمّدوها، وآراء فاسدة لم يعصموا من الوقوع فيها.
ومما يجدر ذِكْره:
1- أنّ إعذار ابن عطية للمفسِّرين، ليس تسويغًا لقبول أقوالهم المنتقَدة، ولا إدخالًا لها في دائرة القبول بعد ثبوت ضعفها؛ وإنما هو بيان لما يمكن الإعذار به لهم في قولهم بتلك الأقوال.
2- لم يكن إعذار ابن عطية لهم لإيجاد مَـخْرَجٍ، أو تَلَمُّس عُذْرٍ؛ وإنما كان إعذاره مستندًا إلى مسوِّغات مقبولة، وعِلل معقولة؛ فمنها:
الاعتذار بعدم بلوغ الحديث للمفسِّر:
تتوقف صحّة التفسير أحيانًا على البيان النبوي للآية المفسَّرة، بحيث يقع الخطأ في تفسيرها ممن جَهِلَ بيانَ النبي -صلى الله عليه وسلم- لها، وبدهي أنَّ المفسِّر المعروف بالعلم والأمانة لا يتعمّد ترك حديث النبي -صلى الله عليه وسلم- المفسِّر للآية ويَعْدِل عنه إلى قوله ورأيه؛ ولذا كان الأجدر بالناقد في مثل تلك الحال الاعتذار عن المفسِّر بكون الحديث لم يبلغه، وهو ما فعله ابن عطية؛ ومن الأمثلة على ذلك: ما ذكره ابن عطية في تفسير قوله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: 230]؛ فقد بَيَّن أنّ جماهير العلماء، مجمِعون على أنّ المراد بالنكاح في الآية الوطء لا العقد، لحديث: (حتى يذوقَ عُسَيْلتَكِ وتذوقي عُسَيْلتَه)[21]، ثم قال: «ورُوي عن سعيد بن المسيّب أنّ العقد عليها يُحِلُّهَا للأوّل؛ وخُطِّئ هذا القول لخلافه الحديث الصحيح، ويتأوّل على سعيد -رحمه الله- أنَّ الحديث لم يبلغه»[22].
الاعتذار بعدم قصْدِ المفسِّر للخطأ:
ومِن الأمثلة على ذلك: ما ذكره عند قوله تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ﴾ [النحل: 9]؛ قال: «معناه: لَـخَلَقَ الهدايةَ في قلوب جميعكم ولم يَضِلّ أحدٌ، وقال الزجّاج: معناه: لو شاء لعَرَضَ عليكم آيةً تضطركم إلى الإيمان والاهتداء. قال القاضي أبو محمد: وهذا قول سوءٍ لأهل البدع الذين يرون أن الله لا يَـخلُقُ أفعالَ العباد، لم يُـحصِّله الزجّاج ووقع فيه -رحمه الله- عن غير قصد»[23].
ومن ذلك أيضًا: ما ذكره ابن عطية عند قوله تعالى: ﴿وَلَوْ شِئْنَا﴾ [السجدة: 13]؛ قال: «أخبَر تعالى عن نفسه أنه لو شاء لهدى الناس أجمعين، بأن يَلْطُفَ بهم لطفًا يؤمنون به، ويخترع الإيمان في نفوسهم. هذا مذهب أهل السنّة. وقال بعض المفسِّرين: تُعرَض عليهم آيةٌ يضطرهم بها إلى الإيمان. قال الفقيه الإمام القاضي: وهذا قول بعض المعتزلة؛ إلّا أنَّ مَن أشرنا إليه من المفسِّرين لم يَدْرِ قدرَ القول ولا مغزاه؛ ولذلك حكاه»[24].
الاعتذار للمفسِّرين عامة في استخدامهم بعض الألفاظ ببيان أنّ لها وجهًا:
قال ابن عطية: «اعلم أنّ القصدَ إلى إيجاز العبارة قد يسوقُ المتكلِّمَ في التفسير إلى أن يقول: خاطَب الله بهذه الآية المؤمنين، وشرَّفَ الله بالذِّكر الرجلَ المؤمن مِن آل فرعون، وحكى الله تعالى عن أُمّ موسى أنها قالت...، وقد استعمل هذه الطريقة المفسِّرون والمحدِّثون والفقهاء. وذكر بعض الأصوليين أنه لا يجوز أن يقال: حكى الله، ولا ما جرى مجراه. قال القاضي أبو محمد عبد الحق: وهذا على تقرير هذه الصفة له وثبوتها مُستعمَلة كسائر أوصافه تبارك وتعالى، وأمّا إذا استعمل ذلك في سياق الكلام والمراد منه حَكَت الآية أو اللفظ، فذلك استعمال عربي شائع وعليه مشى الناس، وأنا أتحفَّظ منه في هذا التعليق جهدي؛ لكني قدّمتُ هذا الباب لِما عسى أن أقع فيه نادرًا، واعتذارًا عمّا وقع فيه المفسِّرون من ذلك»[25].
الثالثة -من سماته النقدية-: التأهُّل العلمي:
«التأهُّل العلمي مهمّ للناقد في فنِّه؛ ليتمكن من الحُكم على الأقوال وتمييز الصحيح من الضعيف، فقد تلتبس المناهج والأقوال على مَن لم يكن مؤهلًا علميًّا، وتخفى عليه الأهداف والتوجّهات»[26]، ومرونة الناقد ودقّة فهمه وسعة أفقه في التعامل مع الأقوال مبنية على قوّة التأهل العلمي؛ فكلّما ازدادت قوّته العلمية، ازداد نقده قوةً ودقةً وعمقًا. والتأهُّل العلمي كان مِن أهمّ السمات التي وَضَعَت ابن عطية في مصافّ النقّاد الكبار في علم التفسير، وجعلَتْ نقده في غايةٍ من القوّة والعُمْق والدِّقة.
والحكم على ابن عطية بتأهُّله العلمي إنما هو حكم العلماء والمؤرِّخين الذين شهدوا له بالإمامة وسعة الاطلاع وغزارة العلم وجودة الذِّهْن، ويكفينا هنا قولُ ابن فرحون المالكي عن ابن عطية: «كان القاضي أبو محمد عبد الحق: فقيهًا، عالمًا بالتفسير والأحكام والحديث والفقه والنحو واللغة والأدب، مقيِّدًا حَسَنَ التقييد، وكان غايةً في الدهاء والذكاء، والتهمم بالعلم[27]، ساري الهمة في اقتناء الكتب»[28]. وقد حدّثَنا ابنُ عطية نفسُه عن مراحل تأهُّله العلمي، ومعاناته الشديدة في تحصيل العلوم الشرعية عامة، والتفسير خاصّة، كما سبق نقله[29].
ومن مظاهر التأهُّل العلمي عند ابن عطية في نقده:
الاستدراك على كثير من الأئمة في فنون العلم المختلفة:
استدرك ابن عطية على كثير من الأئمة، وانتقد بعض أقوالهم في القراءات والتفسير واللغة والفقه وغيرها من الفنون، وكانت انتقاداته واستدراكاته محلّ إكبارٍ وتقديرٍ بين أهل العلم؛ فقد استدرك على الطبري، والمهدوي، ومكي بن أبي طالب، والنقّاش، والزجّاج، وأبي عليّ الفارسي، وغيرهم من أهل العلم؛ وهو في انتقاده يقارع الحُجّة بالحُجّة، والبرهان بالبرهان، ويذكر وجه استدراكه، والعلل التي بناه عليها.
معرفته بمذاهب المخالفين وأصولهم وتفطّنه لأقوالهم:
كان ابن عطية خبيرًا بمذاهب المخالِفين، عارفًا بأصولهم، متفطِّـنًا إلى حِيَلِهم، حاذقًا في الكشف عن كثير من أخطائهم وتلبيساتهم، التي تَرُوج على كثير من أهل العلم ممن لا يوافقهم ولم يفطن لمقاصدهم، والأمثلة على ذلك كثيرة؛ منها: ما ذكره عند قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ﴾ [المجادلة: 22]، قال: «...وذهب أبو عليّ الفارسي وغيره من المعتزلة إلى أنّ المعنى: جعلَ في قلوبهم علامات تَعْرِف الملائكةُ بها أنهم مؤمنون؛ وذلك لأنهم يرون العبد يَخلُقُ إيمانه، وقد صرَّح النقّاش بهذا المذهب، وما أُراه إلا قاله غير مُحَصِّل لِما قال، وأمّا أبو عليّ فعن بصرٍ به»[30].
فقد بَيَّن معنى الآية، ثم ذكر معناها عند المعتزلة مبينًا علّة قولهم، ثم بيَّن وقوعَ النقّاش في القول بقولهم دون تنبّه لِما يلزم عليه من موافقته للمعتزلة في أصولهم، ثم بَيَّن بَصَرَ أبي عليّ الفارسي بما قال وتعمُّده للقول به.
الرابعة -من سماته النقدية-: روح الإنصاف:
مِن أهمّ سمات ابن عطية النقدية روحُ الإنصاف التي التزمها في غالب نقده؛ فالإنصاف من أهم دعائم المنهج النقدي، وهي مزاولة الناقد مهمته بتجرُّدٍ قدرَ طاقته؛ فالنقد حُكم والناقد حاكِم، والحكم لا بد أن يكون مبنيًّا على العدل والإنصاف.
ومِن محاسن الإنصاف «أنه يحدّ مِن طغيان الإحساس الشخصي، ويجعل الناقد يفكّر قبل أن يطلق حُكمه، فهو كذلك بمثابة الرقيب على الناقد الذي يَحُول دون التسرع والتناقض والفوضى، ويحمِلُه على أن يوسِّع أفقه فينظر في النصّ الذي إزاءه مليًّا، وينظر إلى الظروف والعوامل الفاعلة، ويمتحن ما يمكن أن يختلج في نفسه ويشتدّ معه»[31].
والنقد حُكم على الآراء والأقوال، والناقد هو المباشر لذلك الحكم والقائم به، ومِن ثَم كان من مقتضيات إعمال القسط وتحكيمه =العدلُ في نقد الآراء، وعدمُ الحَيْفِ على المنتقَد، أو تحريفِ الكَلِم عن مواضعه، أو بترِ المعاني عن سياقها الذي وردَتْ فيه، أو تأويـلِها بعكس مراد القائل، أو تضخيمِ الخطأ وتعظيمه... إلى آخره من صور الظُّلْم التي يقع فيها الناس في نقدهم بسبب الغفلة عن العدل والقسط والإنصاف[32].
ويظهر إنصافُ الناقد بجلاء عند مناقشة الأقوال والموازنة بينها؛ بحيث ينضبط ميزان نقده بمعايير القبول والردّ، ومقاييس الحكم والنقد، فلا يحرِّكه الهوى والتشهِّي إلى مجافاة الحقّ، ولا تعدِل به مذهبيتُه وآراؤه عن الصواب، ولا تدفعه النِّقمة على قول إلى الغلوّ فينقده، والشطط في حُكمه. وقد كان ابن عطية متحلِّـيًا بروح الإنصاف في غالب نقده، منصفًا في أحكامه، بعيدًا عن الميل للهوى، متجردًا للحكم على الأقوال دون تعصُّب لقائل على حساب آخر.
وصور الإنصاف والموضوعية في نقده كثيرة؛ منها:
تفريقه بين مَن تعمَّد الخطأ ومَن وقع منه سهوًا أو جهلًا:
ومن الأمثلة على ذلك:
ما ذكره عند قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ﴾ [المجادلة: 22]؛ قال: «معناه أثبته وخَلَقَه بالإيجاد، وذهب أبو عليّ الفارسي وغيره من المعتزلة إلى أنّ المعنى: جعل في قلوبهم علامات تَعرِف الملائكةُ بها أنهم مؤمنون؛ وذلك لأنهم يرون العبد يَخلُقُ إيمانَه، وقد صرّح النقّاش بهذا المذهب، وما أُراه إلّا قاله غيرَ مُحَصِّل لِما قال، وأمّا أبو عليّ فعن بصرٍ به»[33]. فقد انتقد القول، ثم اعتذر للنقّاش بكونه لم يفطن لِما في القول من تقريرٍ لمذهب الاعتزال؛ دفعًا للتهمة عنه، ثم بيَّن فقه أبي عليّ الفارسي بالقول وبصره به واعتقاده له.
إنصاف المخالفين له في المذهب والمعتقَد:
كان ابن عطية على مقدارٍ كبيرٍ من الإنصاف؛ وأظهرُ دليل على ذلك إنصافُه لمخالِفيه، وسأكتفي هنا بعرض صور من موضوعيته تجاه المخالِفين له في المعتقَد أو المذهب، القائلين ببعض الأقوال المذمومة والآراء المرذولة؛ استغناءً بذِكْر إنصافه لهم عن ذِكْر إنصافه لغيرهم ممن لم يخالفه في معتقَد أو مذهب، وذكرًا لأقوى صور الموضوعية والإنصاف التي ترشد إلى ما عَداها، وتدلّ على ما دونها.
لقد تحلَّى ابن عطية بروح الموضوعية في انتقاده لأقوال مخالِفيه، فلم يجرِّد تلك الأقوال من كلّ ما لا يقتضي الإنصاف تجريده منها، ولم ينفِ عنها احتمالًا تحتمله، أو دليلًا يقوِّيها، أو تأويلًا سائغًا يعضدها، أو صحةَ بعض أوجهها، أو جوازَ بعض صورها، ولم يُلْزِم قائليها بما لا يلزمهم؛ بل كان يبيِّن ما لها وما عليها، وما يصحّ منها وما لا يصحّ، بموضوعية وإنصاف وتجرُّد، وكان رائده في ذلك قول الله: ﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ﴾ [المائدة: 8].
ومن صور إنصافه -رحمه الله- في التعامل مع تلك الآراء المذمومة:
أ) بيان كون القول الفاسد سائغًا في العربية:
لم يمنع فسادُ بعض الأقوال وظهورُ خطئها في بعض جوانبها ابنَ عطية من التصريح بجوازها في لغة العرب، ولم يحجبه ما يعرفه من مكانة العربية وأثرها في تصحيح الأقوال من بيان جواز القول المذموم لغةً؛ لكون اللغة وحدها غير كافية في تصحيح الأقوال واعتبارها، فليس معنى صحة القول لغةً أن يكون صحيحًا في نفس الأمر، وليس معنى عدم صحته لاعتبارات أخرى أن لا يكون سائغًا في العربية؛ بل الحقُّ وسطٌ بين الطرفين؛ ولهذا انتقد ابن عطية بعض الأقوال وبيَّن فسادَها، ثم صرّح بكونها سائغةً في لغة العرب. ومن ذلك مثلًا ما ذكره عن المعتزلة عند قوله تعالى: ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ * إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾ [القيامة: 22- 23]، قال: «...وأمّا المعتزلة الذين ينفون رؤيةَ الله تعالى فذهبوا في هذه الآية إلى أنّ المعنى: إلى رحمة ربها ناظرة، أو إلى ثوابه، أو مُلكه؛ فقدَّروا مضافًا محذوفًا، وهذا وجه سائغ في العربية، كما تقول: (فلانٌ ناظرٌ إليك في كذا)؛ أي: إلى صُنْعِك فيكذا، والرؤية إنما يُثْبِتُها بأدلةٍ قطعية غيرُ هذه الآية؛ فإذا ثبتَتْ حَسُنَ تأويلُ أهل السنّة في هذه الآية وقوِي»[34].
فقد انتقد ابن عطية قول المعتزلة في نفي رؤية الله تعالى، وبَيَّن أنّ تأويلَ أهل السنّة قويّ لتوافقه مع الأدلة الشرعية الثابتة، إلا أنّ انتقاده للمعتزلة لم يمنعه من بيان أنّ تأويلهم للآية المذكورة سائغ في العربية، وذلك أنّ جملة: ﴿إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾ تحتمل لغةً -في رأيه- أنها بمعنى النظر أو بتقدير مضاف محذوف كما قالت المعتزلة؛ إلا أنّ الأدلة من القرآن والسنّة أكّدَت صحة الاحتمال الأوّل في إثبات الرؤية وبطلان قول المعتزلة.
ب) انتقاده إلزام المخالف بما لا يلزم:
مِن الأساليب التي يستعملها بعض النقاد في ممارساتهم النقدية ومساجلاتهم الفكرية =إلزامُ المخالِف بما يترتب على قوله من لوازم باطلة لا يمكنه الإقرار بها ولا التزامها ليتبيّن خطأَ قوله وفسادَ رأيه؛ فيصير مخيَّرًا بين أمرين: التزام تلك اللوازم الباطلة، أو الاعتراف بفساد قوله والتراجع عنه؛ وإنما يكون هذا إذا ثبت التلازم بين ذلك القول وتلك اللوازم، وأمّا إن ثبت الانفكاك وعدم التلازم بينها وبين القول؛ كان هذا إلزامًا للخصم بما لا يلزمه. وإلزام المخالف بما لا يلزمه يأباه المنصفون من النقّاد؛ إِذْ ليست غايتهم منافسة الأقران ولا ظهور الغلَبة والتميّز على المخالفين، وإنما غايتهم القيامُ بالقسط بين الأقوال، ونَصْب ميزان العدل بين الآراء بقبول ما أيّدَتْه الأدلة وعضدته البراهين، وردّ ما خالفها وخرج عن دلالاتها. وقد يقع السهو من الناقد -في غمار انشغاله بالنقد وممارسته له- في إلزام المخالف بما لا يلزمه، فيَضعُفُ نقده للمخالف من تلك الجهة وقد يصحّ من جهات أخرى، فيكون نقده في تلك الحالة مفتقرًا إلى النقد؛ ومن الأمثلة على ذلك:
ما ذكره ابن عطية عند قوله تعالى: ﴿وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا﴾ [المائدة: 88]؛ قال: «والرزق عند أهل السنّة ما صحّ الانتفاع به، وقالت المعتزلة: الرزق كلُّ ما صحّ تملُّكُه، والحرامُ ليس برزقٍ لأنه لا يصحّ تملُّكُه. ويردُّ عليهم بأنه يَلزمُهم أنّ آكِل الحرام ليس بمرزوق من الله تعالى... وردّ أبو المعالي -في الإرشاد- على المعتزلة بأنهم إذا قالوا: الرزق ما تُـمُلِّكَ، فيلزمُهم أنّ ما ملك فهو الرزق، وملك الله تعالى الأشياء لا يصحّ أن يقال فيه إنه رزق له. قال القاضي أبو محمد: وهذا الذي ألزم غير لازم، فتأمّله»[35].
فابن عطية وإن ردَّ على المعتزلة وانتقدهم في تفسيرهم لمعنى الرزق؛ إلا أنه انتقد أبا المعالي في إلزامهم بما لا يلزمهم رغم أنه وافقه في أصل المسألة على انتقاد المعتزلة[36].
تلك هي أهمّ سمات ابن عطية ناقدًا؛ وهي إجمالًا:
الإخلاصُ في خدمة التخصص، وحُسن القصد، مع الأدب الجمّ، والتأهُّل العلمي، محلّى بروح الإنصاف.
كما أسلفتُ؛ فهذه هي السِّمات الكلية الكبرى التي يندرج تحتها كثيرٌ من السمات الجزئية، فحريٌّ بالباحثين وَضْعُها نُصْبَ الأعين والتخلُّق بها أسوةً بالنقّاد واقتفاءً لآثارهم.
[1] هذه المقالة من كتاب (الصناعة النقدية في تفسير ابن عطية)، الصادر عن مركز تفسير سنة 1437هـ= 2016م، تحت عنوان: (سمات ابن عطية ناقدًا)، ص73 وما بعدها. (موقع تفسير)
[2] المحرر الوجيز (1/ 7، 8) باختصار.
[3] الـمُنَن جمع (مُنَّة) بضم الميم؛ والـمُنَّة: القوّة التي بها قوام الإنسان. ينظر: معجم مقاييس اللغة (5/ 267) [مادة: مَنَّ].
[4] المحرر الوجيز (1/ 9، 10).
[5] الرَّمْس: القَبْر. ينظر: تهذيب اللغة (12/ 294) [مادة: رمس].
[6] سَبَرَ الشيءَ سبرًا: حَزَرَه وخَبَرَه، والسَّبْر استخراج كُنْهِ الأمر. ينظر: لسان العرب (4/ 340) [مادة: سبر].
[7] الخَتْل: الخداع، والمخاتلة مَشْي الصياد قليلًا قليلًا في خُفية؛ لئلا يسمع الصيد حِسَّه، ثم جُعل مثلًا لكلّ شيء وُرِّيَ بغيره وسُتِرَ على صاحبه. لسان العرب (2/ 1100) [مادة: ختل].
[8] المحرر الوجيز (1/ 7، 8) باختصار.
[9] الحَبْو: القُرْب والدنوّ، وكل دانٍ حاب، وبه سُمّي السحاب؛ لدُنوِّه من الأفق. انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس (2/ 132) [مادة: حبو]، والمراد هنا: الاقتراب من أصول العلوم والتمكُّن منها.
[10] المحرر الوجيز (1/ 7).
[11] المحرر الوجيز (1/ 9).
[12] المحرر الوجيز (2/ 424) وهذا الدعاء بالرحمة؛ وإن كان محتملًا في بعض المواطن كونه من صنيع النسّاخ مثلًا إلا أن بعض صيغ الدعاء يقوى فيها أن هذا دعاء من ابن عطية نفسه، إضافة إلى ما يؤيده استقراء انتقاده من عفة اللسان والاعتذار للعلماء.
[13] المحرر الوجيز (5/ 368).
[14] المحرر الوجيز (1/ 9).
[15] المحرر الوجيز (2/ 224)، آل عمران (47). وينظر أمثلة أخرى (1/ 567)، البقرة (230)، (1/ 607)، البقرة (240)، (2/ 221) آل عمران (45)، (3/ 140)، يوسف (31).
[16] أخبار أبي تمام، للصولي، ص6.
[17] فضل علم السلف، لابن رجب الحنبلي، ص42.
[18] المحرر الوجيز (1/ 9)، وفي هذا المعنى يقول ابن القيم: «والكلمة الواحدة يقولها اثنان؛ يريد بها أحدهما أعظم الباطل، ويريد بها الآخر محض الحقّ، والاعتبار بطريقة القائل وسيرته ومذهبه وما يدعو إليه ويناظر عليه» اهـ. مدارج السالكين (3/ 521).
[19] المحرر الوجيز (5/ 197، 198). وينظر أمثلة أخرى: (3/ 177)، الأنعام (59)، (7/ 206)، فاطر (10).
[20] الغربال لميخائيل نعيمة، ص10.
[21] صحيح البخاري، كتاب الطلاق، باب: من أجاز طلاق الثلاث، (ح 4960) (5/ 2014). صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب لا تحل المطلقة ثلاثًا لمطلقها حتى تنكح زوجًا غيره ويطأها ثم يفارقها وتنقضي عدتها، (ح 1433)، (2/ 1055).
[22] المحرر الوجيز (1/ 567).
[23] المحرر الوجيز (5/ 332)، وينظر (8/ 258)، المجادلة (22).
[24] المحرر الوجيز (7/ 74).
[25] المحرر الوجيز (1/ 47).
[26] نقد التفسير عند الصحابة والتابعين، ص172.
[27] تهمّم بالعلم؛ أي: تحسّسه وطلبه. ينظر: المعجم الوسيط (2/ 995).
[28] الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، ص276.
[29] المحرر الوجيز، ص8، 9.
[30] المحرر الوجيز (8/ 258).
[31] مقدمة في النقد الأدبي، ص431 بتصرف.
[32] نظرية النقد الفقهي، ص42 باختصار.
[33] المحرر الوجيز (8/ 258).
[34] المحرر الوجيز (8/ 479).
[35] المحرر الوجيز (3/ 239).
[36] ينظر أمثلة أخرى: المحرر الوجيز (4/ 473)، سورة يونس (26)، (8/ 357).
كلمات مفتاحية
الكاتب:

محمد صالح سليمان
دكتوراه في التفسير وعلوم القرآن- جامعة الأزهر، ومدير الشؤون العلمية بمركز تفسير، أشرف على عدد من المشروعات العلمية المنشورة.
مواضيع ذات صلة
((المعلومات والآراء المقدَّمة هي للكتّاب، ولا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع أو أسرة مركز تفسير))