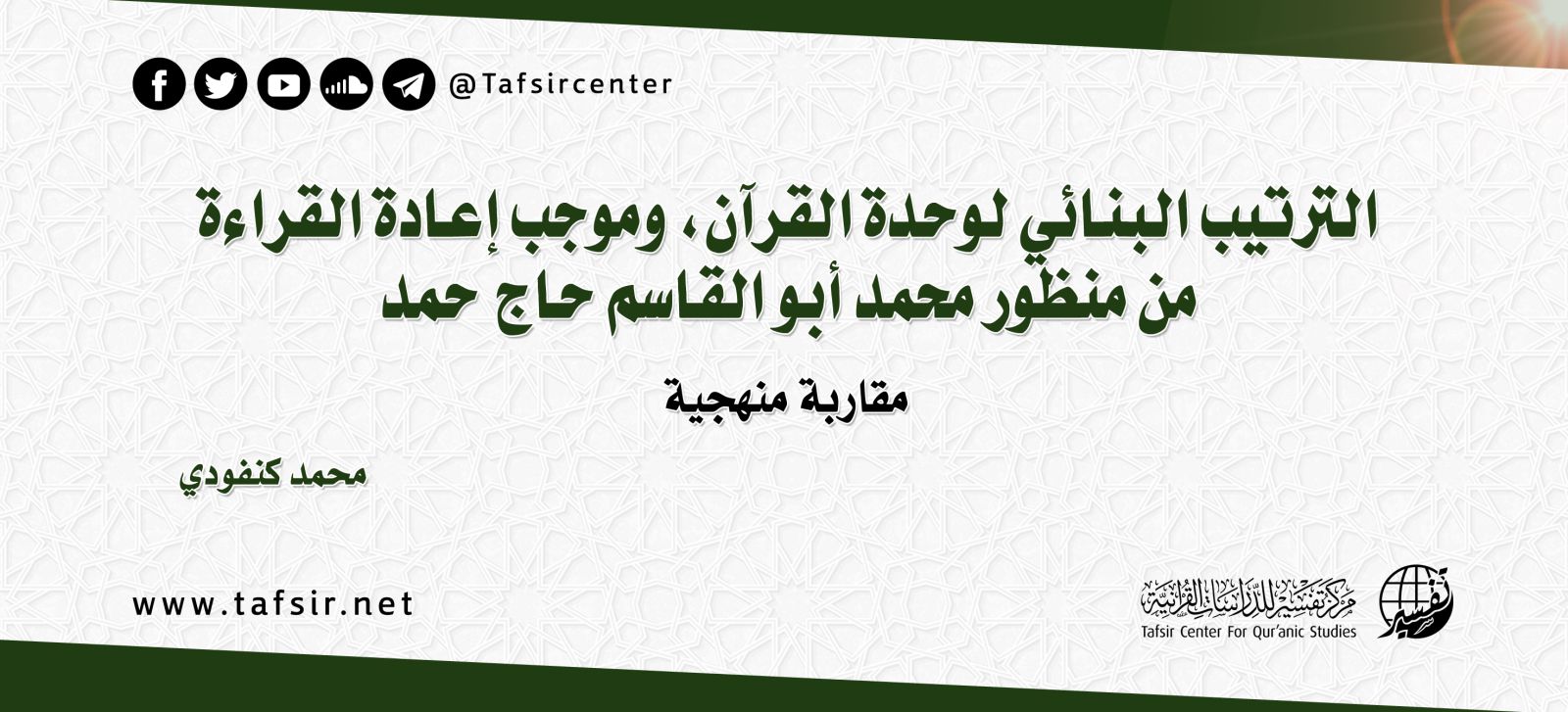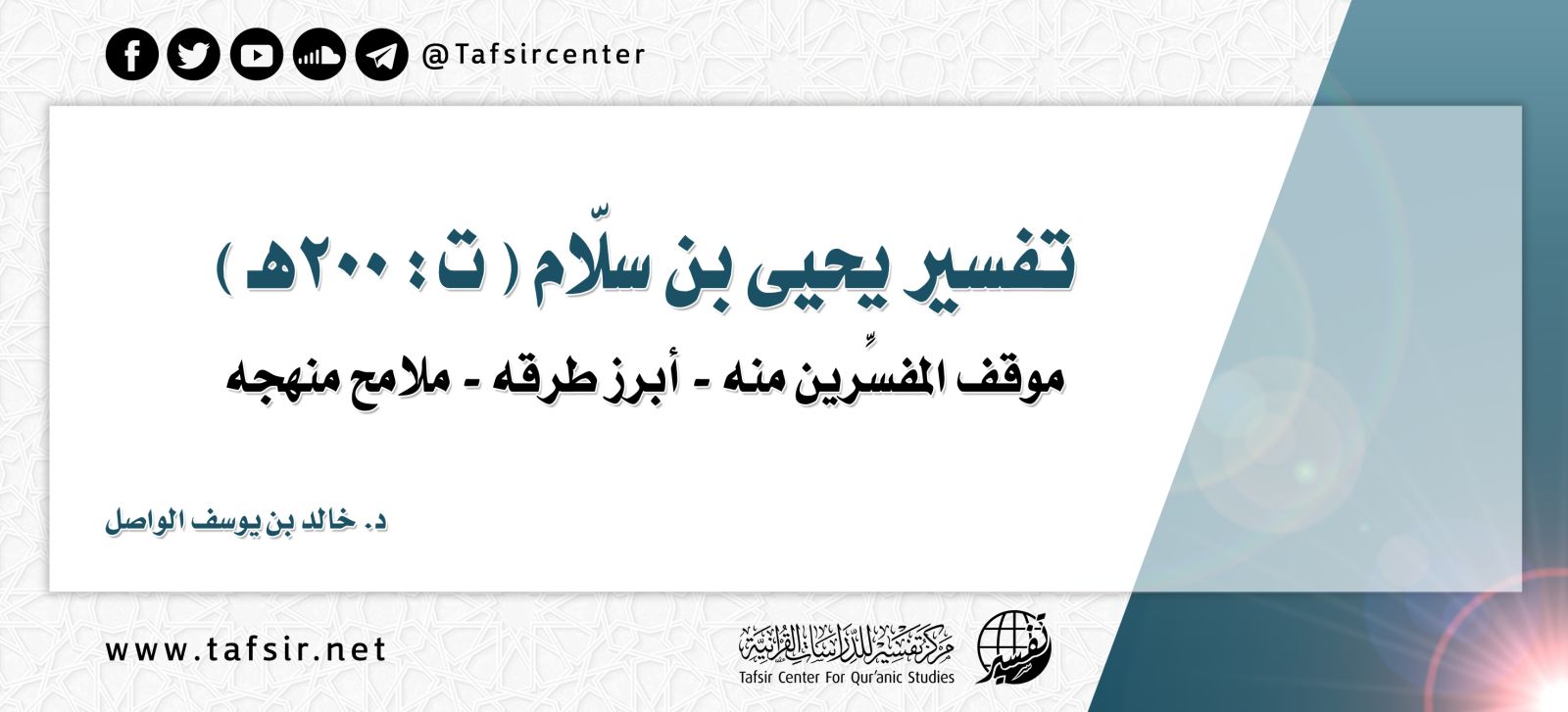سورة العصر؛ معالم منهج حياة متكامل
معالم منهج حياة متكامل
الكاتب: فاطمة الزهراء دوقيه

تقديم:
خلقَ اللهُ تعالى الإنسانَ وميّزه عن سائر خَلْقِه، بما أوكل إليه من مهمّة الاستخلاف في الأرض: ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾ [البقرة: 30]، ومعناها الخلافة عن الله تعالى لتنفيذ أمره وتطبيق منهجه في الحياة، الذي وضعه سبحانه في وحيه ليهدي الإنسان إلى تحقيق حياته السعيدة.
معنى ذلك أنّ وَعْدَ الله تعالى بنيل الإنسان الحياة السعيدة مشروطٌ باتّباع منهجه، مصداقًا لقوله تعالى: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [النحل: 97]، وإلا فقد توعّده -عز وجل- بحياة الشقاء وضنك العيش: ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى﴾ [طه: 124].
وقد خصّ القرآنُ الكريم موضوعَ منهج الحياة الربّاني الموصل إلى الفلاح والنجاة بسورة قرآنية كاملة، حددت معالمه بشكلٍ كامل متكامل، وذلك في سورة العصر التي وضّحت أصول الإسلام الكبرى، ووضعت دستور الحياة الإنسانية[1].
ونتناول في هذا المقال تلك المعالم بعد مقدّمات تعريفية بالسورة وتعريف المنهج.
أولًا: مقدمات تعريفية:
- تعريفٌ بالسورة:
تسمَّى «العصر» كما في مصاحف كثيرة وفي معظم كتب التفسير[2]، كما تسمَّى «والعصر» بإثبات الواو في بعض كتب التفسير؛ كتفاسير: القرطبي، وابن أبي زمنين، والسعدي، والبيضاوي، وفي صحيح البخاري في كتاب التفسير: «سورة (والعصر)»[3]. وعددُ آياتها ثلاثٌ بلا خلاف، وذلك «في جميع العدد، اختلافها آيتان: ﴿وَالْعَصْرِ﴾، لم يعدّهَا المدني الأخير، وعدّها الباقون. ﴿وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ﴾ عدّها المدني الأخير، وَلم يعدّها الباقون»[4]. ولم يرِد لها سبب نزول، فمَثلها كمثل السور والآيات الكثيرة التي أُنزلت عرضًا عامًّا[5].
وهي مكية عند الجمهور، ونُقل أنها مدنية، والأغلب القول الأول؛ لاتّسامها بخصائص المكي وأسلوبه[6]، مِن قصرٍ وإيجاز شديدين، مع قوّة الألفاظ، وإجمال المعاني وكليّـتها، حتى عبّر بعض العلماء عن منحاها الإجمالي، أجمعها قول الشافعي: «لو ما أنزل اللهُ حُجّة على خَلقه إلا هذه السورة لكَفَتْهُم»[7]، وأورده ابن كثير بصيغة: «لو تدبّر الناس هذه السورة، لوسعتهم»[8]، والقول أنها شملت جميع علوم القرآن[9]، وأنها من أجمع سور القرآن للخير بحذافيره[10]، وأنها من أكبر جوامع الكَلِم[11]، وأنها الجامعة لأصول الرسالة[12].
ومن فضائلها أنها من المفصَّل؛ إِذْ رُوي أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (أُعطيتُ مكان التوراة السبع، وأُعطيت مكان الزبور المِئين، وأُعطيت مكان الإنجيل المثاني، وفُضِّلت بالمفصَّل)[13]. ووردَ مِن هَدْي الصحابة -رضي الله عنهم- عن أبي مدينة الدارمي أنه قال: «كان الرجلان من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا التقيا لم يفترقا حتى يقرأ أحدُهما على الآخر ﴿وَالْعَصْرِ * إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ﴾، ثم يسلِّم أحدُهما على الآخر»[14].
أمّا مقصودها العام فهو بيان منهج الله للحياة الإنسانية الموصل إلى الفلاح، المنجي من الخسران؛ فلقد تمثّل فيها المنهج الكامل للحياة البشرية كما يريدها الإسلام[15]. ونعتبر أن تعبيرات بعض المفسّرين عن مقصود السورة تفصّل هذا المعنى وتبيّنه؛ كقول البقاعي: «مقصودها تفضيل نوع الإنسان المخلوق مِن عَلَق، وبيان خلاصته وعصارته، وهم الحزب الناجي يوم السؤال عن زكاء الأعمال بعد الإشارة إلى أضدادهم، والإعلام بما ينجي من الأعمال والأحوال بترك الفاني والإقبال على الباقي؛ لأنه خلاصة الكون ولباب الوجود»[16]. بينما قال ابن عاشور: «اشتملتْ على إثبات الخسران الشديد لأهل الشِّرْك ومَن كان مثلهم من أهل الكفر بالإسلام بعد أن بُلِّغَت دعوتُه، وكذلك مَن تقلّدَ أعمال الباطل التي حذّر الإسلامُ المسلمين منها، وعلى إثبات نجاة وفوز الذين آمنوا وعملوا الصالحات والداعين منهم إلى الحقّ، وعلى فضيلة الصبر على تزكية النفس ودعوة الحقّ»[17].
والسورة جاءت في موقع متناسب مع ما قبلها (سورة التكاثر)، وما بعدها (سورة الهمزة)، حتى ليظهر للمتدبّر أنها موضوع واحد؛ فسورة التكاثر وردَت «في ذِكْر أهل النعيم المنهمكين في التنافس لزخارف الدنيا، وذكر غفلتهم وسوء عاقبتهم، والسورة التالية في تصوير عقاب هذه الطائفة وذلّتها وهوانها، على رغم حبّها للترف والعزّة والفخار. فوضع هذه السورة بينهما بحيث ينبههم على خيبة عملهم وضلال رأيهم، وفي ضمن هذا عرّف لنا خصال المؤمن، وسبيل الفلاح. وكثيرًا ما ترى في القرآن يجمع بين المتقابلين؛ كذِكْر البَرِّ والفاجِر، والجنة والنار، فهكذا ههنا. لم يذكر في السورة السابقة ولا في اللاحقة إلا أهل النار، فأكمل بهذه السورة أسلوبًا عامًّا في القرآن»[18].
* * *
- تعريف المنهج:
المنهج والنهج والمنهاج لغةً الطريق الواضح البيِّن، ونهج الأمر وأنهج: وضح وبانَ، ويُستعمل في كلّ شيء كان بيِّنًا واضحًا سهلًا[19]، وهو مفهوم قرآني أصيل ومركزي، وإن وردَ باللفظ مرّة واحدة في قوله تعالى: ﴿لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾ [المائدة: 48]، تنبيهًا عن وجوده في كتاب الله الموصوف بالمبين والتبيان والهدى والنور، ومعنى الآية: «لكلّ قوم منكم جعلنا طريقًا إلى الحقّ يؤمُّه، وسبيلًا واضحًا يعمل به»[20].
وفي معنى المنهاج والمنهج استخدم القرآن مفاهيم ومفردات عِدّة، أعلاها الصراط المستقيم: ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ [الفاتحة: 6]، وكذلك الصراط السوي: ﴿فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَى﴾ [طه: 135]، ﴿وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ﴾ [ص: 22]، والسبيل الأهدى: ﴿وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا﴾ [النساء: 51]، وسبل السلام: ﴿يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ﴾ [المائدة: 16]، وسبيل الله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا ضَلَالًا بَعِيدًا﴾ [النساء: 167]، وسواء السبيل: ﴿أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ﴾ [البقرة: 108]، وكذا قصد السبيل: ﴿وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ﴾ [النحل: 9]، وغير ذلك مما في معنى إبانة ووضوح الطريق الذي لا يَخشى فيه السائرُ تيهًا أو انحرافًا أو حيرةً أو ضياعًا، بل يشعر بالأمن والاطمئنان إلى أنه بالغٌ غايته، ومدركٌ بغيته، وواصلٌ إلى مراده، ومحقّق سعادته وطيب عيشه[21].
وما هذا المنهاج بمختلف الاصطلاحات إلّا ذلك «الذي رسم القرآن المجيد معالمه وأبانها وأوضحها... فكان القرآن بيانًا ومبينًا ونورًا وهدايةً وصراطًا مستقيمًا، يهدي به الله من اتَّبع رضوانه سبل السلام، ومناهج الاطمئنان والأمن والأمان والعمران والاستقرار»[22].
وعليه، فإنّ المنهج الرباني الكامل للحياة هو هذا الطريق الواضح والصراط المستقيم، الذي وضعه الله -عز وجل- للإنسان متمثّلًا فيما ألزمه به من المبادئ الاعتقادية والتصوّرات اليقينية، وأنواع العبادات التهذيبية، والفضائل الأخلاقية، والقيم العليا في سبيل نهوضه برسالته في الحياة على النحو المرضي لله تعالى[23].
* * *
ثانيًا: معالم منهج الحياة الكامل في سورة العصر:
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
﴿وَالْعَصْرِ * إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ * إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾ [سورة العصر].
جاءت السورة عَرْضًا عامًّا لكلمات الله التي لا تتبدّل: ﴿لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ﴾ [يونس: 64]، يضمّ «حُكمًا ومحكومًا عليه ومحكومًا به: فالحُكم هو ما حكم به تعالى على الإنسان كلّ الإنسان من النقصان والخسران، والمحكوم عليه هو الإنسان ابن آدم، والمحكوم به هو الخسران لمن لم يؤمن ويعمل صالحًا، والربح والنجاة من الخسران لمن آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحقّ وتواصوا بالصبر»[24].
واستخدم له أسلوب القَسَم بعظيم ولعظيم؛ فأقسم بــ: ﴿وَالْعَصْرِ﴾، وهو هذا الزمن ميدان حركة الإنسان ونشاطه، ومجال فعله وسعيه فردًا وجماعةً، وذلك «لِما يقع فيه من اختلاف الأحوال، وتَقَلُّبات الأمور، ومُداولة الأيام بين الناس، وغير ذلك مِمَّا هو مُشاهَدٌ في الحاضر ومُتَحَدَّثٌ عنه في الغابر، فالعصر هو الزمان الذي يعيشه الخَلْق، وتختلف أوقاته شِدَّةً ورخاءً، وحربًا وسِلْمًا، وصِحَّةً ومرضًا، وعملًا صالحًا وعملًا سيِّئًا، إلى غير ذلك مما هو معروفٌ للجميع»[25]. وجواب القسَم: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ﴾؛ فكلّ إنسان خاسر هالك في كلّ أحواله معاشًا ومعادًا، إلا مَن استثناهم الله تعالى بقوله: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾، فهؤلاء هم الرابحون المفلحون في الدنيا والآخرة الناجون من الخُسْرِ؛ لأنهم اتّبعوا هدى الله ومنهجه القويم الذي وضعه لهم.
فالسورة إذًا تقرّر حقيقة كبرى ثابتة تفيد: «أنه على امتداد الزمان في جميع الأعصار، وامتداد الإنسان في جميع الأدهار، ليس هنالك إلا منهج واحد رابح، وطريق واحد ناج، هو ذلك المنهج الذي ترسم السورة حدوده، وهو هذا الطريق الذي تصف السورة معالمه، وكلّ ما وراء ذلك ضياع وخَسار»[26].
وفيما يأتي بيانُ معالمِ هذا المنهج الرباني التي تحددها السورة:
1- قيمة الزمن:
إنّ أوّلَ مَعْلَمٍ للمنهج الإلهي في الحياة الطيبة في السورة، الذي ينبغي الانتباه إليه، والاهتمام به وعيًا وسلوكًا =أوّلُ مذكوراتها؛ الذي أقسم به سبحانه: ﴿وَالْعَصْرِ﴾، وهو الزمان بما هو عُمُر الإنسان الذي يتمتّع به، حيث محلّ فعله وإنجازه؛ دلالةً على عظم شأن فكرة الزمن وعلوّ قيمته، وتوجيهًا إلى العناية به، حتى لا يمضيه فيما لا ينفع من تَوافِه الأمور ومضيعات الأعمار ومسببات الخسران. يؤكّد ذلك الخبرُ المقسَم عليه المُشعر بأهمية محور الوقت وخطورة تضييعه، حين قال سبحانه: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ﴾، حيث حَكم اللهُ بالوعيد الشديد بخسارة الإنسان ونقصانه، إنْ لم ينتفع بعمره الذي يمضي بسرعة ولا يعود، ولن ينفع الندم والتحسّر عليه إنْ فات، «ومجيء هذا الخبر على العموم مع تأكيده بالقسَم وحرف التوكيد في جوابه، يفيد التهويل والإنذار بالحالة المحيطة بمعظم الناس»[27]. وليس خافيًا أن المراد من ذلك أن يدرك الإنسان أنّ عمره هو رأس ماله الذي «كُلِّف بإعماله في فترة وجوده في الدنيا، فهي له كالسوق؛ فإنْ أعمله في خير ربح، وإن أعمله في شر خسر. ويدلّ لهذا المعنى قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ﴾ [التوبة: 111]، وقوله: ﴿هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ * تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ [الصف: 10- 11]»[28].
وإذًا تحدّد سورة العصر عنصر الزمن كأوّل قضية في منهج الحياة بهذا الأسلوب؛ دفعًا إلى الجد والعمل المربح، وتذكيرًا بما أمام الإنسان من مجالٍ للكسب والربح[29]. وإنْ شئنا القول؛ من أجل الاهتداء إلى حلّ أزمَنِ مشكلات الحياة الإسلامية المعاصرة، ألَا وهي مشكلة الوقت، التي خير ما وصفها قول القائل: «وحظّ الشعب العربي الإسلامي من الساعات كحظّ أيّ شعب متحضِّر، ولكن عندما يدقّ الناقوس مناديًا الرجال والنساء والأطفال إلى مجالات عملهم في البلاد المتحضرة، أين يذهب الشعب الإسلامي؟ تلك هي المسألة المؤلمة، فنحن في العالم الإسلامي نعرف شيئًا يسمى (المدة)، ولكنها المدة التي تنتهي إلى عدم؛ لأنّنا لا ندرك معناها ولا تجزئتها الفنية، ولسنا نعرف إلى الآن فكرة (الزمن) الذي يتصل اتصالًا وثيقًا بالتاريخ، وبتحديد فكرة الزمن يتحدّد معنى التأثير والإنتاج، وهو معنى الحياة الحاضرة الذي ينقصنا. هذا المعنى الذي لم نكسبه بعد هو مفهوم الوقت الداخل في تكوين الفكرة، والنشاط في تكوين المعاني والأشياء. فالحياةُ والتاريخ الخاضعان للتوقيت كانَا -وما يزال- يفوتنا قطارهما»[30]. ويرى كاتبنا الحلّ في «توقيت دقيق وخطوات واسعة لكي نعوِّض تأخّرنا. وإنما يكون ذلك بتحديد المنطقة التي ترويها ساعة معيّنة من الساعات الأربع والعشرين التي تمرّ على أرضنا يوميًّا. إنّ وقتنا الزاحف صوب التاريخ لا يجب أن يضيع هباء كما يهرب الماء من ساقيةٍ خربة، ولا شكّ أن التربية هي الوسيلة الضرورية التي تعلِّم الشعب العربي الإسلامي تمامًا قيمة هذا الأمر»[31].
ولا شك أنّ المصدرَ الأول والهادي إلى المنهج الأقوم لهذه التربية في مجتمعاتنا القرآنُ الكريم؛ التربية التي ارتبط تطوّرها بالتزام تعاليمه واتّباع مبادئه ومنهجه، بينما عكست فتراتُ تأخّرها وسلبيتها ضَعْفَ هذا الالتزام، أو عكس ما تقتضيه الهيمنة الروحية للقرآن عليها.
2- قضية الإيمان:
وثاني معالم المنهج الرباني للحياة أوّلُ معيار للربح، وأولُ شرط نجاة الإنسان من الخُسْر؛ أصلُ وأُمُّ كلّ ما سيأتي من قضايا ومسائل، الذي به يحقّق الإنسان أوّلَ مراتب كماله، وهو كمال قوّته العلمية[32]، وذلك في قوله تعالى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا﴾. (الإيمان)، قضية الإنسان الأُولى في الوجود، الذي لا معنى للحياة بدونه، ولا سعادة بغيره. وهو ليس أمرًا هامشيًّا في الوجود، يمكن الاستخفاف به، بل هو أعظم «قضية مصيرية» بالنظر إلى الإنسان. إنه سعادة الأبد أو شقوته، إنه لَجنّةٌ أبدًا أو لَنارٌ أبدًا[33].
بل هو في حقيقته وجوهره «اتصال هذا الكائن الإنساني الفاني الصغير المحدود بالأصل المطلق الأزلي الباقي الذي صَدَر عنه الوجود. ومِن ثَمّ اتصاله بالكون الصادر عن ذات المصدر، وبالنواميس التي تحكم هذا الكون، وبالقُوَى والطاقات المذخورة فيه»[34].
هذا الكائن الإنساني الفاني بغير إيمان هو كريشة في مهبّ الريح؛ لا يعرف استقرارًا ولا سكينةً، ولا يعلم حقيقة نفسه، ولا حِكمة وجوده، ولا غاية حياته، ولا سبب موته بعد حين! بل قلقًا وحيرةً وتيهًا، وحاله كمن وصفه تعالى في قوله: ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا﴾ [الزمر: 29]؛ حيث مَثَّل لإنسانٍ بلا إيمان «في تقسم عقله بين آلهةٍ كثيرين، فهو في حيرة وشكّ مِن رِضَا بعضهم عنه وغضبِ بعضٍ، وفي تردّد عبادته إنْ أرضَى بها أحدَ آلهته، لعلّه يُغضِب بها ضدَّه، فرغباتهم مختلفة... ويبقى هو ضائعًا لا يدري على أيِّهم يعتمد، فوَهْمُهُ شعاع، وقلبه أوزاع =بحالِ مملوك اشترك فيه مالكون لا يخلون من أن يكون بينهم اختلافٌ وتنازُع، فهُمْ يتعاورونه في مهنٍ شتى، ويتدافعونه في حوائجهم، فهو حيرانُ في إرضائهم، تَعبانُ في أداء حقوقهم، لا يستقلّ لحظة، ولا يتمكّن من استراحة»[35].
والمجتمع بلا إيمان يحكمه قانون الغاب، حيث الغلبة للأقوى، لا للأتقى، مجتمع تعاسة وشقاء، وإنْ زخر بكلّ وسائل الرفاهية وجميع أسباب النعيم، لا تتجاوز غايات أهله شهواتهم المادية؛ لأنهم: ﴿يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ﴾ [الروم: 7]. بمقدور عِلمهم أن يهيِّئ لهم وسائل حياتهم، ويرقِّي جانبها المادي؛ فيقلِّص الزمن، ويختصر المسافات الطويلة؛ ولهذا يتردّد أنّ عصرنا «عصر السرعة» أو «التغلب على المسافات»، لكن لا يُسمع أنه عصر «الفضيلة» أو «السعادة والطمأنينة»، ذلك أنّ العلم لا يهديهم إلى غايات حياتهم ومَثلها الأعلى، ولا يصلهم بأعماقها[36]!
وعليه، يظلّ الإيمان «أصل الحياة الكبير، الذي ينبثق منه كلّ فرع من فروع الخير، وتتعلّق به كلّ ثمرة من ثماره، وهو المحور الذي تشدّ إليه جميع خيوط الحياة الرفيعة، وهو المنهج الذي يضمّ شتات الأعمال، ويردّها إلى نظامٍ تتناسق معه وتتعاون، وتنسلك في طريق واحد، وفي حركة واحدة، لها دافع معلوم، ولها هدف مرسوم»[37].
3- العمل الصالح:
لا يكتمل الإيمان إلا بقرينهِ الذي يُظهره ويتمّمه، شرطِ نجاة الإنسان من الخُسر الثاني، وهو في قوله: ﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾، إنه العمل الصالح. وقد عرَّف الله -عز وجل- الإيمان بصورته الكاملة حين وصف المؤمنين مستخدمًا الحصر: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ﴾ [الحجرات: 15]؛ فالإيمان الصادق فضلًا عن كونه تصديقًا قلبيًّا ثابتًا لا شك فيه، لا بد أن ينبثق منه العمل الذي تمثّله هذه الآية في (الجهاد بالمال والنفس في سبيل الله)؛ «فالقلب متى تذوّق حلاوة هذا الإيمان واطمأنّ إليه وثبت عليه، لا بد مندفع لتحقيق حقيقته في خارج القلب، في واقع الحياة، في دنيا الناس، يريد أن يوحّد بين ما يستشعره في باطنه من حقيقة الإيمان، وما يحيط به في ظاهره من مجريات الأمور وواقع الحياة، ولا يطيق الصبر على المفارقة بين الصورة الإيمانية التي في حِسّه، والصورة الواقعية مِن حوله؛ لأنّ هذه المفارقة تؤذيه وتصدمه في كلّ لحظة، ومن هنا هذا الانطلاق إلى الجهاد في سبيل الله بالمال والنفس، فهو انطلاق ذاتي مِن نفس المؤمن، يريد به أن يحقّق الصورة الوضيئة التي في قلبه، ليراها ممثّلة في واقع الحياة والناس، فإذا لم تتحقّق تلك المشاعر في القلب، ولم تتحقّق آثارها في واقع الحياة، فالإيمان لا يتحقّق، والصدق في العقيدة وفي ادّعائها لا يكون»[38]؛ ولذا، يُخشى أن يخرج صاحبه من استثناء الخُسْر.
فالإنسان إذًا، مهما كان متشبِّعًا بالإيمان قلبيًّا، يلزمه أن يعمل العمل الصالح ويتقنه ليحقّق كماله العملي، ثاني مراتب كماله في نفسه[39]، كما أنه «هو عِلّة الخَلْق، ومادة الابتلاء والاختبار، في الدنيا، ومقياس النجاة في الآخرة»[40]، لقوله تعالى: ﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ [الملك: 2].
إنه «بالعمل يحقّق الإنسانُ أصلحَ ما في إنسانيته، وبالعمل يحقّق أصلحَ ما في الكون، الحياة الدنيا مَحكمته الأُولى على ما قدّم من خير أو شر، وحياة الآخرة مَحكمته الثانيــة، ومعيار الحكم في المحكمتين العمل والعمل وحده؛ فبالعمل يتحرّر الإنسان. ولو جاز أن يُوصَف هذا الدين الحنيف بغير دين الاسلام لوُصِف بأنه دين العمل، ﴿وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ﴾ [التوبة: 105]»[41].
ومفهوم العمل الصالح في القرآن عامّ وشامل يمثّل «الترجمة العملية والتطبيق الأكمل للعلاقات التي حدّدتها فلسفة التربية الإسلامية بين الإنسان وخالقه، والكون والحياة، والإنسان والآخرة»[42]، ذلك أن قوله تعالى: ﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾، هو «قول جامع لأشتات الأعمال الحسنة، وهذا ظاهر. ولكن للّفظ دلالة على حِكمة عظيمة: وهي أن الحسنات لمّا سماها الله صالحات، عَلِمَ الإنسانُ بذلك أن فيها صلاح حاله، وقوام أمره في معاشه ومعاده، وأفراده وجماعته، وجسمه وعقله وقلبه. فالعمل الصالح ما به حياة الإنسان ونماؤه حسبما أودع الله في فطرته واستعداد خِلقته. فبه يتم غاية وجوده حتى ينتهي إلى كماله»[43].
ولذا تتنوّع الأعمال الصالحة وتتسع دوائرها، فلا يمكن حصر مفهومها في مجال الشعائر التعبّدية والأعمال الدينية، فقد جاء الهدي الرباني تشريعًا إلهيًّا «يتناول جميع فعاليات الإنسان الدنيوية والأخروية، وجميع وجوه سلوكه من السلوك الروحي إلى السلوك الاقتصادي. إنّ الإنسان القرآني هو كلّ عضوي روحي حيّ. وسلوكه متكامل يهدف وجهة علوية هي السعادة الدنيوية والأخروية»[44]. ثم إنه من خلال استقراء الآيات القرآنية الكثيرة التي تتناول مفهوم العمل الصالح، يمكن تصنيف أنواعه وأشكاله في ثلاثة مظاهر كبرى: «عمل ديني صالح، وعمل اجتماعي صالح، وعمل كوني صالح»[45].
وهكذا، بالعمل الصالح، يرقى الإنسان في سُلَّم كماله، فيحقّق ثاني مراتبه بعد الإيمان، ليستوفي بهما معًا حالة كماله في نفسه والإحسان إليها، وهي الحالة التي يأتمر فيها بأمر غيره[46]. وهذا ما يمثّل بُعده الفردي الذي تناولته سورة العصر، كما نلفاها تتناوله في بُعده الجماعي؛ لتحدّد له معلمًا أساسًا آخر من معالم منهج الله في الحياة، متعلقًا بحالة تكميله لغيره بأن يأمر غيره[47]، وبيانه فيما يلي.
4- التواصي (بالحقّ وبالصبر):
لا يقتصر المنهج الإلهي للحياة على الصلاح الذاتي للإنسان، بل يتعدّاه إلى صلاحه الجماعي، من خلال تكميله غيره بتوصيته وتعليمه الحقّ، وتوصيته بالصبر على العلم والعمل. وهذا ثالث معلم من معالم منهج الله للنجاح في الحياة، والنجاة من الخسران، في قوله تعالى: ﴿وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾، أي: أنْ يأمر المؤمنون بعضُهم بعضًا باتّباع منهج الله الحق الثابت، وبالصبر على مشاقّ إنفاذه في الواقع، ذلك أنّ «الحقّ ثقيل، وأنّ المحن تلازمه؛ فلذلك قرنَ به التواصي»[48].
وقد وردَ التواصي بالحقّ والتواصي بالصبر معطوفًا على عمل الصالحات، وهما منه، «عطف الخاصّ على العام للاهتمام به؛ لأنه قد يُغْفَل عنه، يُظَنّ أنّ العمل الصالح هو ما أثَرُهُ عملُ المرء في خاصته، فوقع التنبيه على أنّ من العمل المأمور به إرشادَ المسلم غيرَه ودعوتَه إلى الحقّ، فالتواصي بالحقّ يشمل تعليمَ حقائقِ الهَدْي، وعقائدِ الصواب، وإراضة النفس على فهمها بفعل المعروف وترك المنكر. والتواصي بالصبر عُطِفَ على التواصي بالحقّ عَطْفَ الخاص على العام أيضًا، وإن كان خصوصه خصوصًا من وجه؛ لأنّ الصبرَ تحمُّلُ مشقةِ إقامة الحقّ وما يعترض المسلم من أذًى في نفسه في إقامة بعض الحقّ»[49].
كما أنّ الحديث عن الحقّ والصبر هو عن جماع الخير كلّه؛ إِذ «الحق يفتح أبواب الخيرات كلّها، والصبر يسدّ عورات الشّر بأجمعها، فالحقّ هو المحبوب، والصبر هو الالتزام به، وبمثل هذا جاء قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا (أي بالصدق) رَبُّنَا اللَّهُ (وهذا قول جامع للإيقان والطاعة، فإنّ مَن أقرّ بربوبيته صار موقنًا مطيعًا) ثُمَّ اسْتَقَامُوا﴾ [الأحقاف: 13]، (أي: تقبَّلوا الحق، ثم صبروا عليه)؛ فجمع الخير كلّه في كلمتين: الحقّ والصبر»[50].
ويندرج مبدأ التواصي بالحقّ والتواصي بالصبر في سياق المقصد القرآني العام المتمثّل في إيجاد وتكوين الجماعة المؤمنة الصالحة، ذلك أنّ «التربية الإسلامية لا تتوقف عند إعداد الأفراد المؤمنين، وإنما تتخذ من هذا الإعداد وسيلة لهدف آخر، هو إخراج أُمة المؤمنين التي يتلاحم أفرادها عبر شبكة من الروابط الاجتماعية، تكون محصّلتها النهائية هي الولاية؛ أي: أن يتولّى كلّ عضو رعاية شؤون الأعضاء الآخرين»[51]، يقول الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ [الأنفال: 72]،ويقول: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا﴾ [آل عمران: 103]، ويقول: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: 2]. فهذه الآيات -وغيرها كثير- دالّة بوضوح على مقصد تكوين الجماعة، وليس أيّ جماعة، وإنما الجماعة المؤمنة، الحاملة للرسالة الإلهية، المؤسّسة لاجتماعها على عقيدتها وشريعتها وقيمها، المنشِّئة لأفرادها على مبادئها وتعاليمها، وهي الجماعة المتعاونة المتواصية بالحقّ والمتواصية بالصبر والمتواصية بالمرحمة.
وقد اقترن التواصي بالمرحمة مع التواصي بالصبر في قوله تعالى: ﴿ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ﴾ [البلد: 17]؛ لتكتمل بذلك حلقات المنهج الإلهي، و«تكتمل مقومات المجتمع المتكامل، قوامُه الفضائل الـمُثْلَى، والقيم الفُضْلَى؛ لأنّ بالتواصي بالحقّ إقامة الحقّ والاستقامة على الطريق المستقيم، وبالتواصي بالصبر يستطيعون مواصلة سيرهم على هذا الصراط، ويتخطّون كلّ عقباتٍ تواجههم. وبالتواصي بالمرحمة: يكونون مرتبطين كالجسد الواحد. وتلك أُعطيات لم يُعْطِها إلا القرآن، وأعطاها في هذه السورة الموجزة»[52].
وعليه، بقول الله -عز وجل-: ﴿وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾، تكتمل معالم منهجه العام والشامل، التي بتمثّلها بمجموعها وتنفيذها يبلغ الإنسان في بُعديه الفردي والجماعي منتهى مراتب الكمال؛ ذلك أنّ «الكمال أن يكون الشخص كاملًا في نفسه مكملًا لغيره، وكماله بإصلاح قوّتيه العلمية والعملية؛ فصلاح القوة العلمية بالإيمان، وصلاح القوة العملية بعمل الصالحات، وتكميله غيره بتعليمه إيّاه وصبره عليه، وتوصيته بالصبر على العلم والعمل»[53].
* * *
خاتمة:
نخلص من كلّ ما تقدَّم إلى أنّ سورة العصر على اختصارها وإيجازها الشديدين وأسلوبها الجامع، قد ضمّت منهج الله الكامل المتكامل الموصل إلى الحياة الإنسانية الطيبة السعيدة على هذه الأرض، وكأنها جاءت تفسيرًا لمعنى قوله تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ [المائدة: 3]، وذلك في محدّدات ومعالم كليّة تمثّلت في تلك القضايا الإنسانية الكبرى الأربع:
أولها: قيمة الزمن.
ثانيها: قضية الإيمان.
ثالثها: العمل الصالح.
ورابعها: التواصي (بالحق وبالصبر).
إنْ أخَذَ بها الإنسان كما يُرشِد الوحي، استطاع أن يحقّق سعادته وكماله، ويقِي نفسه الخسران والخيبة. وإذا أردنا أن نصوغ هدايات السورة بشكلٍ محدّد، نذكر -غيضًا من فيض- ما يأتي:
• أهمية الوقت وخطورة تضييعه، وأنه بمثابة رأس مال الإنسان، إن استثمره في خير ربح وأفلح، وإنْ في شرٍّ خسر وخاب.
• يُشترط للربح والنجاة من الخُسر اتصاف الإنسان فردًا وجماعةً بثلاثة كمالات:
- الإيمان ومعرفة الحقّ واليقين به.
- عمل الصّالحات بما عَلِم من الحق.
- التواصي بالحقّ والإرشاد إليه وتعليمه، وبالصبر عليه وعلى مشاقّه والثبات على طريقه.
والحمد لله ربّ العالمين
[1] التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، وهبة الزحيلي، دار الفكر، دمشق، ط10، 2009م، (30/ 786).
[2] انظر: التحرير والتنوير، محمد الطاهر بن عاشور، الدار التونسية للنشر، تونس، ط: 1984م، (30/ 527).
[3] أخرجه البخاري، كتاب التفسير، سورة (والعصر)، (103)، دار ابن كثير، دمشق- بيروت، ط1، 2002م، ص1267.
[4] البيان في عدّ آي القرآن، أبو عمرو عثمان الداني، تحقيق: غانم قدوري الحمد، مركز المخطوطات والتراث والوثائق، الكويت، ط1، 1994م، ص287.
[5] انظر: التفسير الحديث، محمد عزة دروزة، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط2، 2000م، (1/ 562).
[6] التفسير الحديث، دروزة، (1/ 561).
[7] تفسير الإمام الشافعي، محمد بن إدريس الشافعي، تحقيق: أحمد مصطفى الفران، الدار التدمرية، الرياض، ط1، 2003م، ص1461.
[8] تفسير القرآن العظيم، عماد الدين إسماعيل بن كثير، تحقيق: سامي بن محمد السلامة، دار طيبة للنشر والتوزيع، الرياض، ط2، 1999م، (8/ 479).
[9] روح المعاني في تفسير القرآن الكريم، محمود شكري الآلوسي، طبعة دار إحياء التراث العربي، بيروت، (30/ 227).
[10] مفتاح دار السعادة، ابن قيم الجوزية، تحقيق: عبد الرحمن بن حسن بن قائد، دار عطاءات العلم، الرياض- دار ابن حزم، بيروت، (1/ 153).
[11] تفسير نظام القرآن وتأويل الفرقان، عبد الحميد الفراهي، الدائرة الحميدية، الهند، ط1، 2008م، ص381.
[12] أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ومعه التتمة، محمد الأمين الشنقيطي، محمد عدنان سالم، المؤسسة السعودية، (مطبعة المدني)، ط2، 1980م، (9/ 507).
[13] أخرجه أحمد، في حديث واثلة بن الأسقع رضي الله تعالى عنه، برقم: (16982)، وقال: إسناده حسن. وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة، برقم: (1480)، وقال: فالحديث بمجموع طرقه صحيح.
[14] أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط، رقم: (5124)، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة، رقم: (2648)، وقال: وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات رجال مسلم غير محمد بن هشام المستملي.
[15] في ظلال القرآن، سيد قطب، دار الشروق، مصر، ط9، 1989م، (30/ 3964).
[16] نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، برهان الدين البقاعي، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، ط1، 1984م، (22/ 234).
[17] التحرير والتنوير، ابن عاشور، (30/ 527- 528).
[18] نظام القرآن، الفراهي، ص410.
[19] مفردات ألفاظ القرآن، الراغب الأصفهاني، تحقيق: صفوان عدنان داوودي، دار القلم، دمشق، والدار الشامية، بيروت، ط4، 2009م، ص825، وجامع البيان عن تأويل آي القرآن، أبو جعفر بن جرير الطبري، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، القاهرة، ط1، 2001م، (8/ 493).
[20] جامع البيان، الطبري، (8/ 493).
[21] يراجع: معالم في المنهج القرآني، طه جابر العلواني، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، القاهرة، ط1، 2010م، ص68- 69.
[22] معالم في المنهج القرآني، العلواني، ص69.
[23] انظر: منهج الحضارة الإنسانية في القرآن، محمد سعيد رمضان البوطي، دار الفكر، دمشق، ط2، 1987م، ص26.
[24] أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير، أبو بكر الجزائري، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، ط3، 1997م، (5/ 612).
[25] تفسير القرآن الكريم (جزء عم)، محمد بن صالح بن عثيمين، إعداد: فهد بن ناصر. السليمان، دار الثريا للنشر، ط2، 2002م، ص307. وانظر: تفسير ابن كثير، (8/ 480).
[26] في ظلال القرآن، قطب، (30/ 3964).
[27] التحرير والتنوير، ابن عاشور، (30/ 531).
[28] أضواء البيان، الشنقيطي، (9/ 497).
[29] أضواء البيان، الشنقيطي، (9/ 499).
[30] شروط النهضة، مالك بن نبي، ترجمة: عمر مسقاوي، عبد الصبور شاهين، دار الفكر، دمشق، ط: 1986م، ص140.
[31] شروط النهضة، بن نبي، ص141.
[32] التبيان في أقسام القرآن، ابن قيم الجوزية، تحقيق: عبد الله بن سالم البطاطي، مجمع الفقه الإسلامي، جدة، ط1، 1429هـ، ص136.
[33] يراجع: الإيمان والحياة، يوسف القرضاوي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط4، 1979م، ص5.
[34] في ظلال القرآن، قطب، (30/ 3965).
[35] التحرير والتنوير، ابن عاشور، (23/ 401- 402).
[36] يراجع: الإيمان والحياة، القرضاوي، ص9- 10.
[37] في ظلال القرآن، قطب، (30/ 3965).
[38] في ظلال القرآن، قطب، (30/ 3346- 3347).
[39] التبيان، ابن القيم، ص136.
[40] مقومات الشخصية المسلمة أو الإنسان الصالح، ماجد عرسان الكيلاني، كتاب الأمة، ع29، ط1، 1411هـ، المحاكم الشرعية والشؤون الدينية، الدوحة، ص41.
[41] الإسلام والإنسان، حسن صعب، طبعة دار العلم للملايين، بيروت، ص89.
[42] مقومات الشخصية المسلمة، الكيلاني، ص42.
[43] نظام القرآن، الفراهي، ص399.
[44] الإسلام والإنسان، صعب، ص95.
[45] مقومات الشخصية المسلمة، الكيلاني، ص45.
[46] التبيان، ابن القيم، ص136.
[47] التبيان، ابن القيم، ص136.
[48] التفسير الكبير ومفاتيح الغيب، فخر الدين الرازي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، ط1، 1981م، (32/ 90).
[49] التحرير والتنوير، ابن عاشور، (30/ 532- 533).
[50] نظام القرآن، الفراهي، ص403.
[51] إخراج الأمة المسلمة وعوامل صحتها ومرضها، ماجد عرسان الكيلاني، كتاب الأمة، ع30، ط1، المحاكم الشرعية والشؤون الدينية، الدوحة، ص29.
[52] أضواء البيان، الشنقيطي، (9/ 507- 508).
[53] مفتاح دار السعادة، ابن القيم، (1/ 153).
كلمات مفتاحية
الكاتب:

فاطمة الزهراء دوقيه
حاصلة على الدكتوراه في الآداب من جامعة مولاي إسماعيل مكناس - المغرب، ولها عدد من الأعمال العلمية.
مواضيع ذات صلة
((المعلومات والآراء المقدَّمة هي للكتّاب، ولا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع أو أسرة مركز تفسير))