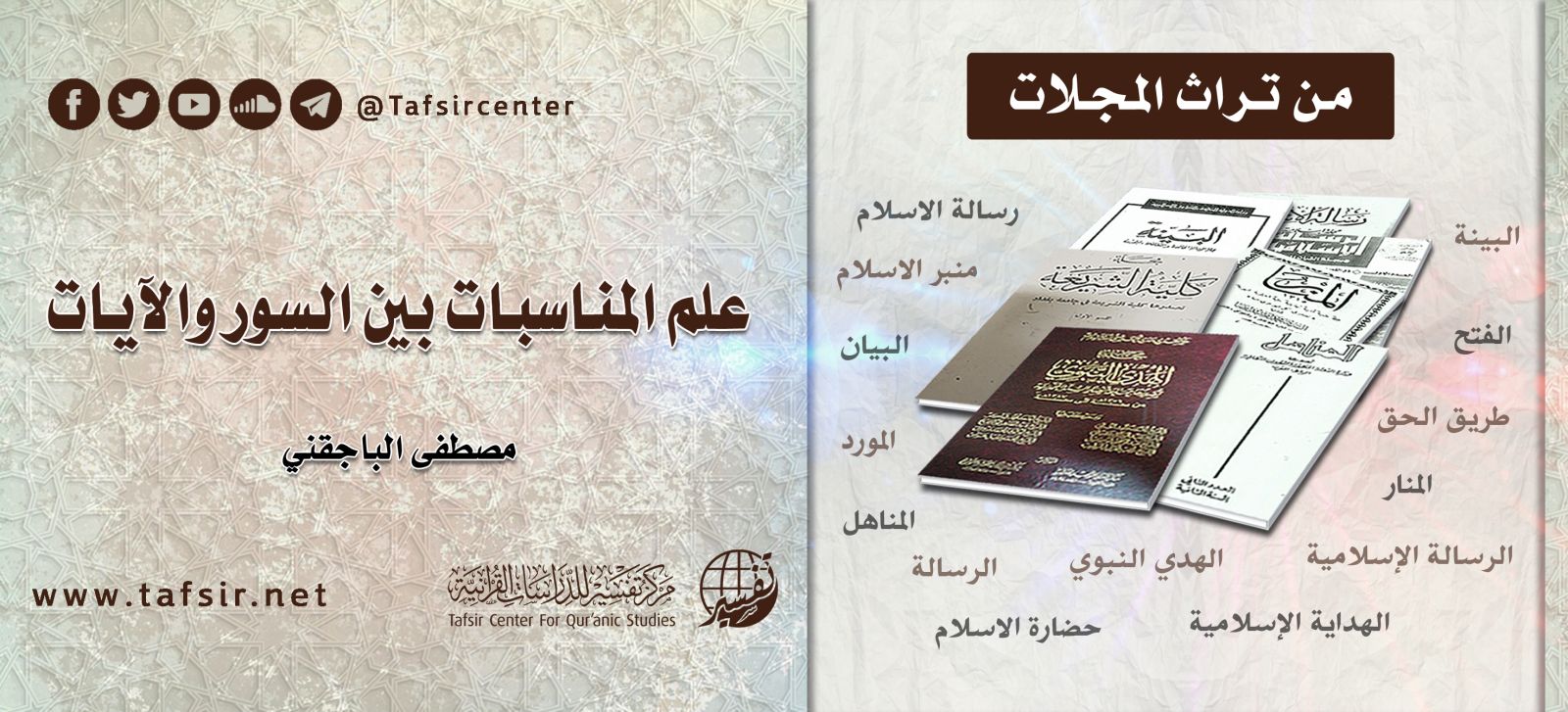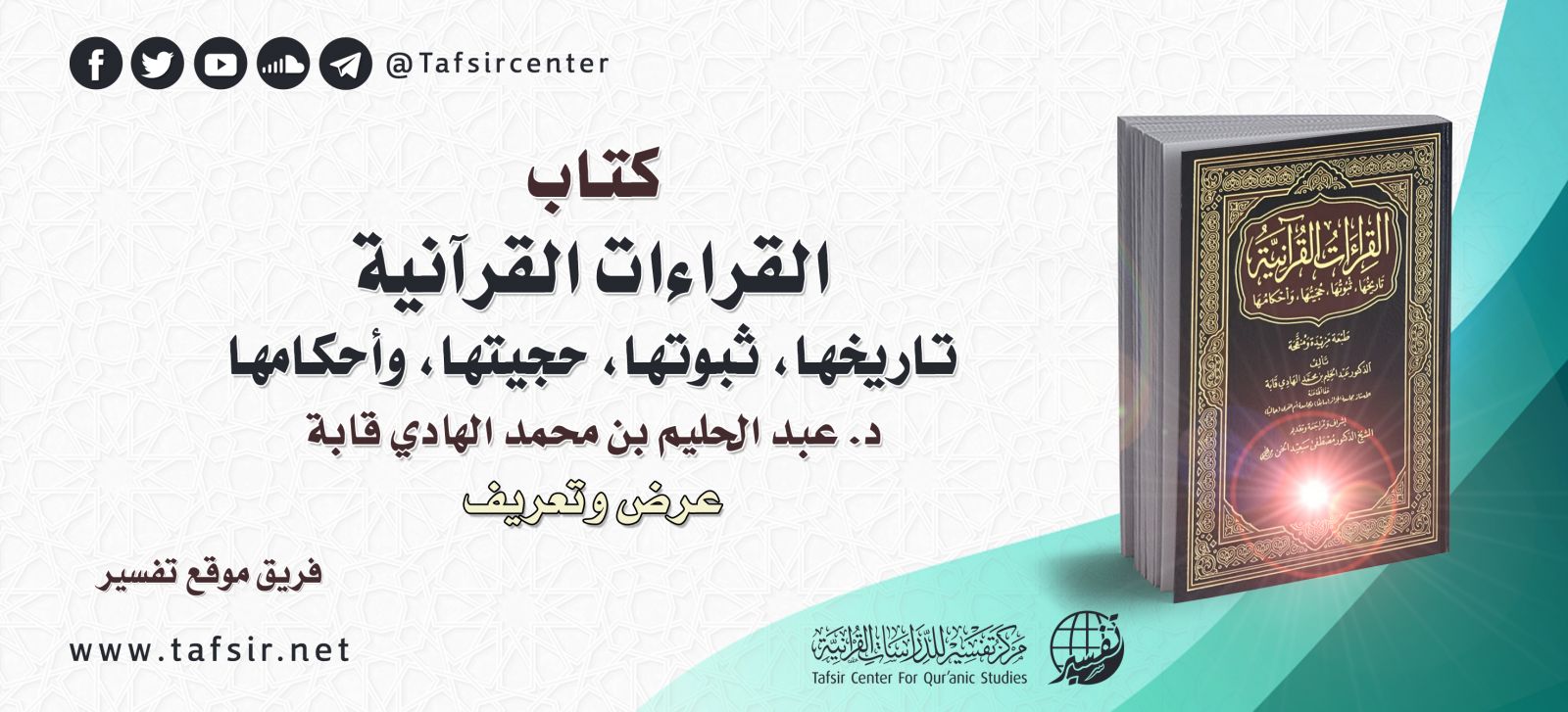المناسبة الدلالية بين مفتتح السورة القرآنية وخاتمتها؛ المفهوم والضوابط - هود والقصص نموذجًا
المفهوم والضوابط - هود والقصص نموذجًا
الكاتب: علاء راجح عبد الحميد

مقدمة:
لقد نزل القرآن الكريم على النبي -صلى الله عليه وسلم- منجّمًا بحسب الوقائع والأحداث وما يطرأ على المسلمين من قضايا ومستجدّات، وبرغم هذا التباعد الزمني بين نزول الآيات، وبرغم اختلاف الأحداث التي نزلت مِن أجلِها الآيات؛ إلا أننا نجد آيات كتاب الله تنتظم في نَظْمٍ بديع، وتضمّها وحدة تجعلها متماسكة مترابطة يأخذ بعضها بأعناق بعض، فكانت السورة في كتاب الله ذات بناء متماسك ترتفع طبقاته الواحدة تلو الأخرى حتى تصل إلى قمة البناء فتتكامل معانيها وتتضافر دلالاتها، فترى نفسك وأنت تقرأ كتاب الله أمام لوحة فنية تبلغ بك ذروة الإبداع والإعجاز معًا عند تدبّر المعاني وتأمّل السياقات التي وردت فيها الآيات؛ فالسورة في كتاب الله بناءٌ محكَم مترابط الأجزاء، المطلَع فيها يُـناسب الموضوع أو المحور الذي تُبنى عليه السورة، وكذلك الخاتمة لا تنفكّ عن أن تكون لبنة في البناء الفني المحكَم لها، وانطلاقًا من ذلك نُبحر في هذه المقالة مع المناسبة الدلالية بين مفتتح السورة القرآنية وخاتمتها، هادِفِين إلى إبراز مدى علاقة المفتتح والخاتمة بالمقصد العام للسورة، ودورهما في علاج القضية المحورية التي تعالجها السورة، مستعينين بضوابط تُعين على إظهار تلك المناسبة الدلالية بين المفتتح والخاتمة، مقدِّمين نموذجًا تطبيقيًّا على سورتي هود والقصص، ولكن قبل ذلك نقدِّم تمهيدًا نتناول فيه الحديث عن الوحدة والترابط في السورة القرآنية قديمًا وحديثًا.
تمهيد: الوحدة والترابط في السور القرآنية قديمًا وحديثًا:
«وحدة السورة تعني أنّ لكلّ سورة غرضًا وهدفًا واحدًا تتجه بكلّ معانيها ومبانيها إلى إيضاحه وإظهاره، وروحًا خاصًّا تشترك المعاني والألفاظ والصور والأصوات في تكوينه ونقل تأثيره»[1].
ولقد وعَى علماؤنا الأجلّاء هذا الترابط داخل السورة القرآنية والتناسب بين أجزائها، وكيف أنّ الآية أو الأجزاء تنضمّ إلى أختها فتكوِّن بناءً متكاملًا محكمًا من المعاني والدلالات، فها نحن نرى الباقلاني عندما يتحدث عن السورة المفتتحة بالحروف المقطعة يشير إلى وحدة السورة وترابط الأجزاء فيها، فيقول: «كثير من هذه السور إذا تأملته فهو من أوّله إلى آخره مبنيّ على لزوم حُجّة القرآن، والتنبيه على وجه معجزته»[2]، بل إنّ الباقلاني جعل هذا الترابطَ الواضح بين الآيات والأجزاء داخل السورة القرآنية دلالةً على الإعجاز والبلاغة، فقال عنه: «بديع النَّظْم عجيب التأليف متناهٍ في البلاغة إلى الحد الذي يعلم عجز الخلق عنه»[3]، فهذا الوصف البديع الذي وصف به الباقلانيُّ القرآنَ الكريم كان من أسبابه مدى الارتباط، والائتلاف، والتناسب، والتناسق بين الآيات، فهو «على اختلاف فنونه وما يتصرّف فيه من الوجوه الكثيرة والطرق المختلفة؛ يجعل المختلف كالمؤتلف، والمتباين كالمتناسب، والمتنافر في الأفراد إلى حدّ الآحاد، وهذا أمر عجيب تبين به الفصاحة وتظهر به البلاغة»[4].
وقد أدركَ هذه الوحدةَ في السورة القرآنية ومدى التناسب والائتلاف بين الآيات الزمخشريُّ، فعند تفسيره لقوله تعالى: ﴿وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ﴾ [النمل: 88]، قال كلامًا يؤكّد فيه ذلك، وهذا الكلام يكشف عن فهمٍ دقيق ووعيٍ تام بمدى تلاحُم النَّظْم القرآني وتعاضد الآيات داخل السورة القرآنية، فيقول: «فانظر إلى بلاغة هذا الكلام، وحُسن نَظْمه وترتيبه، ومكانة إضماده[5]، ورصافة تفسيره وأخذ بعضه بحجزة بعض، كأنما أُفرغ إفراغًا واحدًا، ولأمرٍ ما أَعجز القويّ وأَخرس الشقاشق[6]»[7].
وقد أشار الرازي إلى مدى التلازم والارتباط بين آيات القرآن الكريم، كما أشار إلى أنّ ذلك من أسباب فصاحة هذا الكتاب المعجِز، وسرّ من أسرار بلاغته وإعجازه، فقال عند تفسيره لسورة البقرة: «ومَن تأمّل في لطائف نَظْم هذه السورة وفي بدائع ترتيبها عَلِمَ أن القرآن كما أنه معجِز بحسب فصاحة ألفاظه وشرف معانيه، فهو أيضًا معجز بحسب ترتيبه ونَظْم آياته»[8]، بل أكّد الرازي على وحدة السورة القرآنية وتعاضد أجزائها وترابط آياتها، فقال في تفسير سورة فصلت: «وكلّ مَن أنصف ولم يتعسَّف عَلِمَ أنّا إذا فسَّرنا هذه الآية على الوجه الذي ذكرناه، صارت هذه السورة من أوّلها إلى آخرها كلامًا واحدًا منتظمًا مسوقًا نحو غرض واحد»[9].
وقد ازداد هذا الفهم والإدراك إلى مدى الارتباط والتناسب بين آيات القرآن وسوره عند العلماء بعد ذلك مما دفعهم إلى التأليف فيه والحديث عنه حديثًا خاصًّا[10]، فكان مِن أشهر مَن ألّف في علمِ المناسبة بين آيات القرآن وسوره أبو جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير الغرناطي (ت: 708هـ)؛ حيث ألّف كتابًا في ذلك يسمّى: (البرهان في تناسب سور القرآن)، ويُطلق عليه أيضًا: (البرهان في ترتيب سور القرآن). وقد عقد الزركشي (ت: 794هـ) فصلًا في كتابه: (البرهان في علوم القرآن) تحدّث فيه عن هذا العِلْم كما تحدّث عن وحدة السورة القرآنية والمناسبة بين فواتح السور وخواتمها. كما ألّف أيضًا في المناسبة بين آيات القرآن وسوره الإمامُ البقاعي (ت: 885هـ)، حيث وضع كتابه المشهور: (نظم الدرر في تناسب الآيات والسور)، ويعدّ هذا الكتاب هو أشهر كتاب في هذا العلم، ومؤلِّفه هو واضع حجر الأساس له.
وكذلك عقد السيوطي (ت: 911هـ) فصلًا في (الإتقان) تحدّث فيه عن مناسبة الآيات والسور، وذكر أنه قد ألّف في هذا العلم مؤلَّـفًا لطيفًا سمّاه: (مراصد المطالع في تناسب المقاطع والمطالع)[11].
وفي العصر الحديث كان للحديث عن المناسبةِ بين الآيات والأجزاء في السور القرآنية والترابطِ بينها نصيبٌ وافر من اهتمام العلماء؛ حيث يعدّ الإمام محمد عبده (ت: 1323هـ) أوّل من استعمل مصطلح الوحدة الموضوعية للسورة القرآنية، وعدّها من الأصول التي يقوم عليها منهجه في التفسير، وسار على نهجه في ذلك واقتفى أثره تلميذه محمد رشيد رضا وبعض أساتذة التفسير في العصر الحديث[12].
ولقد ازدادت عناية الباحثين في العصر الحديث بمفهوم الوحدة في السورة القرآنية، فأكّد بعضهم على عُمق معنى الوحدة في السورة والتحام أجزائها التحامًا عضويًّا، وأنها تتجاوز الصِّلات الجزئية أو مجرّد الترابط والتناسب في المعاني والأفكار إلى أنها ذات نظام كلي ومنهج محدّد يقوم على مقدمة وموضوع وخاتمة، وهذه العناصر تتآزر لتحقّق مقاصد السورة وأهدافها[13].
المناسبة الدلالية بين مفتتح السورة القرآنية وخاتمتها:
القرآن الكريم هو كتاب الله المنزَّل على عبده محمد -صلى الله عليه وسلم- ليكون بلاغًا للناس وهدايةً لهم ودستورًا تنبثق منه كلّ القوانين التي يحتكم إليها المسلمون في حياتهم؛ ولذلك فكلّ سورة من سور القرآن بمثابة فصلٍ من فصول هذا الدستور، وبيان لمعالم هذا الدِّين الذي ارتضاه الله -عز وجل- لأمّة نبيّه محمد -صلى الله عليه وسلم-؛ ولذا جاءت السورة من القرآن كالبناء المتكامل الذي رُفعت قواعده، واكتملت طبقاته، وتعالى بناؤه حتى وصل إلى قمة سامقة في أداء المعنى ونقل البيان إلى هذه الأمّة؛ ولذلك فالسورة القرآنية تمثّل بناءً فنيًّا متكاملًا يتكوّن من مقدمة وهي مفتتح السورة، وموضوع، وخاتمة، ويتّضح ذلك من خلال التعريف الذي قدّمه لنا السيوطي للسورة القرآنية، فقد قال فيما نقله عن الجعبري: «حدّ السورة: قرآن يشتمل على آي ذي فاتحة وخاتمة، وأقلّها ثلاث آيات»[14]، فهذا التعريف للسورة القرآنية إنما يدلّ على أنها تمثّل وحدة موضوعية متماسكة لها مقدّمة تمهّد لموضوعها أو القضية التي تتناولها السورة، ثم الشروع في هذه القضية وطرحها من كافة جوانبها، ثم خاتمة تتلاءم مع ما سبقها من مقدمةٍ وطرحٍ لهذه القضية.
وقد أشار القدماء إلى علاقة مفتتح السور بخاتمتها، ولكن هذه الإشارات كانت بمثابة ومضات سريعة وكلمات عابرة لا تروي ظمأ الباحث الذي يريد أن يسبر أغوار النصّ القرآني، ويسبح في دلالاته، ويكشف عن مراميه ومضامن إعجازه؛ فالزركشي (ت: 794هـ) عقد فصلًا في مناسبة فواتح السورة وخواتمها، وأشار إلى فواتح سورة القصص وخاتمتها حيث افتُـتحت بالحديث عن أمر موسى، وقصّته، ونصرته، وخروجه من وطنه، وختمت بأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بأن لا يكون ظهيرًا للكافرين، وتسليته بخروجه من مكة والوعد بعودته إليها[15]. وتابعه في ذلك السيوطي (ت: 911هـ) في (الإتقان)، وجاء بنفس الأمثلة التي أتى بها الزركشي وزاد عليه، ولكن الملاحظ على ما قدّمه الزركشي والسيوطي أنهما أشارَا إلى التناسب بين مفتتح السورة وخاتمتها دون ربط ذلك بالموضوع العام للسورة أو القضية التي تتناولها السورة، وما دور المفتتح والخاتمة في البناء الفني أو الوحدة الموضوعية للسورة القرآنية؟
وممّن أشار إلى مدى المناسبة والترابط بين مفتتح السورة وخاتمتها -خاصة في السور الطّوال- أبو حيان (ت: 745هـ) في (البحر المحيط)، حيث قال في تفسير خواتيم سورة البقرة: «ولمّا كان مفتتح هذه السورة يذكر الكتاب الـمُنزل، وأنه هدى للمتقين الموصوفين بما وُصفوا به من الإيمان بالغيب، وبما أُنزل إلى الرسول وإلى مَن قبله، كان مختتمها أيضًا موافقًا لمفتتحها، وقد تتبعتُ أوائل السور المطولة فوجدتها يناسبها أواخرها بحيث لا يكاد ينخرم فيها شيء»[16]. فأبو حيان قد أشار إلى المناسبة الدلالية بين مفتتح سورة البقرة وخاتمتها، لكنه لم يربط ذلك بالموضوع العام للسورة أو القضية التي تناقشها السورة وتقدّم الحلول لها.
ولقد أشار الإمام البقاعي (ت: 885هـ) -الرائد الأول لعلم المناسبات في السور القرآنية والكاشف الأول عن معالمه ومنهجه- إلى ضرورة أن يتناسب مفتتح السورة وخاتمتها مع المقصد العام لها والمحور الذي تدور عليه، فيقول: «فإنّ كلّ سورة لها مقصد واحد يُدار عليه أوّلها وآخرها ويُستدلّ عليه فيها، فترتب المقدمات الدالة عليه على أتقن وجه وأبدع نهج، وإذا كان فيها شيء يحتاج إلى دليل استدلّ عليه، وهكذا في دليل الدليل، وهلم جرًّا، فإذا وصل الأمر إلى غايته ختم بما كان ابتدأ، ثم انعطف الكلام إليه، وعاد النظر عليه على نهج آخر بديع، ومرقى غير الأول منيع»[17]، فالبقاعي هنا قد وضع لنا المنهج، ورسم لنا الطريق عندما نريد أن نكشف عن التناسب الدلالي بين مفتتح السورة وخاتمتها، وهو أن نربط مفتتح السورة والخاتمة بمقصدها العام، أو بمعنى آخر نربط المفتتح والخاتمة بالقضية التي تعالجها السورة، وأن نبرز دور المفتتح والخاتمة في بيان هذه القضية وبيان وسائل علاجها والتعامل معها.
وفي دراسته الماتعة الرصينة قدّم لنا الدكتور/ سامي العجلان العلاقةَ الأساسية بين مفتتح السورة وخاتمتها، وهي علاقة «الاشتراك والمناظرة» بمعنى أن يشترك كلٌّ من الفاتحة والخاتمة في ذكر المقصود أو في الإيماء إليه، ثم ذكر الدكتور العجلان تحت هذه العلاقة الكبرى والأساسية عدة علاقات تتفرّع عنها[18].
ضوابط الكشف عن المناسبة الدلالية بين مفتتح السورة وخاتمتها:
أولًا: لا بدّ من الكشف عن المقصد العام للسورة أو عن القضية المحورية التي تدور حولها وتعالجها؛ لأن المقصد العام للسورة سيكشف لنا عن التناسب بين المفتتح والخاتمة، كما أشرنا من قبل إلى كلام الإمام البقاعي الذي بيّن فيه أنّ لكلّ سورة مقصدًا عامًّا يُدار عليه أوّلها وآخرها، وأكّد الإمام البقاعي ذلك أيضًا في نظم الدرر، حيث قال: «لعرفان مناسبات الآيات في جميع القرآن، هو أنك تنظر الغرض الذي سِيقت له السورة، وتنظر ما يحتاج إليه ذلك الغرض من المقدّمات، وتنظر إلى مراتب تلك المقدّمات في القُرب والبُعد من المطلوب»[19]، فمِن هذا الكلام نفهم أن الوحدة الموضوعية في السورة لا تتحقّق بتناسق الآيات وقوة الارتباط بينها والتناسب بين الآيات في المعاني فقط، بل لا بدّ للسورة من محور عام تسعى إلى بيانه أو بمعنى آخر قضية مركزية تسعى لإبرازها وتقديم الحلول لها.
ثانيًا: أن نتأمّل كيف استطاعت السورة أن تقدّم لهذه القضية، وما وسائل العلاج التي ظهرت من خلال السورة؟ فالنصّ القرآني ليس نصًّا أدبيًّا يعمل على انتزاع الزفرات من الصدور أو إلهاب المشاعر بين الضلوع، بل هو نصّ فاعل يقدّم الحلول لمختلف القضايا، ويُعين المسلم على مختلف المستجدّات التي تواجهه في حياته؛ ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ﴾[الإسراء: 9]، فما أجمل ما أورده السيوطي في (الدرّ المنثور) عن قتادة أنه قال في هذه الآية: «إنّ هذا القرآن يدلّكم على دائكم ودوائكم...»[20]، فالقرآن يصف الداء ويحدّد الإشكال، ثم يقدّم له الحلول والعلاج.
ثالثًا: ليس المقصود بمفتتح السورة هو الآية الأُولى منها أو الثانية، بل مفتتح السورة هو مجموعة الآيات التي تعدّ تمهيدًا لِما سوف تعالجه السورة من قضايا، وما سوف يدور عليه الإطار العام للسورة، وهذا ما اصطلح عليه عند القدماء بما يسمَّى مطالع السور، وقد عرّف أحد المعاصرين مطالع السور بما يتّفق مع ما ذهبنا إليه في هذا الضابط، فقال: «مطالع السور: يراد بهذا العنوان، بداية السور وفواتحها، وليس بالضرورة الكلمة الأُولى في السورة أو الآية، وإنما المراد جملة المعاني المحورية المترابطة الدالة على موضوع أو قضية ما، ولا غرو أنّ (الألفاظ) الحاملة لهذه المعاني داخلة في مسمّى الفواتح والمطالع، وتركيزنا على (المعنى) مقصود لذاته؛ إذ الغرض هو بيان أثر تلك المعاني المصدرة في الكشف عن مقصود السورة الأكبر»[21].
رابعًا: خاتمة السورة ليست الآية الأخيرة فقط أو ما قبلها، بل هي مجموعة الآيات التي تمثّل في مجملها ما يمكن أن نسمّيه التوصيات التي تقدّمها السورة في سبيل علاج القضية أو تقديم الحلول لها، واصطلح القدماء أيضًا على تسمية خاتمة السور القرآنية بالمقاطع، ويراد بها (خواتيم السور) أي الآيات أو الكلمات أو الجمل التي تختم بها سور القرآن الكريم، وليس بالضرورة آخر آية في السورة أو كلمة منها، بل المراد الآيات المشكّلة لوحدة من وحدات السورة، ذات ترابط معنوي خاصّ، ومِن ثَمّ فقد تكون آية واحدة، أو آيات»[22]. وقد استخدم مصطلح المطالع والمقاطع الإمام السيوطي في كتابه الذي سمّاه: (مراصد المطالع في تناسب المقاطع والمطالع).
التناسب الدلالي بين المفتتح والخاتمة في سورتي (هود والقصص):
1- سورة هود؛ المفتتح والخاتمة ما بين مثـبّطات الدعوة ووسائل الثبات:
سورة هود من السور المكية التي نزلت على الرسول -صلى الله عليه وسلم- قبل الهجرة بعد وفاة أكبر داعمي النبي في دعوته: السيدة خديجة، وعمّه أبو طالب. وبعد ما لاقاه النبي -صلى الله عليه وسلم- في الطائف مِن صدٍّ واستكبار ورفض لدعوته -صلى الله عليه وسلم-، فكان لزامًا مِن تثبيت قلب النبيّ والربط عليه، وتقديم الوسائل التي تعينه على الثبات وتساعد في السَّيْر قُدُمًا في طريق الدعوة، فكانت سورة هود من هذه السور التي رسمَت لنا منهج الثبات على طريق الدعوة وأبرزَت معالمه.
والسورة منذ البداية تُعلن في وضوح تام معالم القضية التي تتناولها وتظهرها شاخصة أمام العين؛ فبعد البدء بالقضية المحورية التي يدور عليها كتاب الله وترتكز حولها دعوة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهي قضية التوحيد والدعوة إلى عبادة الله -عز وجل-، تأتي الإشارة منذ البداية إلى القضية التي سوف تتناولها السورة، وهي قضية المثـبّطات التي تقف في طريق الدعوة وتعوق مسيرتها، والتي تحاول أن تُلْجِئ الدعاة إلى اليأس أو تدفعهم إلى الشعور بصعوبة الطريق ووعورته.
وتبدأ السورة على وجه السرعة في تقديم أوّل هذه المثـبّطات، وهو انطواء القلوب على البُغْض والضّغينة للدعوة لدين الله وإظهار خلاف ذلك، ولكن ذلك قد يكون له أثر ظاهر وهو أنهم إذا رأوا النبي -صلى الله عليه وسلم- يثنون صدورهم ويغطّون وجوههم ويستغشون ثيابهم حتى لا يراهم النبيّ فيدعوهم إلى دين الله تعالى؛ ﴿أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ [هود: 5]، وهذا الأمر قد يجعل الداعية يُصاب بالإحباط، كما يُشعره بعدم جدوى ما يبذله من جهد من أجل الدعوة، فيقعد به هذا الأمر عن مواصلة الطريق والسَّيْر على الأشواك في سبيل الدعوة لدين الله.
ثم تقدِّم لنا السورة ثاني هذه المثـبّطات، وهو الاستهزاء بما يقدِّمه الداعية من وعيد حتى يرتدعَ المدعوّون، ويفكروا في مآلهم، ويدركوا خطورة التكذيب وعاقبة العناد والاستكبار؛ ﴿...وَلَئِنْ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ * وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ [هود: 7- 8].
ثم تكشف لنا السورة عن ثالث هذه المثـبّطات، وهو الافتراء والكذب على الداعية، ونسبة ما ليس منه إليه؛ كافترائهم على رسول الله أنه افترى هذا القرآن، وجاء به مِن تلقاء نفسه، وما هو بوحي من الله -عز وجل-؛ ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [هود: 13].
ومع كثرة هذه المثبطات وشدة العناد ومحاولة تقييد الداعية وإثنائه عن دعوته قد يفكّر الداعية في بعض المواءمات حتى تسير الدعوة في طريقها وتُكْسَر صلابة العناد، وتلين قناة الاستكبار؛ ﴿فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ﴾ [هود: 12]، يقول ابن عطية: «ويحتمل أن يكون النبيّ قد عَظُمَ عليه ما يَلْقَى من الشدة، فمال إلى أن يكون من الله تعالى إذنٌ في مساهلة الكفار بعض المساهلة، ونحو هذا من الاعتقادات التي تليق به كما جاءت آيات الموادعة»[23].
فهنا في مفتتح السورة قد نجدها قدّمت لنا تصورًا عامًّا لتلك القضية المحورية التي تتناولها السورة وترتكز عليها، ثم تسير السورة بعد ذلك فتقدّم لنا نماذج لدعاة واجهوا مثل هذه المثبطات وكيف تعاملوا معها بثبات مقرون بالصبر واليقين والتوكل على الله.
فهذا نبي الله نوح لا يتخلّى عن الفئة المؤمنة ولا يرضى بطردها، فهو لا يقبل المواءمة أو التفريط في ثوابت الدعوة؛ ﴿وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ﴾ [هود: 29]، بل يقول بأعلى صوته مواجهًا هؤلاء المنكرين الذين وصفهم بأنهم قوم يجهلون، منذرًا إياهم بالوعيد الذي توعّدهم الله به وهو العذاب، يقول في ثقة تامّة تكشف عن ثبات ويقين: ﴿...إِنَّمَا يَأْتِيكُمْ بِهِ اللَّهُ إِنْ شَاءَ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ﴾ [هود: 33]، ولا يعبأ بسخريتهم منه وهو يصنع السفينة فيجيب في ثقة شديدة: ﴿...إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ * فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ﴾ [هود: 38- 39]، وعندما ظهرت عاطفة الأبوّة التي قد تدفع إلى الضعف، وقد تؤثّر على الداعية سلبًا؛ كان التوجيه الإلهي والتقويم الرباني لنوح -عليه السلام-: ﴿قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾ [هود: 46]، إنه ردٌّ حاسم قاطع يثـبِّت أقدام الداعية على الطريق، ويحفظ عليه نفسه من الميل أو التخاذل.
وهذا هود -عليه السلام- يعلنها بصوت لا يعروه ضعف ولا يداخله يأس، فيقول مخاطبًا هؤلاء المكذبين المعاندين: ﴿...إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَاشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ * مِنْ دُونِهِ فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنْظِرُونِ * إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [هود: 54- 55- 56].
ونبي الله صالح عندما كذّبَ قومُه وعيدَ الله لهم، وعقروا الناقة، قال في يقين تام: ﴿...تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ﴾ [هود: 65]، يقين في معيّة الله -عز وجل- له ولدعوته، ويقين في هلاك الفئة المكذِّبة، ويقين في أن الدعوة ستسير ولن تقف، فوعدُ الله -عز وجل- لا يُخْلَف، ونصر الله سوف يأتي حتى وإن طال الطريق ومُلِئ بالعقبات.
ونبيّ الله شعيب يقف أمام هؤلاء المكذبين فيردّ عليهم القول بما هو أشد، ويقيم الحُجّة تلو الحُجّة، ويقدِّم الدليل بعد الدليل، ثم يختم حديثه بما يدل على الثبات والثقة التامة في عون الله ونصره في دعوته فيقول: ﴿وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ﴾ [هود: 93].
بعد ذلك تأتي خاتمة السورة مناسبة في دلالتها لما جاء في مفتتحها؛ فالمفتتح عرَضَ القضية، وأشار إليها، وقرّرها، ومضت السورة تقدِّم نماذج تعاملَت مع مثل هذه القضية وهم الأنبياء، ثم تأتي الخاتمة التي كانت بمثابة التوصيات والحلول التي تقدَّم في سبيل التعامل مع هذه القضية المهمّة، وهي قضية الدعوة ومثـبّطاتها والعقبات التي تقف في طريقها، تأتي الخاتمة فترسم المنهج الأمثل في التعامل مع هذه القضية، ومعالم هذا المنهج تتضح في:
1- الاستقامة على المنهج، مع عدم الانحراف أو الطغيان، وعدم الركون إلى الظالمين والميل لهم ومداهنتهم ومواءمتهم، ويتمثّل ذلك في أمرٍ ونهيين أتيا في خاتمة السورة: ﴿فَاسْتَقِمْ﴾، ﴿وَلَا تَطْغَوْا﴾ ﴿وَلَا تَرْكَنُوا﴾، وهذه الاستقامة تتطلب رابطًا روحيًّا يربطك برب المنهج حتى تلجأ إليه كلما اشتدت عليك تبعات الدعوة، وألـمّت بك ملمّات الطريق، وهذا الرابط هو: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ﴾ [هود: 114].
2- ومن معالم المنهج الذي نتعامل به مع قضية الدعوة ومثبطاتها: ﴿وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾ [هود: 115]، فالدعوة ليست طريقًا ممهّدًا سهل المسير، بل هي طريق كثرت عقباته ونصبت الشِّراك على جوانبه؛ ولذا فهي تحتاج إلى صبر وعزيمة لا تلين، وهذا الصبر لن تستطيعه إلا نفوس تربّت على الإحسان، الذي هو أرقى درجات الصِّلَة بين العبد وربه وأعلى درجات اليقين.
3- لا بد أن يستقر في نفس كلّ مَن يتصدر إلى الدعوة لدين الله -عز وجل- أنّ عليه الإصلاح وليس الصلاح فقط، فليست القضية أن تكون صالحًا تنجو بنفسك، وتربّيها على الصلاح، بل إنّ القضية أن تكون مُصلِحًا تأخذ بيد غيرك وترشدهم إلى طريق النجاة: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ﴾ [هود: 117]، فالبُعد عن الهلاك يتحقّق بأن تكون مُصلِحًا وليس صالحًا؛ ولذلك فنحن نريد أمّة أهلُها مصلحون لا صالحون فقط.
4- النظر في مسيرة الدعاة السابقين والتأمّل فيها ومعرفة مواقفهم مع مثل هذه القضايا التي تتعامل معها الدعوة، فهذا يدفع إلى الثبات وملء القلب باليقين، وأن الدعوة باقية وأن شمسها ستشرق يومًا مهما اشتدّ الظَّلام: ﴿وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ [هود: 120].
سورة هود؛ مفتتح يُشعر بالقلق وخاتمة تملأ القلب بالطمأنينة واليقين:
كتاب الله ليس كلمات تُقرأ وصفحات تُطوى، لكنه آيات تمسّ القلوب وتحرك المشاعر، وإذا ما قرأ القارئُ كتابَ الله ولم يتفاعل معه ويتحرّك له قلبُه فما ذاق اللذة وما عرف مكامن السعادة؛ فأنت عندما تبدأ القراءة في سورة هود وترى مفتتح السورة وهو يقدِّم لك المثـبّطات التي تقف في طريق الداعية إلى الله ومظاهر الصدّ والعناد والبُعد عن منهج الله =يساورك القلق ويسيطر عليك الاضطراب، وبعد ذلك يدور هذا الشعور ما بين قلق واضطراب وبين طمأنينة وأمان وأنت تقرأ قصص الأنبياء في السورة، فتارة ترى العناد والاستكبار من هؤلاء المكذبين فتشعر بالقلق على أمر الدعوة، سرعان ما يتحوّل ذلك إلى طمأنينة وسكينة عندما ترى ثبات الأنبياء ويقينهم بالله -عز وجل- ونصر الله لهم، ثم تأتي خاتمة السورة وتجد قلبك قد امتلأ باليقين التام وغُلِّف بالسكينة؛ لأنك علمت أن هناك وسائل، ودونك مقومات هي بمثابة المادة المضادة التي تمنع أن يتسلل إلى قلبك اليأس أو يسيطر عليك الخوف، فما دمت تضع أمام عينك: ﴿استقِم - لا تَطغَوا - لا تَركَنُوا - أقمِ الصلاة - أهلُها مصلحون - أنباء الرسل - نثبّت به فؤادك﴾؛ فأنت في طمأنينة وقلبك يمتلئ باليقين، وإذا بك تخرج من السورة مطمئن النفس مستريح البال قرير العين غير خائف على دعوة الله، ممتلئ اليقين بنصر الله.
وعلى ما سبق نجد أنّ سورة هود قد قدَّمت لنا نموذجًا في المناسبة الدلالية بين مفتتح السورة وخاتمتها، فالقضية العامة التي تناقشها السورة وتمثّل المحور الأساسي فيها هي «الدعوة ومثبطاتها»، ومفتتح السورة وهو الآيات الأربع عشرة الأُوَل قد قدَّمت لنا هذه القضية المحورية وألمحت إليها، وعرضت جوانبها، ثم أخذت السورة تعالج هذه القضية من خلال نماذج لدعاة واجهوا هذه المثـبّطات، وتغلّبوا عليها، وظهر ذلك فيما قدّمته السورة من قصص الأنبياء، ثم جاءت الخاتمة وهي الاثنتا عشرة آية الأخيرة لتقدِّم لنا الحلول والتوصيات التي تُعين على مواجهة هذه المثـبّطات، وتساعد في التغلّب عليها، بل ترسم منهجًا ثابتًا يستطيع أن يسير عليه الدعاة بعد ذلك في طريق دعوتهم.
2- سورة القصص؛ المفتتح والخاتمة ما بين الضعف والخوف من الشتات والوعد بالتمكين:
سورة القصص من السور التي نزلت على الرسول -صلى الله عليه وسلم- قبل الهجرة في لحظة حَرِجة، وهي أثناء خروجه -صلى الله عليه وسلم- من مكة مهاجرًا إلى المدينة، ومع أنّ النبي -صلى الله عليه وسلم- يثق في تأييد الله له إلا أنه بشرٌ تركَ قومه وفارقَ وطنه، وما يدري ما الذي ينتظره؟! فهو ذاهب إلى مصير غير محدّد المعالم، فكان من الطبيعي أن تسيطر على نفسه عاطفة الخوف من هذا المصير؛ يسيطر عليه الخوف من الشتات، فقد مات مَن يحتمي بهم ويلجأ إليهم، مات اللذان يمثلان له حائط الصدّ الأول ضد هجمات المشركين المتتالية ومكائدهم التي لا تنتهي، مات أبو طالب وماتت خديجة، ثم بعد ذلك يترك أهله وعشيرته، ألَا يكون كلّ ذلك سببًا يدعوه إلى القلق الطبيعي الذي ينتاب البشر؟! لذلك كانت سورة القصص التي هي بمثابة البشارة للعودة إلى ما طُرد منه، ولكنها عودة مختلفة فهي عودة بالتمكين والنصر المؤزر، فالقضية التي تتناولها السورة هي قضية الضعف والتمكين؛ فالسورة تمثّل صرخة نداء في نفس كلّ مستضعف، تقول له: لا تيأس فنصر الله آت، ووعد الله لك بالتمكين محقّق لا محالة.
فالسورة منذ البداية تُلقِي بظلالها على هذه القضية؛ ففي المفتتح تركّز الآيات الأُولى على قضية الاستضعاف؛ ﴿إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ﴾ [القصص: 4]، ثم تسوق وَعْد الله -عز وجل- لهؤلاء المستضعفين؛ ﴿وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ﴾ [القصص: 5]، وبعد ذلك تقدِّم لنا السورة نموذجًا من المستضعفين الذين سيطر عليهم الخوف أيضًا وشعروا بالشتات، لكنهم في النهاية تحققَ وَعْد الله لهم وعادوا ممكَّنِين، وتمثّل ذلك في قصة نبي الله موسى، ثم تسوق السورة نموذجًا لِـمَن مكَّنه الله وأنعم عليه لكنه لم يحافظ على تلك النعمة التي منّ الله بها عليه، فعَلَا واستكبرَ، فخسف الله به الأرض، وهذا النموذج الذي ساقه الله -عز وجل- وهو قصة قارون؛ جاء ليكون ماثلًا دائمًا أمام الفئة المؤمنة، إذا مكّنها الله ينبغي عليها أن لا تكون مثل هذا النموذج حتى يتمّ الله عليها نعمته، ولا ينتزع منها ما منّ عليها به.
وتأتي خاتمة السورة لتناسب المفتتح؛ فقد بدأت السورة بالإشارةِ إلى قضية الاستضعاف، ووعدِ الله لهؤلاء المستضعفين، فتأتي الخاتمة لتؤكّد على هذه البشرى، لكنها تؤكّد على أنّ التمكين سيكون على صنفين: تمكين أخروي؛ ﴿تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا...﴾ [القصص: 83]، ولا يكون هذا التمكين إلا بتحقق شروط تصحبه، وهي: ﴿لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [القصص: 83]، فالتمكين في الآخرة لن يتحقّق إلا بتحقّق ثلاثة شروط: 1- عدم العلوّ والاستكبار في الأرض. 2- عدم الفساد في الأرض. 3- تقوى الله عز وجل.
والصنف الثاني من التمكين هو التمكين في الدنيا، وهو ما بشّر الله -عز وجل- به نبيَّه -صلى الله عليه وسلم- فقال له: ﴿إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ﴾ [القصص: 85]، ولا يتحقّق هذا التمكين إلا بتحقّق شروطه التي ذكرها الله -عز وجل- في خاتمة السورة وهي:
1- أنْ لا تساند الكافرين أو تناصرهم، ولا تكن لهم عونًا: ﴿فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ﴾ [القصص: 86].
2- أن تسير في طريق الدعوة ولا تلتفت لمن حولك حتى لا يصدوك عن منهج الله: ﴿وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ﴾ [القصص: 87].
3- أن تحافظ على عقيدة التوحيد وأن يستقر في نفسك أنك مهما بلغت من قوةٍ وسلطان وتمكين؛ فلتعلم أنّ الحُكم لله وأنك راجعٌ حتمًا إلى الله: ﴿وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [القصص: 88].
هكذا تنتقل بنا سورة القصص من مفتتح تشعرُ فيه بالخوف والترقب الناتج عن الاستضعاف، إلى خاتمة تقدِّم لك بُشريات النصر وحتمية التمكين؛ مما يجعلك تخرج من السورة وقد امتلأتَ ثقة في نصر الله، وأصبحتَ على يقين بأنّ الاستضعاف مهما طال أمَدُه فإنّ التمكين آتٍ لا محالة، ولكن إذا تحقّقت شروطه التي أشارت إليه خاتمة السورة.
وفي ضوء ما عرضناه نجد أن القضية العامة التي تناقشها سورة القصص هي قضية «الضعف والتمكين»، وما قد يتسلّل إلى نفوس المستضعفين من الخوف من التشرذم والشتات، وجاء مفتتح السورة متسقًا مع هذه القضية مؤكدًا عليها، وتمثل ذلك في الآيات الستّ الأُوَل، وعالجت السورة القضية من خلال نموذجين: الأول منهما نموذج مستضعف لكنه أخذ بمقومات التمكين، فمكّنه الله، وتمثّل ذلك في قصة موسى -عليه السلام-. ونموذج آخر كان مُـمَكَّنًا لكنه خالف بعض مقوِّمات التمكين فخسف الله به وبداره الأرض، وقد جاءت الخاتمة متناغمة مع المفتتح؛ فالمفتتح قد عرَضَ القضية وأشار إليها، أمّا الخاتمة فكانت هي المقوِّمات التي تقود هؤلاء المستضعفين إلى التمكين، وتحفظهم من التشرذم والشتات، وتمثّل ذلك في الآيات الستّ الأخيرة.
الخاتمة:
كتاب الله نزل منجَّمًا بحسب الحوادث، لكنك تشعر أنّ بين آياته وسوره وحدة موضوعية تجعله بناءً مترابط الأركان متماسك البنيان، وقد أدرك علماؤنا منذ القِدَم هذه الوحدة والتماسك في كتاب الله، فأشاروا إلى المناسبة بين الآيات والسور، وأدرك ذلك المحدِّثون مما جعلهم يفردون مؤلَّفات كاملة عن التناسب بين الآيات والسور في القرآن الكريم، وقد اعتنى أيضًا العلماء بالتناسب بين مفتتح سور القرآن وخاتمتها، لكن معظم العلماء قديمًا لم يجعلوا هذا التناسب بين المفتتح والخاتمة في إطار المقصد العام للسورة أو في إطار القضية التي تناقشها السورة وتقدِّم الحلول لها؛ ولذلك حاولنا في هذه الرحلة القصيرة أن نقدِّم مفهومًا للوحدة والترابط في السورة القرآنية، وإيضاح مدى التناسب الدلالي بين مفتتح السورة القرآنية وخاتمتها في إطار المقصد العام للسورة القرآنية والقضية التي تناقشها، مستعينين بضوابط تساعد عند اقتفاء أثرها على الكشف عن التناسب الدلالي بين مفتتح السورة وخاتمتها، وطبّـقنا هذه الضوابط على سورتين من سور القرآن الكريم، وهما سورتا هود والقصص، وأخيرًا نرجو من الباحثين والعاملين بحقل الدراسات القرآنية إطلاق العِنان لملَكاتهم الفكرية وطاقاتهم الإبداعية عن الكشف عن جوانب الإعجاز في كتاب الله مهتدين بعلمائنا الأوائل، لكن معتمدين على قرائحهم وما اختزنوه من علوم تعلّموها، ليسوا مكرّرين أو مقلّدِين لكلام السابقين، كما نرجو أن نوسّع دائرة الاهتمام والبحث حول مدى التناسب الدلالي بين المفتتح والخواتيم في كلّ سور القرآن الكريم.
[1] التناسب البياني في القرآن الكريم؛ دراسة في النظم المعنوي والصوتي، أحمد أبو زيد، منشورات كلية الآداب- الرباط، مطبعة النجاح الجديدة- الدار البيضاء، 1992م، ص373.
[2] إعجاز القرآن، للباقلاني، تحقيق: السيد أحمد صقر، دار المعارف- مصر، الطبعة الخامسة، 1997م، ص9.
[3] إعجاز القرآن، للباقلاني، ص35.
[4] إعجاز القرآن، للباقلاني، ص38.
[5] إضماده: يقصد تلاحمه والتئامه فهو من ضمد الجرح؛ أي شدّه بعصابة حتى يلتئم.
[6] الشقاشق: الذي يتفيهق بكلامه ويسرده سردًا ولا يبالي بما قال مِن صدقٍ أو كذب، وهو وصف يوصف به الخطباء.
[7] الكشاف، للزمخشري، دار الريان للتراث- القاهرة/ دار الكتاب العربي- بيروت، الطبعة الثالثة، 1407هـ= 1987م، (3/ 387).
[8] التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب، للرازي، دار إحياء التراث العربي- بيروت، الطبعة الثالثة، 1420هـ، (7/ 106).
[9] التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب، للرازي، (27/ 570).
[10] انظر: وحدة السورة القرآنية عند علماء الإعجاز القدماء، د/ يحيى بن محمد عطيف، بحث منشور في مجلة الجامعة الإسلامية، العدد (174)، ص488- 490.
[11] حقق هذا الكتاب الدكتور محمد بن عمر بن سالم بازمول، ونشره مع كتابه: (علم المناسبات في السور والآيات)، طبعة المكتبة المكية- مكة المكرمة، الطبعة الأولى، 1423هـ= 2002م.
[12] انظر: أهداف كلّ سورة ومقاصدها في القرآن الكريم، د/ عبد الله شحاته، طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1976م، ص4، 5.
[13] انظر: وحدة السورة القرآنية عند بعض علماء الإعجاز المعاصرين، د/ يحيى بن محمد عطيف، بحث منشور في مجلة الجامعة الإسلامية، العدد (177)، ص235.
[14] الإتقان، للسيوطي، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1394هـ= 1974م، (1/ 86).
[15] البرهان في علوم القرآن، للزركشي، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية، الطبعة الأولى، 1376هـ= 1957م، (1/ 186).
[16] البحر المحيط، لأبي حيان، تحقيق: دقس محمد جميل، دار الفكر- بيروت، 1420هـ، (2/ 755).
[17] مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور، للبقاعي، مكتبة المعارف- الرياض، الطبعة الأولى، 1408هـ= 1987م، (1/ 149).
[18] الوجوه السياقية للسورة في الدراسات القرآنية، د/ سامي العجلان، دار التفسير- جدة، الطبعة الثانية، 1436هـ= 2015م، ص236.
[19] نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، للبقاعي، دار الكتاب الإسلامي- القاهرة، (1/ 18).
[20] الدر المنثور، للسيوطي، دار الفكر- بيروت، (5/ 245).
[21] المطالع والمقاطع وأثرها في الكشف عن مقاصد السور، د/ سعيد بوعصاب، مقال منشور بجريدة المحجة، العدد (490)، بتاريخ 23 فبراير 2018م
[22] المطالع والمقاطع وأثرها في الكشف عن مقاصد السور، المرجع السابق.
[23] المحرر الوجيز، لابن عطية، تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمية- بيروت، الطبعة الأولى، 1422هـ، (3/ 154).
كلمات مفتاحية
الكاتب:

علاء راجح عبد الحميد
حاصل على ماجستير اللغة العربية وآدابها من كلية الآداب – جامعة الإسكندرية، وله عدد من الأعمال العلمية.
مواضيع ذات صلة
((المعلومات والآراء المقدَّمة هي للكتّاب، ولا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع أو أسرة مركز تفسير))