الباقلاني ودراسته لإعجاز القرآن
الباقلاني ودراسته لإعجاز القرآن
الكاتب: رفيق أحمد
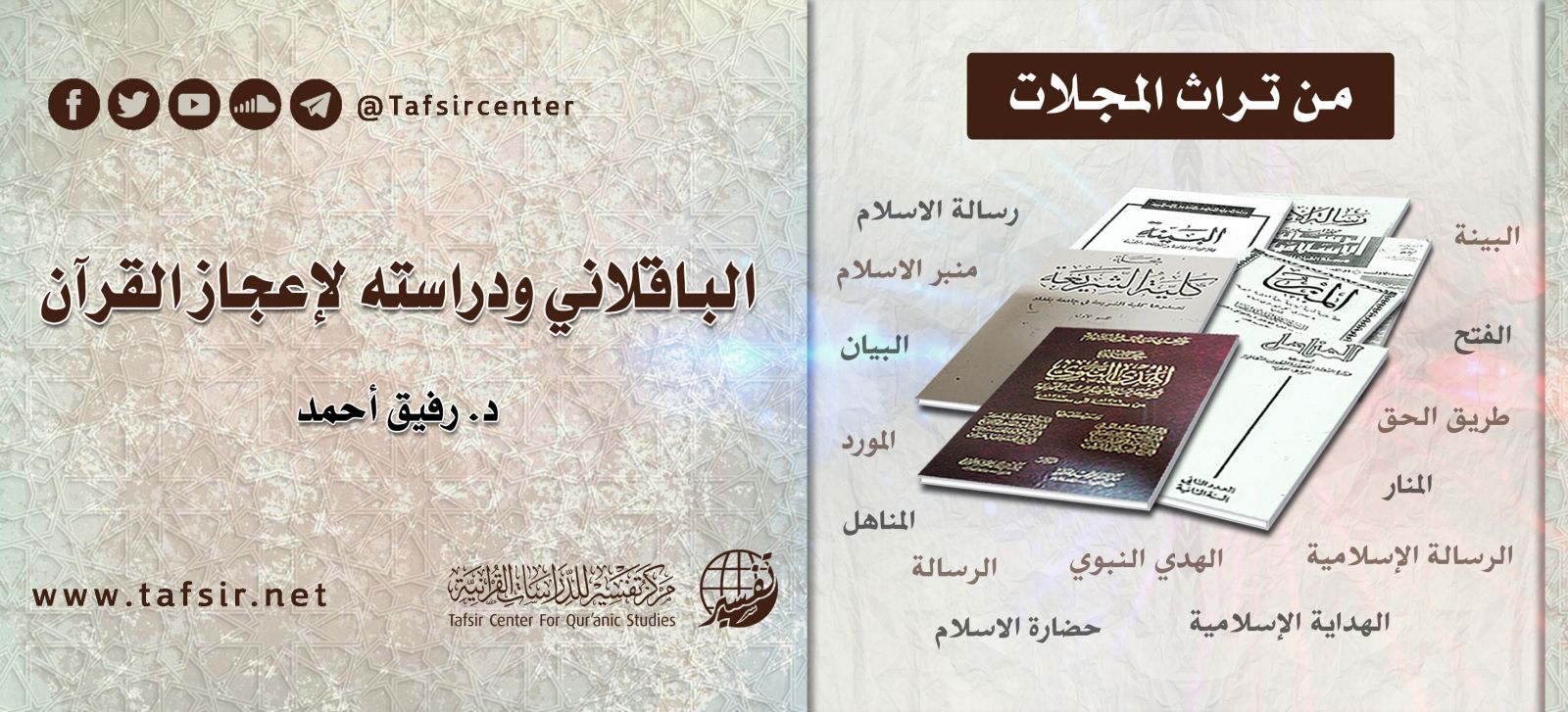
الباقلاني ودراسته لإعجاز القرآن[1]
أرسل اللهُ رسولَه محمدًا -صلى الله عليه وسلم- إلى كافة الناس وجعله خاتم النبيّين، وأيّده بمعجزات حِسّية كمعجزات مَن سبقه من المرسَلين، وخصّه بمعجزات عقلية خالدة وهي إنزال القرآن الكريم الذي لو اجتمعت الإنس والجنّ على أن يأتوا بمثله لم يستطيعوا ولم يقاربوا ولو كان بعضهم لبعض ظهيرًا، وظلّ الرسول -صلى الله عليه وسلم- يتحدّى المشركين الكافرين الذين يُنكرون معجزة القرآن بما كانوا يعتقدون في أنفسهم القدرة عليه والتمكّن منه ولم يزل يقرعهم بعجزهم حتى استكانوا وذلّوا.
ثم بظهور عصر الفتنة بدأت المطاعن في القرآن وظلّت تكثر، فنهض فريق من العلماء يدرؤون عنه وينافحون دونه، وشرعوا أقلامهم لتأليف الكتب والرسائل في الردّ على أعداء القرآن وتبيين مفترياتهم، وكانت مسألة إعجاز القرآن من أبرز المسائل التي تعاورها العلماء بالبحث في أثناء تفسيرهم للقرآن وردّهم على منكري النبوّة وخوضهم في علم الكلام.
وكان القاضي أبو بكر الباقلاني (ت:403هـ) من أعلام القرن الرابع الهجري الذي وهَب حياته وعِلمه للدفاع عن عقيدة السَّلَف، والردِّ على المخالفين والملحدين من الجهمية والمعتزلة والرافضة والخوارج وغيرهم.
وقد صنّف كتابه الشهير «إعجاز القرآن» الذي يعتبر مرجعًا وحيدًا في موضوع الإعجاز حتى الآن. وتُعَدّ آراء الباقلاني في إعجاز القرآن الترجمة العلمية لما جال في خاطره ولما خطر بباله حول الإعجاز، وفي هذه المقالة نحاول أن نحلّل دراسة الباقلاني لإعجاز القرآن، وقبل أن نشرع بتحليل دراسته للإعجاز يجدر بنا أن نتعرّف عليه.
تعريف بالباقلاني:
هو أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم المعروف بابن الباقلاني، أو بالباقلاني[2] نسبة إلى الباقلي وبيعه[3]، وُلِد بالبصرة وقضى فترة شبابه فيها قبل أن يهاجر منها إلى بغداد ليقيم فيها بقية حياته[4]. ولم يعيّن أحدٌ من المؤرخين عامَ ولادته كما لم يعيّن سنة هجرته إلى بغداد، وقد أُتيح للباقلاني أن يتتلمذ على طائفة من العلماء الذين جمعوا بين العلم والعمل، وكان لهم أكبر الأثر في تغذية عقليته وتنوّع اهتماماته العلمية.
فمن أساتذة الباقلاني الذين ورد ذكرهم في المصادر المختلفة[5]: أبو بكر محمد بن عبد الله الأبهري (289- 375هـ) شيخ المالكية في عصره، وقد أخذ عنه الباقلاني الفقه وصحبه فأطال صحبته، وبذلك يُعَدّ من كبار فقهاء المذهب المالكي، ومنهم أبو بكر جعفر بن مالك القطيعي (374- 368هـ) راوي مسند الإمام أحمد وقد أخذ عنه الحديث، ومنهم أبو محمد عبد الله بن إبراهيم بن أيوب بن ماسي (274- 369هـ)، وأبو عبد الله محمد بن جعفر الشيرازي (ت:373هـ) وقد أخذ عنه علم الأصول، بيدَ أنّ أشهر أساتذته أبو الحسن الباهلي البصري وأبو عبد الله محمد بن مجاهد الطائي، وهما صاحبا أبي الحسن الأشعري، وكانا أعرف العلماء بمذهب الأشعري وأشدّهم فقهًا له وأقواهم حُجّة في الدفاع عنه؛ إِذْ إنهما كانا من أقرب تلاميذه، وقد تلقى الباقلاني عليهما أصول المذهب.
وقد اتجه الباقلاني إلى علم الكلام نظرًا لكثرة الملحدين في العراق في القرن الرابع الهجري، وظهور مذهب أبي الحسن الأشعري (270- 330هـ) ودفاعه عن آرائه وجداله الشديد للمعتزلة وأنصارهم. وكان الباقلاني أعرف الناس بعلم الكلام وأحسنهم خاطرًا وأجودهم لسانًا وأوضحهم بيانًا وأصحّهم عبارة، وكان على مذهب الأشعري مؤيّدًا اعتقاده وناصرًا طريقته إلا أنه يثبت الصفات معاني قائمة به تعالى أحوالًا[6]، فهو يُعَدّ فيلسوف المذهب الأشعري الذي نفّذ تعاليمه؛ إِذْ عمل على نُصرة هذا المذهب وصار إمامًا له بعد أن تناوله بالتهذيب ووَضَع لمسائل العلم المقدّمات العقلية التي تتوقّف عليها بالأدلة والأنظار، وذلك مثل إثبات الجوهر الفرد والخلاء وأن العرَض لا يقوم إلا بالعرَض وأن العرَض لا يبقى زمانين وأمثال ذلك مما تتوقف عليه أدلتهم، وجعل هذه القواعد تبعًا للعقائد الإيمانية في وجوب اعتقادهم لتوقف تلك الأدلة عليها، وإن بطلان الدليل يؤذِن لبطلان المدلول[7]، ورأى ابن العماد الحنبلي (1089هـ) أنّ ابن تيمية (728هـ) قال: «إنه -الباقلاني- أفضل المتكلِّمين المنتسبين إلى أبي الحسن الأشعري وليس فيهم مثله لا قبله ولا بعده»[8].
وكان الباقلاني في علمه أوحد زمانه وانتهت إليه الرياسة في مذهبه (المالكي)، وكان موصوفًا في جودة الاستنباط وسرعة الجواب وكثير التطويل في المناظرة. يُروى أنه جرى بينه وبين أبي سعيد الهاروني مناظرة وأكثر الباقلاني فيها الكلام ووسع العبارة وزاد في الإسهاب، ثم التفت إلى الحاضرين وقال: «اشهدوا على أنه إن أعاد ما قلتُ لا غير لم أطالبه بالجواب». فقال الهاروني: «اشهدوا على أنه إن أعاد الكلام نفسه سلّمت له ما قال»[9].
وتتحدّث المصادر كثيرًا عن ذكاء الباقلاني وقوّة لسانه وحججه وسرعة بديهته واقتحامه للخصوم. فمن ذلك ما يُروى أنّ أبا عبد الله محمد بن محمد بن النعمان المعروف بابن المعلم (413هـ) -شيخ الرافضة ومتكلّم- حضر لبعض مجالس النظر مع أصحابه، إِذْ أقبل عليه الباقلاني فالتفتَ ابن المعلم إلى أصحابه وقال لهم: «قد جاءكم الشيطان»، فسمع الباقلاني كلامهم وكان بعيدًا من القوم، فلما جلس أقبل على ابن المعلم وأصحابه وقال لهم: «قال الله تعالى: {أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا}، أي: إن كنتُ شيطانًا فأنتم كفار وقد أُرسلت عليكم»[10].
وقد طار صيت الباقلاني وهو ما زال في فترة الشباب حتى وصل إلى أعلام المعتزلة بشيراز، وكانت شيراز في ذلك الوقت حاضرةَ ملك أبي شجاع فنّا خسرو بن ركن الدولة البويهي الذي آل إليه ملك فارس بعد وفاة عمّه عماد الدولة في سنة 338هـ فتلقب بعضد الدولة. وكان عضد الدولة أميرًا عظيم الهيبة واسع الثقافة مشاركًا في العلوم، وكانت له خزانة كتب عظيمة ولم يبقَ كتاب صُنّف إلى وقته من أنواع العلوم إلا وحصّله فيها، وقد أفرد في داره لأهل الخصوص والحكماء والفلاسفة موضعًا يقترب من مجلسه، فكانوا يجتمعون فيه للمغاوصة والمذاكرة. وكان مجلسه يحتوي على أعلام المعتزلة من مثل أبي سعيد بشر بن الحسين قاضي قضاة شيراز والأحداب رئيس المعتزلة ببغداد وأبي إسحاق النصيبيني رئيسهم بالبصرة وغيرهم، وقد لاحظ عضد الدولة خلوّ مجلسه من أهل السنّة. ولما بلغتْ شهرة الباقلاني إلى عضد الدولة كتب إلى عامله بالبصرة ليبعث الباقلاني إليه، فلما دخل الباقلاني إلى مجلس عضد الدولة وجرى ما جرى بينه وبين أعلام المعتزلة من المباحثة والمناقشة، عَلِمَ عضد الدولة ذكاء الباقلاني ومكانه من العلم والفهم؛ فعظّمه ورفع منزلته، ثم دفع إليه ابنه صمصام الدولة ليعلِّمه مذهب أهل السنّة فعلَّمه الباقلاني، وألّفَ له «كتاب التمهيد».
ولم يزل الباقلاني مع عضد الدولة إلى أن قَدِمَ بغداد، وكان دخوله إياها في سنة 367هـ، وظلّ الباقلاني أثيرًا لديه حتى إنه جعله رئيس البعثة التي أوفدها في سنة 371هـ إلى ملك الروم. وروى الخطيب البغدادي (463هـ) أنه لمّا ورد الباقلاني على ملك الروم بالقسطنطينية وعُرِّف خبره وبُيّن له محلّه من العلم فأفكر الملك في أمره وعلم أن لا يكفر له إذا دخل عليه كما جرى رسم الرعية أن تقبّل الأرض بين يدي الملوك. ثم نتجت له الفكرة أن يضع سريره الذي يجلس عليه وراء باب لطيف لا يمكن أحد أن يدخل منه إلا راكعًا، ليدخل الباقلاني منه على تلك الحال فيكون عوضًا من تكفيره بين يديه، فلما وضع سريره في ذلك الموضوع أمر بإدخال الباقلاني من الباب، فسار حتى وصل إلى المكان فلما رآه تفكّر فيه ثم فطن بالقصة، فأدار ظهره وحنى رأسه راكعًا ودخل الباب وهو يمشي إلى خلفه قد استقبل الملك بدبره، فعجب من فطنته ووقعتْ له الهيبة في نفسه[11].
ومما جرى في مجلس ملك الروم أن الباقلاني قال لبعض المطارنة: «كيف أنت وكيف الأهل والأولاد؟»، فقال له الملك وقد عجب من قوله: ذكَرَ من أرسلك في كتاب الرسالة أنك لسانُ الأُمة ومتقدّمٌ على علماء الملّة، أمَا علمتَ أننا ننزّه هؤلاء عن الأهل والأولاد؟ فقال الباقلاني: «أنتم لا تنزّهون الله سبحانه وتعالى عن الأهل والأولاد وتنزهونهم! فكأن هؤلاء عندكم أقدس وأجلّ وأعلى من الله سبحانه وتعالى! فسقط في أيديهم ولم يردُّوا جوابًا»[12]، فأراد الملك أن يُخزِيَ الباقلاني فقال له: أخبرني عن عائشة زوج نبيّكم وما قيل فيها، فأجابه «هما اثنتان قيل فيهما ما قيل؛ زوج نبيّنا ومريم أم المسيح، فأمّا زوج نبيّنا فلم تلد، وأمّا مريم فجاءتْ بولد تحمله على كتفها، وقد برّأهما الله مما رُميتا به» فانقطع ولم يُحِرْ جوابًا[13].
وعاد الباقلاني إلى بغداد وظلّ مع عضد الدولة حتى مات في سنة 372هـ وتولى بعده ابنه صمصام الدولة. وقد جاء في ترجمة أبي حامد أحمد بن أحمد الأستوائي الشافعي الأشعري (434هـ) أنه ولي القضاء (بعكبر) من قِبل أبي بكر بن الطيب الباقلاني، ولكنه لا يعلم بالتحديد أنه متى تولّى القضاء ومن الذي ولّاه[14].
وقد وقف الباقلاني حياته على أمرين اثنين: هما التدريس والتأليف. أمّا التدريس فقد اجتمعت له كلّ أدواته ولم يصرفه عنه صارف، حتى إنه في أثناء مقامه مع عضد الدولة بشيراز وتدريسه لابنه لم يمتنع عنه، بل عقد دروسًا عامّة لأهل السنّة، ومن الكتب التي درسها لهم كتاب «اللمع» لأبي الحسن الأشعري، وقد ارتوى عنده كثيرون من عَطَشِهم العلميِّ في البصرة وبغداد وغيرهما. وكان يبذل علمه في جامع المنصور ببغداد حيث كانت له حلقة كبيرة يلتحق فيها مقدّرو علمه وطالبو فضله. بيد أنه من أشهر تلاميذه أبو عبد الله الحسين بن حاتم الأزدي وأبو طاهر محمد بن عليّ المعروف بابن الأنباري (448هـ) اللذان هاجرا إلى المغرب العربي -القيروان- ونشرَا علمه هناك.
أمّا التأليف فقد أسهم فيه الباقلاني بنصيب موفور. وكان من عادته إنه إذا صلى العشاء وقضى وِرده وضع دواته بين يديه وكتب خمسًا وثلاثين ورقة من حفظه فإذا صلى الفجر دفع إلى بعض أصحابه ما صنفه ليلته وأمره بقراءته عليه وأملى عليه من الزيادات ما يلوح له فيه. وكان يهمّ بأن يختصر ما يصنّفه فلا يقدر على ذلك لسعة علمه وكثرة حِفْظه، ويروى أنّ أبا بكر الخوارزمي كان يقول: «إنّ كلّ مصنِّف ببغداد إنما ينقل من كتب الناس إلى تصانيفه، سوى الباقلاني فإنّ صدره يحوي علمه وعلم الناس»[15].
ومن المشهور أنّ الباقلاني صنّف سبعين ألف ورقة في الدفاع عن الدِّين[16]، وألّف نيفًا وخمسين كتابًا في الردّ على المخالفين والملحدين والمتفلسفين من المعتزلة والرافضة والجهمية والخوارج وغيرهم، وأشهر كتبه: إعجاز القرآن، وكتاب الانتصار، ومناقب الأئمة ونقض المطاعن على سلف الأمة، وكتاب الفَرق بين معجزات النبيين وكرامات الصالحين، وكتاب الإمامة الكبير، وكتاب الإيجاز، وكتاب كشف الأسرار، وكتاب الأصول الكبير في الفقه، وكتاب كيفية الاستشهاد، وكتاب نقض النقض، وكتاب الإبانة والرسالة الحريّة، وكتاب التمهيد، وهداية المسترشدين، وغيرها من الكتب الدينية ذات الصبغة الكلامية[17].
وعاصر الباقلاني مجموعة غير قليلة من العلماء النابهين الذين كان لهم شأنهم في تيار الثقافة الإسلامية؛ من هؤلاء إبراهيم بن محمد الأسفراييني (417هـ)، وأبو بكر محمد بن الحسن فورك (406هـ) وغيرهم، الذين شُهد لهم بالمقدرة العلمية. ومات الباقلاني في يوم السبت لسبع بقين من ذي القعدة سنة ثلاث وأربع مائة (403هـ) رحمة الله عليه. وصلى عليه ابنه الحسن ودفنه في داره بدرب المجوس من نهر طابق، ثم نقل بعد ذلك في مقبرة باب حرب في تربة بقرب قبر أحمد بن حنبل[18]، وقد رثى الباقلانيَّ بعضُ الشعراء بقوله[19]:
انظر إلى جبلٍ تمشي الرجال به ** وانظر إلى القبر ما يحوي من الصلف
وانظر إلى صارم الإسلام منغمدًا ** وانظر إلى دُرّة الإسلام في الصدف
وكان الباقلاني من العلماء الذين جمعوا بين العلم والعمل والزهد والتقوى، وكان وِرده في كلّ ليلة عشرين ترويحة في الحضر والسفر، وكان ما يضمره من الورع والدِّين أضعاف ما كان يظهره، فقيل له في ذلك فأجاب: «إنما أُظهر ما أظهره غيظًا لليهود والنصارى والمعتزلة والرافضة؛ لئلا يستحقروا علماء الحقّ»[20]، ويروى أنا أبا عبد الله بن مجاهد الطائي -أستاذ الباقلاني- رآه في المنام بعد موته وعليه ثياب حَسَنة في رياض خضرة ونضرة وسمعه يقرأ: «في عيشة راضية في جنة عالية»[21].
وروى الخطيب البغدادي أنّ أبا عبد الله محمد بن عبد الله البيضاوي قال: «رأيتُ في المنام كأني دخلت مسجدي الذي أدرّس فيه، فرأيتُ رجلًا جالسًا في المحراب وآخر يقرأ عليه ويتلو تلاوة لا شيء أحسن منها، فقلتُ: مَن القارئ ومَن الذي يقرأ عليه؟ فقيل لي: أمّا الجالس في المحراب فهو رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأمّا القارئ عليه فهو أبو بكر الأشعري يدرس عليه الشريعة[22].
دراسة الباقلاني لإعجاز القرآن:
يُعَدّ كتاب (إعجاز القرآن) للباقلاني أوّل كتاب صنّفه عالم من علماء السَّلَف في الردّ على مزاعم الملحِدين والمخالفين من الرافضة والجهمية والخوارج وغيرهم. وهو تأليف حول إعجاز القرآن وما يرتبط بهذا الإعجاز من مفاهيم ومضامين، وهو أعظم الكتب التي تناولتْ هذا الموضوع إلى اليوم معبرًا عن آراء السّلف من علماء القرن الرابع الهجري، الذي أجمع المتأخرون مِن بعده على أنه باب في الإعجاز على حدة[23].
حدّد الباقلاني في فاتحة كتابه منهجه في البحث وغايته منه. وقد اعتبر تأليف هذا الكتاب واجبًا دينيًّا في المرتبة الأولى إلى جانب كونه واجبًا علميًّا؛ ولذلك لم يدّخر وسعًا وهو بصدد تحليلاته. وغايته ترجع إلى عدد أمور؛ مثل كشف ما كان لأهل الدين قوامًا ولقاعدة التوحيد عمادًا ونظامًا، وإثبات ما جاء به النبي -صلى الله عليه وسلم- صدقًا وبرهانًا ولمعجزته ثبتًا وحُجّة للردّ على ما طعن فيه الطاعنون والملحدون حول أصول الدين. ثم نفي كلّ ما تقوَّله المتقوِّلون عن معادلة القرآن وموازنته بالشِّعْر اعتمادًا على ما توارثوه من أقوال ملحدة قريش وغيرهم[24].
وقد قسم الباقلاني كتابه إلى أربع مراحل أساسية كلّ مرحلة توصل إلى ما بعدها وترتبط بها؛ حتى يتّسم عمله بطابع الوضوح والتكامل الموضوعي والعلمي في آنٍ واحد. وهي: 1- مرحلة التمهيد. 2- مرحلة التفنيد. 3- مرحلة التحديد. 4- مرحلة التأييد والإثبات.
1- مرحلة التمهيد:
صدّر الباقلاني كتابه بمقدّمة تمهيدية حثّ فيها المسلمين على تدارك كتاب الله تعالى وفهم مضمونه ومشموله؛ للوقوف في وجه الملحدين والمضلّلين الذي خاضوا في أصول الدِّين وشكّكوا ضعاف الإيمان واليقين. واتخذ سبيلًا لذلك إبراز أهمية القرآن الكريم من حيث هو كتاب الله ومن حيث هو حجّة النبوّة ودليل على صِدْق الدعوة وصِدْق النبوّة، وبدأ هذا الأمر بتحفيز أهل الدين على النهوض بواجبهم المقدّس نحو الله والناس[25].
ثم تناول الباقلاني ما أذاعه الملحدون والمغرضون حول القرآن من أباطيل وافتراءات وردت سابقًا على ألسنة مشركي مكة من قريش منذ أن أنزل القرآن على النبي -صلى الله عليه وسلم-، وسفّه آراء هؤلاء الملحدين ووصفهم بالجهل والبُعد عن الرشد؛ وذلك أن مشركي مكة قد تابوا وأنابوا وأنار اللهُ بصائرهم وأبصارهم فأسلموا ورجعوا عن غيّهم، وأمّا هؤلاء الملحدون فهم على جهلهم وتعصّبهم الأعمى الذي لا يستند إلى دليل. ثم هو بصدد مواجهة هؤلاء الملحدين والمغرضين ألقى اللوم على علماء عصره، خاصةً من اشتغل منهم باللغة وعلم الكلام ولم يلتفت إلى توضيح وجوه الإعجاز القرآني والكشف عن أسرارها، وحمّلهم تبعة مَن خلط في هذه المسائل متأثرين ببعض مذاهب البراهمة. بيد أنه التمس لبعضهم الأعذار؛ لأن البحث في إعجاز القرآن لم يكن يتيسّر إلا لمن كدّ فكره وأعمل عقله وأعدّ لهذه الدراسة نفسه[26].
وبعد ذلك تعرّض الباقلاني لِما أُلِّف حول إعجاز القرآن وخالف ما عليه أهل السَّلَف عامة. وقد وجد بغيته في كتاب الجاحظ (255هـ) المعتزلي «نَظْم القرآن» -وهو من كتبه المفقودة- فوصفه بالقصور والسطحية وعدم الموضوعية وأنه لم يأتِ فيه بجديد، بل هو ناقل مردّد لما قاله المتكلِّمون قبله، ولم يكشف عما يلتبس في أكثر هذا المعنى[27]، والملاحظ أن الباقلاني السّلفي متأثّر في قوله هذا بعقيدته وبما قاله الأشاعرة.
ثم وضح الباقلاني منهج بحثه بأنه يذكر «جملة من القول جامعة تُسقط الشبهات وتزيل الشكوك التي تَعرِض للجهال، وتنتهي إلى ما يخطر لهم ويعرض لإفهامهم من الطعن في وجه المعجزة. ويتناول مجموعة من القضايا العلمية المهمة التي تتصل بموضوع الإعجاز؛ فمنها ما يجب وصفه من القول في تنزيل متصرفات الخطاب وترتيب وجوه الكلام، وما تختلف فيه طرق البلاغة وتتفاوت من جهته سبل البراعة، وما يشتبه له ظاهر الفصاحة ويختلف فيه المختلفون من أهل صناعة العربية والمعرفة بلسان العرب في أصل الوضع، ثم ما اختلفت به مذاهب مستعمليه في فنون ما ينقسم إليه الكلام من شِعْر ورسائل وخطاب وغير ذلك من مجارى الخطاب، وإن كانت هذه الوجوهُ الثلاثة أصولَ ما يبين فيه التفاصح وتقصد فيه البلاغة؛ لأن هذه أمور يتعمل لها في الأغلب ولا يتجوز فيها، وما يجب في كلّ واحد من هذه الطرق؛ ليعرف عِظَم محل القرآن وليعلم ارتفاعه عن مواقع هذه الوجوه، وتجاوزه الحد الذي يصح أو يجوز أن يوازن بينه وبينها أو يشتبه ذلك على متأمّل»[28].
2- مرحلة التفنيد:
وإذ انتهى الباقلاني من مرحلة التمهيد وبيّن هدفه ومبتغاه انتقل إلى المرحلة الثانية وهي مرحلة التفنيد، فقسّم بحثه إلى فصول متوالية كلّ فصل يرتبط بما بعده ويتصل بما قبله. وتناول في كلّ فصل منها ناحية من النواحي التي وعد ببحثها تمهيدًا لإبراز وجوه الإعجاز القرآني، فافتتح هذه الفصول بفصل تحدّث فيه عن نبوّة النبي -صلى الله عليه وسلم- وأنّ معجزتها القرآن، فالرسول وإن كان قد أُيّد بعد ذلك بمعجزات جمّة لا يمكن إنكارها، إلا أنّ معجزة القرآن كانت معجزة عامة عصمت الثقلين (الإنس والجن)، وبقيت العصرين (الليل والنهار)، ولزوم الحُجّة بها في أول وقت ورودها إلى يوم القيامة على حدٍّ واحد، وإن كان قد يعلم بعجز أهل العصر الأول على الإتيان بمثله وجه دلالته[29].
ولقد خصّص الباقلاني هذا الفصل للردّ على المتكلمين وتفنيد مزاعمهم، لما حكى عن بعضهم زعم أنه وإن كان قد عجز عنه أهل العصر الأول فليس أهل هذا العصر بعاجزين عنه، يكفي عجز أهل العصر الأول في الدلالة لأنهم خُصّوا بالتحدي دون غيرهم، وبيّن الباقلاني خطأ هذا الزعم واستدلّ على ذلك بأدلة من القرآن نفسه، وبآيات بينات تثبت أن الله تعالى حين بعث نبيّه جعل معجزته القرآن وبنى أمر نبوّته عليه. من ذلك قوله تعالى: ﴿الر كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ﴾ [إبراهيم: 1]، فأخبر أنه أنزله ليقع الاهتداء به، ولا يكون كذلك إلا وهو حجة، ولا يكون حجة إن لم يكن معجزة. وكذلك قوله تعالى: ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ﴾[التوبة: 6]، فلولا أنّ سماعه إياه حُجّة عليه لم يقف أمره على سماعه، ولا يكون حُجّة إلا وهو معجزة. وغيرهما من الآيات الدالة على أن نبوّة النبي -صلى الله عليه وسلم- معجزتها القرآن.
وهكذا لاحظ الباقلاني أنه ما من سورة افتتحت بذِكْر الحروف المقطعة إلا وتدلّ على هذه المعجزة، بل إنّ كثيرًا من السور، إذا تُؤمّل، فهو من أوله إلى آخره مبنيّ على لزوم حُجّة القرآن والتنبيه على وجه معجزته، واستشهد على ذلك بسورتي (غافر) و(فصّلت)، وحلّلهما تحليلًا دقيقًا يبرز أسرار الإعجاز[30].
ثم أعقب الباقلاني هذا الفصل بفصل في الدلالة على أنّ القرآن معجزة في ذاته. وقد اعتمد في تبيين وجه الدلالة على أصلين؛ فالأصل الأول هو إثبات أنّ القرآنَ الذي هو متلوّ محفوظ مرسوم في المصاحف =هو الذي جاء به النبي -صلى الله عليه وسلم-، وأنه هو الذي تلاه على مَن في عصره ثلاثًا وعشرين سنة. والطريق إلى معرفة ذلك هو النقل المتواتر الذي يقع عنده العلم الضروري به؛ وذلك أنه قام به في المواقف، وكتب به إلى البلاد، وتحمّله عنه إليها مَن تابعه، وأورده على غيره من لم يتابعه؛ حتى ظهر فيهم الظهور الذي لا يشتبه على أحد، ولا يخيّل أنه قد خرج من أتى بقرآن يتلوه ويأخذه على غيره على الناس حتى انتشر ذلك في أرض العرب كلّها، وتعدّى إلى الملوك المصاحبة لهم كملوك الروم والعجم والقبط والحبش وغيرهم من ملوك الأطراف[31].
والأصل الثاني هو التحدّي الذي واجه العرب به؛ ذلك أنه تحدّاهم على أن يأتوا بمثله وقرّعهم على ترك الإتيان به طول السّنين، فلم يأتوا بذلك، واستدلّ الباقلاني على صحّة هذا الأصل بما تضمّنه القرآن من آيات التحدي، من مثل قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ﴾ [البقرة: 23- 24]، وغيرها من آيات التحدي[32]، ثم عقّب عليها بقوله: «فجعل عجزهم عن الإتيان بمثله دليلًا على أنه منه، ودليلًا على وحدانيته»[33].
ثم كشف الباقلاني عن المعاني التي استقصى أهل علم الكلام فيها قبله وما جاء به بعدهم، وذكر أنّ النبي -صلى الله عليه وسلم- عرف كون القرآن معجزًا حين أُوحي إليه من قبل أن يقرأه على غيره أو يتحدّى إليه سواه. وأفاض في إبطال قول القائلين بالصّرفة[34]، ووضح لِمَ لمْ يكن الكتب السماوية غير القرآن معجزًا، وقال إن التوراة والإنجيل وغيرها من كلام الله يشارك القرآن في الإعجاز بما تضمّنه من الإخبار عن الغيوب، ويباينه في أنه ليس بمعجز في النَّظْم والتأليف؛ لأنّ الله لم يصفه بما وصف به القرآن، ولم يقع به التحدي كما وقع بالقرآن، ولأنّ الألسنة التي نزل بها لا يتأتّى فيها من وجوه الفصاحة ما يقع به التفاضل الذي ينتهي إلى حد الإعجاز.
3- مرحلة التحديد:
وبعد أن اجتاز الباقلاني مرحلتي التمهيد والتفنيد وأثبت معجزة النبوّة وأصّل الأصول التي اعتمدها في بيان وجه الدلالة على أن القرآن معجز في ذاته، انتقل إلى صلب موضوعه وهو تحديد وجوه إعجاز القرآن، وتبدأ مرحلة التحديد بالفصل الثالث من كتاب إعجاز القرآن، وقد قرّر الباقلاني فيه أن هذا الإعجاز يُرَدُّ إلى ثلاثة أوجه، وهي كما يأتي:
1- ما تضمّنه القرآن من الإخبار عن الغيوب مما لا يقدر عليه البشر ولا سبيل لهم إليه. فمن ذلك ما وعد الله تعالى نبيّه -صلى الله عليه وسلم- أنه سيُظْهِر دينه على الأديان بقوله -عز وجل-: ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ﴾[التوبة: 33]. ففعل ذلك.
2- ما فيه من القصص الدينية وعظيمات الأمور وسير الأنبياء من حين خلق الله آدم إلى مبعث النبي -صلى الله عليه وسلم- مما روته الكتب السماوية، مع أنّ النبي -صلى الله عليه وسلم- كان أُميًّا لا يكتب ولا يُحْسِن أن يقرأ، ولم يكن يعرف شيئًا من كتب المتقدّمين وأقاصيصهم وأنبائهم وسيرهم.
3- بلاغة القرآن، وذلك أنه بديع النَّظْم عجيب التأليف متناهٍ في البلاغة إلى الحد الذي يُعلم عجزُ الخلق عنه.
ولما كان الباقلاني من علماء اللغة والأدب والبلاغة فقد ركّز شرحه على هذا الوجه الأخير؛ فتحدث عن جمال النَّظْم القرآني حديثًا يتّضح منه مفهومه ونظريته في إعجاز القرآن، ولقد أرجع جمال النَّظْم القرآني إلى مجموعة وجوه تتسم بالدّقة والعمق وترابط جزئيات الموضوع في ذهنه. وبيان هذا الوجه فيما يأتي[35]:
1- ما يرجع إلى الجملة، وذلك أنّ نَظْمَ القرآن على تصرّف وجوهه وتبايُن مذاهبه خارجٌ عن المعهود من نظام جميع كلامهم ومباينٌ للمألوف من ترتيب خطابهم، وله أسلوب يختصّ به ويتميّز في تصرفه عن أساليب الكلام المعتاد.
2- ما يرجع إلى الفصاحة، وذلك أنه ليس للعرب كلام مشتمل على هذه الفصاحة والغرابة والتصرّف البديع والمعاني اللطيفة والفوائد الغريزة والحِكَم الكثيرة والتناسب في البلاغة والتشابه في البراعة على هذا الطول وعلى هذا القدر.
3- ما يرجع إلى النَّظْم، وذلك أنّ عجيب نَظمه وبديع تأليفه لا يتفاوت فيه، ولا يتباين على ما يتصرّف فيه من الوجوه التي يتصرف فيها مِن ذِكر قصص ومواعظ واحتجاج وغيرها. وإنما هو على حدٍّ واحد في حسن النَّظْم وبديع التأليف ورصفٍ لا تفاوت فيه ولا انحطاط عن المنزلة العليا، بخلاف كلام الناس فإنه يتفاوت ويتخالف من موضوع إلى موضوع، ومن أجلِ ذلك كان النقاد يلاحظون على الشعراء تقصيرهم في بعض الموضوعات وأنهم يحسنون في بعضها دون بعض.
4- إنّ نَظْم القرآن لا يتفاوت في الصور البيانية والتعبيرية كما أنّ كلام الفصحاء يتفاوت تفاوتًا بيّنًا في الفصل والوصل والعلو والتنزيل والتقريب والتبعيد، وغير ذلك مما ينقسم إليه الخطاب عند النَّظْم، وهذا أمر عجيب تبين به الفصاحة وتظهر به البلاغة.
5- أنّ نَظْم القرآن وقع موقعًا في البلاغة يخرج عن عادة كلام الجنّ كما يخرج عن عادة كلام الإنس، وهم يعجزون عن الإتيان بمثله كعجزنا، ويقصرون دونه كقصورنا.
6- إنّ الذي ينقسم عليه الخطاب من البسط والاقتصار والجمع والتفريق والاستعارة والتصريح وغيرها من الوجوه التي توجد في كلامهم موجودة في القرآن، وكلّ ذلك مما يتجاوز كلامهم المعتاد بينهم في الفصاحة والإبداع والبلاغة.
7- إنّ المعاني التي تضمنها في أصل وضع الشريعة والأحكام والاحتجاجات في أصل الدّين والردّ على الملحدين على تلك الألفاظ البديعة وموافقة بعضها بعضًا في اللّطف والبراعة؛ مما يتعذّر على البشر ويمتنع.
8- إنّ الكلام يتبيّن فضله ورجحان فصاحته بأن تذكر منه الكلمة في تضاعيف الكلام، أو تقذف ما بين شعر فتأخذها الأسماع وتتشوق إليها النفوس، ويُرى وجه رونقها باديًا غامرًا سائر ما تقرن به. ومما يكشف عن روعة نَظْم القرآن أنّ الكلمة منه إذا ذُكرت في تضاعيف كلام تتألّق بين جاراتها تألقًا.
9- إنّ القرآن وَضَع حروفًا في مطالع بعض السور تبلغ عدّتها أربعة عشر، وهي بذلك نصف حروف المعجم. ومعنى ذلك أنّ كلامه منتظم من نفس الحروف التي يستخدمونها، ومع ذلك عجزوا عجزًا تامًّا من معارضته.
10- إنّ نَظْم القرآن سهل المأخذ وخارج عن الوحشي المستكره والغريب المستنكر وعن الصناعة المتكلفة.
وقد أشبع الباقلاني هذه الوجوه العشرة البلاغية شرحًا وتحليلًا وتمثيلًا وألحق بكلٍّ منها ما يؤيّد وجهة نظره، واستشهد بالكثير من الشواهد الشِّعْرِية والنثرية والآيات القرآنية. وواضح من تقسيمات الباقلاني أنه تأثّر في الشطر الأول من نظريته بفكرة الجاحظ التي ذهب فيها إلى أنّ مرجع الإعجاز في القرآن إلى نَظْمِه وأسلوبه العجيب المباين لأساليب العرب في الشِّعْر والنثر وما يطوى فيه من سجع[36]، وأمّا في الشطر الثاني من نظريته فتأثّر بفكرة الرماني (عليّ بن عيسى 376هـ) التي ذهب فيها إلى أنّ القرآن يرتفع إلى أعلى طبقة من طبقات البلاغة[37].
ولم يقتصر الباقلاني على حدود النثر، بل انطلق إلى آفاق الشعر فدرس معلقة امرئ القيس وبيّن ما فيها من تكلّف وحشو وخَلل وتطويل ولفظ غريب، وكيف تتفاوت أبياتها بين الجودة والرداءة والسلاسة والغربة والسلامة والانحلال والاسترسال والتوحش والاستكراه مع «أنه قد أبدع في طرق الشِّعْر أمورًا اتُّبع فيها»[38].
ثم عاد الباقلاني بنا ليتحدّث عن جمال نَظْم القرآن وحُسن تأليفه ورصفه وكيف أنه وزّع على كلّ آياته بقسطاس سواء منها القصص وغير القصص، بينما يتفاوت كلام البلغاء من الشعراء حتى في القصيدة الواحدة. وتناول قصيدة بديعة للبحتري الذي اشتهر بجمال ديباجته وحلاوة أنغامه وعذوبة ألفاظه، وهي لاميته المشهورة[39]:
أهلًا بذلكم الخيال المقبل ** فعل الذي نهواه أو لم يفعل
فشرّح أبياتها تشريحًا مبيّنًا ما يجري فيها من ثقل وتطويل وحشو وتكلّف وألفاظ وحشية جافية، ومن تناقض وكزازة وتعسّف ورداءة صوغ وسبك.
وهكذا نقض الباقلاني أسلوب الجاحظ بأنّ كلامه قريب ومنهاجه معيب ونطاق قوله ضيق. ومن أجلِ ذلك يستعين بكلام غيره ويفزع إلى ما يوشح به كلامه من بيت سائر ومثل نادر وحكمة منقولة وقصة مأثورة، فإذا أطال ولم يستعن بكلام غيره كان كلامه ككلام غيره، وزعم الباقلاني أن ابن العميد سلك مسلك الجاحظ ونازعه طريقته فلم يقصر عنه ولعله قد بان تقدمه على الجاحظ لأنه يأخذ في الرسالة الطويلة فيستوفيها على حدود مذهبه ولا يقتصر على أن يأتي بالأسطر من نحو كلامه[40].
وبعد ذلك عقد الباقلاني فصلًا في وصف وجوه البلاغة، وذكر أن البلاغة على عشرة أقسام؛ مثل الإيجاز والتشبيه والاستعارة والتلاؤم والتواصل والتجانس والتصريف والتضمين والمبالغة وحسن البيان، وبيّن هذه الأقسام وعلّق عليها تعليقات شتى. فكل ذلك ليدلل الباقلاني على أن بلاغة القرآن لا تسمو إليها أيّ بلاغة لشاعر أو كاتب. وكأنه في ذلك يشرح ما ذكره الرماني كما أسلفنا من أن الكلام ثلاث طبقات: عليا وهي طبقة القرآن، ووسطى، ودنيا، وهما طبقتا البلغاء على اختلاف بلاغتهم وما ينظمونه أو يخطبون به أو يكتبون. ونراه دائمًا يردّد أن كلام البلغاء يتفاوت بينما نَظْم القرآن لا يتفاوت آيةً. وأن العبارة لتُجلب منه إلى كلام البليغ فإذا هي تتلألأ كأنها الدرّة الوسطى في العقد. ومضى الباقلاني قائلًا أنّ القرآن ليس معجزًا لأهل العصر الأول الذي نزل فيهم فحَسْب بل هو أيضًا معجز لأهل كلّ العصور.
هذا هو ما يتعلّق بدراسة الباقلاني لإعجاز القرآن، ومن الملاحظ أنه لم يزد في كتابه إعجاز القرآن عن شرحه لما قاله الجاحظ من جمال نَظْم القرآني وما قاله الرماني من أنه في المرتبة العليا من البلاغة والبيان، ومضى يردّد تفسير هذه المرتبة بوجوه البديع التي عدّها ابن المعتز وقدّامة والعسكري وغيرهم، كما ردّد تفسيرها بوجوه البلاغة التي ذكرها الرماني، إلا أنه لاحظ في ذلك كلّه النّظْم وروعة التأليف، فالمدار قبل كلّ شيء على الصياغة والنّظْم. واستمد بهذا الفرع من التصنيف في الإعجاز، واحتمل المؤنة فيه بجملتها من الكلام والعربية والبيان والنقد. وحَسْبه أنه أوّل من هاجم في قوّة نظرية إعجاز القرآن عن طريق تصوير ما فيه من وجوه البديع ومن وجوه البلاغة. ومن هنا تأتي أهميته إذا أُعد للبحث عن أسرارٍ في نَظْم القرآن من شأنها حين توضح توضيحًا دقيقًا أن يقف الناس على إعجازه.
4- مرحلة التأييد والإثبات:
تبدأ هذه المرحلة بالفصل الرابع من كتاب إعجاز القرآن الذي عقده الباقلاني لشرح ما بيّنه من وجوه إعجاز القرآن الثلاثة السابقة؛ وهي الإخبار عن الغيوب، والأنباء عن قصص الأوّلين وسير المتقدِّمين، وبراعة النَّظْم والتأليف والرصف. فقد تناول وجهًا وجهًا من هذه الوجوه الثلاثة ليعاود الكلام عليها ولكن بتركيز شديد وبشواهد جديدة، ولقد ذكر مجموعة من العناصر التي جعلت من نَظْم القرآن وجهًا من وجوه الإعجاز؛ منها أنه نَظْم خارج عن جميع وجوه المعتاد في كلامهم ومباين لأساليب خطابهم، ومن ادّعى ذلك لم يكن له بُدّ من أن يصحح أنه ليس من قبيل الشِّعْر ولا السَّجْع ولا الكلام الموزون غير المقفّى. وهنا نلاحظ أنّ الباقلاني يشير إلى نقطة الانطلاق التي سيبدأ منها الدفاع، فيقول: «لأنّ قومًا من كفار قريش ادّعَوا أنه شِعْر، ومن الملحدة من يزعم أن فيه شِعْرًا، ومن أهل الملّة من يقول أنه كلام مسجَّع إلا أنه أفصح مما قد اعتادوه من أسجاعهم، ومنهم من يدّعي أنه كلام موزون فلا يخرج بذلك عن أصناف ما يتعارفونه من الخطاب»[41].
فقد نفى الشِّعْر عن القرآن في الفصل الخامس كما نفى السّجْع في الفصل السادس. ثم ذكر الصور البيانية والعناصر الجمالية التي يمكن أن يقع بها إعجاز القرآن، وهذا ما فعله الباقلاني تدعيمًا لوجوه الإعجاز وتأييدًا لما ذهب إليه من آراء أثناء ردّه على المزاعم التي قِيلت حول القرآن.
وملاحظ أنّ نفي السّجْع عن القرآن لم يكن من بنات أفكار الباقلاني، ولكنه ردّد ما ذكره الرماني من أن فواصله تباين السّجْع مباينة تامّة؛ إذ الفواصل تتبع المعنى، وأمّا السّجع فيتبعه المعنى. ومن أجل ذلك يتّضح فيه التكلّف والثقل[42].
وخصّص الباقلاني الفصل السابع لذِكْر البديع من الكلام، وهو كعادته حيث يتصدّى لموضوعٍ ما يتساءل: هل يمكن أن يعرف إعجاز القرآن من جهة ما تضمّنه من البديع؟ والملاحظ أنه لم يقصد بالبديع المعنى الاصطلاحي المعروف، وإنما قصد ما جاء في القرآن من ألوان الجمال المعنوي التي تشملها علوم البلاغة. وقد حدّد في هذا الفصل الأبواب والفصول التي ذكرها أهل الصنعة ومَن صنف في هذا المعنى، أيْ إعجاز القرآن. ثم بيّن ما عجزوا عن فهمه أو الوصول إلى كنهه، «ليكون الكلام -على حدّ تعبيره- واردًا على أمر مبين وباب مقرّر مصون»[43].
استعرض العناصر البلاغية التي تناولها القوم وذكروها بوصفها النوافذ التي يمكن من خلالها أن يُطِلُّوا على آيات الإعجاز القرآني، وتحدّث فيه مثل حديث البلاغيين السابقين من أمثال ابن المعتز (296هـ)، وقدامة بن جعفر (337هـ)، وأبي هلال العسكري (395هـ)، وغيرِهم[44] عن الاستعارة والتشبيه والإرداف والمماثلة والمطابقة والجناس، وذكر ضربًا سمّاه «الموازنة»، وهي مما زاده قدامة في جواهر الألفاظ من حسن البلاغة وقد سمّاها «اعتدال الوزن»، وذكر أيضًا المساواة على أنها ضرب من البديع مقتديًا بقدامة في هذا الصنيع، وتأثّر به في حديثه -عقب ذلك- عن الإشارة والمبالغة والغلو والإيغال والتوشيح وصحّة التفسير والتفهيم والترصيع.
ومضى الباقلاني متأثّرًا به يذكر «التكافؤ» وقال أنه قريب من المطابقة، مع أن قدامة يريد به المطابقة نفسها. وذكر عقب ذلك «التعطف» وهو نفس ما سمّاه قدامة باسم «المطابق»، وتحدّث كأبي هلال العسكري عن السّلب والإيجاب فنًّا مستقلًّا عن الطباق، ثم ذكر من البديع الكناية والتعريض، مقتديًا بابن المعتز، وتابع قدامة في ذِكْر العكس والتبديل، هكذا تحدّث عن الالتفات والاعتراض، والرجوع والتذييل، والاستطراد وغيرها. وظلّ ينتقل من موضوع بلاغي إلى آخر ومن صورة شِعْرية فنية إلى أخرى، ملقيًا الضوء على ما فيها من أبعاد وظلال فنية، حتى أتى على كلّ العناصر البلاغية التي تناولها العلماء وظنّوا أنها السبيل إلى معرفة أسرار الإعجاز القرآني.
بيد أنه في آخر المطاف وضع أمام الأذهان سؤالًا مهمًّا: هل لأبواب البديع فائدة في معرفة الإعجاز؟ وأجاب عن هذا السؤال إجابة صريحة، فقال: «ليس كذلك عندنا لأنّ هذا الوجه إذا وقع التنبيه عليها أمكن التوصّل إليها بالتدريب والتعوّد والتصنّع لها... وإنه لا سبيل إلى معرفة إعجاز القرآن من البديع الذي أودعوه في الشِّعْر ووضعوه فيه؛ وذلك أن هذا الفنّ ليس فيه ما يخرق العادة ويخرج عن العُرْف، بل يمكن استدراكه بالتعلم والتدريب به والتصنّع له... وأمّا شأو نَظْم القرآن فليس له مثال يُحتذى عليه ولا إمام يُقتدى به، ولا يصح وقوع مثله اتفاقًا»[45].
فما السبيل إذًا إلى معرفة إعجاز القرآن؟ هذا هو محور الفصل الثامن الذي خصّه الباقلاني لتحديد «كيفية الوقوف على إعجاز القرآن»، وقد لاحظ أنه لا يقف على الإعجاز إلا مَن عرف معرفة بيّنة وجوه البلاغة العربية، وتكوّنت له فيها مَلكة يقيس بها الجودة والرداءة في الكلام، بحيث يميز بين نمط شاعر وشاعر ونمط كاتب وكاتب، وبحيث يعرف مراتب الكلام في الفصاحة، وهذا كما يميّز أهل كلّ صناعة صنعتهم، فقال: «ومتى تقدّم الإنسان في هذه الصنعة لم تَخْفَ عليه هذه الوجوه ولم تشتبه عنده هذه الطرق، فهو يميز قدر كلّ متكلّم بكلامه، وقدر كلّ كلام في نفسه ويحلّه محلّه، ويعتقد فيه ما هو عليه ويحكم فيه بما يستحقّ من الحكم، وإن كان المتكلّم يجود في شيء دون شيء عرف ذلك منه، وإن كان يعمّ إحسانه عرف»[46].
وبهذا المفهوم نستطيع أن نلاحظ أن الباقلاني يردّ المسألة إلى الذّوْق وحُسن تدرّبه على تمييز أصناف الكلام، ولقد دفعه هذا الفهم إلى أن يسوق طائفة من خُطب الرسول -صلى الله عليه وسلم- ورسائله ومن خطب الصحابة وغيرهم ليلمس القارئ فرق ما بين ذلك كلّه وبين القرآن، ولم يقف فيها من وجوه الفصاحة على ما يقع التفاضل الذي ينتهي إلى حدّ الإعجاز، ثم ردّ على ما يزعمه المجوس من أنّ كتابي زرادشت وماني، معجزان لأنهما زاخران بالشعوذة، كما ردّ ما يُزعَم من أنّ ابن المقفع عارض القرآن بكتابه اليتيمة، وقال: «إنّ ما به من حكمة يوجد عند كلّ أمة، على أنه نقل حكمه عن كتاب بزرجمهر، حكيم الفرس المشهور فليس له فيها فضل ولا مزية»[47].
[1] نُشرت هذه المقالة في مجلة «المجمع العلمي الهندي»، العدد (1)، 1 فبراير 1992م. (موقع تفسير).
[2] تاريخ بغداد، الخطيب البغدادي، مطبعة السعادة- مصر 1931م، (5/ 379).
[3] الأنساب، السمعاني، دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد- الهند 1963م، (2/ 53). وفيات الأعيان، ابن خلكان، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة 1948م، (3/ 400).
[4] سير أعلام النبلاء، شمس الدين الذهبي. مؤسسة الرياسة- بيروت 1990م، (17/ 190).
[5] مقدمة تحقيق إعجاز القرآن، السيد أحمد صقر. دار المعارف- مصر، ط3، دون تاريخ، ص18.
[6] الملل والنحل، الشهرستاني، تحقيق: سيد كيلاني. دار المعرفة- بيروت، د.ن. (1/ 95).
[7] المقدمة، ابن خلدون. دار الفكر- بيروت 1977م، ص388.
[8] شذرات الذهب، ابن العماد الحنبلي، دار الميسرة- بيروت 1979م، (3/ 170).
[9] وفيات الأعيان، (3/ 400).
[10] تاريخ بغداد، (5/ 279).
[11] تاريخ بغداد، (5/ 973- 380).
[12] سير أعلام النبلاء، (17/ 191).
[13] البداية والنهاية، أبو الفداء ابن كثير، دار الفكر- بيروت، د.ن. (11/ 350).
[14] مقدمة تحقيق إعجاز القرآن، ص33.
[15] تاريخ بغداد، (5/ 380).
[16] سير أعلام النبلاء، (17/ 193).
[17] هدية العارفين، إسماعيل باشا البغدادي، مكتبة المُسمى- بيروت 1955م، (2/ 383).
[18] تاريخ بغداد، (5/ 382).
[19] وفيات، (3/ 383).
[20] سير أعلام النبلاء، (17/ 191- 192).
[21] شذرات الذهب، (3/ 170).
[22] تاريخ بغداد، (5/ 381).
[23] تاريخ آداب العرب، مصطفى صادق الرافعي- بيروت 1974م، (2/ 153).
[24] إعجاز القرآن، ص7.
[25] إعجاز القرآن، ص3- 4.
[26] إعجاز القرآن، ص4- 5.
[27] إعجاز القرآن، ص6.
[28] إعجاز القرآن، ص6- 7.
[29] إعجاز القرآن، ص8.
[30] إعجاز القرآن، ص68، وما بعدها.
[31] إعجاز القرآن، ص16.
[32] ومن آيات التحدي: الآيتان 13 و14 من سورة هود، والآيتان 33 و34 من سورة الطور، والآية 88 من سورة الإسراء، والآية 28 من سورة يونس.
[33] إعجاز القرآن، ص17.
[34] والقائلون بالصّرفة هم النّظّام وعباد بن سليمان وهشام القرطبي ومَن تابعهم من المعتزلة، وهم يزعمون أنه ليس في نَظْم القرآن وتأليفه إعجاز وأنه يمكن معارضته ولكن الله صرَف العباد بمنعٍ وعجزٍ عن معارضته. راجع: مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري، مطبعة السعادة- مصر 1323هـ، ص225. وأيضًا: إعجاز القرآن، ص65.
[35] إعجاز القرآن، ص33 وما بعدها.
[36] البيان والتبيين، الجاحظ، لجنة التأليف والترجمة والنشر بمصر، (1/ 373).
[37] النكت في إعجاز القرآن، الرماني، طبع دهلي- الهند 1934م، ص18. وأيضًا: البلاغة: التطور والتاريخ، شوقي ضيف، دار المعارف 1977، ص109.
[38] إعجاز القرآن، ص158.
[39] إعجاز القرآن، ص219 وما بعدها، والقصيدة في ديوان البحتري، طبع ببيروت 1911م، (2/ 730- 724).
[40] إعجاز القرآن، ص247 - 248.
[41] إعجاز القرآن، ص50.
[42] النكت في إعجاز القرآن، ص19.
[43] إعجاز القرآن، ص101.
[44] راجع: كتاب البديع، ابن المعتز، نشر كراتشقوفسكي، ص3 وما بعدها. جواهر الألفاظ قدامة بن جعفر، طبعة القاهرة، ص3 وما بعدها. كتاب الصناعتين، العسكري، طبعة الحلبي، ص420 وما بعدها.
[45] إعجاز القرآن، ص107، 111- 112.
[46] إعجاز القرآن، ص120.
[47] إعجاز القرآن، ص32.
كلمات مفتاحية
الكاتب:

رفيق أحمد
أستاذ بقسم اللغة العربية جامعة شيتاغونغ - بنجلاديش
مواضيع ذات صلة
((المعلومات والآراء المقدَّمة هي للكتّاب، ولا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع أو أسرة مركز تفسير))









